شرح ثلاثة الأصول [ عبد الله أبا حسين ]
تأليف : عبد الله بن سعد أبا حسين
نبذة مختصرة
ثلاثة الأصول وأدلتها : رسالة مختصرة ونفيسة صنفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -، وتحتوي على الأصول الواجب على الإنسان معرفتها من معرفة العبد ربه, وأنواع العبادة التي أمر الله بها ، ومعرفة العبد دينه، ومراتب الدين، وأركان كل مرتبة، ومعرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في نبذة من حياته، والحكمة من بعثته، والإيمان بالبعث والنشور، وركنا التوحيد وهما الكفر بالطاغوت,والإيمان بالله، وفي هذا الملف شرح لها.
- 1
شرح ثلاثة الأصول [ عبد الله أبا حسين ]
PDF 1.7 MB 2019-05-02
- 2
شرح ثلاثة الأصول [ عبد الله أبا حسين ]
DOC 2.7 MB 2019-05-02
تفاصيل
شرح ثلاثة الأصول
عبد الله بن سعد أبا حسين
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا..
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وبعد.. فإن رسالة ثلاثة الأصول ألفها الإمام المجدد لما اندرس من معالم التوحيد والسنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان الوهبي التميمي - رحمه الله - تعالى وغفر له وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، «قد جدّ الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها»([1]).
وقد كتبها في أوائل دعوته السلفية قبل انتقاله إلى الدرعية؛ نصحًا للناس وإصلاحًا لأحوالهم ورحمة بهم، فلم يشدد في العبارة ولم يقعر في الكلام؛ بل ساق المراد بما يناسب أحوال المخاطبين على اختلاف مداركهم، ولذلك فَهٍمَ هذه الرسالة العظيمة كل من قرأها أو سمعها أو دُرّست له؛ فإن كان مريدًا للحق مقدمًا له اعتقد ما فيها من التوحيد والإسلام.
وكان المؤلف - رحمه الله - حريصًا على تبليغ ما في هذه الرسالة إلى الناس؛ ولذلك لما تمكن بمساندة الإمام محمد بن سعود - رحمهما الله تعالى - وأقاما دولة التوحيد والإسلام صار يبعث الدعاة وطلبة العلم إلى القرى والهجر؛ ليُعلّموا الناس هذه الأصول الثلاثة، وسار أئمة الدعوة بعده على هذا؛ فكان من أوائل ما يُعلَّمُ الطالب والعامي ثلاثة الأصول.
ومما يبين ذلك أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - كتب إلى أحد الأمراء أن يُلزم أئمة المساجد سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها([2])، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يقول بأنه يتعين على كل إمام مسجد تعليم جماعة مسجده هذه الأصول([3])؛ وذلك لأن المساجد هي طريق تعليم العامة ودعوتهم.
ولما جاءت المدارس النظامية في دولة آل سعود المباركة جُعل تدريس هذه الأصول الثلاثة منهجًا مقررًا لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لأن مراد الجميع – وعلى رأسهم المصنف – نجاة الناس من فتنة القبر وعذابه.
ولا سبيل إلى النجاة إلا بمعرفة أجوبة أسئلة القبر الثلاثة: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ بالأدلة.
وهذا هو مدار رسالة «ثلاثة الأصول».
* ويتعلق بهذه المقدمة مسائل:
- المسألة الأولى:
ينبغي لطالب العلم أن يفهم الرسالة فهمًا دقيقًا؛ لأنها تمثل مرحلة سابقة ومهمة لفهم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ومعرفة ضدّه وكشف الشبهات حول ذلك.
وقد اجتهدت في بيان كل عبارة من هذه الرسالة لثلاثة أسباب:
الأول: قول المؤلف - رحمه الله - عن هذه الرسالة: «قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنته من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل مسمى منها»([4])اهـ
الثاني: ليستفيد عامة طلبة العلم من معانيها العظام، ويتهيئوا إلى فهم أكبر لمسائل التوحيد وكشف شبهات المخالفين في ذلك.
الثالث: لترتيب المعلومات لدى طلاب العلم المبتدئين؛ لأن مراعاة الترتيب ضرورية لتحصيل العلم؛ فينبغي لطالب العلم أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه، ويرتب معلوماته وفوائده؛ لينبني الجديد منها على ما سبق؛ فيكمل بناء العلم شيئًا فشيئًا.
وبعض طلاب العلم يجتهد ويحفظ المتن ويقرأ الشروح والحواشي ويحضر عند معلم في ذلك؛ لكنه غير مرتب الذهب فيعطيك من المعلومة بعضها، ومن الفائدة شطرها، أو كلّها؛ على تخوف واضطراب وقد يتخلف عنه الدليل أو وجه الاستدلال.
وكل ذلك لا ينبغي أن يغيب لحظة واحدة؛ لا سيما في زمان قد اختلط فيه كثير من الأصول ببعضها، وامتزجت القاعدة بأختها؛ فخرجت لأكثر الناس صورة العلم دون حقيقته ودعواه دون تحقيقه.
ولذلك جمعت الشروح والحواشي ورتبت شرحًا يناسب كثيرًا من طلبة العلم – في ظني؛ ليفهموا المراد من هذه الرسالة العظيمة التي اعتنى بها علماؤنا رحمهم الله تعالى.
المسألة الثانية:
المؤلف - رحمه الله - لم يكتب هذه الأصول الثلاثة مرة واحدة؛ بل كتبها أكثر من مرة، فتجد في الدرر السنية (1/125-136) الرسالة كاملة وهي المعتمدة والمتداولة، وتجد بعدها (1/137-143) رسالة في معناها مع شيء من الزيادة والنقص، وثم رسالة أخرى (1/147-151)، وأخرى (1/158)، وتلاحظ في الرسائل عدا الأولى خلوَّها من المقدمات الثلاث؛ التي تتحدث الأولى عن العلم والعمل والدعوة والصبر، وتتحدث الثانية والثالثة عن أصول مهمة تتعلق بالتوحيد.
المسألة الثالثة:
ينبغي لمعلم ثلاثة الأصول أن لا يكون همُّه الوحيد أن يُلقي على المتعلم كل ما تعلمه من شروح هذه الأصول، أو يقرأ عليه شرحًا من الشروح.
بل الواجب عليه أن يتذكر أنه يحمل فحوى رسالة الأنبياء عليهم السلام، وأن يبلغها لغيره؛ فيعتني بأسلوبه وألفاظه وسياقاته بحيث تخدم الهدف الدعوي الصحيح ولا تخدم هدفًا آخر.
وإذا كان كذلك فعليه أن يعتني بالمتعلم ومقدار فهمه واستيعابه ويعطيه ما يتعلق بهذه الأصول على قدر ذلك.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه؛ فإن كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب.
وإن كان رجلًا متوسطًا ذكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد؛ مثل ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ ويصف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي - صلى الله عليه وسلم -»([5]).اهـ
المسألة الرابعة:
المتأمل لهذه الرسالة يجد أنها اشتملت على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ثلاث مقدمات: إحداها في الحث على العمل والعمل والدعوة والصبر، والثانية والثالثة حول أصول عظيمة تتعلق بالتوحيد.
القسم الثاني: مهمات في التوحيد مثل الإيمان بالبعث والرسل والكفر بالطاغوت، وتجدها في آخر الرسالة.
القسم الثالث: صلب الرسالة ولبها وهو أجوبة القبر الثلاثة بأدلتها. وهنا تنبيهان متعلقان بهذا القسم:
الأول: قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - تحت قول المؤلف: «فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذا القسم هو المقصود من الرسالة، وما تقدم من المسائل فلعل بعض تلاميذ المصنف قرنها بها»([6])اهـ
ويدل على ذلك أنه في عام 1218هـ رأى الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - - رحمه الله - - حاجة أهل مكة لبعض رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، فاختصرت رسالة للعوام تبدأ من قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية... إلى آخر ثلاثة الأصول ([7]).
ولأجل هذا لما أراد الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري - رحمه الله - المتوفى عام 1387هـ التعليق على الرسالة لم يذكر المقدمات؛ فقال: «أما بعد فهذا مختصر من كلام إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في «الأصول الثلاثة» التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها؛ وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه - صلى الله عليه وسلم -.
إذا قيل لك: من ربك... »([8])اهـ
الثاني: سأسير سيرة الشرّاح الذين سمعت منهم ونقلت عنهم في مجالسهم أو مؤلفاتهم فأشرح رسالة «ثلاثة الأصول» والمقدمات التي ألحقت بها.
وطريقتي في هذا الشرح كما يلي:
أولًا: أجعل ما أريد شرحه من كلام المؤلف - رحمه الله - بخط متميز، وفي أعلى الصفحة، وبينه وبين الشرح خط فاصل.
ثانيًا: أبدأ الشرح بذكر المعنى العام والإجمالي، وأشير إلى مراد المؤلف ومناسبة الكلام لما قبله، وإن كان ثم استدلال من المؤلف فإنني أذكر وجهه.
ثالثًا: أذكر المسائل والمباحث المتعلقة بكل فقرة.
هذا ما أحاول التزامه في هذا الشرح، وقد يتخلف شيءٌ من ذلك أحيانًا؛ إما لوضوح بعضه كمناسبة الكلام لما قبله أو المعنى العام أو غير ذلك.
هذا وإني أحمد الله الكريم المنان على تيسيره وتوفيقه، وأسأله - جل وعلا - كما يسر لي شرح هذا المتن المبارك أن ييسر لي طريقًا إلى الجنة ووالدي ومشايخي وإخواني وأقاربي.
وليتك أيها القارئ الكريم إذا وقعت على خلل أو زلل – ولا بد – أن تنصح لي وتوجه؛ فمثلي لا يكتب كتابًا أو يشرح متنًا، ولكن الوقوف عند رغبات الأحباب لما رأوا شرح الكتاب وراء إخراجه مع جملة من الأسباب.
ولا يفوتني في مقدمة هذا الشرح أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من: الشيخ الفاضل والداعية الأديب: محمد حبيب شريف السيراليوني، والشيخ: فواز عثمان صالح، والشيخ: بدر بن محمد الوهيبي، والشيخ: عبد الله بن محمد الصامل، الذين اقتطعوا شيئًا من أوقاتهم وجهدهم وصرفوه لهذا الكتاب؛ فصححوا ونقحوا وعدلوا واستدركوا حتى ارتقى هذا الشرح إلى ما سرّ الكثير من طلبة العلم.
وأتقدم أيضًا بالشكر والعرفان لصاحب فضل وإحسان: الشيخ محمد بن حمد بن نمي الذي ما فتئ يتصل بي متابعًا لهذا الشرح باذلاً ما يستطيع توفيره من مراجع، فأسأل الله العظيم أن يرزقه الولد الصالح ويعمر قلبه بالهدى والإيمان ويسكنه فسيح الجنان ووالديه وأحبابه.
لعمرك ما مال الفتى بذخيرة
ولكن إخوان الثقات الذخائر ([9])
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
الفقير إلى عفو ربه القدير:
عبد الله بن سعد أبا حسين
1/9/1424هـ
أهمية رسالة ثلاثة الأصول
1- القبر أول منازل الآخرة فمن سعُد فيه فيما بعده أسعد، ومن شقي فيه فما بعده أشقى؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجُ منه فما بعده أشد منه»([10]).
قال هانئ: سمعت عثمان رضي الله عنه يُنشد على قبر:
فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة
وإلا فإني لا أخالك ناجيًا ([11])
2- قرّرَتْ هذه الرسالة حقيقة التوحيد ودين الإسلام؛ كما قال المؤلف - رحمه الله -: «قررت ثلاثة الأصول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام»([12]).اهـ
3- من عادة أهل العلم أنهم يبدؤون في التعليم بالمختصرات قبل المطولات وبالأهم قبل المهم، وهذه الرسالة جمعت بين كونها تتحدث عن أهم العلوم وأشرفها وكونها مختصرًا فيه.
وهذا أوان الشروع في المقصود، ومن الله تعالى وحده أستمدّ العون والسداد.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــــ المعنى العـام:
ابتدأ المؤلف - رحمه الله - رسالته بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز؛ حيث بُدئ بالبسملة، وتأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في مكاتباته ومراسلاته؛ فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بكتاب يقول فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله... » الحديث([13]).
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وقد جمعت كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة»([14]).اهـ
وهكذا صنع البخاري - رحمه الله -؛ حيث ابتدأ صحيحه بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي... »، قال ابن حجر - رحمه الله -: «طريق التأسي بالقرآن الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها»([15]).اهـ
والمصنف - رحمه الله - يرى ذلك؛ حيث قال: «يُسن كتابتها [أي التسمية] أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل»([16])اهـ
قال ابن كثير - رحمه الله -: و«بسم الله» لها بركة، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول؛ فتستحب في أول الخطبة لما جاء: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم». وتستحب البسملة عند دخول الخلال.. ([17])اهـ وذكر - رحمه الله - ما نَصَّ الدليل على البداءة فيه بالبسملة من الأقوال والأعمال؛ كالذبيحة والوضوء وغيرها.
ومراد المؤلف - رحمه الله -: بسم الله أكتب هذه الرسالة، وهذا يفيده فائدة؛ وهي: التبرك والتيمن بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، وأنت أيها القارئ إذا بسملت فمرادك: بسم الله أقرأ، ومن بسمل وهو يريد الأكل فمراده: بسم الله آكل وهكذا؛ وذلك لأن الباء في «بسم الله» حرف جر مبني لا محل له من الإعراب و«اسم» مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في «بسم الله» يتعلق بفعل محذوف خاص مؤخر.
وقدرناه فعلاً؛ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا فإن الأفعال تعمل بلا شرط بينما الأسماء لا تعمل إلا بشرط.
وقدّرنا فعلاً خاصًا؛ لأن الخاصَّ أدلَّ على المقصود من العام؛ إذ من الممكن أن تقول: التقدير: «بسم الله أبتدئ». فهذا عامٌّ لا يدل على المقصود بوضوح؛ أما إذا قلت: بسم الله أقرأ. فهو أدلُّ على المقصود.
وقدَّرنا هذا الفعل الخاص مؤخرًا ليفيد الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر عند علماء المعاني؛ فإن قولك: بسم الله أقرأ. بمنزلة قولك: لا أقرأ إلا باسم الله.
و«الله» علم على الباري جل في علاه، و«الرحمن الرحيم» اسمان له سبحانه وتعالى مشتقان من الرحمة، و«الرحمن» أشد مبالغة من «الرحيم»، ومختص بالله تعالى فلا يتسمّى به غيره؛ أما «الرحيم» فيتسمى به المخلوق؛ قال ابن القيم - رحمه الله -: إن «الرحمن» دالٌّ على الصفة القائمة به سبحانه، و«الرحيم» دالٌّ على تعلقهما بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف والثاني للفعل.
فالأول دالٌّ على أن الرحمة صفته، والثاني دالٌّ على أنه يرحم خلقه برحمته.
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 43]، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 117]، ولم يجيء قط «رحمن بهم»؛ فعلم أن «رحمن» هو الموصوف بالرحمة، و «رحيم» هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها ([18])اهـ
اعلم - رحمك الله - أنه يجب علينا تعلُّمُ أربع مسائل:
الأولى: العلم؛ وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
الثانية: العمل به.
الثالثة: الدعوة إليه.
الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
بدأ المؤلف - رحمه الله - بمقدمة حول أهمية أربعة أمور، وهي معرفة أجوبة مسائل القبر الثلاثة بأدلتها والعمل بذلك والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وفي هذا تنبيه على أهمية الرسالة وضرورة تعلمها وتعليمها للناس، وفيه أيضًا تأصيل لأمور عظيمة وهي:
العلم ومكانته وعظم شأنه والذي جِماعه معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وهذه الأمور الأربعة تحققت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتختلف مقامات أتباعهم عند الله بقدر تحقيق تلك الأمور المهمة؛ بل إن هذا الدين لا يقوم إلا بتحقيق أهله لهذه المهمات الأربع.
قال ابن القيم - - رحمه الله -: «المراتب أربع، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها معرفة الحق. الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه، فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة»([19]).اهـ يعني سورة العصر.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: «اعلم»: كلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها، و«رحمك الله»: تلطف ودعاء، ومعناه: غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما تستقبل ([20])، وفي هذا إشارة إلى أن مبنى هذا العلم على التراحم بين العالم والمتعلم، كما أن نتيجته الرحمة في الدنيا والآخرة.
وكان العلماء رحمهم الله يروون لمن طلب الإجازة حديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»([21])، وهو الحديث المعروف عند أهل العلم بالمسلسل بالأولية ([22])؛ لأن التسلسل وقع في معظم الإسناد فيقول الراوي لمن بعده: وهو أول حديث سمعته منه ([23]).
قال الشيخ عبد الله البسام - - رحمه الله - - في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب: «أجازه الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف بالحديث المشهور المسلسل بالأولية: «الراحمون يرحمهم الرحمن». من طريقين: أحدهما عن ابن مفلح، والثاني عن ابن رجب، وكلاهما عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وينتهي إلى الإمام أحمد»([24]).اهـ
المسألة الثانية:
الوجوب لغة: هو الثبوت والاستقرار، ومعنى وجبت الشمس: ثبت غروبها أو أنها استقرت في سفل الفلك، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36]: أي ثبتت واستقرت بالأرض([25]).
وشرعًا: ما توعد بالعقاب على تركه ([26]).
قوله: «أنه يجب علينا»: الوجوب العيني والوجوب الكفائي، ومعنى الوجوب العيني أن يجب على كل أحد بعينه، ومعنى الوجوب الكفائي: أن يسقط الإثم عن الباقين إذا فعله من يكفي.
أما معرفة أجوبة القبر الثلاثة بأدلتها فواجب على كل أحد، وأما بقية ما ذكره في هذه الرسالة فمنه ما هو واجب عيني يجب على كل أحد معرفته، ومنه ما هو واجب كفائي؛ كمعرفة مُكث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة ونحو ذلك.
المسألة الثالثة:
العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به.
واختيار هذا التعريف للعلم راجع إلى المفهوم من ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -؛ حيث قال: العلم هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبعضهم عرّف العلم بأنه إدراك الشيء.
وحكم تعلم العلم يختلف باختلاف المعلوم؛ فمنه ما هو واجب؛ كمعرفة الصلاة وبقية أركان الإسلام، ومنه ما هو مستحب كمعرفة المستحبات، ومنه ما هو محرم كتعلم السحر.
وتستطيع أن تقسم حكم تعلم العلم المشروع إلى قسمين:
الأول: فرض عين يجب على كل مكلف كتعلم أركان الإسلام الخمسة.
الثاني: فرض كفاية؛ بمعنى أنه واجب على جميع المسلمين فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، كتعلم علم الفرائض والأصول والنحو ([27]).
المسألة الرابعة:
العمل بالعلم يختلف حكم تركه باختلاف العمل، فهناك من العمل ما تركه كفر كمن علم أن الله هو المستحق للعبادة ثم أشرك معه غيره، ومنه ما تركه كبيرة كمن علم حكم شرب الخمر ثم شربها، ومنه ما تركه صغيرة كمن علم حكم النظر إلى الأجنبية ثم نظر إليها، ومنه ما تركه مكروه كمن علم سنة من سنن الصلاة وتركها، ومنه ما تركه مباح كمن علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل القثاء ونحوه فترك ذلك مباح وفعله مباح إلا من فعله ناويًا الاقتداء([28]).
المسألة الخامسة:
الدعوة إلى العلم والعمل يختلف حكمها باختلاف العلم والعمل، وما ذكره المؤلف من معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لا بد من العمل به والدعوة إليه؛ لأنه بمعرفة هذه المسائل الثلاث والإيمان بها ينجو الناس في قبورهم.
والدعوة إلى الله - جل وعلا - على علم وبصيرة هي مهمة الأنبياء عليهم السلام، ومهمة أتباعهم وورثتهم.
وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل؛ لأن من امتثل أمرًا أمام الناس فإنه يدعوهم بذلك إلى أن يمتثلوه.
وأول ما يبدأ به المسلم في دعوته من الأوامر، التوحيد الذي هو أعظمها ثم يتدرج بعد ذلك بالأهم فالمهم كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.. » الحديث ([29]).
وعلى المسلم أن يبدأ في دعوته القولية والفعلية بأهله وأحق الناس به من والدين وأبناء وزوجة وأخوة وأقارب، ويكون ذلك بالحكمة واللين والكلام الحسن.
المسألة السادسة:
المسلم محتاج في هذه المسائل الثلاث إلى صبر فيصبر على تعلم العلم، ويصبر على العمل به ويصبر على الدعوة إليه.
والصبر على الأذى إنما يكون إذا وُجد الأذى، وقد واجه المؤلف في زمانه أنواعًا من الأذى لما دعا الناس إلى هذه الأصول العظيمة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه - صلى الله عليه وسلم - فاتُّهِم في عرضه، ورُمي بالعظائم وكيد به وطُرد؛ فصبر على ذلك ونشر الله على يديه خيرًا عظيمًا حتى أصبح من عرف أجوبة القبر الثلاثة وعمل بها ودعا إليها لا يؤذي كما كان السابقون في نجد وما حولها.
وسنة الله - جل وعلا - في خلقه أن من تعلم العلم وعمل به ودعا إليه فإنه يؤذى، والأذى عام فمنه التعب والنصب ومنه المعارضة والمخالفة ومنه ما هو أشد من ذلك كالسب والشتم وافتراء الكذب على الداعي والضرب والقتل.
وقد أمر الله - جل وعلا - خير الرسل عليه السلام بالصبر كما صبر من صبر قبله من الرسل فقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35]، وقال: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الروم: 60].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جاء عن بعض السلف ورووه مرفوعًا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إلا من كان فقهيًا فيما يأمر به، فقيهًا فيما ينهي عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما يأمر به، حليمًا فيما ينهي عنه»([30])اهـ
«فالفقه قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبًا في هذه الأحوال»([31]).
والدليل: قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1-3].
قال الشافعي - رحمه الله - تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
وقال البخاري - رحمه الله - تعالى: (باب العلم قبل القول والعمل).
والدليل قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: 19]، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
هنا يدلل المؤلف - رحمه الله - على ما سبق بيانه بدليلين أحدهما قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1-3]، وذكر بعد هذا الدليل قول الشافعي - رحمه الله - لبيان عظم هذه السورة: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم».
ونقل ابن كثير - رحمه الله - عنه «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم»([32]).
ونقل ابن القيم - رحمه الله - عنه: «لو فكر الناس»([33])، أي إذا تفكر المسلم في هذه السورة وتدبرها توصل إلى وجه الاستدلال منها.
ووجه الاستدلال هو أن الله - جل وعلا - أقسم على أن كل الناس في خسارة إلا من امتثل المسائل الأربع التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -.
فهي سورة عظيمة؛ ولذا جاء عن أبي مدينة عبد الله بن حصن الداريني، أنه قال: «كان الرجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخرة سورة العصر إلى آخرها، ثم يُسلم أحدهما على الآخر»([34]).
والدليل الآخر قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: 19]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أنه بدأ بالعلم قبل القول والعمل وهذا ما فهمه البخاري حيث بوّب في صحيحه بباب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية، فلا عمل ولا دعوة إلا بعلم.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
أقسم الله - جل وعلا - بالزمان والوقت لشرفه ومكانته، فهو المحل الذي يعمل فيه العبد فيدخل الجنة أو النار.
والواو واو القسم، و﴿العصر﴾ هو المُقسم به، وخسارة الإنسان هي المقسم عليه، واستثنى من الخسارة من أتى بأمور أربعة وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وجماع العلم وأصله هو أجوبة مسائل القبر الثلاثة.
وجاء هذا القسم مؤكدًا بثلاث مؤكدات أولها: القسم، وثانيها: مجيء «إن» في قوله ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ وثالثها: مجيء اللام التي تسمى المزحلقة في خبر «إن» حيث قال ﴿لفي خسر﴾.
المسألة الثانية:
قوله تعالى: ﴿إلا الذين آمنوا﴾ [العصر: 3]، دليل على العلم والعمل؛ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومن لازم الإيمان بالشيء العلم به.
قال ابن القيم - رحمه الله -: «والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه»([35])اهـ
وقوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 3]، دليل آخر على العمل، وليس فيه أن العمل غير الإيمان لأن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام.
المسألة الثالثة:
قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3] دليل على المسألتين وهما: الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه.
وجه ذلك ما قاله ابن القيم - رحمه الله - «وتواصوا بالحق، وصّى به بعضهم بعضًا تعليمًا وإرشادًا»([36]) اهـ. وقال ابن كثير - رحمه الله -: «وتواصوا بالحق أي أداء الطاعات وترك الحرمات، وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر»([37])اهـ
المسألة الرابعة:
قول الشافعي - رحمه الله - يبين عظم هذه السورة وأهمية التفكر فيها لأنها اشتملت على كل ما يدل الخلق إلى ربهم وخالقهم - جل وعلا -، وليس معنى كلامه - رحمه الله - أن هذه السورة تكفي عن القرآن كله من جميع الوجوه وإنما هي حجة تدل على أصول الخير والعلم وتحصيله.
ولهذا لما كتب رجل لأخيه يكفيك لطلب العلم سورة العصر فإنها كما قال الشافعي: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» فوقع في يد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - - كتب: اعلم أن قول الشافعي - رحمه الله - فيه دلالة ظاهرة على وجوب العلم مع القدرة ومن استدل به على ترك الرحلة والاكتفاء بمجرد التفكر في هذه السورة فهو خلي الذهن من الفهم والعلم والفكرة إن كان في قلبه أدنى حياة ونهمة للخير لأن الله افتتحها بالإقسام بالعصر الذي هو زمن تحصيل الأرباح للمؤمنين وزمن الشقاء بالخسران للمعرضين الضالين، وطلب العلم ومعرفة ما قصد به العبد من الخطاب الشرعي أفضل الأرباح وعنوان الفلاح، والإعراض عن ذلك علامة الإفلاس والإبلاس.([38])اهـ
المسألة الخامسة:
قوله ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾[محمد: 19] خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين؛ لأن الخطابات الموجهة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في القرآن تشمل الأمة إلا لدليل فهو قدوة عليه الصلاة والسلام وتوجيه الخطاب إلى القدوة لا يعني تخصيصه بالحكم بل هو خطاب لأتباعه والمقتدين به من حيث الأصل ([39]).
فائــدة:
المؤلف - رحمه الله - بسمل قبل ذكر الآيات التي استدل بها مع أن من عادته أن لا يُبسمل عند ذكر الدليل.
وقد يُقال بأن السبب أن هذا الدليل فيه بداية سورة، ولكنه يُعارض باستدلاله بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] ولم يُبسمل([40]).
ولعلّ التوجيه هو أن الدليل هنا استغرق سورة كاملة، فبسمل قبل ذكره، ويُستأنس لذلك بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنزلت عليَّ آنفًا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾...» الحديث([41]).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة آية من كل سورة كابن المبارك([42]) - رحمه الله -، والله أعلم.
* * *
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلّم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن.
الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولاً؛ فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.
والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: 15-16].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
يبين المؤلف - رحمه الله - أن العبد مخلوق لغاية عظيمة وهي عبادة ربه الذي خلقه ورزقه، ويدل على هذا أن الله جلا وعلا لم يترك العباد مهملين معطلين كالبهائم بلا أمر ولا نهي بل أرسل إليهم رسولاً يبين لهم طريق تحقيق الغاية من خلقهم وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.
ويدل على هذا الأصل قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: 75]، وقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]، وورد في بعض الكتب الإلهية: «ابن آدم خلقتك لأجلي، وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب»([43]).
ودليل خلق الله تعالى لنا قوله - جل وعلا -: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: 11]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56].
ودليل رزق الله تعالى لنا قوله - جل وعلا - ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: 58]، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ﴾ [سبأ: 24]، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31].
واستدل المؤلف بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: 15-16] على أن الله - جل وعلا - لم يتركنا هملاً بل أرشدنا لتحقيق الغاية ومن خلقنا ورزقنا، وضرب لنا مثلاً في هذه الآية لنعتبر منه وهو حال من أرسل إليهم موسى عليه السلام وهم فرعون وقومه وكيف أخذهم لما عصوه أخذًا وبيلاً وأغرقهم في اليم.
وهذه الأمة من أطاع منهم محمدًا - صلى الله عليه وسلم - نجا ومن عصاه فإنه متوعد بالعذاب من عند الله - عز وجل -، قال تعالى مخبرًا عن حال فرعون وقومه الذين كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 46].
ووجه الاستشهاد من الآية أن الله - جل وعلا - بين نتيجة من عصى الرسول الذي يبين للناس الغاية من خلقهم ورزقهم وكيف يحققون تلك الغاية وهي عبادة الله - جل وعلا - وحده لا شريك له.
وإنما خص موسى وفرعون بالذكر من بين سائر الأمم والرسل لأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - آذاه أهل مكة واستخفوا به بسبب أنه وُلد فيهم كما أن فرعون ازدرى موسى عليه السلام وآذاه؛ بسبب أنه رباه، ولأن خبر موسى وفرعون كانت منتشرًا بين أهل مكة لكونهم جيران اليهود([44]).
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
المسلم هو من أتى بالشهادتين ومقتضاهما ولم يأت بناقض.
وليس في كلام المؤلف أن تلك المسائل الثلاث لا تجب على الكافر بل هي واجبة عليه وسيعاقب عليه لقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المدثر: 42-45].
المسألة الثانية:
الطاعة في قوله «فمن أطاعه» هي الموافقة على وجه الاختيار، والمعصية في قوله «ومن عصاه» هي مخالفة الأمر عمدًا.
المسألة الثالثة:
الدليل على أن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - طريق إلى الجنة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: 13]، وقوله: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: 52].
وطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى واجبة ومستحبة، ومن الواجب ما هو توحيد وتركه شرك وكفر، ومنه ما هو أقل من ذلك.
كما أن معصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى محرم ومكروه، ومن المحرم ما هو كبيرة، ومنه ما هو صغيرة.
وبهذا التفصيل نسلم من الوقوع فيما وقع فيه الخوارج الذين يُكَفِّرُون بالكبيرة، وما وقع فيه المعتزلة الذين يحكمون على فاعل الكبيرة بالخلود في النار.
* * *
الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].
ــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ذكر المؤلف رحم الله هنا أصلاً عظيمًا من أصول الإسلام، وهو أن الله الذي خلقنا ورزقنا لا يرضى منا أن نتوجه إلى عبادة غيره ولو كان أفضل من خُلِقَ في السماء وهو جبريل عليه السلام أو أفضل من خُلِقَ في الأرض وهو محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كان كذلك فغيرهما من باب أولى.
واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، والمراد بالمساجد هنا المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة، وقيل أعضاء السجود ([45])، ووجه الاستدلال من الآية أنه نهى بقوله ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وهذا خطاب لجميع الإنس والجن، و«أحدًا» نكرة أتت في سياق النهي فَتَعُمُّ كل أحد من شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك.
ويدل على هذا الأصل أدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وقوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: 22]، وقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: 7].
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18] نهيٌ عن عبادة غيره، ووجه ذلك أن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولذلك قال أهل التفسير عن قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60] أي اسألوني أعطكم، واعبدوني أُثبكم، والقولان متلازمان ([46]).
ففُسّرت الاستجابة بتفسيرين أحدهما: أعطكم، وذلك إذا كان المقصود بالدعاء السؤال.
الثانية: أثبكم، وذلك إذا كان المقصود من الدعاء العبادة.
وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الكلام على أنواع العبادة والنهي عن صرف شيء منها لغير الله تعالى.
المسألة الثانية:
النكرات إذا جاءت في سياق نفي أو نهي أو شرط أو استفهام فإنها تَعُمُّ، وينبغي عليك فهم ذلك لتعرف أوجه الاستدلال في كثير من نصوص التوحيد والعقيدة.
وتطبيق ذلك هنا أن «أحدًا» نكرة جاءت في سياق نهي فَتَعُمُّ كل أحد من الجن أو الإنس أو الشجر أو الحجر.
المسألة الثالثة:
الله - جل وعلا - يغضب ويرضى، ويحب ويكره، وهذه من الصفات الفعلية التي يتصف بها متى شاء سبحانه وتعالى، ونثبتها له - جل وعلا - كما أثبتها لنفسه، قال تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [النساء: 93]، وقال ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [المجادلة: 22]، وقال: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ [التوبة: 46]، وقال: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54].
المسألة الرابعة:
قوله: «أن يشرك معه»: فيه أن الله - جل وعلا - لا يرضى أي نوع من الشرك صغيرًا كان أو كبيرًا، ظاهرًا أو خفيًا، وسواء كان ذلك الشرك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات.
ووجه ذلك أن «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فالمراد إشراكًا به.
ولكن المؤلف خصص من ذلك الألوهية حيث قال: «أن يُشرك معه أحد في عبادته» وذلك بسبب حال من يخاطبهم ويعايشهم إذ إن أكثر الخلل والزلل إنما وقع في توحيد الألوهية كما أن هذا هو الخطر الذي يحدق بهم فلفت الانتباه للشرك في العبادة، وهذا من حسن دعوته - رحمه الله - تعالى وغفر له وجزاه عن المسلمين خير الجزاء.
المسألة الخامسة:
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وسيأتي ما يتعلق بهذا التعريف عند قول المؤلف «وأنواع العبادة التي أمر الله بها» إن شاء الله تعالى.
* * *
الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
والدليل قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22].
ــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
من أتى بالمسألة الأولى وهي معرفة الغاية من أجلها خُلق، ووجوب طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لتحقيق هذا الغاية، ثم أتى بالمسألة الثانية وهي معرفة خطر الشرك بالله - جل وعلا - وأنه لا يرضاه أبدًا، وحقق النتيجة المطلوبة من العمل بمقتضى ذلك فإنه لا بد له من معرفة أصل عظيم وقاعدة متينة من أتى بها فقد حقق الإسلام، وهذا الأصل العظيم هو الولاء والبراء.
قال أهل العلم في تعريف الإسلام: «هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله»([47]).
فأصل الدّين الذي هو لا إله إلا الله: أن يحب العبد هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد ويحب أهلها، ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض المشركين.
واستدل المؤلف على هذا الأصل بقوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22].
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «يجب على المسلم أن يصارم الكفار ويعاديهم أشد المعاداة»([48])اهـ
والموالاة هي الموادة والصداقة، والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة، والمعاداة وهي مفاعلة من الحدّ، وأصل الحدّ المنع والفصل بين الشيئين يقال: حاد فلانٌ فلانًا إذا صار في غير حدّه، وخالفه في أمر، ولها عند أهل العلم معنيان([49]):
الأول: أن الكفار والمشركين كانوا في حد إبليس وجنوده وهو الكفر والمؤمنين في حد الله ورسوله وهو الإيمان([50]).
الثاني: أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد يعني القتال.
وقوله: ﴿وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ﴾ يعني لو كان من حاد الله ورسوله أبوك أو ابنك أو أخوك أو عشيرتك فإن الله - جل وعلا - قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث.
وقوله: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ أي قواهم بنصره، وقيل: المراد بالروح القرآن أو جبريل عليه السلام. ومال إلى أنه الملائكة ابن تيمية - رحمه الله -([51]).
«والقرب في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب، والمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوّك في الدين»([52]).
وفي قوله ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ سرٌ بديع وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر أرضاهم بما أعطاهم من النعيم العظيم([53]).
ومما يدل على هذا الأصل العظيم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 57]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: 23-24]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة: 4].
ويتعلق بهذا الأصل مسألتان:
المسألة الأولى:
الولاء والبراء بمعنى الحب والبغض وبمعنى الموالاة والمعاداة، وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة.
المسألة الثانية:
موالاة المشركين والكفار عظيمة من العظائم، وليست صورة واحدة، ولذلك ضبطها أهل العلم فقسموها إلى قسمين:
الأول: المُكَفِّر، وهو محبة الكفر، أو نصرة الكفار على المسلمين بقصد ظهور الكفر على الإسلام، ويسمى هذا القسم بالتولي، ودليله قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]، وقوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وكفر بما يعبد من دون الله» وقصة حاطب رضي الله عنه لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله وقال: لقد نافق. لكن لما استفصل منه النبي - صلى الله عليه وسلم - علم منه أنه نصر الكفار على المسلمين لا لقصد ظهور الكفر على الإيمان أو محبة في الكفر وإنما لقصد دنيوي وسيأتي نص الحديث كاملاً إن شاء الله تعالى.
الثاني: محبة المشركين لأجل الدنيا وهذا كبيرة من الكبائر، ومثالها: محبة الكافر لأجل منصبه أو لأجل ماله.
ودليل هذا القسم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: 1] فناداهم الله باسم الإيمان مما يدل على ثبوته لهم.
وأيضًا حديث قصة حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه فقد روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين، معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين». فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب فأنخناها، فالتمسنا فلم نر كتابًا فقلنا: ما كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجدّ أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما حملك على ما صنعت؟ » قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنًا بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أردت أن يكون لي عند القوم يدٌ يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « صدق، ولا تقولوا له إلا خيرًا». فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال: «أليس من أهل بدر؟ » فقال: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم ([54]).
تنبيه:
محبة المشركين لأجل منفعة مباحة تحصل منهم كمحبة الرجل لولده المشرك أو لوالده المشرك أو لزوجته الكتابية أو لجاره المشرك المحسن إليه محبة جائزة وليست بمحرمه يدل عليها قول الله تعالى في بيان حال نوح عليه السلام ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا﴾ [هود: 42]، وقوله: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: 45]، وأحلّ الله لنا الزواج بالكتابية وهي مشركة قال تعالى عنهم: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: 73] ولا بد للزوج أن يكون له مع زوجته مودة ومحبة قد تزيد وقد تنقص وذلك بسبب المنفعة له منها.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب عمّه أبا طالب ولذلك قال الله تعالى عنه ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56].
وسبب المحبة هنا المنفعة المباحة والرابط الذي جمع بينهما.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: «والحب الطبيعي تابع لبعض مرادات النفس والشهوات المتباينة التي تبقى ببقاء ذلك المراد وتزول بزواله.
وأما الذلّ الطبيعي فهو ناشئ عن خوف من عقوبة مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة.
وقد يجتمع الأمران في تعلقهما بالمخلوق فيحبّ غيره ويعظمه ويذل له لما يرى له عليه من حق أبوة أو إحسان أو نحوهما.
وذلك الحب والذل تابع لذلك الحق الذي فعلهما لأجله مع علمه أن المعظم المحبوب له مخلوق مثله ناقص مثله فقير مثله في جميع أحواله، وأنه لا يملك له نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا.
وأما حبه لأولياء الله وأصفيائه فهو حب تابع لمحبة الله؛ لأنه لما رأى محبة محبوبه لهم لما قاموا به من مراضيه أحبهم لله، ولهذا تقوى هذه المحبة بسبب قوة العبودية والتوحيد»اهـ ([55]).
ولا بد أن يفرق بين المحبة الطبيعية وغيرها، فمحبة الجائع للطعام ومحبة الأب لابنه الصغير، ومحبة الأخوة وأصحاب الصناعة الواحدة، وأصحاب التجارة الواحدة وما أشبه ذلك، إنما هي محبة طبيعية فالنفوس جبلت على أن تُحبّ من تعوّدت على رؤيته ومحادثته والانتفاع منه والمشاركة معه في عمل ونحوه، فتفرح برؤيته أحيانًا وتحزن لمرضه وفقده وما أشبه ذلك ([56]).
* * *
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصًا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56].
ومعنى (يعبدون): يوحدون.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو: إفراد الله بالعبادة.
وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو: دعوة غيره معه.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
مراد المؤلف - رحمه الله - أن يبين أهمية التوحيد وعظم أمره، وقد تبين لنا مما تقدم وجوب طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُمر باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123] وهذا فيه أمرٌ لنا باتباعه عليه السلام مع أننا أمرنا باتباع إبراهيم عليه السلام، من جهة أخرى حيث قال - جل وعلا -: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: 130] وملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد، وهذه الملة قد تركها فيمن بعده. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: 26-28]. وهذه الكلمة هي: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: 26-27] ومعناها: لا إله إلا الله.
وأعظم ما أمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتوحيد، وأعظم ما نهوا عنه الشرك قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36]، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك»([57]). فدل هذا على أن أوجب الواجبات التوحيد كما أن أقبح المنهيات الشرك، وورث هذا الأصل العظيم أتباع الأنبياء عليهم السلام من الدعاة المخلصين والأئمة المصلحين.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: «اعلم أرشدك الله لطاعته»: تلطف ثالث منه - رحمه الله - تعالى حيث دعا للمتعلم بالرشد إلى الطاعة وهو الاستقامة على طريق، وهو ضد الغي.
المسألة الثانية:
الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك والمستقيمة على الإخلاص لله - عز وجل -، والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدًا إلى التوحيد والمستقيم على الإسلام المقبل على الله المعرض عن كل من سواه.
وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فإنه يوصف بهذا الوصف.
قال ابن الأثير: الحنيف هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه، والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه السلام. وأصل الحَنَف الميل. ومنه الحديث «بعثت بالحنيفة السمحة»([58]).اهـ
فأصل الحنيف في اللغة الميل، وإبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله بمعنى مال إليه.
تنبيـه:
الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنما فسره بلازم المعنى، فإن الحنف هو الإقبال ومن أقبل على شيء مال عن غيره والحنف في الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتها([59]).
والملة مأخوذة من الملل وهو التكرار والمعاودة، يقال: طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى صار معلمًا ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس، وتطلق الملة على الدّين والشريعة([60]).
وقوله «ملة إبراهيم» أي ملة لإبراهيم عليه السلام فهي إضافة بتقدير اللام التي تفيد الاختصاص.
المسألة الثالثة:
قوله: «مخلصًا له الدين»: أي حال قيامك بالعبادة. قال أبو عبيد - رحمه الله - في غريب القرآن: الخالص هو الصافي، وهو ما زالت عنه الشوائب بعد أن كانت فيه.
«والدين» يطلق على الاعتقاد والعمل والعادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والدين هو الطاعة والعبادة والخلق فهو الطاعة الدائمة اللازمة»([61])، وقال: «ولهذا فسر الدين بالعادة والخلق ويفسر الخلق بالدين أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، قال ابن عباس رضي الله عنه: على دين عظيم، وذكره عنه سفيان بن عيينة، وأخذه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة وبذلك فسراه.
وكذلك يفسر بالعادة كما قال الشاعر: أهذا دينه أبدًا وديني.
ومنه: الديدن، يقال: هذا ديدنه، أي عادته اللازمة.
ويقال (في الأعلى)([62]) كما تدين تدان، وأما دين المطيع فيستعمل متعديًا ودائمًا ولازمًا يقال: دنت الله ودنت لله، ويقال فلان لا يدين الله دينًا ولا يدين لله؛ لأن فيه معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل، فإذا قيل: دان الله فهو قولك أطاع الله وأحبه، وإذا قيل: دان لله فهو كقولك ذلّ لله وخشع لله»([63]).اهـ
المسألة الرابعة:
التوحيد لغة مصدر وحّد يوحد، أي جعل الشيء واحدًا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، والألف واللام في قوله «التوحيد» للعهد الذهني؛ لأنه فسّره بإفراد الله بالعبادة.
وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بقوله «إفراد الله بالعبادة» وهو أعمّ إذ يتناول إفراد الله في كلّ ما يختص به ([64]) ولكن المؤلف خاطب الناس بحسب ما وقعوا فيه من خطأ وبحسب ما يحتاجون إلى معرفته عمليًا، فلم يُعَرف من عمومهم في نجد زللٌ في الأسماء والصفات كما لم يعرف منهم خطأٌ في توحيد الربوبية.
وهو ثلاثة أقسام:
الأول: توحيد الإلهية وهي العبادة فتكون أعمال العبد التعبدية متوجهة لله تعالى وحده.
الثاني: توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله تعالى ربّ كل شيء ومليكه وهو المدبر لأمور خلقه جميعهم.
الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من صفات الكمال التي تعرّف بها سبحانه إلى عباده ونفي ما لا يليق بجلاله وعظمته ([65]).
المسألة الخامسة:
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله» وجاء أيضًا: عبادة الله توحيد الله، والعبادة في اللغة التذلل والخضوع من قولهم طريق معّبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، وسمّيت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يفعلونها لله خاضعين ذالين([66]).
وقد جاء عن السلف عدّة تفاسير لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] منها: ليعرفون، ومنها ليُخلصوا لي العبادة، ولكن كلمة يوحدون أشمل ولذلك أتى بها المؤلف - رحمه الله - تعالى، وهو التفسير الذي رجحه الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره ([67]).
وما ورد من تفاسير عن السلف إنما هو من تفسير الشيء ببعض أفراده؛ لأن العبادة أعمّ إذ هي ذل وخضوع يتضمن فعل الطاعات التي أعظمها التوحيد.
المسألة السادسة:
الشرك هو دعوة غير الله معه وهذا التعريف يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ودعاء المسألة مثل قولك: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني.
ودعاء العبادة مثل صلاتك وصيامك فأنت عابد والعابد في الحقيقة يسأل معبوده رضاه ورحمته وجزاه.
والشرك ثلاثة أقسام: أكبر، وأصغر، وخفي، وبعض أهل العلم يجعله قسمين: أكبر، وأصغر ويجعل من الأكبر والأصغر ما هو خفي، وبهذه تكون نتيجة التقسيمين واحدة.
الشرك الأكبر مثل الدعاء والذبح والسجود لغير الله جلا وعلا وهو مخرج من دين الله وموجب لدخول النار والخلود فيها والعياذ بالله تعالى.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: «أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدًا إلا بالتوبة وأنه يحبط جميع الأعمال وأن صاحبه مخلد في النار»([68]).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: «وتفسير الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله.
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به شرعًا فصرفه لله توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر؛ فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء»([69])اهـ
والشرك الأصغر ما حكم عليه الشارع بأنه شرك، وليس فيه تنديد كامل يُلحقه بالأكبر كالحلف بغير الله تعالى ويسير الرياء.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: «الأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حدّ الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: 48]، وأنه يحبط العمل الذي قارنه، ولا يوجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة، ويدخل تحت الموازنة إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار»([70]).اهـ
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: «حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يُتطرّق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة»([71]).اهـ
وما نقلته لك من كلام بعض أهل العلم في تعريف الشرك الأكبر والأصغر إنما هو للتقريب لأنه كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: «أمور الشرك أكبره وأصغره لا تُدرك بالعدّ وإنما بالحدّ والتمثيل»([72]).اهـ
أما الشرك الخفي فما كان أصغر أو أكبر لكنه خفي، كنفاق المنافقين ويسير الرياء فالأول خفي أكبر والثاني خفي أصغر.
* * *
فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
فقل: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمدًا - صلى الله عليه وسلم -.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
المؤلف - رحمه الله - دخل في لبَّ الرسالة والمراد منها فبيّن الأصول التي يجب معرفتها على كل إنسان؛ لأن الألف واللام في قوله «الإنسان» تفيد العمود فيدخل المسلم والكافر والمنافق.
وهذه الأصول هي: معرفة الرب المعبود، ومعرفة الدين الذي يدين به للمعبود، ومعرفة الرسول الذي أرسله الرب المعبود سبحانه وتعالى.
وأخفى السائل في قوله «فإذا قيل لك»؛ لأن معرفته لا تؤثر في الجواب المطلوب معرفته بدليله، والسائل هو الملكان اللذان يأتيان الميت في قبره، وجاء في وصفهما أنهما أسودان أزرقان، واسمهما منكر ونكير.
وهذه المسائل الثلاثة هي التي يُسأل عنها العبد إذا أُدخل القبر فإن نجا وجاوز فهو السعيد وإن لم يتجاوز فهو الشقي.
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - جوابها مجملاً ثم فصل في أثناء الرسالة، وهذه طريقة معروفة عند أهل العلم باللفّ والنشر.
ومن هذا الموضع من الرسالة إلى آخرها بيانٌ لذلك، أما ما سبق فهو مقدمة وتوطئة للدخول في لُبَّ الرسالة والمراد منها، وتقدم معنا في بداية الكتاب التنبيه على أن أحد تلاميذ الشيخ أدخلها.
وقد دخل المؤلف - رحمه الله - في مقصوده من الرسالة بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أوقع في النفس وأدعى للفهم، وهذه طريقة في التعليم ([73]) استقاها المؤلف من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يخرج العلم والفائدة عن طريق السؤال والجواب، ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التفت إلى أصحابه بعد صلاة الظهر مرّة على إثر سماء [أي: مطر] ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: « يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»([74]).
وقد أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ثم قال في مسائل الباب: «وفيه إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها»([75])اهـ
ويدل على هذا أيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ رضي الله عنه: «أتدري ما حقّ الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟... » الحديث ([76]).
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وسميت هذه الرسالة بهذا الاسم؛ لأن الدين ينبني عليها، والمتأمل لواجبات الإسلام وجميع ما يتعلق به يجد أنه ينبني على هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -.
ولم يأت نص فيه ذكر أن هذه المسائل الثلاث تُسمى بالأصول الثلاثة ولكن التسمية صحيحة ([77]).
قال ابن القيم - رحمه الله - فإن قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 2-4] يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله([78]).اهـ
المسألة الثانية:
هذه المسائل الثلاث تجب معرفتها بدليلها وهذا هو مراد المؤلف - رحمه الله - حيث قال مهتمًا بذلك: «فإذا قيل لك بم عرفت ربك» أي ما هو الدليل على ما استقر عندك؟ ولذلك ذكر كل مسألة من هذه المسائل بدليلها من الكتاب والسنة؛ لكي يعرف المسلم هذه المسائل ويعتقدها بدليل لا بتقليد.
وقد دلَّ على وجوب معرفة هذه الأجوبة بأدلتها ما جاء في الصحيح أن الكافر والمنافق إذا سُئل عن هذه المسائل قال: «هاه هاه سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فلم ينفعه ترديد ما قاله الناس.
ومما يدل عليه قوله - جل وعلا - عن حال أهل الضلال ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: 22] فذم الله - جل وعلا - تقليدهم.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه كالذي يقال له في القبر من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته هو مقلّد فيضرب بمرزبة من حديد»([79])اهـ
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «فالأصول: لا يجوز التقليد فيها بالإجماع، بل يجب على كل مكلف: معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما بعث به من التوحيد، وما أخبر به عن الله من البعث بعد الموت، والجنة والنار، ومثل وجوب الفرائض، من الصلاة والزكاة، والحج، والصيام، ونحو هذا، فلا يجوز التقليد في هذا، والمقلد فيه ممن يعذب في البرزخ، كما ثبت ذلك في الأحاديث منها قوله: «وأما المنافق والمرتاب، فيقول: هاه، هاه، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»([80]).اهـ
وله - رحمه الله - تعالى رسالة تؤيد ذلك حيث بَيَّنَ فيها جهل الناس، وما فيهم من الإعراض عما خلقوا له، وما هم عليه من دين الجاهلية، وكيف أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير فتجدهم إذا بلغ أحد أولادهم عشر سنين علّموه الطهارة وألفاظ الصلاة وحيا على ذلك ومات عليه.
يقول الإمام محمد - رحمه الله - بعد ما صور حال كثير من الناس في زمنه: «أتظن من كانت هذه حاله هل شمّ لدين الإسلام الموروث عن الرسول رائحة؟
فما ظنك به إذا وضع في قبره وأتاه الملكان وسألاه عما عاش عليه من الدين؟ بم يجيب؟
هاه هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»([81])اهـ
وقال - رحمه الله -: «فمن عرف معبوده ودينه ورسوله بدليله وعمل به في الدنيا ومات عليه سئل في القبر فيجيب بالحق»([82])اهـ
المسألة الثالثة:
من اعتقد هذه المسائل الثلاث عن دليل، هل يشترط دوام استحضار أدلتها؟
بمعنى أنه لو اعتقدها بدليلها ثم نسي أدلتها مع بقاء معرفة هذه الأصول فهل يكون قد مات على الإيمان أم لا؟
والجواب عن ذلك «أنه لا يُشترط دوام استحضار الأدلة فإذا استدل على هذه المسائل من الكتاب والسنة فاعتقدها عن دليل ثم نسي الدليل بعد ذلك ومات فإنه يموت على الإيمان»([83]).
المسألة الرابعة:
قال الراغب - رحمه الله -: «المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم.
ويضاده الإنكار، ويُقال: فلان يعرف الله، ولا يُقال: يعلم الله – متعديًا إلى مفعول واحد – لَمَّا كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته.
ويقال: الله يعلم كذا، ولا يقال: يعرف كذا لما كانت المعرفة تُستعمل في القاصر المتوصَل إليه بتفكر»([84])اهـ
المسألة الخامسة:
معرفة الرب سبحانه وتعالى تكون بأسباب منها النظر والتفكر في مخلوقات الله - جل وعلا - فإن ذلك يؤدي إلى معرفته كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190-191]، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185].
ومنها: النظر في آيات الله الشرعية قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24].
ومنها: ما يُلقي الله في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه - جل وعلا - رأي العين قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»([85]).
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: «ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضًا بصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة فالكتاب والسنة مملوءة بذلك»([86])اهـ
فيوفق لاستحضار معاني أسماء الله وصفاته وآثارها في الملكوت فإذا تكلم استحضر أن الله تعالى يسمعه وإذا تحرك تذكر أن الله تعالى يبصره وإذا اختلج في صدره شيء من الإرادة أيقن أن الله تعالى مطلع على حاله ويعلم بما في فؤاده وإن لم تتحرك به شفتاه.
وهذا مقام من مقامات الدين عظيم مبناه على العلم بالله وأسمائه وصفاته لا كما يزعم المخالفون والخرافيون ([87]).
المسألة السادسة:
معرفة العبد ربه أي معرفته معبوده، هذا هو مراد المصنف - رحمه الله - حيث قال: «فمن لم يعرف ربه بمعنى معبوده سُئل عنه في القبر»([88]) اهـ. لأن الربوبية في قول المصنف «ربه» يراد بها العبودية إذ إن الرب عند الإطلاق يدخل فيه المعبود المألوه كما أن المألوه المعبود عند الإطلاق يدخل فيه الرب.
ولذلك تلحظ من المؤلف أنه فسر الرب بتفسيرين:
1- المُربّي بالنعم: حيث قال: «فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه» وهذا يقتضي الخلق والرزق وغيرها من أفراد الربوبية.
2- المعبود: حيث قال «ربّي الله» وقال «وهو معبودي ليس لي معبود سواه».
سئل الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - عن مسائل حول توحيد الربوبية فأجاب: «سرني ما ذكرت من الإشكال، وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية.. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف: 87]»([89]).
وهكذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية من مثل قول الله - جل وعلا - في سورة الزمر: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، هذا توحيد الربوبية، قال بعدها: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: 38]، قال: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ﴾، والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها هو توحيد الربوبية، وما بعدها هو توحيد الإلهية. ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه، ألا وهو توحيد الإلهية، لهذا قال - جل وعلا -: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 80]، معنى «أربابًا»: أي معبودين، وكذلك قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31]، يعني معبودين، لأن عديّ بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نعبدهم ففهم من معنى الربوبية في الآية معنى العبادة وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف: «ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه» قال: بلى، قال: «فتلك عبادتهم» إذًا الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع، تارة بالاستلزام وتارة بالقصد، وبعض علمائنا قال: إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخلا في الألفاظ التي يقال: إنها إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت([90]).
* * *
فإذا قيل لك: من ربك؟
فقل: ربي الله، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
والدليل قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2].
وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ذكر المؤلف - رحمه الله - مقدمة إجمالية للأصول الثلاثة ثم بدأ في ذكرها مفصلة أصلاً أصلاً، وبدأ بمعرفة العبد ربه.
ولفظ الربوبية فيه معنى التربية التي هي تدريج المُرّبّى في مراتب الكمال بما يناسبه، لأن الرب يأتي بمعنى المالك والسيد ([91])، ويأتي بمعنى المُصلح. قال الأصمعي - رحمه الله -: «ربَّ فلان الصنيعة يَرُبُّها ربًا إذا أتمها وأصلحها»([92]). وكل العالمين قد رباهم الله بنعمه فأمدّهم برزقه وأحاطهم برعايته سبحانه وتعالى كما قال - جل وعلا - في قصة موسى عليه السلام وفرعون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 49-50].
وأعظم أنواع التربية التي ربى الله - جل وعلا - بها عباده أن بعث إليهم الرسل يعلمونهم، ويرشدونهم إلى ما يقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى.
وأنواع التربية كثيرة منها تربية الأجسام، ومنها تربية الغرائز، ومنها تربية العقول، وكل هذا وغيره من النعم قد مَنَّ الله - جل وعلا - بها على عباده كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18].
واستدل المؤلف على كلامه بقول الله - جل وعلا -: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] يعني الوصف بالكمال والجمال والجلال والعظمة لله مربي العالمين بالنعم وخالقهم، ومالكهم، والمدبر لهم سبحانه وتعالى.
ومعنى العالمين: كل ما خلق الله كما قال: ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 164] وهو جمع عالم فنقول: عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم النبات ولا واحد لعالم من لفظه؛ لأن عالمًا جمع أشياء مختلفة فإن جعل عالم لواحد منها صار جمعًا لأشياء متفقة ([93]).
ويتعلق بكلام المؤلف مسألتان:
الأولى والثانية: تعريف الحمد والفرق بينه وبين الشكر:
الحمد: هو الثناء بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعم من الشكر، فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ومما يكون منه وفيه بالتسخير، فقد يُمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يُمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول، أي أن الإنسان يُحمد على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك ما يكون منه باختياره، ولا يُحمد على صباحة الوجه وطول القامة وحسن الخِلقة ونحو ذلك مما ليس فيه اختيار.
والشكر: لا يُقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد، وليس كل حمدٍ شكرًا، وكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدًا ([94]).
قال ابن القيم - رحمه الله -: «الفرق بين الحمد والمدح أن يُقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارًا مجردًا من حب وإرادة أو مقرونًا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبارٌ عن محاسن الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه»([95]).اهـ
* * *
فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟
فقل: بآياته، ومخلوقاته.
ومن آياته: الليل والنهار، والشمس والقمر.
ومن مخلوقاته: السماوات السبع، والأرضون السبع، وما فيهن، وما بينهما.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: 37].
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لما كانت الربوبية تحتاج إلى معرفة وعلم عن طريق وسائل ودلائل ذكر المؤلف - رحمه الله - شيئًا من ذلك، ومما يدل على مراد المؤلف قول الله تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: 101]، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185].
فإذا نظر العبد في هذا الملكوت من سماء وأرض وليل ونهار أيقن بأن له ربًا معبودًا واحدًا، وهذا هو مراد المؤلف - رحمه الله -.
قوله: «فقل بآياته ومخلوقاته»: أي: فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، التي نصبها دلالة على وحدانيته، وتفرده بالربوبية والإلهية، والآيات: جمع آية؛ والآية العلامة والدلالة، والبرهان والحجة، والمخلوقات: جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد العدم، وآيات الرب سبحانه هي: دلالاته، وبراهينه التي بها يعرفه العباد، ويعرفون أسماءه وصفاته، وتوحيده، وأمره ونهيه، وآياته العيانية الخلقية، والنظر فيها، والاستدلال بها، يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية.
والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به، وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته، التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية، والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر، والعقل والفطرة، وكل شيء من آياته ومخلوقاته، وإن دق - دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية.
كما قال الشاعر:
فواعجبا كيف يُعصى الإله
أم كيف يجحده الجاحد
ولله في كل تحريكة
وفي تسكينة أبدًا شاهد
وفي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد
وقال آخر:
تأمل في نبات الأرض وانظر
إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لُجين شاخصات
بأبصار هي الذهب السبيك
على قصب الزبرجد شاهدات
بأن الله ليس له شريك
وقال آخر:
تأمل سطور الكائنات فإنها
من الملك الأعلى إليك رسائل
قد خط فيها لو تأملت خطها
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
فإيجاد هذه المخلوقات: أوضح دليل على وجود الباري تعالى، وتفرده بالربوبية والإلهية.
ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضًا: بصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوء بذلك.
وقوله: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ [فصلت: 37] أي: ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار، الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه، حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل، حتى كأن الليل لم يكن، فمجيء هذا، وذهاب هذا بهذه الصفة، وهذه الصورة المشاهدة، دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده، قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص: 71، 72].
وقوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ أي: ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار، الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: 40] دل أعظم دلالة، على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس.
وقوله: (ومن مخلوقاته: السماوات السبع، والأرضون السبع، وما فيهن، وما بينهما): أي: ومن أعظم مخلوقات الله، الدالة على وحدانيته تعالى، السموات السبع، وسعتها وارتفاعها، والأرضون السبع، وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السموات السبع، من الكواكب الزاهرة، والآيات الباهرة، وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار، وأصناف المخلوقات، من الحيوانات والنباتات، وسائر الموجودات، وما بين السموات والأرض، من الأهوية والسحاب، وغير ذلك: دال على وحدانية الباري جل جلاله، وعلى تفرده بالخلق والتدبير.
واستدل المؤلف بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: 37] على أن من حجج وحدانية الله تعالى، وبراهين فردانيته، الدالة على ما تقدم: ما تعرف به تعالى إلينا، بما نراه من مخلوقاته. ومنها: الليل والنهار، فمجيء هذا، وذهاب هذا من دلائل قدرته، وحكمته الدالة على وحدانيته. والشمس والقمر، مخلوقان مسخران دائبان يجريان: دالان على تفرده تعالى، بالخلق والتدبير. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية ههنا.
وقوله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت: 37] لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما، يعتريهما التغير، فلا يستحقان أن يسجد لهما.
بل المستحق للسجود والتعظيم والعبادة خالق الشمس والقمر والليل والنهار وهو الله - جل وعلا - ولذلك قال: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: 37].
واستدل المؤلف أيضًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الأعراف: 54] على أن من أعظم الدلائل، والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده: خلق السموات والأرض، من غير مثال سبق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام.
وأصل الخلق: إيجاد المعدوم، على تقدير واستواء، وإبداعه من غير أصل سابق، ولا ابتداء مقدم. قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: 117]، وقال: ﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: 46].
وقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: 54]، أي استواء يليق بجلاله وعظمته، قال الإمام مالك: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق»([96]). وبهذا قال السلف، وأدلة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه: أكثر من أن تحصر، وأجمع السلف على ذلك.
وقوله: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ [الأعراف: 54]، أي: يأتي بالليل، فيغطي به النهار، ويلبسه إياه، حتى يذهب بنوره ويغشي النهار بالليل، يطلبه حثيثًا، طلبًا سريعًا، لا يفصل بينهما شيء، ولا يدرك أحدهما الآخر.
وقوله: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ [الأعراف: 54] أي: مذللات، جارية في مجاريها بأمر الله، لا تتقدم ولا تتأخر؛ وإذا تأملت هذا العالم: وجدته على أحسن نظام وأتمه، وأدلِّه على وجود خالقه - جل وعلا -، ووحدانيته وقدرته، وكمال علمه وحكمته.
وقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54] أي: هو المتفرد بالخلق، كما أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق، كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله، وله الأمر كله، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82].
وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54] أي: بلغ في البركة نهايتها، إله الخلق ومليكهم، وموصل الخيرات إليهم، ودافع المكاره عنهم، والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
والشاهد من الآيتين: أن الله - جل وعلا - خالق هذا الملكوت العظيم بما فيه من مخلوقات ثابتة كالسماء والأرض، أو متغيرة كالشمس والقمر والليل والنهار وكل ذلك دليل على الله خالقها وموجدها ومصرفها، كما أنه دليل على استحقاقه للعبادة؛ لأن الخالق لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة.
والمتأمل لهذه المخلوقات العظيمة والتي تسير بنظام دقيق: يُدرك أن لها ربًا مالكًا مصرفًا مدبرًا وفق حكمة عجيبة وقدرة عظيمة وهو الله - جل وعلا - وتقدس وتعاظم قال تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: 40].
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
آيات الله - جل وعلا - نوعان: كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي الذي أنزله على رسله.
قال محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسيره العجاب: «والسماوات والأرض وكل موجود من خلقه فمن آياته، والقرآن أيضًا من آياته»([97])اهـ
المسألة الثانية:
المؤلف عطف المخلوقات على الآيات، والعطف غالبًا يقتضي المغايرة، وهذا يدل على أنه فرق بينهما.
والمؤلف فعل ذلك لسبب لطيف وهو أن الآيات جمع آية وهي العلامة والدلالة والبرهان والحجة الواضحة البنية لما يُراد منها كما قال - جل وعلا -: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: 75]، أي لدلالات واضحات بينات.
وإذا تأملت الجواب وجدته يقول: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السموات السبع والأرض ومن فيهن وما بينهما.
فمثَّل للآيات بمتغيرات لا تثبت وهي الليل والنهار والشمس القمر فهذا يذهب وذاك يجيء وهذا يشرق وذاك يغيب.
ومثّل للمخلوقات بثوابت لا تتغير فيُصبح العبد ويُمسي ويكبر وهي ثابتة في نظره لم تتغير ولم تتبدل.
فكون المتغيرات أمثلة للآيات أظهر وأوضح؛ لأن ذلك ظاهر بَيِّنٌ واضح للمراد منه.
ولهذا طلب إبراهيم عليه السلام الاستدلال بالمتغيرات: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ﴾ [الأنعام: 77] ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا﴾ [الأنعام: 77] ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً﴾ [الأنعام: 78] أما السماوات والأرض فلا تدل بظهور ووضوح كدلالة المتغيرات عند عامة الناس وإن كانت تدل بظهور عند أصحاب الفهم السليم واللب القويم، فالمتغيرات من ليل ونهار وشمس وقمر تُحدث أسئلة لدى الناظر:
لم ذهب ذاك؟ لم جاء الآخر؟
من المُسيّر لما يُحدث التغيير في الأرض؟
فهي في الدلالة أوضح وأظهر من المخلوقات الثابتة مع أن في الجميع دلالة على المراد.
فالمؤلف - رحمه الله - يُخاطب عامة الناس وسكان المدن والبوادي والصغير والكبير والذكر والأنثى فلا بد أن يراعي حالهم، ولأجل ذلك فرّق - رحمه الله - تعالى رحمة واسعة وجزاه عمن قرأ وسمع رسالته خير الجزاء.
هذا من جهة ومن جهة أُخرى تجد أنه اتبع النصوص في التسمية حيث جاءت تسمية السماوات والأرض بالمخلوقات وجاءت تسمية الليل والنهار والشمس والقمر بالآيات مع أن المخلوقات التي ذكرها آيات قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190].
المسألة الثالثة:
الأدلة على معرفة الرب ثلاثة:
1- دليل فطري.
2- دليل عقلي.
3- دليل نقلي.
وتقدم معنا ذكر بعض أسباب معرفة الرب تبارك وتعالى ([98]).
والمصنف - رحمه الله - اختار الدليل العقلي فقال: «بآياته ومخلوقاته» إذ عند التأمل فيها يصل العقل إلى أن لها ربًا واحدًا مدبرًا وفق حكمة عجيبة وقدرة عظيمة، وإذا كان كذلك فهو المستحق للعبادة.
وهذا دليل محكم يعرفه كل أحد كما قال الأعرابي:
«البَعَرةُ تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير»([99]).
أما الدليل الفطري فالمراد منه أن الإنسان مفطور على أن للكون خالقًا واحدًا قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» متفق عليه.
المسألة الرابعة:
ذكر السجود في قوله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: 37]؛ لأنه عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغير فلا يستحقان أن يسجد لهما.
والرب هو المعبود.
والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 21-22].
قال ابن كثير - رحمه الله - تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لما قرّر المؤلف - رحمه الله - ربوبية الله على مخلوقاته ودلل على ذلك من كلام الله - جل وعلا - لم يبق لدى السامع والقارئ إلا التسليم للنقل والعقل على المراد وهو أن رب هذه المخلوقات هو الله - جل وعلا -.
وإذا حصل ذلك فإن هذا الرب هو المعبود وحده لا شريك له. ودلل على ذلك من كلام الله - جل وعلا - وهو قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 21-22].
ووجه الاستشهاد من الآية واضح بيِّن وهو أن من ثبتت له الربوبية على خلقه تثبت له الألوهية، والرب هو المعبود، ولذلك جاء الأمر في الآية بعبادة من ثبتت له الربوبية من خلق وإيجاد ورزق وغير ذلك.
فلما قال سبحانه: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ كأن ما بعد ذلك سياق جواب على سؤال وهو: لم استحق العبادة؟
فجاء الكلام بعدها تعليلاً: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشًا وبساطًا تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها والانتفاع بمنافعها.
وجعل لكم السماء بناءً وقبة مضروبة وسقفًا محفوظًا مزينًا بالمصابيح والعلامات التي يهتدون بها في ظلمات البر والبحر.
وأنزل من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم.
وسمّى السحاب سماءً؛ لأن كل ما علاك فهو سماء.
قال أبو عبيدة والزجاج: «السماء سقف كل شيء وكل بيت، والسماء السحاب»([100])اهـ
فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون.
ثم ذكر كلام المفسر عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الحافظ المشهور بابن كثير والذي عرف عنه ذكر تفاسير السلف واعتمادها وعدم الحيد عنها.
وذلك لكي يُبَيِّن للسامع والقارئ أن هذا الفهم لكلام الله - جل وعلا - ليس جديدًا محدثًا وإنما نقله الخلف عن السلف من علماء المسلمين وأئمة الدين.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
أسلوب القرآن: الاستدلال بالربوبية على الألوهية.
والله - جل وعلا - كثيرًا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية.
قال ابن القيم - رحمه الله - عن قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 21-22] «فأمرهم بعبادة ربهم وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا، وكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكًا خالصًا حقيقيًا وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه فعبادته له وشكره إياه واجب عليه ولهذا قال ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ ولم يقل إلهكم، والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له.
ثم قال: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ فنبه بهذا أيضًا على وجوب عبادته وحده وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم كما قال في غير موضع من القرآن ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: 25]، فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود؟ وكيف تجعلون معه شريكًا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟
وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية»([101]).اهـ
وقال - رحمه الله -: «وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فيقرر كونه معبودًا وحده بكونه خالقًا رازقًا وحده»([102]).اهـ
المسألة الثانية:
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21] خطاب لجميع الخلق، وهو أول أمر يمر بك في المصحف، كما أن أول فعل يمر بك هو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وهذا أول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم حيث كان قولهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: 273]، قال ابن عباس رضي الله عنهما «عبادة الله توحيد الله».
المسألة الثالثة:
صدور العبادة من غير توحيد لا تسمى عبادة كمن يشرك مع الله تعالى غيره إذ هي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه.
ومن عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة، ولذلك سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد مثل إخلاصهم عند ركوب البحار وتلاطم الأمواج.
* * *
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل:
الإسلام، والإيمان، والإحسان ومنه الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخشية، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها - كلها لله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لما قرر المؤلف - رحمه الله - أهمية التوحيد ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ناسب أن يذكر بعد ذلك أنواع العبادة التي يُعبد الله بها.
وأشار بقوله «التي أمر الله بها» إلى حدّ العبادة وتعريفها عند بعض العلماء وهو «ما أُمر به من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي»([103])، يعني: لم يُعلم أنه عبادة إلا من الشارع ([104])، ولهم تعاريف غير ذلك، وتقدم معنا أجمعُ تعاريفها وهو أنها «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وسبق ذكر تفصيل يتعلق بتعريف العبادة عند قوله «اعلم أرشدك الله لطاعته» وقد ذكر المؤلف أنواعًا كثيرة من العبادة؛ يقصد بذلك ذكر صور العبادة في تعريف شيخ الإسلام فذكر عبادات قولية وعبادات عملية وذكر عبادات ظاهرة وعبادات باطنة.
والمؤلف لم يقصد الاستيعاب عندما ذكر صورًا للعبادة وإنما اكتفى بأربعة عشر نوعًا تدخل تحت تعريف شيخ الإسلام للعبادة فمنها قولي ومنها فعلي، ومنها ظاهر ومنها باطن، ولذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في رسالته العبودية «العبادة جنس تحته أنواع»([105]).اهـ، وذكر أنواعًا أكثر من المذكور هنا.
والنوع كل ضرب أو صنف من كل شيء، وهو أخص من الجنس.
وقوله «التي أمر الله بها» أي أمر إيجاب أو استحباب؛ لأن المستحب مأمور به بدليل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: 77] ولكن هذا الأمر ليس على وجه الإلزام.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
تتعلق بشرح تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة لأنك تصل به إلى مراد المؤلف بسهولة ويُسر. من قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.([106])اهـ
وقوله: (اسم جامع): يريد به أنه يجمع أفرادًا وأنواعًا كثيرة مما يحبه الله تعالى ويرضاه. ونصل إلى أن هذا النوع من فعل أو قول يحبه الله ويرضاه، بأن يأمر الله تعالى به أو يخبر بأنه يحبه ويرضاه أو يثني على فاعله وقائله.
وقوله: (من الأقوال والأفعال): يدل على أن هناك عبادات قولية، وهناك عبادات عملية وليس قسم ثالث لها.
وقوله: (الظاهرة والباطنة): يريد به أن يبين أنواع العبادات القولية وأنواع العبادات الفعلية، فمن العبادات القولية ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ومن العبادات العملية ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن.
فالأقوال الظاهرة مثل الذكر باللسان وتلاوة القرآن وقول المعروف.
والأقوال الباطنة مثل: قول القلب وهو نيته وقصده.
والأعمال الظاهرة مثل الحج والصلاة والذبح والأعمال الباطنة مثل الإخلاص والتوكل.
وظاهر كلام المصنف - رحمه الله - أن الإسلام والإيمان والإحسان من أنواع العبادة، والمعروف أن هذه الثلاثة أنواع تمثل الدين لما جاء في الحديث الصحيح «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» فهذه تسمية منصوص عليها.
ثم إن الخوف والرجاء من أقسام الإيمان وليس قسمين له، كما أن الذبح والنذر من أقسام الإسلام وليس قسمين له.
فيُحمل كلام المؤلف على أنه يقصد بالإسلام والإيمان والإحسان أن أفرادها تكون لله تعالى.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - عن هذه الجملة: «مثل الشيء شبيهه ونظيره، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين، وأهم أنواع العبادة فلذلك بدأ بها المصنف - رحمه الله -»([107])اهـ
المسألة الثانية:
قوله: (ومنه الدعاء): فيه أن المؤلف اعتبر العبادة بمعنى الذل والخضوع واعتبر الدعاء بمعنى السؤال والطلب؛ ولذا فإن العبادة في كلامه أعم من الدعاء، وهذا الاعتبار من المؤلف - رحمه الله - هو المناسب لأفهام من يخاطبهم بهذه الرسالة.
والمشهور عند بعض أهل العلم أن الدعاء أعم من العبادة والتوفيق بين القولين أن يُنظر إلى الاعتبارات فإن كانت العبادة بمعنى الذل والخضوع، والدعاء بمعنى السؤال والطلب فالعبادة أعم من الدعاء.
وإن كان الدعاء بمعنى الذل والخضوع أي التعبد، والعبادة بمعنى الصلاة والزكاة أي المتعبد به فالدعاء أوسع وأعم من العبادة.
المسألة الثالثة:
قوله: (ومنه): قال بعض أهل العلم بأن الصواب «ومنها»، والأخطاء المطبعية واردة.
وبعضهم يقول بأن الضمير يعود إلى قوله «أنواع»، والله أعلم.
* * *
والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
هنا يدلل المؤلف - رحمه الله - على استحقاق الله - جل وعلا - وحده دون سواه لأنواع العبادات المتقدمة.
وقوله: (فلا تدعوا): أي دعاء العبادة أو دعاء المسألة؛ لأن الدعاء يُطلق في النصوص ويراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد يُراد به أحدهما دون الآخر لقرائن أما هذه الآية فعامة في دعاء العبادة ودعاء المسألة، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60].
وقوله - جل وعلا - عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا * فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [مريم: 48-49].
ففسر الدعاء في الآية الأولى بالعبادة في الآية الثانية وهذا أصل مهم في ردّ شبهات المشركين إذ إن بعضهم يزعم أن قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18] إنما جاءت بخصوص عبادة الدعاء لا بعموم أنواع العبادة، والردّ عليهم يكون بما تقدم تقريره من أن الدعاء يأتي في النصوص ويُراد به المسألة والعبادة.
وتحديد المراد بأحدهما دون الآخر بدون قرينة نوع تحكمّ.
قوله: (المساجد): فُسّرت بأنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده، فلا تعبدوا فيها غيره.
وفسّرت بأنها الأعضاء التي خلقها ليسجد له عليها؛ وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان فلا يسجد بها لغيره ([108]).
و«أحدًا» كلمة شاملة عامة وهي نكرة في سياق النهي فتعمّ كل أحد من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم فلا يُدعى مع الله أحد منهم ([109]).
وهنا تنبيه:
المؤلف - رحمه الله - ذكر نوعين من الأدلة على مسألة وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة.
النوع الأول: استدلال عام كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117].
وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60].
فهذه الأدلة وأمثالها يصلح الاستدلال بها على كل عبادة بعينها ويصلح الاستدلال بها على مسألة وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة.
النوع الثاني: استدلال خاص بكل عبادة على حدة كدليل الخوف قول الله - جل وعلا -: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175]. ودليل الذبح قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163]، وهكذا مما سيأتي بيانه مفصلاً إن شاء الله تعالى.
فيستدل المسلم على كل نوع من أنواع العبادة بالأدلة الخاصة، ويثبت أنها عبادة يجب إفراد الله تعالى بها ثم بعد ذلك يستدل بالأدلة العامة التي تصلح لكل عبادة؛ فينوع الاستدلال ويكثر من الاحتجاج؛ ليمضي الحق واضحًا جليًا، ولا يبقى للسامع أو المناظر حجة أو شبهة. ولا بد لطالب العلم من فهم هذه المقدمة ليحصل له إدراك المراد من الأدلة التي يسوقها المؤلف.
وهنا أذكر لك ما تستعين به على إثبات العبادة:
قال محمد بن جرير الطبري - رحمه الله -: «كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثوابًا وجزاءً، وعلى تركه عقابًا وعذابًا وإن لم يكن خارجًا ظاهره مخرج الأمر ففي معنى الأمر»([110]).اهـ
ويقول الشاطبي - رحمه الله -: «ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي ونحو ذلك فهذا يدل على طلب الفعل في المحمود وطلب الترك في المذموم»([111]).اهـ
* * *
فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لما قرر - رحمه الله - وجوب إفراد الله بالعبادة وبَيَّنَ ذلك وأوضحه غاية الإيضاح، ثم بَيَّنَ بعض أنواع العبادة التي يجب صرفها لله تعالى وحده لا شريك له، ودليل وجوب إفراد الله بالعبادة؛ تكلم هنا عن حكم من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى.
وقرّر أن من فعل ذلك فهو مشرك الشرك الأكبر واستدل لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117]، وقد تقدم معنا أن لفظ الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة ويدخل في ذلك جميع العبادات.
و«من» شرطية عامة تشمل الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والإنس والجن، ويخرج من هذا العموم الصغير والمجنون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل»([112]).
والفاء في قوله: (فهو مشرك كافر) داخلة على جواب الشرط.
وقوله: (لا برهان له به): فيه بيان حقيقة من دعا من دون الله - عز وجل -، فلا برهان ولا دليل ولا حجة تبرر له فعله وجرمه، وليس مفهوم الكلام أن هناك من يدعو مع الله إلهًا آخر وله برهان وحجة ودليل، وإنما قوله «لا برهان له» جملة حالية، والحال في معنى الوصف، وهي صفة كاشفة بمعنى أن هذه الصفة الكاشفة لا مفهوم لها.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - قوله: ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ صفة أخرى للإله، لازمة له، جيء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء ([113])اهـ
وقوله: (إنه لا يفلح الكافرون): يدل على أن من فعل ذلك فقد كفر؛ لأن الله - جل وعلا - سماهم كافرين لدعائهم معه غيره، ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره.
تنبيـه:
قوله: (مشرك كافر): تأكيد للحكم، وكل شرك كفر وليس كل كفر شركًا، ومثال ذلك أن الذبح لغير الله شرك ويقال عنه كفر، أما سبٌّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكفر ولا يقال عنه شرك.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: «والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله، واسمٌ لمن لا إيمان له، وقد يُفّرق بينهما فيُخصُّ الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله فيكون الكفر أعم»([114]).اهـ
* * *
وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة».
والدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
شرع المؤلف - رحمه الله - هنا في ذكر أدلة بعض أنواع العبادة، وبدأ بعبادة عظيمة جليلة وهي عبادة الدعاء.
ومما يبين فضل الدعاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل العبادة الدعاء»([115])، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]([116]).
والدعاء منه ما هو سؤال وطلب ومنه ما هو استغاثة ومنه ما هو استعاذة ومنه ما هو استعانة.
وسؤال غير الله - جل وعلا - ما لا يقدر عليه إلا الله شرك وكفر كمن يسأل «البدوي»([117]) أن يُفرّج كربته أو يسأل محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أن يشفي مريضه.
تنبيـه:
هذه العبادات ذكرت هنا على وجه الإجمال ومكان التفصيل فيها شرح كتاب التوحيد؛ لأن المؤلف - رحمه الله - عقد للخوف بابًا مستقلاً وللتوكل بابًا وللرجاء بابًا وللاستغاثة بابًا وللدعاء بابًا وللذبح بابًا وللنذر بابًا.
ويتعلق بكلام المؤلف مسألتان:
المسألة الأولى:
أنه استدل بحديث «الدعاء مخ العبادة» ومخ الشيء خالصه وهو في المعنى كحديث «الدعاء هو العبادة» وفيه أنه أتى بضمير الفصل، والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، وفيه أيضًا أن العبادة لا تختلف عن الدعاء وإنما هي العبادة لا تختلف عن الدعاء وإنما هي الدعاء نفسه، والدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة كما تقدم.
المسألة الثانية:
أنه استدل أيضًا بقول الله - جل وعلا - ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60] معنى داخرين ذليلين صاغرين حقيرين، ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالدعاء، وأمره هذا يدل على أنه محبوب لديه مرضيٌ عنده، كما جاء في الحديث الصحيح «من لم يسأل الله يغضب عليه» وفي رواية «من لم يدع الله يغضب عليه» وهذا يدل على أن الدعاء عبادة من العبادات يجب إفراد الله تعالى بها.
* * *
ودليل الخوف قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
أي دليل كون الخوف عبادة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175]، وأول هذه الآية ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: 175] فنهى الله - جل وعلا - عن الخوف من غيره وأمر بالخوف منه.
ولا يأمر الله - جل وعلا - إلا بما هو محبوب لديه ومرضيٌ عنده، وإذا كان كذلك فإن تعريف العبادة يصدق على الخوف المراد هنا؛ لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والخوف عمل القلب وقد يظهر أثره على الجوارح.
وهناك وجه استدلال آخر من هذه الآية وهو أنه قال: ﴿وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175] فجعل حصول الإيمان مشروطًا بالخوف منه سبحانه وتعالى والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافون ولا تخافوهم، وهذا يدل على وجوب إفراد الله تعالى بالخوف المراد في الآية.
والخوف المراد هنا هو خوف السر وهو أن يخاف أن يصيبه أحد في نفسه بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة بحيث لا يمكن الاحتراز منه كأنه يخاف من «البدوي»([118]) أن يصيبه بمرض أو مصيبة أو يخاف من الجني أن يصيبه بالفقر أو يخاف من الولي مثلاً أن يعطل شيئًا في سيارته وهو يسير فيها بغير سبب ظاهر ومباشر.
وهذا ليس لأحد من الخلق، وإنما هو لمن له الملكوت كله ومن هو على كل شيء قدير، فيرسل ما يشاء ويمسك ما يشاء بدون أسباب يعلمها العبد وقد يكون لبعضها أسبابٌ معلومة.
وقد كان المشركون يخافون آلهتهم أن تصيبهم بسوء قال تعالى في قصة حجاج إبراهيم عليه السلام وقومه: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 81-82]، وقال عن قوم هود: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: 54] يعني بمصيبة في نفسك من اختلال عقل أو اختلال جوارح، وذلك لأنهم يخافون من آلهتهم خوف السرّ المبني على أن هذه الآلهة تصيب بمصائب من غير أسباب ظاهرة بَيِّنَة وهذا لا يكون إلا لله وحده جل جلاله.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله -: «خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره»([119])اهـ، وقال: «فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً؛ لأن هذا من لوازم الإلهية، سواءً ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال»([120]).اهـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «خوف السر هو أن يخاف الإنسان من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس»([121]).اهـ
فائـدة:
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «العبادة: كونه ما يدعو إلا الله ولا ينذر إلا الله ولا يذبح إلا له، ولا يخاف خوف السر إلا منه...»([122]).اهـ
وكلمة «السر» كانت تطلق في ذلك الزمان ويُراد بها الألوهية، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «والألوهية هي التي تسمى في زماننا: السر»([123]).اهـ
وبهذا ندرك سبب استخدام أئمة الدعوة لهذه الكلمة التي لا يُفهم معناها عند البعض في هذا الزمن.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى: التعريف العام للخوف:
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: «الخوف مصدر خاف فزع ووجل، لكن الخوف يتعلق بالمكروه والفزع بما فاجأ منه وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. والوجل من غير متعد، والخوف من متعد»([124])اهـ
وعرّفه بعضهم بنتيجته فقال: اضطراب القلب ورجفانه.
وقال بعضهم: هو الهروب. وبعضهم قال: وصف يقوم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر وترك النواهي ([125]).
المسألة الثانية:
الخوف أقسام أربعة وهي:
1- خوف السرّ: وقد تقدم تعريفه وضابطه، أما حكمه فشرك أكبر.
2- الخوف الطبيعي: وهو أن يخاف من الأسباب التي جعل الله فيها ما يخافه ابن آدم، كالخوف من النار أن تحرقه والخوف من السبع أن يعدو عليه والخوف من العقرب أن تلدغه والخوف من السلطان الظالم أن يعتدي عليه.
وهذا الخوف جائز ولا ينقص الإيمان لأنه مما جُبل عليه الخلق.
3- أن يخاف من الخلق في أداء واجب من الواجبات كأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفًا من الناس أو يترك الصلاة؛ لئلا يعيب عليه جُلساؤه ونحو ذلك.
وهذا الخوف نصفه كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: «مُحَرَّم ونوع شرك»([126]).
وقال ابن عثيمين - رحمه الله -: «إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم»([127])اهـ
ولا بد من ضبط هذا النوع من الخوف وتمييزه؛ لئلا يتداخل مع خوف السر الذي هو شرك أكبر.
4- خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ [إبراهيم: 14]، وقال: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46]، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان ([128]).
ودليل الرجاء قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
دليل كون الرجاء عبادة قوله - جل وعلا -: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110].
ووجه الاستدلال من الآية أن الله - جل وعلا - امتدح من يرجو لقاءه وجعل طريق ذلك العمل الصالح وترك الشرك ولما امتدح من عمل ذلك العمل القلبي، دلّ على أنه محبوب لديه مرضيٌّ عنده وإذا كان كذلك، فإن تعريف العبادة ينطبق على الرجاء المراد هنا فهو عبادة يجب صرفها لله تعالى وحده.
«فمن رجا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر»([129]).
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الرجاء:
وصف قائم بالقلب يؤدي إلى التوقع والأمل والطمع، واختلفت تعاريف العلماء حوله؛ لأنه معنى نفسي يدركه كل أحد ولكنه لا يقوم بذاته بحيث تقول هذا هو الرجاء مجردًا، بل لا بد أن تكون هناك ذات يقوم فيها هذا المعنى، وهذا هو الحال في جميع المعاني النفسية كالمحبة والخوف والرغبة والرهبة.. الخ.
فإذا رأيت كلام أهل العلم في تعريف هذه المعاني، فاعلم أن كلامهم إنما هو تقريب.
وسأذكر لك بعض ما وقفت عليه من تعاريف لأهل العلم حول الرجاء وغيره من المعاني النفسية؛ والتي أمرنا الله - جل وعلا - بالتعبد له بها وأن لا نوجهها لغيره.
قال الزَّجَّاج - رحمه الله - في قوله ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا﴾ «أي يأمل»([130])اهـ. وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: «توقع وأمل»([131])اهـ. وقال محمد التتائي - رحمه الله -: «والترجي تعلق القلب بمطموع حصوله في المستقبل مع الأخذ في عمل تحصيله»([132])اهـ
المسألة الثانية:
الرجاء الذي هو عبادة لا تصرف لغير الله تعالى، هو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله وحده، كالطمع في شفاء مريض أو تفريج كربة أو دخول الجنة أو النجاة من النار أو السلامة من المصائب.
ويكون الرجاء شركًا أكبر إذا توجه الرجاء والطمع في شيء لا يقدر عليه إلا الله إلى غير الله، كمن يتوجه برجائه في شفاء المرض والرزق بالمولود إلى أحد الأموات والغائبين.
وقد يكون شركًا أصغر وذلك بحسب ما يقوم في القلب ([133]).
المسألة الثالثة: الفرق بين الرجاء وغيره مما يقاربه:
1- الفرق بينه وبين التمني: نقل ابن حجر عن بعضهم: أن بينهما عمومًا وخصوصًا فالترجي في الممكن، والتمني في أعم من ذلك ( )اهـ
قال ابن النجار - رحمه الله - «والفرق بينهما أن التمني يكون في المستحيل والممكن، والترجي لا يكون إلا في الممكن»( )اهـ
2- الفرق بينه وبين الطمع: قال التتائي - رحمه الله -: «الترجي تعلق بمطموع حصوله في المستقبل، مع الأخذ في عمل تحصيله، فإن عُري عن عمل فطمع»( ).
ولأجل أنه تعلق بمطموع به عرّفه بعض أهل العلم بأنه طمع كما فعل ذلك العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - ( ).
وهنا تنبيه متعلق بهذه المسألة:
رجاء غير الله تعالى منه ما هو طبيعي، وهو أن يتوجه القلب راجيًا من يملك ما يُطمع فيه ويؤمّل، فهذا كما قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: طبيعي وجائز.
المسألة الرابعة:
قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ معناه: من يخاف لقاء ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه على طاعته فليعمل عملاً صالحًا ولا يُشرك بعبادة ربه أحدًا ([134]).
يقول العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ المراد بالرجاء: الطلب والأمل؛ أي: من كان يؤمل أن يلقى ربه، والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقيا على نوعين:
الأول: عامة لكل إنسان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6] ولذلك قال مفرّعًا على ذلك: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: 7-8]، وقال: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [الانشقاق: 10-12].
الثاني: الخاصة بالمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية، وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم([135]).اهـ
* * *
ودليل التوكل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23].
وقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ودليل كون التوكل عبادة قوله - عز وجل -: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3].
ووجه الاستدلال من الآية الأولى أن الله - جل وعلا - أمر بالتوكل عليه ولا يأمر إلا بما يحب ويرضى وهذا يدل على أن التوكل على الله عبادة.
ووجه ثان من الاستدلال بهذه الآية:
أنه جعل التوكل عليه شرطًا للإيمان فقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]، ومعنى ذلك أن الإيمان لا يحصل إلا بالتوكل على الله - جل وعلا - وحده.
ووجه ثالث:
أنه قدم الجار والمجرور مع أن حقه التأخير ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ وعند علماء المعاني أن تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر والقصر، أو يفيد الاختصاص فيكون معنى الآية: احصروا واقصروا وخصّوا توكلكم بالله - جل وعلا - إن كنتم مؤمنين.
ووجه الاستدلال من الآية الثانية: أن الله - جل وعلا - أثنى على من توكل عليه وهو سبحانه لا يُثني إلا على عمل يحبه ويرضاه فيدخل في أنواع العبادة؛ لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
ولك أن تستدل بنوعين من الاستدلال تقدم بيانهما وهما:
الاستدلال العام: وذلك لأنك أثبت أن التوكل عبادة فتستدل بالأدلة العامة التي يصلح الاستدلال بها في كل ما ثبت أنه عبادة.
والاستدلال الخاص المتعلق بعبادة التوكل على الله - جل وعلا - وذلك ببيان وجه الاستدلال من هاتين الآيتين من جهة كون التوكل عبادة لا تصرف لغير الله - جل وعلا -.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
حقيقة التوكل تجمع أمرين:
أحدهما: تفويض الأمر إلى الله - جل وعلا -.
والثاني: عدم رؤية السبب بعد فعله، وهذان أمران متعلقان بالقلب، فإذا فعل العبد سببًا من الأسباب فإنه يوقن بأن هذا السبب لا يُحصَّل المقصود والمراد وحده؛ لأن حصول المرادات يكون بأشياء منها السبب ومنها صلاحية المحل لهذا السبب ومنها خلوّه من المضاد للسبب فهذه الثلاثة تحصل بها المرادات، ومثال ذلك: تناولُ الدواء لإزالة المرض والشفاء منه فالمسلم يتناول الدواء باعتباره سببًا للشفاء وهذا السبب لا يكفي بل لا بد من صلاحية المحل لهذا الدواء كما أنه لا بد من خلو المحل من المضاد لهذا الدواء؛ لأن الإنسان قد يتناول دواءً لا يُناسب جسده، أو يتناول دواءً هناك ما يُعارضه ويُبطل مفعوله في جسده.
إذًا تناول الدواء وفعل الأسباب لا يكفي للحصول على النتيجة وهي الشفاء وحصول المرادات بل لا بد من أمر آخر وهو أن يأذن الله - جل وعلا - بحصول النتيجة والمراد بعد فعل الأسباب.
قال ابن القيم - رحمه الله -: «وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب»([136])اهـ
المسألة الثانية:
لا يجوز للمسلم أن يترك الأسباب ويتخلى عنها، كما لا يجوز له أن يلتفت إليها ويتعلق قلبه بها. قال أهل العلم من السلف والخلف: ترك الأسباب جنون والالتفات إليها شرك.
المسألة الثالثة:
تفويض الأمر وتوجه القلب واطمئنانه وسكونه في شفاء مريض، أو تفريج كربة إلى الأموات فهذا شرك أكبر.
وأقلّ منه إذا فوّض الأمر وتوجه القلب في شفاء مرض إلى طبيب حاذق، أو السلامة في السفر إلى سائق متمكن، أو النجاح في الامتحان إلى المذاكرة الجادّة.
أما إذا اعتقد أن ذلك مجرد سبب والله بيده الأمر كله إن شاء أجرى هذا السبب وأمضاه فليس ذلك بشرك.
تنبيه:
هناك فرق بين الاعتماد على الأسباب وتفويض الأمر إليها والوثوق بها وبين الارتياح عند فعلها واتخاذها، فهو عند فعل الأسباب لم يفوّض الأمر إليها ولم يثق بها كمن يُريد السفر يضع سيارته عند من يكشف عليها ويجهّزها للسفر فيرتاح لذلك، لكن لا يثق ويطمئن بأنه لن يصيبه حادث في سيارة.
المسألة الرابعة:
التوكل من الوكالة وهي عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة ([137]).
ومثالها: أن تأذن لأحد في شراء كتاب أو دابة أو بيع بيت أو بستان.
فتقول: وكّلتك في كذا، ولا تقول توكلت عليك فيه؛ لأن التوكل عبادة قلبية فيها التفويض والتعلق والاعتماد.
المسألة الخامسة:
لا يجوز أن تقول: توكلت على الله ثم على فلان؛ لأن حقيقة التوكل لا يتخلف عنها اعتماد القلب وتفويضه وطمأنينته وتعلّقه.
وبعض العامّة يقولها ويريد بها التوكيل ولا يقصد عبادة التوكل فهؤلاء يُرشدون ويعلمون شيئًا فشيئًا بالحكمة والموعظة الحسنة.
* * *
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: 90].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
أي دليل كون الرغبة والرهبة والخشوع عبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: 90].
ووجه الاستدلال: أن الله - جل وعلا - أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء بهذه الصفات التي تحلوا بها فدل ذلك على أن هذه الأفعال محبوبة لديه مرضية عنده فصحّ فيها تعريف العبادة؛ لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
وهناك وجه استدلال آخر من الآية متعلق بذات الخشوع وهو قوله ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ فقدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو اسم الفاعل «خاشع». والجار والمجرور يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر.
وأصل سبك الكلام: كانوا خاشعين لنا، فلما قدّم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدًا للحصر والقصر والاختصاص كما هو مقرر في علم المعاني من علوم البلاغة ([138]).
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: «وتأمل قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ فإنه ظاهر بأن ذلك الخشوع ونحوه مختص بالله تعالى كما ذكر اختصاصه بالعبادة عمومًا في قوله: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: 66]»([139])اهـ
ومما يدل على عبادة الرغبة والرهبة قوله تعالى: ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: 8]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: 59]، وقوله - جل وعلا -: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [البقرة: 40].
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى: تعريف هذه العبادات:
الرغبة: قال أحمد بن فارس - رحمه الله -: «الراء والغين والباء أصلان: أحدهما طلبٌ لشيء، والآخر سَعَةٌ في شيء»([140])اهـ
وقال ابن الأثير - رحمه الله -: «يقال: رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء وطمع فيه، والرغبة: السؤال والطلب، ومنه حديث أسماء «أتتني أمي راغبة وهي مشركة» أي طامعة تسألني شيئًا»([141])اهـ
قال ابن رجب - رحمه الله - في تعريف الرغبة: «الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه»([142])، وقال الشيخ ابن قاسم: «الرغبة السؤال والطلب»([143]).
وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «محبة الوصول إلى الشيء المحبوب»([144]).
فائدة متعلقة بتعريف الرغبة:
قال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: 59]: «وقالوا إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم»([145]).اهـ
ويتبادر لك من سياق الآية وتفسير ابن جرير لها معنى للرغبة وهو أن الرغبة ترك سؤال غير الله - جل وعلا - ولو فيما أباحه الله - جل وعلا - من السؤال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه كما قال: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: 7-8]، فأمر بالرغبة إليه ولم يأمر قط مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان قد أباح ذلك في بعض الأحيان، لكنه لم يأمر به بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله.([146])اهـ
وقال - رحمه الله -: (وقد تواترت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم مسألة الناس إلا عند الضرورة وقال: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مقطع أو دم موجع أو فقر مدقع»، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: 7-8]، فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده)([147]).
الرهبة: قال ابن فارس - رحمه الله -: «الراء والهاء والباء أصلان أحدهما يدل على خوف.
تقول: رهِبتُ الشيء رُهبًا ورَهَبًَا ورَهْبَةً»([148]).اهـ
وهذا الخوف ليس خوفًا عاديًا بل هو خوف معه تحرز واضطراب([149])، قال أبو السعود - رحمه الله - في تفسيره: «والرهبة خوف معه تحرز»([150]).اهـ
ولأجل هذه المعاني قال ابن القيم - رحمه الله - في تفسير الرهبة: «هي الإمعان في الهرب من المكروه»([151]).اهـ
وذكر العسكري - رحمه الله - في الفروق اللغوية([152]): «أنه يُقال في اللغة: جمل رهَبٌ إذا كان طويل العظام كما يقال لعابد النصارى «راهب» لطول عبادته وخوفه»اهـ. فالرهبة خوف طويل وشديد والفرق بينهما زمني فالطويل من الخوف رهبة والقصير خوف والله أعلم.
الخشوع: هو التطامن، قال ابن فارس - رحمه الله -: «الخاء والشين والعين أصلُ واحد يدل على التطامن، يقال: خَشَعَ إذا تطامن وطأطأ رأسه، وهو قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في الصوت والبصر، قال تعالى: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾ [القلم: 43]»([153]).اهـ
وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ [فصلت: 39] يعني ليس فيها حياة وإنما هي متطامنة ذليلة ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [فصلت: 39]؛ فالخشوع سكون فيه ذلّ وخضوع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الخشوع أحدهما التواضع والذل والثاني السكون والطمأنينة»([154])اهـ وقال: «هو الخضوع لله والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح»([155])اهـ
المسألة الثانية:
من صور الشرك في الرغبة والرهبة والخشوع:
إذا رغب إلى الله - جل وعلا - ولم يسأل سواه فهذه رغبة توحيد، إذ إنه لا يسأل إلا الله تعالى، حتى فيما أباحه الله له من السؤال للمخلوقين فيما يقدرون عليه، بل لا يسأل إلا الله وحده.
وإذا توجه ذلك إلى غير الله تعالى، فلا يسأل إلا ذلك المألوه المعبود من دون الله - جل وعلا - حتى فيما يقدر عليه المخلوق، فإن ذلك شرك من جهة الرغبة؛ لأن في ذلك إقبالاً كثيرًا وواسعًا على غير الله تعالى.
وإذا توجه بالرهبة التي هي الخوف الطويل إلى غير الله تعالى كصاحب قبر أو جن أو غير ذلك فإن هذا شرك من جهة الرهبة، ويدل عليه العمل؛ لأن الخوف الطويل يثمر التحرز والعمل من أجل المخوف منه.
وإذا وقف المسلم متوجهًا إلى القبلة وسكنت جوارحه أثناء الصلاة؛ فهو خاشع لله تعالى بجوارحه، وإذا ذلّ قلبه وخضع وسكن واطمأن لله تعالى في تلكم الصلاة فهو خاشع لله تعالى.
وإذا حصلت هذه الصور أمام قبر فهذا خشوع دلّت القرائن أنه لغير الله تعالى وهو شرك أكبر.
ومن مظاهر الشرك الواضحة لدى المشركين، أنهم يقفون عند أوثانهم من قبور وغيرها خاشعين ذليلين، فلا تلحظُ حركةً في الجوارح، بل في الألحاظ والنظرات وذلك؛ لأن قلوبهم قد قام فيها رَغَبٌ ورَهَبٌ وخُشوعٌ؛ لاعتقادهم في صاحب القبر أو ذلك المعبود أنه يجلب النفع ويجيب المضطر ويكشف الضرّ ويفرج الكربات ويغيث اللهفات.
وقد يخشع بعضهم ويتطامن ويذل في تلك البقاع بدرجة لا تراها له في أحب الأماكن إلى الله - جل وعلا - من المساجد والمسجد النبوي والمسجد الحرام.
وهذه العبادات العظيمة لا تكون إلا لله - جل وعلا - وحده لا شريك له ولذلك تقوم هذه العبادات في قلب الموحد أثناء صلاته فإذا قرأ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 3] قام في قلبه رجاء وهو أول الرغبة وإذا قرأ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4] - زادت تلك الرغبة رهبة، وإذا قرأ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، خشع القلب وسكنت الجوارح فلا تتحرك إلا وفق مُراد الرب - جل وعلا -، فإذا ركع ثم سجد سأل الله - جل وعلا - بقلب قد مُلئ بالرغبة والرهبة والخشوع.
المسألة الثالثة:
هذه المقامات العظيمة لا يستوي فيها أهل الإيمان فتزيد عند بعضهم وتضعف عند آخرين، كما أن بعضهم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبعض الآخر لا تُحرك فيه شيئًا وإنما ينصرف ولم يُكتب له شيء من صلاته.
المسألة الرابعة: الفرق بين هذه العبادات وما يقاربها:
الفرق بين الرغبة والرجاء:
قال ابن القيم - رحمه الله -: «والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع، والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء»([156])اهـ
قلت: قد تقدم في حقيقة الرجاء أنه طمع يُثمر عملاً فإن تعرّى من العمل لم يصر رجاء بل مجرد طمع.
وهنا يتبين لك عملاً أثمره الرجاء وهو الرغبة حيث وصفها ابن القيم - رحمه الله - بأنها طلب؛ ولأجل هذا قال بعضهم في تعريف الرغبة: إنها رجاء خاص، وقال بعضهم هي سؤال وطلب.
الفرق بين الرهبة والخوف:
تقدّم في أثناء بيان معنى الرهبة حيث اتضح أن الفرق بينهما زمني فالرهبة خوف ولكنه طويل، ولذلك يقال: جَمَل رهبٌ إذا كان طويل العظام، ويقال لعابد النصارى: «راهب» لطول عبادته وخوفه ([157]).
الفرق بين الخشوع والخضوع:
تقدم في أثناء تعريف الخشوع حيث فرّق بينهما العلامة ابن فارس فذكر أن الخشوع قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن، والخشوع في الصوت والبصر، واستدل بقوله تعالى: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾ [القلم: 43]([158]).
* * *
ودليل الخشية قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 150].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
أي: ودليل كون الخشية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ [البقرة: 150] ووجه الاستدلال: أنه سبحانه نهى أن توجه بالخشية إلى غيره وأمر أن توجه إليه، ولا يأمر إلا بما يحب ويرضى.
ومن أدلة هذه العبادة قوله تعالى: ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: 21]، وقال - جل وعلا - ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: 57].
الخشية بمعنى العلم، قال الفراء في قوله تعالى ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: 80]، قال: فخشينا أي فعلمنا.
وتُلاحظ أن الذي قال: فخشينا هو الخضر ولذلك قال بعدها ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا﴾ [الكهف: 81]([159]).
فالخضر خاف شيئًا وعمل عملاً لأجل أن لا يحصل المخوف منه.
قال الفيروزآبادي - رحمه الله - في تعريف الخشية: «خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه»([160]).اهـ
فالخشية خوف مقرون بمعرفة كما قال ابن القيم - رحمه الله -([161])، ومن هنا نُفرّق بين الخشية وما يشابهها من العبادات والمعاني القلبية كالخوف، فنقول: الخشية تفارق الخوف في العلم إذ لا تكون إلا به وإلا فإنها خوف، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]، والخوف قد يكون من الجاهل([162]).
وبعض أهل العلم يقول: «بأن الخشية خوف مع إجلال وتعظيم»([163])، وإذا تمعنت وجدت أن الإجلال والتعظيم لا يكون إلا عن علم.
فائدة متعلقة بتعريف الخشية والفرق بينها وبين الخوف:
قال العلامة القرطبي - رحمه الله -: «قيل بأن الخوف تطلّعٌ لنفس الضرر، والخشية تطلع لفاعل الضرر»([164]).اهـ
مثلاً: يريد زيد أن يقتل عمرًا، فإن توجه خوف عمرو إلى القتل فإن هذا يُسمى خوفًا، وإذا توجه إلى شخص زيد فإن هذا يُسمى خشية.
ودليل الإنابة قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: 54].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
أي ودليل كون الإنابة عبادة قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: 54].
ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أمر بالإنابة إليه ولا يأمر إلا بما هو محبوب عنده مرضيٌ لديه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
ومن الأدلة على هذه العبادة قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى: 10].
ومعنى أناب في اللغة: تاب فرجع ([165])، قال أحمد بن فارس - رحمه الله -: «النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه»([166])اهـ
قال ابن القيم - رحمه الله - في تفسير معنى الإنابة: «هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه»([167]).اهـ
فالرجوع إلى الله وانصراف دواعي وجواذب القلب إليه سبحانه وتعالى توحيد، والرجوع إلى غيره من وليٍّ أو قبر أو شجر أو حجر، وانصراف دواعي وجواذب القلب إلى ذلك المعبود من دون الله أو مع الله شرك أكبر.
والفرق بين الإنابة والتوبة أن التوبة رجوع إلى الله - جل وعلا - بخصوص فعل أو قول يتضمن الإقلاع والندم والعزم على عدم العود إليه، أما الإنابة فتدل مع الرجوع عما لا ينبغي على قصد ما ينبغي من رضى الله تعالى.
وهذا يُفسر لك كلام ابن القيم - رحمه الله - في الإنابة، حيث قال: «المنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته الراجع إليه في كل وقت والمتقدم إلى محابه»([168]) اهـ.
قال تعالى: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24].
* * *
ودليل الاستعانة قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وفي الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله».
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: 1]، وقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1].
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 9].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ودليل كون الاستعانة عبادة قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وفي الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله».
ووجه الاستدلال من الآية أن «إياك» ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، وأصل الكلام: نعبدك، ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا قُدّم كان ثمّ فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة ألا وهي: الاختصاص أو الحصر والقصر ([169]) بمعنى اختصاص العبادة والاستعانة بالله - جل وعلا - أو حصر العبادة والاستعانة وقصرها بالله وحده سبحانه وتعالى.
فالمعنى: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك.
فأثبت بهذا الدليل أن الاستعانة عبادة خاصة بالله - جل وعلا - وحده وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى.
ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أراد الاستعانة أن يستعين بالله - جل وعلا -، وفيه نهي عن الاستعانة بغير الله - جل وعلا -.
فالمراد: إذا كنت متوجهًا للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله لأن الأمر جاء في جواب الشرط ف«إذا» شرطية غير جازمة و«استعنت» فعل الشرط.
فلما أمر به علمنا أنه من العبادة، ثم لما جاء في جواب الشرط صار متركبًا مع ما قبله بما يفيد الحصر والقصر من جهة المعنى كمعنى قول الله - جل وعلا -: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5].
ودليل كون الاستعاذة عبادة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: 1]، وقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1].
ووجه الاستدلال من الآيتين أن الله أمر بالاستعاذة به وهو سبحانه لا يأمر إلا بما يحب ويرضى وينطبق على هذا تعريف العبادة.
ودليل كون الاستغاثة عبادة قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 9].
ووجه الاستدلال أنه أتى بالاستغاثة في معرض ثناء، ورتب عليها الإجابة وما دام أن الله - جل وعلا - رتب على فعلهم وهو الاستغاثة به إجابته، فإن ذلك يعني أن ذلك الفعل يحبُّه الله ويرضاه، فنتج أنه عبادة إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى: تعريف هذه العبادات:
الألف والسين والتاء في أول الكلمة تدل على الطلب فمعنى استعان: طلب العون، ومعنى استغاث «طلب الغوث، ومعنى استسقى: طلب السقيا، ومعنى استغفر طلب المغفرة، ومعنى استعاذ، طلب العوذ، وهكذا.
وقد تأتي الألف والسين والتاء في الكلمة ويراد بها الفعل دون الطلب كقوله - جل وعلا - ﴿وَاسْتَغْنَى اللَّهُ﴾ [التغابن: 6]: وغني الله.
فالاستعانة: طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ، ومعنى أعوذ: ألتجئ واعتصم وأتحرز، فإذا قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمرادك: ألتجئ واعتصم وأتحرز من الشيطان الرجيم.
وتكون مما فيه شرّ، واللياذ يكون مما فيه خير فإذا كنت مؤملاً لخير تقول: ألوذ بك، وإذا كنت خائفًا من شر تقول: أعوذ بك.
يا من ألوذ به فيما أؤمله
ومن أعوذ به فيما أحاذره
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره
ولا يهيضون عظمًا أنت جابره ([170])
والاستغاثة طلب الغوث وهي أخص أنواع الدعاء، والغوث يُفسر بأنه المدد والنصرة ونحو ذلك، ومن صوره أن يغرق إنسان في نهر أو بركة ماء فينادي من يُنقذه: أغثني يطلب إغاثته. والله - جل وعلا - هو غياث المستغيثين ومدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم إذا قصدوه.
وتلاحظ أن الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة تتعلق بالربوبية؛ ولذلك جاء فيما استدل به المؤلف ذكر الربوبية ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ وفي الاستعاذة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، وذلك لأن الغياث والعياذ من مقتضيات الربوبية فالذي يغيث ويُعيذ ويُعين المالك المتصرف المدبر.
المسألة الثانية:
كل ما يدخل في معنى الطلب من الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة يصلح لها أدلة الدعاء؛ لأن الطلب دعاء كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، وقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].
وتلاحظ أن هناك اتفاقًا بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة في أمر وهو الطلب، وثم اختلاف بينها من جهة الطلب فإذا وقع عليه شر وطلب نصرة بإزالته فهذه استغاثة كالغريق، وإذا لم يقع عليه الشر لكنه في طريقه إليه فهذه استعاذة، وإذا كان في أموره العادية ولم يقع عليه شرّ أو يتوقعه فهذه استعانة.
فائـدة:
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: «تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته»([171]) اهـ. قلت: يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ رضي الله عنه: «يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكر وشكرك وحسن عبادتك».
المسألة الثالثة:
الاستعاذة عبادة قلبية مع أنها قول باللسان ولكن يقوم في القلب التجاء واعتصام واحتراز بمن استُعيذ به فلو قامت تلك المعاني في القلب ولم يُفصح بلسانه صار مستعيذًا بمن اعتصم واحترز والتجأ قلبه به، ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك؛ لأن الاستعاذة عبادة قلبية ولا يصلح فيها الترتيب بثمّ.
«وقال بعض أهل العلم: الاستعاذة طلبٌ للاعتصام، والاحتراز وقد يتوجه العبد بهذا الطلب إلى حي قادر مستطيع على أن يعصمه من الشر الذي خافه فيجوز على هذا أن يقول: أعوذ بالله ثم بك»([172])، قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر، أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز»([173])اهـ، واستدل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفتن «من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذ به»([174])، ورواية الإمام مسلم في صحيحه «أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذت بأم سلمة»... الحديث([175])، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يعوذ عائذ بالبيت فيُبعث إليه بعث... » الحديث([176]).
وهذان قولان: الجواز وعدم الجواز في هذه المسألة، ويُفتى بهما فمن أجاز راعى الاعتصام والتحرز الظاهر، ومن لم يُجز راعي كون ذلك عبادة قلبية، وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه قد يكون تبعًا لذلك إجازة تعلق القلب عند من لم يفهم المراد.
أما الاستغاثة فعمل ظاهر وليست عملاً قلبيًا ولذلك تجوز بمخلوق ولكن بشروط وهي:
1- أن يكون المستغاث به حيًا فإذا كانت الاستغاثة من ميت فإنها كفر.
2- أن يكون حاضرًا يسمع أما إذا كان حاضرًا ولكنه نائم فلا.
3- أن يكون قادرًا أما إذا كان عاجزًا فلا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: 15].
* * *
ودليل الذبح قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163]، ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله».
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ودليل كون الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله - جل وعلا - قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله من ذبح لغير الله»([177]).
ووجه الاستدلال من الآية أنه قال: ﴿وَنُسُكِي﴾، والمعنى أن ذبحي لله رب العالمين، و«اللام» هنا للاستحقاق؛ فالذبح مستحق لله رب العالمين لا شريك له كما أن الصلاة مستحقة له وحده لا شريك له، وهذا يدل على أن الذبح لله - جل وعلا - عبادة مستحقة له وحده دون ما سواه.
وثم وجه استدلال آخر من الآية وهو قوله - جل وعلا - ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ [الأنعام: 163]، وهذا يدل على أن الذبح لله - جل وعلا - وحده مأمور به فدل على أنه عبادة.
ومثل هذه الآية قوله - جل وعلا -: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]: أمر بالصلاة له وأمر بالذبح له؛ فدل على أن الصلاة والذبح عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله - جل وعلا -.
قوله: (ومن السنة): أي الدليل على كون الذبح عبادة مما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله من ذبح لغير الله»، ووجه الاستدلال منه أن من ذبح لغير الله - جل وعلا - ملعون، وداخل في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فدل على أن صرف الذبح لغير الله - جل وعلا - شرك أكبر وعظيمة من العظائم، وفي المقابل الذبح لله وحده توحيد محبوب له سبحانه وتعالى.
والذبح له أحوال:
منها: أن يكون تقربًا وحديثنا عن هذه الحال.
ومنها: أن يقع إكرامًا لضيف فإكرام الضيف مشروع.
ومنها: أن يذبح للأكل فجائز لكن بشرط أن تسمي بالله وتكون الذبيحة مأذونًا فيها.
* * *
ودليل النذر قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ودليل كون النذر عبادة يجب إفراد الله تعالى بها ولا يجوز صرفها لغيره لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التشريك قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾، ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الوفاء بالنذر ذُكر في معرض ثناء فدل على أن هذا الفعل عبادة يحبها الله ويرضاها.
والنذر هو إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبًا عليه؛ تعظيمًا للمنذور وتقربًا له، هذا هو مُراد المؤلف - رحمه الله -.
فائـدة:
قال ابن عثيمين - رحمه الله -: «النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله - عز وجل -؛ فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]»([178]).اهـ
وقال: «والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومًا ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله - عز وجل -، وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحلُّها كتب الفقه»([179])اهـ
إذا تبين لك ذلك فاعلم أن هناك مسائل متعلقة بالنذر الخاص وهي:
المسألة الأولى:
النذر له حالان:
1- ما يكون على وجه المقابلة ويعبر عنه العلماء: النذر المعلق. كقول الرجل: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ صوم يوم، أو إن رزقت بولد فلله عليَّ أن أتصدق بكذا. ونحو ذلك ابتداءً، وهذا النوع من النذر ليس بمحمود ولا ممدوح؛ بل جاءت نصوص تدل على ذمه والنهي عنه؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل»([180]).
2- ما يكون مطلقًا بدون تقييد، ويعبر عنه العلماء: النذر المنجّز؛ كقول الرجل: لله عليَّ أن أصوم الاثنين القادم. أو لله عليَّ أن أصلي هذه الليلة إحدى عشرة ركعة. ونحو ذلك؛ فهذا النوع من النذر محمود وممدوح عند بعض أهل العلم ([181]).
المسألة الثانية:
الوفاء بالنذر في كلا الحالين السابقين واجب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ومن وفّى بنذره دخل في ثناء الله - جل وعلا -: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾؛ لأنه وفّى بنذره سواءً المطلق أو المعلق والوفاء به واجب، وخاف عقاب الله - جل وعلا - إن لم يوفّ بنذره.
المسألة الثالثة:
نخرج بأربع صور:
1- ابتداء النذر على وجه المقابلة.
2- ابتداء النذر لا على وجه المقابلة بل بإطلاق.
3- الوفاء بالنذر الذي على وجه المقابلة.
4- الوفاء بالنذر المطلق.
فالصورة الأولى مكروهة ومنهي عنها، والصورة الثانية محمودة، والصورة الثالثة والرابعة واجبة.
فتحصَّل عندنا أن غالب الحال في النذر كونه محمودًا أو واجبًا، ولذلك نقول بأنه عبادة من العبادات التي يحبها الله - جل وعلا - ويرضاها، ونستثنى من ذلك ابتداء النذر على وجه المقابلة.
المسألة الرابعة:
النذر له شقان: الأول ابتداؤه، والثاني الوفاء به، وكلا الأمرين شرك إذا صرفا لغير الله - جل وعلا - على التفصيل التالي:
إذا ابتدأ النذر المطلق أو المعلَّق لغير الله - جل وعلا - كأن يقول لصاحب القبر الفلاني: عليَّ أن أصوم يومًا، أو للبدوي: نذر عليَّ أن أتصدق بكذا، أو للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو لعيسى أو لموسى أو لخديجة أو لأحد من آل البيت أو للمشهد الفلاني أو للقبر الفلاني؛ فهذا كله شرك لأنه نذر على نفسه عبادة وتوجه بهذا النذر لغير الله - جل وعلا - فصار بذلك شركًا الشرك الأكبر؛ فقوله: «للبدوي عليَّ نذر»: توجه بفعله الذي هو عبادة - وهو النذر - لغير الله - جل وعلا - فأشرك.
فإن قال: (إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام)؛ فإن كلامه قد تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ لأن شفاء المريض فعل الرب - جل وعلا -، وصيام ثلاثة أيام فعل العبد توجه به خاضعًا متذللاً مُحبًا خائفًا راجيًا الله - جل وعلا -.
وإن قال: (إن شفى الله مريضي فللبدوي علي أن أصوم ثلاثة أيام)؛ فإن كلامه قد تضمن توحيد الربوبية والشرك في الألوهية.
وإن قال: (إن شفى البدوي مريضي فله علي أن أصوم ثلاثة أيام). فإن كلامه قد تضمن الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية.
وإذا نذر لغير الله - جل وعلا - فإنه قد أشرك؛ فلا يجوز له أن يوفي بنذره ذلك، وإذا وفَّى بنذره لغير الله فإنه يكون قد أشرك شركًا بعد شرك؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»([182]).
تنبيهات حول العبادات القبلية:
الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة.
أولاً: ما نأتي به من تعاريف إنما هو تقريبي؛ فلا يُظن أننا نأتي بتعاريف جامعة مانعة.
ثانيًا: عندما نتكلم عن هذه العبادات فإنما نتكلم عن معان نفسية لا تُرى بالحس ولا تُشاهد بالعين، ومثلها في المعنى: الرضى والغضب والمحبة؛ فهذه لا تقوم بنفسها؛ بمعنى أنك لا ترى شيئًا يسمى رغبة أو شيئًا يسمى رهبة أو شيئًا يسمى خشوعًا؛ بل هذه أوصاف لا تقوم بذاتها؛ فلا بد من ذات تقوم فيها هذه المعاني.
ويقابل ذلك من العبادات: الذبح والصلاة، فعندما يُقال لك: الذبح. فإنك تتصور مباشرة صورة هذه العبادة وتعرفها.
أما العبادات القبلية كالتوكل والرجاء والخوف فإنها لا تُشاهد في الخارج؛ فلا ترى شيئًا يسمى بالتوكل أو شيئًا يسمى بالخوف أو شيئًا يسمى بالرجاء؛ وإنما هي معان يُدركها كل أحد ويحسها في نفسه ويصعب تحديدها وتوضيحها؛ نعم قد تشاهد في الخارج آثار هذه العبادات القلبية؛ كأن تشاهد طفلاً بين يدي والده ليعاقبه فإنك ترى آثار شيء في قلب هذا الطفل وهو الخوف.
وإذا رأيت الطفل يرتمي في حضن والده فإنك تشاهد أثرًا لمعنى قلبي حصل في نفس هذا الطفل وهكذا.
وإذا كان كذلك فإن عبارات أهل العلم تعددت في بيان هذه المعاني القلبية أو النفسية، والتي فيها هذه العبادات الثلاث: الرغبة والرهبة والخشوع.
ثالثًا: إذا تكلمنا عن المعاني النفسية بشكل عام سواء هذه العبادات أو غيرها فإننا نوضح المعنى النفسي بذكر نتائجه أحيانًا، وكذلك قد ترى في كتب أهل العلم، وبالتالي ينبغي عليك أن تحذر في مثل الرضى والغضب والمحبة؛ فتعتقد أن هذا التعريف إذا كان فيه ذكر النتائج إنما هو متعلق بالمخلوق لا الخالق؛ فإذا قيل عن الغضب بأنه ثوران الدم وتمعر الوجه فهذا متوجه للمخلوق، وإذا أتيت على صفة الرب - جل وعلا - فلا يجب لك أن تذكر مثل هذه العبارات؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
رابعًا: بعض هذه العبادات تتداخل في بعض؛ كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - وغيره؛ حيث ذكر بعضهم أن الرهبة أولها خوف والرغبة أولها رجاء، ولا يُتصور حصول إنابة بدون قيام محبة ورغبة ورهبة في القلب المنيب.
قال ابن القيم - رحمه الله -: «التوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لا يتصور وجودها بدونها، والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضى لا يتصور وجوده بدونها، والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة، والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة، والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة، والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشيةُ لا يكون العبد منيبًا إلا باجتماعهما»([183]).اهـ
وقال - رحمه الله -: «الرغبة والرهبة كل منهما ملتئم من الرجاء والخوف، والرجاء على الرغبة أغلب، والخوف على الرهبة أغلب»([184]).اهـ
فإذا عبد الله - جل وعلا - أحد بعبادة فليس معناه أن لا يكون قد أتى معها بعبادة أخرى؛ بل قد يأتي بعبادة وأكثر في آن واحد؛ فمن عبد الله بالرهبة فإنه قد عبده بالخوف معها، ومن عبده بالرغبة فإنه قد عبده بالرجاء معها، وقد يكون سائلاً من الله - جل وعلا - وقلبه قد تلبَّس بالرَّغَب والرَّهبِ والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والخشوع والخشية.
خامسًا: «الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظٌ متقاربة غير مترادفة»([185]).
* * *
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة.
وهو: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
انتهى المؤلف - رحمه الله - من بيان الأصل الأول وشرع في بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وابتدأ بذكر تعريف الإسلام فقال:
(هو: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله).
وهذا الإيضاح لمعنى الإسلام يبين أن فاعل الإسلام كهيئة المستسلم، والمستسلم لغيره تابعٌ له، لا يفعل إلا ما يريد؛ فليس في قلبه إلا رغبة من استسلم له.
والإسلام مشتقٌّ من التسليم، تقول: استسلم فلان للقتل: أي أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو أنه مأخوذ من المسالمة التي بمعنى ترك المنازعة ([186]).
والاستسلام بمعنى الإسلام؛ فلو قال في تعريفه: هو الإسلام لله بالتوحيد لصحّ.
والإسلام يأتي إطلاقه في النصوص على معان:
الأول: الإسلام العام: وهو دين الأنبياء الذي لا يقبل الله سواه من الأديان كما قال - جل وعلا -: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، وقال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]، وقال - جل وعلا -: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ [المائدة: 44].
الثاني: الإسلام الخاص: وهو الذي بُعث به محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي إذا أطلق في النصوص قُصد على وجه الخصوص؛ لأن الخاصَّ مقدم على العام في الدلالة، ولأن هذا الاسم خُصت به هذه الأمة وخُصّ به النبي عليه الصلاة والسلام([187]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن قول تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: 83]: «فهو سبحانه يدعوهم إلى دين الإسلام ويبين أن كل ما في السموات والأرض مسلم لله؛ إما طوعًا وإما كرهًا، وإذا كان لابد من أحدهما فالإسلام له طوعًا هو الذي ينفع العبد»([188]).اهـ
الثالث: قد يأتي الإسلام في النصوص ويراد به الاستسلام الكوني العام من جميع المخلوقات لربها وخالقها، كما قال - جل وعلا -: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: 83]([189]).
و«الدين» في قوله: «معرفة دين الإسلام» معناه الطاعة والتوحيد وجميع ما يُتعبّدُ به؛ فيدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان.
قوله: (بالأدلة): تنبيه على ما تقدمت الإشارة إليه؛ وهو أن هذه الأصول الثلاثة لا ينفع فيها التقليد.
قوله: (والانقياد له بالطاعة): فيه أن المستسلم لله بالتوحيد منقادٌ له بالطاعة غير ممانع ولا متول؛ بل مُذعنٌ منقاد يمتثل المأمورات ويفعل الخيرات ويترك المنهيات طاعة لله تعالى وابتغاء لوجهه ورغبة فيما عنده وخوفًا من عقابه، وهذا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام([190]).
والطاعة تكون في الأوامر بفعلها وتكون في النواهي بتركها.
قوله: (البراءة من الشرك وأهله): فيه أنه لا يتحقق الإسلام بدون البراءة من الشرك وأهله، وأصل هذه البراءة بُغض القلب للشرك وأهله، ويتبع هذا البغض تكفير من كفره الله ورسوله، ومعاداتهم، وجهادهم عند مشروعية الجهاد.
(ولا بد من توفر العلم في أمرين وهما: القتال والتكفير، ويتلخص من هذا أن عامة الناس عليهم من البراءة أصلها وهو البغض، وبه يحصل الإسلام وبعدمه ينعدم، وأما فروع البراءة من التكفير والقتال فلابد فيه من العلم؛ لئلا يحدث الخلل لدى المسلم ومن ينتمي له من جماعة).
أما العلماء فعليهم من البراءة كل ما تقدم على حسب ما نص عليه السلف في مؤلفاتهم([191]).
وتقدم معنا تفاصيل متعلقة بالولاء والبـراء، ومتى تكون الموالاة مكفِّرة ومتى تكون كبيرة من الكبائر وليست بمكفرة، وهل تجوز محبة المشرك أم لا([192]).
ونأخذ مما سبق أن الإسلام يتضمن أمورًا ثلاثة:
1- الاستسلام لله بالتوحيد.
2- الانقياد له بالطاعة.
3- البراءة من الشرك وأهله.
تنبيـه:
هناك استسلام قدري كوني لا حيلة للإنسان فيه؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾، [آل عمران: 83]؛ فهذا لا ثواب فيه للعبد.
وهناك استسلام شرعي وهو الاستسلام لله بالتوحيد؛ فهذا الذي يُحمد عليه العبد ويُثاب عليه([193]).
* * *
وهو ثلاث مراتب: الإسلام، والإيمان، والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ذكر المؤلف - - رحمه الله - - الأصل الثاني بإجمال، ثم فصّل فيه هنا، وذكر أنه له مراتب ثلاث، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». يريد بذلك سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان.
فدين الإسلام الذي تقدم تعريفه يشمل ثلاث مراتب: أولها الإسلام؛ فمن أتى بهذه المرتبة صار مسلمًا، وثانيها الإيمان؛ من أتى بمرتبة صار مؤمنًا، ثالثها الإحسان من أتى بمرتبة صار محسنًا.
وكلٌّ من المسلم والمؤمن والمحسن من أهل الإسلام ولكنهم مراتب مختلفة ومنازل متفاوتة.
والمؤلف - رحمه الله - ذكر هذه المراتب هنا بإجمال ثم فصّلهن وبَيَّنَ أدلتهن.
وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها.
«ومعنى أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها ولا تكون حقيقته إلا بها»([194]).
وقد سميت بذلك؛ تشبيهًا لها بأركان البيت والبناء الذي لا يقوم إلا بها.
أما مرتبة الإسلام فتشمل الأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فيتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين والمستحق للعبادة وما يترتب على ذلك من عمل، والتصديق بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر وما يترتب على ذلك من عمل؛ فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، لابد من هذا وهذا.
وإذا أطلق الإيمان وحده فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة ويشمل الإحسان، كما أنه إذا أطلق الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان والإحسان.
ويتعلق بهذا المقدمة مسائل:
المسألة الأولى:
لم يرد في النصوص التسمية بأركان الإسلام أو أركان الإيمان، وإنما عَبَّر العلماء بلفظ الركن اجتهادًا منهم.
«والتعبير بالأركان والشروط انتشر بعد ظهور علم المنطق، ولذا تجده عند المتأخرين بكثرة دون المتقدمين، ويريدون بالركن ما تقوم عليه حقيقة الشيء وماهيته، ويريدون بالشرط ما به يصح الركن([195])، وهناك تفصيل يطول ذكره، وتكفي هذه الإشارة هنا لينطلق طالب العلم معتمدًا على النصوص محكِّمًا لها مستأنسًا بتعابير أهل العلم فنقول:
لا يتصور أن يقوم الشيء إلا بوجود أركان، والركن هو ما يقوم عليه الشيء، وإذا تخلف لم يقم البناء.
فإذا تخلف عن الإيمان ركنُ القدر لم يقم الإيمان أصلًا، وإذا تخلَّف ركن الإيمان بالملائكة لم يقم الإيمان كذلك.
وهنا إشكال: بالنسبة للإسلام لم يتفق العلماء على أن تارك الحج وتارك الصيام لا يسمى مسلمًا، واتفقوا على أن من ترك ركنًا من أركان الإيمان لا يُصبح مؤمنًا أصلاً.
وهذا يرجع إلى ما تقدم من أنّ اصطلاح الركن إنما هو حادث، وأن أهل العلم أتوا بمثل هذه الألفاظ للإفهام، وإذا كان كذلك فإننا لا نُحكِّم ألفاظ العلماء واصطلاحاتهم على النصوص، وإنما نحكم النصوص على اصطلاحات أهل العلم فنفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص، ونفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات.
وعلى هذا فإننا إذا قلنا «أركان الإسلام» فليس المراد بالركن أنه ما يقوم عليه غيره.
تنبيـه:
بعضهم قسَّم أركان الإسلام إلى قسمين: أركان أساس لا يقوم البناء إلا بها، وأركان تمام لا يتم إلا بها، وإن كان أصل البناء موجودًا، وهذا التقسيم فيه نظر.
المسألة الثانية:
الإيمان يتفاوت فيه أهله ولذلك صار أعلى مرتبة من الإسلام؛ لأن الإيمان في المرتبة التي هي أعلى من الإسلام قد حُقق فيها الإسلام وما معه من قدر من الإيمان وزاد على ذلك؛ فيكون إيمانه أرفع مرتبة من إسلامه؛ لأنه اشتمل على الإسلام وزيادة.
ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. وهذا يدل عليه قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 14]؛ فلم يبلغوا مرتبة الإيمان التي هي أعلى من مرتبة الإسلام، وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمًا فقلت: يا رسول الله أعط فلانًا فإنه مؤمن. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أو مسلم». أقولها ثلاثًا ويرددها عليَّ ثلاثًا أو مسلم»([196]).
المسألة الثالثة:
من المهم في فهم الشريعة معرفة أن من الألفاظ التي تقسّم ما يكون اللفظ نفسه قسمًا من أقسامه.
فالإسلام الاسم العام، هو الدين، ويشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وليس هو الاسم الخاص إذا جاء مع الإيمان والإحسان، ويدلّ على ذلك حديث جبريل الطويل وفي آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلّمكم أمر دينكم». والذي تقدم في الحديث هو الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان.
وبعض أهل العلم لم يلحظوا ذلك فجعلوا الإسلام والإيمان بمعنى واحد، ولم يفرقوا بينهما، حتى عزا ذلك بعضهم لجمهور السلف، وهذا ليس بصحيح.
المسألة الرابعة:
الإسلام الخاص: فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأعمال الظاهرة.
وإذا رجعنا إلى تعريف الإسلام العام نجد أن الإسلام الخاص استسلام ظاهر يُخبر عنه بنطق الشهادتين وإقامة الأركان العملية الأربعة.
وإذا تأملنا لفظ الشهادة وجدنا فيه اعتقادًا كما أن فيه إخبارًا وإعلامًا؛ فمعنى شهد: علم وأخبر.
ودخول الشهادتين في معنى الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة راجع إلى معنى الشهادة بعد الاعتقاد وهو الإخبار والإعلام، وإذا كان كذلك فإننا نقول: الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة لا يصح إلا بقدر مصحِّح له من الإيمان، وهذا القدر المصحِّح من الإيمان هو الإيمان الواجب بالأركان الستة، ودليل اشتراطه لفظ: «أن تشهد».
المسألة الخامسة:
قرر أهل السنة والجماعة أن الإيمان إذا قُرن مع الإسلام اختلف عنه فيراد به العمل الباطن، ويراد بالإسلام العمل الظاهر، أما إذا افترق عنه بحيث ذكر في سياق لم يُذكر فيه الإسلام فيراد به الإسلام والإيمان.
إذًا الإسلام العام تعريفه: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والإيمان هو استسلام باطن لا يصح إلا بقدر واجب متعلق بالأركان الستة سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
ومن النصوص التي ذكر فيها الإيمان مفردًا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: 15]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: 2-4].
وقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].
وروى البخاري ومسلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفد عبد القيس، وفيه: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع؛ أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال لهم: «هل تدرون ما الإيمان بالله تعالى؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس... » الحديث([197]).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام - فلا يدل على العكس، ولو قدر أنه دلَّ على التلازم فهو صريح بأن مُسَمَّى هذا ليس مسمَّى هذا؛ لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة من المواضع حاد عنها طوائف»([198]).اهـ
وهنا تنبيه: من السلف من رأى أن الإسلام والإيمان يفترقان دائمًا، ومنهم من يرى أنهما بمعنى واحد دائمًا.
* * *
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لما ذكر المؤلف - رحمه الله - مراتب الأصل الثاني ذكر أركان كل مرتبة على وجه التفصيل، وابتدأ بمرتبة الإسلام الذي تقدم تعريفه وبيانه، وذكر أركان الإسلام مرتبة حسب ترتيب ذكرها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: «بني الإسلام على خمس». وفي رواية: «على خمسة».
وقوله في الحديث: «بني» تمثيل للإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها ([199])، وهذا يقتضي أن يكون هناك من بناه على هذه الخمس، وهو الله - جل وعلا -؛ فهو المشرع، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ليس مشرعًا على جهة الاستقلال وإنما على جهة التبليغ فهو مبلغ لتشريع ربه - جل وعلا -؛ قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4].
والإسلام المقصود هنا هو الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم -، أما الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون فيتفق مع الإسلام الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - في العقيدة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأنبياء أخوة لعلَّات؛ الدّين واحد والشرائع شتى»([200]).
ويتعلق بكلام المؤلف مسألتان:
المسألة الأولى:
كل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان؛ فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان ([201]).
المسألة الثانية:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد، وإنما كانتا ركنًا واحدًا مع أنهما من شقين؛ لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معًا؛ فلا تُقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، والإخلاص تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة تضمنته شهادة أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ([202]).
فدليل الشهادة قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله.
(لا إله): نافيًا جميع ما يُعبد من دون الله إلا الله، مثبتًا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكـه.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
شرع المصنف - رحمه الله - في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة، وبدأ بدليل الشهادة وهي بالمعنى العام خبرٌ قاطع، لكن المصنف أطلق لفظ «الشهادة» على شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به؛ فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها.
وعبارة السلف في الشهادة تدور على الحُكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وذكر ابن القيم وغيره «أنه لا تنافي بينها؛ فإنّ الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه.
وأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وتكلمه بذلك وإعلامه غيره بما شهد به وإلزامه بمضمونها.
وشهادة الله - جل وعلا - لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به»([203]).اهـ
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
«الإعلام والإخبار نوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر؛ تارة يعلمه بقوله وتارة بفعله؛ فمن فعل الطاعات وقرب بأنواع القربات فإنه مخبر ومعلم بشهادته لله أنه لا إله إلا هو»([204]).
المسألة الثانية:
الفرق بين «شهيدًا» في حق الله تعالى و«أشهد» في حق المخلوق.
قال ابن سيده: الشاهد العالم الذي يبيِّن ما علمه.
فالله عالم بذلك وبحقيقته.
قال أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن (ثعلب): شهد الله: أي بيَّن الله أنه لا إله إلا هو، وشهادة الله سبحانه وتعالى أعظم شهادة في الوجود وهي أنه لا إله إلا هو في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، والذي شهد بهذه الشهادة أعظم شاهد وهو الله - جل وعلا -؛ فلا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته - جل وعلا - لنفسه بالألوهية.
المسألة الثالثة:
«لا»: حرف لنفي الجنس تعمل عمل «إن» بشرطها، و«إن» تنصب المبتدأ وترفع الخبر؛ كقولك: لا أحدَ في الدار.
وهنا فائدة: «لا» النافية للجنس يسميها بعض النحاة: لام التبرئة ([205])، وتلاحظ أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من آلهتهم سوى الله - جل وعلا - ولم يتبرأ من عبادة الله تعالى؛ بل استثنى ربه من المعبودين.
«إله»: فعال بمعنى مفعول؛ كقولك: إمام بمعنى أنه مؤتمٌّ به، وكتاب بمعنى مكتوب؛ فالإلهية تعني العبادة، والألوهية العبودية، وأصلها من أَلَه يَأْلَهُ إلهةً وألوُهةً: إذا عبد مع الحبّ والخوف والرجاء.
قال رؤية:
لله درُّ الغانيات المدّهْ
سبَّحن واسترجعن من تألهي([206])
فمعنى الإله: المألوه الذي يُقصد للعبادة، وهذا ما يقتضيه لسان العرب([207])، وأجمع عليه أهل العلم؛ فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إلهًا([208])، وهو الذي جاء في القرآن؛ قال تعالى: ﴿وَيَذَرَكَ وَآَلِهَتَكَ﴾ [الأعراف: 127]، وذكر ابن جرير - - رحمه الله - - بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: «ويذرك وإلاهتك». قال: عبادتك. ويقول: إنه كان يُعبد ولا يَعبْدُ. وذكر مثله عن مجاهد ([209]).
وكان فرعون يقول: «أنا ربكم الأعلى». ويقول: «ما علمت لكم من إله غيري». وعلى القراءة المشهورة: «وآلهتك»؛ هي أصنام عبدها قوم فرعون معه.
تنبيـه:
هناك من فسر الإله في هذا الموطن بغير ما تقدّم كما صنع أهل الكلام من أشاعرة وماتريدية وغيرهم؛ فبعضهم فسّر الإله بالقادر على الاختراع، وبعضهم فسّر لا إله إلا الله بقوله: لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله.
فتوجه معنى هذه الكلمة إلى الربوبية؛ وهذا باطل لأدلة منها: أن الله - جل وعلا - أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل لا إله إلا الله؛ قال تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾. [هود: 1-2]، وقال: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾. [المؤمنون: 32]، وكان القوم الذين بُعث إليهم محمد - صلى الله عليه وسلم - مقرِّين بأن الله - جل وعلا - هو الرب؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: 87].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحصين: «كم إلهًا تعبد؟ » قال: (أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء) قال: «فمن الذي تعدّ لرغبك ورهبك» قال: (الذي في السماء)([210])؛ فهذا معنى لا إله إلا الله.
فهي كلمة نفت الإلهية عن غير الله وأثبتتها لله وحده، وسيقت لتوحيد الإلهية مطابقة؛ لا كما يقول بعض المخالفين: إن معناها: لا يخلُقُ ولا يرزقُ إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله.
وهي وإن دلّت على ما ذكر بطريق التضمن إلا أنها موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ولهذا المعنى أُرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل إيضاحه وتقريره.
«إلا»: أداة استثناء، وبعضهم يقول: أداة حصر.
«الله»: أصله الإله، لما أُدخلت الألف واللام على «إلاه» حُذفت الهمزة تخفيفًا، كما قالوا للوشاح: إشاح، وللوجاج: إجاج([211]).
تنبيـه:
خبر «لا» في كلمة «لا إله إلا الله»:
قال العلماء: الخبر محذوف؛ لأن العرب تحذف خبر «لا» النافية للجنس إذا كان واضحًا، قال ابن مالك - رحمه الله -:
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر
إذا المراد مع سقوطه ظهر ([212])
ومن الواضح أن المشركين قالوا بأن هناك آلهة أخرى ولم ينازعوا في ذلك.
فيقدّر الخبر: بأنه «حق»([213])، وبذلك يتبين الجواب عن الإشكال التالي:
كيف يقال «لا إله إلا الله» مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماها الله - جل وعلا - آلهة، كما سماها عابدوها بذلك؟ قال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: 101].
ومزيدًا في الجواب قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: 62]، وقال في قصة يوسف عليه السلام ودعوته لمن معه في السجن: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾. [يوسف: 40]؛ فدلَّ ذلك على أن تلك المعبودات تسمى آلهة؛ لكنها باطلة وليست حقة.
المسألة الرابعة:
قوله: (لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه): فيه أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية.
وقد تقدم معنا شيء من ذلك.
وقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 18] معناه أنه كما شهد الله - جل وعلا - أنه لا إله إلا هو، فإن الملائكة شهدوا بذلك وأولو العلم أيضًا.
وفُسرت شهادة الملائكة بالإقرار والتبيين والإظهار.
ويؤخذ من الآية: تعديل أهل العلم وتزكيتهم إذ ارتقوا إلى هذا المقام، ويؤخذ منها الحث على طلب العلم وتحصيله؛ لينال صاحبه تلكم الرفعة والمنزلة.
والمراد بالعلم في الآية: العلم الشرعي، أما غيره من العلوم الدنيوية من حسابية أو صناعية أو تجريبية فلا يدخل في الآية، وأهله ليسوا من أهل العلم المراد في نصوص القرآن والسنة.
وقوله تعالى: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾: أي مقيمًا للعدل والقسط في جميع أموره.
فـ«قائمًا» حال من «هو» الواقع بعد «إلا».
فتكون الحال في حيز الشهادة، ويكون المشهود به أمرين:
1- الوحدانية.
2- القيام بالقسط.
وقد تكون حالًا من الاسم الجليل، فيكون المشهود به الوحدانية فقط، والحال ليست في حيز الشهادة، والتقدير: شهد لنفسه بالوحدانية حال كونه قائمًا بالقسط.
أما العزيز: فمعناه أنه عزيز في ملكه. راجع لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.
وأما الحكيم: فمعناه أنه حكيم في صنعته، راجع لقوله: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾.
وكرر فقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد.
المسألة الخامسة:
ذكر أهل العلم شروطًا سبعة لكلمة لا إله إلا الله وهي:
1- العلم المنافي للجهل.
2- اليقين المنافي للشك.
3- القبول المنافي للرد.
4- الانقياد المنافي للترك.
5- الإخلاص المنافي للشرك.
6- الصدق المنافي للكذب.
7- المحبة المنافية لضدها.
وبعضهم عدَّها ثمانية شروط مضيفًا الكفر بما سوى الله تعالى.
ولعل مأخذ هذا الشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى»([214]).
وإذا تأملت معنى لا إله إلا الله وجدت أنه لا يوقن أحد بها إلا بكفره بما سوى الله كما أنه لا ينقاد ولا يخلص إلا بذلك.
فالكفر بما سوى الله داخل في الشروط السبعة ولكن الداعية والمعلم قد ينص على هذا الشرط لحاجة مجتمعه ومن حوله لذلك، والله أعلم.
* * *
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: 26-28].
وقوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لما ذكر المؤلف - رحمه الله - دليل الركن الأول من أركان الإسلام دخل في التفصيل فيه لأهميته، ومراده: تفسير (لا إله إلا الله) من القرآن؛ لأن الله - جل وعلا - بيَّنها في كتابه في غير موضع، ولم يكل عباده إلى أحد سواه في بيان معناها.
وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: 26-28]: الذي قاله إبراهيم عليه السلام هو: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
وهذه الكلمة من إبراهيم عليه السلام اشتملت على نفي وإثبات؛ فقوله: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾: نفي وبغض؛ لأن من معاني البراءة البغض، وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾: إثبات.
وهذه الكلمة جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه وولده؛ فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأفضل الرسل بعد محمد - صلى الله عليه وسلم -، والأنبياء من بعده جاؤوا بتقرير هذه الكلمة.
وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: أي لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحَّد منهم. وقيل: لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ويتركون الشرك.
ومثل هذه الآية في المعنى قول الله - جل وعلا -: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64].
في هذه الآية أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: تعالوا إلى كلمة... و«أهل الكتاب» هم من أُنزل على رسولهم كتاب كالتوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام؛ فيكون اليهود والنصارى من أهل الكتاب.
والمعنى: يا أهل التوراة والإنجيل والزبور تعالوا إلى كلمة عدل نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وجاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا﴾: أي آلهة؛ فالمراد بالربوبية هنا الألوهية؛ بدليل أنهم ما ادعوا خالقًا ورازقًا غير الله - جل وعلا -.
﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: أي امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة - فيا أمة محمد قولوا لهم: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ مخلصون لله بالتوحيد دونهم؛ أي: صرحوا لهم مشافهة أنكم مسلمون وأنهم كفار وأنكم براء منهم وهم براء منكم، وهذا دليل على أنه لابد أن تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين، وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف دينك.
والمؤلف - رحمه الله - ذكر نصين من القرآن في معنى لا إله إلا الله وتفسيرهما، وفي القرآن الكريم أكثر من ذلك؛ لكنه - رحمه الله - اكتفى بموضعين عن البقية.
ومن النصوص التي تفسر هذه الكلمة قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: 23]؛ فقوله: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ هو المراد بـ «لا إله»، وقوله: ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ هو المراد بـ «إلا الله».
وبهذا تتحقق أن معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراء.
مسألة:
من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة.
فائدة:
عند الاستقراء والتتبع تعلم أن الكلمة التي يُدعى إليها جميع الناس هي لا إله إلا الله؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقريش: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»([215])، والرسل قالوا لأقوامهم ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾. [الأنبياء: 25].
فلا يختلف فيها رسول ولا كتاب، ويستوي فيها الناس من جهة فرضيتها ووجوبها؛ فهي كلمة عدل ونَصَف.
وإذا كان كذلك فهل يهتم بها تعلمًا وعملًا ودعوة وتعليمًا من انتسب إلى الدعوة إلى الله من أفراد أو مؤسسات أو جمعيات أو غيرها؟
* * *
ودليل شهادة أنَّ محمدًا رسول الله قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128].
ومعنى (شهادة أنَّ محمدًا رسول الله): طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألاَّ يعبد الله إلا بما شرع.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
فرغ المؤلف - رحمه الله - من ذكر دليل شهادة ألاَّ إله إلاَّ الله وتفسير هذه الشهادة وشرع في ذكر دليل شهادة أنَّ محمدًا رسول الله، وكلا الشهادتين داخل في الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة.
واللام في «لقد» تُسمَّى باللام الموطئة للقسم.
وإذا جاءت فإننا نعلم أنَّ هناك قسمًا محذوفًا فالمعنى: والله لقد جاءكم، والمقسم عليه هو مجيء الرسول لنا من أنفسنا وجنسنا ومن بني جلدتنا ويتكلم بلساننا، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: 2].
والله - جل وعلا - يمنُّ على المؤمنين بإرسال محمد - صلى الله عليه وسلم - إليهم رسولاً من أنفسهم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه وأمانته، حتى إنه كان يُسمَّى قبل بعثته بـ«الأمين»، أرسله الله تعالى بشرًا إلى بشر ولم يجعله ملَكًا؛ لتقوم عليهم الحجَّة وتتضح المحجة، فيستطيعون سؤاله عن أمور دِينهم ودنياهم، ومن كان كذلك فإنَّ النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم.
وجاء في قراءة (من أنفَسكم) بفتح الفاء والمراد: من أشرفكم وأكرمكم.
وقوله ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي أنَّ ما يشقُّ على أمته يكون شديدًا وشاقًا عليه، وكان يقول - صلى الله عليه وسلم -: «أحبّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة»([216]). ويقول: «إنَّ هذا الدين يسر»([217]).
وقوله ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار.
وقوله: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ فيه بيان خُلُق هذا النبي عليه الصلاة والسلام تجاه المؤمنين.. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ﴾ [الأحزاب: 21].
ومن صفات المؤمنين أن يكون الواحد منهم رحيمًا بإخوانه برًّا لينًا، وفي وجه الكفار غضوبًا عبوسًا ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 54].
ووجه الاستدلال بالآية التي أوردها المصنف على شهادة أنَّ محمدًا رسول الله يتضح بمعرفة معنى هذه الشهادة فمعناها: الاعتقاد والعلم بأنَّ محمدًا رسول من عند الله، فتعتقد ذلك اعتقادًا يصحبه إخبار وقول، فهو عبدٌ لا يُعبد، ورسول لا يُكذَّب كما قال - جل وعلا -:
﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام: 50].
وقوله سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 188].
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
من الأدلَّة على رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -:
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -:
«وهناك أدلَّة عقلية على شهادة أنَّ محمدًا رسول الله نبَّه عليها القرآن؛ من ذلك: ترك الله خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حقِّ الله، ونبَّه عليه في قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنـزلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنـزلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ﴾ [الأنعام: 91].
ومنـها: أنَّ قول الرجل «إني رسول الله»، إما أن يكون خير الناس، وإما أن يكون شرَّهم وأكذبهم، والتمييز بين ذلك سهل، يُعرف بأمور كثيرة، ونبه على ذلك بقوله: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنـزلُ الشَّيَاطِينُ * تَنـزلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ [الشعراء: 221-222].
ومنـها: شهادة الله بقوله ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 43].
ومنـها: شهادة أهل الكتاب بما في كتبهم، كما في الآية.
ومنـها: وهي أعظم الآيات العقلية، هذا القرآن الذي تحدَّاهم الله بسورة من مثله، ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة العربية، فنحن نعلمها من معرفتها بشدَّة عداوة أهل الأرض له، علمائهم، وفصحائهم، وتكريره هذا، واستعجازهم به، ولم يتعرضوا لذلك، على شدَّة حرصهم على تكذيبه، وإدخال الشبه على الناس.
ومنـها: تمام ما ذكرنا، وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحدٌ أن يأتي بسورة مثله إلى يوم القيامة؛ فكان كما ذكر، مع كثرة أعدائه في كلِّ عصر، وما أُعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم.
ومنـها: نُصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس.
ومنـها: خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا، ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم.
ومنها: أنه رجل أميٌّ لا يخط، ولا يقرأ الخط، ولا أخذ عن العلماء ولا ادَّعى ذلك أحد من أعدائه، مع كثرة كذبهم وبهتانهم؛ ومع هذا: أتى بالعلم الذي في الكتب الأولى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: 48]([218]).
المسألة الثانية:
هناك من يُخالف في وُجوب طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لاعتقاد أنه لا تجب طاعته، فهذا يختلف عمّن خالف لغلبة هوى، فالثاني عاصٍ لا يكفر، والأول لم يأتٍ بشهادة أنَّ محمدًا رسول الله أصلاً.
المسألة الثالثة:
الشهادة مأخوذة من «شهد يشهد شهودًا وشهادة» إذا علم واعتقد بقلبه وأخبر بلسانه، ولا تكون الشهادة شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث: العلم والاعتقاد والإخبار.
والشاهد عند القاضي لا يُسمَّى «شاهدًا» إلا إذا علم وتكلَّم وأخبر.
فشهادة أنَّ محمدًا رسول الله معناها أن يعلم العبد ويعتقد ويُخبر أنَّ محمدًا بن عبد الله القرشي المكي رسولٌ من عند الله - جل وعلا -، أُنـزل عليه الوحي فبلَّغ ذلك؛ لأن الرسول مُبلّغ.
وهناك من يُفسّر شهادة أنَّ محمدًا رسول الله بمقتضاها([219])، كما فعل المصنِّف - رحمه الله - حيث قال: «ومعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع».
تنبيـه:
من تلفَّظ بهذه الشهادة بدون أن يعمل بما دلَّت عليه لا يكون ممن شهد أنَّ محمدًا رسول الله على الحقيقة، فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم بقلبه علم اليقين وينطق بلسانه ويعمل بما دلَّت عليه.
* * *
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5].
ودليل الصيام قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
ودليل الحج قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
أي: ودليل ركنيَّة الصلاة وركنيَّة الزكاة قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5].
أي: وما أُمر الذين كفروا إلا ليوحِّدوا الله ويفردوه بالعبادة حنفاء مقبلين على دين الإسلام مائلين عن الأديان كلها.
وأمروا أيضًا بإقامة الصلاة المكتوبة وإيتاء الزكاة المفروضة، وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأنَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، فهذه الآية دليل على الصلاة والزكاة، كما أنَّ فيها تفسيرًا للتوحيد ولا إله إلا الله.
وقوله: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ أي أنَّ الذي أُمروا به في هذه الآية الكريمة هو الملَّة والشريعة المستقيمة.
قوله: (ودليل الصيام): أي دليل وجوبه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
والمعنى: فُرض عليكم الصيام.
والصوم في اللغة: الإمساك، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: 26] أي صمتًا؛ لأنه إمساكٌ عن الكلام.
وفي الشرع: الإمساك بنيَّة الصيام عن شيءٍ مخصوصٍ في وقت مخصوص، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس([220]).
وقوله: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183].
أي من الأنبياء والأمم، فالصوم عبادة قديمة ما أخلى الله أمةً لم يفرضه عليهم كما فرضه عليكم، فأنتم متعبِّدون بالصيام في أيام كما تعبَّد من كان قبلكم.
﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ المعاصي بالصيام لِما فيه من كسر النفس وترك الشهوات من الأكل والشرب والجماع وغيرها.
قوله: (ودليل الحج): أي دليل وجوبه وفرضيته قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
و«الحج» بفتح الحاء ويجوز كسرها معناه لغة: القصد، وفي الاصطلاح: قصد موضع مخصوص وهو البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص وهو أشهر الحج للقيام بأعمال مخصوصة([221]).
ومعنى الآية: ولله على الناس فرض حج البيت ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، ومن لم يستطع لا يجب عليه الحج.
ويتعلق بكلام المؤلِّف مسائل:
المسألة الأولى:
تقدَّم معنا أنَّ التعبير بالأركان لهذه الخمس إنما هو مصطلح حادث عند الفقهاء ولم يأت نصٌ صريح عليه، والفقهاء عرّفوا الركن بأنه ما تقوم عليه ماهية الشيء، فلا يُتصور قيام الشيء بدون ركنه، فيقولون مثلاً: «أركان البيع» يعني ما تقوم عليه ماهيته، فلا يُتصوَّر بيعٌ موجود إلاَّ بوجود أركانه وهي البائع والمشتري والسلعة والصيغة، والنكاح لا يُتصور وجوده بدون زوجين وصيغة.
وهذه التسمية يُشكل عليها أنَّ أهل السنة قالوا: «إنَّ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأدَّى الصلاة المفروضة وترك بقية الأركان تهاونًا وكسلاً فإنه يُطلق عليه لفظ مسلم ولا يُسلب عنه اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان تهاونًا وكسلاً»، وهذا متفقٌ مع قولهم في الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، ويعنون بالعمل جنسه، ويمثله في أركان الإسلام الصلاة.
فنقول:
مرادهم بهذا ما دلَّت عليه الأدلة الشرعية وقواعد أهل السنة من أنّ هذه الأركان ليس معنى كونها أركانًا أنه إن فُقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام، كما أنه إن فُقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع، وإن فقد من النكاح ركن لم تقم حقيقة النكاح، فالإسلام يتُصور وجوده شرعًا بلا أداءٍ للحج، بمعنى أنه لو ترك الحج تهاونًا فإنه يقال عنه مسلم، ولو ترك تأدية الزكاة تهاونًا لا جحدًا فإنه يقال عنه مسلم، وهكذا في صيام رمضان.. ويتعلَّق بهذه المسألة مسألتان الثانية والثالثة.
المسألة الثانية:
الصلاة اختلاف أهل السنة فيمن تركها تهاونًا وكسلاً هل يسلب عنه اسم الإسلام أم لا؟
فقالت طائفة من أهل السنة: إنَّ ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً لا يسلب عن المسلم الذي شهد أنَّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله اسم الإسلام، وإنما يكون على كبيرة وهو في كفر أصغر، وهذا قول طائفة قليلة من أهل السنة.
وقال جمهور أهل السنة: إَّن ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً كُفر، وأنه من ترك الصلاة فليس له إسلام، ولو أتى بتأدية الزكاة وصيام رمضان والحج، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، والصحابة أجمعوا على أنَّ ترك الأعمال المأمور بها ليس بكفر إلا الصلاة، كما قال شقيق بن عبد الله عن الصحابة رضي الله عنهم «كانوا لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصلاة»([222]).
فالصلاة مُجْمَع على أن تركها كفر وهو الذي دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42-43] الآيات.
وعن بريدة t مرفوعًا: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»([223])، وعن جابر t عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة»([224])، ومن الأدلَّة التي استدلَّ بها الإمام أحمد على كُفر من تركها كسلاً الحديث الذي أورده المصنف في آخر الرسالة «وعموده الصلاة»([225]).
تنبيه:
من ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً فإنّه يُدعى إلى فعلها، فإن أبى وجب قتله، والدّاعي له هو الإمام أو نائبه([226]).
المسألة الثالثة:
جمهور أهل السنة على أنَّ من ترك الزكاة تهاونًا وكسلاً أو ترك الصيام أو ترك الحج فإنه لا يَكفر لأنه ما دلَّ الدليل على ذلك.
وقالت طائفة من أهل العلم من الصحابة فمَن بعدهم: إنَّ من ترك بعض هذه الأركان فهو كافرٌ على خلاف بينهم في هذا، فعمر t قال بأنَّ ترك الحجِّ مع القدرة عليه ووجود الاستطاعة المالية والبدنية كُفر، حيث قال لعُمّاله في الأمصار أن يكتبوا: «من وجد سِعةً من المسلمين ثم لم يَحجُّوا فلتضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين»([227]).
وعبد الله بن مسعود t كفّر من ترك الزكاة حيث قال: «ما تارك الزكاة بمسلم»([228])، وهذا خلاف ما عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في أنَّ من تركها بلا امتناع وإنما تركها تهاونًا فإنه لا يكُفر.
* * *
المرتبة الثانية: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
انتهى من المرتبة الأولى من مراتب الأصل الثاني ودخل في المرتبة الثانية وهي الإيمان، فقوله «الإيمان بضع وسبعون شعبة» يعني به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام، وتقدَّم معنا أن الإيمان إسلام وزيادة فهو أوسع منه.
وجاء في البخاري ومسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»([229]).
فقوله «شُعبة» تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شُعب وفروع، ومثَّل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبأدناها ومثل بشعبة من الشعب، وهذه ثلاث شعب متنوِّعة: لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، والحياء عمل القلب.
وهذا التمثيل مقصود لكي نستدلَّ بهذه الثلاث على نظائرها، فبـ«لا إله إلا الله» نستدلُّ على الشعب القولية، وبـ«إماطة الأذى عن الطريق» نستدلُّ على الشعب العملية، وبـ«الحياء» نستدل على الشعب القلبية.
ويتعلق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
اختلف العلماء في شعب الإيمان وعدّها، وصنفوا في ذلك مصنفات، ومن هؤلاء الحليمي شيخ البيهقي وكتابه «المنهاج في شعب الإيمان»، وألَّف على نسقه البيهقي «شُعب الإيمان» ولكن بشكلٍ أوسع، واختلفوا في العدّ بحسب اختلافهم في القياس على هذه الثلاث.. والذي نخرج به من هذه الشعب أنَّ منها الصلاة والزكاة والصيام والحج.
المسألة الثانية:
تعدَّدت عبارات السلف حول تعريف الإيمان، فبعضهم يقول بأنَّ الإيمان قولٌ وعمل، وبعضهم يزيد فيقول: قول وعمل ونية.
والمراد بالقول والعمل في التعريف الأول: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، فالقول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، والعمل يرجع إلى القلب واللسان والجوارح.. وقول القلب اعتقاده، وقول اللسان تكلمه بالشهادتين.. وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلَّم به المرء في عبادته بلسانه كالفاتحة والأذكار الواجبة، وعمل الجوارح هو ما يتَّصل بعمل اليدين والرِّجلين وسائر جوارح المكلَّفين.
وبهذا يرجع القول والعمل والنية إلى القول والعمل، فالإيمان قولٌ وعملٌ عند أهل السنة، والعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب هو نيته.. فمن قال بأنه قول وعمل ونية أخرج عمل القلب ونص عليه بقوله «هو النية»، ومعلوم أنَّ عمل القلب أوسع من النية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
فعبارات السلف صحيحة وموافقة للأدلَّة كما قال شيخ الإسلام: «ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمَّة السنة في تفسير الإيمان، فتارةً يقولون هو قولٌ وعمل، وتارةٌ يقولون هو قولٌ وعملٌ ونية، وتارة يقولون قولٌ وعملٌ ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح، فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعًا»([230]).اهـ
المسألة الثالثة:
الإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة واستعمال في الشرع من الكتاب والسنة، فالإيمان لغة: «أمِنَ يأمنُ أمانًا»، واشتُقّ منه إيمان، فمن حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن.
ومعناه التصديق الجازم والاستجابة، فالتصديق في اللغة والقرآن لا يُطلق إلاَّ على من استجاب، ولهذا يقول بعض أهل العلم: «الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم»، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذاك لأنه لا يُقال لأحد بأنه مصدِّق إلاَّ إذا كان مستجيبًا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة من أمور التصديق.. قال - جل وعلا - في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: 103-105]
ومعلوم أنَّ إبراهيم - عليه السلام - كان مُصدقًا للرؤيا لأنه هو الذي رآها، فلم يكن عنده شكٌّ من حيث اعتقاد أنه رأى، ولكن سُمِّي مصدِّقًا للرؤيا لَمَّا استجاب بالفعل.
فالتصديق الجازم في لغة العرب تارةً يكون من جهة الاعتقاد، وتارةً يكون من جهة العمل، فما كان من الإخبار تصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي مما يُسمى بـ«الإنشاءات» تصديقه بامتثاله.
والأوضح في تعريف الإيمان لغةً أن يقال: هو التصديق والاستجابة، وأنَّ اشتقاقه من الأمن كما قرَّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -([231]).
وهنا تنبيه:
الإيمان بالمعنى اللغوي في اللغة والقرآن يعُدَّى باللام، قال - جل وعلا - ﴿فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: 26] لأنَّ الإيمان هنا تصديق واستجابة.
وقال - جل وعلا -: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: 17].
وقال - جل وعلا - أيضًا في قصة موسى - عليه السلام - في سورة الدخان: ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ﴾ [الدخان: 21].
فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أن يُعدَّى باللام غالبًا، وأما إذا عُدِّي الإيمان في القرآن بالباء فإنه يُراد منه الإيمان الشرعي المخصوص كقول الله تعالى: ﴿آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنـزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 285]
وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نـزلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [النساء: 136].. والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة.
فعُدِّي الإيمان في تلك المواضع باللام لأنه يتضمَّن معنى الاستجابة، ولك أن تقول لأنَّ معناه التصديق والاستجابة، والاستجابة في اللغة تُعدَّى باللام كقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: 50]
وتقول في الصلاة: «سمع الله لمن حمده»؛ لأنَّ السماع هنا مضمن معنى الإجابة، يعني «أجاب الله لمن حمده»، وهذا يوضِّح أنَّ لفظ الإيمان في اللغة تصديق معه استجابة.
والإيمان الشرعيُّ له صلةٌ بالإيمان اللغوي؛ فهو في اللغة اعتقادٌ واستجابة، وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة اعتقادًا خاصًا واستجابةً خاصة، وثمَّ زيادة مراتب وشروط وأركان.
المسألة الرابعة:
أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي القول والعمل والاعتقاد، وأخذوا هذه الأركان من النصوص، ويريدون بـ«القول» قول القلب واللسان، أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب من الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله والاعتقاد بجميع الأخبار والاعتقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي، فيعتقد أنه مخاطب بذلك وهذا غير اعتقاد الوجوب.
وأمَّا قول اللسان فهو ما يُدخِلُه في الإسلام، فيشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله.
(ويريدون بـالعمل): عمل القلب واللسان والجوارح، أمَّا عمل القلب فللقلب أعمالٌ كثيرةٌ ومتنوِّعة، وأولها وأعظمها «النية» و«الإخلاص»، وهذان اللفظان يأتيان مترادِفَين وأحيانًا يُفارق أحدهما الآخر.
والنية تارة تُستعمل لتمييز العبادة عن غيرها، وتارة تُستعمل في إخلاص القصد والعمل لله، فإذا قلنا بأنَّ عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص فنعني بـ«النية» تمييز العبادة عن غيرها حتى يتعبَّد بعمل ميَّزه عن غيره.
و«الإخلاص» أن يكون القصد وجه الله - جل وعلا - وحده في عمله واعتقاده.
ويدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرَّغَبُ والرَّهَبُ وغير ذلك من أعمال القلوب، وهي واجبات.
وأمَّا عمل اللسان الواجب يعني ما كان امتثاله من الأوامر راجعًا إلى اللسان مثل أن يؤمر بأن يقرأ الفاتحة في الصلاة، فقراءته هي عمل اللسان الواجب، ومثل أن يؤمر بقول حينما يُهلُّ بالحج، فقوله هو عمل اللسان الواجب.
وأمَّا عمل الجوارح فامتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح التي هي غير اللسان.
وأهل السنة والجماعة يريدون بعمل الجوارح هنا جنس الأعمال لا كل عمل، فلو تصوَّر أنَّ أحدًا لم يعمل عملاً البتة فلم يمتثل أمرًا ولم يَجتنب نهيًا فإنه لم يأتِ بهذا الركن من أركان الإيمان والذي هو العمل؛ لأنَّ العمل لا بدَّ فيه من قلب ولسان وجوارح جميعًا، لكن لو تصور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضًا فامتثل أمرًا أو أمرَين أو ثلاثة أو عشرة، أو امتثل النهي عن فعلٍ أو فعلين أو ثلاثة؛ فهذا قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة.
وهنا مسألة متعلِّقة بهذا الركن وهي: هل هذا العمل هو الصلاة أم غيرها؟
فاختلف أهل السنة والجماعة في ذلك، والبحث هنا يكون هل من ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً يخرج من الإيمان أم لا؟
وتقدَّم الكلام على هذه المسألة، لكن نقول هنا إنَّ من أهل العلم من قال: «يخرج من الإيمان ويكفر»، ومنهم من قال: «لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة وإنما يخرج من الإيمان إذا لم يعمل خيرًا قط فلم يصلِّ ولم يزكِّ ولم يحجّ ولم يصمْ ولم يصل رحمه طاعة لله ولم يبرّ بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله، فإذا لم يوجد شيئًا البتة فهذا خارج عن اسم الإيمان»، ولم يأتِ بهذا الركن بالاتفاق، ولكن اختلفوا في الصلاة الخلاف المعروف، وتقدَّم شيء منه.
فهذه أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة: القول والعمل والاعتقاد، ولذلك اشتهر عنهم قولهم في الإيمان أنه «قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان»، فشمل خمسة أشياء ومنها العمل فهو ركن من أركان الإيمان، ودليل ذلك أنَّ الله جلا وعلا سمَّى الصلاة عملاً فقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 143].
والإيمان هو الصلاة، لأنها لما نـزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة: «ما شأن صلاتنا حين توجهنا إلى بيت المقدس؟»، وقال آخرون: «ما شأن الذين ماتوا قبل أن يُدركوا القبلة الجديدة، فهل ضاعت أعمالهم؟ ».
فأنـزل الله - جل وعلا - قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 143]
ووجه الاستدلال أنه سَمَّى الصلاة «إيمانًا»، وإطلاق الكلِّ وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته، وأنه ركن فيه كما هو مُقرَّر في الأصول، وبهذه القاعدة استدلَّ أهل العلم على أنَّ القراءة في الصلاة واجبة لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]
والمراد بـ«القرآن» هنا الصلاة، فسمَّى الصلاة «قراءة»، وأطلق عليها ذلك لأنها جُزءها، فهذا دليل من دلائل الركنية.
ومن الأدلَّة على أنَّ العمل ركن من أركان الإيمان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفد عبد القيس حيث قال لهم «آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدُّوا الخُمس من المغنم»([232]) فأدخل أداء الخمس في الإيمان وأدخل الصلاة والزكاة كذلك، وبالاتفاق هذه أركان الإسلام فجعلها تفسيرًا للإيمان مما دلَّ على أنها ركنٌ منه.
والآيات التي فيها عطف العمل على الإيمان إنما هي من باب عطف الخاص على العام كما قال - جل وعلا -: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [هود: 11]
وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: 96]
فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام، فلا يعني ذلك العطف أنه للتغاير وأنه ليس بركن كما استدلَّ به المرجئة حيث قالوا بأنه خارج عن الماهية، بل الصحيح أنّ هذا العطف من باب عطف الخاص على العام، وقد أتى هذا المعنى للعطف في القرآن حيث قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 98]
فذكر الملائكة والرسل ثم عطف عليهم بذكر جبريل وميكال مع أنهما من الملائكة والرسل.
المسألة الخامسة:
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، والأدلّة على ذلك كثيرة، قال - جل وعلا -: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]
ووجه الاستدلال هنا أنَّ في الآية حصر وصف المؤمنين بأنهم إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا، فدلَّ على أنَّ صفة الإيمان يكون فيها الزيادة، وإذا كانت فيها الزيادة فإنه يكون فيها النقصان؛ لأنَّ الاسم ليس شيئًا واحدًا بل هو متفاوت، وما كان فيه من زيادة فإنها إذا تُركت أو ذهبت رجع إلى نقص.
ومن الأدلَّة قوله - جل وعلا -: ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: 4]
وأهل السنة والجماعة عندهم أنَّ زيادة الإيمان ثابتة بالأدلة، وكلُّ دليل فيه زيادة الإيمان يكون فيه حُجة على نقص الإيمان؛ فالإيمان يزيد وينقص، ولذلك عرَّفوا الإيمان بما دلَّت عليه الأدلَّة، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -:
«المأثور عن الصحابة وأئمَّة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أنَّ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»([233]).
ومن أهل السنة من قال بأنه يزيد ولا ينقص، وذلك لأنَّ الأدلَّة دلّت على زيادته ولم تدلّ على نقصانه، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -:
«وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذِكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص وهذا إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص»([234]).اهـ
وأركانه ستة:
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه.
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: 177].
ودليل القدر قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
بعد أن ذكر المؤلف - رحمه الله - المرتبة الثانية من الأصل الثاني وهي الإيمان ذكر أركانه الستة، وهذه الأركان جاءت في القرآن منها خمسة متتابعة في آية، وواحد أُفرد في آية أخرى، وبين المؤلف ذلك..
ومما يُستدل به على ما ذكره المصنف قوله تعالى: ﴿آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنـزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: 285]
وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: 177]
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نـزلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنـزلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]
فأصول هذه الأركان جاءت في القرآن كما أنها أتت في السنة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
ويتعلق بكلام المؤلّف مسألتان:
المسألة الأولى:
أركان الإيمان الستة فيها قدرٌ واجب لا يصحُّ إسلامٌ وإيمانٌ بدونه، وهناك قدر زائد تابع للعلم وبلوغ الدليل، ومثال ذلك: لا بدَّ أن يكون في قلب المسلم تصديق وإقرار واعتقاد بأنَّ هناك ملائكة، وهم خَلقٌ من خلق الله - جل وعلا -، يفعلون ما يأمرهم الله به، ومنهم من يأتي بالوحي للأنبياء.
هذا القدر لا بدَّ من توفُّره لدى كلِّ مَن ادَّعى الإسلام سواء كان عالمًا أو جاهلاً ذكرًا أو أنثى من أهل القرى أو المدن أو البادية أو من أصحاب الصناعات أو التجارات.
أما ما زاد على هذا القدر فلا يُشترط لصحة الإيمان وللدخول في الإسلام.
فمن بلغه العلم بما زاد مع دليله وجب عليه التصديق والإيمان، ومن لم يبلغه مع الإتيان بالقدر المجزئ فهو مؤمن مسلم.
المسألة الثانية:
الإيمان بالله ثلاثة أقسام:
إيمان بأنه واحد في ربوبيته، وإيمان بأنه واحد في ألوهيته واستحقاقه العبادة، وإيمان بأنه واحد في أسمائه وصفاته ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
فالقدر المجزئ من الأول: أن يعتقد أنَّ الله جلَّ جلاله هو ربُّ هذا الوجود وهو الخالق والمدبِّر له والمتصرِّف فيه.
والقدر المجزئ من الثاني: أن يعتقد أنه لا أحد غير الله - جل وعلا - يستحقُّ العبادة أو شيئًا منها.
والقدر المجزئ من الثالث: أن يُؤمن بأنَّ الله - جل وعلا - له الأسماء الحسنى والصفات العُلى دون تعطيل له عن أسمائه وصفاته بالكلية أو جحدٍ لشيء منها بعد وضوح الحجة في ذلك، وبدون تمثيل لها بصفات المخلوق.
والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة: أن يؤمن بأنَّ الله - جل وعلا - له خَلق من خلقه اسمهم «الملائكة»، عبادٌ يأتمرون بأمره - جل وعلا - مربوبون لا يُعبدون، ومنهم من يأتي بالوحي للأنبياء.
هذا القدر هو الواجب، فإذا قال: «لا، أنا لا أؤمن بالملائكة ولم أرَ أحدًا منها»، فهذا انتفى عنه هذا الركن، لكن لو قال: «أنا لا أعلم أنَّ ميكال من الملائكة»، فإنه لا يقدح في إيمانه بالملائكة؛ لأنه يقول: «أنا مؤمن بوجود هذا الخلق من خلق الله، لكن لا أعرف ميكال».
فيبلغ بالحجة فيه ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98]
فإن علم أنها آية ثم لم يؤمن فإنه يكفر.
فهناك قدرٌ مجزئ وهو الذي يجب على كلِّ أحد، وهناك قدرٌ يتفاضل فيه الناس ويجب مع العلم، فكلَّما علم شيئًا من ذلك وجب عليه الإيمان به، وكلَّما علم شيئًا واجبًا من ذلك زاد أجه وثوابه وإيمانه ويقينه.
والقدر المجزئ من الإيمان بالكتب: أن يعتقد بأنَّ الله - جل وعلا - أنـزل على من شاء من رُسله كتبًا، ومنها القرآن الذي هو كلامه، فهذا هو القدر المجزئ، وما زاد عن ذلك فيجب مع العلم والدليل، لكن أول دخوله في الدين يكون بذلك القدر المجزئ وهو الذي يصحُّ معه إيمان المسلم.
والقدر المجزئ من الإيمان بالرسُل: الإيمان بأن الله - جل وعلا - أرسل رُسلاً لخلقه، وأنَّ هؤلاء الرُسل مُوحَى إليهم من الله - جل وعلا -، وأنَّ خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فيؤمن به ويتبعه، فهذا هو القدر المجزئ وما بعد ذلك يكون واجبًا بقدر ما يصله من العلم، وفيه أشياء مستحبَّة في تفاصيل.
والقدر المجزئ من الإيمان باليوم الآخر: أن يؤمن العبد بأنَّ الله - جل وعلا - جعل يومًا يحاسب فيه الناس يعودون إليه ويبعثهم من قبورهم ويلقون ربَّهم ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويدخل المسلم الجنة، ويدخل الكافر النار.
والقدر المجزئ من الإيمان بالقدر: أن يؤمن بأنه ما من شيء يكون إلاَّ وقد قدّره الله - جل وعلا -، بمعنى: أنه - جل وعلا - علم هذا الشيء قبل وقوعه، وعلمُهُ بذلك أول، وأنه كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى.. وإذا اعتقد أنَّ القدر سابق فإن ذلك يشمل العلم، والكتابة.
ويؤمن أيضًا بأنَّ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيءٍ إلا والله - جل وعلا - هو الذي يخلقه كما قال - جل وعلا - ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: 16].
تنبيـه:
شرح هذه الأركان الستة بتفصيل يطول، ومحل بيانها شروح كتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما شابهها – فيما يتعلق بألوهية الله تعالى واستحقاقه العبادة - وشرح العقيدة العامة كشروح العقيدة الواسطية والطحاوية وما شابه ذلك.
المرتبة الثالثة: الإحسان رُكن واحد.
وهو: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128].
وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء: 217-220].
وقوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: 61] الآية.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
انتهى المؤلِّف - رحمه الله - من المرتبة الثانية، وشرع في المرتبة الثالثة من مراتب الأصل الثاني، وفيه «الإحسان».
الإحسان: من «أَحسن العمل» إذا جعله حَسنًا، وإحسان العمل يكون متوجِّهًا إلى أمرَين، الأول: القصد والنية، والثاني: المتابعة.
فالأول يتعلَّق بالباطن، والثاني يتعلَّق بالظاهر، ويتفاوت الناس في الكمال؛ ولذلك تختلف درجات المحسنين، فبعضهم أفضل من بعض وأكمل إحسانًا من بعض.
ومن أحسن العمل فإنه سيُثمِر له الإخلاص؛ لأنَّ نهاية الإخلاص تنشأ عن حقيقة استحضار استحقاق الله للعبادة وما يتضمَّن ذلك الاستحقاق من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال.
ومن كان كذلك فإنه يدخل في معية الله الخاصة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128].
وهذه المعية المراد بها: أنه مع المحسنين يؤيِّدهم وينصرهم ويوفِّقهم ويُسدِّدهم ونحو ذلك من المعاني.
قوله - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه»..
«يُشير إلى أنَّ العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قُربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يُوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم»([235]).
كما جاء في رواية أبي هريرة «أن تخشى الله كأنك تراه».
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض جسدي فقال: «اعبد الله كأنك تراه»([236]).
وسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كشف العورة خاليًا فقال «الله أحقُّ أن يُستحيا منه»([237]).
ويزداد هذا الاستحضار بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله ونعوت جلاله وجماله وآثار ذلك كلّه في النفس والملكوت.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»:
قال ابن رجب - رحمه الله -:
«قيل إنه تعليل للأول؛ فإنَّ العبد إذا أُمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قُربه من عبده، حتى كأنَّ العبد يراه، فإنه قد يَشقُّ ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأنَّ الله يراه، ويطَّلع على سرِّه وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيءٌ من أمره، فإذا حقَّق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته، حتى كأنه يراه.
وقيل: بل هو إشارة إلى من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه، فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك..
وقال بعضهم: خَفِ الله على قدر قدرته عليك واستحِ منه على قدر قُربه منك.
قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، فأشارت إلى المقامين اللذين تقدَّم ذكرهما، وهما:
الأول: مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مُخلص لله، لأنَّ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل.
والثاني: مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنوَّر القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان.
وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل - عليه السلام -، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر.
وقد فسَّر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله - عز وجل -: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: 27]، بهذا المعنى
ومثله قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: 35]، والمراد: مثل نوره في قلب المؤمن.
كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف»([238]).اهـ
وقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»: دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: 61].
وقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء: 218-220].
ويتعلَّق بكلام المؤلِّف مسألة وهي:
أنَّ كلَّ مسلم عنده قدرٌ من الإحسان لا يصحُّ عمله بدونه، ثم هناك قدر مستحب يتفاوت فيه الناس بحسب الحال الذي تتحقق به هذه المرتبة.
فالقدر الواجب من الإحسان أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالى وصوابًا متابعًا فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: 7].
وأما القدر المستحب فهو أن يكون العمل قائمًا على المقامين اللذين ذكرهما ابن رجب - رحمه الله - تعالى.
* * *
والدليل من السنة:
حديث جبرائيل المشهور عن عمر t قال:
بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفَّيه على فخديه وقال: يا مُحمد، أخبرني عن الإسلام. قال: «أن تشهد ألاَّ إله إلاَّ الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجُّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً»، فقال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة، قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: «أن تلد الأمة ربَّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»، قال: فمضى، فلبثنا مليًّا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم».
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ذكر الدليل على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان من السنة كما دلَّل عليها من القرآن، وهذا الحديث حديث عظيم ومشهور عند أهل العلم، بل قال عنه القرطبي - رحمه الله -: هذا الحديث يصلح أن يقال له «أمُّ السُنة» لِما تضمَّنه من جُمل علم السُنة.
وألَّف البغوي - رحمه الله - كتابين أحدهما «المصابيح» والآخر «شرح السُنة»، واستفتح الكتابين بهذا الحديث، وذلك اقتداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة التي هي أمُّ القرآن لتضمنها علوم القرآن إجمالاً، فكذلك هذا الحديث أمّ السنة لتضمنه جمل علم السنة، فناسب أن يستفتح به البغوي كتابيه في السنة.
قال القاضي عياض - رحمه الله -:
«اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداءً وحالاً ومالاً، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفُّظ من آفات الأعمال، حتى أنَّ علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعِّبة منه»([239]).اهـ
وقد أشبع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - القول في هذا الحديث العظيم وتكلَّم فيه كثيرًا ثم قال: «مع أنَّ الذي ذكرته وإن كان كثيرًا لكنه بالنسبة لِما يتضمنه قليل»([240]).اهـ
وقد جاء في بداية الحديث ذكر صفات السائل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن حالته مستغرَبة؛ فهو ليس من أهل البلد التي هم فيها، كما أنه ليس عليه آثار قادم من غير هذا البلد؛ فثيابه شديدة البياض وشعره شديد السواد، لم تتسخ ثيابه ولم يغبر شعره لنعرف أنه حديث القدوم على البلد.
وجبريل - عليه السلام - كان يأتي للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانًا بصورته الحقيقية وله ستمائة جناح، وأحيانًا على صورة دحية الكلبي أحد صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان معروفًا بجماله وبهاء طلعته.
وفي هذا الحديث لم يأتِ بصورته الحقيقية ولم يأتِ على صورة دحية الكلبي، بدليل قول عمر t «ولم يعرفه منا أحد»([241]).
ومع أنَّ جبريل - عليه السلام - كان يسأل إلاَّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاكم يُعلمكم أمر دينكم»، وهذا يدلُّ على أنَّ السؤال الحسن يُسمَّى «علمًا وتعليمًا»، وقد اشتهر قولهم: «حُسن السؤال نصف العلم»([242]) ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن الفائدة فيه انبتت على السؤال ([243]).
وقوله: (فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه): جاء في رواية أنه (جلس كما يجلس أحدنا للصلاة ثم وضع يديه على ركبتي النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وهذا يفيد أنَّ الضمير في قوله: «على فخديه» يعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن حجر - رحمه الله -:
(صنيعه هذا منبِّه للإصغاء إليه، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جُفاة الأعراب)([244]).اهـ
وهناك قول آخر: وهو أن الضمير راجع إلى جبريل - عليه السلام -، فالمعنى وضع كفَّيه على فخذي نفسه لا فخذي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ونأخذ من هذا الفعل أنَّ طالب العلم ينبغي له أن يكون أمام شيخه ومعلمه في وضع حسن بحيث يكون متهيئًا لتلقِّي العلم وتفهمه.
ويتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: عظم منـزلة أركان الإسلام الخمسة:
هذه الأركان الخمسة خُصت بالذكر لعظم مقامها في الشريعة ولعظم أثرها على العبد، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فالشهادتان أصلهما القلب، والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة مركَّبة من المال والبدن، والصوم عبادة بدنية.
الفائدة الثانية: في سبب تقديم الحج على الصَّوم في بعض الروايات:
جاء في الحديث تقديم الحج على الصوم فقال: «حج البيت وصوم رمضان» وفي بقية الروايات قدَّم الصوم على الحج «وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لِمن استطاع إليه سبيلاً».
وسبب تقديم الحج على الصيام أنَّ الصوم كما تقدَّم عبادة بدنية، وجِنس العبادة البدنية قد تقدَّم في الصلاة فصار مكرِّرًا للعبادة البدنية، ففهم الإمام البخاري ذلك وجعل كتاب الحجّ مقدَّمًا على كتاب الصوم.
الفائدة الثالثة: أنَّ علم الساعة من الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحدًا:
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: 34]
وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الأعراف: 187].
الفائدة الرابعة: الأمارات جمع «أمارة» وهي الدليل والعلامة:
والمراد بها أشراط الساعة كما قال - جل وعلا -: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: 18]
يعني علاماتها الواضحة التي تدلُّ على قربها، وأشراط الساعة نوعان: صغرى وكبرى.
الفائدة الخامسة: ذِكر هذه الأشراط لا يدل على مدح ولا على ذم:
فلا نأخذ من ذِكر أشراط الساعة حُكمًا شرعيًا من جهة الحل أو الحرمة، فقد يكون الشيء من أشراط الساعة وهو محمود كفتح بيت المقدس، وقد يكون من أشراط الساعة ما هو مذموم.
فجهة المدح أو الذم ليس لأنه من أشراط الساعة وعلاماتها، بل مأخوذ من نصوص أخرى تُفهِم ذلك أو تنصُّ عليه.
الفائدة السادسة: «أن تلد الأمة ربتها»:
معناه أن تلد الأمة التي هي رقيق ربَّتها أيّ سيدتها؛ لأنَّ الأمة يطأها سيدها، فإذا حصل من جراء ذلك مولود فإنه يتبع أباه فيكون حرًّا وتبقى الأم أمة غير حرَّة، فيكبر المولود من ذَكرٍ أو أنثى والأب حيّ لم يمت والأم لا تزال بذلك رقيقًا وسيدها الأب والبنت والولد.
وهذه الصورة موجودة في عهد الإسلام الأول، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك إشارة إلى كثرة هذه الصورة فكثرة ذلك من أشراط الساعة، وقد حصل لَمَّا كثرت الفتوحات وصار الواحد من رجال المسلمين ربما يملك أكثر من عشر إماء فينجبن أسيادهن.
الفائدة السابعة: التطاول في البنيان:
جاء ذمه في أحاديث معروفة وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتطاولون في البنيان، وكانت منازلهم قصيرة.. فمن لم يكن أهلاً للتطاول بالبنيان وحصل منه ذلك فإنه يُذَم.
وقوله «أن ترى الحفاة العُراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» معناه أن ترى الفقراء الذين ليسوا بأهل للغنى والتطاول بل هم من رعاة الغنم وتتبُّع الجمال ونحو ذلك، تراهم يتركون رعي الغنم ونحوها ويتجهون إلى التطاول في البنيان، وفي هذا إشارة إلى أنَّ أحوال الناس ستتغيَّر، فيكثر المال حتى يكون في يد من ليس من أهله.
الفائدة الثامنة: قوله «أتاكم يُعلمكم دينكم»:
فيه أنَّ الإسلام والإيمان والإحسان أقسام ثلاثة للدين، وتقدم شيء من ذلك.
الفائدة التاسعة: قوله «فلبثت مليًا»:
اللابث هو عمر t، وجاء في رواية أنَّ مدَّة لبثه ثلاثة أيام.
الفائدة العاشرة: قوله «أخبرني»:
فيه دلالة على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مخُبر، فهو ينقل خبر الإسلام عن ربِّه - جل وعلا - ويبلغ ذلك.
الفائدة الحادية عشرة: تقول جبريل وجبرائيل وميكال وميكائيل:
ومعناه عبد الله فـ«جبر» و«ميك»: عبد، و«إيل»: الله، هكذا بالعبرانية، وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «كل اسم فيه "إيل" فهو الله».
وقيل: اسم «جبريل» عبد الله، و«ميكائيل» عبيد الله – يعني بالتصغير – و«إسرافيل» عبد الرحمن.
وقيل: «إيل» معناه عبد، وما قبله معناه اسم الله، كما تقول «عبد الله» و«عبد الرحمن» و«عبد الرحيم» فلفظ: «عبد» لا يتغيَّر، وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واحدًا، ويؤيِّده أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غالبًا يتقدَّم فيه المضاف إليه على المضاف.
وفي «جبريل» لغات: فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم بغير همز، وهناك من يضيف نون، وهناك من يقول: جبرائيل بفتح الجيم والراء بعدها همز([245]).
* * *
الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم -:
وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
بعد أن انتهى المؤلف - رحمه الله - من الأصلَين الأول والثاني شرع في بيان الأصل الثالث وهو معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم -..
«فكما أنَّ معرفة الأصل الأول والثاني عظيمة وواجبة فكذلك معرفة هذا الأصل؛ لأنَّ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى، ولا وصول لنا أو اطّلاع أو طريق أو معرفة ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقرِّبنا من رضا الله وثوابه إلاَّ بما جاء به نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فإنَّا لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الربِّ جلَّ جلاله، ولا الأصل الثاني الذي هو دِين الإسلام إلاَّ بالواسطة بيننا وبين الله وهي معرفته - صلى الله عليه وسلم -، فصارت بذلك أصلاً ثالثًا»([246]).
«ومعرفة هذا الأصل يدخل فيها الأمور التالية:
الأول: معرفة نسبه - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: معرفة سِنّه ومكان ولادته ومهاجره - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث: معرفة حياته النبوية - صلى الله عليه وسلم -.
الخامس: بماذا أرسل - صلى الله عليه وسلم -، ولماذا؟ »([247]).
«فهذا الأصل يعُني به العلم ببعض سيرته عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك أول ما يدخل ما يتعيَّن ليكون العبد شاهدًا بأنَّ محمدًا رسول الله، إذ لو قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله فقيل له: من محمد هذا؟ ولم يعرف، كانت شهادته مدخولة»([248]).
وما ذكره المؤلف هنا كافٍ لذلك، وبه يحصل الجواب على سؤال الملكين: من نبيُّك؟
ويتعلَّق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
هذا الأصل اعتقادي علمي ولا يستقيم إلاَّ بالعمل من طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - واتباعه وتصديقه.
ولا يكون هذا المعنى إلاَّ بتحقيق شهادة أنَّ محمدًا رسول الله، وبهذا يتفق مع شهادة أنَّ محمدًا رسول الله.
المسألة الثانية:
حُكم تعلّم هذا الأصل واجب، ومقدار الواجب مما ذكره المؤلف ما يحصل به الجواب عند سؤال الملكين في القبر: «من نبيك».
وقد ورد ما يدل على المقدار الواجب، ويتمثَّل في الأمور التالية:
أولاً: اسمه - صلى الله عليه وسلم -، روى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ الملكين يسألان العبد: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم، فيقول: محمد رسول الله»([249]).
ثانيًا: إنه عبدٌ لله ورسولٌ من عند الله، جاء في الصحيحين من حديث أنس t أنَّ المؤمن يجيب فيقول: «أشهد أنه عبد الله ورسوله»([250]).
ويدخل في هذا معرفة نبوته بأنَّ الله تعالى أوحى إليه بقوله ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1] الآيات.
وحصلت له مرتبة الرسالة بأن أوحى إليه بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 1-2] الآيات.
ثالثًا: معرفة ما جاء به - صلى الله عليه وسلم -.. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنَّ المؤمن يُجيب: «محمد رسول الله جاء بالبينات من عند الله فصدقناه»([251])، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - «ذكر المصنف - رحمه الله - جملة مما يعرف به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعظمها وأعلاها معرفة ما بُعث به»([252])اهـ
رابعًا: معرفة الدليل على رسالته ونبوته - صلى الله عليه وسلم -، ويدلُّ على ذلك حديث البراء بن عازب الطويل، «في سؤال الملكين، فيقولان ما يدريك عن هذا الرجل؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت»([253]).
وقوله: «نبيٌّ باقرأ وأُرسل بالمدثر»: هذه معرفة واجبة، قوله «وبلده مكة وهاجر إلى المدينة» هذا من المستحبِّ معرفته.
والمؤلف - رحمه الله - أفاد في المقدمة أنه يجب تعلم الأصول الثلاثة حيث قال: «فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها»، وهنا ذكر الواجب وزيادة فجزاه الله خير الجزاء.
المسألة الثالثة:
تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - بـ«محمد» جديدة في عهده وغير مسبوقة في ذلك الزمان؛ إذ كانت العرب تُسمَّى بـ«أحمد» و«حمد»، ولكنّها لم تسمِّ بـ«محمد».
وقال بعض أهل العلم: بل هناك من سَمَّى بـ«محمد»، ولكنهم قلَّة، وهم اثنان أو ثلاثة، والأرجح هو القول الثاني؛ إذ جاء في بعض كتُب التاريخ أنَّ هناك من اسمه محمد في ذلك الزمان أو قبله ولكن بقلَّة، هذا إن صحَّ النقل([254]).
ومعنى «محمد»: كأحمد وحمد، ومحمود، كلّها أسماء مشتقَّة من «الحَمْدِ»، وكانت العرب تسمِّي بهذه الأسماء رغبةً في أن يكون الولد من ذوي الحمد فيحمده الناس على خصاله، هذا من باب التفاؤل، ومثله التسمية بـ«خالد» و«صخر» و«عاصي» تفاؤلاً.
فمعنى «محمد»: صاحب الخصال التي يُستحق عليها الحمد، وسماه جدُّهُ بهذا الاسم رغبةً منه في تلك الأمور، وحصل ما أراد؛ فإنَّ خصال النبي - صلى الله عليه وسلم - حمده الناس عليها حتى قبل البعثة، وأعظم من ذلك بعثته عليه الصلاة والسلام.
المسألة الرابعة:
قريش أفضل العرب وصفوتهم قال: «إن الله اصطفى قريشًا من كنانة»([255])، وأفضل قريش بنو هاشم وأفضل بني هاشم محمد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: «فأنا من بني هاشم من خيار إلى خيار»([256]).
والعرب من ذرية إسماعيل - عليه السلام -، ومعلوم أنَّ إبراهيم - عليه السلام - ليس بعربي، أخذ زوجته هاجر وابنها إسماعيل حتى وصل بهم إلى أرض مكة في قصة مشهورة، ولَمَّا حصل لإسماعيل وأمِّه ما حصل من نعمة الماء وتفجَّر الأرض بماء زمزم في أرض لم يُعهد فيها الماء دخل فيهم قومٌ من العرب، فكبر إسماعيل وتزوَّج منهم وانفتق لسانه بالعربية الفصحى وتكلم بها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة»([257]).
والعرب قسمان: عرب عاربة، وعرب مستعربة.. قال في المصباح: «يقال: العرب العاربة هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان وهو اللسان القديم، والعرب المستعرَبة هم الذين تكلَّموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم وهي لغات الحجاز وما والاها»([258])اهـ
قال ابن حجر - رحمه الله - في حديث:
«أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل» قوله «المبينة» أفاد أن أوَّليته في ذلك بحسب الزيادة والبيان لا الأولية المطلقة، فيكون بعد تعلُّمه العربية من جُرهُم ألهمه الله العربية الفصيحة المبيَّنة فنطق بها، ويشهد له ما حُكي أنَّ عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا حِميَر وجُرهم، ويُحتمل كون الأولية مقيَّدة بإسماعيل بالنسبة إلى إخوته من ولد إبراهيم([259])اهـ
وأكثر القبائل من هذا الجنس، وقبائل العرب المعروفة كقريش وهذيل وبني تميم وبني دوس وغيرهم كلهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.
المسألة الخامسة:
محمد - صلى الله عليه وسلم - ابن لعبد الله بن عبد المطلب، وهذا له قصة حيث كاد أن يذبحه عبد المطلب فقد جاء بسند فيه ضعف «أنا ابن الذَّبيحين»([260])، لكن معناه صحيح.
واليهود تزعم أنَّ الذبيح إسحاق، وهذا باطل ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ [الصافات: 101-102]
فوصفه بأنه «حليم»، وقد جاء في غير آية الوصف بالحلم لإسماعيل وأيضًا ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾ [الصافات: 113].
فذكره بعده، وغرض اليهود حين دسُّوا ذلك ألاَّ يحظى العرب بذلك الشرف والانتساب.
المسألة السادسة:
إبراهيم الخليل - عليه السلام - وُصف بالخُلّة، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - وُصف بذلك، وموسى - عليه السلام - كليم الله.
ومحمد اجتمع له الوصفان: فهو كليم الله - جل وعلا - وخليله.
المسألة السابعة:
إبراهيم - عليه السلام - أبو الأنبياء عليهم السلام، ومعنى «إبراهيم» بالسريانية أبٌ رحيم، والله - جل وعلا - جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأب الثالث للعالم، فإنَّ أبانا الأول «آدم»، والأب الثاني «نوح»، والأب الثالث «إبراهيم» إمام الحنفاء، وشيخ الأنبياء، كما سمّاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك لَما دخل الكعبة ووجد المشركين قد صوَّروا فيه صورته وصورة إسماعيل ابنه وهما يستقسمان بالأزلام فقال: قاتلهم الله لقد علموا أنَّ شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام([261]).
* * *
وله من العمر ثلاث وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيًا رسولاً.
نُبِّئ بـ«اقرأ»، وأرسل بـ«المدثر»، وبلده مكة وهاجر إلى المدينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - له ثلاثة وستون سنة من مبدأ ميلاده إلى وفاته، فعاش أربعين سنة ثم نُبئ ثم أُرسل.. ولما مضى عليه عشر سنين وهو على ذلك عُرِج به إلى السماء، ثم بقي في مكة ثلاث سنين، وبعدها هاجر إلى المدينة؛ فيكون عمره حينما هاجر ثلاثًا وخمسين سنة، ومكث في المدينة عشر سنين وبضعة أشهر.
وقوله: «نُبِّىء بـ(اقرأ) وأُرسل بـ(المدثر)»: تستفيد منها أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بِمَرحلتين وهما النبوة والرسالة، والنبوَّة تسبق الرسالة.. قال بعض أهل العلم: مكث عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين نبيًّا، ثم مكث عشرين سنة نبيًّا رسولاً.
وهذا يجعلنا نتكلَّم عن معنى النبوَّة والنبي، ومعنى الرسالة والرسول والفرق بينهما، فالنبيُّ لُغة من «النبوة» أو «النبوءة»، وفرَّق بينهما من جهة اللغة، فـ«النبوَّة» لغة من الارتفاع كأنه صار في نَبْوَةٍ من المكان ومرتفع، وسبب هذا الارتفاع النبوءة من الإنباء فصار نبيًّا منبَّـأً.
أمَّا من جهة الشرع فالمعنى واحد، وقد جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: 1] قراءة أخرى «يا أيها النبيء» والقراءة المشهورة «النبي»، وجاء في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: 163] قراءة أخرى بالهمز.
والرسول لغة من الإرسال قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [المائدة: 41].
أمَّا الفرق بين الرسول والنبيِّ فمن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله شيخ الإسلام أحمد بن تيميه - رحمه الله -:
«النبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعمُّ من جهة نفسها، وأخصُّ من جهة أهلها، فكلُّ رسول نبيُّ وليس كلُّ نبيٍّ رسولاً، فالأنبياء أعمُّ والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوَّة، فإنها لا تتناول الرسالة»([262]).اهـ
ولذلك قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -:
«وقد ذكروا فُروقًا بين النبيِّ والرسول، أحسنها: أنَّ من نبَّأه الله بِخبر السماء إن أمره أن يُبلِّغ غيره فهو نبيٌّ رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبيٌّ وليس برسول»([263]).اهـ
وعل هذا قد يَستشكل البعض بلاغ النبي - صلى الله عليه وسلم - لخاصته كأبي بكر وخديجة رضي الله عنهما قبل الإرسال، فالجواب أنَّ هذا منه - صلى الله عليه وسلم - على جهة الاستحباب لا الوجوب.
والمؤلف - رحمه الله - تعالى عبّر بقوله «نُبئ بـ"اقرأ" وأُرسل بـ"المدثر"» لَمَّا روى البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: «أول ما بُدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم»..
فكان لا يرى رؤيا إلاَّ جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبُّد الليالي ذوات العدد قبل أن ينـزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطَّني حتى بلغ مني الجهدُ ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدُ ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم﴾».
فرجع بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: «زملوني زملوني» فزمَّلوه حتى ذهب عنه الرَّوع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي».
فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكَلَّ وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عمّ خديجة، وكان امرأً تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِي، فقالت له خديجة: يا بن عمّ، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟
فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نـزَّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًّا إذ يُخرجك قومك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مُخرجي هم؟ فقال: نعم، لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلاَّ عُودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم لم ينشب ورقة أن توفِّي وفتر الوحي([264]).
وقوله: «ما أنا بقارئ»: أي لست من أهل القراءة.
وقوله في آخر الحديث: «وفتر الوحي»: قال بعضهم: ثلاث سنين([265]).. !
وروى البخاري أيضًا عن جابر t قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحدث عن فَترة الوحي: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسيِّ بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: دثِّروني دثروني»، فأنـزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 1-2] إلى قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: 5] فحمي الوحي وتتابع([266]).
و«المدثر»: أصله المندثر، وهو الذي يتدثَّر في ثيابه ليستدفئ بها، وإنما سمَّاه الله تعالى «مدثِّرًا» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دثِّروني»، وسيأتي تفسير المؤلف لبقية الآيات.
وبعد هذه الحادثة له - صلى الله عليه وسلم - اتضحت معالم الرسالة ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 2] ووجب الإنذار.
وهذه الرسالة على مراحل أولها ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214]، ثم تتابعت إلى أن عمت الإنس والجن.
وهنا تنبيـه:
سورة العلق أول سورة أُنـزلت من القرآن، وأول ما نـزل خمس آيات من أولها إلى قوله تعالى: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 5].. وأمَّا باقي السورة فنـزل بعد ذلك بسنين وأول ما نـزل بعد فترة الوحي سورة المدثر.
وقد حدَّدت هذه الفترة في حديثٍ مرسَلٍ رواه الإمام أحمد عن الشعبي بأنها كانت سنتين ونصف سنة، فإذا ضممنا مدة فترة الوحي إلى مدَّة الرؤيا الصالحة قبل نبوته، كان مجموعها ثلاث سنين، وهي مدَّة النبوة التي لم يُؤمر فيها بالتبليغ، ثم نـزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 1-2]، فكان هذا أول ما تقلَّد مهمة التبليغ والرسالة، فمكث على ذلك عشرين سنة، نصفها في مكة، ونصفها في المدينة، وبهذا يُجمع بين الروايات المختلفة في مدَّة إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة بعد الوحي وهي ثلاث عشرة سنة، إذا حسبت مدَّة النبوة والرسالة، وعشرٌ إذا حسبت مدة الرسالة وحدها.. والله أعلم([267]).
قوله: (بلده مكة): لأنه - صلى الله عليه وسلم - وُلد فيها وشبَّ وترعرع، وكان فيها آباؤه وأجداده وقبيلته.
وكان عليه الصلاة يُحب بلده مكة حبًا شديدًا، فقد كان يتذكرها ويقول: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسلّم علي قبل أن أُبعث إني لأعرفه الآن»([268])، يعني يقول له: السلام عليكم يا رسول الله.
ولما خرج منها مهاجرًا إلى المدينة بعد ما تآمر عليه كفار قريش ليقتلوه التفت إليها دامعة عيناه وهو يقول: «ما أطيبك وأحبك إليّ، ولولا أنَّ قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك»([269]).
قوله: (وهاجر إلى المدينة): ليظهر دينه، ولأنَّ فيها من ينصره ويؤيده من الأنصار فيبلِّغ دين الله - جل وعلا -.
* * *
بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد.
والدليل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: 1-7].
ومعنى ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد..
﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ أي: عظمه بالتوحيد.
﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ أي: طهّر أعمالك عن الشرك.
﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الرجز: الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
يريد المؤلف - رحمه الله - هنا بيان مسألة عظيمة متعلِّقة بهذا الأصل، وهي أنَّ ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الأمر بالتوحيد والنهي والإنذار عن الشرك بالله تعالى؛ حيث كان الناس يجعلون الشرك بالله دينًا يتقرَّبون به إلى الله تعالى، مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يُحصَى، ويعلمون أنه معصية([270]).
يقول المؤلف - رحمه الله -:
«فمن فهم فهمًا جيدًا أنَّ الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقرَّبون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا أو نكاح الأمهات والأخوات وعرف الشرك الذي يفعلونه رأي العجب العجاب، خصوصًا إن عرف أنَّ شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر: 8]»([271]).اهـ
والإنذار: هو الإعلام بالشيء الذي يُحذر منه، وكلُّ مُنذر مُعلِّم وليس كلُّ معلِّم منذرًا([272]).
قال ابن القيم - رحمه الله -: الإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه([273]).اهـ
قال القرطبي - رحمه الله -: الإنذار: الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع للاحتراز، فإن لم يتّسع زمانه للاحتراز كان إشعارًا ولم يكن إنذارًا.
قال الشاعر:
أَنذَرتُ عَمرًا وهو في مَهَلٍ
قَبلَ الصَّباحِ فَقَد عصَى عَمرُو([274]).اهـ
أنذر - صلى الله عليه وسلم - عن الشرك وخوف من النار وعذاب الله وسخطه ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصل: 13]..
فالإنذار يكون عن الشرك وعن عقاب أهل الشرك في الدنيا بالاستئصال ونحوه وفي الآخرة بالعذاب والنكال، وقُدم الإنذار عن الشرك على الأمر بالتوحيد وهو معنى لا إله إلا الله.
ومن القواعد المقرَّرة أنَّ التخلية تسبق التحلية؛ فإخلاء القلب مقدمٌ على تحليته.
ومن الأدلَّة على مراد المؤلف قوله تعالى: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ [الشورى: 7]، وقوله سبحانه: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ﴾ [يس: 6].
ويتعلَّق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
في قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ قدَّم المفعول على عامله وهو الفعل فدلَّ على الاختصاص، وأصل الكلام: كبِّر ربَّك.
المسألة الثانية:
جاء التكبير في القرآن على خمسة أنحاء ذكرها ابن القيم - رحمه الله -، وذكر أنَّ له خمسة موارد وهي: ربوبيته، وألوهيته، وأسماؤه وصفاته، وقضاؤه الكوني، وشرعه وأمره.. ولأجل ذلك صارت هذه الكلمة من شعارات المسلمين.
المسألة الثالثة:
المؤلف - رحمه الله - فسر قول الله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ بقوله: عظِّمه بالتوحيد، وهذا من التفاسير المنقولة عن السلف واختاره المؤلف هنا لمناسبته وملائمته.
المسألة الرابعة:
المؤلف - رحمه الله - فسر الثياب في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ بالأعمال، و«الثوب» في اللغة ملازم لصاحبه يرجع إليه، فكلَّما خلعه رجع وثاب إليه، والعمل يُشبه الثوب من جهة ملازمته لصاحبه قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13]..
والطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل خيرًا كان أو شرًا، فهو ملزوم به كملازمة الثوب لصاحبه، والمؤلِّف اختار أحد التفاسير المنقولة عن السلف([275])، وهو التفسير العام والأنسب هنا؛ إذ الكلام على تعظيم الله والدعوة إلى توحيده وترك الإشراك به.
ورجَّحَ العلامة ابن القيم - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قول قتادة ومجاهد: «نفسك فطهر من الذنب»، فكنَّى عن النفس بالثوب، وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير.
ثم قال:
«ولا ريب أن تطهيرها – أي الثياب – من النجاسات وتقصيرها من جُملة التطهير المأمور به؛ إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق؛ لأنَّ نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أُمِر القائم بين يدي الله - عز وجل - بإزالتها والبُعْدِ عنها.. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنه، ويؤثِّر كلٌّ منهما في الآخر، ولهذا نُهِيَ عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لِما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع»([276])اهـ
المسألة الخامسة:
الرُِّجز: بالكسر والضم – قراءتان صحيحتان، قرأ حفص بالضَّم، والأكثرون بالكسر، وهما لغتان فصيحتان، ويقال في المكسور: «رِجْس» و«رِكْس» أيضًا، وقد ورد استعمال هذه المادة على وجهين:
الأول- أن تكون بمعنى القذر، وهو كل مستفحَش تنبو عنه العقول السليمة، وتنفر منه الطباع الشريفة من النجاسة الحسية والمعنوية، والإثم الظاهر والباطن، ومن ذلك قوله تعالى في الخمر والميسر ولحم الخنـزير إنه «رِجس».
الثاني- أن تكون بمعنى العذاب كما في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: 162].
ويرجع إلى هذين المعنيين استعمالها في الشرك وعبادة الأوثان، كما في قوله تعالى: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: 125]
وذلك أنَّ الشرك قذر معنوي وسبب في العذاب، بل هو أول أنواع الرّجز دخولاً في عموم لفظه عند إطلاقه، ومن هنا فسَّره أبو سلمة في الآية بقوله: «وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون»([277]).اهـ
فـ«الرجز» اسم عام ويدخل فيه ما عُبد من دون الله - جل وعلا -، وقد يكون صنمًا وقد يكون وثنًا، والمعنى: «الأصنام والأوثان اهجر»، وهجرها كما قال المؤلِّف: تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها.
و«الأصنام» جمع صنم، والصنم ما كان على صورة مِما يُعبد من دون الله، ومثاله: صورة على شكل وجه إنسان أو جسم حيوان أو شكل كوكب أو نَجم أو الشمس أو القمر ونحو ذلك، فإذا صوّر صورة فتلك الصورة يقال لها «صنم».
و«الوثن» هو ما عُبد من دون الله وليس على شكل صورة؛ فالقبر وثن والمشهد وثن.
وقد يقال عن الصنم وثن، كما قال تعالى في قصة إبراهيم ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: 17]، فقد يطلق ولكن على قلَّة.
قال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام جميعًا، فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم وفي بعض الآيات ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان، والقول الأول أظهر، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبد»، فصار الوثن ما يُعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -:
«الصنم ما كان منحوتًا على صورة والوثن ما كان موضوعًا على غير ذلك» ذكره الطبري عن مجاهد.
وقد يسمى الصنم وثنًا كما قال الخليل - عليه السلام - ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: 17] ويقال أنَّ الوثن أعمُّ وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أنَّ القبور أوثان([278]).اهـ
تنبيـه:
ولا يلزم من النهي عن الشيء سبق حصوله من المنهي عنه، ولا تَوَقُّع حصوله منه، ولذلك صحَّ نهي نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن هذه المناكير مع أنه نشأ مُبَرًّأً من النقائص الخِلقية والخُلقية، مُتحلِّيًا بِخصال الفطرة السليمة، مبغضًا عليه الأوثان وأهلها.
وإنما يُراد من هذه النواهي ضمّ زواجر النص النقلي إلى ما هو مركوز في فطرته بالاجتهاد العقلي؛ ليتطابق عنده الخُبْرُ والخَبَرُ، ويشترك في حقِّه السمع والنظر، وبذلك يثبت الله فؤاده على أمره، ولا يقع منه إحجام أو تردد في الجهر برأيه والعمل به»([279]).
فائـدة:
بقي من هذه الآيات لم يذكر تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: 6-7].
معناه: لا تُعط مالك مصانعة لتُعطى أكثر مما أعطيت؛ لأنك مأمور بأجلِّ الأخلاق وأشرف الآداب، وهذا قول أكثر المفسرين.
وقيل: لا تمنُن على الناس بما تُنعم عليهم وتعطيهم استكثارًا منك لتلك العطية فإن المن يحبط العمل.
وقوله: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ أي على طاعة أوامره ونواهيه وعلى ما حُمِّلت من أمر عظيم اصبر لوجه الله تعالى وابتغاء ثوابه.
أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد.
وبعد العشر عُرِج به إلى السماء، وفُرضت عليه الصلوات الخمس، وصلَّى في مكة ثلاث سنين.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
يعني قبل أن تنـزل الفرائض، فما كان يدعو إلى شيء إلا إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فمكث على ذلك عشر سنين إلى أن فُرضت عليه الفرائض بعد المعراج.
ويتعلَّق بكلام المؤلف مسألتان:
المسألة الأولى:
كانت هناك صلاة مفروضة في العشر سنين ولكنها صلاتان في اليوم والليلة: الأولى في إقبال النهار، والأخرى في إقبال الليل، بمعنى أنهما الفجر والمغرب.. ويحمل عليه قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130].
وقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: 39].
قال بعض أهل العلم: كانت الصلاة ركعتين: أول النهار وآخره.
وكان يصلِّي الرباعية: ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، كما صحّ في ذلك الخبر([280]).
المسألة الثانية:
المعراج بمعنى الصعود، وعُرج به أي صُعد به، وليلة المعراج ليلة الصعود، فأُسرِي به إلى بيت المقدس على دابة ثم رُبطت عند بيت المقدس، وأخذه جبريل - عليه السلام - بعد ذلك وعُرج به على السلم الخاص الذي يُصعد إليه إلى جنس السماء؛ لأنَّ «السماء» هنا جنس والمراد السماوات، واقترب من ربه - جل وعلا -، وكلَّمه ربُّه بدون واسطة، ورأى تلك الليلة نور الله تبارك وتعالى، ورأى الحجاب الذي احتجب الله به عن خَلقه وهو النور، وسُئل هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًا»، وفي رواية: «نورٌ أنَّى أراه»([281]) يعني فكيف أراه.
ورأى الجنة ورأى النار في تلك الليلة، وهذا من العجب؛ كيف حصل له ذلك في ليلة ومسافة ما بين السماء والأرض خمسمائة عام، ولأجل هذا العجب قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: 1]
كان هذا في ليلة وكانت مركوبات الناس الدواب، وحصل له كل ما تقدّم ورجع وفراشه لم يبرد!
ولَمَّا جاء الصباح نـزل جبريل بفرض الصلوات الخمس، فصلَّى في مكة ثلاث سنين وبعدها أُمر بالهجرة إلى المدينة.
* * *
وبعدها أُمر بالهجرة إلى المدينة.
والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
والهجرة فريضة على هذه الأمَّة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 97-99].
وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: 56].
قال البغوي - رحمه الله - تعالى: (سبب نـزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان).
والدليل على الهجرة من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها».
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
أي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الثلاث عشرة سنة من بعثته أُمر بمفارقة المشركين وأوطانهم لأنه لم يتمكَّن من إظهار دينه والدعوة إلى الله تعالى.. وإظهار الدين فرض واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يستطيع أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله وتوحيده والإنذار عن الشرك كما أمر الله في قوله ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 2] إلا بالهجرة، وكذلك صحابته رضي الله عنهم أُمِروا بالهجرة ليتمكنوا من إظهار دينهم.
«فأعلم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بما أراد المشركون حينما عزموا على قتله وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر t قد تجهَّز للهجرة إلى المدينة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على رِسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي»، فتأخَّر أبو بكر t ليصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار إذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الباب متقنعًا، فقال أبو بكر: فداء له أبي أمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لأبي بكر: «أخرج من عندك»، فقال: إنما هم أهلك، بأبي أنت وأمي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قد أُذِن لي في الخروج»، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: «نعم»، فقال: يا رسول الله، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بالثمن»، ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلامًا شابًا ذكيًا واعيًا، فينطلق في آخر الليل إلى مكة، فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه إلا وعاه، حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام، فجعلت قريش تطلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلِّ وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته مائة من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى أنَّ قريشًا ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال، أبو بكر t: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: «لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»، حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلاً خرجا من الغار بعد ثلاث ليال مُتجهين إلى المدينة على طريق الساحل.
ولَمَّا سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم، كانوا يخرجون صباح كلّ يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحبه حتى يطردهم حرَّ الشمس، فلمَّا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعالى النهار واشتدَّ الحرُّ رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مُقبلين يزول بهم السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: «يا معشر العرب، هذا جَدُّكم - يعني هذا حظكم - وعزُّكم الذي تنتظرون»، فهبَّ المسلمون للقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإيذانًا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم، فتلقوه - صلى الله عليه وسلم - بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين ونـزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم بضع ليال وأسَّس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقَّونه في الطرقات.. قال أبو بكر t: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون «الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد»([282]).اهـ
والدليل على أنَّ الهجرة فريضة على هذه الأمَّة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها.. قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 97-98]
وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: 56].
وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾..
يعني ملك الموت وأعوانه، أو ملك الموت وحده، فإنَّ العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع([283]).
و«التوفِّي»: قبضُ الرُّوح..
﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ بالشرك أو بالمقام في دار الشرك، أو بخروجهم مع المشركين يوم بدر وتكثير سوادهم حتى قتلوا معهم.
﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ سؤال توبيخ وتقريع.
﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ﴾ عاجزين عن الهجرة.
﴿قَالُوا﴾ أي: قال لهم الملائكة.
﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من بين أظهر المشركين في مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم، فأكذبهم الله في قولهم: كنا مستضعفين، وأعلمنا بكذبهم.
﴿فَأُولَئِكَ﴾ يعني: مَن هذه صفتهم.
﴿مَأْوَاهُمْ﴾ منـزلهم.
﴿جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أي: بئس المصير مصيرهم إلى جهنم.
وسبب نـزول هذه الآية:
أنَّ قومًا من أهل مكة أسلموا، وتخلَّفوا عن الهجرة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وافتتن بعضهم وشَهِدوا مع المشركين حرب يوم بدر، فأبى الله قبول عذرهم، فجازاهم جهنم([284]).
روى البخاري - رحمه الله - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ ناسًا من المسلمين كانوا من المشركين، يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي السهم فيرمي به، فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنـزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾([285]) الآية.
قال ابن كثير - رحمه الله -:
«هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع»([286]).اهـ
ثم استثنى الله سبحانه أصحاب العذر الذين علم الله ضعفهم منهم فقال: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ استثناء منقطع..
﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ أي: لا يقدرون على حيلة ولا نفقة، ولا قوة لهم على الخروج؛ لفقرهم وعجزهم.
﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ أي: ولا يعرفون طريقًا يسلكونه يوصلهم إلى مكان هجرتهم.
وتتمة الآيات: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 99]، أي: يتجاوز عنهم بفضله وإحسانه.
و﴿عَسَى﴾ وإن كان للإطماع فهو من الله تعالى واجب؛ لأنَّ الكريم إذا أطمع أنجز.
وفي الحديث «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله»([287]).
قال ابن عباس - رحمه الله -: كنت أنا وأمي من المستضعفين، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو للمستضعفين.
تنبيـه:
نَقَلَ المؤلف كلام البغوي في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: 56] قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -:
«الظاهر أنَّ الشيخ - رحمه الله - نقل عن البغوي بمعناه – هذا إن كان نقل من التفسير؛ إذ ليس المذكور في تفسير هذه الآية بهذا اللفظ»([288]).اهـ
قلت: هذا هو الواجب تجاه نقل أهل العلم ألاَّ يُجزم بخطئهم أو وهمهم.
ويتعلَّق بكلام المؤلف مسائل:
المسألة الأولى:
الهجرة لغة: الترك، قال الراغب في «المفردات»:
«الهَجْرُ والهجْران: مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب، والمهاجرة في الأصل: مُصَارَمةُ الغير ومُتَاركتُه، من قوله - عز وجل -: ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا﴾ [الأنفال: 74]، ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: 100] فالظاهر منه: الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، كمن هاجر من مكة إلى المدينة.. وقيل: مقتضى ذلك هُجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها»([289])اهـ
والهجرة شرعًا: ترك ما لا يحبه الله ويرضاه والانتقال منه إلى ما يحبه ويرضاه.
ويدخل في هذا المعنى: ترك الكفر وترك البدعة وترك المعصية وترك بلد الكفر وترك كلّ ما لا يحبه الله ويرضاه.
أمَّا في الاصطلاح فكما عرَّفها المؤلف - رحمه الله - حيث قال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
قال ابن القيم - رحمه الله -:
«ولله على كلِّ قلب هجرتان، وهما فرض لازم له على الأنفاس: هجرةٌ إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية، وهجرة إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقِّي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تعبُّده به أعظم من تعبُّد الركب بالدليل الماهر في ظُلم الليل ومتاهات الطريق.
فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحثْ على رأسه الرماد، وليراجع الإيمان من أصله، فيرجع وراءه ليقتبس نورًا قبل أن يُحال بينه وبينه، ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور، والله المستعان([290]).اهـ
وفي الحديث: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»([291]) فالهجرة لا يحرز فضلها إلاَّ من أعرض بقلبه وجوارحه عن كلِّ ما نهى الله عنه من ظاهر الإثم وباطنه.
وإنما سكت في هذا الحديث عن هجرة المكان لعلم السامعين بها، أو تنبيهًا على أنها أهون الهجرتين عملاً، على أنَّ تعريف الهجرة يشمل الهجرتين الحسِّية والمعنوية؛ لأنَّ كلمة: «ما نَهى الله عنه» تتناول الإقامة في دار الشرك أيضًا، والله أعلم.
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -:
«فأصل الهجرة أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هُجران بلد الشرك رغبةً في دار الإسلام، وإلاّ فمجرَّد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هي هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك مع القدرة عليه»([292])اهـ
المسألة الثانية:
سبب مشروعية الهجرة: إنَّ المؤمن يجب عليه أن يُظهر دينه([293]) معتزًّا به، ففي هذا الإظهار والاعتزاز بيان للناس عن هذا الدين وإخبار لهم بشهادة الحق «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فالإخبار بهذه الشهادة يكون بالقول ويكون بالعمل.
يقول ابن القيم - رحمه الله -:
«الإعلام والإخبار نوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كلِّ مُعلِم لغيره بأمر، تارة يُعلِمه بقوله وتارة يُعلِمه بفعله، فمن فعل الطاعات وتقرَّب بأنواع القربات فإنه مُخبِرٌ ومُعلِمٌ بشهادته لله أنه لا إله إلا هو»([294]).اهـ
تنبيـه:
بعضهم قال: الهجرة إلى المدينة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة أشدّ وجوبًا لأنَّ سببها أن يجتمع المسلمون في مكانٍ واحد.. وهذا القول لا دليل عليه، فسبب مشروعية الهجرة إظهار الدين لا أن يجتمع المسلمون.
المسألة الثالثة: حكم الهجرة:
إذا لم يستطع المسلم أن يُظهر دينه في بلد كفر وجب عليه مفارقة ذلك البلد والانتقال منه إلى غيره، وإذا كان يستطيع إظهار دينه في ذلك البلد استُحبَّ له أن يهاجر، وقد لا يُستحب له إذا كان في بقائه مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهار دينه([295]).
أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 87]، يعني لم يستطيعوا إظهار دينهم، فهذا هو معنى الاستضعاف..
﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97] فدلَّ على وجوب الهجرة لأنه توعَّدهم بالنار على تركها.
فالقصد الأول من الهجرة أن يتمكَّن من إظهار دينه ويعبد الله تعالى على عزَّة كما قال في الآية الأخرى ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: 56]
والاستفهام في قوله ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97] للإنكار، ومعلوم أنَّ ضابط الاستفهام الإنكاري أن يكون ما بعده غير صحيح، فإذا أزلتَ الهمزة وقرأتَ ما بعدها ووجدته باطلاً وغير صحيح فإنَّ الاستفهام للإنكار.
واستثنى الله - جل وعلا - المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يقدرون على الهجرة والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو لا يمكنهم معرفة الطريق ولا يهتدون إلى السبيل أو ما عندهم ما يركبون ونفقة السفر فهؤلاء قال الله عنهم ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 99].
وهنا تنبيهان:
الأول- الهجرة من حيث وجوبها أو استحبابها أو غير ذلك متعلِّقة بالمسلم من جهة استطاعته إظهار دينه أولاً، وهذا يغنينا عن البحث حول تعريف دار الكفر ودار الإسلام في هذا الموطن.
الثاني- حُكم من ترك الهجرة مع القدرة ولا يستطيع إظهار دينه: ظالم لنفسه مرتكب لكبيرة وليس بكافر لقوله تعالى: ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ولقوله: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: 56].
«فأفاد أنَّ تارك الهجرة بعد ما وجبت عليه ليس بكافر لكنه عاص بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان عاص من عصاة الموحدين المؤمنين»([296]).
المسألة الرابعة:
الهجرة من جهة مكانها هجرتان: عامة وخاصة، أما العامة فهي التي عرَّفها الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله: «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام».
فهذه تبقى إلى قيام الساعة، ولكلِّ بلد يظهر فيه الشرك ويكون غالبًا، فإنَّ الانتقال منه يُسمى «هجرة».
أمَّا الهجرة الخاصة فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، فالانتقال من مكة إلى المدينة في زمنٍ معيَّن انتهى بانتهاء كون مكة دار شرك، ولَما صارت دار إسلام بفتحها فإنه كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»([297])، يعني لا هجرة خاصة من مكة إلى المدينة؛ لأنَّ الدار تحوَّلت إلى دار إسلام يستطيع المسلم أن يظهر دينه فيها([298]).
المسألة الخامسة:
ذكر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم هجرة أخرى غير التي نتحدث عنها هنا وهي الهجرة من بلد يكثر فيها البدع والمعاصي إلى بلد تقلُّ فيها أو لا تظهر.
وذكر أهل العلم أنَّ مثل هذه الهجرة مستحبَّة؛ لأن بقاء المسلم في دار أهلها متوعَّدون بنوعٍِ من العذاب بسبب ظلمهم يعُرضه لتلك العقوبة.
قال الشيخ ابن قاسم - رحمه الله -:
«وكذلك يجب على كلِّ من كان ببلد يُعمل فيها بالمعاصي لا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها»([299]).اهـ
وقد هاجر جمعٌ من أهل العلم من بغداد كالخرقي لَما علا فيها صوت أهل البدع وكثرت فيها المعاصي وظهرت، كالزنا وشرب الخمر([300]).. وبعض أهل العلم بقي هناك قائمًا بالدعوة إلى الله - جل وعلا - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأيضًا ترك بعض العلماء مصر لَما تولت عليها الدولة العبيدية فخرجوا منها إلى غيرها، وهجرة من كان في مصر قد تُحمل على أنها واجبة وقد تُحمل على أنها مستحبَّة على حسب من كان فيها هل يُظهر التوحيد والسنة ويتمكَّن من ذلك أم لا.
المسألة السادسة:
«الهجرة باقية إلى قيام الساعة» يعني إلى قرب قيامها وهو كما جاء في الحديث «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»([301])، فما دامت التوبة باقية فإن الهجرة باقٍ حكمها وهو الوجوب، وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾ [الأنعام: 158].
وقول المؤلف: (إلى قيام الساعة): أي طلوع الشمس من مغربها، وهذا الحدث قريب من قيام الساعة.
أمَّا ثبوت الهجرة من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام وبقاؤها فمعلوم بالنصِّ والإجماع، جاء في الحديث «أنا بريءٌ من مسلم مات بين ظهراني المشركين»([302])، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تراءى ناراهما»([303])، وقال: «الهجرة باقية ما قوتل العدو»([304]).
المسألة السابعة:
إظهار الدين لم يكن واجبًا أول دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم أُمروا بإظهار الدين في قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: 94] فابتُلي من ابتُلي من المؤمنين، ولم يستطيعوا إظهار دينهم، واستأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى الحبشة فأَذِن لهم بالهجرة إليها الهجرة الأولى ثم الثانية، وقيل بأنَّ هناك هجرة ثالثة.
ثم لَمّا تبيَّن أنه لم يعد بالإمكان إظهار الدين بمكة بدليل تآمر قريش على قتل محمد - صلى الله عليه وسلم - تعيَّنت الهجرة إلى المدينة.
فائـدة:
ابتدأ التاريخ الهجري بعد هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال السيوطي - رحمه الله -:
«روى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن ابن سيرين أنّ رجلاً من المسلمين قدم من اليمن، فقال لعمر رأيت باليمن شيئًا يُسمُّونه التاريخ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا، فقال عمر: إنَّ هذا لحسن فأرِّخوا.
فلمَّا أجمع على أن يؤرِّخ شاوَر: فقال قوم بمولد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال قوم بالمبعث، وقال قوم حين خرج مهاجرًا من مكة، وقال قائل: بالوفاة حين توفي، فقال: أرِّخوا خروجه من مكة إلى المدينة.
ثم قال: بأيِّ شهر نبدأ فنُصيِّره أول السنة، فقالوا رجب فإنَّ أهل الجاهلية كانوا يُعظمونه، وقال آخرون شهر رمضان، وقال آخرون ذو الحجة فيه الحج، وقال آخرون الشهر الذي خرج فيه من مكة، وقال آخرون الشهر الذي قدم فيه؛ فقال عثمان: أرِّخوا من المحرم أول السنة، وهو شهر حرام. وهو أول الشهور في العَدِّة، وهو مُنصرف الناس عن الحج؛ فصيَّروا أول السنة المحرم، وكان ذلك في سنة سبع عشرة.
وقد روى سعيد بن منصور في سُننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ [الفجر: 1] قال: الفجر شهر المحرم وهو فجر السنة.
قال شيخ الإسلام ابن حجر - رحمه الله - في أماليه:
«بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخر التاريخ من ربيع الأول إلى المحرَّم بعد أن اتَّفقوا على جعل التاريخ من الهجرة، وإنما كانت في ربيع الأول»([305]).اهـ
المسألة الثامنة: حكم السفر إلى بلاد الكفار([306]):
«السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلاَّ بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لِما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأنَّ الإنسان يُنفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.
أمَّا إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده عِلم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به».
المسألة التاسعة:
«الإقامة في بلاد الكفار خَطرها عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شاهدنا نحن وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك»، فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فُسَّاقًا، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي - بل يتعيَّن - التحفُّظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك.. فالإقامة في بلاد الكفر لا بدّ فيها من شرطين أساسين:
الشرط الأول:
أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العمل والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مُضمرًا لعداوة الكافرين وبُغضهم، مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم، فإنَّ موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان قال الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: 22].
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ [المائدة: 51-52]
وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنَّ من أحبَّ قومًا فهو منهم»([307])، و«أنَّ المرء مع من أحب»([308]).
ومحبَّة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم؛ لأنَّ محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحبَّ قومًا فهو منهم».
الشرط الثاني:
أن يتمكَّن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يُمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يُصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يُمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكَّن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ.
وبعد تمام هذين الشرطين الأساسين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام:
القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوعٌ من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقَّق الدعوة وألاَّ يُوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأنَّ الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين، وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ عنه في كلِّ زمانٍ ومكانٍ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «بلِّغوا عنِّي ولو آية»([309]).
القسم الثاني: أن يُقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرُّف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك؛ ليحذر الناس من الاغترار بهم، ويُبيِّن للمعجبين بهم حقيقة حالهم، وهذه الإقامة نوعٌ من الجهاد أيضًا لِما يترتَّب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمّن للترغيب في الإسلام وهديه، لأنَّ فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قيل: «وبضدها تتبيَّن الأشياء»، لكن لا بدّ من شرط أن يتحقَّق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقَّق مراده بأن مُنع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقَّق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسبِّ الإسلام ورسول الإسلام وأئمَّة الإسلام وجب الكفِّ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 108].
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عَينًا للمسلمين ليعرف ما يُدبِّرونه للمسلمين من المكائد فيحذرهم المسلمون، كما أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم.
القسم الثالث: أن يُقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر كموظفي السفارات، فحُكمها حُكم ما أقام من أجله، فالملحق الثقافي مثلاً يقيم ليرعى شئون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويدرأ بها شرًّا كبير.
القسم الرابع: أن يُقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتُباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نصَّ أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها وهي الإقامة لحاجة، لكنها أخطر منها وأشدُّ فتكًا بدين المقيم وأخلاقه، فإنَّ الطالب يشعر بدنوِّ مرتبته وعلوِّ مرتبة معلِّميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل، ثم إنَّ الطالب يشعر بحاجته إلى معلِّمه فيؤدِّي ذلك إلى التودُّد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال.
والطالب في مقرِّ تعلمه له زملاء يتَّخذ منهم أصدقاء يُحبُّهم ويتولاهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله، فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسين شروط:
الشرط الأول:
أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميِّز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد، فأما بعث الأحداث (صغار السِّن) وذوي العقول الصغيرة فهو خطرٌ عظيمٌ على دينهم وخُلقهم وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع، فإنَّ كثيرًا من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم، ودخل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلومٌ مشاهَد، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية.
الشرط الثاني:
أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكَّن به من التمييز بين الحقِّ والباطل، ومقارعة الباطل بالحقِّ لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقًّا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل.
وفي الدعاء المأثور «اللهم أرني الحقَّ حقًّا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علي فأضل».
الشرط الثالث:
أن يكون عند الطالب دينٌ يحميه ويتحصَّن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوِّعة، فإذا صادفت محلاًّ ضعيف المقاومة عملت عملها.
الشرط الرابع:
أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لِما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة.
القسم السادس: أن يُقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم لِما يترتَّب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودَّة وموالاة وتكثير لسواد الكفار، ويتربَّى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلَّدوهم في العقيدة والتعبُّد، ولذلك جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله»([310])، وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر؛ فإنَّ المساكنة تدعو إلى المشاكلة، وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله t أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا بريءٌ من كلِّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين»..
قالوا يا رسول الله، ولِمَ؟ قال: «لا تراءى ناراهما»([311]). رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن أبي حازم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.. وقال الترمذي: سمعت محمدًا – يعني البخاري – يقول الصحيح حديث قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.اهـ
وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلَن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده، ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دِينهم وأخلاقهم.
هذا ما توصَّلنا إليه في حُكم الإقامة في بلاد الكفر، نسأل الله أن يكون موافقًا للحقِّ والصواب.
* * *
فلمَّا استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
أي لَمَّا هاجر من مكة إلى المدينة واستقرَّ بها وفشا التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بها؛ إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة.
فالزكاة فُرضت في السنة الثانية من الهجرة بشروطها وأنصبائها وأوعيتها، أما جنس الزكاة فقد كان مفروضًا في مكة([312]) كما كان جنس الصلاة مفروضًا في مكة.. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن قول جعفر t للنجاشي «ويأمرنا بالصلاة والزكاة»، «الأولى أن يحمل على أنه كان يأمر بذلك في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول»([313]).اهـ
وجاء في سورة المزمل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا﴾ [المزمل: 20]
ومن الزكاة التي أوجبت في مكة بذل الماعون الذي جاء النهي عن منعه، حيث ذكر الله صفات من يستحقُّ العذاب ومنها ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: 7].
والصوم فرض بالمدينة أيضًا في السنة الثانية من الهجرة، وجاء أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا هاجر وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: «لِمَ تصومون هذا اليوم؟ » قالوا: يوم نجَّى الله فيه موسى ومن معه فقال: «أنا أحقُّ بِموسى منكم» وأمر بصيامه([314]).
فكان صوم عاشوراء فرضًا، ثم لَما فُرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة صار صيام يوم عاشوراء مستحبًّا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]
وقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
والحج فُرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح([315]) فترك الحج تلك السنة - صلى الله عليه وسلم - وأمر أبا بكر t أن يحجَّ بالناس وبعث معه عليًا t.
ثم حجَّ - صلى الله عليه وسلم - في السنة العاشرة ولم يحجُج غير تلك السنة.
وفَرضُ الجهاد جاء متدرِّجًا([316])، والأذان كانت مشروعيته في السنة الأولى من الهجرة.
إذن وهو - صلى الله عليه وسلم - في مكة اهتمَّ بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك، فمكث على ذلك عشر سنين، ثم فُرضت الصلاة في السنة العاشرة، وبقية أركان الإسلام فُرضت عليه في المدينة، وهذا يدلُّ على عِظم شأن التوحيد، وأنَّ الدعوة إليه هي أصل الدعوة إلى الإسلام وأساسها وقاعدتها التي إن تخلَّفت عنها فلا بناء ولا دعوة على الحقيقة، وإن لبست لباس الدين وجعل الإسلام شعارها ومحمد رسولها والله - جل وعلا - غايتها فالعبرة بالحقائق لا بالمسمَّيات.
مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قوم فيهم من الظلم والجاهلية وخصال الشر كشرب الخمور والزنا وغير ذلك ولم يتكلَّم إلا عن شيء واحد هو: «اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره»، يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك.
ولَمَّا استقام أمر الناس في المدينة على هذا الأصل العظيم بُنِي عليه غيره من فرض الفرائض وتحريم المحرمات كالرِّبا والزنا وشرب الخمر.
* * *
أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفِّي صلوات الله وسلامه عليه ودينُه باقٍ.
وهذا دينه لا خير إلا دلَّ الأمَّة عليه، ولا شرّ إلاَّ حذرها منه.
والخير الذي دلَّ عليه التوحيد، وجميع ما يُحبه الله ويرضاه.
والشر الذي حذَّر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
يريد المؤلف - رحمه الله - بقوله: «أخذ على هذا عشر سنين» أنه استمرَّ عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بشرائع الإسلام وأوامر الله - عز وجل - ونواهيه عشر سنين، وبعد ما أكمل الله له الدين وبلغ البلاغ المبين توفى - صلى الله عليه وسلم - مبلغًا رسالة ربّه أكمل بلاغ ومبينًا شريعة الإسلام الخاتمة أحسن بيان.
قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لم يكن نبي قبلي إلاَّ كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمته على خير ما يعلمه لهم ويُحذِّرهم من شرٍّ ما يعلمه لهم»([317]).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أحبُّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة»([318])..
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنِّي لم أُبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بُعثت بالحنيفية السمحة»([319])، كان يقول: «إنَّ هذا الدين يُسر»([320])، ولم يُخيِّر - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا([321]).
يقول أبو ذر t: (تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما من طائر يُقلِّب جناحيه في الهواء إلاّ وهو يذكر لنا منه علمًا)([322]).
فعلَّم أمته كلّ ما تحتاجه حتى الخلاء فكان ينهي عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء البول والغائط([323])، وكان إذا أراد الخلاء أبعد، وعلَّم أمته كيفية الاستنجاء والاستجمار حتى قال أحد اليهود للصحابي سلمان الفارسي t: «علمكم كلّ شيء حتى الخراءة»، يعني كيفية قضاء الحاجة، فقال سلمان الفارسي t: «أجل»([324]).
ومن شدَّة صبره على البلاغ وتحمُّله في ذلك ما ضرب له مثلاً واضحًا حيث رَوى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة t قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مثلي مثل رجل استوقَد نارًا فلمَّا أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهنَّ ويغلبنه فيقتحمن فيها، قال: فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها»([325]).
وقد اجتهد في تحذير أمته أبلغ الاجتهاد حتى أنه أخبرهم ببعض ما سيقع لهم وأرشدهم للخلاص فقال: «إنه من يَعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»([326])..
وقال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، قيل من هي يا رسول الله؟ قال: «هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»([327]).
وإذ علم أمته هذا التعليم وأرشدهم هذا الإرشاد وبين لهم هذا البيان فإنه سيأتي يوم القيامة شهيدًا عليهم ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41].
قوله «ودينه باقٍ» لأنَّ رسالته - صلى الله عليه وسلم - هي الرسالة الخاتمة العامة الباقية الخالدة، وليست لأقوام معينين، ولا لأزمنة خاصة، ولذلك تكفَّل الله سبحانه بحفظ القرآن الكريم، فقال - عز وجل -: ﴿إِنَّا نَحْنُ نـزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].
وهذا الحفظ يستلزم حفظ بيان هذا القرآن الكريم وهو السنة المطهرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 17-19].
وهذا الحفظ يستلزم أيضًا بقاء حملة الكتاب والسنة الذين يبلغون ذلك للأمة إلى يوم الدين.
قوله «وهذا دينه» يرجع إلى ما سبق إيضاحه في هذه الرسالة من معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلَّة.
وهو عليه الصلاة والسلام ترك أمَّته على هذا الدين وتوارثه أهل العلم خلفًا عن سلف.
قال السلف: هذا عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلينا، ونحن عهدناه إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم.
فجرى الخلف على منهاج السلف، واقتفوا آثارهم، ولا يزالون إلى يوم القيامة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقِّ منصورة لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»([328]).
قوله: «لا خير إلاَّ دلَّ الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه» يعني أنَّ الخير الذي دلَّ الأمة عليه أصله وأساسه التوحيد ويتفرَّع عنه جميع ما يُحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
والشر الذي حذَّرها منه أصله وأساسه الشرك بالله، ثم ما هو أقلُّ، منه جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
* * *
بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس.
والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158].
وأكمل الله به الدين.
والدليل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
المؤلف - رحمه الله - ذكر في هذه الجمل مسائل متعلِّقة بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لا بدَّ منها لِمن شهد له بالرسالة.
المسألة الأولى:
إنَّ الله - جل وعلا - بعثه إلى الناس كافة عربهم وعجمهم، ذَكرهم وأنثاهم، حُرهم وعبدهم، أحمرهم وأسودهم، ولا نـزاع في ذلك بين المسلمين.. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: 28].
وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158].
وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: 28]
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود»([329]).
بل ثبت التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - «أُرسل إلى الإنس والجن»([330])، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
المسألة الثانية:
إنَّ الله - جل وعلا - افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس بإجماع المسلمين، وقرن طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه، قال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]
وقال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنـزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: 29-31].
المسألة الثالثة:
الله - جل وعلا - أكمل به - صلى الله عليه وسلم - الدين كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «تركتكم على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»([331])..
قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].
يقول العباس t عمُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والله ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ترك السبيل نهجًا واضحًا»([332])، ولقد أشهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربَّه على أمته بالبلاغ حيث قال لهم: «ألا هل بلغت؟.. اللهم فاشهد»([333]).
والدين هو ما يدين به المرء فيكون عادة له في عبادته، وأصل الدين العادة، وسُمي ما يعتقده العبد ويتعبد به لربه «دينًا» لأنه لازمه وكرَّره حتى أصبح عادةً له، يعني من جهة اللغة([334]).
* * *
والدليل على موته - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: 30-31].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
إنَّ هذا الرسول الكريم قد مات بعد ما بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمَّة وجاهد في الله حقَّ الجهاد، والدليل على موته قول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: 30-31]
وقال تعالى: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 144].
وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 34-35].
فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، فخرج إلى الناس عاصبًا رأسه، لأنَّ أول ما ابتُدئ به وجع الرأس، فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قُتِلوا في أحد ثم قال: «إنّ عبدًا من عباد الله خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده»، ففهمها أبو بكر t فبكى وقال: بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على رِسلك يا أبا بكر»، ثم قال: «إن أمن الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت مُتِّخذًا خليلاً غير ربِّي لاتخذت أبا بكر، ولكنّ خلَّة الإسلام ومودَّته»..
وأمر أبا بكر أن يُصلِّي بالناس، وكانت مدَّة مرضه ثلاثة عشر يومًا في المشهورة، ولَما كان يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره الله لجواره، وفي ذلك اليوم كشفَ السِّتر والناس في صلاة الصبح خلف أبي بكر t، فهمَّ المسلمون أن يفتتنوا من فرحهم برؤيته - صلى الله عليه وسلم - حين نظروا إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، وظنوا أنه يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم: أن مكانكم، ثم أرخى السِّتر.
ونـزل به الموت، فجعل يُدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»، ثم شخص بصره نحو السماء وقال: «اللهم في الرَّفيق الأعلى»، فتوفِّي عند ارتفاع الضحى من ذلك اليوم، وهو نفس الوقت الذي دخل فيه المدينة حينما هاجر إليها.
واضطرب المسلمون؛ فمنهم من دُهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم أن أنكر موته بالكلية، وقال: إنما بعث إليه كما بعث إلى موسى. وكان من هؤلاء عمر t، وبلغ الخبر أبا بكر t، فأقبل مسرعًا حتى دخل بيت عائشة ورسول الله مُسجَى، فكشف عن وجهه الثوب، وأكبَّ عليه، وقبَّل وجهه مرارًا وهو يبكي، وهو يقول: وا نبياه! وا خليلاه! وا صفياه! وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَّا بعد، فإنَّ من كان يعبد محمدًا فإنَّ محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإنَّ الله حيٌّ لا يموت، ثم قرأ: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: 144]
﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30] فاشتدَّ بكاء الناس، وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريمًا له، ثم كُفن بثلاثة أثواب، أي لفائف بيض سحولية (بيضاء) ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلَّى الناس عليه إرسالاً بدون إمام، ثم دُفن ليلة الأربعاء بعد أن تَمَّت مبايعة الخليفة من بعده.. فعليه من ربِّه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم.
ويتعلَّق بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسألتان:
المسألة الأولى:
معنى موته - صلى الله عليه وسلم - أن روحه فارقت جسده لانتهاء أجله عليه الصلاة والسلام، لكن روحه متصلة بجسده ولذا يردّ السلام على من سلّم عليه.
المسألة الثانية:
الناس إذا ماتوا ينتقلون إلى حياة برزخية، وهو - صلى الله عليه وسلم - بعد موته في أكمل أنواع الحياة البرزخية بمعنى أنَّ حياته في البرزخ أكمل من حياة الشهداء وليس معنى ذلك أنه يسمع الدعاء ويُجيب النداء.
«فالحياة الجسمانية لا ريب أنه مات وغُسل وكُفِّن وصُلي عليه ودفن في ضريحه صلوات الله وسلامه عليه»([335]).
ولَما مات قام أبو بكر t يبكي ويقول: «بأبي أنت وأمي، أمَّا الموتة التي كتبت عليك فقد متَّها»([336]).
وتكلَّم ابن القيم - رحمه الله - عن حياة الشهداء بعد موتهم وأنهم عند ربِّهم يُرزقون، وأنَّ حياتهم أكمل من حياتهم في هذه الدنيا وأتمّ وأطيب، وإن كانت أجسادهم متلاشية ولحومهم متمزقة وأوصالهم متفرقة.. ثم قال: «وإن كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم فما الظنُّ بحياة الرُسل في البرزخ»([337]).اهـ
وقال: «فللرسل والشهداء الصديقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم الدنيا أكملها وأتمها، وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة وسعيه وحرصه على الظفر بها»([338]).اهـ
* * *
والناس إذا ماتوا يبعثون.
والدليل قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55].
وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [نوح: 17-18].
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم.
والدليل قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: 31].
ومن كذب بالبعث كفر.
والدليل قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
انتهى المؤلف - رحمه الله - من الكلام على الأصل الثالث، وختم هذه الرسالة العظيمة بذكر مسائل مهمة، بعضها متعلِّقٌ بالأصل الثالث، فختم بالكلام على البعث والإيمان بالرسل ومسألة الكفر بالطاغوت وتعريفه.
أمَّا البعث فالمراد به عودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثالثة نفخة القيام، وخروج الناس من قبورهم إلى حُكم يوم القيامة.
ومناسبة تخصيص هذه المسألة بالذكر وزيادة الكلام عليها أنه كثر في وقت الشيخ إنكار البعث والتكذيب له، ولذلك نصَّ عليه ودلَّل وأعقب ذلك بذِكر حكم من كذَّب بالبعث.
وقوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55].
أي أنَّ مبدأكم في الأرض لأنَّ أباكم آدم - عليه السلام - مخلوق من ترابٍ من أديم الأرض، و«في الأرض نعيدُكم» أي إذا متُّم تصيرون إليها فتُدفنون بها.
ومن الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب مرَّةً أخرى كما قال - جل وعلا -: ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: 25].
وجاء في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ قبضة من تراب فألقاها في القبر ثم تلا قول الله - جل وعلا -: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55].
وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [نوح: 17-18] معناه كما تقدَّم أنَّ مبدأ الخلق آدم من الأرض والناس ولده([339]).
﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ أي الأرض إذا متم..
﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ منها بعد البعث أحياءً فيُعيدكم يوم القيامة..
﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104].
وبعد بعثهم سيُحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم دقيقها وجليلها حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها كما قال - جل وعلا - ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: 31] فمن أساء بالشرك وما دونه سيجزيه بإساءته وعمله، ومن أحسن بالتوحيد والإخلاص وأطاع ربَّه - جل وعلا - فسيجزيه بالحسنى وهي الجنة.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة.. قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47].
وحُكم من كذَّب بالبعث كافر، والدليل على ذلك أنَّ الله - جل وعلا - كفَّر من أنكر البعث، وزعم أنه لن يُبعث كما قال: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ [التغابن: 7]
فدلَّ على أنَّ إنكار البعث كفر، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: 3].
وقد أمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم بربِّه - عز وجل - على وقوع المعاد في ثلاثة مواضع:
الأول- في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: 53].
الثاني- في سورة سبأ في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: 3].
الثالث- في سورة التغابن في قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7].
كما أقسم الله تعالى في موضع كثيرة على وقوع البعث، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [النساء: 87].
قال القاضي عياض - رحمه الله -:
«وكذلك نقطع على كفر من قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص، وتعذيبها أو تنعيمها فيها، بحسب زكائها وخبثها، وكذلك من أنكر البعث والحساب.. فهو كافر بإجماع؛ للنص عليه، وإجماع الأمة على نقله متواترًا»([340]).اهـ
فمن أنكر البعث فقد كذَّب الله تعالى وكذَّب رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكذَّب إجماع المسلمين.
تنبيهــان:
الأول- أمر البعث والمعاد والحساب سهل وهيِّن على الله - جل وعلا -، كما قال في آخر الآية: ﴿وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7].
وقال - جل وعلا -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27].
الثاني- البعث ليس مختصًّا بالإنس، بل يعمُّ الإنس والجنَّ وغيرهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: 5].
* * *
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين.
والدليل قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165].
وأولهم نوح - عليه السلام -، وآخرهم محمد - صلى الله عليه وسلم -.
والدليل على أنَّ أولهم نوح - عليه السلام - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: 163].
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ذكر المؤلف - رحمه الله - مسألة الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لتعلُّقها بالأصل الثالث؛ إذ أنَّ التصديق والإيمان برسول من الرسل يقتضي الإيمان والتصديق بجميع الرسل.
فلا بدَّ للعبد أن يؤمن بأنَّ الله - جل وعلا - بعث رُسلاً، وهذا له جهات:
الجهة الأولى:
أنهم مبشِّرون من أجابهم إلى ما دعوا إليه من عبادة الله وحده وترك ما سواه برضوان الله وكرامته،
ومُنذِرون ومُحذِّرون من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه.. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]، وقال عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام أول شيء بدءوا به قومهم أن قالوا «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره».
وخاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم - أول شيء دعا قومه إليه قوله لهم: «قولوا لا إله إلاَّ الله تفلحوا» أخذ على هذا عشر سنين، وكان جواب قومه «أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ !.. إنَّ هذا لشيء عجاب».
ولَمَّا بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنَّ لا إله إلا الله»، وفي رواية «إلى أن يوحِّدوا الله»، وفي رواية «فادعهم إلى توحيد الله».
الجهة الثانية:
أن أولهم نوح - عليه السلام - وآخرهم محمد - صلى الله عليه وسلم -، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: 163] أي الرسل.
ونوح - عليه السلام - كان بينه وبين آدم - عليه السلام - عشرة قرون كلهم على الإسلام، فلمَّا حدث الشرك بسبب الغلوِّ في الصالحين أُرسل إليهم نوح - عليه السلام -، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين.
فلا رسول قبل نوح - عليه السلام -، ومن ذَكر من المؤرِّخين من أنَّ إدريس - عليه السلام - كان قبله فخطأ، والذي يظهر أنَّ إدريس - عليه السلام - من أنبياء بني إسرائيل([341]).
أما آدم - عليه السلام - فلم يأت ما يدلُّ على أنه رسول، والذي ورد فيه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «آدم نبي مكلّم»([342]).
وآخر الرسل إلى أهل الأرض محمد - صلى الله عليه وسلم - كما دلَّ على ذلك قول الله - جل وعلا -: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40].
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا نبي بعدي»، وأجمع المسلمون على ذلك.
وعيسى - عليه السلام - إذا نـزل آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فهو من أمته بإجماع المسلمين.
الجهة الثالثة:
بعثهم الله - جل وعلا - جميعًا لعبادته وحده دون ما سواه والكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36].
فمضمون البعث جاء بعد «أن» وهو الدعوة إلى
التوحيد ونبذ الشرك والكفر به، كما قال - جل وعلا -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].
وكلا الآيتين فيهما العموم الواضح أنَّ أول شيء بدأت به الرسل قومهم هو التوحيد، وتقدّم معنا أول كلام نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل عليهم السلام لأقوامهم ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: 59]، فهذه دعوة الرسل وزبدة الرسالة، وبه تعرف عظمة شأن التوحيد.
ومعرفتك عظمته تقتضي أن تصرف همَّتك إليه فتتعرَّف عليه وعلى ضدِّه وتعمل بما يقتضيه.
وتذكر أنَّ كلَّ عملٍ بدونه لا ينفع من الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك، كما أنَّ الصلاة لا تنفع مع الحدث.
وتذكَّر أنه يوجد من دخل الجنة ولم يصلِّ ركعة واحدة، لأنه اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكًا به، كأن يقتل قبل أن يصلِّي أو يموت.
واعلم أنه ما هلك من هالك إلاَّ بترك العلم بالتوحيد والعمل به، مع أنَّ العلم به سهل وإدراكه متيسَّر في الأصل.
واليوم مع كثرة الشبهات وتوارد المتشابهات تأكَّد على عموم الناس تعلُّمه خصوصًا أنَّ هناك من يقول بأنه من أهل التوحيد ويعمل بضدِّه.
الجهة الرابعة:
إنَّ الله - جل وعلا - بعث في كلِّ أمَّةٍ رسولاً ليكون حجَّةً عليهم ولا يكون لناس حجَّة على الله بعد الرسل كما قال - جل وعلا -: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165].
فلا يقولون يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولاً أو ما أنـزلت إلينا كتابًا، فبإرسال الرُسل تنقطع حُجة الخلق على الله - جل وعلا -.
وجاء في الحديث الصحيح: «ما من أحدٍ أحبُّ إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشِّرين»([343])، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15].
ولا عُذر بعد إرسال الرسل وإنـزال الكتب.
ولَمَّا ذكر الغاية من إرسال الرسل ناسب أن يتكلَّم عن شيء من هذه الغاية وهو الكفر بالطاغوت وهذه هي المسألة التالية.
* * *
وكلّ أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36].
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله.
قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى:
الطاغوت: ما تجاوز به العبد حدَّه من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاع.
والطواغيت كثيرة، ورءوسهم خمسة: إبليس لعنة الله، ومن عُبد وهو راضٍ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادَّعى شيئًا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنـزل الله».
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لَما ذكر إرسال الرسل عليهم السلام أردف ذلك بذِكر السبب من إرسالهم، وهو عبادة الله وحده والكفر بالطاغوت.
أما الطاغوت لغة: فهو صيغة مبنيَّة للكثرة والسعة من «طغى يطغى طغيانًا»، ومعنى ذلك التجاوز.
تقول: «طغى المال» إذا تجاوز الحد، و«طغى الرجل» إذا تجاوز حدَّه.
والطاغوت من الطغيان، مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك.
أمَّا في الشرع فقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - رحمه الله -: اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت، فقال بعضهم هو الشيطان، جاء عن عمر t.
وقال آخرون: بل الطاغوت الساحر، جاء عن محمد بن سيرين، وقال آخرون: بل الطاغوت هو الكاهن.. جاء عن جابر t([344]).اهـ
ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر من قال ذلك من السلف:
والصواب من القول عندي في الطاغوت:
أنه كلُّ ذي طغيان على الله، فعُبد من دونه، إمَّا بقهر لِمن عبده، وإما بطاعة مِمَّن عبده له، إنسانًا كان ذلك المعبود أو شيطانًا أو وثنًا أو صنمًا أو كائنًا ما كان من شيء.
وأرى أن أصل «الطاغوت»: الطغووت، من قول القائل: «طغا فلان يطغو» إذا عدا قدره، فتجاوز حده، كـ: «الجبروت» من التجبُّر، و«الخلبوت» من «الخلب» (وهو المخادع الكذوب)، ونحو ذلك من الأسماء التي تأتي على تقدير «فعلوت» بزيادة الواو والتاء، ثم نُقلت لامه – أعني لام «الطغووت» - فجعلت له عينًا، وحولت عينه فجعلت مكان لامه، كما قيل: جذب وجبذ، وجاذب وجابذ، وصاعقة وصاقعة، وما أشبه ذلك من الأسماء التي على هذا المثال([345])اهـ
وتلاحظ في تعريف ابن القيم - رحمه الله - أنه يشمل ما ذُكر، فقوله «معبود» يدخل فيه ما ذكره عمر t، وقوله «مطاع» يدخل فيه الساحر والكاهن.
فهذه التفاسير من التفاسير بالأفراد.
وفي تعريف ابن القيم - رحمه الله - للطاغوت يتبين لنا معناه في الشرع وهو الذي أراد الله منّا اجتنابه، وبعث الرسل من أجل ذلك.
وقول المؤلف: «ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع».
فكلُّ شيءٍ يتعدَّى به العبد حدَّه الشرعي وقدره الذي ينبغي له شرعًا يصير به طاغوتًا، سواء تعدَّى حدَّه من معبود مع الله بأيِّ نوع من أنواع العبادة، أو متبوع في معاصي الله، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم بأن كان يُحرِّم ما أحلَّ الله ويُحلُّ ما حرّم الله.
وذكر ابن القيم - رحمه الله - لما عرَّف الطاغوت بما نقله عنه المؤلف: «أنك إذا تأمَّلت طواغيت العالم وجدت أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة»([346]).اهـ
ولأجل ذلك قال المؤلف - رحمه الله - تعالى: «والطواغيت كثيرون» أي لا حصر لها؛ لأنَّ كلَّ من تجاوز حدَّه في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتًا.
ما تجاوز به العبد حدَّه من متبوعٍ بحيث يُقلِّده ويهتدي بهديه حتى يتجاوز بذلك الحدَّ الشرعي فبذلك يكون المتبوع طاغوتًا للتابع إذا كان راضيًا بذلك، كذلك ما تجاوز به العبد حدَّه من مطاعٍ بحيث يطيعه حتى يتجاوز بذلك الحدَّ الشرعي فيكون المُطاع بذلك طاغوتًا للمطيع إذا كان راضيًا.
قوله: «والطواغيت كثيرون ورءوسهم خمسة»: أي بالاستقراء والتأمُّل، وإلاَّ لم يأتِ نصٌّ بذلك، وهذه الخمسة ذكرها المؤلف بقوله: «إبليس لعنه الله»: هذا هو رأس رءوس الطواغيت، لأنه أُطيع وتُوبِع، وتجاوز المطيع والتابع بذلك الحدِّ الشرعي، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: 22] والاستجابة هنا بمعنى المتابعة والطاعة.
وقال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: 60].
قال الإمام محمد بن جرير الطبري - رحمه الله -: «إبليس (إفعيل)، من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن، عن ابن عباس قال: إبليس أبلسه الله من الخير كله، وجعله شيطانًا رجيمًا عقوبةً لمعصيته، وكما قال الله جل ثناؤه: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44]؛ أنهم آيسون من الخير، نادمون حزنًا»([347]).اهـ
قال الراغب - رحمه الله -: «الشيطان: النون فيه أصلية وهو من شطن أي: تباعد، وقيل: بل النون فيه زائدة من شاط يشيط: احترق غضبًا»([348]).اهـ
وقوله: «لعنه الله» اللعن في الأصل الطرد والإبعاد([349])، ونلعنه لأن الله تعالى لعنه حيث قال: (بل لعنه الله) وصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ألعنك بلعنة الله»([350])، يعني: إبليس.
واللعن من الله - جل وعلا - طرد وإبعاد منه([351])، «ومن الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن»([352])، ولذلك قال ابن الأثير: «أصل اللعن من الخلق السب والدعاء»([353]).اهـ
قوله: (ومن عُبِدَ وهو راضٍ): أي بتلك العبادة غير معترض، وغير مُنكِر على العابد، فهذا من رؤساء الطواغيت وكبرائهم، فيخرج من هذا القيد عُزير وعيسى عليهما السلام، وكذلك الملائكة.
تنبيـه مهـم:
إذا عَبد أحدٌ غيرَ الله - جل وعلا - أو اتبعه وأطاعه وتجاوز الحدَّ في ذلك؛ فإنَّ ذلك الغير يكون طاغوتًا بالنسبة للعابد أو المتبع والمطيع، ولا يكون طاغوتًا على وجه الإطلاق إلا إذا كان ذلك المعبود أو المتبوع أو المطاع راضيًا بذلك، لأنَّ من الناس من يعبد محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أو يعبد عيسى - عليه السلام - أو يعبد رجلاً صالحًا وهؤلاء لا يرضون بذلك بل ينهون عنه.
قوله: (ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه): وهذا أعظم من الأول كفرعون الذي قال لقومه: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24] وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: 38]، وكفعل بعض مشايخ الطرق الصوفية ورءوس الرافضة والإسماعيلية.
فيقرُّون الغلو والتعظيم بغير حقّ، وغرضهم العلوّ في الأرض والفساد واتخاذهم أربابًا والإشراك بهم حتى حُكي عن بعض أئمَّة الضلال أنه قال: «من كان له حاجة بعد موتي فليأتِ إلى قبري وليستغث بي».
قوله: (ومن ادّعى شيئًا من علم الغيب): كالساحر والمنجِّم والرمَّال والكاهن ونحوهم.
قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65].
وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 59].
والغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان:
1- نسبي.
2- مطلق.
فالنسبي كغيب الواقع والحاصل، فهو غيب بالنسبة لإنسان دون آخر؛ إذ أنَّ هناك من يعلمه. والمطلق هو غيب الحاضر والمستقبل، فهذا مختصٌّ به الله - جل وعلا -. وقد يُطلع الله تعالى من شاء من الرُسل على شيء من غيب المستقبل، قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾﴾ [الجن: 26-27].
قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله: «من رسول»: يعم الرسول الملكي والبشري([354]).اهـ
وقوله: «رصدا» قال ابن عباس رضي الله عنهما: مُعقِّبات من الملائكة يحفظون النبيَّ من الشيطان([355]).
قوله: (ومن حكم بغير ما أنـزل الله): قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنـزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنـزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 60].
وهذا فيه تفصيل؛ لأنَّ الله - جل وعلا - سمّى الذي يحكمون بغير شرعه كفارًا وظالمين وفاسقين، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44].
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45].
وقال - عز وجل -: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47].
وهذه الآيات نـزلت في أهل التوراة والإنجيل، كما تدلُّ على ذلك أسباب النـزول والسياق نفسه، ولكنَّ خواتيم الآيات ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ جاءت بصيغة العموم، فالعبرة بعموم اللفظ، ولا يجوز قصر أحكامها على غير المسلمين من أهل الكتاب.
ومما يجدر التنبيه إليه ضرورة التفريق بين من لم يحكم بما أنـزل الله ومن ينحرف أو يجور في بعض الأحكام والأمور الجزئية بحكم الضعف أو اتباع الهوى، فلا يجوز المسارعة إلى تكفيره.
قال القرطبي - رحمه الله -: «إن حكم به – أي بغير ما أنـزل الله – هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين»([356]).اهـ
وهذا كما قال ابن عباس - رحمه الله -: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملَّة، كفر دون كفر»([357]).
وقال عطاء: «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»([358]).
فإذا حُكم بغير ما أنـزل الله وهو يعلم أنه عاصٍ بحكمه ذلك، وأن حكم الله - جل وعلا - أفضل وهو المتعين إلاَّ أنَّ نفسه غلبته وشهوته تمكَّنت منه كفعل بعض المفتونين من القضاة الذين يتأثَّرون بالرشوة؛ فهذا معصية، وهذه المعصية سماها الله - جل وعلا - «كفرًا»، ولا شكَّ أنَّ معصية سمَّاها الله «كفرًا» أعظم من معصية لم تُسمَّ بالكفر.
أمَّا من يستبدل الشرع بقوانين وضعية فقد قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته تحكيم القوانين:
«إنَّ من الكفر الأكبر المستبين تنـزيل القانون اللعين منـزلة ما نـزل به الرُّوح الأمين على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - ليكون من المنذرين بلسانٍ عربيٍّ مُبين في الحكم، بين العالمين والردّ إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله - عز وجل -: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]»([359]).اهـ
«وإذا صار الحكم بذلك غالبًا صار كفرًا أكبر، وهذا القيد مهم جدًا»([360]).
فائــدة:
قال ابن عثيمين - رحمه الله -:
في قوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]
وقال - عز وجل -: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47].
«هل هذه الأوصاف الثلاثة تتنـزل على موصوف واحد؟ بمعنى أنَّ كلَّ من لم يحكم بما أنـزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأنَّ الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسوق، فقال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 254]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: 84].. فكلُّ ظالمٍ فاسق، أو هذه الأوصاف تتنـزَّل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنـزل الله.. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم».
فنقول:
من لم يحكم بما أنـزل الله استخفافًا به أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أنَّ غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كُفرًا مُخرجًا من الملَّة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلاَّ وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق؛ إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلَّة الفطرية أنَّ الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.
ومن لم يحكم بما أنـزل الله لا استخفافًا بحكم الله، ولا احتقارًا، ولا اعتقادًا أنَّ غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محابة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله:
هم على وجهين:
الأول: أن يعلموا أنهم بدَّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرَّم وتحليل ما أحلَّ الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الله فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا.
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام([361]) ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
وهناك فرق بين المسائل التي تُعتبر تشريعًا عامًا، والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنـزل الله لأنَّ المسائل التي تُعتبر تشريعًا عاملاً لا يتأتّى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط، لأنَّ هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد([362]).اهـ
تنبيـه مهـم للناشئـة:
«هذه المسألة -أعني مسألة الحكم بغير ما أنـزل الله- من المسائل الكبرى التي ابتُلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألاَّ يتسرَّع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبيَّن له الحقّ، لأنَّ المسألة خطيرة.. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أنَّ على المرء الذي أتاه الله العلم أن يُبيِّنه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجَّة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة، ولا يُحقرنَّ نفسه عن بيانه، ولا يهابنَّ أحدًا فيه؛ فإنَّ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين»([363]).اهـ
* * *
والدليل قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: 256].
وهذا هو معنى «لا إله إلا الله».
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
لَما ذكر أنواع الطاغوت الذي يجب على المسلم أن يكفر به، والذي أُرسلت الرُسل لأجل التحذير منه ذكر دليلاً يُبيِّن أنَّ هذا هو لبُّ التوحيد وأساسه، وهو معنى «لا إله إلا الله»، فالكفر بالطاغوت هو المراد في قولك: «لا إله...» والإيمان بالله هو المراد من قولك: «...إلاَّ الله».
وقوله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ أي لا تُكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام؛ لأنه بّينٌ واضح جليٌّ بدلائله وبراهينه، فلا يحتاج إلى أن يُكره أحدٌ للدخول فيه.
فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوَّر بصيرته دخل على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مُكرهًا مقسورًا.
﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ أي ظهر الحقُّ وتميَّز عن الباطل كما تميَّز الإيمان من الكفر والهدى من الضلال.
﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ قال سعيد بن جبير: أي «لا إله إلا الله»([364]).اهـ
والمعنى: من تمسَّك وتعلَّق واعتصم بالتوحيد ولا إله إلا الله فهذا هو العروة الوثقى، أي القوية الموصلة لرضوان الله - جل وعلا - والجنة.
والاستمساك فيه معنى التمسُّك وزيادة، فناسب أن يأتي بالاستمساك لأنه أقوى من التمسُّك، فقد يتمسَّك الإنسان ولا يستمسك.
وقيل: سبب نـزول هذه الآية أنها نـزلت في عددٍ من أولاد الأنصار أرادوا استردادهم لما أُجليت بنو النضير، رُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ([365]).
قوله ﴿لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: 256] أي لا انقطاع لها حتى تؤدِّيه إلى الجنة.
وقوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 256] تُلاحظ أنه بدأ بالكفر قبل الإيمان والنفي قبل الإثبات والتخلية قبل التحلية.
* * *
وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله».
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
يريد المؤلف - رحمه الله - الاستدلال بهذا الحديث على أنَّ لكلِّ شيءٍ رأسًا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - الإسلام الخاص، وهو الهدى ودين الحقّ، أرسله الله بذلك ليُظهره على الدين كلِّه، وجعل الكتاب الذي أُنـزِل على محمد - صلى الله عليه وسلم - مهيمنًا على ما بين يديه من الكتب ومصدقًا لها، وجعل له شرعة ومنهاجًا، وشرع لأمته سُنن الهدى، ولن يقوم هذا الدين وهذا الأمر إلا بالكتاب المهيمن وبالحديد، فالكتاب يهدي به والحديد ينصره كما قال - جل وعلا - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنـزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنـزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: 25].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تفسير هذه الآية:
«فذَكر تعالى أنه أنـزل الكتاب والميزان وأنه أنـزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورُسله، ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديًا ونصيرًا»([366]).اهـ
وقال: «ودين الإسلام أن يكون السيف تابعًا للكتاب فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعًا لذلك كان أمر الإسلام قائمًا»([367]).اهـ
قال ابن رجب - رحمه الله - عن الحديث:
«أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاثة أشياء: فأمَّا رأس الأمر ويعني بالأمر: الدِّين الذي بُعث به وهو الإسلام، وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين [يقصد رواية الإمام أحمد عن معاذ مرفوعًا: «إنَّ رأس هذا الأمر أن تشهد ألاَّ إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله»([368])]، فمن لم يقر بهما ظاهرًا وباطنًا، فليس من الإسلام في شيء.
وأمَّا قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهو الصلاة، وفي الرواية الأخرى: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»([369]).اهـ
وقال: «وأما ذروة سنامه – وهو أعلى ما فيه وأرفعه – فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض»([370]).اهـ
في الصحيح عن أبي ذر t قال:
قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله»([371]).
وعن أبي هريرة t عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الأعمال: إيمان الله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله»([372]).
فائــدة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
«والله تعالى يقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: 33] بالحجة والبيان وباليد واللسان، وهذا إلى يوم القيامة.
لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد، قال تعالى: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52] وسورة الفرقان مكية، وإنما جاهدهم باللسان والبيان»([373]).اهـ
ويتعلق بالجهاد مسألتان تناسبان هذا المقام:
المسألة الأولى:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الجهاد شرع على مراتب، فأول ما أنـزل الله فيه الإذن بقوله: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ [الحج: 39].
ثم نـزل جوبه بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: 216].
ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم بل قال: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 90].
وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله وإن كان الهدنة عقدًا جائزًا غير لازم، ثم أنـزل في براءة: الأمر ينبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يبح ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنةً مطلقةً مع إمكان جهادهم»([374]).اهـ
وتنبِّه إلى آخر كلامه - رحمه الله - حيث علَّق الحكم بإمكان جهادهم.
وقال ابن القيم - رحمه الله -:
«كان محرَّمًا، ثم مأذونًا به، ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورًا به لجميع المشركين، إمَّا فرض عين على أحد الأقوال، أو فرض كفاية على المشهور، والتحقيق أنَّ جنس الجهاد فرض عين إمَّا بالقلب وإمَّا باللسان وإمَّا بالمال وإمَّا باليد، فعلى كلِّ مسلمٍ أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع»([375])اهـ
المسألة الثانية:
قال ابن رجب - رحمه الله - في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «بُني الإسلام على خمس...».
"ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر، مع أنَّ الجهاد أفضل الأعمال، وفي حديث معاذ: «وذروة سنامه الجهاد»، وذروة سنامه: أعلى شيء فيه، ولكن ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها؛ وذلك لوجهين:
الأول- أنَّ الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان.
والثاني- أنَّ الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نـزل عيسى - عليه السلام -، ولم يبق حينئذ ملَّة غير ملَّة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغني عن الجهاد بخلاف هذه الأركان، فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، والله أعلم"([376]).اهـ
والله أعلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــ المعنى العام:
ختم المصنف - رحمه الله - هذه النبذة الجليلة بردِّ العلم إلى من هو بكلِّ شيء عليم، واحتذى المؤلف حذو أهل العلم المتقدِّمين، حيث يختمون كلامهم في الفتوى أو الدرس أو الكتاب بقولهم «والله أعلم» وهذا فيه اعتراف بقلَّة العلم واعتقاد بأن َّ الله بكلِّ شيء عليم.
ثم صلَّى وسلَّم على النبيِّ الكريم - صلى الله عليه وسلم - امتثالاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صلَّى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»([377]).
والصلاة من الله - جل وعلا - على نبيِّه وعلى المؤمنين ثناؤه في الملأ الأعلى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلَّى عليّ صلاة واحدة صلَّى الله عليه بها عشرًا»، «معناه أنَّ من قال: اللهم صلِّ على محمد، فجزاؤه أن يُثني الله عليه في الملأ الأعلى عشر مرات، والملأ الأعلى هم الملائكة.
اللهم صلَّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله أعلم وصلِّ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكان الفراغ من إتمام هذا الشرح في مدينة الرياض العامرة – حرسها الله تعالى – عصر الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر ربيع الأول من عام أربع وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
([1]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول ص(7)، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الخامسة 1407هـ.
([2]) ينظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/431)، أشرف على طباعتها: محمد رشيد رضا، الطبعة الأولى 1349هـ.
([3]) ينظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (1/277)، جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1399هـ.
([4]) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/117)، جمع: عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة السادسة 1417هـ.
([5]) الدرر السنية (1/170، 171).
([6]) ينظر حاشية «ثلاثة الأصول» لابن قاسم ص(25).
([7]) ينظر الدرر السنية (1/221-226).
([8]) المصقول في التعليق على مختصر ثلاثة الأصول، تأليف: عبد العزيز بن محمد الشثري، اعتنى بإخراجها: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري.
([9]) عيون الأخبار لابن قتيبة (3/4) ت: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت 1418هـ.
([10]) رواه الإمام أحمد في المسند (1/36) المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ، والترمذي وحسنه في الجامع (2308) ت: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/ 330، 331)، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.
([11]) الترغيب والترهيب (4/311)، تأليف: أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
([12]) الدرر السنية (1/117) وينظر حاشية ثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ص5.
([13]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي الباب السادس منه. ت: مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة 1407هـ.
([14]) فتح الباري (8/220)، تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني، ت: محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، الطبعة الثانية، 1409هـ.
([15]) المرجع السابق (1/13).
([16]) آداب المشي إلى الصلاة ص(7)، مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب، قسم الفقه، الجزء الثاني، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
([17]) تفسير ابن كثير (1/120)، ت: سامي السلامة، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ.
([18]) بدائع الفوائد (1/28)، لابن القيم، ت: هشام عبد العزيز وعادل العبدوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1416هـ.
([19]) مفتاح دار السعادة (1/56).
([20]) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(9).
([21]) رواه الترمذي (1924) وقال: حسن صحيح، ورواه الحاكم (4/159) وصححه.
([22]) المسلسل بالأولية هو الحديث الذي اتفق فيه الرواة على صيغة الأداء مثل: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا يقول .. أو: دخلنا على فلان فحدثنا، قال دخلنا على فلان فحدثنا قال دخلنا على فلان فحدثنا .. أو حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته قال حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته .. وهكذا، وينظر نزهة النظر عند شرح كلام ابن حجر على المسلسل.
([23]) تدريب الراوي (2/169)، تأليف: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت: د. أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت 1409هـ.
([24]) علماء نجد خلا ثمانية قرون (1/131) و (1/162).
([25]) ينظر شرح مختصر الروضة (1/267)، تأليف: سليمان بن عبد القوي الطوفي، ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
([26]) ينظر روضة الناظر في أصول الفقه (1/90)، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثالثة 1410هـ.
([27]) ينظر جامع بيان العلم وفضله ص31، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، الطبعة الثانية 1402هـ.
([28]) شرح شيخي صالح بن عبد العزيز آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([29]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ومسلم (1/51).
([30]) الاستقامة (2/233) ومنهاج السنة (5/253، 254)، وينظر الإحياء للغزالي المجلد الثالث الجزء السابع ص(52).
([31]) ينظر الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/233).
([32]) تفسير ابن كثير (8/479).
([33]) عدة الصابرين ص(60)، تأليف ابن القيم الجوزية، ت: زكريا علي يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت.
([34]) رواه الطبراني في الأوسط (5/215) لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني دار الحرمين، القاهرة 1415هـ.
([35]) طريق الهجرتين ص(506)، تأليف: ابن القيم الجوزية، ت: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى 1409هـ.
([36]) مفتاح دار السعادة (1/56).
([37]) تفسير ابن كثير (8/480).
([38]) الدرر السنية (4/340، 341).
([39]) ينظر البحر المحيط للزركشي (3/186، 188)، (3/247).
([40]) كما في متن ثلاثة الأصول، وينظر ص(80) من هذا الكتاب.
([41]) صحيح مسلم (400).
([42]) ينظر تفسير القرطبي (1/93).
([43]) ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/52) جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية 1416هـ، وتفسير ابن كثير (7/426).
([44]) ينظر تفسير الخازن (4/323)، بواسطة حواشي محمد بن أحمد مكي على كتاب تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول لمحمد الطيب الأنصاري، دار نور المكتبات ودار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ، وقد استفدت منه في مواضع أخرى.
([45]) وسيأتي مزيد تفصيل وبيان عن هذه الآية إن شاء الله تعالى عند استدلال المؤلف بها على أن جميع أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله وحده لا شريك له.
([46]) ينظر بدائع الفوائد لابن القيم (3/514).
([47]) الدرر السنية (1/129).
([48]) حاشية ثلاثة الأصول، ص19.
([49]) المرجع السابق.
([50]) المرجع السابق.
([51]) مجموع الفتاوى (4/31).
([52]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(19).
([53]) ينظر تفسير ابن كثير (8/55).
([54]) صحيح البخاري كتاب المغازي باب فضل من شهد بدرًا.
([55]) الفتاوى السعدية ص(28)، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، منشورات المؤسسة السعدية بالرياض.
([56]) ينظر "تيسير العزيز الحميد" ص(467، 468) في شرح باب قول الله تعالى: }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ{.
([57]) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله (والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون بالنفس التي حرّم الله إلا بالحق). ومسلم برقم (86) صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
([58]) النهاية لابن الأثير (2/176) ت: عبد السلام علّوش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ.
([59]) ينظر جلاء الأفهام ص(269)، لابن القيم الجوزية، ت: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية 1419هـ.
([60]) ينظر الصحاح (4/1482)، تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ.
([61]) قاعدة في المحبة، ص32، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ت: د. محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
([62]) هكذا وجدته ولعلها: في الأمثال.
([63]) قاعدة في المحبة ص(32).
([64]) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(33)، إعداد: فهد بن ناصر السلمان، دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 1414هـ.
([65]) مختصر من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (2/90).
([66]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(22، 23)، والدرر السنية (2/174).
([67]) ينظر جامع البيان في تأويل القرآن (27/11، 12)، تأليف: محمد بن جرير الطبري، ت: محمود شاكر، دار الفكر 1405هـ، وللاستزادة الجامع لأحكام القرآن (17/55، 56)، تأليف: محمد بن أحمد القرطبي، ت: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الثانية 1372هـ.
([68]) حاشية كتاب التوحيد ص(50، 51).
([69]) القول السديد ص(48)، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ.
([70]) حاشية كتاب التوحيد ص(51).
([71]) القول السديد ص(48).
([72]) ينظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (2/35).
([73]) ينظر الدرر السنية (1/327).
([74]) رواه البخاري في صحيحه كتاب صفة الصلاة، باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلّم، ومسلم (1/83).
([75]) كتاب التوحيد القسم الأول من مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ص(87)، وتيسير العزيز الحميد ص(458) حيث نقلها الشيخ عبد الله بن سليمان عنه.
([76]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان باب: من أجاب بلبيك وسعديك، ومسلم (1/58).
([77]) شرح شيخي صالح آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([78]) بدائع الفوائد (2/436).
([79]) مجموع الفتاوى (4/200).
([80]) الدرر السنية (4/27).
([81]) المرجع السابق (1/116).
([82]) المرجع السابق (2/81).
([83]) شرح شيخي صالح آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([84]) المفردات ص(516)، تأليف: الراغب الأصفهاني، ت: صفوان داؤدي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1412هـ.
([85]) ينظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(38)، وينظر تفصيل هذا الكلام عند شرح الإحسان.
([86]) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(28).
([87]) وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الإحسان إن شاء الله تعالى.
([88]) الدرر السنية (2/81) باختصار.
([89]) المرجع السابق (2/64).
([90]) الدرر السنية (2/65).
([91]) المرجع السابق، وبدائع الفوائد لابن القيم (4/943).
([92]) تهذيب اللغة (15/128-129)، تأليف: أبي منصور محمد الأزهري، إشراف: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ.
([93]) ينظر تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (2/252، 253).
([94]) ينظر بصائر ذوي التمييز (2/499)، تأليف: الفيروزأبادي، ت: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت.
([95]) بدائع الفوائد (2/93).
([96]) رواه الذهبي في العلوّ (352) ت: أشرف عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1416هـ.
([97]) تفسير الطبري (9/60).
([98]) ص47، 48.
([99]) نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب (5/289).
([100]) تهذيب اللغة للأزهري (13/79)، ومنه تفسير حديث «أين الله» قالت الجارية: في السماء يعني في العلوّ. رواه مسلم في صحيحه (1/381).
([101]) بدائع الفوائد (4/943).
([102]) التبيان في أقسام القرآن (2/272)، تأليف: ابن القيم الجوزية، دار الفكر.
([103]) ينظر الفروع لابن مفلح (1/111).
([104]) ينظر المرجع السابق.
([105]) مجموع الفتاوى (10/149، 150).
([106]) رسالة العبودية مجموع الفتاوى (10/149).
([107]) حاشية ثلاثة الأصول ص(34).
([108]) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/20) وتفسير ابن كثير (8/244).
([109]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(35).
([110]) تفسير ابن جرير (14/57).
([111]) الموافقات (3/144).
([112]) رواه النسائي في الكبرى (3/360) ت: د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ، وابن خزيمة في صحيحه (1003) ت: الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ، والحاكم (4/430)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
([113]) حاشية ثلاثة الأصول ص(35).
([114]) المرجع السابق.
([115]) رواه الحاكم في المستدرك (1/667) وصححه، وقال الذهبي: صحيح.
([116]) رواه الإمام أحمد (4/267).
([117]) يعتقد بعض الناس أن رجلاً كان يُسمى بالبدوي له مقام يتجاوز مقام المخلوق إلى مقام الخالق فعبدوه وألّهوه، وله قبر يُحج إليه كل عام وتصرف له أنواع من العبادات نسأل الله العافية للمسلمين من الشرك وأسبابه.
([118]) تقدم بيانه.
([119]) تيسير العزيز الحميد ص(40).
([120]) المرجع السابق ص(484).
([121]) شرحه رحمه الله على ثلاثة الأصول ص49، دار الفتح للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1416هـ، المدينة.
([122]) الدرر السنية (1/62)، (1/567).
([123]) المرجع السابق (2/121).
([124]) حاشية ثلاثة الأصول ص(37).
([125]) ينظر مدارج السالكين (1/512)، تأليف: ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي، ت: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1393هـ.
([126]) فتح المجيد ص(574)، تأليف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ت: الوليد الفريان، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى 1415هـ.
([127]) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/68)، تأليف: محمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الرابعة 1421هـ.
([128]) تيسير العزيز الحميد ص(486).
([129]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(38).
([130]) ينظر زاد المسير (5/203)، تأليف: ابن الجوزي.
([131]) حاشية ثلاثة الأصول ص(37).
([132]) تنوير المقالة (1/121)، تأليف: محمد التتائي، ت: محمد بشير، الطبعة الأولى 1409هـ، بواسطة كتاب التعريفات الاعتقادية، تأليف: سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ. وقد استفدت منه في مواضع من هذا الشرح.
([133]) ينظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(35).
([134]) تفسير الطبري (16/39).
([135]) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/127، 128).
([136]) مدارج السالكين (3/523).
([137]) ينظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (13/435)، تأليف: علي بن سليمان المرداوي، ت: د. عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو، هاجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1414هـ.
([138]) علم البلاغة من علوم اللغة، ويقسمه أهل هذا الفن إلى ثلاثة أقسام وهي: علم المعاني، وعلم البديع، وعلم البيان.
([139]) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/390).
([140]) معجم مقاييس اللغة (2/415)، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس، ت: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت 1420هـ.
([141]) النهاية لابن الأثير (2/532).
([142]) جامع العلوم والحكم (1/369)، تأليف: ابن رجب عبد الرحمن بن شهاب الدين، ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1412هـ.
([143]) حاشية ثلاثة الأصول ص(39).
([144]) شرح ثلاثة الأصول ص(55).
([145]) تفسير الطبري (10/157).
([146]) اقتضاء الصراط المستقيم (447، 448)، تأليف: أحمد بن تيمية، ت: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الثانية 1369هـ.
([147]) مجموع الفتاوى (8/538).
([148]) معجم مقاييس اللغة (2/447).
([149]) المفردات مادة (رهب)، وابن عثيمين شرح ثلاثة الأصول ص(59).
([150]) (1/165).
([151]) مدارج السالكين (1/550).
([152]) ص(200).
([153]) معجم مقاييس اللغة (2/182).
([154]) مجموع الفتاوى (7/28).
([155]) المرجع السابع (28/31).
([156]) مدارج السالكين (2/58).
([157]) وينظر الفروق اللغوية للعسكري ص(200).
([158]) وينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/182).
([159]) ينظر تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (7/194، 195).
([160]) بصائر ذوي التمييز (2/544)، وينظر مفردات الراغب الأصفهاني مادة خشي.
([161]) مدارج السالكين (1/549).
([162]) القول المفيد لابن عثيمين (2/210، 211).
([163]) نسيم الرياض (1/213)، تأليف: أحمد بن محمد الخفاجي، دار الكتاب العربي، بيروت.
([164]) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/165)، تأليف: محمد بن أحمد القرطبي، ت: محي الدين وآخرون، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
([165]) تهذيب اللغة (15/351).
([166]) معجم مقاييس اللغة (6/367).
([167]) طريق الهجرتين ص(173)، تأليف: ابن القيم الجوزية، ت: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الطبعة الأولى 1409هـ.
([168]) مدارج السالكين (1/434).
([169]) بعض البلاغيين يقول: الحصر والقصر والبعض منهم يقولك الاختصاص؛ ولا مشاحة في الاصطلاح.
([170]) هذه الأبيات للمتنبي يخاطب بها أحد الملوك، وقد دعا بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، وينظر الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/546)، ومدارج السالكين لابن القيم (1/430).
([171]) نقله عن شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين (1/78).
([172]) مختصر من شرح شيخي صالح آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([173]) شرح ثلاثة الأصول ص(60).
([174]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ومسلم (4/2211).
([175]) صحيح مسلم (3/1316).
([176]) رواه مسلم في صحيحه (4/2208).
([177]) رواه مسلم في صحيحه برقم (1977) (3/1567) من حديث علي رضي الله عنه.
([178]) شرح ثلاثة الأصول ص63.
([179]) المرجع السابق.
([180]) رواه مسلم (3/1261).
([181]) وتفاصيله كتب الفقه، وينظر حاشية ابن عابدين المسماة بـ«رد المحتار على الدرر المختار» (2/22).
([182]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة.
([183]) مدارج السالكين (1/136).
([184]) المرجع السابق (1/137).
([185]) ينظر المرجع السابق (1/512).
([186]) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(46).
([187]) ينظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(14).
([188]) جامع رسائل ابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى ص(24).
([189]) ينظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(57).
([190]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(46).
([191]) شرح شيخي صالح آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([192]) ينظر ص(31-33).
([193]) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(64).
([194]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(47).
([195]) شرح شيخي صالح آل الشيخ [أشرطة شرح الطحاوية].
([196]) رواه مسلم (1/132).
([197]) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، ومسلم (1/46).
([198]) مجموع الفتاوى (7/360).
([199]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(47).
([200]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب (واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها).
([201]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(48).
([202]) ينظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(65).
([203]) مدارج السالكين لابن القيم (3/451).
([204]) ينظر المرجع السابق (3/452).
([205]) ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (1/461)، تأليف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هاشم، ت: حسن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ.
([206]) ينظر تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (6/222).
([207]) ينظر الدرر السنية (2/73).
([208]) ينظر المرجع السابق (2/103).
([209]) تفسير ابن جرير الطبري (1/54).
([210]) رواه الطبراني سليمان بن أحمد في المعجم الكبير (18/174)، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية 1404هـ. والروياني محمد بن هارون في المسند (1/105)، تأليف: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الأولى 1416هـ.
([211]) ينظر تهذيب اللغة للأزهري (6/223، 224).
([212]) شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك (2/24).
([213]) إن قلت: لا معبود بحق إلا الله فالأصح أن تقول: «لا معبود بحق»، ولا تقول: لا معبود حق؛ لأن معبود اسم مفعول، واسم المفعول أضعف من الفعل فيحتاج إلى تقوية فلا تقول «حق» وإنما تقول «بحق» كقوله تعالى (فعال لما يريد) ففعال صيغة مبالغة ولذلك قال (لما يريد) ويصح فعال ما يريد.
([214]) رواه مسلم في صحيحه (1/53).
([215]) رواه الإمام أحمد (3/492) (4/341) والحاكم في المستدرك (1/15) والطبراني في الكبير (5/61).
([216]) رواه البخاري تعليقًا في صحيحه في كتاب الإيمان، باب: الدين يُسر.
([217]) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، باب: الدين يُسر.
([218]) ينظر الدرر السنية (2/92).
([219]) ينظر فتح المجيد (1/130)، وشرح ابن عثيمين على ثلاثة الأصول ص(71).
([220]) المغني لموفّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (4/325، 333)، ت: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 1417هـ.
([221]) المرجع السابق (5/4).
([222]) رواه الترمذي (5/14)، وابن أبي شيبة في المصنف (11/49)، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ.
وينظر الكلام حول المسألة في جامع العلوم والحكم (1/145-148)، والشرح الكبير للمقنع تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة والإنصاف للمرداوي (3/27-34).
([223]) رواه الإمام أحمد (5/346) والنسائي في (المجتبي) (1/231) ت: عبد الفتاح أبو غُدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية 1406هـ، ت: شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1414هـ وصححه ابن حبان (1554).
([224]) رواه مسلم (1/88).
([225]) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(101).
([226]) الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/28، 30) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/429).
([227]) ينظر تلخيص الحبير (2/223)، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: السيد عبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة 1384هـ.
([228]) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/114).
([229]) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب: أمور الإيمان، ومسلم (1/63).
([230]) مجموع الفتاوى (7/170).
([231]) كتاب الإيمان في مجموع الفتاوى (7/290).
([232]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب: تحريض النبي ﷺ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، ومسلم (1/48).
([233]) مجموع الفتاوى (7/505).
([234]) المرجع السابق (7/506).
([235]) ينظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (1/126).
([236]) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (6/115)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة 1405هـ.
([237]) رواه أبو داود سليمان بن الأشعث (4017) ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، والترمذي (2769).
([238]) جامع العلوم والحكم (1/128-130).
([239]) ينظر فتح الباري لابن حجر (1/152).
([240]) المرجع السابق.
([241]) المرجع السابق.
([242]) روي مرفوعًا وفي إسناده مقال، وينظر مجمع الزوائد (1/160) للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 1402هـ، وقال ابن حجر «أورده ابن السني حديثًا مرفوعًا بسند ضعيف» فتح الباري (12/138).
([243]) ينظر فتح الباري (1/152).
([244]) المرجع السابق (1/142، 143).
([245]) ينظر فتح الباري (8/165، 166).
([246]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(75).
([247]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول ص (75)، وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول ص(121، 122).
([248]) شرح شيخي صالح آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([249]) مسند الإمام أحمد (6/139).
([250]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، باب: الميت يسمع خفق النعال، ومسلم (4/2200).
([251]) مسند الإمام أحمد (6/139).
([252]) حاشية ثلاثة الأصول ص(79).
([253]) شرح شيخي صال آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([254]) ينظر المستدرك للحاكم (1/94) قال العلامة الألباني: صحيح، صحيح الترغيب والترهيب (3/397). مكتبة المعارف، الرياض الطبعة الثالثة 1409هـ.
([255]) رواه مسلم (4/1782).
([256]) رواه الحاكم في المستدرك (4/83) والهيثمي في مجمع الزوائد (8/215).
([257]) قال ابن حجر: «رواه الزبير بن بكار في النسب من حديث علي بإسناد حسن» اهـ. فتح الباري (6/403).
([258]) المصباح المنير للفيومي (2/400)، المكتبة العلمية، بيروت.
([259]) فتح الباري (6/403).
([260]) رواه الحاكم في المستدرك (2/604).
([261]) ينظر في هذا جلاء الأفهام ص(389، 390) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء، باب: قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً).
([262]) مجموع الفتاوى (7/10).
([263]) شرح الطحاوية ص(158)، تأليف: محمد بن علاء الدين بن أبي العز، ت: جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثامنة 1404هـ.
([264]) صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.
([265]) ينظر فتح الباري (1/36).
([266]) كتاب التفسير باب: تفسير سورة المدثر، صحيح البخاري وأثبت رواية «دثروني» وتُركت رواية «زملوني» وكلاهما في الصحيح.
([267]) المختار من كنوز السنة، عبد الله دراز، ص(38-39)، بواسطة حواشي كتاب «تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول» تأليف: محمد الطيب الأنصاري، وعناية: مجد بن أحمد مكي، دار نور المكتبات ودار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 1419هـ، وقد استفدت منه في مواضع من هذا الشرح.
([268]) رواه مسلم (4/1782).
([269]) رواه الطبراني في المعجم الكبير (10/267) والحاكم في المستدرك (1/661) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
([270]) ينظر الدرر السنية (1/120).
([271]) المرجع السابق.
([272]) تهذيب اللغة (14/304).
([273]) طريق الهجرتين ص(622).
([274]) تفسير القرطبي (19/37).
([275]) تفسير الطبري (14/9-12).
([276]) مدارج السالكين (2/21).
([277]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب: تفسير سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق).
([278]) فتح المجيد (1/176).
([279]) المختار من كنوز السنة ص(50-51).
([280]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء.
([281]) رواه مسلم (1/161).
([282]) من كلام ابن عثيمين في شرحه على ثلاثة الأصول حيث سرد مختصرًا لحادثة الهجرة ص(128، 129).
([283]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(84).
([284]) البخاري في صحيحه كتاب التفسير (4320).
([285]) صحيح البخاري كتاب التفسير باب: }إنَّ الَّذين توفَّاهُم الملائكَة ظَالمي أنفسهم قَالوا فِيم كُنتم قالوا كنا مُستضعَفين في اِلأرض{.
([286]) تفسير ابن كثير (2/389).
([287]) رواه أبو داود (3/93)، والحاكم (2/141، 142) بلفظ آخر وطريق أخرى، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، قال العلامة الألباني: «فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين»اهـ السلسلة الصحيحة (5/436)، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة 1405هـ.
([288]) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(131).
([289]) ص(833).
([290]) مدارج السالكين (2/463).
([291]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
([292]) فتح الباري (1/39).
([293]) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(83).
([294]) مدارج السالكين (3/452).
([295]) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/91).
([296]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(85).
([297]) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير.
([298]) ينظر فتح الباري (4/484).
([299]) حاشية ثلاثة الأصول ص(85).
([300]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/484).
([301]) رواه النسائي في الكبرى (5/217) وأبو دود (3/3).
([302]) رواه الطبراني في المعجم الكبير (2/303).
([303]) رواه الطبراني في المعجم الكبير (2/303).
([304]) رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/17)، ت: محمد عبد القادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة 1414هـ, وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (5/251).
([305]) تدريب الراوي (2/508، 509).
([306]) هذه المسألة والتي تليها من كلام ابن عثيمين في شرحه على ثلاثة الأصول ص(131-139).
([307]) لم أجده في الصحيح ووجدته عند الطبراني في المعجم الكبير (3/19)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/281) عن رواية الطبراني: فيه من لم أعرفه اهـ
([308]) رواه مسلم (4/2034).
([309]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء، باب: ذكر بني إسرائيل.
([310]) رواه أبو داود (3/93).
([311]) رواه الطبراني في المعجم الكبير (2/303).
([312]) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(139).
([313]) فتح الباري (3/266) بتصرف.
([314]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء.
([315]) رجع ذلك ابن القيم في زاد المعاد وقبله القرطبي والقاضي عياض، وينظر زاد المعاد (2/101) ت: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة والعشرون 1409هـ.
([316]) كما سيأتي بيانه في آخر الرسالة – إن شاء الله تعالى -.
([317]) رواه مسلم (3/1472).
([318]) رواه البخاري في صحيحه تعليقًا كتاب الإيمان باب الدين يسر.
([319]) رواه الإمام أحمد (6/116).
([320]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب الدين يسر.
([321]) رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبي ﷺ.
([322]) رواه الإمام أحمد (5/53، 162)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/263، 264): رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله المقرئ وهو ثقة.اهـ
([323]) رواه مسلم (1/223).
([324]) الحديث في مسلم (1/223).
([325]) صحيح مسلم (4/1789).
([326]) رواه أبو داود (4/200)، والترمذي (5/44)، والإمام أحمد (4/126، 127)، والحاكم (6/95-97).
([327]) رواه الطبراني سليمان بن أحمد في المعجم الصغير (2/92)، ت: محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ، والحاكم في المستدرك (1/218)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/189): «رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي لا يتابع على حديثه هذا وقد ذكره ابن حبان في الثقات» اهـ. قلت: وروى الحديث المروزي في السنة ص(23) من طريق آخر.
([328]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ومسلم (3/1523).
([329]) رواه مسلم في صحيحه (1/370).
([330]) ينظر فتح الباري لابن حجر (6/345) حيث قال: «وثبت التصريح بذلك في حديث» وكان النبي يُبعث إلى قومه وبُعثت إلى الإنس والجن فيما أخرجه البزار.اهـ
([331]) رواه الإمام أحمد (4/26) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (79) من حديث العرباض بن سارية t.
([332]) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (2/267)، دار صادر، بيروت.
([333]) رواه مسلم (3/1307).
([334]) تقدم معنا الكلام على الدين عند شرح قول المؤلف: «اعلم أرشدك الله لطاعته» المسألة الثالثة.
([335]) ينظر حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص(90).
([336]) رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ ووفاته.
([337]) مدارج السالكين (3/282، 283).
([338]) المرجع السابق (3/282).
([339]) «نباتًا» اسم وضع موضع المصدر أي إنباتًا.
([340]) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/1067)، تأليف: القاضي عياض بن موسى اليحصبي، ت: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
([341]) ينظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(151).
([342]) الحديث طويل، رواه الإمام أحمد (5/168)، والبيهقي في الشعب (1/148)، ت: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/160): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه وعند النسائي طرف منه وفيه المسعود وهو ثقة ولكنه اختلط»اهـ
([343]) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب: قول النبي ﷺ: لا شخص أغير من الله، ومسلم (4/2114).
([344]) جامع البيان في تأويل آي القرآن (5/416).
([345]) المرجع السابق.
([346]) ينظر إعلام الموقعين (1/50)، تأليف: ابن القيم الجوزية، ت: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م.
([347]) تفسير الطبري (1/509).
([348]) المفردات للراغب، ص(454).
([349]) ينظر النهاية لابن الأثير (5/54).
([350]) رواه مسلم (1/385).
([351]) ينظر النهاية لابن الأثير (5/54).
([352]) ينظر تيسير العزيز الحميد ص(256).
([353]) النهاية لابن الأثير (5/54).
([354]) تفسير ابن كثير (8/247).
([355]) المرجع السابق.
([356]) تفسير القرطبي (6/19).
([357]) أخرجه الحاكم (2/342)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
([358]) ينظر تفسير الطبري (6/256).
([359]) رسالة تحكيم القوانين من الدرر السنية (16/206).
([360]) شرح شيخي صالح آل الشيخ [أشرطة شرح ثلاثة الأصول].
([361]) في الأصل من مجموع الفتاوى (7/70، 71): (بتحليل الحرام وتحريم الحلال) ولا يستقيم مع السياق فعلله خطأ من الناسخ.
وقد نقلها ابن عثيمين «بتحليل الحرام وتحريم الحلال وقال: «كذا العبارة المنقولة عنه»، ونقلها الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير وابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد والصواب ما أُثبت» والله أعلم.
([362]) شرح ابن عثيمين على ثلاثة الأصول ص160-162.
([363]) المرجع السابق.
([364]) تفسير الطبري (3/20).
([365]) تفسير القرطبي (3/280).
([366]) مجموع الفتاوى (10/13).
([367]) المرجع السابق (20/393).
([368]) مسند الإمام أحمد (5/230) وذكرها الحافظ ابن رجب قبلُ ثم أشار إليها في أثناء هذا الكلام.
([369]) جامع العلوم والحكم (2/145)، وقصده بالرواية الأخرى رواية الإمام أحمد المتقدمة.
([370]) المرجع السابق (2/146).
([371]) رواه البخاري في صحيحه كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل.
([372]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب فضل الحج المبرور.
([373]) مجموع الفتاوى (28/38).
([374]) الجواب الصحيح (1/233، 234)، تأليف: أحمد بن تيمية، ت: د. عبد العزيز العسكر وعلي حسن ناصر وحمدان محمد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى 1414هـ.
([375]) زاد المعاد (3/71).
([376]) جامع العلوم والحكم (1/152).
([377]) رواه مسلم في صحيحه (1/288).
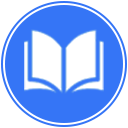 قراءة
قراءة