شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد [خالد المصلح]
تأليف : خالد بن عبد الله المصلح
نبذة مختصرة
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد : كتاب نفيس صنفه الإمام المجدد - محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يحتوي على بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهوكتاب عظيم النفع في بابه، بين فيه مؤلفه - رحمه الله - التوحيد وفضله، وما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع؛ وفي هذه الصفحة ملف لشرح الشيخ خالد بن عبد الله المصلح - أثابه الله -، وهي عبارة عن تفريغ لشرحه الصوتي والمكون من ثلاثين شريطاً.
-
1
شرح كتاب التوحيد [ خالد المصلح ]
PDF 4.6 MB 2019-05-02
-
2
شرح كتاب التوحيد [ خالد المصلح ]
DOC 5.6 MB 2019-05-02
تفاصيل
- كتاب التوحيد
- باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
- باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
- باب الخوف من الشرك
- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله
- باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلـٰه إلا الله
- بابٌ من الشرك لُبْس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
- باب ما جاء في الرقى والتمائم
- باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما
- باب ما جاء في الذبح لغير الله
- باب من الشرك النذر لغير الله
- باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله
- باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
- باب قول الله تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾( ) الآية. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾( ) الآية.
- باب الشفاعـة
- باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾( )الآية.
- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهِم دينَهم هو الغلو في الصالحين
- باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر
- باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين
- باب ما جاء في حماية المصطفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جناب التوحيد
- باب ما جاء أن بعض هـٰذه الأمة يعبد الأوثان
- باب ما جاء في السحر
- باب بيان شيء من أنواع السحر
- باب ما جاء في الكهان ونحوهم
- باب ما جاء في النُّشرة
- باب ما جاء في التطير
- باب ما جاء في التنجيم
- باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾( )، الآية
- باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾( ).
- باب قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾( )
- باب قول الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾( )
- باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
- باب ما جاء في الرياء
- باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
- باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباً من دون الله
- باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾( )الآيات
- باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾( ).
- باب قول الله تعالى: ﴿فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾( )
- باب ما جاء فيمن لم يَقْنَع بالحلف بالله
- باب قول: ما شاء الله وشئت
- باب: من سب الدهر فقد آذى الله
- باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه
- باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
- باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾( )
- باب قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا﴾( ).
- باب قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾( ) .
- باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت.
- باب لا يقال: عبدي وأَمَتِي
- باب: لا يُرَدُّ من سأل بالله.
- باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة
- باب ما جاء في الـ(لَوْ)
- باب: النهي عن سَبِّ الريح
- باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾( ).
- باب: ما جاء في مُنْكِري القدر
- باب ما جاء في كثرة الحَلِف
- باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
- باب ما جاء في الإقسام على الله
- باب: لا يُستَشفَع بالله على خلقه
- باب ما جاء في حماية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِمَى التوحيد، وسَدِّه طرق الشرك
شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد [خالد المصلح]
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح
الدرس الأول [المتن]
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
كتاب التوحيد
وقول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾( )، وقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾( ) الآية، وقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾( ) الآية، وقوله: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾ ( ) الآية. وقوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾ ( ) الآيات.
قال ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَّ هـٰذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا..﴾( ) الآية.
وعن معاذ بن جبل -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: كنت رديف النّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على حمار فقال لي: ((يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟)) [فـ]قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً))، فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)) أخرجاه في الصحيحين. ( )
[الشرح]
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فهـٰذا الكتاب المبارك - كتاب التوحيد - للشيخ العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهـٰذا الكتاب فريد في نوعه، وهو من أهم الكتب التي أُلفت في بابه؛ أي في باب توحيد العبادة، بل لا يبالغ الإنسان إذا قال: إنه لم يؤلَّف مثله في بابه، فإنه كتاب حوى آيات وأحاديث كثيرة من أحاديث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وآثار الصحابة التي تجلِّي وتبين حقيقة ما دعت إليه الرسل، فهـٰذا الكتاب لا تجد له نظيرًا، وليس هـٰذا مبالغة بل هـٰذا هو الواقع، فإنه كتاب لا نظير له فيما نعلم: من حيث حسن التبويب، ومن حيث جودة الانتقاء للأدلة، ومن حيث وضوح المعاني؛ فإن الشيخ رحمه الله ذيل الأبواب بمسائل تبين مقاصد الباب وتوضح المراد من سياق الآيات والأحاديث والآثار في هـٰذه الأبواب التي جعلها شبيهةً بكتاب الإمام البخاري رحمه الله؛ حيث إنه ترجم لكل باب، حتى إنه ترجم لكل باب بما يناسبه من الآيات والأحاديث.
ثم إنه لم يُجمع ما يتعلق بهـٰذا الباب من أبواب العلم وهو ما يتعلق بتوحيد العبادة كما جُمِّع في هـٰذا المصنف، فإنك تجد من كلام أهل العلم ما يتعلق بتوحيد العبادة مُفرَّقًا في ثنايا كلامهم، سواءً في التفسير أو في كتب العقيدة، ولكن الشيخ جمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، فهـٰذا الكتاب خرج بهـٰذا الشكل البديع، فجزاه الله خيرًا ونفع الله به الأمة.
وهـٰذا الكتاب ألفه الإمام قبل أن يذيع صيتُه وقبل أن تشتهر دعوته، فممَّا قيل: إنه ألفه لَمَّا كان في البصرة يتلقى عن علمائها في رحلته لطلب العلم، ولعل الشيخ - رحمه الله - بدأ الكتاب في البصرة ، وأعاد وأبدأ فيه حتى خرج بهـٰذا العقد البديع والنظم الذي يَعجَب منه المُطالِع من حُسْن تصنيفه وبديع سبكه.
المؤلف - رحمه الله - بدأ هـٰذا الكتاب كسائر أهل العلم بالبسملة تأسيًا بكتاب الله، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- افتتح كتابه بالبسملة، وتأسيًا برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واقتداء بسنته، فإن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يفتتح كتبه بذكر البسملة، وعلى هـٰذا جرى أهل العلم قديمًا وحديثًا يفتتحون كتاباتهم باسم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وقد ورد في هـٰذا حديث ولكنه ضعيف لا يستند إليه في سُنِّية البداءة بالبسملة، وإنما المستند في سنية البداءة بالبسملة في الكتابات إلى كتاب الله وما جرى عليه عمل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما سار عليه وسلكه سلف الأمة.
والبسملة الكلام فيها مشهور معروف وما أظن أننا بحاجة إلى تكراره فهو متكرر كثيًرا في الكتب، إنما نعرف أن البداءة بالبسملة تبركٌ باسم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وطلبٌ لفتحه ورحمته، يستفتح الإنسان بهـٰذه الأسماء العظيمة التي عنها تصدر الخيرات: باسم الله العظيم، وباسمه الرحمـٰن، وباسمه الرحيم، فإنها اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: الله، الرحمـٰن، الرحيم.
ومما يقال في البسملة: إنها جملة مفيدة. هـٰذا اعرفه واضبطه، ثم اعلم أن العلماء اختلفوا: هل هي جملة اسمية أم فعلية؟ ومنشأ خلافهم اختلافهم في التقدير: هل يقدِّرون اسمًا أم فعلاً؟ الذين قدروا الفعل قالوا: لأن الأصل في العمل للفعل، والذين قدروا الاسم قالوا: إن الاسم هو أصل الأفعال، فمنه تشتق الأفعال. والذي عليه جمهور أهل النحو وأهل اللغة أن البسملة جملة فعلية؛ لأنّ المقدر فيها فعل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنها جملة اسمية؛ لأنه قدر متعلق البسملة باسم.
ومما يقال أيضًا ويُذكّر به أن هـٰذا الاسم أو الفعل الذي تعلق به الجار والمجرور أفضل ما قيل فيه تقديره بمناسب، أن يكون فعلاً مناسبًا يناسب حال القائل لهـٰذه الجملة: فعند القراءة تقول: باسم الله أقرأ، وعند الذبح تقول: باسم الله أذبح، وعند الأكل: باسم الله آكل... وهلم جرّاً، يكون الفعل المقدر الذي تعلقت به الباء في البسملة فعلاً مناسبًا.. وهكذا.
وأيضًا مما يقال في هـٰذا أنه مؤخر تبركًا بالبداءة باسم الله عز وجل. يكفي هـٰذا فيما يتعلق بالبسملة، الكتب التي تكلمت عن البسملة كثيرة، وكتب التفسير مليئة وكتب أهل العلم مليئة بالحديث عن هـٰذه الجملة، وما ذكرناه هو زبدة وخلاصة يستحضرها طالب العلم عند قراءته للبسملة: أنها جملة مفيدة إما فعلية أو اسمية، تتعلق بفعل مقدر مؤخر مناسب، هـٰذا أبرز ما تستحضره في البسملة، ثم معاني ما تضمنته من الأسماء: اسم الله، واسم الرحمـٰن، واسم الرحيم، هـٰذه تأتي -إن شاء الله تعالى- في ثنايا كلامنا على هـٰذا الكتاب المبارك.
وهنا ابتدأ الشيخ - رحمه الله - ببيان موضوع الكتاب بعد ذكر البسملة فقال: (كتاب التوحيد.)
و(كتاب) على وزن فِعَال بمعنى مفعول أي مكتوب، فالكتاب هنا بمعنى مكتوب، والأصل في الكتاب هو الجمع، فالمؤلف أراد أن يبين أن هـٰذا الكتاب قد جمع ما يتعلق بالتوحيد، والتوحيد المشار إليه هنا هو توحيد الإلهية بالدرجة الأولى، وكذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن المؤلف - رحمه الله - قد تطرّق في هـٰذا الكتاب إلى جميع أنواع التوحيد، فلم يَقْصُره على توحيد الإلهية فقط، بل تكلم عن توحيد الأسماء والصفات وتكلّم عن توحيد الربوبية، وإنما غالب الكتاب في تقرير توحيد الإلهية.
واعلم - بارك الله فيك -أن التوحيد مصدر مأخوذ من وحَّد، وهـٰذا الأصل - وَحَّد - معناه أفرد، فالتّوحيد هو الإفراد أو التفريد، هـٰذا معنى التوحيد في اللغة.
أما في الاصطلاح فأجمع ما قيل في تعريف التوحيد: هو إفراد الله بما يستحقه في الإلهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، هـٰذا أجمع تعريف ينتظم أنواع التوحيد.
ومن هـٰذا نعرف أن للتوحيد أقسامًا ثلاثة وهي: توحيد الإلهية أو الألوهية -يصح هـٰذا وهـٰذا-، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات.
وأما توحيد الإلهية فتعريفه المختصر المفيد: توحيد العبادة، فهو إفراد الله بالعبادة: أن لا تعبد مع الله غيره. ويفصل بعض أهل العلم في التوحيد فيقولون: هو إفراد الله -عز وجل- بالعبادة، بأن لا تصرف نوعًا من أنواع العبادة إلى غيره. لكن هـٰذا تطويل في التعريف؛ لأننا إذا قلنا: إفراد، يعني ألا تصرف؛ لأن الإفراد مقتضاه منع الشركة، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة.
ومن التعاريف التي اشتهرت: إفراد الله بأفعال العباد. لكن يرد على هـٰذا التعريف إشكال، وهو أن أفعال العباد ليست كلها عبادات، منها ما هو أفعال عبادية، ومنها ما هو أفعال عادية كالمعاملات وما يجري في حياة الناس من عادات، لذلك فإن أدقّ تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهـٰذا هو موضوع الكتاب في الأصل.
أما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد الربوبية، وهـٰذا النوع تعريفه هو: إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والرّزق، وعرَّفه شيخ الإسلام ببعض هـٰذا فقال: توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله هو خالق كل شيء ومليكه. ولكن التعريف الذي يجمع توحيد الربوبية هو ما ذكرناه، وهو: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والرزق.
القسم الثالث: هو توحيد الأسماء والصفات، وتعريفه: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من حقق هـٰذا التعريف فإنه قد حصَّل تكميل توحيد الأسماء والصفات.
هـٰذا التقسيم هو المشهور للتوحيد عند أهل العلم.
هناك تقسيم آخر ذكره ابن القيم - رحمه الله - وجاء ذكره أيضًا في كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - فقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والإرادة.
هل هـٰذا التقسيم يخالف التقسيم السابق؟ الجواب: لا، لا يخالف؛ لأن التقسيم أمر اصطلاحي وليس أمرًا تعبديًّا منصوصًا لا تجوز مخالفته، إنما هو أمر اصطلاحي، فتوحيد الإثبات والمعرفة يقابل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإرادة والقصد والطلب هو توحيد الإلهية.
بعد ذكر هذين النوعين من التقسيم للتوحيد يرد سؤال وهو: ما دليلكم على هـٰذا التقسيم؟ هل جاء هـٰذا التقسيم عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ هل جاء عن الصحابة؟ هل جاء في الكتاب أو السنة؟
الجواب: من أسهل ما يكون أن يقال لهم: هـٰذا التقسيم استفدناه من استقراء الأدلة من الكتاب والسنة، فدليله الاستقراء، والاستقراء هو التّتبع، أي: إن أهل العلم تتّبعوا ما ورد من الآيات والأحاديث التي تتكلّم عن التوحيد فصنّفوها إلى ثلاثة أصناف، وقسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بتوحيد الإلهية، قسم بالربوبية، قسم بالأسماء والصفات. ونحن نقول: لا مشاحة في الاصطلاح إن أبيتم هـٰذا التقسيم، أهم من إثبات هـٰذا التقسيم الإقرار بمضمونه، وهنا يُسقط في أيديهم؛ لأن المخاصمين الذين شنعوا على المقسمين وقالوا: إن هـٰذا التقسيم بدعة أحدثها شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه عليها محمد بن عبد الوهاب، نقول لهم: دعكم من هـٰذا التقسيم إذا كنتم تأبون، لنتكلم عن مضمونه، هل تقرون بمضمونه؟ إن أقروا بمضمونه فلا خلاف، فيكون الخلاف لفظيّاً لا حقيقيّاً، لكن هم في الحقيقة ينكرونه؛ لأن شيخ الإسلام –رحمه الله- بيَّن وقرَّر تقريرًا واضحًا أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يفيد الإنسان الدخول في الإسلام؛ لأنّ المشركين كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية، وكثير ممن ينكر هـٰذا التقسيم عندهم أن معنى لا إلـٰه إلا الله: لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع، لا صانع إلا الله. فإذا قلت: إن هـٰذا الذي تقولونه أمر قاصر عما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أتى محتجًّا بتوحيد الرّبوبية على إثبات توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهـٰذا هو السر في تشنيعهم على هـٰذا التقسيم. وإلا لو نظرنا في كلام أهل العلم لوجدنا أنهم أحدثوا من التقسيمات التي تسهِّل العلم على طلابه شيئًا كثيرًا لم يكن على عهد السلف الصالح، الآن أين الدليل في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أن الصلاة فيها أركان وشروط وواجبات ومستحبات ومكروهات؟ أين هـٰذا؟ ليس موجوداً.
لو قلنا لهم: أين دليلكم؟ يقولون: دليلنا التتبع. نقول: أنتم تتبعتم في هـٰذا الأمر وتوصلتم إلى هـٰذه النتيجة، ونحن تتبعنا نصوص التوحيد وتوصلنا إلى هـٰذه النتيجة، ولا خلاف بيننا وبين من يوافق في مضمون ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. ثم إنه في الواقع قد ورد هـٰذا التقسيم في كلام المتقدمين من أهل العلم، فليس أول من ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - بل ذكره غيره ممن سبقه، فليس هو ببدعة محدثة تشددون فيها، لكن أنتم عرفتم سبب إنكارهم.
دليل توحيد الإلهية ما سيذكره المؤلف - رحمه الله -، ودليل توحيد الأسماء والصفات الآيات التي لا حصر لها التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾( ) لكان كافيًا في إثبات الأسماء والصفات؛ لأنّ أسماء الله تتضمن صفاته، والدليل الخاص في الصفات قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( )، ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( ).
إذاً عرفنا الأدلة على النوعين، بقي توحيد الربوبية ما دليله؟
توحيد الربوبية أدلته كثيرة، ولكن هناك آية جمعت أركان هـٰذا التوحيد وهي آية سورة يونس: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾( ) الآية.
فهـٰذا خطاب، أمَرَ الله رسوله أن يخاطب المشركين فيسألهم هـٰذا السؤال: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ هـٰذا فيه إثبات الرزق ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ﴾ هـٰذا فيه إثبات الملك ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ فيه إثبات الخلق ﴿وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ﴾ فيه إثبات التدبير.
الجواب: مَن الذي سيقول؟ المشركون الذين بعث فيهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾ أي: تتقون الشرك، وتذرون ما أنتم عليه من شرك، وتذرون ما أنتم عليه من تكذيب للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟
ولم يذكر في السياق ما يُتَّقى ليعم كل ما يجب اتقاؤه، كما مضى في قواعد التفسير.
هـٰذه الأنواع الثلاثة هل وردت مجموعة في كتاب الله عز وجل؟
الجواب: نعم، وردت في آية في سورة مريم، وهي قوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وهـٰذا فيه إثبات للربوبية ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ وهـٰذا فيه إثبات للإلهية ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾( ) هـٰذا فيه إثبات أسمائه وصفاته، وأنه المنفرد بكمال الأسماء والصفات، معنى الآية أي: هل تعلم له نظيرًا ومثيلاً وشبيهًا؟ تعالى الله عن ذلك.
وبعد هـٰذا التقديم لهـٰذا الكتاب نلج فيما ذكره رحمه الله.
قال: (كتاب التوحيد.)، ثم قال: (وقول الله تعالى.) ولم يجعل المؤلف مقدمة بين يدي كتابه، وهـٰذا ليس بغريب، اكتفى بالبسملة وشرع في مقصوده، وهـٰذا مسارعة منه - رحمه الله - في بيان ما يريد الحديث عنه والكتابة فيه.
قال رحمه الله تعالى: (قول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾( ).)
من بديع تصنيف المؤلف وبراعة استهلاله أنه بدأ بهـٰذه الآية لأمرين:
الأول: بيان موضوع الكتاب وأنه في توحيد الإلهية.
والثاني: حث القرّاء والمطالعين لهـٰذا الكتاب على العناية بهـٰذا الكتاب وما تضمنه؛ لأنّه هو غاية الخلق والمقصود من الوجود، فالمؤلف يقول: هـٰذا الكتاب يتعلّق بغاية الخلق ومقصود الوجود؛ لأنّ الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، فإذا كان كذلك كان هـٰذا حافزًا مشجّعًا على قراءته والاستفادة منه. فإذا قيل لك: الغرض من هـٰذا الكتاب هو بيان غاية الوجود، وأنت لم تدرك هـٰذه الغاية إدراكًا تامًّا، أو لم تدرك سبيل تحقيق هـٰذه الغاية؛ فإنك ستقبل على هـٰذا الكتاب لأجل معرفة كيفية تحقيق الغاية وطرق تحصيلها.
قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾، هـٰذه الآية الكريمة فيها حصر الله الغاية من الخلق بأمر، وهو قوله تعالى: ﴿ليَعْبُدُونِ﴾ يعني حصر الغاية من خلق الجن والإنس بالعبادة فقال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾. وهـٰذا النوع من أنواع الحصر هو من أقوى أنواعه؛ لأنه نفي وإثبات، فمن أقوى أساليب الحصر النفي والإثبات.
يقول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ﴾ الخلق هو الإيجاد والتكوين. ﴿الْجِنَّ﴾ هم عالم غيبي خلقهم الله من نار، وهم مكلّفون، وخلقهم سابق لخلق بني آدم، ولذلك قُدِّموا في الذكر هنا، فقُدِّموا على الإنس مع أن الإنس أشرف منهم. وأما ﴿الإنْسَ﴾ فهم بنو آدم وهم البشر، وخص هذين النوعين بالذكر دون سائر المخلوقات لأنهم هم الذين خلقوا للابتلاء، ولأنّ غيرهم من الخلق مسخَّر لهم، فما في الدنيا والآخرة من المخلوقات جعلها الله مسخرةً لهذين الصنفين الجن والإنس.
قال: ﴿إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾ هـٰذا حصر، والحصر هنا من أجل عموم المقاصد والأغراض، يعني لم يخلقهم لشيء إلا لعبادته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، هـٰذا حصر من عموم الأغراض والمقاصد.
لكن اعلم - بارك الله فيك - أن الغرض من الخلق نوعان: هـٰذه الآية بينت الغاية المرادة بالخلق، لو قيل لك: ما الغاية المرادة بالخلق؟ تقول: العبادة.
قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾( )، هـٰذه بينت الغاية من الخلق أيضًا، فإن ملك الله عز وجل وخلقه لما في السمٰوات والأرض لماذا؟ ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ وهـٰذه هي الغاية التي تراد من الخلق. عندنا قسمان: الغاية من الخلق عبادة الله، والغاية التي يصير إليها الخلق هي الجزاء على الأعمال؛ الإحسان بالإحسان والإساءة بما يليق بها، فعندنا غاية مطلوبة وغاية ينتهي إليها الأمر: الغاية المطلوبة هي العبادة، والغاية التي ينتهي إليها الأمر هي قوله عز وجل: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾( ). فالناس صائرون إلى هـٰذا المآل كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾( ). ففهم من هـٰذا أن الحصر هنا للأغراض المطلوبة من الخلق، فإنما أُوجِدوا وخُلقوا لتحقيق العبودية لله عز وجل، وقوله: ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾ اللام هنا للتعليل، ويعبدون أي يوحدون كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين، فالعبادة هنا هي التوحيد.
والعبادة في الأصل معناها اسم جامع لكمال المحبة لله وكمال الذل له. عرَّفها شيخ الإسلام بهـٰذا التعريف في بعض كلامه، وهو تعريف يجمع ركني العبادة اللذين ترجع إليهما جميع الصور، فكل ما شرع من العبادات لتحقيق هذين: المحبة والذل، وبهما تقوم العبادة ولا تقوم العبادة إلا بهما، ولذا قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) ( ) نعوذ بالله وعيد شديد، مثقال ذرة هل نرى هـٰذا المثقال؟ يعني وزن الذرة، والذرة قد لا تدركها ببصرك، فإذا كان في قلب العبد وزن ذرة من كبر منعه ذلك من دخول الجنة حتى يخلص من هـٰذا الكبر الذي في قلبه؛ لأن الجنة دار العباد، والكبر هو المعارض الأكبر للعبادة، لذا ينبغي أن يعالج المرء قلبه؛ لأنّه من أعظم أسباب تخلّف العبودية لله جل وعلا.
إذن نعود؛ ما هي العبادة؟ اسم جامع لكمال المحبة ولكمال الذل له سبحانه، وبهما تتحقق للعبد العبودية لله عز وجل.
التعريف الآخر المشهور هو ما ذكره ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة. فالله عز وجل خلق الخلق لهـٰذا.
وأعظم ما تتحقق به العبودية هو التوحيد، فمن لا توحيد له لا عبودية له، فلو أن رجلاً صلَّى وصام وزكَّى وحج وفعل شرائع الدين؛ لكنه أشرك مع الله غيره، لم يُفرد الله بالعبادة، ما مصيره؟ مصيره: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾( ). نعوذ بالله من الخسران، لا يحصِّل من هـٰذا شيئاً مهما كان، ولذا لما سألت عائشة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن عبد الله بن جدعان قالت: يا رسول الله! على ما كان عليه من خير في الجاهلية هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( لا، إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)) ( ) أي: إنه كان يكذّب بالبعث والحساب، فما نفعه مع ما كان عليه من خير من إحسان وصدقة، ولذا كان من فقه ابن عباس ودقيق علمه وفهمه لكتاب الله أن فسَّر العبادة هنا بالتوحيد.
واعلم أنه كلّما رسخ التوحيد في قلب العبد وثبت كان ذلك سببًا للإتيان ببقية شرائع الدِّين، ولذلك قال الله في يوسف: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾( ) وفي قراءة: ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾. ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ يكون من فعله و﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ يكون من اصطفاء الله له، واصطفاء الله له لا يكون إلا لأنه حقق التوحيد، فالقراءتان تبين إحداهما الأخرى، فهـٰذه الآية بيان لسبب خلق الجن والإنس وهو أنه للعبادة.
ثم قال رحمه الله: (قوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾( ).) هـٰذه ثاني آية في هـٰذا الكتاب، وفيها بَيَّن المؤلف - رحمه الله - أن الله عزّ وجل إنما بعث الرسل لتقرير هـٰذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، فإن الله تعالى لما أنزل آدم وحواء إلى الأرض ظل هو وزوجته والناس من بعده على التوحيد عشرة قرون، فلما حدث الشرك بعث الله عز وجل الرسل ليقيموا الناس على الصراط المستقيم، وليردّوهم إلى عبادة الله، فبعث الله عزّ وجل الرسل لما تخلّفت هـٰذه الغاية ولما حصل اختلال في تحقيقها، قال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا﴾ أي أرسلنا، والبعث أصله الإثارة، بعثتُ الشيء أي أثرته، فبعث الله عز وجل في كل أمة -وهـٰذا يشمل جميع الأمم الماضية، فإنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، بعث الله فيها- رسولاً، ماذا يفعل؟ ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾، ﴿أَنْ﴾ هنا تفسيرية؛ لأنها جاءت بعد البعث الذي فيه معنى القول دون حروفه، (أن) التفسيرية تأتي بعد فعل مُحْتَوٍ على معنى القول دون حروفه، فالبعث هنا لأجل أي شيء؟ ليقول لهم: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾. فأمرهم بأمرين متلازمين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾. وهـٰذا فيه طلبهم بإفراد العبادة، طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة، ثم قال: ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أي اجعلوا الطّاغوت في جانب وأنتم في جانب، فاجتناب الشيء لا يتحقق إلا إذا جعلت الشيء المجتنب في جانب وأنت في جانب، يعني أنت في طرف وهو في طرف، وهـٰذا معنى ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾.
﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أعظم ما يعبد الله به التوحيد، ولذلك (من قال: لا إلـٰه إلا الله دخل الجنة)؛ لأنها مفتاح التوحيد وأصل التوحيد وكلمة التوحيد، ولكن المقصود بالقول هنا القول الذي يوافقه القلب، لا القول الذي يخالفه القلب والفعل والقول، فقوله: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ هـٰذا فيه دعوتهم إلى التوحيد، فجميع الرسل جاؤوا بهـٰذه الدعوة : ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ فيه أن الرسل اتفقوا على النهي عن عبادة الطاغوت، فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والفعل طغى هو المجاوزة، أصله تجاوز الحد، إذا تجاوز الإنسان حدّه كان طاغية أو نقول: قد طغى، والطّاغوت على وزن فعلوت صيغة مبالغة.
وأحسن ما قيل في تعريفه أنه: اسم جنس لكل ما عُبد من دون الله أو دعا الناس إلى ضلالة. هـٰذا أجمع وأحسن ما قيل في تعريف الطاغوت.
وما في كلام العلماء المتقدمين من تعريف الطاغوت بالشيطان أو بالساحر أو بالكاهن إنما هو تفسير بالمثال، لكن المعنى الجامع لجميع هـٰذه الصور هو ما ذكرناه، وقد ذكر شيخ الإسلام في تعريف الطاغوت فقال: هو اسم جنس للشيطان والكاهن والدرهم والدينار؛ لأنّ الدرهم والدينار يحملان الإنسان على التخلف عن العبادة، قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة)) ( ) فكل هـٰذه إذا حملت الإنسان على المجاوزة جعلته قد طغى وتكون هي طاغوتًا.
إذن يكون عندنا تعريفان: تعريف شيخ الإسلام: اسم جنس للشيطان والوثن والكاهن والدرهم والدينار وغير ذلك، عرفه غيره بقوله: اسم جنس لمن عُبد من غير الله أوكان رأسًا في الضلالة. هـٰذا تعريف، وفيه آخر قال: أو لمن دعا الناس إلى ضلالة. والتعريف الأخير أشمل.
فالله في هـٰذه الآية أمر المؤمنين باجتناب الطاغوت وكل شيء يحملهم على الطغيان والخروج عن حد العبودية، ولذا قال ابن القيم في تعريف الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده، أي ما حده له الشرع من معبود أو متبوع أو مطاع، كل هـٰذه التعريفات تصب في معنى واحد.
والخلاصة: أن الشيخ ساق هـٰذه الآية لبيان اتفاق الرسل على دعوة التوحيد، وأنهم جاؤوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره.
ثم قال - رحمه الله -: (وقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾( ).) في هـٰذه الآية يُخبر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقضاءٍ قضاه وهو ما بينه في قوله: ﴿أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا..﴾. إنما الشاهد في قوله: ﴿أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾. وقضاء الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- نوعان: قضاء كوني قدري، وقضاء شرعي ديني. هـٰذا الذي في الآية هو من النوع الثاني، من القضاء الشرعي الأمري الديني، أي ما يتعلق بما يحبه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، أما النوع الثاني وهو القضاء الكوني فذاك ما قدره وقضاه كونًا وهو لا يتعلق بمحبته، بل يتعلق بحكمته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ومنه ما ذكره الله في كتابه في سورة الإسراء: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾( ). ومعلوم أن الفساد في الأرض مما يبغضه الله ويكرهه، فالقضاء في ذلك الموضع هو القضاء الكوني القدري.
ومقصود المؤلف - رحمه الله - من سياق هـٰذه الآية بيان أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قضى وحكم وقدر شرعًا ألا يُعبد إلا هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فكما أنه –سبحانه- خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل للدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له فإنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قضى شرعًا ألا يُعبد إلا هو، فمن عبد غيره فإنه قد خالف حكم الله الشرعي.
وقوله: ﴿أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾ المراد بالعبادة هنا جميع ما أمر الله به من العبادات الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة، وهو اسم لكمال المحبة وكمال الذّل والتعظيم لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كما تقدّم. ولاحظ في هـٰذا الموضع كما في سائر المواضع التي فيها تقرير التوحيد أنه يأتي بصيغة الحصر، وصيغ الحصر متنوِّعة، هنا أتى بصيغة النّفي والإثبات وهي من أقوى صيغ الحصر، والحصر إما أن يكون بصيغة لفظية أو بأمر معنوي، فالذي في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾. الحصر هنا معنوي؛ لأنه لما أمر بعبادته وأمر باجتناب الطاغوت عُلم بأنه أمر بعبادته وحده لا شريك له.
ثم بعد أن فرغ من ذكر حقه -جل وعلا- ذكر أعظم الحقوق بعد حقه وهو حق الوالدين، فقال سبحانه: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾. والذي يهمنا هنا في هـٰذه الآية فيما يتعلق بدرسنا القضاء الأول، وهو قضاء الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على عباده بالتوحيد وإفراده بالعبادة.
ثم قال رحمه الله: (وقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾.)
أيضًا في هـٰذه الآية أمر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بعبادته وحده فقال: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾. ثم أكّد انفراده بالعبادة وأنها لا تكون لغيره بقوله: ﴿وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، وهـٰذا نهي عن الشرك بجميع صوره؛ لأن قوله: ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النهي، والنّكرة في سياق النهي تُفيد العموم، فيشمل الشرك الأصغر والأكبر، ويشمل الشرك الفعلي والقولي والقلبي، ويشمل الشرك بمن له جاه ومنزلة عند رب العالمين وبمن ليس كذلك، ويشمل الشرك بالأحياء والأموات والجوامد. المهم أنه نهيٌ عن جميع صور الشرك؛ لأن قوله: ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي، وفائدة هـٰذه الآية زيادة على ما تقدم في قوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾ أن التوحيد هو أمره؛ فكما أنه قضاؤه -وقضاؤه ملزم- إلا أنه لم يكتف بذلك -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، بل صرح بالأمر به، فكان التوحيد غاية الوجود، وهو أيضًا دعوة الرّسل، وهو أيضا قضاء رب العالمين، وهو أمره جل وعلا.
ثم قال رحمه الله: (وقوله: ﴿قَلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾.)
هـٰذه الآية فيها أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يدعو المشركين، فقل يا محمد: ﴿تَعَالَوْا﴾. الخطاب للمشركين الذين كفروا بالله وأبوا دعوة التوحيد، وهـٰذه آية من سورة الأنعام، ومعلوم أن سورة الأنعام من السور التي كثر فيها جدال المشركين وبيان ما هم عليه من كفر وتكذيب وإقامة الحجة عليهم. ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ فهـٰذا هو الذي أوصاهم به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهو ألا يشركوا به شيئًا، وهـٰذا فيه بيان أن صرف التوحيد لغير الله -وهو ما يضاد التوحيد ويقابله- نهى الله عنه، فالآية السابقة فيها أنّ التوحيد أمره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وفي هـٰذه الآية أن التوحيد نهى -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عما يضاده ويخالفه، فقال: ﴿أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾. وهـٰذه الآية كثر الكلام في تركيبها، ونُرجئ الكلام عليها إلى درس التفسير حتى ما يطول بنا المقام، لكن اعلم أن قوله: ﴿أَلا تُشْرِكُوا﴾ لأهل العلم فيه قولان:
منه أنه جملة تفسيرية؛ لأنها جاءت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه، وهو قوله سبحانه: ﴿أَتْلُ﴾ والتلاوة قول.
ومنهم من قال: إنها مصدرية.
ومنهم من قال: إن قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ مضمن معنى الوصية، فالمعنى: تعالوا أتل ما وصاكم الله به.
ومنهم من قال: إنه مقدر، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وأوصاكم ألا تشركوا به شيئاً.
أقوال كثيرة، وأهم ما علينا أن نعرف أن المقصود من سياق هـٰذه الآية هو النهي عن الشرك، وأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- جعله بين يدي أصول المحرمات، فإن هـٰذه الآية فيها ذكر أصول ما حرمه الله على الأمم على اختلاف أنواعها وأزمانها وشرائعها، فإنها تضمنت أصول المحرمات. ونظير هـٰذه الآية ما ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...﴾ الآيات إلى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾( ). فإن السياق هناك مشابه للسياق هنا في ذكر ما حرمه الله عز وجل من أصول المحرّمات في جميع الأمم. ونظيره ما في سورة الإسراء في قوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾. فهـٰذه ثلاثة مواضع في القرآن ذكر فيها أصول المحرمات، كلها ابتدئت بذكر التوحيد والنهي عن الشرك، مما يدلّ على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهـٰذا يوجب على المرء أن يتعلم التوحيد وأن يعرف الشرك: يتعلم التوحيد ليعمل به، ويعرف الشرك ليحذره ويتجنّبه وينأى عنه. ثم قال: (إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هـٰذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾) وهـٰذه الآيات ذكرنا أنها تضمنت أصول المحرمات.
وبعد ما ساق الشيخ - رحمه الله تعالى - الآيات التي تضمنت أهمية ما تضمنه هـٰذا الكتاب، وعظم شأن التوحيد، أتى بآثار تبين أيضًا أهمية هـٰذا الأمر وعظم شأنه.
فذكر أولاً حديث ابن مسعود، (قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾).
قول ابن مسعود: (من أراد أن ينظر) أي: من أحب ورغب (أن ينظر إلى وصية محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)، الوصية هنا ليست الوصية الاصطلاحية عند الفقهاء وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، إنما المراد بالوصية هنا ما هو أعم من ذلك، وهو العهد بالشيء، فقول ابن مسعود: (من أراد أن ينظر إلى وصية محمد) أي: ما عهد به إلى أمته وما أمرهم به وما كرره عليهم، فهو من قبيل الوصايا القولية، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يترك وصية مكتوبة، بل لما هم أن يكتب لهم كتابًا وقع الاختلاف بين الصحابة في الكتابة، فتركها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يكتب شيئًا. فقول ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (إلى وصية محمد التي عليها خاتمه). يعني: التي لو كان موصيًا خاتِمًا لأوصى بها، وذكر الخاتم هنا لأن الغالب فيما يعتنى به من الأمور أن يُمهر ويختم، وهـٰذا يشعر بأن ابن مسعود يرى أن ما تضمنته هـٰذه الآيات من أهم ما كان يأمر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهي كذلك، فهي وصايا عظيمة تكفل سعادة الخلق في الدارين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
إنما المراد أن هـٰذه الوصايا التي أشار إليها ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بدأت بالنهي عن الشرك: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، فدل ذلك على أهمية هـٰذه الوصية وعلى أهمية هـٰذا الأمر ووجوب الحذر منه، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يكرر على أصحابه التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد إلى آخر رمق -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو كذلك، وسيأتي –إن شاء الله تعالى- بيان هـٰذا الأمر وعناية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتقرير التوحيد وصيانة جنابه في كلام الشيخ.
ثم بعد أن ذكر هـٰذا الأثر، وهو أثر اختلف العلماء في تحسينه: فمنهم من حسنه، ومنهم من ضعّفه. والذين حسنوه حسنوه لأنهم رأوا أنه من طريق داود الأودي، وهو داود بن عبد الله الأودي الثقة. وعلى كل حال فالأثر عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فهو مطابق من حيث المعنى، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ختم ما ذكر في كتابه في هـٰذه الآيات بقوله: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾. فهي وصية الله جل وعلا، ومعلوم أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لو كان موصيًا بشيء لأوصى بما أوصى به الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم ذكر بعد ذلك في آخر هـٰذا التقديم لهـٰذا المقطع من كتابه: (وعن معاذ بن جبل -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: كنت رديف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على حمار). الرديف هو الذي يَركب في الخلف (فقال لي: ((يا معاذ!))). القائل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ((يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟))لم يذكر معاذ إلى أي شيء كانا ذاهبين هو ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إنما ذكر أنه كان معه على هـٰذه الصفة، وأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأله هـٰذا السؤال: ((ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟)) وهما سؤالان. (قلت: الله ورسوله أعلم) أجاب معاذ بن جبل بهـٰذا الجواب، وهو جواب متكرّر من صحابة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في كثير من الأسئلة التي يوردها عليهم: (الله ورسوله أعلم). وفيه رد العلم إلى عالمه، فإنه رد علم ذلك إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وإلى رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال مبينًا: ((حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)) إفراده بالعبادة، هـٰذا حق الله على عباده: إفراده بالعبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا كائنًا ما كان، وهـٰذا فيه ما تقدم من المعنى الذي قررته الآيات السابقة من وجوب إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وهـٰذا واضح. ثم قال: ((وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً)). هـٰذا حق العباد على الله، فحقّهم إذا قاموا بما أمروا به أن يجزيهم هـٰذا الجزاء: أن يؤمنهم من العذاب، وليس الأمر واقفًا عند التأمين من العذاب، بل فضل الله واسع، فإن أمْنهم من العذاب سبب لدخول الجنة أو يتضمّن دخول الجنة، وإن كان الإنعام يحصل بالأمرين: التأمين من العذاب نعمة، ودخول الجنة نعمة. ولذلك لما يسأل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أهل الجنة: ((إن لكم موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟)).( ) فالنجاة من العذاب منّة تذكر، فقوله في هـٰذا الحديث: ((ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا)). يتضمّن الأمن من العذاب ودخول الجنة، لكنّه اهتم في السياق بذكر الأمن من العذاب؛ لأن الذي أمن من العذاب فمآله النعيم والجنة.
لكن من الذي يأمن من العذاب؟ من لا يشرك به شيئًا، سواءٌ كان شركًا أصغر أو شركًا أكبر؛ لقوله: ((شيئًا)) وهو نكرة في سياق النفي. واعلم أن العذاب مختلف باعتبار الشرك، فالشرك الأكبر عذابه دائم لا انقطاع له: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾( ). وأما الشرك الأصغر فيحاسب عليه صاحبه ويذوق من العذاب ما يقابله، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. فقوله: ((لا يعذب من لا يشرك به شيئًا)). هنا نفي أصل العذاب بنوعيه العذاب الأكبر والأصغر، العذاب الدائم والعذاب المنقطع.
ثم قال: (قلت: يا رسول الله! أفلا أبشّر الناس؟). وهـٰذا سؤال غريب، ولكنه يدل على دقة فهم معاذ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. وجه غرابة هـٰذا السؤال أن الأصل فيما يبلغ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبلغ أو أن يكتب، لذلك دعا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمن سمع حديثه وبلغه وقال: ((بلغوا عني ولو آية)). لكن معاذاً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لما سمع الحديث من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكان عميق الفقه خشي أن يكون في الإخبار به مفسدة، فسأل عن الإخبار فقال: أفلا أبشرهم؟ ثم انظر: الإخبار هنا ليس الإخبار الشخصي فيما يظهر، بل هو التبشير وهو إظهار البشارة، ولا يكون كذلك في الغالب إلا على وجه العموم، ولذا قال: (أفلا أبشر الناس؟) أي أخبرهم على وجه العموم؟ فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تبشرهم فيتكلوا)). فنهاه عن تبشيرهم خشية أن يركنوا ويتكّلوا ويعتمدوا على مثل هـٰذا الحديث، فيكون سببًا في وقوعهم في ما لا تحمد عقباه من التقصير في حقوق الله سبحانه. وبهـٰذا يكون قد انتهى الحديث الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - لبيان فضل التوحيد.
وفائدة هـٰذا الحديث: أنّ التوحيد حق الله، ومن أشرك فقد نقص الله حقه، ومن نقص الله حقه فإنه لا يأمن من عذابه وعقابه. ثم انظر في هـٰذا الحديث: حيث بدأ بحق الله قبل حق العباد، وسبب ذلك: لأن حق العباد مرتب على حق الله، فإنه لا ينال حق العباد على الله إلا إذا أوفوا الله حقه. أيضًا بدأ بحق الله قبل حق الناس؛ لأن الغالب في الناس المطالبة بحقوقهم والاشتغال بطلبها عن حقوق غيرهم، فقدم الإخبار بحق الله على الإخبار بحق العباد لكون الناس تشتغل أنفسهم بطلب ما لهم، وأما ما عليهم فإنهم يغفلون عنه، فقدمه لأهميته ولشحذ الهمم للوفاء بهـٰذا الحق.
واعلم أن إثبات حق الله على عباده لا خلاف فيه بين أهل القبلة، فالجميع يثبت حق الله على عباده، وأما حق العباد على الله فهـٰذا اختلف فيه أهل القبلة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول المعتزلة، وهو: أن على الله حقوقًا لعباده، لكن هـٰذه الحقوق تثبت بالعقل والقياس والاعتبار والنظر. وهـٰذا قول مجانب للصواب، لماذا؟ لقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾( ) فهو لا يقاس بعباده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فيما يجب له وفيما يمتنع عليه وفيما يجوز عليه، فالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لا يقاس بعباده في شيء من الأشياء، ولذلك إثبات الحق بالعقل بناء على القياس، فهم يقيسون ما يجب عقلاً بين الخلق، ويقولون: يجب على الخالق أن يفعل كذا وألا يفعل كذا. وهـٰذا مردود.
القول الثاني: قول من يقول: لا يجب عليه حق بالكلية، وإنما نعرف ما يفعل من خبره وما يقع. وهؤلاء هم الأشاعرة.
القسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة - جعلنا الله وإياكم منهم - الفرقة الناجية قالوا: نثبت ما أثبته الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على نفسه من الحقوق، وليس للعقل مجال في إثبات ما لم يرد في النص، بل نقتصر في ذلك على ما دلّت عليه النصوص، هـٰذا من جهة؛ أيضًا من جهة أخرى يقولون: هـٰذا الحق الذي نثبته، هـٰذا الاستحقاق هو استحقاق إنعام وفضل لا استحقاق مقابلة، فإن الله -عز وجل- أوجب على نفسه ذلك تكرمًا منه وإحسانًا بالخلق، ولذلك قال الناظم:
ما للعباد عليه حق واجب
إن عذبوا فبعدله أو نُعِّموا
كلا ولا سعي لديه ضائع
بفضله فهو الكريم الواسع
إن عذبوا فبعدله أو نعموا
فبفضله وهو الكريم الواسع
سبحانه وبحمده، ولذلك الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يخاف جوره بل يخاف عدله، ويؤمّل ويرجى فضله، بخلاف غيره، فإنه يخاف جوره -ظلمه-، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرمًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾( ). إنما يخاف عدله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فلو أجرى قانون العدل في خلقه كان ذلك سببًا لهلاكهم؛ لأنه مهما كان فعل العبد فلا يوفّي ما ينبغي أن يقوم به لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
العلماء ذكروا أجوبة عن سبب تحديث معاذ بهـٰذا الحديث، مع أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تبشّرهم)). فقالوا: إنه أخبر به تأثمًا خشية كتمان العلم، وقيل: أخبر به لما استقرت شرائع الدين وأمن من المحظور في قوله: ((فيتكلوا)). وقيل: أخبر به -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يمنعه ابتداءً، إنما أخبره بالخبر ثم أشار عليه بألا يبشِّر لما سأله: هل أبشر الناس أو لا؟ وهـٰذا الجواب فيه ضعف.
وعلى كل حال أخبر به اجتهادًا. ولا حجة فيه للمستهترين الذين يقولون: يكفي في التوحيد قول اللسان؛ لأن حق الله -عز وجل- عظيم والتوحيد أصله، ولا يعني أنه ليس له إلا ذلك وليس على العبد إلا هـٰذا، بل هـٰذا أصل الحقوق، وبقيّتها بينتها النصوص في القرآن والسنة بيانًا واضحًا شافيًا.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس .
[الشرح]
وهي العبادة: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾.
[المتن]
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه.
[الشرح]
وذلك في قوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً﴾.
[المتن]
الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ﴿وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾.
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل.
الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة.
السادسة: أن دين الأنبياء واحد.
[الشرح]
لأن جميعهم بعثوا بـ: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾.
[المتن]
السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾( ) الآية.
[الشرح]
﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ فالاستمساك بالعروة الوثقى مرتّب على أمرين، وهما:
الكفر بالطاغوت- وهو الكفر بكل ضلالة وبكل شرك-.
وعلى الإيمان بالله، ورأس الإيمان بالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- توحيده.
[المتن]
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عُبد من دون الله.
[الشرح]
هـٰذا تعريف الشيخ - رحمه الله – للطاغوت: أنه عام لكل ما عُبد من دون الله، وذكرنا لكم أنه اسم جامع لكل ما عبد من دون الله ولكل من دعا الناس إلى ضلالة.
[المتن]
التاسعة: عظم شأن الآيات الثلاث المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
[الشرح]
وجه ذلك قول ابن مسعود: (من أراد أن ينظر إلى وصية محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التي عليها خاتمه فليقرأها). وهـٰذا بيان عنايتهم بها، وهي حَرِية وجديرة بذلك؛ لما فيها من أصول السعادة في الدنيا والآخرة، ونظيرها ما في سورة الأعراف وما في سورة الإسراء.
[المتن]
وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك.
العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: ﴿وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً﴾ وختمها بقوله: ﴿وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ ونبهنا اللهُ –سبحانه- على شأن هـٰذه المسائل بقوله: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾.
الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾.
[الشرح]
ضم لهـٰذه الثلاثة المواضع ما في سورة الأعراف، فإنه قريب من هـٰذه في جمعها لأصول المناهي والأمر بما فيه السّعادة، وذكرنا لكم مبدأها في قوله: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ إلى نهاية قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾. نص على هـٰذا شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، ولو تأملتها لوجدتها مطابقةً للمواضع السابقة في سورة النساء والأنعام والإسراء.
[المتن]
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عند موته.
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا.
[الشرح]
شيخ الإسلام كأنه يشير إلى أن هـٰذه الوصية كانت عند موته، ولا شك؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى آخر حياته كان يحذر من الشرك، فمما حُفظ عنه في آخر أيامه قوله –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). .( ) ولعل الشيخ يشير إلى قول بعض أهل العلم: إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لو أراد أن يوصي لأوصى بهـٰذه الآية عند موته. وقد ذكرنا لكم أن الوصية هنا هي ما أمر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قولاً وكرّره وعهد به إلى الناس.
[المتن]
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
الخامسة عشرة: أن هـٰذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
[الشرح]
وجه ذلك أن معاذاً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: (أفلا أبشر الناس؟). ولو كانت شائعة لما سأل هـٰذا السؤال، ولما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا تبشرهم)). فدلّ ذلك على أنها ليست مما عم العلم به.
[المتن]
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
[الشرح]
هـٰذا صحيح، وليس كل كتم للعلم ممنوعاً مذموماً، بل منه ما هو محمود، بل منه ما هو واجب كما قال ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ما أنت محدث قومًا بحديثٍ لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم.
[المتن]
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.
الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
[الشرح]
هـٰذا يأمن منه الإنسان بالنّظر إلى ما جرى عليه فعل الله -عز وجل- في بعض من عاقبه، فإن آدم عليه السلام أخرجه الله من الجنة بخطيئة، فلا يأمن الإنسان من مواقعة السيئات ويقول: أستند إلى سعة رحمة الله وفضله. فما أدراك أن فضله يدركك وأنك أهل له؟ فالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أعلم بأهل الفضل، الله أعلم بالمهتدين، وهو أعلم حيث يمن ويرحم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر.
[المتن]
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
[الشرح]
أما إذا كان في مسائل الشريعة فلا إشكال؛ أنه يقول ذلك في حياة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبعد موته، إذا سئل الإنسان مسألة من مسائل الدين والشرع وهو لا يعلمها فيقول: الله ورسوله أعلم، في حياة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبعد موته.
أما بعد موته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مسائل الكون فإنه لا يضاف العلم إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل يضاف العلم إلى الله وحده، وكذلك في حياته في ما لا يدركه عادة من أمور الكون، فلا يقال: الله ورسوله أعلم، لم يرد مثل هـٰذا إلا في مسائل الأخبار الدينية الشرعية، أما الأخبار العادية الكونية فإنه لا يعلمها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فيميز بين مسائل الشرع ومسائل الكون.
[المتن]
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
الحادية والعشرون: تواضعه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة.
الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.
الرابعة والعشرون: عظم شأن هـٰذه المسألة.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثاني
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
وقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾( ).الآية
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من شهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). أخرجاه. ( )
ولهما في حديث عتبان: ((فإن الله حرم على النار من قال: لا إلـٰه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)).( )
وعن أبي سعيد الخدري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((قال موسى: ياربِّ علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به؟ قال: يا موسى قل: لا إلـٰه إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هـٰذا. قال: يا موسى، لو أن السمٰوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إلـٰه إلا الله في كفة، مالت بهن لا إلـٰه الله)). رواه ابن حبان، والحاكم وصححه. ( )
وللترمذي وحسنه عن أنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة)). ( )
[الشرح]
هـٰذا هو الباب الثاني، أو هـٰذا هو أول باب ذكره المؤلف رحمه الله بعد المقدمة، فإن في المقدمة التي قدم بها بعد ذكره لعنوان الكتاب أنه كتاب التوحيد بين مضمون الكتاب وأنه يبحث في الغاية من الوجود، ويبحث فيما بعث الله الرسل من أجله، ويبين حق الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على عباده. ثم في هـٰذا الباب أتى المؤلف -رحمه الله- ببيان فضل التوحيد؛ ليشجع على تحقيقه والعمل به والأخذ به والبعد عن ضده، ولا يمكن لأحد أن يحصّل هـٰذه الفضائل إلا بعد العلم به، فإن العلم بالتوحيد هو سبيل العمل به، وإذا عمل به الإنسان حصّل ما رتّب الله -عز وجل- من الفضائل على التوحيد.
قال رحمه الله: (باب فضل التوحيد). أي: باب بيان فضل التوحيد، فالمؤلف رحمه الله جعل هـٰذه الترجمة مدخلاً لبيان ما امتاز به التوحيد وما فضل به عن سائر العمل. ثم قال رحمه الله: (وما يكفر من الذنوب.)
التوحيد في قوله: (باب فضل التوحيد) في الأصل المراد به توحيد الإلهية، وإذا قلنا: توحيد الإلهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن من حقق توحيد الإلهية لا بد أن يكون حقق نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهـٰذا الفضل لتوحيد الإلهية الذي لا سبيل إلى تحصيله إلا بتحصيل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهـٰذا فضل التوحيد بجميع أنواعه، فالفضل للتوحيد بجميع أنواعه للغاية والوسيلة.
قال: (وما يكفر من الذنوب).
(ما) هنا أحسن ما قيل فيها أنها مصدرية، يعني والتقدير: وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب.
ويصح أن تكون (ما) موصولة ويكون المعنى: والذي يكفره من الذنوب.
ويصح أن تكون استفهامية ويكون المعنى السؤال عن: ما الذي يكفره التوحيد من الذنوب.
لكن أقوى هـٰذه المعاني وأبلغها هو أن تكون مصدرية؛ لأن المصدرية تفيد أن التّوحيد يكفر جميع الذنوب، وهـٰذا هو الواقع، فإن التوحيد يكفر جميع الذنوب ويحط جميع الخطايا، كما دلّ عليه حديث أنس الذي ذكره المصنف في آخر هـٰذا الباب في الحديث الإلهي: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة)).
وهـٰذا واضح في أنّ التوحيد تتلاشى بجانبه الذنوب. ويشهد له أيضًا حديث صاحب البطاقة فإنه يؤتى ببطاقة فيها: لا إلـٰه إلا الله، فتوضع في كفة، ويوضع في الكفة الأخرى تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل مد البصر من الخطايا والذنوب، فإذا وضعت لا إلـٰه إلا الله في الكفة المقابلة طاشت تلك الصحف.( ) وهـٰذا يبين بيانًا واضحًا أن التوحيد يكفر الذنوب وتتلاشى معه الخطايا، وهو فضل عظيم، فأفضل ما قيل في (ما) أنها مصدرية؛ لأنها تطابق ما دلت عليه الآثار من أن التوحيد يكفر الذنوب.
وقوله: (ما يكفر من الذنوب.)
(الذنوب) جمع ذنب وهي الخطايا، وهـٰذا يشمل -فيما يظهر- حق الله وحق الخلق، لكن أخرجت النصوص حق الخلق، ولعلّ الله -عز وجل- إذا علم من عبده صدق التوحيد يتحمّل عنه، ولكن الأصل أن الذنوب التي هي حقوق العباد ليست تحت المغفرة إلا إن أسقطها أهلها وأصحابها، وقد يغفرها الله، وليس معنى غفرانها أنها تذهب كحقوق الله بلا مقابل، بل يعوض الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أصحاب الحقوق عن هـٰذه الحقوق، فيتحمل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن المخطئ، ولكن الأصل أنها لا تغفر إلا بوضعها من أهلها أو رد مقابلها إليهم.
ثم قال رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾( )) افتتح المؤلف هـٰذا الباب بهـٰذه الآية العظيمة، وهي الآية التي عقب الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها ما قصَّه في كتابه في سورة الأنعام من المحاجة التي كانت بين إبراهيم وقومه، وهـٰذه المحاجة كانت في تقرير التوحيد ونفي الشرك وبيان بطلانه، بعد ذلك قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ فمن العلماء من قال: إن الآية من كلام إبراهيم. ومنهم من قال: إنها من كلام الله جل وعلا. وعلى كلٍّ فإن إبراهيم إنما يتكلم بما أعلمه الله، ولذلك الظاهر أنها من كلام الله جل وعلا، إما استئنافًا وإما تبليغًا: إما استئنافًا أن الله سبحانه لما قص النبأ وذكر خبر ما كان من إبراهيم وقومه من المحاجة عقَّب بهـٰذا البيان، وقد يكون من إبراهيم الذي يبلغه قومه ويقيم عليهم به الحجة، وهو من الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
مناسبة الآية للباب:
هـٰذه الآية مناسبتها للباب ظاهرة، فإن الله ذكر فيها فضل تحقيق التوحيد فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾. فالله عز وجل أخبر بأن الذين آمنوا وهم من حققوا الإيمان تحقيقًا تامّاً كاملاً..
والإيمان: اسم للعبادات الظاهرة والباطنة، فيشمل عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ثم أضاف قيدًا آخر فقال: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ﴾ أي: لم يخلطوا إيمانهم بظلم ﴿لَمْ يَلْبِسُوا..﴾ يعني:لم يخلطوا إيمانهم بظلم، هؤلاء ما الخبر عنهم وما هو حالهم؟ أولئك الذين قال الله جل وعلا عنهم في الآية: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾. فلهم فضيلتان مقابل هـٰذين العملين، العملان هما: تحقيق التوحيد، والبراءة من كل ما يضاده، وأول وأعظم وأهم ما يضاده الشرك. والفضل المرتب على هذين هو: الأمن والاهتداء، فلهم الأمن التام ولهم الاهتداء التام، لما كملوا الإيمان وسلموا من الشرك. والإيمان هنا ذكرنا أنه اسم لجميع ما أمر الله به من العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة.
وقوله: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ المراد به ما فسرها به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبينه، وإذا جاء التفسير عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا معدل عنه، فإنّ ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال لما نزلت هـٰذه الآية: شق على أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما فيها، فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله! أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الآية فيها إطلاق الظلم، ففهم الصحابة أن الأمن والاهتداء لمن سلم من الظلم كله دقيقه وجليله، صغيره وكبيره. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مطمئنًا لهؤلاء: ((إنه ليس كما تظنون، إنما هو قول لقمان لابنه: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)﴾ ( ))). ففسر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الآية بأعظم الظلم وهو الظلم بالشرك.
والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، هـٰذا أصله في اللغة، ولا شك أن من يصرف العبادة لغير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فقد وضعها في غير موضعها وصرفها إلى غير مستحقها، وهـٰذا من أعظم الظلم والجور؛ لأنه تعطيل لغاية الوجود، وإنكار لأعظم من تفضّل على العبد وجاد، فإنّه ما بالإنسان من نعمة إلا من الله جل وعلا، وحق هـٰذه النعمة أن تشكر، وشكرها بإفراد الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بالعبادة، ولذلك يطلق الله جل وعلا الشكر في عدة مواضع بمعنى العبادة، كقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾( ). فالعبادة حقه الذي لا يجوز أن يُصرف لغيره، حقه لأن الله -جل وعلا- جعل غاية الخلق لذلك، وحقه من جهة أخرى أنه أمدنا بالنعم وأنعم علينا بألوان المنن، وهـٰذا يستوجب أن يفرد بالشكر -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وعلى هـٰذا يكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، وهـٰذا التفسير تفسير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ أي: الأمن المطلق التام، أي: ولهم الهداية التامة.
واعلم أن هـٰذه الآية كما فسرها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظاهرة.
خالف في معنى الظلم في هـٰذه الآية المعتزلة فقالوا: إن الظلم هنا هو المعاصي، فقالوا: إن المعصية تنفي الأمن والاهتداء، وعليه فإن من عصى خرج من الإيمان.
وهـٰذا المعنى مخالف لما فسره النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال شيخ الإسلام رحمه الله- وذكر ذلك الشيخ عبد الرحمـٰن السعدي أيضًا- بأن الظلم هنا نوعان: ظلم أكبر وهو الشرك، ووجوده في سلوك الإنسان وعمله ينفي عنه الأمن والاهتداء، يرتفعان عنه، فإن سلم من الشرك وقارف أنواعًا من المعاصي دون الشرك فله مطلق الأمن والاهتداء، لكنه لا يحصل على الأمن التام والاهتداء التام إلا إن سلم من ظلمه لنفسه وظلمه لغيره. وهـٰذا المعنى صحيح، لكن المراد بالآية هو ما فسرها به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من ارتفاع تمام الأمن والاهتداء، وأن سبب رفع ذلك الشرك بالله.
وهل جرى القرآن على تسمية الشرك بالظلم؟
الجواب: نعم، من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾( )، وور في مواضع أخرى منها قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾( )، ومنه: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ (106)﴾ ( ). فدل ذلك على أن الشرك ظلم كما تقدّم بيانه بتفسير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ﴾ هـٰذا خبر المبتدأ؛ لأنّ قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مبتدأ. ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ و﴿أُولَئِكَ﴾ اسم إشارة، وأتى بالكاف الدالة على البعد لبيان شريف مكانتهم وعظيم منزلتهم، وأنهم لما حققوا هذين الوصفين بلغوا الغاية فيما يستحقون. ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ فالأمن ضد الخوف، وذلك أن الله يؤمِّن أهل التوحيد من أنواع المخاوف في الدنيا والآخرة، فهم آمنون من الخوف في الدنيا لأن قلوبهم معلقة بالله؛ ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما أنه لا يمنع السيئات إلا هو ولا يعطي الحسنات إلا هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وإذا كان العبد ملأ قلبه بهـٰذه المعاني فمم يخاف؟! لا يخاف شيئًا. وهم آمنون كذلك في الآخرة من العذاب؛ لأنهم حققوا غاية الوجود، وأتوا ما يستحقون بسببه الفضل والإنعام من رب العالمين، فهم آمنون من المخاوف في الدنيا، وفي الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نسأل الله أن نكون منهم.
ثم أفادهم وصفًا آخر وأثبت لهم فضلاً زائدًا فقال: ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ والاهتداء هو سلوك الصراط المستقيم، فهم سالكون للصراط المستقيم الذي يحصل به فلاح الدنيا والآخرة.
مناسبة الآية للباب واضحة، وهي بيان فضل التوحيد، وأنه سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة.
ثم قال: (عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من شهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)).)
((من)) شرطية، فعل الشرط قوله: ((شهد أن لا إلـٰه إلا الله)) فهـٰذا هو الشرط، وأما جوابه فقوله: ((أدخله الله الجنة)). هـٰذا الحديث من أجمع الأحاديث التي ذكر فيها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يخرج به العبد من الكفر ويدخل به إلى الإيمان، فقد جمع فيه من العقائد التي هي سبب للفوز في الدنيا وفي الآخرة. بدأ ذلك بأهمها وأعظمها وأشرفها وأعلاها وهو التوحيد فقال: ((من شهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له)) وذكر الشّهادة لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بالإلهية بصيغة الحصر بالنفي والإثبات الذي هو أقوى صيغ الحصر، ثم أكد ذلك بقوله: ((وحده لا شريك له)). أكد النفي والإثبات: فـ((وحده)) تأكيد للإثبات، وتوكيدُ النفي قولُه: ((لا شريك له)).
والشهادة في الأصل تدور على القول والعقد والإظهار والبيان، فـ ((من شهد)) يعني: من اعتقد بقلبه وقال بلسانه وأظهر ذلك، ((أن لا إلـٰه إلا الله)) أي لا معبود إلا الله، فإلـٰه فِعال بمعنى مفعول، ومعناه المعبود المطاع، هـٰذا معنى الإله، أي: لا معبود مطاع إلا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
واعلم أن كلمة (إلـٰه) في لغة العرب اسم لما عبد بحق أو باطل، ولذا معبودات الكفار تسمى آلهة: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾( ) فسماه الله –عز وجل-: إلهًا، هـٰذا الأصل في الإله، الأصل في الإلـٰه اسم جنس لما يُعبد بحق أو باطل، لكن غلب استعماله على الإلـٰه الحق، وعرفنا معنى الإلـٰه هو أنه المعبود المطاع -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وفسره الشيخ في عدة مواضع بتعريفات متنوعة تدور على معنى واحد، فقال: (الإلـٰه الذي يقصد بالعبادة.) هـٰذا تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الرد على من فسر الإلـٰه بأنه القادر المخترع:
فسره جماعة من أهل العلم بأنه المخترع أو الصانع أو القادر على الخلق، وهـٰذا التفسير تفسير مبتدع ترده اللغة ويرده القرآن والسنة. وإنما قدمتُ باللغة -وإن كان الحق في مثل هـٰذه الألفاظ ألا ينظر فيها إلى اللغة، وإنما ينظر فيها بالقرآن والسنة- وذلك أنهم احتجوا باللغة، قالوا: هـٰذا معناه في اللغة.
والصحيح أن ليس في كلام أهل اللغة أن الإلـٰه هو المخترع ولا القادر والصانع، وإنما هو المعبود، ويمكن مراجعة المعاجم، وما نقلوه عن أهل اللغة إنما هو باطل، ولم يُنقل عن أحد من سلف الأمة أنه فسر الإلـٰه بهـٰذا المعنى، وهل هـٰذا أمر سهل حتى يغفل عنه السلف؟ هـٰذا أمر يتعلق بكلمة الإسلام وكلمة التقوى وأصل الدين ومفتاح الجنة، فلو كان ذلك صحيحًا لبُين، لكن لم ينقل عن أحد منهم هـٰذا المعنى.
ثم إن تفسير (الإلـٰه) بالخالق أو بالصانع أو القادر هو تفسير باللازم، ونحن لا نعارض أن من لوازم هـٰذا الوصف أن يكون خالقًا قادرًا صانعًا، لكن قَصْر هـٰذه الكلمة الجليلة على هـٰذا المعنى غلطٌ. هـٰذا الوجه الثالث.
الوجه الرابع: أنه لا خلاف بين الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبين من عارضه من المشركين على أنه لا قادر على الصنع ولا خالق إلا الله جل وعلا،لم تكن الخصومة بين النّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبين قومه في هـٰذا الأمر، بل الخصومة كانت في العبادة لا في الخلق، ولو كان معنى لا إلـٰه إلا الله أي لا صانع ولا قادر على الاختراع إلا الله لما عارضه معارض.
هـٰذه أربعة أوجه يجاب بها على من قال: إن الإلـٰه هو الصانع أو الخالق أو القادر.
ثم اعلم أن هـٰذه الكلمة (لا إلـٰه إلا الله) جملة تامة، والجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، هـٰذه الجملة اسمية، إذا قلنا: إنها اسمية فلا بد لها من ركني الجملة المبتدأ والخبر، هـٰذه الجملة دخل عليها حرف النفي (لا) فنصب (إلـٰه) اسمًا له، فـ(لا إلـٰه): (لا) نافية، (إلـٰه) اسم (لا) التي تعمل عمل إن مبني على الفتح، (إلا الله) لفظ الجلالة بدلٌ - هـٰذا أصح ما قيل فيه، بدل- عن الخبر، ولا يصح أن تقع خبرًا؛ لأن من شرط إعمال لا أن تعمل في النكرات، ولفظ الجلالة (الله) أعرفُ المعارف، ولذلك احتاجوا إلى تقدير خبر (لا)، وأصح ما قيل في تقدير الخبر أنه حق: لا إلـٰه حقٌّ إلا الله. ودليل هـٰذا التقدير هو قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾( )، ﴿فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ﴾( ). فالله عز وجل وصف نفسه بالحق، وهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الحق وغيره باطل.
ومن العلماء من قدره بموجود، قال: لا إلـٰه موجود. لكن هـٰذا التقدير غلط، غلطٌ من جهة المعنى وغلطٌ من حيث الواقع: أما غلطه من جهة المعنى فأنه يلزم أن يكون كل إلـٰه موجود هو الله وأنه حق، فتقدير موجود غلط من حيث المعنى ومن حيث الواقع.
بعض العلماء قال: لا داعي للتقدير. ولكن هـٰذا قول من لا يعرف اللغة العربية؛ لأنه لا بد للجملة من خبر، ولا يصلح أن يكون لفظ الجلالة الذي بعد أداة الاستثناء خبرًا، فأصح ما يقال أن خبرها حق، ودليله: ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ...﴾، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحق...﴾؛ لأن هـٰذا الباب تكررت فيه هـٰذه الكلمة، ومن المهم أن نعرف معناها؛ لأنها أصل التوحيد، ولأنها مفتاح الجنة، فلا بد أن يعرف الإنسان معنى هـٰذه الكلمة، وليصحح أيضًا المفاهيم الخاطئة في تفسيرها وأنه لا قادر على الاختراع ولا صانع إلا الله عز وجل.
نعود للحديث: ((من شهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له)). لا شريك له في إلهيته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولا فيما يجب له من العبادة، ولا فيما هو متصف به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولا فيما يجوز ولا فيما يمتنع ولا فيما يجب، كل هـٰذا داخل في قوله: ((لا شريك له)).
((وأن محمدًا عبده ورسوله)). عبدُ مَنْ؟ الضمير يعود إلى الله، ووصفه بهذين الوصفين اللذين هما أعظم ما وُصف به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: العبودية والرسالة، والشهادة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة مقترنة بالشهادة لله بالإلهية، وذلك أن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو المبلِّغ عن الله، وهو الداعي إلى هـٰذه الجملة وإلى هـٰذه الشهادة، فلا طريق إلى تحقيق شهادة أن لا إلـٰه إلا الله إلا بالشهادة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة.
ثم قال: ((وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه)). أطال في عيسى، وذلك لأن عيسى ضلت فيه أمتان عظيمتان: اليهود والنصارى، فبين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يجب اعتقاده فيه؛ ليسلم أهل الإسلام من هاتين الضلالتين: ضلالة اليهود وضلالة النصارى، فقال: ((وأن عيسى عبد الله)). وفي هـٰذا رد على النصارى الذين قالوا: هو الله - تعالى الله عما يقولون علوّاً كبيرًا - وجعلوه ولدًا لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. ((وأن عيسى عبد الله)). فهو عبده ورسوله، أي: أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل. وفي قوله: ((ورسوله)) ردّ على اليهود الذين قالوا: إنه ابن زانية - نعوذ بالله - وليس برسول وهموا بقتله.
ثم بيَّن ما اختص به عيسى عن غيره من الرسل، فقوله: ((وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه)). هـٰذا أمر اختص به عيسى عن غيره من الرسل بل ومن البشر، فإن عيسى عليه السلام اختص بأن كان خلقه بكلمة الله، وأنه روح منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- .
فنقف عند قوله: ((وكلمته)) ثم قوله: ((وروح منه)). قوله: ((وكلمته)). الضمير يعود على من؟ يعود على الله عز وجل، وأصح ما قيل في معنى هـٰذه اللفظة: أنه خلق بكلمة الله. وهـٰذا المعنى رجحه ابن كثير، وهو أوضح المعاني، وقد صرح الله –عز وجل- بذلك في مواضع عديدة في كتابه:
فقال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (59)﴾( ). فبين الله أن خلق عيسى كان بالكلمة. ومن ذلك قوله: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (35)﴾.( ) هـٰذه ثلاثة مواضع بيَّن الله فيها معنى الكلمة، وهي قوله جل وعلا في خلق عيسى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. والمعاني الأخرى من أراد أن يرجع إليها في التفسير، لكن هـٰذا أصح ما قيل في معنى ((وكلمته)).
و((أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ)). أي انتهت كلمته إلى مريم؛ لأنها محل هـٰذه الكلمة فعلاً، وأما الكلمة التي هي (كن فيكون) فهي وصفه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- .
وقوله: ((وروح منه)) هـٰذا أيضًا فيه بيان ما اختص به عيسى من أنه كان بنفخ الروح، فإن الله أرسل الروح القدس جبريل فتمثل لها بشرًا سويّاً وبشرها بالكلمة ونفخ فيها، فكان عيسى من نفخ الروح ومن قول الله: كن فيكون، ولذا تميز في هـٰذا الحديث بأن وصف بأنه كلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه.
وأما قوله: ((وروح منه)) فإن النصارى احتجوا على أنه بعض الله بأن (مِنْ) هنا للتبعيض. وهـٰذا غلط لم يقل به أحد من أهل الإسلام، فإن من هنا ابتدائية، وهي نظير قول الله جل وعلا: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾( ). فهل ما في السمٰوات وما في الأرض جزء من الله؟ تعالى الله عما يقولون علوّاً كبيرًا، ولم يقل أحد بهـٰذا المعنى. ففهم من هـٰذا أن قوله: ((وروح منه)) أنها روح مبتدأة منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كسائر الأرواح.
ثم قال: ((والجنة حق، والنار حق)). أي: شهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق، ومقتضى هاتين الشهادتين أن يعتقد أن هاتين الدارين دارا الجزاء في الآخرة، وأن الناس صائرون إليهما: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.( ) والجنة هي اسم لدار النعيم الكامل المطلق أعدها الله لعباده الصالحين، والنار هي دار العذاب الكامل المطلق أعدّها الله للكافرين والمعاندين، ومقتضى الشهادة أن النار حق والجنة حق أن يعتقد أنهما موجودتان الآن، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، ذلك أن وجود الجنة والنار أمر معلوم بالاضطرار من نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا شواذ من المبتدعة حكَّموا عقولهم وقالوا: الحكمة تقتضي أن لا تكون الجنة والنار موجودتين.
ثم قال: ((أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). هـٰذا جواب الشرط، أدخله الله الجنة التي قلنا: إنها دار النعيم المطلق الكامل، أدخله الله الجنة إذا وفى بهـٰذه الأمور الخمسة، وكلها مما يتعلق بالاعتقاد الذي يترتب عليه العمل، فإن قوله: ((من شهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق)) هـٰذه الأمور الخمسة كلها من أصول الاعتقاد التي تتعلق بالله وبرسله وباليوم الآخر.
وما لم يذكر في هـٰذا الحديث فإنه يدخل في مضامين هـٰذه الأمور، فإن الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بأن محمدًا رسول الله؛ لأن الرسول لا يكون رسولاً إلا ببلاغ من الملائكة الذين هم الواسطة بين الرّسل وبين الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. المهم أن هـٰذه الأصول يرجع إليها ما لم يذكر من أصول الاعتقاد والدين، فمن أتى بهـٰذه الأصول ووفى بها وحقق الشرط الذي ذكره رسول الله فإنه موعود بقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)).
وقوله: ((على ما كان من العمل)) أي: وإن قل. وقال بعض أهل العلم: وإن قبح. والمعنيان صحيحان: فإن قل عمله وأتى بأصول الدين فإنه يدخل الجنة، ومن قبح عمله بمخالفة الواجبات وارتكاب المنهيات فإنه يدخل الجنة في نهاية المطاف، فإن الله حرم على النار من قال: لا إلـٰه إلا الله، فالنار ليست دارًا للموحدين، بل أهل التوحيد سالمون منها ابتداءً أو بعد حين، لكن القرار لا يكون للموحدين في النار كما دلّت على ذلك النصوص الكثيرة، وسوف يأتي شيء منها فيما نستقبل، إذًا قوله: ((على ما كان من العمل)) معناه: إن قل وإن قبح.
وقال بعض العلماء: ((أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). يعني: أن منزلته في الجنة تكون على قدر عمله، فليس المراد بدخول الجنة على ما كان من العمل أنه يدخل وإن كان عمله قليلاً، إنما المراد أن منازل الناس في الجنة على ما كانوا عليه من العمل في الدنيا، وهـٰذا المعنى أشار إليه بعض الشراح، وهو معنى صحيح ولكنه لا يخالف المعاني المتقدّمة، هم أتوا به لينفكوا عن المعنيين السابقين، ولكنِ المعنيان السابقان صحيحان، وأنه يدخل الجنة الموحد وإن قل عمله وإن قبح، ما لم يترك ما لا يصح الإسلام والإيمان إلا به: كالصلاة مثلاً، فإنه لا يستدل بهـٰذا مستدل ويقول: إن ترك الصلاة ليس بكفر؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من شهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). نقول: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذا لم يكن هناك مانع يمنع من دخول الجنة كترك الصلاة، فإن ترك الصلاة يمنع من دخول الجنة؛ لأن تارك الصلاة كافر، كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكما أجمع عليه الصحابة.
كذلك لو أتى بمكفر غير هـٰذه الأمور، وفى بهـٰذه الأمور، يعني: شهد أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله... إلى آخر ما ذُكر، ولكنه سب الله مثلاً فإنه يكفر إن لم يتب، أو سب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو لم يؤمن بشيء جاء به رسول الله، لا شك أنّ هـٰذه الأمور لا تحصل إلا من نواقص في الشهادة المتقدمة.
لكن نقول: إنّ هـٰذه الأمور المذكورة هي سبب دخول الجنة، فإن وجد مانع لدخول الجنة غير ما وجد فإنه يمنع، ولا تعارض بين تلك الأحاديث التي تفيد الموانع وبين هـٰذا الحديث الذي يفيد سبب دخول الجنة أو شروط دخول الجنة؛ لأن الحكم في الدنيا وفي الآخرة لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع: لا بد فيه من توافر الشروط يعني وجودها، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع حتى يثبت الحكم، والشاهد من هـٰذا الحديث لهـٰذا الباب قوله: ((أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) بعد ذكره أصول الاعتقاد والتوحيد.
وهـٰذا الحديث يفيدنا فائدة مهمة: أنه لا يكفي في حصول الوعد بدخول الجنة قول: لا إلـٰه إلا الله، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك ما دلت النصوص على اشتراطه لدخول الجنة، وقد أحسن المؤلف - رحمه الله وغفر له- حيث بدأ في ذكر الأحاديث التي فيها أن من قال: لا إلـٰه إلا الله دخل الجنة بهـٰذا الحديث؛ لأنّ هـٰذا الحديث لم يقتصر فقط على قول: (لا إلـٰه إلا الله) بل أضاف إلى ذلك أمورًا أخرى، فدل ذلك على أن الأحاديث المطلقة التي فيها ((من قال: لا إلـٰه إلا الله دخل الجنة)) يضاف لها ما جاء في النصوص الأخرى حتى يحصل الإيمان التام بما أخبر به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أما من أعمل بعض النصوص دون بعض فإنه يخشى أن يكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض.
ثم قال رحمه الله: (أخرجاه) أي: البخاري ومسلم.
قال: (ولهما) أي البخاري ومسلم (في حديث عتبان) أي ابن مالك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((فإن الله حرم على النار من قال: لا إلـٰه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.)) الحديث.
((حرم)) أي: منع وحظر على النار. ((من قال: لا إلـٰه إلا الله)). ((مَنْ)) هنا موصولة بمعنى الذي. ((قال: لا إلـٰه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)). أي: يريد ويطلب ويقصد بهـٰذا القول وجه الله تعالى.
وهـٰذا الحديث فيه فضل (لا إلـٰه إلا الله)، وأن قولها ابتغاء وجه الله سبب للتحريم على النار، والنار هي نار العذاب التي أعدها الله للكفّار والمكذّبين، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- حرم على النار من قال: (لا إلـٰه إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله، فأفاد هـٰذا الحديث أنه لا يكفي مجرد القول بل لا بد من عمل القلب، فإن قوله: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله)) هـٰذا يفيد قول اللسان، وأضاف إليه قيدًا آخر وهو قوله: ((يبتغي بذلك وجه الله)) وهـٰذا عمل قلبي. ويمكن أن نقول: إن قوله: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله)) يشمل قول القلب وقول اللسان؛ لأن القلب له قول واللسان له قول، فلا يكفي قول اللّسان مجردًا عن قول القلب وعمله، فأشار الحديث إلى اشتراط قول القلب وقول اللسان وعمل القلب.
قول القلب واللسان من قوله: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله)). ومعلوم أن هـٰذا القول لا يترتب عليه الفضل المذكور وهو تحريم النار إلا إذا كان قولاً صادقًا ، وإلا فإن المنافقين يقولون: لا إلـٰه إلا الله، وهم في الدرك الأسفل من النار، فلم يغنهم قولهم: لا إلـٰه إلا الله لما تخلفت قلوبهم عن قولها.
واعلم أن كل فضل رتبه الله -عز وجل- أو رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على القول فإنه لا يكفي فيه قول اللسان، وهـٰذه قاعدة مهمة: كل فضل رتّبه الله -عز وجل- أو رسوله على قول اللسان لا يكفي في حصوله التلفظ فقط، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك قول القلب وعمله، ولذلك سيد الاستغفار مثلاً الفضل المترتب عليه هل يحصل بمجرد التلفظ به دون عقل معناه ودون العمل بمقتضاه؟ الجواب: لا. التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات ما رُتب عليه من فضل هل يكفي لتحصيله أن يتكلم بها الإنسان غافلاً عن معناها؟ الجواب: لا. فإنّ الفضائل المعلّقة على الأقوال لابد أن توافقها الأفئدة قولاً وعملاً.
وهـٰذا الحديث صريح في اشتراط عمل القلب في قوله: ((يبتغي بذلك وجه الله)). والابتغاء والقصد عمل من أعمال القلوب، والحديث فيه إثبات الوجه لله تعالى حيث أضاف الوجه إليه، وأوَّله بعضهم فقال: يبتغي بذلك جهة الله, وهـٰذا خلافُ ظاهرِ اللفظ، فظاهرُ اللفظ إثبات الوجه لله عز وجل، وهو صفة لائقة به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- دل عليها الكتاب والسنة: السنة في هـٰذا الحديث، والكتاب في مثل قوله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (27)﴾( ). هنا ما يمكن يقولون: إن الوصف يعود إلى الرب؛ لأن ﴿ذُو﴾ عائد إلى الوجه. المهم أن إثبات الوجه لله -عز وجل- ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
وسبب سياق هـٰذا الحديث في هـٰذا الباب فضل التوحيد، فإن من قال: (لا إلـٰه إلا الله) حرمه الله على النار.
وانظر حسن تصنيف المؤلف: فالحديث الأول ذكر أن قول: (لا إلـٰه إلا الله) سبب لدخول الجنة، وفي الثاني أن قول: (لا إلـٰه إلا الله) سبب للتحريم على النار، وكلاهما فضل من رب العالمين. والتحريم هو المنع، والأصل فيه المنع الكلي فإن من حقق هـٰذا فإنه يمنع منعًا كليّاً من النار، وهـٰذا يبين فضيلة التوحيد وأنه سبب للنجاة من النار.
ثم قال: (وعن أبي سعيد الخدري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((قال موسى: يارب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به؟)).) هـٰذا فيه خبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن موسى -عليه السلام- أنه قال: ((يا رب)). يدعو الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ((علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به؟)). أذكرك وأدعوك هـٰذا عطف، فهل العطف هنا للمغايرة؟ الأصل في العطف أنه للمغايرة، لكن هنا عطف في الحقيقة ليس مغايرًا بل هو عطف خاص على عام، الذكر عام والدعاء من الذكر الخاص، فالذكر يشمل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ويشمل حتى الصلاة –يعني: الأفعال- ويشمل الدعاء ويشمل قراءة القرآن ويشمل تعليم العلم، كل هـٰذا يدخل في ذكر الله، وتعلم العلم كله من ذكر الله، لكن قوله: ((وأدعوك به)) هـٰذا ذكر، شيء خاص من الذكر، فهو من باب عطف الخاص على العام. ((وأدعوك به)) الباء هنا للتوسل، يعني: من خلاله أو بسببه وعن طريقه.
((قال)) من القائل؟ قال الله تعالى معلمًا موسى: ((يا موسى قل: لا إلـٰه إلا الله)). علمه هـٰذه الكلمة العظيمة، ((فقال:)) القائل موسى عليه السلام ((يا رب كل عبادك يقولون هـٰذا)). والمقصود بعبادك هنا العبودية الخاصة، ليست العبودية العامة، المقصود عباده المؤمنون، أي: كل عبادك المؤمنين يقولون هـٰذا، فهو أراد شيئًا يختص به دون غيره من المؤمنين، وليس المراد أن جميع العباد مؤمنهم وكافرهم يقولون هـٰذا؛ لأنه معلوم أن فرعون وقومه ما أقروا بهـٰذا، فالخبر عن عباده المؤمنين وهم الذين آمنوا بموسى، فأراد موسى عليه السلام أن يختص بشيء دون سائر عباد الله في هـٰذا الوقت. ((قال: يا موسى، لو أن السمٰوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إلـٰه إلا الله في كفة، مالت بهن لا إلـٰه الله)). هـٰذا فيه بيان فضل هـٰذه الكلمة، وأنه وإن كان الكل يقولها فإن ذلك لا يقلل من قدرها وعظيم مكانتها، ولا شك، فإن لا إلـٰه إلا الله أعظم كلمة: هي مفتاح الجنة، وبها يدخل الإنسان إلى الإسلام في الدنيا، وفضائلها وخيراتها كثيرة، ومن فضلها ما ذكره الله في هـٰذا الحديث: ((لو أن السمٰوات السبع وعامرهن غيري)) السمٰوات السبع، السمٰوات معروفة، والسبع هـٰذا عددها، والمراد بالسمٰوات هنا السقف المحفوظ، وقوله: ((وعامرهن)) أي ساكنهن، وقوله: ((غيري)) أي سواي، والاستثناء هنا استثناء منقطع؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ليس في السمٰوات ظرفًا له جل وعلا، بل هو على السماء، فيقال: إن الاستثناء هنا منقطع، ويكون المعنى: وعامرهن غيري يعني سواي، فيكون الاستثناء منقطعاً. ويمكن أن يقال: إن هـٰذا كقوله: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء﴾.( ) وتبينه الآيات والأحاديث الأخرى التي تفيد أنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على السماء وليست السماء ظرفًا له، على أن بعض أهل العلم ضعف هـٰذا الحديث لضعفٍ في رواته، وعلى كل حال على القول بتصحيحه كما ذهب إلى ذلك ابن حجر فإن الحديث معناه لا إشكال فيه، يكون معنى قوله: ((وعامرهن غيري)) كقوله سبحانه: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء﴾. ومعلوم أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، وهـٰذا لا إشكال فيه كما تقدم تقريره. ((والأرضين السبع)). هـٰذه المخلوقات العظيمة ((في كفة)) من كفتي الميزان، ((ولا إلـٰه إلا الله في كفة مالت بهن لا إلـٰه إلا الله)). أي رجحت بهن لا إلـٰه إلا الله، ولا يكون ذلك إلا لعظيم ثقل هـٰذه الكلمة. وقد جاء نظير هـٰذا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن نوحًا عليه السلام قال لابنه: ((آمرك بلا إلـٰه إلا الله، فإنه لو كانت السمٰوات السبع والأرضون السبع في كفة ولا إلـٰه إلا الله في كفة لمالت بهن لا إلـٰه إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مبهمة لفصمتهن لا إلـٰه إلا الله)). ( ) وهـٰذا يدل على عظيم تأثير هـٰذه الكلمة ثقلاً ونفوذًا، فإنها كلمة عظيمة. ويدلّ لذلك أيضًا حديث صاحب البطاقة عند الترمذي وغيره بسند جيد: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر عن رجل ينادى فيقال له: هل لك من حسنة. بعد أن تعرض عليه سيئاته، فيخاف، فيقول: لا، فيقول الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: إنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتب عليه لا إلـٰه إلا الله، فيقول: ما هـٰذه البطاقة في تلك السجلات، فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات.. وهـٰذه البطاقة يقول ابن القيم رحمه الله: هي لكل موحد، لكن رجحانها بالسجلات المقابلة هـٰذا لا يكون لكل أحد، إنما يكون على قدر ما يقوم في قلب العبد من التّعظيم والإجلال والعمل بمقتضى هـٰذه الكلمة.
(رواه ابن حبان، والحاكم وصححه.
وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((قال الله تعالى.)))
هـٰذا الحديث حديث إلـٰهي، حديث قدسي يرويه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربه جل وعلا، والحديث الإلهي هو ما رواه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الله -عز وجل- معنىً ولفظًا، هـٰذا هو الأصل، ومن قال: إنه ما رواه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربه معنىً دون لفظه يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قال الله)) الأصل أن يكون القول باللفظ والمعنى، وهـٰذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الموافق لظاهر اللفظ.
قال الله تعالى: ((يا ابن آدم)) خطاب لجنس الإنسان وهم بنو آدم ((لو أتيتي بقُراب الأرض خطايا)) ويصح: بقِراب، والمقصود ما يقارب ملء الأرض، خطايا جمع خطيئة، وهي ترك الواجب أو فعل المحرم. ((ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً)) يعني لا شركاً أصغر ولا أكبر ((لأتيتك)) هـٰذا جواب الشرط ((لأتيتك بقرابها)) أي: بملئها ((مغفرة)). وهـٰذا بيان عظيم فضل التوحيد: فهـٰذا رجل يأتي بقراب الأرض خطايا أو ما يقارب ملء الأرض خطايا، لكنه يأتي موحّدًا لم يقع في شيء من الشرك دقيقه وجليله صغيره وكبيره، فهو موعود بهـٰذا الفضل: ((لأتيتك بقرابها مغفرة)) أي: تتلاشى معها تلك الخطايا والذنوب، هـٰذا معنى قوله: ((لأتيتك بقرابها مغفرة)) أي تمحو تلك الخطايا والذنوب. ولكن لا بد من تقييدٍ هنا: أن الخطايا الأصل فيها أن تكون في حق الله، أما ما كان في حق المخلوق كما تقدم فقد يتحمله الله عن العبد وقد يؤاخذ به، فالكلام في الخطايا التي في حقه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ، والحديث ظاهر المناسبة بالنسبة لما ساقه المؤلف من أجله في هـٰذا الباب.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: سعة فضل الله.
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله.
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.
الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
[الشرح]
وهي: شهادة ((لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق))
[المتن]
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: (لا إلـٰه إلا الله)، وتبين لك خطأ المغرورين.
[الشرح]
وأنه لا يكفي مجرّد القول، بل لا بد من أن يضاف إلى ذلك ما أضافته النصوص كما تقدّم بيانه في الشرح.
[المتن]
السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
[الشرح]
وهو: ((يبتغي بذلك وجه الله)).
[المتن]
الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل (لا إلـٰه إلا الله).
[الشرح]
لاحتمال أن موسى عليه السلام لم يتفطن لفضلها؛ لأنه قال: ((كل عبادك يقولون هـٰذا))، ويحتمل –ما ذكرته في الشرح- أنه أراد شيئاً يختص به، وعندي أن الثاني أقرب وأليق لمقام موسى عليه السلام، وهو أنه طلب من الله عز وجل ما يختص به، لا أنه لم يتبين له فضل لا إلـٰه إلا الله وهو الذي دعا إليها وصبر في الدعوة إليها.
[المتن]
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه.
[الشرح]
لأنه يقتصر في قولها على اللسان، ولا يأتي ببقية الأركان، وما جُعل في هـٰذه الكلمة من معان.
[المتن]
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسمٰوات.
[الشرح]
هـٰذه جاءت في القرآن في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾( )
[المتن]
الحادية عشرة: أن لهن عمارًا.
الثانية عشرة: إثبات الصفات، خلافًا للمعطلة.
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس، عرفت أن قوله في حديث عتبان: ((فإن الله حرم على النار من قال: لا إلـٰه إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله)) أن ترك الشرك، ليس قولها باللسان.
[الشرح]
لأن المنافقين يقولونها، ولكنها لا تفيدهم، فهم في الدرك الأسفل من النار.
[المتن]
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
[الشرح]
لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر بأنه عبد الله ورسوله، ونهى عن الغلو فيه، وطلب له في الحديث الشهادة له بالعبودية والرسالة، ولعيسى بهذين الأمرين أيضًا، ثم ذكر ما اختص به عيسى عليه السلام.
[المتن]
السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه.
السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
الثامنة عشرة: معرفة قوله: ((على ما كان من العمل)).
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.
[الشرح]
هـٰذا واضح في حديث موسى عليه السلام، وفيه: ((لو أن السمٰوات السّبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إلـٰه إلا الله في كفة، مالت بهن لا إلـٰه الله)) وفيه رد على من قال: إن المراد بالميزان هو العدل مثل المعتزلة، نقول: إن العدل أمر زائد يثبت من المعنى، لكن المراد بالميزان ما أخبر الله به من الميزان الحقيقي، أما صفته وكيفيته فالله أعلم به، له كفتان كما دلت عليه الأحاديث.
[المتن]
العشرون: معرفة ذكر الوجه.
[الشرح]
أي لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثالث
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾( )، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾( ).
عن حصين بن عبد الرحمـٰن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لُدِغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حُمَة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: ((عرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هـٰذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هـٰذه أمتك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله)). فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبروه، فقال: ((هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون)). فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: ((أنت منهم)). ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: ((سبقك بها عكاشة)).
[الشرح]
قال المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد: (باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب).
قوله رحمه الله: (من حقق). (من) شرطية و(حقق) فعل الشرط، و(حقق) أي: بلغ درجة اليقين، فالتحقيق في اللغة هو بلوغ اليقين، وهو من حَقَّ، وهـٰذه المادة مادة - حَقَّ - تدور على إثبات الشيء وصحته، جميع المعاني المشتقة من هذين الأصلين: الحاء والقاف تدور على إثبات الشيء وصحته، والمراد هنا مَن كمَّل التوحيد وبلغ فيه درجة اليقين، وذلك لا يكون إلا بأن لا يبقى في قلبه شيء لغير الله أصلاً، بل يبقى قلبه مواليًا لربه جل وعلا في كل شيء: يحب ما أحبه ويبغض ما أبغضه، يتّبع أمره ويترك ما نهى عنه، فهو دائر مع أمر الله ونهيه، ليس في قلبه ميل إلى غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهـٰذه درجة عالية رفيعة كبيرة يسعى إليها المشمِّرون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال: (من حقّق التوحيد دخل الجنة بغير حساب).
(دخل الجنة) وتقدّم لنا أن الجنة هي دار النعيم الكامل المطلق التي أعدّ الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. (بغير حساب) أي: بغير محاسبة، فيدخل الجنة دون أن يحاسب، بل يدخل بلا حساب، والذين لا يحاسبون في الآخرة صنفان:
هؤلاء الذين سنقرأ وصفهم في خبر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهؤلاء الغاية في السعادة، نسأل الله أن نكون منهم.
والقسم الآخر هم الكفار، فإن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم؛ لأنه لا حسنات لهم، بل هم كما قال الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- : ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾. وكما قال الله تعالى: ﴿فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾. فالله -جل وعلا- لا يقيم لهم حسابًا ولا وزنًا يوم القيامة.
الكلام عن الصنف الأول الذين سيأتي وصفهم، يبقى قسمان من الناس يحاسبون، وسيأتي الكلام عليهما في كلامنا على الحديث إن شاء الله تعالى.
قوله: (وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.)
﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، خليل الرحمـٰن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إبراهيم وصفه الله عز وجل في هـٰذه الآية بصفات عظيمة تبين درجته في التوحيد وفي تحقيقه، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً﴾. والأمة في هـٰذا السياق المراد به الإمامة؛ لأنه كان إمامًا في التقى والتوحيد والإخلاص. ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً﴾ ثم بين سبب إمامته فقال: ﴿قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا﴾، ﴿قانتًا لله﴾ أي: طائعًا له –جل وعلا-، مقبلاً عليه ممتثلاً لأمره، مخلصًا له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فقوله: ﴿لله﴾ لا لغيره، فهـٰذا وصف من الأوصاف التي نال بها إبراهيم عليه السلام الإمامة. الوصف الثاني الذي لا يحصل لأحد الإمامة إلا به، بل لا يحصل الإسلام والإيمان إلا به قوله: ﴿حنيفًا﴾. والحنيف هو المائل عن الضلالة إلى الهدى؛ لأن أصلها من الحنف وهو الميل من الضلالة إلى الهدى.
وبهـٰذا نعلم أنه لا يتحقّق التوحيد لأحد إلا بوصفين:
الوصف الأول: إخلاص العبادة لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
الوصف الثاني: والكفر بغيره جل وعلا، الكفر بالطاغوت كما قال سبحانه: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.( )
وكما ذكرنا لكم سابقًا أن التوحيد لا يقر إلا بهذين الأمرين: النفي والإثبات، وهنا نفي وإثبات، الإثبات في قوله: ﴿قانتًا لله﴾، والنفي في قوله: ﴿حنيفًا﴾ وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ هـٰذا تأكيد لمعنى ما تقدم من كونه مخلصًا حنيفًا، فإنه ليس من المشركين في شيء، لم يكن من المشركين في عبادتهم ولا في أحوالهم ولا في شيء من شؤونهم، ليس من المشركين لا حالاً ولا مآلاً: لا حالاً في هـٰذه الدنيا، فإنه فارقهم أحوج ما يكون إليهم. ولا مآلاً فإنه يفارقهم يوم القيامة، وذلك أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير.
الشاهد من هـٰذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، وبهـٰذا يحصل للعبد تحقيق التوحيد الذي رتّب الله عليه الفضل في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب)، كما سيأتي في حديث حصين بن عبد الرحمـٰن.
الآية الثانية في هـٰذا الباب قوله: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾.( )
وتقدم هـٰذه الآية قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58)﴾ ( ) فوصفهم بأوصاف، من أخص هـٰذه الأوصاف أنهم لا يشركون بربهم، ولم يذكر في هـٰذه الآية المشرَك به: هل هي الأصنام؟ هل هم الصالحون؟ هل هم الأولياء؟ لم يذكر ذلك، السبب: لتعميم كل ما يقع فيه الشرك من الأصنام والأولياء وغيرهم، وهـٰذه الآية أيضًا من الآيات التي تدل على معنى تحقيق التوحيد، وأنه الخلوص من الشرك.
ثم قال رحمه الله -في ذكر الحديث الطويل حديث حصين بن عبد الرحمـٰن-: (كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟). والكوكب المقصود به الشهب التي يرمى بها ، فسأل سعيد بن جبير جلساءه عن الكوكب الذي انقض، فقال حصين بن عبد الرحمـٰن: (فقلت: أنا. أي: أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لك أكن في صلاة ولكني لدغت). وهـٰذا فيه دفع توهم أنه رآه لكونه قائمًا يصلي، فبيّن أنه إنما وقع منه ذلك لهـٰذا السّبب، وهـٰذا فيه خلة وصفة من صفات المخلصين، وهي أنهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فبيّن الواقع لئلا يظن به ما ليس من عمله وفعله.
(ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟). يعني: لما لدغت ما صنعت؟ (قلت: ارتقيت). أي: رقيت نفسي، والرقية هنا ظاهرها أنها طلب من الغير، والرقية هي تعاويذ وسيأتي الكلام عليها في (باب ما جاء من الرقى والتمائم)، المراد أنه قرأ على نفسه كلمات يحصل بها التعوذ. (قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بُريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حُمَة). يعني: لا رقية نافعة، والمقصود بالعين هنا عين الحاسد، (أو حمة): السم وشبهه، سم العقارب والحيات وما أشبه ذلك.
ثم قال له سعيد -لما بَيَّن له ما صنع وما حمله على ذلك الصنع-: (لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع). يعني: من كان نهاية عمله ومنتهى حاله أن يعمل بما بلغه من خبر فقد أحسن. ثم بعد أن أثنى على وقوفه على ما سمع وعمله بما أخذ نقله إلى درجة أعلى، قال: (ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: ((عرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد))).
هـٰذا خبر من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه عرضت عليه الأمم، وقد اختلف أهل العلم في وقت هـٰذا العرض متى كان؟
فمنهم من قال: إن وقت هـٰذا العرض كان في ليلة الإسراء، واستدل لذلك بما رواه الترمذي بسند جيد أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لما أُسري بي عُرضت علي الأمم - أو رأيت الأنبياء -، فرأيت النبي ومعه الرجل...)) إلى آخر الحديث. فيكون هـٰذا العرض حصل ليلة الإسراء بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وقيل: إن هـٰذا العرض حصل منامًا، واستدلوا لذلك بما رواه جابر قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((رأيتُ فيما يرى النائم الأنبياء، فرأيت النبي ومعه الرجل...)). وهـٰذا الحديث يفيد أن العرض كان منامًا، إلا أن هـٰذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفًا فنسقطه من الاعتبار.
يبقى الآن الذي سلم لنا أن هـٰذا العرض حصل متى؟ ليلة الإسراء وكان في مكة، جاءت بعض الأحاديث تفيد أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر بهـٰذا الخبر في المدينة، ففي المسند من حديث ابن عباس بسند جيد أنه قال: أبطأنا عند رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذات ليلة، ثم غدونا عليه صباحًا فقال - وحدّث بالحديث -: ((عرضت علي الأمم)). فاحتار بعض أهل العلم في الجمع بين الحديثين فقالوا: حدث للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إسراءان: إسراء في مكة وإسراء في المدينة. وهـٰذا قول مُطَّرح، والصحيح أن الإسراء لم يتكرر إنما هو في مكة، وأما هـٰذا الذي أخبر به ابن عباس وأيضًا جاء من طريق أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فيفيد أنه حصل هـٰذا العرض ثانية في المدينة، وعليه فيكون هـٰذا العرض الذي أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث حصل مرتين: عرض في مكة ليلة الإسراء، وعرض في المدينة كما في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. ولا مانع من أن يتكرر العرض، وهـٰذا الذي دلت عليه الأحاديث، ونحن تبع لما جاء في الأحاديث؛ لأن الأمر لا مجال فيه للعقل، والحديثان لا يمكن أن يحملا على حادثة واحدة.
فنقول: إن العرض تكرر ولا إشكال في ذلك، وهـٰذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن العرض تكرر مرتين: عرض في مكة ليلة الإسراء، وعرض في المدينة؛ لصحة الأحاديث بالأمرين. قال: ((فرأيت النبي ومعه الرهط)) يعني: الجماعة ((والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد)). أي: لم يتبعه أحد. ((إذ رفع إلي سواد عظيم)). المقصود بالسواد الجمع الكبير، وسمي سوادًا لأنه إذا كثر المجتمعون غلب على جمعهم السواد، فكانوا سوادًا إذا قارنهم الإنسان بالفضاء المجاور لهم. ((فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هـٰذا موسى وقومه))، وفي هـٰذا إشكال: كيف لم يعرف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمته مع أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أخبر بأنه يعرف أمته بالغرة والتحجيل؟ فالجواب على هـٰذا الإشكال أن يقال: يحتمل أن هـٰذا قبل أن يخبر بهـٰذه السمة التي تميز أمته عن غيرها من الأمم، فيكون قوله: ((فظننت أنهم أمتي)) قبل أن يخبره الله بأن أمته تعرف بالغرة والتحجيل، وهـٰذا يرتفع به الإشكال. احتمال آخر يصلح أن يكون جوابًا على هـٰذا الإشكال، وهو أن يقال: إن هـٰذه الميزة التي يعرف أمته بها هي فيما إذا قربوا منه، أما إذا كانوا على هـٰذه الصفة وهـٰذا الحال في البعد فإنه لا يتبين له هـٰذا الوصف. والجواب الأول أقرب، وكلا الجوابين محتمل.
((فقيل لي: هـٰذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم)). وإذا السواد العظيم أعظم من السواد السابق. ((فقيل لي: هـٰذه أمتك)) والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، أي: من أجابه في دعوته. ((ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)). وهـٰذا فيه فضيلة هـٰذه الأمة على غيرها من الأمم، فإنّهم سواد عظيم، وفيهم هـٰذا العدد الكبير ممن قال فيهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب))، وهـٰذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله: ((بغير حساب)) واضح، أي: إنهم لا يحاسبون على أعمالهم، وأما قوله: ((ولا عذاب)) فهـٰذا بيان لأن نفي الحساب لأمنهم من العقوبة، وليس لكونهم كحال أهل الكفر الذين لا يقيم الله -عز وجل- لهم وزنًا، فإنه لا يقيم لهم وزنًا لكونه لا حسنات لهم، وأما هؤلاء فلا حساب لهم لعظيم ما جاؤوا به من التوحيد كما سيتبين إن شاء الله.
قال: (ثم نهض فدخل منزله) أي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم:) أي الصحابة تكلموا في تعيين هؤلاء، (فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً). هـٰذا احتمال آخر (وذكروا أشياء) أي احتمالات أخرى طوى الراوي ذكرها، وإنما اقتصر على أبرز وأهم ما ذكر صحابة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ومن هـٰذا المقطع في هـٰذا الخبر يتبيّن لنا عميق فقه الصحابة، فإنهم جزموا وأيقنوا أن هـٰذا الفضل لا يحصل بلا عمل، بل لا بد من عمل يكون أجره وثوابه هـٰذا المفهوم، ولذلك اختلفوا وخاضوا في صفة المستحِق لهـٰذا الفضل: ما هي صفة هولاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب؟
(فخرج عليهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبروه). أخبروه بما جرى من خوض وكلام وبحث في تعيين هؤلاء، ومن هـٰذا أخذ جماعة من العلماء أنه يجوز الخوض في مسائل العلم ولو لم يتقدم للإنسان فيها علم جازم، إذا كان يراجع ولا يستقل بما يتوصل إليه من نتيجة، فللإنسان أن يبحث ويديم النظر والفكر في مسألة لم يسبق له بها علم، ثم يعرض ما توصل إليه من فكر ونتيجة على من هو أعلم منه؛ ليتبين الصواب من الخطأ، وهـٰذا هو الذي جرى من الصحابة: فإن الصحابة خاضوا في تعيين هؤلاء، وهو خوض بلا علم؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما بيَّن لهم، والمقصود بلا علم أي بلا علم معين، وإلا فهم حرصوا واجتهدوا في تعيين هؤلاء من خلال ما عرفوه من أسباب الفضل والسبق في دين الإسلام. (فأخبروه فقال لهم) أي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((هم الذين لا يسترقون)) أي لا يطلبون الرقية، فالاسترقاء هو طلب الرقية من الغير، وفي رواية لمسلم: ((ولا يرقون)).
نقف أولاً عند قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يسترقون)). يعني: الذين لا يطلبون الرقية. وأشكل هـٰذا على جماعة من أهل العلم: لماذا جعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذا الوصف من موجبات ذلك الفضل، مع أن الرقية جائزة وقد فعلها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بنفسه، وأمر بها في حق غيره؟
فالتمسوا لذلك أجوبة:
فمنهم من قال: إن هـٰذا الوصف يفيد كراهية التداوي بالرّقية، وأن التداوي بالرقية مكروه، وما جاء من فعله أو أمره فهو يدل على الجواز.
وقالوا: إن البخاري أشار إلى ذلك فيما ترجم له حيث قال: باب من لم يرق، يعني من لم يستعمل الرقية، وساق هـٰذا الحديث. هـٰذا احتمال.
وقال بعضهم: ((لا يسترقون)) أي: لا يستعملون الرقى الجاهلية، فالرقية معروفة في الجاهلية، ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الرقى قال: ((اعرضوا علي رقاكم)). فهو أمر معروف قبل الإسلام، فحملوا قوله: ((لا يسترقون)) على ما كان في الجاهلية. هـٰذا احتمال ثانٍ.
احتمال ثالث قالوا: لا يستعملون الرقية قبل وقوعها، أي: قبل وقوع موجبها وهو المرض. هـٰذه أوجه ثلاثة للجواب عن الإشكال، والحقيقة أنه لا يرتفع بها الإشكال:
أما كراهية التداوي: فالتداوي ليس بمكروه، التداوي تجري فيه الأحكام الخمسة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذلك.
أما قولهم بأن المقصود بالرقى هنا الرقى الجاهلية: فليس فيه ما يدل على هـٰذا التقييد، فقوله: ((لا يسترقون)) عام في الرقى الجاهلية وفي غيرها.
وأما قولهم: إن هـٰذا في الرقية قبل نزول المرض، فلا يُسَلَّم هـٰذا؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يرقي نفسه ويعوذ الحسن والحسين، ومن أذكار النوم أن يقرأ الإنسان وينفث في يده ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما استطاع من جسده، وهـٰذا نوع من أنواع الرقية سواء كان مريضًا أو غير مريض، فالرقية مشروعة للرفع والدفع كما سيأتي.
إذاً ما الجواب على هـٰذا الإشكال في قوله: ((لا يسترقون))؟
الجواب: ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- في قوله: "وهو أن الحديث أشار إلى أن من تمام التوكل والتوحيد ترك طلب الدّعاء من الغير، فإن الاسترقاء هو طلب الدعاء من الغير، فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر في وصف هؤلاء أنهم لا يطلبون الدعاء من الغير، أما إذا رقوا أنفسهم فإنهم فعلوا مشروعًا مندوبًا فعله رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكذلك إذا رقوا غيرهم فقد أحسنوا إلى غيرهم، والإحسان قد أمر الله به.
إذًا قوله: ((لا يسترقون)) ما معنى ((لا يسترقون))؟ لا يطلبون الدعاء بالرقية من غيرهم، وهـٰذا أوضح الأجوبة، وهو الذي يتسق مع هـٰذه الأوصاف المذكورة في الحديث.
وأما رواية ((لا يرقون)) التي انفرد بها مسلم فهي رواية ضعيفة شاذة دلت الأحاديث على عدم صحتها.
ثم قال: ((ولا يكتوون)) هـٰذا الوصف الثاني. ((لا يكتوون)) أي: لا يستعملون الكي، سواء بفعل منهم أو بفعل من غيرهم، بطلب أو بغير طلب، وذلك أن الكي فيه إيلام. والكي قد ورد الإذن به، وهو من أسباب العلاج كما جاء ذلك في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن يكن الشفاء في شيء ففي شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار، وأنا لا أكتوي)) فأخبر أنه من طرق العلاج، إلا أنه امتنع منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وذلك لما فيه من الإيلام، وأن ثمرة هـٰذا الكي غير معلومة؛ لأنه لا يعلم حصول الشفاء بالكي، وما كان من الأدوية على هـٰذا النحو فتمام التوكل أن يُترك كما سيأتينا.
إذاً فهمنا من قوله: ((ولا يكتوون)) أن فيه إيلاماً مع عدم التحقق من حصول المقصود.
ثم قال: ((ولا يتطيرون)) التطير سيأتينا باب خاص به، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم.
ثم قال: ((وعلى ربهم يتوكلون)) اختلف العلماء في هـٰذا الوصف الأخير: هل هو وصف يعود على الأوصاف السابقة، فيكون من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الأوصاف السابقة تدور على التوكل؟ أو هو وصف جديد زائد على ما ذكر؟ قولان لأهل العلم، والظاهر أنه وصف جديد؛ لأنه إذا دار الكلام بين أن يكون تأسيسًا أو تأكيدًا فالأصل التأسيس، ونقول: إن التوكل أعم من الصور المذكورة، فإن قوله: ((لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون)) هـٰذه من صور التوكل، ولكن التوكل أوسع من هـٰذا، فالتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المحاب ودفع المضار، وهـٰذا هو الوصف الرابع الذي أوجب لهؤلاء هـٰذا الوصف العظيم، الأوصاف ما هي؟ ((لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون)). وانظر إلى قوله: ((على ربهم يتوكلون)) قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر في التوكل، وأنه على الله وحده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
قال: (فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم) هـٰذا القول للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طلب عكاشة من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يدعو الله أن يجعله منهم، أي: من هؤلاء الذين تقدم وصفهم وأجرهم، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أنت منهم)) وهنا خبر من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأنه منهم، والخبر ليس دعاء، ولكن في رواية البخاري قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اللهم اجعله منهم)) فيكون قد طابق جوابُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سؤالَ عكاشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فسأل الله -عز وجل- أن يكون منهم، ثم أخبر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه منهم، فتكون هـٰذه الرواية قد طوت السؤال وأتت بالخبر أو بالنتيجة، وهو أن عكاشة بن محصن -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- من هؤلاء الذين تقدم وصفهم وأجرهم. (ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((سبقك بها عكاشة))). وهـٰذا رد حسن منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على سؤال هـٰذا الرجل، فإنه لم يقل: لست منهم، ولم يجبه إلى ما سأله، وإنما تخلص بجواب حسن فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((سبقك بها عكاشة)). فإذا سبقه بها فلا مجال إلى تحصيله إياها؛ لأن السبق هو التقدم إلى الشيء قبل الغير، هـٰذا هو السبق، فلما تقدم عكاشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إلى هـٰذا الفضل سبق غيره.
وقد اختلف أهل العلم في سبب اعتذار النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن إجابة هـٰذا السائل. فمنهم من قال: إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجبه سدّاً للذريعة أو سدّاً للباب؛ لأنه لو أجابه لقال آخر: ادع الله أن يجعلني منهم، ثم انفتح الباب وصار كل أحد يسأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يدعو الله أن يجعله منهم، ولا ينتهي الأمر عند حد، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهـٰذا الرجل: ((سبقك بها عكَّاشة)) سدّاً للباب. وهـٰذا جواب لا بأس به.
أجاب آخرون فقالوا: إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما امتنع من إجابة سؤال هـٰذا السائل لأنه كان منافقًا. وهـٰذا الجواب غير سديد؛ وذلك لأنه جاء في بعض الروايات أن السائل سعد بن عبادة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وسعد من كبار الأنصار، وفي رواية أن السائل أحد المهاجرين، وليس في المهاجرين منافق. وعلى كل لو لم تثبت تلك ولا هـٰذه فإن الأصل في الصحابة أنهم عدول، ثم إنه يبعد غاية البعد أن يصدر هـٰذا السؤال من منافق، بل الغالب والقريب أن هـٰذا سؤال مؤمن مصدق وليس سؤال منافق مكذب، فهـٰذا الجواب جواب ظاهر الضّعف؛ لما تقدم.
أجاب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره بأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجب هـٰذا الرجل إلى سؤاله لأنه أوحي إليه أنه لا يجاب إلا في عكاشة، فلما علم أنه لا يجاب إلا في عكاشة قال: ((سبقك بها عكاشة)). وهـٰذا جواب لا بأس به. والذي يظهر أن الجواب الأول هو أولى الأجوبة.
ثم بهـٰذا يكون المؤلف قد انتهى مما في هـٰذا الباب من آثار أو من نصوص، فذكر أولاً آية: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا﴾، ثم ذكر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾. ثم ذكر حديث حصين بن عبد الرحمن. ومناسبة حديث حصين بن عبد الرحمن للباب واضحة: حيث قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيان الذين ((يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب))-: ((هم الذين لايسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون)). وهـٰذه أوصاف تدور على تحقيق التوحيد وتكميله، وألا يكون في قلب العبد شيء غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- .
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
[الشرح]
هـٰذه المسألة أنّ الناس في التوحيد متفاوتون، وليسوا على درجة واحدة: فمنهم من يأتي بأقله، ومنهم من يأتي بغايته، وذلك بتحقيق التوحيد وتكميله وتخليصه من الشوائب والأدران، فالناس في التوحيد على مراتب وليسوا في درجة واحدة، بل هم متفاضلون في التوحيد كما أنهم متفاضلون في الإيمان.
[المتن]
الثانية: ما معنى تحقيقه؟
[الشرح]
تحقيق التوحيد هو تكميله، لئلا يبقى في قلب العبد شيء غير الله تعالى؛ لأن التحقيق هو التثبيت، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قلبه خالصًا له؛ محبة وخوفا ورجاء وخشة وإنابة .. جميع أعمال القلوب، ويكون مواليًا لربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ، قريبًا منه مسارعًا إلى محابه، مبتعدًا عن كل ما يغضبه.
[المتن]
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
[الشرح]
فعلم بذلك أنه لا يحصل تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك.
[المتن]
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
[الشرح]
وذلك في الآية ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾( )
[المتن]
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
[الشرح]
المراد بترك الرقية هنا: ترك طلبها كما تقدم بيانه في الشرح، وترك الكي تقدم أيضا وسيأتي نزيد بيان لهذين.
[المتن]
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
[الشرح]
وهـٰذا من الشيخ -رحمه الله- ترجيح لكون قوله: ((وعلى ربهم يتوكلون)) لأنه من عطف العام على الخاص، وأنها تعود على جميع ما تقدم من الصفات.
[المتن]
السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
[الشرح]
لأنهم خاضوا في تحديد ما يثبت به هـٰذا الفضل.
[المتن]
الثامنة: حرصهم على الخير.
[الشرح]
وجهه أنهم بحثوا وخاضوا وحققوا ثم رجعوا يسألون رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ ليتوصلوا إلى تلك الأوصاف التي توجب ذلك الفضل.
[المتن]
التاسعة: فضيلة هـٰذه الأمّة بالكمية والكيفية.
[الشرح]
الكمية لأنّهم سواد عظيم، والكيفية منهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين صفاتهم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقوله: ((هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون)) فهـٰذا فضل في الكيفية وفضل في الكمية.
[المتن]
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى.
[الشرح]
من حيث الكثرة، وأنه من أكثر الأنبياء تابعًا، وإلا فهم من أعتى الأمم جحودًا واستكبارًا.
[المتن]
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-.
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
[الشرح]
هـٰذا ظاهر فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((عرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط)) ممن تبعه ((والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد)) ثم ذكر أمة موسى، ثم ذكر أمته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فالأمم يوم القيامة تتمايز مع أن الموقف واحد، ولكنهم يتمايزون كل في زمرة من تبع.
[المتن]
الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء.
[الشرح]
لقوله –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: ((رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد)). وهـٰذا من أعجب ما يكون! أن يأتي نبي ليس معه أحد، وهـٰذا مصداق قول الله جل وعلا: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾( ) وقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13)﴾ ( ) وغير ذلك من الآيات التي تدل على قلة الاهتداء في بني آدم.
[المتن]
الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
[الشرح]
وهـٰذا ظاهر في قوله: ((والنبي وليس معه أحد))، وهـٰذا لا ينقص منزلته ولا يقدح في مكانته، ولا يقلل من أجره؛ لأن المطلوب من العبد أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يبين الحق، أما الاستجابة ليست إليه، إنما إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يمن بها على من يشاء،فلا تثريب على الإنسان إذا لم يجب أحد دعوته، فلا يكترث المؤمن بكثرة أو قلة من يجيبه بل يكترث بصحة ما يدعو إليه، فإذا كان الإنسان في دعوته وتبليغه على حق لا يضره ألا يجيبه أحد إلى ما هو عليه.
[المتن]
الخامسة عشرة: ثمرة هـٰذا العلم، وهو عدم الاغتـرار بالكثـرة، وعـدم الزهد في القلة.
[الشرح]
(عدم الاغتـرار بالكثـرة) فتعميه عن الحق، (وعـدم الزهد في القلة) لا يزهد في القلة فيخالف سبيل الهدى لطلب كثرة التابع، فهو يعامل الله رب العالمين -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-؛ لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ومعيار السعادة في معاملة الخلق أن تعامل الله تعالى فيهم لا تعاملهم في الله. ومعنى هـٰذا الكلام: أن ترجو الله في معاملتك لهم، أما هم فلا يقدمون ولا يؤخرون، بل ينظر المؤمن في كل شؤونه في حق الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. وإذا سار الإنسان على هـٰذه الطريقة سلم له عمله، وانشرح له صدره، فلا يكترث بما يلقاه من صدود أو إعراض أو غير ذلك من أذى الخلق بسبب دعوتهم إلى التوحيد.
[المتن]
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة.
السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا). فعُلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
[الشرح]
(قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) هـٰذا فيه بيان أنه لم يأتِ نقصًا ولم يغشَ خطأً، وأما قوله: (ولكن كذا وكذا) هو نقل له من منزلة إلى منزلة أعلى منها، فلم يثرب عليه بل نقله إلى الكمال، ولذلك قال: (فعُلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني)؛ لأن الحديث الأول رخصة وإباحة، أما الثاني ففضيلة وسبق.
[المتن]
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
التاسعة عشرة: قوله: ((أنت منهم)) علم من أعلام النبوة.
الشرح]
لأنه إخبار بأمر غيبي.
[المتن]
العشرون: فضيلة عكاشة.
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض.
الثانية والعشرون: حسن خلقه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الرابع
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب الخوف من الشرك
وقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾.( )
وقال الخليل عليه السلام: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾( ).
وفي الحديث: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)). فسئل عنه فقال: ((الرياء)).
وعن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندّاً دخل النار)). رواه البخاري.
ولمسلم عن جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار)).
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ..﴾ الآية.)
مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: أنه في الباب السابق ذكر تحقيق التوحيد، وفي هـٰذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله الخوف من الشرك، يعني من المناسبة أنه يشير بهـٰذه الترجمة إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يركن إلى كونه قد حقق التوحيد، بل لابد -مع مجاهدته وعمله في تحقيق التوحيد- أن يكون خائفًا وجلاً من الشرك، ويمكن أن يقال أيضا: إنه لا يكون ولا يحصل تحقيق التوحيد إلا بالخوف من الشرك، فيكون لهـٰذه الترجمة مناسبتان.
المناسبة الأولى: ألا يركن الإنسان إلى ما يظنه من تحقيق التوحيد فيقول: إذا حققت التوحيد فقد أمنت من الشرك، بل يجب -مع مجاهدته في تحقيق التوحيد- أن يكون على حذر من الوقوع في الشرك.
المناسبة الثانية: أن من كمال تحقيق التوحيد وتمامه أن يكون الإنسان خائفًا من الشرك وجلاً منه، فإنه إذا كان كذلك سلم له توحيده، وصح له إيمانه.
أما مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد فهي ظاهرة: فإن الخوف من الشرك من أهم ما يكون من ثبوت التوحيد، قال رحمه الله: (باب الخوف).
(الخوف) ضد الأمن، وهو الوجل والخشية.
(من الشرك). و(الشرك) يدل في اللغة على التسوية، وهو في الاصطلاح: تسوية الله بغيره في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات. وأصل الشرك بجميع صوره وأنواعه يرجع إلى أمرين.
الأمر الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق.
والأمر الثاني: التشبّه بالخالق.
وإلى هـٰذين الوصفين يرجع كل شرك في الدنيا، سواء كان شركًا في الرّبوبية أو شركًا في الإلهية أو شركًا في الأسماء والصفات. وقد عاب الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على المشركين شركهم، ووصفه بأنه عدل وتسوية فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾( ) أي: يسوون به غيره، ففهم من هـٰذا أن الشرك الذي وقع فيه هؤلاء مداره على التسوية.
و(الشرك) يقسمه العلماء إلى شرك في الربوبية وشرك في الإلهية وشرك في الأسماء والصفات، وهو يقابل التقسيم الذي تقدم في التوحيد، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات.
أفادت هـٰذه الترجمة أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف من الشرك، وألا يأمن على نفسه منه، وهـٰذا يوجب دوام المراقبة.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب، قال: (وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾( ).)
هـٰذه الآية آية عظيمة، فيها بيان فضل التوحيد وخطورة الشِّرك، فهي توجب للعبد الإقبال على التوحيد وتحقيقه، والخوف من الشرك والتحذير منه. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾. والمغفرة هي الستر والتجاوز إذا أُطلقت، فنفى الله -عز وجل- مغفرة الذنوب والستر على فاعلها والتجاوز عنه في هـٰذه الآية إن كان الفاعل قد قارف شركًا، فإن الشرك غير قابل للمغفرة.
﴿أَنْ﴾ مصدرية ﴿يُشْرَكَ﴾ فعل مضارع هو وأَنْ في تأويل مصدر. تقدير الكلام: إن الله لا يغفر إشراكًا به. وهـٰذا يوجب الخوف، فإذا كان الشرك سببًا لمنع المغفرة فإن الواجب أن يحذر منه وأن يخاف منه، لأنه يحول دون رحمة الله ومغفرته، وفي المقابل: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ يغفر الله -جل وعلا- بالستر والتجاوز ما دون ذلك. ﴿مَا﴾ هنا بمعنى الذي ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ أقل أو سوى، قولان لأهل العلم، فيغفر ما سوى أو ما أقل من ذلك ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ والمشار إليه في قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ الشرك، ولكنه فيما دون الشرك علق المغفرة بالمشيئة فقال: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فعُلم أن المغفرة فيما دون الشرك ليست مطلقة، بل هي معلقة بالمشيئة: إن شاء الله غفر، وإن شاء أخذ. وهـٰذه الآية دالة على عظم جرم الشرك، وأنه من أعظم أسباب منع المغفرة.
لكن ما المراد بالشرك الذي يمنع المغفرة، هل هو الشرك الأصغر أو الأكبر؟ أو الشرك الأصغر والأكبر؟ قولان لأهل العلم:
فمنهم من قال: إن المراد بالشرك في هـٰذه الآية الشرك الأكبر، وجعل هـٰذه الآية نظير قول الله عز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلَّظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾( ) وهـٰذه الآية اتفاق أهل العلم منعقد على أن المراد بالشرك فيها هو الشرك الأكبر، وقال: هـٰذه مثلها، وهـٰذا قول لشيخ الإسلام رحمه الله في موضع.
والقول الثاني: أن الآية تشمل نوعي الشرك: الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فكلاهما لا يغفر؛ لأن أَنْ والفعل الذي دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إشراكًا، إن الله لا يغفر إشراكًا به، وإشراكًا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ومقتضى هـٰذا أن يدخل في الآية كل أنواع الشرك.
وهـٰذا القول الثاني قال به شيخ الإسلام في موضع، وقال به الشيخ عبد الرحمـٰن السعدي رحمه الله في كلام له.
وعلى كل حال الشرك الأصغر أمره عظيم وخطره جليل، وظاهر الآية يشمل الشرك الأصغر، فإن لم يدل الإجماع على أن الشرك الأصغر ليس داخلاً في الآية فالأصل إجراء اللفظ على ما دل عليه من العموم؛ لأن الأصل عدم التخصيص.
لكن هل معنى هـٰذا أن الشرك الأصغر يوجب الخلود في النار؟
الجواب: لا، فإن هـٰذا مما يفارق فيه الشرك الأصغر الشرك الأكبر. الشّرك الأصغر يفارق الشرك الأكبر في أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، وأما الشرك الأصغر فلا يوجب الخلود في النار، هـٰذا فرق.
الفرق الثاني: أن الشرك الأصغر لا يخرج به صاحبه من الإسلام، والشرك الأكبر يخرج به صاحبه من الإسلام.
الفرق الثالث: أن الشرك الأصغر في الوسائل، والشرك الأكبر في المقاصد، يعني: في العبادات.
ولذلك الشرك الأكبر هو صرف أي عبادة لغير الله عز وجل، أن يجعل لله ندّاً بأن تصرف له العبادة.
والشرك الأصغر هو كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر. هـٰذا أفضل ما عرف به الشرك الأصغر أن يقال: هو كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر. هـٰذه ثلاثة فروق، ويأتي من الفروق من إطلاقات الشارع، فإن الشارع استعمل في الدلالة على الشرك الأصغر ألفاظًا تخالف الألفاظ التي استعملها للشرك الأكبر، ويتبين ذلك إن شاء الله تعالى من خلال ما يمر علينا. والصحيح في هـٰذه الآية أنها تشمل النوعين، هـٰذا هو الأصل مالم يدل على خلاف ذلك إجماع.
هـٰذه الآية أفادت أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يغفر الذنوب ما دون الشرك، والمراد بما دون الشرك أي ما سواه وما أقل منه، وأما ما كان مثل الشرك أو أشد منه فإن الله لا يغفره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
هل هناك شيء أشد من الشرك؟ الإلحاد أعظم من الشرك. أنت الآن عندك شخص يعبد الله ويعبد غيره، وآخر لا يعبد الله يقول: ما فيه رب أصلاً، أيهما أعظم كفرًا؟ الذي يثبت الله ويعبد معه غيره أو الذي ينفي الله بالكلية؟ الذي ينفي الله بالكلية، ولذلك كان كفر التعطيل أعظم من كفر الشرك ، فالملحدون أعظم كفرًا وأشد عذابًا من المشركين الذي يعبدون الله ويصرفون العبادة لغيره، فالآية تشمل ما دون الشرك، أما ما كان مثل الشرك في المرتبة -كسائر أنواع الكفر التي دل الكتاب والسنة على أنها كفر- أو كان أعظم كالإلحاد فإنه داخل في الآية في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾. وقال: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي: بقية الذنوب التي دون الشرك، وهي الكبائر.
ثم قال: (وقال الخليل عليه السلام: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾.( ))
الآية الثانية هي من قول إبراهيم -عليه السلام- في قوله: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾( ) فسأل إبراهيم الله أن يجنبه عبادة الأصنام. ﴿وَاْجُنْبِنِي﴾ أي: باعد بيني وبين عبادة الأصنام، وذلك بأن تكون عبادة الأصنام في جانب وأنا في جانب. ﴿وَبَنِيَّ﴾ قيل في المراد بهم قولان: الأول: أنهم بنوه لصلبه، وهم إسماعيل وإسحاق، وقيل: هم ذريته. وعلى القول الثاني هل يكون قد أجاب الله دعاء إبراهيم؟ لا؛ لأن قريشاً من ذريته وقد وقعوا في الشرك، والظاهر في قوله: ﴿وَبَنِيَّ﴾ أنهم بنوه لصلبه، أو بنوه الذين أدركهم، سواء المباشرون أو من تفرعوا عنهم.
ثم قال: ﴿أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾ ويشمل هـٰذا العبادة بأنواعها، وذلك بصرف أي نوع من أنواع العبادة، والأصنام جمع صنم، والصنم قيل: هو الجثة -من شجر أو حجر أو خشب أو غير ذلك- التي تُعبد من دون الله. وقيل: إنه كل ما عبد من دون الله. وقيل: هو ما صرف عن الله. وكل هـٰذه المعاني متقاربة، لكن أشملها أن يقال: الصنم كل ما عُبد من دون الله، لكن في الغالب أن يطلق ذلك على ما كان له هيئة وصورة من حجر أو شجر أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.
ثم قال المؤلف (في الحديث: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)). فسئل عنه فقال: ((الرياء)).)
هـٰذا الحديث أتى به المؤلف -رحمه الله- لبيان أن خوف الشرك لا يكون فقط على من ضعُف إيمانه وقلّ يقينه، بل يجب أن يخاف الشرك كل أحد، فإذا كان إمام الموحدين إبراهيم -عليه السلام- خافه على نفسه وعلى ذريته فغيره أحقّ بهـٰذا الخوف؛ لهـٰذا قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)). يعني: أشد ما أخاف عليكم من الأمور الشرك الأصغر، وذلك أن الشرك الأصغر يخفى كثيرًا ولا يتنبّه له الإنسان، كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في الليلة الظلماء)). وهـٰذا خفي جدّاً يعسر إدراكه ويصعب تبينه، ولا يمكن أن يتوقى منه الإنسان إلا بشدة الحذر ودوام المراقبة وكثرة الاستغفار والاستعاذة بالله من الشرك، ولذلك لما سأل أبو بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن سبيل النجاة من هـٰذا الشرك الدقيق الخفي قال: ((أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم)).
وقد فسّر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشرك الأصغر في هـٰذا الحديث بـ((الرياء)).
والرياء: هو أن يعمل العمل لأجل أن يُرى، لا طلبًا لما عند الله عز وجل وطلبًا لمرضاته وابتغاء لوجهه، إنما لأجل أن يراه الرائي، وتفسير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للشرك الأصغر بـ((الرياء)) هو تفسير بالمثال، وإنما ذكر الرياء دون غيره من الشرك الأصغر لأنه أخطرها وأكثرها انتشارًا وأقلها تنبّهًا، فإن الناس لا يتنبهون إليه؛ لخفائه واختلاطه وكونه لا يظهر. وأما تعريفه العام الذي ينتظم الصور فهو ما تقدّم من أن كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فإنها من الشرك الأصغر.
وفي هـٰذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ألا يركن إلى ما عنده من الخير، وأن يحذر الشرك الأصغر والأكبر جميعًا، وأن الخوف لا يكون فقط من الشرك الأكبر بل حتى الأصغر، فهو أولى بشدة الخوف؛ لكونه يخفى على الإنسان، بخلاف الأكبر فإنه ظاهر وقد يحترز منه الإنسان، وإبراهيم -عليه السلام- ذكر الخوف من الشرك الأكبر: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾.( ) الشرك الأكبر في أظهر صوره وهي عبادة الأصنام، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر الشرك الأصغر في أخفى صوره وهي الرياء، وبهـٰذا نعلم أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يشتركان في وجوب الخوف من الوقوع فيهما، ويشتركان في وجوب الحذر منهما. وهـٰذا الحديث ثبت بسند جيد من حديث محمود بن لبيد، ومناسبته للباب ظاهرة.
أما الحديث الثاني فحديث ابن مسعود، وفيه: (أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندّاً دخل النار)).)
((من)) شرطية، و((مات)) فعل الشرط، وجوابه قوله: ((دخل النار)). وأما قوله: ((وهو يدعو من دون الله ندّاً)) فهـٰذه جملة حالية، أي: من مات حال موته وهو على هـٰذه الحال وهو على هـٰذه الصفة فإنه موعود بدخول النار، نعوذ بالله من الخذلان.
يقول: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندّاً)) وفي بعض الروايات: ((من مات وهو يدعو لله ندّاً)). والدعاء أصله النداء، ولكنه يفارقه في أنه لا يلزم منه رفع الصوت ولا يشترط فيه حرف النداء، والدعاء يكون بالقول والفعل وأما النداء فلا يكون إلا بالقول الظاهر، والدعاء في هـٰذا الحديث هو العبادة بجميع أنواعها وصورها. والمراد من قوله: ((يدعو من دون الله ندّاً)) أي يعبد من دون الله أحدًا، سواء كان هـٰذا المعبود ملكًا أو رسولاً أو وليّاً صالحًا أو شجرًا أو حجرًا، كل هـٰذا مما يدخل في عموم قوله: ((يدعو لله ندّاً)) وهـٰذا فيه بيان عظم الشرك وخطورة تسوية الله بغيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وتسويةُ غير الله به هي الشرك، بل هي أصل الشرك كما تقدم في بيان الشرك وتعريفه. قوله: ((ندّاً)) نكرة في سياق الشرط يشمل كل مماثل، فمعنى الند: المثيل والنظير والمساوي. وقيل: هو المثيل المناوئ، لكن هـٰذا لا يلزم، الصحيح أن الند هو النظير والمثيل والسمي، كل هـٰذا مما عُرف به الند. وقد نهى الله -جل وعلا- أن يدعى من دونه أندادٌ أو أن يجعل له أندادٌ، فهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- المنزه عن ذلك في كل أمر وفي كل شأن، فقال سبحانه: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾( ) فنهى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن جعل الأنداد، وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: أنه لا ندَّ له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-؛ لأن هـٰذا مما استقر في الفطر ولا شك فيه، فإن المشركين يقرون بأنه لا رب إلا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
وقوله: ((دخل النار)) الدخول هنا هل هو الدخول الأبدي؟
الجواب: إن كان شركًا أكبر فنعم يكون دخولاً أبديّاً، وهو الظاهر أن المراد بهـٰذا الحديث الشرك الأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (72)﴾( ) والنار هي الدار التي أعدها الله -عز وجل- لعباده المعاندين، ودخولها بالنسبة لأهل الشرك دخول أبدي كما تقدم في الآية؛ لأنّ الله حرم عليهم الجنة.
ومناسبة هـٰذا الحديث للباب ظاهرة: فإن الشرك إذا كان هـٰذا مآل صاحبه فإنه يوجب الحذر والخوف واليقظة والتنبه من أن يكون الإنسان فيه الشرك الذي يسبب حرمان الجنة والخلود في النار، ثم قال: (رواه البخاري.)
(ولمسلم عن جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار)).)
أيضًا هـٰذا الحديث فيه ما في الحديث المتقدم من التحذير والتخويف من الوقوع في الشرك دقيقه وجليله؛ لأنه من لقي الله يشرك به شيئًا فإنه موعود بدخول النار، فإنْ كان شركه أكبر فدخوله أبدي، وإن كان شركه أصغر فيدخل إلى أن يمحَّص ويخلص من أوضار الشرك ولوثاته ثم بعد ذلك ينقل إلى الجنة. وأما قوله: ((من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة)). فهـٰذا في حق من حقق التوحيد وسلم من الشرك دقيقه وجليله.
وهـٰذا الحديث فيه المناسبة التي في الحديث السابق من وجوب الخوف والحذر من الشِّرك؛ لأن قليل الشرك وكثيره واحد في كون صاحبه متوعَّدًا بدخول النار، نعوذ بالله من الخسران.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- مسائل فقال:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: الخوف من الشرك.
الثانية: أن الرياء من الشرك.
[الشرح]
هـٰذا لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)). فسئل عنه فقال: ((الرياء)).) فسماه شركا.
[المتن]
الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.
[الشرح]
وهـٰذا كما ذكره النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث، ومنه نأخذ منه أن الشرك قسمان: شرك أكبر، وشرك أصغر.
[المتن]
الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين.
[الشرح]
لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خافه على أصحابه، وهم خيار الأمة؛ بل هم خيار الناس بعد الأنبياء، فخوفه على من سواهم أولى وأحرى.
[المتن]
الخامسة: قرب الجنة والنار.
[الشرح]
وهـٰذا من قوله: ((من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار)). دل ذلك على قربهما وسهولة الوصول إليهما.
[المتن]
السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.
[الشرح]
في حديث جابر.
[المتن]
السابعة: أن من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
[الشرح]
لأن الشرك مانع من دخول الجنة، والدليل على أنه مانع ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾( ) لأن التحريم هو المنع، فلو وجد الشرك في إنسان ولو كان على أكمل أحوال الناس عبادةً وتقربًا إلى الله فإنه يمنع من دخول الجنة؛ لكونه بخس الله حقه بهـٰذا الشرك الذي وقع فيه. والمراد بالشرك أي الشرك الأكبر، أما الأصغر فإنه يحاسب عليه ثم يؤول أمره إلى الجنة.
[المتن]
الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
[الشرح]
وذلك في قوله: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾( ) وهي مسألة عظيمة؛ لأن إبراهيم عليه السلام اجتهد اجتهادًا عظيمًا في تبليغ التّوحيد والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ولقي في ذلك ما لقي تحقيقًا له وعملاً به، ومع ذلك لم يأمن على نفسه من أن يقع في أظهر صور الشِّرك وهي عبادة الأصنام، وهـٰذا يوجب الخوف ويظهر أن المسألة عظيمة وليست سهلة.
[المتن]
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾( ).
[الشرح]
إذا كان هـٰذا حال الأكثر فما يؤمنك أن تكون منهم، وفيهم الأذكياء وأصحاب الفكر، والنظر؟ ولكن حال الله تعالى بينهم وبين الهداية: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾،( ) ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118)﴾ ( )
[المتن]
العاشرة: فيه تفسير (لا إلـٰه إلا الله) كما ذكره البخاري.
الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الخامس
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله
وقول الله تعالى: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾( ) الآية.
عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله-، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) أخرجاه.
ولهما عن سهل بن سعد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال يوم خيبر: ((لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه)). فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: ((أين علي بن أبي طالب؟ )). فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه، ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: ((انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا، خير لك من حمر النعم)). يدوكون: يخوضون.
[الشرح]
هـٰذا الباب (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله) مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن هـٰذا الباب فيه بيان فضل الدعاء إلى التوحيد، وأن هـٰذا سبيل المرسلين.
وأما مناسبته لما قبله: فإنه -رحمه الله- لما تكلم فيما مضى عن التوحيد وفضله وفضل من حقّقه، وعن الشرك ووجوب الخوف منه- بيَّن في هـٰذا الباب أهمية الدعوة إلى التوحيد، وأنه من حق التوحيد أن يدعو الإنسان إليه، من حقه أي من لوازمه وواجباته أن يدعو الإنسان إليه. ومجيء المؤلف رحمه الله بهـٰذا الباب في مقدمة كتابه والذي مضى مما يتعلق بالتوحيد، سبب ذلك: أنه -رحمه الله- أراد أن يبين أنه لا يلزم في تبليغ التوحيد والدعوة إليه أن يلمّ الإنسان بجميع ما يتعلق بهـٰذا الباب من مسائل، بل يكفي في وجوب الدعوة إلى التوحيد أن يحيط علمًا بأصول هـٰذا الباب ومجملاته، فإن التوحيد المجمل مما يجب الدعوة إليه، وأما تفصيل ذلك فيمكن أن يدركه الإنسان فيما يستقبل، فلا يمتنع عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بعلة أنه لم يستكمل دراسة هـٰذا الباب ولم يستكمل الإحاطة به، بل يكفي للدعوة إلى هـٰذا الإحاطة بالمجملات، وهو أن يعلم الإنسان وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه لا يجوز أن يصرف شيئًا من العبادة لغير الله عز وجل. هـٰذا وجه.
الوجه الثاني: أن من سبل تحقيق التوحيد ومن طرق السلامة من الشرك أن يدعو الإنسان إلى التوحيد، فإن من دعا إلى شيء امتلأ قلبه به وصلب فيه، بخلاف من أدرك الشيء في ذهنه وعمل به في نفسه دون أن يدعو إليه غيره، فإن هـٰذا أقل صلابة فيما هو فيه. ولذلك لاحظ نفسك إذا قرأت بابًا من العلم ثم يسّر الله لك أن تعلم هـٰذا العلم إما في كلمة أو في درس أو في خطبة أو في غير ذلك من وسائل التعليم، تجد أنك أرسخ في هـٰذا الذي علمت من أبواب العلم منك في غيره، والسبب أن التعليم تثبت به المعلومات وتستقر به قدم صاحبه، فالدعوة إلى التوحيد من أعظم وسائل الثبات عليه، وكذلك هو من وسائل الحذر من الشرك.
ثم إنه مما يستفاد من جعل المؤلف -رحمه الله- هـٰذا الباب في أوائل الكتاب أنه يكفي في فهم دعوة الرسل ما تقدم، فإن الرسل أتوا يأمرون الناس بهـٰذا الأمر المجمل: لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له، يأمرونهم بعبادة الله وحده دون غيره، وعلى هـٰذا تواطأت دعوة الرسل، فيكفي في دعوة الناس إلى التوحيد أن يُدْعَوا إلى هـٰذا.
أيضًا مما يفيده تقديم المؤلف -رحمه الله- هـٰذا الباب قبل غيره أنه يجب في الدعوة إلى التوحيد أن يبدأ بالدعوة إلى أصله وأُسه وأَساسه الذي لا يقوم بغيره، وهو إفراد الله بالعبادة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها كلمة الدخول في الإسلام وهي مفتاح الجنة، هي أول واجب على المكلف وهي آخر ما يشرع للمكلف، فإن ((من كان آخر كلامه من الدنيا لا إلـٰه إلا الله دخل الجنة)).كل هـٰذا مما يمكن استفادته من تقديم المؤلف -رحمه الله- هـٰذا الباب بعد ذكره للتوحيد والشرك وقبل ذكره للتفاصيل.
وقوله رحمه الله: (الدعاء إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله) ولم يقل: الدعاء إلى التوحيد؛ ليبين ما الذي يُدعى إليه من التوحيد، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وهو توحيد العبادة، فإن الرسل جاءت تدعو إلى هـٰذا: أن اعبدوا الله، هـٰذا الذي أمرت به الرسل، عبادة الله وحده: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)﴾.( ) فأمر الله -عز وجل- الرسل بالدعوة إلى عبادته وحده.
وأما توحيد الربوبية: فإن توحيد الربوبية يذكر لا لأجل تقريره- فإنه مما استقر في الفطر- إنما يذكر لأجل الاستدلال به على توحيد الإلهية، وكذلك الأسماء والصفات تذكر لتقرير الإلهية، فمن تمام الإيمان بالأسماء والصفات وما ذكره الله عن نفسه من جميل الأفعال يلزم منه إثبات أنه لا إلـٰه غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- . فتصريح المؤلف بالشهادة هنا لبيان أن الرسل إنما دعت إلى هـٰذا، وأنه أول ما يدعى إليه، وأنه الأصل الذي يجب أن يشتغل به من يدعو إلى الله عز وجل.
ثم في هـٰذا الباب ذكر المؤلف -رحمه الله- آية وحديثين، الآية قول الله تعالى: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ ﴿قُلْ﴾ أمر بالتبليغ، أمر الله -عز وجل- رسوله أن يبلغ الناس، والأمر بالتبليغ الخاص فائدته الاهتمام بهـٰذا البلاغ والتنبيه إلى ما تضمنه. وقوله: ﴿هـٰذه سَبِيلِي﴾ المشار إليه ما كان عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فـ﴿هـٰذه سَبِيلِي﴾ أي هـٰذه طريقي التي أسلكها. ثم بيَّن هـٰذا السبيل بعد الإِشارة إليه، والذي تفيده الإشارة هو التنبيه وشد النظر والفكر إلى هـٰذا السبيل، قال: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ فسبيل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدعوة إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وقوله: ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ البصيرة هي نور يقذفه الله في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، هـٰذه هي البصيرة، فرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمره ربه في هـٰذا أن يبيِّن للناس أمرين: أن يبين المدعو إليه وذلك في قوله: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾، وأن يبين طريقة دعوته إلى الله وذلك في قوله: ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾؛ لأن من الناس من يدعو إلى الله لكنه على غير بصيرة وهدى، فيفسد أكثر مما يصلح، وإنما يكتمل الصلاح بهذين الأمرين: بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له، وبكون الداعية في دعوته على بصيرة ونور وفرقان من رب العالمين يميِّز به بين الحق والباطل.
وقوله: ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ أتى بحرف ﴿عَلَى﴾ الذي يفيد الاستعلاء؛ ليبين تمكنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من هـٰذه البصيرة، وأنه عليها مستقر في جميع أحواله وفي جميع دعوته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ قوله: ﴿أَنَا﴾ قيل: هـٰذا تأكيد للضمير في قوله: ﴿أَدْعُو﴾ وسبب هـٰذا التأكيد ليعطف عليه قوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾. فيكون الكلام: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ فيكون هو ومن اتبعه على هذين الأمرين: على بصيرة، وعلى دعوة إلى الله عز وجل، ودعوة إليه دون غيره.
وقال بعض أهل العلم: إن قوله: ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ أن الكلام ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ ثم يستأنف خبرًا جديدًا وهو في قوله: ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ فتكون ﴿أَنَا﴾ هنا مبتدأ مؤخراً و﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ خبراً مقدماً، وقدم لإفادة الحصر.
وكلا المعنيين صحيح: فهو -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو ومن اتبعه على بصيرة، وهو -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن اتبعه يدعو إلى الله.
والمعنى الأول أكمل؛ لأنه يثبت له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدعوة إلى الله وأنه على بصيرة، ويثبت ذلك لكل من اتبعه، وهـٰذا لا إشكال فيه؛ لأن من اتبع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- موافق له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذين الأمرين، بل لا يكمل الاتّباع ولا يحصل إلا بموافقة هذين الأمرين: بإفراد الله عز وجل بالدعوة، وكونه على بصيرة في أمره ودعوته ودعائه وعبادته.
ومناسبة هـٰذه الآية للباب ظاهرة، وذلك في قوله: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ وهـٰذا فيه مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل؛ لقول الله عز وجل آمرًا رسوله: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾. وهو مطابق لما ترجم له المؤلف رحمه الله في قوله: (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله.)
قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾.) وتكلمنا على هـٰذا الجزء من الآية.
بقي قوله: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ هـٰذا تكملة لبيان سبيله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومنهجه وطريقه في دينه ودعوته وما جاء به؛ لأن قوله: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي﴾ هـٰذا وصف لكل ما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على وجه العموم. والسّبيل هي الطريق والمنهج الذي يسلكه الإنسان، فبيَّن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سبيله بهـٰذه الأمور: بدأها بأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدعو إلى الله: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾. أي: ومن منهجه وسبيله وطريقه تنزيه الله جل وعلا، فالتسبيح هو التنزيه، ﴿وَسُبْحَانَ﴾ مصدر حذف عامله وهو أسبح، والتقدير: وأسبح سبحانًا، هـٰذا تقديره. فيكون منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة إلى الله والتسبيح وهو التنزيه، والتنزيه لله -عز وجل- يكون بنفي ما وصفه به الجاهلون هـٰذا واحد. ويكون أيضًا بنفي النّقص عما أخبر به عن نفسه هـٰذا اثنان. ويكون أيضًا بنفي المماثلة في صفات الكمال. فكلما قال القائل: سبحان الله فليستحضر هـٰذه الأمور الثلاثة:
فإنك تنزه الله عن هـٰذه الأمور:
أن يكون له شريك أو مثيل في أسمائه وصفاته وما يختص به.
الثاني: أن يكون موصوفًا بصفات النقص التي وصفه بها الجاهلون.
الثالث: النقص في صفات الكمال. ف-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- له المثل الأعلى، أي له الصفة العالية الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
ثم قال: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ هـٰذا ثالث ما وصف به الله عز وجل سبيل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو التبرؤ من الشرك: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا في القول ولا في العقد ولا في العمل ولا في المشاركة ولا في الاجتماع ولا في المحبة ولا في أي شيء من أمورهم، فهو تبرؤ تام من أهل الشرك وأفعالهم وصفاتهم.
وبه نعلم أن قوله: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ عطف على قوله: ﴿أَدْعُو﴾. فيكون منهجه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو ما تضمنته هـٰذه الآية من الخلال الثلاث والصفات التي وصف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها منهج رسوله وطريقه.
ثم قال: (عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما بعث معاذاً إلى اليمن.) بعث رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معاذًا إلى اليمن يدعو إلى الله -عز وجل- كما سيأتي بيانه في هـٰذا الحديث، وهـٰذه البعثة قيل: إنها في السنة الثامنة، وقيل: إنها في أوائل السنة التاسعة بعد رجوعه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من تبوك، وقيل: إنها في السنة العاشرة، وهو الذي رجحه البخاري حيث مال إلى أن بعث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معاذًا وأبا موسى كان في السنة العاشرة. وعلى كل حال ليس هـٰذا مؤثرًا فيما نحن فيه، إنما هو بيان لواقع البعث متى كان؟ قال: (إلى اليمن).
قال: (فقال له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب))) أي من النصارى واليهود، فأهل الكتاب هم النصارى واليهود، وغالب من كان في اليمن كان يرجع إلى هاتين الملتين، والغالب فيهم النصارى وفيهم يهود، فبين له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من سيُقبل عليهم، ثم بين له ما يدعو إليه، فقال: ((ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله)) وفي رواية: ((إلى أن يعبدوا الله)). وفي رواية: ((إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمداً رسول الله)). وهـٰذه الرواية الأخيرة هي أكثر الروايات وأشهرها، وهي التي تجمع معاني الروايات الأخرى، والواقعة واحدة فلا بد أن يكون القول الذي صدر عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واحدًا، وإذا كان كذلك فعند النظر والترجيح بين هـٰذه الروايات نرى أن أرجحها -من جهة كثرة الورود، ومن جهة جمع المعاني، ومن جهة موافقة ما أجمع عليه أهل العلم- هي هـٰذه الرواية التي فيها التصريح بأن الدعوة إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهـٰذه الرواية رجحها ابن حجر -رحمه الله- على سائر الروايات؛ لكثرة رواتها.
المهم أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين له ما يدعو إليه، وبدأ فيما يدعو إليه بشهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وذلك أنه لا يدخل أحد دين الإسلام إلا من هـٰذا الطريق، فلا بد من الشهادتين لدخول الإسلام، وهـٰذا أمر أجمع عليه أهل العلم، وأنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بهـٰذا وهو شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ورأى بعض أهل العلم زيادة التبرؤ من الكفر.
أقول: زاد بعضهم على الشهادة التبرؤ من الكفر وقال: لا بد من التبرؤ من الكفر، وإلا فإنه لا يحصل الإسلام بمجرد شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله مع البقاء على عقائد الكفر السابقة. واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بمثل قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.( ) فجعل الاستمساك بالعروة الوثقى مرتبًا على أمرين: على الكفر بالطاغوت وهو التبرؤ من الشرك والكفر والعقائد الباطلة، وعلى الإيمان بالله وهو الشهادة لله بالألوهية وللنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله كافية في دخول الإنسان إلى دين الإسلام، ولكن إذا دخل يبين له أن العقائد التي عليها أهل الباطل يجب الكفر بها، وأن كل ما خالف دين الإسلام يجب الكفر به ولا يجوز اعتقاده؛ لأن مقتضى الشهادة الإيمان بالله عز وجل، ومقتضى الشهادة للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة تصديقه في الأخبار واتباعه في الأحكام أو الانقياد له في الأحكام. وهـٰذا القول اختاره شيخنا رحمه الله: أنه لا يلزم للدخول في الإسلام زيادة على ما دل عليه حديث معاذ من الشهادة لله بالألوهية وللرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة، وأنه فيما بعد إذا حصل منه ما يوجب الكفر نبه عليه، فإن تنبه وإلا فإنه يحكم بردته إذا بُين له الحق ولم ينزع عنه، لكن الإسلام يكفي في حصوله لصاحبه أن يشهد أن لا إلـٰه إلا الله.
واشتراط التبرؤ من الكفر هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.
والذي يظهر ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وأيده شيخنا محمد الصالح العثيمين غفر الله له؛ لأنه ظاهر في حديث معاذ أنه لم يطلب منهم زيادة على أن يشهدوا أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمداً رسول الله، مع أن اليهود لهم عقائد مخالفة لعقيدة الإسلام كما قالوا: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾.( ) والنصارى كذلك لهم عقائد تخالف ما عليه دين الإسلام كما قالوا: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾.( ) وإلا لو كان يلزم أن يتبرأ لزم أن يعرض عليه كل عقائد الإسلام حتى يعتقد الصحيح ويترك الباطل، لكن يكفي في دخول الإسلام ما دلّ عليه الحديث من الدعوة إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
ثم قال: ((فإن هم أطاعوك إلى ذلك)). أي أطاعوك إلى هـٰذا الأمر وهو شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات)) وذلك أن الصلاة ثاني أركان الإسلام، لا يتم إسلام أحد إلا بها، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((بني الإسلام على خمس)) وذكر بعد الشهادتين الصلاة، وحددها بهـٰذا العدد لأنها هي المفروضة في كل يوم. وأما ما قيل من فرض غير ذلك من الصلوات الخمس فهو فرض مؤقت بوقت، كصلاة العيد مثلاً على القول بوجوبها، وكصلاة الكسوف وغير ذلك من الصلوات التي قيل بأنها واجبة.
قال: ((في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) والمراد بالصدقة هنا الزكاة. وقوله: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) هـٰذا بيان لمصرف الزكاة الأول وليس قصرًا ولا حصرًا، إنما هو بيان لمصرفها الأول، ولذلك في آية التوبة التي ذكر فيها مصارف الزكاة بدأ الله -عز وجل- بذكر الفقراء: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾.( )
وقوله: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) اختلف العلماء في مرجع الضمير هنا: هل هو إلى أهل البلد أي أهل المكان الذين بعث إليهم معاذًا، أم أن الضمير يعود إلى أهل الإسلام الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأطاعوا في إقام الصلاة؟ فمن قال: إنه يعود إلى أهل البلد رأى أنه لا تنقل الزكاة من مكانها إلا إذا لم يجد محتاجاً أو من أهلها أي من أهل الزكاة المستحقين لها، فعند ذلك ينتقل. وأما من رأى أن الضمير يعود إلى عموم المسلمين فإنه يرى جواز نقلها من المكان الذي أهله -أي أهل المال- فيه؛ لأن الضمير يعود إلى عموم المسلمين، فـ((تؤخذ من أغنيائهم)) أي أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم. وهـٰذا المعنى الأخير رجحه شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، والمسألة خلافية تحقق في كتب الفقه.
قال: ((فإن هم أطاعوك لذلك)) أي: أطاعوك لهـٰذا الفرض ((فإياك وكرائم أموالهم)). تحذير من أخذ أطايب المال؛ لأن النفوس تتعلق به، ولأن فيه مشقة على أهل الأموال أن تؤخذ من كرائم الأموال، فحذر من كرائم الأموال، فهل يأخذ خبيثها ورديئها؟ الجواب: لا، وإنما يأخذ أواسطها، وهـٰذا كمال العدل الذي لا إجحاف فيه على أهل الأموال ولا ضرر فيه على أهل الزكاة المستحقين لها.
ثم قال: ((واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)). هـٰذه الموعظة فيما يتعلق بالأموال، أي أخر هـٰذه الموعظة إلى أن جاء ما يتعلق بالأموال؛ لأن الغالب فيمن يتولى أمرًا أن يقع منه خطأ أو تقصير في حقوق الناس وأموالهم، فحذره بقوله: ((واتق دعوة المظلوم)). والمظلوم هو من وقع عليه الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه: إما بأخذ حق، أو بتحميل ما لا يجب. فحذره من دعوة المظلوم ليحذر في جِبَايته للزكاة، ولا يأخذ إلا ما وجب شرعًا من غير وكس أو شطط، أي من غير زيادة أو نقص.
قال: ((فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) وهـٰذا فيه بيان خطورة دعوة المظلوم، وأنها لا تحجب عن الله عز وجل، وتبلغه، وهـٰذا مما يوجب الحذر من دعوة المظلوم.
الشاهد من هـٰذا الحديث قول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)). هـٰذا هو الشاهد من سياق الحديث، حيث وجه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رسوله - يعني معاذًا –إلى الدعاء إلى هـٰذه الشهادة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق بهـٰذا الحديث من أحكام في المسائل التي يذكرها الشيخ.
ثم قال: (ولهما عن سهل بن سعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال يوم خيبر: ((لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه)). فبات الناس يدوكون ليلتهم...) الحديث.
هـٰذا الحديث فيه خبر ما وقع من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم خيبر، وخيبر مدينة أو منطقة في شمال المدينة كان يقطنها اليهود، فخرج إليهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما اجتمعوا فيها وحاربوا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وألَّبوا عليه، وحاصرهم فيها، استعصى عليه فتح الحصن المحيط بخيبر، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)). وهـٰذا فيه بيان فضيلة المعطَى، يعني فضيلة من سيأخذ هـٰذه الراية؛ لشهادة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهذين الأمرين: محبة الله ورسوله له، ومحبته لله ورسوله. وهـٰذه منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة، من ثبتت له فقد حاز فضلاً كبيرًا.
ثم قال: ((يفتح الله على يديه)). يجعل الفتح على يديه. وذكر هـٰذا الوصف قبل هـٰذا الخبر يدل على أن محبة العبد لربه ومحبة العبد لرسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومحبة الله ورسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للعبد من أسباب إجراء الخير على يديه، فإنه لما قدم هـٰذا الوصف بين يدي الخبر بحصول الفتح دل ذلك على أن هـٰذا الوصف له كبير الأثر في الخبر، ولذلك من أراد أن يكون مفتاحًا للخير فليحقق محبة الله ومحبة رسوله، فإن ذلك من أعظم أسباب تحصيل الخير، وأن يكون الإنسان مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر يفتح الله على يديه.
يقول: ((فبات الناس يدوكون ليلتهم)). ((يدوكون)) أي يخوضون كما ذكر المؤلف رحمه الله في آخر الباب، يخوضون فيمن يكون هـٰذا الذي شهد له الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهـٰذا الفضل وهـٰذه المنقبة، والدوك والخوض الذي جرى منهم في ليلتهم يدل على شدة حرصهم على الخير هـٰذا من وجه. ويدل أيضًا على تشوفهم لهـٰذا الخير، ولذلك قال عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في رواية مسلم لهـٰذا الحديث: "فما تمنيت الإمارة إلا يومئذٍ". وذلك لكون هـٰذه الإمارة وهـٰذا الفضل المذكور يحصل به فضل ديني ودنيوي.
أما الفضل الديني فذلك شهادة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له بالمحبة. وأما الفضل الدنيوي فهو الفتح، وإن كان فضلاً دنيويّاً فهو أيضًا يؤول لأمر الآخرة، وهو أن تكون هـٰذه البلاد تحت أيدي المسلمين، ولذلك تسور لها رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وتشرف لها، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال: (فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كلهم يرجو أن يعطاها فقال: ((أين علي بن أبي طالب؟ ))). طلب عليّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه) وذلك أنّ علي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في أول الأمر تخلف عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسبب رمد في عينيه أصابه، ثم لما ارتحل -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وخرج شق عليه البقاء فتبعه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، ولم يكن معهم في وقت قوله: ((لأعطين الراية غداً رجلاً)) بل كان في طريقه إليهم، فلما سأل عنه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قيل له: (هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه) فأُتي به يقوده سلمة بن الأكوع كما في الصحيح (فأرسلوا إليه فأُتي به، فبصق في عينيه) أي بصق رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في عينيه (ودعا له). فجمع له بين بركة نفثه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهي بركة ذاتية وبين بركة دعائه، حيث دعا له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالشفاء فبرأ وارتفع ما به من وجع. يقول: (فبرأ كأن لم يكن به وجع). أي عاد صحيحًا، وهـٰذا من آيات الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. (فأعطاه الراية فقال: ((انفذ على رسلك))). ((انفذ)) أي امضِ ((على رسلك)) أي على مهلك، والأصل في الرِّسْل: التمهل والتؤدة التأني، ومنه: ترسل في حديثه أي تأنى وتمهل.
((حتى تنزل بساحتهم)) أي إلى أن تنزل بمكان قريب منهم. ((ثم ادعهم إلى الإسلام)). فوجهه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى ألا يبدأهم بالقتال، بل يبدؤهم بالدعوة إلى الإسلام. ((وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله -عز وجل- فيه)). وحقه فيه ما دلت عليه النصوص من عبادته وحده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ، والمراد بالإخبار بحق الله تعالى في الإسلام الإخبار بأصوله لا بتفاصيله، إنما الإخبار بالأصول أي الإخبار بالأركان التي يبنى عليها هـٰذا الدين. ((فوالله)) أقسم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمْر النَّعم)) وهي أشرف أموال العرب وهي الإبل الحمر، وذلك لعظيم الأجر المترتب على الهداية بسببك. فبيّن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فضل الهداية- هداية الشخص إلى دين الإسلام- وأنها خير من أنفس الأموال، وذكر حُمْر النعم لأنها أنفس الأموال في ذلك الوقت، وهي خير من نفيس المال في كل زمان ومكان.
ثم الشاهد من هـٰذا الحديث هو قول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثُم ادعهم إلى الإسلام)). وهـٰذا هو شاهد ذكر هـٰذا الحديث في هـٰذا الباب. قوله: (((يدوكون)) أي يخوضون).
في هـٰذا الباب مسائل.
[المتن]
فيه مسائل.
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الشرح]
هـٰذه المسألة مستفادة من قوله تعالى: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾( ). فإن سبيل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الدعوة إلى الله، وهو سبيل من اتبعه، وهي دعوة على بصيرة، فالمسألة مأخذها واضح من الآية.
[المتن]
الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
[الشرح]
وهـٰذا مستفاد من قوله: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾. فإنه يدعو إلى الله –جل وعلا- بَيَّن المدعو إليه، فهو لا يدعو إلى نفسه ولا إلى جماعته ولا يدعو إلى أهل بلده، إنما يدعو إلى الله جل وعلا، وهـٰذا فيه وجوب استحضار إلى من تدعو في دعوتك، فإن الإنسان يغفل كثيرًا في تعليمه ودعوته، فقد يلتبس عليه الحق بالباطل فيدعو إلى نفسه ويظن أنه يدعو إلى الله، أو يدعو إلى جماعته وأهل بلده وهو يظن أنه يدعو إلى الله عز وجل، فالواجب تحرير المدعو إليه، أن يكون واضحًا في نظر الداعية ونظر المدعو إليه، حتى يتبين المدعو إلى من يصير وإلى من يسير.
[المتن]
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
[الشرح]
كل هـٰذه الفوائد والمسائل مأخوذة من الآية. وجه كون البصيرة من الفرائض أن الله جل وعلا قال: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ أمر رسوله بأن يبين سبيله وبينه بهـٰذا الوصف، وسبيله واجب الاتباع؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾( )، ولقول الله جل وعلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾( )، ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾( ). هـٰذه النصوص وغيرها تدل على أن وصف السبيل الذي سلكه واجب، وأنه لا يكفي أن يسلك السبيل دون أن يأخذ بأوصافه، ومن آكد أوصاف سبيل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه على بصيرة، فاتضح وجه قول المؤلف رحمه الله: (أن البصيرة من الفرائض.)
[المتن]
الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن المسبَّة.
[الشرح]
وجه ذلك أنه لما فرغ من بيان سبيله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾( ). والتسبيح هو التنزيه للرّبّ -جل وعلا- عن كل نقص وكل عيب وعن كل ما وصفه به الجاهلون، فمن كمال توحيده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن دلائل حسن مسلكه في توحيد ربه أنه ينزِّه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن الشرك في كل صوره: الشرك في الألوهية، والشرك في الربوبية، والشرك في الأسماء والصفات.
الشرك في الألوهية أن تعبد غيره، والشرك في الربوبية أن تثبت مدبرًا معه، والشرك في الأسماء والصفات أن تثبت للمخلوق ما أثبته الله لنفسه، بأن تسوي بين الخالق والمخلوق، فمن كمال التوحيد أنه يتخلص من كل مسبة ونقص وُصِفَ به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. وذكرنا لكم أثناء الشرح أن التسبيح تنزيه الله عز وجل بقولك: سبحان الله عن مماثلة المخلوق وعن وصفه بصفات النقص، كقول اليهود: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾( ). الثالث: النقص في صفات الكمال، تنزهه عن هـٰذه الثلاثة.
[المتن]
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
[الشرح]
ما فيه إشكال، وذلك لأنه نسبة النقص لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فالشرك يقتضي أن يكون له مثيل فيما يجب له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ، والله جل وعلا قد نفى المثيل في كل شأن من شؤونه وفي كل أمر من أموره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾،( ) وكذلك قال: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾،( ) وقال: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾( ). كل هـٰذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه لا مثيل له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا في ذاته وصفاته ولا فيما يجب له. وهـٰذه الآيات تساق ليستدل بها على أن لا مثيل له في ذاته وصفاته، ولكن يجب أيضًا أن يستدل بها على أنه لا مثيل له ولا نظير له فيما يجب له، وهو إفراد العبادة.
[المتن]
السادسة -وهي من أهمها-: إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا يصير منهم وإن لم يشرك.
[الشرح]
وذلك في قوله: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾( ) فإن من تمام توحيد العبد تجنّب الشرك وأهله، ولا يصحّ إيمان عبد ولا إسلامه إلا بمباينة أهل الكفر وأهل الشرك؛ لأنه عنوان الإسلام أن تحب لله وأن تبغض فيه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وقد نهى الله جل وعلا أهل الإيمان عن القرب من أهل الشرك، وفي هـٰذه الآية قال: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ولم يقل: وما أنا بمشرك؛ لأن قوله: ما أنا بمشرك، نفي للشرك عن فعله، وأما قوله: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا في أفعالهم ولا في صفاتهم ولا في ذواتهم، فهو مباين لهم من كل وجه.
[المتن]
السابعة: كون التوحيد أول واجب.
[الشرح]
هـٰذه المسألة مأخوذة من حديث ابن عباس عندما بعث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معاذًا إلى اليمن حيث قال: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله)) وهـٰذا واضح وظاهر وبيّن في أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إلـٰه إلا الله، وأنه لا يُبدأ بغيرها، فهي التي يدعى إليها أولاً، وهي التي يطلب من المكلف الإتيان بها للدخول في الإسلام.
أما من قال: إن أول واجب النظر- تعلمون ما هو النظر؟ هو الاستدلال بالأدلة العقلية على وجود الرّب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ، أما من قال: إن أول واجب هو النظر- أو: إن أول واجب هو جزء النظر، أو: إن أول واجب هو الشك في وجود الرب؛ فهؤلاء كلهم منحرفون عن طريق الرسل؛ لأن الرسل لم يأمروا الناس بهـٰذا، وإنما بنوا على ما هو مستقر في الفطر، والذي استقر في الفطر هو وجود الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فلا حاجة إلى طلب الأدلة على إثباته ووجوده؛ لأنه موجود جل وعلا، وهـٰذا مما تُقر به الفطر، ولذلك طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية في إثبات وتقرير توحيد الألوهية، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله)).لم يقل: أول ما تدعوهم إليه النظر أو جزء النظر أو الشك كما يقول أهل الكلام من المنحرفين عن طريق أهل السنة والجماعة.
وهـٰذه أقوال ليست ضربًا من الخيال. هـٰذه أقوال لها من يستند إليها ويصدر عنها، ولكن - الحمد لله - الحق واضح وبيّنٌ، ما هو؟ ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله)).
[المتن]
الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
[الشرح]
الثامنة من المسائل أنه يبدأ به- أي: بالدعوة إلى التوحيد، وهو شهادة أن لا إلـٰه إلا الله- قبل كل شيء، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله، فإن هم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات)) فجعل الإخبار بفرضية الصلوات مرتباً على الاستجابة والإقرار بالشهادة بالتوحيد، وهـٰذا يدل على أنه لا يقبل غيرها قبلها . ولكن اختلف أهل العلم في مسألة، وهي: لو فعل الكافر ما هو من خصائص أهل الإسلام -كما لو صلى الكافر- فهل يكون مسلمًا بصلاته؟ على قولين لأهل العلم:
منهم من قال: إنه يصير بذلك مسلمًا، وهـٰذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
والقول الثاني: أنه لا يصير بذلك مسلمًا؛ لأن الفعل يحتمل؛ يحتمل الاستهزاء ويحتمل الموافقة الظاهرية، فقد لا يكون عن عقد.
ومذهب الحنابلة ينص على أن الكافر إذا صلى صار مسلمًا حكمًا، بأن يحكم بإسلامه فتُجرى عليه أحكام الإسلام. والقول الثاني: أنه لا يكون بذلك مسلمًا؛ لما ذكرنا من الاحتمال. وإذا وجد الاحتمال فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو الكفر المتيقّن سابقًا.
وطرد بعض أهل العلم هـٰذا القول الذي ذكره جماعة من العلماء في الصلاة في كل ما هو من خصائص الإسلام، فجميع ما يختص به أهل الإسلام إذا فعله الكافر فإنه يصير به مسلمًا: فمثلاً لو حج هـٰذا من خصائص أهل الإسلام يكون بذلك مسلمًا، ولو صام؟ الصيام عند غيرنا ولكن لا أدري هل هو على صفة صيامنا أم لا؟ لكن الصيام ليس من خصائص أهل الإسلام، هم يصومون ولكن صيام له صفة معينة. المهم كل ما هو من خصائص الإسلام إذا فعله الكافر يصير به مسلمًا، وهـٰذا اختيار شيخنا رحمه الله، رجّح قول شيخ الإسلام.
فإذا ظهر منه ما هو من خصائص الإسلام قصدًا، يعني قاصدًا هـٰذا الفعل فإنه يحكم بإسلامه. واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يكون بذلك مسلمًا حتى يظهر التوحيد ويتبرأ من الكفر؛ لما ذكرنا من الاحتمال في الفعل.
[المتن]
التاسعة: أن معنى ((أن يوحدوا الله)) معنى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله.
[الشرح]
وجه تفسير التوحيد بشهادة أن لا إلـٰه إلا الله أن الروايات جاءت بهـٰذا وبهـٰذا، فقد ذكر المؤلف رحمه الله روايتين، فالراوية الأولى: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله)). والرواية الثانية: ((إلى أن يوحدوا الله)). فجعل التوحيد هو الشهادة. هل يحمل تعدد الروايات في هـٰذا الحديث على تعدد الوقائع، أي: هل يكون النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث معاذًا إلى اليمن في هـٰذه الوصية وأوصاه بأكثر من مرة؟ الجواب: لا؛ لأنه لم يحفظ ذلك إلا في مرة واحدة، فإذا علم أنه لم يحصل البعث إلا مرة واحدة فيعلم يقينًا أن القول الذي صدر عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو أحد هـٰذه الأقوال، فلا يمكن أن يصدر عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جميع هـٰذه الأقوال التي جاءت بها الروايات.
وإذا كان كذلك فالمنهج في اختيار الرواية أن يقال: إن رجح الرواة لفظًا- إما بقوة في الرواة أو بكثرة- فالعمل بما رجّحه النظر في السند، فإذا كان السند لا سبيل إلى الترجيح من خلاله فالترجيح الصحيح في هـٰذا أن يختار من الراويات أوفاها معنى، يعني: الرواية التي تجمع ما في معاني الروايات الأخرى. وهـٰذا المنهج اضبطه فيما تعددت فيه الروايات ولم يمكن حمل ذلك على تعدد القصة، إذا لم يمكن الترجيح من خلال الرواية فاختر من الروايات ما هو أوفاها معنى وأجمعها، يعني: الذي تلتقي فيه جميع الروايات. نحن في نظرنا للروايات التي وردت في هـٰذا الحديث ذكرنا أن الرّاجح منها هو رواية: ((فادعهم إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمداً رسول الله)). فهـٰذه الرواية هي أكثر ما جاء عن الرواة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وعلى هـٰذا نقول: إنّ الرواة الذين نقلوا غير هـٰذه اللفظة نقلوها بالمعنى، وفُهم من ذلك أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -إن كان التصرف منهم في اللفظ- أن التوحيد عندهم هو شهادة أن لا إله إلا الله.
[المتن]
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
[الشرح]
وجه هـٰذه الفائدة: أنّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب)) وأهل الكتاب يعبدون الله أم لا؟ يعبدون الله، ويقول كثير منهم: لا إله إلا الله، ومع ذلك أمره بدعوتهم إلى أن يوحدوا الله، وذلك سبب هـٰذه الدعوة مع أنهم يعبدون الله ويقرون بأنه لا إله إلا الله، أو يقر بعضهم بأنه لا إله إلا الله، لا سيما اليهود الذين بُعث إليهم، وهم كثيرون في اليمن؛ لأن أهل الكتاب في هـٰذا السياق في الأصل هم اليهود والنصارى، واليهود يقرون بأن لا إله إلا الله، مع ذلك أمرهم بلا إله إلا الله؛ لِمَا طرأ عليهم من إخلال بهـٰذه الشهادة، فهم لم يفهموها، أو أنّهم فهموها ولم يعملوا بها فقالوا: عزير ابن الله، ووقع منهم مخالفات لهـٰذه الشّهادة فطُلبت منهم، إضافة إلى هـٰذا أنهم مطالبون بالشهادة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرّسالة وهـٰذا لم يكونوا يقرون به؛ لذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمعاذ: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله)). وهـٰذا وجه قول المؤلف رحمه الله: (أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب). يعني من اليهود خاصة أو من النصارى (وهو لا يعرفها) أي لا يعرف هـٰذه الكلمة (أو يعرفها ولا يعمل بها)، هـٰذا الغالب في اليهود، (لا يعرفها) هـٰذا الغالب في النصارى.
[المتن]
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.
[الشرح]
وذلك واضح في حديث ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فإنه لم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد استتمام قبول الدرجة الأولى أو الدرجة السّابقة، فإنه قال: ((فادعهم إلى شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة)) وهـٰذا تدرج -لا إشكال- في التعليم والدعوة مع أن شرائع الإسلام قد تمت، ولو أن أحدًا من هؤلاء أقر بأن لا إله إلا الله ولم تكن الدعوة وجهت إليه بالصلاة فإنه يموت مسلمًا، وهـٰذا مستند ومستمسك لأن التدرج في التبليغ والدعوة ثابت حتى بعد استكمال الشريعة، وأنه ليس فقط في وقت التشريع؛ لأن من العلماء من يرى أن التدرج يكون فقط في زمن التشريع، كما تدرج التشريع في الخمر، وأما بعد ذلك فإنه لا تدريج، بل يطلب من الشخص كل ما يقتضيه الدين. وظاهر حديث معاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وقد بُعث في السنة العاشرة بعد استكمال وجوب شرائع الإسلام وأركانه وأكثر أحكامه كان توجيه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له بالتدرج في قوله: ((فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم)).
[المتن]
الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.
[الشرح]
هـٰذا واضح، فقد بدأ بالتّوحيد ثم ثنى بالصلاة ثم أتى بالزكاة، ولم يذكر الصيام والحج فما السبب؟
ذكر أهل العلم عدة أجوبة لعدم ذكر الصيام والحج في الحديث مع أنّ البعث متى كان؟ في السنة العاشرة على الصحيح، وفي السنة العاشرة استكملت الشرائع والأركان أم لم تستكمل؟ استكملت الأركان، فالحج مفروض والصيام مفروض ولم يذكرا.
أجاب شيخ الإسلام -رحمه الله- جوابًا مسددًا فقال: إن الصيام لم يذكر في حديث معاذ لأنه تابع لغيره، ولأنه عبادة باطنة.
ويمكن أن يضاف على ما ذكر جواب ثالث: أن وقته لم يأت بعد، فقيل: إن البعث كان في ربيع الثاني أو ربيع الأول، وذلك قبل مجيء رمضان بزمن واسع يمكن أن يدعوهم إذا جاء وقته أو قرب.
أما بالنسبة للحج فالحج لم يذكر أيضًا، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لأنه ليس واجبًا على كل أحد، فوجوبه ليس عامّاً بل وجوبه مقيد بالاستطاعة كما قال جل وعلا: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾.( ) وإذا كان كذلك فإنه يؤخر أو لا بأس في تأخيره. ويمكن أن يضاف الجواب الثاني على الجواب الأخير الذي زدناه في الصيام إلى الحج: فإنّ الحج وقته في ذي الحجة وأشهُرُه لم تدخل شوال وذو القعدة وذو الحجة، والبعث كان قبل ذلك بزمن.
[المتن]
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.
[الشرح]
حيث قال: ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم)).
وهل استوعب ذكر مصارف الزكاة في هـٰذا الحديث؟
الجواب: لا، إنما ذكر مصرفًا واحدًا من المصارف وهو أهمها، لذلك بدأ به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في الآية فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ ( ) الآية. ويستفاد من هـٰذا أنه يجوز في صرف الزكاة أن تكون في مصرف واحد، ولا يلزم أن توزع في جميع المصارف الثمانية، بل لو جعلها في الفقراء أو في المساكين أو في سبيل الله أو في ابن السبيل يكفي.
[المتن]
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
[الشرح]
وذلك مأخوذ من قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب)). فبعث الرّجل إلى قوم من أهل الكتاب محل اشتباه؛ لأن هؤلاء يتفقون مع أهل الإسلام في أصول، وهي: الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح، هـٰذه الأمور اتفقت عليها الشرائع، ولذلك احتاج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبيّن لمعاذ بماذا يبدأ، وكيف يبدأ مع هؤلاء الذين يقرّون بهـٰذه الأمور، ولم يكن له سابق معرفة فيما يظهر على دعوة أمثال هؤلاء؛ لأن الدعوة يظهر في المدينة وما حولها كانت لقوم مشركين ليسوا من أهل الكتاب، وهـٰذا وجه قول المؤلف رحمه الله: (كشف العالم الشبهة عن المتعلم.)
والشبهة المقصود بها محل الاشتباه والالتباس، وذكرنا لكم تعريفها فيما مضى: أنها عارض يعرض للقلب يحول بينه وبين النظر أو بين معرفة ما أخبر به الله ورسوله. ويمكن أن يقال بأعم من هـٰذا، فيقال: إن الشبهة عارض يصيب القلب يحول بينه وبين رؤية الأمور على حقائقها؛ ليشمل الشبهة في الكتاب والسنة وفي غيرهما.
وأيضًا يمكن أن يؤخذ هـٰذا من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فإياك وكرائم أموالهم)). فإنه لما أخبرهم بفرض الزكاة بيَّن له أنها لا تؤخذ من كرائم الأموال.
[المتن]
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال.
[الشرح]
وجه ذلك - وجه النهي - أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إياك)). وإياك للتحذير، هـٰذا من وجه. ومن وجه آخر قال بعدها: ((واتق دعوة المظلوم)). فدل ذلك على أن أخذ كرائم الأموال من الظلم الذي يجب أن يتّقى؛ لأن اتقاء دعوة المظلوم لا يحصل إلا باتقاء الظلم، وهو السبب الباعث للدعوة. وكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة وجمعها نفائس، والنفائس إما لتعلق النفوس بها، سواء كان ذلك لجودة فيها، أو لعظيم نفع منها، حتى ولو لم تكن مما علا في الجودة لكن عظم نفعه، فهو من النفائس أو من الكرائم التي تتقى.
[المتن]
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.
[الشرح]
ويحصل ذلك باتقاء الظلم الذي هو سببها.
[المتن]
السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.
[الشرح]
(لا تحجب) أي لا ترد ولا تمنع، فالحجب هو المنع، وهـٰذا فيه أن دعوة المظلوم من الأدعية المستجابة، لكن هل يكون هـٰذا في كل دعوة لكل مظلوم؟
أما الجزء الثاني وهو: هل هي لكل مظلوم؟
فالجواب: نعم؛ لأن الحديث لم يميز، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا شك أن السبب في المسلم؛ لأن المأخوذ منه زكاة مسلم، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اتق دعوة المظلوم)) فيشمل المظلوم من أهل الكفر والمظلوم من أهل الإسلام، هـٰذا جواب على الشطر الثاني من السؤال.
الشطر الأول هل هو لكل دعوة؟ أي: هل كل دعوة يدعو بها المظلوم فإنها لا تحجب، يعني لا بد من إجابتها؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال: إن كل دعوة للمظلوم فإنها تجاب ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يتعدّ في الدعاء، أما إذا دعا على الظالم بقدر مظلمته فإنه يجاب.
وقال آخرون: إنها لا تخرج عن عموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إذا دعا الداعي فإنه إما أن يجاب، وإما أن يدفع عنه من الشر نظيرها، وإما أن تدّخر له في الآخرة.
ولكن هي تتميز عن غيرها حتى على هـٰذا القول الثاني، تتميز عن غيرها بأنها أجدر وأقرب إلى الإجابة من غيرها من الدعوات. وهـٰذا القول له وجه؛ القول الثاني له وجه من العموم في الأحاديث الأخرى.
[المتن]
الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
[الشرح]
وهـٰذا انتقال إلى الحديث الثاني وهو حديث سهل بن سعد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وفيه ما ذكر المؤلف رحمه الله من المشقة؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجد من المشقة في خيبر هو وأصحابه ما لم يجده في غيرها من الغزوات، فاجتمع عليهم المشقة والجوع.
أما المشقة فهو ظاهر؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد حاول فتح حصنهم مرات وطال حصاره لهم ولم يفتح فقال: ((لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)) الحديث. كيف يكون هـٰذا دليلاً على التوحيد؟
يكون هـٰذا دليلاً على التوحيد أن سيد المرسلين أعظم الخلق جاهًا عند الله -عز وجل- لم يملك أن يكشف عن نفسه ما حل به، ولم يملك أن يدفعه، فإذا كان عاجزًا عن الدفع أو الرفع وأن أصحابه لم يتوجهوا إليه بالطلب دل ذلك على أن الذي يملك كشف الضر ورفعه هو الله جل وعلا، وأنه مهما عظم جاه المخلوق فإنه لا يرقى إلى درجة الخالق، ولا يتمكّن من شيء مما هو من خصائص الرّب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من تدبير الكون، بل إنّ الأمر إليه كما قال جل وعلا: ﴿أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾( ).
[المتن]
التاسعة عشرة: قوله: ((لأعطين الراية.. )) إلى آخره علم من أعلام النبوة.
[الشرح]
وجه كون ذلك علمًا من أعلام النبوة الكثيرة: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر بأمر غيبي. أليس كذلك؟ ما هو؟ قوله: ((يفتح الله على يديه)) ووقع كما أخبر. فدلّ ذلك على صدقه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو علم من أعلام نبوته الكثيرة.
[المتن]
العشرون: تفله في عينه هو علم من أعلامها أيضًا.
[الشرح]
وذلك أن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قدم وفي عينيه رمد، ثم ما كان من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلا أن بصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهـٰذا لا إشكال في أنه من دلائل نبوته وأعلامها.
[المتن]
الحادية والعشرون: فضيلة علي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
[الشرح]
وذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شهد له بشهادتين:
الشهادة الأولى قال: ((يحب الله ورسوله)) وهـٰذا من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله -عز وجل- تحقيق المحبة.
وأهم من هـٰذا الشهادة الثانية وهي قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((يحبه الله ورسوله)) وهـٰذا الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا.
وهـٰذه الفضيلة هل هي خاصة بعلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؟
احتج الرافضة بهـٰذا الحديث على أن عليّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أفضل الصحابة، وهـٰذا ليس بصحيح، فإن الحديث يُثبت فضيلة علي - لا إشكال - بل هو من أصح ما ورد في فضل علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، هل هـٰذا الفضل الذي ثبت لعلي في هـٰذا الحديث خاص به دون غيره؟
الجواب: لا؛ لأنّ إثبات الفضيلة لشخص لا ينفيها عن غيره، فقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)) لا ينفي هـٰذا الفضل عن غير علي. ثم إن ما ثبت لغيره من الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- كأبي بكر وعمر وعثمان أعظم مما ثبت له -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، لا سيما الشيخين أبي بكر وعمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، فعلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ما جاء في فضله يشركه فيه غيره في كثير منه إلا في أشياء قليلة، أما أبو بكر فإن أكثر فضائله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مما اختصّ به.
ومن نسج خيال الرافضة أنهم قالوا: إن الراية قد أعطيت قبل ذلك لأبي بكر ولم يفتح على يديه، ثم أعطيت لعمر ولم يفتح على يديه، ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، ويفتح الله على يديه)). ولكن هـٰذه القصة لم تثبت، فإن الراية لم تؤتَ لأبي بكر ولم تكن له ولم يقربها لا هو ولا عمر، بل إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما قال هـٰذا القول قال عمر كما في صحيح مسلم: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لإصابة هـٰذا الفضل، ولو كان قد أعطيها ولم يفتح على يديه لما طمع فيها، لكنه طمع فيها وتسور إليها –أي: تشرف لها- ليصيبها. فهـٰذا من أباطيلهم وأكاذيبهم فيما يتعلق بالشيخين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-.
لكن المهم أن نعرف هل هـٰذه الفضيلة مما اختص به علي عن غيره؟ الجواب: لا، هـٰذه من الفضائل التي ثبتت لعلي ويشركه فيها غيره.
[المتن]
الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
[الشرح]
وذلك أن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- لم يكترثوا بالفتح قدر ما اهتموا واشتغلوا بتحصيل الفضل المذكور، (فباتوا يدوكون ليلتهم) أي يخوضون فيمن يعطاها، ثم إنهم لما أصبحوا غدوا مبكرين لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كلهم يرجو أن يعطاها. ولا شك أن هـٰذا يدل على عظيم رغبتهم فيما عند الله وعند رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فيما عند الله من الوعد وفيما عند رسوله من الخبر، ولذلك غدوا إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليعلموا من الذي يصيبه ذلك الفضل، وهـٰذا لشدة حرصهم ومسابقتهم في الخيرات -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.
[المتن]
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسعَ إليها ومنعها عمن سعى.
[الشرح]
وهـٰذا واضح جدّاً: فإن علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لم يطمع بها، لم يكن ليطمع بهـٰذه الفضيلة ولا بهـٰذا الشفاء العاجل، لكنّه شق عليه أن يبقى وقد خرج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، فبعد أن خرج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن معه تبعهم علي بن أبي طالب، ولما قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قولته: ((لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)) لم يكن قد جاء علي ابن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، بل كان في طريقه، فهو لم يسع لها ولم يهتم لها؛ لأنه لم يسمع ذلك من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكن الله ساقها إليه فيما يظهر - والعلم عند الله - لصدق نيته وعزمه على نصر الله ورسوله، فإنه -مع ما ألم به من رمد، وهو عذر يبيح له القعود عن القتال، إلا أنه- خرج رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في متابعة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وموافقته، فكان له هـٰذا الفضل العظيم، وهو شهادة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له بهاتين الشهادتين، بينما الذين تسوروا لها وتشرفوا لها وباتوا يخوضون فيمن يأخذها لم يعطوها، لا لقصور في نياتهم ولا لقصور في فضلهم، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾( ).
[المتن]
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: ((على رسلك)).
[الشرح]
الأدب من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله لقائده وصاحب رايته: ((على رسلك)) أي تمهّل. فوجهه إلى السير على مهل وعلى تؤدة؛ لأنه يمضي إلى أمر الله ورسوله. ووجهه أيضًا إلى ألا يلتفت في مشيه كما في بعض الروايات التي تفسر قوله: ((على رسلك)). حيث قال له: لا تلفت يمنة ولا يسرة. ولذلك لما مضى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- شيئًا من الطريق صرخ علي بن أبي طالب كما في بعض الروايات ولم يلتفت امتثالاً لأمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال له: يا رسول الله أقاتل الناس على ماذا؟ يعني: على أي شيء أقاتلهم أو: على أي شيء أقاتل الناس؟ فامتثل توجيه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في التؤدة وعدم الالتفات.
[المتن]
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
[الشرح]
(الدعوة إلى الإسلام قبل القتال) تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: واجب. دعوة واجبة، وهي الدعوة إلى من لم تبلغه الرسالة ولم يسمع بها، وهـٰذا لا يجوز قتاله؛ لأنه لم تقم عليه الحجة.
والقسم الثاني من الدعوة: مستحب. وهو دعوة من بلغته الرِّسالة وسمع بها ولكنه لم يتبعها، فهـٰذا دعوته مستحبّة؛ لهـٰذا الحديث. فإنّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجه علي بن أبي طالب إلى من؟ إلى اليهود، وهؤلاء اليهود الذين في خيبر سمعوا برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل كثير منهم أو جزء ليس بالقليل منهم ممن أجلاهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من المدينة من يهود بني النضير وغيرهم، فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة، لكنه مع ذلك أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، والأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ للاستحباب. كذلك كان من هديه-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا بعث رجلاً على سرية أو جيش قال له: ((إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم)). فقدم الدعوة إلى الإسلام مع أنهم قد يكون هؤلاء قد بلغتهم دعوة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكن هـٰذا يقال فيه إذا كان في قوم لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بها فإنه على الوجوب، الدعوة واجبة، وإن كانت قد بلغتهم فهي مستحبة؛ لأنه ثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قاتل أقوامًا دون دعوة، فيُحمل ذلك على الجواز، كما في قتاله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لبني المصطلق ، فإنه لم يدعهم بل ذهب وهم غارّون.
الإمام أحمد -رحمه الله- يرى أنه لا حاجة إلى الدعوة بعد إنتشار الإسلام، الدعوة مستحبة وليست واجبة فقال: أما اليوم فلا وجوب، فلا تجب الدعوة؛ لأن كل أحد قد بلغه ذكر الإسلام وسمع به، فلا تجب الدعوة وإنما تستحب؛ جمعًا بين الأحاديث.
[المتن]
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
[الشرح]
(لمن دعوا قبل ذلك) أي قبل القتال الحاضر، فإن اليهود الذين في خيبر كثير منهم قد دعوا قبل ذلك لما كانوا في المدينة قبل إجلاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهم (وقوتلوا) على الإسلام، ومع ذلك جدد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدعوة لهم بتوجيه علي بن أبي طالب في قوله: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)).
[المتن]
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: ((أخبرهم بما يجب)).
[الشرح]
لأنه دعاهم إلى الإسلام وبيَّن لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وما الذي يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن كان قد فرض، ولكن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مما علم من حق الله تعالى فيه، ولذلك جاءت هـٰذه المقولة مفسّرة في رواية أخرى حيث قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله)).
وقد بيّن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حقها في أحاديث عديدة، منها حديث ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وفيه قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)). هـٰذا من حق الإسلام الذي إذا لم يأت به الإنسان ولم يوف به أبيح دمه مع بقاء وصف الإسلام.
[المتن]
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.
[الشرح]
وهو ما ذكرناه قبل قليل.
[المتن]
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
[الشرح]
وذلك في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)). أي خير لك من أنفََس الأموال التي تجنيها وتكتسبها في الدّنيا؛ وذلك لأن أجرها باق، ولأن العامل بهـٰذا العمل لك من أجره بمثل ما عمل لا ينقص من أجر العامل شيئًا كما قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
المهم أن فضل الهداية -فضل هداية الناس- إلى هـٰذا الدين عظيم كما تبيّن في هـٰذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، ولكن هل هـٰذا الفضل في الهداية من الكفر إلى الإسلام؟ لا إشكال أنه في الهداية من الكفر إلى الإسلام؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتكلم مع علي وهو متوجّه إلى كفار أو إلى مسلمين؟ إلى كفار. فالحديث في هداية الكفار إلى الإسلام، لكن هل يدخل في هـٰذا هداية المسلمين الضالين المقصرين إلى الطريق المستقيم، إلى ما هو أحسن وأقوم؟ يحتمل، والظاهر أنّه لا إشكال في أن له فضلاً؛ لأنه من الدلالة على الخير، لكنه ليس كفضل الهداية من الكفر إلى الإسلام؛ لأنه إنقاذ من النار، فتلك لا يعدلها هداية، لكن لا نخليها من فضل، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد بين فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن ((من دلّ على خير كان له من الأجر مثل أجر من عمل بما دعا لا ينقص من أجورهم شيئًا)). والهداية المذكورة هنا هي هداية الدلالة والإرشاد.
[المتن]
الثلاثون: الحلف على الفُتيا.
[الشرح]
وذلك في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فوالله)) مع أنه لم يُستقسم ولم يطلب منه الحلف، لكن الحلف يأتي في كلام الله وفي كلام رسوله لتأكيد ما هو عظيم وإن كان لا يدخل إليه شك ولا ريب، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يكذب ولا يُكذب، ومع ذلك -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حلف في هـٰذا الموضع وفي غيره. والحلف لتعظيم المحلوف عليه ولبيان رفعة قدره.
لكن هنا الحلف على الفُتيا أم على التعليم؟
ظاهر هـٰذه الرواية أنه حلف على التعليم؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أعطاه الراية علمه ماذا يفعل، لكن في رواية من روايات الإمام مسلم قال ذلك في جواب سؤال: (على ماذا أقاتل الناس؟) أو (أقاتل الناس على ماذا؟) فإنه سأل فأجابه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فيكون كما ذكره الشيخ رحمه الله: (الحلف على الفُتيا). بهـٰذا يكون قد انتهى الباب.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس السادس
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلـٰه إلا الله
وقول الله تعالى: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ...﴾( ) الآية.
وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلا الَّذِي فَطَرَنِي...﴾( ) الآية.
وقوله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ...﴾ ( ) الآية.
وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ...﴾( )الآية.
وفي الصحيح عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرُم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل)).
وشرح هـٰذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلـٰه إلا الله).
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن المؤلف -رحمه الله- عقده لبيان التوحيد الذي تقدم فضله وفضل من حققه وفضل الخوف ووجوب الخوف مما يضاده. المهم يبين لنا ما تقدم مما سبق الكلام عليه في الأبواب السابقة.
ما هو التوحيد الذي تقدم؟
سيبينه المؤلف رحمه الله لنا في هـٰذا الباب، لكن بيان المؤلف رحمه الله للتوحيد في هـٰذا الباب بيان مجمل يتبعه البيان المفصل، وذلك ما أشار إليه رحمه الله في قوله: (وشرح هـٰذه الترجمة ما بعدها من الأبواب). أي تفصيلها وبيان ما بعدها من الأبواب على وجه الكمال.
فسلك المؤلف -رحمه الله- في بيان التوحيد مسلكين.
المسلك الأول: البيان الإجمالي للتوحيد.
والمسلك الثاني: البيان التفصيلي.
أما البيان الإجمالي فهو بيان الأصول التي لا يتحقق التوحيد إلا بها.
أما البيان التفصيلي فهو شرح لتلك الأصول وما يندرج تحتها.
واعلم أن هـٰذا المسلك -وهو الإجمال والتفصيل- مسلك نبوي: فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سُئل عن الإسلام والإيمان والإحسان بيّن ذلك على وجه الإجمال، ثم كان تفصيل ذلك وبيان تلك المجملات في سائر ما جاء عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سنته، والتوحيد الذي يتكلم عنه المؤلف -رحمه الله- تفسيرًا في هـٰذا الباب وما بعده هو تفسير توحيد الإلهية؛ لأنه هو الذي عقد الكتاب لأجل بيانه وألّف هـٰذا المصنف فيه.
ويبين هـٰذا قوله رحمه الله: (وشهادة أن لا إلـٰه إلا الله.) فإن الواو هنا عاطفة، وهو من باب عطف ماذا؟ من باب عطف المترادفات؛ لأن التوحيد هو شهادة أن لا إلـٰه إلا الله.
مَن يبين لنا أن دليل التوحيد يرادف شهادة أن لا إلـٰه إلا الله؟ نعم، القول في الروايات المتقدمة في حديث معاذ، فإنهم قالوا: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله)). وفي رواية: ((فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)) تقدم هـٰذا.
فقوله هنا: (وشهادة أن لا إلـٰه إلا الله) هو من عطف المترادفات. مثال لعطف المترادفات في الكتاب قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾( ) فالبث هو الحزن، وهـٰذا من باب عطف الترادف، والأمثلة في ذلك كثيرة. المهم أن عطف الترادف يأتي في كتاب الله وهـٰذا منها.
وكلام المؤلف هنا من باب عطف المترادفات، وبعضهم قال: إن هـٰذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن التوحيد يشمل توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن هـٰذا ليس بسديد؛ لأن الأصل في بيان المؤلف في هـٰذا الكتاب هو توحيد الإلهية، التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وبُعثت لأجله الرسل وهو توحيد الإلهية، ولا شك أنه سيتطرق لما يتعلق بتوحيد الربوبية ولما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات لكن ذلك على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال.
(تفسير التوحيد) التفسير هو الكشف والإبانة، فالمراد بهـٰذا الباب الكشف عن التوحيد وبيان التوحيد، وكذلك بيان شهادة أن لا إلـٰه إلا الله.
ذكر المؤلف -رحمه الله- في تفسير التوحيد خمسة نصوص: أربع آيات وحديثاً. أما الآيات فبدأها بقول الله تعالى: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾( ) هـٰذه الآية لها صلة بما قبلها، والذي قبلها قول الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً﴾( )، ثم قال: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾. ﴿أُولَئِكَ﴾ أُولاء هـٰذا اسم إشارة، وهو مبتدأ، له خبر في هـٰذه الجملة، وهو قوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ﴾ هـٰذا خبر المبتدأ ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أخبر عنهم بخبر، وهو قوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ﴾ فمن المشار إليهم في قوله: ﴿يَبْتَغُونَ﴾؟
اختلف العلماء في المشار إليه على قولين:
منهم من قال: إن المشار إليهم في الآية السابقة هم قوم من الجن كانوا على عهد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعبدهم بعض المشركين، فأسلم هؤلاء الجن لما بلغتهم الدعوة واستمر عابدوهم على الشرك بهم، فقال الله جل وعلا: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ يعني: هؤلاء الذين تتوجهون إليهم بالدعوة والطلب حقيقة أمرهم أنهم يطلبون القرب إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهم يعبدون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فجدير بكم وحقيق بكم أن تتركوا عبادتهم وتعبدوا من يعبدون وهو الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهـٰذا التفسير ورد عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
والقول الثاني: أن ذلك في الملائكة والصّالحين، وزاد بعضهم: والأنبياء، وهـٰذا القول أوسع؛ لأنه يشمل الجن وغيرهم؛ لأن الصالحين من الجن والإنس. والمراد أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أخبر أن كم هؤلاء الذين تعبدونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين حقيقتهم أنهم يبتغون ويطلبون الفضل من الله عز وجل، فحقيقٌ بكم أن تكونوا مثلهم. ويكون المقصود بالآية هو كل من عُبد من دون الله وهو عابد لله، وهـٰذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل كل من توجه إليه أحد بعبادة وهو- أي: المعبود- عابد لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فيشمل الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يعبدون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وهم معبودون.
هل يدخل في ذلك الأصنام؟ قال بعض أهل العلم: يدخل الأصنام. لكن الصحيح أن الأصنام لا تدخل؛ لأن الأصنام لا يصدق عليها الخبر في قوله: ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾.
إذًا عرفنا المشار إليه في الآية، وأنه كل من عبد من دون الله وهو عابد لله، هـٰذا أصح ما قيل. ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾. ﴿الَّذِينَ﴾ اسم موصول وهو بدل ﴿يَدْعُونَ﴾ ولم يذكر المعمول؛ ليشمل كل من توجِّه إليه بدعوة، سواء كانت الدعوة دعوة عبادة أو دعوة مسألة، كما تقدّم أن الدعاء في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، ﴿يَبْتَغُون﴾ أي يطلبون، ﴿إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ والوسيلة هنا هي القربة، أي: إنهم يسألون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- التقرب إليه، وذلك بفعل ما أُمروا به من الواجبات أو من المستحبات، فالوسيلة هي ما يُتقرب به إلى الله -عز وجل- من الواجبات ومن المستحبات، فيكون المعنى: الذين تدعونهم حقيقة فعلهم أنهم مشتغلون بما يقربهم إلى الله -عز وجل- من الواجبات ومن المستحبات.
قوله: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ أي: إن فعلهم هـٰذا لطلب القرب من الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
وقوله: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ قيل في تفسيره: إنه بدل من الضمير في قوله: (يبتغون) فيكون المعنى: أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يتسابقون في القرب من الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، كلهم يطلب ويرجو أن يكون سابقًا قريبًا إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، والقرب إليه في هـٰذه الدنيا، بماذا يكون؟ بفعل الطاعات وترك المنكرات. قال الله عز وجل: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)). فالتقرب هنا بفعل الواجبات وإعقاب ذلك بفعل المستحبات والنوافل. إذًا المؤلف -رحمه الله- ساق هـٰذه الآية لتفسير التوحيد، فكيف نستفيد منها في تفسير التوحيد؟ ما المقصود؟ وكيف فسر المؤلف رحمه الله التوحيد بهـٰذه الآية؟
فسره بأن الآية تضمّنت ثلاثة أركان لا يقوم الإيمان ولا التوحيد إلا بها، وهي: المحبة والخوف والرجاء. فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذكر عن هؤلاء الصالحين المعبودين من دون الله أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهـٰذا فيه المحبة: ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾، ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ هـٰذا فيه إثبات الرجاء، ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ هـٰذا فيه إثبات الخوف من العذاب، وهـٰذه الأركان الثلاثة بها يستقيم إيمان العبد ويصح توحيده.
إذًا تفسير التوحيد هنا لبيان أصوله التي يبنى عليها، وهي: إفراد الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بالمحبة، وإفراده بالرجاء، وإفراده بالخوف:
المحبة من قوله: ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾؛ لأن بها تحصل المحبة، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الإلهي: ((ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبه)). وقد قال الله جل وعلا: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾. والاتباع يكون في الواجب والمستحب، فالاتباع دليل المحبة.
وأما الرجاء ففي قوله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾.
وأما الخوف ففي قوله: ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾. هـٰذه الآية الأولى.
الآية الثانية فسر المؤلف -رحمه الله- التوحيد فيها بما هو مشهور ومعروف، وهو أن التوحيد لا تثبت قدمه إلا بنفي وإثبات، فقد قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾( ) وهـٰذه الآية في خبر قول إبراهيم -عليه السلام- لأبيه وقومه. قوله: ﴿وَإِذْ﴾ أي: اذكر قول إبراهيم لأبيه وقومه: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ﴾ أي متبرئ ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ من الذي تعبدون، فـ﴿مَا﴾ هنا موصولة بمعنى الذي، فتبرأ -عليه السلام- مما يعبد هؤلاء، وبراءته من عبادة هؤلاء هي براءة من الأعيان المعبودة من دون الله، ومن الأفعال التي يعبد بها هؤلاء، فالبراءة تكون من أمرين: من الفعل ومن المعبود نفسه، ليست فقط البراءة من أحد هذين. وماذا كان يعبد قوم إبراهيم؟ كانوا يعبدون الكواكب وما يقيمون من التماثيل التي ترمز لهـٰذه الكواكب، فيعبدون آلهة أرضية وآلهة آفاقية أي سماوية من النجوم والكواكب. هل كانوا يعبدون الله مع ذلك؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
منهم من قال: إنهم كانوا يعبدون الله، أي: إنهم مقرون بالصانع، وهـٰذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله: إنه لم تعرف عن طائفة من الطوائف التي بعث إليها الأنبياء من ينكر الله جل وعلا إنكارًا كليّاً، واستدل لذلك بأدلة عديدة من ظواهر القرآن تدل على أنهم كانوا يعبدون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مع عبادتهم لهـٰذه الأصنام، وعلى هـٰذا يكون قوله: ﴿إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ استثناءً متصلاً، ومعنى الاستثناء المتصل أي يخرج من النفي السابق والبراءة المتقدمة عبادة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في قوله: ﴿إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ فاستثنى الله -جل وعلا- مما يعبد هؤلاء، والاستثناء جاء بهـٰذا الوصف: ﴿إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ لبيان أن سبب استحقاق الله -جل وعلا- لهـٰذه العبادة كونه الفاطر، ولذلك قال صاحب (يس) لقومه: ﴿وَمَالِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾( ) فجعل ترك عبادة الفاطر من أعجب ما يكون ومن أعظم ما يستغرب منه.
إذًا الاستثناء على هـٰذا القول يكون متصلاً.
على القول الثاني -وهو أن هؤلاء لا يعبدون الله إنما يعبدون الكواكب والأصنام- يكون الاستثناء منقطعاً، والاستثناء المنقطع معناه المستثنى منه من غير جنس المستثنى، ويكون تقدير الكلام: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ لكن ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ لا بد من أن تقدر: هو معبودي، أو: لكن الذي فطرني معبودي.
تكلمنا عن الآية وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ساق هـٰذه الآية أو ذكر هـٰذه الآية في باب تفسير التوحيد؛ ليبين أن التوحيد لا تقوم ساقه ولا يستقر قراره إلا بأمرين، الأمر الأول: الإثبات. والأمر الثاني: النفي. إثبات الألوهية لله -عز وجل- ونفيها عما سواه، وهـٰذا ما تضمنته هـٰذه الآية، فإن الآية تضمّنت نفي ما عدا الله من الآلهة وإثبات الألوهية له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وتضمّنت أيضًا البراءة من عبادة غيره، فقوله تعالى فيما ذكره عن إبراهيم: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ هـٰذا يشمل البراءة من الأعيان المعبودة من دون الله ومن الأفعال المتعبد بها لغير الله ومن الفاعلين لتلك العبادات، كل هـٰذا يفيده قول الله تعالى: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾. وقوله: ﴿إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ فيه إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وذكر في الإثبات الصّفة الموجبة لعبادة الله وحده والمسوِّغة لنفي العبادة عن غيره، وهي: ﴿إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أنه فاطر -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وهي صفة الخلق، فهـٰذه الصفة هي التي أوجبت أن يعبد -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- دون غيره، ولذلك جاء ذكر هـٰذه الصفة في الاحتجاج على المشركين في كثيرٍ من الآيات لإبطال عبادتهم وإبطال شركهم، فإنه لا يستحق العبادة إلا الفاطر جل وعلا، ولذلك قال صاحب (يس) في كلامه لقومه: ﴿وَمَالِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾( ) فجعل المسوِّغ للعبادة والموجب لها هو ماذا؟ أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الفاطر. وقد قال الله جل وعلا: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾( ) في إنكار عبادة غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. فالموجب لذكر هـٰذا الوصف في هـٰذه الآية هو بيان علة إفراد العبادة له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. واضح الكلام؟
أفادتنا هـٰذه الآية في تفسير التوحيد أن لابد في التوحيد من إثبات ونفي، ولا بد في التوحيد من براء من المشركين، وأنه لا يكفي فقط في التوحيد إفراد العبادة لله -عز وجل-، بل لا بد أن يضاف إليها البراءة من الشرك وأهله.
ثم قال: (وقوله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾( )) هـٰذه الآية أتى بها المؤلف رحمه الله في تفسير التوحيد؛ ليبين أن التوحيد لا يتم إلا بالتخلي من الشرك الذي وقع فيه هؤلاء، وما هو الشرك الذي وقع فيه هؤلاء؟ أنهم صيّروا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، فقوله: ﴿اتَّخَذُوا﴾ أي جعلوا وصيروا ﴿أَحْبَارَهُمْ﴾ جمع حَبر وقيل: جمع حِبر وكلاهما صحيح ورجح بعض أهل العلم الكَسر أي حِبر، وعلى كلٍّ كلاهما صحيح حَبر وحِبر كلاهما يدل على العالم. وقوله: ﴿وَرُهْبَانَهُمْ﴾ جمع راهب، والراهب هو العابد، ولماذا سمي العابد راهبًا؟ لأن الحامل على العبادة هو الرهبة. قال: ﴿أَرْبَابًا﴾ جمع رب، والرب هو الخالق المالك الرازق المدبر، وهل جعل هؤلاء -والكلام في الخبر عن بني إسرائيل وعن أهل الكتاب، هل جعل هؤلاء- الأحبارَ والرهبانَ يملكون ويرزقون ويدبرون ويخلقون؟
الجواب: أنهم لم يجعلوا الأحبار والرّهبان على هـٰذه الصفة من كل وجه، يعني: لم يثبتوا لهم جميع ما يتصف به الرب أو ما يختص به الرب، بل أثبتوا شيئًا مما يختص به الرب وهو الملك والتدبير، وبهـٰذا نعلم أنه لا يلزم في الشرك أن تجعل لله ندّاً من كل وجه، بل جعل الند لله -عز وجل- ولو من بعض الوجوه يصح وصفه بالشرك وأنه موجب للخروج من الملة، فإن هؤلاء لم يعبدوهم من دون الله. ولذلك لما قرأ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذه الآية على عدي بن حاتم ماذا قال؟ قال: يا رسول الله! إنا لم نعبدهم. قال: ((ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم، ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟)) قال: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)). فجعل الطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله من الشرك المخرج عن الملة، وجعله عبادة لغير الله. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف باب مستقل لبيان هـٰذا النوع من الشرك وهو شرك الطاعة.
ولكن اعلم أن الطاعة التي تكون شركًا هي الطاعة في التحليل للحرام أو التحريم للحلال، وليست الطاعة في فعل المحرم أو ترك الواجب، فإنّ هـٰذه معصية من المعاصي لا توجب الشرك ولا الكفر. ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ ثم قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾( ) هـٰذا الشّاهد في أن ما فعلوه شركا. ثم قال: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فنزه نفسه عن الشرك الذي أضافه إلى مَن؟ إلى هؤلاء الذين تقدم الكلام عنهم في أول الآية في قوله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾. إذاً الشيخ -رحمه الله- فسر التوحيد هنا بصورة من صوره، وهي إفراد الله تعالى بالطاعة في التشريع في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فإن ذلك حق لله، وقد قال الله جل وعلا: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾( ) فجعلوا ما لم يأذن به الله شرعًا من اتخاذ الشركاء.
واعلم أنّ الشرك في الطاعة له صلة بنوعي التوحيد: الربوبية والإلهية.
له صلة بالربوبية من حيث إنه لا يصدر إلا عن الرب المالك المدبر.
وله صلة بالألوهية أنه لا يتعبد به إلا للإله الرب المستحق للعبادة دون غيره.
فشرك الطاعة له صلة بتوحيد الإلهية، يعني: له صلة بانتقاص توحيد الإلهية وبانتقاص توحيد الربوبية، ويأتي إن شاء الله بيان هـٰذا وتفصيله في الباب الذي عقده المؤلف لذلك.
ثم قال: (وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾( ))، ﴿مِنْ﴾ هنا للتبعيض أي بعض الناس ﴿مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا﴾، ﴿يَتَّخِذُ﴾ أي يصير ويجعل. ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ﴿مِنْ﴾ هنا بيانية ويصح أن تكون زائدة، ﴿دُونِ اللَّهِ﴾ أي سواه وغيره، ﴿أَندَادًا﴾ جمع ند، والند تقدم تفسيره وهو المثيل والنظير والمساوي والكفء والمسامي ،كل هـٰذا مما يفسر به الند. قال: ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ الضمير في قوله: ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ يعود على من؟ على هـٰذه الأنداد، الواو واو الفاعل في (يحبون) عائد على من؟ إلى قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾، ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ الهاء يعود على من؟ على الأنداد ﴿كَحُبِّ اللَّهِ﴾ أي كمحبة الله، فحب مصدر مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعله أو مفعوله؟ مصدر مضاف إلى مفعوله، والمعنى: كمحبة الله. فجعلوا محبتهم لهـٰذه الأنداد والأمثال التي جعلوها لله واتخذوها من دونه كحبِّهم لله، هل هـٰذه الآية فيها إثبات أنهم يحبون الله؟ تحتمل، يحتمل أنهم جعلوهم كمحبة الله مع إثبات محبتهم لله، ويحتمل أنهم استعاضوا بمحبتهم عن محبة الله – واضح؟ - يعني:
يحتمل أنهم أحبوهم مع الله وسووا بين الله وغيره في المحبة.
ويحتمل أنهم استعاضوا بمحبتهم عن محبة الله، فلم يحبوا الله وجعلوا محبتهم لهـٰذه الأصنام.
وهـٰذان قولان لأهل العلم في هـٰذه الآية، والذي يظهر أنهم سووا بين الله وغيره في المحبة، لا أنهم استعاضوا بمحبتهم عن محبة الله واستبدلوا بمحبة الله محبتهم، يعني: جعلوا محبة الله هي التي في قلوبهم وخلوا قلوبهم من محبة الله، المعنى الذي يظهر أنهم أحبوا الله ولكنهم وقعوا في شرك التسوية في المحبة. ودليل هـٰذا أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذكر عن الكفار في قوله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾( ) أي: يسوون، فذكر التسوية من هؤلاء. والتسوية هي أن يجعلوا مع الله مساويًا. وأيضًا قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في بيان كفر الكافرين وندمهم على ما كان منهم من تسوية الله بغيره: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98)﴾( ). فعُلم من هـٰذا أن هؤلاء سوّوا غير الله به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في أي شيء؟ في المحبة. فلمّا وقع منهم هـٰذا تشعبت قلوبهم وتفرّقت؛ لأن القلب وعاءٌ لطيف لا يستوعب هـٰذا التفريق والتشتيت، فلما كانوا كذلك فاقهم أهل الإيمان الذين أثنى الله عليهم بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ أشد حبّاً لله من أي شيء؟ من هؤلاء لله أم من هؤلاء لآلهتهم؟
قولان لأهل العلم، منهم - من العلماء - من قال: من هؤلاء لله. ومنهم من قال: من هؤلاء لآلهتهم. والذي يظهر أن المعنى أن الذين آمنوا أشدُّ حبّاً لله من هؤلاء لله، يعني: لما خلص هؤلاء محبتهم لله ووفروها عليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وله؛ كانت محبتهم أعظم من محبة هؤلاء المشركين الذين فرقوا قلوبهم في هؤلاء الأنداد – واضح؟ - وهـٰذا المعنى أقرب وأليق؛ لأن المقارنة والموازنة بين محبة المشركين لله وبين محبة المخلصين والموحدين لله، وليست المقارنة والموازنة بين محبة المشركين لآلهتهم ومحبة المؤمنين لله فالجهة منفكة، إنما الموازنة في شيء واحد وهو محبة هؤلاء وهؤلاء لله عز وجل، ولماذا كانت محبة أهل الإيمان أكمل وأعظم؟ ذكرنا السبب قبل قليل: لأنهم أخلصوا المحبة لله هـٰذا سبب. والسبب الثاني وهو مهم: أنهم كمل علمهم بالله، والقاعدة أن المحبة تابعة للعلم، فبقدر ما مع الإنسان من العلم بالمحبوب بقدر ما يكون معه من المحبة، فلما كمل علمُ أهل الإيمان بالله عز وجل عظمت محبتهم له وخلصت ولم يقابلها شيء من محبة هؤلاء الذين جمعوا أمرين: الجهل بالله حيثُ جعلوا له أندادًا، والتّشتيت لقلوبهم حيثُ فرّقوا قلوبهم بين هؤلاء الأنداد.
وهـٰذه الآية فسّر فيها المؤلف -رحمه الله- التوحيد بركنه العظيم الذي لا يقر ولا يستقيم إلا به، وهو إخلاص المحبة لله، فالمحبة أصل أصيل في تحيق التوحيد؛ لأن العبادة التي فرض الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على عباده والتي خلق من أجلها الخلق وأمر بإفراده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها لا تقوم إلا بنهاية المحبة ونهاية الذل، وهما المعبر عنهما في كثير من كلام شيخ الإسلام بـ: غاية المحبة وغاية الذل، فالغاية هنا بمعنى النهاية أي المنتهية.
ثم قال رحمه الله في تفسير التوحيد: (في الصحيح عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله، وكفر بما كان يعبد من دون الله حرُم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل))).
قوله: ((مَنْ)) هـٰذه شرطية، وذكر بعدها فعل الشرط وهو قول: ((لا إلـٰه إلا الله)) وعطف عليه الكفر بما يعبد من دون الله فقال: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله)) أي أتى بالتوحيد. وقول: ((لا إلـٰه إلا الله)) يتضمن الإقرار للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالرسالة؛ لأنه لا تتحقق هـٰذه الكلمة لأحد إلا بالشهادة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة، ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا: أشهد أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنه كما لو قال: لا إلـٰه إلا الله، ومن قال: لا إلـٰه إلا الله، فإنه يتضمّن هـٰذا شهادته للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرِّسالة، ولذلك لا يشكل أنه لم يذكر الإقرار للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق هـٰذه الكلمة إلا من طريق النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وذلك يتضمن الإقرار له بالرِّسالة.
ثم قال: ((وكفر بما يعبد من دون الله)) هـٰذا فيه قيد زائد على ما تقدم، فـ((لا إلـٰه إلا الله)) فيها إثبات العبادة لله عز وجل، وتتضمن أيضًا نفي العبادة عما سواه، لكنه أكّد هـٰذا النفي بقوله: ((وكفر بما يعبد من دون الله)) فذكر الكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما يعبد من دون الله يشمل كل من عُبد من دون الله أيّاً كان المعبود، ومهما كانت الطريقة التي سلكها العابد، ومهما كانت النسبة التي ينتسب إليها العابد، فيشمل الكفر بكل ملل الكفر المخالفة لدين الإسلام، وهـٰذان الوصفان والقيدان هما في كثير من آيات الكتاب وأحاديث رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من أصرح ما يكون في ذلك من كتاب الله -عز وجل- قوله جل وعلا: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾( ) الاستمساك بالعروة الوثقى هو الثبات على كلمة لا إلـٰه إلا الله، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جواب هـٰذا الشرط في هـٰذا الحديث: ((حرم ماله ودمه)) فذكر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جواب الشرط تحريم المال والدم، وهـٰذا في الحكم الدنيوي يحرم ماله فيكون ماله معصومًا، ويحرم دمه فيكون دمه معصومًا، أي: تثبت له العصمة في المال والدم، ولم يذكر العرض لأنه إذا حرم المال والدم فالعرض ثابت معهما، ولأن العرض قد يحرم حتى من الكافر. المهم أن عدم ذكر العرض هنا لكونه داخلاً في ثبوت تحريم المال والدم.
وأما ما يتعلق بالآخرة فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((وحسابه على الله عزّ وجل)). هـٰذا فيما يتعلق بالآخرة، أي: ما يكون في قلبه وما يكون من عمله بعد هـٰذا الإقرار إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، المجازاة والمحاسبة الأُخروية ليست إلينا، إنما الذي يرجع إلينا هو إجراء أحكام الدين بعصمة المال والدم لمن قال: لا إلـٰه إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، أما النار والجنة فهـٰذا إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم قال رحمه الله -بعد أن فرغ من هـٰذا الحديث الذي أفادنا أن التوحيد لا بد فيه من الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دونه-: (وشرح هـٰذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.)
(شرح) هو البيان والتفصيل. وقوله: (هـٰذه الترجمة) الترجمة الأصل فيها هو ما يعبّر به عن كلام الغير، وقد اصطلح أهل العلم على تسمية عناوين الفصول والأبواب بالترجمة لأنها تعبر وتفسر وتبين ما تضمنه الباب، فهي كالمترجم الذي يعبر لك ويبين لك كلام من لا تفهم كلامه.
يقول المؤلف رحمه الله: (شرح هـٰذه الترجمة) أي تفصيلها وبيانها (ما بعدها من الأبواب) وذلك أن المؤلف -رحمه الله- سلك في تفسير التوحيد الإجمال والتفصيل:
الإجمال ما تضمنه هـٰذا الباب من الآيات التي تمثل أصول التوحيد التي يرجع إليها.
وأما التفصيل فهو ما سيأتي في الأبواب القادمة.
واعلم أن المؤلف -رحمه الله- سلك في تفسير التوحيد في هـٰذا الباب تفسير التوحيد ببيان أصوله وبيان ما يضاده وينافيه، وذلك أن الشيء يتبين بالتفصيل والتوضيح له، وأيضًا يتبين ببيان ضده ومقابله، وقد قال الشاعر:
الضد يظهر حسنه الضد
..................................
................................
وبضدها تتميز الأشياء
والمؤلف سلك هذين المسلكين في تفسير التوحيد الإجمالي في هـٰذا الباب؟ نعم.
[المتن]
فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبيَّنها بأمورٍ واضحة.
منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هـٰذا هو الشرك الأكبر.
[الشرح]
يقول رحمه الله: (فيه) أي في هـٰذا الباب (أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة) لماذا كان تفسير التوحيد وتفسير الشهادة أكبر المسائل وأهمها؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بفهمه والكشف عنه، فالذي يقول: لا إلـٰه إلا الله. ولا يدرك معناها هل تنفعه؟ لا تنفعه. من قال: لا إلـٰه إلا الله. وسجد للصنم هل يكون قد حقق هـٰذه الكلمة؟ الجواب: لا. فلا تنفعه هـٰذه الكلمة، لكن ينفعه أن يعقل هـٰذا المعنى وأن يفهمه، وأن يترتب على هـٰذا العقل والفهم العمل، ولذلك قال: (أكبر المسائل وأهمها) يعني في هـٰذا الكتاب كله؛ لأنه لا يمكن أن يدرك التوحيد ولا يحقق إلا بفهمه والكشف عنه ، قال في البينات التي ذكرها في بيان التوحيد: (منها آية الإسراء)، وهي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾( ) (بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين من الأنبياء والملائكة وغيرهم، ففيها بيان أن هـٰذا هو الشرك الأكبر). ما هو الشرك الأكبر؟ دعاء الصالحين دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وكيف بين ذلك؟ بين ذلك أن الصالحين المدعوين من دون الله يتسابقون في القرب من الله عز وجل، وهم يعبدون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كما قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾.
[المتن]
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾( )، وبين أنهم لم يؤمروا إلا أن يعبدوا إلهًا واحدًا، مع أنّ تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعُباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
[الشرح]
يقول رحمه الله: (ومنها) أي من الآيات والبينات التي فسر بها التوحيد في هـٰذا الباب (آية براءة) وهي قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، (فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهًا واحدًا).
سؤال: هل أهل الكتاب مشركون؟ الله -عز وجل- يقول: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾( ) ففرّق -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بين أهل الكتاب وبين المشركين هـٰذا موضع. وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ...﴾ ( ) ثم قال: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾( ) ففرق بين المشركين وبين أهل الكتاب، هـٰذه من المواطن التي يقع فيها إشكال على بعض الناس.
فمنهم من يقول: أهل الكتاب مشركون مطلقًا، ومنهم من يقول: إنهم ليسوا بمشركين.
وهـٰذه الآية دليل على أنهم مشركون، وذلك أن الله عز وجل ختمها بقوله: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾( ) فحكم عليهم بالشرك. وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ قف ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾( ) لا تصل؛ لأنك إن وصلت يفسد المعنى. ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ أي: ومنهم من عبد الطاغوت، وعبادة الطاغوت كفر وشرك. الجواب: أنه لا يطلق على أهل الكتاب وصف الشرك مطلقًا، لا يمكن أن نقول: أهل الكتاب مشركون، ولا يمكن أن ننفي عنهم الشرك؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وصفهم بالشرك وفرق بينهم وبين المشركين، وذلك أن أهل الكتاب أصل دينهم التّوحيد، وإنما وقع الشرك في بعض أعمالهم كالذين قالوا: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ والذين قالوا: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾( ) والذين ذكر الله عنهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. فهؤلاء الشرك طرأ عليهم وليس من أصل عبادتهم ودينهم، بخلاف المشركين الذين عبدوا الأصنام من مشركي مكة وأهل الأوثان، فإن أولئك أصل دينهم الشرك بالله عز وجل والكفر. أما هؤلاء فأصل دينهم التوحيد وطرأ عليهم الشرك، فهـٰذه الآية فيها إثبات أن أهل الكتاب يوصفون بالشرك، لكنه شركٌ غير مطلق؛ لدلالة الآيات الأخرى.
(منها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾) فأشركوا من هـٰذا الوجه.
(وبين أنهم لم يُؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهًا واحدًا، مع أن تفسيرها) أي تفسير الآية، فالضمير يعود إلى الآية، (مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعُباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم) والمقصود بالطاعة في المعصية هنا الطاعة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام وليس مجرّد الطاعة في المعصية، يعني: في مخالفة أمر الله دون اعتقاد، فإن هـٰذا لا يكون من الشّرك الأكبر الذي يدخل في هـٰذه الآية، وسيأتي مزيد تقرير لهـٰذا -إن شاء الله تعالى- في الباب الذي عقده المؤلف لهـٰذا.
ثك قال:
[المتن]
ومنها قول الخليل -عليه السلام- للكفار: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾( ) فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هـٰذه البراءة وهـٰذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إلـٰه إلا الله فقال: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾( ).
[الشرح]
(ومنها قول الخليل) يعني من البينات التي فسر بها المؤلف -رحمه الله- الشهادتين والتوحيد أو الشهادة والتوحيد. (ومنها قول الخليل -عليه السلام- للكفار: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾) وذكرنا في تفسير هـٰذه الآية أنّ قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله وغيره أو يعبدون الأصنام والأوثان فقط؟ قولان لأهل العلم، المؤلف رحمه الله مشى على أنهم يعبدون الله وغيره، يعبدون مع الله غيره، يعني قال: (فاستثنى من المعبودين ربه) فيكون الاستثناء هنا استثناءً متصلاً، (وذكر سبحانه أن هـٰذه البراءة وهـٰذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إلـٰه إلا الله فقال: ﴿وَجَعَلَهَا﴾) أي كلمة التوحيد ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون﴾ وهـٰذا على كون الضمير عائداً إلى قوله: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾، وبعضهم قال: الضمير في قوله: ﴿وَجَعَلَهَا﴾ يعود على البراءة، فيكون قد جعل البراءة من أهل الشرك كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- أعم من جهة المعنى، وأن التي جعلها كلمة باقية في عقبه هي إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك.
ثم قال:
[المتن]
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾( ) ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبّاً عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!
[الشرح]
يقول: (ومنها يقول: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبّاً عظيمًا) وجه دلالة الآية على أن هؤلاء يحبّون الله حبّاً عظيمًا، من يبين وجه الدلالة في الآية؟ أنه جعل حب الله أصلاً وحب الأنداد فرعًا مقيسًا فقال: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾( )، فنظَّر وشبَّه ومثَّل حبّ هؤلاء بحب الله تعالى. ويمكن أن يقال من وجه آخر: إنه وازن بين محبتهم ومحبة المؤمنين، لكن الوجه الأول أقوى.
ثم قال: (ولم يدخلهم في الإسلام)؛ لأنهم أشركوا في المحبة. وهـٰذا يفيد أنه مهما كان الإنسان عابدًا لله إذا كان يقع في الشرك فإنه لا تنفعه هـٰذه العبادة مهما عظمت ومهما كبُرت. يقول: (فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!) يكون أعظم شركًا وكفرًا.
[المتن]
ومنها قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله)) وهـٰذا من أعظم ما يبين معنى (لا إلـٰه إلاّ الله)، فإنه لم يجعل التلفّظ بها عاصمًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله، فإن شك أو توقّف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!.
[الشرح]
هـٰذا الكلام الأخير واضح؟ نعم -والله تعالى أعلم-.
ثم بعد هـٰذا الباب شرع المؤلف رحمه الله في بيان التوحيد مفصّلاً، وابتدأه بالشرك الأصغر في قوله: (باب من الشرك)، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس السابع
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
بابٌ من الشرك لُبْس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
وقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾( ) الآية.
وعن عمران بن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر فقال: ((ما هـٰذه؟)) قال: من الواهنة. فقال: ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) رواه أحمد بسند لا بأس به ( ) .
وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)) وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))( ) .
ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلاً في يده خيطٌ من الحُمى فقطعه وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾( ).
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب من الشرك لبسُ الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هـٰذا الباب هو أول الأبواب التي شرع فيها المؤلف -رحمه الله- بشرح الشهادتين، بشرح التوحيد شرحاً مفصلاً؛ لأنه في الباب السابق بعد أن ذكر التّفسير المجمل للتوحيد قال رحمه الله: (وشرح هـٰذه الترجمة ما بعدها من الأبواب).
وبدأ المؤلف -رحمه الله- بشرحه لنوعٍ من الشرك وهو الشرك المتعلق بالأسباب؛ لأن الشرك منه ما يتعلق بالأسباب، ومنه ما يتعلق بالألفاظ، ومنه ما يتعلق بالإرادات.
وبدأ المؤلف -رحمه الله- بشرك الأسباب:
لكونه منتشراً كثيراً في الناس، وإن كان غيره من الشرك كثيراً؛ لكن الشرك في الأسباب يظهر أنه أكثر من غيره، هـٰذا من وجه.
وأيضاً أنه يخفى ملحظ الشرك فيه لاسيما فيما يتعلق بالركون إلى الأسباب على كثيرٍ من الناس فيختلط عنده الأمر حيثُ يجعلُ من أخذ الأسباب الركون إليها، ومعلوم أن الركون إلى الأسباب شرك.
والمؤلف -رحمه الله- في هـٰذه الترجمة لم يبيِّن مرتبة الشرك ومنزلته؛ بل أطلق القول فقال: (بابٌ من الشرك) ولم يبيِّن هل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟
وذلك أن (لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه) يحتمل أن يكون شركاً أكبر، ويحتمل أن يكون شركاً أصغر، والفارق بين الأمرين ما يقوم في قلب العبد.
وهـٰذه خذها قاعدة: أن كل شركٍ أصغر قد يكون أكبر باعتبار ما يقوم بقلب صاحبه وقصده( ) فالشرك الأصغر قد يرتفع إلى درجة الشرك الأكبر مع أنه مساوٍ للشرك الأصغر في الصورة، والذي رفعه ونقله إلى المرتبة العليا ما قام بقلب صاحبه.
فقول المؤلف رحمه الله: (بابٌ من الشرك) يحتمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والفارق بينهما أيش؟ القصد وما يقوم بقلب صاحبه.
قوله رحمه الله: (لُبس الحلقة والخيط) اللُُّبس هنا بمعنى التعليق، سواء كان في اليد، أو في العنق أو على الثياب.. أو غير ذلك من المواضع. والحلقة معروفة. والخيط معروف.
قال: (ونحوهما) أي مما يشبهما من المعلقات كالودع والصدف وغير ذلك مما يعلق للغاية في قوله: (لرفع البلاء أو دفعه) والرفع: هو الإزالة بعد النزول. والدفع: هو المنع قبل الحصول. والبلاء: يشمل الأمراض والأسقام والكوارث والعين وكل ما يتضرر به الإنسان في ماله أو بدنه.
هـٰذه هي الترجمة لهـٰذا الباب.
مناسبة هـٰذا الباب لما قبله واضحة، أنه شروعٌ في الشرح التفصيلي للتوحيد.
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه مما يناقض التوحيد، ومما يخلُُّ بالتوحيد إما إخلالاً كليّاً أو إخلالاً جزئيّاً.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب عدة نصوص فبدأ بالأدلة من الكتاب فقال: (وقول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾( )) هـٰذه الآية أمر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالقول فقال: ﴿قُل﴾ مبلغاً لهؤلاء المشركين ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾، ومعنى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني، وهـٰذه صيغة تتكرر في القرآن، وهو تفسير لها باللازم؛ لأن الاستفهام هنا عن الرؤية التي ينبني عليها الخبر، فالاستفسار والسؤال في الحقيقة عن الخبر.
﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ﴿مَا﴾ هنا موصولة أي الذي تدعون من دون الله، والدعاء –تقدم الكلام عليها- هنا يشمل: دعاء العبادة، ودعاء المسألة.
﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ﴿مِنْ﴾ تقدم الكلام فيها وأنها إما بيانية أو زائدة، ﴿دُونِ اللَّهِ﴾ أي: سواه.
﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾، ﴿إن﴾ شرطية ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ والضر هنا يشمل كل ضرر. واعلم أن الضُّر والضَّر يختلفان في المعنى، فالضُّر يراد به الضرر النازل على البدن، وأما الضَّر –بالفتح- فهو كل ضرر في البدن وغيره، فأيهما أعم؟ ما كان مفتوحا (الضَّر). لكن إذا لم يجتمعا فيذكر أحدهما ويراد به الآخر .
﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ يشمل كل ضرر؛ لأن ضُر نكرة في سياق الشرط فتعم كل ضرر في البدن أو غيره.
﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ هـٰذا جواب الشرط، وهو جملة استفهامية المراد بها نفي النفع، أي إنّهُن لا يكشفن الضُّر الذي قدره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- وأنزله.
وقوله: ﴿كاشِفَاتُ﴾ وكاشفات جمع:كاشفة، وأصله الكشف وهو الإزالة والرفع، ويشمل في الحقيقة الكشف هنا الإزالة بالرفع والإزالة بالدفع؛ لأن الجميع كشف. أما في حال النزول فهو كشفٌ ظاهر؛ لأنها إزالة لنازل، وأما الدفع فهو أيضاً إزالة؛ لأنه دفعٌ لقادم فتشمل الآية دفع الضُّر ورفعه.
﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ أي أو أراد الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- عبده برحمة، ويشمل كل خير يصل إلى العبد، فالرحمة هنا المراد بها كل خير يصل إلى العبد في دين أو في دنيا أو في غير ذلك.
﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ أي: مانعات، ﴿رَحْمَتِهِ﴾؟ الجواب: لا، فالاستفهام هنا أيضاً لنفي قدرة هؤلاء المدعوين على دفع الضُر أو إمساك الخير .
ثم بعد أن قرر هـٰذين الأمرين وهما أن ما يدعى من دون الله ويقصد مهما كان في جلب خير أو دفع ضُر لا يحصل الإنسان منه مقصوده ولا ينال مطلوبه، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ:﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ فأمر الله -عز وجل- رسوله بأن يعلم هؤلاء إلى من يلجؤون ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ والحسب هو الكفاية وهنا يشمل الحسب دفع الضُّر وجلب الخير، وقد ذكر الله -عز وجل- الحسب وهو الكفاية في جلب الخير وفي دفع الضر:
في جلب الخيركما في قوله سبحانه: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾( ).
وفي دفع الضرر في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾( ) فهنا الكفاية في دفع ضرر وشر.
وفي هـٰذا الموضع تشمل المعنيين الدافع للضرر والرافع، وتشمل أيضاً الجلب للخير: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ أي إنما تتم الكفاية به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- في حق من صدق في توكله ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ فيحصِّلون ما ذكره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- من الكفاية.
هـٰذه الآية مناسبتها للباب واضحة:
فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- قطع العلائق كلها، فلا سبيل لتحصيل نفع أو دفع ضُر إلا من طريقه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- وكل من رجا جلب خير ودفْع سوء من غير طريقه فإنه لا يحصِّل ما يريد؛ بل لو حصل له ما يريد فإنما يحصل له فتنة واستدراجاً ، وإلا فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- بيده الخير لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
هـٰذه الآية هل هي في الشرك الأصغر أم في الشرك الأكبر؟
الأصل أنها في الشرك الأكبر؛ لأن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، وهنا قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فيشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ لكنها تشمل أيضاً الشرك الأصغر حيث إنها توافقه في المعنى؛ لأن الذي يلبس الحلقة ويلبس الخيط ويلبس الودع والصدف والحديد وما أشبه ذلك من الملبوسات لدفع البلاء أو رفعه يرجو نفعاً أو رفع ضُر، فهو مشابه لهؤلاء الذين توجّهوا بالعبادة لغير الله؛ لأنه قصد غير الله في تحقيق مطلوبه الأمن من المرهوب؛ لكنه لا يحصّل لأنه لا يمنع ولا يدفع إلا رب العالمين -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- فالشرك الأصغر داخل فيها بالمعنى العام، وإلا فالآية مسوقة في إنكار الشرك الأكبر؛ لكن اعلم أن الآيات التي فيها ذم الشرك الأكبر يستدل بها في ذم الشرك الأصغر وذلك:
من حيث النقل: لأن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- استدلوا بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر.
ومن حيث النظر:
• لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، ووسيلة الشيء تأخذ حكمه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
• أن الاستدلال بآيات الشرك الأكبر في التحذير من الشرك الأصغر يفيد التنفير والتعظيم؛ لأن الشرك خطره كبير.
ثم قال رحمه الله: (وعن عمران ابن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر)، (حلقة) حلقة أشبه ما يكون بأسورة أو ما أشبه ذلك أدارها على يده .(من صُفر) أي من نحاس، فقال: ((ما هـٰذه؟)) أي: ما الذي جعلك تضع هـٰذا في يدك؟ (قال: من الواهنة)، (من) هنا للسببية، أي: وضعتُها بسبب الواهنة، والواهنة: مرض يصيب الإنسان يهن به بدنه ويضعف.
فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((انزعها)) أمرها بنزعها، والنزع هو الخلع والمفارقة، ثم بعد أن أمره بالنزع بين له علة ذلك فقال: ((إنها لا تزيدك إلا وهناً)) أي: إلا ضعفاً؛ وذلك أن الشرك أعظم ما يضعف به القلب، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ بماذا؟ ﴿بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً﴾( ) فجعل من أعظم أسباب الرعب في قلوب الكفار ما هم عليه من الشرك، وهـٰذا وجه قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنها لا تزيدك إلا وهناً)) لأنها تضعف القلب، وبهـٰذا نعلم أن الشرك لا يحصل به المطلوب مهما كان، حتى ولو جنى ثماراً قريبة فما هي إلا استدراجٌ، فإن عاقبة ما يحصله وهنٌ وضعفٌ في قلبه ويشهد لهـٰذا ما قصّه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- في كتابه عن أقوام كانوا يعوذون برجال من الجن: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾( )، واذكر دائما قول الله تعالى: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ فالباء هنا للسببية، فالكفر والشر من أعظم أسباب ضعف القلوب.
بعد أن بيّن له النتيجة والثمرة الدنيوية انتقل إلى بيان الثمرة الأخروية للشرك فقال: ((فإنك لو مِت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) نفى عنه الفلاح الأبدي، والفلاح المنفي هنا هو: إدراك المطلوب؛ والأمن من المرهوب، وأصل الفلاح هو الفوز بما يطلب.
نفى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الفلاح عنه في وهـٰذا الحديث، وهـٰذا يناسب أن يكون الرّجل قد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه هو الذي ينتفي به الفلاح كليّاً أبديّاً ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾( ) هـٰذا في الشرك الأكبر ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾،( ) أما الشرك الأصغر فإنه دون ذلك فالفلاح، المنفي فلاح نسبي؛ لأنه إذا عُوقب على شركه آل إلى الجنة وكان من المفلحين بعد التمحيص والتنقية والتطهير.
فلماذا نفى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الفلاح الكلي في قوله:((ما أفلحت أبداً))؟
قال العلماء: لعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علم من حاله أنّ هـٰذا الرجل يعتقد أن الخير صادر عن هـٰذه الحلقة التي في يده، وأن دفع الشر منها، ولا شك أن اعتقاد ذلك شركٌ أكبر بالله رب العالمين. لأن لابس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يلبس ذلك معتقدا أنها سبب لجلب الخير أو رفع البلاء أو دفعه. وفي هـٰذه الحال يكون شركه من الشرك الأصغر لأنه من شرك الأسباب الذي هو التفات إلى السبب.
الحالة الثانية: أما إذا كان يعتقد أن الحلقة أو الخيط أو ما علقه يدفع عنه الشر بنفسه ويجلب إليه الخير بنفسه، هـٰذا شركه أكبر، وهو شرك في الربوبية، فهو أثبت خالقا مدبرا غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ فيكون بذلك من الشرك الأكبر.
وهـٰذا معنى الكلام الذي ذكرناه في أول الدرس، عند كلامنا على الترجمة أنه يحتمل أن يكون من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، بناء على قصد الفاعل وما قام في قلبه.
ثم قال رحمه الله: (رواه أحمد بسند لا بأس به ) الحديث تكلم فيه جماعة من المحدثين، وذهب كثيرٌ منهم إلى ضعفه، إلا أن الحديث جاء من عدة طرق وأقل ما يقال فيه: أنه صحيحٌ موقوفٌ على عمران بن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وعمران من الصحابة إلا أن الحديث رواياته متعددة تشهد لثبوته، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (بسندٍ لا بأس به) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ثم قال: (وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً) أي الإمام أحمد، (مرفوعاً) أي يبلغ به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له))، ((تميمة)): على وزن فعيلة بمعنى متممة مفعلة، كـ(نذير) بمعنى (منذر). والمقصود بها: ما يعلقه الإنسان، فالتميمة في لغة العرب أصلها: القلادة؛ لكن هـٰذه القلادة لها معنى فهي تتمم نقصاً في الحُسن إذا كانت قلادة في التجمل كالتي يضعها النساء، وتتمم -بزعم صاحبها- ما قصُر من عافيته وصحته إن كان قد علقها طلباً للشفاء، أو دفعاً للعين؛ ولذلك سميت تميمة، فهي اسمٌ لكل ما يعلق لجلب خير أو دفع شر.
((من تعلق تميمة فلا أتم الله له)) هـٰذا دعاء أو خبر؟
يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر، والمقصود: أي أن الله لا يتم له صحته وعافيته ومقصوده ومطلوبه؛ لأن هـٰذا الذي علق التميمة يريد بهـٰذه التميمة تتميم ما نقص من الصحة والعافية، فعاقبه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- بنقيض مقصوده وبخلاف مراده، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فلا أتم الله له)).
((ومن تعلق ودعة)) والودعة: هي خرز أبيض يخرج من البحر كانوا يعلقونه يشبه الصدفة، قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فلا ودع الله له)) أي: من تعلق الودع فلا تركه الله بعافية وصحة.
وهـٰذه الرواية جاءت بهـٰذه الصيغة ((من تعلق)) وفي بعض الروايات ((من علق)) أيهما أبلغ ؟
((من تعلق)) أبلغ، لأنها وتفيد تشير إلى نوعين من التعلق:
• التعلق الحسي.
• والتعلق المعنوي.
التعلق الحسي: بوضعها على الصدر أو في اليد أو في أي موضع من البدن.
والتعلق المعنوي: أن يعلق قلبه بها في جلب الخير أو دفع الضُّر .
حكم تعليق الودع شرك أصغر أم شرك أكبر؟
الجواب: يحتمل أن يكون شركاً أكبر، ويحتمل أن يكون شركاً أصغر، فالعبرة هنا بالقصد وما يكون في قلب المعلق، إن كان قد علق ذلك على أن الودع يجلب بنفسه الخير ويدفع بنفسه الضُّر فهو شركٌ أكبر، وإن كان علقه يرجو به كسبب لتحصيل دفع الضُّر وجلب الخير فهو شرك أصغر.
ثم قال: (وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك)) ) في الرواية السابقة خبر بعدم حصول المطلوب، وهنا حكم على هـٰذا الفعل؛ فإنه وإن كان الحكم يستفاد من ذاك؛ لكن هنا فيه التصريح بمرتبة المعصية؛ لأنه قد يكون تعليق التميمة من الكبائر، وقد يكون من المعاصي؛ لكن لما قال: فقد أشرك، تبين أنه ليس من جملة المعاصي؛ بل هو من الشرك والشرك ظلمٌ عظيم.
((من تعلق تميمةً فقد أشرك)) ولم يبين أي نوع من أنواع الشرك لأن الشرك هنا فيه تفصيل: يحتمل أن يكون شركاً أصغر ويحتمل أن يكون شركاً أكبر على ما ذكرناه آنفاً.
هـٰذا الحديث حديث حسن برواياته ولم يتكلم عليه الشيخ رحمه الله؛ لأن الطعن فيه أقل من الحديث الذي قبله.
(قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة) ابن اليمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُما (أنه رأى رجلاً في يده خيطٌ من الحُمى فقطعه وتلا قوله: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾( )) هـٰذا الأثر فيه الإنكار الفعلي على من علق خيطاً أو غيره في دفع بلاء أو رفعه، فإنّ هـٰذا الرجل علّق الخيط في يده من أجل دفع فقوله: (من الحُمى)، (من) هنا للسببية (فقطعه وتلا) أي قطعه حذيفة وتلا قوله: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ هـٰذا قاله الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- في بيان حال المشركين شركاً أكبر.
﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ وذلك أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك، وأنه هو الذي يرجع إليه في تدبير أمر الكون مع ذلك كان يقع منهم الشرك فيصرفون العبادة لغيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- فقال –سبحانه- في بيان حالهم: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ﴾ أي لا يؤمن بأنه رب العالمين الذي يستلزم أن يكون الإلـٰه المستحق للعبادة دون غيره ﴿إلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ أي إلا ويقعون في الشرك، وهـٰذه في الشرك الأكبر، واستدل بها حذيفة على نوع من الشرك الأصغر، وذلك أن الآية تشمل نوعي الشرك؛ فقوله: ﴿وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
وهـٰذا الأثر تكلم فيه من حيث صحته؛ ولكنه على كل حال يستأنس به ويشهد له ما تقدم من الأحاديث.
ثم قال رحمه الله:
[المتن]
وفيه مسائل:
الأولى: التغليظ في لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
[الشرح]
قوله: (التغليظ) حيثُ قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) وهـٰذا تغليظٌ شديد في هـٰذا الأمر، وهو حريٌّ بهـٰذا التغليظ؛ لأنه إما أن يكون مخرجاً عن الملة أو يكون طريقاً ووسيلة للخروج من الملة.
[المتن]
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
[الشرح]
وهـٰذا لا إشكال فيه أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ويدلك لهـٰذا أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- منع المغفرة في الشرك، وتقدم أن من العلماء من يجعل الشرك الأصغر من الشرك الذي لا يدخل تحت المغفرة، ثم إن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- وصف الشرك بأنه ظلمٌ عظيم، وهـٰذا الوصف يصدق على جميع صور الشرك وأنواعه، فهو أعظم من الكبائر مهما كانت.
وأما قوله: (أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح) ذلك أن الرجل الذي رأى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليه هـٰذه الحلقة من الصحابة، فدل ذلك على أن الشرك خطره جسيم يحبط العمل حتى لو كان العمل في جملته صحبة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
[المتن]
الثالثة: أنه لم يُعذر بالجهالة.
[الشرح]
يشير في هـٰذه المسألة إلى حديث عمران بن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وفيه: (أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر فقال: ((ما هـٰذه؟)) قال: من الواهنة. فقال: ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا))) ثم قال: (((فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً))) وهـٰذا وجه قوله -رحمه الله: (أنه لم يُعذر بالجهالة) لأن ظاهر الحال أن هـٰذا الرجل جهل الحكم ومع ذلك لم يعذره؛ بل قال:((إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)).
وهـٰذا الظاهر من هـٰذا الحديث لا يمكن أن نجعله قاعدة عامّة في مسألة العُذر بالجهل؛ وذلك أن الجهل نوعان:
نوعٌ: لا يُعذر معه صاحبه وهو الجهل الناتج عن تفريط في تحصيل ما يجب تعلمه.
النوع الثاني من الجهل: هو الجهل الناتج عن عُذر إما لقرب إسلام أو نشوءٍ ببادية، أو لكونه لا يدرك مثل هـٰذه المسألة.
فهـٰذه الأعذار وأمثالها لا يمكن أن نلغي العُذر فيها بالجهل مع قيام الأدلة من الكتاب والسنة على العُذر بالجهل:
قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾( ) فنفى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- المؤاخذة والتعذيب حتى يبعث رسولاً.
ومن السنة الحديث المشهور في قصة الرجل الذي أمر أولاده بأن يحرقوه ثم يذروه فلما جُمع قيل له: ما حملك على هـٰذا؟ قال: خشيتك، وقد قال في تعليل هـٰذا الفعل: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه لأحد، فشك في حصول القدرة( ).
المهم أن الأدلة كثيرة تدل على العُذر بالجهل، ولا يمكن أن يؤخذ حكم عام في مسألة خطيرة من مجرد حديثٍ واحد لاسيما أن الأحاديث الأخرى تعارض هـٰذا الحديث.
وأن عدم عُذر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذا الرجل بالجهل غير ظاهر في الحقيقة؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمره بنزعها فقال: ((انزعها)) ثم بين له حكم النزع أو بين له علة النزع فقال: ((فإنها لا تزيدك إلا وهناً وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) فهـٰذا بيان لحكم لُبس مثل هـٰذا، وهـٰذا الحكم إنما يثبت بعد العلم ولا ندري أن هـٰذا الرجل كان عالماً بالحكم أم لا، وكون الحكم يقرن بالعلة لا يلزم أن تثبت هـٰذه العلة قبل بلوغ الحكم.
وعلى كل حال فيمكن أن يقال في جواب هـٰذا: إنه قضية عين، إن سلمنا على عدم العُذر بالجهل فيمكن أن يقال بأنه قضية عين.
وأما بالنسبة للشيخ -رحمه الله- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإنه رحمه الله له نصوصٌ صريحة يُفهم منها ويُعلم أنه ممن يقول بالعُذر بالجهل، وكذلك أئمة الدعوة، ففي مؤلفاتهم وكلماتهم ما يدل على أنهم يعذرون بالجهل، وأن الجهل عندهم من موانع التكفير، ومن موانع إثبات حكم الكفر ولعل الله ييسر بسط هـٰذه المسألة في غير هـٰذا الموضع.
[المتن]
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضُر لقوله: ((لا تزيدك إلا وهناً)).
[الشرح]
هـٰذه المسألة أيضاً مأخوذة من مجموع الأحاديث، وإن كان المؤلف -رحمه الله- استدل لها من حديث عمران لكنها مأخوذة من الأحاديث كلها أما من حديث عمران فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فإنها لا تزيدك إلا وهناً)) ومن حديث عقبة فقوله: ((فلا أتم الله له)) ومن قوله: ((فلا ودع الله له))، فهـٰذه كلها تدل على هـٰذا المعنى وهو أن الشرك يضر صاحبه في الدنيا قبل الآخرة.
[المتن]
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك.
[الشرح]
واضح في أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أغلظ القول لهـٰذا الرجل، وكذلك حذيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وهـٰذه سنة نبوية في التغليظ؛ لكن ينبغي أن يُعلم أن التغليظ إنما يكون ممن يُقبل منه التغليظ، أما من لا يُقبل منه التغليظ كمن يكون من عوام الناس، أو ممن لا قبول له فإنه ينبغي أن يسلك معه جانب الرفق في تقرير ما يريد؛ لكن إن كان محل قبول واجتمعت عليه القلوب فتغليظه نافع؛ لأنه أبلغ في الزجر.
ولذلك ينبغي للإنسان أن يترفق فيما إذا كان من عوام الناس، لا يُرى له مكانة ولا يُعرف له قدر، ينبغي له أن يترفق في بيان الحق وأن لا يغلظ على الناس لأن الغلظة مدعاة للجفوة والرفض وعدم القبول، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في دعوته لقومه ولأمره كان في غاية الرفق مع ما هم عليه من شركٍ عظيم فهـٰذا ينظر فيه للحال وإلى حال الداعية وحال المدعو والحال التي تكون فيها الدعوة.
[المتن]
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وُكِل إليه .
[الشرح]
وهـٰذا يؤخذ من حديث: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له)) حيثُ إنه لما قطع تعلقه بقلبه وعلقه بهـٰذا لم يحصل له مقصوده، وإن كان هـٰذا الحديث لم يأتِ إلى الآن سيأتي في الباب القادم هـٰذا اللفظ (أن من تعلق شيئاً وكِل إليه) أليس كذلك؟ نعم لكن هـٰذا مأخوذ من ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعاً فلا ودع الله له)).
[المتن]
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
[الشرح]
وهـٰذا في رواية حديث عقبة بن عامر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وفيه الحكم في تعليق التمائم وأن من علق تميمة فإنه قد وقع في الشرك.
[المتن]
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
[الشرح]
وذلك في أثر حذيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وهو واضح.
[المتن]
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليلٌ على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
[الشرح]
إن الرجل الذي أنكر عليه حذيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ما كان منه إنما يظهر من فعله أنه علقه من سبب لا على أنه يحصل به المقصود استقلالاً، ومع ذلك قال له: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾( ) وهـٰذا الاستدلال كثير في كلام الصحابة، يستدلون بما ورد في الشرك الأكبر في إنكار ما يكون من الشرك الأصغر.
[المتن]
العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك.
[الشرح]
لقوله: ((من تعلق ودعاً فلا ودع له)) فدعاؤه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليه يدلّ على أنه لم يصب صواباً؛ بل إنما فعل ما لا يجوز له من تعليق قلبه بالشرك.
[المتن]
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي: لا ترك الله له.
[الشرح]
أي: لا ترك الله له الصحة والعافية والدعة والسكون كما تقدم هو في الشرح.
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنه كان مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض أسفاره فأرسل رسولاً ((أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت))( ).
وعن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) ( )رواه أحمد وأبو داود.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: ((من تعلق شيئاً وكِل إليه))( )رواه أحمد والترمذي .
التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العين والحُمة.
التولة: شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
وروي أحمد عن رويفعٍ قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجي برجيع دابة أو عظمٍ فإن محمداً بريء منه)).
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ".
[الشرح]
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد، واضحة وذلك أن كثيراً من التمائم ومن الرقى يكون فيها شرك فاحتاج المؤلف -رحمه الله- إلى بيان القول في ذلك .
أما مناسبة هـٰذا الباب للباب الذي قبله، فهو فبعد أن ذكر ما يتعلق بلُبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وتلك الأشياء مما لا شبهة فيه في عدم حصول المقصود بها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع وليس فيها متعلق إلا لمن سفه نفسه وعطّل عقله، أما في هـٰذا الباب فإنه ذكر الرقى والتمائم.
والرقى والتمائم: تعويذات وأقوال إما أن تقال أو تعلق فهي أخص من تلك التي لا تنفع؛ لأن منها ما هو نافع كالرقى، والتمائم أيضاً اختلف في حكم تعليقها.
اختلف أهل العلم في حكم تعليقها بينما لم يقع خلاف في عدم جواز تعليق الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. إذاً مناسبة هـٰذا الباب أنها بيان لما وقع فيه الخلاف من المعلقات والمتلوّات لدفع البلاء أو رفعه.
قال رحمه الله: (باب ما جاء في الرقى والتمائم) ولم يذكر حكمه! وذلك لأن الرقى ليست على نوع واحد، وقد اختلفت الأحاديث فيها فمنها ما يدلّ على جوازها ومنها ما يدل على تحريمها، فأطلق القول في الرّقى ليتبين من خلال ما يأتي، كذلك التمائم وقع الخلاف بين العلماء في حكم التمائم ولذلك أطلق أيضا المؤلف -رحمه الله- الكلام ولم يبين الحكم، بل أطلق القول فقال: (باب ما جاء في الرقى والتمائم).
والرقى: جمع رقية، وسيأتي تفسيرها في كلام الشيخ.
والتمائم: جمع تميمة، وسيأتي بيانها في كلام الشيخ وقد تقم أنها على وزن فعيلة، مفعلة أي متممة.
ساق المؤلف رحمه الله في هـٰذا الباب عدة أحاديث ابتدأها بقوله: (في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-)، والصحيح هنا: البخاري ومسلم فالحديث مخرج في الصحيحين .
(عن أبي بشير الأنصاري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنه كان مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض أسفاره) ولم يبين السفر وهل هو في غزوة أو في سفر عادي ؟ (فأرسل رسولاً) أي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)). الرسول المرسل مرسل بالتبليغ أم مرسل بالقطع –يعني بالفعل-؟ الظاهر أنه مرسل بالتبليغ، لأنه ورد في بعض الراويات (أرسل منادياً ينادي أن لا يبقين) وفي بعض الراويات (أرسل رسولاً ألا لا يبقين) وهـٰذه أداة استفتاح للكلام تدل على أنه أُرسل بالبلاغ.
وعلى كلّ حال المقصود أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اهتم بهـٰذا الأمر، وأرسل من يبلغ الناس منع ذلك، ((أن لا يبقين)) البقاء هو الدوام وعدم الزوال، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدمه في هـٰذا الأمر وهو ((أن لا يبقين في رقبة بعير قلادةٌ من وتر)) القلادة هي: ما يقلد به الشيء، والغالب أنها تطلق على ما يوضع في الرقبة ولكن في هـٰذه الرواية قال: ((أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر))، (من) هنا بيانية لتبين جنس القلادة، والوتر: هو وتر القوس، والغالب أن يصنع من أحشاء البهائم، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع القلادة من الوتر.
ثم قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أو قلادةٌ إلا قطعت))، ((أو)): هنا اختلف فيها الشراح على قولين:
منهم من قال: إنها للشك، شك الراوي، هل الإرسال كان بأمر قطع القلائد من الوتر أو القلائد من أي شيء كانت فقال: ((لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)) .
وقال آخرون: هي للتنويع ؛ فيكون من باب عطف العام على الخاص؛ لأن القلادة تعم القلادة من الوتر والقلادة من غيره؛ كالتي تكون من الخيوط والسيور وغير ذلك ويشهد لهـٰذا:
• أن الأصل عدم توهيم الراوي، هـٰذا من وجه.
• وجه آخر أنه في رواية أبي داوود جاءت الرواية بالواو، وهـٰذا يؤيد القول بأنها للتنويع .
وعلى القول هـٰذا لا إشكال.
وعلى القول بأنها للشك: فأي الأمرين أعم؛ هل قول: قلادة من وتر أعم من قول قلادة أو العكس؟ العكس أعم، فأيهما نعمل؟ نعمل الثاني؛ لأن به تبرأ الذمة واليقين حتى على القول بالشك.
فلا خلاف في الحقيقة سواء إن قلنا إنها للتنويع أو إنها للشك.
ثم حتى لو صحت الرواية بأن الذي ورد هو قوله: ((لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت)) لقلنا: غير الوتر يلحق به في الحكم؛ لأن هـٰذا القول خرج مخرج الغالب، فغالب ما كان يعلقه العرب في ذلك الوقت هو القلائد من وتر. ومعلوم أن ما خرج مخرج الغالب لا يقيد به الحكم؛ لأنه قيدٌ أغلبي.
وعليه فنقول: هـٰذا الخلاف لا ثمرة تحته لأنه على أي وجه حملت الحديث فتصل إلى نتيجة واحدة وهي تحريم المعلقات مطلقاً إذا كانت لدفع البلاء أو رفعه.
وعلى هـٰذا أيضا نقول: لو كان التعليق في غير الإبل كالخيول هل يأخذ الحكم ؟
نعم يأخذ الحكم، فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يبقين في رقبة بعيرٍ)) ليس قيداً بل هـٰذا وصفٌ أغلبي لا يقيد به الحكم .
والخلاصة: أن الحديث أفادنا تحريم تعليق التمائم مهما كانت وفي أي شيء وبأي شيء عُلقت؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أرسل يأمر بنزعها وإزالتها وعدم دوامها في قوله: ((ألا يبقين في رقبة بعيرٍ قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)) وهـٰذا يشهد لتحريم تعليق التمائم؛ لأن التميمة تشمل كل ما عُلق سواء كان مما كُتب فيه شيء أو مما لا يُكتب فيه شيء كما سيأتي في تعريفها.
ثم قال: (وعن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) رواه أحمد وأبو داود.) .
ذكر في هـٰذا الحديث ثلاثة أمور وجمعها في حكم واحد، وابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- نقل عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذا القول وهو: ((إن الرقى)) وهـٰذا يشمل كل رقية:لأن الألف والأم هنا للاستغراق هـٰذا أحد القولين. والقول الثاني: أن الرقى هنا المراد بها ما كان فيه شرك؛ لأنه دل الدليل على أن الرقى منها ما هو جائز؛ بل منها هو مندوب إليه .
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في الرقى بناء على اختلاف الأحاديث الواردة فيها، فالأحاديث منها ما يأمر بها، ومنها ما ينهى عنها.
فمن الأحاديث التي تأمر بالرقى كقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه)) وهـٰذا ندب إلى استعمال كل ما يحصل به النفع للأخ.
ومنها ما ينهى عنها: كحديث ابن مسعود .
فقال بعضهم في الجمع بين هاتين الطائفتين من الأحاديث: إن أحاديث النهي محمولة على النهي عن الرقى الشركية، وأما الأحاديث النادبة والمبيحة فهي في الرقى التي ليس فيها شرك .
وذهب بعضهم إلى الترجيح: فقال: إن أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث النهي. وقال بعضهم: أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة .
لكن هـٰذا القول ضعيف والصحيح أن يقال بالقول الأول وهو أن الأحاديث المطلقة التي فيها النهي عن الرقى ووصفها بأنها شرك المراد بها الرقى الشركية، أو الجواب الثاني يقال: إن ذلك منسوخ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سئل عن الرقى قال: ((اعرضوا علي رقاكم)) ثم أعطاهم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إباحة مقيدة بوصف فقال: ((لا بأس بها ما لم يكن شرك)) يعني ما لم يوجد شركٌ فيها فدل ذلك على الإباحة والاستثناء فقط فيما كان شركيا.
وكذلك في حديثٍ آخر عند الإمام مسلم: أن آل عمرو بن حزم سمعوا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن الرقية وكانوا يرقون فسألوه فقال: ((لا بأس بها ما لم يكن شرك)) فنهاهم عن الرقى الشركية، وأباح لهم الرقى التي ليس فيها شرك.
وبهـٰذا تجتمع الأحاديث فيكون قول ابن مسعود في هـٰذا الحديث أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن الرقى شرك)) المقصود بها الرقى الشركية.
وهنا قولٌ رابع: وهو جيد في الحقيقة، أن الرقى نهي عنها أولاً نهياً عاماً وذلك لما كان منتشراً عند أهل الجاهلية من الرقى الشركية، ثم بعد ذلك جاء الإذن في ما لم يكن فيه شركٌ من الرقى، وهـٰذا ليس ببعيد، وله نظير في نهي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن زيارة القبور في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أذن فيها لما فيها من المصلحة، فيكون الإذن بعد النّهي وهـٰذا قريب من القول الذي ذكرناه أن حديث الإباحة ناسخة للنهي؛ لكن هـٰذا بيان علته ونظيره، فيمكن أن يقال أن هـٰذا هو القول الأول الذي ذكرناه أن يقال أنه كان هناك نهي ونسخ بالإباحة، وهـٰذا وجهه.
ثم قال: ((والتمائم)) والتمائم: جمع تميمة وهي تشمل كل تميمة ؛ لأن الأصل انطباق هـٰذا الوصف على كل ما يصدق عليه من المعلقات، وأن المقصود بها: حصول تمام العافية بالسلامة من البلاء دفعاً أو رفعاً.
قوله: ((والتولة)): وأيضا ستأتي .
ثم قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الخبر عن هـٰذه الأمور الثلاثة: ((شرك)) وهـٰذا حكم يبين أن الرقى والتمائم والتولة شرك .
وقوله: ((شرك)) فيه إطلاق هل هو شرك أصغر أو شرك أكبر؟
فيه احتمال، وقد ذكرنا أنه في الأصل من الشرك الأصغر، وقد يرتقي إلى الأكبر باعتبار ما يقوم بقلب الإنسان وباعتبار قصده.
ثم قال: (رواه أحمد وأبو داود).
قال: (وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعا: ((من تعلق شيئاً وكِل إليه)) ) هـٰذا فيه أيضاً التحذير من تعلق القلب أو التعليق على البدن أو على الدابة أو على غير ذلك رغبةً في تحصيل النفع أو دفع الضُّر لقوله: ((من تعلق شيئاً وكِل إليه)) أي جُعل أمره إليه؛ ومعنى جُعل أمره إليه أي أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ- يكفُّ عنه فضله ورحمته وإحسانه وعنايته، بخلاف من توكل على الله، فإن من توكل على الله فهو حسبه كما قال الله جل وعلا: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾( ) أي كافية.
وقوله: ((شيئاً)) نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء يتعلق به القلب أو يعلق على الأشياء لأجل دفع البلاء أو رفعه؛ وهـٰذا يشمل التمائم بجميع أنواعها والمعلقات مما له معنى ومما لا معنى له لعموم قوله: ((شيئاً)).
قال: (رواه أحمد والترمذي).
ثم شرع المؤلف -رحمه الله- في بيان التمائم فقال: (التمائم شيء يعلق على الأولاد) وهـٰذا من المؤلف -رحمه الله- تعريفٌ للتمائم بالغالب، وإن كانت التمائم تعلق على الأولاد وعلى غير الأولاد؛ لكن هـٰذا التعريف بالمثال أو بالصورة أو بالغالب، وهـٰذا يجري في كلام أهل العلم كثيراً، ومنه قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أخوف ما أخاف عليكم الشِّرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: ((الرياء)) فعرّف الشرك الأصغر ببعض صوره، وهـٰذا جارٍ في كلام العلماء التعريف بالصورة أو بالمثال أو بما يغلب.
والتعريف العام للتمائم: هي كل ما يعلق لأجل دفع البلاء أو رفعه سواء كان المعلَّق له معنى كالأوراق والحروز التي يكتب عليها قرآن أو يكتب عليها ذكر أو يكتب عليها كلام له معنى صحيح، أو ما يكتب من الشركيات والطلاسم، أو ما لا يكتب عليه شيء كالودع والصدف والحِلق والخيوط وغير ذلك مما يعلق، كل ذلك يشمله معنى التميمة، فإن التميمة: ما يعلق رجاء دفع البلاء أو رفعه سواء كان على الأولاد أو على غيرهم.
قال: (من العين)، (من) هنا سببية أي بسبب العين والمقصود أنهم يعلقونها اتقاء العين، وإنما جرى ذلك لكون العين من أعظم ما يخشاه الناس على أنفسهم وأموالهم، وهو أثر خفي لا يمكن التحرّز منه بأسباب ظاهرة، فيلجؤون إلى هـٰذه الأسباب لدفع هـٰذا الضرر الخفي الذي يكون من حيث لا يشعر الإنسان؛ وهي تكون من العين وتكون من غيره؛ لكن ذكر العين هنا على وجه الغالب.
قال: (لكن إذا كان المعلق من القرآن) هـٰذا استثناء مما تقدم في تعريف التمائم، قال:(لكن إن كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) حكى المؤلف -رحمه الله- الخلاف فيما إذا كان المعلق من القرآن.
واعلم أن التميمة لا تخلو من أمرين:
إما أن تكون من القرآن أو الأدعية الصحيحة.
وإما أن تكون من غيرهما، وهـٰذا يشمل كما ذكرنا ما فيه شرك، وما فيه خفاء وعدم ظهور كالطلاسم والرسوم، وما فيه سحر، وأيضاً يشمل ما لا شيء فيه من المعلقات التي يعتقد فيها دفع البلاء أو رفعه.
أما القسم الثاني: وهو ما ليس من القرآن، فالإجماع منعقد على تحريمه، وأنه لا يجوز من الشرك لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) ولما أشبه ذلك من الأحاديث التي فيها التصريح بأن التمائم شرك.
وأما القسم الأول: وهو التمائم التي من القرآن وشبهه مما له معنى صحيح؛ فهـٰذه اختلف فيها العلماء على قولين:
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تعليقها:
• واستدلوا بالعموم في الأحاديث التي تنهى عن التمائم.
• واستدلوا أيضا آثار الصحابة المتقدمة في الباب الذي قبله، وفيها أنهم هتكوا المعلقات وأنكروها وعدوها من الشرك ولم يفرقوا بين القرآن وغيره.
• مما استدلوا به قالوا: إن التعليق طريقٌ للاستشفاء بالقرآن والاستشفاء بالقرآن موقوفٌ على من إليه بيان القرآن وهو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يبين هـٰذا الطريق من طرق الاستشفاء بالقرآن، ولم يقره كما أقر الرقى، وقال فيها: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه))، وقال للذي قرأ الفاتحة على أنها رقية: ((ما أدراك أنها رقية)) وبهـٰذا يبطل استدلالهم بعموم الأدلة التي فيها أن القرآن شفاء.
• الرابع قالوا: إن إجازة التعليق من القرآن وغيره مما له معنى صحيح يفضي إلى امتهان القرآن؛ لأنه لا يتحرز منه الإنسان دخولاً إلى الأماكن المكروهة كالحشوش وشبهها، وأيضاً لا يتحرز منه حال الجنابة وحال عدم الطهارة، ومعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر سواء كان القرآن كاملاً أو جزءاً منه كالمكتوب في ورقة معلقة.
• الخامس قالوا: إن منع التعليق هو من باب سد الذرائع أيضاً؛ لأنه لا يمكن التمييز بين التمائم الشركية والتمائم غير الشركية، فإجازة التمائم من القرآن تفضي إلى أن يُعلق غير القرآن مما فيه شرك فسد الذريعة التحريم.
ولكن عندنا أن هـٰذا الدليل الأخير لا حاجة إليه مع وجود النصوص الصريحة، لكن هـٰذا مما يعتضد به هـٰذا القول ولا يستقل في الاستدلال للحكم.
أما القائلون بالإباحة وهم جماعة العلماء قديماً وحديثاً:
• فقالوا: إن هـٰذا من الاستشفاء بالقرآن؛ والاستشفاء بالقرآن يشمل كل نوع من أنواع طلب الشفاء منه ما لم يرد تحريمه.
وقد تقدم الجواب على هـٰذا بأن بيان طريق الاستشفاء إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يبين هـٰذا الطريق هـٰذا واحد، وإن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- أنكروا على من استعمل هـٰذا الطريق فهتكوا التمائم وعمموا القول في المنع منها دون تمييز بين القرآن وغيره.
• دليلهم الثاني قول عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها: "إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده".
وهـٰذا في ثبوته عنها نظر. ومرادها أن التمائم المحظورة من الشرك هو ما يكون قبل نزول البلاء أما إذا نزل البلاء، فإنه لا مانع أن يستشكل الإنسان في التمائم التي من القرآن.
• الثالث مما استدلوا به ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حيث كان يعلق على أولاده الصغار الذين لم يبلغوا ألواحا فيها كتابة دعاء الفزع إذا استيقظ من النوم.
والجواب من وجهين:
الأول: أن في ثبوت هـٰذا عن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نظراً.
الثاني: لو ثبت فإنه لا يلزم من التعليق أنه أراد بذلك التميمة؛ لأنه لم تجر العادة بأن تعلق الألواح؛ لأجل الحرز والتتميم والحفظ، إنما يعلق معلقات صغيرة، وإنما مراده بتعليق الألواح أن يحفظوها، ولذلك في الأثر نفسه أنه كان يحفظها من بلغ من أولاده، ومن لم يبلغ علق لوحا في صدره قد كتب فيه ذلك، قال بعض الشّراح: وهـٰذا التعليق من أجل أن يحفظها لا لأجل أن يُحفظ بها.
وعلى كل حال الحديث لا يصح وهـٰذا يكفينا مؤونة الرد، عليه.
والراجح من هذين القولين: القول الأول، وأن التمائم لا تجوز مطلقاً لا من القرآن ولا من غير القرآن .
لكن هل من التمائم أن يكتب الإنسان شيئاً من القرآن على موضع من بدنه؟
بعضُ أهل العلم يرى أن هـٰذا من قبيل التميمة وعليه فإنه ممنوع.
وآخرون يقولون: لا؛ ليس هـٰذا من التمائم في شيء؛ لأن التمائم تعليق وهـٰذا ليس بتعليق، إنما هـٰذا كتابة لآيات جُرب نفعها في مواضع الألم أو المرض.
وهـٰذا القول الثاني هو الصحيح أن ذلك ليس من التمائم ولا بأس به؛ لأنه نظير النفث بالقرآن على موضع الألم، وكذلك نظير الكتابة في ماء وشربه، ثم إنهم لا يقصدون بالكتابة بقاء الكتابة، إنما يقصدون أن يكتب على الموضع الذي فيه الألم دون أن يبقى ذلك أو يزول، ولذلك لا يجدد الكتابة إذا زالت، وطمس الكتابة بحث أنها لم تقرأ ما ضر ذلك، هي ليست من قبيل الكتابة، وهـٰذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- وأنه لا بأس بذلك، مع أنه يقول بتحريم تعليق التمائم، يقول رحمه الله: (لا بأس بالكتابة في بعض المواضع كبعض الأمراض الجلدية التي جرب كتابة بعض الآيات للاستشفاء وإزالة المرض).
إذن عرفنا الخلاف في هـٰذه المسألة التي أشار إليها المؤلف في قوله: (ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.) ومنهم أيضاً عمران بن حصين، وحذيفة بن اليمان في الآثار السابقة؛ بل إنه لم يُعرف عن الصحابة قائل بالجواز ما عدا الأثر الوارد عن عبد الله بن عمرو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- على اختلاف في فهم المقصود بالتعليق، وعدا أيضاً ما ورد عن عائشة على القول بعدم صحته وثبوته عنها رَضِيَ اللهُ عَنْها.
قال: (والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العين والحمة)
الرقى:جمع رقية كما تقدم، وعرفها المؤلف رحمه الله هنا بقوله: (هي التي تسمى العزائم) وهو تعريفٌ لها بالاسم العرفي المشهور في زمن المؤلف -رحمه الله- وهي: عوذة يتعوذ بها، والمقصود بالرقية كلمات يرجى حصول دفع البلاء أو رفعه، سواءٌ قرئت في ماء، أو قُرئت مباشرة على المريض، أو كُتبت في إناء وشربها المريض كلها من قبيل الرقى.
قال رحمه الله: (وخص منها الدليل ما خلا من الشرك) خص منها الدليل في الإباحة؛ لأنه تقدم من الأحاديث ما يدل على أنها شرك، وعلى نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنها، ثمّ دل الدليل أيضاً على إباحتها؛ لكن بشرط ألاّ يكون فيها شرك، وذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما قيل له: إنك قد نهيت عن الرقى، قال: ((اعرضوا علي رقاكم)) ثم قال:((من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه))، وحديث آخر قال: ((لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)) فدل ذلك على جوازه بهـٰذا الشرط؛ وهو أحد الشروط التي لا بد من توافرها في الرقية، وهو أن تكون سالمة من الشرك.
يُشترط أيضاً في الرقية الجائزة أن تكون بألفاظ عربية أو بألفاظ مفهومة المعنى إذا لم تكن من اللغة العربية.
يشترط فيها أيضاً ألا تكون من ساحر ولا كاهن.
ويشترط فيها أيضاً أن يُعتقد فيها أنها سبب لرفع البلاء أو دفعه؛ لا أنها تدفع بعينها؛ بل هي من الأسباب -إن شاء الله- رفع بها البلاء أو دفعه، وإن شاء لم يفعل ذلك.
هـٰذه من الشروط التي لا بد من ملاحظتها في الرقية، ولا فرق في الرقية بين نزول البلاء، وبين كونها قبل نزوله فكلا النوعين جاءت به السنة.
أما من النوع الذي يكون قبل البلاء: فما ورد عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصحيحين أنه يجمع يديه فينفث فيهما ويقرأُ الإخلاص والمعوذتين كل ليلة ويمسح بهما ويمرهما على ما استطاع من رأسه وجسده ، فهـٰذا يدل على جواز ذلك قبل نزول البلاء.
وأما بعد نزوله: فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رقاه جبريل، ورقته عائشة في مرض موته، ورقاه الملكان لما سُحر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأمر بالرقية ورخص فيها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
كل هـٰذا يدل على جوازها بهـٰذه الشروط.
ثم قال: (فقد رخص فيه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العين والحُمة)، (من) هنا سببية، (العين) والمراد بالعين هنا: النظرة، وهي ما يصيب الإنسان بسببِ عين الحاسد، قال: (والحُمة) المراد بها السُّم، والمعنى من سُم اللوادغ حية أو عقرب أو غير ذلك فتشمل الرخصة الرقية من العين ومن الحُمة.
هل هـٰذا تخصيص بجواز الرقية بهما؟
الجواب: لا، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما عُرضت عليه الرقى قال: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل)) وقال: ((لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)) وهـٰذا يشمل الرقية من كل شيء، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رُقي من السحر، ورُقي في مرض موته مع أنه لم يكن به عين ولا حُمة. فالصحيح أنه تجوز الرقية من كل ما يصيب الإنسان من العين والحُمة وغيرهما.
أما قوله: ((لا رقية إلا من عينٍ أو حُمة)) المقصود بذلك أن لا دواء أنفع ولا رقية أدعى في حصول الشفاء من الرقية في العين والحُمة .
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (إن الرقية من أعظم وأنفع الأدوية لعموم الأدواء)، وذلك أن الرقية علاجٌ روحاني.
ومعلوم: أن علاج النفس أهم من علاج البدن؛ لأن النفس إذا قويت تتغلب بقوتها على وطأة المرض، بخلاف النفس الضّعيفة الواهية فإنه يتغلب عليها أدنى عارض ويعيقها عن النشاط والقوة، وهـٰذا السر في كون الرقى من أعظم أسباب الشفاء؛ لكن لا بد في الرقية من آلة قوية ومحلٍّ قابل؛ لا بد من فاعل قوي ومحلٍّ قابل، ثم هي سبب من الأسباب قد يكون به الشفاء وقد لا يكتب الله به الشفاء فيكون فيه أجر للقارئ الذي قرأ عليه.
ثم قال رحمه الله: (والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.)
يصنعونه ثم هل يعلق أو لا؟ هذا فيه احتمال، والظاهر أنه يعلق أو يوضع في الفرش أو ما أشبه ذلك، وبه نعلم أن التولة نوع من السحر؛ لأنه يحصل به إمالة الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها، وهـٰذا ما يسمى في السحر بالعطف، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب السحر.
قال: (وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه)).)
هـٰذا فيه خطاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لرويفع وإخباره بأن الحياة ستطول به، لكن لم يجزم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، بل أتى بحرف الترجية وهو قوله: ((لعل)) والمقصود منها الترجية، ترجية حصول ذلك. ((لعل الحياة تطول بك)) وهو الذي وقع، فإن الحياة طالت به -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
قال: ((فأخبر الناس أن من عقد لحيته)). وعقد اللحية إما يكون بربطها وإما بتنفيشها وتعظيمها، لا سيما ما كان يفعل في أيام الحرب لطلب العظمة والعلو.
قال: ((أو تقلد وترًا)). أي علَّق وترًا، ويشمل ذلك ما إذا تقلّده في نفسه أو ولده أو غيره من الناس أو الدواب أو غير ذلك من الأشياء، يشمل تعليق الوتر في أي شيء، والمقصود تعليقه لدفع البلاء أو رفعه.
قال: ((أو استنجى برجيع دابة أو عظم)).
((استنجى)): طلب النّجى، أي أزال أثر الخارج برجيع دابة وهو الروث، والدابة يشمل ما إذا كانت دابة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه: أما إن كان مما يؤكل لحمه ففيه إفساد لهذا الرّجيع على إخواننا من الجن، فإنه طعام دوابّهم. وأما إن كان من دابة مما لا يؤكل لحمها فإنه نجس كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لابن مسعود: ((إنها ركس)) لما أتاه بروثة.
((أو عظم)) كذلك؛ لأن فيه إفساد العظم على إخواننا من الجن. ويشمل هذا العظم عظم ما يؤكل لحمه وعظم ما لا يؤكل لحمه: أما عظم ما لا يؤكل لحمه فقيل: إنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، لكن لعدم حصول كمال الطهارة به. وأما إن كان مما يؤكل لحمه فإنه لإخواننا من الجن كما تقدم.
قال: ((فإن محمدًا بريء منه)).
((محمداً)) أي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ((بريء منه)) أي متبرئ منه، وبراءة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الشخص تدل على عظم الذنب، وهي من الصيغ المستعملة في بيان كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فإنّ الذنوب الكبيرة - أي الكبائر - هي ما توعد عليه بنار أو لعن أو عقوبة في الدنيا، وأضاف شيخ الإسلام رحمه الله: أو تبرأ منه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإن براءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تدل على أن الفعل كبيرة؛ لكن هل هـٰذا يعني أنه ليس من الشرك في قوله: ((أو تقلد وترًا))؟
الجواب: لا، إنما بيان لبراءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أصحاب هـٰذه الذنوب، ومنها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك.
ومعلوم أن البراءة من الشرك ليست كالبراءة مما دون ذلك، وإنما تجتمع هـٰذه الأشياء الثلاثة في كونها سببًا لبراءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأما وصف هـٰذا الذنب هل هو كبيرة أو شرك؟ فيعلم من بقية النصوص.
ثم قال: (وعن سعيد بن جبير قال: ((من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة)). رواه وكيع.)
قول سعيد رحمه الله: ((من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة)) جعله بعض أهل العلم من الآثار التي لها حكم المرسل؛ لأن هـٰذا مما لا يُحدَّث ويقال فيه بالرأي، إنما يتلقى من الأخبار. ويحتمل أن يكون هذا من رأيه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ لأنه في الحقيقة المعنى أن من قطع تميمة من إنسان فكأنما فكه أو فهو في الحقيقة قد فكه من الشرك الموبق الذي يماثل ويضارع ما لو أن الإنسان أعتق عبدًا في الدنيا، فإنه يعتق منه بكل عضوٍ عضوٌ من النار، فلا يظهر جليّاً أن هـٰذا مما لا يقال بالرأي؛ لأنّ المعنى في هذا ظاهر، وهو أنه فكه من النار لمَّا أنقذه من الشرك فكان كعدل رقبة، أي: فكما لو أعتق رقبة من النار فإنه يُعتق منه بكل عضوٍ عضوٌ من النار.
قال: (وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".)
(له) أي: لوكيع عن إبراهيم، وإذا أُطلق إبراهيم فالمراد به إبراهيم النخعي، وهو ممن تلقى عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، واشتهر أنه إذا قال: (كانوا) أو ما أشبه ذلك من الصيغ أنه يريد بذلك أصحاب ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، وذلك أن ابن مسعود -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تلقى عنه جمع من أهل العلم من التابعين، وصارت له مدرسة في الكوفة ينتسبون إليه ويأخذون برأيه في كثير من مسائل الأحكام، وابن مسعود من فقهاء الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-. فقوله: (كانوا يكرهون التمائم) يعني: أصحاب ابن مسعود، والتمائم تقدم الكلام عليها.
يقول: (كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن ومن غير القرآن). وقد تقدم أن التمائم نوعان:
التمائم التي من القرآن: هـٰذه التي وقع فيها الخلاف.
أما التي من غير القرآن: فقد تقدّم أنه لا خلاف في أنها لا تجوز وأنها من أسباب الشّرك، وأن لابسها قد يكون مشركًا شركًا أكبر، وقد يكون مشركًا شركًا أصغر حسب ما يقوم بقلبه.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الرقى والتمائم.
[الشرح]
وهـٰذا واضح في تفسير الشيخ رحمه الله وبيانه لمعنى الرقى ومعنى التمائم.
[المتن]
الثانية: تفسير التولة.
[الشرح]
وهـٰذا مثل الذي قبله.
[المتن]
الثالثة: أن هـٰذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
[الشرح]
(من غير استثناء) لأنه لم يستثن صنفًا منها أو نوعًا منها، والمراد بذلك حديث ابن مسعود: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)). وقد ورد الاستثناء في الرقى بأحاديث أخرى، وأما التمائم فلا دليل على الاستثناء، والتولة كذلك.
[المتن]
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
[الشرح]
وجه ذلك أنها قد استثنيت بالأحاديث الكثيرة الدالة على جواز الرقية بالكلام الحق من القرآن والذكر وغير ذلك من المعاني الصّحيحة السليمة التي لا شك فيها ولا شوب.
[المتن]
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟
[الشرح]
والجواب: أنّها من ذلك على الرّاجح عند أكثر أهل العلم وفي قول الجمهور، فإن جمهور العلماء على أن التّمائم التي من القرآن تدخل في النهي العام؛ لما تقدم من الأدلة التي ذكرها جمهور أهل العلم في منع التمائم مطلقًا.
[المتن]
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدّواب عن العين، من ذلك.
[الشرح]
تعليق الأوتار: تقدم أن الأوتار جمع وتر، ويشمل كل معلَّق على كل دابة.
من ذلك: أي مما ورد النهي عنه، ووجه هـٰذا، وجه أنه من المنهي عنه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أرسل من يقطع الأوتار المعلقة على الإبل، فإنّه أرسل رسولاً: أن لا يبقين في رقبة بعيرٍ قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت.
[المتن]
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا.
[الشرح]
وذلك في حديث رويفع، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد تبرأ منه.
[المتن]
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
[الشرح]
وهـٰذا في كلام سعيد بن جبير -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
[المتن]
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
[الشرح]
وهـٰذا واضح.
%%%%
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثامن
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما
وقول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى﴾( ) الآيات.
عن أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الله أكبر! إنها السنن، قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾( ). لتركبن سنن من كان قبلكم)). رواه الترمذي وصححه.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما).
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أنّ التبرك بهـٰذه الأشياء من الشرك، والشرك يناقض التوحيد ويقابله، فأتى المؤلف -رحمه الله- بهـٰذا الباب لبيان قادح من قوادح التّوحيد.
وأما مناسبته لما قبله: فإنه في الباب السابق والذي قبله أيضًا البحث كله في شرك الأسباب وهـٰذا منها، فإن التبرك بالشجر أو الحجر أو ما أشبههما من الشرك في الأسباب؛ لأنه جعل ما ليس بسبب في الشرع ولا في الحس سببًا، فهـٰذا وجه ارتباط هـٰذا الباب بما قبله.
ننظر إلى الترجمة: قال رحمه الله: (باب من تبرك بشجر)، عندكم شجرة أم شجر مفرد؟ وجهان، (من تبرك بشجرةٍ أو حجرٍ ونحوهما).
(مَنْ) هنا شرطية، وفعل الشرط: (تبرّك)، والفاعل لم يذكره وهو ضمير يعود على اسم الشرط المتقدم.
المهم، أين جواب الشرط؟ لكل شرط لا بد من جواب، فأين جواب الشرط في الترجمة؟
المؤلف -رحمه الله- لم يذكر جواب الشرط، وقدره بعض الشرَّاح فقال: فهو مشرك، فيكون جواب الشرط الذي تكتمل به الترجمة ويتم به الكلام: (من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) فهو مشرك. ولعل الشيخ -رحمه الله- لم يذكر جواب الشرط لأنه معلوم من النصوص التي ضمّنها الباب، فإن الشيخ -رحمه الله- ذكر في هـٰذا الباب آية وحديثًا يدلان على أن من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فإنه واقع في الشرك أو في أسبابه، ويتبيّن هـٰذا -إن شاء الله- تعالى من النصوص.
قوله رحمه الله تعالى: (من تبرك).
(تبرّك) على وزن تفعّل، وهـٰذا الوزن يأتي على أوجه كثيرة ومعانٍ عديدة، المقصود به هنا: من طلب البركة، أو من اتخذ الشجر والحجر لأجل البركة، فهو من باب الطلب أو من باب التصيير، التصيير يعني صير الشجر والحجر محلاًّ لأخذ البركة، أو للتبرك، وهـٰذا الوزن يصلح لهـٰذا ولهـٰذا، يعني: يصلح تفعل بمعنى الطلب وبمعنى التصيير، فهو يفيد أيضًا معنى الصيرورة.
طيب، قوله رحمه الله: (بشجر). وفي بعض النسخ (بشجرة).
الشجر معروف، والمراد به النبات الذي له ساق.
(أو حجر): أيضًا الحجر معروف.
قوله: (ونحوهما) أي: مما يشابه الشجر والحجر في كونه ليس مصدرًا لأخذ البركة، وهـٰذا يفيدنا إخراج ما دل الدليل على أنه يتبارك به وتؤخذ منه البركة، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قد جعل بعض عباده مباركًا، والبركة إما بركة ذوات أو بركة منافع وأعمال.
بركة الذّوات كبركة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه مبارك، ولذلك كان الصّحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- يتبرّكون به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبآثاره الحسّية كعرقه وبصاقه وما أشبه ذلك من شعر وغيره مما جاءت به النصوص، المهم أن قوله رحمه الله: (ونحوه) لإخراج ما يجوز التبرّك به، سواء كانت البركة بركة ذات أو بركة منفعة، لكن المنفي هنا بركة الذّات لا بركة المنافع، المنفي هنا أو الذي هو من الشرك هو إثبات البركة الذاتية للأشجار والأحجار، وقد جاءت النّصوص بإثبات البركة في بعض أنواع الشّجر، وذلك في قوله –تعالى- في سورة النور: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾( ). ﴿مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ فأثبت البركة لها، وكذلك يثبت الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- البركة لبعض الأماكن ولبعض الأزمان، ولكن هـٰذه البركة المثبتة ينبغي فيها أن يُتلقّى وجه التبرك من الشرع، وهـٰذا من الضوابط التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى- فيما يجوز التبرك به.
المهم أن قوله رحمه الله: (من تبرك بشجر –أو: بشجرة- أو حجر ونحوهما) المراد: نفي ما كان عليه المشركون من طلب البركة من هـٰذه الأشياء، وهو التبرك بذواتها واعتقاد أنها تنفع أو أنها أسباب لحصول البركة، ولم يثبت ذلك شرعٌ يُعمل به ويعتمد عليه.
وذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب آية وحديثًا:
أما الآية فقال رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾( ).) ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ هـٰذا استفهام، الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا للتعجيب والإنكار من حال هؤلاء الذين سووا هـٰذه المعبودات من الأصنام بالله رب العالمين وبعباده الصالحين، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذكر في أول السورة التي ذُكرت فيها هـٰذه الآية ما له من كمال وما يجب له من تعظيم، وذكر ملائكته وذكر رسوله البشري وهو محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما خصّه الله به، ثم بعد أن فرغ من ذكر ذلك كله جاء الخبر فيما يتعلّق بما يعبده أهل الجاهلية من الأصنام، فذكر ثلاثة من أعظم أصنامهم ومن أعظم معبودات العرب: ﴿اللاتَ﴾ وكانت الصنم المعظم عند ثقيف، ﴿وَالْعُزَّى﴾ وكانت الصنم المعظم عند قريش، ﴿وَمَنَاةَ﴾ وكانت الصنم المعظم لأهل المدينة، وكانت هـٰذه الأصنام تتفق العرب على تعظيمها، وإن كان كل واحد منها تختص به طائفة أو جهة من الجهات، وأعظم هـٰذه الثلاثة مناة، ولذلك خصه بالوصف دون غيره فوصفه بوصفين: ﴿الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾ وذلك لكونه أعظم هـٰذه المعبودات من الأصنام في ذلك الوقت، أما اللات والعزى فلم يصفهما هنا بوصف: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى﴾ ثم قال: ﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾ فوصفها بوصفين يدلان على تخصيصِها، وتخصيصُها وجهُه أنه مما اتفق العرب على تعظيمه تعظيمًا زائدًا على الصنمين السّابقين.
يقول الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مخاطِبًا هؤلاء المشركين: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ وهـٰذه الصيغة تتكرر، والأصل فيها طلب الرؤية والإخبار، ولذلك يفسرها كثير من العلماء بأخبروني: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى﴾ أي: أخبروني عن اللات والعزى، والرؤية هنا رؤية بصرية ورؤية علمية؛ لأن هـٰذا مما يدرك بالبصر ومما يدرك عاقبة عبادته بالعقل والعلم والبصيرة.
﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ﴾، ﴿اللاتَ﴾ رجل يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وأقاموا عنده صنماً، وقيل: إنهم عبدوا الحجر الذي كان يلت عليه السويق تعظيمًا لفعله واستذكارًا لحسن صنيعه، فوقعوا في الكفر بذلك، فإنهم طلبوا البركة من هـٰذا الحجر الذي لا يضرّ ولا ينفع، فوقعوا في الشرك والكفر الأعظم الذي قاتلهم عليه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فيكون قوله: ﴿اللاتَ﴾ دالاًّ على قوله: (من تبرك بحجر) فهو مشرك.
قوله تعالى: ﴿وَالْعُزَّى﴾.
﴿وَالْعُزَّى﴾: شجرة كانت تعبدها قريش، ويعبدها العرب لكن تختص قريش بتعظيمها، وكانت شجرة قريبة من عرفة، وهي التي أشار إليها أبو سفيان لما خاطب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد وقعة أُحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من يجيبه؟ )) فأجابه عمر فقال: الله أعز وأجل، الله أعز وأجل. قال أبو سفيان:اعلُ هبل! فقال النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((ألا تجيبونه؟)) قالوا: بم نجيبه؟ قال: ((قولوا: الله أعلى وأجل)). فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم!)).
طيب، وهـٰذا فيه الدليل على قوله: (من تبرك بشجر -أو بشجرة-)، فهؤلاء كانوا يأتون إلى هـٰذه الشجرة يتبركون بها، يذبحون عندها، يطلبون منها حوائجهم، ويعظمونها دون الله.
ثم قال: ﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾.
﴿وَمَنَاةَ﴾: هـٰذه أيضًا من معبوداتهم، وهو صنم يعبد من دون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ويطلب منه البركة، وذكرنا لكم وجه تخصيص مناة بقوله تعالى: ﴿الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾.
وقيل: إن هـٰذه الأسماء اشتقت من أسماء الله عز وجل فـ﴿اللاتَ﴾ مشتق من الإله، ﴿وَالْعُزَّى﴾ مشتق من العزيز، ﴿وَمَنَاةَ﴾ مشتق من المنان، هـٰذا في كلام كثير من المتأخرين.
يقول شيخ الإسلام: والمنان مشتق من (مَنَى، يمني) بمعنى (قَدِرَ، يقدر)، فهو مشتق من صفة القدرة لا من صفة المن، وهـٰذا قليل من ينبه عليه.
والمقصود أنهم اشتقوا لهـٰذه الأصنام، الأوثان التي لا تضر ولا تنفع، اشتقوا لها من أسماء الله وأوصافه ما جعلوه لها أعلامًا عليها، ثم اعلم أن هـٰذه المعبودات زعم هؤلاء أنها أو أنهم إناث، ولذلك قال الله تعالى: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى﴾( ).
وهـٰذا فيه التقبيح لصنيع هؤلاء، حيث نسبوا لله -عز وجل- ما يكرهون نسبته لأنفسهم كما قال الله عز وجل: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾( ). فجعلوا لله عز وجل البنات، وكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، فعاب عليهم بقوله: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى﴾. في الآية التالية قال: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾( ). أي قسمة جائرة غير عادلة أن ترضوا لأنفسكم بالكمال ولربكم المستحق لغاية الكمال ترضون له ما تكرهون أن تنسبوه لأنفسكم وأن يكون لكم، والشاهد من هـٰذه الآية قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾ وهو أنهم جعلوا هـٰذه الأصنام من الأحجار والأشجار محلاًّ للتبرك بطلب الخير منها، والذبح لها وتلقي ما يظنونه أنه يأتي من قِبلها من الخير، وهم بهـٰذا مشركون شركًا أكبر، وهـٰذا النوع من التبرك من الشرك الأكبر؛ لأنه يجعل البركة لغير الله استقلالاً، والأصل في البركة أنها منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((البركة من الله)) وهـٰذا حديث خاص، وأما الحديث العام فقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والخير كله في يديك)). فأثبت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البركة لله بلفظ عام وبلفظ خاص: اللفظ العام قوله: ((والخير كله في يديك))، واللفظ الخاص قوله: ((البركة من الله)).
ثم قال: (عن أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى حنين.) وحنين كانت بعد فتح مكة، وهي مكان بين مكة والطّائف. (ونحن حدثاء عهد بكفر) المراد أنهم قريبٌ عهدهم بالكفر، فإنهم خرجوا منه قريبًا ودخلوا في الإسلام عن قرب، هـٰذا معنى قوله: (حدثاء عهد بكفر.)
وقوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر.) هـٰذه الجملة حالية، وهي اعتذارية في الحقيقة، يعتذر بها عما بدر ممن صدر منهم ما سيأتي في الحديث.
قال: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها).
(للمشركين) أي الذين يعبدون غير الله عز وجل، ومنهم هؤلاء الذين كان عهدهم بالكفر قريبًا، فهـٰذه السدرة - وهي شجرة معروفة - كانت تعبد ويتبرك بها ويفعلون عندها ما سيأتي ذكره، معروفة عند العرب، فهؤلاء الحدثاء، هؤلاء الذين كان عهدهم بالكفر قريبًا، ودخولهم الإسلام عن قرب قالوا لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما اقترحوه، قال في بيان ما يفعله الكفار عند هـٰذه السدرة: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها).
(يعكفون). العكوف هو الملازمة مطلقًا، هـٰذا الأصل في العكوف، ولكنه يطلق على الملازمة التي يصحبها نوع تعبد، وهـٰذا غالب إطلاقه يكون في هـٰذا، وهو العكوف المقترن بأمر عبادي.
قال: (وينوطون بها أسلحتهم).
(ينوطون) أي يعلّقون، وأصله من النوط، ومنه قول الأصوليين: مناط الحكم، أي: محل تعليق الحكم، ومحل علته.
يقول: (وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط). أي ذات التعاليق. (أنواط) جمع نَوْط وهو المعلَّق، وذلك لكثرة ما يعلَّق بها.
يقول: (فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله) على وجه الاقتراح (اجعل لنا ذات أنواط) يعني: صيّر لنا شجرة ننوط بها أسلحتنا كما أن للمشركين شجرة ينوطون بها أسلحتهم، وهـٰذا منهم طلب مضاهاة الكفار.
قال: (كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الله أكبر!))) تعجبًا منهم وبيانًا لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أعظم وأجل من أن يرضى بالشرك وأن يشرع الشرك، فالله أكبر وأجل من ذلك كله، ولاحظ في قوله: ((الله أكبر)) لم يبين من أي شيء أكبر حتى يعم كل شيء، فهو أكبر من كل شيء -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وقد يبين ذلك السياق الذي يرد فيه كما هو هنا، فإنه ورد تكبيرًا لله في مقام طلب الشرك، فيكون المعنى: أكبر من أن يشرع الشرك ويرضى بالشرك، فإنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يرضى بالكفر.
ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنها السَّنَن))، أو ((السُّنن)).
((إنها)). أي: ما جرى منكم من طلب شجرة أو سدرة كما للمشركين سدرة، بيَّن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مراده فقال: ((قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل)) اليهود ((لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾( ))). أي: إنكم طلبتم مني نظير ما طلبه بنو إسرائيل من موسى، ومعلوم أن المشابهة لا يلزم منها المطابقة من كل وجه، وهـٰذا من أدلة ذلك، فإن بني إسرائيل طلبوا آلهة تُعبد من دون الله أو تعبد مع الله، وهؤلاء لم يطلبوا ذلك لكنهم شابهوهم في أصل الطلب وهو طلب مشابهة الكفار؛ لأن بني إسرائيل لمَّا مروا بقوم يعبدون أصناماًً من دون الله قالوا: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾. فطلبوا آلهة في الأرض تعبد كما للمشركين آلهة في الأرض تعبد.
﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾. ولا إشكال أن من طلب ذلك فإنما يصدر هـٰذا الطلب عن جهل عظيم به؛ لأن من علم حق العلم فإنه يجل الله عز وجل ويقدره أن يكون له شريك في العبادة؛ لأنه يعلم أن الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يرضى الشرك ولا الكفر.
ثم قال: ((لتركبن سنن من كان قبلكم)).
اللام هنا: لام القسم، الموطئة للقسم، والتقدير: والله لتركبن، فالتأكيد هنا في هـٰذا بالقسم وباللام وبالنون في قوله: ((تركبن)).
((سَنن من كان قبلكم)). أي: طرق ومسالك من كان قبلكم من الأمم، والمراد بمن قبلنا: اليهود والنصارى كما جاء مصرحًا به في الصحيحين، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا أخبر باتباع سنن من قبلنا قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)). قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟ )). يعني: من القوم إلا أولئك؟ رواه الترمذي وصححه.
والشاهد من هـٰذا الحديث أن الصحابة من مسلمة الفتح الذين لم يرسخ إيمانهم ولم يثبت يقينهم وتتشرّب قلوبهم الإيمان طلبوا من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سدرة ينوطون بها أسلحتهم، والظاهر هنا أنهم طلبوا نظير ما يفعله المشركون من تعليق الأسلحة طلبًا للبركة والقوة والنصر، وهل هـٰذا أنهم طلبوا أن يصيّرها مباركة أم أنهم طلبوا مجرد المشابهة ولو لم تكن مباركة في حقيقة الأمر؟
الظاهر أنهم طلبوا مجرد المشاركة والمضاهاة، لا أنه يصيرها لهم مباركة؛ لأنه لو كان هـٰذا الطلب لما كان هناك مشابهة لما جرى من بني إسرائيل مع موسى من طلب إلـٰه يعبد من دون الله.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية النجم.
[الشرح]
نعم وهـٰذا تقدم.
[المتن]
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوه.
[الشرح]
ما هي صورة الأمر الذي طلبوه؟ المقصود ما هو الأمر الذي طلبوه؟ المشابهة. هـٰذا قول، القول الثاني وذكره بعض أئمة الدعوة: أنهم طلبوا أن يصيرها مباركة، والله عز وجل يجعل الشيء مباركًا ومصدرًا للبركة كما أنه جعل نبيه مباركًا، فهم طلبوا أن تكون الشجرة مباركة، لكن هـٰذا الوجه في الحقيقة ما هناك ما يساعده في ظاهر النص، فالظاهر أنهم طلبوا مجرد المضاهاة والمشابهة للمشركين.
[المتن]
الثالثة: كونهم لم يفعلوا.
[الشرح]
وذلك أنهم طلبوا دون فعل.
[المتن]
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه.
[الشرح]
لم يظهر لي هـٰذا، ما ظهر لي أنا من الحديث أنهم إنما طلبوا ذلك لأجل التقرب إلى الله عز وجل، إلا إن كان مراد الشيخ رحمه الله أن هـٰذا بناءً على ما كان في قلوبهم من أن هـٰذه تقرب إلى الله وأن الله يحبها، فإذا كان كذلك فهو ظن كاذب أبطلته الشريعة، لكن إن كان هناك، يعني فيما يظهر من الحديث ليس فيه ما يدل إلا على مجرد طلب المشابهة ومضاهاة المشركين في جعل سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، بغض النظر عن أن ذلك يحبه الله أو لا يحبه، فيمكن أن يقال: إن هـٰذه المسألة مأخوذة مما كانوا يعتقدونه في هـٰذه المعبودات من دون الله وأنها تقربهم إلى الله زلفى، فتكون من بقايا الشرك الذي في نفوسهم، يمكن أن يقال هـٰذا، أقول: مع أن فيه نوع تكلف. لكن على كل حال من ظهر له شيء فليفدنا.
[المتن]
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هـٰذا فغيرهم أولى بالجهل.
[الشرح]
هـٰذا إنما صدر من قوم قال عنهم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-: (ونحن حدثاء عهد بكفر)، فقول الشيخ رحمه الله: (أنهم إذا جهلوا هـٰذا فغيرهم أولى بالجهل).
وجهه: لا أنهم حدثاء عهد بكفر لكنهم أهل لسان يعقلون معاني الكلام، فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جاء محذرًا من الشرك، مسفهًا لعبادة غير الله عز وجل، ناهيًا عنها بألفاظ واضحة متكررة بليغة، وهم أهل لسان ومع ذلك ما فهموا من هـٰذا أنه لا يجوز مثل هـٰذا الطلب، فجهل غيرهم من باب أولى يعني: ممن لم يكن صاحب لسان ولم يدرك حقيقة ما دعا إليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جهله لهـٰذا الأمر من باب أولى، واضح؟
يقول: (فغيرهم أولى بالجهل). من يريد بـ(غيرهم)؟
أي: ممن لم يدرك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويفهم دعوته، ولم يكن صاحب لسان، فهؤلاء أدركوا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وشهدوا دعوته وفهموا ما يدعو إليه وهم أصحاب اللسان الفصيح ومع ذلك لم يدركوا مع كل هـٰذه الأشياء أن هـٰذا الطلب من الشرك، أو أنه من أسباب الشرك، فغيرهم ممن لم تتوفر فيه هـٰذه الأوصاف، ولم يتيسر له هـٰذه الأمور جهله بأن هـٰذا من الشرك من باب أولى.
[المتن]
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
[الشرح]
ما فيه إشكال؛ لأنهم صحابة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهم من المغفرة والسابقة ما ليس لغيرهم، لكن هـٰذه المغفرة لا تصدق على الشرك، فلو وقع الشرك من أحدهم لكان سببًا لعدم المغفرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾( ). ولقوله
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾( ) فالسابقة والفضل وعظيم الحسنة لا تقابل سيئة الشرك، وإنما مراد الشيخ أنه وقع منهم هـٰذا مع ما هم عليه من الفضل ومع ما لهم من المغفرة، فينبغي أن يحذر وألا يظن بالإنسان إذا بلغ من الطاعة والتقى والصلاح مبلغًا كبيرًا أنه لا يقع منه شيء من الشرك، أو لا يقع في أسباب الشرك، بل يجب عليه أن يحترز ويحذر، وقد تقدم لنا فيما مضى في (باب الخوف من الشرك) قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾( ).
[المتن]
السابعة: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: ((الله أكبر! إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم)) فغلَّظ الأمر بهـٰذه الثلاث.
[الشرح]
نعم لم يعذرهم، لم يقل: هؤلاء حدثاء عهد بكفر، لا بأس نتغاضى عن هـٰذا الطلب، أو نرجئ الإنكار عليهم، بل بادَر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى إنكار الأمر وبيان عظم ما طلبوه، وخطورة ما وقعوا فيه بهـٰذا الكلام حيث قال: (((الله أكبر! إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم)). فغلظ الأمر بهـٰذه الثلاث) الثلاث: قوله: ((الله أكبر!))، وقوله: ((إنها السنن))، وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)). نعم.
[المتن]
الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا﴾( ).
[الشرح]
هـٰذه المسألة التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- وهي قوله: (الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا﴾)، حيث إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما طلبوا منه ذلك قال: ((الله أكبر! إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾)). وإن كان التشبيه بينهما يعني في جنس الطلب لا في عينه، فإن الصحابة لم يطلبوا شجرة تعبد من دون الله بخلاف ما كان من بني إسرائيل، ولكن المشابهة تقع ولو في جزء الصورة، ولا يلزم المطابقة من كل وجه، ولذلك أنكر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك، وتقدم وجه إنكاره في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الله أكبر! إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى)).
[المتن]
التاسعة: أنّ نفي هـٰذا معنى (لا إلـٰه إلا الله)، مع دقته وخفائه على أولئك.
[الشرح]
أن نفي هـٰذا، أي نفي طلب البركة من غير الله ولو على وجه التسبب من معنى لا إله إلا الله، فقوله: هـٰذا، المشار إليه: طلب البركة من غير الله على وجه التسبب لا على وجه الاستقلال، فإن الصحابة لم يطلبوا بركة مستقلة؛ لأنهم يعلمون أنه لا يأتي بالخير إلا الله -جل وعلا- كما أنه لا يدفع الشر إلا هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، إنما طلبوا أمرًا يكون سببًا لحصول البركة، ومع ذلك بيّن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه نظير قول بني إسرائيل: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ فهو قدح ونقص في التوحيد، ومن هـٰذا يُعرف أن الإله ليس فقط ما كان على صورة أو ما سُجِد له وعُبِد ، ما خُص بعبادة أو سجود أو ما أشبه ذلك، إنما الإله هو كل ما قصد بشيء من العبادة، كل ما قُصد بشيء من العبادة فإنه إلـٰه، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهؤلاء: ((قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾)). وهـٰذا أصح ما قيل في تعريف الإله: أنه كل ما قصد بشيء من العبادة، فهو اسم جنس يعم كل ما قصد بشيء من العبادة.
وقوله: (مع دقته وخفائه)؛ لأنه خفي على هؤلاء الذين هم أشد الناس فهمًا باللغة، وهم أعرف الناس بما كان يدعو إليه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فبهـٰذا يتبيّن أنه ينبغي للمؤمن أن يدقق في معنى لا إلـٰه إلا الله حتى يتبين ما ينافيها من دقيق وجليل، وجلي وخفي، وظاهر وباطن؛ ليجتنبه ويسلم منه.
[المتن]
العاشرة: أنه حلف على الفتيا، وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
[الشرح]
وذلك في قوله: ((والذي نفسي بيده)) فحلف بوصف من أوصاف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وحلفه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الغالب لا يكون إلا لمصلحة، والمصلحة هنا تأكيد الخبر، وإلا فلا شك فيما يخبر به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكن يأتي الحلف لتأكيد المخبر به وإن كان المخبر لا يتصور منه الكذب، كما جرى القسم من رب العالمين، وكما أمر الله رسوله بالقسم، وكما أقسم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مواضع كثيرة.
[المتن]
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهـٰذا.
[الشرح]
وهـٰذا مهم أن يعرف أن الشرك قسمان: أصغر وأكبر؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يحكم بكفرهم ولم يقل: هـٰذا شرك، إنما بين لهم أنه مضاهٍ لما كان من بني إسرائيل من طلب الآلهة، ولو كان كفرًا لبين أنهم قد كفروا بذلك، وإنما نهاهم وغلظ عليهم القول لكون ذلك من أسباب الشرك ووسائله. وبه نعلم أن الشرك الأصغر ليس فقط محصورًا في ما نصّ الشارع على أنه شرك، بل هو يشمل كل ما كان سببًا للوقوع في الشرك، وأن من الفروق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الشرك الأصغر لا يخرج به صاحبه من الإسلام ولا يخلد في النار، بخلاف الأكبر فصاحبه خارج من الإسلام، وإن مات عليه فهو خالد في النار.
[المتن]
الثانية عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر). فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
[الشرح]
وهـٰذا فيه الاعتذار عن الذين صدر منهم هـٰذا الطلب، وأنه إنما صدر من مسلمة الفتح الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، وأما غيرهم ممن تربى على يد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتلقى عنه فإنه يميز بين هـٰذا وبين غيره، وأن هـٰذا ليس من الإسلام، بل هو من الشرك ومن أسبابه.
[المتن]
الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب، خلافًا لمن كرهه.
[الشرح]
وفي رواية الترمذي أنه سبح -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وكلاهما وارد: فالتكبير يكون عند التعجب من الأمر، ويكون التسبيح كذلك عند التعجب من الأمر واستعظامه.
[المتن]
الرابعة عشرة: سد الذرائع.
[الشرح]
(سد الذرائع) هـٰذه من القواعد الفقهية، بل من القواعد الشرعية التي تستعمل كثيرًا، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على مضمون هـٰذه القاعدة وإن كان بعضهم لا يُعمل اسم هـٰذه القاعدة، يعني: يمنع القول بسد الذرائع لكنه في العمل والتطبيق تجده يقول في مسائل كثيرة بسد الذريعة؛ لكن من خلال قاعدة أخرى، فهم يتفقون على العمل بمسماها ومضمونها، وإن كانت المذاهب تختلف في إعمال هـٰذه القاعدة، فأوسع المذاهب عملاً بها مذهب المالكية، وأضيقهم مذهب الشافعية والحنفية، والحنابلة وسط، وهـٰذه قاعدة معروفة في كتب القواعد الفقهية.
وأخذها من هـٰذا الحديث هو أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منع ذلك لأنه يفضي إلى عبادة هـٰذه الأشجار والأحجار؛ لأنها إذا كانت تطلب منها البركة فإنه يتقرب إليها فيما بعد وتعبد من دون الله، فمنع طلب البركة منها من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر.
وهل كل ذريعة تسد أو لا تسد؟
هـٰذا بحث في القواعد الفقهية، ومعلوم أن الذرائع التي تسد هي الذرائع القريبة وليست كل ذريعة، الذرائع القريبة يعني الذرائع التي وقوع المحرم بسببها محتمل وقريب، أما ما كان موهومًا أو بعيدًا فإنه لا يسد، وإلا كان منع من مباح كثير بسبب سد الذرائع: فبيع العنب مثلاً على من يظن أنه يستعمله لصنع الخمر ما يجوز من باب سد الذرائع، لكن إن كان ذلك محتملاً وقريبًا، أما على شخص عادي لا تعرف عنه إلا الخير، أو أنك تجهل حاله ويبعد أن يستعمله في ذلك فإنه لا يمنع بيعه سدّاً للذريعة؛ لأن هـٰذه ذريعة موهومة.
[المتن]
الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
[الشرح]
وهـٰذا أصل في هـٰذه الشريعة المباركة: أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- شرع فيها ما يميز أهل الإيمان عن أهل الكفر، فنهى عن التشبه بأهل الكفر، وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من تشبه بقوم فهو منهم)). وهـٰذا فيه التحذير الشديد من مشابهة الكفار، والشريعة لم تأت فقط بالنهي عن التشبه بالكفار بل أتت بالنهي عن التشبه بكل من كانت حاله ناقصة: فجاء النهي عن التشبه بالكفار، وجاء النهي عن التشبه بالفساق، وجاء النهي عن التشبه بالأعراب، وجاء النهي عن التشبه بالحيوانات، كل هـٰذا يدور في باب واحد وهو النهي عن التشبه بمن كانت حاله ناقصة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله هـٰذا تقريرًا جيدًا واضحًا بينًا في كتابه العظيم: " اقتضاء الصراط المستقيم"، فإنه في مخالفة صراط أهل الجحيم، بين فيه رحمه الله الأدلة الشرعية الدالة على هـٰذا الأصل من أصول الإسلام.
من أين نأخذ الفائدة الخامسة عشرة من الحديث؟
من قوله: ((لتركبن سنن من كان قبلكم)) وهـٰذا جاء بعد ذكر الطلب القبيح من بني إسرائيل، فبين النهي عن هـٰذا، فالحديث بمضمونه يدل على النهي عن التشبّه بهؤلاء، فإن قوله: ((لتركبن سنن من كان قبلكم)) ليس خبرًا مجرّدًا، إنما هو خبر للتحذير والنهي عن سلوك سبيل هؤلاء الذين كانت حالهم ناقصة، وقد دلت الأدلة على تحريم مشابهتهم واقتفاء سبيلهم.
[المتن]
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم.
[الشرح]
واضح من أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أغلظ لهم القول، فكبر وفي رواية سبح، وهـٰذا فيه التنزيه والتعظيم للأمر، ثم قال: ((قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى))، ثم قال: ((لتركبن سنن من كان قبلكم)). وهـٰذا كله يدل على عظم ما وقع منهم، وعلى شدة إنكار النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليهم.
[المتن]
السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: ((إنها السنن)).
[الشرح]
((إنها السنن)): هـٰذا فيه بيان أنّ ما تقع فيه هـٰذه الأمة من مخالفات إنما هي سالكة في سبيل وسنن من كان قبلها من الأمم، وأن ما يقع في هـٰذه الأمة من الشرور فهي متأسية فيها بالأمم السابقة.
[المتن]
الثامنة عشرة: أن هـٰذا عَلم من أعلام النّبوة؛ لكونه وقع كما أخبر.
[الشرح]
وهـٰذا واضح، فإنه قد وقع من ذلك الشيء الكثير، وصدق ما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حيث قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)). وهـٰذا واقع في حال كثير من أهل الإسلام: يتلقون عن الغرب الدقيق والجليل، ويتلقون عن أهل الكفر كل ما جاء عنهم دون تمييز وتمحيص ونظر في النافع والضار.
[المتن]
التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
[الشرح]
مقصود المؤلف -رحمه الله- بهـٰذه المسألة أن ما ذم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به اليهود والنصارى مما وقعوا فيه ليس خاصّاً بهم، بل هو عام لهم ولكل من وافقهم فيما ذموا من أجله، فإذا وقعت الأمة في شيء مما ذمهم الله به وعابهم عليه فإنهم يشاركونهم في الذم والعيب، المراد بهـٰذه المسألة أن ما ذم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به الأمم السابقة من اليهود والنصارى ليس ذمّاً خاصّاً بأولئك فإذا وقع في هـٰذه الأمة فإنها لا تذم عليه! بل هو ذم لها وذم لكل من شاركها فيما ذمت به أو ذمت من أجله. فمثلاً ذم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- اليهود على أكلهم السحت وتحريفهم الكلم عن مواضعه، فإذا وقع هـٰذا من هـٰذه الأمة هل يشملهم الذم أو لا؟ الجواب: يشملهم الذم.
[المتن]
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمـر، فصـار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما (من ربك)؟ فواضح، وأما (من نبيك)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما (ما دينك)؟ فمن قولهم: (اجعل لنا..) إلخ.
[الشرح]
طيب، هـٰذه المسألة يقول: (أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر)، أي أمر؟ الأمر الشرعي، فإن الصحابة لم يبتدئوا ذلك من قِبل أنفسهم، معنى ذلك أنهم لم يتخذوا شجرة للبركة ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، بل طلبوا ذلك من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فدل ذلك على أن المتقرر عندهم أنه لا يشرع شيء من العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله، وهـٰذا واضح جلي في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾( ). وأما السنة فقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((من أحدث في أمرنا هـٰذا ما ليس منه فهو رد)). ثم قال رحمه الله: (فصار فيه التنبيه على مسائل القبر)، (صار فيه) يعني في هـٰذا الحديث (التنبيه على مسائل القبر) يعني الأسئلة التي يسألها المقبور ويمتحن بها الناس في قبورهم.
أما (من ربك) فواضح، وذلك أن العبادة له وحده لا شريك له.
وأما (من نبيك) فمأخوذ من أنّهم رجعوا إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في طلب التّشريع، هـٰذا من وجه، والوجه الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- ظاهر أيضًا في أنه وقع ما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنّ الإخبار بالغيب لا يكون إلا من رسول؛ لأن الله جل وعلا لا يظهر الغيب إلا لمن ارتضى من رسول كما قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾( )، وهـٰذا استثناء حاصر – انتبه - أنه لا يظهر الغيب على وجه متحقّق متيقن لا تخلف فيه إلا للرّسول، أما غيره فقد يظهر له شيء من الغيب كما يكون في الرؤى لكنه ليس متحققًا ولا متيقنًا، وهـٰذا وجه الحصر في قوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ فكون النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخبر بما سيكون في المستقبل، يخبر بالغيب ثم يقع وفق ما أخبر فإن ذلك يدل على نبوته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
قال: (وأما (ما دينك) فمن قوله: (اجعل لنا) إلى آخره)، حيث طلبوا منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يجعل لهم هـٰذه الشجرة محلاًّ لنوط الأسلحة والعكوف، ودل ذلك على أن الشرع يتلقى منه وأن الدين ما جاء به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فهـٰذا يدل على نبوته كنا تقدم، ويدل أيضًا على أن الدين ما شرعه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[المتن]
الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
[الشرح]
وجه ذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عاب عليهم الأخذ بسبيل أولئك فقال: ((لتركبن سنن من كان قبلكم)) وجاء مصرحًا في البخاري ومسلم أن السنة المقصود بها هنا هي سنة اليهود والنصارى، فسنة اليهود والنصارى مذمومة كسنة المشركين؛ لأن دينهم قد بطل ولا يجوز لهم التعبد به، ولا ينفعهم التقرب به إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، بل يجب عليهم تركه إلى دين الإسلام؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ﴾( ) ولقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾( ). [المتن]
الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤمَن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة؛ لقوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر).
[الشرح]
وهـٰذا واضح، فإن المنتقل من الباطل الذي مرن عليه قلبه واعتاد عليه يصعب عليه جدّاً التخلّي عن ذلك الباطل، ولا يمكنه التخلّي عنه إلاّ بعد رسوخ الإيمان فيه، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في تخليص قلبه من شوائب الشّر ومن أوضار الشرك ومن كل شائبة تعوقه عن امتثال أمر الله ورسوله، وإذا لاحظ المؤمن هـٰذا زال عنه كل ما علق في قلبه مما اعتاده مما يخالف أمر الله ورسوله.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس التاسع
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في الذبح لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ﴾( ) الآية، وقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾( ).
عن علي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: حدثني رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأربع كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غيَّر منار الأرض)). رواه مسلم.
وعن طارق بن شهاب، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب)). قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: ((مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابًا. فقرب ذبابًا، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة)). رواه أحمد.
[الشرح]
قال: (باب ما جاء في الذبح لغير الله).
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن الذّبح عبادة فيجب إفراد الله تعالى بها.
وأما مناسبته لما قبله: فإنه في الأبواب السابقة ذكر ما هو وسيلة إلى الشرك غالبًا، وفي هـٰذا الباب بدأ بذكر ما هو شرك في ذاته، فإن الذبح عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر كما تقدم، فانتقل من الشرك في الوسائل إلى الشرك في المقاصد، وبدأ ذلك بالذبح؛ لكونه من أكثر ما يقع من أهل الشرك من صور التقرب لغير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، هـٰذه مناسبة الباب لما قبله.
يقول رحمه الله: (باب ما جاء في الذبح لغير الله) ولم يذكر حكم ذلك، وتقدم لنا أن أهل العلم ينصون على الأحكام في التراجم أحيانًا ويتركون النص على الحكم في الترجمة أحيانًا أخرى، وإذا تركوا النص على الحكم في الترجمة فذلك إمّا لكون الحكم واضحًا، وإما لكون الحكم مختلفًا فيه، وإمّا لكون المسألة المترجم لها تحتاج إلى تفصيل في الحكم، وإما تمرينًا للطالب ليستنتج الحكم من النصوص المذكورة في الباب، وإما لغير ذلك من الأسباب.
الذّبح هو: التذكية، وهو القطع، قطع الحلق، ولم ينص المؤلف رحمه الله على الحكم هنا لكونه واضحًا مما ساق -رحمه الله- من النصوص في الباب، ويحتمل أنه لم يذكر الحكم في الترجمة لكون الذبح لغير الله ليس على قسم واحد من حيث الحكم، فمنه ما هو شرك ومنه ما ليس شركًا كما سيتبيّن في أقسام الذّبح، ولذلك لم ينص المؤلف -رحمه الله- على الحكم ليراعى هـٰذا التقسيم.
والذبح لغير الله يشمل الذبح تقربًا لغير الله، ويشمل أيضًا الذبح لغير الله لا على وجه التقرب بل لغرض عادي، كذبح الشاة للحم، فإن هـٰذا الذبح ليس لله، أي ليس مما يتقرب به إلى الله عز وجل، المذبوح لا يتقرب به إلى الله عز وجل، وذلك أن الذابح لهـٰذه الذبيحة لا يرجو أجرًا في ذبحه؛ لأنه من الأمور العادية، ولذلك لما ذبح أبو بردة بن نيار قبل صلاة العيد، قال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((شاتك شاة لحم)). ففرّق رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين ما ذبح قبل الصّلاة وبين ما ذبح بعدها، فجعل المذبوح بعد الصلاة قربة، والمذبوح قبل الصلاة لحم، عادة ليس فيه أجر.
والذبح في ذاته ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين: ذبح مشروع، وذبح ممنوع.
الذبح المشروع: على درجات: منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو جائز.
الواجب: كهدي المتمتع، وكالعقيقة على قول، والأضحية على قول.
المستحب: كالعقيقة في قول، والأضحية في قول، والهدايا التي ترسل إلى مكة، وما يذبحه غير المتمتع في الحج.
والجائز: ما كان المقصود منه اللحم وذُكر اسم الله عليه، ما كان المقصود منه اللحم وروعيت فيه شروط التذكية.
أما الممنوع من الذبح فيندرج تحته أقسام:
القسم الأول: الذبح لغير الله قصدًا وتسميةً، مثاله: أن يذبح للصنم أو للولي أو للجني أو غير ذلك من المعبودات، ويذكر اسم ذلك المذبوح له، فيذبح مثلاً لعلي بن أبي طالب تقربًا ويقول: باسم علي، يذبح للبدوي تقربًا ويذكر اسمه عند الذبح، يعني يذكر اسم المتقرب إليه عند الذبح، وهـٰذا شرك أكبر باتفاق الأمة؛ لأنه مما أُهل لغير الله به، ومما ذبح على النصب، وهو شرك أكبر يخرج به صاحبه من الإسلام؛ لأنّ الذبح عبادة، وصرفها لغير الله كفر، هـٰذا القسم الأول من الذبح الممنوع، وهو ما كانت فيه التسمية لغير الله والقصد لغير الله.
القسم الثاني من الذبح الممنوع: ما كان القصد فيه غير الله وذكر عليه اسم الله جل وعلا.
مثاله: أن يذبح تقربًا للجن، أو يذبح تقربًا للولي أو للنبي أو للملك هـٰذا في نيته وقلبه، وأما في تسميته ولفظه فيذكر الله، فيقول: باسم الله، وهـٰذا شرك، وهو داخل في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾( ) ويدخل أيضًا بالمعنى في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾( )؛ لأن ما أهل لغير الله به المقصود به ما ذكر عليه اسم غير الله عزّ وجل، فإذا كان النهي عن ذكر اسم غير الله على الذبيحة ولو كان يقصد الله فكيف إذا كان القصد لغير الله؟ يكون التحريم من باب أولى؛ لأن الأصل ما يقوم في القلب من المقصد، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنما الأعمال بالنيات)). هـٰذا ثاني الأقسام، وهو ما كان القصد فيه لغير الله والتسمية فيه لله، وهـٰذا شرك أكبر.
القسم الثالث: ما كان القصد فيه لله وذكر عليه اسم غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهنا القصد التقرب إلى الله عز وجل، لكنَّه في الذبح ذكر اسم غير الله عز وجل، هـٰذا أيضًا من الشرك الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عبادة، فإذا ذكر اسم غيره فقد صرف العبادة لغير الله، وهـٰذا هو الشرك الأكبر، وعلى هـٰذا أئمة الدعوة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد رحمهما الله.
خالف في ذلك بعض أهل العلم فقال: إن الذبيحة محرمة؛ لأنها داخلة في قوله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾( ) وهـٰذه لم يذكر عليها اسم الله، ولكنها ليست شركاً، ذبيحة محرمة وليست شركًا، والصواب ما قدمناه، هـٰذا ثالث الأقسام في الذبح المذموم.
وسيأتي أقسام أخرى يكون الذبح فيها مذمومًا لكن لمعنى خارج عن الذبح: كأن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما سيأتي في الباب التالي، فالمنع لا لأجل الذّبح نفسه إنما لأمر خارج، هـٰذه هي أقسام الذبح من حيث المشروعية ومن حيث المنع.
نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله في هـٰذا الباب، قال: (وقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ﴾( ).)
هـٰذه الآية أمر الله فيها رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالقول تبليغًا للأمة أمة الدعوة وكل من يسمع الخطاب. ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي﴾: الصلاة معروفة، وهي: التعبد لله عز وجل بأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتّسليم.
﴿وَنُسُكِي﴾: النسك في اللغة يطلق على العبادة، ومنه قول الله جل وعلا: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾( ). ومنه قول الله عزّ وجل في دعاء إبراهيم وإسماعيل: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾( ) أي طرق عبادتنا إياك. ويُطلق ويراد به الذبح. وهـٰذان قولان في النسك هنا: فعلى الأول يكون عطف النسك على الصّلاة من باب عطف العام على الخاص، وأما على القول الثاني وأن المراد بالنسك الذبح فيكون عطف عمل على عمل، وخص هـٰذان العملان بالذكر دون غيرهما لأنهما أعظم الأعمال: فالصلاة أعظم الأعمال البدنية، والذبح أعظم القرب والأعمال المالية، فإذا كان الصلاة والذبح وهما أعظم العبادات لله عز وجل فغيرهما من باب أولى، إخلاص هذين لله يستلزم إخلاص سائر الأعمال له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
وقوله: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾.
﴿وَمَحْيَايَ﴾: أي أمر محياي، وما يكون فيه.
﴿وَمَمَاتِي﴾: أي ما يكون في مماتي لله عز وجل، فهو الذي يدبر أمر محياي وهو الذي يدبر أمر مماتي، فيكون هنا قد ذكر توحيد الإلهية وتوحيد الرّبوبية: توحيد الإلهية في قوله: ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي﴾ وتوحيد الربوبية في قوله: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
وقيل: إن قوله: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ المراد بذلك العمل في المحيا والممات، أما العمل في الحياة فواضح، وهو ما يتقرب به الإنسان إلى ربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في حياته من صلاة وزكاة وصيام وحج وإحسان وغير ذلك من الأعمال.
وأما قوله: ﴿وَمَمَاتِي﴾ فالمراد بالممات ما قارب الموت من العمل، وهو ما يكون في سياق الموت والاحتضار، وهـٰذا فيه بيان أن عمله كله لله -عز وجل- في حال قوته ونشاطه وفي حال ضعفه وانتهائه؛ ليبين أن جميع ما يكون منه لله عز وجل، وكلا المعنيين قال بهما أهل التفسير.
وقوله: ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ اللام هنا قيل: إنها للمِلك، وقيل: إنها للتعليل. فإذا قلنا: ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي﴾ توحيد الربوبية، ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ توحيد الإلـٰهية، فيصلح أن تكون دالة على التعليل ودالة على الملك والتصرف. وإذا قلنا: إن المراد بالسابق كله العمل وجاء تعميم بعد تخصيص: ﴿صَلاتِي وَنُسُكِي﴾ عبادات خاصة، ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ كل ما يكون من عمل في الحياة والممات، فتكون اللام هنا للتعليل.
﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ثم انظر! -لم يقل: لرب العالمين- بل قال: ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فذكر وصفين بهما يثبت لله -عز وجل- كمال الإلهية وكمال الربوبية: فكمال الإلهية في اسم الله المشتق من الألوهية، وهو إله إلا أن الهمزة أسقطت للتخفيف كما تقدم، فهو دال على العبادة والإلهية، و﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ دال على الربوبية. والشاهد من هـٰذه الآية قوله تعالى: ﴿وَنُسُكِي﴾ على القول بأنها الذبح، فيكون مما أفادته هـٰذه الآية وجوب إفراد الله عز وجل بالذبح، أما ذبائح القربة فلا بد من إفراد الله عز وجل بها قصدًا وتسمية، وأما ذبائح اللحم فلا بد من إفراد الله -عز وجل- بها تسميةً، ولذلك لو سمى الله وغيره على الذبح ما حل، لو قال: باسم الله والرسول، أو: باسم الله والولي ما حلّت الذّبيحة؛ لأنه ذكر غير الله عليها، فتكون داخلة في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾( ).
ثم قال: (وقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾( )) الفاء هـٰذه عاطفة، وهي تفيد التعليل، فإن الله عز وجل ذكر في أول هـٰذه السورة ما منَّ به على رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الخير الكثير فقال: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ثم قال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ شكرًا وثناء على الله عزّ وجل بالفعل والقول على هـٰذه المنة، وذكر هذين النوعين من العبادة لما تقدّم: لكونهما أعظم ما يتقرب به من العبادة لله عزّ وجل. والشاهد في هـٰذه الآية قوله: ﴿وَانْحَرْ﴾ أي اذبح الهدي واذبح الذبائح تقرّبًا إلى الله عز وجل، الهدي في الحج وما يهدى إلى مكة في غير الحج، والذبائح كالأضحية والعقيقة وذلك لكل أحد في كل مكان، فأمر الله –عز وجل- تعالى بالصلاة والنحر. والشاهد في هـٰذه الآية قوله: ﴿وَانْحَرْ﴾ وقوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾ حيث خص النحر به: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ أي له، هـٰذا تقدير الكلام، فالصلاة والنحر له لا لغيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم قال: (عن علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قال: حدثني رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأربع كلمات.)
(كلمات) جمع كلمة، والكلمة في اصطلاح النحويين تطلق على اللفظ المفرد، وهو في اللغة أوسع من ذلك، فالكلمة في اللغة تطلق على الجملة؛ بل وعلى الجمل الكثيرة التي تفيد معنى، ولذلك قال النبي –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: ((أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، وهي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)) وهـٰذه كلمات. فالمقصود بالكلمات هنا جمل.
((لعن الله من ذبح لغير الله)). وهـٰذا الشاهد، فإنّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر بلعن الله أو دعا على من ذبح لغير الله، وهـٰذا يشمل كل ذبحٍ محرّم: سواء كان الذبح لغير الله تسميةً وقصدًا، أو كان قصدًا دون تسمية، أو تسمية دون قصد، كل هـٰذا مما يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لعن الله من ذبح لغير الله)). واللعن هو الطرد والإبعاد، ففي الخبر إذا كان الكلام سيق مساق الخبر فالمراد أن الله لعن أي أبعد وطرد، وإذا كان سؤال دعاء فالمعنى سؤال الله جلّ وعلا لعن وطرد وإبعاد هـٰذا الذي فعل ما ذُكر بعد اللعن: ((لعن الله من ذبح لغير الله)). ويدخل فيه من ذبح لله وغيره معه، والدليل على ذلك قول الله تعالى في الحديث الإلهي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)). فيكون العمل لمن؟ للمشرَك به، فمن ذبح وسمى الله وغيره فإنه داخل في قول النّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لعن الله من ذبح لغير الله)).
هل يمكن أن نستفيد من هـٰذا الحديث مرتبة الذّبح لغير الله؟ ما هي مرتبته؟ هل هو شرك أو كبيرة من الكبائر؟ لا يمكن أن نأخذ أنه شرك من هـٰذا اللفظ، لكن نأخذ ذلك من النصوص الأخرى الدالّة على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، كما في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
أما هـٰذه الصيغة فإنها ترد في الشرك وترد فيما دون الشرك من المعاصي، ولذلك كل ما ذُكر بعد اللعن الأول وهو لعن من ذبح لغير الله كله في معاصٍ دون الشرك، وبدأ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأخطر الذنوب والمعاصي وهو الشرك فقال: ((لعن الله من ذبح لغير الله)).
ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لعن الله من لعن والديه)). وهـٰذا من كبائر الذنوب، ولعن الوالدين يكون بتوجيه اللعن لهما مباشرة، أو بما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أن ((الرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)).
ثم قال: ((لعن الله من آوى محدِثًا أو محدَثًا)). اللفظ محدِثاً ويشمل محدَثاً، فاللعن للمحدث هو لعن لما أحدثه، والمقصود بالمحدِث هنا هو كل من طُلب بحق لله عز وجل في حد أو غيره من حقوق الله جل وعلا، ويشمل أيضًا كل من ابتدع في الدين ما ليس منه، فإنه داخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لعن الله من آوى محدِثًا)). والإيواء يكون بالسّتر والإخفاء لمن طُلب في حقّ من حقوق الله، ويكون بالتأييد والنّصر والذّب عن البدع، فإنه داخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لعن الله من آوى محدثًا)).
آخر الجمل الأرْبع في هـٰذا الحديث قوله: ((لعن الله من غير منار الأرض)). ((من غيَّر)) أي بدّل، فالتغيير هو التبدّيل، والمقصود بمنار الأرض هنا ما يُستنار به منها، والمقصود به علامتها التي تميز الأملاك من المراسيم وشبهها وحدودها، ويشمل أيضًا العلامات التي يهتدي بها النّاس في الطرقات، فمن غيَّر العلامات التي يستدل بها الناس على الأماكن بطمس أو تحريف يحصل به إضلال الناس وإتعابهم فإنه من تغيير منار الأرض.
من تغيير منار الأرض أيضًا إضلال المسترشد من أعمى أو بصير، فإذا سألك الأعمى عن الطريق وقلت له: الطريق من ها هنا وهو مخالف لما قلت فإنه من تغيير منار الأرض يدخل في اللعن؛ لأنه موافق له في المعنى، وكذلك لو أن شخصًا سألك من غير أهل البلد عن مكان فيه فدللته على غيره فإنه من تغيير منار الأرض، وهـٰذا تغيير حسي.
من التغيير أيضًا تغيير حدود الأراضي في الصكوك،كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتواه، فإنه داخل في تغيير منار الأرض؛ لأن تغيير ما تضمنته الصكوك كتغيير المراسيم الحية، ولا فرق في التغيير بين أن يكون التغيير للأخذ من حق معين كأرض الجار مثلاً، أو من حق عام كالأخذ من الشوارع العامة , فإن كل ذلك داخل في اللعن وفي قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لعن الله من غير منار الأرض)).
ثم قال: (وعن طارق بن شهاب أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((دخل الجنة رجل في ذباب)).)
(طارق بن شهاب) ممن اختلف في صحبته، فاختلف العلماء هل هو صحابي أم لا؟ على قولين، وبعضهم أجرى الخلاف في ثبوت هـٰذا الحديث بناءً على الاختلاف في صحبته، والصّحيح أنه لا دخل لصحبته في ثبوت هـٰذا الحديث من عدمه؛ لأن (طارق بن شهاب) إنّما نقله ورواه عن سلمان الفارسي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، كما في الحلية وكما في كتاب الزّهد للإمام أحمد، فالحديث صحيح موقوفًا على سلمان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أما رفعه إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه لا يصح.
يقول في هـٰذا الأثر منسوبًا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((دخل رجل الجنة في ذباب)). ((في)) هنا للسببية، أي بسبب الذباب، ونظير ذلك قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((دخلت امرأة النار في هرة)) يعني بسببها.
قال: ((دخل الجنة رجل في ذباب)) أي بسببه ((ودخل النار رجل في ذباب)) أي بسبب ذباب. (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟) يعني: بيِّن لنا. (قال: ((مر رجلان على قوم لهم صنم))) وتقدم تعريف الصنم ((لا يجوزه)) لا يتعداه ولا ينفذ منه ((أحد حتى يقرب له شيئًا)) أي: يتقدم إليه بقربة، وقوله: ((شيئًا)) يشمل الدقيق والجليل، الحقير والكبير ((فقالوا لأحدهما: قرِّب. قال: ليس عندي شيء أقربه)).
الآن هـٰذا بماذا اعتذر؟ اعتذر بإنكار التقريب لهـٰذا الصّنم أو بأنه لا يملك ما يقرب؟ بأنه لا يملك ما يقرب، فماذا كان؟
((قالوا له: قرب ولو ذبابًا)). و((لو)) هنا المقصود بها أي شيء حتى ولو كان في الضآلة والانحطاط إلى درجة الذباب، وهـٰذا فيه حرص هؤلاء على إيقاع الناس في الشرك، وإلا فما فائدة تقريب الذباب؟ ليس فيه إكرام ولا فيه تعظيم، بل لو أنك قدمت لأحد ذباباً لكان ذلك إهانة، لكن هؤلاء أرادوا وقصدوا إيقاع الناس في الشرك.
((فقرَّب ذباباً فخلَّوا سبيله)) أي: تركوه وشأنه ((فدخل النار)). والفاء هـٰذه للتعقيب، أي: لترتيبب الحكم على الوصف السابق، فهي تفيد السببية، فدخل النار، ما سبب دخوله النار؟ تقريبه الذباب لهـٰذا الصنم.
((وقالوا للآخر: قرِّب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا)). فامتنع من التقريب لاعتقاد أو لعدم مِلك؟ لاعتقاد، وهو أنه لا يستجيز أن يقرب لأحد دون الله شيئًا.
((فضربوا عنقه)) أي: قتلوه ((فدخل الجنة)) بسبب امتناعه عن الكفر.
وهـٰذا الحديث يبين مقصود المؤلف فيه: أن التقرب بالذبح أو بأي شيء ولو كان حقيرًا لغير الله على وجه التعبد فإنه من الشرك، فهـٰذا لما قتل الذباب وقرب الذباب تعبدًا وقع في الشرك فدخل النار، والآخر لما امتنع من ذلك وحقق التوحيد وأنه لم يقرب لأحد، لم يصرف شيئًا من العبادة لأحد دون الله وقُتِل من أجل ذلك كانت عاقبته الجنة.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي﴾.
[الشرح]
فهـٰذه مسائل الباب المتقدّم، أولى هـٰذه المسائل تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي﴾.
[المتن]
الثانية: تفسير ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
[الشرح]
الشاهد من هـٰذه الآية، المراد بالنحر هنا الذبح.
[المتن]
الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
[الشرح]
وذلك في حديث (علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وفيه قال: حدثني رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأربع كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله)).)
فبدأ بهـٰذه المسألة قبل غيرها لأنها أعظم ما استحقّ عليه الإنسان اللعن في هـٰذه المذكورات، فبدأ بها قبل غيرها.
[المتن]
الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
الخامسة: لعن من آوى محدِثًا، وهـو الرّجـل يحـدث شيئًا يجـب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
[الشرح]
وهـٰذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أنه يدخل فيه أيضًا من أحدث في شريعة الله ما ليس منها، فإن إيواءه يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لعن الله من آوى محدثًا)).
[المتن]
السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تُفرِّق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير.
[الشرح]
تقدم الكلام على هـٰذا، وبينا أنه لا فرق بين أن يكون الحق حق الجار حقّاً خاصّاً أو حقّاً عامّاً، فكله يدخل في اللعن، الحق الخاص مثل أن يكون ملكًا لشخص معين، والحق العام أن يكون لعموم المسلمين مثل الطرقات وشبهها، فإنه لا يجوز التغيير في هـٰذا، وهو داخل في لعن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من غير منار الأرض)) , وأيضًا مما ذكرنا في ذلك تغيير العلامات التي يستدل بها على الأماكن والطرق.
[المتن]
السابعة: الفرق بين لعن المعيّن، ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
[الشرح]
وهـٰذا واضح: فإن كل ما ورد فيه اللعن في السنة إنما ورد اللعن فيه على وصف لا على شخص، وفرق بين لعن الأوصاف ولعن الأشخاص، فلعن الأوصاف يوجب التحذير منها وثبوت العقوبة لكل من اتصف بهـٰذا الوصف.
بقي لعن الأشخاص، جاء في السنة في مواضع أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعن أشخاصًا بأعيانهم، فلعن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قنوته: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً)) وسمَّى بعض الكفرة، لكنه عوتب في ذلك فانتهى لما نزل عليه قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾( ) فانتهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن لعن المعينين.
واختلف العلماء في لعن المعين المسلم والكافر:
أما المسلم فلا شك أن لعنه محرّم؛ لأن سباب المسلم -وهو دون اللعن- فسوق؛ لأن السّب يكون باللعن وبغيره وأشده اللعن، فوصفه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأنه ((فسوق)) , وقال –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: ((ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء)). فهـٰذا يدل على منع لعن المسلم.
وأما الكافر فقد اختلف فيه، والصحيح أنه لا يجوز لعن الكافر المعين إلا إذا عُلم مآله ومصيره، كأبي جهل وفرعون وغيرهما من الكفرة الذين نوقن بأنهم في النار، أما من لا يعلم مصيره فإنه لا يلعن. وبعضهم قال: يلعن إذا مات على الكفر. وعلى كل حال الأحوط ترك اللعن؛ لعموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ليس المؤمن باللّعان ولا بالطعان)). فنفي هـٰذا الوصف هو الأصل وهو ترك اللعن.
والفرق بين لعن الموصوف ولعن الشخص: أن لعن الموصوف قد لا يتنزل على الأشخاص؛ لأن انطباق اللعن على الشخص لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد تتوافر الشروط وتنتفي الموانع فيستحق الشّخص اللعن، وقد يفوت شرط أو يوجد مانع فيرتفع حكم اللّعن، ولذلك فالأحسن في اللعن أن يكون لعنًا للأوصاف التي لعنها الله ورسوله، أما الأشخاص فليحذر الإنسان من ذلك.
[المتن]
الثامنة: هـٰذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.
[الشرح]
تقدم الكلام على هـٰذه القصة وما فيها، وأنها تصح عن سلمان موقوفة وليست مرفوعة إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والشاهد فيها بالنسبة للباب عظم وخطورة الذبح لغير الله، من جهة أن أحدهما قرب ذبابة فكان ذلك سببًا في دخوله النار.
[المتن]
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلُّصًا من شرهم.
[الشرح]
هـٰذه المسألة أخذها الشيخ -رحمه الله- من أن الرجل لما قيل له: ((قرب. قال لهم: لا أجد شيئًا أقربه أو ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرّب ولو ذبابًا)). فأمروه بتقريب أدنى ما يكون حتى الذباب ((فقرّب ذبابًا فخلوا سبيله)). فقال الشيخ -رحمه الله- في المسألة: (كونه دخل النار بسبب ذلك)؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((دخل رجل النار في ذباب)). قال: (بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصًا من شرهم.)
ما فيه إشكال أنه فعله تخلصًا من شرهم، لكن في قول الشيخ رحمه الله: (لم يقصده) إشكال، وذلك أن الرجل لم يعتذر بأنه لا يقرب لأحد شيئًا، إنما اعتذر لأي شيء؟ لأنه لا يجد ما يقرّب، فلما اقترحوا عليه هـٰذا لم يتردد، بادر إلى التقريب، فدل ذلك على أنه موافق لهم في التقريب لغير الله، وأن ذلك الفعل لم يكن عن إكراه محض، إنما عن موافقة وطاعة لهؤلاء فيما طلبوه منه من الكفر بالله عزّ وجل. معلوم أن الإكراه إذا كان المكرَه موافقًا منشرح الصدر لما أُكره عليه فإنه يؤاخذ به في المعصية والكفر، يعني في المعاصي التي دون الكفر وفي الكفر؛ لأن شرط عدم المؤاخذة بالإكراه أن يكون القلب مطمئنّاً بالإيمان وألا ينشرح إلى الكفر؛ لقول الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾( ) فإذا أُكره الإنسان على فعل من الأفعال- كفر فما دونه- وكان منه قبول لهـٰذا المكره عليه فإنه يُؤاخذ به في الكفر فما دونه؛ لصراحة هـٰذه الآية في الاستثناء حيث قال: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ فإنه يؤاخذ بذلك.
ثم إنّ من قال: إن الرجل كان مكرهًا؟ اختلفوا في دلالة الحديث على تأثير الإكراه على الفعل إذا كان كفرًا، فمن العلماء من قال: إن هـٰذا في شرع من قبلنا، وأما شرعنا فإنه وضع عنا ما يكون من الإنسان حال الإكراه فلا يؤاخذ به، فحمل الحديث على شرع من قبلنا، وأما شرع الإسلام فإن الإنسان إذا فعل فعلاً ولو كان كفرًا وهو مكره فإنه لا يُؤاخذ به.
وقال آخرون في الجواب على هـٰذا الحديث: إن الإكراه إنما يصح إذا كان في الأقوال دون الأفعال، فقالوا: إذا أُكره الإنسان على فعل فإنه لا يجوز له أن يفعله، لكن إذا أُكره على قول فلا بأس. واستدلوا لذلك بسبب نزول الآية وهو قصة عمار بن ياسر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فإنهم أكرهوه أن ينال من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فنال من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال في آلهتهم ما يرضيهم من التعظيم، فقالوا: نقصر الآية على سبب النزول وهو ما كان في الأقوال فقط. والصحيح ما عليه المحققون من أهل العلم من أنه لا فرق في الإكراه بين الفعل والقول، وأنه إذا أُكره الإنسان على فعل ما لا يجوز أو قول ما لا يجوز فإنه لا أثر لفعله من حيث المؤاخذة والإثم ولا يرتفع عنه وصف الإيمان. ولذلك جاء في قصة عمَّار أنه لما قص للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحكى له ما جرى منه قال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن عادوا فعد)). فأذن له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في العودة إلى قول الكفر إذا أُكره عليه إذا كان قلبه مطمئنّاً بالإيمان، وهـٰذا القول هو الصحيح وأن هـٰذا لا فرق فيه بين الفعل والقول.
[المتن]
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل، ولم يوافقهم على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
[الشرح]
وذلك أن هـٰذا الرجل امتنع عن تقريب أدنى ما يكون لهـٰذا الوثن ولهـٰذا المعظم وهـٰذا الصنم، فامتنع من تقريب أدنى ما يكون ورضي بالقتل على أن يقرب لأحد دون الله شيئًا، فهل هـٰذا على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟
ظاهر الحديث لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، لا سيما إذا قلنا: إن الرجل الذي قرب قرب معتقدًا موافقًا لهؤلاء على عقيدتهم، أما على قول من يقول: إنه أُكره ومع إكراهه لم ينفعه الإكراه في رفع المؤاخذة بالفعل، فإن الرجل امتنع امتناعًا واجبًا. وعلى كل حال ليس لنا نظر في أخذ هـٰذا الحكم من هـٰذا الأثر؛ لكونه موقوفًا على سلمان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فنأخذ الحكم من مصادر أخرى، فإذا نظرنا إلى ما دلّ عليه الكتاب وجدنا أنه يجوز للإنسان الموافقة على الكفر إذا أُكره على ذلك إكراهًا ملجئًا إذا كان قلبه مطمئنّاً بالإيمان، ولا يقدح ذلك في إيمانه ولا في منزلته ولا في مكانته.
لكن هل الأولى أن يصبر أو لا؟
هـٰذا يرجع إلى المصلحة: فإن كانت المصلحة أن يصبر ويقتل على الكفر فذاك هو المشروع مشروعية وجوب أو استحباب , وإن كانت المصلحة في الموافقة فذلك أيضًا هو المشروع مشروعية وجوب أو استحباب على حسب الحال، وأما مسألة الجواز فيجوز، إلا إن كان يترتب على الموافقة مفسدة أعظم من عدم الموافقة، فعند ذلك يتعين ألا يوافق.
[المتن]
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: ((دخل النار في ذباب)).
[الشرح]
وهـٰذا واضح؛ لأنه لو كان سبب دخوله النار غير ذلك لما رُتب عليه الفعل هـٰذا واحد. وثانيًا لكان سبب دخوله النار غير ذلك إذا كان مشركًا كافرًا، فلم يكن سبب دخوله النار تقريبه الذباب إنما هو ما كان عليه من الكفر قبل ذلك، فلما قال: ((دخل رجل النار في ذباب)) دل ذلك على أنه هو السبب الوحيد الذي أدخله النار.
[المتن]
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: ((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك)).
[الشرح]
وجه ذلك أنه لم يكن بين دخول الجنّة ودخول النار إلا هـٰذا الامتناع وهـٰذا الفعل، فدل ذلك على قربهما، وهو مصداق قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله)). فليس بين الإنسان والجنة إلا العمل الصالح، وليس بينه وبين النار إلا مقارفة السيئات وأعظمها الشرك.
[المتن]
الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
[الشرح]
وجهه أنهم طلبوا منه أن يعظم هـٰذا الصنم بأدنى ما يكون، فدل ذلك على أنه ليس مقصودهم من التقريب تقريب اللحم أو الأكل، إنما مقصودهم ما يقوم بالقلب من تعظيم هـٰذا المعبود من دون الله، فلذلك قالوا له مقترحين ملحّين: قرّب ولو ذباباً، ولو كان مقصودهم ما يؤكل وما يذبح لعذروه فيما اعتذر به حيث قال: ليس عندي شيء أقرّبه.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾( )الآية.
وعن ثابت بن الضّحاك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا. قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا. فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)). رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن الذبح لله -عز وجل- بمكان يذبح فيه لغيره من أسباب الشرك ووسائله؛ لأنه يفضي إلى تعظيم هـٰذه الأماكن التي يكفر فيها بالله عز وجل، هـٰذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد.
أما مناسبة الباب لما قبله: فإنه في الباب السّابق ذكر الشرك الأكبر وهو الذبح لغير الله تقربًا، وفي هـٰذا الباب ذكر سببًا من أسباب الشرك الأكبر، وهو أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن هـٰذا من أسباب الشرك ووسائله المفضية إليه، وهـٰذه مناسبة يتبين فيها أن المؤلف انتقل فيها من الأعلى إلى الأسفل، انتقل من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر كما فعله رحمه الله فيما تقدم فيما يلبس.
قدم أول باب من الإشراك: (لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه)، ثم أتى في الباب الثاني (باب ما جاء في الرّقى والتمائم)، وهي دون الحلقة والخيط؛ لأن الحلقة والخيط لا نفع فيهما بالكلية. ثم إن المؤلف أفادنا في الترجمة تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؛ لأنه قال: (باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله).
لكن لم يبين -رحمه الله- مرتبة ذلك هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وذلك لأنه يختلف باختلاف ما يقوم بقلب صاحبه: فقد يكون شركًا أكبر، وقد يكون شركًا أصغر.
وساق المؤلف رحمه الله في هـٰذا الباب على هـٰذه الترجمة آية وحديثاً.
الآية قول الله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ وهـٰذا نهي لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقوم في مسجد الضرار، فإن الضمير في قوله: ﴿فِيهِ﴾ يعود إلى مسجد الضرار، وهو مسجد بناه المنافقون في المدينة تفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله، فأتوا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يطلبون منه أن يصلي في المسجد لتحل فيه البركة، هكذا ذكر أصحاب السّير، فواعدهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يأتيهم يومًا، فأتاه الوحي بهـٰذه الآية في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًَا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾( ) ثم بعد أن ذكر هـٰذه الأوصاف الموجبة للتحريم قال بعد ذلك: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾. فنهاه عن القيام، وأبَّد هـٰذا النهي للدلالة على أن هـٰذا المسجد لا يكون لله ولرسوله، إنما هو للنفاق والمقاصد التي تقدّم ذكرها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، مع أنهم قدّموا الأيْمَان إنما أرادوا بذلك الإحسان، لكنها رُدت عليهم، وأثبت الله شهادتهم عليهم بالكذب فقال: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.
بعد هـٰذا كله قال: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ والشاهد في هـٰذه الآية على الباب أنه إذا كان المسجد -وهو بيت من بيوت الله –عز وجل-، والذي يعبد فيه الله -جل وعلا- منع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الصلاة فيه لكونه مقصودًا للضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، فالمنع من الذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله -عز وجل- من باب أولى، هـٰذه هي مناسبة ذكر هـٰذه الآية في هـٰذا الباب، وأنه إذا منع الله رسوله من القيام في مسجد من المساجد لأجل أن غرض أهله وأصحابه سيئ وقبيح -وهو أمر غير ظاهر- فالمنع من التقرب إلى الله في الأماكن التي يكفر فيها به ويشرك فيها به من باب أولى، ولذلك لما نهاه الله تعالى عن القيام في ذلك المسجد لما فيه من المفاسد أمره بأن يقوم فيما أُسِّسَ على التقوى فقال: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾. فدلّ ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يتحرى في عبادته مواطن القبول، وألا يشارك أهل الشر ولو كانت المشاركة في عمل خالص لله عزّ وجل. ومما يدلّ على هـٰذا الحكم أيضًا قول الله –تعالى- في بيان المحرمات من الذبائح: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾. فإن النُّصُب قيل: إنها أحجار تذبح العرب عندها وتنشر عليها اللحم تبرّكًا، وقيل: إنها أصنام. والمهم أنهم يذبحون عندها تعظيمًا لها سواء أكانت أحجارًا أم أصنامًا، فنهى الله -عز وجل- عن أكل ما ذُبح على النصب لأنه من جملة الشرك والكفر.
ومما يدل على ذلك أيضًا -يعني على الترجمة التي ذكرها المؤلف: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله- قول الله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾( ).
فمنع الله عز وجل أهل الإيمان من مشاركة الخائضين في آيات الله بالكفر والاستهزاء، وأمرهم بالمفارقة في هـٰذه الحالة، فالمشاركة في الأماكن التي يُعظم فيها غير الله ويذبح فيها لغيره أعظم وأخطر. المهم الدلائل على ما ذكره المؤلف رحمه الله كثيرة من هـٰذه الآية التي ذكرها وغيرها من الآيات.
ذكر المؤلف -رحمه الله- بعد ذلك دليلاً من السنة، وهو حديث (ثابت بن الضحاك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة.) وبوانة اسم مكان قيل: في الشّام، وقيل: إنها قرب ينبع، وقيل: إنها في أسفل مكة قريبة من ميقات يلملم. ولا حاجة للبحث في تحديد مكانها، المهم مكان من هـٰذه الأمكنة، قال: (فسأل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن هـٰذا النذر: هل يفي به أو لا؟ فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا. قال) أي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا). فسأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سؤالين، السؤال الأول سأل: ((هل كان فيها)) أي هـٰذا المكان بوانة ((هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟)) سواء أكان على صورة أم على غير صورة، وفرقوا بينه وبين الصنم في أنه على صورة مجسمة وأن الصنم على صورة غير ممثلة بشيء. أما الوثن فهو ممثل إما بإنسان أو بحجر أو بغيره أو شجر، على كل فالصحيح هو كل ما يعبد من دون الله. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد لبس الصليب قال له: ((انزع عنك هـٰذا الوثن)). فهو كل ما يعظم من دون الله.
سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرجل الذي سأله عن الوفاء بنذره: (((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا). المجيب هم الصحابة، ويحتمل أن يكون الرجل ومن معه إن كان معه جماعة قد أتوا، أو من حضر مجلس رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ثم سأل سؤالاً آخر فقال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)). والعيد هو كل ما يعود ويتكرر مما يحصل فيه الاجتماع أو عمل معيّن، وذلك يكون في الأزمنة وفي الأمكنة: أمّا الأزمنة فكيوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، وأما الأمكنة فأيام منى ويوم التّروية ويوم عرفة، فإنها من الأعياد المكانية؛ لأنّ الناس يعودون إليها كل عام في وقت محدد. (فقالوا: لا. فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أوف بنذرك)).) فأذن له رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالوفاء بالنذر.
وهل هـٰذا أمر إيجاب أو أمر استحباب؟
العلماء لهم في هـٰذا قولان، منهم من قال: إنه أمر إيجاب؛ لأن الأصل في النذر الوجوب، وهـٰذا ليس نذرًا مباحًا؛ لأنه نذر يتعلق بمنفعة أهل ذلك المكان، فكما لو نذر أن يتصدق على أهل بلد من البلدان فإنه يتعيّن عليه أن يرسل صدقته التي نذرها إلى أهل تلك الجهة التي نذرها؛ لأنه تقرّب إلى الله عز وجل بفعل معين، وليس نذرًا مباحًا يُخَير الإنسان فيه بين الفعل والترك. ومنهم من قال: إن قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أوف بنذرك)) هو رخصة، ولا يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك المكان، إنما الواجب عليه أن يفي بالنذر أي بأصل النذر لا بمكانه. والظاهر أن عليه أن يفي بالنذر وبمكانه إذا كان قصده نفع تلك الجهة؛ لأنه من الطاعة التي تدخل في عموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). فهو من الطاعة.
ثم قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -بعد أن قال له: ((أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله)). فأفادنا هـٰذا القول أنه إن كان المكان الذي نذر العبادة فيه من ذبح أو غيره فيه وثن من أوثان الجاهلية، أو فيه عيد من أعيادهم فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر، بل هو من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء بالنذر فيه, فإن كان الناذر يقصد تعظيم ذلك المكان فإنه يكون شركًا أكبر، ولا يمنع هـٰذا أنه يكون معصية؛ لأن المعصية تشمل الشِّرك وما دونه؛ لأنَّ المعصية هي مخالفة الأمر بشرك فما دونه , وإن كان قصده التقرّب إلى الله في ذلك المكان دون تعظيمه إنما موافقة لمن يفعله فهـٰذا من الشرك الأصغر؛ لأنه من أسباب الشرك.
وعلى الحالين لا يجوز له الوفاء بنذره، يحرم عليه الوفاء بالنذر؛ لأنّه من المعصية، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
ثم قال: ((ولا فيما لا يملك ابن آدم)) أي: ليس على المؤمن الوفاء بنذر إلا فيما يملكه، فإذا نذر أن يتصدق بما لا يملك فإنه لا يجب عليه الوفاء؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾( ) وهـٰذا لا يستطيع. لكن هل تكون ذمته بريئة، أي: لا يلحقه شيء بهـٰذا النذر؟
الجواب: لا، يجب عليه أن يكفر كفارة يمين؛ لأن كل نذر لا يتمكن الإنسان من الوفاء به شرعًا أو حسّاً فإنه يجب عليه أن يكفر؛ لعموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((كفارة النذر كفارة اليمين)).
وعلى هـٰذا من نَذَر نَذْر معصية، من نذر أن يذبح في مكان يعظم فيه غير الله، هل يجب عليه الوفاء؟
لا يجوز له الوفاء، ويجب أن يذبح لكنه في غير هـٰذا المكان، يبقى فوات المكان هل يكفر عنه؟
الجواب: نعم يكفر عنه؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر في حديث عقبة بن عامر بالعموم فقال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)). وفي حديث عائشة الذي رواه الخمسة أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به وقالت: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((وكفارته كفارة يمين)). فدل ذلك على أن نذر المعصية يكفر عنه إذا لم يف به الإنسان، لا يجوز له أن يفي به لكن لا يسقط عنه النذر بمنعه وعدم جواز الوفاء، بل يجب عليه الكفّارة.
ثم قال رحمه الله: (رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما)، أي: إسناد الحديث على شرط البخاري ومسلم. والحديث صحيح، صححه جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. الشاهد فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن وفاء النذر إذا كان معصية، ومنه إذا كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو كان فيها عيد من أعيادهم.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير قوله: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾( ).
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذا الطاعة.
[الشرح]
ما فيه إشكال أن المعصية قد تؤثر في الأرض، ومن تأثيرها في الأرض أنه لا يجوز الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ومن تأثيرها في الأرض أن الله -عز وجل- نهى نبيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن القيام في هـٰذا المسجد لما كان الغرض منه والمقصود من بنائه الكفر والتفريق والصد عن سبيل الله والإرصاد لمن حارب الله ورسوله.
[المتن]
الثالثة: رد المسألة المُشْكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.
[الشرح]
وهـٰذا لا يختص بهـٰذا الباب، بل هو في كل باب: إذا أشكلت عليك مسألة وخفي عليك شيء من وجهها أو حكمها فردها إلى المسألة البينة. ومراد المؤلف رحمه الله أنه رد في هـٰذا الباب مسألة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله إلى قوله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾. فالمسألة هنا واضحة ظاهرة، وبها يتبين حكم المسألة التي ترجم لها المؤلف رحمه الله.
[المتن]
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
[الشرح]
وذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سأله الرجل: هل يفي بنذره؟ سأله قال: (((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) فقالوا: لا. قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) فقالوا: لا). وهـٰذا استفصال، وهو مما يحتاج إليه المفتي ليصل إلى الجواب الصواب , وذلك فيما يحتاج إلى استفصال من مسائل العلم.
وكثيرًا ما يستفتى الشخص وقد يبادر إلى الجواب، ثم مع المناقشة من المستفتِي يتبين أن جوابه غير مطابق للصواب، بحكم أن المستفتِي قد أخفى شيئًا له أثر في الحكم، لم يبين شيئًا يظن أنه لا يؤثر في الحكم. ويقابل هـٰذا أن بعض المستفتين يأتي بالقصة من أولها إلى آخرها، ويذكر نوع الطعام والشراب والمنام وأشياء تفصيلية لا أثر لها في الحكم يظن أنها تؤثر. والوسط أن ينظر المفتي ما يحتاجه من الاستبانة فيستبينه من المستفتي حتى يصل إلى الحكم، كما جرى من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذه المسألة.
[المتن]
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
[الشرح]
أي: إنه يجوز لا لكونها مقصودة بذاتها، إنما لكون المقصود نفع أهلها، أما قصد بقعة معينة بعبادة لأجل البقعة فهـٰذا غير مشروع إلا في المساجد الثلاثة: ((لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)). فكل من قصد مكانًا معينًا بعبادة وجعلها محلاًّ لعبادته -والقصد هو المكان بعينه لا من في المكان- فإنه يمنع منه؛ لعموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)).
[المتن]
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
[الشرح]
لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) يعني: في الماضي. ((وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ )). وهـٰذا يشمل النهي عن ذلك إذا كان قائمًا موجودًا أو إذا كان قد مضى وانتهى؛ لأنه إذا كان موجودًا فهو مشاركة فعلية لهم، وإذا لم يكن موجودًا فهو إحياء لما كانوا يعتقدونه، وفي كلتا الحالين فهو محظور من جهة أنه سبب من أسباب الشرك.
[المتن]
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
الثّامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية.
[الشرح]
والنّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). والشّرك من أعظم ما يعصى به الله عز وجل: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾( ) فلا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان يتضمن الشرك أو إذا كان وسيلة إلى الشرك؛ لأنه من المعاصي بل هو أعظم المعاصي، وإن كان يشاركها في الجملة ولكنه أعظم منها خطرًا وأعظم منها عقوبة وإثمًا.
[المتن]
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
[الشرح]
وذلك أنّ هـٰذا الرجل لم يقصد بهـٰذا النذر مشابهة المشركين، إنما قصد الذبح لله في هـٰذا المكان فليس له غرض في مشابهتهم، ومع ذلك (سأل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ... هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ))). ولم يقل: هل قصدت إحياء ما كانوا يعظمونه من الأعياد والأوثان؟ بل نهاه. وهـٰذه فائدة وقاعدة مهمة، وهي: أن مسائل التشبه لا دخل للمقاصد فيها. نهى الشارع عن التشبه بالكفار، فإذا قال قائل في فعل فعله مما يختص بالكفار مشابهة لهم: أنا لم أقصد التشبه. نقول: أنت منهي عن ذلك ولو لم تقصد التشبه، فتكون آثمًا بمجرد الموافقة ولو لم يكن هناك قصد التشبه، فإذا كان قصد التشبه موجودًا ازداد الإثم إثمًا فكان الإثم في عمل القلب وعمل الظاهر، لكن التشبه بنفسه إثم ولو لم يكن فيه قصد مشابهة أهل الكفر. وقد قرر هـٰذا شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم تقريرًا واضحًا بينًا، وأنه لا أثر للقصد في التشبه من حيث المنع، وأنه يمنع سواء قصد أو لو لم يقصد.
[المتن]
العاشرة: لا نذر في معصية.
[الشرح]
لا نذر ابتداءً ولا نذر وفاءً، يعني: لا يجوز أن ينذر الإنسان ابتداءً معصية من المعاصي، ولو نذر فإنه لا يجوز له الوفاء. والمعصية هي كل ما نهى عنه الله ورسوله، فلا يجوز نذر المعصية، ولا الوفاء بتلك المعصية إذا نذر.
[المتن]
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
[الشرح]
وهـٰذا واضح في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ولا فيما لا يملك ابن آدم)). وقوله: ((لا يملك)) يشمل ما إذا نذر ما ليس في ملكه- يعني: ما ليس تحت يده- كأن ينذر أن يذبح شاة ليست في يده: إما في يد غيره أو أنه لم يملكها , وكذلك يدخل في هـٰذا فيما لا يملك أي فيما لا يقدر ولا يستطيع، ففيه النهي عن النذر بنوعيه: نذر ما لا يستطيعه الإنسان، ونذر ما ليس تحت يده.
هل يترتب على هـٰذه الأنواع من النذر شيء؟
الجواب: إذا نذر نذر معصية أو نذر ما لا يستطيعه فإنه يكفره كفارة يمين؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((كفارة النذر كفارة اليمين)). وهـٰذا يشمل جميع أنواع النذر، لكن يبقى نذر الشرك سيأتينا البحث فيه في الباب القادم هل يكفره أو لا يكفره؟
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب من الشرك النذر لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾( ). وقوله: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ﴾( ).
وفي (الصحيح) عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
[الشرح]
فهـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي: أن النذر عبادة كما دل عليه الكتاب والسنة، فصرف النذر لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد، هـٰذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. وأما مناسبته للباب الذي قبله: ففي الباب الذي قبله ذكر النذر في حديث (ثابت بن الضحاك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-في قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة)، فذكر في هـٰذا حكم النذر، وأنه من الشرك أن ينذر لغير الله، والآن يذكر الشرك في العبادة نفسها، وهو الشرك الأكبر بصرفها لغير الله؛ لذلك قال: (من الشرك النذر لغير الله.)
واللام في قوله: (لغير الله) لام التعليل، أي: لأجل غير الله تعبدًا فإنه يكون قد وقع في الشرك. ويشمل هـٰذا إذا ما نذر لغير الله تعبداً صرفًا: كأن يتقرب للولي بالنذر، أو يتقرب للقبر بالنذر، ويشمل أيضًا ما إذا كان نذره لغير الله لسبب: إما دفع ضر، أو جلب نفع. مثاله: النذر للجن، فإذا نذر للجن ليدفعوا عنه شرّاً أو يجلبوا له نفعًا فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر.
والنذر أصله هو إلزام المكلف المختار نفسه لله شيئًا غير محال. هـٰذا أصل النذر، وأما صيغته فالصحيح أنه لا صيغة له محددة، بل ينعقد النذر بكل قول يدل عليه. فقول الله تعالى في سورة براءة فيما قصه عن المنافقين: ﴿لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ هـٰذا نذر، هل فيه لفظ النذر؟ ليس فيه لفظ النذر لكن فيه معناه، وهو ماذا؟ إلزام النفس بشيء لله تعالى.
واعلم أن النذر قد يتأكد بالقسم أو يتأكد بالمؤكدات، لكن هـٰذا لا يخرجه عن كونه نذراً، فإذا قال: لله علي عهد أن أذبح. هـٰذا نذر أو لا؟ نذر؛ لأن النذر معناه إلزام النفس بشيء لله تعالى، سواء بلفظه أو بغير لفظه، لذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريف النذر قالوا: بكل قول دل عليه. والمؤلف رحمه الله بيَّن في الترجمة حكم النذر فقال: (باب من الشرك النذر لغير الله.)
سؤال: هل هـٰذا الشرك أصغر أو أكبر؟
هـٰذا شرك أكبر؛ لأنه نذر عبادة وقد صرفها لغير الله، فلا إشكال أنها من الشرك الأكبر.
ذكر المؤلف رحمه الله في هـٰذا الباب آيتين وحديثًا. أما الآيتان فقال: (وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾.) وهـٰذا على وجه الثناء والمدح في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾( ) ثم أثنى عليهم وبين أن من أسباب استحقاقهم لهـٰذا الفضل المذكور وفاءهم بالنذور فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾. ومعنى الوفاء بالنذر هو: إتيان ما عاهد الله عليه، وهـٰذا يدل على أن الوفاء بالنذر من العبادات والقربات التي يؤجر عليها الإنسان.
لكن يبقى النظر في النذر نفسه، هل هو مما حثت عليه الشريعة وأمرت به؟
الجواب: لا، بل إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن النذر، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وقال: ((لا يأتي بخير)). لكن هـٰذا من حيث إنشاء النذر، أما من حيث الوفاء به فإن الوفاء به من القربات، بل هو من القربات التي يستحق بها صاحبها النعيم في الآخرة؛ للآيات التي ذكرناها قبل قليل، فهو من صفات الأبرار.
وقوله: ﴿بِالنَّذْرِ﴾ هنا يشمل كل ما أوجبه الله عز وجل؛ لأن الأصل في النذر الوجوب، ومما أوجبه الله على عباده أنهم إذا عاهدوه عهدًا وجب عليهم الوفاء به، وهـٰذا المعنى العام للنذر يشمل كل الواجبات: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ يعني كل ما أوجبه الله عليهم يقومون به ويفعلونه.
أما القول الثاني في الآية فهو: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ المعين الخاص، وهو ما ألزموا به أنفسهم.
هل جاء في القرآن ما يدل على المعنى الأول أن النذر هو كل ما أوجبه الله عليهم؟
في قوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾. ومعلوم أن من قصد البيت لم ينذر نذراً، إنما المقصود ليوفوا نذورهم أي ليكملوا ويفعلوا ما أوجبه الله عليهم من فرائض الحج.
إذاً النذر في هـٰذه الآية يحتمل أن يكون بمعناه العام، وهو: ما أوجبه الله على الإنسان. ويحتمل أنه على المعنى الخاص، وهو: ما ألزم الإنسان به نفسه من الطاعات.
وقوله: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ﴾. وهـٰذا فيه الإشارة إلى (وجوب الوفاء بالنذر)، وذلك في قوله: ﴿أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ﴾. فقول الله: ﴿فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ﴾ ما فائدة ذكر العلم هنا؟ هي المجازاة على فعله والمعاقبة على تركه، وإلا فمعلوم أن الله تعالى يعلم من الإنسان كل ما يكون منه، فالله عز وجل بكل شيء عليم، لكن لما خص ذلك في هـٰذه الآية دل على أن المقصود حصول المجازاة بفعل ما تقدم وحصول المعاقبة بترك ما تقدم. والشاهد في الآيتين للباب إثبات أن النذر عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة دل على ما ترجم له المصنف في قوله: (باب من الشرك النذر لغير الله)؛ لأنه لو قال قائل: الآية ليس فيها أنه من صرف النذر لغير الله فقد أشرك، فكيف الجواب؟
الجواب: أن الآيات تفيد أن النذر والوفاء به عبادة، وإذا كان عبادة فإن صرف العبادة لغير الله حكمه الشرك، وصرفه لله عز وجل توحيد وطاعة.
ثم قال: (وفي الصحيح عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).)
((من نذر أن يطيع الله)). وهـٰذه تشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. فـ ((من نذر أن يطيع الله)) يعني: أن يقوم بما أمر الله به ورسوله على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، فإنه يلزمه الوفاء بما نذر. فمن نذر أن يصلي الفجر يجب عليه أن يصلي الفجر أو لا؟ يجب عليه في أصل الشرع؛ لأن الله فرضها على جميع الناس، ويجب عليه أيضًا وجوباً زائداً؛ وفاءً بنذره والتزامه. من نذر أن يتصدق، يعطي المساكين من غير الزكاة، هـٰذا نذر وفعله مستحب في الأصل، لكنه ينتقل إلى الوجوب بنذره؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)).
الشاهد في الحديث قوله: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). وهـٰذا فيه حكم النذر إذا كان معصية، وتقدم لنا أن المعصية هي مخالفة أمر الله ورسوله، وأعلى ما يكون في المعاصي الشرك بالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فمن نذر شركًا ما حكم الوفاء بالنذر في الشرك؟
يحرم أن يفي به؛ لأجل أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
إذا حرم عليه الوفاء به هل يلزمه بنذر المعصية شيء؟
هذة مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم في نذر المعصية إذا نذره الإنسان، اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يفي بالنذر؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). ووقع الخلاف بين العلماء إذا ما نذر نذر معصية هل تجب بنذره كفارة أو لا؟ قولان:
الجمهور على أنه لا كفارة.
والقول الثاني أن فيه الكفارة، وهو قول ابن القيم، واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين - رحم الله الجميع -، واستند القائلون بوجوب الكفارة في نذر المعصية إلى حديث عائشة عند الخمسة وعند الإمام أحمد وأصحاب السنن، وفيه قالت: ((لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة يمين)). ويدل له أيضاً عموم حديث عقبة في صحيح مسلم: ((كفارة النذر كفارة اليمين)). وهـٰذا لا إشكال فيه إذا ما كان النذر نذر معصية دون الشرك، أما إذا كان النذر شركاً فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا ينعقد، يعني: لا يثبت به شيء، يجب على صاحبه أن يتوب، ولا يترتب على قوله شيء، ولا تلزمه كفارة، ولا يلزمه إلا التوبة والاستغفار، وهـٰذا لا إشكال فيه، وهو الصحيح فيما لو نذر نذراً شركيّاً، أما إذا نذر نذر معصية؟ ففيه الخلاف الذي ذكرناه: قول الجمهور، وقول ابن القيم ومن اختاره.
لذلك فمن المستحسن أن نقول: إن نذر المعصية ينقسم إلى قسمين: إذا كان شركًا فإن هـٰذا لا ينعقد أصلاً؛ لأنه صرف العبادة لغير الله، والكلام في النذر وتكفيره فيما إذا كان النذر يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، فهنا نقول: لا تفِ بنذر المعصية؛ لأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالمعصية، ولكن يلزمك كفارة لهـٰذا النذر؛ للأحاديث التي مرت، أما نذر الشرك فإنه لا ينعقد من أصله.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس العاشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله
وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾( ).
وعن خولة بنت حكيم -رَضِيَ اللهُ عَنْها- قالت: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك)). رواه مسلم.
[الشرح]
يقول رحمه الله: (باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾.)
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن الاستعاذة هي طلب العوذ، والعوذ هو طلب الحماية والحفظ، فيكون معنى الاستعاذة طلب الحماية والحفظ. والحماية –والحفظ- المطلقة التامة إنما تكون من الله تعالى، وإذا كانت كذلك فإن طلبها من غير الله تعالى يكون من الشرك الذي يقدح في توحيد صاحبه. لم يبين المؤلف -رحمه الله- من أي أنواع الشرك، لكن ترك بيان ذلك لظهوره ووضوحه، فإن الاستعاذة نوع دعاء، الاستعاذة في الحقيقة دعاء خاص وهو دعاء الحماية والحفظ، ويكون في طلب دفع الشر قبل وقوعه، وكذلك يكون في طلب رفعه بعد وقوعه، فإذا كان دعاءً فصرفه لغير الله شرك أكبر أم أصغر؟
شرك أكبر؛ لأن الدعاء لله وحده كما تقدمت الأدلة على ذلك، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده.
المهم أن قوله: (من الشرك) أي: من الشرك الأكبر، وعرفنا معنى الاستعاذة وأنها تكون في دفع الشر وفي رفعه. أما في دفعه فكقول القائل: أعوذ بالله العظيم، وسلطانه القديم، من شر الشيطان الرجيم. وكتعويذ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من عَوَّذه من الناس، كتعويذه الحسن والحسين، وكقوله: من نزل منزلاً فقال: ((أعوذ بكلمات الله التامات)). هـٰذا طلب دفع الشر قبل وقوعه. ويكون أيضاً في طلب رفعه بعد وقوعه، وهـٰذا ينازع فيه بعض أهل العلم ويقول: إن الاستعاذة لا تكون في الشر بعد وقوعه، إنما تكون في الشر قبل وقوعه.
والصحيح أنها تكون في الأمرين، دليل ذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إذا وجد أحدكم شيئاً فليضع يده على موضع الألم وليقل: أعوذ بعزة الله العظيم وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)). وهـٰذه استعاذة من شر أمر نازل أو أمر متوقع؟ من أمر نازل، فهـٰذا دليل على أن الاستعاذة تكون من أمر نازل أي واقع، وتكون من الأمر الذي يخشى ويخاف وقوعه.
وقوله: (بغير الله). يشمل الاستعاذة بالملائكة، والاستعاذة بالجن، والاستعاذة بالصالحين والأولياء والأنبياء، ويشمل كل ما يستعيذ به الناس في دفع الشر عنهم، كل هـٰذا لا يجوز؛ لأن الأصل في الاستعاذة أنها حق لله تعالى. لكن ينبغي أن نعلم أن الاستعاذة التي هي حق لله عز وجل هي الاستعاذة المطلقة، أما الاستعاذة المقيدة، وهي: ما كان في مقدور الإنسان الحي الحاضر فإنها ليست من الشرك، سواءٌ أكانت بلفظ الاستعاذة أم بلفظ الاستعانة أم بلفظ الاستغاثة، لا حرج في ذلك.
ومنه قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر الدجال في صحيح مسلم: ((فمن وجد ملجأً أو مَعَاذًا فليعذ به)). فدل ذلك على أن الاستعاذة التي في مقدور الإنسان لا تكون من الشرك، وهـٰذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم، فتنبه! إذ إن كلامنا في قول المؤلف رحمه الله: (من الشرك الاستعاذة بغير الله)، هي الاستعاذة المطلقة، ويندرج تحتها صور:
1- الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، مثل: طلب النصر، وطلب هداية القلوب، وطلب مغفرة الذنوب، وما أشبه ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فهـٰذا سؤاله من المخلوق والاستعاذة بالمخلوق فيه من الشرك الأكبر.
2- ومما يدخل في قول المؤلف رحمه الله: (من الشرك الاستعاذة بغير الله)، الاستعاذة بالأنبياء والصالحين الميتين، فإن هـٰذا من الشرك.
3- ومثله أيضًا الاستعاذة بالحي الغائب.
4- ومثله أيضًا الاستعاذة بالحي ولو كان حاضرًا فيما لا يقدر عليه إلا الله.
كل هـٰذه الصور تدخل في قول المؤلف رحمه الله: (من الشرك الاستعاذة بغير الله). والذي يسلم من أنواع الاستعاذة من أن يكون شركًا هو الاستعاذة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه.
بعد هـٰذا ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب آية وحديثًا.
أما الآية فهي: (وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾( ).)
هـٰذه الآية صلة ما ذكره الجن في سورة الجن، قالوا مخبرين عن أنفسهم: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ﴾ أي يطلبون العوذ ﴿بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾ فماذا كانت عاقبتهم؟ ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أي: فزاد الإنسُ الجنَّ رهقاً، فالفاعل هم الإنس زادوا الجن رهقاً.
الرهق في لغة العرب يطلق على الإثم وغشيان المحارم والمعاصي، فيكون المعنى: أن الإنس لما استعاذوا بالجن زادوا الجن إثماً ووقوعاً في المعاصي والمآثم، وجه ذلك: أن الجن استكبروا وطغوا لما استعاذ بهم الإنس، فإن العرب في جاهليتهم كانوا إذا نزل أحدهم في واد من الأودية قال: أعوذ بسيد هـٰذا الوادي من سفهاء قومه. فتعاظم الجن في أنفسهم وقالوا: سُدنا على الإنس والجن. فكان ذلك سببًا لطغيانهم ولاستطالة شرهم، هـٰذا معنى قوله تعالى: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾.
وجه الشاهد من الآية قوله تعالى: ﴿يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾. فإن الاستعاذة الشركية كانت سببًا في زيادة الطغيان والكفر من الجن، ومن هـٰذه الآية يستفاد أنه لا يجوز الاستناد في الاستعاذة على غير الأسباب الظاهرة.
فالأسباب الخفية ليس لها اعتبار في الشرع
الجن ألا يمكن أن يكونوا حاضرين وقت الاستعاذة؟ بلى يمكن. ألا يمكن أن يكون سيدهم قادراً على منع سفهائهم من أذية هـٰذا؟ بلى. لكن لما كان ذلك أمرًا خفيّاً فإن الله جل وعلا منعه وذمه، وجعله من أسباب الزيادة في الكفر والطغيان والوقوع فيما حرم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وعليه فإنه لا يستند في الأسباب إلى الأسباب الخفية التي لا تظهر؛ لأنه ما لم يكن السبب ظاهرًا واضحًا سليمًا من الشرك من كل وجه لا يجوز تعاطيه، ولا يجوز أخذه، ولا يجوز الاعتماد عليه، يعني: العمل به.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((من نزل منزلاً))). منزلاً هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل منزل ينزله الإنسان في حضره وسفره أو في سفره؟ في حضره وسفره؛ لأنه ما فيه دليل على أنه في السفر فقط، في العمار وفي الفناء، يعني: فيما بني من الأرض وفيما لم يبن.
من نزل منزلاً، بل بعض العلماء عمم ذلك حتى في المركوبات، فإذا ركبت السيارة فقلها أيضاً تسلم من الشر، إذا ركبت الطائرة قل هـٰذا تسلم من الشر، قال ذلك شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله.
((فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك)).
((فقال: أعوذ بكلمات الله)). وهـٰذا فيه الاستعاذة، وفيه الشاهد من الحديث، حيث وجه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الاستعاذة بكلمات الله التامات. و((الكلمات)) جمع كلمة، وهي ما تكلم به الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. و((التامات)) التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهـٰذا وصف كاشف أو وصف مقيد؟ وصف كاشف؛ لأن جميع ما تكلم به الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- تام لا نقص فيه؛ لأن الكلام صفته، وصفاته ليس فيها نقص: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( ) الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾( ).
فقوله: ((التامات)) هنا صفة كاشفة. فما المراد بالكلمات؟ هل هي الكلمات الشرعية، أم الكلمات الكونية؟
الشرعية كالقرآن والتوراة والإنجيل وما تكلم به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في كتبه، أم الكلمات الكونية، وهي: كل ما تكلم به جل وعلا؟ فالمراد المعنى الثاني: الكلمات الكونية، يدل على ذلك أنه وصفها في حديث آخر فقال: ((اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)). وهـٰذا إنما يكون في الكلمات الكونية؛ لأن الكلمات الشرعية هل يجاوزها الكافر أو لا؟ يتجاوزها الكافر ولا يلتزم بها، فالمراد بالكلمات هو الكلمات الكونية. ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)). وهـٰذه استعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا.
وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهـٰذا الحديث على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وأنه غير مخلوق؛ لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق بحال من الأحوال، فلما كان كذلك دل هـٰذا على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل.
قال: ((من شر ما خلق)). والشر ضد الخير، وهو: ما يقبح من القول أو الفعل، فوجه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المؤمن إلى أن يستعيذ بكلمات الله الكونية القدرية من شر ما خلق. ((ما)) هنا بمعنى الذي، أي: من شر الذي خلق، وهل هـٰذا يشمل جميع الخلق؟ لا يشمل جميع الخلق؛ لأن من الخلق ما لا شر فيه كالجنة. وقال بعض العلماء: والملائكة وما أشبه ذلك مما لا شر فيه من الخلق، فيكون المعنى: من شر ما خلق أي من شر الخلق الذي فيه الشر، وليس كل مخلوق فيه شر.
قال: ((لم يضره شيء)). وهـٰذه أيضاً نكرة في سياق النفي، فيشمل الضرر الحسي والضرر المعنوي، كما ينزل بالإنسان من ضيق الصدر وما أشبه ذلك، هـٰذا هو المعنوي، والحسي كتسلط الآفات عليه والهوام وما أشبه ذلك. ((لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك)) يعني: من هـٰذا المنزل الذي ابتدأ نزوله بقوله: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)).
والشاهد في هـٰذا الحديث الاستعاذة بالله عز وجل، وأنه لا يستعاذ إلا به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وبصفاته، وهـٰذا أمان مؤقت أم مطلق؟ مؤقت بقوله: (((حتى يرحل من منزله ذلك)). رواه مسلم.)
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية الجن.
الثانية: كونه من الشرك.
[الشرح]
وجه ذلك: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أي كفرًا وطغيانًا، والوجه الذي ذكرناه أنه عبادة ودعاء، فصرفه لغير الله يكون من الشرك.
[المتن]
الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأنّ العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأنّ الاستعاذة بالمخلوق شرك.
[الشرح]
وقد عرفتم أن من استدل بهـٰذا الإمام أحمد -رحمه الله- في مناظرته للمعتزلة في مسألة خلق القرآن.
[المتن]
الرابعة: فضيلة هـٰذا الدعاء مع اختصاره.
[الشرح]
سبحان الله! كلمات معدودة: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)). القرطبي -رحمه الله- شارح مسلم ذكر أن هـٰذا من أعظم الأذكار، وأنه منذ عرف هـٰذا الدعاء لم يتركه، ولم يصبه شيء، إلا مرة نزل منزلاً فلدغته حية أو عقرب، فلما تأمل وجد أنه لم يقل هـٰذا الذكر، يقول: فلم أزل أقوله. وهـٰذا فيه بيان فائدة الأذكار الشرعية، وأنها –إضافة إلى كونها اتباعًا للسنة وتحصيلاً للأجر- يحصل بها للإنسان نفع دنيوي، والنفع الدنيوي جائز أيضًا وهو من الفوائد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى.
يعني: لو أن الإنسان قال هـٰذا الذكر ليحمي نفسه، ما كان في باله إلا أن يحفظ نفسه فإنه جائز ويحصل له مقصوده، لكن قد يفوته الأجر، أي: أجر اتباع السنة.
[المتن]
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية -من كف شر أو جلب نفع – لا يدل على أنه ليس من الشرك.
[الشرح]
هـٰذه هي المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل.
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾( )الآية.
وقوله: ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾( ) الآية.
وقوله: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾( ) الآيتان.
وقوله: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾( ).
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من هـٰذا المنافق. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل)).
[الشرح]
هـٰذا الباب في الحقيقة صلة الباب المتقدم؛ لأن الاستعاذة والاستغاثة الكلام فيهما واحد. مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا، وهي عبادة، وهي نوع دعاء إلا أنه دعاء خاص كالاستعاذة، فلا يجوز صرفها إلى غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وصرفها إلى غيره من الشّرك. والاستغاثة هي طلب الغوث، أي: طلب النصرة، وهي إنما تكون في الغالب عند اشتداد الكرب وضيق الحال، فإنه يُتلفظ بهـٰذا اللفظ ومشتقاته في طلب الإنقاذ من الشدة والكرب، والغالب أن يكون نازلاً بالإنسان. والاستغاثة كالاستعاذة فيما يجوز منها وما يحرم على التفصيل السابق، فالاستغاثة من حيث الأصل لا تكون إلا بالله عز وجل، ولا يستغاث إلا به جل وعلا، والاستغاثة التي تكون من الشرك هي:
1- أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل.
2- أن يستغيث بالأنبياء والصالحين الأموات.
3- أن يستغيث بالغائب.
4- أن يستغيث بالحي الحاضر الذي لا يستطيع، وهـٰذا يدخل في القسم الأول.
5-أن يستغيث بالحي غير الحاضر، هـٰذا أيضاً مما يدخل في الشرك الذي ذكره المؤلف رحمه الله: (من الشرك أن يستغيث بغير الله).
وقوله: (بغير الله) كالكلام في الباب الذي قبله.
قوله: (أو يدعو غيره)، وهـٰذا تعميم بعد تخصيص.
(أو يدعو غيره) أي: يدعو غير الله سبحانه. والدعاء هنا هو دعاء المسألة، بقرينة السياق، وإلا في الأصل فالدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، هـٰذا هو الأصل , لكن قرينة السياق دلت على أن المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة. و(غيره) يشمل دعاء الملائكة والأنبياء، ودعاء الجن، ودعاء الصالحين، ودعاء الأموات، ودعاء الأحياء فيما لا يقدرون عليه , لكن إذا كان دعاءً فيما يقدر عليه، كأن قال له: أعطني كذا، فهـٰذا في اللغة يسمى دعاءً، أو ناداه باسمه وهو حاضر: أعطني كذا، فهـٰذا دعاء لكنه ليس مرادًا في هـٰذا الكلام.
ذكر المؤلف رحمه الله في الاستغاثة والدعاء عدة نصوص تدل على ما ترجم به أنه من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعو غيره.
واعلم أن دعاء غير الله -عز وجل- على صور، منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو دون ذلك.
فدعاء غير الله من الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، هـٰذا القسم الأول.
القسم الثاني من الأدعية الشركية: دعاء الميت، أو خطاب الميت تسأله أن يدعو لك الله، وصورته أن يأتي الإنسان إلى القبر ويقول: يا فلان اسأل الله لي كذا: تفريج الكُرَب، وهداية القلوب، وما أشبه ذلك من المطالب، هـٰذا النوع من الدعاء هل هو دعاء للميت؟ هـٰذا طلب للشفاعة، طلب للواسطة أن يدعو له الله، يعتقد أن الميت يسمعه وأن له جاهًا، فيسأله بناءً على هـٰذا أن يسأل الله له كذا وكذا. وهـٰذا النوع من أنواع الدعاء اختلف فيه أهل العلم من أهل السنة على قولين، منهم من قال: إنه بدعة منكرة، وهو وسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه يدعوه اليوم أن يسأل الله له كذا وغدًا يتوجه بالسؤال إليه، وهـٰذا قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في عدة مواضع من كلامه أنه بدعة منكرة. واختاره شيخنا محمد رحمه الله.
والقول الثاني أنه شرك أكبر يخرج به صاحبه من الملة، وهـٰذا هو الذي عليه كثير من أئمة الدعوة، وهو أن دعاء الأموات ولو كان دعاءً لطلب الدعاء من الله فإنه شرك أكبر يخرج به صاحبه من الملة.
القسم الثالث من أنواع الدعاء الشركي: الدعاء بالجاه، كأن تقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان، هـٰذا استقر الأمر على تحريمه، وعند المتقدمين من السلف قول بجوازه، وممن قال بجوازه الإمام أحمد رحمه الله، وقد ورد في ذلك حديث موضوع، وهو ما ينسب إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم)). وهـٰذا حديث كذب موضوع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لا يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . هـٰذه أقسام الدعاء من حيث مراتبها في البدعة والشرك.
قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾.)
نهى الله رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو نهي لكل أحد، لكل من بلغه الخطاب- ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ﴾ والدعاء المنهي عنه أي أنواع الدعاء؟ هو دعاء العبادة ودعاء المسألة كما ذكرنا؛ لأن النهي عن الدعاء هو نهي عن نوعيه: دعاء العبادة الذي يشمل الصلاة والزكاة والحج وجميع العبادات، ودعاء المسألة الذي هو طلب الحوائج من الله تعالى. فنهى الله تعالى عن صرف العبادة لغيره، ونهى أيضاً عن سؤال غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من دون الله. ﴿مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ﴾ هـٰذا فيه التعليل للنهي، ما علة النهي؟ لماذا نهى الله عز وجل عن دعاء غيره؟ لأنه لا ينفع ولا يضر، ومن كان لا ينفع ولا يضر فإنه من الجهل والحماقة وسوء العقل أن يصرف له الدعاء. ﴿فَإِن فَعَلْتَ﴾ يعني: إن أبيت ولم تنظر إلى ما أمرك الله به ﴿فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾؛ ﴿فَإِن فَعَلْتَ﴾ أي دعوت غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- دعاء مسألة أو دعاء عبادة، ﴿فإنك﴾ الخطاب لمن وجه إليه الخطاب ﴿فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾، والظلم هنا هو الظلم الأكبر، وهو الشرك الذي فيه قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.
الخطاب على القول بأنه للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهـٰذا يفيد احتمال وقوع ذلك منه , أو بيان مرتبة العمل ولو لم يكن واقعًا منه؟
هـٰذا فيه بيان مرتبة العمل، مثل قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾( ) ففائدة مثل هـٰذا هي بيان مرتبة العمل، أما من حيث الوقوع فإن الله عز وجل قد عصمه من الوقوع في المعاصي الكبار، فضلاً عن الشرك.
الشاهد في هـٰذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ﴾ ففيه النهي عن دعاء غير الله، وفيه النّهي عن الاستغاثة بغير الله؛ لأن الاستغاثة تقدم لنا أنها دعاء خاص، نوع خاص من الدعاء.
قال: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾؛ ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ اقتصر على هـٰذا ثم قال: الآية؛ لأن الاستغاثة تكون في أي شيء؟ في كشف الضر، فهـٰذا دليل على أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل؛ لأنّه إذا كان لا كاشف لهـٰذا إلا الله فإنه لا يسأل غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. وقوله: ﴿بِضُرٍّ﴾ سواء أكان ضرّاً قليلاً أم ضرّاً كبيرًا فذلك مما لا يسأل في كشفه إلا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ما لم يكن في مقدور الإنسان الحاضر فإنه لا بأس من طلب الغوث منه وطلب العوذ منه، ومنه قول الله جل وعلا في قصة صاحب موسى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ﴾( ) على أن بعض العلماء يقول: إن هـٰذه الآية لا يستدل بها على جواز الاستغاثة بالمخلوق؛ لأنها من رجل لا حجة في فعله، فإنه ظالم معتدٍ، ولذلك لما استنصره في اليوم التالي ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾( ) فمثل هـٰذا لا يستدل بقوله. على كل حال الاستغاثة -طلب الغوث، طلب النصر- من الحي الحاضر فيما يقدر عليه جائزة، سواء سميناها استغاثة أو سميناها استعاذة أو سميناها استجارة. وهـٰذا محل إجماع لا خلاف فيه، وإنما المنهي عنه هو الاستغاثة والاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفي الصور التي تقدم ذكرها.
وقوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ هـٰذا في الدعاء؛ لأنه طلب خير: ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾. والرزق هنا يشمل الرزق الحسي والمعنوي، يشمل كل رزق يجب طلبه وابتغاؤه من الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فلا يطلب من غيره.
قوله: ﴿وَاعْبُدُوهُ﴾. هـٰذا عطف عام على خاص؛ لأن ابتغاء الرزق من الله عز وجل عبادة، وإنما قدمها لأن فيها بيان أن الرزق إنما سبيل تحصيله من الله عز وجل؛ لقطع حجج من يظن أن عبادة غير الله عز وجل هي سبب رزقه وسبب تحصيل مكسبه، فبين الله جل وعلا أن الرزق من عنده، وأنه يجب إفراده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بطلب الرزق، ولذلك قال: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ فقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر. ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾.
قال: (وقوله: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾). ﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ هـٰذا استفهام بمعنى النفي الذي يفيد سوء حال هـٰذا، وهو مشرب بالتحدي كما هو معلوم، فإن الاستفهام إذا جاء مضمنًا معنى النفي كان مشربًا بمعنى التحدي، يعني: أتحدّى أن يكون أحد أضل من هـٰذا، ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾. وجه الضلال ظاهر أو لا؟ بينته الآية أم لم تبينه؟ بينته في قوله تعالى: ﴿مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾ يعني: لو ظل يدعو ويسأل ويتضرع ويلح في سؤاله وطلبه ما حصَّل مطلوبه هـٰذا ولو استمر هـٰذا إلى يوم القيامة.
﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ فهم في غفلة عن دعاء هؤلاء.
ثم قال: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ كل هـٰذا بيان لوجه ضلال دعوة هؤلاء وطلب الحاجات منهم، سواءٌ أكانت دعاءً مطلقًا أم دعاء استغاثة أم دعاء استعاذة أم دعاء استجارة.
ثم قال: وقوله: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ هـٰذا استفهام أيضًا لبيان عظيم وصف الله عز وجل، وأنه لا يكشف ما نزل بالإنسان من الضرورات وما حل به من الكربات إلا هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهـٰذا استفهام بمعنى النفي، أي: لا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف السوء إلا هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فإذا كان كذلك وجب ألا يسأل غيره، وألا يستغاث بغيره، وألا يستعاذ إلا به؛ لأن بيده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مفاتيح الفرج، وهو -جل وعلا- الذي يكشف السوء ويرفع ما نزل بالإنسان من الكربات والظلمات.
وكل هـٰذه الأدلة دالة على ما تقدم في الترجمة من أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، ولا دعاء غيره، وأن من الشرك الاستعاذة بغير الله ودعوة غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
قال رحمه الله تعالى: (وروى الطبراني بإسناده). أي: بإسناد الطبراني، ولم يبين المؤلف -رحمه الله تعالى- راوي الحديث ولا قصته؛ لأن المقصود المعنى الذي تضمنه، فقال رحمه الله: (أنه كان في زمن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منافق يؤذي المؤمنين.)
(المنافق) معروف، وهو: من أبطن الكفر وأظهر الإسلام. وهـٰذا هو الأصل في إطلاق هـٰذا الوصف، وأنه لا يطلق على النفاق العملي على وجه الإطلاق، وإنما يطلق على النفاق الاعتقادي؛ لأن المنافق في كلام السلف هو الزنديق، وهـٰذا لا يكون إلا لمن فسد اعتقاده بأن أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فالذي عنده مخالفات في العمل وعنده خصال من خصال المنافقين لا يوصف بالنفاق المطلق، إنما نفاقه لا بد من تقييده وهو نفاق العمل، فالمنافق هنا هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. (يؤذي المؤمنين). ولم يبيّن الحديث وجه الأذى، والغالب أن أذاهم قولي؛ لأنهم لا يجرؤون على الأذى الفعلي، أذاهم قولي بالسبّ والشتم والطعن والتشبيه والتشكيك والتحريض على المؤمنين والإرجاف بينهم وما أشبه ذلك. (فقال بعضهم). أي بعض المؤمنين: (قوموا بنا نستغيث برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). والقائل هنا هو أبو بكر كما بينته الروايات، فإن أبا بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- هو الذي أشار عليهم بهـٰذا الرأي فقال: (قوموا بنا نستغيث برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).
والاستغاثة هنا فيما يظهر هي في أمر مقدور للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم لا؟
الجواب: أنها في أمر يقدر عليه ويستطيعه، هـٰذا الذي كان في ذهن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- وعلى رأسهم أبو بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الذي أشار بهـٰذا الرأي، والاستغاثة هنا هي سؤال كف الشر من هـٰذا المنافق: إما بقتله، وإما بعقوبته، وإما بتهديده، وإما بغير ذلك من وسائل كف الأذى. وهم يذهبون إلى الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي هو ولي أمرهم، فهم يطلبون من ولي الأمر -وهـٰذا وصف أخص من وصف الرسالة- أن يكف شر أحد أفراد المجتمع، وهـٰذا في مقدور ولي الأمر أو لا؟ الغالب أنه في مقدوره، ولذلك أشار عليهم أبو بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بهـٰذا الرأي، فذهبوا (فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في جواب طلبهم: ((إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل)).
((لا يستغاث بي)) أي: لا يطلب الغوث في هـٰذا الأمر مني ((وإنما يستغاث بالله))؛ لأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن يستطيع أن يكف شر المنافقين، وكف الشر بمعنى القطع، أي: استئصال شرهم.
ويشهد لهـٰذا -أن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن قادرًا على كف شرهم- أن شرهم بلغه في أهله كما في قصة الإفك، فاتهموا زوجه العفيفة الطاهرة بما رموها به من الإفك، ولم يملك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يكف أذاهم ولا شرهم، بل قال على المنبر: ((من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟)). فلم يتمكن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من كف أذاهم، مع علمه بمن أذاع الشر في أهله لم يتمكن من كف شره، وطلب العذر من الناس على المنبر.
فعُلم بهـٰذا أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((إنه لا يستغاث بي، ولكن يستغاث بالله)). أنه لا يستطيع كف شر هـٰذا الرجل، ووجههم إلى من بيده كف كل شر، وهو الله -جل وعلا- فقال: ((إنما يستغاث بالله)). فرجعهم إلى الله تعالى الذي بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله: ﴿أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾( ) ليكف شر هـٰذا عنهم.
هل هـٰذا الحديث يدل على عدم جواز الاستغاثة برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما لا يقدر عليه؟
الجواب: نعم يدل؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيّن لهم أنه في هـٰذا الأمر لا يستغاث به، مع أن هـٰذا الأمر -كما ذكرنا- المتوقع والمظنون والذي كان في ذهن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- أنه في مقدور الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفي استطاعته، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه كمغفرة الذنوب، وهداية القلوب، وإصلاح الأمور، وكشف الكروب وما أشبه ذلك؟ هـٰذا من أبعد ما يكون، وهـٰذا دليل على أنه لا يجوز الاستغاثة بالمخلوق في كل ما لا يستطيعه ولا يقدر عليه، حتى لو ظن الإنسان المستغيث بأن المستغاث به يستطيع ذلك يجب عليه أن يبيّن له، وهـٰذا في الأمور التي يتوهم فيها أنه يستطيع أن يقوم بها، فكيف بالأمور التي لا يظن ولا يتوهم أنه يقدر عليها؟ ففي هـٰذه الحال فإن الإنكار فيه أشد.
لهـٰذا لم يشدد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النكير على الصحابة لما سألوه؛ لأنه أمر متوقع من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-, بخلاف ذلك لما قال الرجل للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما شاء الله وشئت. ماذا قال –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-؟ قال: ((أجعلتني لله ندّاً؟)). فشدد في الأمر لأنه أمر يتعلق بالتوحيد، ولا يمكن أن يسوغ ولا يقبل التسوية بين الله وأحد من خلقه مهما كان. وكما جاء في الأثر أيضاً الذي قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك. فقال: ((سبحان الله، سبحان الله! شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد)). أي: لا تطلب الوساطة من الله عند أحد؛ لأنه جل وعلا الكبير المتعال. وهـٰذا يدلنا على أن السؤال الذي سألوه أمر ليس مما يقدح في توحيدهم، ولا مما ينقص إخلاصهم.
لكن يستفاد من هـٰذا أن سؤال ما لا يقدر عليه الإنسان يجب أن يفرد به الله جل وعلا، ولا يجوز سؤاله من أحد كائناً من كان. وحرف بعض المنحرفين عن السبيل المستقيم هـٰذا الحديث فقال: إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله)). لا يدل على عدم جواز الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما قال ذلك على غرار قوله للأشعريين: ((ما حملتكم إنما حملكم الله)). وعلى غرار قول الله جل وعلا: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. وهو ما يسمى في علم التصوف شهود القيومية، ومعناه: أن كل ما في الكون هو فعل لله تعالى.
فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما قال: ((إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله)). يعني: أنكم لما استغثتم بي إنما استغثتم بالله، وهـٰذا يدل على أي شيء؟ على جواز طلب الاستغاثة منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما لا يقدر عليه إلا الله، لماذا؟ لأنه إذا كانت الاستغاثة بالنبي –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- هي استغاثة بالله فإن الموضوع إذاً واحد، لا فرق بين أن تقول: يا ألله أغثني، وبين أن تقول: يا رسول الله أغثني. الأمر واحد عند هؤلاء؛ لأن الفعل كله لله جل وعلا, وهـٰذا من تحريف الكلام عن مواضعه، وهـٰذا فيه نسبة الجهل لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ونسبة سوء الظن بصحابة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
هـٰذا الحديث في سنده ضعف، ولم يصححه شيخ الإسلام رحمه الله، إنما ذكر أنه يحتج به على وجه الاعتضاد بغيره، لا على وجه الاستقلال في الاستدلال به؛ لأن مضمونه قد جاء في أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وما كان كذلك فإنه يذكر على وجه الاعتضاد لا على وجه الاستدلال والاعتماد, وفرق بين الاعتضاد والاعتماد:
• الاعتماد إثبات الحكم بالنص.
• والاعتضاد التقوي بهـٰذه الآثار لإثبات ما دلت عليه النصوص الصحيحة.
ومن هـٰذا ما يفعله بعض العلماء في تقرير ما ذهبوا إليه، فتجده يقول: المسألة حكمها كذا، والدليل من الكتاب كذا والدليل من السنة كذا، وقد يذكر أحاديث ضعيفة، ثم يأتي بآثار ما تعلم صحتها، ثم يأتي بأقوال ونقولات عن أهل العلم. كل هـٰذا لو استقل في الاستدلال، لو أن شخصاً استدل بقول شخص من هؤلاء الذين ساق كلامهم أو أثرا من الآثار الضعيفة على الحكم ما استقل في إثبات الحكم، لكنه يفيد في عضد الحكم وتقويته وإن كان ثابتاً بالأدلة الصريحة.
وأما الحديث ففيه علة، وهي أنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وهو -رحمه الله- إمام فاضل وعالم جليل وقاضٍ مشهور من المفتين المشهورين، لكنه اختلط في آخر عمره مما تسبّب عنه ضعف حديثه، لكن الشيخ -رحمه الله- يقول: غالب ما يرويه صحيح, لكن لا يكفي في إثبات نسبة الحديث إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
[الشرح]
واضح هـٰذا؛ لأن الاستغاثة دعاء خاص، وهو طلب النصرة.
[المتن]
الثانية: تفسير قوله: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ﴾.
الثالثة: أنّ هـٰذا هو الشرك الأكبر.
الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين.
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا، مع كونه كفرًا.
[الشرح]
وجهه قوله تعالى: ﴿مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾، وأيضًا في قوله: ﴿فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ﴾، فإذا كان لا كاشف له إلا الله جل وعلا فدعاء غيره عبث ولا فائدة فيه، فهو لا يفيد الداعي، ويضره في دنياه وآخرته: أما في الدنيا فتجري عليه أحكام الكفر، وأما في الآخرة فمآله إلى النار: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾( ).
[المتن]
السابعة: تفسير الآية الثالثة.
[الشرح]
﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾
[المتن]
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
[الشرح]
وجه ذلك تقديم ما حقه التأخير: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ تقديم الظرف.
[المتن]
التاسعة: تفسير الآية الرابعة.
[الشرح]
قوله: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾.
[المتن]
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
[الشرح]
(من) مضمنة هنا معنى النفي، ذكرنا هـٰذا في تفسير الآية.
[المتن]
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
[الشرح]
الله أكبر! لقوله: ﴿مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾. وهـٰذه غفلة ممتدة أم مؤقتة؟ غفلة ممتدة؛ لقوله: ﴿إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ﴾.
[المتن]
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
[الشرح]
وذلك لقوله: ﴿كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾.
[المتن]
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
[الشرح]
وذلك لقوله: ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾.
[المتن]
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة.
[الشرح]
يعني: كفر المسؤول بتلك العبادة، وأنه لا يقبلها ولا يقرّ بها، ويتبرأ منها؛ لأن الإقرار بها ندامة: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾( ) فإذا رضي دخل في هـٰذه الآية، ولذلك يكفر بها ويأباها وينكرها على فاعلها.
[المتن]
الخامسة عشرة: أن هـٰذه الأمور سبب كونه أضل الناس.
السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة.
[الشرح]
﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾
[المتن]
السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هـٰذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
[الشرح]
نعم، فهم مقرون بهـٰذا؛ لذلك فهم يدعونه في الشدة ويتركونه جل وعلا في الرخاء.
[المتن]
الثامنة عشرة: حماية المصطفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حمى التوحيد، والتأدب مع الله عز وجل.
[الشرح]
وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله)).
وفي هـٰذا الحديث فائدة: أن الإنسان ينبغي له ألا يخجل إذا نسب إليه ما لا يستحق بالتبرؤ منه؛ لأن بعض الناس تحمله المجاملة على قبول كلام ليس فيه ووصف لا يستحقه، وهـٰذا خلاف ما كان عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فالواجب التبرؤ مما ليس في الإنسان، والواجب إثبات الفضل لأهله، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله)).
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الحادي عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾( ) الآية. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾( ) الآية.
وفي (الصحيح) عن أنس قال: شُجَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: ((كيف يفلح قوم شَجُّوا نبيهم؟)). فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾( ).
وفيه عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: ((اللهم العن فلانًا وفلانًا)). بعد ما يقول: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمــد)). فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾.
وفيه عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين أنزل عليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ فقال: ((يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا أغني عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا)).
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي: أنه لا يجوز صرف العبادة لأحد مهما كان، ولو بلغ من الجاه والمكانة عند الله عز وجل الدرجة العليا، فإن أعظم البشر جاهًا عند الله عز وجل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ومع ذلك لم يتمكن عليه الصلاة والسلام أن يدفع عن نفسه الشر، وذلك فيما جرى له يوم أحد، ولا أن يجلب لأحد الخير من غير إذن الله تعالى، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لقومه: ((لا أغني عنكم من الله شيئاً)). ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد من التفصيل في هـٰذا في الشرح، المهم أن المناسبة ظاهرة، فإن هـٰذا الباب يبين أن الإنسان مهما بلغ من المكانة والجاه عند الله عز وجل فإنه لا يخرج عن كونه مربوبًا ضعيفًا مفتقرًا إلى الله جل وعلا، لا يتمكن من قضاء الحوائج إلا ما أمكنه الله منه.
ومناسبته للباب الذي قبله ظاهرة: أنه في الباب الذي قبله ذكر الاستغاثة، وقبله ذكر الاستعانة، والغالب أن المستعين والمستغيث يستغيث بمن يعتقد أنه قادر على كشف ما نزل به ورفع ما حل به أو دفع ما يخشاه ويخافه.
وفي هـٰذا الباب بيان أن أعظم الناس جاهًا لا يتمكن من هـٰذا، فإذا كان أعظم الناس جاهاً لا يقدر على تحقيق هـٰذا فالسؤال منه عبث، هـٰذا فوق أنه شرك وكفر بالله عز وجل؛ لأن الإنسان إنما يسأل من ينتفع بسؤاله، ويطلب ممن يفيده الطلب منه، ويستغيث بمن يرجو منه كشف الكربات أو دفعها، فإذا كان لا يستطيع لا هـٰذا ولا هـٰذا فلا يسوغ الاستعاذة به، ولا يسوغ الاستغاثة به ولا دعاؤه.
المؤلف -رحمه الله- ذكر في هـٰذا الباب آيتين وحديثاً.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾. الاستفهام هنا استفهام إنكار وتعجيب من حال هؤلاء الذين غيبوا عقولهم وعطلوا أفكارهم، ووقعوا في أبين الضلال وأعظم الكفر: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾ والشرك هنا يشمل شرك الربوبية ويشمل شرك الإلهية:
شرك الربوبية بإثبات الفعل لهؤلاء.
وشرك الإلهية بصرف العبادة لهم.
وهؤلاء لا يستحقون أن يصرف لهم شيء من العبادة، ولا أن يثبت لهم ما لا يثبت إلا لله جل وعلا، ولذلك ذكر الوصف الذي يسقط ويبين ضلال هـٰذا الفعل فقال: ﴿مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾. وهـٰذه حجة متكررة في القرآن الكريم: أن الله -جل وعلا- يستدل على بطلان عبادة الكفار بأنهم يعبدون من لا يخلق شيئاً وهم يخلقون، فالخلق من أعظم أدلة التوحيد؛ لذلك يذكر الله –جل وعلا- من آياته السماوية الأفقية والأرضية ما يدل على أنه الرب المستحق للعبادة؛ لكونه انفرد بخلق هـٰذه الأشياء، فهو المستحق بأن يفرد -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بالعبادة: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾( ). والآيات التي يحتج الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها على إبطال عبادة هؤلاء في عدم قدرتهم على الخلق كثيرة، ومنها هـٰذه الآية: ﴿مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾. و﴿شَيْئًا﴾ هنا نكرة في سياق النفي, وما معنى الخلق هنا؟
الخلق هو الإيجاد من العدم، وهـٰذا لا يقدر عليه أحد ولو كان أصغر ما يكون، فإن الناس لا يخلقون إلا من مواد يركبون ويجمعون ويصنعون ويخلقون، لكن هـٰذا الخلق خلق مجازيّ؛ لذلك قال الله جل وعلا متحديًا من وقع في الشرك: ﴿هـٰذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾( ) فهـٰذا الدليل قائم، وهو خلق الله -جل وعلا- في السمٰوات والأرض والأنفس، فأين خلقكم؟ أو خلق من تعبدون وتدعون؟ لا خلق لهم لا في الدقيق ولا في الجليل؛ لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، وهـٰذا لا يكون إلا من الله جل وعلا.
﴿مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾ هـٰذا وصف ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ أي: إنهم هم مخلوقون، وهم قد أوجِدوا من قبل من العدم، فالمستحق للعبادة هو من أوجدهم وأنشأهم من عدم.
ثم قال في بيان الإنكار على هؤلاء في شركهم: ﴿وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ والنصر هنا يشمل كل ظفر، سواء كان في حرب أو في نقاش أو في جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك، النصر هو الظفر ﴿وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾. فهم عاجزون عن نصر غيرهم وعاجزون عن نصر أنفسهم، ومن كان كذلك فإنه لا يستحق شيئاً من العبادة، ولا يصرف له شيء منها.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾). تدعون من دونه دعاء مسألة ودعاء عبادة، ما يملكون من قطمير، (ما) هـٰذه نافية، ﴿يَمْلِكُونَ﴾ والملك هو تمام التصرف ﴿مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ القطمير هو الغشاء الذي يغلّف نواة التمرة، وهو مثل يضرب في القلة والحقارة. والتمرة فيها أربعة أشياء تضرب مثلاً في لغة العرب للقلة والحقارة: هـٰذا القطمير في الآية في قوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾. الثاني النقير، وذلك في قوله: ﴿وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾( ) الثالث الفتيل، وذلك في قوله: ﴿وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيَلاً﴾( ) الرابع ليس في القرآن، وهو التفروق.
والاقتصار على ما في القرآن كافٍ، ثلاثة أشياء في التمرة تضرب مثلاً للحقارة والقلة منها هـٰذا، فهؤلاء لا يملكون حتى غشاء نواة التمرة، فكيف يطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ إن هـٰذا لسفه بيِّن وضلال واضح: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (191) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكِمْ﴾. وهـٰذا نظير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ الآيات.
المهم أن هاتين الآيتين قدم بهما المؤلف -رحمه الله- لبيان أن جميع ما يعبد من دون الله لا يخلق، وهو مخلوق، ولا ينصر غيره ولا ينصر نفسه، ولا يملك شيئًا. فإذا كان لا يخلق، وليس في قدرته النصرة، وليس له ملك، فكيف يعبد؟ عبادته وهو على هـٰذا الحال، هـٰذا من أعظم الضلال والسفه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ما جرى للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزوة أحد، قال: (وفي الصحيح عن أنس قال: شُج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). والشج هو الجرح في الرأس، وقيل: الرأس والوجه. (شُج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم أحد، وكسرت رباعيته.) والرباعية هي مقدمة الأسنان. (فقال: ((كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟))). هـٰذا استفهام استبعاد، أن من جرى منهم مثل ذلك يبعد أن تقع منهم الهداية، ويبعد أن يحصل لهم الفلاح؛ لأنهم بلغوا في الكفر غايته والمعاندة منتهاها، قال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾.) وهـٰذا مضمن النهي عن استبعاد هداية هؤلاء بسبب ما وقع للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أذى؛ لأن الله جل وعلا بيده القلوب يصرفها كيف يشاء، فهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يجوز أن يستدل بالحال الحاضر على ما يكون في المستقبل من الهداية والضلال. ولذلك قال ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((فوالذي لا إلـٰه غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)). فالاستدلال بالحال الحاضر على المآل فيما يتعلق بالهداية أمر غير صحيح؛ لأن القلوب بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء، وهـٰذا يوجب غاية الحذر من كل أحد؛ لأنه إذا كانت القلوب بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء فإنه ينبغي للمؤمن أن يضرع إلى الله تعالى، وأن يلح عليه في الدعاء أن يحفظ قلبه من الزيغ والضلال، وألا يعتمد على جمال حاله الحاضرة ويستدل بها على حسن منقلبه وجميل خاتمته، فإن هـٰذا غير مطرد.
﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ لماذا؟
لأن الله جل وعلا قد يتوب عليهم، ويدل على أن هـٰذا هو علة النهي تمام الآية، حيث قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾. فقد تقع منهم التوبة فيسلمون، وقد وقعت التوبة كما أشارت الآية من كثير من هؤلاء: فأبو سفيان قائد حزب الكفار في تلك الوقعة أسلم وحسن إسلامه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
وهـٰذا الحديث يدل على أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس في يده شيء من الأمر، وأنه ليس له شيء من الأمر، فإذا كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منعه الله من أن يقول هـٰذه الكلمة التعجبية التي قد تكون صادرة عن انفعال حالي من شدة ما أصابه ووقع عليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فكيف بمن يظن أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقدر أن يفعل ما لا يفعله إلا الله جل وعلا؟ فقد أبعد النجعة وأخطأ خطأً واضحًا بينًا.
((كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟)). فجاءت هـٰذه الآية: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾. لا الأمر الشرعي ولا الأمر الكوني، وهـٰذا مهم أن تعرفه، فإن الأمر هنا يشمل الأمرين، فالأمر الكوني فهو لله جل وعلا: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾( ) ولا الأمر الشرعي؛ لأن الشرع هو شرعه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما يبلغ شرع الله جل وعلا، كما قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (03) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾( ).
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول إذا رفع رأسه من الركوع -أي في الركعة الأخيرة من الفجر-: ((اللهم العن فلانًا وفلانًا)). بعد ما يقول: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)). فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾.)
هـٰذا الحديث مناسبته للباب واضحة، وهي: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يملك أن يلحق الضرر أو ينزل السوء بأعدائه وخصومه، ولذلك سأل الله جل وعلا أن يلعنهم في قنوته (فقال: ((اللهم العن فلانًا وفلانًا))). هـٰذا من وجه. ومن وجه آخر أنه أيضًا لا يملك شيئاً، حيث إن الله عز وجل منعه حتى الدعاء عليهم بهـٰذه الصفة وهي اللعن المعين، فإذا كان كذلك فهو لا يملك أن يجلب لمن دعاه أو سأله أو استغاث به خيرًا أو يدفع عنه ضرّاً فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو بعد موته، وعلى هـٰذا فإنه لا يجوز الاستغاثة به ولا سؤاله ولا شيء من ذلك؛ لكونه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبداً ليس له من الأمر شيء، كما قال الله -جل وعلا- في هـٰذه الآية التي كان من سبب نزولها هاتان القصتان: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾.
أما قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (((اللهم العن فلانًا وفلانًا)).) فقد بينته الرواية الثانية، وهي أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دعا على صناديد قريش الذين حاربوه وآذوا أهل الإسلام: يدعو على (صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام). وهـٰذا الدعاء دعاء النازلة، وذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دعا على الكفار شهرًا لما قتلوا القراء، فلعن من قتل القراء، وعين أشخاصًا دعا عليهم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولعنهم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾. فكف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك، ولم ينقل عنه أنه دعا على معين باللعن بعد هـٰذا.
وأما هـٰذا الحديث ففيه من الفوائد: مشروعية دعاء القنوت في الصلاة، ولا إشكال في هـٰذا، فإنه يشرع دعاء القنوت في الفرائض للنوازل، وهـٰذا أمر واضح ومعروف، ولكن في الحديث فائدة مهمة، وهي أنه في دعاء النازلة ودعاء القنوت إذا رفع الإمام من الركوع لا يزيد في الذكر بعد الرفع من الركوع على قول: ((ربنا ولك الحمد)). فيقول: ((سمع الله لمن حمده)) حال رفعه، ثم يقول: ((ربنا ولك الحمد)). ثم يشرع في الدعاء مباشرة، وهـٰذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله، فإنهم نصوا على ذلك، لا سيما فقهاء الشافعية، فإنهم نصوا على أنه يشرع ولا يقول الذكر بعد الرفع؛ لأنه ظاهر من حديث ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنه لا يقول الذكر، بل يقول: ((ربنا ولك الحمد)) ثم يشرع مباشرة في دعائه، ولا فرق في هـٰذا بين دعاء القنوت الذي في الوتر وبين دعاء القنوت في النوازل، ففي الجميع يقول الدعاء مباشرة بعد قول: ((ربنا ولك الحمد)). ولا يطيل في ذكر الدعاء الذي يكون بعد الرفع: ((ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركاً فيه...إلخ)). لا يقول هـٰذا فيما يظهر من الحديث. وبعض العلماء قال: لا، بل يكمل ذكر الاعتدال ثم يدعو. لكن الأظهر والأقرب إلى السنة هو هـٰذا، وهو اختيار شيخنا رحمه الله أنه يشرع مباشرة في دعائه.
الحديث فيه النهي عن لعن المعين، وقد اختلف العلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره في لعن المعين الفاسق على قولين، فمنهم من قال: يجوز اللعن؛ لأنه فعل ما يوجب اللعن. وقال آخرون: إنه لا يجوز لعن المعين؛ لأن اللعن سؤال الطرد من رحمة الله، وهـٰذا لا يسوغ؛ لأنه من أشد ما يقع على الإنسان أن يُلْعَن، ولقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((ليس المؤمن بالطعَّان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء)). وهـٰذا القول أقرب، وأنه لا يلعن المعين، وإنما يكون اللعن على وجه العموم، فإذا فعل الإنسان ما يقتضي اللعن يلعن على وجه العموم لا على وجه التعيين، كما فعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا رأى من وسم حمارًا في وجهه قال: ((لعن الله من فعل هـٰذا)). فهـٰذا لعن معين أو لعن عام؟
هـٰذا لعن عام، من فعل هـٰذا يعني: الذي فعل هـٰذا، ومَنْ مِن ألفاظ العموم، فيشمل كل من فعل هـٰذا. لكن اعلم أنه فرق بين اللعن المعين واللعن العام: أن اللعن العام كآيات الوعيد العامة، قد يصدق فيمن فعل ذلك وقد لا يصدق، فإن المعين قد يكون عنده من الحسنات ما يمحو به الله جل وعلا موجب هـٰذه السيئة وهـٰذه المعصية، وقد يكون عنده من الذنوب ما هي مُكفََّرَة، وقد يكون له سابقة، وقد يكون قد تاب منها، وقد يكون جاهلاً بالحكم.
المهم أن أسباب رفع العقوبة كثيرة، ولذلك لا يلعن المعين، بعض الناس يقول: إنني أجد في نفسي رغبة في لعن من عرف بالظلم والكفر؛ لشدة طغيانه وسوء عمله وشدة أذاه لعباد الله المؤمنين وأذاه لدين الله عز وجل، ففي هـٰذه الحالة نوجهه إلى ما وجه به الإمام أحمد رحمه الله من لعن الحجاج وهو من الولاة الظلمة، فإن الإمام أحمد كره لعنه وقال لمن أراد لعنه: لا تلعنه، إنما إذا أردت أن تلعن إذا ذكر الحجاج فقل: ألا لعنة الله على الظالمين. وهـٰذا لعن عام أو لعن خاص؟
هـٰذا لعن عام وليس لعنًا خاصّاً، ومثل هـٰذا إذا أراد الإنسان أن يلعن من آذاه أو من اعتدى عليه، فإنه لا ينبغي له أن يلعنه على وجه التعيين؛ لما ذكرنا من أن المعيَّن قد ينتفي موجب اللعن في حقه لأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم، لكن الأحسن والأعدل والأكمل والأتبع للسنة أن يكون اللعن على وجه العموم فيقول: ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾( ). ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ إذا كان من أهل الكفر، أو ما أشبه ذلك ولا يعين، وينبغي للإنسان ألا يطاوع نفسه في لعن الناس والنيل منهم، بل يذكر قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾. وهـٰذا خطاب للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وإذا دار الأمر بين أن تلعن وأن لا تلعن فالأحسن أن لا تلعن؛ لأنه ليس من صفات المؤمن كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان)). هـٰذا بالنسبة للَّعن المعين، أما بالنسبة للعن العام فقد لعن الله تعالى في كتابه أهل الكفر وأهل الفسق وأهل الظلم وأهل الكتاب، فاللعن العام خلاف اللعن الخاص، وهو تمامًا كأحاديث الوعيد العامة والخاصة، وهو تمامًا كالتكفير المطلق والتكفير المقيد، كل هـٰذا الباب فيه واحد، والتفريق فيه مهم لطالب العلم، حتى يميز بين ما يجوز وما لا يجوز من هـٰذا كله.
ثم في هـٰذا الحديث: أن الله -جل وعلا- نهاه وبين له علة النهي، وهـٰذا فيه أن الأحكام الشرعية معللة، وهـٰذا أمر ظاهر ومستقل وبين لكل من تدبر وتأمل النصوص من الكتاب والسنة. يقول الله تعالى في تعليل النهي: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾. فعلة النهي عن الدعاء عليهم ولعنهم احتمال التوبة عليهم؛ لأنه قال: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾. يعني: احتمال أن يتوبوا، واحتمال أن يستمروا على كفرهم فيتولى الله عذابهم، وليس لك من عذابهم شيء حتى تدعو عليهم، فالأمر لله جل وعلا، وهـٰذا فيه بيان علة الحكم. ومن حيث الواقع صدق ما أخبر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به من احتمال توبة هؤلاء: فإن (صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام) كلهم أسلموا وحسن إسلامهم، فهـٰذا من حكمة الله جل وعلا، ومن سابق رحمته وفضله، فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾. لاحظ أنها نزلت عندما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزوة أحد: ((كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟)). وكذلك في لعنه لمعينين من قريش، وكذلك في لعنه لمعينين من قبائل العرب، وهـٰذا يفيد فائدة مهمة، وهي: أنه قد يتكرر نزول الآية الواحدة في عدة أحداث، وفائدة هـٰذا بيان أن الآية تشمل هـٰذا الحدث فتكرر نزول الآية، هـٰذه فائدته، وهي بيان أن الآية تشمل هـٰذا الحدث وهـٰذا الحدث، فليست قاصرة على الحدث السابق، وهو مما يدل ويفيد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كان بخصوص السبب لما تكرر نزول الآية في مناسبة أخرى.
ثم قال رحمه الله في سياق أحاديث هـٰذا الباب: (وفيه عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين أُنزل عليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾.) أي: حين أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾. أمره الله عز وجل بإنذار عشيرته، والعشيرة في الأصل تطلق على الأبناء والأقارب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له أبناء، فيكون معنى العشيرة هنا الأقارب، ثم بين أن الأحق بالدعوة هم الأقربون فقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الإنسان الداعية فحقه في الدعوة أكثر من غيره, مع أن دعوة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليست خاصة بأقاربه، بل هي عامة لكافة الناس، بل لجميع الإنس والجن.
ثم بين تأويل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهـٰذه الآية- أي: عمله بها- فقال: ((يا معشر قريش)) وهؤلاء هم عشيرته الأقربون ـ (أو كلمة نحوها) ـ يعني: مما يفيد النداء والدعاء. ((اشتروا أنفسكم)). ومعناه أي: خلصوها وأنقذوها من الهلكة، والشراء يطلق في كل ما يكون فيه استنقاذ للشيء من مخوف، لا سيما إذا عُدِّي إلى النفس: ((اشتروا أنفسكم)).
ثم بين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجه أمره بذلك فقال: ((لا أغني عنكم من الله شيئًا)). ((لا أغني)) أي: لا أملك غناءً ونفعًا عنكم ((من الله شيئاً)). يعني: لا أملك أن أدفع عنكم من عقوبة الله شيئاً إذا فعلتم ما يقتضي العقوبة. ((لا أغني عنكم من الله شيئاً)).
وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((شيئاً)) نكرة في سياق النفي , وأما قوله: ((عن)) فهي على باب المجاوزة، والمعنى: لا أدفع عنكم من الله شيئاً إذا فعلتم ما يقتضي العقوبة. ثم قال: ((يا عباس بن عبد المطلب)). وهـٰذا عم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فدعاه باسمه وهو من أخص أقاربه وعشيرته الأقربين: ((لا أغني عنك من الله شيئًا)). فبعد التعميم انتقل إلى التخصيص، حتى يزيل ما قد يتوهمه المتوهمون من أنه قد ينفع الأقربين منه، وإن كان لا ينفع عموم العشيرة ولكن ينفع الأقربين منه، فخص رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجلاً ذكرًا من أقاربه الأقربين فقال: ((يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً)). هـٰذا كالذي قبله، أي: لا أدفع عنك ولا أملك لك من الله شيئاً. ثم قال: ((يا صفية عمة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا أغني عنكِ من الله شيئاً)). واختار في هـٰذا النداء امرأة من أقاربه، ووجه اختيار المرأة: أنه تخصيص أيضًا أخص من السابق؛ وذلك أن الإنسان يدفع عن محارمه الأقربين أكثر من دفعه عن الرجال؛ لأن الرجال قد يستغنون بأنفسهم وقوتهم وجاههم وما معهم من مُكنة فيدفعون عن أنفسهم، لدفع هـٰذا التوهم خص النساء من الأقربين فقال: ((يا صفية عمة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا أغني عنك من الله شيئًا)). ثم أتى بأخص من كل ما تقدم فقال: ((يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا)). فناداها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باسمها وقال: ((سليني من مالي ما شئت)). أي: اطلبي مني من المال ما تشائين، وهـٰذا فيه الإشارة إلى أنه -وإن كان يستطيع أن يوصل إليها بعض النفع في الدنيا من جهة المال وشبهه مما هو في مقدور المخلوق، لكنه- لا يغني عنها من الله شيئاً، فهو لا يملك أن يدفع عنها من الله شيئاً: لا في أحكام الله القدرية، ولا في أحكام الله الشرعية. ومثال عدم غناء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ابنته شيئاً في الأحكام الشرعية قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). ولو كان يملك لها من الله شيئاً لدفع عنها الحد إذا استوجبته وفعلت ما يوجبه، فهو لا يملك أن يدفع عنها شرع الله وحكمه الشرعي، ولا يملك أن يدفع عنها حكمه القدري أيضًا. وهـٰذا كله يوجب الانجذاب إلى الله جل وعلا، وإخلاص العبادة وأعمال القلب له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وإخلاصه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بالرغبة والرهبة.
مناسبة هـٰذا الحديث للباب ظاهرة، وهي تدل على دقة تصنيف المؤلف رحمه الله، وعمق فهمه جزاه الله عنا خير الجزاء، حيث إنه في الأحاديث السابقة أتى بما يدل على أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يملك أن يدفع الضر عن نفسه، ولا عمن آمن برسالته: فعن نفسه في حديث: (شُج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم أحد وكسرت رباعيته). وعمن آمن به في حديث ابن عمر.
وأما حديث أبي هريرة ففيه الدلالة على أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يستطيع جلب الخير لغيره، وأنه لا يملك غناء لأحد بدفع شر عنه أو بجلب خير إليه إلا بإذن الله جل وعلا، وهـٰذا يدل على أنه لا يُسأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شيئاً في الدنيا بعد موته، وأما في حياته فإنه لا يُسأل ما لا يستطيعه وما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وأن سؤال ذلك من الشرك؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يملك ذلك ولا يقدر عليه، فسؤاله هو تنزيله منزلة لا يستحقها، وقد نفاها عن نفسه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . اتضحت مناسبة هـٰذه الأحاديث للباب.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآيتين.
[الشرح]
اللتين في أول الباب، وهي قوله: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾. والثانية: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾.
[المتن]
الثانية: قصة أحد.
الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمِّنون في الصلاة.
[الشرح]
ووجه هـٰذا: أن سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء خير الناس بعد الأنبياء ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر، واحتاجوا في دفع الضر إلى التوسل والتضرع وسؤال الله عز وجل أن يرفع عنهم، فكيف بمن سواهم؟ إذا كان هؤلاء -على ما هم عليه من الجلال والقدر والمكانة عند رب العالمين- لا يملكون أن يدفعوا عن أنفسهم الضر، بل ينزلون حوائجهم بالله جل وعلا، فكيف بغيرهم من الناس؟ هـٰذا وجه قول الشيخ رحمه الله: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، أي: في جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم.
[المتن]
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار.
[الشرح]
لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾. فإن الله شهد عليهم بالظلم.
[المتن]
الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
[الشرح]
وهـٰذا فيه بيان سبب قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟)). وهو إنما صدر لعظيم ما فعلوه به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وبالغ ما وصله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أذاهم.
[المتن]
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾.
[الشرح]
مع أن الضرر قد وصله وبلغه، وهـٰذا يوجب طلب الانتقام والرغبة في طلب الثأر من الخصم والتشفي ، ومع ذلك قال له الله جل وعلا: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾. فما كان من العبد الذي كمَّل العبودية إلا أن كفَّ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
[المتن]
السابعة: قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ ( ). فتاب عليهم فآمنوا.
الثامنة: القنوت في النوازل.
[الشرح]
وهـٰذا تكلمنا عليه، والنوازل التي يُقنت فيها هي النوازل العامة وليس النوازل الخاصة، وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في القنوت :
هل يكون في النوازل الخاصة ؟
فذهب جماعة من العلماء إلى أنه يقنت في النوازل الخاصة لكن قنوتًا خاصّاً، وممن اختار هـٰذا:
شيخ الإسلام – رحمه الله–، فشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله– يرى جواز القنوت في النافلة، وفي الصلاة الخاصة، يقنت الإنسان لرفع ما نزل به وما حل به.
وأما القنوت الذي يكون في المساجد، فإنه لا يكون إلا للنوازل العامة، ولا يكون للنوازل الخاصة.
وقد ذكر العلماء أن الذي يقنت هو الإمام العام، والإمام العام معروف من هو، الذي له الولاية العامة في البلاد، ويقوم مقامه أن يقول للناس: اقنتوا، فإذا أمرهم بالقنوت فإنهم يتبعونه في ذلك؛ لأنه كقنوته وتوكيل منه لهم.
ذكر الفقهاء في القنوت أنه لا يُقنت لمثل الزلزلة غير الدائمة وما أشبه ذلك، مسائل في ما يقنت له وما لا يقنت له تجدونها في كتب الفقه، المراد أن الحديث دل على مشروعية القنوت في النوازل.
[المتن]
التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
[الشرح]
وأن هـٰذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه دعاء، والذي نُهي عنه المصلي هو الكلام، أما الدعاء -ولو كان بأسماء معينة- فلا يبطل الصلاة.
[المتن]
العاشرة : لعن المعين في القنوت.
[الشرح]
المراد من هـٰذه أنـها من المسائل التي تضمنتها الأحاديث، وليس فيها أنه من المشروع أن يلعن المعين في القنوت؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نُهِيَ عن ذلك في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾( ).
[المتن]
الحادية عشرة : قصته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أُنزل عليه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ ( ).
الثانية عشرة : جِده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
[الشرح]
(جِده) أي: في امتثال أمر ربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فإن رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امتثل أمر الله – جل وعلا -أكمل امتثال، ولذلك قام -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنذارة حق القيام، فمنذ أن قال الله له: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (01) قُمْ فَأَنْذِرْ﴾( ) ما جلس رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النِّذَارة والتبليغ حتى في رمقه الأخير، فكان صلى الله عليه وآله وسلم في رمقه الأخير يأمر بما أمر الله به من التوحيد، ومن المحافظة على الصلاة، ومن أداء الحقوق ، فجَدَّ في الأمر غاية الجد – نسأل الله أن يتبعنا أثره.
[المتن]
الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئاً، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر في ما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين .
[الشرح]
يعني: ما وقع في قلوبهم من أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يملك النفع والضر، وأنه يُسأل، وأنه يُستغاث به، ويُستعاذ به، علم حال التوحيد وغربة الدين في العصور المتأخرة التي أدركها الشيخ رحمه الله.
والحمد الله دلائل التوحيد واضحة وبينة، ولا لبس فيها ولا غبش، والعجيب أن الذين يشبهون ويشغبون على أهل التوحيد إنما يستندون فيما يستندون إليه إما إلى ضعيف لا يقوى على مقابلة النصوص الصريحة الواضحة الظاهرة في الكتاب والسنة، وإما على ما فيه اشتباه ولبس، ولا تخرج استدلالات المبتدعة من أهل الشرك والمسوِّغين له عن هذين :
إما ضعيف لا يقوى على مقابلة الصحيح، وإما شُبَه تعامل معاملة المتشابه في ردها إلى المحكم والأخذ بما هو محكم في كتاب الله وسنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾( ).
وفي (الصحيح) عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع -ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)).
وعن النواس بن سمعان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمـر تكلـم بالوحي, أخذت السمٰوات منه رجفة ـ أو قال: رعدة ـ شديدة خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السمٰوات صعقوا وخروا سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل)).
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد، كمناسبة الباب السابق تماماً:
فإن الباب السابق بيَّن فيه أن المخلوق لا يملك غناءً عن نفسه ولا عن أقاربه ولا عن أتباعه، وكذلك هـٰذا الباب بيَّن فيه أن أعظم الخلق قوة وقدرة فيما أُخبرنا -وهم الملائكة- لا يملكون لأنفسهم غَناءً.
فالباب السابق بين فيه أن أعظم الخلق جاهًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يملك لنفسه ولا لأتباعِه ولا لأقارِبِه ولا لأخص أقاربه نفعًا ولا ضرّاً، وهـٰذا الباب بيَّن فيه أن أعظم الخلق قدرة ومن أشرفهم مكانة وهم الملائكة لا يملكون دفعًا عن أنفسهم ولا جلبًا للخير إليها، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، ولا لهم ولا لغيرهم.
قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.( ))
﴿فُزِّعَ﴾ أي: أُزيل الفزع وكُشف عن قلوب الملائكة، فالضمير يعود إلى الملائكة.
﴿قَالُوا﴾ أي: قال الملائكة الذين كُشف عن قلوبهم الفزع.
﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ أي: أي شيء تكلم الله به؟
﴿قَالُوا الْحَقَّ﴾ وظاهره أن الجواب منهم أيضًا، وأنَّ السؤال منهم، ويحتمل أن السؤال من بعضهم والجواب من البعض الآخر كما دلت عليه بعض الروايات:
فإذا كان الجواب منهم والسؤال منهم جميعًا، فيكون السؤال هنا على وجه التعظيم لا على وجه الاستعلام، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ تعظيماً لقوله جل وعلا.
وإذا كان السؤال من بعضهم والجواب من البعض الآخر فهو سؤال استفهام واستعلام.
﴿قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾. أي: إن قوله –جل وعلا– الحق، وهـٰذا الجواب بيان لوصف القول لا لعينه؛ لأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كما تدل الأحاديث التي ساقها المؤلف -رحمه الله- يتكلم بالأمر من أمره –جل وعلا– فتقول الملائكة هـٰذا الجواب.
بعض العلماء قال: هـٰذه الآية هي وصفٌ لحال الملائكة في كل كلام لله –جل وعلا– يتكلم به .
وقال آخرون: إنه وصف لهم في يوم العرض على الله –جل وعلا– في يوم القيامة، وذلك أن الملائكة تشفع، فإذا استأذنت للشفاعة وتكلم الله –جل وعلا– بالإذن كانت هـٰذه هي حال الملائكة.
والظاهر من الأحاديث أنها ليست حالة خاصة بالشفاعة، وإنما هي حال عامة، إذا تكلَّم الله –جل وعلا– بالكلام فيكون ذلك هو حالهم الدائم مع كلام الله جل وعلا.
وذكر الآية في سياق الشفاعة يكون ذكراً لحالهم العامة في إحدى صورها، وهو عند طلبهم واستئذانهم في الشفاعة لمن أراد الله –جل وعلا– أن يُشَفِّع الملائكة فيهم؛ لأن هـٰذه الآية جاءت في سياق الآيات التي نفى فيها الله –جل وعلا– الشفاعة إلا بإذنه، فقال –-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾( ) يعني: إذا طلبوا الشفاعة وطلبوا الإذن وفزع عن قلوبهم بمجيء الإذن وكُشِف عنها ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾.
ولكنَّ المعنى الأعم الذي دلت عليه الأحاديث أقوى وأظهر، وتكون الآية صورة من الصور التي هي لوصف حال الملائكة في الأحاديث التي بينت عموم وصفهم في كلام الله عز وجل.
يقول : (في الصحيح عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إذا قضى الله الأمر في السماء)).) والأمر هنا يشمل الأمر الشرعي والأمر الكوني.
((إذا قضى الله الأمر في السماء)) و(في) هنا للظرفية، و(السماء) المراد بها العلو، يعني: في العلو.
((ضربت الملائكة بأجنحتها.)) ضربت أي: وضعت أجنحتها، ولكنه ليس وضعًا رفيقًا إنما هو وضع شديد، ولذلك عبَّر بالضرب: ((ضربت الملائكة بأجنحتها)). وهـٰذا يدل على أن للملائكة أجنحة، ويكفي في الدلالة على ذلك أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى جبريلَ له ستمائة جناح قد سدَّ الأفق، وكذلك الآية في سورة فاطر: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ﴾( ). فثبوت الأجنحة للملائكة لا إشكال فيه.
((خضعاناً لقوله)). أي: إنها وضعت أجنحتها حال كونها خاضعة.
((لقوله)). اللام هنا للتعليل، أي: بسبب قوله، أي: لأجل قوله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. والمراد بقوله هنا أي كلامه، وهـٰذا يبين أن هـٰذا الخلق العظيم، وانظر إلى ذكر الأجنحة الدالة على القوة وما خوَّلهم الله –عز وجل– من المُكنة والقدرة، مع ذلك إذا قضى الله –عز وجل– الأمر في السماء، هـٰذه حال هـٰذا الخلق العظيم أنه- يضرب بأجنحته خضعانًا، ذلاًّ وخضوعاً لله –جل وعلا– ولقوله وكلامه.
يقول: ((كأنه)) كأن من أدوات التمثيل والتشبيه، وقوله: ((كأنه)). الضمير فيها يحتمل أن يعود إلى القول، ((ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله كأنه))، أي: كأنَّ قوله ((سلسلة على صفوان)). أي: كأن قوله سلسلة على صفوان، وقد جاء ذلك مبيَّنًا في بعض الروايات بإسنادٍ صحيح، كما ذكر الطبري أنه إذا تكلَّم الله –عز وجل– كان لقوله –جل وعلا–كصوت السلسلة على الصفوان، فهـٰذا يبين لنا أن الضمير في قوله: ((كأنَّه)) عائدٌ إلى قوله جل وعلا.
((سلسلة)) والسلسلة معروفة، هي حلق الحديد التي أخذ بعضها ببعض.
((على صفوان)). الصفوان هو الحجر الأصم، ومعلوم أن جرَّ السلسلة على الصفوان يحدث صوتًا مزعجًا ينفذ نفوذًا كبيرًا، ولذلك قال: ((ينفذهم ذلك)). الضمير في ينفذهم يعود إلى الملائكة، أي ينفذُ الملائكة ذلك الصوت .
وهنا إشكال وهو : ما الجواب على قوله: كأنه سلسلة على صفوان؟ وقلنا: إن الضمير يعود إلى قوله، والله –جل وعلا– قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾( ). فهل هـٰذا يتضمن التشبيه والتمثيل؟
الجواب: لا، بل الآية محكمة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ولا تشبيه ولا تمثيل.
ثم هل التشبيه في هـٰذا -على القول بأن مرجع الضمير إلى قول الله –عز وجل–، هل التشبيه- لصوته؟
الجواب: لا، ليس تشبيهًا لصوته؛ لأن الله –جل وعلا– ليس كمثله شيء: لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في ما يجب له، والصوت صفة من صفات الله عز وجل، فليس تشبيهًا لصوته، هـٰذا يجب أن يكون مقررًا مهما كان؛ لأنه المحكم الذي تُرجع إليه النصوص المتشابهة، وهـٰذا من المتشابه يحتمل أن يراد به صوت الله، فالتشبيه لصوت الله ويحتمل معنًى آخر، فننفي المعنى الذي ترفضه وتمنعه النصوص المحكمة، والنصوص المحكمة تمنع أن يكون لله –عز وجل– نظيرٌ أو مثيل أو سمي أو نِد في شيء من صفاته أو أسمائه أو أفعاله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾( )، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾( )، ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾( ).
كلُّ هـٰذه نصوص محكمة تدل على نفي الشبيه ونفي النظير والمثيل والسمي له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
بقي على القول بأن الضمير يرجع إلى قول الله –عز وجل– كيف يكون المعنى ؟
يكون المعنى: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم. فالتشبيه ليس لصوت الله –جل وعلا– إنما هو لنفاذ الصوت في هؤلاء، والنفاذ ليس صفةً له إنما صفةٌ لهم، فهو بيان لصفة إدراكهم ونفوذ هـٰذا الصوت فيهم، أما الصوت فليس كمثله شيء، وهـٰذا يحل الإشكال وهو واضح وبيّن.
يبقى المعنى الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم: أن الضمير يعود إلى السماء، كما في بعض الروايات عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، وفيها: ((يسمع أهل السماء للسماء صوتاً كأنه سلسلة على صفوان)). فيكون المشَبَّه ما يحدث في السماء من جراء كلام الله عز وجل، وما يحدث في السماء صفة لله أم صفة للسماء ؟ صفة للسماء ليس صفة لله.
فما يحدث في السماء من جراء الكلام ليس صفة لله عز وجل .
ونظيره ما ذكره الله –عز وجل – في تجليه للجبل: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً﴾( ). والدك هـٰذا صفة للرب أو صفة للجبل؟ صفة للجبل، لكن ما سببه؟ هو تجلي الرب جل وعلا.
فنظيره هـٰذا المعنى في هـٰذا الحديث: ((كأنه سلسلةٌ على صفوان)). أي : كأن صوت السماء لكلام الرب –جل وعلا–كصوت السلسلة على صفوان ينفذهم.
ثم قال: ((ينفذهم ذلك)) المشار إليه الصوت المشبه به، أو المشبه له؟ الصوت المشبه له.
يقول: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾( ). (حتى) غائية، وهي تختلف عن (إلى) في أن ما بعدها داخل في ما قبلها، أي: إنه داخل في الغاية وليس منتهى الغاية، بخلاف (إلى) قد يدخل المُغَيَّا وقد لا يدخل.
﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ وهـٰذا يدل أن هـٰذه الحال تعتريهم حتى بعد فراغ الله –عز وجل– من الكلام، يحتاجون إلى فترة حتى يُكشف عنهم، وذلك لعظيم أثر هـٰذا الكلام عليهم.
﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ قلوب الملائكة ﴿قَالُوا﴾ ذكرنا فيها في التفسير أن القائل بعضهم لبعض، ويحتمل أن الجميع يقولون هـٰذا على وجه التعجب والتعظيم لهـٰذا الكلام الذي تكلَّم به الرب جلَّ وعلا.
﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ وهل هـٰذا وصف مقيد أو وصف كاشف؟ هـٰذا وصف كاشف؛ لأنّه وصف لجميع ما يتكلم به الرب جل وعلا، كما قال جلَّ وعلا: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾( ).
قال: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾. وذَكَرَ هذين الوصفين للدلالةِ على عظيم صفة الكلام، وأنها دالة على عظمة الرب وكِبَره جل وعلا، وعظيم وصفه.
ثم قال: ((فيسمعها مسترق السمع.)) مسترق السمع هم الجن الذين يسرقون ما تتكلم به الملائكة من قضاء الله –جل وعلا– وقدره، وما يقضي به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
(((فيسمعها مسترق السمع))، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.)
يقول: (وصفه سفيان) أحد رواة الحديث (بكفه فحرفها). أي أمالها، أمال يده، (وبدد) أي فرق (بين أصابعه). هـٰذا وصف إما أن يكون متلقى من الرواة قبله تلقوها عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونقله سفيان عمّن رواه، ومن رواه نقله عمّن قبله.
ويحتمل أن يكون من فهم سفيان؛ لأنهم يسترقون السمع من أين؟ من السماء، ومن لازم استراقهم السمع من السماء كما في بعض الروايات أنه ((يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا عنان السماء أو السماء الدنيا)). ليسمعوا ما قضاه الله وقدره، فهو إما أن يكون اجتهاديّاً أو توقيفيّاً، والظاهر أنه اجتهادي من سفيان رحمه الله.
(فحرفها وبدد بين أصابعه، ((فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته))). من الذي يسمع؟ أعلاه يسمع الكلمة.
والمقصود بالكلمة: أي من القضاء الذي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا له، وذلك بعد أن يُكشَف عنهم ويتناقلوا الخبر ويخبر بعضهم بعضًا بما قضاه الله –جل وعلا–، تسمعه الشياطين.
((فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته))، وهكذا يُبَلِّغ الأعلى الأسفل.
((حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن)). الساحر: هو من يتعاطى السحر، والكاهن: هو من يخبر بالمغيبات.
يقول: ((فربما ألقاها)). أي: مسترق السمع .
((قبل أن يدركه)). يعني: الشهاب والرجوم .
((فيكذب معها)) من الذي يكذب؟ الكاهن، الساحر، ويحتمل أن يكون الكاذب هم هؤلاء، يزيدون فيكون الكذب منهم ومن السحرة والكهان.
وقد قال الله –جلَّ وعلا– في بيان من يتلقى عنهم في نفي التهمة عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ ( ). فجمع وصفين: عظيم الإفك وهو الكذب، وعظيم الإثم وهو الفجور والمعاصي، وهـٰذه حال الكهان والسحرة.
((فيكذب معها مائة كذبة)). فتكون مائة وواحدة، والمقصود بمائة كذبة هنا التكثير في الكذب، وأنه لا نسبة لصحة كلام هؤلاء مع ما يقولونه؛ لأن الغالب أن ينسب الشيء إلى المائة لا سيما في أوقاتنا –وأما في وقت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا أدري هل ينسبون إلى المائة أو لا- لكن المراد أنه يكذب مع هـٰذا الخبر وهـٰذه الكلمة التي تلقاها عن الوحي كذبًا كثيرًا يضمحل ويغيب فيه هـٰذا الصدق القليل، وما كانت نسبته هـٰذه النسبة فلا يلتفت إليه ولا يستند إليه ولا يعتمد عليه.
((فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟)). من الذي يقول هـٰذا القول؟ الذي يقول هـٰذا القول هم الذين يستمعون إلى السحرة والكهان ويتلقون عنهم.
((فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟)). أي: يحتجون بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فوقعت كما أخبر بها الكاهن والساحر على صدقه في ما يكذب من الكذبات، فيصدق بتلك الكلمات، أي: التي سمعت كما قال، التي سُمِعت من السماء، فعلم أن ما عند هؤلاء من الإخبار بالغيب إنما هو مما يتلقاه عن مسترق السمع، وإلا فالغيب لله جل وعلا، لا يعلمه إلا هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾( ). وهـٰذا أمر لا إشكال فيه، ومن كذبه فقد كذب القرآن؛ لأن انفراد الله بالغيب واضح وضوحًا لا ريب فيه، وهو معلوم من الدين بالضرورة؛ لكثرة ما جاء من الأدلة الدالة على انفراده –-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-– بعلم الغيب.
والشاهد من هـٰذا الحديث:
أنَّ الملائكة خلق من خلق الله، ليس بهم غنىً عن الله -جل وعلا-، لا يملكون من أمر تدبير الكون أو القضاء فيه شيئاً، إنما هم مربوبون مقهورون لا سبيل لهم إلى شيء إلا بإذن الله –عز وجل– ومشيئته، وأنهم على عظيم خلقهم وقدرتهم إلا أن هـٰذه حالهم عند كلام الله –جل وعلا– بما يتكلم به.
ثم جاء في الحديث الآخر مزيد توضيح لحال الملائكة في كلام الله عز وجل.
يقول: (وعن النواس بن سمعان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة -أو قال: رعدة- شديدة خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السمٰوات))).
سمعوا أي شيء؟ الرجفة والرعدة، وهـٰذا هو المعنى الثاني الذي ذكرناه في فك الضمير في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((كأنه سلسلة على صفوان)). فيكون الصوت صوت السماء.
((فإذا سمع ذلك أهل السمٰوات صعقوا وخروا لله سجداً)). فجمعوا بين أمرين: صعقوا، وخروا لله سجداً.
وما فائدة ذكر الخرور سجدًا؟
ليتبين أن الصعق ليس صعق إغماء، لا قدرة لهم عليه، أو يفقدون به كلَّ ما يدركون به الأمر أو يدركون به القضاء، إنما هو صعق إجلال وتعظيم يقترن معه الخرور، والخرور سجود وتعظيم.
((خروا سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد)).
هـٰذا ظاهره أنه يكلمه تكليمًا خاصّاً بعد هـٰذا الكلام العام، فيكون الكلام العام يشمل جميع الملائكة، يسمع أثره الجميع، وأما تكليمه جبريل فهو بعد ذلك، وهو تكليم خاص.
((فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل)).
والحديث هـٰذا ليس فيه زيادة على ما مضى إلا بيان مرجع الضمير، وأيضًا بيان أن أول من يرفع رأسه جبريل، وأنه هو الذي يبلغ الملائكة بما قضاه الله -عز وجل– بعد ذلك.
وقد ذكر العلماء بياناً لسبب هـٰذا الحديث:
أنه لما انقطع الوحي ما بين محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبين عيسى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذه المدة الطويلة، ثم تكلم الله بالوحي وهو الوحي الشرعي حصل من الملائكة هـٰذا.
فظاهر هـٰذا القول أن الحديث خاص بتلك الحال، وهي أول ما تكلم الله فيه بالوحي للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد انقطاع الكلام من عيسى ليه السلام.
لكن هـٰذا ما عليه دليل واضح، والظاهر أن هـٰذه هي حالهم على وجه العموم. وبهـٰذا نعرف أن قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه عام لحال الملائكة في كل كلام لله جل وعلا.
الثاني: أنه حال الملائكة عند طلب الشفاعة، وتلقي الإذن بالشفاعة.
القول الثالث: أنه خاص بابتداء الوحي للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد انقطاعه ما بينه وبين عيسى عليه السلام.
والظاهر: العموم؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يبين ذلك في الحديث الصحيح قال: ((إذا قضى الله الأمر في السماء)). وهـٰذا يشمل ما كان في ذلك الوقت وما بعده.
ويدل على هـٰذا أيضًا ما ذكره من استراق السّمع، واستراق السمع ليس منقطعًا بل هو مستمر، إنما انقطع في فترة إنزال الوحي على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حفظت السماء: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً﴾( ). هـٰذا في وقت بعثة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والوحي إليه، ثم لما مات -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُزيل هـٰذا الحفظ، لكنَّه لم يُزَل بالكلية، هو أشد مما كان الأمر عليه قبل بعثة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكنه ليس كوقت بعثته أي وقت الوحي إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
واستراق السمع مستمر، ويشير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى ما يجري من الكهان من الإخبار بما يخبرون به من الغيب، وتصديق الناس الكهان بسبب ما يتلقونه من أمر السماء.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآية.
[الشرح]
الآية: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾. فزع ما معناه؟ كشف وجُلِّي وأزيل.
[المتن]
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصاً من تعلَّق على الصالحين، وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
[الشرح]
وهي قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ(22) وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾( ). في هـٰذه الآية ذكر الله –عز وجل– أربعة أمور بها يسوغ توجيه السؤال إلى من يُسأل من دون الله وهي منفية، فإذا كانت منفية عن كل من سئل من دون الله فإنه لا يجوز السؤال ولا التوجه إلى غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: فنفى -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الشركة في شيء، ونفى الملك، ونفى المعاونة، ثم لم يبقَ إلا الشفاعة فبين أنها لا تكون إلا بإذنه، فدل ذلك على أنها لا تطلب إلا منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب القادم.
[المتن]
الثالثة: تفسير قوله: ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.
[الشرح]
(سبب سؤالهم)، ما هو سبب سؤالهم؟ ما يعتريهم من الصعق والفزع، فيقولون هـٰذا القول استعلامًا أو تعظيمًا.
استعلامًا: إذا كانوا لم يدركوا ما تكلم به الله –عز وجل– بسبب الصعق.
فإن كانوا أدركوا ما تكلم به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فهو تعظيم وإجلال لما تكلم به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: (قال كذا وكذا).
[الشرح]
كما في الرواية الثانية حديث النواس بن سمعان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
[المتن]
السادسة: ذكر أن أوَّل من يرفع رأسه جبريل.
[الشرح]
وهـٰذا فيه شرفه وعظيم منزلته عند الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
السابعة: أنه يقول لأهل السمٰوات كلهم؛ لأنهم يسألونه.
[الشرح]
وهـٰذا أيضًا فيه بيان فضله وشرفه أنَّ أهل السمٰوات يسألونه عما تكلم به الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
[المتن]
الثامنة: أن الغشي يعم أهل السمٰوات كلهم.
[الشرح]
هـٰذا واضح في قوله: ((ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله)). والملائكة هنا يشمل الجميع؛ لعدم الاستثناء، وللتصريح به في الحديث الآخر، حيث ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، فهو من جملة من صعق.
[المتن]
التاسعة: ارتجاف السمٰوات لكلام الله.
[الشرح]
هـٰذا واضح : ((أخذت السمٰوات منه رجفة)) .
[المتن]
العاشرة: أنَّ جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
[الشرح]
هـٰذا أيضًا واضح .
[المتن]
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.
[الشرح]
هـٰذا في الحديث الأول ، وواضح أيضًا.
[المتن]
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً.
[الشرح]
هـٰذا واضح أيضًا.
[المتن]
الثالثة عشرة: إرسال الشهاب.
الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
[الشرح]
فهو مدركه لا محالة، لكن قد يدركه قبل التبليغ وقد يدركه بعد التبليغ، المهم أنه لا بد أن يدركه.
[المتن]
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة.
السابعة عشرة: أنه لم يُصدَّق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
[الشرح]
لأنها هي الكلمة الموافقة والمطابقة للواقع، ولذلك يغتر به من يغتر، ولذلك لما سُئل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنهم، عن الكهان الذين يخبرون بما يقع قال: ((ليسوا بشيء)). وصدق رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ليسوا بشيء؛ لأنهم لا يأتون به من قبل أنفسهم، إنما يأتون بما يأتون به من صدق قليل نزر نادر عن طريق ما يتلقونه من مسترق السمع الذي ينقل ما تتكلم به الملائكة من قضاء الله عز وجل.
[المتن]
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟!.
[الشرح]
الله أكبر! صحيح، لكن سبب ذلك أنَّ الناس يتشوفون إلى استشراف ومعرفة ما يكون في المستقبل، النفوس مجبولة على هـٰذا، ولذلك نجد أن الناس الآن يتعلقون بالرؤى وما يكون فيها تعلقًا عظيمًا، والسبب أنهم يستجرون منها ما يكون في المستقبل، وهـٰذا فيه نوع غلو وخطأ ينبغي أن يُحذَرَ منه وأن يُحَذَّر منه.
مسألة التعلق بالرؤى وما يكون هـٰذه مسألة تجاوزت الحدود، ووجدت من يروِّج لها من بعض طلبة العلم وهو غلط كبير، لا شك أن الرؤى مبشرات، لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله: الرؤى تسر ولا تغر.
والواقع أن الرؤى في حال الناس الآن تغر وتسر: يغترون بها ويبنون عليها أحكامًا، ويجعلونها أصلاً للتشريع في بعض الأحيان، أو أصلاً لتعيين ما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أحداث، وهـٰذا غلط كبير ينبغي أن يحذر منه.
الرؤى تسر وهي لا تضر، كما قال أحد السلف: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام .
[المتن]
التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
العشرون: إثبات الصفات، خلافاً للأشعرية المعطِّلة.
[الشرح]
إثبات الصفات. المقصود أصل الصفات، ولكن الصفة المعينة هنا هي كلام الله عز وجل، وذلك يؤخذ في الحديث من عدة مواضع:
((إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله)). ولم يقل: خضعاناً لخلقه.
ثم إن الله –عز وجل– يخلق ولا ينفك من الخلق –جل وعلا–، ومع ذلك هم يؤولون الكلام بالخلق، فإذا كان الكلام هنا هو الكلام الشرعي كما حمله بعض أهل العلم، فلا يسوغ تفسير القول هنا بالخلق، وهو على كل حال غير سائغ؛ لدلالة النص على الفرق بين القول والخلق.
ثم لما سئلوا عمّا جرى في زمن صعقهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا خلق؟ ثم جاء الجواب: قالوا الحق. أي: قال الحق. وكل هـٰذا لا يمكن أن يصرف ويؤول.
ثم إن مسترقي السمع ماذا يسترقون؟ يسترقون خلقاً أو كلاماً؟ كلامًا، كل هـٰذا يدل على كذب هؤلاء وانحرافهم في تأويل هـٰذه الصفة العظيمة للرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
الحادية والعشرون: التصريح بأنَّ تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز وجل.
[الشرح]
لقوله: ((خضعاناً لقوله))، وقوله: ((أخذت السمٰوات رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل)).
[المتن]
الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً.
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب الشفاعـة
وقول الله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾( ).
وقوله: ﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾( ) .
وقوله: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾( ) .
وقوله: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾( ) .
وقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ...﴾ الآيتين( ).
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كلَّ ما يتعلق به المشركون: فنفى أن يكون لغيره مُلك أو قسط منه، أو يكون عوناً لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبيَّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى﴾( ). فهـٰذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً، ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تُعط، واشفع تُشفع.
وقال أبو هريرة له -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله خالصاً من قلبه)). فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضَّل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذِنَ له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهـٰذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيَّن النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
[الشرح]
فمناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: فإنَّ من أعظم أسباب الوقوع في الشرك قديمًا وحديثًا طلب الشفاعة، والسعي في تحصيلها، ولذلك كان من المناسب أن يبيِّن المؤلف –رحمه الله– ما يتعلق بهـٰذا الباب؛ حتى يقطع حجة وشبهة كلِّ من تعلَّق بهـٰذا الأمر، وليتبين ما الذي يثبت من الشفاعة من الذي لا يثبت، هـٰذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنَّه في الباب السابق ذكر الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله لا يستطيعون لأحد نفعًا ولا ضرّاً إلا ما شاء الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولما كان المشركون تعلقوا في شركهم بالملائكة أنهم شفعاء إنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى؛ ناسب أن يبين المؤلف رحمه الله– بعد بيان حال الملائكة، وأنهم لا يستطيعون جلب النفع ودفع الضر- أنهم لا يملكون هـٰذا الشيء الخاص الذي كان سببًا للشرك بهم، وهو طلب الشفاعة منهم.
فالمناسبة الخاصة -أي مناسبة هـٰذا الباب للذي قبله-: أن الملائكة يطلب منهم شيء كثير، يطلب منهم المشركون أشياء كثيرة، لكن أعظم ما ذُكر مما يطلبه المشركون من الملائكة هو الشفاعة، كما قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ ( ). فبيَّنت هـٰذه الآية حكم الشفاعة.
قال رحمه الله: (باب الشفاعة).
والشفاعة: أصلها مأخوذ من الشفع وهو جعل الفرد زوجًا، جعل الواحد اثنين، هـٰذا من حيث اللغة.
وأما من حيث المعنى الاصطلاحي: فهي طلب جلب النفع أو دفع الضر عن الغير.
وعرَّفها بعضُ أهل العلم بأنَّها: التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة لأجل الغير.
هـٰذا كله معنى متقارب، واعلم أنَّ من العلماء من فسَّر الشفاعة بالدعاء فقال: الشفاعة هي الدعاء.
لكن ينبغي أن يقال: إنه دعاء خاص وليس دعاءً بمعناه المطلق؛ بل هو دعاء خاص في جلب نفع معين أو دفع ضر معين.
المؤلف –رحمه الله– رتّب هـٰذا الباب ترتيبًا بديعاً: فذكر أولاً الآيات المتعلِّقة بالشفاعة، ثم بعد ذلك جاء بكلامٍ لشيخ الإسلام –رحمه الله– تضمّن بيان ما تضمنته هـٰذه الآيات من معانٍ، فنبدأ بما ذكره أولاً –رحمه الله– من الآيات فقال: (وقول الله عز وجل: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ﴾.) هـٰذه الآية أمر الله –عزّ وجل– فيها رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يُنذِر الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربّهم.
ومن هم أولئك؟
هم من آمن به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصدّقه فيما جاء به من الهدى ودين الحق. ﴿أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾ أي: يخافون لقاء الله جل وعلا؛ لأنّهم يعلمون أنهم ملاقوه، فهـٰذا فيه أنهم يؤمنون باليوم الآخر، وفيه أيضًا أنهم يؤمنون بأن اليوم الآخر يوم جزاء على الأعمال، ولذلك وقعت منهم المخافة.
﴿يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا﴾ والحشر: هو الجمع .
﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾ وهـٰذا بيان منتهى الحشر، وأن الحشر غرضه ومنتهاه أن يبلغ العبد ربه جل وعلا.
﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من دون الله –عز وجل– في ذلك اليوم ولا في غيره، لكن في ذلك اليوم يتّضح هـٰذا اتضاحاً بيّنًا.
﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ يعني: في ذلك اليوم.
﴿وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ﴾ ولي ناصر أو شفيع جالب للخير ودافع للشر عندهم بالتوسط، فنفى الطريقين اللذين يؤمل منهما الخير ويرجى منهما دفع الشر، وهما: الولاية والشفاعة، فليس لهم من دون الله ناصر يمنعهم دونه جل وعلا، وليس لهم من دونه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- شفيع يشفع لهم إلا بالشروط التي ستأتي.
وهـٰذه الآية فيها: نفي الشفاعة، وهو نمط من الآيات أو نموذج من الآيات التي في كتاب الله –عز وجل– التي جاءت فيها الشفاعة منفية، فالله -جل وعلا- نفى الشفاعة، كما في هـٰذه الآية نفى الشفيع قال : ﴿وَلا شَفِيعٌ﴾ وهـٰذا نفي للشفاعة، إذا انتفى الشفيع فالشفاعة منتفية.
ومن ذلك أيضًا: ما ذكره في الآية الثانية التي ساقها المؤلف رحمه الله.
(وقوله: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً﴾.) لله لا لغيره، وقدّم الجار والمجرور ليفيد انحصار الشفاعة فيه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- دون غيره: ﴿لِلَّهِ الشَّفَاعَة﴾ ثم أكد ذلك فقال: ﴿جَمِيعاً﴾ أي: جميع أنواعها، وجميع ما يتعلق بها، وجميع شأنها لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. وبه يعلم أن الشفاعة محض فضل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ومحض كرمه وجوده على عبده، ليس للعبد فيها استحقاق، بل هي منة ومنحة وكرامة وإحسان وبر من رب العالمين.
وهـٰذا النص، وهـٰذه الآية من الآيات التي فيها نفي الشفاعة.
ولكنَّ النفي هنا معنوي أو لفظي؟ النفي هنا معنوي؛ لأنه بصيغة الإثبات الحَصري الذي يفيد الحصر والقصر، أما الآية السّابقة فالنفي فيها لفظي صريح: ﴿وَلا شَفِيعٌ﴾ وهـٰذا هو النوع الأول من الآيات التي ذُكرت فيها الشفاعة، وهو نفيها عن غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فإذا كانت منفية عن غيره ومثبتة له وحده لا شريك له كان الحق والواجب أن تطلب منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وأن تسأل وأن ترجى منه دون غيره، فمن سألها من غير الله أو طلبها من دونه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فقد وقع في الشرك.
قال رحمه الله: (وقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ﴾( ).) هـٰذه الآية أثبتت الشفاعة للخلق، لكنَّها أثبتتها بتقييد ولم تثبتها بإطلاق، فهي ثابتة لمن أذِنَ له الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- .
واعلم أن الشفاعة المنتفية السابقة هي الشفاعة الشّركية التي يزعمها أهل الشرك، وأيضًا هي الشفاعة التي اختلّت فيها الشروط.
فالشفاعة المنفية في الآيتين الأوليين هي الشفاعة الشّركية أو الشفاعة التي اختلّت فيها الشروط.
أما ما تضمّنته هـٰذه الآية من إثبات الشفاعة فهي الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد، وهي مشروطة بشروط، منها:
ما ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في هـٰذه الآية في قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ﴾. (من) هنا استفهام إنكار، أي: لا أحد يشفع عنده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إلا بإذنه.
وهـٰذا نفي وإثبات لبيان أنه لا تحصل الشفاعة لأحد إلا بإذن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
والله –جلَّ وعلا– إنما يأذن لمن يرضى كما ستبينه الآيةُ التالية، فالإذن هنا ليس إذنًا مطلقًا غير مبيَّن، بل هو إذن واضح مبيَّن بالآية الأخرى، فعُلِم من هـٰذا أن الشفاعة لا بد فيها من الإذن، والإذن إنما يكون لمن رضي عنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾( ).) ﴿لا تُغْنِي﴾: أي لا يحصل بها الغَناء، ولا يحصل بها النفع، ولا يحصل بها دفع الضرر والضر عن المخلوق .
﴿لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾. و﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي، فتعم الشفاعة في دقيق الأمر وجليله، تعم الشفاعة في دخول الجنة وفي النجاة من النار، وفي رفع الدرجات،وفي جميع أنواع ما تحصل فيه الشفاعة .
﴿إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾. وهنا ذكر شرطًا مفصلاً، فذكر الإذن ثم بين لمن يكون الإذن، فالإذن إنما يكون لمن رضيه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ليس لكل أحد.
والله –جل وعلا– لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، الذين أخلصوا العبادة له، إن الله لا يرضى لعباده الكفر.
فمن وقع في ما لا يرضى الله –جل وعلا– فإن الله لا يرضى عنه، ومن حقق الغاية من الخلق والوجود فقد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وهـٰذا يبين لنا أن التوحيد شرط أساسي في تحصيل الشفاعة وحصولها للعبد يوم القيامة.
وقوله تعالى: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ﴾؛ ﴿كَم ﴾هنا تكثيرية، كثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا بالشرط المذكور: ﴿إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾. والنص على الملائكة دون غيرهم في هـٰذه الآية -مع أن الشفاعة ليست خاصة بهم-: لكون المشركين تعلَّقوا بالملائكة في الشفاعة، وقالوا: إن الملائكة يشفعون لنا عند الله، فبيَّن أن الملائكة الذين تتعلقون بهم وتظنون منهم الخير لا يشفعون إلا بهـٰذه الشروط، فدلَّ ذلك على أنه لا بد من إرضاء الله –جل وعلا– قبل الشّفاعة، والله –عز وجل– لا يرضى الشفاعة إلا لأهل التوحيد.
وقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ( ).. ﴿قُلِ﴾ هـٰذا أمر من الله –عز وجل– لنبيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أمر بالقول لمن؟ القول لمن وقع في الشرك، فهو أمر من الله للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يوجه هـٰذا الخطاب لأهل الشرك. ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. ادعوا دعاء عبادة ودعاء مسألة ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. أي: افتريتم ونسبتم إليهم الخير، وأنهم يجلبون لكم ما تريدون وصرفتم لهم العبادة. ﴿لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ﴾. فنفى عنهم الملك، وليس النفي هنا نفيًا خاصّاً لملك خاص، بل هو نفي لأدق ما يكون من الملك وأقل ما يكون من الملك، وهو ملك ذرة في هـٰذا الملكوت العظيم في السمٰوات والأرض. ﴿لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾. مثقال يعني: وزن، ميزان، ميزان ذرة في السمٰوات ولا في الأرض، فنفى عنهم ملك شيء في السماوات والأرض .
فانتفى عنهم سبب من أسباب الشفاعة؛ لأن الذي يشفع وينفع إنما يكون كذلك بمسوغ ومبرر: إمَّا أن يكون ملكًا أو مالكًا لشيء من هـٰذه الأشياء التي يطلُبُ الشفاعة فيها، وهو ليس له ملك. ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾. فبعد أن نفى الملك الخاص المستقل نفى الشركة، فالشركة أيضًا منفية عنهم، فليس لهم في ملك السماوات والأرض شركة حتى تدعوهم وتعبدوهم وتصرفوا لهم العبادة.
﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾. هـٰذا ثالث ما نفته الآية، وهو الإعانة، فالله -عز وجل– نفى الإعانة منهم، فليس لهم عون ولا معاونة يستوجبون بها صرف العبادة.
ثم بعد أن نفى هـٰذه الأمور الثلاثة: الملك والشركة والمعاونة في الخلق، بقيت الشفاعة، فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَه﴾. ثم بيَّن أن هـٰذا الإذن ليس إذن ند لنده ولا نظير لنظيره، بل هو طلب العبد المخلوق الذليل الضعيف الإذن من الرب جل وعلا الكبير المتعال، فقال:
﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾. وهـٰذا بيان حال الشافع وأنه في منتهى الذل، فإذا تكلم الرب –جل وعلا–كانت هـٰذه حاله، فكيف يرجى منه ما يغضب الله –جل وعلا–، وهو أن يشفع الشفاعة الشركية؟
وهـٰذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم: قطعت عروق الشرك، فقد قطعت أسبابه وحسمت مادته، فلم يبق للمشركين ما يتعلقون به أو يركنون إليه، فإن الله نفى الملك عن غيره ونفى الشركة ونفى المعاونة، وبيَّن أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه .
وقد تقدم أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضيه –-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-–، والله –جل وعلا– لا يرضى إلا من حقق التوحيد.
بعد هـٰذا السياق للآيات التي بيَّن فيها المؤلف –رحمه الله– أنواع الشفاعة وما يثبت منها مما لا يثبت، نقل عن شيخ الإسلام –رحمه الله– كلامًا شارحًا موضحًا فقال: (قال أبو العباس) وهـٰذه كنية الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، شيخ الإسلام رحمه الله.
وهـٰذا النقل من المجلد السابع في الصفحة السادسة والسبعين أو السابعة والسبعين، يقول: (قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه –أي: قسط من الملك-، أو يكون عوناً لله، ولم يبق إلا الشفاعة –يعني: بعد هـٰذا النفي لم يبق إلا الشفاعة-، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى﴾. فهـٰذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة، فلا يحصل بها النفع لهم ولا يحصل بها الخير لهم، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً.)
وهـٰذا فيه بيان الشفاعة المثبتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهي الشفاعة لأهل التوحيد بعد إذن الله –عز وجل– ورضاه.
وأعظم هـٰذه الشفاعات شفاعة النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الموقف لأهل الموقف، وهي التي أشار إليها الشيخ –رحمه الله– في نقله هـٰذا.
قال: (وأخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده). وهـٰذا المجيء بعد أن يطلب أهل الموقف الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يحيل إلى الآخر، فإذا جاؤوا إلى عيسى عليه السلام أحالهم إلى محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فيقول: أنا لها أنا لها.
يقول: (فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً.) وهـٰذا فيه أن الشفاعة ليست حقّاً للشافع، إنما هي أمر يتوسل إلى الله –عز وجل– في تحصيله، فلا بد من الإذن، لا يبدأ بالشفاعة أولاً، ثم يقال له –أي: يقال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -: (ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع.) فيؤذن له في الشفاعة.
والأحاديث التي ذكرت الشفاعة في الصحيحين تطوي ذكر الشفاعة العظمى وتنتقل مباشرة إلى ذكر شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أمته، والسبب في هـٰذا أن الشفاعة العظمى لا ينكرها المنكرون ممن أنكر الشفاعة، ولم يكن فيها خلاف، إنما الخلاف في شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأهل الكبائر من أمته، هـٰذه الشفاعة هي التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والوعيدية وغالية المرجئة، فالشفاعة ثابتة لأهل الكبائر؛ ولذلك اهتم بها نقلة الأحاديث، ولم يذكروا شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أهل الموقف، مع أن السؤال جاء من أهل الموقف، فالجواب على هـٰذا الإشكال: أن الرواة طووا ذكر الشفاعة العظمى -وهي شفاعته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أهل الموقف- لكونه لم يقع فيها خلاف، وأما التي وقع فيها الخلاف فذكروها ورووها بالتفصيل .
ثم قال رحمه الله: وقال أبو هريرة. وهـٰذا الحديث فيه إثبات الشفاعة، الشفاعة العظمى للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وفيه أيضًا إثبات الشفاعة الخاصة به وهي شفاعته في أمته. وشفاعات النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ست:
منها ثلاث خاصة به، وثلاث له ولغيره.
أما الخاصة به: فهي شفاعته في أهل الموقف أن يأتي الله –جل وعلا– لفصل القضاء.
والثانية: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذاب النار.
والثالثة: شفاعته في دخول أهل الجنةِ الجنةَ. هـٰذه الشفاعات الثلاث الخاصة بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
وأما الشفاعات التي له ولغيره: فشفاعته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وفي قوم دخلوها أن يخرجوا منها، وشفاعته أيضًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وغيره في رفع الدرجات.
وهناك شفاعة أيضًا خاصة بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهي شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فإنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أنا أول شفيع في الجنة)). وهـٰذا يشمل أنه أول من يشفع في دخول الجنة لجميع أهلها، فإنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ((يأتي إلى باب الجنة ويستفتح، فيقول الخازن: من؟ فيقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك)).
ويشمل أيضًا أنه أول من يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، يشفع فيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا يدخلها، يشفع أيضًا في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، يشفع أيضًا في قوم دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، وكل هـٰذا يدخل في عموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أنا أول شفيع في الجنة)).
تلخّص لنا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له ست شفاعات:
الشفاعات الخاصة:
الأولى: شفاعته في أهل الموقف.
الثانية: في عمه.
الثالثة: في دخول الجنة.
الشفاعات العامة:
الرابعة: في رفع الدرجات.
الخامسة: في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها.
السادسة: في قوم دخلوها أن يخرجوا منها.
ست شفاعات: ثلاث خاصة، وثلاث عامة.
واعلم أن العامة التي يشاركه فيها غيره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نصيبه منها أعظم وأوفر من غيره، ولا مساواة بينه وبين غيره في الشّفاعات العامة، بل نصيبه منها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعظم من غيره.
قال : (وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ((من قال: لا إلـٰه إلا الله خالصًا من قلبه.))) وهـٰذا يبيّن لنا أنه بقدر تحقيق العبد للتّوحيد يحصل له شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأسعد الناس يعني: أوفى الناس حظّاً، وأعظم الناس نصيبًا من شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو من قال: لا إلـٰه إلا الله خالصًا من قلبه.
فبقدر تحقيق العبد للتوحيد بقدر ما يحصل له من الشّفاعة، وهـٰذا ندب إلى تحقيق التوحيد.
والنصوص التي وردت في شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نوعان:
نوع ذكر فيها: أن أسعد الناس بشفاعته ((من قال: لا إلـٰه إلا الله خالصاً من قلبه)).
والنوع الثاني: أنّ النّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي)). وانظر الفرق بين التعبيرين: هناك قال :(حلّت) يعني أبيحت وثبتت له، لكن في هـٰذا الحديث بين أن أوفى النّاس نصيبًا من شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هم أعظم الناس تحقيقًا.
وبهـٰذا نعلم أن الناس في حصول شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهم على درجات، وليسوا على درجة واحدة:
فمنهم من تحل له الشفاعة ويستحقها.
ومنهم من يكون له منها النصيب الأعلى والحظ الأوفى.
((من قال: لا إلـٰه إلا الله خالصاً من قلبه))، قال: (فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.) هـٰذا من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-، فهي شفاعة لأهل التوحيد، وهـٰذا بيان لما أجملته الآيات في قوله تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾( ) فالرّضا هو الرضا بمن كان موحدًا، وليس الرضا مجملاً لا يدرى ما هو، إنما الرضا هو بالتوحيد.
قال: (فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.) لأن الله لا يرضى الشرك.
قال: (وحقيقته) وهـٰذا مهم، (حقيقته) يعني: حقيقة الأمر (أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود.)
إذًا يا أخي الشفاعة يحصل بها عدة أمور:
أولاً: بيان فضل الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وعظيم رحمته جلّ وعلا، فلولا فضل الله ورحمته ما حصلت الشفاعة، فهي محض فضل الله –عز وجل–، وفضله على صنفين من الناس:
على الشافع وعلى المشفع فيه: أما الشافع فلكونه بالشفاعة يظهر فضله ومكانته وجاهه عند الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فهو إكرام له، وأما المشفع فيه فهو فضل من الله عليه ورحمة إذ قبل فيه شفاعة الشافعين.
ثم حقيقة الأمر أنه بيان لعظيم فضل التوحيد؛ لأن التوحيد هو الذي يحصل به للعبد الشفاعة، وبه أيضًا يكون العبد شافعًا، فإنه لا يشفع إلا أهل التوحيد، ولا يُشفع إلا في أهل التوحيد.
قال رحمه الله: (فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك)يعني: ما وجد فيها الشرك (ولهـٰذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص) –اللهم اجعلنا منهم–. انتهى كلامه رحمه الله.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآيات.
[الشرح]
هـٰذا واضح.
[المتن]
الثانية: صفة الشفاعة المنفية.
[الشرح]
وهي الشفاعة الشركية.
[المتن]
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.
[الشرح]
وهي الشفاعة لأهل التوحيد بعد إذن الله.
[المتن]
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.
[الشرح]
واضح هـٰذا في الحديث الذي ساقه.
[المتن]
الخامسة: صفة ما يفعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً، بل يسجد، فإذا أذن الله له شفع.
[الشرح]
نعم، هـٰذا واضح من قوله: إنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً.
[المتن]
السادسة: من أسعد الناس بها؟
[الشرح]
أهل التوحيد جعلنا الله منهم.
[المتن]
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
الثامنة: بيان حقيقتها.
[الشرح]
هـٰذا كله واضح من كلام المؤلف رحمه الله.
بقي أن نذكر الشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر خالف فيها الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وخالف فيها أيضًا غلاة المرجئة.
أما المعتزلة والخوارج فحملوا الآيات التي فيها ذكر الشفاعة على الشفاعة لأهل الجنة في رفع الدرجات؛ لأنه عندهم أنَّ من فعل الكبيرة كافر خالد في النار فلا يخرج منها بشفاعة ولا بغيرها.
وأما غالية المرجئة فقالوا: لا حاجة إلى الشفاعة؛ لأن المعاصي لا تضر مع الإيمان، فالإيمان به يدخل الجنة ولا تضره المعاصي، فلا حاجة إلى الشفاعة.
وأوَّلَ هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة وصادموا النصوص، أوَّلوها بنوع خاص من الشفاعة، وهو الشفاعة في من؟ في أهل الجنة، في رفع الدرجات.
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثاني عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾( )الآية.
في (الصحيح) عن ابن المسيَّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: ((يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله)). فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فأعادا، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب.وأبى أن يقول: لا إلـٰه إلا الله. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)). فأنزل الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾( ) الآية.
وأنزل الله في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ ( ).
[الشرح]
فقد قال الإمام المؤلف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ( باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾.)
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي: أنَّ الهداية من الله جل وعلا، وأنها له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ملكًا، فلا تُسأل من غيره، فمن سأل الهداية أو طلبها أو ظنها في غير الله جل وعلا فإنه قد أخطأ ووقع في شرك الربوبية وفي شرك الإلهية: في شرك الربوبية حيث جعلها من فعل غيره، وفي شرك الإلهية حيث سألها من غيره، هـٰذه مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد.
أما مناسبة هـٰذا الباب للباب الذي قبله: فإنَّه في الباب الذي قبله -وكذلك ما تقدّمه من أبواب قريبة- ذكر المؤلف –رحمه الله– عجزَ المخلوق مهما بلغ في الجاه والمكانة، وفي القدرة والقوة، عن أن يوصِل خيرًا أو يمنع ضرّاً عن أحد استقلالاً عن الله عز وجل، فبيَّن فيما مضى أن أشرف الخلق وأعظمهم جاهًا لا يستطيع أن يجلِبَ لنفسه ولا أن يدفع عنها، ولا يجلب لغيره نفعًا ولا يدفع عنه ضرّاً، وكذلك أعظم الخلق قدرة وهم الملائكة لا يستطيعون ذلك.
ثم بيَّن أنه حتى الشّفاعة من هؤلاء لا تمكن ولا تحصل إلا بشروط، وهي:
إذنُ الله جل وعلا، ثم رضاه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن الشافع وعن المشفوع فيه.
في هـٰذا الباب أتى وبيّن -رحمه الله- أن الهداية لا تكون من غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهي لا تُطلب لا من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا من الملائكة ولا من غيرهم، بل إنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يتمكّن من إيصال الهداية إلى أعظم النّاسِ محبةً ودفاعًا عنه وهو أبو طالب، فإنَّه من أعظم الناس محبة لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن أعظمهم دفاعًا عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنَّ أبا طالب ضحّى بماله وجاهه ومكانته وكلِّ ما يملك في الدِّفاع عن النّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأثنى على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثناءً بالغاً، كما في لاميته:
وقد علموا أن ابننا لا مُكذَّبٌ
لدينا ولا يُعنى بقول الأباطلِ
اللامية المشهورة من قصيدة أبي طالب في الثناء على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبيان صدق ما جاء به، وأن ما يدعو إليه حق، مع ذلك لم يتمكن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من إيصال الهداية إليه، مع أنَّ الله -جل وعلا- قال في وصفه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقيم ﴾( ).
لكن الهداية التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدّلالة والإرشاد والبيان والتوضيح، أما هداية التوفيق والعمل والإلهام فهـٰذه لا تكون إلا من الله جلَّ وعلا، فتلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقيمٍ﴾ هداية دلالة وإرشاد، وهـٰذه التي في قوله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾( ) هداية توفيق وعمل، وهـٰذه لا تكون إلا من الله جلَّ وعلا، فمهما اتضحت البينات واستبان الحق، فإنه لا يتمكن الإنسان من سلوك السبيل، والعمل بمقتضى هـٰذا الدليل، إلا بتوفيق الله جل وعلا.
إذًا مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: أنه نوع منه، فإنه كما أن النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يستطيع أن يوصل الخير، ولا يستطيع أن يدفع الضر وكذلك الملائكة، فهو أيضًا لا يستطيع أن يوصل الهداية لمن أحب، ولمن حرص حرصًا بالغًا على هدايته، هـٰذا وجهٌ في مناسبة هـٰذا الباب لما قبله.
ومن الأوجه -وهو وجه خفي لكنَّه قد يكون قريبًا-: أنَّ المؤلف -رحمه الله- فيما تقدَّم بيَّن التوحيد، وبيَّن ما رتَّب الله -جل وعلا- من الأجر عليه، وما رتَّب من العقوبة على من خالفه، وبيَّن الشرك وعقوبة أهله، وبيَّن بعض ما يتعلق بالشرك، في شرك الأسباب، وفي شرك الطلب، وفي شرك العبادة بعدة صور تقدَّمت، وهي واضحة بالأدلة البينة.
فبعد أن بين ما بين كأنه يقول: فمن لم يقتنع بذاك فليس عليك هدايته، إنما هدايته إلى الله جل وعلا، فأنت قد قمت بهداية البيان والتوضيح وإقامة الحجة، وأما هداية العمل والتوفيق والامتثال فهـٰذه إلى الله جل وعلا، فلعل هـٰذا من مقاصد المؤلف -رحمه الله- بهـٰذا الباب.
هـٰذا الباب ذكر فيه -رحمه الله- آيةً وحديثًا، الآية هي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾( ) الخطاب في هـٰذه الآية لمن؟ للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهو المخاطَب بهـٰذه الآية. ﴿إِنَّكَ﴾ أي: يا محمد ﴿لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. والهداية المنفية تقدم لنا أنها هداية العمل، هداية التوفيق، هداية الإلهام، هـٰذه لا تكون لأحد، فهي منفية عن كل أحد ولا تكون إلا لله جل وعلا.
﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. (من) هنا موصولة بمعنى: الذي. ﴿أَحْبَبْتَ﴾ ولم يذكر في صلة الموصول العائد، وهو الضمير المقدَّر في قوله: أحببت، أي: إنَّك لا تهدي من أحببته، فما هي المحبة التي أثبتها النص لأبي طالب؟ لأن هـٰذه الآية نزلت في أبي طالب، هل هي محبته ذاته؟ أم هي محبة هدايته؟
قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إن هناك مقدراً محذوفاً تقديره: من أحببت هدايته، وهـٰذا قاله كثيرٌ من المفسرين ومن أهل العلم.
والقول الثاني: أن الضمير يعود إلى أبي طالب. والمحبة هنا هي المحبة التي لا لوم فيها على الإنسان، وهي محبة الرّحمة، ويمكن أن تكون محبة القرابة؛ لأنَّ المحبة التي تكون للمخلوق إما أن تكون محبة طبيعية، وإما أن تكون محبة إلف وأنس، وإما أن تكون محبة رفق ورحمة.
ومن أنواع المحبة التي قد تندرج في بعض ما تقدّم محبة القرابة، فقد تكون من إلف، وقد تكون من رحمة، وقد تكون محبة طبيعية كمحبة الوالد لولده. المهم أنَّ من العلماء من قال: إننا لا نحتاج إلى تقدير؛ بل نقول: ﴿أَحْبَبْتَ﴾ أي: أحببته لذاته، وذلك أنّ أبا طالب دافع عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مدافعة عظيمة، وأبلى في ذلك بلاءً بيّنًا واضحًا، حتى إن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حزن على موته، وحزن على عدم استجابته حزنًا عظيمًا، فقولان لأهل العلم في توجيه قوله تعالى: ﴿مَنْ أَحْبَبْت﴾؛ ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾.
﴿لَكِنَّ اللَّهَ﴾ هـٰذا استدراك لبيان لمن أو ممن تكون الهداية. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾. فالهداية منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهي منه وفق مشيئته، والمشيئة حيث ذكرت مضافة إلى الله عز وجل فاعلم أنها مشيئة مقترنة بالحكمة، فإنَّ الله -جل وعلا- لا يفعلُ شيئًا إلا لحكمة، فهو الحكيم الخبير
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ذو الحكمة البالغة والقدرة النافذة، فمشيئته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مقترنة بحُكمِه.
﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾ والهداية التي نفاها عن غيره وأثبتها له هي هداية التوفيق والإلهام والعمل.
ذكر المؤلف -رحمه الله- سبب نزول هـٰذه الآية حتى يتضح المعنى اتضاحًا جليّاً، فقال رحمه الله: (في الصحيح عن ابن المسيِّب) ويقال: ابن المسيَّب، مع أن بعض العلماء نقل عنه قوله: سيَّب الله من سيَّبَنِي، فنحتاج إلى تحقيق: هل هو المسيِّب أم المسيَّب، هما وجهان يقرأ بهـٰذا وبهـٰذا، لكن المشهور: المسِّيب.
(عن أبيه) وهو حَزْن، من الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: (لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل).
(حضرت): أي نزلت الوفاة، وحضور الوفاة يطلق على أمرين:
يطلق على نزول علامات الموت وكون الإنسان في سياق الاحتضار وسياق الموت .
ويطلق أيضًا على نزول الموت بمعنى نزول بداياته، وليس النزول الذي يكون فيه الإنسان محتضرًا في سياق الموت، يعني: نزل به ما يُعلم منه أنه يموت منه.
فعندنا قوله: (لما حضرت الوفاة) يحتمل أنها حضور العلامات التي يكون الإنسان فيها في سياق الموت، والثاني: أنه نزل به ما يموت منه وإن لم يكن قد قارب الموت .
والذي يظهر من سياق الحديث أنَّ المراد: ساعة الاحتضار؛ لأن هـٰذه المجادلة والمراجعة التي كانت بين رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبين هؤلاء الذين حضروا محاورة المشفق الذي يريد أن يستبق فوتًا، ويأخذ شيئًا قبل أن يمضي.
قال: (لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعنده) يعني: عند أبي طالب (عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له : ((يا عم))).
وهـٰذه كلمة فيها من التلطف والشفقة والحنو ما يستوجب قبول ما يدعوه إليه.
((يا عم، قل: لا إلـٰه إلا الله)) وهـٰذا القول مفتاح الجنة، وهو مفتاح الإسلام، فمن قاله دخل في الإسلام.
((قل: لا إلـٰه إلا الله)) ولم يقل: وأني رسول الله؛ لأن هـٰذا معلوم، ولأنه في الظاهر أن أبا طالب لا يُنكر رسالة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكنه لم يقبل ما جاء به، فهو يصدقه فيما يقول لكنه لم يقبل منه، فعرض عليه هـٰذه الكلمة التي إذا حصَلت ثبت له ما بعدها من الشهادة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة.
((قل: لا إلـٰه إلا الله، كلمة أُحاج لك بها عند الله)).
((أحاج لك بها عند الله)). قال بعض العلماء: أي أجادل لك بها الله جل وعلا. وقال آخرون: المحاجة المراد بها هنا الشهادة كما جاء في رواية أخرى، وهي رواية مسلم: ((أشهد لك بها عند الله)) وهـٰذا المعنى أقرب، وهو تفسيرٌ لهـٰذه الرواية، فالمراد بالمحاجة: هو الشهادة له بأنَّه قال الكلمة التي يكون بها مسلمًا.
((قل: لا إلـٰه إلا الله، كلمة أُحاج لك بها عند الله)) وهـٰذا القول فيه إشكال، يعني: قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((أُحاج لك بها عند الله)) فيه إشكال، من جهة أن أبا طالب قال هـٰذه الكلمة التي طُلبت منه في ساعة الاحتضار، وقد قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾( ) والتي بعدها: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ﴾( ). انظر إلى قوله: ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾. وهو ما وقع في هـٰذا الحديث، حيث قال: (لما حضرت أبا طالب الوفاة). يعني: لما حضره الموت، فالآية تدل على أن التوبة تنقطع بحضور الوفاة، بحضور الموت، والحديث يدل على أن هـٰذه الكلمة تنفع، ولذلك قال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((قل: لا إلـٰه إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله)). فأجاب العلماء رحمهم الله عن هـٰذا الإشكال، أو على هـٰذا الإشكال بجوابين:
الجواب الأول: قال جماعة منهم: إن حضور الوفاة هنا هو نزول ما يموت به الإنسان، ولا يلزم أن يكون في ساعة الاحتضار التي ذكرها الله في الآية: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾. وانفكوا من الإشكال.
الجواب الثاني: وهو الذي رجحه جماعة، ومنهم شيخنا -رحمه الله-: أنَّ هـٰذا خاص بأبي طالب، أن هـٰذا مما اختص الله به أبا طالب، أنه لو قالها في تلك الساعة لنفعته، وأما غيره فإنَّ هـٰذه الساعة ليست ساعة توبة وأوبة؛ لأنه إذا غرغر الإنسان وبلغت الروح الحلقوم وكان الإنسان في ساعة الاحتضار لم يقبل منه توبة ولا رجوع.
وهـٰذا الجواب الثاني جواب جيد في الحقيقة ولا إشكال فيه، ودليل الخصوصية أن أبا طالب له من الخصوصية ما ليس لغيره، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شفع في تخفيف العقوبة وقُبلت الشفاعة فيه، ثم إنه فعل من النصرة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولدين الإسلام ما لم يفعله أحد من أهل الشرك والكفر، فهـٰذا دل على أن ما عُرض عليه إنما هو على وجه الخصوصية.
(فقالا له) الضمير يعود إلى عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل.
(فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟). والرغبة معناها: الترك، يعني: أتترك ملة عبد المطلب؟ ومن هـٰذا نفهم أن ملة عبد المطلب ليست هي لا إلـٰه إلا الله، وأنه لم يكن على ما كان عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل كان على أمر يخالف ما يدعو إليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكان على الشرك.
ومنه نعلم أن عبد المطلب كان مشركًا؛ لأن نسبة الملة إليه ومقابلتها لما دعا إليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تبيّن لنا حاله.
ثم نفهم من هـٰذا أن المشركين يفهمون معنى لا إلـٰه إلا الله، كما سيبين المؤلف رحمه الله في المسائل، إذ إنهم جعلوا هـٰذا القول يقتضي عملاً، وهـٰذا القول يخالف ما هم عليه، ففهموا من لا إلـٰه إلا الله ما لم يفهمه كثيرٌ من المتأخّرين.
فلا إلـٰه إلا الله معناها: أي لا معبود حقٌّ إلا الله كما تقدم، وهـٰذا ما لا يرضاه أهل الجاهلية؛ لأنهم تعجبوا من ذلك غاية العجب، فقالوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هـٰذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾( ) . فجعلوه مما يُستغرب منه ويُندهش منه ويُتعجب منه أن يختصر هـٰذه الآلهة المتعددة التي يعبدونها في إلـٰه واحد، وما ذلك إلا لفساد عقولهم، وفساد فِطَرِهم، وإلا فالفِطَر مركوز فيها أن لا تعبد إلا إلهاً واحدًا، ولذلك هم في الشدائد عند نزول كربهم يتركون هـٰذه الآلهة ولا يتوجهون إلا إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
قال: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أعاد عليه أي شيء؟ أعاد عليه العرض السابق: ((قل: لا إلـٰه إلا الله، كلمة أُحاج لك بها عند الله)) وهـٰذا فيه أنه ينبغي لمن يدعو إلى الله عزّ وجل أن لا يَمَل وأن لا يَكل، بل ينبغي له أن يواصل في الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الخلق مهما كانت دِعاية المقابلين، ومهما كانت حججهم، فحججهم شُبَه؛ ولذلك لم يتعرّض رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى مقالتهم، بل أعاد الحق فقط دون أن يتعرّض لما عرضاه؛ وهـٰذا لأن المقام ليس مقام مناقشة ومجادلة؛ بل هو مقام دعوة وإنقاذ، ولذلك باشر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدعوة إلى لا إلـٰه إلا الله دون أن يتعرض إلى ملة عبد المطلب، ودون أن يقول: هي ملة باطلة، اتركها، احذرها، تقع بسببها في النار، بل أعاد الحق الذي يدعو إليه، وفي الدعوة إلى الحق كفاية في إبطال الباطل.
(فأعاد عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تلك المقالة، فعادا) أي: أعاد أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية تلك المقالة السيّئة التي صدَّت عن التوحيد وصدَّت عن الإيمان بألوهية الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
(فكان آخر ما قال) من؟ أبو طالب (هو على ملة عبد المطلب) نعوذ بالله من الخسران: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾ مات على هـٰذه الملة الفاسدة التي مآل أهلها إلى النار –نعوذ بالله من الخذلان- وأبىَ أن يقول: لا إلـٰه إلا الله. وفي رواية أخرى بيَّن أبو طالب سبب هـٰذا الامتناع، فقال: ((لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك)) تعيره بماذا؟ تعيره أنه جزع في حال السياق والموت وترك ملة أبيه، وملة من يعظمونه وهو عبد المطلب، أبىَ أن يقول: لا إلـٰه إلا الله.
(فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لأستغفرن لك)).) اللام هنا موطئة للقسم، وأكد النبي
-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذا العزم على الاستغفار بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، والنون. ((لأستغفرن لك)) أي: لأطلبنّ لك المغفرة.
((ما لم أُنه عنك)) انظر إلى انصياع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أمر الله عز وجل، وملاحظته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما يأمره به ربه، وأنه لا يفعل من قِبل نفسه، مهما كان ذلك مخالفًا لما يحبه، فإنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع شدة حرصه على هداية عمه وشفقته عليه وما كان منه من إعراض، قال: ((لأستغفرن لك ما لم أُنه عنك))، فقَيَّد ذلك بأنه يستمر على الاستغفار إلا إذا جاء نهي، وفي هـٰذا وجوب تقييد أحوال الإنسان بما جاء عن الله وعن رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وبذلك يتحقق للإنسان كمال الإيمان، مَن حكمَ عواطفه، وحكَم مشاعره بما جاء به الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكتاب والسنة كان على خير عظيم وسلِم من شر عظيم، فأنزل الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾( ). هـٰذه الآية نزلت لبيان امتناع أن يستغفر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه ومن معه وأهل الإسلام لمن تيقّنوا موته على الشرك.
﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ أي: أن يطلبوا المغفرة للمشركين ﴿وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾. يعني: ولو كانوا أصحاب قرابة وأهل قرابة، فإنَّ شركهم يقطع هـٰذه الصلة، ويبت هـٰذا الحق لهم، فإنه لا حق للمشرك-إذا مات- في طلب المغفرة.
وقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ﴾ يستخدم في بيان الامتناع الشرعي أو الامتناع الكوني القدري، وكذلك: ما ينبغي. هنا امتناع شرعي أم امتناع كوني؟ هـٰذا امتناع شرعي، يعني: يمتنع شرعًا أن يستغفر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والمؤمنون للمشركين. والامتناع الكوني مثاله قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾( ) . يعني: يمتنع عليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أن ينسى؛ لأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الحفيظ العليم.
أيضًا من الأمثلة الظاهرة: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً﴾( ) فهـٰذه قريبة من هـٰذه، والامتناع هنا امتناع قدري. المهم أن ﴿مَا كَانَ﴾ تأتي للامتناع الشرعي، وتأتي للامتناع القدري.
قال: (وأنزل الله في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾( ) .) وهـٰذا لا خلاف بين أهل العلم في أنها نزلت في أبي طالب، كما أنه لا خلاف بين أهل العلم أن أبا طالب مات كافرًا، وهـٰذا مما أجمع عليه أهل العلم، وما يدّعيه المدَّعون من أن أبا طالب أسلم، إنما هـٰذا كذب وبهتان تردّه الأدلة الظاهرة ويرده إجماع أهل العلم.
وقد كان جماعة من أهل التصوف يعتقدون أن أبا طالب، وأن عبد المطلب قد ماتا على التوحيد، ولكن هـٰذا يخالف ما هو ظاهر في هـٰذا الحديث وفي غيره، ويكفي في ذلك حصول الإجماع ممن يُصدَر عن إجماعهم وهم أهل العلم في أن أبا طالب مات كافرًا.
وأما قول الراوي: (فأنزل الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾( )). فظاهر هـٰذا السياق أن هـٰذه الآية نزلت في هـٰذه الحادثة، وهي نزلت متأخرة، وبعض العلماء يقول: لا يمنع أن يكون النزول قد تكرر، فنزلت في هـٰذا الأمر، ونزلت أيضًا في استئذان النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الله – عز وجل- أن يستغفر لأمه، ولكن الظاهر أنها نزلت في ذلك، وأما ما نزل في هـٰذا الحدث فهو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾( ).
الاستغفار للمشركين ما حُكمه؟ بعد الموت محرَّم ولا إشكال؛ لقوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾( ).
في الحياة ما حكمه؟ الصحيح أنه جائز، أن يستغفر الإنسان للمشرك، ومنه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزوة أحد: ((اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون)).
ولكن اعلم أن المغفرة التي سألها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لقومه وهم مشركون في حياتهم ليست المغفرة التي هي العفو عن الشرك، فالشرك لا يقع تحت المغفرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾( ). إنما هي طلب هدايتهم والتوبة عليهم، بترك الشرك، فقول النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)). هو كقوله: اللهم اهدهم، اللهم تب عليهم من هـٰذا الشرك، وليس المقصود أن يبقوا على شركهم ويغفر لهم، فهـٰذا ممتنع؛ لأن الله قد بين أنه لا يغفر الشرك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾( ).
إذًا طلب المغفرة للمشرك في حال حياته جائزة أو ليست جائزة؟ جائزة، والمعنى هو طلب الهداية والتوبة عليه من الشرك الذي هو فيه، وأما بعد موته فلا شك أنه لا يجوز طلب المغفرة للمشرك إذا مات على الشرك.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾( ).
[الشرح]
وهـٰذا واضح. ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. ما الهداية التي نفاها الله عن رسوله؟ هداية التوفيق والعمل.
[المتن]
الثانية: تفسير قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾( ).
[الشرح]
هـٰذه واضحة.
[المتن]
الثالثة وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قل: لا إلـٰه إلا الله)) بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
[الشرح]
هـٰذه المسألة -كما قال الشيخ رحمه الله- مسألة كبرى، وهي فهم معنى لا إله إلا الله، ويشير الشيخ -رحمه الله- في هـٰذه المسألة إلى خطأ من يفسر هـٰذه الكلمة العظيمة الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، الموجبة للدّخول في الإيمان وهي أولّ الواجبات وآخر المطلوبات؛ لأن ((من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)). هي أول الواجبات وآخر المطلوبات، مع هـٰذا يجهل معناها كثير من الناس، فيفسرها على غير وجهها فيقول: لا إله إلا الله معناها: لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو لا صانع إلا الله، وهـٰذا معنى باطل، تقدَّم بيان بطلان هـٰذا فيما تقدم من الدروس، فما هي أوجه بطلان هـٰذا التفسير، تفسير لا إله إلا الله بلا خالق أو لا صانع أو لا قادر إلا الله؟ غلط من وجوه عدة ذكرناها في الدروس السابقة، نراجعها:
أنَّ هـٰذا تمنعه اللغة، فليس في معاني الإله في كلام العرب لا القدرة ولا الاختراع ولا الصنع، هي من التفسير باللازم، لكن ليس صحيحًا أن يتركَ الإنسان التفسير المطابق الذي يُفهم به المعنى إلى التفسير باللازم، ولا يُصار إلى التفسير باللازم إلا إذا تعذر التفسير المطابق الذي يتبين به اللفظ.
إذاً أولاً: أن هـٰذا مما تمنعه اللغة.
ثانيًا: أنَّ الخصومة التي وقعت بين الرسل وأقوامهم ليست في أن الله هو الخالق أو أنه هو الصانع، بل هم يقرون بذلك، وأنه لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا صانع إلا الله، لكنهم كانوا يجادلون ويناقشون في أي شيء؟ في العبودية، في أنها حق لله، فهم يرون أنها ليست حقّاً له وحده، بل هي حق له ولمن اخترعوه من الأصنام والمعبودات، هـٰذا الوجه الثاني.
[المتن]
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قال للرجل: ((قل: لا إلـٰه إلا الله)). فقبَّح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
[الشرح]
ما فيه إشكال أن أبا جهل كان مدركًا إدراكًا تامّاً لمعنى هـٰذه الكلمة، لكنه أبى أن يقرَّ بها، فباء بالخسران نعوذ بالله من الخذلان، وهـٰذه تابعة للتي قبلها، فإذا كان أبو جهل يعلم من لا إله إلا الله ما لا يعلمه كثير من المسلمين دلَّ على عِظم جهل هؤلاء، وأنهم في ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية.
[المتن]
الخامسة: جِدُّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومبالغته في إسلام عمه.
[الشرح]
اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهـٰذا واضح في تكرار الدعوة، بشفقة، ورفق، ولين، ورحمة، وبيان أنها تنفعه: (كلمة أُحاج لك بها عند الله). وفي رواية: ((أشهد لك بها عند الله)). كل هـٰذا يبين عظيم جِدِّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وشفقته وحرصه على هداية عمه، مع أنَّ عمه مودع، يعني: لا يستفيد منه شيئًا يعود عليه بالنصر أو بالتمكين أو بالقوة أو بالعز، ومع ذلك حرص -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على هدايته.
ونظير هـٰذا ما كان منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المدينة لما عاد الصبيَّ اليهودي، فإنَّه عرض عليه الإسلام، فلما أجابه الصبي بعد مراجعة أبيه، قال له أبوه: ((أجب أبا القاسم)). فشهد أن لا إلـٰه إلا الله، خرج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تبرق أساريره فرحًا بإسلامه، مع أنه ماذا سيستفيد؟ ماذا سيستفيد بالمعنى المادي؟ ما الذي سيعود عليه بإسلام هـٰذا الذي قد ودَّع وانصرف؟ إنما هي الشفقة والرّحمة والحرص على هداية الخلق، ومن كان متأسيًا بالنبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا وُفِّق إلى القبول يا إخوان، فإنَّ من أسباب قبول الدعوة أن يكون الإنسان شفيقاً في دعوته، أن يُظهر الحرص واللَّهف على إنقاذ هـٰذا من الهلكة والنار.
[المتن]
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
[الشرح]
وهـٰذا واضح في الحديث.
[المتن]
السابعة: كونه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استغفر له فلم يُغفر له، بل نُهي عن ذلك.
[الشرح]
وهـٰذا فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يملك من الأمر شيئًا، كما قال الله جل وعلا: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾( ) فالأمر لله جل وعلا، الأمر الكوني القدري، والأمر الشرعي الديني لله جلَّ وعلا، فرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مبلِّغ لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرّاً ولا نفعًا، فلم يملك جلب النفع لأعظم الناس شفقة عليه، وهو عمه.
[المتن]
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
[الشرح]
وهـٰذا واضح جدّاً، حيث كان هـٰذان الرجلان سببًا في الضلال، وهـٰذا مما يُستفاد منه-كما قال الفقهاء-: أنه ينبغي أن يحضره -أي المحتضر- أهل الصلاح وأن يبعد عنه أهل السوء، فقد يُختم له بسوء بسبب من عنده.
[المتن]
التاسعة: مضرَّة تعظيم الأسلاف والأكابر.
[الشرح]
وهـٰذا واضح وسيقرره المؤلف -رحمه الله- تقريراً واضحًا في الباب القادم، ووجه هـٰذا: أنهما لم يحتاجا في رده وثنيه عن قول: لا إله إلا الله إلا أن ذكروه بملة عبد المطلب، قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان ذلك سببًا لامتناعه عن قول هـٰذه الكلمة.
[المتن]
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لاستدلال أبي جهل بذلك.
الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته.
الثانية عشرة: التأمل في كبر هـٰذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهما لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتكريره، فلأجل عظمها ووضوحها عندهم، اقتصورا عليها.
[الشرح]
فهـٰذه المسألة هي المسألة الأخيرة، وفيها أشار المؤلف -رحمه الله- إلى كِبَر هـٰذه الشبهة، وهي البقاءُ والاستمرار على ما كان عليه الآباء والأسلاف، حيث إن عبد الله بن أبي أمية وأبا جهل لم يذكرا لأبي طالب غيرَ هـٰذه الشبهة، فلما عرَض عليه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الإسلام ما كان منهما إلا أن قالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فانتهى عن إجابة النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى قول تلك الكلمة التي لو قالها لنجا ولسعد في الدارين.
كِبَر هـٰذه الشبهة في قلوب الضالين؛ (لأن في القصة أنهما لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها)، وهـٰذه المسألة توطئة للباب الذي سنقرؤه الآن إن شاء الله تعالى.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهِم دينَهم هو الغلو في الصالحين
وقول الله عز وجل: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾( ).
في (الصحيح) عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- في قول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾( ). قال: "هـٰذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسِي العلم عبدت".
وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلَهم، ثم طال عليهم الأمدُ فعبدوهم.
وعن عمرَ بنِ الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله)). أخرجاه.
وقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)).
ولمسلم عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((هلك المتنطعون)) قالها ثلاثاً.
[الشرح]
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وذلك أن المؤلف -رحمه الله- ذكر في هـٰذا الباب السبب الذي جعل الناس يخالفون التّوحيد، ويخرجون عن دائرة التّوحيد إلى الشرك، فقال رحمه الله: (باب ما جاء أنّ سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوّ في الصالحين.)
فأعظم ما يخرج به الناس عن التوحيد، ويقعون بسببه في الشِّرك هو الغلو في الصالحين، ولذلك بيَّنه المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فهي أيضًا واضحة، وذلك أنه في الباب السابق أشار -رحمه الله- إلى شبهة المشركين في شركهم، وهي تعظيمهم لكبرائهم ورؤسائهم ومقدَّميهم، وغلّوهم في هؤلاء، فذكر في هـٰذا الغلو، لكنه ذكر الغلو الذي هو أصل الشّرك، وهو الغلو في الصالحين، فلما كان في الباب المتقدِّم ذكرُ نوع من الغلو منع من الانقياد للحق، ذكر هنا الغلو الذي كان سبب الكفر وكان سبب خروج كثير من الناس عن جادة التوحيد، هـٰذا وجه.
الوجه الآخر الذي يمكن أن يكون مناسبة بين البابين: أنه في الباب السابق ذكر ملة عبد المطّلب، وذلك في قول النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعمِّه: ( ((يا عم قل: لا إلـٰه إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله)). فقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟) أي: عبد الله وأبو جهل قالا- لأبي طالب-: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فبيَّن في هـٰذا الباب أصل هـٰذه الملة التي جعلوها بإزاء قول: لا إلـٰه إلا الله، في مقابلة لا إلـٰه إلا الله، أصل هـٰذه الملة هو الغلو في الصالحين، فملة عبد المطلب هي بقايا ما كان عليه أهل الشرك الذين أشركوا بالله -عز وجل- بسبب غلوهم في الصالحين، فكان من المناسب أن يُبيِّن في هـٰذا الباب أصل تلك الملة التي جُعلت في مقابل ملة الإسلام.
التّرجمة احتوت عدة معانٍ:
المعنى الأول: بيانُ سبب الكفر وترك الدِّين، وأنَّ هـٰذا لا يخصّ فئةً من الناس، بل هو في جميع بني آدم، ولذلك قال: أنَّ سبب كفر بني آدم في القديم والحديث، في الماضي والحاضر، وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
أفادت الترجمة أيضًا: أنَّ أصلَ محبة الصالحين عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأنَّ المنهي عنه هو الغلو، وأما أصل المحبة فإنها عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والذي يُنهى عنه هو الغلو وهو الزيادة.
وقوله: (في الصالحين) هـٰذا يشمل كلَّ من صدق عليه وصف الصلاح من ملَك، أو رسول، أو ولي من الجن والإنس، من ذكر أو أنثى، فكل هؤلاء يدخلون في قوله -رحمه الله-: (في الصالحين).
وفي هـٰذا أيضًا فائدة في هـٰذه الترجمة : وهي أنَّ الأصل في الناس التوحيد، وأنَّ الشرك طارئ، وهـٰذا مصداق قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- فيما يرويه عن ربه -عز وجل- في الحديث الإلهي: ((خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين)). حنفاء أي: مستقيمين على التوحيد مائلين عن الشرك، فالأصل هو إفراد الله بالعبادة، والذي طرأ هو الشرك، هـٰذا كله مما يستفاد من ترجمة المؤلف رحمه الله.
ثم قال -رحمه الله- : (وقول الله عز وجل: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾( ).)
هـٰذه الآية الخطاب فيها لأهل الكتاب، وأهل الكتاب في الأصل هم اليهود والنصارى، وسموا بذلك لأنهم من الأمم الباقية إلى عهد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإلى وقت بعثته ومعها كتاب ترجع إليه وتصدر عنه، وإن كان قد طرأ على الكتاب تحريف وتغيير وتبديل، لكن أصل الرّسالة باقٍ.
والمراد بأهل الكتاب في هـٰذه الآية هم النصارى خاصة، فخرج بذلك اليهود فإنّهم لا يدخلون في هـٰذه الآية؛ لأنَّ اليهود أهل جفاء، خلافًا للنصارى الذين هم أهل غلو، هـٰذا مرجح.
المرجّح الثاني الذي يدلُّ على أن المراد بأهل الكتاب النصارى هو السياق، فإنَّ السياق في الحديث عن غلو النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام وفي أمه، ثم جاء بعد ذكر هـٰذا الغلو قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾( ). ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ المراد بأهل الكتاب النّصارى، وقال آخرون: إن المراد اليهود والنصارى؛ لأن اليهود حصل عندهم غلو أيضًا، لكنه ليس غالبًا ولكنَّه في بعض طوائفهم، وهم الذين قالوا: عزيرٌ ابن الله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾( ). لكن الظاهر أن المعنى الأول هو المتبادر، وأنَّ الخطاب للنصارى؛ لأن الآية في خاتمتها تدل على ذلك، حيث قال الله جل وعلا: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾( ). كلُّ هـٰذا في إثبات ضلال هؤلاء، والضلال وصفٌ للنصارى، والضلال هو عدم الهدى، وأما اليهود فوصفهم الغضب واللعنة؛ لأنهم أهل غيّ، وهم الذين لم يعملوا بالعلم ولم يعملوا بالهدى، فالآية تدلّ بسياقها وسباقها على أن المراد بالنداء في قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ النّصارى.
ثم قال تعالى بعد النداء: ﴿لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وهـٰذا نهي عن الغلو، والغلو في الأصل هو مجاوزة الحد، وهو الزيادة على المشروع.
وقوله: ﴿فِي دِينِكُمْ﴾ يشمل كلَّ ما يُدان به من قول أو اعتقاد أو عمل، فنهى الله -جلَّ وعلا- أهلَ الكتاب عن الغلو في الدين وهو الزيادة، ومن الغلو في الدين الزيادة فيما شرع الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
واعلم أنَّ الغلوَّ الذي نهت عنه الشريعة نوعان:
نوع يعود على العبادة بالإبطال.
ونوع يعود على صاحبه بالانقطاع والاستحسار.
أمّا النّوع الأول الذي يعود على العبادة بالإبطال: فكزيادة ركعة في الصلاة، أو زيادة شوط في الطواف، أو زيادة شوط في السعي، قصدًا وتعمدًا، فهـٰذا يعود على العبادة بالإبطال؛ لأنه خروج عن الشريعة، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أحدث في أمرنا هـٰذا ما ليس منه فهو رد)).
القسم الثاني من أقسام الغلو ما يعود على صاحبه بالانقطاع والاستحسار، وهـٰذا لا يعود على العبادة بالإبطال، لكنّه يؤول بصاحبه إلى الانقطاع، وهو الزّيادة في العبادة على وجه غير مشروع، كقيام اللّيل كله، وصيام الدهر عدا ما نهي عنه من الأيام، فهـٰذا يعود على صاحبه بأي شيء؟ بالانقطاع والاستحسار، فيستحسر وينقطع عن العبادة، وهـٰذا الذي قال فيه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اكلَفوا من الأعمال ما تطيقون)). وقال فيه: ((إن الله لا يمل حتى تملوا)).
والنهي عن هـٰذا وذاك، وإنما فرقنا بينهما باعتبار أثر الزيادة على العبادة، سواء كانت زيادة مبطلة أو لا.
﴿لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾، ﴿غَيْرَ﴾ هنا صفة لمصدر محذوف تقديره: غلوّاً غير الحق، وهـٰذه آية المائدة، وهي في النساء وفي المائدة، في النساء: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ﴾( ). هـٰذه التي في النساء، أما التي في المائدة فهي: ﴿لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا﴾ التي قرأناها قبل قليل، المراد آية المائدة، وآية النساء قريبة لكنها تكلمت عن صورة من صور الغلو وهي غلوهم في المسيح بن مريم عليه السلام.
﴿لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾. قلنا ﴿غَيْرَ﴾ ما إعرابها؟ صفة لمصدر محذوف: (غلوّاً غير الحق). وهـٰذا يصدق على كل زيادة لم يرد بها الشرع، فإنها من غير الحق، فنهى الله عز وجل عن الغلو كله، والآيات التي تحذر وتنهى عن الغلو بمنطوقها ومفهومها كثيرة، وكذلك في السنة النبوية.
ومناسبة هـٰذه الآية للباب واضحة؛ لأن من جملة ما نهي عنه هؤلاء خصوصًا –وهم النصارى- غلوهم في صالحيهم، فإنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح عيسى بن مريم، فنهاهم الله -عز وجل- عن الغلو في هؤلاء باتباعهم وسماع ما عندهم وأخذ أقوالهم المعارضة لما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
يقول: (في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾.)
هـٰذه الآية في سورة نوح، وهي خبرٌ عن قوم نوح مما قصَّه الله -عز وجل- في كتابه عن هؤلاء الذين وقعوا في الشرك، قالوا من جملة ما قالوه في مقابل دعوة نوح عليه السلام:
﴿لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾. أي: لا تتركوا ولا تدعوا آلهتكم لقول من؟ لقول نوح.
والآلهة: جمع إلـٰه، وهو ما عُبد، ولكن في هـٰذا السياق: ما عُبد من دون الله عز وجل.
﴿وَلاَ تَذَرُنَّ﴾. وهـٰذا تأكيد للنهي السابق، أو تخصيصٌ بعد تعميم، فإما أن يكون تأكيداً، فيكون قولهم: ﴿لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ ثم أكدوا هـٰذا المعنى بالنهي ثانية فقالوا: ﴿وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ فيكون تأكيداً للنهي الأول السابق.
وإما أن يكون من باب عطف الخاص على العام، فيكون لهم آلهة كثيرة، وخَصُّوا هـٰذه الآلهة بالذكر لكونها أعظم ما يعبدون، والمعنيان محتملان.
هـٰذه الآية فيها قول هؤلاء في آلهتهم وإصرارهم على عبادتها: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر.
قال ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- -وهو منقول عن غيره أيضًا من السلف-: (وهـٰذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح).
وقوله: (من قوم نوح) لا يلزم أن يكونوا قد وجدوا في عهد نوح، بل الأمر سابق على نوح، ولذلك في بعض الروايات: هـٰذه أسماء رجال صالحين من بني آدم، وقع الشرك في قوم نوح بسببهم.
(فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا). أي: علامات، والأنصاب هنا مجملة، تشمل تصاويرهم وتشمل ما يحصل تذكرهم به ولو لم يكن على صورهم، كالأنصاب التي تكون على القبور وشبهها.
(وسموها بأسمائهم). أي: سموا هـٰذه الأنصاب بأسماء هؤلاء المعبودين المعظمين. (ففعلوا). فعلوا أي شيء؟ فعلوا ما أوحاه الشيطان إليهم، والسبب في هـٰذا أنه جاءهم بشبهة، وهي تذكيرهم نشاط هؤلاء وما كانوا عليه من الطاعة والعبادة، وأنَّ هـٰذه الأنصاب ستحيي في قلوبهم الطاعة والعبادة، وسيقبلون بنشاط على ما كان عليه هؤلاء من الصلاح والتُّقى. (ففعلوا ولم تُعبد). أي: فعلوا ما أوحاه الشيطان، ولم يحصل شرك بعبادة هـٰذه الأصنام وهـٰذه الأنصاب من دون الله.
(حتى إذا هلك أولئك). المشار إليه من؟ الذين استجابوا للشيطان بوضع الأنصاب. (ونُسي العلم). أي: ودرس العلم ولم يبق أهل العلم الذين يمنعون الناس من الوقوع في الشرك.
(عُبدت) أي: عُبدت من دون الله؛ وذلك أن الشيطان جاءهم وقال لهم: إن سلفكم كانوا يدعون هؤلاء ويعبدونهم ويستمطرون بهم ويستسقون، فعبدوهم من دون الله فوقع الشرك، وبهـٰذا يتبين جليّاً واضحًا أن سببَ الشرك كان منشؤه من الغلو في الصالحين، فنشأة الشرك إنما كانت ناتجة عن الغلو في الصالحين، وهـٰذا الذي جعل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحذر من الغلو تحذيرًا فعليّاً وفي مناسبات كثيرة؛ لأن الغلو في الصالحين يفضي بالغالين تدريجًا إلى عبادة هؤلاء الذين وقع فيهم الغلو من دون الله، وقد صارت هـٰذه الأصنام إلى العرب. هل صارت بأعيانها؟
بعض الناس يقول: صارت بأعيانها إلى العرب، فتفرقت في جزيرة العرب، شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، فاتخذ كلُّ قوم صنمًا من هـٰذه الأصنام يُعبد من دون الله.
وقال آخرون: إنه يبعد أن تكون أعيان تلك الأصنام حَيِيَت؛ لأن الطوفان درَس كل ما كان موجودًا من الشرك وأهله، وإنما الذي حيي وعاد في العرب هو أسماء أولئك؛ وذلك أنَّ الذين نجوا مع نوح في السفينة كانوا يذكّرون أقوامهم وذرياتهم بنعمة الله عليهم، ويحذرونهم من الشرك، ويذكرون أن أقوامهم كانوا يعبدون كذا وكذا وكذا، فبقيت هـٰذه الأسماء حتى آلت إلى العرب.
(وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا) أي هؤلاء الصالحون (عكفوا على قبورهم). من الذي عكف؟ هؤلاء القوم الذين عظموا هؤلاء الصالحين، ومعنى العكوف: الملازمة، أي: لازموا قبورهم، وليس المراد من العكوف الاعتكاف الذي هو لازم لنوع العبادة، وإنما المقصود أنهم لازموا قبورهم، والملازمة إما أن تكون بكثرة المجيء إليها أو بالإقامة عندها.
(عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم). عكفوا عليها يتذكرون عبادتهم وما كانوا عليه من الخير، ثم سوَّل لهم الشيطان أن يصوروا تماثيلهم، أي: تماثيلَ تُشبه أولئكَ الصالحين.
(ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) أي: عبدوهم من دون الله عز وجل. وبهـٰذا نعلم أنَّ الفتنةَ وقعت أولاً بالغلو، وثانيًا بالقبور، وثالثًا بالتصاوير. والمراقبُ لأفعال أهل الشرك قديمًا وحديثًا يجد أنهم يعظمون صالحيهم ومن يعتقدون فيهم الصلاح، ويعظِّمون المشاهد والقبور، ويعظمون التصاوير، وهـٰذه هي أصول الشرك ومنابع الشر، ولذلك جاء التحذير من هـٰذا كله: فجاء النّهي عن الغلو، وجاء النهي عن التصوير، وجاء النهي عن الصلاة في القبور والعبادة عندها، كما سيأتي.
فبدأ المؤلف -رحمه الله- بأصلِ هـٰذه الأسباب الشركية وأولها وهو الغلو في الصالحين، فبيَّن نهي الله عز وجل، ونهي رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الغلو في الصالحين.
قال المؤلف رحمه الله: (وعن عمر بنِ الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله)). أخرجاه.)
هـٰذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أن سبب تكلم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك ما جرى من معاذ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لما قدِم من الشام، فإنه سجد للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فلما قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ما هـٰذا؟ قال: رأيتهم يفعلون ذلك بأحبارهم ورهبانهم وعظمائهم، ففعلته. فنهاه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك، وقال: لو كنت آمرًا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعِظم حقه عليها)).
هكذا ذكر -رحمه الله- في سبب قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا تطروني كما أطرت النصارى)). والحقيقة أن هـٰذا يحتاج إلى دليل، أي: إلى ما يثبت تلك الرواية أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما قال هـٰذا القول عند ذلك الفعل، وعلى كل حال النهي في هـٰذا الحديث ليس مقصورًا على تلك الصورة، بل هو شامل لكل إطراء قولي أو فعلي.
فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا تطروني)). المنهي عنه هنا هو الإطراء، والإطراء في الأصل هو المجاوزة في مدح الشيء، فإذا تجاوز الإنسانُ في مدح شيء حدَّه الذي هو عليه فقد وقع في الإطراء.
وعلى تفسير وقول ابن حجر -رحمه الله- في سبب الحديث يدخل في ذلك أيضًا الإطراء الفعلي، فيكون النهيُ عن الإطراء القولي بمجاوزة الحد في المدح والثناء والتعظيم والتمجيد، وعن الإطراء الفعلي بصرف ما لا يجوز صرفه للمخلوق من التعظيم كالسجود والانحناء وغيره، فإنَّ ذلك مما يُنهى عنه؛ لأن الله عز وجل أمر بالسجود وبالركوع له، وكل ما أمر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به من العبادات فإنَّه لا يجوز صرفُها لغيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
إلا إذا دلَّ الدليل على أنَّ للمخلوق أن يتوجه إلى المخلوق، يعني: إلى غير الله بذلك، كالشكر مثلاً، فإنَّ الشكر عبادة، أمر الله بشكر الوالدين، وشكر الوالدين عبادة لله وليس عبادة للوالدين.
المهم أن كلَّ ما أمر الله به ورسوله فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، هـٰذا الأصل فلا يُنقل عنه، وأما أن ينطلق الإنسان مع مشاعره وعواطفه في أنواع التعظيم القولي والفعلي لمن أمر الله بتعظيمه فلا يجوز هـٰذا؛ لأن المشاعر والعواطف إذا لم تُحكم بالشريعة فإنها تُوقع الإنسان في المهالك، ولذلك يجب على كل من أثنى على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قول أو أثنى على من أمر الله بالثناء عليه وبتعظيمه أن يُراعي في ذلك حق الله جل وعلا، وأن لا يتجاوز الحدَّ؛ لأن الأمر خطير.
ولذلك قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا تطروني)). أي لا تتجاوزوا في مدحي والقول فيّ بشيء لم أكن عليه -يعني: لا يطابق الواقع- أو بشيء يوقعكم فيما حرَّم الله عليكم من التعظيم.
ولذلك سيأتينا في الأبواب القادمة -إن شاء الله- القوم الذين جاؤوا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: أنت أفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((قولوا بقولكم -أو ببعض قولكم في رواية- ولا يستجرينكم الشيطان)). أي: لا يستركضكم ويستجرَّكم في الوقوع فيما حرَّمَ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من التعظيم الذي لا يجوز إلا له .
فقوله: ((كما أطرت النصارى ابن مريم)). أي: كما غَلَت وتجاوزت في مدحه حتى بلغت به أن قالت: هو الله، أو: هو ابن الله، أو ما قالوه من التعظيم الذي لا يجوز إلا لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
وهـٰذا ليس للحصر إنما هو للتمثيل، فإنَّ من غلاة الصوفية المنحرفين عن طريق السنة والجماعة من يُجيز في رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كلَّ قول إلا أن يقال: إنه هو الله، ولذلك يقول:
دع ما ادعته النصارى في نبيهم
....................................
من أنه الله أو أنه ابن الله أو ما أشبه ذلك من الأقوال الكفرية،
....................................... واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم
ثم قل بعد ذلك ما شئت فيه ولا يحدك حد، ومن هـٰذا وقعوا في الشرك المبين والظلم الكبير؛ لأنَّ كل من غلا في شيء من المخلوقات فإنه قد تعدى على حق الخالق.
ولذلك من ظنَّ أنه يوفي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حقَّه بالمدح والثناء بالمجاوزة عن الحدِّ الشرعي، فإنه في الحقيقة ظلم نفسه، وبخس رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حقه، وظلم نفسه أيضًا بالوقوع فيما نهى الله عنه من القصور بالإلهية عمّا هي عليه.
فكل من وصَفَ المخلوق بما هو وصْفٌ للخالق، أو بما هو حقٌّ لله عز وجل، فإنَّه قد وقع في نقص حق الله جل وعلا، وفي تنقص الربوبية، فينبغي للمؤمن أن يحذر، وأن يكون في هـٰذا الباب وَفق السنة.
وأصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعظم الأمة تعظيمًا لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأشدهم محبةً له، فلا يأتي بعدهم من هم أشدُّ حبّاً لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منهم، ومع ذلك لم يُنقل عنهم تلك العبارات التي يقشعرّ منها البدن عندما يسمعها في تعظيم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهي عباراتٌ تدخل في حيز الغلو أو الشرك.
فينبغي للمؤمن أن يحذر، لا سيَّما أن كثيرًا من الناس في افتتاح الكلام يغلو ويتجاوز في وصف رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكلام لم يُنقل عن السلف، ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا نهى عن الإطراء بيَّن أعلى ما يوصف به وأشرف ما بلغه من المنازل فقال: ((إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله)). إنَّما أنا عبد فلا يجوز لي شيٌء مما يستحقه الله عز وجل، لا في القول ولا في الفعل.
ثم بعد أن بين منزلته التي هو عليها وأنه لا يرضى أن يُتجاوز به عن هـٰذا الحد، قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في بيان أعظم ما يُثنى به عليه ويُمدح به-: ((فقولوا: عبد الله ورسوله)). وهـٰذان الوصفان هما أشرف ما وُصف به الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مع أنَّ كثيرًا من الناس يرى أنهما لا يفيان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حقَّه من التعظيم، وهـٰذا من جهلهم وضعف عقولهم، فإنَّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وصف رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهذين الوصفين في أشرف مقاماته، وأعظم أحواله: ففي الإسراء قال الله جل وعلا: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾( ) مع أنَّ المعراج هو أفضل مقامات النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومع ذلك لم يجز هـٰذا الوصف. وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في مقام الوحي: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾( ). ولم يتجاوز هـٰذا الوصف، فينبغي للمؤمن أن لا يتجاوز ما وصف الله به رسولَه وما رضيَه رسولُه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لنفسِه.
ثالث المقامات الحميدة التي قامها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يتجاوز فيها اللهُ -عز وجل- وصفَه عمّا ذكر في هـٰذا الحديث قول الله عز وجل: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً﴾( ) قال: عبدالله، وهو أشرف مقاماته، وهو الرسالة والتبليغ لدين الله عز وجل.
هـٰذه الآيات الثلاث فيها أعظم مقامات النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولم يتجاوز وصفُ اللِه لرسوله عمّا جاء في هـٰذا الحديث من أنه عبد وأنه رسول.
قال: ((فقولوا: عبد الله ورسوله)) العبودية التي يُوصفُ بها رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هي العبودية الخاصة، بل هي خاصة الخاصة، هي العبودية التي لم يبلغها أحدٌ من الخلق، وليست العبودية العامة التي تشمل كلَّ شيء، بل هي عبودية خاصة اختيارية فضَّله اللهُ بها وخصَّه بها دون غيره. ((ورسوله)). أيضًا هـٰذا الوصف مما اختُص به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكثر من غيره، فالرسل الذين شاركوه هو أعظم منهم في هـٰذا الوصف -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فينبغي في الثناء على الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفي مدحه وفي ذكره أن لا يقصُر الإنسان عن هذين الوصفين، وأن لا يتجاوز هذين الوصفين، وأن يجعلهما في مُقَدَّم وصف الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
الآن إذا تكلَّم عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: قال البشير النذير، قال سيد البشر، قال خاتم الأنبياء، وما أشبه ذلك من الأوصاف التي تصدُق على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولكنَّه يترك هذين الوصفين اللَّذين رضيهما رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لنفسه، وهما أعظم ما وُصف به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ولذلك في الشهادة وهي أعظم ما يكون من حقوق النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، الشهادة له بالرسالة، ماذا نقول؟ أشهد أن لا إلـٰه إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله. فينبغي للمؤمن أن لا يُفرِّط في هذين الوصفين، وأن لا يَقصُر عنهما.
يقول: (أخرجاه) هكذا في النسخة، وبعض المحشين يقول: إنه ليس في صحيح مسلم، إنه فقط في صحيح البخاري، يتحقق منه هل هو في مسلم أو لا، وراجعوا النسخ لعلها في نسخ غير التي بين أيدينا؛ لأنه يبعد أن شيخ الإسلام -رحمه الله- في موضعين أو في ثلاثة يذكر أنه في الصحيحين وليس فيهما، فلعله في بعض النسخ وما أشبه ذلك.
يقول: (وقال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)، من الذي قال ؟ (وقال: قال)؟ هكذا عندكم (وقال: قال)؟ الحديث هـٰذا عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في مسند الإمام أحمد وغيره، ولا أدري هل هو مروي أيضًا عن ابن عمر؟ لم أقف على هـٰذا، على كل حال الحديث مشهور من رواية ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في مسند الإمام أحمد وغيره، وفيه: (قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)).)
ومناسبة هـٰذا القول: أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجة الوداع أمر أن يُلتقط له حصى، فلما التقطوا له حصى رفعها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الناس وقال: ((بمثل هـٰذا فارموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)).
وهـٰذا فيه التحذير من الغلو العملي، وذكرنا أنَّ الغلوَّ في العبادات ينقسم إلى قسمين:
غلو يُبطل العبادة، وهو الزيادة على المشروع، كأن يصلي ركعةً زائدة، أو يرمي رميًا زائدًا في الرّمي، وكذلك أن يخرج في العبادة عن الوصف المشروع، كأن يرمي مثلاً بحجر كبير، فإنه لا يجزئ الرمي، ولا يصح رميه، فهو كما لو لم يرم، فإذا زاد في العبادة زيادة غير مشروعة في وصفها أو في عددها فإن ذلك يُبطِل العبادة، هـٰذا القسم الأول من الغلو المبطل للعبادة.
القسم الثاني من الغلو: هو ما لا يبطل العبادة، ولكنَّه سببٌ للانقطاع والاستحسار، ومثَّلنا له بسرد الصيام في غير ما نهي عنه، كأن يصوم الدهر إلا ما نُهي عنه من أيام العيد، وقيام الليل كله، وما أشبه ذلك من العبادات التي يؤول حال الإنسان فيها إلى الانحسار والانقطاع عن العبادة، وكلا هذين مما نَهى عنه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ((وإياكم والغلو)).
كذلك يدخل النهي عن الغلو فيما يتعلَّق بالعقائد، فإنَّ الغلو في العقائد أيضًا من أسباب الشر والفساد، وقول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)). من كان قبلنا هلكوا بالغلو في العمل؛ وذلك بمجاوزة الحد المشروع، وأيضًا هلكوا بالغلو فيما أُمروا به من محبة الصالحين، فعظموهم وخرجوا بهم عن مرتبة العبودية إلى أن جعلوهم أربابًا وأندادًا من دون الله، كما قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾( ). فكلُّ هـٰذا مما نهى عنه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ((فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)). وفي قوله: ((إياكم والغلو)).
والغلو أصله الزيادة ومجاوزة الحد المشروع، فكل من زاد أو تجاوز الحد المشروع فإنه قد وقع في الغلو المنهي عنه.
قال: (ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((هلك المتنطعون)). قالها ثلاثاً.)
أي: كرر هـٰذا القول، وينبغي للواعظ والمُذكِّر أن لا يقول: قالها ثلاثًا ويقتصر، بل يكرر القول، وإنما قال العلماء: قالها ثلاثًا اختصارًا في التأليف والكتابة، وأما في التبليغ فمن تمام التبليغ أن يقولَ الإنسانُ القول كما نُقل عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ففي مثل هـٰذا يقول: ((هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون))؛ لفائدتين:
أولاً: لأنه أوفق للسنة.
ثانيًا: أنه موافق لتبليغ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وبيان شدة الأمر وشدة التحذير والتنفير من هـٰذا الفعل، فإنك إذا قلت: هلك المتنطعون ثم سَكَتَّ، فإن هـٰذا ليس كقولك: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أيهما أوقع في نفس السامع، الأول أو الثاني؟ الثاني؛ لأن تكرار الكلام تأكيد له، وإعادة للفظ والمعنى ليستقر في نفس السامع.
وقول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((هلك المتنطعون)) اختلف العلماء هل هو دعاء أم خبر؟ فمنهم من قال: إنَّه دعاء، يدعو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المتنطّعين. ومنهم من قال: إنَّه خَبَر. ولا إشكال، فإنَّه خبرٌ ودعاء، يعني: الخبر لا ينافي الدّعاء، فهو خبر ودعاء على هؤلاء؛ لكونهم تجاوزوا ما أُمروا به، ورغِبُوا عن سنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
والمتنطعون جمع متنطِّع، وهو من خرج عن المشروع بتشديد وتعنُّت وزيادة، فكلُّ من خرج عن المشروع في القول أو في الاعتقاد أو في العمل، فإنَّه داخل في هـٰذا الحديث، والله -عزّ وجل- قد بيَّن لنا هديَ رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في كتابه، وهو السّهولة واليُسْر، فقال -جل وعلا- في وصف رسوله: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾( ). والتكلُّف هو التنطع والتشدد.
فرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس من المتنطعين المتكلفين المتعمقين المتشددين في شأن من شؤونه، لا في قوله، ولا في فعله، ولا في دعوته وتبليغه، بل هو -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الحنيفية السمحة، كما قال فيما صح عنه: ((بُعثت بالحنيفية السمحة)). ما معنى الحنيفية السمحة؟ ((بالحنيفية)) هي التوحيد، و((السمحة)) هي اليسر والسهولة في العمل. وهـٰذا الحديث اختصر لك معنى الرسالة التي بُعث بها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فهي استقامة في الاعتقاد، واستقامة في العمل.
((بُعثت بالحنيفية)): أي بالتوحيد، ((السمحة)): أي التي لا مشقة فيها ولا عناء ولا تكلُّف، بل هي موافقة لما تقتضيه الفِطَر، فهي سهلة يسيرة، وهـٰذا يتعلق بالاعتقاد أو بالعمل؟ بالعمل، فهـٰذا اختصار لما جاء به النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في عَقْدِه وعمله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، نسأل الله أن يُتَبِّعَنا آثاره.
وقد كَرِه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التشدد حتى في اللفظ، وهو وسيلة للتبليغ، فكيف إذا كان التشدد والتعمق في الاعتقاد وفي تكليف الناس ما لا يطيقون، وفي الزيادة على المشروع؟ كلُّ هـٰذا مما يدخل في النهي، ولذلك نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التفيهق والتشدق بالكلام، وجعله من أسباب البعد عنه، وجعله من أسباب بغضه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأصحاب هـٰذا الوصف، فينبغي للمؤمن أن يمشي على السهولة واليسر وعدم التشديد وعدم التكلف.
لكن ليس من التيسير أن يتتبع طالب العلم أو المفتي الساقط من الأقوال ويفتي به الناس، فإذا جاءه جاءٍ يسأله عن مسألة من مسائل العلم قال: هـٰذه قال بها العالم الفلاني ولا حرج عليك، وهو لا يعتقد هـٰذا، فإنَّه لا يجوز له أن يفتيه بناء على قولٍ سمعه لا يدري عن صحته، ولا يعتقد صوابه، ولا يختاره لنفسه؛ لأن الدين النصيحة، ومقتضى النصح لمن يستفتيك أن تدله على ما تبرأ به الذمة، وما يحقق له كمال العبودية، أما أن يُلتقط السّاقط من الأقوال كما هو منهج شائع الآن، منهج الميسِّرين في الفتوى والتعليم؛ فهـٰذا ليس بصحيح.
نحن لا ندعو إلى التشديد لكن ندعو إلى التزام السّماحة التي جاء بها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما -لكن هناك ضابط- ما لم يكن إثمًا، والإثم هو الخروج عن الشريعة والخروج عن أمر الله عز وجل، أو الوقوع فيما نهى عنه، فأنت إذا سرت على هـٰذا الطريق؛ فأنت على السماحة التي جاء بها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-، أما التقاط الساقط من الأقوال والبحث عن الرخص في أقوال أهل العلم وإفتاء المستفتين بذلك، أو تعليم المتعلمين ذلك بناءً على أن الدين يُسر؛ فهـٰذا ليس بصحيح، هـٰذا ليس من تيسير الدين بل هـٰذا من تمييعه، وإذهاب رهبته وما فيه من قوّة ينبغي للمؤمن أن يأخذ بها، وأن يأخذ الكتاب بقوة كما أمره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بذلك.
على كل حال هـٰذه المسألة خارجة، وإنما جرى التنبيه عليها بمناسبة قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((هلك المتنطعون)).
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: أن من فهم هـٰذا الباب وبابين بعده، تبيَّن له غربةُ الإسلام، ورأى من قدرةِ الله وتقليبه للقلوب العجب.
[الشرح]
الله المستعان، على كل حال نؤجل الكلام على هـٰذه المسألة بعد استكمال البابين حتى يتبين عِظم الغربة التي أشار إليها الشيخ -رحمه الله-، فالآن إذا اقتصرت على قولك: (رسول الله) أو: (اللهم صل على محمد) ولم تقل: (سيدنا) أو لم تقل: (حبيبنا) أو ما أشبه ذلك، عدَّ الناس ذلك بخسًا لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حقه، واتهموا من لا يقول ذلك بأنه يبغض رسول الله، وهـٰذا مما يبيِّن لنا غُربة الإسلام، وأنَّ كثيرًا من الناس من هؤلاء المنحرفين ليس عندهم من الإسلام إلا هـٰذه القشور التي يتعلقون بها ويظنون أنها الدين، وهي مخالفة لما جاء به الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
أعظم الناس تعظيمًا لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هم أصحابه، ومع ذلك يقول أنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((لم يكن أحدٌ أشد محبة لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أصحابه، وكانوا إذا رأوه لا يقومون له)) لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته ذلك، فلم يعظموه بالقيام، مع أننا الآن لو دخل علينا رجل كبير في منصبه أو في علمه أو في مكانته؛ رأينا من أنفسنا لزامًا أن نقوم له، وأننا إذا لم نقم فإننا نكون قد بخسناه حقه، ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين أظهرهم يُمَدّ بالوحي من السماء ويرون على يديه الآيات العظام، ومع ذلك كانوا امتثالاً لأمره ونزولاً عند رغبته ومحبته لا يقومون له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لِما يعلمون من كراهيته لذلك.
[المتن]
الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
[الشرح]
وهـٰذا واضح فيما جرى من تعظيم قوم نوح لمن عظموهم في قولهم: ﴿لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً﴾( )، وتقدَّم أنَّ هـٰذه أسماء رجالٍ صالحين.
وجه الاستدلال: كيف صار في هؤلاء الشرك حتى عبدوهم من دون الله.
[المتن]
الثالثة: أول شيء غُيِّر به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أنَّ الله أرسلهم؟
[الشرح]
أول شيء غُيِّر به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين.
[المتن]
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردّها.
[الشرح]
وهـٰذا من تزيين الشيطان، وإلا فالفطر تردّها وتنكرها وتأنف منها، ولذلك صاحب الفطرة السليمة يكره هـٰذه الأشياء، ويرفض هـٰذه الأفعال التي فيها تعظيم غير الله بما لا يليق إلا به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فيكرهها ويرى بطلانها بعقله وفطرته وما في قلبه، ولو لم يقم عليها برهان أو دليل من الكتاب والسنة، يعني: في علمه وفيما أدرك، لكنَّه يكرهها بفطرته؛ لأن الله فطر الناس على الحنيفية: ((خلقت عبادي حنفاء)) أي: على التوحيد، ثم حصل اجتيال الشياطين فزيَّنت لهم عبادة غير الله عز وجل، وزينت لهم البدع.
[المتن]
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل.
فالأول: محبة الصالحين.
والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً، فظنَّ من بعدهم أنهم أرادوا غيره.
[الشرح]
وهـٰذه مسألة مهمة، وهي ضرورية لطالب العلم أن يدركها في نظره في أقوال المبتدعين والمنحرفين: ما من صاحب بدعة إلا ويتمسّك في بدعته بشيء من الحق، وهـٰذا الذي جعل البدع تنطلي على أصحابها، لو كانت البدع شرّاً محضًا وباطلاً لا صواب فيه، لا حقّ فيه لما راجت عند أحد ولما قبلها أحد، لكن لما كان الباطل ممزوجًا بشيء من الحق انطلى هـٰذا على النّاس وخرجوا به عن الصراط المستقيم، وشيخ الإسلام –رحمه الله– يكرّر هـٰذه القاعدة كثيرًا في مناقشته لأهل البدع، ويبين أن ما معهم من الحق يردّ على ما زاغوا فيه وما خرجوا فيه عن الصّراط المستقيم، فلولا امتزاج الحق بالباطل لَما راجت البدع والأقوال الفاسدة.
فيما نحن فيه يقول الشيخ رحمه الله: (أن سبب ذلك) –أي: سبب الوقوع في الشرك والكفر- (كله مزج الحق بالباطل)، خلط – المزج: هو الخلط- (فالأول محبة الصالحين)، محبة الصالحين حق أو باطل؟ حق امتزج بشيء من الباطل وهو الزيادة على المشروع، فوقع ما نهى الله عنه من الكفر والشرك.
(والثاني) الذي حصل به الامتزاج (فعل أُناس من أهل العلم شيئًا أرادوا به خيرًا فظنَّ من بعدهم أنهم أرادوا به غيره)، فهؤلاء احتجوا بفعل من تقدَّم من الصالحين من أهل العلم فقالوا: لولا أن العلماء يقرون هـٰذا لما فعلوه، ولولا أن هـٰذا صواب ما أقره العلماء. وهـٰذه حجة وشبهة يستدل بها كلُّ صاحب باطل على باطله في الغالب، والحجة ليست في فعل أحد، إنما الحجة في قول الله ورسوله، أما فعل غير المعصومين من العلماء فمن دونَهم فلا حجة فيه، بل الحجة في من جعل الله الحجة في قوله، في قول الله –عز وجل– وفي قول رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفي قول من أخبر النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن قولَه حجة، كالصحابة والخلفاء الراشدين أصحاب السّنّة المتبعة، وكما لو أجمعت الأمة على شيء، فإنَّ هـٰذه حجج كلها ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[المتن]
السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح.
[الشرح]
قوله تعالى: ﴿وقالوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً﴾( ).
وقد تكلمنا على هـٰذا.
[المتن]
السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد.
[الشرح]
الله المستعان، من أين أخذ هـٰذه المسألة؟
مما ذكره في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: هـٰذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم. ففعلوا، ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ونسيان العلم نقص للحق في قلب الإنسان، وإذا نقص الحق اشتغل القلب بالباطل؛ لأن القلب لا بد له من شغل، ولا بد له أن يملأ إما بحق أو باطل، فإذا نقص الحق زاد الباطل ولا بد، كما قال ابن القيم رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد.
[المتن]
الثامنة: أن فيه شاهداً لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
[الشرح]
ما فيه إشكال، هـٰذا واضح، حيث إن هؤلاء وقعوا أولاً في البدعة بهـٰذه التصاوير وبالأنصاب التي جعلوها، ثم آل بهم الأمر إلى أن وقعوا في الكفر الصُّراح نعوذ بالله من ذلك.
[المتن]
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حَسُن قصد الفاعل.
[الشرح]
ولذلك يجب أن تحارب البدع ولو كانت البواعث الباعثة لها حسنة؛ لأنّ حسن القصد لا يشفع لصحّة الفعل، بل حُسن القصد قد يُخفف المؤاخذة أو يرفع المؤاخذة عن صاحبه، لكنَّه لا يسوِّغ قبول الخطأ.
ولذلك لما أُخبر ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كما في المسند- عن أقوام في المسجد يجتمعون في حلق، وعلى كل حلقة رجل يقول: سبحوا كذا، سبحوا كذا. أتى إليهم، وقال لهم: إما أن تكونوا على هدي خير من هدي محمد، وإما أن تكونوا مقتحمي باب ضلالة. وهم على خير: التسبيح عبادة، وفي مسجد وذكر، لكنَّهم على غير هدي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: أنتم بين أمرين: إما أن تكونوا على هدي –يعني: على طريقة وسنة- خير من هدي محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وهـٰذا لا يُمكن أن يقوله مؤمن، وإما أن تكونوا مقتحمي باب ضلالة، وهـٰذا هو الواقع، والضلالات لا تبدأ بانحرافات كبيرة، إنما تبدأ بشيء يسير ثم تؤول -نعوذ بالله– إلى ضلال كبير.
فينبغي للمؤمن أن يحذر البدع دقيقها وجليلها في نفسه وفي مجتمعه وفي من حوله، ويحذِّر من البدع وينهى عنها ويبيِّن خطرها، ويستعين الله –عز وجل– في ذلك، وإذا صحَّت النية وصدق العزم فإنّ الله –جلّ وعلا– يبارك في القول ويكتب له القبول.
[المتن]
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه.
[الشرح]
صحيح، وهـٰذا واضح في التّحذيرات التي مرت في حديث عمر وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود.
[المتن]
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
[الشرح]
وهـٰذا واضح، وسيأتي مزيد بيان له في الباب التالي، فإنه يُنهى عن لزوم القبور للأعمال الصّالحة، وسيأتينا فعل العمل الصالح عند القبر، وأقسام ذلك في الباب التالي إن شاء الله، ولكن المضرَّة واضحة في أن هؤلاء عكفوا على قبور هؤلاء الصّالحين ولازموا هـٰذه القبور؛ ليتذَّكروا عبادتهم، فآل الأمر بهم إلى أن عبدوهم من دون الله.
[المتن]
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها.
[الشرح]
صحيح، وسيأتي مزيد بيان لهـٰذا في الباب القادم إن شاء الله، حيث إن التماثيل آلت بالناس إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل.
[المتن]
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هـٰذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
[الشرح]
قصة؟ يشير إلى قصة عبادة قوم نوح للصالحين، كما قال الشيخ –رحمه الله– هـٰذه القصة عظيمة الشأن، وتحتاج من أهل التعليم أن يذكروها للناس في مجامعهم، وأن يذكِّروهم بها حتى يقصروا عن التعظيم، لا سيما في البلدان التي يرى الناس فيها أن الرّكوع وأن تقبيل يد العالم أنه مما يجب، وأن دونَ ذلك يكون قصورًا، هـٰذا أقل ما يكون من وسائل التعظيم عند هؤلاء، وإلا فعندهم من العظائم ما الله به عليم، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
الانحناء:
ما حكم الانحناء لغير الله؟ لا يجوز، الانحناء لغير الله لا يجوز، نهى الله عنه، أولاً أمر الله به عبادةً فلا يجوز لغيره: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾( ). ونهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنه لما سألوه: ((إن أحدنا يلقى أخاه أيقبله؟ قال: لا. قالوا: أينحني له؟ قال: لا)). فنهى عنه، فالانحناء لغير الله لا يجوز، وهو من وسائل الشرك وأسبابه.
وهو شائع في بعض المجتمعات، هـٰذا الانخفاض في السلام أو للمعظَّم أمر –يعني- معتاد، وبعض الناس يقول: أسكت مجاملة لهم، وهـٰذا هو الذي جرى في الذين صوّروا التصاوير، صوروها بحسن القصد ليتذكّروا عبادة هؤلاء، فآل الأمر إلى أن عُبدوا من دون الله. وينبغي في مسائل التّوحيد الحزم، وألا يتهاون الإنسان، وهـٰذا هو هدي النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، التوحيد لا سهولة فيه، ولا تغاضي فيه، بل ينبغي التنبيه، لكن بما يناسبُ الحال من الغِلظة أو الرفق؛ لأن الناس يختلفون في ما يناسب من غلظة أو رفق، المهم يسلك ما يحصل به المقصود.
[المتن]
الرابعة عشرة -وهي أعجب وأعجب-: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه، فهو الكفر المبيح للدم والمال.
[الشرح]
يشير الشيخ –رحمه الله– إلى من يرى أن عدم تعظيم الأولياء -بالعكوف على قبورهم، والتشييد عليها، ودعائهم من دون الله، أنَّ هـٰذا- قصور في حقهم ونزول بهم عن المنزلة التي يستحقونها.
[المتن]
الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
[الشرح]
نعم، إنهم لم يكونوا يعبدون هؤلاء عبادةً مستقلة، إنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى كما ذكر الله –جل وعلا– ، فالتصريح ليس في ما ساقه المؤلف، لكنَّه معلوم من قوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾( ).
[المتن]
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
[الشرح]
يعني: أرادوا عبادتهم من دون الله.
[المتن]
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)). فصلوات الله وسلامه على من بلَّغ البلاغ المبين.
[الشرح]
آمين! وجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيّاً عن أمته.
[المتن]
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
[الشرح]
يعني العلم، ولا شك أنه إذا وُجد العلم شاع الخير وانتشر، وإذا فُقِد العلم انتشر الشر، فبقدر ما في المجتمع من العلم وبقدر ما في الأمة من العلم بقدر ما تأمن من الشّرور، وأنت لاحظ كلّما كثر أهل العلم وطلابه في بلد من البلاد كثر خيره، وكلما قلَّ عددهم أو قلّ تأثيرهم شاع الشر وانتشر، ولذلك كان من علامات القيامة رَفْعُ العلم وظهور الجهل.
[المتن]
العشرون: أن سبب فقد العلم هو موت العلماء.
[الشرح]
الله المستعان.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثالث عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر
رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
في (الصحيح) عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة -رَضِيَ اللهُ عَنْها- ذكرت لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصّور، فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله)). فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل.
ولهما عنها قالت: لما نُزِل برسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طفِقَ يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذِّر ما صنعوا. ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خُشي أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل أن يموت بخمسٍ وهو يقول: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإنَّ الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً. ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنيِّ أنهاكم عن ذلك)).
فقد نهى عنه في آخر حياتِه، ثم إنه لعن -وهو في السياق- من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يُبْنَ مسجد، وهو معنى قولها: خُشِيَ أن يُتَّخَذَ مسجدًا، فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتُّخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه يُسمى مسجدًا، كما قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)).
ولأحمدَ بسند جيد عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعاً: ((إنَّ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد)). ورواه أبو حاتم في صحيحه.
[الشرح]
فمناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: فإنَّ من أعظم ما يخرج به الناس عن التوحيد العبادة عند القبور، فإنَّ العبادة عند القبور من أعظم أسباب الشرك، وهي أقرب إلى الشرك بأهل القبور، لا سِيَّما إذا كان المقبور صالحًا من عبادة الأصنام والأخشاب والأحجار التي يعبدها كثير من الناس.
فلما كانت عبادة الله –عز وجل– عندَ القبورِ من أسبابِ الشرك احتاج المؤلف –رحمه الله– إلى بيان ذلك، وذكر ما ورد عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الأمر.
أما مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: فهو ذكرٌ لصورة من صور الغلو في الصالحين، فإنَّه في الباب السابق ذكرَ أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وفي هـٰذا الباب ذكر صورة من صور الغلو في الصالحين، وهي عبادة الله –عز وجل– عند قبر رجلٍ صالح، فإنَّها من أعظمِ الوسائل والأسباب التي تُوقِعُ في الشرك، وهي من صور الغلو في هـٰذا الرجل الصالح.
اتضحت مناسبةُ الباب لكتاب التوحيد، ومناسبة الباب للباب الذي قبله.
قال رحمه الله: (باب ما جاء في التغليظ). التغليظ أي: التنفير الشديد (فيمن عبد الله عند قبر رجلٍ صالحٍ). عبد الله بأي نوع من أنواع العبادة: من صلاة، أو دعاء، أو قراءة أو غيرِ ذلكَ من العبادات، كالذَّبْحِ والطواف وما أشبه ذلك، مع أنّ الطواف لا يمكن أن يُمَثل به؛ لأنه لا يتعبد لله –عز وجل– بالطواف بغير الكعبة، فالطواف له محل خاص لا يكون في غيره عبادة وهو البيت، فإنَّه مما يختص بالبيت، لكن التمثيل بسائر العبادات سائغ.
يقول: (باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح). يشمل الأنبياء والأولياء والشهداء وسائر من اتصف بالصلاح، ولو كان الصلاح في ظن الشخص، يعني: لا يشترط أن يطابق الصلاح حالَ هـٰذا المقبور، ولذلك يُذكَر أنهم يعبدون قبورًا لا يُعرف أهلها بالصلاح ولا بالطاعة، بل يذكر أنهم يعبدون قبورًا ويعظمونها والمقبور فيها حيوان، كحمار أو كلب يظنونه صالحاً، وهـٰذا واقع.
ويُذكر أنهم أيضاً يعبدون ويعظمون بعض ما يعظمه النصارى من قبور القسيسين والأحبار، بل إنَّ من الذين وقعوا في هـٰذه البدعة وهي بدعة التعظيم من يعظمون أحبار اليهود والنصارى، لا سِيَّما النصارى، يعظمون أحبار النصارى وهم على كفرهم ويرجون منهم البركة، يعني: من الأحياء لا من الأموات، وهـٰذا ذكره شيخ الإسلام –رحمه الله–، وكذلك أظن ابن القيم ذكره في بعض كتبه، عمّن وقع في الشرك من أهل زمانهم.
يقول –رحمه الله– بعد الترجمة: (في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كنيسةً) أم سلمة هي زوج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وذكرت لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذه الكنيسة وهي محلُّ عبادة النصارى، رأتها بأرض الحبشة، ولم يبيِّن الحديث متى ذكرت ذلك.
ذكر ابن القيم –رحمه الله– أنَّ رواية البخاري فيها أنها ذكرت ذلك في مرض موته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فيكون هـٰذا الحديث ثاني ما ورد فيه التنفير والتحذير من عبادة القبور ومن تعظيم القبور في سياق الموت، كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وأم سلمة رأت ذلك لما كانت في أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
(وما فيها من الصّور). أي: وذكرت ما فيها من الصور التي تُعَلَّق وتعظم وتعبد من دون الله –عز وجل–، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لها: (( أولئك)) أي: الذين ذكرتِ ((إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا)). أي: بنَوا على قبره محلاًّ للعبادة.
ثم قال: ((وصوروا فيه تلك الصور)) يعني: التي رأيتها، فتلك الصور من صنيع هؤلاء.
ثم ذكر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -بعد أن وصف فعلهم- حُكمَ ذلك الفعل، فقال: ((أولئكِ شرار الخلق عند الله)) أي: من ذكرتِ ((شرار الخلق عند الله)) فهم أشدُّ الناسِ شرّاً، أو من أشد الناس شرّاً عند الله –عز وجل–؛ لكونهم أخرجوا الناس مما خُلِقُوا له وهو عبادة الله –عز وجل– إلى الشرك، فإنَّ الله –عز وجل– خلق عباده حنفاء، كما في الحديث الإلهي: ((خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين)). والشياطين هنا يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، اجتالتهم وحرفتهم عن الحنيفية.
وقوله: ((شرار الخلق عند الله)) ذِكر العِندية هنا لبيان سوء حالهم ومنقلبهم، وأنهم شرّ من يقدم على الله جل وعلا، وإلا فكان يكفي في وصفهم بالسوء الاقتصار على قوله: ((أولئك شرار الخلق)) كما في الحديث الذي ذكره المؤلف في آخر الباب: ((إنَّ من شرار الناس)) ولكن ذكر العندية هنا لبيان شِدَّة ما فعلوا وعظيم ما اقترفوا.
وقد تكلَّم العلماء -رحمهم الله- في ما يفيده هـٰذا القول من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، هل هو حكم بالكفر؟
فقال بعضهم: إن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((أولئك شرار الخلق عند الله)) يدل على أنَّ بناء القبور على المساجد من كبائر الذنوب؛ لأنه من أسباب الشرك.
وقالوا: ويَحتمل أن يكون المراد بقوله: ((أولئك شرار الخلق عند الله)) أنَّه كفر بالله عز وجل.
والظاهر أن هـٰذه الاحتمالات ترجع إلى اختلاف قصد الفاعل، فمنه ما يكون من كبائر الذنوب ومن أعظم الخطايا دون الشرك، ومنه ما يكون كفرًا وشركًا بالله عز وجل، والمقصود أن الحديث دل على تحريم هـٰذا الفعل.
واعلم أن الأمة اجتمعت، اجتمع علماؤها وأجمعوا على أنَّه لا يجوز بناء القبور على المساجد، وأنَّ بناء القبور على المساجد محرَّم، فهـٰذا مما أجمع عليه العلماء وأحاديثه مستفيضة؛ بل هي متواترة كما قال ابن حزم رحمه الله، الأحاديث في النهي عن البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد متواترة، ولذلك لم يُنقل عن أحد من العلماء تسويغ البناء على القبور، ومن نقِل عنه الكراهة قال ابن القيم رحمه الله: فمراده كراهة التحريم، وهـٰذا من باب إحسان الظن بالعلماء، وأنهم لا يمكن أن يخالفوا ما تواتر النص على تحريمه والتحذير منه وبيان سوء عاقبته.
فلا يمكن أن يقول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أمر: ((أولئك شرار الخلق عند الله)) ثم يكون هـٰذا الأمر غايته أنه مكروه، أي: دون المحرَّم، بل هو من كراهة التحريم، ومعلوم أنَّ السلفَ كانوا يطلقون الكراهة على المحرَّم.
قال –رحمه الله– معلِّقاً على هـٰذا الحديث: (فهؤلاء جمعوا بين فتنتين). (هؤلاء) المشار إليه من ذكرتهم أم سلمة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، والذين قال فيهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((أولئك شرار الخلق عند الله)). (جمعوا بين فتنتين) أي: شَرَّين يحصل بهما الانصراف عن الحق والوقوع في الباطل: فتنة القبور، وفتنة التماثيل، (فتنة القبور) وهي تعظيمها، (وفتنة التصاوير) وهي الفتنة بالمقبور؛ لأن التمثال صورة للمقبور.
فهم لا يعبدون الصور لكونها حجرًا والتماثيل لكونها أخشابًا مثلاً، إنما لكونها تذكرهم بالمقبورين، فهـٰذا الحديث حذَّر من هاتين الفتنتين: من الغلو في القبور، ومن الغلو في المقبورين، وذكر سبباً وصورة، صورة من صور الغلو في الصالحين وهي أن تجعل لهم التماثيل، وأما القبور فصورته البناء عليه، وسيأتي مزيد ذكر لصور الغلو في القبور.
المهم أن هؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل.
قال: (ولهما عنها)؛ (لهما) للشيخين (عنها) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (لما نُزل برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). نُزل به أي: حضرته الوفاة .
(طفق يطرح خميصة له على وجهه). (طفق) من أفعال الشروع، أي: شرع يجعل خميصة -وهي قطعة من القماش- على وجهه؛ لشدة ما يجد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من سكرات الموت.
(فإذا اغتم) أي: إذا بلغ الشدَّة والكرب كشفها .
(فقال) يعني: وهو في هـٰذه الحال وهي حال المنازعة وحال خروج الروح .
(قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو كذلك) يعني: على هـٰذه الحال وهـٰذه الصفة، ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). اللهم صل وسلم على رسول الله، ينصح للأمة وهو في هـٰذا الكرب الشديد، وقد نُزِل به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ينصح للأمة ويحذِّرها من سلوك سبيل من تقدَّم من الأمم، فيقول: ((لعنة الله على اليهود والنصارى)). واللعن هنا يَشمَلُ الجميع، يعني: هو لعن لهـٰذه الفئة بجميعها وكذلك النصارى.
وهـٰذا اللعن لفئة أو لوصف؟ لفئة متصفة بأوصاف جاء ذكرها في كتاب الله -عز وجل– وفي سنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، واليهود لم يستحقوا اللعن لكونهم يهودًا إنما لفعلهم، وإلا فالهَود هو التوبة، فاللعن ليس للاسم إنما لمن تسَمَّوا به فصار علمًا عليهم، وإن كانوا لا يتحققون بمعنى هـٰذا العلم، وكذلك النصارى فإنها من النصرة، كما قال عيسى بن مريم: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾( ). ولذلك سموا بالنصارى، ولكنَّهم ليسوا بنصارى، أصبح هـٰذا علماً عليهم وإن تخلف في حقهم الوصف.
((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ذكرَ اللَّعن وهو سؤال الطرد من رحمة الله –عز وجل– ونزول السوء والشَّر بمن لُعِنَ، ثم ذكر سببَ اللعن فقال: ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). وهـٰذا يفيد أنَّ كلَّ من فعل ذلك فإنَّه مستحق للعن، وهـٰذا يدل في أقل ما يدلُّ عليه أن هـٰذا الفعل من كبائر الذنوب، كما تقدَّم في الكلام على قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((أولئك شرار الخلق عند الله)).
((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وهـٰذا الحديث يفيدُ أنَّ اليهود والنصارى وقع فيهم الغلو، أما النصارى فلا إشكال أن الغلو قد وقع فيهم، وأنهم من أشد الأمم غلوّاً وتجاوزًا للحدود بما لم يُشرَع. وأما اليهود فقد وقع فيهم الغلو لكنه قليل.
وقد طعن بعض من في قلبه مرض في هـٰذا الحديث وقال: إنَّ هـٰذا الحديث لا يثبت؛ لقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، واليهود ليسوا أهل غلو. فالجواب: أنهم وقعوا في الغلو وإن كان ليس وصفًا ظاهرًا عندهم، اليهود وقعوا في الغلو ولكنَّه ليس من الأوصاف الظاهرة فيهم، وإلا فالغلو مسجل عليهم في كتاب الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾( ). وهـٰذا غلو ولا إشكال ولا يماري فيه أحد، حيث تجاوزوا بعُزَير منزلته فجعلوه ابنًا لله تعالى، ولكنَّه في النصارى أكثر كما تقدم.
يقول: ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ولم يقتصروا على ذلك، لكنَّه هـٰذا هو الغالب فيهم، بل هم اتخذوا قبور أنبيائِهم وصالحيهِم كما دلَّ عليه حديثُ أمِّ سلَمة: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور)) فهـٰذا ليس تخصيصًا، إنما هو ذكر لمنشأ وأصل ما وقعوا فيه من الغلو.
وقوله: ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))لم يبيِّن صفةَ الاتخاذ كيف اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد جاء في الحديث السّابق أنهم بنَوا عليها مساجد، فهـٰذا من صوَر اتّخاذ القبور مساجد: البناء عليها، إذًا:
من صور اتخاذ القبور مساجد أن يُبنى عليها بناء.
من صور اتخاذ القبور مساجد: أن يُصلّى عندها؛ لأنَّه إذا صُلي عندَها فقد اتُّخِذت مسجدًا كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله.
الصورة الثالثة من صور اتخاذ القبور مساجد هي: الصلاة إليها.
وكلُّ هـٰذه الصور داخلة في تحذير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن اتخاذ القبورِ مساجد.
قال: قالت عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها، في بيان وتفسير قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، يُحَذِّرُ ما صنعوا). أي: يحذر من الذي صنعوا ومن الذي وقعوا فيه، وهو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد.
ثم قالت رضي الله عنها: (ولولا ذلكَ). يعني: ولولا خشية أن يُتخذ قبره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مسجدًا (أُبرز قبره). غير أنه خُشي أن يُتخذَ مسجدًا .
وهـٰذا المقطع من الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها، فيه أن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- إنما امتنعوا من دفن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قبور المسلمين في البقيع لأجل هـٰذه العلة؛ لأنها قالت: (ولولا ذلك أبرز قبره). أي: أظهر، ومعنى الإبراز أي الإظهار عن المكان الذي هو فيه بعد موته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو الحُجرة، حجرة عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-.
غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجدًا، والذين خشوا هم الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.
وفي بعض الشروح ذكر أنه بفتح الخاء يعني: (خَشِي) فيكون الذي خشي هو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى قولها: خُشي -بضم الخاء- أي: الصحابة، يعني: هم الذين خشوا هـٰذا، ولم تقع الخشية من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
وعلى كل حال هـٰذا لا يعارض أن دفنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان بنص؛ لأن دفن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن عن اجتهاد، بل كان عن نص وهو قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الأنبياء يدفنون حيث يموتون)). وقد سمعوا مناديًا يؤكِّدُ هـٰذا الأمر بعد وفاته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على دفنه في حجرته، ويكفي دليلاً في صحة ما فعلوا رضي الله عنهم لو لم يرد نص.
فقولها: (لولا ذلك أُبرز قبره). كأنَّه نوع تعليل للفعل، وإن كان الفعل قد ثبت بنص، وهـٰذا لا معارضة، يعني: لا إشكال فيه، ولا يعارض أن يكون الحكم ثابتًا بالنص؛ لأن الحكم يثبت بنص ويثبت بتعليل، فهي أثبتت العلة التي من أجلها دفن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجرته.
ومن هـٰذا نعلم أن قبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يبن عليه، فمن يستدل على جواز بناء المساجد على القبور بأنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دفن في بيته نقول:
هـٰذا أولاً: خاص بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وثانيًا: أنه لم يبن عليه، البناء قائم قبل موته، ثم إنَّ دفنَه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بيته بنص منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
قول المؤلف –رحمه الله: (ولمسلم عن جُنْدُب بن عبد الله قال: سمعت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل)) ).
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إني أبرأ إلى الله)) البراءة تقدَّمَت معنا وهي: الانفصال عن الشيء والتخلي عنه والبعد والنأي، كلُّ هـٰذا مما تُفَسَّرُ به البراءة، فقول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو في هـٰذه الحال: ((إني أبرأ إلى الله)) أي: أتخلى وأُبعِد وأنفصل عن كلِّ خليل. ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل)) فتخلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من كل خُلَّة.
وقوله: ((إلى الله)) أي: من أجله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ويحتمل أن يكون المعنى أي: وأظهر ذلك، ويحتمل أن يكون المعنى أي: أتقرب إلى الله عز وجل بهـٰذا، أي: إنني أبرأ إلى الله تقربًا إليه أن يكون لي منكم خليل .
والخليل مأخوذ من الخُلَّة وهي المودة، وهي الغاية في المحبة .
وسُمِّي الخليل خليلاً :
إما لكونه يتوسط من نفس محبوبه، وما توسط من الشيء سمي خليله.
وإما لكون النفس تختل به، يعني: لا تكون على حالتها السوية، بل تختل بفقده وتتأثر به تأثرًا بَيِّنًا، ولذلك قال الشاعر في بيان معنى الخلة:
بَلَغت حتى مسلك الروح مني
وبذا سُمـِّيَ الخليلُ خليلاً
مسلك الروح: أي بلغت مني مبلغ الروح والنفس، ولذلك ولهـٰذا المعنى: لكون المحبة قد توسطت الفؤاد والنفس، وكانت من البدن كموطن النفس منه سُمِّي الخليل خليلاً.
المهم يقول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مرض موته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً)). وهـٰذا تعليل للخبر، فبعد أن بيَّن -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- براءته من كلِّ خُلَّة بيَّن -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سبب ذلك، وهو أنه قد اشتغل قلبُه بمحبة ربه، ولهـٰذا فقد تفرَّغ تفرغًا تامّاً من كل عُلقة. ((فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً)) ونصيب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من هـٰذه الخُلَّة أعلى وأوفى، وإنما التشبيه هنا في أصل ثبوت هـٰذه المرتبة، وإلا فرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له من هـٰذه المرتبة ما ليس لغيره .
فقوله: ((كما)) التمثيل هنا ليس للمطابقة من كل وجه، إنما للاتفاق في أي شيء؟ في أصل حصول هـٰذه الرتبة لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً)) هنا بيَّن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أحقُّ الناس بالخُلة من أمته لو كان يجوز له أن يخالل، أو لو حصل في قلبه فراغٌ للخلة.
((ولو كنت متخذًا من أمتي)) والمراد بالأمة هنا أمة الاتباع؛ لأنها الأحق بذلك والأخص به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
((ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً)) وفي هـٰذا بيان عظيم منزلة أبي بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في نفسِ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وما له من المكانةِ العظيمة، وذلك أنَّه لم ينصر أحدٌ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما نصره أبو بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، ولم يُصَدِّق أحدٌ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما صدق أبو بكر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وآمن به، وكان من حُسن جزاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له أن بيَّن فضله في مرض موته بهـٰذا الكلام العظيم.
((ألا وإن من كان قبلكم)) وهـٰذا هو الشاهد من الحديث .
((ألا وإن من كان قبلكم)) والمراد بهم اليهود والنصارى، وليس المراد أهل الشرك؛ لأن أهل الشرك وإن كان يقع في الأمة تشبه بهم من بعض الوجوه لكن الأصل في التشبه الواقع في هـٰذه الأمة أنه باليهود والنصارى؛ ولذلك لما قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لتتبعُن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)). قالوا: اليهود والنصارى؟. الصحابة يسألون رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من المراد بقوله: قبلَكم؟ قالوا: اليهود والنصارى؟ قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((فمن؟)). يعني: من يكون أولئك إن لم يكونوا هؤلاء؟ فإنهم هم الذين يقع في هـٰذه الأمة متابعتهم، ويقع في هـٰذه الأمة سلوك سَنَنِهم .
قال: ((وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد))؛ ((مساجد)): أي مواضع للسجود.
هـٰذا هو المراد بقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وليس المراد البناء فقط، بل البناء من اتخاذها مساجد، والسجود عندها ولو لم يبن عليها من اتخاذها مساجد، بل إنَّ كلَّ عبادة يخص بها القبر رجاء البركة منه فإنَّها من اتخاذ القبر مسجدًا.
إذًا اتخاذ القبور مساجد يكون بالسجود عندها، ويكون أيضًا بالبناء عليها، ويكون أيضًا بالصلاة إليها، وأمر رابع: بكل عبادة، يكون بكل عبادة يخصُّ بها الإنسان هـٰذا المكان رجاءَ بركةِ القبر، أو رجاء إلقاء القبول بسبب القبر.
يمكن أن تقول: ما وجه دخول هـٰذه الصورة الرابعة في اتخاذ القبور مساجد؟
الجواب على هـٰذا: أنَّ المساجد بنيت لماذا؟ بُنيت لعبادة الله، للذكر وقراءة القرآن والصلاة، فكلُّ نوع من هـٰذه الأنواع إذا فُعِل عند القبر رجاء بركة القبر فإنَّ من فعله قد اتخذه مسجدًا؛ لأنه عامله معاملة وفعل فيه ما يفعل في المساجد، فيكون قد اتخذ القبر مسجدًا، وهـٰذا معنى لطيف أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله.
قال: ((كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد)) هـٰذا خبر لأجل أي شيء؟ للتحذير والتنفير؛ لأنَّ الأحاديث مستفيضة في بيان حرمة هـٰذا الشيء، وهو منع اتخاذ القبور مساجد، ثم جاء التحذير الواضح البَيِّن الصريح الذي لا يلتبس بشيء فقال: ((ألا)) وهـٰذه الأداة للتنبيه، أتى بهـٰذا لينبه .
((ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)) فأتى بالنهي بلفظه وأتى بمعناه، أتى بلفظه فقال: ((فلا تتخذوا القبور مساجد)) فإنَّ هـٰذا من ألفاظ النهي ((لا)) هنا ناهية، وقوله: ((فإني أنهاكم عن ذلك)) هـٰذا تأكيدٌ للمعنى الذي تضمنه النهي في قوله: ((فلا تتخذوا القبور مساجد)). ومعلومٌ أن من كان في مثل هـٰذه الحال في حال المرض وفي مرض الموت -ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرَّ معنا وصفُ ما كان ينزلُ به من المرض، لا سِيما في مرض موته من الشدة والكرب- الغالب أن يكون الكلام مختصرًا أو مفصلاً؟ الكلام مختصرًا، فلما فصل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعاد وكرر دل ذلك على أهمية الأمر وعِظَم الخطب وشدة عنايته صلى الله عليه على آله وسلم بالتحذير من هـٰذا الأمر .
((ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)) والنهي هنا نهي للتحريم بإجماع أهل الإسلام، لم يخالف في ذلك أحد من هـٰذه الأمة، فإنَّ الأمة مُجمِعة على تحريم اتخاذ القبور مساجد بالصور المذكورة كلها، الصور المتقدمة كلها.
قال المؤلف -رحمه الله- في فقه هـٰذا الحديث: (فقد نهى عنه في آخر حياته). نهى عن أي شيء؟ الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى اتخاذ القبور مساجد.
(فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن -وهو في السياق-) يعني: وهو في حال الاحتضار (من فعله ) أي من فعل ماذا؟ من اتخذ القبور مساجد.
ثم قال المؤلف –رحمه الله– في بيان معنى اتخاذ القبور مساجد: (والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد). بل الأولى أن يقال: المراد بقوله: ((ألا فلا تتخذوا القبور مساجد)) وما أشبه ذلك، المراد السجود ولو لم يبن، يعني: ولو لم يبن الساجد مسجدًا في هـٰذا المكان؛ لأن هـٰذا هو المراد باتخاذها مساجد.
ومنه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما سيذكر المؤلف: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)). ومعلوم أن الأرض ليست مسجدًا، يعني: مسجدًا مبنيّاً يأخذُ أحكام المساجد المبنية، إنما المراد بقوله: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)). مسجدًا: أي موضعًا للسجود، فيسجد حيث تيسر له وحيث سهل عليه، ولا يلزم أن يخص بقعة من البقع بالصلاة فيها، فقوله -رحمه الله-: (والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد). أي: هـٰذا بيان لمعنىً من معاني اتخاذ القبور مساجد.
وقد خص بعض الفقهاء –رحمهم الله– النهي بما إذا صلى في مكان فيه ثلاثة قبور فأكثر، وذكروه قولاً في مذهب الإمام أحمد، أنه إذا صلى في مكان فيه ثلاثة قبور فأكثر فإنه يكون مما نهى عنه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أما إذا صلى في مكان فيه قبر فإنَّه لا يدخل في النهي.
ووقع الخلاف فيما إذا كان فيه قبران: هل هو من النهي أو لا؟
والصحيح أن النهي يشمل ما فيه قبر وما فيه أكثر من قبر، وجه ذلك أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما ذكرتْ له أمُّ سلمة وأم حبيبة فعلَ النصارى، هل قال: هـٰذا قبر أو هـٰذه قبور؟ لا، إنما قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره)) فهنا عندنا قبر واحد، ثم الصورة والمعنى الذي من أجله ورد النهي عن اتخاذ القبور مساجد موجود فيما إذا كان هناك عدة قبور أو كان هناك قبر واحد.
فالعِلَّة موجودة في القبر وفي المقابر، إذًا النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل ما فيه قبر وما فيه أكثر من قبر، وصور ذلك: الصلاة عندها، وعندها يشمل إليها وعليها وما جاورها.
الثانية من الصور: فعل أي عبادة من العبادات وتخصيص البقعة بها.
الثالثة وهي التي لا إشكال فيها: البناء عليها.
كلُّ هـٰذه من الصور التي تدخلُ في نهي النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن اتخاذ القبور مساجد.
ثم قال: (وهو معنى قولها: خُشي أن يتخذ مسجدًا). أي: موضع سجود. (وهو) المشار إليه أي شيء؟ السجود، وأنَّ المعنى السجود ولو لم يحصل بناء، وهو معنى قولها: (خُشي أن يتخذ مسجدًا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكل موضع قَصدْتَ الصلاةَ فيه -أو قُصِدت الصلاةُ فيه- فقد اتُّخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًا، كما قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)) ). وهـٰذا واضح.
ثم قال رحمه الله: (ولأحمد بسندٍ جيد عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعًا: ((إنَّ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبورَ مساجد)) ). ذكر النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صنفين من الناس: عيب بسبب الزمن، وعيب بسبب الفعل.
أما العيب الذي بسبب الزمن:
فهو قوله: ((من تدركهم الساعة وهم أحياء)) لكن انتبه! إذا تأملت في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من تدركهم الساعة وهم أحياء)) ونظرت إلى بقية النصوص علمت أن الذم هنا ليس للزمان، إنما الذم لفعل أهل ذلك الزمان، فإنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر ((أنه لا تقوم الساعة على من يقول: الله الله)). يعني: أنهم لا يعرفون الله –جل وعلا–، بل هم على الشرك والكفر، وبذلك عِيبَ زمانهم، وأما الزمان من حيث الظرف، الليل والنهار فإنه لا يعاب، والعيب في أهله لا فيه.
فقوله: ((من تدركهم الساعة وهم أحياء)) لأنهم وقعوا في أي شيء يا إخوان؟ وقعوا في الشرك. ((والذين يتخذون القبور مساجد)) هـٰذه صورة من صور الشرك، وهي اتخاذ القبور مساجد، بالمعاني التي تقدمت الإشارة إليها قبل قليل.
وهـٰذا الحديث فيه بيان شرِّ هؤلاء، وأنهم من شرار الخلق عند الله –عز وجل–، وفي رواية: يوم القيامة، وذلك أنَّ أهلَ الشركِ هم أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية.
(رواه أبو حاتم في صحيحه، والحديث بسند جيد). كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وبهـٰذا يكون قد انتهى الباب.
يبقى في قول المؤلف –رحمه الله– للترجمة: (ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح). المؤلف –رحمه الله– أحسن حيث قال: (فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح). ولم يذكر نوعًا من العبادة، فيشمل هـٰذا جميعَ العبادات التي تُخَصُّ بها البقعة، أي: يخص بها القبر رجاء بركته، ولو لم تكن العبادة مصروفة لصاحب القبر.
والعبادة عند القبر إما أن تكون كبيرة من الكبائر ومن وسائل الشرك، وإما أن تكونَ شِركًا وكفرًا بالله –عز وجل–. أما ما كان كفرًا فهو ما صُرِف إلى المقبور: كالذبح والنذر والصلاة لصاحب القبر ودعاء صاحب القبر والاستغاثة به وما أشبه ذلك، هـٰذا كفر وشرك، ولا فرق بين أن يفعلها عند القبر وبين أن يفعلها في غير القبر، يعني: في مكان غير المقبرة، لكن فعلها عند القبر أعظم؛ لاجتماع المحظورين: الشرك، وكونه اتخذ القبور مساجد.
إذا فعل ذلك لله –عز وجل– كأن يقصد القبر لا لعبادة صاحبه، بل لأجل التقرب إلى الله -عز وجل– بالصلاة في هـٰذه البقعة، فهـٰذا قد فعل بدعة منكرة، وهو من أسباب الشرك، لكنه ليس بمشرك؛ لأنه لم يصرف العبادة لغير الله، لكنَّه وقع في سبب من أسباب الشرك.
واعلم أن العلماء –رحمهم الله– أجمعوا على أنَّه لا يجوز تخصيص البقعة -يعني القبر -بالدعاء، يعني: لا يجوز أن يقصد الإنسان مكانًا من المقابر ليدعو الله عز وجل.
وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز وضع مصحف يقرؤه من يزور القبر، فإنَّ هـٰذا من اتخاذ القبور مساجد.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: ما ذكره الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيمن بنى مسجدًا يُعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل.
الثانية: النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك.
الثالثة: العبرة في مبالغته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ذلك، كيف بيَّن لهم هـٰذا أولاً، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لمَّا كان في السياق لم يكتف بما تقدم.
[الشرح]
نعم، على رواية البخاري أنَّ قِصَّةَ أم حبيبة وأم سلمة كانت في مرض موته، فيتبين الأمر بشكل واضح، أنه نهاهم قبل ثم أعاد وأبدأ في النهي عنه في مرض موته، ثم إنه نهى عنه في السياق، يعني: وهو في الاحتضار -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما نزل به الموت.
[المتن]
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
[الشرح]
وهـٰذا سيتبين إن شاء الله تعالى واضحًا في الباب القادم، وهو واضح أيضًا من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، يُحَذِّر ما صنعوا). وهو إنما قال ذلك تحذيرًا لهم أن يفعلوا به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما فعل أولئك بأنبيائهم.
[المتن]
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
السادسة: لعنُه إياهم على ذلك.
[الشرح]
وهـٰذا يدل على أنَّه محرَّف؛ لأنهم إنما لعنوا لأجل هـٰذا .
وفيه جواز لعن اليهود والنصارى، لكن هـٰذا اللعن هل هو على وجه التخصيص أو على وجه العموم؟ اللعن على وجه العموم، وهو يكون لكلِّ من لعنه الله ورسوله من الكفار على وجه العموم، وأيضًا لمن ارتكب ما يوجِبُ اللعن على وجه العموم من هـٰذه الأمة ولو لم يكن كافرًا.
فاللعن لا يدل بمجرده على الكفر إنما يدل على التحريم، ثم يبيَّن مرتبة هـٰذا التحريم هل هو شرك أو كبيرة من الكبائر من النصوص الأخرى.
أما لعن المعين:
فإنَّه لا يجوز لعن المعين، أما من هـٰذه الأمة فلا إشكال أنه لا يجوز لعنه، وكذلك لا يجوز لعن اليهودي والنصراني المعين. إذا مات على الكفر فبعض العلماء يقول: يُلعن؛ لأنه تبين كفره.
[المتن]
السابعة: أن مراده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تحذيره إيانا عن قبره.
[الشرح]
واضح هـٰذا؛ لقولها: (يُحَذِّر ما صنعوا).
[المتن]
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.
[الشرح]
وهو قولها: (خُشي أن يتخذ مسجدًا).
[المتن]
التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدًا.
[الشرح]
ذكرنا في ذلك أربعة على التفصيل، وهي ثلاثة على الإجمال: البناء عليها، الصلاة عندها سواء عليها أو إليها أو حولها، الثالث: العبادة عندها، تخصيصها بالعبادة.
[المتن]
العاشرة: أنَّه قرَن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
[الشرح]
رحمه الله، هـٰذا من فقهه أنَّه بيَّن سبب اقتران هذين، اقتران من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد .
فالذين يتخذون القبور مساجد هم سبب الشرك الواقع في آخر الزمان الذي استوجب أهلُه أن يقول فيهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء)). فقد ذكر السبب والغاية.
[المتن]
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبلَ موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعضُ أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافِضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
[الشرح]
نعم، وهـٰذه مسألة مهمة، وهي أنَّ الذين خالفوا أمر الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الأمر -وهو ما يتعلق بتحقيق التوحيد بمنع تعظيم القبور بأي صورة من صور التعظيم- هم: الرافضة والصوفية.
لكن مبدأ الشر في اتخاذ القبور مساجد من الرافضة، ولذلك لما كانت دولة بني العباس كثرت المشاهد والأضرحة والقبور، فعمروا المقابر وهجروا المساجد؛ لأنهم لا يصلون إلا خلف المعصوم.
وأما المقابر فإنها تملأ بهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويدعونهم ويسألونهم من دون الله.
وقد ألَّف بعض علمائهم كتابًا سماه (مناسك المشاهد)، يعني: الأعمال العبادية التي تُفعل عند المشاهد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ومعلوم يا إخوان أن المناسك لا تكون عند أهل الإسلام إلا في أعمال الحج والعمرة، أما هـٰذه الأشياء فإنَّها لا تعظم، بل لا يؤتى إليها إلا لنفع أهلها والانتفاع بالعِظَة والذكرى .
وهـٰذا هو المقصود من الزيارة الشرعية للقبور، الزيارة الشرعية للمقابر غرضها وغايتها أمران:
انتفاع الميت بالدعاء له، لا بسؤاله؛ لأنه لا يملك نفعًا ولا ضرّاً.
وانتفاع الزائر بأي شيء؟ بالعظة والعبرة والتذكر، هـٰذا إذا كانت المقبرة التي يزورها مقبرة أهل الإسلام، أما إذا كانت المقبرة التي يزورها مقبرة أهل الكفر فإنَّه ينتفع فائدة واحدة فقط، وهي الاتعاظ والاعتبار والتذكر، وهو الذي جرى من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في زيارته لقبر أمه، حيث بكى وأبكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند زيارتها.
[المتن]
الثانية عشرة: ما بُلي به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من شدة النزع.
[الشرح]
كان يوعكُ كما يوعك الرجلان، وهـٰذا لعظم أجرِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
[المتن]
الثالثة عشرة: ما أُكرم به من الخلّة.
[الشرح]
اللهم صل وسلم عليه، نعم هـٰذا واضح.
[المتن]
الرابعة عشرة: التصريح أن أبا بكر أفضل الصحابة.
[الشرح]
لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صرح بأنه لو اتخذ من أمته خليلاً لاتخذ أبا بكر، وهـٰذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة. ثم إن الخلة أعلى من المحبة؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يمتنع من اتخاذ الأحباب والمحبوبين من هـٰذه الأمة، إنما امتنع من الخلة، فدلَّّ ذلك على أنَّ الخلة أعلى درجة من المحبة، وهي الغاية في المحبة، يعني: المنتهى في المحبة.
[المتن]
الخامسة عشرة: الإشارة إلى خلافته.
[الشرح]
وهـٰذا أيضًا واضح، وهـٰذا من المواطن التي فيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- . وقد قسَّم العلماء -رحمهم الله- النصوصَ الدالة على خلافة أبي بكر إلى نصوص قريبة من التصريح، ونصوص فيها الإشارة لبيان فضله وتقدمه على غيره.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله
روى مالكٌ في (الموطأ): أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالَ: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصوٍر عن مجاهد: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى﴾( ). قال: كان يلت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلتُّ السويق للحاج.
وعن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قال: لعن رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (بابُ ما جاء أنَّ الغلو في قبور الصالحين). الغلو: تقدم معناه، وهو مجاوزة الحدِّ فيها بالتعظيم وفعل العبادة وشبهها عندها.
(ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين). وذكرَ قبورَ الصالحين لأنَّ الغالب أن يكون الغلوُّ في قبورهم، وإلا فإنَّ الغلو في القبور كلها محرم، سواء كان المقبور صالحاً أو غير صالح.
(يصيرها أوثانًا). أي: إن الأمر، أمرَ الغلو في قبور الصالحين يؤول بصاحبه إلى أن تكون هـٰذه القبور معبودة من دون الله، يصيرها أوثاناً، والأوثان: جمع وثن، وتقدم لنا أن الوثن هو ما عُبد على غير صورة، وقيل: ما عُبِد على صورة كالصنَم، والظاهر أنه ما عُبِد سواء كان له صورة أو ليس له صورة فإنَّه يصدُق عليه أنه وثن.
(يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله). أي: تصرف لها العبادة من دون الله.
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: فإنَّ أصل الشرك الواقع في بني آدم هو من قِبَل الغلو في قبور الصالحين، كما تقدَّم في الباب الذي قبل السابق: (باب ما جاء في أن سببَ كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين).
أما مناسبة هـٰذا للباب الذي قبله: فإنَّه في الباب الذي قبله (ذكر ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟). فهناك ذكرَ الحكمَ، وفي هـٰذا الباب ذكرَ العلة من الحكم والغاية، لماذا كان التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح؟ لأن العبادة عندها -وهي صورة من صور الغلو- تؤول بصاحبها إلى أي شيء؟ إلى أن يُصَيِّر هـٰذه القبور أوثانًا تُعبد من دون الله.
وذكرنا أنَّ الغلوَّ في قوله: (باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين) هو مجاوزة الحدِّ فيها بأي نوع من أنواع المجاوزة .
والمؤلف رحمه الله ذكر صورة من صور الغلو في الباب السابق، وهي العبادة لله –عز وجل– عند القبور، ولكن هـٰذا ليس حصرًا، إنما هو ذكرٌ لأشد وأعلى ما يُصَيِّر القبور أوثانًا تعبد من دون الله، وإلا فكلُّ غلوٍّ في القبور -سواء في الأفعال التي تكون عندها، أو فيها هي: بأن تُرفع، أو تُجَصَّص، أو تُميَّز- كلُّ ذلك مما يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله من الغلو المحرم.
فالقبور المشرِفة المرتفعة فيها غلو أو ليس فيها غلو؟ فيها غلو ولو لم يبن عليها.
القبور المميزة بجص أو بنوع من الحجارة يفارق سائر ما يوضع على القبور في المقبرة، هـٰذا نوع من الغلو الذي يصيرها أوثانًا تعبد.
وقد نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الإشراف في القبور، ونهى عن التماثيل، فبعث علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فقال له: ((لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا صورة أو تمثالاً إلا طمسته)). كما في صحيح مسلم.
فنهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن هذين الأمرين؛ لما يؤولان إليه وما يصيران إليه من وقوع الشرك في الناس، فالواجب الحذر من كل أنواع الإشراف.
واعلم أن النهي عن الإشراف لا يقتصر -كما هو المتبادر- على ارتفاعها فقط، بل حتى على تمييزها بأي نوع من التمييز كما تقدم قبل قليل، فنقول: الإشراف المنهي عنه في القبور نوعان:
إشراف حسي، وإشراف معنوي.
الإشراف الحسي: بأن تُرفع عن سائر القبور، أو تجصص.
والإشراف المعنوي: يعني التجصيص فيه عملٌ حسي، لكن التجصيص بأن لا يرتفع عن القبور، هو كسائر القبور من حيث الارتفاع الحسي، لكنَّه مميَّز: إما بألوان، أو بزخارف، أو بنوع من الحصى، هـٰذا من الإشراف الذي يجب إزالته، ويجب النهي عنه؛ لأنه يؤول بالقبور إلى المحظور الذي يؤول بها إليه الرفع، فهو موافق لعلة النهي في الرفع.
والمقصود: أنَّ الغلو بجميع صوره، سواء بصرف العبادة لله عند القبور، أو بالبناء عليها، أو بتعظيمها ورفعها وتزويقها، كلُّ هـٰذا مما يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله.
قوله رحمه الله: (يُصيرها). أي: يجعلها ترجع وتؤول وتصير إلى كونها أوثانًا، والأوثان: جمع وثن، والوثن: ما عُبِد على غير صورة، وقال بعضهم: هو ما عُبِد على صورة من ذهب أو من فضة أو من غيرهما، وعلى كل حال الظاهر أنَّ الوثن أعم من الصنم، فيشمل ما عبد على صورة وما عبد على غير صورة، أما الصنم: فهو ما عبد على صورة، هـٰذا الفرق بينهما.
ذكر المؤلف رحمه الله في هـٰذا الباب ما رواه الإمام مالك في موطئه، قال: (روى مالك في الموطأ أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ).
هـٰذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه مرسلاً، وورد موصولاً بسنٍد لا بأس به، صححه شيخ الإسلام رحمَه الله، وابن عبد البر في التمهيد... وغيرهما.
هـٰذا الحديث يفيد كراهية رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يؤول قبره إلى أن يكون وثنًا، قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا)). والوثن: هو ما كان سببًا للفتنة، أو ما كان سببًا لوقوع الشرك، بأن يُعبد من دون الله أو يُتمسح به طلباً للبركة، أو يقصد بنوع من أنواع العبادة، المهم أنه يدخل فيه كلُّ ما نهى عنه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الغلو في القبور.
قال بعض أهل العلم: إنَّ المراد بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا)). أي: لا تمكن أحداً من مباشرة الشرك عنده أو فيه، فيكون دعاء رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ألا يتوصل أحد إلى شرك مباشر للقبر، بأن يسجد عليه أو يتمرَّغ به أو يعبده من دون الله مباشرة، يصلي إليه، أو ما أشبه ذلك من أنواع الشرك التي تكون عند القبور.
وعلى هـٰذا المعنى الثاني فإنَّ الله –عز وجل– قد أجاب دعاءه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فإنَّ قبرَه لم يقع فيه شيء من ذلك، ولم يخلص أحدٌ إلى أن صَيَّره وثنًا يعبد من دون الله، فإنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دُفِن في حجرته، في حجرة عائشة، وبقيت عائشة رضي الله عنها تسكن هـٰذه الحجرة التي اقتطع طرف منها قبرًا لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، سكنتها حياتها، ودفن مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تلك الحجرة أبو بكر وعمر، وعائشة تسكن الحجرة إلى أن توفاها الله، ثم أُخرِجت من الحجرة ودفنت في البقيع رضي الله عنها، ثم بعد ذلك أغلِقت الحجرة ولم يكن لأحدٍ سبيلٌ إليها، وقد أحاط الله –جل وعلا– بما يسره من الأسباب هـٰذه الغرفة بجدران ثلاثة تمنع من أن يَتَوَصل أحد إلى القبر، أو أن يصل إليه، أو أن يقصده بالصلاة.
وكانت الحجرة في شرقي المسجد كما هو معلوم؛ لأن حُجر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانت في شرقي المسجد، وجزء منها في قبلته اليسرى، ثم بقي هـٰذا الأمر إلى أن وَسَّع عثمان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- المسجد ولم تدخل الحجرات، إلى أن جاءت توسعة الوليد بن عبد الملك، فضاق المسجد فرأوا إدخال حجر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المسجد، ومن جملة ما دخل في مساحة المسجد حجرته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التي دُفِن فيها، لكنها لم تدخل دخول سائر الحجر، بمعنى: أنها لم تصر من المسجد، إنما بقيت مغلقة وأحاط بها المسجد من جهة الشمال، ومن جهة الشرق، فدخولها كدخول البيت الملاصق للمسجد فيه، بمعنى: أنه أحاط بها لكنها لم تكن من المسجد، ليس لها حكم المسجد، فلو أن أحدًا خلص إلى الحجرة وصلى فيها لم يكن له أجر الصلاة في المسجد؛ لأنها ليست من المسجد، فهي مملوكة لصاحبها وهو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؛ لأن القبور مملوكة لأهلها كما أنَّ الدور في الدنيا مملوكة لأهلها، فلا يُعتدى عليها ولا تُؤخذ ولا تسلب، بل هي ملكٌ لأهلها، فكذلك قبرُ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يدخل في المسجد.
وبهـٰذا يجاب على إشكال من يستشكل كون الحجرة في مسجد النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو يقول: إنَّ القبر في مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. نقول: هـٰذا غلط في الفهم، القبر ليس في المسجد، بل القبر في الحجرة، والحجرة دخلت المسجد ولم تأخذ حكم المسجد، فلا يجوز الصلاة فيها، ولو صلّى أحد فيها لم يَنَل أجر الصلاة في المسجد النبوي.
وبهـٰذا يكون ما دعاه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسأله ربَّه محققاً وواقعاً، فإنَّ قبره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يُجعل وثنًا، فلم يُبن عليه ولم يتوصل إلى شرك فيه، فهو لم يُتَّخذ وثنًا، بل البناء موجودٌ من قبل؛ لأنه سكنه، وسكنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبيته كان مبنيّاً في حياته.
((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد)) هكذا دعا وسأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربَّه، وقد أجاب الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- دعاءه كما بيَّنا، وقد صرَّح بذلك جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام رحمه الله في "الجواب الباهر"، وصرَّح به أيضًا ابن القيم في نونيته حيث قال:
وأجاب رب العالمين دعاءه
وأحاطه بثلاثة الجدران
وهـٰذه الثلاثة الجدران هي التي حالت دون أن يُستقبل القبر، ودون أن يُصلى إليه، ودون أن يُخلَص ويُتوَصل إليه.
ثم بعد أن سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربَّه هـٰذه المسألة، ذكر العِلَّة لهـٰذا الطلب وهـٰذا السؤال، فقال: ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) اشتدَّ غضب الله أي: عَظُم وقَوِي غضب الله –جل وعلا– على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ذكر قومًا بفعلهم، وذكر هـٰذا الفعل دليل على أنه سبب الغضب، وما أغضب الله –جل وعلا– فهو من المحرمات، ويُعلم بعد ذلك منزلة هـٰذا الذي وقع به الغضب هل هو شرك أو معصية من النصوص والأحاديث الأخرى.
المهم أنَّ هـٰذا يفيدُ أنَّ البناءَ على القبور وأنَّ اتخاذها مساجد مما يغضب الله جل وعلا، ولذلك سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يحمي الله قبره من أن يكون سببًا لغضبه، فأجاب رب العالمين دعاءه وسلمه –ولله الحمد– من أن يقع فيه شيء من الوثنية، فقبره سالم من أن يكون وثنًا يُعبد من دون الله.
وما يجري مما يفعله ضعفاء العقول من التَّمَسُّح بما حول القبر من حديد، أو من التوجه إلى القبر من الخارج في الدعاء والسؤال، أو ما أشبه ذلك من الأفعال، هـٰذا لا يعارض قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)) فهؤلاء كالذي أشرك به في أي مكان آخر؛ لأنهم لم يتوصلوا ولم يخلصوا إلى القبر، والذي سأل رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربَّه ألا يقع الشرك عند قبره، أما أن يكون في خارج المكان فهـٰذا لم يأت سؤاله من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لربه، فلم يقل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اللهم لا تجعلني سببًا لوقوع الشرك في أمتي، أو ما أشبه ذلك، إنما دعا دعاءً خاصّاً، وهو ألا يكون قبرُه سببًا للشرك بالله عز وجل، وهـٰذا من حرصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على تحقيق ما جاء في الدعوة إليه، وهو عبادة الله وحده، فإنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قام بالنذارة من الشرك إلى الرمق الأخير -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم رغِب إلى ربه أن يحفظ دعوته في قبره فلا يقع عند قبره شيء من الشرك، ولا يصير قبره وثنًا يُعبد من دون الله.
قال رحمه الله: (ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى﴾( ). قال) يعني في تفسير هـٰذه الآية (كان يلتّ لهم السَّويق)؛ (يلتّ) أي: يبُلُّ، (السويق) والسويق دقيق الحنطة، يبله بماء أو سمن أو ما يبلل به السويق.
(كان يلت لهم السويق فمات) أي: هـٰذا الرجل الصالح الذي يسعى في خدمة الحاج.
(فعكفوا على قبره) أي: لازموا قبره، فوقع بسبب ذلك الشرك، إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادته من دون الله –عز وجل–. وانظر إلى نوع الغلوّ الذي وقع فيه هؤلاء، وهو العكوف عند القبر، وهو الملازمة، لم يذكُر أنهم بنَوا إنما ذكر الملازمة، فملازمة قبر صالح هي من صور الغلوّ فيه، التي يجبُ على المؤمن أن يتخلى عنها وأن لا يقع فيها، ولو لم يبن عليه، ولو لم يميّزه دون غيره من المقابر، مجرد الملازمة سببٌ لوقوع الشرك، وهـٰذا ما جرى من هؤلاء.
يقول: (وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس) يعني: في تفسير الآية (كان يلتّ السويق للحاج .. فعكفوا) يعني: (على قبره) ووقع الشرك بسبب هـٰذا العكوف وهـٰذه الملازمة.
وفي بعض التّفاسير في تفسير هـٰذه الآية أنَّهم عكفوا على الحَجَر الذي كان يلت عليه السويق، فاتخذوا أثرًا من آثاره فوقعوا في الشّرك، وهـٰذا يدلُّ على أنَّ التبرك بآثار الصالحين من أسباب الشرك، حيث إنَّ هؤلاء طلبوا البركة من هـٰذه الصخرة، أو من هـٰذا الحجر الذي كان يلت عليه السويق فوقعوا في الشرك، وهـٰذا من الأدلة الدالة على تحريم تتبّع آثار الصالحين، أو اعتقاد البركة فيها، فإنَّ ذلك من أسباب الوقوع في الشِّرك.
قال: (وعن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قال: لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور).
(لعن): هـٰذا خبر عمَّا جرى، أو خبرٌ عن إخبار النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، لعن في هـٰذا السياق هو خبر عما جرى من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أي: أخبر ابن عباس أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعن زائرات القبور بالدعاء عليهن.
والدعاء هنا باللعن هو سؤال الله –عز وجل– الإبعادَ والطرد عن الرحمة، ويأتي مثلُ هـٰذا في الكبائر، ويأتي مثل هـٰذا في الشرك ، كما قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). وهنا لعن الزيارة، فاللعن لا يدل على مرتبة المعصية - من حيث الشرك وعدمه- إنما يدلُّ على أنّ هـٰذا من الذنوب الكبار العظام، ثم تعرف مرتبة الذنب من الشرك وعدمه من النصوص الأخرى، وقد تبين في النصوص الأخرى أن اتخاذ القبور مساجد من الشرك والكفر بالله عز وجل؛ لأنه سبب لها، وأما هنا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وإثم من عظائم الآثام؛ لأنَّه يؤول بأصحابه إلى الشرك.
(لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور). زائرات: جمع زائرة، وهي التي تزور القبر، ولو كان قبرًا واحدًا، وهـٰذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء.
وقد جاء بلفظ آخر عند الإمام أحمد وغيره: ((لعنَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زوّارات القبور)). وزوارات: صيغة مبالغة، وهن اللواتي يكثرن الزيارة.
فقال بعض العلماء: إنَّ المنهي عنه هو كثرة الزيارة لا أصلها، وأما أصل الزيارة فإنَّه جائز أو مكروه لكنه لا يصل إلى درجة التحريم؛ لأن اللعن هو للكثرة.
لكن الصحيحَ أنَّ اللعن لأصل الزيارة؛ لهـٰذا الحديث، وهـٰذا الحديث ضعَّفه بعض أهل العلم؛ لأنه من رواية أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس ولم يسمع منه، ولكن الصحيح أن الحديث له من الشواهد ما يدل على ثبوته وصحته، وقد صححه شيخ الإسلام -رحمه الله- واحتج به، وكذلك صححه ابن القيم في موضع، والحديث قوي في دَلالته على تحريم الزيارة.
وأما حديث: لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زوارات القبور. فإنَّه لا يعارض هـٰذا؛ لأنَّ اللعن توجه إلى أصل الزيارة وإلى الإكثار منها.
ثم إن اللعن في حديث: لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زوارات القبور. يدلُّ من حيث الجملة على أنَّ هـٰذا الفعل من المحرَّمات؛ لأنّ ما كان سببًا للعن وجب على المؤمن أن يتوقّاه وأن يحذر منه، ولذلك في المحرَّمات ينهى الله –جل وعلا– عن مقدّماتها فضلاً عن مواقعتها:
قال الله جل وعلا: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾( ) فنهى عن قربان الزنى، وهو ما يكون من مقدِّماته، فلعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزوارات يدلُّ على تحريم الزيارة؛ لأنه لا يتأتى الانفكاك والتخلّص من سبب اللعن إلا بالهجر التام الكلي.
وقد عارض بعض أهل العلم هـٰذا الحديث، حديث: لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زوارات القبور. بما في الصحيحين من حديث أنس: أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى امرأة عند قبر تبكي، فقال لها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اتقي الله واصبري)). ثم إن المرأة قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي... لم تعرفه، فلما عرفته جاءت واعتذرت.
قالوا: إنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم ينكر عليها الزيارة، إنما أنكر عليها البكاء والضجر وعدم الصبر، والصحيح أنه أنكر عليها الأمرين إن كان هـٰذا الحديث قد وقع بعد النهي عن الزيارة؛ لأن الحديث لا يخلو من حالين:
إما أن يكون قد وقع بعد نهي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النساء عن زيارة القبور، ففي هـٰذه الحال نقول: قوله: ((اتقي الله واصبري)) هو نهي عن مجمل ما فعلت من المحرَّمات؛ لأن التقوى هي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وقد ثبت وصح أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعن زائرات القبور، فيدخل في جملة ((اتقي الله واصبري))؛ لأنه ما حملها على المجيء إلا قلة صبرها، ما حملها على مواقعة المعصية وزيارة القبر إلا قلة صبرها.
وإما أن يكون الحديث قبل النهي، فيكون منسوخًا بقوله: لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور.
فعلى الاحتمالين لا دلالة في هـٰذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور.
احتجوا أيضًا بأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علَّم عائشة ما يقوله الإنسان إذا أتى المقابر، وقالوا: هـٰذا دليل على الجواز.
نقول: إن مطالعة سياق الحديث يتبيَّن بها أنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يأذن لها في الزيارة، وأنَّ الذي وقع منها ليس زيارة، إنما تبعته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلما رجع سألته عما يقول من يأتي القبور، فأرشدها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى ما تقول، فما وقع من عائشة ليس بزيارة إنما هو مرور، وتعليم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إيَّاها الذِّكر فهـٰذا لا إشكال فيه؛ لأنَّه قد يتعلم الإنسان ما لا يحتاجه لينقله إلى غيره، كما أنَّ الرجال يتعلمون أحكام الحيض وهم لا يحيضون ولا يحتاجون إلى ذلك في أنفسهم، فكذلك ما نقول إذا نقل الحديث من أحاديث الرجل؟ نقول: هـٰذا الحديث يدلُّ على أنَّ الرجال تحيض، أو: إنَّ الحكم يتعلق بالرجال؟ لا يمكن هـٰذا، فلا يلزم من كون المرأة تنقل ما تمنع منه من الأذكار أو ما أشبه ذلك أن يكون هـٰذا الذكر لها؛ لأن الإنسان يتعلم لنفسه ولغيره.
على كل حال نقول: إنَّ المرأة إذا مرَّت على المقابر في طريقها فإنَّ السنة أن تقول ما قاله رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين)). لكن لا تقصد الزيارة؛ لأن الحديث واضح في النهي: (لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور).
ثم على فرض أنَّ الحديث فيه ما يشير وما يدل على جواز الزيارة، فإننا نقول: إنَّ هـٰذا الحديث محتمل، ولعنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور ليس بمحتمل، بل هو محكم في النهي عن هـٰذا.
والقاعدة في ما إذا كان عندنا نص محكم ونص متشابه: ردّ المتشابه إلى المحكم، وهـٰذا هو الصحيح في هـٰذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم من حيث حكم الزّيارة.
ثم قال: (والمتّخذين عليها المساجد والسرج). أي: لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيضًا (المتّخذين عليها) -أي على القبور- (المساجد)، (لعن رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد) وقد تقدم الكلام على هـٰذا.
وقوله: (والسرج) أي: الإضاءة على اختلاف صورها، وإنما ذكر السرُج لأنه ما يعتاده النّاس في الإضاءة في ذلك الوقت، فالآن لو وضعوا "أكباساً" أو "لمبات" الحكم واحد؛ لأن النهي عن أن تعظّم القبور بأي نوع من أنواع التعظيم، فالعِلَّة في لعن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اتخاذ السرج على القبور هي أن ذلك يُصَيِّرها أوثانًا تُعبَدُ من دون الله؛ لأنه من صور تعظيمها، والقبور ليست محل تعظيم ولا محل رغبة، بل هي محل عظة وعبرة، فلذلك لا يجوز إحداث ما يكون سببًا للوقوع في الشرك.
قال بعض العلماء: إنَّ اللَّعن في هـٰذا الحديث محمولٌ على مجموع المذكور في الحديث، يعني: على الزّائرات المتخذات على القبور مساجد والمتخذات على القبور السرج، المتخذات أو المتخذين، يعني: المهم أنَّ النهي عن مجموع الأفعال، وهـٰذا ليس بصحيح.
الصحيح: أنَّ اللعن متوجه إلى كل فعل بمفرده؛ لأنه لا اتصال بين هـٰذه الأفعال ولا تلازم، فقد يجري شيء ولا يجري آخر، والعطف لا يدل على لزوم الاقتران والتلازم، بل مجرّد وقوع واحد من هـٰذه الأمور المذكورة هو سبب لتوجّه اللعن.
فاللعن لزائرات القبور يصدق على كل من زار القبور من النساء، والمتخذين عليها السّرج ولو لم يكونوا من النساء، والمتّخذين عليها المساجد ولو لم يكونوا من النساء ولو لم يتخذوا سُرُجًا.
(رواه أهل السنن). وبهـٰذا يكون قد تم هـٰذا الباب.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الأوثان.
[الشرح]
وهـٰذا تقدَّم.
[المتن]
الثانية: تفسير العبادة.
[الشرح]
في قوله: (تُعبد من دون الله) والمراد بالعبادة هنا أن تصرف العبادة لله –عز وجل– عند القبور، وهو أن يفعل كلَّ ما أمر الله به أمرَ إيجاب أو أمر استحباب.
[المتن]
الثالثة: أنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعَه.
[الشرح]
(يستعذ) في قوله: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد)) فإنَّ هـٰذا سؤال مِنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لله -عز وجل- أن يعيذ قبره من أن يكون سببًا للوقوع في الشرك.
كأنَّه –رحمه الله– يشير إلى قول من قال: إنَّ ما يجري حول قبر النّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الأفعال ليس من الشرك؛ لأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)). والنبي مجاب الدعوة، فعلى هـٰذا ما يجري من التوجه إلى القبر وما يجري من الاستغاثة بصاحب القبر كل هـٰذا ليس من الشرك؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) وهو مجاب الدعوة.
والجواب على هـٰذا:
أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل سؤالاً خاصّاً وهو أن لا يقع الشرك بقبره، وهـٰذا لم يكن، وليس المراد في ما حول القبر مما لا يباشره، هـٰذا وجه.
والوجه الثاني: إذا أبوا أن يُسَلِّموا بهـٰذا الوجه فنقول: إنَّ دعاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يلزم أن يكون مجابًا في كلِّ ما سأله وفي كل ما دعا به، لا هو ولا غيره، فإنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل ربه ثلاثة أمور فأعطي أمرين ومنع الثالث، وإبراهيم عليه السّلام سأل ربه ومنع من بعض ما سأل في قوله: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾( ) على القول بأن بنيه يشمل كل ذريته وليس ذرية الصلب، فإن قريشاً من ذريته ووقعوا في الشرك.
المراد أنه يجاب عليهم أولاً بأنً المراد بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)) أي: لا تجعله سببًا لوقوع الشرك، بأن يسجد عليه أو يسجد إليه أو يقبل أو يؤخذ شيء من التراب الذي عليه، وما أشبه ذلك من أفعال الشرك المتعلقة بالقبر نفسه.
فإن أبَوا هـٰذا المعنى وقالوا: إنَّ ما يجري دليل على عدم الوقوع، نقول: لا يلزم من دعاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تحقق الإجابة.
هـٰذا الجواب الثاني: يسميه العلماء الجواب بالتسليم، إذا سلمنا ما تقولون فإننا نجيب بكذا، وأما الأول فالجواب بالمنع نمنع أن يكون ما يجري حول القبر من أفعال الشرك مما سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربه أن لا يقع، واضح يا إخوان؟
لأن هـٰذا من الشبه والحجج التي يثيرها هؤلاء على أهل التوحيد.
[المتن]
الرابعة: قرنه بهـٰذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
[الشرح]
وذلك في قوله: ((اشتد غضب الله)). فإنه قَرَن بين دعائه وسؤاله واستعاذته، وبين خبره عن شدة غضب الله عز وجل.
[المتن]
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.
[الشرح]
وهـٰذا فيه إثبات صفة الغضب لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهي ثابتة يثبتها أهل السنة والجماعة، ويثبتها الذين يثبتون الأفعال الاختيارية لله جل وعلا، وينكرها منكرة الأفعال الاختيارية؛ لأنهم يقولون: إن هـٰذا يقتضي الحدوث، والحدوث يلزم منه أن يكوم محدثًا، من قام به المحدث فهو محدث.
على كل حال هـٰذا كلام فارغ يعارض الكتاب والسنة، وبأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟!
ما دلَّ عليه الكتاب والسنة يجب الإيمان به على مراد الله ورسوله وعلى الوجه اللائق به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
وفيه أن غضب الله –جل وعلا– ليس على درجة واحدة، بل هو متفاوت، ويدل لذلك أيضًا قول الأنبياء في عرصات القيامة: ((إن الله غضب غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله)). فيدلُّ ذلك على أنَّ هـٰذه الصفة تتفاوت، وكذلك سائرُ صفات الله –عز وجل- الفعلية فإنها متفاوتة، المحبة والرضا هـٰذه متفاوتة.
[المتن]
السادسة -وهي من أهمها –: معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
[الشرح]
من أين أخذ الشيخ –رحمه الله– أنَّ اللات أكبر الأوثان؟
أنَّ الله قدَّمها في الذكر: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى﴾( ) وإنَّ ما يُقدَّم أعظم ما يكون، من أهم صفة معرفة عبادة اللات ما ذكر المفسرون من أنهم عكفوا على القبر، قبر هـٰذا الرّجل الصالح، أو أنهم عكفوا على أثر من آثاره.
[المتن]
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح.
[الشرح]
نعم واضح هـٰذا.
[المتن]
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذِكر معنى التّسمية.
[الشرح]
نعم (أنه اسم صاحب القبر)، اسم صاحب القبر اللاّت، (وذِكر معنى التسمية) أنه مشتق من اللت، وبهـٰذا يعلم خطأ من يقول: إنَّ اللات مأخوذة مشتقة من اسم الجلالة، لفظ الجلالة الله، اسم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الله.
[المتن]
التاسعة: لعنه زَوَّارَات القبور.
[الشرح]
وهـٰذا واضح، والمؤلف –رحمه الله– أشار إلى الرواية الثانية ولم يأت بالرواية التي ذكرها؛ للدلالة على أنَّ هـٰذه الرواية لا تعارض تلك، وهـٰذا من دقة فقهه -رحمه الله- في الاستنباط.
[المتن]
العاشرة: لعنه من أسرجها.
[الشرح]
وهـٰذا واضح في الحديث: (والمتخذين عليها المساجد والسرج).
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الرابع عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في حماية المصطفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جناب التوحيد
وسدّه كل طريق يوصل إلى الشِّرك
وقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم﴾( ) الآية.
عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ، فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات.
وعن علي بن الحسين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أنَّه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجَة كانت عند قبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقال: ألا أحدِّثُكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟ قال: ((لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا عليّ، فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم)). رواه في المختارة.
[الشرح]
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ فإنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالغ في حماية جناب التوحيد، وجاهد في ذلك وبيَّن، وأقام الحُجَّة، حتى اتضح الأمر في قوله وفعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ومناسبة هـٰذا لكتاب التوحيد: أنه إذا كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد فعل ذلك فإنَّ من السنة في حق أتباعه أن يسلكوا مسلكه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صيانة وحماية جناب التوحيد من أوضار الشرك ولوثاته، وأن يحتاطوا في ذلك، وأن يعتنوا بذلك عناية فائقة؛ لأن الشرك يبدو في أول الأمر على حال يسيرة، ثم ينمو ويكبر حتى يقع الناس في الشرك الأعظم والشرك الأكبر.
فينبغي الاحتياط، وينبغي سدُّ أبواب الشرك، والاجتهاد في ذلك قدرَ الطاقة والوسع. هـٰذه مناسبته لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنَّ الأبواب السابقة تضمنَّت من الأحاديث ما يفيدُ ما ترجَم له المؤلف –رحمه الله– في هـٰذا الباب، فلأهمية هـٰذه الفائدة وعُمْق صلتها بكتاب التوحيد جعلها –رحمه الله– في ترجمٍة خاصة، فهـٰذا الباب هو تأكيدٌ لما استفيد من الأحاديث في الأبواب السّابقة، فإنَّ فيها حماية النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جنابَ التوحيد، وعنايته بسَد كل طرق الشرك ووسائله وأسبابه المؤدية إليه.
إذًا مناسبة هـٰذا الباب لما قبله هي: بيان فائدة تضمنتها الأحاديث في الأبواب السابقة والتنصيص عليها.
يقول المؤلف –رحمه الله– في الترجمة: (باب ما جاء في حماية المصطفى). (حماية): أي صيانة ورعاية وحفظ، كلُّ هـٰذا يدخل تحت معنى الحماية.
(والمصطفى) المراد به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وذكره بهـٰذا الوصف لأنَّه من أعظم الناس اتِّصافاً بهـٰذا الوصف، فإنَّ الله -جل وعلا- يصطفي من خلقه ما يشاء، اصطفى من الملائكة رسلاً، ومن الناس رسلاً، أعظم المصطَفَين هو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولذلك كان هـٰذا الوصف علمًا له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإذا قيل: المصطفى لم ينصرف الذهن إلا لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؛ لأنَّه قد حاز من الاصطفاء الدرجة العليا، فهو أوفر المصطفَين نصيبًا من الاصطفاء.
والمصطفى مأخوذ من الصّفوة، وأصلها (مصتفى) بالتاء فقلبت تاؤها طاءً، والمقصود أنَّه مأخوذ من الصفوة، والصفوة هي الخلاصة من الشيء، فمعنى (المصطفى) أي الخلاصة من أوليائه وعباده، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
لكن هل يستغني بهـٰذا الوصف عن غيره من الأوصاف؟
الجواب: لا، هـٰذا الوصف في الذكر ينبغي أن يكون تابعًا لغيره لا مقدمًا على غيره، خلافًا لما يجري عليه حال كثير من الناس في وصفهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حيث يقتصرون في وصفه على قولهم: المصطفى، قال المصطفى، وفعل المصطفى، وما أشبه ذلك، وليس هـٰذا بجيِّد، بل الذي ينبغي أن يُذكر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأعلى أوصافه وأخصها وهي الرِّسالة، ثم بعد ذلك يذكر بقية الصفات التي يشاركه فيها غيرُه، لكن أخص ما اختص به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الصفات الرسالة، وله منها أعلى نصيب -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ولذلك المؤلف –رحمه الله– في نهاية الكتاب ذكر: (باب ما جاء في حماية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). ولعلَّ المؤلف –رحمه الله– ذكر هـٰذا الاسم في هـٰذا الموضع موافقة لما اشتهر من تسميته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهـٰذا الاسم، وإن كان غيره أشهر وأحسن وأكمل في إيفاء النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حقَّه، فتنبه لهـٰذا.
قال: (جناب التوحيد)، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد.
(جناب) المقصود به الجانب، والجانب هو الناحية، والمقصود بالجانب والجناب والناحية، المقصود بهـٰذا كله هو ما قارب الشيء ولو لم يكن فيه، فكلُّ ما قارب الشيء ودنا منه فإنَّه جانب وجناب وناحية.
والمقصود: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد حمى جانب التّوحيد، يعني: حمى حماه كما في ترجمة المؤلف –رحمه الله– في آخِرِ الكتاب، فهو لم يقتصر في حمايةِ التوحيد على حماية الأصل، بل حمى الأصل وحمى الفِناء، وحمى الناحية، وحمى ما قارب التّوحيد فضلاً عن حمايته للتوحيد نفسه.
و(التوحيد) قد تقدم بيانُه، والمقصود بالتوحيد هنا ما هو؟ التوحيد المقصود به توحيد الإلهية، وأيضًا توحيد الربوبية، والأسماء والصفات، فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد حمى جميع ذلك، وهو ظاهر في الأحاديث التي مضت، وسيتبين أيضًا في الأحاديث التي ستأتي.
قال رحمه الله: (وسده كلَّ طريق يوصل إلى الشرك)؛ (سده): أي منعه وإغلاقه لكلِّ طريق يفضي إلى الشِّرك، ويؤدي إلى مخالفة التّوحيد، فرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عمِلَ على حفْظ التّوحيد من جهتين:
الجهة الأولى: الحماية والحفظ لحمى التّوحيد وجناب التّوحيد.
والجانب الثاني: سده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لكلِّ ما ينقض التوحيد ويُفضِي إلى الشرك.
وذكر المؤلف –رحمه الله– في هـٰذا الباب آيةً وحديثين:
أما الآية فهي قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾( )، هـٰذه الآية الكريمة فيها بيان وصف رسولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ذكرَ فيها الله –جل وعلا– عن رسولِه أمورًا، وأكَّدَ ذلك بالقسم، وباللام الموطئة له، وبـ(قد)، فهناك ثلاثة مؤكدات كما هو معروف من هـٰذا الأسلوب، ﴿لَقَدْ﴾ فيها ثلاثة مؤكدات.
﴿جَاءكُمْ﴾ الخطاب في هـٰذا قيل: إنَّه لقريش، وقيل: إنه للعرب، وقيل: إنَّه للناس. والأخير هو أقربها للصواب؛ لأن التوبة من آخر السور نزولاً .
قال الله جل وعلا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾( ). هـٰذا خطاب لجميع من اتصف بالإيمان، وليس خاصّاً بالعرب أو بقريش، فالخطاب في قوله: ﴿جَاءكُمْ﴾ لجميع الناس وليس خاصّاً بالعرب؛ لأن هـٰذه الآية من آيات سورة التوبة وهي من آخر السور نزولاً.
﴿رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ من أنفسكم: أي من جنسكم، فلم يكن من الجن، ولم يكن من الملائكة، ولا من غيرهم.
ثم بعد أن بيَّن هـٰذا وهو وصفـه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأول ذكر أوصافًا أخرى فقال: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾؛ ﴿عَزِيزٌ﴾: أي يَشُقُّ عليه ويصعب عليه ويلحقه العنت أن تنزل بكم مشقةٌ أو صعوبةٌ، فمعنى ﴿عَزِيزٌ﴾ أي: يصعب، أو صعب عليه، أو يشق عليه.
﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ أي ما يشقّكم ويلحقكم العنت والشدة، وهـٰذا من تمام نصحه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للأمة، وإذا أردت أن تعرف ذلك فاقرأ قول الله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾( ). أي: مهلك نفسك أن لم يتبعوك، وهـٰذا فيه بيان عظيم ما كان يلحقه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الألم والشدة والمشقة بسبب إعراض الناس، لا لكونهم أعرضوا عنه لكن لكونهم أوقعوا أنفسهم في الهلكة، فإنَّ من أعرض عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعمّا جاء به قد وقع في الهلاك وكان من الخاسرين.
﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ يفيد منع كل ما يضرّ.
﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ فيه إفادة أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حريص على أن يوصل للأمة كل ما ينفعها، فهو يمنع عنها كل ما يلحقها المشقة والضرر، ويسعى في إيصال كلِّ ما يوصلها إلى الفضلِ والخير والنفع، وبهـٰذا يكتملُ الوصف، فإنَّ من كان على هـٰذه المنزلة في معاملته للناس كان من أكمل الناس نصحًا لهم.
﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ ثم قال -بعد ذكر هـٰذين الوصفين العامين لجميع الناس، وليست الآية خاصة بالمؤمنين، بل هي لجميع من خوطب بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾. أما ما يختصّ المؤمنين فهو قوله تعالى-: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وهـٰذا فضل على فضل، إذا كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع عموم الناس المسلم والكافر يشق عليه ويصعب عليه ما يكون من أسباب المشقة لهم، ويحرص على إيصال كل خير لهم فكيف بالمؤمنين؟ الأمر أعظـم وأشـد، ولـذلك قال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ الرأفة هي أعلى درجات الرحمة. ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وأما غيرهم فليس لهم من هـٰذين الوصفين نصيب، بل لهم ما يكمل به إقامة الحجّة عليهم من قوله تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾.
وبهـٰذا نعلم أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد بلَّغ البلاغ المبين، فإنَّه لم يمنعه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما لقيه من المشركين، ولم تمنعه عداوة المعتدين عليه، والمعادين له من أن ينصحهم، وأن يبلِّغهم البلاغ المبين، بل بلَّغ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- البلاغ المبين مع شدة عداوة خصومه له، مع أنَّ مقتضى الجِبِلّة وما يفعله كثير من الناس أنه إذا اُعتدي عليه منع الخير الذي عنده، لكن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- سَلِم من هـٰذا، فكان مبلغًا لما أوحي إليه بلاغًا تامّاً مبينًا.
مناسبة هـٰذه الآية للباب: أنها ظاهرة في أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يترك خيرًا إلا دلَّ الأمّة عليه، ولم يترك شرّاً إلا حذّرها منه، ومن أعظم الخير الذي دعاها إليه التّوحيد، ومن أعظم الشّر الذي حذرها منه الشرك، فقد بلَّغ في هـٰذين البلاغ المبين، وأدى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما أمره الله به من البيان والبلاغ.
ثم ذكر المؤلف –رحمه الله– بعد هـٰذه الآية حديثين:
الحديث الأول يقول: (عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)) ).
نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن جعل البيوت قبورًا، وقال الشرَّاح في هـٰذا النهي: إن له معنيين:
المعنى الأول: النهي عن الدفن في البيوت، وهـٰذا ما عليه أهل الإسلام، فإنَّ أهل الإسلام عملوا على ألا يكون دفن في البيـوت، بل من مات منهم نُقِل إلى المقابر في غير البيوت. ولم يدفن أحد في بيته إلا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لما ورد من أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((الأنبياء يدفنون حيث يموتون)). ولمِـا ذكرت عائشـة -رَضِيَ اللهُ عَنْها- من الخشية أن يتخذ قبره مسجدًا.
والمعنى الثاني لقوله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)) ما ثبت في الصحيحين من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا)) فالمعنى في قوله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)) أي: لا تجعلوها مهجورة من العبادة والطاعة كما هي حال المقابر، فإنَّ المقابر ليست محلاًّ للطاعة والعبادة، فهي مهجورة من العبادات والطاعات لا تقصد لذلك، وما يكون من عبادة وطاعة كالدعاء -مثلاً- أو الصلاة على المقبور إنما هو على وجه التّبع، وليس مقصودًا لذاته.
فليس مقصودًا أن يُتعبّد الله –جل وعلا– في المقابر، إنّما لكون الإنسان يزورهم يدعو لهم، فالدعاء هنا تابعٌ للزيارة وليس مقصودًا به هـٰذا المكان بعينه.
فقوله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)) أي: لا تعطِّلوها عن العبادات التي لا تكون في المقابر فتكون كالمقابر، فلا تعطِّلوها من الصلاة ولا من الذكر ولا من قراءة القرآن، ولا من غير ذلك من أنواع العبادة.
((ولا تجعلوا قبري عيدًا)) هـٰذا النهي الثاني، ومعنى العيد في اللغة: هو ما يعتاد مجيئه وقصده، هـٰذا معنى العيد، ما يُعتاد مجيئه وقصده من الأماكن والأزمنة، فالعيد يُطلَق على الأماكن ويطلَق على الأزمنة.
مثال أعياد الأماكن: المشاعر، مكة، البيت الحرام، مِنى، مزدلفة، عرفات، هـٰذه أعياد لأهل الإسلام جعلهـا الله –سبحانه وتعالى– أعيادًا للحنفاء يعتادون مجيئها وقصدها ويتعبدون الله عز وجل بمجيئها وقصدها، وهـٰذا من الأعياد المكانية.
فكل ما اعتاد الناس قصده ومجيئه على وجه التعبد فإنَّه عيد؛ لأنهم اعتادوا المجيء إليه واعتادوا قصده.
النوع الثاني مما يتخذ عيدًا: الأزمنة، وهو المشهور في الاستعمال، فإنَّ المشهور في الاستعمال إطلاق العيد على الأزمنة، فكلُّ ما اعتاد الناس مجيئه من الأزمنة واجتمعوا له وفرحوا به فإنَّه عيد، ومن ذلك عيد الجمعة في الأسبوع وعيد الأضحى وعيد الفطر، فهـٰذا من الأعياد الزمانية.
هل الأعياد عادات أم عبادات ؟
الأعياد عبادات، هـٰذه قاعدة اضبطها: الأعياد عبادات .
ولذلك لا يجوز أن يُحدَث فيها ما لم يأت به الشّرع، فكل من أحدث عيدًا مكانيّاً أو زمانيّاً فإنَّه قد ابتدع في دين الله، وشرَعَ ما لم يأذن به الله.
وعلى هـٰذا نعلم خطأ وبطلان هـٰذه الأعياد المحدَثة التي يحتفل بها بعض الناس، كعيد الأم وعيد الحب.. ما أشبه ذلك من الأعياد المحدثة، ويقولون: إن هـٰذه عادات .
نقول: الأعياد لا عادات فيها، الأعياد عبادات، شرائع، ولذلك لما رأى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احتفال الأنصار بشيء مما كانوا يحتفلون به في الجاهلية نهاهم وقال: ((إن الله أبدلكم بهما عيد الفطر وعيد الأضحى)).
فنعود إلى قوله: ((لا تجعلوا قبري عيدًا)) النهي أن يُجعل قبره محلاًّ للاجتماع المعتاد، نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يُجعل قبره محلاًّ لاجتماع معتاد، أي اجتماع يعود كل شهر أو كل سنة أو كل يوم أو كل صلاة أو كل دخول للمسجد.
ولذلك كره الإمام مالك –رحمه الله– أن يؤتى إلى القبر للسلام في كلِّ دخول، وقال: لم ينقل عن السلف فعلُه إلا في السفَر والقدوم من السفر.
وغاية ما نُقل في ذلك عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، ونُقل عن أنس أيضًا، لكنه لم يكن هديًا عامّاً للصحابة أنهم إذا سافروا أو قدِموا أتوا إلى القبر ليسلموا على النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويزوروا قبره.
فلم يفعله أبو بكر، ولم يفعله عمر، ولم يفعله عثمان، ولم يفعله علي، ولم يفعله سائر الصحابة، وإنما نُقل عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وعن أنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، ومن عداهما فلم يُنقل عنه ذلك، مع أنَّ هـٰذا أمر يُهتم به ويُستشرف له، فلما كانوا لم يفعلوه لم ينقل عنهم -رَضِيَ اللهُ عَنْهم-.
فلذلك نهى الإمام مالك –رحمه الله– عن الزيادة في هـٰذا الأمر على ما ورد عن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، فقال: يكره أن يأتي إلى القبر كلما دخل المسجد كما هو فعل بعض الناس الآن، أو كل يوم أو ما أشبه ذلك، لا يأتيه إلا عند السفر أو القدوم من السفر؛ لأن هـٰذا هو الذي ورد فعله عن بعض الصحـابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.
والإمام مالك –رحمه الله– كره أيضًا أن يقول القائل: زرتُ قبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لما في ذلك من اتخاذه عيدًا.
والإمام مالك من أشد الأئمة احتياطًا في هـٰذا الأمر، وانظر كيف كان الاحتياط من إمام دار الهجرة؛ لأنه –رحمه الله– يشهد ما يفعله بعض الناس، ويعي وينظر ما يمكن أن يؤول إليه الأمر من كثرة المجيء، من التعظيم واتخاذ القبر عيدًا.
((لا تجعلوا قبري عيدًا)) أي: لا تجعلوه محلاًّ للاجتماع زماناً وكذلك مكانًا.
قال: ((وصلوا عليَّ، فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) وهـٰذا كالموجه لهم والمبيِّن لهم أن الصلاة لا تقترن بالمجيء إلى القبر. فمن ظن أنه لا يتحقق له الصلاة على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلا بالمجيء إلى القبر فقد أخطأ الفهم، فإنّ الصلاة لا تختص بالمكان، ولذلك قال: ((صلوا عليَّ، فإن صلاتكم تبلغني)) يعني حيثما كنتم. ولذلك قال: ((حيث كنتم)). فلا مزية لمن صلى على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عند قبره.
وما ورد من أنه: (من صلى عليَّ عند قبري -أو: من سلَّم علي عند قبري- سمعته، ومن صلى علي في غيره بلغته). فإنَّ هـٰذا الحديث لا يصح، فيه متروك فلا يثبت سندًا، كما أنه في الحقيقة لا يثبت متنًا، ولا يثبت واقعًا الآن؛ لأنه لا يمكن أن يأتي أحدٌ إلى القبر، فكلُّ من وقف على موضع الوقوف الآن من أي جهة كانت من جهات القبر أو من جهات الحجرة فإنِّه لا يتمكن من السلام على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سلامًا يسمعه؛ لأن بينه وبينه مسافة، وبينه وبينه أبواباً، فلا يمكن أن يتحقق هـٰذا الذي ذُكِر في هـٰذا الحديث الضّعيف.
على كلٍّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجَّه الأمة إلى الصلاة عليه في كلّ مكان، وأن لا يقيدوا ذلك وأن لا يربطوه بالمجيء إلى قبره، بل قال: ((صلوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)).
وأما كيفية البلوغ فقد بيَّنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث صحيح وفيه: أنّ الله -جل وعلا- أوكل به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ملائكة سيّاحين يبلغونه سلام أمته عليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-.
يقول المصنف رحمه الله: (رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات) .
وهـٰذا الحديث مناسبته للباب واضحة:
فإنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ابتدأ الأمر أولاً بالنهي عن اتخاذ البيوت قبورًا، فقال: (( لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)). ثم بيَّن -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما اختص به قبره من عدم جواز تصييره عيدًا يُجتمع عنده في كل وقت أو في أوقات، بل لا يجوز ذلك؛ لنهيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ثم بيَّنَ طريق توصيل السلام إليه في قوله: ((وصلوا علي، فإنَّ صلاتكم تبلغني)) وفي هـٰذا سد لكل طريق يوصل إلى الشرك، وفيه الحماية، حماية جناب التوحيد.
قال رحمه الله: (عن علي بن الحسين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-) ورحمه الله (أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة). والفرجة هي الكوة (في الحائط كانت عند قبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). ولا تفهم أنها كانت بجوار القبر وأن القبر مكشوف، القبر مغلق، بعد خروج عائشة منه أُغلقت الحجرة، ولا يتمكن أحد من الوصول إليها، إنما كانت هـٰذه الكوة بقرب بيته الذي فيه قبره، يأتي إليها هـٰذا الرجل يقول: فيدخل فيها فيدعو، يدعو من؟ هل يدعو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟
الجواب: لا، يدعو الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وإنما تخيل وتوهم أن الدعاء في هـٰذا المكان له مزية وله خاصية، وأنه من المواطن التي تُتَحرى فيها الإجابة، فنهاه.
من الذي نهاه؟ علي بن الحسين، وهو مِمَّن ؟
من ذرية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، من أسباطه، فنهاه وقال: (ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عـن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟)؛ (من أبي): عن الحسين بن علي، (عن جدي): عن علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، (عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تتخذوا قبري عيدًا)).) هـٰذا فيه ما في الحديث السابق من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تجعلوا قبري عيدًا)) فالمعنى واحد. ((ولا بيوتكم قبورًا)) هـٰذا أيضًا فيه قوله: ((ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا، وصلوا عليَّ، فإنَّ تسليمكم ليبلغني أينما كنتم)). هـٰذا مطابق لما تقدم في الحديث السابق من حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
وبهـٰذا نعلم أنَّ هـٰذا الحديث على ضعفه فإنَّ فيه رجلاً مبهمًا في سنده ولكنَّه لا يضر؛ لأن كل جملة فيه قد جاءت الأحاديث مستفيضة بإثباتها.
فالأحاديث دالة على صحة ما تضمنه هـٰذا الحديث، ويكفي في إثباته ما في حديث أبي هريرة السابق الذي قال عنه المصنف –رحمه الله–: (بإسناد حسن)، وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- وحسنه أيضًا ابن القيم رحمه الله.
يقول: (رواه في المختارة). المختارة: هـٰذا كتاب صنَّفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، وزبدة تصنيف هـٰذا الكتاب أنه جمع فيه الزوائد على الصحيحين ككتاب المستدرك للحاكم، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وصنيعه فيه أحسن من صنيع الحاكم، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم.
نقرأ المسائل:
[المتن]
الأولى: تفسير آية براءة.
الثانية: إبعاده أمته عن هـٰذا الحمى غاية البعد.
[الشرح]
اللهم صل وسلم عليه، نعم، هـٰذا يستفاد من هـٰذه الأحاديث، ومن الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة، وقد يكون في الأحاديث السابقة ما هو أدلّ وأظهر في الدلالة على هـٰذه الفائدة.
[المتن]
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.
[الشرح]
اللهم صل وسلم عليه، بيَّنا أن الحرص عام: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾. هـٰذا عام، والخاص بهـٰذه الأمة الرأفة والرحمة.
هـٰذا العموم هل هو كالكفار؟ يعني: هل حرصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المسلمين كالكفار؟
لا، لهم من هـٰذا أعلى نصيب، ولذلك خُصّوا بالرأفة والرحمة.
[المتن]
الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أنَّ زيارته من أفضل الأعمال.
[الشرح]
الوجه الذي نُهِيَ عنه هو أن يُجعَل عيدًا مكانيّاً، بأن يؤتى إليه ويجتمع عنده في زمان معيّن أو في فترات محدّدة، بل لا يفعل ذلك وإنما يزار إذا تيَسَّر، على أنّ شيخ الإسلام –رحمه الله– له رأي في الجواب الباهر يقول: إنه لا تمكن زيارة قبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وأن الذين يأتون ويقفون على حجرته أو قريبًا من بيته فإنهم لم يزوروا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؛ لأنَّ الزيارة تقتضي مباشرة المزور، وأين أنت والقبر؟ وهـٰذا الرأي الحقيقة أنه له قوة، لكن يصعب القول به؛ لكثرة المنكِر له، والشيخ –رحمه الله– ابتُلي بسبب هـٰذه الرسالة الجواب الباهر، وكان من أسباب سجنه –رحمه الله– ما ذكره في ذلك.
[المتن]
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة.
[الشرح]
لأن الإكثار يُصَيِّر القبر عيدًا.
[المتن]
السادسة: حثه على النافلة في البيت.
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يُصلى في المقبرة.
[الشرح]
وجه ذلك قوله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)) وضح هـٰذا رواية الصحيحين: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا)) وهـٰذا يبين لنا المراد بقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)) ولكن يُستثني من هـٰذا الصلاة على الجنازة، سواء كانت في القبر أو خارج القبر، فإن الصلاة المنهي عنها في القبور الصلاة ذات الركوع والسجود، وأما الصلاة على الجنازة -سواء كانت في القبر إذا دفنت أو كانت خارج القبر- فإنَّ ذلك لا بأس به، وهو جائز، وقد فعله الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.
[المتن]
الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
[الشرح]
من أنَّه يُسمِع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سلامه، فإنَّ الحديث في ذلك غير ثابت، وقد جاء في بعض الروايات حديث علي بن الحسين أنه قال: ما أنتم والذين في الأندلس إلا واحد.
[المتن]
التاسعة: كونه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
[الشرح]
لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)). فإنَّ هـٰذا يدلُّ على أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تعرض عليه أعمال أمته، لكن هل العرض لجميع الأعمال؟ هـٰذا الحديث لا يساعد في إثبات هـٰذا العموم، بل هو عرض خاص، وهو عرض الصلاة والسلام عليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء أن بعض هـٰذه الأمة يعبد الأوثان
وقول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾( )، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾( )، وقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾( ).
عن أبي سعيد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟)). أخرجاه.
ولمسلم عن ثوبان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إنَّ الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإنَّ ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضًا)). ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: ((وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)).
[الشرح]
فهـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد واضحة: فإنَّ عبادة الأوثان مما يناقض التوحيد، فكان من المناسب أن ينبه المؤلف –رحمه الله– إلى أنَّ ما جاء به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من التوحيد، وما تبعه عليه الأمة، وما ارتفع به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الشرك ليس ارتفاعًا كُلِّيّاً بل إنَّه سيعود، ويعود في هـٰذه الأمة، يعني: وليس العود في من لم يُسلم ولم يقبل دعوة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، بل العود إلى الشرك يكون في هـٰذه الأمة، ولذلك قال: (باب ما جاء أنَّ بعض هـٰذه الأمة يعبد الأوثان)؛ (بعض هـٰذه الأمة) أي: جزء منها كثير أو قليل الله أعلم، لكن بعض هـٰذه الأمة يعبد الأوثان.
و(الأمة) هي أمة الاتباع وليس المراد أمة الدعوة؛ لأن الأمة تطلق ويراد بها أمة الدعوة، وهـٰذا يشمل كل من جاء بعد بعثة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وسلم وَسَلَّمَ-، فهو من أمَّةِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باعتبار أمة الدعوة، يعني: أن الدعوة موجهة إليه وهو مخاطب بها وهو مطالب بالإيمان بالنبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ليس هـٰذا هو المراد بهـٰذه الترجمة، إنما المراد بالأمة هنا أمة الإجابة.
القسم الثاني من الأمة: أمة الإجابة، وهم كلُّ من آمن بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وهـٰذا يشمل جميع أهل الإسلام، كل من نطق بالشهادتين.
القسم الثالث: أمة الاتباع، وهم أخص الأمم، يعني: وهم أخص الأمة وصفوتها.
فالمراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة، ليس أمة الاتباع، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، يعني: من أهل الإسلام ممن يصدق بالإسلام ويصدق بأنَّه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
(يعبد الأوثان). أي: يحصل منه صرف نوع من العبادة قليل أو كثير إلى الأوثان.
(والأوثان). جمع وثن، وهو ما عبد على غير صورة، فيشمل الصنم الذي له صورة وجثة، ويشمل كل ما عبد من دون الله ولو لم يكن له صورة، فالوثن أوسع من الصنم.
فمناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة.
أما مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: فإنه في الباب السابق بيّن لنا حماية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جناب التوحيد، وحرصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على سدّ الطرق المفضية إلى الشّرك، فحتى لا يظن الظان أنَّ هـٰذا الحرص يمنع وقوع الشرك بيَّن المؤلف –رحمه الله– أنه مع هـٰذا الحرص الشديد وهـٰذه الحماية الأكيدة من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنَّ الشرك واقع في الأمة، كما دلَّت على ذلك الآثار والسّنن، فساق هـٰذا الباب ليبين أنَّ هـٰذه الحماية وهـٰذا الحرص وهـٰذا السد لأبواب الشرك وطرقه لن يمنع وقوع الشرك في هـٰذه الأمة؛ بل أخبر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّ الشرك سيقع في هـٰذه الأمة، وأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فِئام من هـٰذه الأمة –جماعات- فِئام يُطلق على الجماعات الكثيرة، فِئام من أمتي الأوثان.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول ذي الخلصة)) صنم كان يعبد في الجاهلية، ومعنى هـٰذا أن الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية تبعث وتعاد وتعظّم، وتعبد من دون الله -عز وجل- في آخر الزمان.
المهم أن مناسبة هـٰذا الباب لما قبله هي بيان أنَّ ذلك الحرص لا يمنع وقع الشرك، حتى لا يحتج مبطل ويقول: إن الشرك لا يقع في هـٰذه الأمة، فإنها معصومة من الشرك.
نقول: الشرك واقعٌ في هـٰذه الأمة بخبر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، الخبر الخاص والخبر العام، أما الخبر العام فسيأتينا وجهه، وكذلك الخبر الخاص سيأتينا وجهه، والمؤلف -رحمه الله- ذكر الأدلة الدالة على وجه العموم على وقوع الشرك في هـٰذه الأمة والأدلة الخاصة.
ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب ثلاث آيات، وكل هـٰذه الآيات في خبر من سبق من الأمم، وأنه وقع فيهم الشرك والكفر بالله عز وجل.
أما الأولى: فقال فيها رحمه الله: وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾( ) الاستفهام هنا: استفهام تعجيب وإنكار على هؤلاء الذين ﴿أُوتُوا﴾ أعطوا ﴿نَصِيباً﴾ أي: حظّاً ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ والكتاب هنا: يشمل التوراة ويشمل الإنجيل، فإن هـٰذا هو الذي وقع من اليهود والنصارى حيث آمنوا بالجبت والطاغوت.
فهـٰذه الآية فيها التعجيب والإنكار من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب، ومقتضى أنهم عندهم الكتاب وعندهم العلم ألا يقع فيهم الشرك، ومع ذلك قال -جلَّ وعلا– في بيانِ اختلاف النتيجة عن المقدِّمة: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾.
المقدمة أنهم عندهم الكتاب، ومقتضى أن الكتاب عندهم أن يؤمنوا به وألا يقعوا في الشرك؛ لأن العلم حماية وصيانة من الشرك، ومع ذلك حصل منهم الإيمان بالجبت والطاغوت .
﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾. والجبت سيأتينا في الباب القادم تفسيره على وجه التفصيل، لكنه يطلق على السحر، ويطلق على العيافة، والطرق، والطِّيَرة. ويطلق على الكهان، فهو اسم لكـل ما عبُد من دون الله، وكذلك الطاغوت يطلق على الشيطان والكاهن والساحر.
وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- التفريق بينهما في باب ما جاء في السحر؛ لأنه بيَّن في ذلك الباب معنى الجبت ومعنى الطاغوت.
لكن اعلم أن الطاغوت صيغة مبالغة على وزن فعلوت، كالرّحموت والملكوت، والمراد بها المبالغة في الطغيان . والطغيان هو المجاوزة في الحد، وما معناه؟ معناه هو: كل من عبد من دون الله وهو راض أو دعا الناس لعبادته، والعبارات في بيان الطاغوت متقاربة لكن تدور على هـٰذا المعنى.
شيخ الإسلام –رحمه الله– عرَّف الطاغوت بأنَّه: اسم جنس للشيطان والكاهن والعرَّاف والساحر، قال: والدرهم والدينار وغير ذلك.
هؤلاء أوتوا نصيبًا من الكتاب ووقع منهم الإيمان بالجبت والطاغوت، ومقتضى الإيمان بالجبت والطاغوت الكفر بربّ العالمين؛ لأنَّه من آمن بالجبت والطاغوت فقد كفر بالله، دليل ذلك قولُه تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾( ). هؤلاء وقع منهم الإخلال في أي شيء ؟ الإخلال في الكفر بالطاغوت، فلم يكفروا بالطاغوت، فهؤلاء كفروا بالله -عز وجل- لأنَّهم لم يكفروا بالطاغوت، بل الواقع أنهم آمنوا به وصدَّقوا به، فالإيمان هو التصديق والإقرار والإذعان والقبول، كل هـٰذا يفيده قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾.
إذًا الآية دلَّت على أمر، وهو المقصود من سياقها، وهو أن الشرك وقع في الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، مع أن الكتاب في أيديهم.
وقوله:﴿أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: حظّاً من الكتاب، ويدلُّ هـٰذا على أنَّ معهم علماً، فالعلم لا يمنع من الوقوع في الشرك إذا كان علمًا لم يبتغَ به وجه الله، ولم يقصد به الدار الآخرة.
أما الآية الثانية: فهي قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ والأحسن أن تقف ثم تقول: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ حتى لا يتوهم المتوهم أنها معطوفة على قوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِير﴾ أي: وجعل منهم عبدة الطاغوت.
طيب نأتي على تفسيرها، الله عز وجل في هـٰذه الآية يقول لمحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في خطابه لأهل الكتاب:
﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ أي: هل أخبركم ﴿بِشر مِنْ ذَلِكَ﴾. أي: بأسوأ حالاً في الدنيا والآخرة، والمشار إليه في قوله: ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ من تقدم ذكرهم في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ بعد أن أنكر عليهم أنهم ما نقموا على أهل الإسلام إلا أنهم آمنوا بالله وبما أنزل إلى أهل الإسلام، وما أنزل من قبل، قال جلَّ وعلا: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي: بشر من تصرفكم هـٰذا وهو نقمتكم علينا إيماننا.
﴿مَثُوبَةً﴾ أي: جزاءً وأجرًا، وجاء بمثوبة من باب التهكم بهم، وإلا فلا يُطلَق على الشر مثوبة؛ لأن مثوبة مأخوذة من الثواب ، والثواب لا يطلق إلا في الأجر على العمل الصالح.
والمعنى: قل هل أنبئكم بشر من نقمتكم على أهل الإسلام إيمانهم؟
هم ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ هؤلاء شر من أهل الإسلام الذين لا شر فيهم في الحقيقة، لا شر فيهم لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله عز وجل وبما أنزل إليهم وبما أنزل من قبل، وهـٰذا هو المطلوب من المؤمن، وإنما ذكر هـٰذا الأسلوب على وجه المجاراة لهم في اعتقاد الشر في أهل الإسلام، وإلا فأهل الإسلام، ومن تحقَّقَ فيه الوصف السابق لا شر فيه.
﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ بيان للترهيب والتهديد، وأنَّ التفاضلَ في الحقيقة بما يكون عند الله لا بما ينظر الناس إليه، فإنَّ الفضلَ والسبقَ هو فيما عند الله عز وجل، أما الناسُ فقد يَمدحون من لا يستحق المدح، ويذمّون من لا يستحق الذم.
ولذلك لما جاء رجلٌ إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله: إن مدحي زَين ، وذمي شَين. ماذا قال له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟ قال له: ((ذاك هو الله)).
يعني: الذي مدحه يزين الشخص وينفعه الله جل وعلا، والذي ذمه يقدح في الشخص ويقبح بالشخص أن يكون قد نزل به ذم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، أما ذم المخلوق فإنه لا يعتبر في هـٰذا.
إذا كان الإنسان مذمومًا عند الله -عز وجل- فلو مدحه الناس ما نفعه، وإذا كان ممدوحًا عند الله عز وجل فلو ذمَّه الناس ما ضرَّه.
﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ يعني: الذي لعنه الله، ومن الذي لعنه الله؟ هم هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل من اليهود والنصارى.
﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ فجمع له سوءتين: الطرد من الرحمة، واستحقاق العذاب؛ لأن الغضب موجبه أن ينزل به العذاب، فهم مُنعوا من الرحمة، وحلّ عليهم العذاب، وكان يكفي واحدة من هاتين العقوبتين، لكن جمع الله لهم هاتين العقوبتين، جمع لهم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الطرد من الرحمة والمنع منها، وأضاف إليهم الغضب: ﴿وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾.
﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ وهـٰذه عقوبة معجَّلة في الدنيا يدركها بنو إسرائيل، وهم يقرون بها لا ينكرونها، فإنهم يقرون بأنَّ جماعةً منهم مُسخوا قردة وخنازير. ومسخهم على هذين الصنفين من الدواب له حكمة بالغة:
فالقرد أقرب ما يكون شبهًا بالإنسان، والخنزير من أقبح الحيوانات وأرذلها وأوقعها على القاذورات، فهم وإن شابهوا الإنس في صورهم، لكنهم في الحقيقة قلوبهم قلوب هـٰذه البهائم، فلهم شبه بها.
﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾. والعطف هنا في قوله: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ على قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ وليس على القردة، بل هو معطوف على قوله: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ وبهـٰذا يستقيم المعنى، ومن جعله معطوفًا على القردة لم يأت بالمقصود من الآية؛ لأن المقصود من الآية هل هو الإخبار بأنَّ ما وقع منهم من العبادة للطاغوت بمشيئة الله؟ هل هـٰذا هو المقصود من الآية؟ أم المقصود ذمهم بما وقع منهم من العبادة لغير الله؟
المقصود: الذم، وإذا قلنا: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ أي: وجعل منهم عبدة الطاغوت، ففي الحقيقة هـٰذا خبر لا ذمَّ فيه، لكن لمَّا كان المقصود ذمهم، وبيان سوء أعمالهم كان العطف في المناسب على المعنى على قوله تعالى: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾.
ثم إنَّه أيضًا من حيث السياق ﴿عَبَدَ﴾ فعل ماضٍ، والأصل في العطف في الغالب أن يتعاطف على التشابه في المتعاطفات، فلو عطفناه على ﴿الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ كان عطف فعل على اسم، فهو من حيث اللفظ ومن حيث المعنى لا ينبغي الوصل، بل ينبغي الوقف وإعادة العطف على قوله: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾.
﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾. الطاغوت هنا كما تقدم: اسم لكل ما عُبد من دون الله عز وجل، فيشمل عبادتهم للرهبان، ويشمل عبادتهم للأحبار، ويشمل عبادتهم لعُزَيْر، ويشمل عبادتهم لعيسى، ويشمل عبادتهم للصالحين والأنبياء منهم، وأيضًا يشمل عبادتهم للعجل في حق اليهود.
والفائدة من هـٰذه الآية ما هي؟ أن الشركَ وقع في مَن قبلنا.
وقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾( ).
﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِم﴾ هـٰذا في خبر أصحاب الكهف.
﴿عَلَى أَمْرِهِم﴾ على أمر الناس في ذلك الزمان، والذين يغلبون على الأمر هم الكبراء والعظماء والمُقَدَّمون والرؤساء، هؤلاء الملأ لما وجدوا هؤلاء الصالحين على هـٰذه الهيئة، لفترة طويلة، قالوا: ﴿لنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾. اللام هنا موطئة للقسم، يعني: أكَّدُوا اتخاذهم المسجد على هؤلاء بالقسم، وتقديرُ القسَم: والله ﴿لنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم﴾ على أصحاب الكهف ﴿مَّسْجِدًا﴾ أي: محلاًّ للعبادة، ومكانًا للسجود.
وقد اختلف أهل التفسير في هـٰذا القائل، هل هم مسلمون أو كفار؟
فمنهم من قال: إنه قول الكفار.
ومنهم من قال: إنه قول المسلمين في ذلك الوقت.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه قول النصارى الذين لعنهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).
فهـٰذا من فعل النصارى؛ لأن أصحاب الكهف من بني إسرائيل، فعلى هـٰذا يكون فعل المسلمين، ومعلوم أن هـٰذا الفعل من أسباب الشرك، وتقدم لنا أنه قد يكون كبيرة وقد يكون كفرًا وشركًا، اتخاذ المساجد على القبور ليس في كل صوره مُخرجاً عن الملة، بل منه ما هو كبيرة، ومنه ما هو كفر وشرك، كما تقدم.
والذي أفادته هـٰذه الآية؛ أي شيء؟ ماذا أفادت هـٰذه الآية؟
أفادت أن الشرك وقع في الأمم السابقة، إذًا هل في هـٰذه النصوص من القرآن الكريم دلالة على وقوع الشرك في هـٰذه الأمة؟
لا، هـٰذه النصوص ليس فيها دلالة على أنَّ الشرك سيقع في الأمة، ما فيه شك أن فيه التحذير من فعل هؤلاء؛ لأنَّه فعل استوجبوا الذمَّ من أجله، لكن هل فيه إفادة بأنَّه سيقع في هـٰذه الأمة؟ لا، إنما هـٰذا يتبين من الحديث الذي ساقه المؤلف –رحمه الله- وفيه قال: (عن أبي سعيد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة)). )
((لتتبعن)) اللام هنا موطئة للقسم، والقسَم مُقدر تقديره: والله لتتبعن، يُقسِم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على وقوع هـٰذا الأمر، وهـٰذا خبر عن أمر مستقبل.
((لتتبعن)) وأيضًا هناك تأكيد، هـٰذا أُكِّد بالقسم وباللام وبالنون في قوله: ((لتتبعن)) فالنون هنا للتوكيد.
((سنن من كان قبلكم)) أي: طرق وسبل من كان قبلكم، ولم يبيّن رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث من الذين قبلنا؟
فيحتمل أنهم: اليهود والنصارى، ويحتمل أنّهم: فارس والروم؛ لأن هـٰذه هي الأمم التي أدركها المخاطَبون بهـٰذا الخطاب في ذلك الوقت، ويتبين من خاتمة الحديث من هم.
((حذو القذة بالقذة)) يعني: كما تحاذي القذة القذة، والقذة هي رياش السهم، يوضع في مؤخرة السهم قذة من جانب ويوضع في مقابلها من الجهة الأخرى قذة أخرى، فتكون القذة مقابلة للقذة، ومساوية لها في الطول وموافقة لها في الموضع، والسبب في هـٰذا لتحفظ توازن السهم.
فكذلك هـٰذه الأمة سيكون منها متابعة لأولئك كما أن صانع السهم يحرص على أن تتابع القذة القذة في الشكل والموضع، فكذلك هـٰذه الأمة سيكون منها متابعة لمن تقدَّم من الأمم في الموضع والشكل، يعني: في نوع المخالفة العام؛ في جنس المخالفة، وفي أفراد المخالفات.
ولتأكيد ذلك قال: ((حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه)). حتى هنا للغاية، أي: إلى أن يصل الأمر بالمتابعة أنهم لو دخلوا جحر ضبٍّ، وما الذي يرجوه الإنسان في جحر الضب؟ لا يرجو خيرًا بل يخشى عَطبًا؛ لأن جحر الضب مأوى للعقارب والآفات والهوام، ومع ذلك ((حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه)). أي: لحصل منكم موافقتهم ومتابعتهم في دخوله.
(قالوا: يا رسول الله). القائل الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.
(اليهود والنصارى) يعني: من قبلنا الذين ذكرتهم في الحديث اليهود والنصارى؟ قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فمن))؟ يعني: إن لم يكونوا أولئك فمن هم؟
لأن هـٰذه الأمم هي الأمم التي سبقت ولها كتاب ومحلُّ الأسوة من بعض أهل الإسلام؛ لأنهم يتأسون بهم ويقتدون بهم.
قال: ((فمن))؟ في رواية أخرى في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لتسلكن مسالك من كان قبلكم -أو مسالك الأمم قبلكم- شبراً بشبر وذراعًا بذراع. قالوا: من يا رسول الله؟ قالوا: فارس والروم؟ قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فمن الناس إلا أولئك؟)). يعني: من الناس الذين يتبعون ويقتدى بهم إلا أولئك؟ والروم هم النصارى، وفارس هم المشركون.
فأضافت الرواية الثانية رواية أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنَّ من الأمة من يتابع حتى أمم الشرك، وقد وقعت المتابعة في هـٰذه الأمة للأمم السابقة، لليهود والنصارى ولأهل الشرك.
ومن الأصول المقررة الملاحظة في كثير من أحكام أهل الإسلام أنَّ الشارع قصد مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، ولذلك تجد كثيرًا من الأحكام في الشريعة معللة بقصد المخالفة.
فقصد المخالفة أمر ظاهر يدركه الإنسان من أدنى نظر في تفاصيل الأحكام، وهـٰذا لِما في متابعتهم من الشّر والسوء، وقد قرر هـٰذا شيخ الإسلام –رحمه الله– تقريرًا واضحًا جليّاً بين في كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" .
بل إنه قال –رحمه الله–: إنَّ النصوص دلت على النهي عن مشابهة كل ناقص حتى ولو لم يكن كافرًا، فنهت النصوص عن مشابهة الأعراب، نهت النصوص عن مشابهة الحيوانات، نهت النصوص عن مشابهة أهل الفسق والمعاصي، فكل من كان ناقصًا في الدين والتقوى كان النهي منصبّاً على مشابهته، وجاءت النصوص بالنهي عن مشابهته.
هـٰذا الحديث يدل بمفهومه العام على أنَّ الأمة ستوافق الأمم السابقة في كل ما وقعوا فيه من اللوثات والمخالفات والمعاصي، الصغير والكبير.
وقد تقدَّم في النصوص السابقة في الآيات أنَّ الشرك وقع فيه أهل الكتاب من قبلنا، فهـٰذه الأمة يقع فيها من الشرك ما وقع في الأمم السابقة.
إذًا دلالة هـٰذا الحديث على أن بعض هـٰذه الأمة يعبد الأوثان دلالة بالنص أو باللازم؟ باللازم؛ لأنه لم ينص هنا على أنَّ الأمة تقع في الشرك، إنما دلَّ الحديث على أنَّ الأمة تتبع سنن من كان قبلها وطرق من كان قبلها، ومن طرق من كان قبلها الوقوع في عبادة الطاغوت، فمن لازم هـٰذا أن تكون الأمة موافقة لهم في هـٰذا الأمر، فهـٰذا من النصوص الدالة على أن بعض الأمة يعبد الأوثان على وجه العموم.
أما على وجه الخصوص فما أتى به المؤلف –رحمه الله– في حديث ثوبان، وهـٰذا من بديع تصنيفه –رحمه الله– أنه دلل على الترجمة بما هو عام، ثم أتى بنص خاص، والنص الخاص يقطع النزاع، يرفع توهم أنَّ هـٰذا لا يقع في الأمة.
يقول رحمه الله: (ولمسلم عن ثوبان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن الله زوى لي الأرض)) ) زوى أي جمع، كيف زوى؟ الله أعلم، لكن نؤمن بما أخبر به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- زوى له الأرض، والأرض هنا تصدق على جميع ما نحن عليه، فلا يستثنى منها طرف.
قال: ((فرأيت مشارقها ومغاربها)) ((رأيت مشارقها)) يعني: جهات الشروق فيها ((ومغاربها)) جهات الغروب.
وقال: ((مشارقها))، لأن الأرض لها مشارق متعددة وليس مشرقًا واحدًا، فمشارقها متعددة، الشمس كل يوم تخرج من مكان لا تعود إليه في اليوم الثاني، إلا من العام القادم في نفس يومها، فلها مشرق ومغرب كل يوم –سبحان الخلاق العليم– كل يوم تشرق من مكان لا تعود إليه إلا في العام القابل، وهكذا حتى ينقضي العام، فرأى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مشارق الأرض ومغاربها.
قال: ((وإن أمتي)) والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أمة الإسلام .
((سيبلغ ملكها)) أي سلطانها ونفوذها.
((ما زوي لي منها)) أي ما جمع لي منها، وبهـٰذا نعلم أنَّ الإسلام سيعم الأرض كلها بلا استثناء.
وما قاله بعض شراح الحديث -من أن امتداد الإسلام فقط في المشرق والمغرب لأنه لم يذكر الشمال والجنوب- فهم فيه نظر في الحقيقة، فيه نظر من حيث دلالة الحديث عليه، وأيضاً من حيث دلالة حديث آخر عليه.
أما من حيث دلالة الحديث هـٰذا عليه: فإنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((فرأيت مشارقها ومغاربها)) ومعلوم أن ما من بقعة في الأرض إلا وتشرق عليها الشمس وتغرب، وإن كان الشروق والغروب متفاوتاً، حتى إن بعض المناطق لا تشرق عليها الشمس إلا مرة واحدة في السنة، تمكث ستة أشهر ثم تغيب ويبقون ليلاً إلى ستة أشهر، لكن ما من مكان إلا سيبلغه هـٰذا الدين.
ويدل عليه أيضاً قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -فيما رواه الإمام أحمد بسند جيد، قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ--: ((ليبلغن هـٰذا الأمر ما بلغ الليل والنهار)) يعني كل مكان يبلغه الليل والنهار فإنه سيبلغه هـٰذا الأمر أي هـٰذا الدين ((ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هـٰذا الدين)). وهـٰذا يفيد العموم، وأما كون المشرق والمغرب هو الأكثر انتشارًا فلا يعني أنه لا يصل إلى الجهات الأخرى شمالاً وجنوبًا.
المهم على كل حال هـٰذه بشارة من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهـٰذه الأمة بالعز والسناء، وأنها ستبلغ الآفاق، وهـٰذا ما وقع ولله الحمد، فأينما توجهت تجد أن هـٰذا الدين قد بلغ تلك الجهات، وهـٰذا من فضل الله ومن رحمته بهـٰذه الأمة ومن رحمته بالناس.
قال: ((وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض)) والمعطي هو الله –سبحانه وتعالى– ولم يبينه للعلم به.
و((الكنزين)): يصدق على المال والملك.
((الأحمر)): مال وملك الروم.
و((الأبيض)): مال وملك فارس.
((وإني سألت ربي)) بعد هـٰذه البشائر أخبر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه سأل الله – جل وعلا –، وفيه فاقة رسول الله لربه وأنه محتاج إليه كسائر الناس، يسأل الله – عز وجل – لا يسأل غيره.
((إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة)). يعني: ألا ينزل بها هلاكًا عامّاً بسنة قحط وجدب تهلك به الأمة، قحط وجدب عام تهلك به الأمة، فأعطاه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هـٰذه المسألة كما دلَّت عليه النصوص.
((وأن لا يسلِّط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم)) يعني عدوّاً من غيرهم، والمراد بغير هـٰذه الأمة أهل الكفر على اختلاف مللهم وأجناسهم من اليهود والنصارى والمشركين.
((لا يسلط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم)) أي: فيأخذ ملكهم وما في حوزتهم على وجه العموم، ولا يعني هـٰذا ألا تقتطع أطراف من الأمة، لكن الذي سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربه ألا تستباح البيضة وتنتهك حرمة وحوزة الإسلام، فلا يبقى للمسلمين دار ولا قرار.
قال: ((وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاًء فإنَّه لا يُرد)). وهـٰذا فيه إثبات القول لله عز وجل وفيه إثبات القضاء، وأن قضاءه –جل وعلا– لا رد له، إذا قضيت قضاءً، هـٰذا القضاء يشمل القضاء الشرعي والقضاء الكوني، لكنه هنا في ما يظهر من السياق المراد به القضاء الكوني.
((إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد)) أي لا يمكن رده ولا يقدر أحد على رده، والمراد بالقضاء الذي لا يرد هنا القضاء المبرم الذي قضى الله أنه لا يرد، لكن قد يقضي الله عز وجل أمراً معلقًا على شيء فلا يمضي هـٰذا القضاء؛ لوجود الشرط الذي يعطله، كأن يقضي الله -عز وجل- على شخص بالموت في أربعين سنة إن لم يصل رحمه، فإن وصل فيموت في خمسين، فهـٰذا قضاء يرد أو لا يرد؟ يرد؛ لأنه رده الشرط، ومنه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يرد القضاء إلا الدعاء)) كما في السنن وهو حديث صحيح، فأفاد أن القضاء يرد، لكن القضاء الذي يرد -انتبه!- هو القضاء غير المبرم.
أما القضاء المبرم فلا رادّ له، كما قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في هـٰذا الحديث: ((يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)) أن القضاء الذي لا يرد هو القضاء المبرم، وهو المنعقد الذي لا تعليق فيه، وأما القضاء المعلَّق بسبب فإنه قد يرد، لكن هـٰذا لا باعتبار علم الله عز وجل، بل هو باعتبار المكتوب، فإنَّ المكتوب قد يكون ثابتاً وقد يكون مما يلحقه المحو، فالله عز وجل يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾( ) فيمحو الله –جل وعلا– من هـٰذه الأقدار ما يشاء ويثبت ما يشاء.
فالمبرم والمعلق هو باعتبار أي شيء يا إخواني؟ باعتبار المكتوب، أما باعتبار القضاء نفسه وما أراده الله عز وجل فإنه لا راد لقضائه سواء كان مبرماً أو معلقاً، يعني القضاء الذي هو فعل الله الذي يقع لا راد لقضائه، فإذا قضى الله أمراً فلا بد أن يقع، وأما مسألة الإبرام وعدم الإبرام فهـٰذا في ما يتعلق بالمكتوب.
يقول: ((وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة)) فأجابه الله -عز وجل- إلى الأمر الأول، وهو أنه أمّنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقع الهلاك لأمته في عام يجتثها، إما بجدب أو بغير ذلك من أسباب الهلاك، ولكن في الغالب وفي إطلاق السنة على قحط المطر وجدبه.
((وألا يسلط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم)). هـٰذا إجابة إلى ثانية المسائل، وهي أن الله سبحانه وتعالى أجاب رسوله في ألا يسلط على هـٰذه الأمة عدوّاً من غيرهم.
((فيستبيح بيضتهم)) أي يأخذ ما بأيديهم من الأراضي، وهـٰذا من رحمة الله عز وجل بالأمة.
ومن نظر إلى تاريخ الأمة يجد أنَّ ما أخبر به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث من إجابة الله -عز وجل- له في المسألتين، أنه واقع ومطابق للواقع، فإنَّ الأمة لم تهلك بسنة بعامة ولله الحمد، وكذلك لم يسلَّط عليها عدوٌّ يستبيح ما في أيديها، حتى في غزو التتار الذي اجتيحت فيه الخلافة إلا أنه بقي كثير من بلاد المسلمين في أيديهم ولم تستبح بيضتهم.
يقول: ((ولو اجتمع عليهم من بأقطارها)) ولو اجتمع على هـٰذه الأمة من بأقطارها على اختلاف مذاهبهم ومللهم وعقائدهم وعداواتهم، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- حافظ هـٰذه الأمة.
لكن قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً))؛ ((حتى)) هنا هل هي للغاية أو هي للعطف؟
إذا كانت للغاية فيكون التأمين من تسليط العدو على الأمة فيستبيح بيضتهم معلقاً بهـٰذا الأمر، وهو ألا يتسلط بعضهم على بعض، فإذا وقع تسلط بعضهم على بعض فإن الله -عز وجل- قد يبتلي الأمة بمن يجتاحها ويستبيح بيضتها، وهـٰذا أحد المعنيين في ((حتى)).
الثاني: أنها عاطفة، فيكون المعنى: ولكن الذي يقع هو أن بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا، فيكون إخباراً عن ما يقع في الأمة من خلاف وشقاق واضطراب، وهـٰذا يصدقه الواقع منذ أزمان بعيدة من أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، والأمة وقع تسليط بعضها على بعض.
والظاهر في المعنى هو المعنى الثاني: أنها للعطف وليست للغاية؛ لأنه لم يقع أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- سلط عدوّاً على الأمة يستبيح بيضتها، حتى في مراحل الضعف ومراحل التدهور لم يقع أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- سلط على الأمة من يستبيح بيضتها ويأخذ جميع ما في يدها، بل بقيت ولله الحمد بلاد كثيرة من بلاد المسلمين تحت أيديهم، هم الذين يحكمونها وهم الذين يتصرفون فيها.
والشاهد من هـٰذا الحديث لم يأت؛ لأن الشاهد هو أن من هـٰذه الأمة من يعبد الأوثان، وهو في ما رواه البرقاني في صحيحه، قال المؤلف –رحمه الله– بعد ذكر رواية مسلم: (ورواه البرقاني) وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي (روى البرقاني في صحيحه هـٰذا الحديث وزاد عليه: ((وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)) ). ((وإنما أخاف)): وهـٰذه أداة حصر، فبين رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن ما يخافه على أمته ليس ما تقدم مما جرى منه التأمين، وهو ألا يسلِّط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا يهلكهم بسنة بعامة ((إنما أخاف على أمتي)) والمقصود بالأمة: أمة الإجابة ((الأئمة المضلين)) الأئمة جمع إمام، وهو من يُتّبع، ويصدق هـٰذا على كل من كان إماماً للناس يقتدى به ويصدر عن قوله وأمره، سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا.
يعني ((الأئمة المضلين)) يشمل العلماء ويشمل من بيدهم السلطة وتصريف الأمور، يخاف رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الأمة الأئمة المضلين؛ لأنهم يحصل بضلالهم وإضلالهم شر كثير، ولم يقل فقط: الضالين بل المضلين، يعني الذين يسعون في إضلال الناس، وهـٰذا أمر زائد على الضلال، وإن كان الضلال قبيحًا لكن القبح يزداد والشر يتفاقم إذا كان هـٰذا الإمام داعيًا إلى الضلالة.
((وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة)) إذا وقع عليهم السيف بقتل بعضهم لبعض لم يرفع إلى يوم القيامة، أي لا يحصل ارتفاعه عن الأمة حتى يأتي يوم القيامة، وهـٰذا فيه أن الخلاف في الأمة باقٍ، وأنه لا يرتفع حتى تقوم القيامة.
يقول: ((ولا تقوم الساعة)) هـٰذا الشاهد ((حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين)) والحي يطلق على الجماعة الكبيرة من الناس، ويصدق هـٰذا على الجهات والقبائل، الجهات في الأماكن والقبائل في الأنساب، فكل هؤلاء يصدق عليهم حي، وقوله: ((حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين)) وهـٰذا فيه -فيما يظهر- أنهم يلحقون وهم يظنون أنهم على الإسلام وينتسبون إليه، وذلك من قوله: ((من أمتي)) حيث إنه لم يخرجهم من الأمة، وإنما لحقوا بالمشركين مع بقائهم وانتسابهم إلى الإسلام.
وهـٰذا ما يجري في كثير من بلاد المسلمين من الذين يطوفون على القبور ويدعون المقبورين ويستغيثون بهم ويذبحون لهم، هؤلاء لحقوا بالمشركين في الأفعال وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام.
((وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان)) وهـٰذا فيه تعميم، يعني ليس فقط الشرك الذي يقع في الأمة أو الشّر الذي يقع في الأمة بأن يلحق بعض هـٰذه الأمة أو أحياء من هـٰذه الأمة بالمشركين في أفعالهم التي هي دون الشرك الأكبر، بل حتى في الشرك الأكبر.
فقوله: ((وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان)) هـٰذا فيه بيان منتهى اللّحوق، وأنه يلتحق حيّ من الأمة بالمشركين، وينتهي هـٰذا اللّحوق وهـٰذا الاتّباع من الأمة للمشركين حتى يحصل من بعض الأمة عبادة الأوثان، ولذلك قال: ((حتى تعبد فئام من أمّتي الأوثان)).
ثم قال: ((وإنه سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون)). وهـٰذا خبر من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيه بيان أنه ستبتلى الأمة بهـٰذا العدد من الكذابين، وليس المراد من يكذب كذباً سهلاً إنما المراد من يكذب كذباً عظيماً يحصل به شر كبير للناس، وإلا فالكذابون أكثر من هـٰذا العدد، لكن حصرهم بهـٰذا العدد هو للذين عظم كذبهم وشرهم وفسادهم في الأرض.
((كلهم يزعم أنه نبي)) يعني: هؤلاء الثلاثون يدّعون النبوة ويكون لهم شأن كما ذكرنا، وإلا فالمدعون عبر التاريخ بالنبوة أكثر من هـٰذا العدد.
ثم قال: ((وأنا خاتم النّبيين)) هـٰذا فيه بيان كذبهم، وأنه لا نبي بعد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- ،كما قال الله جل وعلا: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾( ) فهو خاتم النبيين -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا نبي بعده.
قال -بعد ذكر هـٰذه الأمور التي يَجِلُ منها القلب ويخاف منها الإنسان على الشريعة الاندراس والعفو والزوال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)). وهـٰذا فيه البشارة للأمة، وفيه تصديق ما أخبر الله –جل وعلا– به من أن هـٰذه الأمة محفوظ كتابها، وأن هـٰذه الأمة محفوظ شرعها ودينها، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾( ). فالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- تكفل بحفظ هـٰذه الشريعة وهـٰذا الكتاب المبين الذي هو مصدر التشريع لهـٰذه الأمة، حفظه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من الزوال، وحفظه من التبديل والتغيير والتحريف الذي يزول به الحق.
جرى على الكتاب تبديل وتحريف كغيره من الكتب، لكن الذي امتاز به القرآن أن التبديل والتغيير لم يتطرق إلى ألفاظه، وأن معانيه محفوظة بحفظ هـٰذه الألفاظ.
((ولا تزال طائفة من أمتي)) والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة وأمة الاتباع، وهم أخص من أمة الإجابة، ((على الحق منصورة)) أي متمكنين من الحق، لذلك قال: ((على الحق))، والعلو يقتضي التمكن والقرار، على الحق منصورة فهم منصورون، ((لا يضرهم من خذلهم)) وفي الحديث الآخر قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((على الحق ظاهرين)) وهـٰذا بيان لمعنى النصر وهو الظهور والعلو، وأنه لا تزال طائفة من أمة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظاهرين مقيمين الحجة على الخلق وعلى أهل الزمان، فلا يخلو زمان من الأزمان من قائم لله بالحجة.
((لا يضرهم من خذلهم)) وهـٰذا يدل على أن هناك من يخذلهم ويسعى في إضعافهم وإذهاب ظهورهم ونصرهم، لكن هـٰذا لا يضرهم، فنصرهم ثابت وظهورهم مؤكد ومستقر لا يضره كيد كائد ولا خذلان خاذل.
وإلى متى يكون هـٰذا الأمر؟ قال: ((حتى يأتي أمر الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-))، هـٰذا الظهور وهـٰذا البقاء لهـٰذه الأمة ممتد حتى يأتي أمر الله تعالى، ولم يبين الحديث أمر الله عز وجل، وقد جاء ذلك في أحاديث أخرى، فالأمر الذي جعل غاية لبقاء هـٰذه الطائفة ظاهرة منصورة هو الريح التي يبعثها الله عز وجل فتقبض أرواح المؤمنين، فلا تدع مؤمناً إلا امتدت إليه وكانت سبباً لقبض روحه، وبه يكون منتهى هـٰذه الطائفة التي أخبر عنها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
والشاهد من هـٰذا الحديث هو قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان)).
نقرأ المسائل:
[المتن]
فيه مسائل
الأولى: تفسير آية النساء.
[الشرح]
تقدم هـٰذا.
[المتن]
الثانية: تفسير آية المائدة.
الثالثة: تفسير آية الكهف.
الرابعة: وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
[الشرح]
الجواب الثاني يشمل الأمرين، الإيمان بالطاغوت درجات: منه ما يكون باعتقاد القلب، ومنه ما يكون بموافقة أصحابها مع بغضها -أي مع بغض الجبت والطاغوت- ومعرفة بطلانها، وهـٰذا من قوله تعالى: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾( ). فهؤلاء عبدوا الطاغوت أيضاً، ومن قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾( ). وهو في الآية الأولى أظهر؛ لأن هؤلاء أوتوا نصيبًا من الكتاب، وإيتاؤهم نصيبًا من الكتاب يقتضي أن عندهم علمًا يعرفون به الحق من الباطل ويميزون به الغي من الرشاد، ومع ذلك حصل منهم الإيمان بالجبت والطاغوت، ويوضح هـٰذا سبب نزول هـٰذه الآية، فإن المشركين قالوا لأهل مكة- لما سألوهم: أي الأمرين أو الحالين أحسن: ما نحن عليه أو ما يدعو إليه محمد؟ فقالوا-: ما أنتم عليه، مع علمهم بصدق ما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومع علمهم بأن ما عليه أهل مكة من الكفر والشرك باطل، ومع ذلك جعل الله عز وجل هـٰذه الشهادة منهم إيماناً بالجبت والطاغوت.
فالإيمان بالجبت والطاغوت يكون باعتقاد القلب، ويكون أيضاً بموافقة أصحابها ولو كان مبغضاً لها وكارهاً ويعلم بطلانها، لكنه وافقهم لمصلحة وحاجة، ففي هـٰذه الحال يكون مؤمناً بالطاغوت.
[المتن]
الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين.
[الشرح]
هـٰذا من الآية الأولى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾( ).
[المتن]
السادسة- وهي المقصود بالترجمة- :أن هـٰذا لا بد أن يوجد في هـٰذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعيد.
[الشرح]
(أن هـٰذا) المشار إليه الشرك والإيمان بالجبت والطاغوت وعبادة الطاغوت، كل هـٰذا لا بد أن يكون في الأمة؛ لحديث أبي سعيد، وهو قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)).
[المتن]
السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هـٰذه الأمة في جموع كثيرة.
[الشرح]
وذلك من قوله: (حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين)، ومن قوله: (وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان) وفئام يطلق على الجماعات الكثيرة.
[المتن]
الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار –عفا الله عنه– مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هـٰذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين، ومع هـٰذا يصدق بهـٰذا كله مع التضاد الواضح.
[الشرح]
وهـٰذا يفيد أنه من تكلّم بالشهادتين واعتقد مضمونهما ظاهراً فقد يقع منه ما يُخالف هاتين الشهادتين، وينقض هاتين الشهادتين، فالواجب على المؤمن التحري في تحقيق هاتين الشهادتين، وألا يأتي بما ينقضهما ويخالفهما، فهـٰذا المختار هـٰذه حاله: يتكلم بالشهادتين ويصرح بأنه من هـٰذه الأمة، ويقر للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة ويؤمن بأنه خاتم النبيين، ومع ذلك يدّعي النبوة، وهـٰذا الادعاء نقض لما تقدم أو لأكثر ما تقدم، وعلى هـٰذا فإنّ التكلم بالشهادتين لا يحمي الإنسان من أن يكون من أهل الكفر إذا أتى بما ينقض هاتين الشهادتين ويخالف مقتضاهما.
لكن ليس كل ناقض يلحق الإنسان بالكفر، وهـٰذه مسألة مهمة، فإن النواقض منها ما يعود على الأصل بالإبطال ومنها ما هو دون ذلك، فيجب على المؤمن أن يتحرّى في ذلك، والقاعدة التي ينبغي أن يستمسك بها طالب العلم في هـٰذا الأمر أن من ثبت إيمانه بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا ينقل عنه إلا بيقين؛ لأن التّسرّع في التكفير من أشد ما يكون وأخطر ما يكون، كما أن ترك تكفير من كفره الله ورسوله خطير أيضاً، لكن العمل بالأصل لا شك أنه هو المخرج من هـٰذه المضايق، فإذا اشتبه على الإنسان الأمر هل هـٰذا مكفر أو ليس بمكفر؟ ثم هل هـٰذا المعين كافر أو ليس بكافر؟ فإنه يجب عليه أن يُعْمِل الأصل، وهو: من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا ينقل عنه إلا بيقين، لا في أصل الفعل، يعني في الحكم على الأصل بالكفر، أو بالحكم على المعين بالكفر.
عندنا أمران في موضوع التكفير:
الحكم بكفر الفعل، هـٰذا يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة.
الأمر الثاني: تنزيل هـٰذا العام على الشخص، هـٰذا أيضاً لا بد فيه من التحري والتأني؛ لأنه قد يكون الإنسان فاعلاً للمكفر وليس بكافر؛ لوجود مانع أو فوات شرط.
المسألة تحتاج إلى تحرير وتدقيق وتأمل، ولا يغتر الإنسان بكلام العلماء في قولهم: من قال كذا فهو كافر، فهـٰذا حق على حقيقته؛ لأنه تكفير للفعل لا للفاعل، بعض الناس يظن أن قولهم: من قال كذا كافر، يعني: كل من تكلم، بغض النظر عن هل هو معذور أو غير معذور، هل توافرت الشروط؟ هل انتفت الموانع؟ ويوقع هـٰذا في لوثة التكفير، وهي مسألة خطيرة وكبيرة.
[المتن]
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
[الشرح]
وهـٰذا من -رحمة الله- بهـٰذه الأمة بل بالناس جميعاً؛ لأن بقاء الحق بينهم ولأن بقاءه ظاهرًا أيضاً من أسباب الأمان من الوقوع في الشرك والمضلات، وأن الحق لا ترفعه القوة، مهما عتت القوة فإنها لا ترفع الحق؛ لأن الحق أقوى من الباطل مهما بلغ في قوته، قال الله جل وعلا: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾( )، وقال في آية أخرى: ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾( ) يعني: هـٰذا وصف ذاتي للباطل، مهما أوتي من قوة مادية وأوتي من قوة إعلامية وأوتي من قوة معنوية فإنه زهوق، يزهق سريعاً ويضمحل سريعاً، بخلاف الحق، فإن بقاءه وثباته ظاهر ولا يتزعزع، بل هو راسٍ رسوّ الجبال، الله يثبتنا وإياكم على الحق.
[المتن]
العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
[الشرح]
وهـٰذا لا يكون إلا بتأييد الله -عز وجل- ونصره، فإنهم مع قلتهم وقلة ذات يدهم وكثرة خصومهم إلا أن الله –جل وعلا– كتب لهم البقاء، فبقاؤهم بإبقاء الله عز وجل، وإلا لو نظر الإنسان للأسباب المادية لكان زوال الحق منذ أزمان بعيدة؛ لكثرة المتسلط على الحق والدّاعي للباطل، لكن الله –جل وعلا– يحفظ هـٰذا الدين ويعلي رايته، ويبعث من يجدده على رأس كل مائة سنة، والله -عز وجل- حافظ دينه وناصر أهله وأولياءه.
فالدين ممتحن ومنصور فلا
تعجب فهـٰذي سنة الرحمـٰن
كما قال ابن القيم رحمه الله.
[المتن]
الحادية عشرة: أنّ ذلك الشّرط إلى قيام الساعة.
[الشرح]
شرط وهو الحفظ والبقاء على هـٰذه الصّفة من الظهور والنصر حتى يأتي أمر الله، وفي رواية ثانية: حتى تقوم الساعة.
[المتن]
الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب،وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبره، بخلاف الجنوب والشمال.
[الشرح]
تكلمنا على هـٰذا وقلنا: إن الجنوب والشمال داخل في المشارق والمغارب؛ لأنه ما من مكان إلا وله مشرق ومغرب في الشمال والجنوب، وإنما ذكر المشرق والمغرب لأنه أمر يدركه كل أحد بخلاف الجنوب والشمال، فإنه يخفى على من لا يعرف الجغرافيا ولا يعرف الجهات، أما الشمس فشروقها وغروبها يدركه العالم والعامي، الصغير والكبير، الحاضر والبادي، الجاهل والمتعلم، كلٌّ يدرك مشرق الشمس ويدرك مغربها.
[المتن]
وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هـٰذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هـٰذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
[الشرح]
كل هـٰذه آيات للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأنّ الآية هي البرهان الدال على صدق من جرت له هـٰذه الآية، وكل هـٰذه براهين دالة على صدقه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؛ لأنها وقعت موافقة لما أخبر به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-.
[المتن]
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
[الشرح]
وذلك لشدة الضرر بهؤلاء، ولا يعارض هـٰذا قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أخوف ما أخاف عليكم الدجال)) فإن الدجال من الأئمة المضلين.
[المتن]
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
[الشرح]
نعم وأنه لا يقتصر فقط على صورة معينة، بل يشمل كل صرف عبادة لهؤلاء، فكل من صرف عبادة لهؤلاء فإنه قد وقع في عبادتهم، ومن عبادتهم موافقة أصحاب هـٰذه الأصنام على ما هم عليه من الشرك والكفر؛ لأن ذلك إيمان بالطاغوت، كما تقدم.
والطائفة المنصورة هل هي في جهة من الجهات أو بلد من البلدان أو مكان من الأماكن؟ الجواب: هي في عموم الأمة وفي عموم جهاتها، قد تكون في جهة أقوى منها في جهة أو أظهر منها في جهة، قد تخلو منها جهة من جهات الأمة لكن هي في عموم الأمة موجودة، وتكون في العلماء وفي المجاهدين وفي سائر الأمة، ولكن أولى النّاس بانطباق هـٰذا الوصف عليهم هم أهل العلم، ولذلك لما سئل الإمام أحمد –رحمه الله– عن الطائفة المنصورة قال: هم أهل الحديث، وهم أهل العلم؛ لأنّ الحديث هو الذي يشتغل به طلاب العلم في ذلك الوقت، وإلا فأهل القرآن أشرف، لكن لما كان المشتغلون بالعلم يشتغلون بحفظ الحديث وفهمه وجمعه كان عَلَماً عليهم، والمراد بكلام الإمام أحمد هم أهل العلم، وغيرهم ممن هو دونهم فإنه منهم، كما قال الإمام النووي رحمه الله.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الخامس عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في السحر
وقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾( ) وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾( ).
قال عمر: (الجبت): السحر، (والطاغوت): الشيطان.
وقال جابر: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان، في كل حي واحد.
وعن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)).
وعن جندب مرفوعاً: ((حد السّاحر ضربه بالسيف)) رواه الترمذي، وقال: الصّحيح أنه موقوف.
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
وصح عن حفصة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت، وكذلك صح عن جندب.قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في السحر) ولم يبيّن المؤلف –رحمه الله– حكم السحر لأنه سيتبين أنه أنواع وأن لكل نوع حكماً.
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد واضحة؛ لأن من السحر ما لا يكون إلا بالشرك، فإذا كان لا يكون إلا بالشرك فإنه من قوادح التوحيد، فاحتاج إلى أن ينبه إليه المؤلف –رحمه الله– بهـٰذه الترجمة، كما أن الفتنة به عظيمة.
أما مناسبته للأبواب التي قبله فلا يظهر لي مناسبة واضحة للباب الذي قبله، إنما بعد أن فرغ من ذكر نوع من أنواع الشرك انتقل إلى نوع آخر مستقل من أنواع الشرك وهو ما يتعلق بالسحر، فالشرك أنواع: منها ما يتعلق بتعظيم المقبورين، تعظيم الصالحين وقبورهم والعبادة عند قبورهم والفتنة بهم وبتماثيلهم، ومنها ما يكون بغير ذلك، فذكر ضربًا من ضروب الشرك التي يحصل بها الفتنة لكثير من الناس.
أما معنى السحر، بعد ذكر مناسبة الباب للكتاب ومناسبته لما تقدم فالسحر في اللغة: هو ما دق وخفي ولطف سببه، هـٰذا هو المعنى الذي تدور عليه هـٰذه المادة السين والحاء والراء، على اختلاف مواردها فهي تدور على هـٰذا المعنى.
وأما في الاصطلاح: فإنه ليس هناك حد ضابط للسحر، فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في تفسيره اختلافاً كبيراً متبايناً، وعلى ضوء هـٰذا الاختلاف في تعريفه اصطلاحاً وقع الاختلاف في حكمه؛ لأن منهم من يعرفه بما يكون كفراً، ومنهم من يعرفه بما يشمل الكفر وما دون الكفر، ولكن هـٰذه التعاريف على اختلافها وأنواعها تدور على المعنى اللغوي وهو: التوصل إلى شيء من الباطل من طريق خفيّ، والباطل قد يكون شركاً وقد يكون دون الشرك من المعاصي.
ذكر المؤلف –رحمه الله– في هـٰذا الباب آيتين وحديثين وأثراً.
أما الآيتان فقال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾( ).) هـٰذه الآية جزء من آية السحر التي ذكر الله –جل وعلا– فيها اتباع اليهود لما تتلوه الشياطين على ملك سليمان حيث قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾( ). فذكر الله – جل وعلا – في هـٰذه الآية اتّباع اليهود للسحر الذي تتلوه؛ أي تأخذه وتعمل به وتتبعه الشياطين ﴿عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ يعني في ملكه، وهـٰذا النوع من السحر حكم الله –جل وعلا– عليه بالكفر في قوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾( ). ومن هـٰذا نعلم أن السحر المأخوذ المتلقى عن الشياطين كفر أكبر؛ لأن الله حكم بكفر صاحبه حيث قال: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ ثم بين وجه الكفر فقال: ﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ فجعل تعليم السحر من الكفر، وتعلمه أيضاً من الكفر، ثم في خاتمة الآية قال جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾( ) ﴿عَلِمُوا﴾ أي علم اليهود الذين ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾، ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ أي لمن أخذه ﴿مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ أي ليس له في الآخرة من نصيب، وهـٰذه الآية أكد الله –جل وعلا– فيها الحكم المذكور بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدر في قوله: ﴿وَلَقَدْ﴾، واللام الموطئة للقسم، وقد، فهـٰذا كله تأكيد للحكم الذي تضمنته هـٰذه الآية، وهـٰذه الآية تفيد أن السحر كفر، لكن من استدل بهـٰذه الآية على أن جميع أنواع السحر كفر في استدلاله نظر؛ لأن الآية مذكورة في نوع منه، وهو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان، وأما ما عدا ذلك فإن في الاستدلال بهـٰذه الآية على أنه كفر نظراً، لا سيما وأن السحر ورد إطلاقه على ما ليس بكفر بلا إشكال، كالنميمة فإنه يطلق عليها السحر ولكنها ليست بكفر، وكما أطلق النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على البيان سحرًا فقال: ((إن من البيان لسحرًا)). ومعلوم أنه ليس كل بيان كفراً وإن كان يتضمن هـٰذا البيان قلب الحق باطلاً لكنه قد يكون دون الكفر، فلما كان إطلاق الشارع للسحر على ما ليس كفراً دل ذلك على أنه ليس كل سحر كفراً، وهـٰذا هو القول الصحيح في الكفر بالسحر: أنه لا يطلق القول بأن السحر كفر في جميع موارده أو في جميع أنواعه، ولذلك المؤلف –رحمه الله– بعد أن أجمل القول في بيان حكم السحر وحكم الساحر ذكر في الباب الذي يليه أنواع السحر، مما يدل على أن السحر ليس على رتبة واحدة في الحكم بالكفر، بل هو متفاوت: فمنه ما يكون كفراً، ومنه ما يكون دون ذلك.
﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ﴾ أي عند الله جل وعلا ﴿مِنْ خَلاقٍ﴾ وقال: ﴿فِي الآخِرَةِ﴾ لأنه يتبين فيها الخسران الحقيقي، وفي الدنيا أيضًا ليس له نصيب، فما يحصله إنما يحصل ضرراً، ولذلك قال الله جل وعلا: ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾( ) وهـٰذا يشمل ما يكون من المنافع في الدنيا وما يكون من المنافع في الآخرة، فإن الله –جل وعلا– نفى الفلاح عن الساحر، وهـٰذا النفي يشمل نفيه في الدنيا ونفيه في الآخرة، وإنما نص هنا على الآخرة لأنه بها يحصل التفاضل والتمايز بين الناس، وأما الدنيا فقد يحصّل الساحر من مقصوده ما يظن أنه حصّل به نصيباً، وأن له نصيبًا، لكن في الآخرة يتبين خسرانه، وقد قال الله جل وعلا في هـٰذه الآية: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ﴾ فبيّن أن تعلمه ضرر لا منفعة فيه، وأن ما يظنه السّاحر أو من يتعاطى السِّحر من المنافع ليس نافعًا في الحقيقة، بل هو ضرر في نفسه وضرر في عقيدته.
إذاً مناسبة هـٰذه الآية لهـٰذا الباب: بيان حكم السِّحر وأنه كفر، ولكن كما ذكرنا لكم أن هـٰذا لا يصلح أن يكون في عموم أنواعه وأصنافه؛ بل هو في السحر المتلقى عن الشياطين، وهو واضح لمن تأمل الآية، فإنّ الآية واضحة في الدلالة على هـٰذا.
وبيّن الله عز وجل- بعد أن أغلق هـٰذا الطريق وبيّن فساد هـٰذا السبيل- الطريقَ النافع لتحصيل مصالح الدنيا والآخرة، فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بعد هـٰذه الآية: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾( )، فدل هـٰذا على أن طريق تحصيل المنافع الدنيوية والأخروية هو الإيمان والتقوى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ﴾ أي لرجعوا بالخير من الله عز وجل. وهـٰذه الآية تدل –أيضاً- دلالة واضحة على أن من أسباب دفع شر السحر على الإنسان التقوى والإيمان، فإنّ من أسباب دفع كيد السحرة وأتباعهم أن يتحصّن الإنسان بالتقوى والإيمان، فإنّ التقوى والإيمان يندفع بهما الضرر الحسي عن الإنسان، ويندفع بهما الضرر المعنوي، فإن الله -عز وجل- ذكر هـٰذا في هـٰذه الآية، وذكر أيضاً ذلك في الأذى المباشر الذي يصيب المؤمنين، فبعد أن ذكر -جل وعلا- ما ينال أهل الإيمان من أهل الكفر من أهل الكتاب والمشركين من الأذى قال –جل وعلا– في سورة آل عمران: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾( ) فالصّبر والتّقوى، والإيمان والتقوى من أعظم ما يدفع به الإنسان عن نفسه الضّرر والشر الحسي والمعنوي، والنّاس لا يفطنون لهـٰذه الأسباب؛ لأنها أسباب قد لا تأتي نتائجها سريعة، والنّاس جُبلوا على محبة العجلة في تحصيل النتائج، فإنّ الإنسان خلق من عجل، فيريد أن يدرك ويحصّل مقصوده في أقرب برهة وأقصر زمن، وهـٰذا غلط؛ لأنّ الأمور تأخذ وقتاً حتى تؤتي ثمارها، فالإنسان يبذر الحبة ولا تنتج في لحظة ولا في لحظتين، إنما يحصّل النّتاج بعد زمن ووقت.
فينبغي للمؤمن أن يأخذ بالأسباب الشرعية وينتظر الفرج من رب العالمين، فإن الله – جل وعلا – لا يخلف الميعاد، وما أخبر به صدق لا يتخلف ولا يتأخر.
ثم قال -رحمه الله في الاستدلال على ما جاء من الآيات المتعلقة بالسحر: (وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾( )) ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي يصدقون ويقرون ويقبلون بالجبت والطاغوت، والإيمان هنا ليس مجرد التصديق بالوجود، فإننا نصدق بأن السحر موجود وأنه حقيقة، وهـٰذا ما أجمع عليه علماء الإسلام أن السحر له حقيقة موجود، إلا أنهم اختلفوا: هل هو اختلاف في الحقيقة، أو أنه مجرد تخييل في نظر الرائي المسحور؟ وأما من حيث الوجود فإنهم يقرون بوجوده وأثره، ولكن منهم من يقول: أثره حقيقة، ومنهم من يقول: أثره مجرد تخييل، مع اتفاقهم على أن السحر لا يقلب الأعيان، فلا يحول العين من عين إلى عين؛ لأن هـٰذا لا يكون إلا من رب العالمين، إنما يصورون ويخيلون ما تنقلب به الأمور في نظر الإنسان، وهـٰذا أمر متّفق عليه.
فمعنى قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ أي يقرّون، فهـٰذا إيمان مستلزم للقبول والإقبال على هـٰذين الأمرين.
﴿بِالْجِبْتِ﴾ الجبت: فسره عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كما نقل المؤلف –رحمه الله– فقال: (الجبت السحر، والطاغوت الشيطان) فهم يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشيطان.
(وقال جابر: الطواغيت: كهّان كان ينزل عليهم الشيطان، في كل حي واحد)، وقد فسّر العلماء –رحمهم الله– الجبت والطاغوت بتفاسير متعددة، أجمعها ما ذكره أبو جعفر الطبري –رحمه الله– في تفسيره من أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة.
لكن لا بد من التفريق بين الجبت والطاغوت، فما هو الفرق بين الجبت والطاغوت؟
أحسن ما وقفت عليه من التفريق بين الجبت والطاغوت أن الجبت يطلق على الأفعال والطاغوت يطلق على الأشخاص، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ كما سيأتينا-: ((إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت)) وهـٰذه أشخاص أو أفعال؟ أفعال، فدلّ هـٰذا على أن الجبت يطلق على الأفعال.
وأما الطاغوت فإنه يطلق على الأشخاص، وهـٰذا يستفاد أيضاً من تفسير عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حيث فسر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، فجعل الجبت فعلاً والطاغوت شخصاً، وهـٰذا أجود ما وقفتُ عليه من التفريق بين الجبت والطاغوت.
والجبت يشمل أوسع من هـٰذا، يشمل السحر، وسيأتينا كذلك أن العيافة والطرق والطيرة كلها من الجبت؛ لأنها من الباطل، فالجبت يطلق على كل فعل باطل من أفعال الجاهلية، والطاغوت يطلق على كل شخص يحصل به الطّغيان.
وقد تقدّم لنا بيان معنى الطاغوت وأنه اسم جنس لكلّ ما عبد من دون الله -عز وجل- وهو راض، أو لم يرضَ؛ لأنه طاغوت لا بذاته لكن باعتبار الافتتان به، وهـٰذا التعريف ذكره شيخ الإسلام –رحمه الله– فقال: الطاغوت اسم جنس لكل من عبد. ويضاف إليه أيضاً: أو كان رأسًا في الضلالة. وشيخ الإسلام ذكر أيضاً تفسيراً آخر في موضع آخر للطاغوت قال: هو اسم للكاهن والساحر والرمال والعراف والدرهم والدينار وغير ذلك، والمقصود أن الطاغوت يطلق على كل ما هو سبب للطغيان ومجاوزة الحد.
فكل ما يحصل للناس به مجاوزة للحد فإنّه طاغوت، ووزن طاغوت على وزن فعلوت، هـٰذا الوزن يأتي لإفادة المبالغة، أي المبالَغ فيه في الطّغيان والمجاوزة.
شيخ الإسلام ذكرها في رحموت وملكوت، وفعلوت، قال: هي على هـٰذا النحو: ومَلَكُوت، لا تقول: مَلْكوت ورَحْموت، إلا إن كان فيها لغة ما أدري، فتكون هنا طغَيوت صحيح لكن ملكوت كذلك صحيح، تصير أصلها طغيوت يعني أصل الفعل: طغيوت، فإذا كانت أصلها طغيوت فتمشي على هـٰذا البناء بالفتح.
(عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات.)) )
((اجتنبوا)) أي اتركوا، هـٰذا معناها لكن في الحقيقة تفسير اجتنبوا باتركوا فيه قصور؛ لأنه ترك مبالغ فيه وليس مجرّد الترك؛ لأن الترك يمكن أن تترك الشيء ويكون بقُربك، لكن اجتنبوا ترْكٌ مبالغ فيه بأن تكون في جانب والمتروك في جانب آخر.
((اجتنبوا السبع الموبقات)) والسّبع هنا عدد، وهـٰذا العدد لا مفهوم له، يعني: ليس حصراً لعدد الموبقات، إنما نصّ عليها في هـٰذا الحديث والأحاديث الأخرى زادت على هـٰذه السّبع. ((والموبقات)) جمع موبقة، وهي المهلكات، والإيباق أصله الإهلاك كما قال الله جل وعلا: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً﴾( ) أي محلاًّ للهلاك، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ وهن موبقات باعتبار العاقبة وباعتبار الدنيا أيضاً؛ لأنها يحصل بها هلاك الناس وفساد أمورهم في دنياهم في معاشهم ومعادهم، فهي موبقة في الدنيا والآخرة وليست موبقة فقط في الآخرة، وهـٰذا أمر مهم ينبغي لنا أن نستحضره عند ذكر المعاصي، فالمعاصي ليست آثارها فقط على الآخرة بل حتى آثارها في الدنيا، فكل شؤم في الدنيا إنما سببه المعصية، كل شر في الدنيا مصدره المعصية، سواء كان الشر خاصّاً بالإنسان أو شرّاً عامّاً، قال الله –جل وعلا– في الشر الخاص: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾( ).
وقال في الشر العام: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾( ). ( ((اجتنبوا السبع الموبقات)). قالوا: يا رسول الله وما هن؟) فعدّهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وهـٰذا الأسلوب فيه شحن النفوس وحثها على طلب المعرفة؛ لأنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات وسكت، وذلك ليشحذ نفوس السّامعين إلى طلب ما هي هـٰذه الموبقات؟ ولذلك سأل الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- عن هـٰذه الموبقات ليجتنبوها ويحذروها، فقال: ((الشرك بالله)). وهـٰذا أولها وهو أعظم الموبقات لا إشكال؛ لأنه يوبق إيباقاً تامّاً ويهلك هلاكاً لا حياة بعده، يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة، أما في الدنيا فهو ظلمة وظلم: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾( ).
وأما في الآخرة فقد قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾( ). فهو غاية الهلاك، ولذلك بدأ به قبل غيره.
قال: ((والسحر)) وهـٰذا دون الشرك في المرتبة، وقد يكون فيه من الشِّرك، وإنما نص عليه لأنه يكون شركاً ويكون غير شرك، فإذا قيل: إن كل السحر شرك فهـٰذا لا يسلم، لكن لو قيل هـٰذا فيكون النص عليه ما وجهه؟ بيان خطورة هـٰذا النوع وشدة الافتتان به.
قال: ((وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)) قتل النفس إزهاقها، و((التي حرم الله)) يعني التي منع الله –جل وعلا– قتلها، ((إلا بالحق)) يعني إلا بمبيح للقتل، ويدخل في هـٰذا أربع أنفس: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. هـٰذه هي الأنفس المعصومة، وما عداها فإنه ليس بمعصوم.
((إلا بالحق)) والحق هنا قد يكون حقّاً عامّاً كقتال الكفّار المحاربين، فالحق فيهم عام وليس خاصّاً، وقد يكون حقّاً خاصّاً يستباح به دم معين، وهو أن يرتكب الإنسان ما يبيح دمه: كزنى المحصن، وكقتل النفس بغير حق، والردة وغير ذلك من موجبات القتل.
قال: ((وأكل الربا)). هـٰذا رابع الموبقات، وأكل الربا، وذكر الأكل لأنه المقصود من كسب المال، وإلا فالمال يكسب ويؤخذ للأكل ولغيره، لكن أعظم المقاصد من أخذ المال الأكل.
قال: ((وأكل الربا، وأكل مال اليتيم)) المقصود باليتيم من فقد أباه دون البلوغ.
قال: ((والتولي يوم الزحف)) كل هـٰذا ذكره المؤلف استطراداً، والمقصود هو السحر. والتولي يوم الزحف هو الفرار من القتال، واستثنى الله -عز وجل- من هـٰذا أمرين: ﴿إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ﴾( )؛ ﴿إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍٍ﴾ أي: متهيئاً لقتال، يعني: ليس انزواؤه وتوليه فراراً، إنما هو ليتهيأ لقتال آخر، أو ليعيد الكرّة، أو ليصلح أمراً يحصل به النكاية بالعدو.
﴿أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ﴾ أي: منضمّاً إلى فئة تحتاجه في جهة من جهات المسلمين.
((وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)). قذف، القذف هو الرمي بالزنى وما شابهه. ((المحصنات)) المقصود بالمحصنات هنا الحرائر. ((الغافلات)) أي البعيدات عن الزنى العفيفات، ((المؤمنات)) معروف من حصل منهن الإيمان، والمقصود من هـٰذا الحديث قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والسحر)).
طيب هل هـٰذه الموبقات على مرتبة واحدة؟
الجواب: لا، ليست على مرتبة واحدة، إنما هي على مراتب: منها ما هو شرك، ومنها ما هو معصية عظيمة، ومنها ما هو دون ذلك، والجميع يشترك في كونه موبقة.
طيب المعاصي أليست موبقات؟ دقيقها وجليلها موبق يهلك صاحبه، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إياكم ومحقّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرّجل)) فماذا يصنعن؟ ((فيهلكنه)). يعني: يحصل بهن الإيباق، ولكن نص على الإيباق بهـٰذه الذنوب لكونها موبقة منفردة، بخلاف الصغائر فإن الإيباق في اجتماعها، ولذلك لما سُئل ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن الكبائر: هي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، ولا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فدل ذلك على أن الصغائر إذا أصر عليها الإنسان التحقت بالكبائر، وأنّ الكبائر إذا عولجت بالتوبة والاستغفار زال أثرها وما يترتب عليها من هلاك.
ثم قال: (وعن جندب مرفوعاً: ((حد الساحر ضربة بالسيف)) ).
الظاهر لي أن الشيخ –رحمه الله– ساق حديث أبي هريرة ليبيّن أن من السحر ما يكون كفراً ومنه ما يكون دون الكفر، وهـٰذا سيتّضح جليّاً في الباب التالي، في باب بيان شيء من أنواع السحر.
فالآيتان الأوليان فيهما السّحر الذي هو من الكفر، وحديث أبي هريرة فيه السحر الذي يحتمل أن يكون من الكفر ويحتمل أن يكون دون الكفر.
ثم بعد أن فرغ من بيان حكم السحر من حيث هو انتقل إلى بيان حكم الساحر، قال المؤلف رحمه الله: (وعن جندب مرفوعاً: ((حد الساحر ضربة بالسيف)) ). وفي نسخ: ((ضربه بالسيف)) وجهان، وهـٰذا الحديث قال المؤلف رحمه الله: (رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف) أي: على جندب وليس مرفوعًا، وذهب جماعة من العلماء إلى تضعيف رفع هـٰذا الحديث، ومنهم ابن حزم رحمه الله.
إلا أن فعل الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- يدل على هـٰذا الحكم، كما أن الحكم بالكفر سبب للقتل، ولو لم يثبت هـٰذا الحديث؛ لكن هـٰذا الحديث يفيد أن السحر سبب للقتل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السحر كفريّاً وبين أن يكون السحر من كبائر الذنوب، بل في الجميع يجب القتل؛ لأن هـٰذا الحديث يفيد أن الساحر علاجه وحكمه ضربة بالسيف.
وقوله: ((حدّ الساحر)) يفيد أن قتل الساحر حدّ، وإذا كان القتل حدّاً فإنه يتحتّم قتله حتى ولو تاب إذا بلغ السلطان؛ لأن الحدود لا يسقط موجبها إذا بلغت السلطان، فإذا بلغ السلطان فإنه يقتله وإن أظهر التّوبة.
وقوله: ((بالسيف)) المراد به قتله وإزهاقه؛ لأن به يحصل انقطاع شرّه، هـٰذا إذا كان كفراً فإنه يشكل عليه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث: ((حد الساحر ضربة بالسيف)). يشكل عليه لأن الحد طهرة للمحدود، هكذا قال جماعة من العلماء، وعليه فإنه لا يحمل على السحر الذي يحصل به الكفر، إنما يحمل على السحر في ما دون الكفر، فالسحر في ما دون الكفر مما يحصل به ضرر عام وفساد كبير ولا يمكن توقيه، علاج صاحبه- ولو لم يكن كافرًا بسحره- أن يقتل؛ قطعاً لشرّه وقطعاً لفساده، وهـٰذا أمر ثابت بأدلة عديدة، فإنّ النصوص دلت على أن من عظم شره وفساده ولم يمكن قطع شره وفساده إلا بالقتل فإنه يقتل، كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرّق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان)). مع أنه ما فعل ما يوجب القتل في ما يتعلق بإزهاق نفس أو ردة أو ما أشبه ذلك، لكن لما كان ضرره كبيراً بالتفريق والإفساد بين الناس استحق القتل، ومثله الساحر.
قال: (وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة). هـٰذا الأثر ليس في صحيح البخاري بهـٰذا اللفظ، فإن موضع الشاهد منه: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) ليس في صحيح البخاري إنما هو في مسند الإمام أحمد وفي السنن، سنن أبي داود وغيره كسنن الدارقطني، والأمر بقتل الساحر والساحرة ثابت عن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
قال: (فقتلنا ثلاث سواحر). رجال أم نساء؟ أما من حيث اللفظ فهو لفظ مؤنث ما فيه إشكال؛ لأنه ذكّر العدد، وأما من حيث المقتول فيحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، ولكن الأقرب أنهن إناث؛ لكثرة السحر فيهن، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾( ) لكثرة السحر في النساء( ).
قال: (وصح عن حفصة -رَضِيَ اللهُ عَنْها- أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب، قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). أي: ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل ثبت عن أكثر من ثلاثة، فثبت عن عمر وعن حفصة وعن ابن عمر وعن سعد بن قيس وعن عثمان بن عفان وعن جندب رضي الله عنهم، هؤلاء الستة صح عنهم قتل السواحر.
خالف في ذلك فيما ذكر المقابلون لقتل الساحر عائشة، حيث إن جارية سحرتها فلم تقتلها، لكن ترك عائشة لقتلها لا يدل على عدم جواز ذلك؛ لأن عائشة لم تقل: لا يجوز قتل الساحرة، إنما تركت القتل، وقد يعفو الإنسان ويترك كما ترك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قتل من سحره؛ لبيد بن الأعصم، فالترك لا يدل على عدم الجواز، لا سيما وأن النصوص دالة على أن من عظم شره وكثر فساده فإنه يقتل.
أما إذا كان السحر كفريّاً فإنه يقتل ولا إشكال، وهـٰذا محل اتفاق أنه يقتل لكفره، والخلاف في ما إذا كان السحر دون الكفر، هل يقتل أو لا يقتل؟ الصحيح أنه يقتل إذا عظم شره وفساده.
[المتن]
فيه مسائل
الأولى: تفسير آية البقرة.
الثانية: تفسير آية النساء.
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
[الشرح]
واضح الفرق بينهما؟ الشيخ أشار إلى الفرق من خلال كلام عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-،حيث جعل الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
[المتن]
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
الخامسة: معرفة السّبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
السادسة: أن السّاحر يكفر.
[الشرح]
نعم، على التفصيل السابق.
[المتن]
السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب.
[الشرح]
لقوله: ((حد الساحر ضربه بالسيف)).
[المتن]
الثامنة: وجود هـٰذا في المسلمين على عهد عمر فكيف في ما بعده؟
[الشرح]
الله أكبر! صحيح بل وجوده في ملك سليمان، وهـٰذا العجيب أن سليمان –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- سلط على الشياطين ومع ذلك ما استطاع أن يمنع سحرهم، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾( ).
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب بيان شيء من أنواع السحر
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت)). قال عوف: العيافة: زجر الطير، والطرق: الخط يخط بالأرض، والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
وعن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد)). رواه أبو داود، وإسناده صحيح.
وللنسائي من حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وُكِلَ إليه)).
وعن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة، القالة بين الناس)). رواه مسلم.
ولهما عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن من البيان لسحراً)).
[الشرح]
فمناسبة هـٰذا الباب لكتاب التّوحيد بيّنة، وهي أن من أنواع السحر ما هو شرك، فلذلك ذكر المؤلف –رحمه الله–شيئاً من أنواع السحر ليتبين الشركية منها من غيرها.
ثم ذكر -رحمه الله– هـٰذا الباب بعد باب ما جاء في السحر، والمناسبة ظاهرة بين البابين: ففي الباب السابق بين حكم السحر ومنزلته وبين حكم الساحر، وفي هـٰذا الباب ذكر أنواع السحر، فهـٰذا الباب صلة الباب السابق وتتمته.
يقول رحمه الله: (باب بيان شيء من أنواع السحر).
(بيان) أي إعلام وتوضيح وإظهار شيء من أنواع السحر، يعني: أنّ البيان ليس لكل أنواع السحر إنما هو لشيء منها، وهـٰذا الذي بينه –رحمه الله– في هـٰذا الباب بعض الأنواع، وخص منها الأنواع الظاهرة المشتهرة حتى تحذر، وأيضاً خصّ منها ما جاء النص بأنه من السحر، فتكلم في هـٰذا الباب عن الأنواع الظاهرة المنتشرة المشهورة، وعمّا صرّحت به النصوص، يعني ما نصّت النصوص على أنه من السحر.
قال رحمه الله: (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه) يعني قبيصة (أنه سمع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت)).)
وهـٰذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال المؤلف –رحمه الله–: (إسناده جيد.) وقد احتج بهـٰذا الحديث وحسنه شيخ الإسلام –رحمه الله– وأيضاً النووي وغيرهما، وإن كان في سنده بعض المقال، لكن صححه هؤلاء الأئمة لصحة ما تضمنه، ولانجباره بتعدد طرقه، فالحديث ثابت من حيث السند.
وكذلك من حيث المعنى، فإن كل ما تضمنه هـٰذا الحديث دلت الأدلة على أنه من المحرمات، فالعيافة هي: زجر الطير كما قال عوف أحد رواة الحديث، قال: (زجر الطير) في بيان العيافة، والزجر هو: التهييج، والطير: معروف الطائر، وزجر الطير كان يفعله أهل الجاهلية ليتشاءموا ويتيامنوا، فهو من أنواع الطيرة، إذ إنهم يفعلون هـٰذا لأجل حصول التشاؤم والتيامن بطيران الطير، فهو ضرب من التكهّن وضرب من استقراء المستقبل، أو استكشاف واستجلاء ما يكون في المستقبل، فهو نظير الضرب بالأزلام أو الاستقسام بالأزلام.
و(الطرق) قال: (الخط يخط بالأرض)، ذكر في تعريفه منتهاه، وإلا فإنه ليس مجرد خط يخط بالأرض، إنما يخط وفق سير النجوم ليعلم ما يكون في المستقبل، فهو من الكهانة ومن السحر ومن التّنجيم، ولذلك عرفه بعضهم بأنه قراءة النجامة، يعني: نوع من قراءة النجوم، هـٰذا الطّرق.
وأما ((الطيرة)) فالطيرة معروفة وسيأتي لها باب مستقل، والطيرة مأخوذة من التطير وهو التشاؤم بمعلوم أو مسموع أو مرئي، وذكرها استقلالاً مع أن من صورها العيافة، لكن لأن التطير لا يستقل بالطيور فقط، بل يكون بالطير وبغيره، ذكره على وجه الاستقلال، فتبين من هـٰذا أن الذي له صلة قال: ((من الجبت)) أي من السحر، كما فسر ذلك عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾( ). وذكر المؤلف هنا تفسير الحسن للجبت قال: (رنة الشيطان). (رنة) أي صوت، و(الشيطان) معروف، فهو صوت الشيطان؛ فالعيافة والطرق والطيرة كلها من الجبت الذي هو رنة الشيطان، وهو صوته وعمله وكيده ومكره.
وقد تقدم في الدّرس السابق أن الجبت يُطلق على الأفعال والأقوال الباطلة، يعني: يطلق على الأفعال والأقوال التي يحصل بها الطغيان، وأما الطاغوت فهو يطلق على الأشخاص التي يحصل بها الطغيان، والشاهد في هـٰذا الحديث قوله: ((والطرق)) لأن الطرق نوع من قراءة النّجوم التي سيأتي حكمها بعد قليل، فهي نوع من السحر، والمعنى العام للسحر يشمل هـٰذه الأنواع كلها؛ لأنها توصل إلى ما يزعم أنه سيقع في المستقبل من طريق خفي؛ لأنه ما فيه مناسبة بين زجر الطير وبين ما يقع في المستقبل، ولا هناك مناسبة بين الخط وما يقع في المستقبل، ولا هناك مناسبة بين الطيرة وما يقع في المستقبل، فهو إخبار بما سيقع أو توقّع لما سيقع من طريق خفي، ولذلك سمي جبْتاً وهو السحر كما فسّره عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وقد تقدم أن السحر هو كل ما لطف ودق وخفي سببه.
يقول رحمه الله: (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه) يعني هـٰذا الحديث مخرج عند هؤلاء.
قال: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) ). ((من اقتبس)) الاقتباس: أصله الأخذ، وأصله يطلق على شعلة النار، ومنه قوله تعالى: ﴿لًعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾( ) أي بشعلة من النار، ويطلق الاقتباس أيضاً على التعلم، فيقال: اقتبس منه علماً أي تعلم منه علماً، فقوله هنا: ((من اقتبس شعبة من النجوم)) أي من تعلم، ((شعبة)) الشعبة هي القطعة، و((النجوم)) معروفة وهي ما زينت به السماء من المصابيح.
فمن اقتبس قطعة من النجوم، من تعلم قطعة من النجوم أي: من علم النجوم ((فقد اقتبس شعبة من السحر)) أي فقد تعلم شعبة وقطعة من السحر.
ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((زاد ما زاد)) يعني زاد في علمه بالسحر ما زاد في علمه بالنجوم، فبقدر توغله وازدياده في معرفة علم النجوم بقدر ما يكون قد أخذ واقتبس من السحر، هـٰذا معنى قوله: ((زاد ما زاد)).
واعلم أن هـٰذا الحديث يفيد تحريم تعلم علم النجوم المتصل بالسحر، إلا أن العلم بالنجوم ينقسم إلى قسمين: علم أحكام ، وعلم حساب.
علم الحساب: هو معرفة الكواكب في سيرها وما يترتب على هـٰذا السير من تغير الفصول وجهات القبلة، وما أشبه ذلك مما يتعلق بمعاش الناس ومصالحهم، فهـٰذا تعلمه لا بأس به، ولكن ينبغي ألا يزيد على ما يحصل به المقصود؛ لأن ما زاد على المقصود يدخل في العلم الذي لا ينفع، هـٰذا العلم الأول وهو علم الحساب.
ومنه معرفة أوقات الصلوات ودخول الأهلة ودخول الشهور وحدوث الكسوف وما أشبه ذلك، كل هـٰذا يدخل في علم الحساب، وهو من حيث الأصل جائز بل مطلوب في ما يحصل به المقصود من معرفة القبلة وشبهه مما يعين على الطاعة، وما زاد فإنه ينبغي عدم الاشتغال به لقلة نفعه.
أما القسم الثاني من علم النجوم: فهو علم الأحكام، وهو ما سيأتي الكلام عليه في باب التنجيم، وملخصه: اعتقاد تأثير حركات الأفلاك على الحوادث الأرضية، فيقال: سيكون كذا إذا اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني أو إذا دخل البرج الفلاني أو ما أشبه ذلك من الاقترانات التي يستدلون بها على وقوع الحوادث.
فهـٰذا من علم التنجيم الذي سيأتي بيانه وأحكامه، وهو محرم وهو من السحر، وأيضاً هناك قسم آخر من هـٰذا القسم وهو ممّا يتعلق بعلم الأحكام وهو ما يتعلق بالجانب العملي، وهو ما يسميه أهل السحر استنزال روحانيات الكواكب والنجوم، وذلك لا يكون إلا بدعاء وسؤال وصرف أنواع من العبادة يحصل بها مقصود الساحر.
يقول شيخ الإسلام –رحمه الله–: وهـٰذا النوع من أرفع أنواع السحر، ولا يمكن أن يحصل المقصود فيه إلا بشرك وكفر.
إذاً علم الأحكام نوعان: نوع علمي، ونوع عملي.
القسم العلمي من الأحكام هو الإخبار بما سيكون وفق سير الكواكب وجريانها.
القسم الثاني: العملي، وهو استنزال ما يزعم من روحانيات هـٰذه النجوم والكواكب لحصول المقصود، ولا يحصل ذلك إلا باستنزال هـٰذه الروحانيات بأدعية وطلاسم وأنواع من التّعويذات الشركية التي يحصل للساحر بها مقصوده.
واعلم أن هـٰذه الأنواع لا تحصل إلا بقدر ما مع الإنسان من الشّر، فبقدر ما تكون نفس الإنسان خبيثة بقدر ما يحصل له من القوة في هـٰذه الأمور.
قال الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾( ).
فكلما كان الإنسان متأصلاً في الإفك والإثم تحقق له تنزل الشياطين؛ لأنه ذكر التنزل بوصف، والحكم إذا كان معلقاً بوصف فإنه يزيد بازدياده وينقص بنقصانه، وهـٰذه ليست فقط في الأحكام الشرعية الفقهية بل حتى في الأحكام الخبرية، وحتى في الأحكام الجزائية، فالقواعد لا تنحصر فقط في باب الفقه بل في الفقه وغيره.
فبقدر ما مع الإنسان من الإفك والكذب والبهتان والخبث بقدر ما يحصل له من تنزل هـٰذه الشياطين، والتي يقترن بها الشر ويقترن بها الكفر ويقترن بها الضرر.
إذاً مفاد هـٰذا الحديث الإشارة، يعني في سياق المؤلف –رحمه الله– له، الإشارة إلى أن من أنواع السحر ما يتعلق بأي شيء؟ بالنجوم وسيرها وهو من أرفع أنواع السحر.
ثم قال رحمه الله: (رواه أبو داود وإسناده صحيح) وهو كما قال المؤلف –رحمه الله– إسناده صحيح.
والملاحظ أن المؤلف –رحمه الله، وهـٰذا شبه مطّرد- أنه إذا نص على حكم حديث أنه ينقله عن غيره، إما عن شيخ الإسلام –رحمه الله– أو عن ابن القيم، أو عن ابن مفلح، بل بعض الأحيان يكون النقل بالعبارة، يعني: يكون نقل سياق الحديث بعبارة المنقول عنه، ولكن بحكم أنه مؤلف الشيخ –رحمه الله– لا يشير إلى ذلك، ولكن بالتتبع وجدت أنه رحمه الله إذا نص على حكم حديث فإنما ينص عليه بناء على قول من سبقه من أهل العلم، ويكون ذلك بنقل العبارة بدون تغيير منه رحمه الله.
يقول: (وللنسائي من حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) ).
((من عقد عقدة)) هـٰذا فيه بيان أن من أنواع السحر ما يكون بالعقد والنفث، وهو غالب أنواع السحر، ولذلك جاءت الإشارة إليه في سورة الفلق: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (01) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (02) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (03) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد﴾( ) وإنما نص على هـٰذا النوع من السحر لكثرته وانتشاره وعظم شره.
((من عقد عقدة ثم نفث فيها)). والنفث هو النفخ مع شيء من الريق، ولكن ليس التأثير في النفث والريق بمجرده، إنما التأثير بما يكون في نفس النافث من الشر والخبث وإرادة السوء بالمسحور، مستعيناً على هـٰذا بالجن والشياطين، وبهـٰذا ينعقد السحر –نعوذ بالله– ينعقد شر هـٰذا بالمسحور.
يقول: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)) وليس المقصود بالعقدة العقد نفسه، إنما المقصود العقد المقترن بهـٰذه الأمور من النفث وإرادة الشر بالمسحور.
((فقد سحر)): أي فقد وقع في السحر الذي نهى عنه الله ورسوله، وبينت النصوص كفر صاحبه.
يقول: ((ومن سحر فقد أشرك)). وهـٰذا فيه الحكم على السحر بهـٰذه الطريقة، فلا يصلح الاستدلال بهـٰذا الحديث على كفر كل ساحر، كما تقدم ذلك في الآية: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾( ) أنها في السحر المتلقى عن الشياطين، وهـٰذا مثله.
((ومن سحر فقد أشرك)). يمكن أن يقال: إن هـٰذا في السحر المذكور؛ لأنه بعد أن ذكر أن هـٰذا الفعل سحر بين حكم السحر، ولا يمكن أن نستفيد من هـٰذا أن كل سحر كفر؛ لأن من السحر ما يعتمد على خواص المواد وعلى معرفة أمور أو خفة حركة يحصل بها خداع العين، فلا يكون هـٰذا من السحر الكفري.
يقول: ((ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) أي من علق قلبه بشيء وكل إليه، وذكر هـٰذا بعد ذكر السحر لأن الغالب أن الساحر يتعلق بالشياطين في تحقيق مقصوده، فقوله: ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) يعني أنه يوكل إلى هؤلاء الشياطين الذين لا يفلح من تعلق بهم، ولا يحصل له مقصوده، وإن حصل بعض مراده في الدنيا لكن عاقبة ما يحصله في الدنيا شر له، وأما الآخرة فشرها بالنسبة له ظاهر وبين، ولذلك نص على الشر الأخروي في الآية دون الشر الدنيوي فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾( ) فذكر الآخرة، وإن كان الحكم يشمل الآخرة والدنيا كما قال تعالى: ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾( ) والفلاح المنفي فلاح الدنيا وفلاح الآخرة، وهو: إدراك المطلوب والأمن من المرهوب.
((ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) ، ويمكن أيضاً أن يقال: إن ذكر هـٰذا بعد السحر هو ذكر لسبب من الأسباب التي يسلم بها الإنسان من شر السحر، فإنه من تعلق بالله عز وجل وُكِل إلى الله، ومن توكل على الله فهو حسبه، يدفع الله –سبحانه وتعالى– عنه شر السحر وأثره.
وفيه أيضاً التحذير من تعلق المسحور بغير الله عز وجل، وأنه مهما تعلق من المخلوقات فإنه يُوكل إليه، ومن وكل إلى مخلوق فإنه ضائع لا يحصّل مرغوباً ولا يأمن من مرهوب، وهـٰذا وجه ختم هـٰذا الحديث بهـٰذه الجملة، فهو بيان لطريق السلامة من السحر وبيان لسوء حال السحرة.
يقول: (عن ابن مسعود أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وهـٰذا الحديث حديث تكلم فيه العلماء، وقال شيخنا عبد العزيز –رحمه الله–: في إسناده نظر، وقد حسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. (وعن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ألا هل أنبئكم ما العضه؟)) ) سؤال سأله رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أصحابه عن إخبارهم العضه، يعني: هل يخبرهم بالعضه؟ والسؤال هنا ليس للاستعلام، إنما هو لشحذ الأذهان وشد الانتباه، ولذلك لم ينتظر منهم جواباً، بل بادر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى بيان العضه فقال: ((هي النميمة، القالة بين الناس)).
والعضه قيل في بيانه عدة أقوال، فقيل: العضه الإفك، وقيل: الكذب، وقيل: البهتان، وقيل: القطع. وكل هـٰذه المعاني تصدق على العضه؛ لأنه قطع وكذب وبهتان وإفك. ومما فسر به العضه أيضًا: السحر، وهو مقصود المؤلف –رحمه الله– في سياق هـٰذا الحديث؛ لأنه أراد أن يبين أن من أنواع السحر ما لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر، بل يكون دون ذلك، وهو العضه، وهي النميمة القالة بين الناس.
وإنما سميت النميمة سحراً لأنها يحصل بها من الفساد ما يحصل بالسحر، بل قد قال بعض السلف: إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة؛ لأن مقصود الساحر الإفساد والتفريق بين الناس وهـٰذا هو غرض النمام، ولذلك لما ذكر الله -عز وجل- السحر في آية البقرة قال: ﴿يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾( ). فجعل مقصودهم من السحر التفريق بين المرء وزوجه، وهـٰذا يحصل بالسحر ويحصل بالنميمة، فالنميمة نظير السحر، ولذلك جعلها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من قبيل السحر، فالنميمة لما كانت تفسد كما يفسد السحر ألحقت به، وإن كانت النميمة ليست من السحر الكفري، إنما هي من السحر الذي هو من كبائر الذنوب، (رواه مسلم).
قال: (ولهما) أي للبخاري ومسلم (عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن من البيان لسحرًا)) ). إن من البيان، والبيان المراد به الإظهار، ويطلق أيضاً البيان على الظهور والمقصود به هنا كلام المتكلمين، إنّ من كلام الناس ما يكون سحراً، إن من بيان الناس ما يكون سحراً.
وسمي بالسحر: إما لكونه يأخذ القلوب ويسلب الألباب بجماله وحسن رصفه، فيحصل به المتكلم مقصوده من وجه خفي، وهـٰذا يكون ممدوحًا أو مذمومًا؟ هـٰذا يختلف باختلاف المقصود، فإن كان المقصود منه الخير والحق فهو ممدوح، وإلا فهو مباح إذا كان لتحصيل لأمر دنيوي لا محذور فيه، وأما إن كان مقصوده شرّاً فهو شر ومحرم.
والوجه الثاني من إطلاق السحر على البيان: أنه يحصل به قلب الباطل حقّاً والحق باطلاً، فينقلب الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق ببيان المبين وكلام المتكلم، وعلى هـٰذا يكون مساق الحديث للذم أو للمدح؟ للذم؛ لأنه صرف للحق وإخفاء له. ولكن: اعلم أن جمهور العلماء حملوا هـٰذا الحديث على أنه مدح للبيان وليس ذمّاً، هـٰذا قول جمهور أهل العلم، ولعلهم ذهبوا إلى ذلك لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أثنى على البيان في كتابه، بل امتدحه، بل جعل تعليم البيان من المنن على الإنسان فقال سبحانه وتعالى: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾( ) أي علم الإنسان البيان، ووصف كتابه بالبيان، وأمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالبلاغ المبين، ووصفه بذلك، المهم أنه ورد الثناء على البيان في كتاب الله عز وجل، فيحمل قوله هـٰذا: إن من البيان لسحرًا على ذلك. وأيضًا استدل بعضهم بدلالة الاقتران، حيث ورد في الحديث قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((وإن من الشعر لحكمة)). وهـٰذا لا إشكال في أنه ثناء ومدح، والمقصود أن المؤلف رحمه الله بين في هـٰذا الحديث أن من السحر ما هو حلال.
وبهـٰذا نعلم أن السحر ليس على مرتبة واحدة، بل هو مراتب، إلا أنه في الإطلاق لا يطلق السحر إلا على القبيح من الفعل والقول.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
الثانية: تفسير العيافة والطرق.
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.
[الشرح]
واضح من حديث ابن عباس.
[المتن]
الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك.
[الشرح]
يعني من السحر، وهـٰذا واضح من حديث أبي هريرة.
[المتن]
الخامسة: أن النميمة من ذلك.
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.
[الشرح]
هـٰذا من حديث ابن عمر على القول بأن الحديث سيق مساق الذم، (من ذلك) يعني من السحر المذموم (بعض الفصاحة).
ننتقل للباب الذي بعده.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في الكهان ونحوهم
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)).
وعن أبي هريرة عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)). رواه أبو داود.
وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً.
وعن عمران بن حصين مرفوعاً: ((ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ((ومن أتى..)) إلى آخره.
قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل: هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهـٰذه الطرق.
وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
[الشرح]
قال المؤلف – رحمه الله-: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم).
(الكهان) جمع كاهن وسيأتي بيانه في كلام المؤلف –رحمه الله– وهو من يخبر عن المغيبات في المستقبل، ومعلوم أن من يخبر عن المغيبات في المستقبل فقد نازع الله عز وجل أمراً اختص به وهو علم الغيب؛ ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾( ) فلذلك ناسب أن يأتي المؤلف –رحمه الله– ببيان حكم هؤلاء في كتاب التوحيد؛ لكونهم وقعوا في ادعاء مشاركة الله عز وجل ما اختص به، فقدح ذلك في توحيدهم، هـٰذا وجه.
الوجه الثاني من مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن الكهان لا يتوصّلون إلى الإخبار بما يخبرون به من أمور المستقبل إلاّ بطريق الاستعانة والعبادة للشّياطين الذين يسترقون السّمع، فلما كان طريق الوصول إلى هـٰذا العمل -وهو الكهانة- شركيّاً ناسب أن يذكره المؤلف –رحمه الله– في كتاب التّوحيد؛ ليُحذِّر منه.
هاتان مناسبتان لذكر هـٰذا الباب في كتاب التوحيد، أما مناسبة هـٰذا الباب للذي قبله فإنه في البابين السابقين ذكر السحر وأنواع السّحر، وفي هـٰذا الباب أتى بالكهانة لأنها في الحقيقة نوع من السّحر؛ لأنها توصل إلى ما يكون في المستقبل من طريق خفيّ، فهي ضرب من السّحر، ولذلك جاء في الحديث: ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) والنجوم يقتبس منها نوعان: علمي وعملي، العلمي هو ما يكون في المستقبل، والعملي هو استنزال روحانياتها لتحقيق المطلوب والغرض كما تقدم قبل قليل هـٰذه مناسبة.
مناسبة أخرى بين هـٰذا الباب والذي قبله: أن الغالب في من بلي بالسحر أن يذهب إلى الكهان يطلب منهم الشفاء، فبين المؤلف –رحمه الله– حكم الكهان وحكم إتيانهم بعد ذكر البلاء بالسحر، حتى يرتدع من بلي بالسحر عن سلوك هـٰذا الطريق؛ لأنه لا يحصل به مطلوباً، ولذلك سيذكر المؤلف –رحمه الله– في الباب الذي بعد هـٰذا الطريق الشرعي للسلامة من السحر، فهو بين الطريق الممنوع المحرم لطلب رفع السحر وحله، وفي الباب الثاني سيذكر الطريق المشروع لطلب فك السحر وحله، هـٰذه مناسبة هـٰذا الباب لما قبله.
ذكر المؤلف –رحمه الله– (باب ما جاء في الكهان ونحوهم)
(الكهان) جمع كاهن، وهو في الأصل من يخبر بالغيب بأسباب يتعاطاها، يعني ليس إخباره بالغيب رجماً ولا حدْساً وظنّاً، إنما خبره مبني على سبب يبني عليه الإخبار.
واعلم أن المتكلمين بالغيب أنواع، منهم:
من يتكلم بالغيب استنادًا إلى النجوم وحركاتها، وهـٰذا يسمى في اللغة (الحزّاء) وهو الذي ذكر في حديث هرقل في صحيح البخاري، فإن الذين ينظرون في النجوم من الحزائين أخبروا هرقل بأنّ ملك العرب قد ظهر، وعلم أنه يكون منهم نبي.
والثاني: من يخبر بالغيب استناداً إلى خبر الجن، وهؤلاء يسمّون بالكهان.
والثالث: من يخبر بالغيب حدساً وظنّاً يعني تخميناً، وهـٰذا ليس من القسم المذموم؛ لأنه يبني على ظن وفراسة قد تصيب وقد تخطئ، لكن لا ينبغي ولا يجوز له أن يجزم بخبره، فليقل: أظن، يبدو والعلم عند الله، ظاهر هـٰذا أن يؤول إلى كذا... هـٰذا لا بأس به، ولكن الاعتماد على هـٰذا كثيراً من اعتماد الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً كما قال الله سبحانه وتعالى.
الرابع: الإخبار بالغيب وفق ما جرت به العادة مما يعلم بالعادة أو بطرق الحساب، كدخول الفصول وأوقات النبات والشهور وما أشبه ذلك، هـٰذا القسم الرابع.
القسمان الأولان هما المذمومان، وهما اللذان الكلام عليهما في هـٰذا الباب، أما القسمان الأخيران فكل منهما منه ما هو مذموم ومنه ما ليس بمذموم، أما القسمان الأولان فهما مذمومان على وجه الإطلاق؛ لما فيهما من الشر والفساد ومنازعة الله -عز وجل- ما اختص به من علم الغيب، فإن علم الغيب من خصائص الرب –جل وعلا–، بيّن ذلك -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في كتابه في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ﴾( ) فنفى علم مفاتح الغيب والمفاتح وهي الخزائن عن أحد سواه.
وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾( ) كل هـٰذا احتياطاً للغيب، فإنه يظهر من يشاء من رسله على الغيب ثم يجعل من يرصد الرسل في إخبارهم فلا يزيدون ولا ينقصون.
وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في اختصاصه بالغيب: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾( ). فنفى علم الغيب عمّن في السمٰوات والأرض إلا هو جل وعلا، وهـٰذا أمر واضح، ولذلك أجمع العلماء على أن من ادعى أنه يعلم ما في غدٍ فإنه كافر؛ لكونه مكذِّباً بالقرآن الكريم، ولما أجمع عليه علماء الأمة من أنّ الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
المؤلف –رحمه الله– ذكر في هـٰذا الباب عدّة أحاديث تبيّن خطورة الكهانة، وليس المقصود من الكلام هو هـٰذه الصّورة فقط من الإخبار بالغيب، إنّما المقصود التكهّن وكل طريق يسلكه الإنسان يخبر به عن المغيبات في المستقبل؛ لأنّ المعنى يشمل كل من أخبر بما يكون في المستقبل بأي طريق كان، سواء كان عن طريق النجوم أو كان عن طريق الجن أو غير ذلك من الطرق كالخط والطرق وما أشبه ذلك، فالجميع مذموم ومما جاء النهي عنه.
يقول رحمه الله: (باب ما جاء في الكهّان ونحوهم). يعني: من يسلك طريقهم في الإخبار عن المغيبات المستقبلة، فيشمل العرّاف ويشمل المنجّم ويشمل الرمّال، ويشمل من يسمى بالفقيه ويشمل من يسمى بالشيخ في بعض الجهات، يشمل كل من يخبر بالغيب، هـٰذا الضابط العام، كل من يخبر بالغيب بأي طريق فإنه يدخل في قوله رحمه الله: (ونحوهم). يقول: (روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)) ). هكذا ذكر المؤلف –رحمه الله– الحديث، والذي في صحيح مسلم ليس فيه قوله: ((فصدقه))، الذي في صحيح مسلم:((من أتى عرافاً فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) هـٰذا لفظ مسلم، وذكر التصديق في رواية أخرى غير رواية مسلم.
((من أتى عرافاً))؛ ((من)) هـٰذه أداة شرط، ((أتى)) المقصود بالإتيان: الإتيان الحضوري بالبدن، أو الإتيان بمعنى الإقبال ولو لم يحضر، كالذي يتصل على الكاهن بالهاتف ويسأله عما يكون، أو يكتب له رسالة يسأله عما يكون، فإن الإتيان منه ما يكون إتياناً بالفعل والحضور ومنه ما يكون الإتيان بالمعنى، والمراد: الإقبال، من أقبل على الكهان وقَبِل خبرهم، وأخذ منهم؛ فإنه مهدد بهـٰذا الوعيد.
((من أتى عرافاً)) والعراف: سيتكلم المؤلف -رحمه الله عن شرح معناه، ولكن اعلم أن العراف الصحيح في معناه أنه: اسم للمنجم والرمال والكاهن وكل من يخبر بالغيب، بأي طريق يسلكه، هـٰذا هو العراف، وإن كان بعض أهل اللغة يخصّ العرّاف بنوع خاص من المخبرين بالغيب، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله.
لكن الصّحيح أن العراف اسم يشمل المنجم والكاهن والرمّال وكل من يخبر بالغيب بأيّ طريق يسلكه، إلا ما كان من طريق الوحي، فالوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنّه خبر عن الله عز وجل، والخبر عن الله خارج عن الكلام.
((من أتى عرافاً فسأله)) الفاء هـٰذه عاطفة على فعل الشّرط ((أتى)) أي: من جاء وحصل منه السؤال.
((عن شيء)) وشيء هنا نكرة في سياق الشرط فيشمل كل سؤال، لكن اعلم أن السؤال المقصود هنا ما يتعلق بمهنته، لكن لو قال للكاهن: كيف حالك؟ هل يدخل في الحديث؟ الجواب: لا، مع أنه أتاه وسأله، لكن المقصود السؤال المتعلق بالوصف المذكور، وهو العرافة والكهانة، من أتى فسأله عن أمر من أمور الغيب، أما لو قال له: كيف حالك؟ أو متى تأتينا؟ أو أين أولادك؟ أو سأله عن أمر من الأمور التي يدركها الناس من دون ادعاء الغيب؛ فإنه لا يدخل في الحديث، ولذلك السؤال هنا عائد إلى الوصف المذكور وهو العراف.
((من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه)) هـٰذا أيضاً معطوف على فعل الشرط ((أتى)).
أما الجواب، جواب الشرط فهو قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)) لم تقبل، نفى القبول عن الصّلاة، والمراد بالصّلاة هنا الصلاة المفروضة والنّافلة؛ لأن ((صلاة)) نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، سواء كانت مفروضة أو نافلة، ونفي القبول دليل على أن سيئة إتيان الكاهن وسؤاله وتصديقه تحيط بالعمل الصالح فتحبطه، وليس المقصود أنّه يسقط عنه فرض الصلاة، بل هو مطالب بالصّلاة، ولو ترك الصلاة لكفر على قول بعض أهل العلم، إذا ترك صلاة واحدة وإذا ترك الصلاة بالكلية فهو كافر؛ لكن الكلام على أن نفي القبول هو بيان لعِظم سيّئة الفعل، لا لسقوط فرض الصلاة عنه، ولا لكونها لا تبرأ بها ذمّته، فذمته تبرأ ويسقط عنه المطالبة بالصلاة، لكن الأجر الذي يحصل من هـٰذه العبادة العظيمة الجليلة التي هي رأس العبادات وأعظمها وهي عمود الإسلام يذهب نفعها ولا يحصّل الإنسان من بركتها شيئاً، بسبب إتيان الكهان.
ورواية مسلم ليس فيها التصديق، فيكون هـٰذا العقاب المذكور في هـٰذا الحديث مرتّباً على إتيان الكهّان وسؤالهم ولو لم يصدقهم، فكلّ من أتى الكهان وسألهم عن أمر من أمور الغيب فإنه مهدّد بهـٰذه العقوبة العظيمة، وهي حبوط صلاته أربعين ليلة، فلا يقبل منه صلاة؛ لعِظم ما ارتكب.
واعلم أن هـٰذا الحديث اختص بهـٰذه العقوبة دون سائر الأحاديث التي فيها بيان عقوبة من أتى الكاهن، فالعقوبات المذكورة في الأحاديث غالبها الإخبار بكفر من أتى ((من أتى الكاهن فسأله)) كما سيأتي في الأحاديث الأخرى، فحديث مسلم اختص بأنه ذكر عقوبة حبوط العمل، أو العقوبة التي فيه هي: حبوط العمل، حبوط الصلاة أربعين ليلة، وسنبين الجمع بين الأحاديث إن شاء الله تعالى بعد أن نستعرضها.
يقول: (عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: ((من أتى كاهنًا فصدقه في ما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد)).)
هـٰذا الحديث كالسابق في التحذير من إتيان الكهان، هناك ذكر العراف وهنا ذكر الكاهن، وهو داخل في المعنى السابق.
((من أتى كاهناً فصدقه)) يعني: فيما سأله عنه ((بما يقول))، وهنا الحديث يشمل تصديق الكاهن سواء كان السؤال منك أو من غيرك، فإذا جاء الإنسان للكاهن وصدقه في خبره ولو لم يكن هو الذي سأل فإنه مهدد بهـٰذه العقوبة؛ لأن العقوبة ليست لمجرد السؤال، إنما العقوبة في التصديق بالخبر، ولذلك من جاء إلى الكاهن وسأله يريد بيان كذبه وزيفه وتضليله فإنه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بل هو مأجور على هـٰذا، ولا يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا))، ((أربعين ليلة)) ويدل على هـٰذا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل ابن صياد، سأله عن أشياء لما شكّ الصحابة أنه الدجال، فسأله عن أشياء اختباراً له، ثم بيّن -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كاهن من الكهان، فقال له: ((اخسأ فلن تعدو قدرك)) الشاهد في سؤال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لابن صياد، وهـٰذا يدل على جواز سؤال هؤلاء الذين يدعون الغيب لبيان كذبهم وزيف ما يقولون، وأنهم يرجمون بالغيب.
((من أتى كاهنًا فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد)) -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهـٰذه العقوبة غليظة وعظيمة، لكن هل هي معارضة للعقوبة السابقة؟ الجواب: ليست معارضة؛ لأن العقوبة السابقة مرتبة –كما في صحيح مسلم على المجيء والسؤال، ولم يُذكر فيها التصديق، فمن جاء وسأل الكهان فإنه متوعد بهـٰذه العقوبة سواء صدق الكاهن في قوله أو لم يصدقه، وأما قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أُنزل على محمد)) فقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فقد كفر بما أنزل على محمد)) يحتمل أنه الكفر المخرج عن الملة، ويحتمل أنه الكفر الذي لا يخرج به الإنسان عن الملة، بل هو كفر دون كفر، فإذا صدق الرجل الكاهن فيما يخبر به من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله كأن يقول: غداً سيأتيك كذا وسيحصل لك كذا من أمور الغيب فإنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه كذّب القرآن في كون الغيب لا يعلمه إلا الله، أما إن سأله في أمر يغيب عنه ويعلمه غيره، أو سأله ويعلم أن الكاهن إنما يخبر فيما يخبر به من أمور الغيب استناداً إلى استراق السمع وما تخبر به الجن، فإنه لا يكون بذلك كافراً كفراً أكبر؛ بل هو كفر دون كفر، فيكون كفراً موصوفاً بالكفر الأصغر، ومتوعّداً بقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً)) أو ((أربعين ليلة)) فتجتمع له العقوبتان:
* الوصف بالكفر.
* وأنه لا تُقبل له صلاة أربعين ليلة.
ومن هـٰذا نعلم أنّ الجمع بين العقوبتين في الحديثين، هو باعتبار اختلاف أحوال الناس، أحوال الآتين إلى الكهّان، فلا يخلو الآتي إلى الكاهن من أحوال:
الحالة الأولى: أن يصدقه في ادّعائه علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو العلم بالغيب المستقبَل، فهـٰذا كافر كفراً أكبر.
الحالة الثانية: أن يسأله مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب، إنما يخبر بما يخبر به من استراق السمع، وهو يقر أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أو يسأله عن غيب نسبي، كأن يسأله عن مسروق أو عمّن فعل كذا، أو عن مكان الضالة ويعلم أن الكاهن يستعين بالجن لمعرفة هـٰذه الأمور، فهـٰذا كفر دون كفر، وهو متوعد بأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)).
الثالث: الذي يسأل هزواً ويقول: خلينا نشوف إيش عنده، هـٰذا أيضًا يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أتى كاهناً فسأله، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) ولو كان على وجه المزح؛ لأن هـٰذا لا يجوز الاستهزاء به ولا المزح به؛ لأنه من الاستهزاء بآيات الله، إذ إن هـٰذا الرجل سيغتر ويظن أنه يُصدَّق قوله.
أما إن سأله، وهـٰذه هي الحالة الرابعة: إن سأله عن شيء يريد بيان كذبه وضلاله فإن هـٰذا مأجور على سؤاله، وقد فعله النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع ابن صياد.
وبهـٰذا تجتمع الأحاديث، على أن أكثر الأحاديث ليس فيها العقوبة السابقة: ((لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)) أو ((أربعين ليلة)) إنما فيها: ((فقد كفر بما أنزل على محمد)).
يقول: (وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: ((من أتى عرافًا أو كاهنًا)) ). جمع بين الأمرين، جمع بين ما تضمنه الحديثان السابقان؛ العراف والكاهن، ((فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهـٰذا كالذي قبله في التّفصيل.
(ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفًا) يعني: على ابن مسعود، ولا يضره الوقف؛ لأن مثل هـٰذا لا يُقال بالرأي، إنما هو مما له حكم الرّفع؛ لأنه لا يخبر فيه الصحابي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- برأيه وقوله.
(وعن عمران بن حصين مرفوعًا: ((ليس منَّا من تطير أو تُطُيِّر له)) ) انتقل المؤلف -رحمه الله- إلى حديث عمران، وفيه قال: ((ليس منَّا من تطير أو تُطُير له)).
التطير: هو التشاؤم، وسيأتينا في باب مستقل، نفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يكون المتطير من هـٰذه الأمة ((ليس منَّا)) أي: أمة الإسلام ((من تطير)) أي: تشاءم ((أو تُطُير له)) يعنى: أو تشوئم له، بأن يقال له: حظك اليوم ما هو حسن، حظك اليوم نحس، لا تذهب، لا تراجع في المعاملة الفلانية، لا تفعل هـٰذا الأسبوع العمل الفلاني، لا تتزوّج، لا تعقد عقدًا، هـٰذا كله من التطيّر، من التشاؤم الذي يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ليس منَّا من تطيَّر أو تُطُيِّر له)).
قال: ((أو تكهن أو تُكُهن له)) والفرق بينهما- مع أن التطير نوع من الإخبار بما سيكون؛ لأنه يتوقع من الطيرة أن يكون في الفعل خيرٌ له أو شر له، فيترك أو يفعل-: أن التكهن أعم من التطير؛ لأنه لا يختص بالتشاؤم، بل هو للخبر عن المستقبل على وجه الإطلاق، سواء فيما يُتشاءم به، أو فيما لا تشاؤم فيه.
((أو تكهن أو تُكُهن له)) تكهن بنفسه، بأن تعاطى الكهانة ((أو تُكُهن له)) بأن طلب من الكهان الخبر، أو وصى من يأتي له بالخبر من الكهان.
قال: ((أو سحر)) سحر بنفسه ((أو سُحر له)) أي طلب السحر من غيره، وهـٰذا فيه التحذير من الفعل ومن قصد الفاعل.
وفاتنا أن ننبه في الأحاديث السابقة، وفي هـٰذا الحديث أيضًا في قوله: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد)) هـٰذا فيه ما في الأحاديث السابقة من التحذير من إتيان الكهان، لكن تأمل هـٰذه الأحاديث: ((من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد)) هـٰذا هو عقوبة من يأتي الكاهن، فكيف بعقوبة الكاهن؟ وهـٰذا يدلك على عِظم شرّ العمل، وأنه فساد كبير، إذا كانت هـٰذه عقوبة من يأتي الكهّان فكيف بعقوبة الكهان أنفسهم؟ عقوبتهم أعظم وأشد وأشق، ولذلك يجب على المؤمن أن يَحْذَر منهم، وأن يُحَذِّر منهم، لا سيما وأن الكهانة شاعت وانتشرت بين الناس، وأصبحت علمًا يسمونه العلم النوراني في بعض البلدان، يسمونه علمًا نورانيّاً ، وهو علم نيراني في الحقيقة؛ لأنه يفضي بأهله إلى النار، ويوقعهم فيما يستوجبون به عقوبة رب العالمين؛ لأنهم ينازعون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ما اختص به من العلم بالغيب.
والعجيب أن بعض الصّحف في غير هـٰذه البلاد، في غير بلادنا تحتوي على زاوية للأبراج يخبر فيها عن السعود والنحوس، ولا سعد إلا من الله جل وعلا، ولا نحس إلا من نفسك، فيجب على المؤمن أن يَحْذَر من هـٰذه الأمور، وأن يُحَذِّر منها، الناس يتهاونون بها ويظنّونها فكاهة ونزهة ومتعة، نسأل الكاهن ويش يقول؟ خلونا نشوف حظنا، خلونا نشوف ويش نقابل، وهم في قرارة أنفسهم لا يصدقونه، لكن مجرد السؤال يُوقع الإنسان في المحذور الذي ذكره رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)) أو ((أربعين ليلة)) فيجب التحذير من هـٰذا وبيان شره، لا سيما وأن الناس انفتحوا على الخارج بالاتصالات والقنوات وغيرها من وسائل الاتصال بالمجتمعات التي بُليت بهـٰذه البلايا، نسأل الله -عز وجل- أن يطهِّر بلاد المسلمين من هؤلاء.
يقول: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ((ومن أتى)) ) يعني في آخر الحديث إلى آخره.
بعد أن فرغ المؤلف -رحمه الله- من ذكر النصوص والأحاديث التي فيها التحذير من إتيان الكهان وبيان أنه من الكفر، إما الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، قال رحمه الله: (قال البغوي: العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.)
هـٰذا في بيان معنى العراف في اصطلاح خاص، وإلا من حيث المعنى العام ذكرنا لكم أنه اسم للكاهن والمنجم والرمال وكل من يخبر بأمور الغيب بأي طريق يسلكها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان المعنى اللغوي لا يساعد على هـٰذا العموم فإنه يشمله العموم المعنوي، فالعموم المعنوي للكاهن والمنجم يدخله في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)) وفي قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)).
(والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم) يعني: من الذين يخبرون بالغيب لذلك قال: (ممن يتكلم في معرفة الأمور بهـٰذه الطرق.)
إذًا الفرق بين المنجم والكاهن والرمال وغيرهم ممن يخبر عن أمور الغيب، هو في الطريق الذي يتوصلون به إلى الخبر عن الغيب، أما المعنى العام الذي يشتركون فيه فهو أنهم يتكلمون عن أمور غيبية لا يعلمها إلاّ الله، وهـٰذا من أجمع الكلام وأوضحه.
قال رحمه الله: (وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) ) ما هو أبا جاد؟ أبجد هوّز حطّي كلمن.. إلى آخره، هـٰذه الكلمات يستعملها بعض الناس لمعرفة الغيب، حيث يجعلون لكل حرف رقمًا، وهـٰذه الأرقام تُجمع وتُطرح ويُبنى عليها الخبر الذي يُخبرون به، ولذلك ذكرها المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب، فـ (أبا جاد) هي استناد إلى (أبا جاد) أحد الطرق التي يُتوصّل بها إلى التكلم بالغيب، فهي من جنس فعل الرمّال، ومن جنس فعل العرّاف، ومن جنس فعل المنجّم والكاهن.
قال: (وينظرون في النجوم) يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم، فجمعوا طريقين: استعمال الحساب، واستعمال النجوم.
(ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق) يعني: من نصيب؛ لكونه قد كفر بالله -عز وجل- ونازع الله فيما اختص به من علم الغيب.
[المتن]
وفيه مسائل:
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
[الشرح]
نعم صحيح؛ لقوله: ((كفر بما أنزل على محمد)) والذي أُنزل على محمد هو القرآن الكريم: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾( ). [المتن]
الثانية: التصريح بأنه كفر.
[الشرح]
ذكرنا أنه يحتمل الكفر الأكبر أو الأصغر، نعم.
[المتن]
الثالثة: ذكر من تُكهن له.
الرابعة: ذكر من تُطير له.
الخامسة: ذكر من سحر له.
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
[الشرح]
ما هو الفرق بين الكاهن والعرّاف؟ اختلاف الطرق في التوصل إلى الغيب.
طيب، أيهما أقرب للإصابة، المنجم أو الكاهن؟ الكاهن، وجه ذلك أن الكاهن إما أنه يستدل بمقدمات أو يتلقى عن مسترق السمع، أما المنجم فيعتمد على حركة النجوم، والضلال فيها أعظم وأكبر.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في النُّشرة
عن جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عنه أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل عن النُّشرة؟ فقال: ((هي من عمل الشيطان)) رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هـٰذا كله.
وفي "البخاري" عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. اهـ.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
إحداهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهـٰذا جائز.
[الشرح]
قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في النشرة)
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن النشرة منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، فاحتاج المؤلف رحمه الله لذكرها لبيان ما يجوز منها مما لا يجوز، هـٰذه مناسبته لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للكتاب الذي قبله؛ فإنه في الباب السابق ذكر المجيء إلى الكهان بعد ذكر السحر وأنواعه؛ لأن كثيراً من الناس إذا بلوا بهـٰذا البلاء العظيم، إذا بُلوا بالسحر طلبوا علاجه من الكهان، فذكر رحمه الله الطريق الثاني الذي يُسلك في كشف هـٰذا البلاء وعلاجه، وهو النشرة، ولم يجزم رحمه الله في الترجمة بحكم، بل أطلق ذلك بقوله: (باب ما جاء في النشرة)؛ لأن الذي جاء في النشرة ليس على وجه واحد، بل هو مختلف وذلك باختلاف نوع النشرة.
والنشرة: فُعلة، مأخوذة من النشر، وهـٰذه المادة دائرة في معناها على الكشف والإظهار، النشر يدور على الكشف والإظهار، وسميت النشرة بهـٰذا الاسم لأنه يُكشف بها ما حل بالمسحور، ويُظهر بها ما نزل به، ويخرج بها مرضه وداؤه، فلذلك سميت نشرة، ولم يفسرها المؤلف -رحمه الله- في بداية الباب، بل نقل كلام ابن القيم فيها وقد تضمن معناها فقال: النشرة حل السحر عن المسحور، وهـٰذا في الحقيقة اصطلاح خاص، وإلا فالنشرة أعم من ذلك، إذ إنها تطلق على كل أوجه الاستطباب، ولذلك سمى العلماء رحمهم الله الاستغسال -طلب الغسل من العائن- نشرةً، سموه نشرةً لأنه يُكشف به ويزال به ما نزل بالمعيون، بمن أصابته العين، وأيضًا أطلقوه على الرقى وعلى التعويذات، والرقى والتعويذات لا يقتصر استعمالها في السحر بل هي أعم من ذلك، فالنشرة على وجه العموم تشمل كل أوجه الاستطباب وطلب رفع الداء، لكن في الاصطلاح الخلاص هي حل السحر عن المسحور.
ذكر المؤلف رحمه الله في هـٰذا الباب حديثًا وآثاراً، أما الحديث فقال: (عن جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل عن النشرة) سُئل عن النشرة ولم يبين السائل، والمسؤول عنه هو النشرة، والنشرة هنا معرفة بالألف واللام، واختلف العلماء في الألف واللام هنا، هل هي للجنس؟ أم هي للعهد؟ فمنهم من قال: إنها للجنس، ومنهم من قال: إنها للعهد، والصحيح: الثاني، أنها للعهد؛ لأن النشرة لا تدخل كلها فيما ذكره رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ((هي من عمل الشيطان))؛ بل الذي يدخل في ذلك ما كان معروفًا في الجاهلية، وهو حل السحر بالسحر، أو حل السحر بالمجيء إلى الكهان أو ما أشبه ذلك من الطرائق التي كانوا يسلكونها في حل السحر عن المسحور، فالنشرة هنا الألف واللام فيها للعهد الذهني، وهو ما كان معهودًا معروفًا عند أهل الجاهلية، هكذا قال كثير من الشراح لهـٰذا الحديث، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز رحمه الله، وكذلك اختيار شيخنا محمد رحم الله الجميع.
يقول: (فقال: ((هي))) أي يقول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جواب هـٰذا السائل: ((هي من عمل الشيطان)) أي النشرة من عمل الشيطان، و((من)) هنا تبعيضية، و((عمل الشيطان)) أي من سعيه وتزيينه وشأنه، فقوله: ((من عمل الشيطان)) يعني: مما يدعو إليه، قد لا يباشرها الشيطان بنفسه، قد يباشرها الساحر، قد يباشرها الكاهن، لكن لما كان الحامل إليها والداعي إليها الشيطان كانت مضافة إليه.
ومن هـٰذا نعلم أن الإضافة قد تكون بسبب التزيين والدعوة والحث على الفعل ولو لم يباشره الإنسان، فهنا قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جواب السائل-: ((هي من عمل الشيطان)). وهـٰذا كافٍ في أي شيء؟ في التنفير عنها والتحذير منها وبيان منعها؛ لأن التحريم يستفاد من النصوص بصيغ عديدة، وليس بصيغة واحدة، من هـٰذه الصيغ أن يضاف العمل للشيطان، ومن ذلك قول الله تعالى في الأنصاب والأزلام والخمر: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾( ) فأضافها إلى عمله وسعيه وتزيينه وحثه، والشيطان له أثر على قلب الإنسان من جهة دعوته إلى أعمال السوء والشر وتزيينها له.
قال المؤلف رحمه الله: (رواه أحمد بسند جيد) أي روى هـٰذا الحديث الإمام أحمد بسند جيد، وهـٰذا الحكم مستفاد من كلام ابن مفلح رحمه الله في الفروع، فإنه حكم على الحديث بهـٰذا الحكم، وحسنه الحافظ في الفتح، وتكلم عنه تضعيفًا أو تليينًا أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فقال بعد ذكر الأحاديث التي في هـٰذا المعنى: وهـٰذه الأحاديث والآثار لينة.
وهـٰذا أحد ما أُجيب به على الحديث على وجه العموم؛ لأنه إذا قلنا: النشرة هنا عامة تشمل كل ما يُحل به السحر عن المسحور حتى المباحات، فإنه يُشكل على ما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث ابن مسعود لما سُئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، وقال: لا بأس ما لم تكن شركًا، وهناك إذن وحث، إذن في قوله: لا بأس ما لم تكن شركًا، وحث في قوله: من استطاع أن ينفع أخاه في شيء فلينفعه.
ولذلك ضعف بعض العلماء الحديث من جهة السند وأيضًا من جهة المعنى، لكن الخروج من إشكال المعنى أن نقول: إن النشرة هنا الألف واللام فيها للعهد، وعلى هـٰذا فالحديث حكم على نوع خاص من النشرة وليس حكمًا على جميع أنواعها.
وقال: (سُئل أحمد عنها فقال) أي سُئل أحمد عن النشرة فقال: (ابن مسعود يكره هـٰذا كله) يكره هـٰذا كله أي: يكره ماذا؟ يكره النشرة كلها، وهـٰذا ظاهره أنه يكره حتى المباح منها، ولكن هـٰذا الظاهر ليس متوجهًا؛ لأن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- هو راوي الحديث، حديث الرقى التي فيها الإذن، بل والحث في قوله: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه))، وهـٰذا يشمل نفعه فيما يتعلق بالسحر وبغيره من الأمراض التي تصيب البدن.
والإمام أحمد -رحمه الله- لما سُئل أجاب بأثر ابن مسعود لذلك، وهـٰذا الجواب لعله لعدم صحة الأحاديث عنده، وإلا فما يصرف الإمام أحمد الجواب من السنة إلى الأثر إلا لحكمة، وهي أنه لم يكن يثبت عنده شيء في ذلك، وهو الظاهر من اختياره -رحمه الله- كما سيتبين بعد قليل.
يقول: (وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب) يعني: به سحر (أو يؤخذ عن امرأته) يعني يُصرف عنها، ولا يتمكن من إتيانها، وهو ما يسمى بسحر الصرف (أيحل عنه) يعني: هل يطلب الحل عنه؟ أيحل عنه؟ هل يجوز أن يُسعى في حل السحر عنه؟ (أو ينشر؟) يعني: أو تُطلب له نُشرة وتستعمل النشرة في حل ما نزل به؟ (قال: لا بأس به) لا بأس به هـٰذا إذن وإباحة (إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه).
فقوله: (لا بأس به) هو بيان لعدم المنع، وقوله: (إنما يريدون به الإصلاح) هـٰذا بيان لأن هـٰذا الفعل مستحب؛ لأنه إذا كان يراد به الإصلاح فالإصلاح مطلوب ومندوب إليه (إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه)؛ لأن ما نُهي عنه هو الضار كما قال الله جل وعلا: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ﴾( ) فأنكر عليهم تعلم ما يضر وليس فيه نفع.
وظاهر كلام ابن المسيب -رحمه الله- أنه يجوز حل السحر بأي وسيلة حتى بالسحر؛ لأنه علل الإباحة وعدم المنع بأنه (إنما يريدون به الإصلاح) أي بهـٰذا الفعل (فأما ما ينفع فلم ينه عنه) يعني: أما ما ينفع من السحر فإنه لم يُنه عنه، فظاهر كلام ابن المسيب رحمه الله جواز حل السحر بالسحر، وهـٰذه المسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله على قولين، المسألة فيها قولان:
القول الأول: جواز حل السحر عن المسحور، وهـٰذا هو قول الأصحاب.
والثاني: عدم الجواز.
والثالث: التوقف، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان صاحب الفروع قال: وهو إلى الجواز أميل.
لكن اعلم أن الذي أجازه العلماء من ذلك هو ما لا يفضي إلى الشرك، وما لا يقع فيه الإنسان بالشرك، أما ما أفضى إلى الشرك، أو وقع به الإنسان في الشرك؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الشرك لا تحله الضرورة، وإنّما تحل الضرورة الممنوعات والمحظورات. والذي يترجح من هـٰذه الأقوال: هو عدم جواز حل السحر بالسحر؛ لحديث جابر (أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئل عن النشرة، فقال: ((هي من عمل الشيطان)) ). ومعلوم أن السحر إنما هو من عمل الشيطان، والأصل فيه الضرر، والأصل فيه عدم تحصيل المقصود؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾( ) حيث أتى: من أي جهة جاء، أراد نفعًا أو ضرّاً، فنفى عنه الله تعالى الفلاح وهو تحصيل المطلوب، وتحصيل القصد والغرض.
ثم إن الغالب في السحرة أنهم لا يتوصلون إلى ما يريدون من حل السحر إلا بكفر أو شرك، ثم بعد بيان أدلة القائلين بالمنع، الذين قالوا بالجواز أجازوه للضرورة، والحقيقة أن المحرم لا تبيحه الضرورة إلا إذا توفر فيه شرطان، فإذا لم يتوفر هـٰذان الشرطان فإن الضرورة لا تبيح المحرم، هـٰذان الشرطان هما:
أولاً: تعين هـٰذا الطريق لتحصيل المقصود، يعني: لا سبيل إلى تحصيل المقصود إلا من هـٰذا الطريق المحرم، فليس هناك طرق أخرى يسلكها لتحصيل غرضه ومقصوده.
والثاني: تيقن حصول المقصود بارتكاب المحرم.
وهـٰذان الشرطان كلاهما منتفٍ في إتيان السّحرة لحلّ لسحر، فإن حلّ السحر لا يتعين له هـٰذا الطريق، يعني: ليس حل السحر فقط من طريق السحرة، بل يُحل السحر بغير ذلك، بالدّعاء والرقى والأسباب التي تُؤخذ وتُتّبع من غير الشرك والكفر، ومن غير إتيان السحرة، إذًا اختلّ الشرط الأول وهو ماذا؟ تعيّن هـٰذا الطريق لدفع الضرورة، فالآن لم يتعيّن إتيان الساحر لدفع الضرورة، هناك طرق أخرى.
الثاني: وهو تيقّن اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم، هـٰذا أيضًا غير موجود، كثيرًا ما يذهب هؤلاء إلى السحرة ولا يحصلون مقصودهم، بل يصرفون أموالهم، ويكدون أبدانهم بالسفر والذهاب والإياب ولا يحصل لهم غرضهم، فليس حصول المقصود متيقّنًا.
إذًا الشّرطان اللذان يحصل بهما إستباحة المحرم للضرورة غير متوفرين، واضح؟ واضح أم لا يا إخوان؟
إذًا لا يجوز الإتيان إلى السحرة لحل السحر.
الأمر الثّاني في الجواب على إباحة إتيان السّحرة للضّرورة، أن العلماء قرروا أنه لا ضرورة في مسألة الدواء، يعني: مهما بلغ المرض بالإنسان فإنه لا ضرورة له في أخذ الدّواء؛ لأن الداء قد يندفع بلا سبب، وإذا كان كذلك فإنه لا يتعيّن ارتكاب المحذور، وليس ما يتعلق بالأمراض من الضرورات، وهـٰذا وجه ثالث وإن كان يرجع إلى أحد الشرطين ولكنه ذُكر مستقلاًّ وهو واضح إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: (وروي عن الحسن أنه قال: لا يحلّ السّحر إلا ساحر.)
هـٰذا بيان للغالب في حل السّحر، وأنه لا يكون إلا من السحرة، ولا يعني أن السحر لا يرتفع أثره إلا بالسحر؛ بل الكلام على الذين يدّعون أنهم يستطيعون حلّ السحر ويستطيعون كشف أثره، فهؤلاء في الغالب أن يكونوا سُحَّارًا، أو سحرةً.
وأما حلّ السّحر: فالسحر يحل بالسحر ويحل بغيره من الطرق، كالقراءة والتعاويذ والدعاء وإخراج السحر ونقضه، فالطرق كثيرة لحل السحر، لكن الكلام على من يدّعي أنه يستطيع أن يحل السحر، وأن يكشف ما بالمسحور، الغالب أن يكون ساحرًا.
وهـٰذا الكلام من الحسن -رحمه الله- يبين لنا أنه يرى تحريم النشرة؛ لأن النشرة التي شاعت في استخدام المتقدمين هي حل السحر بالسحر، ولذلك قال رحمه الله: (لا يحل السحر إلا ساحر).
وقوله: (إلا ساحر) بيان لتحريم ذلك؛ لأنّ الوصف بالسحر لا يُوصف به إلا على وجه الذم، لا يكون على وجه المدح، حتى فيما ينفع.
وبهـٰذا نعلم أن السلف -رحمهم الله- اختلفوا في حل السحر بالسحر على قولين:
القول الأول: الإباحة.
والقول الثاني: التحريم.
وذكرنا هذين القولين، وذكرنا أدلة القائلين بجوازه للضرورة، وأدلة المانعين، وأجبنا على قول من قال: إن ذلك ضرورة، أليس كذلك؟ طيب.
ثم قال رحمه الله: (قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور).
هـٰذا اسمها العام، فهي حل السحر عن المسحور، ولم يبين ابن القيم -رحمه الله- الطريق الذي يُسلك لحل السحر عن المسحور؛ لكونه يشتمل على الطرق المباحة وعلى طرق محرمة.
قال رحمه الله: (وهي نوعان) هـٰذا بيان أنواع حل السحر.
يقول: (حل بسحر مثله) أي حل السحر بسحرٍ مثله.
(وهو الذي من عمل الشيطان) يعني: هـٰذا الذي أجاب عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سُئل عن النشرة فقال: ((هي من عمل الشيطان))؛ لأنها لا يمكن أن تكون طريقًا مباحًا لرفع السحر، إذ إن الفساد لا يُدفع بالفساد والشر لا يُدفع بالشر.
ولا يقال: إنه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؛ لأن المفسدة قد حصلت وانتهت، وحل السحر بالسحر ليس دفعاً لمفسدة، إنّما هو ارتكاب لمفسدة جديدة، فلا يقال: إن هـٰذا من باب دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، فإن المفسدة الأولى وهي انعقاد السحر قد مضت وانتهت، وإنما يقال هـٰذا في ما إذا كان الإنسان مضطرّاً لارتكاب إحدى المفسدتين، أما أن يأتي بمفسدة جديدة ويقول: هـٰذا من باب دفع المفسدة بمفسدة أهون منها فليس بصحيح.
قال: (وعليه يحمل قول الحسن في قوله: لا يحل السحر إلا ساحر).
يقول –رحمه الله– في بيان أن ذلك من عمل الشيطان: (فيتقرب الناشر والمنتشر) الناشر: الذي يحل السحر، والمنتشر: المسحور- (إلى الشيطان بما يحب)، يعني من الأقوال أو الأعمال أو غير ذلك من وسائل التقرب.
وقد يقول قائل: إن التقرب لا يكون من المنتشر إنما يكون من الناشر، يعني الذي يتقرب هو الناشر فقط –الساحر- نقول: ما أفضى إلى الشيء فله حكمه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا علمت أن هـٰذا لا يتمكن من حل السحر إلا بطريق محرم فلا يجوز لك أن تأتيه؛ لأنك ستكون سببًا لارتكاب الشرك والكفر، والله –عز وجل- منع المحرم ومنع الوسائل المفضية والمؤدية إليه.
فلو قال قائل: إن المسحور يذهب إلى الساحر لا يتقرب بعبادة ولا بذبح ولا بغيره، إنما يدفع مالاً ليتخلص من شر السحر الذي عانى منه؟ فالجواب: أن هـٰذا لا يجوز؛ لأن هـٰذا إعانة للساحر على سحره الذي لا يتوصّل إليه في الغالب إلا بالكفر والشرك.
قال: (فيبطل عمله عن المسحور) يبطل عمل السحر عن المسحور.
(والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهـٰذا جائز)، وقوله: (جائز) في مقابل التحريم في القسم السابق، وإلا فقد يكون مستحبّاً إذا كان السحر يعوق الإنسان عن كمال الطّاعة، وقد يكون واجباً إذا كان السِّحر يعوق الإنسان عن الواجبات، كالسحر الذي يمنع الإنسان من العبادة، ويمنع الإنسان من الإتيان بها على الوجه الواجب، فقوله: (جائز) هـٰذا بيان لأصل الحكم، يعني: الحكم في الأصل، وقد ينتقل عن هـٰذا الأصل إلى الوجوب أو الاستحباب على حسب حال المسحور وتمكنه من رفع ما نزل به، وهـٰذا الطريق سلكه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ما نزل به من السحر، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُحر ولم يسلك سوى هـٰذا الطريق في حله، إذ إنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استعمل الأدعية الشرعية والتعويذات لحل السحر، ثم هدي إلى مكان السحر فاستخرجه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وانحلّ ما به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، على أن السحر الذي أصاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس سحرًا يؤثر على تبليغه الرسالة، بل هو في أمر خاص كان يخيل له أنه أتى النساء ولم يكن قد أتاهن -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وبهـٰذا يكون قد تم الباب الذي عقده المؤلف –رحمه الله– لبيان حكم حل السحر عن المسحور.
[المتن]
فيه مسائل
الأولى: النهي عن النشرة.
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
[الشرح]
وهـٰذا واضح، فالمنهي عنه ما كان بسحر، والمرخص فيه ما كان بالأدعية والتعويذات المباحة.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس السادس عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في التطير
وقول الله تعالى: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾( ).
وقوله: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾( ) الآية.
عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر)). أخرجاه، زاد مسلم: ((ولا نوء، ولا غول)).
ولهما عن أنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل)). قالوا: وما الفأل؟ قال: ((الكلمة الطيبة)).
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: ((أحسنها الفأل، ولا ترد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك)).
وعن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعاً: ((الطيرة شرك، الطيرة شرك))، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
ولأحمد من حديث ابن عمرو: ((من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك)). قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: ((أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إلـٰه غيرك)).
وله من حديث الفضل بن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)).
[الشرح]
قال المؤلف –رحمه الله– في هـٰذا الباب الجديد: (باب ما جاء في التطير)
والتطير هو: التشاؤم والتفاؤل، وأصله مأخوذ من الطير، وذلك أن العرب كانت تتفاءل في الأصل بالطير وتتشاءم بالطير وحركاتها وأصواتها، ثم أطلق هـٰذا اللفظ على التشاؤم خاصة، ويقابله الفأل، فإن الفأل من التيامن، وهو طلب اليمن واليسر.
الطيرة جاء بها المؤلف –رحمه الله– في هـٰذا الباب في كتاب التوحيد لأن الطيرة شرك، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((الطيرة شرك)). ووجه كون الطيرة شركاً أن فيها اعتقاد التأثير في غير مؤثر، يعني التأثير من غير مؤثر ممن لا يصلح أن ينسب إليه التأثير، وهو حركات الطيور وأصواتها، فلما كانت هـٰذه النسبة- أي: نسبة اليمن والشؤم إلى ما لا يصح نسبة الشيء إليه- كان ذلك من شرك الأسباب، وقد يرقى بصاحبه إلى الشرك الذي هو الكفر، الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة على حسب ما يقوم بقلب صاحبه، وهـٰذا قد قررناه سابقاً، وهو أن الشرك الأصغر قد ينتقل إلى الأكبر باعتبار ما يقوم بقلب الفاعل، هـٰذا وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للأبواب التي قبله: فإنه في الأبواب التي قبله ذكر الكهانة، وهي إحدى الطرق التي يستكشف بها الغيب ويستجلى بها المستقبل، وفي هـٰذا الباب ذكر طريقاً آخر يسلك لاستكشاف الغيب واستشرافه وهو الطيرة، فإنهم يستدلون بحركات الطيور وأصواتها على ما سيكون في المستقبل من اليمن والشؤم، من اليسر والعسر، فأتى به المؤلف –رحمه الله– بعد باب الكهانة للمناسبة بينهما في كونهما يشتركان في استكشاف الغيب واستجلائه.
ولم يجزم المؤلف –رحمه الله– في الطيرة بحكم؛ لأن الطيرة منها ما أقره النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو الفأل، فإن الفأل مضاف إلى الطيرة، ولذلك جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف –رحمه الله– أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن الطيرة، نهى أو نفى يحتمل النهي ويحتمل النفي في قوله: ((لا عدوى، ولا طيرة))، ثم قال: ((ويعجبني الفأل)) بعد ذكر الطيرة، وهـٰذا يدل على أن الفأل في الجملة من الطيرة.
ثم إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جاء عنه الخبر بأن الطيرة التي هي الشؤم تكون في أشياء فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة)).
وفي رواية مسلم: ((والخادم)) بدل ((المرأة))، وسيأتي الكلام على هـٰذا إن شاء الله تعالى.
فلما كان الأمر كذلك لم يجزم المؤلف –رحمه الله– في الترجمة بحكم بين، بل أطلق ذلك ليستقى ويستفاد مما يذكره من النصوص، يعني يستفاد حكم الطيرة مما يذكر من النصوص.
ذكر المؤلف –رحمه الله– في باب الطيرة آيتين وأحاديث، أما الآيتان فقال المؤلف –رحمه الله–: وقول الله تعالى: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾( ). هـٰذه الآية ذكرها الله عز وجل في قصة موسى مع قومه حيث قال – جل وعلا-: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هـٰذه﴾ هـٰذا قول قوم فرعون ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ﴾ والحسنة المراد بها النعمة في المال والأهل والرزق وغير ذلك، فالحسنة المراد بها النعمة في كل شيء ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هـٰذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ والسيئة هنا المصيبة ﴿يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ فماذا كان الجواب على هـٰذا الفعل من رب العالمين؟ قال: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾. فأنكر الله –جل وعلا– على هؤلاء تطيرهم بموسى ومن معه، أي تشاؤمهم بموسى ومن معه، فإنهم يتطيرون بموسى ومن معه في ما أصابهم ويقولون: ما أصابنا، يعني: ما أصابنا من البلايا والنقم والنوازل إلا بسبب وشؤم موسى ومن معه، فأجابهم القرآن فقال: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وأتى بهـٰذه العبارة التي استرعى فيها الانتباه أولاً حيث أتى بأداة التنبيه وهي ﴿أَلا﴾، ثم أتى بأداة الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا﴾، ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ﴿طَائِرُهُمْ﴾: أي شؤمهم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي من قِبل الله - جل وعلا –. هـٰذا أحد ما فسرت به هـٰذه الآية، فشؤمهم من قبل الله عز وجل، لكن الله –جل وعلا– لا يظلم الناس شيئاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً﴾( )، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ﴾( )، ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾( ). فالشؤم الذي نزل عليهم من الله هو بسبب أعمالهم، وقد جاء ذلك مصرحاً به في تشاؤم الكفار بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حيث كانوا يقولون في قولهم للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هـٰذه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هـٰذه مِنْ عِنْدِكَ قُل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾( ) الحسنات والسيئات المصائب والنعم ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وهـٰذا نظير الجواب هنا: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ﴾ أي ما نزل بهم ممّا يسوؤهم ويكرهونه من عند الله، فكل بقضاء وقدر: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾( ).
ثم بعد ذلك بين الله –جل وعلا– لرسوله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التفصيل في هـٰذا فقال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾( ) من نفسك أي منك بسبب عملك وبسبب كسبك، وأما الحسنة فهي محض فضل من رب العالمين. فمعنى قوله: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: إن شؤمكم الذي نسبتموه إلى موسى ومن معه إنما هو من عند الله، وذلك بسبب كفركم وجحودكم واستكباركم، وهـٰذا أحد ما قيل في تفسير هـٰذه الآية. وقيل في قوله: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: ما قضي عليهم وقدر من عند الله، وهـٰذا عائد في الحقيقة إلى المعنى السابق.
ثم قال: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يعلمون ذلك علماً يدركون به أن ما أصابهم إنما هو بسبب سيئاتهم فينتهون عنها، ونفي العلم عنهم ليس العلم الذي يحصل به إقامة الحجة إنما العلم الذي يحصل به النفع والثمرة والالتزام بما جاء به الرسول.
قال: (وقوله) أي وقول الله تعالى: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾( ).
في جواب من هـٰذا؟ هـٰذا في جواب أصحاب القرية في سورة يس، فإنهم لما تطيروا بالرسل الذين جاؤوهم وقالوا: إنا تطيرنا بكم، قال لهم رسلهم: ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ أي شؤمكم وشركم معكم، وذلك بسبب ما كان منهم من العمل السيئ الذي به استوجبوا النقم واستوجبوا نزول السيئات بهم.
ففي هـٰذه الآية نسب الطائر إلى من؟ إلى الخلق، وفي الآية السابقة نسب الطائر إلى الله عز وجل،فما الفرق بين النسبتين؟ هل بينهما تعارض؟
الجواب: لا ليس بينهما تعارض، بل النسبتان صحيحتان، فهم شؤمهم معهم لأنه بعملهم وكسبهم، وشؤمهم من الله لأنه هو الذي عاقبهم على هـٰذه السيئات وهـٰذه المعاصي، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: الطائر هو عمل الإنسان وجزاؤه، أي وجزاء العمل، فإذا أضيف إلى الله كان بمعنى الجزاء، وإذا أضيف إلى العبد كان بمعنى العمل، فقوله تعالى: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي جزاء عملهم، فحيث نسب الطائر إلى الله كان المراد به الجزاء على العمل والثواب على العمل، وحيث ما أضافه إلى العبد كان المراد به العمل نفسه، ومن ذلك قول الرسل لقومهم: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾.
ومنه أيضًا قول الله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾( ) ﴿أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ﴾ أي: عمله وجزاء عمله، فيلزمه الله عز وجل يوم القيامة عمله في كتاب يلقاه منشوراً، ويلزمه جزاء العمل لأنه مرهون بعمله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾( )فهم مفكوكون من هـٰذه الرهنة.
إذاً اتضح لنا معنى الطائر، وما قاله ابن القيم –رحمه الله– ينتظم جميع ما قيل في تفسير الآيتين وهو واضح سهل.
الطائر في لغة العرب: هو العمل وجزاؤه، فإذا أضيف إلى الله كان الجزاء، وإذا أضيف إلى الإنسان إلى العبد المخلوق كان بمعنى العمل.
والآيتان ظاهرهما ما هو؟ إثبات الشؤم أو لا؟ نعم إثبات الشؤم؛ لأن الله عز وجل أضاف الطائر إليه جزاءً وأضاف الطائر إليهم عملاً، وهـٰذا ليس هو التطيّر الممنوع، إنما أراد المؤلف –رحمه الله– بيان أن الشؤم يكون من الإنسان ويكون عقوبة للإنسان: يكون من الإنسان بعمل السيئات، ويكون عقوبة للإنسان بسبب عمل السيئات. وهـٰذا الشؤم ليس هو الشؤم الذي نفاه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأخبر فيه أن الطّيرة شرك؛ لأن هـٰذا ليس فيه تشاؤم، إنما فيه الخبر بالشؤم الحاصل على الإنسان بسبب معصيته أو بسبب عمله.
قال –رحمه الله- بعد ذكر الآيتين: (عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)). أخرجاه، زاد مسلم: ((ولا نوء ولا غول)).)
فالمنفي في هـٰذا الحديث ستة أمور: العدوى والطيرة والهامة والصفر والنوء والغول، ستة أمور نفاها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فما معنى النفي؟
أولاً بعض العلماء قال: إن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا عدوى ولا طيرة)) إلى آخره، هـٰذا نهي وليس نفيًا، وقال آخرون: إنه نفي، والصحيح أنه نفي، وهو أبلغ من قولنا: إنه نهي؛ لأن النفي يتضمن النهي، نفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث العدوى، وما هي العدوى؟ هي انتقال المرض من المريض المعيوه- يعني الذي أصابته عاهة- إلى الصحيح، هـٰذا معنى العدوى، فنفى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك.
ويشكل على هـٰذا النفي أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صح عنه قوله: ((لا يورد ممرض على مصح)). فنهى عن إيراد المريض على الصحيح، ويشكل عليه أيضًا أنه قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)). وهـٰذا يشعر إثبات العدوى ويظهر منه ذلك.
ولذلك اختلف العلماء – رحمهم الله – في الجمع بين هـٰذه النصوص: فبعضهم لم يجد للجمع سبيلاً، فحمل أحاديث نفي العدوى على أنها إما أن تكون ناسخة أو منسوخة.
وحاول بعضهم التّرجيح، فرجّح أحاديث نفي العدوى على أحاديث إثبات العدوى، وهـٰذان طريقان.
الطريق الثالث الذي سلكه جمهور العلماء: الجمع بين النصوص؛ لأنّه إذا كان الجمع ممكناً فإنه لا يصار إلى النسخ والترجيح؛ لأن النسخ إبطال لأحد النصين، وكذلك الترجيح إبطال لأحد النصين، وما أمكن العمل فيه بجميع ما ورد أولى من تعطيل بعض الوارد، ولذلك المسلك الصحيح في هـٰذا هو مسلك الجمع بين النصوص الواردة في نفي العدوى وإثباتها، وسلكوا في الجمع مسالك عديدة أصحها أو أقربها للصواب ما يلي:
أن النّفي في الأحاديث ليس نفيًا لأصل العدوى ووجودها، إنما هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه من المريض إلى الصحيح، هـٰذا ما نفاه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذاً النفي ليس للوجود، العدوى موجودة، وإنما المنفي هو انتقال المرض بنفسه دون إرادة الله عز وجل، هـٰذا الذي نفاه، وهـٰذا الذي كان عند أهل الجاهلية، وهـٰذا المسلك من مسالك الجمع رجحه شيخنا عبد العزيز بن باز –رحمه الله– ومال إليه شيخنا محمد –رحمه الله– وذكره كثير من الشراح، أن النفي في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا عدوى)) ليس لأصل العدوى، يعني: ليس لوجودها فهي موجودة، إنما المنفي ما كان يعتقده الجاهليون من أن المرض ينتقل بنفسه.
والطريق الثاني من طرق الجمع:
أن النفي هنا على حقيقته، وأنه لا عدوى وأن المرض لا ينتقل، فالنفي نفي للوجود، وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يورد ممرض على مصح)) وقوله: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) هـٰذا لحفظ اعتقاد الإنسان من أن تقع العدوى بسبب مخالطة المريض فيظن كذب ما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وليس لكون العدوى تؤثر، فالأحاديث التي ظاهرها إثبات العدوى لا تفيد إثبات العدوى، إنما لصيانة اعتقاد الإنسان من أن يظن -إذا أصيب بسبب المخالطة للمريض- أن ذلك بسبب العدوى، فيكون مكذباً لما جاء عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من نفي العدوى، فيكون قوله: ((لا يورد ممرض على مصح)) وقوله: ((فر من المجذوم)) هـٰذا القول ليس لإثبات العدوى، إنما لأجل ماذا يا إخوان؟ لصيانة اعتقاد الإنسان من تكذيب خبر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في نفي العدوى، وهـٰذا سلكه جماعة من العلماء، وهو الموافق لظاهر النص في قوله: ((لا عدوى))، ولكن الأقرب للنفس والقبول هو القول الأول.
وهناك مسالك عديدة ذكروا ستة أو سبعة مسالك مجموع ما ذكر في الجمع، لكن ما نريد أن نطيل المقام بذكر ذلك، يراجع في كتب الأحاديث.
ثم قال: ((ولا طيرة)) هـٰذا أيضًا نفي للطيرة، نفى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الطيرة، والمنفي هنا هو التّشاؤم ويتضمن النهي، والتطير المنفي هو التشاؤم بمسموع أو مرئي، فنفى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التشاؤم ولا إشكال فيه.
يبقى الجواب على الأحاديث التي ظاهرها إثبات الشؤم نجعله في آخر البحث، وهو كقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الشؤم في ثلاثة)) وما أشبه من ذلك من الأحاديث التي ظاهرها ثبوت الشؤم وعدم عموم قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا طيرة)).
قوله: ((ولا هامة)) الهامة هي إما أن تكون الطائر وهو البومة حيث كانوا يتشاءمون بها إذا نزلت في مكان، وإما أن يكون ما كان يعتقده الجاهليون من أن المقتول إذا قتل خرجت روحه وتشكلت بصورة هامة تطلب الثأر، فنفى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذين المعنيين.
قوله: ((ولا صفر)) ورد في معنى صفر معنيان، المعنى الأول: لا صفر أي لا صفر الذي كان يفعله أهل الجاهلية من تقديم شهر صفر الذي أشار إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾( ).حيث كانوا يؤخرون المحرم ويقدمون صفر حتى يتمكنوا من البغي والعدوان.
والمعنى الثاني الذي ذكروه: أنه دابة حية أو مرض يصيب بطن الإنسان يسمى صفر.
الأمر الخامس الذي نفاه هـٰذا الحديث قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ولا نوء)) والنوء هو أحد منازل القمر، والقمر له ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها في الشهر، وقيل: في السنة، وهـٰذه المنازل يجري الله عز وجل ما يشاء فيها مما جرت به العادة من الأمطار وغيرها، لكن هـٰذه ظروف للأقدار وليست مسببة لها، ولذلك نفى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تأثير الأنواء في جلب الأرزاق والأمطار، ولذلك جاء في الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)).
وقوله: ((ولا غول)) الغول واحد الغيلان، وهو ما كان يعتقده الجاهليون من أنه يعرض لهم شيء في الفضاء الصحراء يدعى غولاً يتشكل ويتلون، يضلهم الطريق ويوقعهم في المهالك، فنفاه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
لكن المنفي هل هو أصل الوجود أو لا؟ الجواب: لا، ليس المنفي أصل الوجود؛ لأن الغول هم سحرة الجن على الصحيح، ولذلك قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صحيح مسلم: ((لا غول ولكن السعالي)) وهم سحرة الجن لهم تأثير، يعني: لهم ضرر، يلحقون الضرر بالإنسان بمشيئة الله وقدرته، والذي نفاه النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو أنها تفعل ذلك بنفسها، أو أنها تتلون كما يقول أهل الجاهلية بألوان وأشكال تضل الناس عن الطريق.
نفى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كل ذلك، والنفي علم منه أنه ليس على إطلاقه في ما مضى، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى التي تثبت بعض المعاني التي صحت في سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كالعدوى وكالطيرة وكذلك الغول، أمّا الباقي التي هي النوء وصفر وهامة فلم يرد ما يعكر على ثبوتها، إلا في الهامة في ما جاء عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان يعوذ الحسن والحسين من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، قالوا: إذا كانت الهامة لا حقيقة لها فلماذا يعوذ الحسن والحسين منها؟ فالجواب: أن الهامة التي عوذ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الحسن والحسين منها غير الهامة المنفية؛ لأن الهامة المنفية هي ما ذكرناه من البومة أو التشاؤم بالبوم أو ما اعتقدوه من أن المقتول له روحه وتتشكل بالبوم وتطالب بدم المقتول، فبقي مما لم يرد فيه استثناء النوء وصفر.
وقوله: ((ولا هامة)) فيها وجهان: وجه بالتشديد: ولا هامّة وهـٰذا قليل.
والثاني: ولا هامَة بالتخفيف، وبينهما فرق في المعنى أو ليس هناك فرق؟ هناك فرق في المعنى بين ولا هامّة بالتشديد وبين ولا هامَة بالتخفيف.
فالمعنى الذي بيناه في الدرس السابق ذكرنا معنيين في نفي الهامة، وهو ما يعتقده الجاهليون من التشاؤم بالبومة أو طائر من الطيور؛ لأن بعض العلماء يقول: إنه ليس البومة إنما هو طائر من الطيور.
القول الثاني في النفي: أنه نفي لما يعتقده الجاهليون من أن المقتول تخرج روحه على صورة طير تطالب بدمه، ولا تقرّ إلا بالأخذ بثأره، هـٰذا على رواية التخفيف وهي رواية الأكثر.
الرواية الثانية: وهي رواية التشديد كيف تقرأ؟ هامّة بتشديد الميم، وهي مفرد هوامّ، وهي الدواب دواب الأرض، وقيل: هو ما يقتل من ذوات السم، وذكرنا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أثبت ذلك، أثبت شر هـٰذا واستعاذ بالله منه في حديث تعويذ الحسن والحسين: ((أعيذكما بالله من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة)) فالهامة هنا هي دواب الأرض أو ما يقتل من ذوات السموم.
فالمنفي هنا غير المثبت هناك، واعلم أنه لا يمكن أن يرد نفي وإثبات متناقض في كلام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل إذا ورد ذلك فاعلم أن النفي يرد على أمر والإثبات يرد على أمر؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتكلم بالوحي من رب العالمين، ولا يمكن أن يقع في الوحي اضطراب أو تناقض أو تعارض: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾( ).
قال: ((ولا صفر)) وذكرنا المعاني المتعلقة به، ثم قال: ((ولا نوء ولا غُول)) بضم الغين، وبعض النسخ فيها فتح الغين والصواب الضم كما في النهاية: ولا غُول، والغول ما هو؟ واحد الغيلان، والمنفي هل هو ذات الشيء أو ما يعتقده الجاهليون فيه؟ المنفي هو ما يعتقده الجاهليون في الغول من أنها تتلون وتضل الناس وتضرهم بذاتها، فنفى ذلك رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصح عنه قوله: ((لا غول ولكن السّعالي)). قلنا: معنى ((السّعالي)) وهم السحرة من الجن، كل هـٰذا تقدم.
ثم قال: (ولهما) أي للبخاري ومسلم (عن أنس قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا عدوى ولا طيرة)) ). لا عدوى هـٰذا فيه ما تقدم من النفي في الحديث السابق، وبعض العلماء قال: ((لا)) هنا ليست نافية إنما هي ناهية، ينهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الاعتقاد الجاهلي في العدوى، وهـٰذا أيضًا يرجع إلى ما ذكرنا في السابق أن النفي هنا ليس نفياً لوجود الشيء، إنما هو نفي لما يعتقده أهل الجاهلية فيه.
قال: ((ولا طيرة)) أي ولا تشاؤم، فنفى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الطيرة، أيضًا مما يدخل في النفي هنا التيامن؛ لأن الطيرة تطلق على التشاؤم وعلى التيامن، فهم كانوا إذا مر الطير من جهة اليسار إلى اليمين استبشروا بذلك وتيامنوا ومضوا في حاجتهم، وإذا مر من اليمين إلى اليسار تشاءموا به وانكفوا عن حاجتهم، فالطِّيرة تشمل معنيين، فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ولا طيرة)) يشمل النهي عن التيامن والنهي عن التشاؤم في ما لم يجعله الشارع محلاًّ للشؤم ولا محلاًّ لليمن، إذاً النفي للطيرة ليس فقط نفيًا للتشاؤم إنما هو نفي للتشاؤم ونفي للتيامن أيضًا؛ لأنهم كانوا يفعلون هـٰذا في أسفارهم وأعمالهم فيتشاءمون ويتيامنون بحركات الطيور.
وبعضهم يزيد على ذلك فيتشاءم ويتيامن بالاستقسام بالأزلام، فيستقسمون بالأزلام، فإذا هم أحدهم بعمل ضرب القداح التي هي ثلاثة: قدح فيه افعل، وقدح لا تفعل، وقدح مهمل لا فيه افعل ولا تفعل، فالذي يخرج يمضيه. هـٰذا أيضًا من الطيرة التي نهى عنها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإن كانت بطريقة خاصة وهي الاستقسام بالأزلام، لكنها تجتمع مع الطيرة في أي شيء؟ في المعنى أنها تيامن وتشاؤم.
إذاً قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ولا طيرة)) هـٰذا نفي لأي شيء يا إخواني؟ نفي للتشاؤم والتيامن بما ليس محلاًّ لذلك.
ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ويعجبني الفأل)) وهـٰذا كالاستثناء في التفاؤل في التيامن، استثناء في التيامن في صورة خاصة، فالتيامن منهي عنه ومنفي كالتشاؤم، إلا في صورة خاصة أباحها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبان جوازها وهي الفأل، والفأل هو ظن الخير في المستقبل، لكن انتبه! استناداً على أمر ظاهر، ظن الخير في المستقبل استناداً على أمر ظاهر، وهل الأمر الظاهر في الفعل أو في القول؟ الجواب: أنه في القول فقط، فلا تفاؤل بالأفعال إنما التفاؤل بالأقوال، ويتبين هـٰذا من جواب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
قال: ((ويعجبني الفأل)) أي: وأحبه ويسرني وأفرح بالفأل، ولماذا استثني الفأل دون غيره من التيامن والتشاؤم؟ لأن الفأل فيه موافقة الطبيعة، وفيه الاستناد إلى أمر محسوس من كلام مسموع، فإن الخارج إلى شُغله إذا سمع كلمة يسر بها تشجعه على مقصوده وعلى تحصيل مطلوبه فرح بذلك، ووجد لذلك موافقة في نفسه، وهـٰذا ليس ممّا نهى عنه الشارع، الذي نهى عنه الشارع من التيامن هو ما كان باعثاً على العمل حاملاً عليه، وهـٰذا فرق دقيق، أما ما كان موافقًا للفعل وليس حاملاً عليه فإنه لا ينهى عنه، ولذلك سئل شيخ الإسلام –رحمه الله– عن الفأل هل يكون باعثًا آمراً؟ فقال –رحمه الله–: لا يكون الفأل باعثًا آمرًا، إنما يكون موافقًا حافزاً، معنى ذلك الآن الذي يخرج إلى سفر ثم يقابله شخص من أصحابه فيقول له -كما هي عادتنا في الأسفار، يقول له-: سفرة. يعني: السفر هـٰذا سافر، يعني إن شاء الله تجد فيه سفراً وانشراحاً وتحصيل المقصود، هـٰذا من الفأل الحسن الذي تسر به النفس. إذا سمعت شخصاً يقول: ناجح موفق، هـٰذا هل هو الباعث على السفر أم أنه وافق الفعل؟ وافق الفعل، الجاهليون كيف كانوا يتفاءلون؟ كيف كانوا يتيامنون؟ كان أحدهم يأتي ويضرب القداح افعل أو لا تفعل، وبناء عليه يمضي، كان أحدهم إذا خرج يهيج الطير ويزجرها حتى تتحرك، فإذا ذهبت يمنة مضى في طريقه وإذا ذهبت يسرة رجع، وأما الفأل فهو خلاف ذلك، هو كلمة يسمعها يسر بها تحثه وتشجعه على تحصيل مطلوبه ومقصوده، وهـٰذا الذي كان يعجب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فهو استثناء خاص مخالف للطيرة في الصورة والمعنى، ولذلك جعل بعض العلماء الفأل خارجاً عن الطيرة؛ قال: والفأل يقابل الطيرة وليس من الطيرة؛ لأنه يفارقها في كونه ليس باعثاً هـٰذا واحد، وكونه موافقًا للطبيعة، وكونه حاثّاً حاملاً على المقصود وليس مانعاً، وأما الطيرة فخلاف ذلك: فهي باعثة على العمل أو مانعة منه. والثاني أنها تستند إلى غير مستند؛ لأن فعل الطير وحركات الطيور لا يعلم بها ما تخفيه الغيوب بخلاف الكلمات، فإنه قد يجري بالكلمة أو قد يعلم بالكلمة ما سيكون في المستقبل، ولذلك قال القائل:
احفظ لسانك أن تقول فتبتلى
إن البلاء موكل بالمنطقِ
فالمنطق والقول له أثر فيما يكون في المستقبل، ولذلك قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سئل عن الفأل (قالوا: وما الفأل؟ قال: ((الكلمة الطيبة)).) وهـٰذا التعريف ليس تعريفًا له بالمثال، بل هو تعريف له بالحقيقة التي وقع الاستثناء فيها؛ لأن بعض العلماء جعل الفأل أوسع من هـٰذا فجعلوه على سبيل المثال، الفقهاء جعلوا قلب الرداء في صلاة الاستسقاء من الفأل، أي تفاؤلاً قالوا: ويقلب رداءه تفاؤلاً بتغيّر الحال من القحط إلى المطر، وهـٰذا تفاؤل بقول أو بفعل؟ بفعل، لكن الحقيقة أن هـٰذا القول ليس بصحيح، وأن التفاؤل لا يمكن أن يكون بالأفعال؛ لأننا إذا تفاءلنا بالأفعال كان ذلك هو فعل الجاهلية، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سئل عن الفأل حصره في جميع الروايات بالكلمة وهو قول، ثم إن ذلك مترجم في سيرته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أي مبين وموضح في سيرته وهديه، فكان إذا خرج -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحب أن يسمع: يا راشد يا نجيح، وهـٰذا كلام أو فعل؟ كلام، هـٰذا كلام وليس فعلاً، فلا يتشاءم بالأفعال، ولا يتيامن بها أيضًا، إنما يتيامن بالأقوال الموافقة كما كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
إذاً عرفنا أن قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ويعجبني الفأل)) هـٰذا استثناء من قوله: ((ولا طيرة)) وهو استثناء لصورة خاصة.
قالوا: وما الفأل؟ قال: ((الكلمة الطيبة)) يعني: التي تنشرح لها النفس وتجد فيها حثّاً على عمل الخير وإقبالاً على المقصود والمطلوب.
وبهـٰذا نعلم أن الفأل يخالف الطيرة من حيث الثمرة ومن حيث الصفة أيضًا؛ يعني صفة القول.
قال: (ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: ((أحسنها الفأل)) ). أي أحسن الطيرة الفأل؛ لأن الضمير في قوله: ((أحسنها)) يعود إلى الطيرة، وهـٰذا مما استدل به من يقول: إن التفاؤل نوع من الطيرة، لكنه نوع مستثنى كما ذكرنا قبل قليل.
قال: ((أحسنها الفأل)) يعني الجائز منها والذي لا بأس به منها هو الفأل.
قال: ((ولا ترد مسلماً)) وهـٰذا بيان لحكم أردى أنواعها، لما ذكر الأحسن تكلم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بحكم ما دون ذلك، قال: ((ولا ترد مسلماً)) أي لا تمنعه من مقصوده وطلبه، وهـٰذا خبر ونهي، فإنه لا يجوز أن يرجع الإنسان عن عمله وقصده بناء على ما يتشاءم به من مسموع أو مرئي أو معلوم؛ بل الواجب أن يمضي في قصده وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا مانع لما أعطى –جل وعلا– ولا معطي لما منع، وأن الامتناع بمثل هـٰذا ليس من الأسباب الشرعية، حتى لا يلبس الشيطان فيقول: هـٰذا سبب شرعي، نقول: هـٰذا ليس سببًا شرعيّاً بل نفاه الشارع، وهو كذلك ليس سببًا حسيّاً، فكم من إنسان يجد في نفسه انقباضاً لكلمة يسمعها من شخص في حال عمل عملاً من الأعمال يظن أنها ستؤثر في تحقيق مقصوده وتحصيل غرضه، ثم يكون الأمر على خلاف ذلك: يحصل مقصوده ويبلغ غايته.
((ولا ترد مسلمًا)). ثم قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في علاج ما يقع في النفس من طلب العودة والرجوع عن العمل بسبب الطيرة-: ((فإذا رأى أحدكم ما يكره)) وهـٰذا فيه أن الغالب في الطيرة مرئي، وإلا فإنه يصدق على ما إذا سمع أيضًا ما يكره ((فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت)) الحسنات: جمع حسنة، ومعناها: النعم بجميع أنواعها، النعم الدينية والنعم الدنيوية ((لا يأتي بالحسنات إلا أنت)) وهـٰذا فيه تفويض الأمر إلى الله –جل وعلا–، وأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بيده الخير كله، فلا يأتي بالخير إلا الله جل وعلا.
((ولا يدفع السيئات))؛ ((السيئات)): جمع سيئة، والمراد بها هنا المصائب، ليس السيئات المعاصي فقط؛ بل المصائب ومن جملتها المعاصي ((ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك)) أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هـٰذا التحول إلا بك، وهـٰذا فيه كمال التفويض إلى الله عز وجل.
وبه نعرف أنّ العمل بالطيرة قدح في التوكل؛ لأن من ظن أن الطيرة سبب لشر فإنه في الحقيقة قد وَهَى وضعف توكله على الله عز وجل، إذ لو صدق في توكله واعتماده وانجذابه إلى الله عز وجل وركونه إليه لما جعل ذلك سببًا للامتناع، ولعلم أن الخير كله بيد الله عز وجل: ((لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع)).
يقول: (وله) لأبي داود (من حديث ابن مسعود مرفوعًا: ((الطيرة شرك، الطيرة شرك)) ). وهـٰذا فيه الحكم على الطيرة، وأنها شرك، وهو يحتمل أن الطيرة شرك أصغر ويحتمل أن الطيرة شرك أكبر وهو كذلك، فالطيرة قد تكون شركًا أصغر وقد تكون شركًا أكبر باعتبار ما يقوم بقلب المتطير.
فمن اعتقد أن مرور الطير من جهة اليسار إلى اليمين شؤم يمنعه من العمل فهـٰذا شرك أصغر؛ لأنه اعتقد أن هـٰذا سبب للشؤم، لكن من اعتقد أن حركة الطير هي التي توجد الخير وتوجد الشر فهـٰذا شرك أكبر.
فقوله: ((الطيرة شرك، الطيرة شرك)) يحتمل الشرك الأصغر ويحتمل الشرك الأكبر.
طيب ما وجه الشرك في الطيرة؟
تقدم لنا بيان ذلك، يعني: إما أن تكون شركاً في الأسباب وإما أن تكون شركاً في الخلق والإيجاد، فهي شرك في الربوبية: إما في الأسباب وإما في الخلق والإيجاد.
الخلق والإيجاد شرك في الربوبية أكبر، والشرك في الأسباب شرك في الربوبية أصغر.
طيب قال: (وما منا) هـٰذا مدرج من كلام ابن مسعود على الصحيح، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يقل ذلك، (وما منا إلا) أي: ويقع في شيء من التطير، والمقصود بالتطير هنا لا العمل بمقتضى الطيرة، إنما ما يجده الإنسان في قلبه من كراهية بعض الأشياء التي توحي إليه بأن في المستقبل شرّاً، أو بأن في المستقبل ما يكره، فهـٰذا لا يلام عليه الإنسان إذا أزاله بالتوكل، ولذلك قال: (ولكن الله يذهبه) أي يذهب هـٰذا الذي يعرض على القلب، (يذهبه بالتوكل).
وهـٰذا فيه أولاً بيان وجه كون الطيرة شركاً وأنها قدح في التوكل، وفيه أيضًا طريق علاج الطيرة، وأن الإنسان يعالج قلبه وما يقع فيه من هـٰذه الوساوس بصدق الاعتماد والتوكل على الله عز وجل في جلب الخير ودفع الضر.
ثم قال: (رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود) وهو كذلك. قال: (ولأحمد من حديث ابن عمرو) يعني عبد الله بن عمرو بن العاص -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (ولأحمد من حديث ابن عمرو-: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)) ). وهـٰذا أيضًا فيه ما في الحديث السابق من الحكم على الطيرة بالشرك، لكن فيه زيادة وهي بيان متى يقع الإنسان في الشرك، ليس الشرك في أن يقع في قلب الإنسان كراهية أمر ما، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان -كما في السنن من حديث أنس- إذا بعث رجلاً سأله عن اسمه، فإن كان اسمه حسناً سر بذلك، وإن كان اسمه قبيحًا عرف ذلك في وجهه، يعني كره اسمه، ولكن هل كراهية الاسم منعته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من إمضاء الرجل في مهمته؟ الجواب: لا.
ولذلك لا يعد ما يقع في القلب من تشاؤم لا أثر له في الخارج، يعني:لم يعمل الإنسان بمقتضاه لم ترده عن حاجته- أي هـٰذه الوساوس- فإنه لا يؤثر عليه، إنما يكون الشرك في ما إذا عمل الإنسان بمقتضى هـٰذا الذي وقع في قلبه، إذا عمل بمقتضاه فإنه قد وقع في الشرك، أما ما يعرض للقلب دون قرار ودون عمل بمقتضى ذلك فإنه لا يؤثر عليه: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)).
قالوا: (فما كفارة ذلك؟) وهـٰذا فيه أن الشرك له كفارة، ويحتمل أن يكون الشرك الأكبر ويحتمل أن يكون الشرك الأصغر، قال: ((أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك)) والخير ما تحبه النفوس ويلائم الطباع، ((لا خير إلا خيرك)) يعني: لا خير يصل إلى العبد إلا من قِبَلك، وهـٰذا معنى قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والخير كله في يديك)) فالخير كله في يدي الله عز وجل، فإذا كان في يديه لا يصل الإنسان شيء من الخير إلا من طريق الله جل وعلا، ((لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك)) وقد فسر جماعة من العلماء الطير هنا بالشؤم، وفسره آخرون بالقضاء والقدر، وفسره آخرون بالحظ والنصيب، فيكون المعنى لا خير إلا خيرك: أي لا قضاء إلا قضاؤك، ولا حظ إلا حظك، ولا قدر إلا قدرك، وفي هـٰذا المعنى والمراد أنه لا يصيب الإنسان إلا ما قدره الله له.
((ولا طير إلا طيرك، ولا إلـٰه غيرك)) وهـٰذا فيه -بعد إفراده بالربوبية سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-إفراده بالإلهية والطلب، وأنه يطلب منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الخير، ويطلب منه دفع الشر؛ لأنه لا إلـٰه غيره جل وعلا.
ثم قال: (وله) أي للإمام أحمد (من حديث الفضل بن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) ). هكذا ذكره عن الفضل بن عباس من غير رفع، أليس كذلك؟ ذكره موقوفًا على الفضل، وعلى كل حال هـٰذا الأثر في ثبوته ضعف لضعف سنده، ومعناه صحيح؛ لأنه قد تقدم في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)) فبين أن الطيرة إنما يقع إثمها ويثبت وزرها بكونها تؤثر في المنع والفعل.
قال: ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) وهـٰذا مصداق ما قلنا قبل قليل من أن الطيرة تصدق على التيامن وعلى التشاؤم؛ لأن الذي يمضي الإنسان يمضيه يجعله يمشي ويسير في قصده وغرضه شؤم أو يمن؟ يُمن، والذي يرده ويمنعه شؤم، فهـٰذا فيه بيان أن الطيرة تطلق على المعنيين على التيامن وعلى التشاؤم، وأن ما أمضى الإنسان كالذي يرده، لكن انتبه! الذي يمضي باعثاً آمراً، أما الذي يمضي موافقًا فإنه لا حرج فيه، وهو من الفأل الذي بين رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جوازه، وبين أنه أحسن الطيرة وأنه يعجبه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وبهـٰذا يكون قد تم هـٰذا الباب، نعم بقي الجواب على الرواية التي فيها أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والمسكن والدابة)) وفي رواية مسلم بدل ((المرأة)): ((الخادم)).
هـٰذا فيه إثبات الطيرة؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أثبت الشّؤم، فما الجمع بين الأحاديث التي فيها نفي الطيرة والأحاديث التي فيها إثبات الطيرة؟
أولاً اعلم أن هـٰذه الرواية جاءت بصيغتين، الصيغة الأولى صيغة الجزم، يعني الخبر الجازم: ((الشؤم في ثلاثة، أو: إنما الشؤم في ثلاثة))، والصيغة الثانية التي جاء بها هـٰذا الخبر معلقًا بصيغة: ((إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاثة)) والعلماء الذين حاولوا الجمع بين الأحاديث غلَّطوا رواية الجزم، قال بعضهم: إن رواية الجزم ليست بصحيحة، وإنما الصحيح التعليق: (( إن يكن الشؤم في شيء)) وهـٰذا ليس جزمًا، هـٰذا يقول: إن كان هناك شؤم أو يمكن أن يقع شؤم فهو في هـٰذه الأشياء الثلاثة، وليس في هـٰذا إثبات للشؤم وإنما فيه أنه إن وقع فهو أحرى وأولى ما يكون ويقع في هـٰذه الأمور الثلاثة.
ولكن الصحيح أن رواية الجزم ثابتة لا سبيل لردّها، فإذا كانت ثابتة وأيضًا يعضدها آثار أخرى فإنه لا سبيل لقبول هـٰذا الجواب وهو تغليط الرواة؛ لأن الأصل عدم الغلط.
فيبقى ما الجمع بين الأحاديث التي فيها إثبات الشؤم والأحاديث التي فيها النفي؟
الجواب من عدة أوجه ذكرها العلماء، قبل أن نذكر الأجوبة يجب اعتقاد ما ذكرناه قبل قليل من أنه لا يمكن أن يرد نفي وإثبات على أمر واحد، ما يمكن أن يثبت الشيء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خبرًا وينفي نفس الخبر؛ لأن هـٰذا تناقض وتضارب، وخبر الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ممنوع من الاختلاف، فإذا كان هـٰذا مقررًا في نفوس أهل الإسلام فالواجب أن يطلبوا حل هـٰذا بالتوفيق، وهو أن يصدر عن أمر وهو أن ما نفاه خلاف ما أثبته، وهـٰذا المنهج -يعني في الجمع بين الأمور التي فيها إثبات ونفي- سلكه العلماء وتباينت وتعدّدت الطرق في الجمع، لكن كلهم يرجعون إلى شيء واحد ويصدرون عن مصدر واحد، وهو أن ما نفاه ليس هو الذي أثبته، فما نفاه غير ما أثبته، فقوله: ((لا طيرة)) غير قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الشؤم في ثلاثة)). ولذلك طلبوا الجمع فقالوا: إن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الشؤم في ثلاثة)) محمول على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، خبر عمّا يعتقده أهل الجاهلية من أنّ الشؤم في هـٰذه الأشياء الثلاثة. وهـٰذا الجواب ضعيف؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يبعث مخبرًا بما يعتقده أهل الجاهلية، إنما بعث مصححاً لعقائدهم مبيناً لما يجب أن يعتقدوه، فلا يصح هـٰذا الجواب.
الثاني: قالوا: إن الشؤم المثبت ليس ما نفي، إنما الشؤم في المرأة أن تكون سيئة الخلق، وفي الدار أن تكون ضيقة، وفي المركب أن يكون سيئًا غير هنيء، وفسروا ذلك بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من سعادة المرء المرأة الصالحة والمركب الصالح والبيت الصالح، ومن شؤمه المرأة السيئة والبيت السيئ والدابة السيئة)). فقالوا: هـٰذا معنى الشؤم الذي أثبته رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
الطريق الثالث في الجمع بين أحاديث النفي والإثبات: أن النفي باعتبار ما يقع في نفس الإنسان لا باعتبار الواقع، يعني: أكثر ما يتشاءم الناس إنما يتشاءمون في هـٰذه الأمور، ويشهد لهـٰذا التّوجيه الأحاديث التي فيها التعليق، يعني: عدم الجزم بالخبر في الشؤم: ((إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاثة))، فهـٰذا يشهد أن غالب ما يكون من الشؤم إنما يكون في هـٰذه الأمور الثلاثة، وهـٰذا ليس فيه إقرار التشاؤم بهـٰذه الثلاثة، إنما فيه الإخبار عن أن غالب ما يقع فيه التشاؤم هو هـٰذه الأمور.
فإذا كان كذلك فينبغي للمؤمن إذا وقع له شر مصاحب لهـٰذه الأمور أن يتخلى عنها حتى يسلم من اعتقاد الشؤم فيها، وقد قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا طيرة)) يعني لا تشاؤم، فالشؤم ليس في هـٰذه الأشياء.
هكذا وجهوا قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الشؤم في ثلاثة))، وأكدوا هـٰذا المعنى لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما جاءه قوم شكوا إليه قالوا: إنا كنا في دار كثير عددنا، كثير مالنا، وانتقلنا إلى دار قل فيها عددنا وقل فيها مالنا؟ فقال لهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ذروها ذميمة)) وذميمة فعيلة بمعنى مفعولة أي مذمومة، فنسب الذم إليها، وهـٰذا معنى الشؤم.
قالوا: إن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمرهم بتركها، لا إثباتاً للشؤم، إنما لكونها تفضي إلى اعتقاد خلاف ما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من إثبات الطيرة التي نفاها.
وعلى كل حال فهـٰذه الأجوبة لو تأملها الإنسان لا يجد أن النفس تطمئن اطمئناناً تامّاً لها؛ لأن كلاًّ منها عليه مؤاخذة، ولذلك ابن القيم –رحمه الله– في مفتاح دار السعادة لما ذكر هـٰذه الأجوبة وغيرها من الأجوبة التي قالها العلماء في الجمع بين هـٰذه الأحاديث، قال: ما قدمنا به أولاً من أنه يجب اعتقاد أن ما نفاه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير ما أثبته، ثم اطلب حل هـٰذا من أي طريق، وكأنه يقول: إن هـٰذه الأجوبة ما انشرح لها الصدر واطلب حلها من أي طريق، معتقداً أنّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يقول كلاماً متناقضاً.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: التنبيه على قوله: ﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾( )، مع قوله: ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾( ).
[الشرح]
هـٰذا واضح، المضاف إلى الخالق بمعنى الجزاء والمضاف إلى المخلوق بمعنى العمل.
[المتن]
الثانية: نفي العدوى.
[الشرح]
وتقدم هـٰذا وتفصيله.
[المتن]
الثالثة: نفي الطيرة.
[الشرح]
مثله.
[المتن]
الرابعة: نفي الهامة.
الخامسة: نفي الصفر.
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
[الشرح]
وجه استحبابه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((وأحسنها الفأل)) وقال أيضًا في الحديث الآخر: ((يعجبني الفأل)).
[المتن]
السابعة: تفسير الفأل.
[الشرح]
بماذا فسره رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ بالكلمة الطيبة.
[المتن]
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.
[الشرح]
نعم هـٰذا مستفاد من حديث ابن مسعود في إدراجه، ومن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث عبد الله بن عمرو: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)).
[المتن]
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده.
[الشرح]
تمام، وذلك في قوله: ((اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك)). وأيضًا الآخر، الآخر كفارة لوقوعه.
[المتن]
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك.
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.
[الشرح]
كل هـٰذا تقدم.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس السابع عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في التنجيم
قال البخاري في (صحيحه): قال قتادة: خلق الله هـٰذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. اهـ.
وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخّص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثلاثة لا يدخلون الجنّة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر)). رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
[الشرح]
قال المؤلف –رحمه الله– في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في التنجيم) والتنجيم مأخوذ من نجم، فهو مصدر: نَجَّم ينجِّم تنجيماً، وهو يطلق على التأجيل، هـٰذا عند الفقهاء كتنجيم الدية، ونجوم الكتابة هي آجالها التي تدفع فيها، فتنجيم الدِّية وأنها مؤخرة ثلاث سنوات على العاقلة.
تنجيم الكتابة: هو ما يفرضه السّيد على عبده ليدفعه في كل أجل.
أصل المادة مأخوذ من النجم وهو: الطّالع، وأطلقت على الوقت، لكن هـٰذا ليس هو المقصود في هـٰذا الباب، إنّما المقصود في هـٰذا الباب هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هـٰذا هو المقصود بالتنجيم في هـٰذا الباب، الاستدلال بالأحوال الفلكية يشمل حركة النجوم وأشكال النجوم واقتران النجوم ومطالع النجوم ومغارب النجوم وما إلى ذلك ممّا يكون في السماء من شأن النجوم يستدلون بها على ما سيكون وما سيحدث، هـٰذا هو التنجيم الذي عقد له المؤلف –رحمه الله– هـٰذا الباب.
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن التنجيم نوع من الشرك في الربوبية؛ لأن المنجم يعتقد أن الكواكب تفعل، أو يعتقد أنها سبب للفعل.
وهو أيضًا –التنجيم- يتصل بشرك الإلهية، من حيث إنّ من يعتقد في النجوم يتقرّب إليها بذبح أو نذر أو عبادة من العبادات، كما كان يفعله قوم إبراهيم، حيث صوّروا للنجوم والكواكب هياكل وأصناماً يتقرّبون إليها ويعبدونها من دون الله.
إذاً تبيّن لنا أن هـٰذا الباب له اتصال بالتّوحيد من جهتين: من جهة توحيد الرّبوبية، ومن جهة توحيد الإلهية.
أما مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: فإنّه في الباب السابق ذكر الطِّيرة، وقبله ذكر السحر والكهانة، وهي كلها من الطرق التي يستكشف بها الغيب ويستجلى بها ما يكون في المستقبل، فذكر التّنجيم لأنه طريق من الطرق التي تُسلك في الكشف عن المغيّبات، وهو -أي التنجيم- علم باطل يبنى على الحدس والظن والتخمين، فليس مبنيّاً على قواعد راسخة ولا على أصول واضحة، إنما هو حدس وظن وتخمين، فيخبر بما يكون في المستقبل بناءً على هـٰذا، ولا يعني أنه لا يمكن أن يوافق الواقع، فقد يوافق الواقع في بعض الشيء: إما لكون الجن تسترق السمع وتنسب العلم الذي تخبر به المنجمين إلى النجوم، أو إلى غير ذلك من أسباب، المهم أنه قد يوافق الواقع موافقة، وليس أن النجوم لها أثر في ما يكون في المستقبل.
وبهـٰذا نجيب على ما في صحيح البخاري من حديث هرقل الذي فيه أنه أخبره الحزّاء بأن ملك العرب قد ظهر، فجمع من كان من العرب في بلاده وصارت المناقشة التي دارت بينه وبين أبي سفيان، فالحزّاء -والحزاء هو الذي ينظر في النجوم- أخبره بما سيكون ووافق خبره الواقع، لكن هـٰذا لا يدل على صحة هـٰذا العلم؛ بل هـٰذا العلم باطل، وقد سألت عن هـٰذا شيخنا عبد العزيز بن باز –رحمه الله– فقال: لا يمكن أن يثبت بهـٰذا شيء من هـٰذا العلم الذي أبطله الله ورسوله، وإنما هي موافقة فلا يحتجّ بهـٰذا، وهم -أي الذين يقولون بعلم النجوم- يستندون إلى عدة مشتبهات يجعلونها أصولاً لهم في صحّة ما يذهبون إليه من علم التنجيم، ومن ذلك ما أخبر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به في قصّة مجادلة إبراهيم لقومه حيث قال: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾( ).
قال هؤلاء الذين يدّعون أن للنجوم أثراً: إن إبراهيم استفاد شر خروجه من نظره في النجوم، ولذلك اعتذر وقال: إني سقيم ولم يخرج، لكن هـٰذا ليس بصحيح، ولا نريد أن نذكر ما استدلوا به من الحجج؛ لأن هـٰذا يطول، وقد تكلم عليها غير واحد من العلماء، من أبرزهم وأبهرهم وأشهرهم الإمام ابن القيم –رحمه الله– تكلم كلاماً وافياً جيداً في إبطال ما يستند عليه المنجمون من صحة علم التنجيم في كتاب مفتاح دار السعادة، فليراجع فإنه كلام جيد نفيس، وليس في ما استدل به هؤلاء إلا الشبه، وإلا فإن الحق بيّن، وقد أبطل الله –جل وعلا– ذلك، ولذلك ذكر المؤلف –رحمه الله– في هـٰذا الباب حصر ما يستفاد من النجوم في ما نقله عن قتادة، وليس من ذلك معرفة ما يكون في المستقبل.
واعلم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم يتعلق بالتأثير وعلم يتعلق بالتسيير، علم تأثير وعلم تسيير.
علم التأثير: هو الاستدلال بحركات النجوم واقترانها وافتراقها وغروبها وظهورها وأشكالها على ما سيكون في المستقبل، وهـٰذا كفر بإجماع أهل العلم وهو من الرّجم بالغيب.
القسم الثاني من علم النّجوم علم التسيير: يعني الذي يتعلّق بسير هـٰذه النجوم ومنازلها، وهـٰذا النوع من العلم جائز إذا أفضى إلى ما فيه مصلحة للعباد من معرفة الجهات والأوقات وما أشبه ذلك، كتغير الفصول وأوقات الزروع وغيرها، فهـٰذا علم جائز وهو علم صحيح كما قال شيخ الإسلام – رحمه الله -، لكن الكثير منه لا يفيد، فهو من العلم الذي لا ينفع إذا تجاوز المصالح.
ننظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد هـٰذه المقدمة في التنجيم قال: (قال البخاري –رحمه الله– في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هـٰذه النجوم لثلاث:) هـٰذه النجوم المشار إليها المصابيح التي في السماء تضيء، (لثلاث) أي: لثلاث غايات، وهـٰذه الغايات غايات شرعية قدرية، والمقصود بها الحكم التي من أجلها خُلقت هـٰذه الأشياء.
(زينة للسماء) وفائدة هـٰذا: الدّلالة على عظمة الخالق البارئ المصوّر، ولذلك لفت الله -جل وعلا- الأنظار إلى ما في السّماء من زينة؛ ليستدلّ بذلك الخلق على عظيم قُدرة وقَدْر الخالق لهـٰذه السماء وهـٰذه المصابيح، هـٰذه العلّة الأولى.
قال: (ورجوماً للشياطين) أي ويرجم بها الشّياطين، والشياطين المراد بهم: مسترقو السمع وليس كل الشياطين؛ لأن النصوص دلت على أن الذي يرجم هو مسترق السمع: ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً﴾( ).
والثالث: قال: (وعلامات يهتدى بها)، ولم يبيّن نوع الاهتداء، لكنه معروف أنه اهتداء بها في الجهات والمسير، ويدل لذلك الآية التي فيها قوله تعالى: ﴿وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾( ).
والاهتداء هنا في البر، ويشمل الاهتداء بها في معرفة الأوقات ومعرفة الجهات، وأيضًا معرفة الفصول، وما أشبه ذلك مما هو من علم التّسيير.
قال: (فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه) من تأوّل أي من ذهب فيها غير هـٰذا المذهب وفسّرها بغير هـٰذه العلل وعمل بها في غير هـٰذه الأمور، فتأوّل هنا يشمل التفسير ويشمل العمل (فمن تأوّل فيها غير ذلك) يعني: غير ما تقدم ذكره مما دلت عليه النصوص (أخطأ وأضاع نصيبه) أخطأ: هـٰذا فيه الحكم على الفعل، وأضاع نصيبه: هـٰذا فيه بيان العقوبة المرتّبة على ذلك الفعل، والنصيب هو الحظ، وإضاعة النصيب فقده وخسرانه، والمقصود بالنصيب هنا حظه من الآخرة.
ثم قال: (وتكلف ما لا علم له به) وهـٰذا لا إشكال فيه، تكلف ما لا علم له به؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لم يذكر إلا هـٰذه الأمور الثلاثة، ولو كانت لغير ذلك وفيها مصلحة للناس ونفع لما سكتت عنها النصوص؛ لأن النصوص جاءت مبينة لكل شيء دالة على ما ينفع الناس ويحصل لهم به الخير.
ثم قال –رحمه الله بعد أن ذكر ذلك–: (وكره قتادة تعلم منازل القمر). منازل جمع منزلة، وهي المراحل التي ينزل بها القمر، وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها القمر في الشهر، وتنزلها الشمس في العام، وبعضهم قال: إنها منازل ينزلها القمر في السنة، لكن الظاهر الأول: أنه ينزلها القمر في الشهر.
ولذلك يختلف القمر من حيث الظهور والخفاء باختلاف هـٰذه المنازل التي ينزلها وتنزلها الشمس في عام كامل.
(ولم يرخّص ابن عيينة فيه) أي: لم يرخص ابن عيينة في تعلم منازل القمر، وهـٰذا احتياط منهم للتوحيد، وألا يقع الناس في شيء مما وقع فيه أهل الشرك والكفر من اعتقاد تأثير هـٰذه النجوم وما أشبه ذلك.
ثم قال: (ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق) وهـٰذا هو الصّحيح، هـٰذا هو القول الثاني: أنَّ تعلمها جائز ولا حرج فيه؛ لأنّه من العلم الذي ينفع إذا كان يُفضي إلى معرفة الجهات: القبلة، أوقات الصلوات... وما أشبه ذلك.
وتعرفون أنَّ عملَ الناس بالمنازل وسير الشمس والقمر معتبر في أوقات الصلوات، وأما في الهلال فإنَّ العبرة ليست في الحساب، إنما العبرة بالرؤية؛ لكون ذلك يُدرك بالنظر، بخلاف الأوقات فإنها قد تخفى، قد تخفى بعض الشيء، وإن كانت قد وُقِّتت بأوقات ظاهرة من طلوع الفجر، وزوال الشمس، وميلها إلى الغروب، وغروبها، وغياب الشفق، كلها علامات ظاهرة يدركها من يعرف الحساب ومن لا يعرف الحساب، لكن عمل المسلمون بهـٰذه بالحساب المعتمد على المنازل، وعلى سير الشمس والقمر في الصلاة دون الصيام، وكان عملهم فيها بالصلاة بإجماع، كما ذكر ذلك القرافي وغيره.
قال: (وعن أبي موسى قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة)) ) وهـٰذا فيه التحذير الشديد من هـٰذه الثلاثة لكونها تمنع من دخول الجنة.
((مدمن الخمر)) والمدمن على الشيء: هو المداوم له المصاحب الملازم الذي لا ينفك عنه. ((مدمن الخمر)) والمراد: الذي يديم شربها.
((وقاطع الرحم)) وهو الذي بتّ رحمه فلم يصلها، ويشمل الرحم البعيد والرحم القريب، وكلَّما كانت الرحم المقطوعة أقرب كان ذنبه وجرمه أعظم، لكن قوله: ((قاطع الرحم)) يشمل قطع القريب والبعيد.
و((الرحم)): هم كل من بيْنك وبينه صلة ولادة، وهـٰذا يشمل القريب والبعيد، لكن تعرفون أن صلة الرحم لم يرد في الشرع حدّ لها، ما فيه حد محدّد لصلة الرحم، مرة في الأسبوع، مرة كل يوم، مرة في السنة، إنما نرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف على القاعدة: أن كل ما ورد في الشرع، ولم يحدد فالمرجع فيه إلى العرف.
ثم قال: ((ومصدِّق بالسحر)) وهـٰذا هو الشاهد، ((ومصدق بالسحر)) والتّصديق هنا: ليس تصديق التأثير والوجود، فإنَّ هـٰذا لابد من تصديقه لخبر القرآن عنه، وإنما المقصود بالتصديق هنا: القبول والعمل، فالمصدِّق بالسِّحر القابل له والعامل به مهدد بمنع دخول الجنة، والسحر المراد به ما تقدَّم في الأبواب السابقة، وهو ما لطف وخفي سببه مما لا يوصل إليه إلا عن طريق شركي.
ولماذا ذكر السحر هنا مع أنَّ الباب في التنجيم؟ لما تقدم من أن التّنجيم نوع من السحر؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد)). يعني: زاد في السحر ما زاد من علم النجوم.
(رواه أحمد وابن حبان في صحيحه). والحديث وإن كان قد صححه ابن حبان إلا أن كثيرًا من العلماء على تضعيفه، وما جاء فيه تشهد له النصوص الأخرى.
بقي مسألة وهي: هل للنجوم أثرٌ على ما يكون في الأرض؟ هل للأحوال الفلكية تأثير على الحوادث الأرضية؟
من الناس من يقول: لا أثر للأحوال الفلكية على ما يجري في الأرض بالكلية، وهـٰذا ليس بصحيح.
ومنهم من يجعل الحوادث الأرضية مرتبطة بالأحوال الفلكية، وهـٰذا أيضًا غير صحيح.
والصواب: أنَّ الأمر متوسط، فهناك أمور دلَّ الشرع فيها على أنَّ الأحوال الفلكية لها أثر على الحوادث الأرضية، ولكنَّ الشرع أمرنا بأن ندفع شرَّ هـٰذه الأحوال الفلكية، ومن ذلك قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته)). فهـٰذا فيه نفي أي شيء ؟ نفي أن يكون للأحوال الفلكية تأثير على الحوادث الأرضية، فليس موت أحد ولا حياته مرتبطًا بالأحوال الفلكية، ولكن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ولكن يخوف الله بهما عباده)) يدل على أن لهما تأثيرًا، أليس كذلك؟
وجه كون خسوف الشمس والقمر وهما من الأحوال الفلكية يؤثران على الحوادث الأرضية أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((يخوف الله بهما عباده)). وإنما يقع التخويف من الشر الذي يخشى وقوعه، ويحذر وقوعه، ويخاف وقوعه، ولو كان الخسوف لا يخشى أن يتصاحب معه شيء، أو يقترن به عقوبة لَمَا كان للتخويف معنى، فدلَّ هـٰذا على أي شيء؟ دلَّ هـٰذا على أنَّ الأحوال الفلكية قد يقترن بها ما يكون مؤثرًا على الأرض، لكن هـٰذا لا يعلم بالنظر في النجوم، وإنما الذي شرع الله لنا فعله في مثل هـٰذا هو أن ندفع هـٰذه الشرور المتوقعة بأي شيء؟ بالصلاة والزكاة والصوم والتكبير والدعاء وما إلى ذلك مما يشرع في أي شيء؟ مما يشرع عند الكسوف.
هناك آثار مدركة بالحس لا يمكن نفيها، كأثر القمر وحركته في المد والجزر، وكأثر القمر على بعض النبات فهـٰذا لا يمكن إنكاره، وهو مما جرت به العادة، فهـٰذا النوع من التّأثير لا يُنكر، أمّا الذي يُنكر من التأثير فهو أن يكون سير القمر، سير الشمس له أثر فيما سيكون وما سيقع، أو حتى سائر النجوم، يعني: القمر والشمس هما أعظم ما في السّماء مما نشاهد، والحكم لهما ولغيرهما.
إذًا: مسألة تأثير حركة الكواكب، أو ما هو أعم من الحركة وهو الأحوال الفلكية على الأرض فيها تفصيل:
منها ما هو مقبول، ودلّت على وجوده النّصوص والعادة، ومنها ما هو ممنوع مرفوض.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
[الشرح]
هـٰذه تقدمت في كلام قتادة: خلق الله هـٰذه النجوم لثلاث - اللام هنا للتعليل-: (زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يهتدى بها).
[المتن]
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك.
[الشرح]
وذلك في قوله: (فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلَّف ما لا علم له به).
[المتن]
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
[الشرح]
وذلك فيما حكاه عن قتادة وابن عيينة وأحمد وإسحاق، والصحيح: ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق من الترخيص في ذلك فيما يتعلق بعلم التسيير.
[المتن]
الرابعة: الوعيد فيمن صدَّق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
[الشرح]
وذلك في الحديث: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة)) وذكر منهم: (مصدق بالسحر)، هـٰذا واضح إن شاء الله، ننتقل إلى الباب الثاني.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
وقول الله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾( ).
وعن أبي مالك الأشعري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطّعن في الأنساب، والاستسقاء بالنّجوم، والنّياحة على الميت)). وقال: ((النّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جَرَب))، رواه مسلم.
ولهما عن زيد بن خالد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: صلّى لنا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة الصّبح بالحديبية على إثر سماء كانت من اللّيل، فلمَّا انصرف أقبل على النّاس فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأمَّا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)).
ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هـٰذه الآية: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ إلى قوله: ﴿تُكَذِّبُونَ﴾( ).
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء).
(الاستسقاء) طلب السُّقيا، و(الأنواء) جمع نوء، وهو النّجم، أو مَنزِل النجم.
و(الاستسقاء بالأنواء) هو طلب السقيا منها، إما بأن تدعى من دون الله عز وجل، أو بأن تنسب السّقيا -يعني المطر- إليها، كلّ هـٰذا من الاستسقاء بالأنواء، سواءً طُلب المطر من النجوم، أو أُضيف المطرُ إلى النجوم على أنَّه سبب، كلُّ هـٰذا داخل في ما عقد المؤلف -رحمه الله- من أجله هـٰذا الباب.
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد واضحة: أنَّه إذا نسب المطر إيجاداً وخلقًا وتكوينًا إلى الأنواء يكون قد أشرك في الرّبوبية، وإذا نسب ذلك على وجه السّببية والعلّة فإنَّه يكون قد أشرك شركًا أصغر في الرّبوبية أيضًا، فإذا دعاها وسألها وتوجّه إليها بالطلب يكون أضاف إلى شرك الرّبوبية شرك الإلهية، هـٰذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنَّه في الباب الذي قبله ذكر التّنجيم، وذكر فيه إبطال تأثير الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ثم ذكر بابًا خاصّاً أو وجهًا خاصّاً من أوجه التّأثير وهو نزول المطر، فليس للأنواء والنّجوم وهي من الأحوال الفلكية في حركاتها وتنقلاتها أثرٌ في نزول المطر، فهـٰذا الباب نوعٌ من الباب السّابق فيه صورة من صور إبطال الشّريعة تأثير الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، اتضحت المناسبة بين البابين.
ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب آيةً وأحاديث، أما الآية فهي (قول الله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾( ).)
الجعل هنا بمعنى التصيير، أي: تصيرون رزقكم، وهو ما مَنَّ الله به عليكم أنكم تكذبون، أي تكذِّبون بهـٰذا الرزق، والتكذيب نوعُ ردٍّ ورفض وعدم قبول لرزق الله ونعمته، ومعلومٌ أنَّ حقَّ النعمة أن تُقبل وتُشكَر، وأن يعترف بها للمنعم بها المتفضل، فإذا أخلَّ بشيء من ذلك بأن ردها أو نسبها إلى غير المنعم بها، أو أنَّه لم يشكر هـٰذه النعمة فإنَّه لم يقم بالواجب، ولم يقم بحق هـٰذه النِّعمة.
يقول تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ فسَّر جماعة من العلماء الرزقَ هنا بالحظ، أي: نصيبكم مما أنعم الله عليكم من النِّعم، أنكم تكذِّبون بنسبتها إلى غيره، وإضافتها إلى غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
وفسَّر ابن عباس وغيره من الصحابة الرِّزق هنا بالشكر قال: وتجعلون شكركم _أي نعم الله عليكم- أنكم تكذِّبون بهـٰذه النعم، فلا تقومون بما أوجب الله عليكم فيها من الشّكر، وبعضهم قال: هناك مقدَّر وهو: (تجعلون شكرَ رزقكم). والحقيقة أنَّه لا حاجة إلى التقدير ؛لأن الرزق نوعان: رزق أبدان، ورزق قلوب:
رزق الأبدان: لقوتها، وما تقوم به من الطعام والشراب.
ورزق القلوب: بالإيمان والطاعة.
والذي تخلَّف هنا هو رزقُ الإيمان والطاعة، فجعلوا رزقهم-أي رزق الأبدان –الذي يوجب أن يكون الإنسان شاكرًا جعلوه تكذيبًا وكفرًا وجحودًا لنعمة الله عليهم، فلا حاجة إلى التّقدير، ولذلك فسَّر هـٰذه الآية غير واحد من الصّحابة بما ذكرنا من أنَّ الرِّزق هنا الشكر؛ لأن الشكر رزق قلبي أو بدني؟ رزق قلبي في الأصل؛ لأنه يقوم بالقلب أصلاً، ثم ينتقل إلى اللسان والجوارح، لكن في أصله يكون من أعمال القلوب.
والشاهد من هـٰذا أنَّ الله –جلَّ وعلا – بعد أن ذكر إنزال المطر، وذكر ما ذكر من النِّعم التي أنعم بها على عباده، بيَّن كفرهم لهـٰذه النعم، وذلك بتكذيبها، وذكرنا لكم صورًا من التكذيب من أبرزها أن تُنسب النعمة والرزق لغير الله عز وجل، فيقال: هـٰذا المطر من النجم الفلاني أو النوء الفلاني، وكذلك في غير المطر من رزق الأموال، أو رزق الأبدان، أو رزق القلوب إذا نسبه إلى غير الله إيجادًا فقد كذَّب بهـٰذه النِّعمة وجعل رزقه التَّكذيبَ بها.
النوع الثاني من أنواع التكذيب: أن ينسبها إلى غير الله -عزّ وجل- سببًا، وذلك ليس إلغاءً للعلل والأسباب؛ فإن العلل والأسباب معتبرة في الشَّريعة، بل دلَّت الشريعة على اعتبارها والعمل بها، وطلبها في ما لا يتمّ الأمر إلا به، أي: إلا بهـٰذا السّبب، ولكن الكلام على أنَّه يجب على المؤمن مع أخذه بالأسباب ألا يلتفت إليها، وألا يركن إليها، وألا ينجذب إليها؛ بل يعلم أنها وسائل تؤدِّي إلى المقصود، فإن قدّر الله حصول المقصود بها حصل، وإن لم يقدِّر الله –جل وعلا- حصول المقصود بها فإنه لا يحصل ولو فعل الإنسان ما فعل من الأسباب.
ولهـٰذا ينبغي ألا تضاف النِّعم إلى الأسباب؛ بل يجب إضافتها إلى الله -عز وجل-، ثم لا بأس أن يُذكر مع الله غيره، لكن على وجه التّبع وفي منزلة ورتبة أقل من ذكر الله عز وجل، بأن يعقب بـ (ثم) أو ما أشبه ذلك مما يفيد نزول الرتبة، وبيان المنزلة لهـٰذا السبب، والأكمل والأولى أن يُفرد الأمر لله عز وجل بنسبة الفضل إليه، وما ذكرنا لا يفيد إلغاء الأسباب؛ بل الأسباب معتبرة، فمن ألغى الأسباب فإنَّه قد ألغى ما اعتبره الشرع، وما أمر به الشرع.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- بعد هـٰذه الآية حديثين:
الحديث الأول: (حديث أبي مالك الأشعري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية)) )، ((أربع)) هل هـٰذا على وجه الحصر؟ الجواب: أن هـٰذا عدد، والعدد لا يفيد الحصر؛ لأن مفهوم العدد على الصحيح من أقوال أهل الأصول أنَّه لا يفيد مفهوم المخالفة، يعني: لا نقول: إنه محصور في هـٰذا وما عداها ليس منها؛ بل هو مفهوم عدد، ومفهوم العدد لا حجة فيه إلا إذا اقترن بالنص ما يدل على أن العدد مقصود، كقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أربع لا تجوز في الأضاحي)). فاقترن بالنص ما يدلّ على قصد هـٰذا العدد وحصره، وكذلك في غيره من النصوص التي جاءت القرينة دالّة على إرادة الحصر فيها، أما إذا لم يرد ما يدل على الحصر فإن الأصل أن العدد لا يفيد حصرًا؛ بل قد يأتي في نصوص أخرى ما يدل على الزيادة على ما ذكر.
((أربع في أمتي)) والأمة هنا منسوبة إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ونسبة الأمة إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا تخلو من أحد ثلاثة أمور:
الأمر الأول: نسبة الدعوة.
الثاني: نسبة الإجابة.
الثالث: نسبة الاتباع.
فالأمة أمة دعوة، وأمة إجابة، وأمة اتباع.
أمة الدعوة: هم جميع من أدرك بعثة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم، فهؤلاء كلهم أمة دعوة؛ لأنهم كلُّهم مخاطبون بدعوة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
أمة الإجابة: وهم الذين أجابوه فيما دعا إليه من التوحيد لله عز وجل، وإثبات الرسالة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-، وهو المقصود في هـٰذا الحديث.
أمة الاتباع: وهم أخص هـٰذه الأصناف برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وهم الذين جعلوا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أسوة لهم: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾( ). فهو أسوة لهم يتأسون به، ويتبعونه.
فقوله: ((أربع في أمتي)) المراد بالأمة هنا أمة الإجابة.
قوله: ((من أمر الجاهلية)) يعني من شأن الجاهلية، والجاهلية مأخوذة من الجهل، وهو في الأصل عدم العلم؛ لكن قد يطلق الجهل على عدم العمل بالعلم؛ لأنه في الحقيقة علم لم ينفع صاحبه، فتطلق الجاهلية على عدم العلم، وعلى عدم العمل بالعلم، وهو المراد هنا، فقوله: ((من أمر الجاهلية)) أي: ممن لم يدركوا علمًا، أو ممن أدركوا علمًا ولم يعملوا به، والمقصود بالجاهلية: ما كان عليه الأمر قبل بعثة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
والجاهلية تُطلق ولها اعتباران:
تطلق ويراد بها الفترة الزمنية السّابقة لبعثة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-.
وتطلق ويراد بها المعنى الذي أشرنا إليه وهو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم.
فهـٰذا باعتبار الوصف، وذاك باعتبار الزمن، فلها اعتباران: اعتبار وصفي، واعتبار زمني.
((لا يتركونهن)) أي: لا ينفكّون عنهن، هـٰذه الخلال الأربع، وهـٰذه الصِّفات لا تتركها الأمة، والأمة هنا، أو نفي التّرك هنا باعتبار مجموع الأمة، لا باعتبار أفرادها، فإنه لا تجتمع الأمة على ضلالة، ولا تجتمع على سيِّئة؛ بل لا يزال في هـٰذه الأمة من يقيم الشرع ويحفظه كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما مرّ معنا: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله)).
فقوله: ((لا يتركونهن))، وقوله السابق: ((في أمتي)) هـٰذا باعتبار المجموع، أي إن هـٰذه الصفات تبقى في الأمة مع أنها أمة مسلمة، ومن هـٰذا نستفيد أنه من شُعب وأعمال الجاهلية ما يكون في أهل الإسلام، فليس هناك مانع من أن يكون الإنسان موصوفًا بالإيمان وفيه بعض خصال وشعب الكفر، والكفر شعب منها ما هو كفر يبطل العمل، ومنها ما هو كفر لا يعود على الأصل –أي: أصل الإسلام- بالإبطال.
كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الآخر: ((ثلاث من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النِّفاق)) وفي الرواية الثانية: ((أربع)).
ثم عدّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذه الأربع فقال: ((الفخر بالأحساب)) وأصل الفخر تقدم لنا أنه ماذا؟ طلب العلو والشرف والتعاظم. وقوله: ((بالأحساب)) جمع حسب، والحسب هو ذكر مفاخر الآباء ومآثرهم، وما كانوا عليه من تقدم وشرف، هـٰذا أصل الحسب، فهو مآثر الآباء وشرفهم، وما يرتفعون به على غيرهم، فالفخر بالأحساب أي: طلب التعاظم والعلو والشرف بما كان عليه الآباء من المنازل والمآثر والمكانة، هـٰذا لا يزال في الأمة، فإن الأمة لم تترك هـٰذه الخصلة التي ورثتها من الجاهلية.
قال: ((والطعن في الأنساب)) هـٰذه ثانية الخصال ((الطعن في الأنساب)) الطعن: أصله ضرب الشيء بما يصيب وينفذ، والأنساب جمع نسب وهو القرابة في الأصل، القرابة بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة، والمقصود بـ((الطعن في الأنساب)) أي: الطعن في الأصول، وهـٰذا فيه النهي عن الطعن في الأنساب.
هل هـٰذا يعني عدم الاعتناء بالأنساب؟ الجواب: لا؛ لأن المنهي عنه هو الطعن في الأنساب، أما الاعتناء بالأنساب فليس من شأن الجاهلية، بل تعليق الأحكام بالأنساب جاء في بعض أحكام الشريعة، لكنه محصور محدود، ثم إن العلة في تعليق الحكم الشرعي بالنسب هي ماذا؟ هي أن طيب النسب مظنة وجود المقصود من الحكم، وهـٰذه فائدة مهمة في الجواب على من يقول: إذا كانت الأنساب غير معتبرة في الشريعة فلماذا جاءت بعض الأحكام معلقة بالأنساب، كقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان))؟ الآن علق الحكم بالنسب أو لا؟ بالنسب، لماذا علَّق الحكم بالنسب؟
الجواب: أنَّه لما كان النسب مظنة تحقيق المقصود من الحكم علَّق الشارع الحكم به؛ ولكن هـٰذا قليل ولله الحمد، ولكن ما ورد فهـٰذه علته والله حكيم خبير، فالطعن في الأنساب هو الذم والاحتقار، سواءٌ كان الذم لفظيّاً، أو الذم المعنوي بغير اللفظ: بالنظر، بالمعاملة، أو غير ذلك من وسائل الاحتقار، والطّعن في أنساب الناس.
ثم بعد أن ذكر هـٰذا قال: ((والاستسقاء بالنجوم)) وهو الشّاهد، الاستسقاء بالنجوم يعني: طلب السّقيا بالنجوم، والباء هنا إما للاستعانة، أو للسّبب، يعني: بسبب النجوم وواسطتها، أو مستعينًا في تحقيق المطلوب بها.
((الاستسقاء بالنجوم))؛ والنجوم جمع نجم، والترجمة الاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم؟ بالأنواء، قلنا: الأنواء جمع نوء، وهو النجم أو منزل النجم.
لماذا سمي النجم نوءاً؟ قالوا: لأن النجم ينهض من جهة المغرب، ونهوضه يصدق عليه وصف أنه نأى، ومنه ما ذكره الله في خزائن قارون ماذا قال: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ﴾( ) يعني: تنهض بها، وتقوم بها العصبة، فدلَّ ذلك على أنَّ المادة باقية عليها، يعني: باقية على معناها، فالنوء سمي نوءًا لأن النجم يخرج من جهة المشرق، ويسقط في جهة المغرب، وهـٰذا في كل ثلاث عشرة ليلة يسقط نجم، ويخرج نجم آخر، العرب عند سقوط النجم في جهة المغرب وظهور مقابله من جهة المشرق يرقبون المطر، ولذلك جعل النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذا مما يُنهى عنه ويطلب تركه؛ لما فيه من نسبة الخير والفضل إلى غير محلّه، سواءٌ إيجادًا أو سببًا، فهـٰذه الأنواء ليس لها أثر في نزول المطر، ولا في عدم النزول.
قال: ((والنياحة)) النياحة: هي البكاء على الميِّت بصوت، رفع الصوت في البكاء على الميت قد يصاحبه ندبة، وقد لا تصاحبه ندبة، رفع الصوت والتسخط والبكاء الشديد على الميت هو النياحة.
ثم بعد ذلك قال: ((والنائحة إذا لم تتب)) يعني من نياحتها ((قبل موتها تقام يوم القيامة))، ولم يذكر مكان إقامتها، إنما ذكر ظرف الإقامة، ((وعليها سربال)) السربال: هو القميص الذي يغطي البدن.
((من قطران)) والقطران هو النحاس، يقول: ((ودرع من جرب)) درع من جرب: أي إن الجرب يكون في بدنها كما لو كانت لابسةً درعاً، الدرع ما يغطي معظم بدن المرأة، فاجتمع عليها ألمان: القطران في حد ذاته مؤذٍ، ولو كان لباساً، ولو كان الإنسان صحيح البدن، فكيف إذا كان الإنسان موبوء البدن بما يوصل الألم إلى البدن نافذًا قويّاً مؤلماً وهو الجَرَب؟ فيكون الألم شديدًا نعوذ بالله.
ومن هـٰذا نفهم ونعرف أن النياحة من كبائر الذنوب؛ لأن النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر عقوبتها، وقد ذهب إلى هـٰذا جمهور العلماء، وخالف في ذلك المالكية رحمهم الله فقالوا: إنَّ النياحة مكروهة وليست محرمة.
والصحيح: ما دلَّت عليه النصوص من أنَّ النياحة محرَّمة، ولا وجه للقول بالكراهة مع هـٰذه العقوبة الشديدة، وأما ما استدلوا به من استثناء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم عطية لما استثنت قالت: إلا آل فلان فإنهم قد أسعدوني في الجاهلية في نياحة فلا بد لي منها. فقال: افعلي، فهـٰذه قضية عين، لا تعارض هـٰذه النصوص. ثم لا ندري ما النياحة التي استثنيت، لعلها مجرد البكاء، ولا نعلم..
المهم: أجود ما يقال في الجواب: أنَّ هـٰذه القضية قضية أم عطية، وطلبها الاستثناء في آل فلان من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضية عين، وقضايا الأعيان لا تفيد العموم، ولا تخصّص العموم، فيبقى هـٰذا النص عامّاً.
وقوله: ((النائحة)) هل هـٰذا الحكم يخص النساء، أو يعمُّ النساء والرجال؟ الجواب: أنَّه يعم النساء والرجال، وإنما ذُكِر بوصف الأنثى النائحة لكونه غالبًا في النساء، فلو ناح الرجل كان مهددًا بهـٰذه العقوبة: إذا لم يتب قبل موته أقيم يوم القيامة وعليه سربال من قطران، وثوب من جَرَب، (رواه مسلم.)
والشاهد في هـٰذا الحديث قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الاستسقاء بالنجوم)).
ما وجه التحريم، أو الذم في هـٰذا الحديث لهـٰذه الأمور الأربعة؟ أين وجه أن هـٰذه الأربعة مذمومة من الحديث، انظر للحديث؟ يعني: من أين استفدنا ذم هـٰذه الخصال؟
من إضافة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذه الأمور إلى الجاهلية، ومعلوم أن ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم، فهو من صيغ الذم، واعلم أن صيغة التحريم كما تقدم لنا لا تأتي على صورة واحدة، بل صيغ التحريم والمنع في النصوص الشرعية كثيرة تحتاج إلى أن يستقري طالب العلم هـٰذه الصيغ حتى يستفيد منها الأحكام.
ومن الصيغ التي تفيد التحريم في النصوص الشرعية: أن يضاف الأمر إلى الجاهلية، فإنَّ ما أضافه النص إلى الجاهلية الأصل فيه يفيد التحريم، وقد يفيد ما دون التحريم بقرينة، يعني: الكراهة، لكن الأصل فيه أنه يفيد التحريم.
يقول: (ولهما عن زيد بن خالد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: صلى لنا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة الصبح بالحديبية).
كيف يقول: (صلى لنا)؟ اللام هنا ما هي؟ للتعليل أم لا؟ هل هي للتقرب أم للتعليل؟ هي بمعنى الباء، يعني: صلى بنا، هي بمعنى الباء، ولذلك الظاهر أن في بعض الروايات بالباء.
(صلى لنا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة الصبح) كيف صلاة الصبح؟ الفجر.
(بالحديبية): وهو مكان بعضه في الحرم، وبعضه في الحل.
(على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟))) انصرف: ظاهر الحديث أنه ابتدأ الكلام مباشرة بعد انصرافه، وهـٰذا فيه جواز الاشتغال بغير الذكر لحاجة، فإنَّ ظاهر النص أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما فرغ من الصلاة أقبل على أصحابه، وحدثهم بهـٰذا الحديث، (فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟))) وعلى هـٰذا فإذا احتاج الإنسان إلى أن يكلِّم شخصًا في أمر يفوت، أو في ما يخشى أن يتفرق فيه الناس، فلا بأس أن يبدأهم بالحديث، والكلام، ثم يأتي بالذكر بعد ذلك، ولكن لو كان سيسأل عالماً هل يبادر إلى سؤال العالم، ويشغله عن الذكر؟ الظاهر أنه لا.
وقد رأيت شخصًا قام من مجلسه لشيخنا عبد العزيز -رحمه الله- وهو يذكر، فلما سلّم مباشرة قام الأخ ليسأل الشيخ، فقطع عليه ورده قال: يا أخي هـٰذا ليس من الآداب الشرعية، الآداب الشرعية أن تأتي بالذكر تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، ثم علمه الذكر كاملاً، ثم سكت الشيخ إلى أن فرغ من ذكره، وعاد إلى جواب السؤال.
المهم: أن الضابط فيما يجيز الفصل بين الذكر بعد الصلاة وبين الصلاة هو الحاجة، أما إذا لم يكن حاجة فيخشى أن الكلام يفوِّت على الإنسان السنية؛ لأن هـٰذه سنة مؤقتة بوقت، فإذا أخلَّ بها الإنسان تكون سنةً فات وقتها، ولذلك ينبغي التنبه لهـٰذا؛ لأن بعض الناس مباشرة ساعة ما يسلم يبدأ يكمل حديثه الذي قبل الصلاة، وهـٰذا غلط.
((هل تدرون ماذا قال ربكم؟)) هـٰذا سؤال من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأصحابه، وهو سؤال يعلم جوابه، أنهم لا يعلمون؛ لأن هـٰذا لا يوقف عليه إلا بالوحي، وإنما مقصوده ماذا؟ التشويق وشحذ الذهن والتنبيه.
وفي هـٰذا أيضاً جواز إضافة الرب لمن يكلمهم دون نفسه، وليس في هـٰذا سوء أدب، إنما فيه شحذ الهمة، ولفت الأنظار إلى ((ماذا قال ربكم؟)) الذي تعبدون وتتقربون إليه، فلذلك أضاف الرب إلى من يخاطبهم.
(قالوا: الله ورسوله أعلم) ما فيه إشكال أن الله ورسوله أعلم، أما علم الله فلا إشكال؛ لأنه لا تخفى عليه خافية، وأما رسوله فلأن علمه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من ربّه، فهو أعلم بذلك من غيره.
(قال: ((قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)) ) من قال؟ قال الله عز وجل، في جواب السؤال قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بيان ما قاله الرب: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)). انظر! يقول: أصبح من عبادي، ثم قال: مؤمن بي وكافر، فعلمنا أن قوله: عبادي العبودية هنا عبودية القدر؛ لأن الكافر لا يوصف بالعبد في الاختيار والشرع، ويمكن أن يقال: إنه لما كان الكفر هنا دون الكفر المخرج عن الملة فما زال هـٰذا الرجل موصوفًا بأي شيء؟ بالعبودية الشّرعية.
فيحتمل قوله: ((من عبادي)) العبودية الشّرعية، ويحتمل العبودية القدرية بناءً على أي شيء؟ بناءً على درجة الكفر: فإن كان كفرًا مخرجًا عن الملة، فإنها عبودية قدرية، وإن كان كفرًا غير مخرج- بمعنى أنه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج به صاحبه من الملة- فإنها عبودية شرعية.
((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)) ثم جاء بيان ذلك، وهـٰذه القسمة هي قسمة الخلق، فالله عز وجل خلق الناس فمنهم مؤمن ومنهم كافر: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾( ) هـٰذه هي القسمة، وانقسم الناس في نعمة الله الخاصة وهي المطر هـٰذه القسمة أيضًا.
قال: ((فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته)) الفضل في الأصل الزيادة في الخير.
((مطرنا بفضل الله ورحمته)) يعني: بزيادة الله وإحسانه ورحمته، والرحمة أصلها أو معناها ما هو؟ إيصال الخير إلى المرحوم ودفع الشر عنه، هـٰذه حيث وردت تدور على هـٰذا المعنى: الرحمة إيصال الخير إلى المرحوم ودفع الشر عنه.
((مطرنا بفضل الله)) أي: بزيادته إيانا الخير، ((ورحمته)): أي إحسانه وإيصاله الخير إلينا، فمن نسب الفضل إلى الله عز وجل ((فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب)) وكفره بالكوكب هو من قبيل الكفر بالطاغوت؛ لأن الكوكب طاغوت باعتبار أنه يحمل الناس على الطغيان والخروج عن الصراط المستقيم بنسبة المطر إليه، ولذلك سمى عدم نسبة المطر للكوكب كفرًا به.
((وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا)) الباء هنا للسببية أو للاستعانة؟ للسببية، لكن سببية إما سببية إضافية أو إيجاد وخلق ((فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)).
ثم قال: (ولهما من حديث ابن عباس معناه) أي: معنى حديث زيد بن خالد الجهني. قال: (وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا) صدق: أي طابق الواقع، فأصل الصدق موافقة الواقع ومطابقة الواقع، فقوله: صدق نوء كذا، أي: وافق ما كنا نعتقده فيه من أنه سبب، أو طابق ما كنا نعتقده فيه من أنه موجد، فأنزل الله هـٰذه الآية: (﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ إلى قوله: ﴿تُكَذِّبُونَ﴾( )). وهي الآية التي جعلها المؤلف رحمه الله في أول الباب، وهي قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذي نزل هو قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ فقط دون قوله: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾( ) إلى آخر الآيات، فإنه لم ينزل فقط إلا قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾. ومن هـٰذا نستفيد فائدة، وهي أن العلماء قد يتجوّزون في ذكر أسباب النزول، ومن درس وعاين طريقة العلماء والرواة في مسألة ذكرهم لأسباب النزول يعلم أن هناك تجاوزًا وتجوزًا كثيرًا في هـٰذا الأمر.
فإنهم يذكرون أنها نزلت، ويكون قد نزل جزء منها أو نزل بعضها، أو أنها لم تنزل في هـٰذه الحادثة إنما نزلت فيما يشابهها، وهـٰذا يتبين من خلال دراسة الأحاديث الواردة في أسباب النزول.
ثم بعد هـٰذا قال المؤلف رحمه الله:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية الواقعة.
[الشرح]
وهي أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله في الباب.
[المتن]
الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.
الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.
[الشرح]
(في بعضها) حديث أبي مالك الأشعري ذكر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن)). وقد ورد الحديث في صحيح مسلم: ((اثنتان في أمتي هما بهم كفر)) وذكر الطعن في الأنساب والنياحة، فهاتان الخصلتان ورد النص بأنهما من الكفر، ولكن الكفر هنا لا يلزم أن يكون الكفر الأكبر، بل الظاهر أنه من الكفر الأصغر، فقوله: ذكر الكفر في بعضها يعني: في أحاديث أخرى.
[المتن]
الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة.
[الشرح]
وهو ما جاء في الحديث، وما تضمنه حديث أبي مالك الأشعري، والضّابط في الكفر الذي يخرج عن الملة والذي لا يخرج عن الملة، الصحيح أنه ليس هناك ضابط مطرد، وإذا كان الضابط غير مطّرد فإنَّه يصعب أن يجعل مستندًا في التفريق بين النصوص، لكن ظاهر كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه يعتبر التعريف دالاًّ على درجة الكفر، فالشرك والكفر إذا اقترنا بالألف واللام قد يفيد أنَّه من الشرك الأكبر، والكفر المخرج عن الملة، وإذا جاء منكَّرًا فإنه لا يكون كذلك.
ذكر هـٰذا في عدة مواضع، وكأنَّه يجعله نوع ضابط في هـٰذا الأمر، مع أنه في الحقيقة ليس بمطرد، فقد جاء ما فيه لفظ الكفر والشرك محلى بالألف واللام وليس من الشرك الأكبر، لكن هـٰذا يعرف من درجة الفعل الموصوف ودرجة مناقضته للأصل وكلام العلماء على ذلك، يعني: يمكن أن يعرف من مجموع النصوص ومن كلام أهل العلم لا من مجرد اللفظ، والذي يقف على ضابط في هـٰذا الأمر في التفريق بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وبين ما كان من الشرك الأصغر والكفر الأصغر يفيدنا بهـٰذا؛ لأنه الحقيقة مشكل، ما هناك ضابط مطرد.
[المتن]
الخامسة: قوله: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)) بسبب نزول النعمة.
[الشرح]
يعني: كان السبب في افتراق الناس إلى مؤمن وكافر هو ما أنزله الله عز وجل من النعمة عليهم بهـٰذا المطر فافترقوا إلى مؤمن وكافر، وهـٰذا شأن الناس في كل ما ينعم الله به عليهم: ينقسمون إلى قسمين مؤمن وكافر، وليس فقط في عين هـٰذه النعمة، بل هو في جميع ما ينعم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به على عباده.
[المتن]
السادسة: التفطن للإيمان في هـٰذا الموضع.
[الشرح]
وذلك بأن ينسَب الفضل والنعمة إلى المنعِم بها، المتفضِّل بها وهو الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
السابعة: التفطن للكفر في هـٰذا الموضع.
[الشرح]
وهـٰذا مثل السابق، فلا يضيف النعمة إلى غير الله عز وجل، لا على وجه السبب، ولا على وجه الإيجاد، بل يضيفها إلى الله عز وجل، ولا يمنع أن يذكر السبب، ولكن يذكره على وجه التبع فينزله منزلته، ولا يجعله أصلاً ويغفل الأصل، فيلتفت إلى السبب ويترك المسبب الذي لولا تقديره وفضله لما وصل إليه الخير.
[المتن]
الثامنة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء كذا وكذا).
[الشرح]
هـٰذا كالسابق.
[المتن]
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: ((أتدرون ماذا قال ربكم؟)).
[الشرح]
هـٰذا واضح وفائدته: شد الانتباه ولفت الأنظار.
[المتن]
العاشرة: وعيد النائحة.
[الشرح]
وهـٰذا أيضًا واضح في حديث أبي مالك الأشعري، وفي حديث: ((ثنتان في أمتي هما بهم كفر)). لكن يبقى من قال: (مطرنا بنوء كذا) ويريد الظرف ما حكمه؟ الجمهور على كراهية هـٰذا؛ لأنه هو الذي ورد النهي فيه، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر: (مطرنا بنوء كذا) مع أنه في لغة العرب تستعمل الباء للظرفية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ﴾( ) يعني: وفي الليل، ومع ذلك منع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من ذلك، فهـٰذا اللفظ فيه إيهام، ولذلك الصحيح أنه لا يجوز استعمال هـٰذا اللفظ ؛ لأنه عين ما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكون بعض الجهات يستعملون هـٰذا في الدلالة على الظرفية يعدل لفظه إذا كان يخشى منه المحظور، وإذا وافق ما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيعدل اللفظ، وإن كان الإثم هنا ليس كالإثم في ما إذا كنت معتقدًا بأن الباء هنا للسببية، وليست للظرفية، ما فيه إشكال؛ لأن الموافقة للنهي هنا في الصورة لا في المعنى، يعني: من قال: مطرنا بنوء كذا، ويريد الظرفية وافق النهي في الصورة لا في المعنى؛ لأنه وافق اللفظ، ولكن المعنى غير موجود؛ لأنه لا يريد السببية إنما يريد الظرفية، بخلاف من قال ذلك معتقدًا أنه سبب، فهنا يكون وقع في النهي لفظًا ومعنًى، ونحن عندنا الباء تستعمل للظرفية كثيراً، فيقال: جاء بالليل، بالنهار، مطرنا بالوسن وهو أحد الأنواء، ولكن لا يقصدون بذلك السببية، إنما يقصدون الظرفية، فالأحسن أن يغير اللفظ؛ لأنه موافق لما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصورة.
أما إذا قال: مطرنا في نوء كذا. فإنه لا محظور فيه؛ لأنه للظرفية ؛ لأنه يريد بذلك الظرفية.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثامن عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾( )، الآية
وقوله: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾.( )
عن أنس، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) أخرجاه.
ولهما عنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار))، وفي رواية: ((لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى..)) إلى آخره.
وعن ابن عباس: من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإنّما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً. رواه ابن جرير، وقال ابن عباس في قوله: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾( ) قال: المودة.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ﴾ الآية.)
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإنَّ العبادة قوامها على المحبّة والتعظيم، على غاية الذل، وغاية المحبة، أي: منتهى المحبة، ومنتهى التعظيم، ومنتهى الذل لله جل وعلا، فالمحبة هي ساق العبادة وقطبها الذي لا تقر ولا تثبت إلا به.
ولذلك ذكر المؤلف -رحمه الله- المحبة في كتاب التوحيد، وذكر أن الشرك فيها، أن تسوية غير الله -عز وجل- به في هـٰذا الشأن ممّا يخرج الإنسان عن التوحيد، ومما يوقعه في الشرك، فهـٰذه مناسبته لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للأبواب التي قبله: فلم يظهر لي مناسبة واضحة تربطه بالباب السابق والأبواب التي قبله، لكن هـٰذا الباب مبدأ لذكر الشرك في أعمال القلوب، وإن كان السابق فيه نوع صلة بالقلب؛ لأنّ الشرك في الحقيقة محله في الأصل القلب، فإذا اختل التوحيد في القلب ظهرت علامات الشرك في القول وفي الفعل، وفي صرف العبادة وغير ذلك، لكن هنا في أعمال خفية لا يدركها كل أحد، وإن كانت تظهر آثارها، لكن هي في الأصل من أعمال القلوب، ولذلك هنا بدأ المؤلف -رحمه الله- بذكر المحبة، ثم يأتي الخوف، ثم تأتي الأعمال الأخرى المتعلقة بعمل القلب.
يقول رحمه الله: (باب قول الله تعالى) ترجم المؤلف -رحمه الله- لهـٰذا الباب بآية من كتاب الله عز وجل، وهـٰذا من حسن تصنيفه -رحمه الله- أنه جعل بعض تراجم الأبواب آيات ليدل بها على مضمون الباب، من ذلك هـٰذا الباب حيث قال المؤلف رحمه الله: (باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾).
﴿مِنَ﴾ هنا للتبعيض، و﴿النَّاسِ﴾ يشمل الإنس والجن، لكنه ذكر الناس هنا لأنه هو الغالب فيهم، والجن تابعون للإنس في هـٰذا الحكم.
﴿مَن يَتَّخِذُ﴾ يعني: يجعل ويصير.
﴿مِن دُونِ اللّهِ ﴾ أي: من غيره جل وعلا.
﴿أَندَاداً﴾ جمع ند، والند: هو النظير والمثيل والمكافئ المساوي، يجعلونهم أندادًا لله عز وجل؛ ولكنه لم يذكر فيم كانت الندية، يعني: في ماذا حصل التنديد، لكن جاء بيانه في قوله: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾ وهـٰذا ذكر وجه التنديد، أو التمثيل، والمساواة بين الله -عز وجل- وبين غيره من المعبودات، فهو في المحبة؛ لأن المشركين لم يسووا الله -عز وجل- بغيره في الخلق، ولا في الرزق، ولا في الملك، ولا في التدبير؛ بل أفردوا الله جل وعلا بذلك، وإنما وقعت التسوية فيما يتعلق بالمحبة والعبادة.
والمحبة أجناس كثيرة، وأنواع عديدة، ليست على درجة واحدة، فمنها ما يصلح للمخلوق، ومنها ما لا يصلح إلا للخالق، ولذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله ترجمة لفظية، يعني: ترجمة من عنده، إنما اقتصر على ذكر الآية للدلالة على المحبة التي لا تناسب المخلوق، والتي لا يجوز صرفها إلا للخالق وهي المحبة العبادية، فالمحبة هي العبادة، المحبة التي يجب إفراد الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها هي العبادة؛ لأن العبادة لا تكون إلا بالمحبة.
ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذكر المحبة في بعض المواضع وهو قليل بلفظها، وذكرها بلفظ العبادة والولاية في كثير من المواضع الأخرى، فمما ذكر فيه المحبة ظاهرة بلفظها قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾( ) فإنه ذكر المحبة ظاهرة، وكقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ هـٰذه محبة العبد لربه ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾( )، فهي مواضع معدودة ذكرت فيها المحبة بلفظها، وإلا فالغالب يعبر عن المحبة بأي شيء؟ بالعبادة والولاية وما أشبه ذلك؛ لأن المحبة درجات أعلاها إفراد الله -عز وجل- بالعبادة، وهي لا تصلح إلا للرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾ فهم سوَّوا الله -عز وجل- بغيره في المحبة، وهـٰذا الذي ذكره الله – جل وعلا – في قوله في أول سورة الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾( ) أي: يسوون به غيره، فقوله: ﴿يَعْدِلُونَ﴾ أي: يجعلون غيره عديلاً له، مثيلاً له مساويًا له، في أي شيء؟ في المحبة لا في الخلق، ولا في التقدير، ولا في الملك والتدبير، بل في المحبة فقط.
ومنه أيضًا قوله –تعالى- فيما ذكره عن الكفار: ﴿تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾( ) فالتسوية التي أثبتوها هنا تسوية في المحبة والعبادة لا في الخلق والربوبية.
قوله تعالى: ﴿يُحِبُّونَهُم﴾ الضمير يعود في قوله: ﴿يُحِبُّونَهُم﴾ على الأنداد، يحبون الأنداد كحب الله، أي: نظير حب الله، فالكاف هنا للتمثيل والتشبيه، أي: كحب الله، فمحبتهم للأصنام وللأوثان وللأنداد كمحبتهم لله عز وجل، لكن انظر في قوله تعالى: ﴿كَحُبِّ اللّهِ﴾ لم يضف المحبة للفاعل، بل أضافها للمفعول، فـ (حب) مصدر، ولفظ الجلالة (الله) مضاف إليه وهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فهل المعنى أنهم يسوّون الله بغيره في المحبة؟ يعني: هم يحبون الله وفي نفس الدرجة يحبون الأنداد، هـٰذا أحد المعنيين في الآية.
المعنى الثاني: أنهم يحبون الله كمحبة المؤمنين لله، فتكون الجهة ليست مستوية، يعني: المحبة ليست مجتمعة، تكون محبة المشركين للأصنام كمحبة المؤمنين لله -عز وجل-، فيكون الفاعل في الأمرين واحداً أو مختلفاً؟ مختلفاً، وهـٰذا هو القول الثاني في معنى الآية.
وعلى هذين القولين يترتب الخلاف في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ﴾( ) أشد حبّاً ممن؟ قالوا: أشد حبّاً لله من محبة المشركين للأصنام هـٰذا المعنى الأول.
المعنى الثاني: قالوا: أشد حبّاً لله من محبة المشركين لله، فالموازنة في محبوب واحد لا في محبوبين، والمحبوب الواحد هو الله، والذي جعل المؤمنين أشد حبّاً لله من المشركين أن المؤمنين أخلصوا المحبة، فلم يقع في قلوبهم تشتّت ولا تفرق بخلاف المشركين فإنهم شتتوا المحبة وفرّقوها، ومعلوم أن من وحّد القصد والوجهة ليس كمن شتتها وفرقها، والذي يظهر من القولين هو القول الثاني، وهو أن الموازنة في محبوب واحد لا في محبوبين؛ لأن به يتبين فضل الإخلاص، وليست الموازنة بين محبة المؤمنين لله، ومحبة المشركين للأصنام؛ لأنه لا موازنة في هـٰذا، فأهل الإيمان محبتهم لله -عز وجل- أعظم وأكبر من محبة المشركين لأصنامهم وأوثانهم وأندادهم.
المحبة التي في الآية، ما هي المحبة التي في الآية؟ هي المحبة العبادية التي لا تكون إلا لله -عز وجل-، فخرج بذلك المحبة الطبيعية التي يقتضيها الطّبع، أو المحبة الناتجة عن المشاركة في أمر كمحبة الصاحب لصاحبه، وما أشبه ذلك، فهـٰذه المحاب خارجة؛ لأنّها لا تكون عبادية؛ يعني: لا يتوجه فيها الحب تعبدًا، ومنها ما يكون الإنسان مأمورًا به فتكون عبادة في ذاتها كمحبة الخير، محبة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، محبة الصالحين، هـٰذه مأمور بها، فلا تدخل فيما نحن فيه، بل هي تابعة منضوية في محبة الله عز وجل.
ثم قال رحمه الله: (وقوله) يصلح أن نقول: وقولِه على العطف، ويصلح أن نقول: وقولُه على الاستئناف: (﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾( ).)
هـٰذه الآية ذكر الله – جل وعلا – فيها المحبوبات أو أصول المحبوبات التي تنازع وتزاحم محبة الله عز وجل، وهـٰذه المحبة، المحبة في هـٰذه الآية دون المحبة المذكورة في الآية السابقة، المحبة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ هي محبة الشرك التي يصرف الإنسان فيها المحبة العبادية لغير الله، المحبة المذكورة في هـٰذه الآية هي المحبة التي تحمله على ترك ما أمر الله به، ولكنها لا تستوي مع محبة الله عز وجل، يعني: لم يسوِّ المحب في هـٰذه الآية هـٰذه المذكورات بالله عزّ وجل، إنما المحظور فيها أنها زاحمت محبة الله عز وجل، وذلك بأن الإنسان امتنع عمّا أوجبه الله عز وجل عليه، واقرأ الآية: قال الله تعالى في خطاب رسوله: ﴿قُلْ﴾ وهـٰذا أمر من الله لنبيه محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقول هـٰذا القول مبلغًا الأمة: ﴿إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ﴾ والآباء هم الأصول ﴿وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ وهم الفروع ﴿وَإِخْوَانُكُمْ﴾ وهم الحواشي، ﴿وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ وهم العلاقة بالصهر أو العلاقة بالزوجية، العلاقة بالزوجية في الزوجة نفسها والزوج، والعلاقة بالمصاهرة فيمن يتعلق به ويتصل بالزوج والزوجة ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ وهنا العلاقة التي هي أوسع دائرة من الأبوة والبنوة والأخوة وهي علاقة النسب، ثم ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ الآن ذكر الأموال وهـٰذا يشمل كل ما يُتموّل وتتعلق به النفس ﴿وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ أي: نقصانها وبوارها ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا﴾.
﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا﴾ ثمانِية مذكورات ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ والمساكن تشمل التعلق بالأرض، سواء المسكن الذي يؤوي الإنسان وهو الدار، أو المسكن الذي يتعلق به وهو الأرض التي نشأ فيها وترعرع، يشمل هـٰذا وهـٰذا ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا﴾ هـٰذا هو المحبوب. ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ يعني: محبتكم لهـٰذه الأشياء مقدمة على محبة الله ورسوله فالعقوبة والوعيد ما هو؟ ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ التربص هو الانتظار ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فهـٰذا الوعيد هو في حق من قدّم هـٰذه المحبوبات أو بعضها على محبة الله ورسوله، بأن كانت مانعة عن الطاعة، أو حاملة على المعصية، لكن الوعيد هنا في هـٰذه الآية ليس لأهل الشرك؛ لأن هـٰذه المحاب لم تكن في درجة محبة الله ورسوله، لم يصرف إليها ما يجب صرفه لله -عز وجل- من المحبة العبادية، إنما هو في تقديم هـٰذه المحبوبات على محاب الله ورسوله، فهـٰذه المحبة ليست من المحبة الشركية، إنما قد تفضي بالإنسان إلى المحبة الشركية، فهي وسيلة وطريق للمحبة السابقة في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ والمحظور في هـٰذه المحاب ما هو؟ هل هو أصل الحب؟ الجواب: لا، ليس المحظور في هـٰذه المحبوبات الأصل الذي فطر الله الناس عليه، فإن الناس مفطورون على محبة هـٰذه الأشياء: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾( ). فهـٰذا أمر مزيّن للناس، وليس هناك محظور في محبة هـٰذه الأشياء؛ بل محبة بعض هـٰذه الأشياء عبادة، إنما المحظور في أي شيء؟ في تقديم هـٰذه المحبوبات على محابّ الله ورسوله، أما المحبة من حيث هي صرف المحبة لهـٰذه الأشياء فليست محظورة، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء)) ولو كان محظورًا ممنوعًا لما وقع من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
واعلم أن المحبة التي تصلح للمخلوق ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المحبة الطبيعية: وهي محبة ما يلائم الطبيعة، كمحبة العطشان للماء، والجائع للطعام، والمحترّ للتبرّد، وما أشبه ذلك، هـٰذه محاب طبيعية لا يلام عليها الإنسان.
النوع الثاني- من المحاب التي تصلح أن تكون بين الخلق، وليست داخلة في كلامنا لا من قريب ولا من بعيد-: محبة الرحمة والشفقة، كمحبة الوالد لولده، وكذلك محبة الولد لوالده، وكذلك محبة الرجل لأهله.
النوع الثالث -من المحاب التي تدخل في دائرة الجواز وليست مما نحن فيه-: المحبة التي تنشأ عن الأنس والمصاحبة، كمحبة الصاحب لصاحبه، ومحبة المشتركين في الأعمال بعضهم لبعض.
فهـٰذه الأنواع الثلاثة خارجة عن بحثنا، وإنما المحظور فيها هو أن تقدم على محاب الله ورسوله، أما هي من حيث الأصل فمنها ما هو عبادة، ومنها ما يؤجر عليه الإنسان.
ثم اعلم أن محبة الله عز وجل هي أصل الإيمان الذي لا يقر ولا يثبت إلا به، ومحبة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كذلك، ومحبة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليست على وجه التنديد بالله عز وجل والمساواة والمماثلة، بل هي تابعة، ولذلك لا تكون إلا تبعًا لمحبة الله، وجعل الله – جل وعلا- اتباع رسوله عنوان ومعيار محبته: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾( ) وهـٰذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن محبة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تابعة لمحبة الله عز وجل، بل اعلم أن كل محبة أمر بها الإنسان فإنها تابعة لمحبة الله داخلة فيها، فمحبة الصالحين من محبة الله عز وجل، محبة الطاعات من محبة الله عز وجل، محبة الرسل والأنبياء من محبة الله عز وجل، محبة الملائكة من محبة الله عز وجل، وهلم جرّاً، فكل ما أمرت بمحبته إنما هو فرع وتابع لمحبة الله لا يمكن أن يرقى إلى التسوية، محبة الله – عز وجل - محبة تعظيم وذل وخضوع وعبادة، محبة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- محبة تعظيم لا إشكال فيها، لكنه تعظيم مناسب للمخلوق، لا يرفع الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- إلى درجة الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، بل هي محبة تناسب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وسيأتينا الكلام عنها بعد قليل.
بعد هـٰذا ذكر المؤلف -رحمه الله -عدة أحاديث في بيان وجوب إفراد الله – عز وجل – بالمحبة، من ذلك قوله رحمه الله: (عن أنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)).)
هـٰذا فيه وجوب محبة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل فيه وجوب تقديم محبة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على كل محبة، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نفى الإيمان قال: ((لا يؤمن أحدكم)) نفى الإيمان عن كل أحد ((حتى)) وهنا غاية، فـ ((حتى)) هنا غائية، يعني: لا يحصل الإيمان إلى أن أكون أحب إليه من ((ولده)) وهو فرعه، ((ووالده والناس أجمعين)) وبدأ بالولد والوالد، وقدم الولد لأن محبة الولد في الغالب أعظم من محبة الوالد، يعني: محبة الإنسان لفرعه أعظم من محبته لأصله، فقدّم أقرب المحاب الطبيعية وهي محبة الولد، ثم ذكر محبة الأصول، ثم عمّم ليشمل كل محبوب من الخلق، فرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- محبّته مقدمة على جميع هـٰذه الأنواع من المحاب، لكن ما هي هـٰذه المحبة التي لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟ ذكرنا أن المحبة التي له هي محبة التعظيم والإجلال له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والاتباع والانقياد لأمره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ذكر بعض العلماء: وزيادة على هـٰذا محبة قلبية، معنى محبة قلبية أي: محبة يتذكّر فيها الإنسان إحسان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إليه وعظم نفع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إيّاه، فإن هـٰذا يورث في القلب محبة قلبية، ومحبة انجذاب لشخصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، زيادة على محبة التعظيم، زيادة على محبة الانقياد لأمره، والترك لما نهى عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والانتصار لشريعته، محبة له في شخصه، وكيف لا؟! ولم يكن يصل المؤمن من خير إلا من طريق النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، بل كل خير في الدنيا والآخرة يصل إليك فسبيله ووسيلته وطريقه هو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- ، فهو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، هو الذي تحصل لنا به سعادة الدنيا والآخرة، لكن بأي شيء؟ هل بدعائه واستغاثته وسؤاله والتوجّه إليه؟ لا، إنما هو باتباع شرعه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وتعظيم ما جاء به عن ربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولذلك لا غرابة أن تكون منزلة محبة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على هـٰذه الدرجة ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)).
وهنا نكتة بليغة في هـٰذا الحديث تربط الحديث بالباب الذي نبحث فيه، وهي المحبة الشركية، إذا كانت هـٰذه محبة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكيف بمحبة الله؟ أعظم، إذا كان الواجب على العبد أن يقدم محبة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على كل محبة فكيف بمحبة الله الذي لا خير إلا من قبله، والذي ما بالإنسان من نعمة إلا منه جل وعلا؟ محبته أعظم وأجل وأكبر، وهـٰذا وجه ربط هـٰذا الحديث بالباب، المؤلف -رحمه الله- أراد أن يبين لنا منزلة محبة الله بما ندركه من محبة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإذا كان الرسول وهو مخلوق لا يُسوّى غيره به، بل لو سووا أحداً غير رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- به في المحبة لكان منقوص الإيمان: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين))، فكيف بمحبة الله التي يجب أن يفرد بها؟ لا شك أن شأنها أعظم وأجل، هـٰذا في المحبة التابعة كما ذكرنا قبل قليل، فمحبة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- محبة تابعة، فكيف بالمحبة الأصلية التي هي محبة الله؟ لا شك أن شأنها أجلّ وأعظم، ولذلك يجب أن يحرّر الإنسان هـٰذا المقام، فإن مقام المحبة أصل الأعمال القلبية وأصل الأعمال الجوارحية، فبقدر تحرير الإنسان وتحقيقه لمحبة الله -عز وجل بقدر- ما يحصل له من كمال الإيمان واستقامته.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- حديثًا آخر فقال: (ولهما عنه) أي للبخاري ومسلم (عن أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ثلاث من كن فيه)) ) ثلاث خصال ((من كن فيه)) يعني: من وجدن فيه ((وجد بهن حلاوة الإيمان)) أي حصَّل بهن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان هي طعمه الذي جاء في بعض الروايات وهو السرور والانشراح وابتهاج القلب ولذته، هـٰذه هي حلاوة الإيمان: ما يجده العبد في قلبه من اللذة، ما يجده في قلبه من الابتهاج، ما يجده في قلبه من السرور، هـٰذه هي حلاوة الإيمان التي ذكرت في هـٰذا الحديث وفي حديث: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاً وبالإسلام دينًا وبمحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نبيّاً)). والحلاوة هـٰذه مضافة هنا إلى الإيمان، وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة المصدر إلى سببه، فالحلاوة التي سببها ومنشؤها ومصدرها الإيمان، كيف تحصل؟وكيف يجدها الإنسان؟ بهـٰذه الخلال الثلاث:
الأولى: ((أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) وهـٰذه الخصلة الأولى هي أصل الإيمان، لا يقر الإيمان ولا يثبت إلا بها: أن تكون محبة الله ومحبة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مقدمة على كل المحبوبات، ومحبة الله لا شك أنها أعظم.
الثانية: ((أن يحب المرء لا يحبه إلا لله)). هـٰذه الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهـٰذه فرع للأصل، فإن محبة الشخص لما معه من الصّلاح، والتقوى، والإيمان، والاستقامة فرع عن محبة الأصل، وهي محبة الله، ومحبة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
الثالثة: ((أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يُقذف في النار)). وهـٰذه الخصلة من كمال الإيمان، بل لا يحصل الإيمان إلا بها؛ لأن من أحب شيئًا كره ضده، فإن الإنسان إذا تحقق في قلبه محبة أمر من الأمور أبغض وكره كل ما يضاده، وهـٰذا هو الذي تضمّنته هـٰذه الخصلة: أن يكره الإنسان ما يضاد كل محبةٍ تخالف محبة الله ورسوله، كل شيء يخالف ما يحبه الله ورسوله، ولذلك أن يكره أن يعود في الكفر، وهـٰذا عَوْد إلى الكفر من حيث الأصل، وعَود إلى الكفر من حيث الشعب والفروع، فيكره أن يعود في الكفر بالردة، يكره أن يعود في الكفر أيضًا بخصال الكفر وشُعب الكفر؛ لأنّ الإيمان له شعب، والكفر له شُعب، فالمؤمن الصادق إذا كره أن يعود في الكفر بالردة، وأن يعود إلى خصال الكفر، ولو لم تصل به إلى حد الردة؛ حقق الإيمان.
فقوله: ((أن يكره أن يعود في الكفر)) يشمل الكفر من حيث الأصل، والكفر من حيث الشُّعب والخصال.
((بعد إذ أنقذه الله منه)) أي نَجّاه، وانظر إلى قوله: ((إذ أنقذه الله منه)) فالسّلامة من الكفر إنقاذ، يجب على العبد أن يحمد الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عليه، وأن يستحضر هـٰذه المنة والنعمة من رب العالمين عليه.
((كما يكره أن يُقذف في النار)) وذكر النار لأنها من أشد ما يُعاقب به الإنسان، ومن أشد ما يفر منه الإنسان في الدنيا، أشد ما يفر الإنسان منه هو النار، فإذا كان يفر من الكفر وخصاله كما يفر من النار؛ فقد حقق الإيمان.
ومن هـٰذا الحديث نعلم أن المحبة لا تحصل إلا بالأصل، وبالفرع، وبكراهة ما يُضاد، فهناك ثلاثة أمور يتحقق للعبد بها حلاوة الإيمان التي هي فرعٌ عن كماله وتحقيقه:
الأول: تكميل الإيمان بالله ورسوله، تكميل المحبة بمحبة الله ورسوله.
والثاني: محبة ما تقتضيه محبة الله ورسوله، وهو الفرع.
والثالث: كراهية ما يضاد محبة الله ورسوله، وهي في الخصلة الأخيرة التي فيها: ((أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار)).
قال: (وفي رواية: ((لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى..)) ) وهي في معنى ما تقدم.
يقول: (وعن ابن عباس قال: من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإنما تُنال ولاية الله بذلك).
(من) شرطية، ثم ذكر فعل الشرط (أحب في الله) وعطف عليه أفعالاً أخرى، وهي (وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله) ذكر فعلين يتعلّقان بالقلب، وهما: الحب والبغض :(من أحب في الله وأبغض في الله) هـٰذا من عمل القلب.
ثم ذكر فعلين يكونان في القلب، وتظهر آثارهما في الجوارح، وهما: (والى في الله، وعادى في الله). وبهـٰذا نعلم أنه لا يتحقق للإنسان كمال الإيمان إلا بالانقياد ظاهرًا وباطنًا لله عز وجل ورسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ونظير هـٰذا قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أحب في الله، وأبغض في الله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان)) فالخصلتان الأوليان من أعمال القلب أم من أعمال البدن؟ من أعمال القلب.
العطاء والمنع من أعمال القلب أو من أعمال البدن؟ من أعمال البدن، فبهـٰذا يكتمل تحقيق الإيمان في الظاهر والباطن، وهـٰذا معنى قول ابن عباس: (من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإنما تُنال ولاية الله بذلك). والولاية هنا مأخوذة من (ولي الشيء)، فهي بمعنى القرب وهو المحبة، فإنما تُنال محبة الله، والقرب منه -سبحانه وتعالى- بذلك.
ثم قال: (ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك). حتى يكون كذلك كيف؟ حتى يحب في الله، ويبغض في الله، ويوالي في الله، ويعادي في الله. (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا). هـٰذا في زمن التابعين، يتكلم ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن حال الناس في زمن التابعين، (صارت عامة مؤاخاة الناس) يعني ما بينهم من صِلات إنما سببه الدنيا، فكيف بالناس بعد ذلك؟.
يقول: (وذلك لا يجدي على أهله شيئًا) أي لا يُحصِّل به أهله شيئًا من الخير الذي يبقى ويثبت؛ لأن كل هـٰذا يزول، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾( ) ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (وقال ابن عباس في قوله :﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾ قال: المودة)، أي انصرم حبل المودة بينهم، متى؟ يوم القيامة، وذلك أنَّ ما كان للدنيا ينقطع بانقطاعها، أما ما كان لله فهو دائم ببقاء الله جل وعلا، وهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، ليس فوقه شيء وليس دونه شيء -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فما كان له فهو دائم باقٍ؛ لأنَّ ما كان لله باقٍ لا يزول ولا ينقطع، بخلاف ما كان للدنيا فإنه ينصرم حبله، وينقطع أوده بانقطاع سببه، وهو ما يكون في هـٰذه الدنيا بزوالها.
﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾ فسَّرها ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بالمودة، وفسَّرها غيره بالعلائق، فسَّرها غيره بالمحاب، وفسَّرها آخر بالأرحام، قال ابن القيم رحمه الله: (وكل هـٰذه التفاسير صحيحة). يعني: من حيث المعنى؛ لأنها في الحقيقة تنقطع، كل هـٰذه الأمور تنقطع، والمعنى: أنَّ كل الوُصَل والعُلَق التي بين الناس من أجل الدنيا، أي لغير الله -عز وجل- تزول بزوال الدنيا، فما بينهم من مواد، من مودَّات، وما بينهم من أرحام، وما بينهم من أنساب، وما بينهم من أموال، كل ذلك ينقطع بانقطاع الدنيا، وهـٰذا معنى قوله تعالى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾ وهو معنى قول ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الذي نقله الشيخ رحمه الله: (وذلك لا يجدي على أهله شيئًا) لأنه ينقطع ويزول.
ذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في الناس، فلا تنظر إلى كثرتهم في الجوامع، ولا إلى ازدحامهم في أبوابها، إنما انظر إلى محبتهم لأولياء الله وبغضهم لأعداء الله.
فإن هـٰذا أمر عزيز، وهـٰذا مما ذكره ابن مفلح رحمه الله في كتاب (الآداب الشرعية) وقرأته على شيخنا محمد رحمه الله، فتعجب منه، وأُعجب به؛ لأنه قول حقيق، وذلك أنّ قليلاً من الناس يراعي جانب الحب في الله، والبغض في الله، والمنع لله، والعطاء لله، بل يحب ما تشتهيه نفسه، ويبغض ما تبغضه نفسه، فلا يراعي حق الله -جل وعلا- في المحاب والمباغض، والمؤمن إنما يستكمل الإيمان بما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان).
ثم قال:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية البقرة.
الثانية: تفسير آية براءة.
الثالثة: وجوب محبته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على النفس والأهل والمال.
الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
[الشرح]
لأنه لم يخرجه من الإسلام في قوله: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)). إنما هو نقص في الإيمان، وليس خروجًا عن الإسلام.
[المتن]
الخامسة: أن للإيمان حلاوةً قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تُنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحدٌ طعم الإيمان إلا بها.
[الشرح]
وهي قوله: (من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله) فهي من أعمال القلوب، وإن كانت لها آثار تظهر على الجوارح.
[المتن]
السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
الثامنة: تفسير: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾.
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبّاً شديداً.
[الشرح]
هـٰذا على أحد التفسيرين في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ﴾. ووجه هـٰذه الفائدة أنَّ الله أثبت محبةً شديدةً للجانبين، إلا أنَّه أثبت للمؤمنين زيادة فضل، بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه﴾.
[المتن]
العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
[الشرح]
وذلك في قوله: ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾( ) فحكم عليهم بالفسق، وأمرهم بالانتظار والتمهل حتى يأتي الله بأمره، وأمره هو عقوبته لهؤلاء.
[المتن]
الحادية عشرة: أنَّ من اتخذ ندّاً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
[الشرح]
وقد بيَّنا ذلك، بأن يجعل مع الله -عز وجل- محبوبًا يصرف له من المحبة نظير ما يصرفه لله عز وجل من الذل والخضوع والانقياد والطاعة، وما يسميه بعض العلماء: خوف السر، أي: يخافه بقلبه، يخافه في غيبته، وهـٰذا لا يكون إلا لله -عز وجل-، وبهـٰذا تكون انتهت المسائل.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس التاسع عشر
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾( ).
وقوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ﴾( )الآية.
وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾( ) الآية.
عن أبي سعيد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعاً: ((إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.))
وعن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)). رواه ابن حبَّان في صحيحه.
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أنَّ الخوف لا يكون إلا لله جل وعلا، الخوف العبادي الذي يحمل على فعل الطاعات، وترك المعاصي، الذي يرجو فيه الإنسان المَخُوف سرّاً وجهرًا، غيبًا وشهادةً لا يكون إلا لله جل وعلا، فمن خاف أحدًا من المخلوقين هـٰذا الخوف فقد وقع في الشرك الأكبر، وهو شركٌ في عمل من أعمال القلوب.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنَّه في الباب السابق ذكر المحبة، وما يتعلق بها، ووجوب إفرادها لله سبحانه وتعالى، وقرين المحبة: الخوف؛ لأن الإنسان في سيره إلى الله -جل وعلا- محتاجٌ إلى المحبة التي تنشِّطه إلى عمل الصالحات، والقيام بالطاعات، ومحتاجٌ إلى الخوف الذي يزجره عن ارتكاب الموبقات، وترك المنهيات، فإنه بهـٰذين يحصل له سلامة السير واستقامة الطريق، فإذا اختل أحد هذين اختل ركنٌ من أركان العمل، وركنٌ من أركان الإيمان، لا يستقيم سير الإنسان إلا بتوافر هـٰذين: الخوف، والمحبة.
وقدَّم المؤلف -رحمه الله- المحبة لأنها الأصل، وهي الباعثة على كل عمل، ثم أتى بالخوف لأنه المزيل للعوائق، المذهب للعوارض التي تعرض، وتمنع العبد من مواصلة السير في طاعة الله جل وعلا.
وأما الرجاء، فالرجاء ملازم للخوف، فإنه لا يمكن أن يتحقق الخوف الذي أمر الله به ورسوله إلا بالرجاء، ولذلك لم يذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذه الأبواب بابًا يتعلق بالرجاء؛ لأنَّ الخوف ملازم للرجاء، فكل راجٍ خائف، وكل خائفٍ راجٍ، وهـٰذا هو الذي جعل الخوف والرجاء يتبادلان في النصوص، أي يأتي الخوف بمعنى الرجاء، والرجاء بمعنى الخوف، فمن ذلك قول الله جل وعلا: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾( ). فالوقار هنا هو الخوف الحامل على الطاعة المنشِّط على امتثال الأمر، واجتناب النهي. ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾ تَرْجُون: والرجاء هنا بمعنى: الخوف، كما جاء في تفسير جماعة من السلف، أي ما لكم لا تخافون الله.
وكذلك في قوله: ﴿لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾( ) معناها: للذين لا يخافون أيَّام الله، ووقائع الله في الأمم، وجاء الرجاء في مكان الخوف لأنَّ الخوف ملازمٌ للرجاء، فإنَّ الخائف إذا لم يكن معه رجاء كان قنوطًا، كما أنَّ الراجي إذا لم يكن معه خوف كان أمنًا من مكر الله؛ فلا سلامة للراجي من الأمن إلا بالخوف، ولا سلامة للخائف من القنوط إلا بالرجاء، ولذلك الرجاء الشرعي مقارنٌ وملازمٌ للخوف، فكل راجٍ رجاءً شرعيّاً خائف، وكل خائفٍ خوفًا شرعيّاً فهو راجٍ.
يقول رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾( ).)
هـٰذه الآية فيها بيان فعل الشيطان، وما يمكر بأولياء الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ﴾. و﴿إِنَّمَا﴾ من أدوات الحصر، أي ما يقع في قلوب عباد الله المؤمنين، ما يقع في قلوب أولياء الله من الخوف من أولياء الشيطان إنما هو من الشيطان، وليس معهم ما يوجب الخوف، أي ليس مع أعداء الله ما يوجب أن يُخاف منه، بل إنَّ حق من عصى الله ألا يُخاف منه؛ لأنَّه أذل من أن يُخاف منه؛ إذ هو عدو الله جل وعلا، فليس معه من نصر الله، ولا من تأييده، ولا من عونه، ولا من مدده ما يوجب أن يُخاف منه، ولذلك ما يقع في قلوب الصالحين، ما يقع في قلوب أولياء الله من خوف أولياء الشيطان من الكفرة إنما هو بسبب تخويف الشيطان، ولذلك جاء في تقرير هـٰذا المعنى بالحصر، قال: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ وقوله: ﴿أَوْلِيَاءَهُ﴾، هـٰذا المفعول الثاني، أما المفعول الأول فجرى لسان العرب على حذفه في مثل هـٰذا التركيب، وتقديره: يخوفكم أولياءه، وهـٰذا الذي عليه جميع المفسِّرين كما قال ابن القيم رحمه الله، فيكون المُخَوَّف مَنْ؟ هل أولياء الشيطان هم المُخَوَّفون؟ أم هم المُخَوَّف بهم؟ هم المخوف بهم، ومن المخوفون؟ أولياء الله، ويدل لهـٰذا المعنى أنَّ الله جل وعلا قال: ﴿فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، فلو كان المُخوَّف هم أولياء الشيطان لما احتاج أن يقول: ﴿فَلاَ تَخَافُوهُمْ﴾ لأنَّه لا خوف منهم، لكن لما قال: ﴿فَلاَ تَخَافُوهُمْ﴾ دلَّ على أنَّ المعنى: الشيطان يخوِّف المؤمنين، يخوف أولياءَ الله أولياءهُ، أتباعهُ، الذين يقبلون وحيه، ويقبلون قوله.
﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ﴾ فنهى الله تعالى عن خوفهم ، عن خوف أولياء الشيطان.
أولياء: جمع ولي، والولي هو القريب، والمقصود: من كان قريبًا من الشيطان، والقرب هنا قرب الاتّباع، والامتثال، والسير، ويدخل في هـٰذا كل من عصى الله جل وعلا، فإنَّ كل من عصى الله كان من أولياء الشيطان، لكنَّ الولاية مختلفة، فمن النَّاس من ينزل ويتوب، فلا يكون وليّاً للشيطان، ولا يصدق عليه هـٰذا الوصف، ومنهم من يستمر في العصيان فيكون له من ولاية الشيطان بقدر ما معه من المعصية للرحمـٰن، ولكنَّ هـٰذا اللفظ يطلق على الكفرة بلا تقييد؛ لأنهَّم أولياء الشيطان حيث وافقوه في الكفر بالله عز وجل، فأولياء الشيطان على وجه الإطلاق هم الكفار، أما أهل الإيمان الذين يقعون في المعاصي فلهم من ولاية الشيطان بقدر ما معهم من اتباعه، وقبول وسوسته ووحيه، ولذلك كل من عصى الله فهو من جند الشيطان، هـٰذا على وجه الإطلاق، لكن يبقى التفصيل بين من يكون وليّاً منطبقًا عليه الوصف، أي يصح إطلاق الوصف عليه، وبين من يكون فيه نوع ولاية للشيطان، لكنَّها ولاية ضعيفة، بسبب ما معه من المعصية.
﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ﴾ والولاية هنا المقصود بها ولاية الكفر، أي الولاية التي كان سببها الكفر؛ لأنَّ الآية وردت في سياق خبر ما كان من المنافقين الذين خوَّفوا المؤمنين من المشركين في غزوة أحد، حيث قالوا لهم: إنهم سيعودون إليكم ويقتلونكم فخوَّفوهم، خوَّفوا أهل الإيمان، فقال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ﴾ فنهى الله -جل وعلا- عن خوفهم.
ثم قال: ﴿وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ فأمر -جل وعلا- بخوفه وحده دون غيره، وجعل خوفه من دلائل الإيمان، وعلامات الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ والتقدير: إن كنتم مؤمنين فافعلوا، أي فافعلوا خوفي، ولا تخافوا غيري، فالواجب على أهل الإيمان أن يخافوا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وأن لا يخافوا أعداء الله مهما بلغت قوتهم وقدرتهم؛ لأنَّ هـٰذه القوة وهـٰذه القدرة لا تخرج عن قدرة الله وقوته وإحاطته، فالله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء محيط، المؤمن إذا قرَّ في قلبه واعتقد هـٰذا فإنَّه لن يخاف أحدًا مهما كان في القوة والبطش؛ لأنَّه يعلم أنَّ هـٰذا ناصيته بيد الله جل وعلا، لا يمكن أن يوصل إليك شرّاً، أو يوصل إليك خيرًا إلا بتقدير الله جل وعلا، فإذا كان كذلك فالواجب أن يُخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف من غيره؛ لأنَّ غيره مهما بلغ فإنه لا يخرج عن تقدير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهـٰذا وجه النهي عن خوف غيره، والأمر بخوفه؛ لأنَّ من خاف الله أخاف الله منه كل أحد، وأما من قلَّ في قلبه خوف الله، خاف من كل أحد، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يسعى دائمًا في مراقبة قلبه، وإقامة خوف الله فيه، وخوف الله أن يمتثل أمر الله جل وعلا، وأن يترك ما نهى عنه، ولذلك حتى لو تسلَّط عليك متسلِّط بأذًى قولي أو حسي فاعلم أنَّه لا يدفع هـٰذا الأذى الحسي ولا القولي؛ أن تتقي هـٰذا بأسباب منك –أي بأسباب منك تتعلق بالشخص المؤذي لك- إنما ينبغي لك أن تحرص على أن تطهر قلبك من الذنوب والآثام، فإنّما سُلِّط عليك بسبب ذنوبك، فإذا تبت إلى الله -جل وعلا- دفع الله عنك: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾( ). فالله -جل وعلا- يدافع، وهو جل وعلا الذي بيده الأمور كلها وإليه تصير، فينبغي للمؤمن أن يصدق في خوفه من الله جل وعلا، وفي مراقبته له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وإذا تحقق هـٰذا سَلِمَ من كل المخاوف، وكان آمنًا من كل مخوِّف.
والمقصود بالخوف هنا: هو الخوف الذي يحمل على ترك الطاعات، أو فعل المعاصي، أمَّا ما كان من الخوف الطبيعي، كأن يخاف الإنسان من السّبع، أو يخاف من الأمور المخوِّفة، فهـٰذا لا حرج عليه في ذلك، وينقسم هـٰذا النوع من الخوف إلى قسمين:
أن يُخاف مما الخوف منه متحقق، كأن يخاف من السبع، أو من الذئب، أو ما أشبه ذلك، فهـٰذا لا بأس به، ولا يُلام على هـٰذا الخوف.
القسم الثاني: أن يَخاف مما يُتوهم، أو مما يظن الخوف منه على وجهٍ ضعيفٍ، فهـٰذا الخوف منه جُبْن، ولكنه لا يقدح في توحيد العبد وعقيدته.
إنما الذي يقدح هو أن يخاف خوفًا قلبيّاً في جلب المنافع، وفي دفع المضار، في امتثال الأمر، وفي تركه، في خوفٍ يسمَّى عند بعض أهل العلم: خوف السر، يعني خوف الغيب، يعني تخافه لسرٍّ فيه، هـٰذا معنى خوف السر، أن تخافه لسرٍّ فيه، لأمر خفيٍّ فيه، وهـٰذا لا يكون إلا لله -جل وعلا-، فإنَّه لا يُخاف إلا هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم قال رحمه الله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ﴾( ). هـٰذه أيضًا جاء فيها حصر في قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ﴾ فحصر الله -جل وعلا- عمارة المساجد التي هي محالّ العبادة، ومواضع الصلاة في ﴿مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ﴾ فما المراد بالعمارة هنا؟ العمارة هنا هي العمارة المعنوية لا العمارة الحسيَّة فحسب؛ فإن العمارة الحسية تكون ممن اتصف بهـٰذه الأوصاف، وتكون ممن لم يتصف بها، فالمساجد يعمرها حتى الكفار في بعض البلدان، فليست العمارة الحسية هي المقصودة بهـٰذه الآية، إنما المقصود العمارة المعنوية، وهي عمارة العبادة والطاعة: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (36) رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾( ) هؤلاء هم عمار المساجد الذين أثنى الله عليهم وحصر العمارة بهم في قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ﴾. أما العمارة الحسيَّة، بمعنى تشييد المساجد، فهـٰذا يكون ممن اتصف بهـٰذه الأوصاف، وممن اختل فيه بعضها، وممن لم يتصف بشيءٍ منها، كما ذكرنا فيما مثلنا.
الشاهد من هـٰذه الآية قول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ﴾. فجعل الله -سبحانه وتعالى-هـٰذه الصفة من صفات عمار المساجد الذين أثنى عليهم جل وعلا.
﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ﴾ أي لم يخف إلا الله جل وعلا، والخشية هل هي الخوف أو غيره؟ قال جماعة من العلماء: الخشية هي الخوف، والحقيقة أن الخشية والخوف والوجل ألفاظ لمعانٍ متقاربة، فإذا أُطلق أحدها في موضع شمل الآخر، وإذا اجتمعت استقل كل واحدٍ منها بمعنىً، فالخوف هو الخشية، والخشية هي الخوف، إلا أنَّ الخوف أعم من الخشية، فالخوف منه ما هو محمود، ومنه ما ليس بمحمود، أما الخشية فهي محمودة إذا كانت لله جل وعلا، فهي محمودة لأنها تحمل على فعل الطاعة، ولا تكون إلا من عالم.
أما الخوف، فإن من الخوف ما يكون قنوطًا، يسمَّى خوفًا لكنه قنوط، بخلاف الخشية فإنها لا تكون قنوطًا؛ لأنها لا تكون إلا من عالم، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾( ) فحصر الله -جل وعلا- الخشية في العلماء؛ لأن العلم يظهر الخشية في القلب، فالخشية هي أشد الخوف، هكذا قال بعض العلماء، وقال آخرون: الخشية هي الخوف عن علم، وهـٰذا القيد الثاني، أو الضابط الثاني، أو التعريف الثاني للخشية أجود؛ لأنه مطابق لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.
يقول رحمه الله: (وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾.)
﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ (من) هنا للتبعيض، و﴿النَّاسِ﴾ عموم الناس، في وقت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبعده.
﴿مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ وانظر حيث قال: من يقول آمنا بالله، ولم يقل: من يؤمن بالله، إنما جعل الإيمان بالله قولاً له، ولم يكن وصفًا له، وفرق بين من كان الإيمان وصفه، ومن كان الإيمان قوله، فمن كان الإيمان وصفه فإنه يبعد أن يكون منه ما ذكر الله -جل وعلا- في الآية؛ لأن إيمانه يحمله على الصبر على الأذى في الله جل وعلا، بخلاف من كان الإيمان قوله فإنه قد لا يصبر، إذ ليس معه من الإيمان القلبي ما يثبت فؤاده، ويرسخ قدمه في الصراط المستقيم.
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ إذا أُوذي -سواءٌ كان الأذى قوليّاً أو فعليّاً أو معنويّاً- ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ أي كانت حاله أن وازن هـٰذا الذي أصابه بسبب إيمانه بما يكون من عذاب الله في الآخرة، ولا شك أنَّه لا استواء، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)). ولا مقارنة بين الألمين وبين العذابين، فعذاب الدنيا لا يساوي شيئًا أمام عذاب الآخرة، فالواجب على المؤمن أن لا يُسَوِّي، وأن يصبر على ما يلحقه من الأذى والعذاب في الدنيا مهما بلغ في الشدة؛ لأنَّ ما يكون في الدنيا من العذاب مقارنةً بما يكون في الآخرة لا شيء، ولذلك يؤتى يوم القيامة بأتعس أهل الدنيا، أشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، ممن يدخلون الجنة، فيغمس في الجنة غمسةً واحدةً، غمسة، والغمسة تعرفون هي إدخال وإخراج ليس فيه مُكث، فيقال له: هل لقيت شقاءً قط؟ فيقول: لا، يُنسيه ما يجده من اللذة في هـٰذه الغمسة ما كان من العذاب والمشقة في الدنيا. وفي المقابل أنعم النَّاس في هـٰذه الدنيا من أهل النار يؤتى به يوم القيامة فيغمس فيها -والعياذ بالله- غمسة، والغمسة كما ذكرنا إدخالٌ وإخراجٌ ليس فيه مكث، فيقال له: هل مرَّ عليك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا، يُنسيه ما لقيه من هولٍ وعذابٍ وألمٍ في هـٰذه المشقة كل نعيمٍ كان في السابق، فعذاب الآخرة أعظم، ولا مقارنة بينه وبين عذاب الدنيا، فالعاقل البصير يوازن بين ما يلقاه من المشاق بسبب التزامه بأمر الله وأمر رسوله، استقامته على قول الله وقول رسوله؛ بما يلقاه في الآخرة، إن هو ترك ذلك، ولا شك أن العاقل البصير سيوفَّق إلى احتمال ما يكون من الأذى في هـٰذه الدنيا، مع أنَّه لا يكون أذىً مستقرّاً ، بل يكون معه من النعيم القلبي ما تزول به هـٰذه الآلام، وتتلاشى معه هـٰذه المنغِّصات والمكدِّرات، فينقلب العذاب الذي يلقاه في الدنيا حُلوًا كما جاء فيما نُقِل أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أصابه شيءٌ في قدمه فقال:
ما أنت إلا إصبعٌ دميتِ
وفي سبيل الله ما لقيتِ
وكما قال: يُنسي الإنسان في هـٰذه الدنيا ما يلقاه من المشاق حلاوة ما يترتب على هـٰذه المشاق من الأجر، أنستني حلاوة أجرها مرارة صبرها، ثم كما قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان في هـٰذه الدنيا لا بد له من ألم، لا بد له من ألم مهما كان على كمالٍ في العيشة، وكمالٍ في الظاهر، لا بد له من آلام، لا يخلو الإنسان من ألم، وهـٰذا معنى قول الله جل وعلا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾( ). والإنسان جنس يشمل كل أحد، المؤمن والكافر، الغني والفقير، الشريف والوضيع، كل أحدٍ على هـٰذه الحال ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾. فالكبد مكتوب على كل بني آدم، لكنَّ النَّاس يختلفون في أنَّ:
منهم من يكون كبده وشقاؤه في هـٰذه الدنيا، ثم يزول إلى نعيمٍ -نسأل الله أن نكون من أهله- إلى نعيمٍ دائمٍ لا ينقطع.
ومنهم من يكون ما يلقاه في هـٰذه الدنيا قليلاً في كثير مما سيلقاه في الآخرة، وذلك إذا كان ممن كفر بالله جل وعلا.
المهم يقول الله -جل وعلا- في هـٰذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ أي جعل الاختبار والابتلاء الذي يأتيه من قِبل الناس في أقوالهم أو أعمالهم أو أذاهم ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ والنتيجة أن يترك ما يكون عليه من الحق والخير، وينقلب على عقبه نعوذ بالله من الخسران.
والشاهد من هـٰذه الآية: أنَّه ينبغي على المؤمن ألا يخاف إلا الله -جل وعلا-، وألا يوازن بين ما يكون من عذابٍ يأتيه من قِبل الناس في هـٰذه الدنيا، بما يكون في الآخرة مما أعدَّه الله لمن كفر نعوذ بالله من الخسران.
ثم قال رحمه الله: (عن أبي سعيد الخدري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعًا- أي: إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله)).)
((من)) هنا تبعيضية؛ لأنَّ ضعف اليقين يكون بهـٰذا ويكون بغيره، فالحديث ليس حصرًا لضعف اليقين؛ إنما هو بيانٌ لصورةٍ من صور ضعف اليقين.
و ((اليقين)) هو الإيمان الجازم، والاعتقاد الراسخ، فمن دلائل ضعف الإيمان، وعدم رسوخه أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله.
فذكر ثلاثة أمور تدلّ على ضعف اليقين:
((أن ترضي الناس بسخط الله)) أي: تسعى في حصول رضا الناس، وسيلتك في ذلك إسخاط الله جل وعلا، والسخط: هو الغضب، أي: بغضب الله، ولا يكون ذلك إلا بمخالفة أمر الله جل وعلا، ومخالفة أمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ومن ضعف اليقين أيضًا ((أن تحمدهم على رزق الله)) ما معنى ((تحمدهم)) ؟ أي: تذكرهم بالجميل، وتثني عليهم.
((على رزق الله)) يعني: غافلاً عن الله جل وعلا، حيث جعلت الشكر لهم، لا للمنعم الأول الذي لا خير إلا من قِبله، الذي الخير كله في يديه سبحانه وبحمده، فإنَّ ما يصلك من إنعامٍ عن طريق الناس إنما هو من الله جل وعلا، وإنما هؤلاء أسباب سخَّرهم الله لأن يصل إليك الخير من قبلهم، وليس أنهم هم الذين ابتدؤوا الخير، فالاشتغال بحمدهم وثنائهم، والثناء عليهم دون الثناء والحمد لله -جل وعلا- يكون من ضعف اليقين.
وهل هـٰذا يعني أن لا نشكر الناس على إحسانهم؟ الجواب: لا، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله)). وقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له)). فجعل للمحسن صاحب المعروف حقّاً من الشكر والمكافأة، فإن لم نستطع فالدعاء.
((حتى تروا أنكم قد كافأتموه)) أي: حتى تظنوا أنكم قد بلغتم من الدعاء ما يكافئ إحسانه وجميله.
لكنَّ المقصود في هـٰذا الحديث الاشتغال بحمد الخلق عن حمد الخالق، نسبة الرزق إلى الخلق دون نسبته إلى الله جل وعلا، قطع النظر عن المحسن الذي كل خيرٍ من قِبله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، هـٰذا الذي هو من ضعف اليقين.
ثم قال: ((وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله)) وهـٰذه كثيرة، ((وأن تذمهم)) أي: تذم الخلق على ما لم يؤتك الله، سواءٌ من مال، أو من منصب، أو من رزق، أو من علم، أو من غير ذلك مما يؤتى الناس، ومما يُطلب منهم، فإذا مُنعت شيئًا فاعلم أن الذي منعك هو الله جل وعلا، وأن هؤلاء أسباب، ليس أكثر من ذلك، فالإنسان ليس بيديه ما يمنع، ولا ما يعطي، إنما الأمر لله جل وعلا، والإنسان إنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله جل وعلا، ((لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع))، هـٰذا أمر نقوله، نحتاج إلى أن ننقله من القول إلى العقد، من القول إلى القلب؛ لأنه يكفي الإنسان كثيرًا من الهموم، ويزيل عنه كثيرًا من الضيق الذي يجده بسبب عدم تيسُّر شيء له، أو بسبب حرمانه شيئاً يظن أنَّ المانع له فلان، والمانع هو الله جل وعلا، والله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يقدر لعبده إلا الخير ((أن تذمهم على ما لم يؤتك الله)).
ثم قال: ((إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره)) وهـٰذا كالتعليل لبيان كيف كانت تلك الأمور من ضعف اليقين، كانت من ضعف اليقين لأن صاحبها لم يعتقد أن رزق الله لا يجره حرص حريص، رزق الله في المال، رزق الله في الولد، رزق الله في العلم الشّرعي، رزق الله في كل شيء لا يجرّه حرص حريص أبدًا، لا يمكن أن يحصِّله الإنسان بحرصٍ وكدٍّ وجهدٍ، إنما يحصِّله بتقدير الله جل وعلا، هـٰذا لا يعني نفي الأسباب، فإنّ الله -جل وعلا- قد جعل لكل شيءٍ سببًا في الدنيا والآخرة، فالله -جل وعلا- قدَّر أشياء وقدَّر أسبابها، لكن الحديث يلفت النظر، وينبه إلى عدم النظر إلى الأسباب، والاشتغال بها عن المسبب، وعن الأصل الذي إليه ترجع الأمور، وإليه تصير سبحانه وبحمده.
((رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره)). فلو كره الناس لك ما كرهوا وقدَّر الله -عز وجل- أن يأتيك فهو آتيك، لا يمنعه كراهيتهم.
وهـٰذا الحديث رواه البيهقي وأبو نُعيم في الحلية، وهو ضعيف الإسناد، لكنَّ معناه صحيح.
(وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من التمس رضا الله بسخط الناس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرضى عنه الناس)).)
((من التمس)) الالتماس: هو الطلب، فقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من التمس)) أي: من طلب رضا الناس، والناس هنا يشمل كل أحد، إلا من كان طلب رضاه من مرضاة الله جل وعلا، فمن كان طلب رضاه من مرضاة الله -جل وعلا- فإنه لا يدخل في هـٰذا الحديث؛ لأنه لا يمكن أن يكون رضاه بسخط الله، لكن إذا كان رضاه من رضا الله -جل وعلا- من حيث الأصل، كالوالد مثلاً، لكنه أمر بشيءٍ محرم، فإنه يكون داخلاً في هـٰذا الحديث.
فـ ((من التمس رضا الله بسخط الناس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)) وهـٰذا فيه الجزاء من جنس العمل، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- جزى هـٰذا الذي سعى في تحصيل رضا الله جل وعلا، ولو ترتَّب على ذلك سخط الناس بأن يرضى الله -جل وعلا- عنه ((رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرضى عنه الناس)) أي: انقلب سخط الناس عليه بسبب ما كان من امتثاله أمر الله -جل وعلا- فيهم مع سخطهم عليه في أول الأمر رضاً.
ولا تعجب فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بيده قلوب العباد يصرفها كيف شاء، فهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يحول بين المرء وقلبه، فلا تعجب أن يكون الذامّ لك في أول الأمر بسبب امتثال أمر الله حامدًا لك في العاقبة، فإنَّ الله -جل وعلا- يصرِّف قلوب العباد كيف شاء.
وقد جاء في ذلك أثر، فإنه مما نقل شيخ الإسلام -رحمه الله- في عدة مواضع من كتبه:
أن الله ملك قلوب العباد، أو مالك قلوب العباد، فقلوب العباد بين يديه يصرفها كيف شاء.
فينبغي للعبد أن يلاحظ رضا الله -جل وعلا- أولاً وآخرًا ، وأن يسعى في تحصيله.
أما الناس فإن رضاهم إذا كان بسخط الله لا سبيل إلى تحصيله، ولا سبيل إلى السعي في طلبه؛ لأنه يترتّب عليه سخط من السعادة في رضاه، وهو الله جل وعلا.
((من التمس رضا الله بسخط الناس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه)) أي: من طلب رضا الناس بسخط الله، أي: وكان ذلك سببًا لسخط الله، ولا يكون هـٰذا إلا فيما نهى الله عنه، من ترك واجب، أو فعل محرم ((سخط الله عليه)) والسخط هنا الغضب، أي: غضب الله عليه ((وأسخط عليه الناس)) أي: أغضب عليه الناس، فترتّب على هـٰذا السعي سوءتان:
السوءة الأولى: سخط الله.
والسوءة الثانية: سخط من سعى في رضاه، وهم الناس؛ وذلك أنه لا بد أن يكون في مآل الأمر وعاقبته سخطٌ في قلوب الناس، على من سعى في رضاهم بتحصيل سخط الله، أي: بالوقوع فيما يكرهه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من ترك الواجبات، أو فعل المحرمات.
وهـٰذا فيه أن من حاول ما منعه الشارع منه فإنه يعاقب بنقيض مقصوده، فإنه سعى في تحصيل رضا الناس بسخط الله فعاقبه الله -جل وعلا- بنقيض مقصوده، وهو حصول سخط الناس عليه، وإذا استحضر الإنسان هـٰذا الأمر وكان حاضرًا في معاملته للخلق؛ منعه من شر كثير، وحمله على أن لا يرقب الناس في الله جل وعلا، بل ينبغي للمؤمن كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- أن ينظر إلى الله -جل وعلا- أولاً في معاملته للخلق. قال رحمه الله: ومعيار السعادة أن تعامل الله في الخلق، لا تعاملهم في الله، وأن تخاف الله في الخلق، لا تخافهم في الله، وأن ترجو الله في الخلق، لا ترجوهم في الله.
وهـٰذا كلام نفيس مستفاد من مجموع النصوص الدالة على وجوب مراعاة حق الله، وتقديمه على جميع الحقوق، فحق الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- سابقٌ على كل حق، مقدمٌ على كل حق ، وإذا سعى الإنسان في تحصيل رضا الله كفاه الله -جل وعلا- مؤونة الناس: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾( ). أما من سعى في طلب مرضاة الناس، فإنه لا يحصل رضاهم إذا كان ذلك في سخط الله، أي: إذا كان رضاهم لا يحصل إلا بسخط الله، أما إذا كان رضاهم في طاعة الله، فإنه من طاعة الله؛ لأن إدخال السرور على المؤمن، وحسن المعاملة لأهل الإسلام مما دعا الله إليه، ورتَّب عليه الأجر، وقد قال الله –جل وعلا- في قاعدةٍ كليةٍ عامةٍ: ﴿هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ﴾( ) .فمن أحسن جزاؤه الإحسان.
مناسبة هـٰذا الحديث للباب ظاهرة؛ حيث إنّ الإنسان يحمله ضعف الخوف من الله على السعي في تحصيل رضا الناس بسخط الله، ولو قام في قلبه خوف الله وكمال رجائه لما سعى في مرضاة الناس بالوقوع فيما يسخط الله جل وعلا.
وبهـٰذا يكون قد انتهى هـٰذا الباب، وهـٰذا الحديث (رواه ابن حبَّان في صحيحه)، وهو مما كتبته عائشة -رضي الله عنها- لمعاوية، حيث إنه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كتب إليها: أن اكتبي إليَّ بوصية، ولا تكثري عليَّ، فكتبت له، صدَّرت الرسالة بما صدَّرت، ثم قالت: (أما بعد، فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). وختمت الرسالة. وفي هـٰذا حاجة من ولي أمرًا عامّاً إلى مثل هـٰذا، وهو أن يرقب الله في معاملته للخلق، ولا يرقب الخلق؛ لأن رضا الناس غاية لا تُدرك، أي لا تُحصّل إلا فيما يمكن مما أمر الله به من الإحسان إليهم، فإنه أمر يُسعى في تحصيله، لكن إذا كان يترتب على ذلك سخط الله فلا سعي في تحصيل رضاهم.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية آل عمران.
الثانية: تفسير آية براءة.
الثالثة: تفسير آية العنكبوت.
[الشرح]
نعم، هـٰذا تقدم.
[المتن]
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى.
[الشرح]
نعم، وهـٰذا واضح في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((إن من ضعف اليقين))، فدلَّ ذلك على أن اليقين مراتب، وليس مرتبةً واحدةً، فمنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو قوي، وقوته في تمام التصديق بوعد الله عز وجل، وامتثال الأمر، وتمام التصديق بأنَّه ما من شيء إلا بقدر، فإن هـٰذا جماع كمال اليقين، كمال اليقين يحصل بهذين الأمرين:
الإيقان أن كل شيء بقدر، وأن الله -جل وعلا- خالق كل شيء.
الثاني: تصديق وعد الله عز وجل، وخبره، وامتثال أمره.
وبهـٰذا يتحقق للإنسان كمال اليقين، بقدر الضعف الذي يحصل في هـٰذه الأمور يحصل ضعف اليقين للإنسان.
[المتن]
الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هـٰذه الثلاث.
[الشرح]
وهي: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، كما في الحديث المتقدم.
[المتن]
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
[الشرح]
وجه ذلك قول الله تعالى: ﴿فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾( ). فنهى الله عن خوف أولياء الشيطان، وأمر بخوفه، فدلَّ ذلك على أن الخوف من الفرائض والواجبات، وتقدَّم أنه لا يستقيم الإيمان إلا بالخوف، والخوف الذي أُمرنا به هو ما حمل على فعل الطاعات، وزجر عن ارتكاب المنهيات، هـٰذا هو الخوف الذي يجب على كل مؤمن، واعلم أن الخوف يستلزم الرجاء كما تقدم، فلا يمكن أن يكون الإنسان خائفًا الخوف الذي أمر الله به، إلا إذا قرنه بأي شيء؟ بالرجاء؛ لأن فرط الخوف يفضي إلى القنوط واليأس من رحمة الله، وهـٰذا مما حرّمه الله جل وعلا، ونهى عنه، فلابد للخائف من الله -جل وعلا- أن يرجوه، ولذلك جاء الرّجاء في الكتاب بمعنى الخوف في مواضع عديدة منها قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾( )، وأيضًا: ﴿لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾( ).
[المتن]
السابعة: ذكر ثواب من فعله.
[الشرح]
في حديث عائشة، فإنه ذكر ثواب من حقّق خوف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ((من التمس رضا الله بسخط الناس؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)). فذكر ثواب تحقيق الخوف، وثواب تخلفه، ثواب التحقيق حصول رضا الله جل وعلا، وحصول رضا الخلق، ولا تعجب كما ذكرنا، فالقلوب بيد الله: ((إن الله إذا أحب عبدًا نادى في السماء –كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة- : يا جبريل إني أُحب فلانًا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فينادى في الأرض: إن الله يحب فلاناً فيوضع له القبول في الأرض)). إذا أحبه الله، ثم أحبه جبريل، ثم أحبه أهل السماء، وُضع له القبول في الأرض، والقبول هو المحبة. وكذلك في المقت والبغض: ((إن الله إذا أبغض عبدًا نادى في السماء: يا جبريل إني أُبغض فلانًا فأبغضه)). ويا لتعاسة من نادى الله جل وعلا– من نادى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- جبريل ببغضه: ((إني أبغض فلانًا فأبغضه،فيبغضه جبريل، فينادي في السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، فتكتب له البغضاء، وتوضع له البغضاء في الأرض)). قلوب العباد بين يدي الله يصرفها كيف شاء، يحول بين المرء وقلبه، فينبغي للمؤمن أن يعلِّق رجاءه وخوفه ومحبته بالله عز وجل، ولا يكترث وينشغل بما يكون من الناس، فالناس كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للذي قال له: ((إن مدحي زين وذمي شين)) قال: ((ذلك هو الله)). الناس ليس لهم مدح ثابت، ولا ذم ثابت، كل هـٰذا يتلاشى، ويضمحل إذا ما شاء الله جل وعلا، فإذا امتلأ قلب العبد بمثل هـٰذه الأمور، لم يبال بالناس في حق الله جل وعلا، ولم ينظر ويرقب الناس في حقوق الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
الثامنة: ذكر عقاب من تركه.
[الشرح]
وهـٰذا واضح في حديث عائشة رضي الله عنها: (ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) وبهـٰذا يكون قد انتهى هـٰذا الباب.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾( )
وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾( )، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ ﴾الآية( )، وقوله: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾( ).
وعن ابن عباس قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم -عليه السلام- حين ألقي في النار، وقالها محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين قالوا له: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً﴾( ) رواه البخاري والنسائي.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾).
مناسبة هـٰذا لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن التوكل من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهو من أوجب الواجبات، ولذلك عطفه الله على العبادة في قوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾( )؛ لأنه لا يستقيم حال العبد في عبوديته لله -جل وعلا- إلا بتمام التوكل على الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فالضعف في التوكل ضعفٌ في التوحيد، هـٰذه مناسبة هـٰذا الباب لكتاب لتوحيد.
أما مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: فالبابان كلاهما مما يتعلق بأعمال القلوب، فالخوف من عمل القلب، والتوكل من عمل القلب، هـٰذا وجه.
وجه آخر في المناسبة بين البابين: أنَّ مما يحقق به الإنسان الخوف من الله صدق التوكل على الله جل وعلا، فمن توكل على الله تلاشى من قلبه كل خوف، واضمحل في فؤاده كل وجل، لم يبق في قلبه إلا خوف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فالمؤلف -رحمه الله- ذكر بعد الخوف سبيل تحصيله، وهو التوكّل على الله عز وجل، فإن الخوف أصله: الحذر والوجل من وقوع المكروه، فإذا كان الإنسان قد علَّق قلبه بالله في حصول المطالب، وفي دفع المكاره، فإنه لن يخاف غير الله جل وعلا، فناسب بعد أن ذكر وجوب إفراد الله -عز وجل- أن يذكر السبب والوسيلة التي يتحقّق بها كمال الخوف، فمن كَمُل توكُّله وحَّد خوفه؛ لأنه لا يرغب من الناس شيئًا فيخاف فواته، فيسعى في طلبه، ولا يخشى أن يقع عليه شيء من مضارهم فيسعى في دفعه، بل قد وكل أمره إلى الله جل وعلا، فالمطالب كلها من الله جل وعلا، والمخاوف كلها لا تدفع إلا به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وبهـٰذا يتحقّق للإنسان كمال التوحيد، وكمال الخوف من الله جل وعلا.
إذًا ما مناسبة هـٰذا الباب للذي قبله؟ أن التوكل على الله -عز وجل-سببٌ لحصول الخوف، ووسيلة لتحقيق توحيد الخوف من الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾).
التوكل ما هو؟ التوكل في اللغة معناه: التفويض، والاعتماد على الغير، هـٰذا معناه في اللغة، أما معناه في الشرع- يعني التوكل الذي أمر الله به ورسوله- فهو: صدق الاعتماد على الله -جل وعلا- في جلب المنافع، ودفع المضار، هـٰذا معنى التوكل، فإذا صدق العبد في اعتماده على الله -عز وجل- في جلب المنافع، وهي كل ما يحبه الإنسان، ويلائم طبعه، وفي دفع كل ما يكرهه وينافر طبعه، فقد حقق التوكل.
التوكل من العبادات التي أمر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بإفراده بها، فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾؛ فأمر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بأن يُتوكل عليه وحده دون غيره، وجه إفادة هـٰذه الآية وجوب توحيد التوكل، وإفراد الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به: أنه قدَّم ما حقه التأخير حيث قال: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ والأصل في التركيب: توكلوا على الله، لكن لما قدَّم ما حقه التأخير دلَّ ذلك على إفادة الحصر، ثم أكَّد هـٰذا المعنى بقوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ فجاء بالشرط أي: إن كنتم مؤمنين فحققوا هـٰذا.
فقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم﴾، ﴿إن﴾: شرطية، ﴿كُنتُم﴾: فعل الشرط، وجوابه مُقَدر عُلم مما تقدم، تقديره: فحققوا ما تقدم، أو فاعملوا بذلك، أو فتوكلوا على الله، تقدير ما يناسب تمام الكلام، وفي هـٰذا جعل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- التوكل عليه جل وعلا شرطًا في الإيمان، حيث قال: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ في قوله: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾، ومعنى هـٰذا أنه إذا لم يتوكلوا عليه؛ لم يحققوا الإيمان، وهـٰذا لا إشكال فيه، وقد دلَّت عليه آيات عديدة، حيث جعل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من أوصاف أهل الإيمان التوكل عليه، وهـٰذا يدلّ على أن انتفاء التوكل سببٌ لانتفاء الإيمان، فمن لم يحقق التوكل، فإنه ليس بمؤمن، ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر انتفاء وصف الإيمان عنه بانتفاء هـٰذا العمل القلبي، وهو صدق الاعتماد على الله -جل وعلا- في جلب المنافع ودفع المضار.
ثم قال رحمه الله: (وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾( ).) فحصر الله -جل وعلا- في هـٰذه الآية وصف الإيمان في أهل هـٰذه الأعمال، ما هي الأعمال؟ ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: خافت، والوجل: مرتبة من مراتب الخوف، ولكنه خوفٌ مشوبٌ بهيبةٍ وتعظيمٍ، فالوجل ليس خوفًا يوجب النفرة، إنما هو الخوف المشوب بالهيبة والتعظيم، كما قال الله جل وعلا: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾( ) فهـٰذا هو الوجل المذكور في هـٰذه الآية، بينته آية الزمر، فالخوف هنا ليس خوفًا مجردًا، إنما خوف هيبةٍ وتعظيمٍ للرب جل وعلا، ومعلوم أنَّ من عرف الله حق معرفته إذا ذُكر -جل وعلا- وجل قلبه تعظيمًا وهيبةً للرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ومن قلَّ علمه بالله ضعف وجله منه، فمن أوصاف أهل الإيمان: أنه ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً﴾ والآيات هنا تشمل الآيات الشرعية، والآيات الكونية، والتّلاوة هنا تشمل القراءة، وهـٰذا في الآيات الشرعية، وتشمل أيضًا العرض، فإن عرض الآيات، ومجيء الآيات الكونية إذا حصل به زيادة الإيمان كان ذلك دليلاً على سلامة قلب صاحبه، وأنه من المؤمنين، بخلاف الذين يمرُّون على الآيات، ثم يعرضون عنها كما قال الله في وصف أهل الكفر: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾( ). فأهل الإيمان على خلاف هـٰذا الوصف؛ الآيات الكونية في الخلق، في السماوات والأرض، في الكون تزيدهم إيمانًا، والآيات الشرعية إذا تليت عليهم زادتهم إيمانًا، ولانت قلوبهم لها، وأقبلوا عليها، وازدادوا خيرًا بها، بخلاف الذين إذا تليت عليهم آيات الله -عز وجل- زادتهم ظلمًا وعتوّاً وخسرانًا.
﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.هـٰذا ثالث الأوصاف التي حصر الله -جل وعلا- وصف الإيمان بمن اتصف بها. ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي: يلجؤون في جلب المنافع أو يعتمدون في جلب المنافع ودفع المضار، فليس لهم ركنٌ أو ملجأٌ أو معتمدٌ سوى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، بل هو عدَّتهم جل وعلا، وهو الذي إليه يلجؤون في جلب المنافع ودفع المضار.
والآية دالة على ما في الآية السابقة من أن من لوازم الإيمان التوكل على الله عز وجل، فمن لوازم الإيمان صدق التوكل عليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وفيها أيضًا وجوب حصر التوكل بالله، أو على الله وحده، يؤخذ من آية الأنفال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ فقدَّم ما حقه التأخير.
ثم قال رحمه الله: (وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ﴾)
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ الخطاب للنبي محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
﴿حَسْبُكَ اللّهُ﴾ أي: كافيك الله ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الواو هنا عاطفة، والمعطوف عليه فيه قولان:
قيل: إن العطف على الضمير في قوله :﴿حَسْبُكَ﴾ وهـٰذا هو الصحيح، أي حسبك، وحسب من اتبعك: الله، فالله -جل وعلا- كافي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكافي أتباع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
والمعنى الثاني: وهو الوجه الثاني في العطف، أنه على لفظ الجلالة، أي: حسبك الله وحسبك من اتبعك ، أي: يكفيك الله، ويكفيك من اتبعك، هـٰذا المعنى، لكنَّ هـٰذا المعنى ليس بصحيح، بل الله -جل وعلا- هو الحسب، فالحسب له وحده، يعني: الكفاية منه وحده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- دون غيره، ولذلك لم يُذكر الحسب في حق غيره من المخلوقين، في حق غيره من الخلق، بل له وحده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولذلك أمر الله بالتوكل عليه وحده دون غيره، وجاء في الذكر وفي قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((حسبنا الله ونعم الوكيل)). فالله هو الحسب وحده، الكفاية منه وحده لا من غيره.
فالمعنى الصحيح في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المعنى الصحيح: يا أيها النبي الله كافيك وكافي من اتبعك، وفي هـٰذه الآية بشارة لأتباع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فكل من حقق الاتباع فالله كافيه، فإذا أردت كفاية الله -جل وعلا- فاستكثر من اتباع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فبقدر ما معك من المتابعة بقدر ما يحصل لك من الكفاية، وهـٰذا ميزان قسط جرِّبه تجده: بقدر ما معك من المتابعة بقدر ما يحصل لك من الكفاية، ووعد الله حق: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾( ) فإذا صدق العبد في المتابعة كملت له الكفاية.
والشاهد في هـٰذا على التوكل: أنه إذا كانت الكفاية من الله للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولأتباعه فطلبها من غيره غير سائغ؛ لأنه هو الحسب، هو الكافي جل وعلا، كافي من توكل عليه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾( ).)
هـٰذا فيه بيان الشاهد من الآية السابقة، وهو أن طريق تحصيل الكفاية من الله هو التوكل عليه، فإذا حقق العبد التوكل على الله -جل وعلا- حصلت له الكفاية منه سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي: كافيه، والكفاية هنا في أمر الدين أو في أمر الدنيا؟ في أمر الدين وفي أمر الدنيا؛ لأن التوكل متعَلَّقه شيئان:
التوكل على الله -عز وجل- في حصول المطالب الدنيوية من المآكل والمشارب، وغير ذلك، هـٰذا عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة، التوكل على الله في حصول المطالب الدنيوية عبادة؛ لأن الله -عز وجل- أمر بالتوكل عليه في كل شيء: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ﴾( ) وأتى بالأمر بالتوكل بعد ذكر الرزق فقال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (02) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾( ). فالتوكل على الله يكون في المطالب الدنيوية، وهـٰذا عبادة من حيث هو، لكن من حيث غايته ليس بعبادة، يعني من حيث مقصوده ليس بعبادة؛ لأن الأكل والشرب والمطالب الدنيوية ليست بعبادة، إنما هي من حظوظ الإنسان.
الثاني من متعلَّقات التوكل: التوكل على الله في حصول مرضاته، أي: في حصول المطالب الدينية، كمن يتوكل على الله في الاستقامة، من يتوكل على الله في الهداية، من يتوكل على الله في اتباع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وهـٰذا أيضًا مما يجب إفراد الله -سبحانه وتعالى- به، وهو عبادة في ذاته وغايته، في ذاته: لأن التوكل حقه، وفي غايته: لأن المطلوب الذي يحصل بالتوكل عبادة أو غير عبادة؟ عبادة، فمتعلََّق التوكل إما مطلبٌ دنيوي، وإما مطلبٌ ديني، وفي الحالين التوكل ما هو يا إخواني؟ عبادة، لكن يختلفان في أي شيء؟ في الغاية والمنتهى والمقصد، ففي المطالب الدينية المقصد والغاية عبادة، وفي الثاني ليس بعبادة، ومن حقق الثاني كفاه الله الأول، يعني: من حقق صدق التوكل على الله في المطالب الدينية كفاه الله أمر المطالب الدنيوية، أما من حقق الأول فقد لا يحصل الثاني، وهـٰذا فرق آخر بين متعلََّقات التوكل.
فقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ فهمنا أن التوكل يكون في أمر الدين، ويكون في أمر الدنيا، وعرفنا الفروق بينهما.
قال المؤلف رحمه الله: (عن ابن عباس قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل).) يشير إلى قول الله عز وجل، إلى ما هو آية، وما هو ذكرٌ معروف: (حسبنا الله ونعم الوكيل)
(حسبنا) أي: كافينا الله، والقول هنا: (حسبنا الله) باعتبار الجمع؛ لأن الضمير المتصل بالفعل ما هو؟ نا الفاعلين التي تدل على الجمع.
إذا قال الإنسان المنفرد: (حسبنا الله) وهو منفرد، هل لها وجه؟ تمامًا مثل: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾( )، مثل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾( ). لماذا لم يقل المنفرد: (إياك أعبد)؟ ولماذا لم يقل: اهدني الصراط المستقيم؟ لماذا جاء بضمير الجمع؟ جاء بضمير الجمع في مثل هـٰذا، توسلاً إلى الله جل وعلا بكثرة فعله؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كافي كل أحد، فكأن الداعي يقول: يا رب كما كفيت غيري اكفني، يا رب كما هديت غيري اهدني، يا رب كما عَبَدك غيري فأنا من جملتهم فأدخلني في زمرتهم، فهـٰذا من التوسل إلى الله -جل وعلا- بوصفه، وهو كثرة قاصده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهـٰذا معنىً لطيف فيما جاء في الأدعية والأذكار على وجه الجمع مع أن القائل واحد.
(حسبنا الله) أي: كافينا الله، فالله –جل وعلا- كافي الخلق، من لم يكفه الله فلا كافي له.
(ونعم الوكيل). الوكيل: فعيل بمعنى مفعول، أي: نعم المُوَكَّل –سبحانه وبحمده- فنعم المُوكَّل إليه: الله جل وعلا؛ لأنّ من وكَّل إليه الأمر، وفوَّض إليه الأمر حصل المقصود بلا ريب.
واعلم أن التّوكل ينقسم إلى قسمين:
توكل اضطرار، وتوكل اختيار.
توكل الاضطرار: لا يمكن أن تتخلف عنه الثمرة، لا يمكن أن تتخلف عنه النتيجة، لا بد أن تحصل الكفاية، وهو ما جاء في هـٰذا الحديث من توكل إبراهيم عليه السلام وتوكل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (يقول ابن عباس: (حسبنا الله ونعم الوكيل)، قالها إبراهيم -عليه السلام- حين ألقي في النار) هـٰذا توكل اضطرار والتجاء أو توكل اختيار؟
توكل اضطرار والتجاء، والفارق بينهما: أن توكل الالتجاء والاضطرار تنقطع فيه الأسباب، ما يمكن أن يأخذ الإنسان سبباً من الأسباب، ما عنده سبب، لما ألقي في النار -عليه السلام- هل كان له سبب يدفع به عن نفسه؟ لم يكن له سبب يأخذه، إنما سببه: نصر الله وتوفيقه، التوكل على الله جل وعلا، هـٰذا التوكل يسمِّيه العلماء: توكل الاضطرار، ومن حصل منه لا يمكن أن يتخلف عنه المقصود، ولذلك لما توكل إبراهيم -عليه السلام- في هـٰذه الحال أتاه الفرج من الله، فقال الله للنار: ﴿كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾( ). هـٰذا القسم الأول من التوكل، وهو توكل الاضطرار الذي تنقطع فيه عن الإنسان الأسباب، فلم يبق له إلا الله -جل وعلا-، وفي هـٰذا لا يمكن أن يتخلف النصر، ولا يمكن أن يتأخر الفرج: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ كافيه سبحانه وبحمده.
وهو أيضًا الذي جرى من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، يقول:
(وقالها محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين قالوا له: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾( )). فماذا كانت النتيجة؟ :﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾( ). سبحان الله! وهـٰذا من كمال الكفاية ﴿لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ نفى الله -جل وعلا- مس السوء عنهم بالكلية لما قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قالوها بألسنتهم وصدقتها قلوبهم.
إذًا هـٰذا النوع الأول من أنواع التوكل، وهو توكل الاضطرار.
النوع الثاني: توكل الاختيار، وهو عند وجود الأسباب التي يمكن أن يأخذها الإنسان لتحصيل مطلوبه، والتوكل في هـٰذا القسم ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من يعتمد على السبب، وهـٰذا شرك.
القسم الثاني: من يلغي السبب، ما ينظر إليه، وهـٰذا نقص في العقل؛ لأنه لا يمكن أن تُلغى الأسباب، الأسباب دل الشرع والإجماع والعقل والحس على أنها لا بد أن تُؤخذ، ما فيه شيء إلا وله سبب، فمن ألغى الأسباب وقال: الأسباب لا تنفع، فقد ألغى ما دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس، كل حركة وسكون لا بد فيها من سبب، لو لم يرفع الإنسان قدمه على الأرض ليمشي ما مشى، فكل شيء له سبب، لا بد، هـٰذا القسم الثاني من أقسام الناس في الأسباب، وهم الذين ألغوا الأسباب، وهـٰذا في الصوفية كثير.
القسم الثالث: هم الذين كملوا النظر إلى المسبب –وهو الله جل وعلا- فنظرهم وقلوبهم معلقة به، وأخذوا ما جعله طريقًا لتحصيل المقصود -السبب، الوسيلة- لتحصيل المقصود، لكن لم يلتفتوا إلى الأسباب، ويتركوا المسبب، بل علقوا قلوبهم بالذي لا تتم الأمور إلا به، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وأخذوا ما جعله سببًا لتحصيل المطلوب، وهؤلاء الذين كَمَل دينهم وعقلهم، وهو هدي الرسل وأتباعهم، فإن المرسلين وأتباعهم على هـٰذا سائرون، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظاهر بين درعين في غزوة أحد، وهديه واضح في اتخاذ الأسباب: كان يدخر قوت أهله سنةً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
والمقصود أن القسم الثالث هـٰذا هو أكمل الأقسام، ويمكن أن نقسم أقساماً تحت هـٰذا: الذين يقرون بالسبب، وينظرون ويعتمدون على الله -عز وجل-.
منهم من يغلب عليه النظر إلى السبب، ويغفل عن المسبب.
ومنهم من إذا أخذ السبب اشتغل قلبه، وتشتت همه وضعف توكله، فما حكم مثل هـٰذا؟
هل نقول: خذ السبب، أو نقول: اترك السبب واكتف بالتوكل؟
الجواب: أنَّ من كان أخذ السبب سببًا لتفرق قلبه، واشتغاله بالسبب عن المسبب، نقول له: لا تأخذ السبب؛ لأن التوكل أعظم الأسباب في تحصيل المطالب، وهناك أسباب أخرى تقترن بالتوكل، على سبيل المثال: السعي في تحصيل الرزق، وما أشبه ذلك، فإذا كان أخذ السبب سببًا لضعف التوكل قلنا له: لا تشتغل بالسبب الأصغر إذا كان يؤثر على السبب الأكبر، لكن الأكمل في الإنسان أن يسعى إلى تكميل الأمرين، وهو أن ينظر إلى الله – جل وعلا – ويصدق في الاعتماد عليه، ويأخذ الأسباب، لكن إذا كان الإنسان قلبه لا يتمكن من الجمع بين هذين، فإذا أخذ السبب تشتت قلبه، وضعف توكله على الله -عز وجل-، قلنا له في هـٰذه الحال: لا تأخذ السبب؛ لأن أخذك للسبب سببٌ لتحصيل المطلب الدنيوي وبه يفوت المطلب الشرعي، وهو صدق الاعتماد على الله -عز وجل- ، فلو فاتك المطلب الدنيوي، وسَلِمَ لك المطلب الشرعي كان ذلك خيرًا لك، واضح هـٰذا.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: أن التوكل من الفرائض.
الثانية: أنه من شروط الإيمان.
[الشرح]
التوكل من الفرائض أدلته واضحة في الباب. أنه من شروط الإيمان قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾( )، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾( ) الآية.
[المتن]
الثالثة: تفسير آية الأنفال.
الرابعة: تفسير الآية في آخرها.
[الشرح]
في آخرها في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾( ).
تفسير الآية في آخرها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: (تفسير الآية في آخرها) أي في آخر سورة الأنفال، تفسير الآية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾( ) و ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ﴾ ثم ذكر آية الطلاق.
[المتن]
الخامسة: تفسير آية الطلاق.
[الشرح]
﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾( ).
[المتن]
السادسة: عِظَمُ شأن هـٰذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الشدائد.
[الشرح]
اللهم صل وسلم عليه، نعم هـٰذا واضح.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾( )
وقوله: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ﴾( ).
وعن ابن عباس، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئل عن الكبائر؟ فقال: ((الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.))
وعن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: ((أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله)). رواه عبد الرزاق.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾.)
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن الأمن من مكر الله يوقع الإنسان في الشرك، فمن أسباب الوقوع في الشرك الأمن من مكر الله، ومن أسباب الوقوع في الكفر الأمن من مكر الله سبحانه وبحمده، فالمؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب ذكر شيئًا من الأسباب التي توقع في الشرك.
ومناسبة هـٰذا الباب لما قبله: في البابين السابقين ذكر المؤلف –رحمه الله– الخوف من الله جل وعلا، وذكر التوكل عليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فالخوف هو العبادة، والتوكل هو الوسيلة لتحقيق الخوف من الله جل وعلا، فإنه من توكل على الله وحَّد خوفه، ولم يخف غيره سبحانه وبحمده، أما من ضَعُفَ توكله على الله في جلب مصالح الدنيا ومصالح الآخرة فإنه يتوكل على غيره، وينظر إلى غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
هـٰذا الباب ذكر فيه المؤلف –رحمه الله– أمرًا مما ينبغي أن يُلاحظ، وهو الخوف من الله -جل وعلا- فيما يتعلق بالمكر، فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾. فهـٰذا الباب ذكره المؤلف –رحمه الله– لبيان نوعٍ من الخوف الذي ينبغي أن يكون عند أهل الإيمان.
ومن مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: أنه بيَّن فيه أيضًا سببًا آخر من أسباب الخوف، يعني: من وسائل تحصيل الخوف ألا يأمن الإنسان من مكر الله، فإن من أمن من مكر الله لم يخفه، فذكر المؤلف –رحمه الله– في الباب السابق سببًا من الأسباب وهو التوكل، وفي هـٰذا الباب ذكر سببًا آخر، وهو ماذا؟ وهو عدم الأمن من مكر الله -عز وجل- ، فإذا كان الإنسان يجب عليه ألا يأمن من مكر الله، فما هي الحال التي يجب عليه أن يكون عليها؟
الخوف؛ لأن الأمن ضد الخوف.
قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾). الاستفهام في هـٰذه الآية عن حال أهل الكفر والشرك؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ الذين خسروا أنفسهم، وخسروا الدار الآخرة، فهـٰذه الآية في الأصل موجهة لأهل الشرك والكفر؛ لأنهم هم الذين أمنوا مكر الله -عز وجل- على وجه الكمال، وإلا لو لم يأمنوا مكره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لقاموا بما أمر، ولتركوا ما نهى عنه وزجر، ويدخل في هـٰذا أيضًا أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان يجب عليهم ألا يأمنوا مكر الله، يجب عليهم أن يخافوا مكر الله، فخوفهم من مكر الله -عز وجل- يكون بخوف أن يؤاخذهم الله –جل وعلا– على ذنوبهم، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إذا آخذ العبد بذنبه هلك العبد كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من نوقش الحساب عُذِّب)). وكما قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾( ). فالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يعفو عن كثير من أخطاء عباده، وإلا لو آخذ كل أحد بخطئه لهلك كل أحد، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: ((واعلموا أنه لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته)). وهـٰذا يدل على أنه لولا رحمة الله لهلك الجميع، فرحمة الله وسعت كل شيء، وممن وسعت -وهم أحق الخلق بها- أهل الإيمان مع ما معهم من التقصير.
﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ فالذين يأمنون مكر الله حكم الله –جل وعلا– عليهم بالخسار.
ثم قال رحمه الله: (وقوله: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ﴾( ).) بعد أن ذكر الأمن من مكر الله ذكر ما يقابله، وهو القنوط من رحمة الله، والقنوط هو: قطع الطمع في رحمة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهو اليأس من رحمة الله -عز وجل-، إلا أن بعض العلماء يفرِّق بين القنوط واليأس بأن القنوط أشد حالاً من اليأس: فاليائس قطع الرجاء من رحمة الله، والقانط قطع الرجاء من رحمة الله وزاد على ذلك ظهور ذلك على حاله وقوله، فاليأس أمر قلبي، والقنوط أمر في القلب ويظهر على الجوارح، هكذا فرَّق بعضهم بين اليأس والقنوط.
والظاهر أن اليأس والقنوط شيءٌ واحدٌ إذا لم يجتمعا، أما إذا اجتمعا فاليأس غير القنوط، ويكون القنوط أشد من اليأس.
وهل يجتمعان؟ هل اجتمعا في كلام الله -عز وجل-؟
نعم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ﴾( ) في سورة فصلت، ما هي؟
اجتمعا في قوله تعالى: ﴿فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ﴾( ) فاليأس في هـٰذه الآية غير القنوط، لكن في جميع الموارد الأخرى التي ذكر الله –جل وعلا– فيها اليأس والقنوط فهما كالإيمان والإسلام: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
قال رحمه الله: (قوله: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ﴾) فحكم الله –جل وعلا– على القانطين من رحمة الله -عز وجل- بالضلال.
ثم ذكر المؤلف –رحمه الله– أثرين:
أما الأول فقال: (عن ابن عباس أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل عن الكبائر؟ فقال: ((الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله)) ) وهـٰذه كبائر كما وصفها في الأثر، لكنَّها ليست على درجة واحدة، فأعظم ذلك الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾( ) ثم بعده اليأس من روح الله، ثم بعد ذلك الأمن من مكر الله. واليأس كما تقدم هو قطع الرجاء والأمل والطمع في ما عند الله -عز وجل-.
وهنا (اليأس من رَوْح الله) الرَّوْح بمعنى: الرحمة، أي: من رحمة الله، وسمِّيت الرحمة رَوْحًا لأنه يحصل بها الفرج لمن جاءته، ولمن مسَّه الكرب.
وقوله: (والأمن من مكر الله). هـٰذا فيه أنَّ الأمن من مكر الله من الكبائر، وقد يصل بصاحبه إلى الشرك، كما أخبر الله –جل وعلا– عن المشركين في قوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾.
ثم قال رحمه الله: (وعن ابن مسعود قال: ((أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله)). )
((أكبر الكبائر: الإشراك بالله)) وتقدم، وذلك بأن تجعل لله -عز وجل- ندّاً في شيءٍ مما يختص به الله -عز وجل-، سواءً في الإلهية، أو في الربوبية، أو في الأسماء والصفات.
قال: ((والأمن من مكر الله)). هـٰذا ثاني ما أخبر بأنه من الكبائر، وذلك أن من أمن مكر الله -عز وجل- وقع في مغاضبه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم قال: ((والقنوط من رحمة الله)). أي: شدة اليأس من رحمة الله، فإن من اشتد يأسه من رحمة الله -عز وجل- منعه هـٰذا من العمل الصالح، وأوقعه في سوء الظن بربه، ومن أساء الظن بالله -عز وجل- فإنه واقعٌ في شرٍّ كبيرٍ؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قد قال في الحديث الإلهي: ((أنا عند ظن عبدي بي)). لكن لا يحمل هـٰذا الإنسانَ على الغرور، بل يجب على الإنسان أن يسير إلى الله -عز وجل- بالخوف والرجاء والمحبة.
قال: ((واليأس من روح الله)) هـٰذا كالتكرار للذي قبله، وذكرنا أنه إذا اجتمعا كان القنوط له معنى واليأس له معنى، وفي هـٰذا يكون القنوط أشد أحوال اليأس، وهو ما كان في القلب وظهر على الجوارح.
وهـٰذا الأثر رُوِيَ مرفوعًا عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، لكنه لا يصح مرفوعًا، إنما يصح موقوفًًا على ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، ومثله هل هو مما يقال بالرأي؟ مثله يغلب أن لا يقال بالرأي، يعني: يغلب على الظن أنه مما لا يقوله برأيه، إنما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
[المتن]
فيه مسائل
الأولى: تفسير آية الأعراف.
الثانية: تفسير آية الحجر.
الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط.
[الشرح]
الأمن من مكر الله الواقع من الكفار هو أنهم يفعلون ما يفعلون من الكفر والشرك، والمخالفة لأمر الله ورسوله، والمحادة له ولرسله، ويظنون أنّ ذلك لن يضرهم ، هـٰذا الأمن الذي يقع من أهل الشرك.
الأمن الذي يقع من أهل الإيمان، ويجب أن يحذروه في أمور، ذكرنا منها أمرًا، وهو ألا يؤاخذهم الله -عز وجل- بذنوبهم، أن يؤخر عنهم العقوبة، ويستدرجهم بالتأخير.
الثالث: أن يؤاخذهم بذنوبهم في حال محبتهم نصر الله -عز وجل- وتأييده، فإنَّ من سيِّئات الذنوب أن الله -جل وعلا- يخذل العبد في موطنٍ يحب أن ينصره فيه.
هـٰذه الأمور الثلاثة هي التي يخشاها أهل الإيمان في ما يتعلّق بالأمن من مكر الله، وليس مما يتعلّق بأهل الإيمان في الأمن من مكر الله أنهم لا يعاقبون بذنوبهم، فإنّ هـٰذا في الغالب لا يكون إلا من أهل الكفر، أما أن المؤمن يظنّ أنه يسرف على نفسه، ويحاد الله ورسوله وأن الله لن يؤاخذه بذلك فهـٰذا لا يكون ممن في قلبه إيمان.
أما قوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ ففيه إثبات المكر لله -عزّ وجل-، والمكر: هل هو صفة مدح أو صفة ذم؟ من الناس من لا يرى المكر إلا ذمّاً، ولذلك يقولون: لا نثبت المكر صفةً لله -عز وجل-، وهـٰذا غلط؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أعلم بنفسه من خلقه، وقد أثبت لنفسه المكر في آيات عديدة، منها قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾. وأثبت لنفسه الكيد كما قال تعالى: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾( ). فالمكر والكيد ليس مذمومًا في جميع الموارد؛ بل منه ما هو محمود، وهو: ما كان في مقابل من استحق المكر والكيد، فإن الكيد بمن يكيد أهل الإسلام وأولياء الله محمود، والمكر بمن يمكر بأولياء الله محمود وصفة كمال، فهـٰذا المعنى الذي فيه جانب مذموم وفيه جانب محمود هل يثبت لله -عز وجل- مطلقاً؟
الجواب: لا، إنما يثبت لله منه ما هو محمود، ولذلك من العلماء من يرى ألا يطلق هـٰذا على وجه الإطلاق دون ذكر مقابله، فلا يقال: من صفاته المكر، بل يقال: من صفاته المكر بمن يستحقه؛ لأنه ليس على الإطلاق صفة مدح، وأكثر الموارد في الكتاب وفي السنة ذكر هـٰذه الصفات في مقابل من يستحق المكر والكيد، فهو وصف مقيَّد، ومن الصفات ما لا يطلق منفردًا، بل لابد من أن يقترن بما يقابله، مثل: (الظاهر) فلا يصح أن يوصف فقط بالظاهر؛ لأنه لا يكتمل المعنى الكامل الذي ثبت لله إلا بذكر مقابله، وهو (الباطن).
كذلك (الأول) لا يكتمل المعنى الكامل له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إلا بذكر المقابل، وهو الآخر.
كذلك (الرافع)، أو (الخافض) لا يكتمل معنى الكمال إلا بذكر المقابل، وهـٰذا في بعض أسماء الله -عز وجل-، وإلا فالأغلب في أسماء الله -عزّ وجل- وفي صفاته أنه يثبت الكمال بمجرد ثبوت الصفة والاسم له سبحانه وبحمده.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس العشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
وقول الله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾( ). قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلِّم.
وفي صحيح مسلمٍ عن أبي هريرة، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النّسب، والنياحة على الميت)).
ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: ((ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)).
وعن أنسٍ أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة)). وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنّ عِظَمَ الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحبّ قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط)). حسنه الترمذي.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (بابٌ: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.)
هـٰذا أيضًا من أعمال القلوب، التّوحيد في أعمال القلوب.
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن الصبر على أقدار الله من كمال التوحيد، ومن تمام الإيمان بالله -عز وجل-، فإن من الإيمان بالله -عز وجل- الإيمان بقضائه وقدره، وأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- خالق كل شيء، وأنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
أما متعلّق هـٰذا الباب بما قبله: فأن الأبواب هـٰذه يبحث فيها المؤلف –رحمه الله– ما يتعلّق بتوحيد أعمال القلوب لله -عز وجل-، ومن تمام توحيد القلب أن يكون صابرًا على أقدار الله، والصبر على أقدار الله لا يكون إلا لمن اعتقد أن ما يصيبه من المصائب فهو من الله جل وعلا، وإذا اعتقد العبد أنَّ كل شيء ينزل به فمن الله، فإنه لن يضجر من قدر الله -عز وجل-، بل سيكون هـٰذا حاملاً له على الرضا بالقضاء، لكن إذا غاب عنه الأمر، وظنَّ أنَّ غير الله يوصل إليه النفع والضر، فإنه سيوجِّه السخط على من أوصل إليه الضر، ومنع منه الخير، ولذلك كان الصبر على أقدار الله من تمام توحيد العبد. وأقدار الله -عز وجل- التي يُصْبَرُ عليها ما هي؟ هل هي الأقدار الملائمة للطبع، أو الأقدار التي تنافر الطبع؟ الصبر إنما يكون على ما ينافر طبع الإنسان مما يكرهه ولا يطمئن إليه.
أما ما يلتذ به الإنسان ويحبه فإنه لا يقابل بالصبر، إنما يقابل بالشّكر، كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث صهيب: ((عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير: إن أصابته سراء)) -ماذا؟ صبر أم شكر؟- ((شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)). فالصبر إنما يكون على أقدار الله المؤلمة، وإضافة الأقدار في الترجمة إلى الله هو من باب إضافة الأمر إلى من؟ إلى فاعله، يعني: الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا.
ثم ذكر المؤلف –رحمه الله– في هـٰذا الباب آيةً وأحاديث، فقال: (وقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾.) والإيمان بالله إنما يتحقق بتكميل أصول الإيمان: فيؤمن بأن الله هو رب كل شيء
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وأنه إله كل شيء، وأنه -سبحانه وبحمده- له الأسماء الحسنى، والصفات العلا، هـٰذا الإيمان بالله. وإذا أُطلق الإيمان بالله فإنه يستلزم بقية أركان الإيمان: كالإيمان بالملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والرسل والقدر خيره وشره، فإنه إذا أطلق الإيمان بالله، ولم يقرن به غيره دخل فيه بقية أصول الإيمان؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سئل عن الإيمان قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء -أو بالقدر- خيره وشره)). فهـٰذه أصول الإيمان كلها إذا نظرت تندرج تحت الإيمان بالله، وإن كان كل واحدٍ منها يجب الإيمان به على وجه الانفراد.
فقول الله -عز وجل-: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ أي: من كمَّل إيمانه بالإيمان بهـٰذه الأصول الستة ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ أي: يمنح قلبه الهداية. والهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان أو هداية التوفيق والإلهام والعمل؟ هداية التوفيق والعمل؛ لأن الأولى حصلت بالإيمان: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾. فالإيمان لا يمكن أن يحصل لأحد إلا إذا علم ما الله، وما صفاته، وما يجب له.
فقوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ الهداية هنا هداية التوفيق إلى العمل الصالح، فالله -عز وجل- يهدي قلبه، وخصَّ القلب بالهداية لأن هداية القلب هي المقصودة في الأصل: ((ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)) فالذي يُعْقَد عليه الصلاح والفلاح والنجاة يوم القيامة هو هداية القلب وصلاحه، ولذلك قال: ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ وإذا هُدِيَ قلبه فهل ستهتدي جوارحه وأعماله؟ الجواب: نعم، لا بد، ما لم يوجد مانع، لكن لو قال: يهد بدنه هل يلزم من هـٰذا هداية القلب؟ الجواب: ما يلزم؛ لأنه قد يصلح الظاهر ويكون الباطن فاسدًا، كما هو الحال في من؟ في المنافقين، فالمنافقون صلحت ظواهرهم بشرائع الإسلام، ولكن خربت قلوبهم بخلوِّها من الإيمان.
(قال علقمة: هو الرجل)، أي: المقصود بالآية (تصيبه المصيبة) أي: تنزل به المكروهات، فالمصيبة هي ما يكرهه الإنسان في ماله، في نفسه، في أهله، في من يحب، كل هـٰذا يدخل في قوله رحمه الله: (تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله) أي: أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: (01) علمها، وأنه (02) كتبها، وأنه (03) شاءها، وأنه (04) خلقها، أربعة أمور؛ لأنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا إذا آمن بهـٰذه الأربع المراتب، فيعلم أنها من عند الله علمًا، وكتابة،ً ومشيئةً، وخلقًا، إذا آمن العبد بهـٰذا فإنه لا بد أن يرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله، ويسلم: أي يستسلم لا يدافع ما قدَّره الله عليه مما لا يمكن مدافعته، بل يسلم للقضاء، ويرضى بما جرى به القلم؛ لأنه من الله جل وعلا.
وإذا استحضر الإنسان هـٰذا الأمر عند نزول المصائب عليه وحلول ما يكره كان حاملاً له على الصبر والرضا وعدم الكآبة الزّائدة على ما تقتضيه الحالة، فإن من الناس من إذا أصابه شر انقلبت أموره، وساءت أحواله، واسودّت الدّنيا في عينيه، وهـٰذا خطأ؛ لأنه ضعفٌ في الإيمان بالله -عز وجل-، ولو صدق في إيمانه وكمَّله لهدى الله قلبه إلى اليقين، وإلى الصّبر على قضاء الله -عز وجل-.
(وقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة.)
قوله رحمه الله: (هو الرجل تصيبه المصيبة) يشمل المصيبة الدينية، والمصيبة الدنيوية، ويشمل المصيبة التي من الله -عز وجل- ، والمصيبة التي ترتبت على فعل العبد، فكل هـٰذا يدخل في قول الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾( ) فالآية تشمل كل المصائب التي يصاب بها العبد، فإنه إذا صبر عليها هدى الله –جل وعلا– قلبه، وهداية القلب هي دلالته على ما فيه خيره.
ثم قال: (فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم). فيعلم أنها من عند الله أي: أنها بعلمه، وكتابته، ومشيئته، وخلقه، إذا اجتمع له تمام الإيمان بهـٰذه المراتب الأربع حمله ذلك على الرضا والتسليم، وعدم المدافعة لما قضاه الله، وعدم الجزع مما قضاه الله، والمقصود بالمدافعة: أي ما لا يمكن دفعه، أما ما يمكن دفعه فإنه يدافع؛ لأنّ قدر الله يدفع بقدر الله كما قال عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (نفر من قدر الله إلى قدر الله).
ثم قال رحمه الله: (وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر)) ) ثم بيَّن قالك (((الطعن في النسب، والنياحة على الميت)). )
((اثنتان)) أي: خصلتان، وفي رواية: ((اثنان))، فيحمل على معنى المذكر، أي: أمران، أو خلقان، أو ما أشبه ذلك.
وقوله: ((في الناس)). الناس المراد به هنا عام أو خاص؟ الناس لفظ عام، لكن هل المراد به عمومه أو مرادٌ به الخصوص؟ الخصوص، المراد به أهل الإسلام؛ لأن غير أهل الإسلام فيهم من خصال الكفر ما هو أعظم من هـٰذا، فقوله: ((اثنتان في الناس)). أي: في هـٰذه الأمة من أهل الإسلام الذين انقادوا للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فهو من العام الذي يراد به الخصوص.
ومنه: قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن)). فبيَّن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها في الأمة، وأما غيرهم فعندهم أعظم من هـٰذا.
وقوله: ((هما بهم كفر))؛ ((هما)): أي هاتان الخصلتان، فالضمير المثنى يعود على الخصلتين.
((بهم)) أي: بالناس ((كفرٌ)) أي: من شعب الكفر وأعماله وخصاله.
وقال بعض الشرَّاح: إن قوله: ((هما بهم كفر)) من الانقلاب على وجه الاتساع، يعني: انقلب فيه التركيب على وجه الاتساع، والأصل أن يقول: ((هم بهما كفر)). ولكنَّ الظاهر أن قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا انقلاب فيه، بل هو على وجهه؛ لأن المقصود الحكم على هاتين الخصلتين ((هما بهم كفر))، وليس المقصود الحكم على الأمة، فإن الأمة لا يُحكم عليها بالكفر بمجرد وجود هاتين الخصلتين من خصال الكفر؛ لأنه كما أن للإيمان خصالاً لا يثبت الإيمان إلا بأصلها، فكذلك الكفر له شعب وخصال لا يثبت حكم الكفر المطلق إلا باستكمالها.
معنى الكلام على وجه التفصيل أو البيان: أن الكفر له شعب، فمن شعبه الطعن في النسب، والنياحة على الميت، وما ذكر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الغش، وغير ذلك من الصفات التي تبرأ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من فاعلها، وأخبر بأن فعلها كفر، فهـٰذه خصال الكفر، لكن هل يثبت لكل من اتصف بهـٰذه الصفات أنه كافر؟
الجواب: لا، فالنصوص دلَّت على أنه قد يكون في الإنسان خَلَّة من خِلال الكفر، أو وصف من أوصافه، ولا يثبت له الكفر المطلق، من ذلك قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن)). فأخبر بأنها في أمته، والأمة هنا أمة الإجابة، ومع ذلك لم يرتفع عنهم هـٰذا الوصف، وكذلك قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبي ذر لما عيَّر الرجل بأمه، قال له: ((إنك امرؤ فيك جاهلية)). ولم ينف عنه أنه أصدق الصحابة، أو أصدق أهل الإسلام لهجة، فما ثبت من فضائله ثابت مع وجود هـٰذه الخصلة فيه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- .
المهم أن خصال الكفر إذا وجدت لا يلزم منها إثبات الكفر حتى يثبت ما يوجب الخروج، وهو الكفر المطلق.
كذلك خصال الإيمان لا تُثبت الإيمان إلا إذا وُجِدَ أهلها، أو إذا وجد أصلها، فمثلاً: عندنا رجل من أهل الكفر محسن، يحب الإحسان، إعانة الفقير، إعانة المسكين، كفالة الأيتام، هل يكون بهـٰذا مسلمًا؟ لا يكون بذلك مسلمًا، لماذا؟ لأنه لم يأت بأصل الإسلام، وهو الإحسان الذي هو أن يعبد الله كأنه يراه، وقبل هـٰذا لم يأت بالإسلام الذي هو قول: لا إلـٰه إلا الله، الشهادة لله بالإلهية، وللنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة.
((اثنتان في الناس هما بهم كفر)). للعلماء في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (كفر) عدة أقوال:
أصوبها ما ذكرناه من أن المراد بقوله: ((هما بهم كفر)) أي: إنهما من أعمال الكفار، ومن خصال الجاهليين.
قال بعضهم: إن الكفر هنا كفر النعم، وليس المراد به الكفر المعروف. وقال آخرون: إن المراد بالكفر هنا المبالغة في التنفير من هـٰذا الخلق، والتغليظ على من عمل هـٰذا العمل. وقال بعضهم: إن الكفر هنا على بابه، لكنه في حق المستحل، يعني: من استحل الطعن في النسب، والنياحة على الميت. فصار عندنا كم قولاً؟
أربعة أقوال، أصوبها: القول الأول الذي ذكرناه، وإنما ذكرنا هـٰذه الأقوال لأنها ذكرت وهي كلها ليست بصحيحة، إلا القول الأول؛ لأن كفر النعمة: إما أن يكون جحدًا، والجحد يكفر به كفرًا مطلقًا، وإما أن يكون قصورًا في الشكر، أو تقصيرًا في الشكر، إما أن يكون جحدًا لنعمة الله فهـٰذا كفر يخرج به الإنسان من الملة بالاتفاق، وإما أن يكون تقصيرًا في الشكر، فهـٰذا لا يختص هذين الفعلين، وعليه فإن كل من قصَّر في شكر نعمة الله فإنه يكون كافرًا، وهـٰذا يرتفع به التخصيص المذكور في هـٰذا الحديث من وصف بعض العمل بالكفر.
وأما التغليظ فهـٰذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يمكن أن يبلغ التنفير والتغليظ في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حدّاً يُفهَم منه خلاف الصواب، وهـٰذه مسائل مهمة؛ لأنها تأتي في مثل هـٰذا النص، في هـٰذا النص وفي أمثاله من حمل العلماء وشرحهم للأحاديث، وحملهم، وبيانهم لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
نقول: قولكم: إنَّ هـٰذا على وجه التغليظ وليس مرادًا، ليس بصحيح؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا ينطق عن الهوى، فلو كان الأمر دون هـٰذه المرتبة ما ارتفع به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى هـٰذه المرتبة تنفيرًا وتحذيرًا وتغليظًا، بل إن شيخ الإسلام –رحمه الله– قال: إن من قال هـٰذا يخشى عليه الكفر؛ لأنه ينسب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى التضليل، وإلى حال الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، حيث يتجاوزون في أقوالهم الحدود الواقعة، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا ينطق إلا بالحق: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾( ) كما قال الله جل وعلا.
أما القول الثالث وهو تكفير المستحل فيقال: إن هـٰذا لا يختص هذين الفعلين، بل هو عام في كل محرم استُبيح، فإنه يكفر به صاحبه، فلم يبق إلا ماذا؟ القول الأول، وهو أن المراد بالحديث أعمال الكفار وخصالهم. ولا يشكل عليك هـٰذا، فإنه قد يجتمع في الإنسان عملٌ من أعمال الكفار مع كونه مؤمنًا، كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في خصال المنافق: ((ثلاث من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كان فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق)).
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الطعن في النسب)). المراد بالطعن: الطعن يطلق في اللغة على أمرين: على أمرٍ معنوي، وعلى أمرٍ حسي. الأمر الحسي معروف، وهو إدخال شيءٍ في شيءٍ، وأما الطعن المعنوي فهو قريب منه؛ لأنه يوجع المطعون، وإن كان الإيجاع فيه معنويّاً لا حسيّاً، فللاشتراك في المعنى- وهو حصول الألم- سمِّي النيل من الأنساب طعناً، لأنه يوجع من؟ يوجع المطعون في نسبه. والطعن في النسب يشمل صورًا كثيرة، منها: نفي أصحاب النسب المعلوم، فإن هـٰذا من الطعن في النسب، كأن يكون الإنسان قرشيّاً فيقال: هـٰذا ما هو قرشي، هـٰذا ليس قرشيّاً.
أيضًا من الطعن في النسب: المفاضلة بين القبائل على وجه الفخر، والكبر، والعلو، فهـٰذا لا يجوز. كذلك من الطعن في النسب علو النسيب -يعني القبلي- على غيره، فإن هـٰذا من الطعن في النسب.
وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والنياحة على الميت)). النياحة أصلها من النوح، وهو البكاء بصوت، وهـٰذا الصوت إما أن يكون كصوت الحمام في نوحها وبكائها، وإما أن يكون صوتًا يثير الحزن، ويجدد الهم، ويظهر التسخّط والجزع، كالبكاء الذي يصاحبه تعداد لفضائل الميت ورفع الصوت باسمه، فإن هـٰذا من النياحة.
بل إن بعض العلماء قال: إن من النياحة تعداد شمائل الميت ولو لم يكن معها بكاء. فهـٰذا أيضًا من خصال الجاهلية التي أخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ببقائها في الناس.
الشاهد في هـٰذا الحديث: أي الخصلتين تشهد للباب؟ قوله: ((النياحة على الميت)).
ثم قال: (ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا) ما معنى مرفوعًا؟ إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وهـٰذا على وجه الاختصار، عوضًا عن قولهم: ( قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)، أو: (سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أو ما أشبه ذلك.
يقول: ((ليس منا من ضرب الخدود)). النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تبرأ بهـٰذا اللفظ من أصحاب أوصاف، أو من أشخاص؟ تبرأ من أصحاب أوصاف: ((ليس منا)) أي: أهل الإسلام ((من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)). الجامع في هـٰذه الخلال كلها الجزع، وعدم الصبر على أقدار الله -عز وجل-.
فضرب الخدود يكون عند المصائب: الموت أو غير الموت، فإن من الناس من إذا أصيب بمصيبة، ونزلت به نازلة ضرب نفسه، وهـٰذا مما نهى الله عنه، وجعله النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سببًا للتبرؤ، لكن ليس كل ضرب للوجه، أو ضرب لجزء من الجسم يكون ممنوعًا، فإن الله -جل وعلا- أخبر في كتابه عن امرأة إبراهيم فقال: ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾( ). لكن هـٰذا الصك من سارة --رَضِيَ اللهُ عَنْها- ليس على وجه التسخط والجزع، إنما هو على وجه التعجب، وما كان كذلك فإنه لا محظور فيه، فإن الإنسان قد يضرب نفسه إذا تعجب، لكن لا على وجه التسخط والجزع، ومنه ما جرى من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما قال لعلي بن أبي طالب وفاطمة: ((ألا تقومان؟ فقال علي -رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ-: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أمسكها، وإن شاء أرسلها)). فخرج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من عندهما يضرب على فخذه يقول: ﴿وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾( ). فهـٰذا الضرب ضرب تعجب واستغراب، وليس ضرب تسخط وجزع.
فقوله: ((ليس منا من ضرب الخدود)) أي: على وجه التسخط والجزع، وعدم الصبر على قدر الله -عز وجل-.
وهل هـٰذا خاص بالوجه؟
الجواب: لا، ليس خاصّاً بالوجه، فلو ضرب غير الوجه، غير الخد، ضرب الرأس، ضرب الكتف، ضرب الصدر، ضرب أي جزء من جسمه، فإنه يدخل في النهي، وإنما ذكرت الخدود لأن الغالب في من يصاب بمصيبة أن يضرب وجهه.
ومن هـٰذا نعلم خطأ الذين يضربون أنفسهم في ذكرى موت بعض الناس، فإن هـٰذا ممّا يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ليس منا من ضرب الخدود)).
قال: ((وشق الجيوب)). الجيوب: جمع جيب، والجيب: المخباة؟ الجيب هو: مدخل الرأس من الثوب، هـٰذا هو الجيب، المكان الذي يدخل منه رأسك في الثوب هو الجيب، وليس ما اصطلح عليه الناس من أن الجيب هو: محل حمل الأغراض، والذي يسمى: المخباة.
فشق الجيوب أيضًا هـٰذا من أعمال الجاهلية التي تبرأ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من فاعلها في قوله: ((ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب)).
وشق الجيوب فيه إظهار السخط على قدر الله، والجزع مما قضاه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم قال: ((ودعا بدعوى الجاهلية)) أي: صاح واعتزى وتعزى بعزاء الجاهلية، فإن هـٰذا من أعمال الجاهليين الذين تبرأ منهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . ويدخل في دعوى الجاهلية النياحة على الميت، الندبة، النعي، الدعاء بالويل والثبور عند الموت، أو عند نزول المصائب، كل هـٰذا يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ودعا بدعوى الجاهلية)).
قال بعض العلماء: دعوى الجاهلية هي العصبية، وهي أن يقول الإنسان لقبيلته: يا آل فلان، فيأتون ينصرونه مع أنه ظالم، لقبيلته، أو جماعته، أو من ينصره، فهـٰذا من دعاء الجاهلية، كلا هذين المعنيين يدخلان في قوله: ((ودعا بدعوى الجاهلية)). لكن أيهما أنسب؟ الأول، بدلالة الاقتران، حيث إن المذكورات في هـٰذا الحديث كلها مما يتعلق بالجزع والتسخط وعدم الصبر على أقدار الله: ((ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)).
هل فرق بين دعوى الجاهلية التي بمعنى العصبية- أن يدعو باسمٍ شريفٍ كالأسماء الشرعية التي أقرَّها الشرع- وبين أن يدعو باسمٍ من الأسماء التي لم يقرّها الشرع، أي: لم يأت بها الشرع؟ هل هناك فرق بينهما؟ يعني: هل هناك فرق بين أن يقول: يا للأنصار أو يا للمهاجرين، وبين أن يقول: يا للأوس ويا للخزرج؟
الجواب: لا فرق، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال -لما وقع نزاع بين المهاجري والأنصاري في غزوة بني المصطلق، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ--: ((أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!)). فجعل الدعوة إلى الأنصار والدعوة إلى المهاجرين من دعوى الجاهلية، مع أنهما اسمان شريفان رتب الله عليهما الفضل كما قال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ﴾( ) فهما من الأسماء الشريفة الممدوحة، لكن لما جاءا في سياق النعرات والعصبيات كانا من دعوى الجاهلية. فلا فرق في التحزُّب والتعصُّب بين أن يكون اسمًا شرعيّاً أو يكون اسمًا عاديّاً من أسماء النّاس، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جعل ذلك من دعوى الجاهلية، فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، العبرة بمقاصد الدّاعي لا باللفظ، فلو اعتزى إلى اسمٍ شريفٍ، اسمٍ محمودٍ، لكنه على وجه التعصّب فإنه مذموم.
ثم قال: (وعن أنسٍ أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إذا أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة)) -أو: ((حتى يوافيه به يوم القيامة.)) -)
هـٰذا الحديث فيه أن الله –جل وعلا– إذا أراد بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا. والمراد بالعقوبة أي: إصابته ببعض ما كسب كما قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾( ). فالمراد بالعقوبة المصائب التي تنتج عن المعاصي والسيئات؛ لأنه لا يمكن أن تُسمى المصائب التي لا فعل للإنسان فيها عقوبة، يعني: ما لم يكن من الإنسان تسبب فيه فإنه لا يسمى عقوبة إنما يسمى مصيبة، لكن المراد بالعقوبة هنا هو المؤاخذة بالذنب -أو بعضه- في الدنيا.
((إذا أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا)) يعني: قبل الموت، يُعجل له العقوبة في الدنيا قبل الموت بأن ينزل به من المصائب ما يحصل به تكفير الذنوب، وهـٰذا إذا صبر، أما إذا تسخط وضجر من هـٰذه المصيبة فإنه لا تُكفر بها خطاياه، بل تكون زيادة في الإثم والسوء.
قال بعد ذلك: ((وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه)) يعني:لم يؤاخذه بذنبه، بل أمهله، وأخر عقوبته.
قال: ((حتى يوافيه به)). أي: حتى يوافيه بذنبه، أو: ((حتى يوافى به يوم القيامة)) فيؤاخذه عليه، ويحاسبه عليه. وفي هـٰذا الحديث إثبات إرادة الله -عز وجل- للخير، ولا شك في ذلك، وإثبات إرادة الله -عز وجل- الشر، لكنَّ الشر الذي أضيف إلى الله -عز وجل- هنا ليس في فعله، إنما هو فيما يتعلق بالمخلوق، أما فيما يتعلق بفعل الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فلا شر فيه، كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والشر ليس إليك)). وغالب النصوص لا تضيف الشر إلى الله -عز وجل- صراحةً، إنما تأتي به على وجه عدم ذكر الفاعل، أو عدم ذكر من ينسب إليه.
ثم قال: (وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن عِظم الجزاء مع عِظم البلاء)) ). ((عِظم الجزاء)) أي: كثرته، والكثرة هنا في الكمية والكيفية، ليست فقط في الكمية، إن عظم الجزاء أي: كثرة الجزاء كمية وكيفية مع عظم البلاء كمية وكيفية، ويقرأ: ((إن عُظْم الجزاء مع عُظْم البلاء)) بضم الأول وتسكين الثاني.
ثم قال: ((وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم)) والابتلاء هنا يشمل المؤاخذة بالسيئات التي تقدمت منهم في الدنيا، ويشمل الابتلاء المبتدأ الذي لا فعل للإنسان فيه، معنى هـٰذا يشمل مؤاخذته على ذنبه، ويشمل ما يجريه الله -عز وجل- عليه من الابتلاء الذي يحصل به اختباره وامتحانه، ولو لم يكن منه فعل، ولو لم يكن منه تسبب، فإنه يدخل في قوله: ((إذا أحب قوماً ابتلاهم)) وأما الحديث السابق فإنه فقط فيما يتعلق بماذا؟ بالبلايا التي هي ناتجة عن المعاصي، عن فعل الإنسان.
البلايا التي تصيب الإنسان، وتنزل به دون فعلٍ منه ولا كسب، هل تكفر بها الخطايا؟
الجواب: نعم.
هل ترفع بها الدرجات؟
الجواب: نعم، ترفع بها الدرجات.
أما ما كان مترتبًا على فعل الإنسان فإنه لا ترفع به الدرجات، فقط تكفر به الخطايا، وهـٰذا الفرق بين النوعين.
يقول: ((فمن رضي فله الرضا)).
((له الرضا)). اللام هنا للاستحقاق، أي: إنه استحق الرضا من الله -عز وجل-.
((ومن سخط)) أي: كره ما نزل به من البلايا ((فله)) أي: استحق السخط، أي: فله كراهية الله -عز وجل- وبغضه حيث لم يرض بقضائه وقدره، حيث لم يرض بفعله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. ولاحظ في قوله: ((ومن سخط فله السخط)) عدَّى السخط باللام في قوله: ((فله السخط)). ولم يقل: فعليه السخط، وهـٰذا نظير قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾( ). هـٰذا نظير هـٰذا أو لا ؟ ما الذي هنا ؟ (له) لكن جاء في القرآن إضافة السوء باللام: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾( ). والمراد باللام هنا –أي: الاستحقاق- أنهم استحقوا الإساءة، واستحقوا السخط من رب العالمين.
والشاهد في هذين الحديثين بيان ما ينبغي للمؤمن عند نزول البلاء به، فإن فيهما تصبيره، وتنشيطه على الصبر؛ لأنه يعلم أنه إما أن تكفر به خطاياه، وإما أن ترفع به درجاته وتكفر خطاياه.
[المتن]
فيه مسائل
الأولى: تفسير آية التغابن.
[الشرح]
هـٰذه تقدّمت.
[المتن]
الثانية: أن هـٰذا من الإيمان بالله.
الثالثة: الطعن في النسب.
الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية.
[الشرح]
نعم هـٰذا كله واضح، تقدم الكلام عليه.
[المتن]
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير.
[الشرح]
نعم، وهي أن يعجل له العقوبة في الدنيا، ليس فقط التعجيل، التعجيل مع الصبر، يوفقه للصبر عليها.
[المتن]
السادسة: إرادة الله به الشر.
[الشرح]
هـٰذا واضح في الحديث، وهو أن يمسك عنه ذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة.
[المتن]
السابعة: علامة حب الله للعبد.
[الشرح]
يعني يبتليه، بأن يختبره، وأن يوفقه إلى الصبر والرضا بقضائه.
[المتن]
الثامنة: تحريم السخط.
[الشرح]
لقوله: ((من سخط فله السخط)).
[المتن]
التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء.
[الشرح]
وذلك في قوله: ((فمن رضي فله الرضا)) نسأل الله رضاه .
انتهت المسائل، وانتهى الباب.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الحادي والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في الرياء
وقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾( ).
عن أبي هريرة مرفوعًا: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.)) رواه مسلم.
وعن أبي سعيد مرفوعاً: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) قالوا: بلى! قال: ((الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي، فيزيّن صلاته؛ لما يرى من نظر رجل.)) رواه أحمد.
[الشرح]
قال المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في الرياء)
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد واضحة، إذ إن الرياء قدح في التوحيد ونقص فيه، وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأنه شرك كما في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)). قالوا: ما هو؟ قال: ((الرياء)). فالرياء شرك، والشرك ينافي التوحيد، ولذلك أتى به المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد؛ ليحذر منه، ويبين خطره، ووجوب التخلي منه.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن الرياء من أعمال القلوب؛ لأن من عمل القلب إخلاص العمل لله جل وعلا، وإخلاص العمل هو تصفيته من الشوائب، وتخليصه من الكدر، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مما ابتغي به وجه الله تعالى، فإذا دخله الرّياء خبا الإخلاص وذهب نوره، ولذلك أتى به المؤلف -رحمه الله- في جملة الأبواب التي يتكلم فيها عن الشرك المتعلق بعمل القلب.
فالباب السابق تكلم فيه المؤلف –رحمه الله– عن الصبر، والذي قبله عن الأمن من مكر الله، والذي قبله عن الخوف والتوكل، كل هـٰذه من أعمال القلوب، ومن جملة ذلك الإخلاص.
والقلب له قول وعمل، ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فالبحث الآن في أعمال القلوب، ولذلك أتى بما يتعلق بالرياء.
هـٰذا من حيث مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ومناسبة الباب للباب الذي قبله.
وأما معنى الرياء، فالرياء: مشتق من الرؤية، وهو فِعَال من (رأى يرى رؤية)، على وزن فِعَال، ومعناه: إظهار العمل ليراه الناس، هـٰذا من حيث اللغة، فهو إظهارٌ للعمل ليراه الناس.
ومن هـٰذا نفهم أن الرياء يقترن بالعمل، بخلاف العجب والمن، وغيرهـما مما يبطل العمل، فإنه قد لا يقترن بالعمل، يأتي بعده وقد يصاحبه، أما الرياء فإنه يقترن بالعمل، يلازم العمل، فإذا انقضى العمل انقضى الرياء.
أما من حيث معناه في كلام العلماء: فالعلماء لهم طرائق متعدّدة في تعريف الرياء. منهم من يوسِّع في معنى الرياء، فيدخل عمل العبادة لأجل الدنيا، وهـٰذا يشمل العمل لأجل المال، العمل لأجل الجاه، العمل لأجل المنصب، العمل لأجل الذكر، وهـٰذا معنًى واسع للرياء.
ومنهم من يضيِّق، ويجعل الرياء هو: إظهار العمل لحمد الناس، يعني: ليحصِّل حمدَ الناس وثناءَهم. ومقاصد الرياء تنحصر في أمور ثلاثة: حصول التعظيم ، وجلب مصلحة ، ودفع مضرة.
فهـٰذه المعاني الثلاثة إذا تأملت في مقاصد المرائين ترى أنها لا تخرج عن هـٰذه المقاصد الثلاثة: إما أن يعمل العمل ليراه الناس فيعظموه، أو يعمل العمل ليراه الناس ليجلب به منفعةً، أو يعمل العمل ليراه الناس ليدفع عنه مضرة.
وأما حكمه: فالرياء يختلف حكمه باختلاف نوعه، فالرياء أنواع وليس نوعًا واحدًا، وأنواعه باعتبار الشيء الذي يطرأ عليه الرياء، وسيأتي تفصيله بعد قليل.
نقرأ في كلام المؤلف -رحمه الله -ويقول: (وقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.)
هـٰذه الآية أتى بها المؤلف –رحمه الله– في أول الباب لبيان المطلوب من الخلق.
قال الله - جل وعلا - آمرًا رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقوله: ﴿قُلْ﴾ فأمره بتبليغ هـٰذا خاصة، ومعلوم أن الله – جل وعلا – أمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالبلاغ العام لكل ما أوحي إليه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، وهـٰذا يشمل كل ما أنزله الله على رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم جاء الأمر ببلاغ أمور خاصة، وهـٰذه الأمر ببلاغها وإظهار الأمر بإبلاغها لعظم شأنها وأثرها، من ذلك هـٰذه الآية: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾. ﴿إِنَّمَا﴾ هـٰذه أداة حصر، ﴿أَنَا﴾ يعني: محمداً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المتكلم بالقرآن تبليغًا من رب العالمين.
﴿بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ هـٰذا حصر، هل هو حصر إضافي أو حصر حقيقي؟ الحصر نوعان: منه ما هو حصرٌ حقيقي، ومنه ما هو حصر نسبي، هـٰذا حصر حقيقي؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سائر شؤونه لا يخرج عن كونه بشرًا، لكن في مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ﴾( ). الحصر هنا هل هو حقيقي أو إضافي؟ حصر إضافي؛ لأنه لا يختصر أحوال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في النذارة، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نذير وبشير وبشر، وله أوصاف كثيرة، فالحصر في وصف من أوصاف الشخص المتعددة يسمَّى حصرًا إضافيّاً نسبيّاً، وأما الحصر الذي تندرج تحته جميع أوصاف الشخص فهـٰذا حصرٌ حقيقي، ومنه هـٰذا: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ أي: فلا أستحق شيئاً من العبادة، وإنما أنا مبلغ ما أمرني الله – جل وعلا – بإبلاغه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ فبعد أن بيَّن ما ساوى به غيره من مقتضى البشرية ذكر ما امتاز به عن غيره فقال: ﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾. فالذي تميَّز به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الوحي الذي أمده الله به من السماء: ﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾ ثم ذكر ما يوحى إليه على وجه الخصوص: ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ وهـٰذا فيه بيان أصل ما أوحي إليه، موضوع ما أوحي إليه، وإلا فإنه أوحي إليه هـٰذا وأوحي إليه غيره، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أوحى إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قصص الأنبياء، والأمم المتقدمة، وما جرى من أخبار لتلك الأمم، وأوحى إليه ما يكون في المستقبل، أوحى إليه ما يقوم به معاش الناس، ويصلح به معادهم، لكن قوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ بيان لصلب ما أوحي إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وأساس وأصل ما أوحي إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.
﴿إِلَه﴾ إله على وزن فِعال، بمعنى مفعول، أي: مألوه، أي: مألوهكم معبودكم ﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ معبودٌ واحدٌ وهو الله جل وعلا، والإله هو من قُصِدَ بشيء من العبادة، فقوله: ﴿إِلَهُكُمْ﴾ أي: من تقصدونه بالعبادة هو معبودٌ واحدٌ، وهو الله جل وعلا: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.
ثم قال: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ يرجو: يخاف ويطمع، فالرجاء هنا يتضمن الطمع والخوف، كيف هـٰذا؟ كيف الرجاء يتضمن الطمع والخوف؟ لأنا ذكرنا لكم أنه لا يمكن أن يكون رجاءٌ صادقٌ إلا بخوف، ولا يمكن أن يكون خوفٌ صادقٌ إلا برجاء، ولذلك جاء في كلام السلف تفسير الرجاء في مثل هـٰذه الآيات، أو مثل هـٰذه السياقات بالخوف: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ هنا يخاف لقاء ربه، ويطمع في لقاء ربه، لكن أي لقاء؟ هل هو اللقاء العام؟ الجواب: لا، اللقاء الخاص؛ لأن اللقاء المذكور في كتاب الله -جل وعلا- لله سبحانه وتعالى نوعان:
نوع عام: يشمل كل أحد، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ﴾( ). وهـٰذا يشمل كل أحد، ولذلك ذكر أقسام الناس بعد ذلك، وأيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ﴾ هـٰذا خطاب عام لكل أحد، كل من اتصف بأنه إنسان فهو ملاقٍ ربه، لكنَّ اللقيا نوعان: لقيا يسعد بها الإنسان ويفرح، وتكون غاية أمنيته، ومنتهى طلبه، وهي لقيا المؤمنين المذكورة في هـٰذه الآية.
والثانية: لقيا التقريع والتوبيخ التي يكرهها الإنسان، وهي لقيا أهل الكفر، فإن الله –جل وعلا– يأتي بعبده الكافر ويقرره بنعمه: ((ألم أُسَوِّدْك؟ ألم أُرَبِّعْك؟ ألم أُزوجك؟)). كل هـٰذا يقوله الله –جل وعلا– للعبد فيقول: ((يا ربي بلى، بلى، بلى))، فيقول: ((أكنت تظن أنك ملاقي؟ يقول: لا)). وهـٰذا لا يكون إلا من الكافر. ((أكنت تظن)) أي: تعتقد، فالظن هنا بمعنى الاعتقاد ((أنك ملاقي؟ قال: لا، قال: اليوم أنساك كما نسيت)). فهـٰذا في حق الكفار، لا في حق أهل الإيمان.
فهـٰذه اللقيا لقيا لا يفرح بها صاحبها، بل هي عليه حسرة وندامة. أما أهل الإيمان فلقياهم لقيا فرح وسرور.
﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ يطمع في ذلك اللقاء الذي تحصل به غاية المسرَّات، ويظهر به الفوز، فليأخذ ما وجه إليه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾. فذكر لحصول اللقيا التي يُسَرُّ بها العبد عملين:
العمل الأول: أن يعمل عملاً صالحًا.
والثاني: ألا يشرك بعبادة ربه أحدًا.
وهـٰذان العملان هما عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة: أن يكون عمله صالحًا، ولا يكون صالحًا إلا إذا كان مُتَّبِعًا فيه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . وأن يكون عمله خالصًا لله جل وعلا. أما الصالح في قوله: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾ فذلك ما كان مقيدًا بالسنة، فما لم يقيد بالسنة فإنه ليس بصالح.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من أحدث في أمرنا هـٰذا ما ليس منه فهو رد)). البدع على جميع أصنافها وتنوعاتها وتشققاتها كلها داخلة في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أحدث في أمرنا هـٰذا ما ليس منه فهو رد)). فالبدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدًا، أبداً لا يمكن أن تقربه من الله، مهما تخيل أنها تقرب، وتلين القلب، وتصلح العمل لا يحصل ذلك مهما كان، بل تنقلب إلى أنها سبب للبعد عن الله -عز وجل- . فالعمل الصالح ما كان مقيدًا بالسنة مُتَّبَعًا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما الشرط الثاني: فهو إخلاص العمل لله جل وعلا، وذلك بأن يكون عمله مقصودًا فيه الله –جل وعلا–، لا يبتغي بعمله من الناس جزاءً ولا شكورًا، ولا يبتغي إلا مرضاة الله جل وعلا، ولذلك قال: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾. من أين أخذنا العموم؟ من قوله: (أحدًا)، حيث أتى بها وهي نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، كل شيء: لا يشرك في عمله، لا يشرك في قصده مع الله سبحانه وتعالى غيره ، بل يفرد القصد له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ومناسبة هـٰذه الآية للباب واضحة: ففيها بيان إخلاص العمل لله -عز وجل- ، وأنه إذا لم يكن الإخلاص لم ينفع العمل، ولم يحصل للإنسان النجاة.
ثم قال: (عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعًا: ((قال الله تعالى)) ). آية؟ قرآن؟ في أي سورة؟ ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك))؟ قدسي، ما معنى الحديث القدسي؟ الذي يخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربه، لماذا سمي قدسيّاً؟ لماذا ما سمي حديثاً إلهيّاً ؟ يسمى إلهيّاً، واضح؟ لأنه إذا قلنا: حديث إلهي واضح أنه ينسبه إلى الله -عز وجل-؛ لأن الحديث الإلهي يعني الحديث الذي تكلم به الله، هـٰذا من باب إضافة الشيء إلى فاعله، لكن قدسي؟ ويمكن أن يكون المقصود الحديث القدسي مأخوذ من القدس، وهو الطهور السالم من كل نقص، فإضافته إلى القدس إضافته إلى الله جل وعلا، يمكن أن يكون من (القدوس) مع أن النسبة إلى القدوس قدوسي لا قدسي، ويمكن أن يكون نسبة إلى الطريق الذي جاء به وهو جبريل روح القدس، يحتمل هـٰذا ويحتمل هـٰذا.
لكن في تعريف الحديث الإلهي -وهو أحسن من التعبير عنه بالحديث القدسي-ماذا نقول ؟ الحديث الإلهي هو الذي يخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربه، بالمعنى أو باللفظ؟ باللفظ والمعنى على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني: هو الحديث الذي يخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الله لفظًا ومعنًى، وهـٰذا هو المعنى الذي قرره شيخ الإسلام –رحمه الله–، وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص. من العلماء- وهو قول جمهور أهل العلم من المتقدمين وغيرهم، من أهل السنة وغيرهم-من يرى أن الحديث القدسي هو ما رواه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربه بمعناه دون لفظه، وإنما قالوا هـٰذا ليفرِّقوا بينه وبين القرآن، لكنَّ هـٰذا التفريق غير ظاهر، وقد قال شيخ الإسلام –رحمه الله– في تعريف الحديث الإلهي ما ذكرناه، من أن الأصل فيه أن اللفظ والمعنى من الله -عز وجل- .
كيف نفرق بينه وبين القرآن؟
نفرق بينه وبين القرآن: أن القرآن معجز في لفظه، بخلاف الحديث الإلهي، فليس في لفظه ما في القرآن من إعجاز.
القرآن تكفل الله بحفظه، بخلاف الحديث الإلهي، فإنه قد لا يدخل في الحفظ؛ لأن الله –جل وعلا– قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾( ).
الأصل في الحفظ يكون للقرآن، فإنه محفوظ بلفظه ومعناه، أما السنة، فإنه يحفظ معناها وقد لا يحفظ لفظها.
الثالث: أن الحديث الإلهي لا يُتعبد بقراءته، ولا تثبت له أحكام قراءة القرآن، من وجوب الطهارة الكبرى عند القراءة، أو الطهارة الصغرى عند المس، هـٰذا ما نفرق به بين القرآن وبين الحديث الإلهي.
قال الله تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)).
((أنا أغنى الشركاء عن الشرك)). هـٰذا فيه إخبار الله – جل وعلا – عن نفسه بكمال الغنى، فإنه-سبحانه وتعالى- لا يقبل الشركة في عمل، ولذلك قال: ((أنا أغنى الشركاء)) يعني: فيما اشتركوا فيه ((عن الشرك)) فليس لله –جل وعلا– حاجة في عملٍ يُشرك معه غيره، لماذا؟ لأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الغني الحميد، كل شيء مفتقرٌ إليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يشرك معه غيره في قصدٍ، ولذلك إذا وقعت الشركة في عمل ترك الله العمل للشركاء، وهـٰذا من واسع غناه، وعظيم صفاته سبحانه وبحمده.
((من عمل عملاً)) هـٰذا بيان لمثال من الأمثلة التي يحصل فيها الاستغناء عن الشركاء ((من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)) وهـٰذا فيه أن الله -عز وجل- لا ينظر إلى العمل إذا وقع فيه الشرك؛ لأن الترك طرح وإعراض، ومن تركه الله وطرحه وأعرض عنه فإنه لا خير في عمله ولا قبول له.
الشاهد في هـٰذا الحديث قوله: ((تركته وشركه)) فإن فيه بيان أن الشرك سبب لحبوط العمل، فإن الترك يقتضي الإبطال وعدم القبول، فما هو الرياء الذي يبطل العمل؟ وإن كان الحديث يشمل الرياء وغيره؛ لأن الشركاء قد يشتركون في القصد وتختلف المقاصد، قد يشرك الإنسان في العمل غير الله يريد بذلك حظّاً دانيًا من أجرة أو مال، هـٰذا أشرك أو ما أشرك مع الله غيره؟ أشرك مع الله غيره. من يريد الثناء والذكر أشرك مع الله غيره أو لا؟ من يريد بعمله الانتصار لقبيلته والانتصار لحزبه فهو أيضًا وقع في الشرك؛ لأنه أشرك مع الله غيره في هـٰذا العمل، فالمشرك به مختلف، لكنه مختلف من حيث القصد، لكنه يتفق من حيث النتيجة، وهو أن الجميع مطروح لا ينظر الله –جل وعلا– إليه: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) ويدخل في هـٰذا الرياء، أما ما عدا الرياء فسنتكلم عليه في الباب الذي قال فيه المؤلف –رحمه الله–: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، لكنَّ ما يهمنا في هـٰذا الباب مما يتعلق بهـٰذا الحديث: الرياء، فهل كل رياء يبطل العمل؟
الجواب: أن في ذلك تفصيلاً:
فمن الرياء ما يحصل به إبطال العمل:
أولاً- إذا كان الإنسان لم يعمل العمل إلا لطلب مدح الناس وثنائهم ليروه، يجذب بذلك مدحهم ويدفع ذمّهم، فهـٰذا عمله باطل، ولا ينفعه أن يصحح النية في أثناء العمل.
مثال ذلك: شخص افتتح الصلاة يريد ثناء الناس وذكرهم، هـٰذا مراءٍ أو لا؟ مراءٍ ، ما قصد عبادة الله –جل وعلا– بهـٰذه الصلاة، هـٰذا عمله حابط بإجماع أهل العلم، لو أصلح النية في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة قرأ قول الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (01) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (02) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (03) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (04) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (05) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (06) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾( ) فوعظته هـٰذه الآية وترك الرياء هل يستمر في العمل؟
الجواب: لا، لا يستمر في العمل؛ لأن العمل في أصله لم يكن لله، بل يجب عليه أن يترك العمل، وأن يستأنفه من جديد إذا أراده بنية صالحة، هـٰذا النوع من الرياء يحبط العمل.
النوع الثاني من الرياء: ما يطرأ على العمل بعد صحة القصد.
شخص افتتح صلاته رغبةً فيما عند الله جل وعلا، وطلبًا لمرضاته، وفي أثناء الصلاة هجم عليه وسواس أدخل إليه الرياء، رياءً مستقرّاً، يعني: أصبح يقصد ثناء الناس ومدحهم، فهل هـٰذا يبطل العبادة؟
الجواب: نعم يبطل العبادة إذا كان رياءً مستقرّاً لا عارضًا، فإذا طرأ الرياء في أثناء العمل لا يخلو العمل من حالين:
الحال الأولى: أن يكون العمل مما يبنى آخره على أوله، كالصلاة في المثال الذي ذكرناه، فهنا لا ينفعه هـٰذا العمل، وعمله كله باطل حابط؛ لاقترانه بالرياء، وفوات شرط الإخلاص.
القسم الثاني من العمل: أن يكون مما لا يبنى بعضه على بعض، بل هو مستقل، كالذي معه ألف ريال، ويمشي، ويعطي هـٰذا عشرة، وهـٰذا خمسة، وهـٰذا مائة، وهـٰذا خمسين، ففي أثناء إعطائه أعطى شخصاً بقصد مدح الناس وثنائهم، فهل تبطل صدقته المتقدمة؟ لا.
هل يمكن أن يصحح الصدقة القادمة؟
الجواب: نعم، يمكن بأن يصحح النية، ويقصد بعمله الله جل وعلا.
إذًا: هـٰذا النوع من الرياء لا يبطل العمل كله، إنما يبطل العمل المقارن، وهو ما كان آخره لا ينبني على أوله.
القسم الثالث من الرياء: أن يطرأ الرياء في صفة العمل لا في ذاته، وهو ما ذكره النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث أبي سعيد، نقرأ الحديث: (وعن أبي سعيد مرفوعًا: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) قالوا: بلى. قال: ((الشرك الخفي)) ). ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مبينًا الشرك: ((يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل)). يعني: لما يرى من أن أحدًا يرقبه وينظر إليه، فهـٰذا طرأ الرياء على أصل العبادة أو على صفتها؟
الظاهر أنه طرأ الرياء على صفة العبادة، ففي هـٰذه الحال لا يبطل العمل، إنما يذهب أجر الصفة، فإذا افتتح الإنسان الصلاة مخلصًا لله، يبتغي وجه الله، لكن في أثناء الصلاة شعر بدخول أحد، فبدل أن يقول: سبحان الله ثلاث مرات في سجوده وركوعه بدأ يقول عشراً، فهل عبادته باطلة؟
الجواب: لا، لكن الذي يبطل هو هـٰذا القدر الزائد الذي لم يلاحظ فيه الإخلاص، إنما أشرك مع الله غيره. وهـٰذا القول اختاره ابن القيم –رحمه الله– وجماعة من أهل العلم أن الإبطال إذا كان الرياء واردًا على الصفة، ليس لكل العمل، بل للصفة التي جرى فيها التحسين والتزيين والرياء، وهو اختيار شيخنا محمد –رحمه الله– لما سألته.
القسم الرابع من الرياء: وهو أن يكون الإنسان قاصدًا بعمله الله جل وعلا، يعني: هو يبتغي ما عند الله، لا يريد الناس بل يريد الله –جل وعلا– بعمله، ومع ذلك يحب ثناء الناس وذكرهم، هـٰذا خلاف القسم الأول، القسم الأول ما حاله؟ ذاك لا يريد إلا ثناء الناس، هـٰذا القسم اختلف العلماء فيه على قولين:
منهم من قال: إن هـٰذا الرياء يبطل العمل؛ لأنه لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه، وهـٰذا -فيما أذكر- قول أبي جعفر الطبري.
وقال جماعة من العلماء: إن الذي يبطل هو القصد السيئ، يعني: أجر القصد السيئ، وأما أصل العمل فإنه مما ابتغي به وجه الله فيثبت له الأجر. وهـٰذا ما ذكره الغزالي في الإحياء، لكن الظاهر من النصوص أن العمل يبطل؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سئل عن المقاتل يقاتل: أي ذلك في سبيل الله؟ فسئل -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المقاتل يقاتل حميةً، وسئل عن المقاتل يقاتل شجاعة، وسئل عن المقاتل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله))، فدل ذلك على أنه ما عدا ذلك فليس في سبيل الله.
ويدل لهـٰذا أيضًا حديث أبي أمامة في مسند الإمام أحمد بسند جيد، وهو قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، وابتغي به وجهه)). فذكر وصفين لعمل واحد، وهما: الخلوص من الشركة، وأن يكون ذلك مما ابتغي به وجه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لم يقصد به غيره.
وهـٰذا يدل على أن الإنسان إذا بدأ العمل ملاحظًا الناس فإنه ليس له من عمله نصيب، وهو ما يدل عليه أو ما يدل له حديث أبي هريرة الذي معنا: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)).
هـٰذا في القسم الرابع من أقسام الرياء.
القسم الخامس: أن يرد الرياء لا على وجه الاستقرار، يرد هاجس الرياء لا على وجه الاستقرار، يعني: وهو يصلي يأتيه وارد يقول له: راءِ ، أو حسِّن صلاتك حتى يقول الناس لك خيرًا، ويمدحوك خيرًا، ويثنوا عليك خيرًا. فهـٰذا ما دام في المدافعة فهو على خير، له أجر المدافعة، ولعل أجر المدافعة يذهب أجر الاختلاط، بخلاف من استقر قلبه وركن إلى الرياء، فإنه يلحق بالقسم الرابع.
قال: (وعن أبي سعيد مرفوعاً: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)). قالوا: بلى. قال: ((الشرك الخفي)).)
هـٰذا فيه بيان عِظَم الشرك الخفي، وأنه ينبغي أن يُحذر منه غاية الحذر؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خافه على خيار أمته، خافه على صحابته رضي الله عنهم.
قوله: ((ألا)) هـٰذا استفتاح، فـ ((ألا)) أداة استفتاح وتنبيه.
((أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) والمسيح الدجال هو شر غائب ينتظر كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وفتنته أعظم الفتن، ولذلك ما من نبي وإلا وحذر أمته المسيح الدجال، ولكن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيَّن أمره، وجلاّه غاية التجلية لكونه آخر الرسل -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(قالوا: بلى. قال: ((الشرك الخفي)).) فوصفه بأنه خفي، وذلك أنه لا يظهر للناظر، فإن من ينظر إلى العامل يعجبه عمله، ويقول: هـٰذا من العُبَّاد الصالحين؛ لأنه قد شابه أولياء الله في مظهره، فهو إما في عبادة صلاة، أو حج، أو صيام، أو غير ذلك من العبادات، فالظاهر واحد، ولكنه عطَّل عمل الباطن، حيث جعل لغير الله -عز وجل- نصيبًا في هـٰذا العمل، فعمله ليس لله عز وجل، بل عمله لغير الله.
فقوله: ((الشرك الخفي)). خفيٌُّ من حيث ظهوره للناس، وهو خفيٌّ أيضًا من حيث إنه قد يخفى على الإنسان، حيث إنه لا يتنبه له إلا بعد أن يتمادى، فينبغي لطالب العلم، ولكل مسلم أن يحذر هـٰذا النوع من الشرك، وقد سمَّاه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما رواه ابن حبان في صحيحه بـ ((شرك السرائر))، وذلك أنه شرك خفي لا يظهر، ثم بيَّن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذا الشرك بمثال، والبيان بالمثال من أسهل وسائل البيان، وأقربها لفهم السامع، وذلك أن المعاني الغائبة تظهر، وتتجلى، وتبين للسامع إذا بُيِّنَت بالمثال المشاهد الذي يدركه الإنسان بنظره وبعقله، فهو أمر مُدرك قريب، بخلاف التعريف بالحد، فإن الحد فيه نوع صعوبة لا يدرك المعنى به كل أحد، ولذلك بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الشرك هنا بصورة من صوره، وبمثال من أمثلته، حتى يتبين ويدركه المتعلم وغير المتعلم، الفقيه وغير الفقيه، صاحب المعاني وغيره.
يقول: ((يقوم الرجل فيصلي)) والصلاة هي أشرف العبادات، ويشمل الصلاة المفروضة والصلاة المستحبة، لكن فيما يظهر أنها صلاةٌ مستحبةٌ، أي: إنها صلاة نافلة، وليست صلاةً مفروضةً.
يقول: ((فيزيّن صلاته)) أي: يحسنها ويجملها، وذلك بتكميل شروطها وواجباتها، وسننها ومستحباتها.
((لما يرى)) هـٰذا بيان السبب، والعلة في هـٰذا التزيين، قال: ((لما يرى من نظر رجل)) و((يرى)) هنا بمعنى: يعلم، ولا يلزم أن تكون الرؤية رؤية بصر؛ لأنه قد يكون خلفه، أو مختفيًا عليه، لكن المقصود ((لما يرى)) أن عمله في نظر الناس، وأن الناس يلاحظون ما يكون منه من عمل، فهـٰذا معنى قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لما يرى من نظر رجل)).
ثم قال في بيان من روى الحديث: (رواه أحمد). والحديث تكلم العلماء فيه من جهة ثبوته كلامًا بيِّناً، وأكثرهم على تضعيفه، إلاّ أن الرِّواية التي فيها ذكر ((شرك السرائر)) وهي موافقة لهـٰذا الحديث في المعنى تعضد هـٰذا الحديث، وترتقي به إلى درجة الحسن، فالحديث من حيث المعنى -لا سيما في جزئه الأخير- ثابت؛ لوروده من عدة طرق، أما صدره وهو قوله: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) فإنه لم يرد من طرقٍ يُعْتد بها، والمقصود أن الحديث فيه التحذير من شرك السرائر، والشرك الخفي وهو: الرياء. ثم السؤال هنا: هل الحديث الرياء فيه طارئ على أصل العمل، أم على صفته؟ يحتمل أن يكون الرياء واردًا على صفة العمل: ((يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته)) فالرياء طرأ على صفة العمل، حيث قال: ((فيزين صلاته)) ويحتمل أن الرياء واردٌ على أصل العمل؛ لأنه ما قام إلا لأجل نظر الرجل، فالعمل من أصله فيه قصد غير الله، ووصفه أيضًا فيه قصد غير الله، فيحتمل هـٰذا، ويحتمل هـٰذا، يعني: يحتمل أن يكون العمل من أصله لم يُقصد به الله جل وعلا، ويحتمل أن يكون العمل مقصودًا به الله عزّ وجل، لكن ورد عليه الرياء في صفة العمل حيث زيَّن الصلاة لما يرى من نظر رجلٍ إليه.
وبهـٰذا يكون قد انتهى الباب، وقد عَلِمنا أقسام الرِّياء، وأثرها في صحة العمل، ذكرنا في ذلك خمسة أقسام.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية الكهف.
[الشرح]
الآية التي صدَّر بها المؤلف -رحمه الله- الباب في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ والشاهد فيها في قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾.
طالب العلم في مثل هـٰذه الآيات ينبغي له أن يحفظ الآية كاملة؛ لأنه قد يكون الشاهد ما جاء، مثل هـٰذه الآية، الشاهد لم يذكره المؤلف رحمه الله.
[المتن]
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
[الشرح]
وهـٰذا في حديث أبي هريرة: ((أنا أغنى الشّركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)).
[المتن]
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى.
[الشرح]
ذلك المشار إليه ما هو؟ قوله: (لذلك) الرد، المشار إليه: (الرد) ذكر السبب المُوجب للرد، وذلك كمال غنى الرب جل وعلا، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: قال الله تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك)) فلكمال غناه لا يقبل الشركة في العمل، وهـٰذا يدل على أن ما يجب لله ليس كما يجب لغيره، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ليس كمثله شيء في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في ما يجب له، وهـٰذا قَلَّ من يذكره داخـلاً في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾( ) نبَّه عليه كثيرًا شيخ الإسلام -رحمه الله- وابن القيم أن الله -جل وعلا- ليس كمثله شيء حتى فيما يجب له، وذلك أن ما يجب له من الحقوق لا يقبل فيه الشركة، وغيره يقبل الشركة.
[المتن]
الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
[الشرح]
وذلك لتركه العمل لمن قُصِد معه في قوله: ((من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)). وفي رواية: ((تركته للذي أشرك)).
[المتن]
الخامسة: خوف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أصحابه من الرياء.
[الشرح]
هـٰذا من قوله: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)). وفي قوله أيضًا في الحديث الذي جاء فيه تصريح الرياء ذكرناه لكم الدرس السابق حديث محمود بن لبيد: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو؟ قال: الرّياء)).
[المتن]
السادسة: أنه فسَّر ذلك بأن المرء يصلِّي لله، لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه
[الشرح]
(فسر ذلك) أي: فسَّر الشرك الخفي بهـٰذا العمل، وهو تفسير بالمثال كما ذكرنا، فمن زكى فهو كذلك، من حج كذلك، بل كل من عمل عملاً صالحًا كذلك، لكن من حيث البطلان، أي: من حيث بطلان العمل يختلف باختلاف العمل، فمنه ما يبطل، ومنه ما لا يبطل، إنما يبطل الجزء المقارن للرياء.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
وقول الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾( ).
وقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السّاقة كان في السّاقة، إن استأذن لم يُؤذن له، وإن شفع لم يُشفّع)).
[الشرح]
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد كالباب الذي قبله: فإنّ إرادة الإنسان بعمله الدنيا نقص في التوحيد، وقصور فيه، وقد يبطله ويذهبه، فالذين أسلموا من المنافقين لعصمة دمائهم وأموالهم هؤلاء أرادوا بعملهم الدنيا، أرادوا حفظ الأموال، وعصمة الدماء، فليس لهم في الآخرة من خلاق: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾( ). فإرادة الإنسان بعمله الدنيا إما أن تُزيل التوحيد، وإما أن تنقصه، ولذلك ذكره المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد.
أما مناسبة هـٰذا الباب لما قبله: فإنه في الباب السابق ذكر شيئًا مما يقصده العاملون في أعمالهم العبادية، وهو مدح الناس وثناؤهم، ورؤيتهم لأعمالهم الصالحة، وهنا ذكر ما هو أوسع من ذلك وأعم، فإنَّ الإنسان قد يعمل العمل ولا يلاحظ ثناء الناس ونظرهم، بل يعمل العمل لأمر دنيوي غير هـٰذا، فقوله رحمه الله: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) يعني: فيما عدا الرياء؛ لأنَّ الرياء تَقَدم، كأن يقصد بالعمل التكسب وأكل المال، أو حفظ النفس، أو حفظ المال، أو ما أشبه ذلك من المقاصد الدنيوية، فإن هـٰذا إما أن يُذهب التوحيد، وإما أن ينقص به التوحيد كما سيأتي من تفصيل.
قال رحمه الله: (من الشرك) ولم يبيِّن -رحمه الله- درجة الشرك، هل هو الشرك الأكبر، أو الشرك الأصغر؟ وذلك لاختلاف حكمه، فمنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، منه ما يبطل العمل كله، ولا يبقى مع الإنسان شيء، ومنه ما هو دون ذلك.
وقوله: (بعمله) المقصود بالعمل هنا العمل الذي الأصل فيه مرضاة الله -جل وعلا-، يعني: العمل العبادي، وليس المقصود كل عمل؛ لأنّ من الأعمال ما يعمله الإنسان ويقصد به الدنيا، لا يقصد به غيرها، ولا يكون بذلك ناقصًا في توحيده، ولا واقعًا في محظور. فقوله: (بعمله) أي: بعمله العبادي الذي الأصل فيه طلب مرضاة الله جلّ وعلا.
وقوله: (الدنيا) المقصود به: منافعها ومصالحها، وما يكون فيها من عاجل الثّواب، ثم بيَّن -رحمه الله- حكم ذلك بآية وحديث فقال: (وقولِ الله تعالى) هكذا عندي، فيكون على هـٰذا الواو عاطفة على الترجمة: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) و(باب قول الله). وأحسن من هـٰذا أن تكون على الاستئناف، فيكون: (وقولُ الله تعالى).
ذكر في هـٰذا الباب قول الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
فذكر الله -جل وعلا- عمل هؤلاء، وما ترتب على عملهم من الجزاء، فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ من كان يريد بعمله، وجهده، وسعيه، وكدِّه، وذهابه، ومجيئه ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ أي: من كان يقصد الحياة الدنيا بعمله، ويقصد زينتها ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ أي: نُكَمِّل لهم ما قصدوه ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ﴾ فذكر التوفية، وذكر عدم النقص، مع أن أحد الأمرين يغني عن الآخر، لكنه ذكرهما لبيان اكتمال ماذا ؟ العطاء لهم في الدنيا في سعيهم وعملهم ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾.
قوله: ﴿نُوَفِّ﴾ هـٰذا جواب الشرط ﴿أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ﴾ هـٰذا حال، حال من الفاعل، أو حال من المفعول، حال كونهم غير مبخوسين في هـٰذه التوفية.
﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ﴾ ثم ذكر جزاءهم، بعد أن ذكر جزاءهم في الدنيا ذكر جزاءهم في الآخرة، فقال: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾ فليس لهم فيها غيرها، وهـٰذا معنى قوله تعالى فيمن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة: ﴿وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾( ) أي: ليس لهم في الآخرة من نصيب، ليس لهم إلا النار.
﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ أي: في الدنيا مما تُرجى عاقبته وثمرته في الآخرة؛ لأنهم وُفُّوا عليه، وحصلوا ما قصدوه في الدنيا.
﴿وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ باطل: أي لاغٍ، لا فائدة فيه، فالباطل هو ما لا فائدة فيه، ولا نفع لصاحبه فيه.
﴿وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: إن ما عملوه مما له عاقبة حميدة في الآخرة يذهب نفعه، وتتعطل عائدته، فلا يُحَصِّلون شيئاً ﴿وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. وهـٰذا كله بيان لسوء حال هـٰذا الصنف من الناس، هـٰذه الآية ذكرت من كان لا يعمل إلا للدنيا، وبيَّنت جزاءه. وقد أشكلت هـٰذه الآية على جماعة من العلماء حيث قالوا: إن إرادة الدنيا بالعمل تحصل من أهل الإسلام، ومع ذلك لا يترتب لهم ما ذكره الله -جل وعلا- في هـٰذه الآية من العقوبة، حيث قال جل وعلا: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. فحملوا الآية على أهل الكفر، فقالوا: المراد بهـٰذه الآية أهل الشرك، وهـٰذا قول ابن عباس في المشهور، وجماعة من المفسِّرين.
والقول الثاني: أن هـٰذه الآية في أهل الكفر، وأهل القبلة، أي: إن لأهل القبلة منها نصيباً، فلا تختص الكفار، بل لأهل القبلة منها نصيب، والمقصود بأهل القبلة أهل الإسلام، وهؤلاء أجابوا على ما في قوله تعالى: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾: أنّ الآية كالآيات الأخرى التي جاءت في الكتاب من الإخبار بأنه من أراد الحياة الدنيا، فإنه لا يُحَصِّل إلا نعيم الدنيا إن حَصَلت له، وأما الآخرة فليس له فيها شيء، كقوله تعالى في سورة الشورى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾( ). وكآية سورة الإسراء: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً﴾ ( ) .
هـٰذه الآيات الثلاث ذكر الله -جل وعلا- فيها مقاصد الناس، والآيات كلها تنتظم في معنًى واحد ويُفسر بعضها بعضًا، فإنها بيَّنت أنَّ الناس في مقاصدهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يقصد الدنيا، وقسم يقصد الآخرة، فآية الشورى وآية الإسراء ذكرتا القسمين، أليس كذلك؟ من كان يريد حرث الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد العاجلة، ومن كان يريد الآخرة، في سورة الإسراء، فذكر القسمين، أما في سورة هود فذكر قسمًا واحدًا، ولم يذكر القسمين حيث قال: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾( ) هـٰذا نظير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾. فهـٰذا القسم يقابل ذلك القسم، ويقابل أيضًا القسم الأول الذي ذكره الله في سورة الإسراء: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً﴾. وإذا نظرت وجدت أن آية الإسراء وآية الشورى قسمتا الناس إلى قسمين، أما آية هود فلم تذكر إلا قسمًا واحدًا.
فالجواب: أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذكر في هـٰذه الآيات الثلاث مقاصد الناس، وذكر انقسامهم إلى قسمين كسائر شأن القرآن في ذكر الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالله -جل وعلا- إذا ذكر أقسام الناس في غالب القرآن يذكر أهل الإيمان وما أعدّ لهم، وأهل الكفر وما أعد لهم، ثم يسكت النص عن قسمٍ ثالثٍ، وهو من خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا، فهل يدخل في الآيات التي فيها الوعيد، أو يدخل في الآيات التي فيها البشارة والنعيم؟
الجواب: أن القسم الثالث له من النعيم بقدر ما معه من صحة القَصد وصفات أهل الإيمان، وله من العقوبة وما أعدَّه الله لأهل الكفر بقدر ما معه من شعب الكفر وخِصاله، وهـٰذا يحل إشكال في كثير من الآيات. ومن هـٰذا نأخذ أن هـٰذه الآية ذكرت أهل الكفر على وجه الاستقلال، لكن من كان من أهل الإيمان قد عمل عملاً يريد به الدنيا، فإن له نصيبًا من هـٰذه الآية، فيكون العمل الذي قارن إرادة الدنيا باطلاً حابطاً يعاقب عليه الإنسان بالنار، فإذا كان معه أصل الإيمان ثم عمل عملاً أراد به الدنيا هل نقول: هو داخل في قوله: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؟
الجواب: نقول: له من هـٰذا الوعيد بقدر ما معه من العمل، أصل الإيمان الذي معه، هل هو مما أراد به الناس ؟ أراد به الدنيا؟ أسألكم: المؤمن الذي آمن بالله، لكن خلَّط في عملٍ معينٍ في دراسته مثلاً، في طلبه للعلم خَلَّط، وأراد المناصب، وأراد الإمامة، وأراد شيئًا من الدنيا، هل هـٰذا مهدد بقوله تعالى، أو داخلٌ في قوله: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في كل عمله، أم في عمله هـٰذا الذي جرى فيه التخليط؟
إذًا: هو مهدد بما في هـٰذه الآية من الوعيد في العمل الذي جرى فيه التشريك، وجرى فيه التخليط، وإرادة الدنيا، أما ما كان خالصًا لله، وهو أصل الإيمان فإنه لا يحبط ولا يبطل، وليس مهددًا بالنار عليه؛ لأنه قد أتى بالأصل، ولا تعجب، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قد ذكر في الصحابة إرادة الدنيا، قال الله جل وعلا: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾( ) هـٰذا في أي شيء؟ في غزوة أحد، وهي في الذين نزلوا من الجبل من الرماة، مع أنهم من خير أهل الإسلام، لكن حصل عندهم إرادة الدنيا، يقول ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ما شعرت أن أحدًا من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يريد الدنيا حتى جاء يوم أحد، ونزلت هـٰذه الآية. فالمقصود أن الذين جرى منهم ما جرى، هل هم داخلون في قوله: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؟ الجواب: لا؛ لأن هـٰذا في حق الكفار، لكن كل من خَلَّط فله من هـٰذه الآية نصيب إذا لم يعفُ الله -جل وعلا- عنه ويصفح.
إذًا: عرفنا أنّ الصحيح في هـٰذه الآية أنها ليست خاصة بأهل الكفر، بل هي كسائر الآيات التي يذكر الله – جل وعلا-فيها الوعيد لأهل الكفر على وجه الكمال، فمن شابههم في شيء من الخصال نال شيئًا من العقاب مناسبًا لما معه من خصال وشعب الكفر، الكلام واضح أو غير واضح ؟
ومن هـٰذا نستفيد هـٰذه الفائدة في كثير من الآيات التي يذكر الله – جل وعلا- فيها انقسام الناس إلى قسمين دون ذكر القسم المُخَلِّط الذي فيه من هـٰذا وفيه من هـٰذا.
ثم قال: (في الصحيح عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة)).) ذكر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أربعة أوصاف، وأخبر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بتَعَسِهم، فقوله: ((تعس)) خبر ودعاء، فهو خبر عن شقائهم، ونحسهم، وسوء حالهم، وعملهم. ودعاءٌ عليهم بالتعاسة والشقاء، فقوله: ((تعس)) خبرٌ ودعاءٌ.
وقوله: ((عبد الدينار)) هل هـٰذا دعاءٌ على معين، أو على موصوف؟
هـٰذا دعاء على موصوف؛ لأنّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دعا في هـٰذا الحديث، وأخبر في هـٰذا الحديث عمّن اتصف بهـٰذا الوصف، وهو ((عبد الدينار)) والدينار هو: العملة من الذهب، و((الدرهم)) هو: العملة من الفضة، و((الخميصة)) هي ما يُجلس عليه، و((الخميلة)) هي ما يرتدى من أرخص الثياب.
أخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن العبودية تقع لهـٰذه الأشياء، فقال: ((تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة)) وكل هـٰذه المذكورات من أمور الدنيا، وأثبت فيها عبوديته، ومن هـٰذا نعلم أن الشرك يقع في عبادة الأوثان، ويقع في عبادة الأثمان كالذهب والفضة وما يشبه الذهب والفضة، فكل هـٰذا من العبودية لغير الله عز وجل، وإن كانت العبودية متفاوتة، فمنها ما يخرج به الإنسان عن حيِّز الإسلام، ومنها ما يكون باقيًا معه في دائرة أهل الإسلام.
يقول: ((تعس عبد الدينار)) وأضاف العبودية للدينار لأن القلب قد تعلَّق به وانصرف إليه، فإن العبودية في هـٰذه الأشياء الأربعة: (الدينار، والدرهم، والخميصة، والخميلة) إما لكونه تعلَّق بها حبّاً، فأصبحت هي همَّه الشاغل، وهي التي من أجلها يقوم، ومن أجلها يقعد، وهي التي بها يمنع وبها يعطي، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط)) فهـٰذا بيان لوجه العبودية، وهو تمام التعلُّق في الرضا والمحبة والسخط والغضب والمنع والإعطاء، كله من أجل هـٰذه الأمور، وما كان كذلك فقد وقع في أي شيء؟ في نوعٍ من العبودية لهـٰذه الأشياء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله، وأن تبغض في الله، وأن تعطي لله، وأن تمنع لله)). فالعطاء والمنع إذا كان لأجل غير الله فهو نوع تعلُّقٍ عبادي لا يجوز، ولذلك وصف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المتعلق بغير الله على هـٰذا الوجه بأنه عبد، وهـٰذه العبودية لا تخرج الإنسان عن الإسلام، إنما هي قدحٌ في التوحيد وكماله، لكن إن كان الإنسان لا ينظر إلا إلى الدرهم والدينار والخميصة والخميلة نظرًا واحدًا، ليس له نظر إلى مرضاة الله جل وعلا، ولا إلى أمره ونهيه، فهنا تكون هـٰذه عبادة مخرجة عن الملة، لكن هـٰذه العبودية المذكورة في الحديث لا يلزم منها الخروج عن الإسلام، فقد تكون في بعض أهل الإسلام، فيتعلَّق بالدرهم والدينار، ويتعلق بالخميصة والخميلة حتى يُوصف بأنه عبدٌ لها.
ومن أوجه العبودية لهـٰذه الأشياء أن يعتقد الإنسان النفع والضر فيها ومن قِبلها، ويقطع تعلُّقه بالله جل وعلا، هـٰذا الوجه الثاني من أوجُه إضافة عبودية الشخص إلى هـٰذه الأشياء أنه قطع التعلُّق بالله عز وجل، فأصبحت هـٰذه الأشياء هي مستعانه، يعني: هي التي بها يستعين، وهي التي يرقُبُ الخير منها، وهي التي يظن أنها تجلب له النفع، وتدفع عنه الضُّر، هـٰذان وجهان يصدُق بهما وصف الشخص بأنه عبد للدرهم والدينار والخميلة والخميصة.
الدرهم والدينار هما الأثمان، والخميصة والخميلة هما من أنواع المتاع؛ الخميصة ما يُجلس عليه، والخميلة ما يُرتدى وهي من أقل أنواع الألبسة، وإنما ذكرت مع أنها من أنواع اللباس المتدني تنبيهًا على ما هو أعلى، فذكر دني يشير إلى ما هو أعلى منه.
قال: ((إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط)) يعني: إن أعطي من هـٰذه الأشياء رضي، وانشرح صدره، وحصل فرحه، وحصل له محبوبه، وإن لم يعط –أي من هـٰذه الأمور- سخط، فكان حبه وبغضه، رضاه وسخطه مُعلقًًا بأي شيء؟ بهـٰذه الأمور، لا بأمر الله جل وعلا، لا بما يحبه الله ويرضاه، وما يبغضه ويكرهه، ولا شك أن هـٰذا ثلمٌ في التوحيد، وعتبةٌ من عتبات الشرك، ونوعٌ من العبودية لهـٰذه الأشياء، قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تعس وانتكس))، ((تعس)): هـٰذا فيه إعادة الدعاء على هـٰذا الشخص، وهو توكيد لفظي، فبعد أن ذكر التعس في حق كل واحد من هؤلاء، عاد بذكر التعس على وجه الإجمال فيهم جميعاً.
((تعس وانتكس)) ومعنى ((انتكس)) أي: إنه لم يخرج من الشر، أو: إنه اشتغل بما أصابه من الشقاء حتى إنه لا يسلم من الوقوع في الشر مرةً ثانيةً، والمراد أنه تردّت حاله، فهو دعاء عليه باتصال الشر ودوامه، وعدم التمكن من الخروج منه، هـٰذا معنى قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((وانتكس)) وهـٰذا دعاءٌ وخبرٌ كقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تعس)).
ثم قال: ((وإذا شيك)) أي: إذا أصابته شوكة، ((فلا انتقش)) أي: لم يتمكن من إخراج الشوكة، ولا شك أن من أُصيب بالشوكة وعجز عن إخراجها حُصِر؛ لأنه لا يتمكن من السعي، ولو سعى لكان سعيه غير قوي، بل سعيه إلى الضعف، وإلى التَّعَسُّر قريب، ولذلك دعا عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهـٰذا: ((وإذا شيك فلا انتقش)) أي: إنه لا يُحَصِّل مطلوبه، وهـٰذا يدل يا إخواني دلالة واضحة على أن من سعى في تحصيل الدنيا على حساب الدين فاته الدين والدنيا، لا يحصِّل مقصوده، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش)) كل هـٰذا خبر عن أن هـٰذا لا يحصل له مقصوده، بل يعاقبه الله -جل وعلا- بنقيض مقصوده. ثم بعد أن ذكر هـٰذه الصّورة لهـٰذا العامل ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من السعي في تحصيل مصالح دينه ودنياه، فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مُغبَرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع)).
وهـٰذا مثال لمن سعى في طاعة الله ومرضاته، جهده وطاقته، وأنه مُوَفَّق، وإن كان قد فاته العز والتمكين في الدنيا، فإن العز والتمكين في الدنيا إن فات الإنسان لم يفته شيءٌ كبيرٌ إذا كان يلقى رضا الله -جل علا- ونعيمه في الآخرة، ويحصل له رضا الله-جل وعلا- في الدنيا، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يخلف على هـٰذا الذي فاتته الدنيا من سعادة القلب وانشراحه، وسعة الصّدر، والفرح بطاعة الله ما ينسيه لذّات الدنيا، حتى تصبح ملاذ الدنيا عنده لا قيمة لها، ولا نظر له إليها.
((طوبى)) شجرةٌ في الجنة، ورد في ذكرها ووصفها أحاديث متعددة تدلّ بمجموعها على أن هـٰذه الشجرة كبيرة، عظيمة، هي من أفضل ومن خير شجر الجنة، ولذلك قال العلماء: طوبى في هـٰذا: هو دعاء له بالشجرة، وقيل: هو دعاء له بالجنة؛ لأن الشجرة في الجنة، ودعاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له بالشجرة يلزم منه أن يدخل الجنة، وقيل: إن ((طوبى)) مصدر مأخوذ من الطيب، وهو كل ما طاب، كل شيءٍ طيبٍ، فله كل شيءٍ طيبٍ في الدنيا والآخرة، وهـٰذا المعنى أشمل، وإن كانت شجرة طوبى أعظم في النعيم؛ لأنه النعيم الباقي الدائم، لكن هـٰذه أوسع؛ لأنها تشملها، وتشمل سعادة الدنيا، والله –جل وعلا- قد بَشَّر الذين يستقيمون على أمره في الدنيا بأنَّ لهم حياةً طيبةً، قال الله جل وعلا: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾( ). الحياة الطيبة هـٰذه ليست في الآخرة فقط، بل هي في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنه بعد ذكر الحياة الطيبة ذكر الأجر الأخروي، المهم أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((طوبى)) يشمل الطيب من كل شيء في الحياة الدنيا، وفي الآخرة.
((طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه)) وذكر الفرس لأنه آلة الجهاد الباقية إلى قيام الساعة، قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)). فهي آلة الجهاد الباقية، ولم يذكر غيرها لكونه قد يتغير، ويحدث من الوسائل ما يستعمل في الجهاد، وفي إعلاء كلمة الله غيره.
((طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله)) وهـٰذا يبين أنه إنما أراد الله -جل وعلا-، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ماذا قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ هل ذلك في سبيل الله؟ قال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)).
فقوله: ((في سبيل الله)) أي: قد أخلص سعيه، وجهاده، وعمله لطاعة الله -جل وعلا-، فلم يَرقُب غيره.
قال: ((أشعث رأسه)) هـٰذه صفة لعبد في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((طوبى لعبد)) وشَعَث الرأس يدل على الاشتغال بالطاعة، وليس شَعَث الرأس مقصودًا في ذاته، يعني: ليس قُبح المنظر مقصودًا لذاته في تحصيل وصف وفضل الآخرة، إنما هو أمرٌ لازمٌ لطاعة الله -جل وعلا-، فإن من اشتغل بالجهاد على هـٰذه الصفة يطلب مرضاة الله -جل وعلا-، مشتغلٌ بالقتال في سبيله فإنه يَغْفُل عن هـٰذه الأمور.
((أشعث رأسه مُغبَرةً قدماه)) كذلك هـٰذا حاله، أنا ذكرت أن ((أشعث)) صفة والصحيح أنها حال، والحال صفة في المعنى.
((أشعث رأسه)) صفة من قوله: ((لعبدٍ)) وكذلك ((مُغبَرة قدماه)) وفيها وجه آخر: ((أشعثُ رأسهُ مغبرةٌ قدماهُ)) لكنه وجه ضعيف.
ثم قال: ((إن كان في الحراسة كان في الحراسة)).
((إن كان في الحراسة كان في الحراسة)) ما هـٰذا الكلام ؟ أين الشرط وجواب الشرط؟
((إن)) حرف شرط ((كان في الحراسة)) هـٰذه جملة الشرط، ((كان في الحراسة)) هـٰذه جواب الشرط، وهـٰذا من المواضع القليلة التي يوافق فيها الشرط جوابه، التي يوافق فيها جوابُ الشرطِ الشرطَ، يعني: يتوافق الشرط والجزاء، فإنه قال: ((إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة)) فاتفق الشرط والجزاء في اللفظ، لكن هل اتفقا في المعنى؟ الجواب: لا، لم يتفقا في المعنى، والمعنى ((إن كان في الحراسة)) يعني: إن كان هـٰذا العبد في عمل الحراسة، فهو قائم بها على أكمل وجه:
((كان في الحراسة)) وقيل: كان في الحراسة: على وجه التعظيم، أي: كان في أمر عظيم؛ لأنه في مرضاة الله سواءًٌ كان في المقدمة، أو كان في الحراسة.
((وإن كان في الساقة)) يعني: في مؤخر الجيش ((كان في الساقة)) ليس له هم في التقدم والتصدُّر، وأن يكون في أوائل الجيوش، وأوائل المجالس، إنما همُّه طاعة الله جل وعلا، فحيثما كانت طاعة الله، حيثما كانت محبة الله -جل وعلا- وجدته، ليس له نظر إلى غير ذلك.
فقوله: ((إن كان في الحراسة كان في الحراسة)) أي: قام بها على أكمل وجه، لم يأنف عن هـٰذا العمل، ولم يقصر فيه، بل اجتهد فيه جهده، وسعى فيه طاقته طلبًا لمرضاة الله جل وعلا، ((وإن كان في الساقة كان في الساقة)).
ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بيان أنه قد خَمَل ذكره، ولم يسعَ إلى طلب مدح الناس وثنائهم، قال: ((إن استأذن لم يؤذن له)) إن استأذن: أي طلب الإذن في الدخول على أحد مهما كان لم يؤذن له، يعني: لم يفرح به حتى يؤذن له، بل هو مدفوع بالأبواب كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره)) وهـٰذا مطابق لهـٰذا الوصف، فهو مدفوع بالأبواب: ((إن استأذن لم يؤذن له)).
((وإن شفع لم يشفع)) يعني: وإن توسّط في جلب خير لأحد، أو دفع ضر عنه لم يحصل بشفاعته المقصود، هل هـٰذه الأوصاف معناها أن من كان على هـٰذه الحال فهو متقدم على غيره؟ ليس الشأن في أفراد هـٰذه الأوصاف، الشأن كل الشأن في أن يكون الإنسان مخلصًا لله عز وجل: ((طوبى لعبد آخذ بعِنان فرسه في سبيل الله)) الشّأن في كونه في سبيل الله، أما كونه أشعث أغبر، إذا استأذن لم يؤذن له، إن شفع لم يشفع: فهـٰذا قد لا يتحقق في كل أحد، قد يفوت المؤمن بعض مصالح الدنيا، ولا يدل هـٰذا على فضله، كما أنه قد يُوَسَّع له في الدنيا، ولا يدل هـٰذا على فضله، الفضل كل الفضل في تقوى القلب وصلاحه، وكمال عبوديته لله جل وعلا، وإنما هـٰذه الأوصاف تابعة، قد تحصل وقد لا تحصل.
معنى هـٰذا أنه إذا رأينا من وصفه كهـٰذا الذي ذكر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((آخذ بعنان فرسه في سبيل الله)) لكنه ليس بأشعث، ولا بأغبر، لكنه ((إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة))، وقد يكون إذا استأذن أُذِن له، وإذا شَفَعَ شُفِّع، فإن هـٰذا لا يعني نقص إخلاصه ومكانته عند الله جل وعلا؛ لأن الشأن كل الشأن في أن يبلغ الإنسان مرضاة الله جل وعلا، وأن يحقق التوحيد بقلبه، وما يأتيه من نعيم الدنيا: من مكانةٍ في قلوب الخلق، من قبول شفاعة، من تقدم، إذا كان ليس له نظرٌ إلى هـٰذه الأمور، وليس له قصدٌ إليها فهو على خير، لا سيما إذا استعمل هـٰذه الأمور في نفع الناس، ونشر الخير، والدعوة إلى البر، فلا يلزم أن تجتمع هـٰذه الأوصاف حتى يحكم على الإنسان بالإخلاص، بل قد يكون الإنسان على هـٰذه الأوصاف من حيث المنظر، ومن حيث نظر الناس إليه، لكنه ليس مخلصًا، قد يكون الإنسان مدِلاًّ بعمله، وإن كان خَلَقَ الثياب، لذلك قال بعض السلف: ليس الشأن أن تصلي ثم تصبح –يعني تصلي في الليل- ثم تصبح مدِلاًّ بعملك على الله جل وعلا، معجبًا به، فإن أنين المستغفرين أحب إلى الله -جل وعلا- من عبادة الإنسان إذا كانت تؤول به إلى العجب والمن والإدلال، وأن يرى الإنسان لنفسه على الله -جل وعلا- مكانة، انتهى الحديث، ثم ذُكِرَ في معنى الخميصة والخميلة: أن الخميصة هي ثوب، نوع من الثياب، والخميلة قطعة قماش لها خَمَل.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
[الشرح]
الإنسان في إرادته الدنيا بعمل الآخرة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يريد بعمل الدنيا الآخرة من كل وجه، واضح؟
أن يريد بعمله الدنيا من كل وجه، يعني: ليس له غرض في الآخرة، إنما غرضه في الدنيا، وهـٰذا الذي يصدق عليه قول الله -جل وعلا- في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
القسم الثاني من إرادة الدنيا بالعمل: أن يكون مريدًا لله جل وعلا، لكن يخلط مع ذلك إرادة الدنيا، وهـٰذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يريد من الدنيا ما جاء الشرع بذكره جزاءً للعمل، مثاله قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه)). فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رتَّب على صلة الرحم مصلحتين من مصالح الدنيا: البسط في الرزق، والإنساء في الأثر، فقصد هـٰذا جائز إذا قصده مع إرادة الآخرة، يعني: يريد الآخرة، ويريد تحصيل الفضائل التي نصَّ عليها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما يُحصَّل في الدنيا، ويُرتَّب على العمل، لكن هـٰذا ليس في الأجر كالذي لم يقصد إلا الدار الآخرة، فإنه من قصد ما ذكره النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من مصالح الدنيا المرتَّبة على العمل لم يتمم الإخلاص، لكنه ليس قادحًا فيه، بل ينقص الأجر، وليس ممنوعًا مذمومًا، لكن من وصل رحمه، ولم يلاحظ إلا تحصيل المكسب الدنيوي فقط: بسط الرزق، وإنساء الأثر، ولم ينظر ولم يخطر له على بال الأجر الذي رتَّبه الله في الآخرة، فهـٰذا لا شك أنه قد فوَّت على نفسه خيرًا كثيرًا، وقد يكون قد وقع في الإثم.
القسم الثاني: هو أن يقصد ما لم يذكره الله ورسوله من الدنيا بالعمل الصالح، لكنَّه قصد تابع، وليس قصدًا أصليّاً، فهـٰذا ينقص الأجر، وله من الأجر بقدر ما معه من إرادة الله والدار الآخرة، مثال ذلك: أن يعمل عملاً صالحًا ويقصد بالعمل ثواب الآخرة، ولكن يجني منه مصلحة دنيوية، فهـٰذا عمله صحيح، لكنه ناقص، ويكون مأجورًا على عمله إذا كان يريد أن يستعين بهـٰذا الذي يحصله من أمر الدنيا على أمر الآخرة، يعني: هـٰذا الذي قَصَد أمرًا لم يذكره الله ورسوله مرتَّبًا على العمل الصالح، لكنه قصده على وجه التبع، وأراد به الاستعانة على طاعة الله -جل وعلا- فإنه لا حرج عليه، بل هو مأجور؛ لأنه يسعى في تكميل أمر الله وأمر رسوله، مثاله: شخص فقير ليس عنده من المال ما يتمكن به من الوصول إلى مكة، ومشاركة المسلمين في مناسك الحج، وهو يحب الحج، ويحب أن يشهد تلك المشاهد، فجاءه شخص قال: أعطيك مبلغاً لتحج عن فلان. فقال: طيب، الآن أخذ المال ليحج، أو حج ليأخذ؟ أخذ المال ليحج، فهو أخذه ليستعين به على طاعة الله عز وجل، ويحصل له المشاركة مع المسلمين في هـٰذا الموقف العظيم، فهـٰذا لا حرج عليه، أما من لم يحج إلا ليأخذ، ليس له نظر إلى مشاركة أهل الإسلام في هـٰذه الشعيرة، وليس له نظر إلى الحج، ولا محبة له، إنما نظره إلى هـٰذه الدراهم التي يأخذها، سواءٌ كانت جعالة، أو إجارة، أو على أي وجه جاءت، فإنه ليس له من حجه أجر، بل هو عائدٌ بالإثم، واختلف العلماء في إجزاء مثل حج هـٰذا، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ والقاعدة: أنه من أخذ ليستعين بذلك على طاعة الله -جل وعلا- فهو على خير، وهو من أعمال أهل الصلاح، أما إذا عمل ليأخذ، فإنه قد وقع فيما نهى الله عنه ورسوله، وليس له في الآخرة من خلاق، كما قال الله جل وعلا: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
هـٰذا ملخص فيما يتعلق بإرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
[المتن]
الثانية: تفسير آية هود.
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة.
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط سخط.
الخامسة: قوله: ((تعس وانتكس)).
السادسة: قوله: ((وإذا شيك فلا انتقش)).
[الشرح]
تكلمنا عليها.
[المتن]
السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
[الشرح]
نعم، وذكرنا أن الثناء عليه بقوله: ((أشعث أغبر مغبرة قدماه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع)). هل هي لذاتها أو لكونها حصلت بسبب الإعراض التام عن الدنيا؟ بسبب الإعراض التام عن الدنيا.
¹
نملي عليكم أقسام التشريك في النية في العبادة:
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهـٰذا بحث مختصر حول التشريك في نية العبادة نفع الله به كاتبه ومن يطلع عليه:
اعلم وفقك الله أن أسمى المراتب توحيد القصد للواحد الأحد، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾( ). وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ((إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه)). وأثر التشريك في النية وحكمه يختلف باختلاف نوعه، وهو على أقسامٍ ثلاثة:
الأول: أن يقصد بعمله غير الله تعالى، فهـٰذا عمله حابط، وهو واقع في الشرك، قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ويدل لهـٰذا أيضًا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك)) الحديث.
يقول: والأدلة على هـٰذا القسم كثيرة معروفةٌ، طيب هـٰذا القسم الأول.
إذًا: أن يقصد بعمله غير الله تعالى، هـٰذا العمل، وحكمه: عمله حابط، وهو واقع في الشرك.
الثاني: أن يقصد بعمله وجه الله تعالى، ويقصد مع ذلك ما دلَّ النص الشرعي على أنه من ثمار العمل ونتائجه.
يقول: فحكم هـٰذا القسم ينقسم إلى ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن تكون الثمرة المقصودة – يعني التي يقصدها العامل- مطلوبةً في الشرع، ومقصودةً له، ففي هـٰذه الحال يجوز قَصْد هـٰذه الثمرة تبعًا أو استقلالاً. تبعًا يعني: يقصد الله جل وعلا، ويقصد هـٰذه الثمرة، واستقلالاً: يقصد الثمرة ابتداءً، ومن أمثلة هـٰذه الحال: ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :((يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)). هـٰذا مثال للحال الأولى.
يقول: فالصيام بقصد العبادة، وقصد تحصيل العفاف، والنجاة من اشتداد الشهوة مشروعٌ لا حرج فيه.
إذًا: الآن قصد العبادة وقصد تحصيل دفع الشهوة، واضح؟
هـٰذا مقصد شرعي، تخفيف الشهوة لئلا يقع في المحرم مقصد شرعي، أليس كذلك؟ ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)). هـٰذا صام ابتغاء مرضاة الله، ومع ذلك قصد تخفيف شهوته، فهـٰذا قصد ما جعله الشارع ثمرة للعمل إلا أنه مقصودٌ للشارع، يقول: فهـٰذا جائز، لا حرج فيه، بل لو لم يقصد إلا الأخير فقط، يعني: ما قصد من الصيام إلا حفظ الشهوة، وتخفيف وطأتها عليه، فإنه في عملٍ صالٍح، يقول: فأجره ثابت؛ لأنه في تحصيل ثمرةٍ هي مقصودةٌ للشارع، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً﴾( ). فطلب العفاف مقصودٌ للشارع، ولذلك أمر به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، قال القرافي في كتابه الفروق: فأمر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالصوم لهـٰذا الغرض، يقول: ولو كان قادحًا -يعني في التوحيد والنية- لم يأمر به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في العبادة، فدلَّ ذلك على صحة قصد هـٰذا من الصيام، هـٰذه الحال الأولى من القسم الثاني.
القسم الثاني: أن يقصد بعمله وجه الله تعالى، ويقصد مع ذلك ما دلَّ النص الشرعي على أنه من ثمار العمل ونتائجه، وهـٰذا قلنا: له كم حالاً ؟ له ثلاث أحوال، هـٰذه الحال الأولى، الحال الأولى ما هي؟ أن تكون الثمرة مقصودة مطلوبة للشارع، مثاله: حفظ الفرج، تخفيف الشهوة، هـٰذا مقصود للشارع أو ليس مقصودًا؟ هو ثمرة لعبادة أم لا ؟ هو ثمرة الصيام؛ لأن الصيام يضيق مجاري الدم، فيشتغل الإنسان عن الشهوة بالصيام، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) أي: حفظ وصيانة.
قصد هـٰذا ما حكمه؟ قصد هـٰذه الثمرة جائز تبعًا واستقلالاً، تبعًا يعني: يقصد التعبد، مثلاً: يقصد إصابة السّنّة في صيام الأيام البيض مثلاً، هـٰذه عبادة أو ليست بعبادة؟ عبادة، ومع ذلك يقصد الوجاء، يقصد تخفيف الشّهوة، هـٰذا مقصودٌ جائز تبعًا واستقلالاً.
القسم الثاني، أو الحال الثانية من هـٰذا القسم: أن تكون الثمرة المقصودة مع الله تعالى من حظوظ النفس –انتبه!- الثمرة في هـٰذه الحال من حظوظ النفس، ومن المكاسب الدنيوية، لكن قد ذكرها الشرع ثمرةً للعبادة، ففي هـٰذه الحال يجوز قصد هـٰذه الثمرة تبعًا لا استقلالاً، مثال هـٰذا: من أكثر من الاستغفار قاصدًا التوبة إلى الله، وقاصدًا إنزال المطر، أو تكثير النسل؛ لقول الله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾( ). إرسال السماء مدرارًا هـٰذا من مكاسب الدنيا أو..؟ من مكـاسب الدنيا ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾( ) كل هـٰذا من متاع الدنيا وزينتها؛ ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾( ) فهـٰذه كلها مقاصد دنيوية جعلها مرتبة على عبادة وهي الاستغفار، فهل يصح أن يستغفر الإنسان يقصد بذلك طلب المغفرة من الله، ويقصد مع ذلك هـٰذه الأمور التي ذكرها الله؟
الجواب: نعم، يقول: ومن ذلك أيضًا: من وصل رحمه طاعة لله، وطلبًا لبسط الرزق، وإنساء الأثر؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما أخرجه الشيخان من حديث أنس: ((من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)). وكذلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وطلب الغنيمة، أو الأسلاب، فإن هـٰذا لا يبطل جهاده، وذلك لورود اعتبار هـٰذا القصد من الشرع، ثم ذكر الدليل على هـٰذا.
المهم: الثمرة في هـٰذا القسم من مقاصد الدنيا، من مصالح الدنيا ومكاسبها، ما حكم قصدها بالعمل؟ إن كانت تبعًا فلا بأس، أما استقلالاً فلا، يعني: لا يجوز أن يستغفر الإنسان، وليس في باله إلا طلب المطر فقط، أو يجاهد وليس في باله إلا طلب الغنيمة فقط، لكن لو جاهد لإعلاء كلمة الله، وحصول ما يحصل من الرزق بالغنائم فإن هـٰذا لا بأس به، واضح القسم؟
الحالة الثالثة: قصد الثمرة التي هي من حظوظ النفس، أو من مكاسب الدنيا استقلالاً، فهـٰذا لا يجوز، وهو داخلٌ تحت القسم الأول فعمله حابط، وهو واقع في الشرك، ويدل لذلك ما أخرجه النسائي عن عبادة بن الصامت -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى)).
يقول: ويدل لذلك أيضًا ما أخرجه أبو داود من قصة أجير يعلى بن مُنيَّة الذي استأجره بثلاثة دراهم ليجاهد عنه، فذكر ذلك للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: ((ما أجد له في غزوته هـٰذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمَّى)).
الثالثة: قصد الثمرة التي هي من حظوظ النفس، أو من مكاسب الدنيا استقلالاً، فهـٰذا لا يجوز، وهو داخلٌ تحت القسم الأول الذي هو: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾.
ثم آخر الأقسام: أن يقصد بعمله ثمرةً أو نتيجةً نهى الشارع عن قصدها أو النظر إليها، فهـٰذا لا يجوز قَصْدُه سواءٌ تبعًا أو استقلالاً، أن يقصد بعمله ثمرةً أو نتيجةً نهى الشارع عن قصدها، أو النظر إليها، نهى الله ورسوله عن قصدها أو النظر إليها، فهنا لا يجوز هـٰذا القصد تبعًا أو استقلالاً، مثاله: أن يجاهد شجاعةً أو حميةً مع قصد إعلاء كلمة الله، هل يصح هـٰذا القصد؟ الجواب: لا يصح، فلا يجوز قصد هـٰذا سواءٌ على وجه الاستقلال أو على وجه التبع .
نعيد القسم: أن يقصد بعمله ثمرةً أو نتيجةً نهى الشرع عن قصدها أو النظر إليها سواءٌ تبعًا أو استقلالاً، ففي هـٰذا القسم يكون قصد هـٰذا حرامًا مبطلاً للعمل، وهو من الشرك، مثل: أن يقصد الذكر، أو يقاتل حميةً أو شجاعةً، أو غير ذلك مما ورد الشرع بالنهي عن قصده.
الدليل على هـٰذا أنه لا يصح قصده تبعًا ولا استقلالاً: ما رواه أبو داود والنسائي بسند جيد عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله –انتبه! يسأل هـٰذا الرجل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر)) يعني: يطلب الأجر من الله، والذكر من الناس ((ما له؟)) يعني: أي شيء له؟ قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا شيء له)) ، فأعادها عليه ثلاثاً يسأله: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟كل ذلك يقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا شيء له)). ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه)). وهـٰذا يدل على أنه لا يصح مثل هـٰذا القصد، يقول: فهـٰذا دليل صريح في أن قصد هـٰذه الأمور، ولو كان تبعًا يبطل العمل، والله تعالى أعلم.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثاني والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباً من دون الله
وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!
وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعـالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾( ) أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ هـٰذه الآية: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾( ) فقلت له: إنَّا لسنا نعبدهم؟ قال: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟)) فقلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)). رواه أحمد، والترمذي وحسنه.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (بابٌ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباً).
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام، أو تحريم الحلال من الشرك، وهو من الشرك الواقع في الرّبوبية من حيث التشريع، أي: من حيث فعل العلماء والأمراء، وهو من شرك الطاعة والعبادة في حق من أطاعهم في التحليل والتحريم، يعني: تحليل ما حرَّم الله، وتحريم ما أحلَّ الله له جانبان:
الفاعل لذلك وقع في شرك الربوبية؛ لأن الله -جل وعلا- ليس له شريك في الحكم، له الحكم، فكل من شَرَّع بتحريم أو تحليل فقد نازع الله -جل وعلا- في ملكه، ولذلك قال جل وعلا: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾( ). فكل من شرع في الدين، أي: في العبادة والعمل ما لم يأذن به الله، ما لم يشرعه الله -جل وعلا- فقد وقع في الشرك، فالمشرع لدين غير دين الله واقعٌ في شرك الرّبوبية؛ لأنه نازع الله في هـٰذه الصفة، ولذلك قال الله -جل وعلا- عن اليهود والنصارى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾( ) ما قال: آلهةً، قال: أربابًا، أي: صيروهم أربابًا من دون الله؛ حيث إنهم جعلوا لهم التصرف في التشريع، في التحريم والتحليل، في تحريم ما أحلّ الله، وفي تحليل ما حرَّم الله فوقعوا في الشِّرك، أما من حيث المطيع لمن أحلَّ ما حرم الله، أو المطيع لمن حرم ما أحل الله فإنه قد اتخذه ربّاً وإلهًا: ربّاً حيث صرف له ما لا يجوز إلا لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فجعله شريكًا لله في الربوبية، وإلهاً حيث أطاعه وامتثل تحليله وتحريمه، فيكون قد اجتمع في هـٰذا الباب نوعا الشرك: شرك الربوبية وشرك الإلهية، هـٰذه مناسبة ذكر هـٰذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأنه يتضمّن الوقوع في شرك الربوبية، وفي شرك الإلهية.
أما مناسبته لما قبله: فإنه في الباب السابق ذكر -رحمه الله- عبادة الأموال والدنيا في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ وفي قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة)). وفي هـٰذا الباب ذكر عبادة الرجال، حيث ذكر طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، وهناك مناسبة بين البابين؛ لأنه في الغالب إنما تحصل طاعة الرجال طمعًا في حصول الأموال، هـٰذه المناسبة بين البابين.
يقول رحمه الله: (من أطاع العلماء).
(من) هنا شرطية، (أطاع) فعل الشرط، (العلماء) المقصود بهم: المنتسبون لأهل العلم، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون عالمٌ متحققًا بالعلم، وهو يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله.
(من أطاع العلماء والأمراء).
(الأمراء): من لهم الولاية، وقدَّم العلماء لأن الغالب في التحليل والتحريم يُرجع فيه إليهم، فهم الجهة التي تخبر عن الله عز وجل، ثم ذكر الأمراء بعد العلماء لأن الأمراء هم الجهة التنفيذية في الغالب، فإنهم ينفذون ما يقوله العلماء، ويعملون بما يقوله أهل العلم، فمن أطاع هؤلاء أو هؤلاء (في تحريم ما أحل الله)، يعني: ما علم حِلَّه، (أو تحليل ما حرمه)، (فقد اتخذهم) هـٰذا جواب الشرط (فقد اتخذهم أربابًا) أي: صيرهم أربابًا، وأرباب: جمع رب، والرَّب: هو المالك المتصرف الذي يربي عباده حيث يتدرج بهم -جل وعلا- ليبلغهم درجات الكمال، ومن معاني الرَّب: السيد، المالك، المدبِّر، كل هـٰذا مما يقال في معاني الرب.
وهـٰذا فيه بيان حكم من أطاع مخلوقًا في تحريم ما أحلَّ الله، أو تحليل ما حرم الله، هل هـٰذا خاصٌّ بهذين الصنفين من الناس؟ يعني: من أطاع عاميّاً، من أطاع والده، من أطاع كائنًا من كان في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، أيكون قد اتخذه ربّاً؟ الجواب: نعم، فلماذا النص ذكر هؤلاء؟ ذكر هؤلاء لأننا مأمورون بطاعتهم، أما العلماء فقد قال الله جل وعلا: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾( ) فالمرجع إليهم في معرفة الأحكام. وأما الأمراء فلأن الله أمر بطاعتهم أيضًا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾( ) فإنهم يدخلون في قوله تعالى: ﴿وَأُولِي الأَمْر﴾ فإن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فلذلك نصَّ على هذين، وإن كان الحكم يشمل طاعة كل أحد، فلو أطاع أباه، أطاع عاميّاً، أطاع كائنًا من كان في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرَّمه الله فإنه قد اتخذه ربّاً.
ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب آثارًا من ذلك:
قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجـارة من السماء، أقول: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!
قبل أن نُعلِّق على هـٰذا الأثر، نقول: طاعة العلماء تنقسم إلى قسمين، أو نقول بعبارة أعمَّ وأشمل: الطاعة في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله نوعان:
النوع الأول: أن يعلم الإنسان أنَّ من أمرَهُ قد بَدَّل الشرع، أن يعلم أن آمره قد بدَّل الشرع، فجعل الحلال حرامًا، أو الحرام حلالاً، فأطاعه في التبديل، فهـٰذا مشرك، كافرٌ بالله العظيم، وشركه في الربوبية والإلهية؛ لأنه بدَّل شرع الله جل وعلا، وأثبت مع الله مالكًا مُشَرِّعًا، وهو المشار إليه في قول الله تعالى في ما ذكره عن النصارى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾.
القسم الثاني: أن يطيعه في فعل المحرم، وفي اجتناب المباح، لكن لا على وجه التبديل، فهـٰذا معصية، وليس شركًا، أن يطيعه في فعل المحرم، فيقول له مثلاً: اشرب الخمرة يشربها، لكن في قرارة نفسه يعتقد أن الخمرة حرام، فلم يبدل حكم الله، لكن شربها مجاراةً لهـٰذا، أو خوفًا منه، أو طمعًا فيما عنده من مال، فهـٰذا ليس مشركًا، لكنه عاصٍ لله عز وجل، فَعُلِم أن الطاعة التي يحصل بها الكفر والشرك هي الطاعة في التبديل، في تبديل الشرع، في تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، أما الطاعة في مخالفة الشرع دون تبديله، فإنها معصية من المعاصي، وعلى هـٰذا الذين يقال لهم: افعلوا كذا من المحرمات، ويمتثلون أمر الآمر مع إقرارهم بحكم الشرع هؤلاء مشركون أو عصاة؟ عصاة.
يقول رحمه الله: (وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟). هـٰذا الأثر عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كان لما راجعه الناس في قوله في المتعة، في متعة الحاج، فإنه كان يرى وجوب المتعة على الحاج، يرى أنه يجب التمتع على الحاج، فكان الناس يناقشونه ويراجعونه في هـٰذا، ويقولون له: كيف تقول هـٰذا وأبو بكر وعمر كانا يأمران الناس بالإفراد، وينهيان الناس عن التمتع؟ فكان ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يرد عليهم، يقول: (يوشك) أي يقرب ويدنو ويُسرع أن يقع بكم عقاب عام، وهو أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء.
ثم بين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سبب هـٰذا قال: (أقول لكم: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟). أي إنكم عارضتم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقول غيره، بقول أبي بكر وعمر، وهـٰذا موجب للعقوبة؛ لأنه متضمن للإعراض عن قول الله وقول رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا يجوز لأحد كائناً من كان أن يعارض قول الله وقول رسوله، بل يجب الإيمان والتسليم بقول الله وقول رسوله: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾( ) ولذلك لا تجوز معارضة قول الله وقول رسوله بقول أحدٍ من الناس، كائنًا من كان القائل والمتكلم، بل الواجب التسليم والانقياد لقول الله وقول رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أما قول الله فلأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الذي له الشرع فهو الذي يحرم وهو الذي يبيح، وأما قول رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلأن الرسول هو المبُلغ عن الله -عز وجل-، فلا يجوز مخالفة أمر الله ولا أمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا يجوز معارضة قولهما بقول أحدٍ من الخلق، ولذلك كان ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يقول لهم هـٰذا القول، وتعلمون أن النقَاش والمجَادلة يحصل فيهما مُرَادَّة وخروج في بعض الأحيان عن الصراط المستقيم، ولذلك كانوا يردون عليه ويقولون: قال أبو بكر وعمر، على قوله: (وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟) كانوا يردون عليه ويقولون: إنهما أعلم منك برسول الله، لكن الشاهد في قول ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء) وذكر السبب وهو معارضة قول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وقد جاء مثل ذلك أو قريب منه عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فإنه كان إذا أمر الناس بالمتعة قالوا له: كيف تقول هـٰذا وعمر يقول كذا وكذا؟ فكان إذا أطالوا عليه البحث والنقَاش قال: أتأخذون بقول عمر وتتركون كتاب الله؟! أفقول عمر تتبعون وتذرون كتاب الله أو قول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟
والشاهد من هـٰذا كله واحد، وهو أنه يجب ألا يعارض قول الله وقول رسوله بقول أحد من الناس أيّاً كان؛ لأن هـٰذا الأثر فيه الإنكار على من عارض قول الله وقول رسوله بقول أحد من الناس كائنًا من كان، بغض النظر عن السياق الذي وردت فيه هـٰذه المناقشة، فإنه ليس الشأن أو البحث في عين ما قال ابن عباس -أي في المسألة التي قال فيها ابن عباس هـٰذا القول- إنما الشأن في المعنى الذي يُشِير إليه، وهو أنه لا يجوز معارضة قول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقول أحد من الناس أيّاً كان القائل.
وذكرنا أن هـٰذا القول ذكره غير واحد من الصحابة، أو هـٰذا المعنى ذكره غير واحد من الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، كما قاله ابن عمر وغيره.
وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: عجبت لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾( ). أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولِهِ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
الإمام أحمد –رحمه الله– هو إمام أهل السنة والجماعة الذي رد الله به بدعة خلق القرآن، وكتب الله له القبول بعدها في أمة الإسلام، يقول رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته). يعني: عرفوا الإسناد وهو الطريق الذي وصل به النقل عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، و(صحته) أي وتمييز الصحيح من الضعيف، (يذهبون إلى رأي سفيان). أي يتركون الحديث ويأخذون بقول سفيان، والمراد بسفيان: سفيان الثوري وهو من كبار أئمة السلف –رحمه الله–، فالإمام أحمد – رحمه الله – يتعجب من هؤلاء الذين يتركون أقوال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويذهبون إلى أقوال غيره من الناس، ولو كانوا في العلم من كانوا؛ لأن الأصل في التلقي والقبول والعمل أن يكون قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُقدمًا على كل ذلك، فعَجَب الإمام أحمد هنا عجب استحسان أو عجب إنكار؟ عجب إنكار، ومن هـٰذا نفهم أن التعجب يكون منه ما هو استحسان ومنه ما هو استقباح واستنكار.
من الاستحسان قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((عَجِبَ ربُّنا لشابٍّ ليس لهُ صَبْوة)). ومن عجب الاستنكار قول الله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾( ). فإن هـٰذا عجب استنكار، ومنه أيضاً على قراءة الضم عجبتُ: ﴿بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ﴾.
والمقصود أن الإمام أحمد يُنكر على الذين يعارضون قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -مع التمكن من معرفته- بقول أحد من الناس، ثم يقول في بيان خطورة هـٰذا الأمر: والله –تعالى- يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾( ) وهـٰذا جزء من قول الله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. وأول الآية قول الله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ ثم قال: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ...﴾الآية، فالله –جل وعلا– حذر في هـٰذه الآية عن مخالفة أمره سبحانه وتعالى.
والحذر: هو الخوف من وقوع مُهلك أو من ملاقاة مُخيف، فالحذر أخص من الخوف، إذ إنه خوف من وقوع مهلك، وفيه الانتباه والتوقع لوقوع المُهلك، بخلاف الخوف.
﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ الضمير في قوله: ﴿أَمْرِهِ﴾ قيل: إنه يعود إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقيل: إنه يعود إلى الله –جل وعلا–. والأظهر أنه عائد إلى الله –سبحانه وتعالى–؛ لأنه أقرب مذكور، حيث قال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي: عن أمر الله تعالى، ولأن الأمر في هـٰذه الآية من الله -جل وعلا-، حيث إن الله -عز وجل-قال: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ بعد أن نهى عن هـٰذه المقولة قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾. والأمر هنا يشمل الأمر كله، وليس المقصود به طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني: ليس الأمر المقصود هنا هو الأمر القولي الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، بل هو الطريقة والشأن ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي أمر الله -عز وجل- ، عن طريقته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. وإذا كان مضافاً إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على القول الثاني، أي شأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وطريقته ومسلكه: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
والأمر يأتي بهـٰذا المعنى كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾( ). أي: وما شأنه، وما طريقته، فليس المقصود بالأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
وقوله: ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ يخالفون: من المخالفة، والمخالفة هي سلوك طريق غير الطريق المخالَف، أي المغايرة في السير والمشي والمَسْلَك، فالمقصود بالمخالفة هنا: هو أن يسلك الإنسان طريقًا وأن يمشي مشيًا مخالفًا لما عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولما عليه أمر الله جل وعلا.
الأصل في هـٰذا الفعل أن يتعدى بنفسه، لكنه ورد في القرآن مُعَدّىً بـ (عن) ومُعَدّىً بـ (إلى)، المُعَدَّى بـ (عن) يفيد معنى الصدود، والمعنى: فليحذر الذين يصدون عن أمره، وهـٰذا فيه زيادة على المخالفة، إذ إنه مخالفة وزيادة، فقوله: ﴿يُخَالِفُونَ﴾ مُضَمَّن معنى الصدود ولذلك عَداهُ بـ (عن)، وأما المخالفة إلى كذا فهي بمعنى الذهاب، الذهاب إلى الشيء.
﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ توعد الله –جل وعلا– الذين يخالفون أمر الله أو أمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعقوبتين:
الأولى: الفتنة.
والثانية: العذاب الأليم.
أما الفتنة: فهي ما يكون من المصائب في الأموال والأنفس والبصائر والعقول والآراء، كل هـٰذا يدخل في الفتنة، فكل ما يصابون به في أموالهم، في نفوسهم، في أهليهم، في بصائرهم وعقولهم وآرائهم، كل هـٰذا من الفتنة التي تهدد الله –جل وعلا– من خالف أمر الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بها.
وقال بعضهم: الفتنة هي عذاب القلب. والعذاب الأليم في البدن، يعني الفتنة في القلب والعذاب في البدن.
وقال بعضهم: الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.
وعلى كل حال الفتنة والعذاب متلازمان، وإنما ذكرهما لبيان أفراد ما ينزل بهؤلاء، فإنهم إذا فتنوا استحقوا العذاب الأليم، فقد ذكر الله –جل وعلا– في هـٰذا أنَّهم يصابون بابتلاء واختبار، فتكون عاقبة هـٰذا البلاء والاختبار نزول العذاب بهم.
وقوله تعالى: ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أليم: فعيل بمعنى مؤلم، أي: عذاب مؤلم، وهـٰذا فيه تحذير هؤلاء من هاتين العقوبتين.
قال رحمه الله: (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك). أي: إنه سبب للوقوع في الشرك، وقد جاء تفسير الفتنة بالكفر، ولا إشكال في المعنيين، فالفتنة تطلق على الشرك وتطلق على الكفر، ومنها قول الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾( ). فإن المراد بالفتنة الكفر والشرك، وكذلك: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾( )، فالمراد بالفتنة الشرك والكفر.
وكيف تكون مخالفة أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سببًا للوقوع في الشرك والكفر؟
الجواب: أن من قدم رأيه على وحي الله -عز وجل- وهدي رسوله فقد أشرك مع الله -عز وجل- هواه، وصدق فيه قول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾( ).هـٰذا إذا كانت مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله بسبب اتباع الهوى.
وقد يكون بسبب اتباع أمر من يأمر -كما هو الشأن في هـٰذا الباب- بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، فيكون قد عَبَدَ هـٰذا المحُلَِّل للحرام، وهـٰذا المُحَرِّم للحلال، ولذلك يقع من خالف الأمر على هـٰذا الوجه في الشرك.
ثم إن الأمور لا تبتدئ بالشرك والكفر في أول الأمر، بل يتدرج الشيء بالإنسان حتى يبلغ به الشرك أو الكفر، كما قال السلف في المعاصي: إنها بريد الكفر.
قال رحمه الله: (لعله إذا رد بعض قوله) أي: بعض قول الله -عز وجل- أو قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). ولا شك أن رد قول الله أو قول رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سبب للزيغ، وهـٰذا الزيغ قد يتمكن في القلب فيقع الإنسان بسببه في الهلاك، والله –جل وعلا– يَبتلي الناس، فإذا أفلح المؤمن في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله كان ذلك سببًا لزيادة إيمانِهِ وصلاح حالِهِ، وإذا رد أمر الله أو أمر رسوله واستكبر عن الانقياد، كان هـٰذا من أسباب هلاكه ووقوعه في عَظَائِم الذنوب.
ثم قال رحمه الله: (عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ هـٰذه الآية: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾( ) الآية) وهي في سورة التوبة. (فقلت له) القائل مَنْ؟ عدي بن حاتم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- :(إنا لسنا نعبدهم). وهـٰذا القول منه لما قدم على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكان نصرانيّاً، فقال: (إنا لسنا نعبدهم). أي: لا نصلي لهم، ولا نزكي ولا نحج لهم، أي لا نتوجه بالعبادة لهؤلاء؟ (قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟)) فقلت: بلى). أجاب بإيجاب أو نفي؟ بإيجاب، أي: يقع منا ذلك، فهؤلاء يحرمون الحلال فنحرمه، ويحلون ما حرم الله فنحله، هـٰذا معنى قوله: (بلى). أي إنه يقع منهم هـٰذا. (قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((فتلك عبادتهم)) ). أي فهـٰذه هي عبادتهم، فخفي على عدي وجه اتخاذ هؤلاء أربابًا من دون الله، وظن أنهم لا يكونون أربابًا من دون الله إلا بصرف الصلاة أو الذبح أو غير ذلك من أنواع التعبد لهؤلاء، وظن أن طاعتهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام ليست من الشرك وليست من العبادة.
فبَيَّن له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها من العبادة، قال: ((فتلك عبادتهم)) أي: تلك التي ذكرها الله -جل وعلا- في قوله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً﴾( ). فجعل الله -عز وجل- طاعة هؤلاء في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة.
قال: (رواه أحمد، والترمذي وحسنه، وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم). والشاهد من الحديث: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سمى طاعة غير الله ورسله في تحريم الحلال أو تحليل الحرام عبادة، وذكرنا في الدرس السابق أن الطّاعة في مثل هـٰذا تنقسم إلى قسمين:
الطاعة في التبديل، أي في تبديل الحرام حلالاً وفي تبديل الحلال حرامًا، فهـٰذه شرك وكفر بالله العظيم ولو كان في حكم واحد.
والثاني: الطاعة في مخالفة أمر الله وأمر رسوله، مع الإقرار بأمر الله ورسوله، يعني: مع إقرار الحرام حرامًا والحلال حلالاً، فهـٰذا معصية من المعاصي وليس شركاً.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية النور.
[الشرح]
تقدمت: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾. بالنسبة لآية النور ذكرنا أن يخالفون تعدى في القرآن بـ (عن) وبـ (إلى)، بـ (عن) في مثل هـٰذه الآية، بـ (إلى) في قوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾( ) والمعنى: أذهب إلى خلاف ما دعوتكم إليه.
[المتن]
الثانية: تفسير آية براءة.
[الشرح]
وهي قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾.
[المتن]
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
[الشرح]
حيث قال: (إنا لسنا نعبدهم) فبين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجه عبادتهم.
[المتن]
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
[الشرح]
في أنه لا تعارضوا قول الله وقول رسوله بقول أحد أيّاً كان.
[المتن]
الخامسة: تغير الأحوال إلى هـٰذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عُبِدَ من دون الله من ليس من الصالحين، وعُبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
[الشرح]
وهـٰذا يبين لنا أهمية بيان هـٰذه الأبواب، وأنها مما يحصل به تقرير التوحيد بين الناس، بعض الناس يظن أن هـٰذا من فُضول البحث، وأن الناس قد تخلصوا من عبادة الرجال ومن عبادة الأموال، ولم يكن في الناس شيء من هـٰذا، والواقع أن الناس بحاجة إلى تقرير التوحيد في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك تجد أن القرآن رحاه دائرة على تقرير التوحيد وبيانه، فليس بالناس غنًى، مهما حققوا التوحيد ليسوا بغنًى عن تقرير التوحيد والإعادة في بيانه وتوضيحه والاستدلال له والدعوة إليه.
نعم نقرأ الباب التالي.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾( )الآيات
وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾( ).
وقوله: ﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا﴾( ).
وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾( ) الآية.
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به.))
قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب "الحجة" بإسناد صحيح.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد -لأنه عَرَفَ أنه لا يأخذ الرشوة-. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود -لعلمه أنهم يأخذون الرشوة-. فاتفقا أن يأتيا كاهنًا في جهينة فيتحاكما إليه، فنـزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ الآية.
وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد كالباب الذي قبله، فإن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله من الشرك، أو منه ما هو من الشرك، فلذلك ذكر المؤلف –رحمه الله– الآيات الناهية عن التحاكم إلى غير الله وغير رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وقد سماه –جل وعلا– في كتابه: تحاكماً إلى الطاغوت حيث قال: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾.
وأما مناسبته للباب الذي قبله: فهو باب تابع للذي قبله؛ لأن الباب السابق فيه بيان حكم طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وفي هـٰذا الباب بيان حكم التحاكم إلى غير شرع الله.
قال –رحمه الله– في هـٰذا الباب: (باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً﴾( ).)
﴿أَلَمْ تَرَ﴾ استفهام هنا ما نوعه؟ استفهام إنكار على هؤلاء الذين جرى منهم هـٰذا الفعل، وهو مخالفة فِعْلِهم لزَعمِهِم، فهؤلاء زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما أنزل من قبله، ثم خالفوا هـٰذا الزعم بما قام في قلوبهم من إرادة التحاكم إلى الطاغوت.
وانظر حيث قال: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا﴾ ولم يقل: يتحاكمون، وهـٰذا يبين أن مجرد الإرادة فيها ما فيها، وسبب للذم والتعجب والإنكار، فكيف بمن تحاكم؟
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ وما أنزل إليه: هو القرآن وما جاء به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من السنة: ((ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه)).
﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾. أي الكتب التي تقدمت، ومن لازم الإيمان بكتاب الله وبما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الإيمان بما جاء قبل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الرسل والكتب.
﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾؛ ﴿يَتَحَاكَمُوا﴾: أي يطلبوا الحكم، والحكم هو الفصل بين المتخاصمين.
وقوله: ﴿إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ الطاغوت تقدم الكلام عليه، وهو: كل ما يحصل به الطغيان، سواء كان فعلاً أو قولاً أو عَقْدًا، وهنا المراد به: كل مَنْ حَكَمَ بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة، فإن كل من حكم بغير الشرع فهو طاغوت، سواء كان الحكم في دقيق الأمر أو جليله، في صغيره أو كبيره، فالطاغوت هنا هو: كل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾. يعني: والشأن والحال أنهم مأمورون بأي شيء؟ بأن يكفروا به لا بأن يتبعوه ويلجؤوا إليه ويسيروا إليه، وأين أُمروا بالكفر به؟ أُمروا بالكفر به في قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾( ). فالكفر بالطاغوت يشمل الكفر بكل ما يَحصُل به الطغيان، سواء كان معبودًا أو مخرجًا عن عبادة الله -عز وجل-. ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيـداً﴾ أي: يُريد الشيطان بما ألقاه في قلوبهم من الميل إلى التحاكم إلى الطاغوت ﴿أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً﴾. والضلال البعيد يشمل الضلال في الدين والضلال في الدنيا؛ لأنه لا تستقيم أمور الناس بغير حكم الله -عز وجل-، فمهما سَنُّوا من قوانين وشرعوا من تنظيم يريدون به إصلاح الدنيا وهو مخالف لأمر الله، فإنه يفسد به الدين ولا تصلح به الدنيا، ، فمن أراد إصلاح دنياه فليصلح دينه، ومن أصلح دينه ظاهرًا وباطنًا لابد أن تَصلُح دنياه، فإن الدين صلاح للمعاش والمعاد.
هـٰذه الآية ذكرها الله –جل وعلا– في المنافقين تعجيبًا من حالهم وشأنهم وعملهم، فإنهم ساعون في تكذيب ما زعَموه وهو الإيمان بالله ورسوله، وذلك بما قام في قلوبهم من الكفر الصُّرَاح، وبما قام في أعمالهم من نِتَاج ذلك الكفر الذي في قلوبهم.
فالآية في المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أظهروا الإيمان بما أُنزل إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما أُنزل من قبل وطَوَت قلوبهم غير ذلك، وعَقَدَت قلوبهم خلاف ذلك، ولذلك فضحهم الله –جل وعلا– في هـٰذه السورة الفاضحة: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ لأن المؤلف يقول: (الآيات) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ﴾ وهنا تصريح بوصفهم الذي استحقوا به هـٰذا الوصف، يعني الذي كان نِتَاجًا لما تقدم من عمل ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾( ).
قال رحمه الله: (بَابٌ: قولُ الله تعالى –أو بابُ قولِ الله تعالى-: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾) وذكرنا أن هـٰذه الآية فيها الإنكار والتعجيب من هؤلاء الذين خالف قولهم وخالفت دعواهم عملهم، حيث قال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾. والطاغوت كل ما يحصل به الطغيان، هـٰذا الأصل، والمراد به في هـٰذه الآية كُلُّ مَنْ حَكَم بِغَيِر شَرْعِ الله -عز وجل-؛ لأنه مما يحصل به الطغيان وتجاوز الحد، قال: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا﴾ مَن الذين أمروا؟ أهل الإسلام وعموم الناس ﴿أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه﴾. وقلنا: الأمر بالكفر به في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾. هل هناك آية أخرى فيها الأمر بالكفر بالطاغوت غير آية البقرة؟: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾( ) واجتنابه: كفرٌ به.
قال: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً﴾.
ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾. هـٰذه الآية فيها بيان الحكم على هـٰذا الفعل، وأن من كان شأنه الإعراض عن حكم الله وعن حكم رسوله فهو منافق، هـٰذه الآية فضحت أصحاب هـٰذا الفعل، وهـٰذه الآية من سورة النساء، هـٰذه الآية فضحتهم وحكمت عليهم، فإن الله –جل وعلا– حكم على أصحاب هـٰذا الفعل بالنفاق، هل حكم عليهم بالكفر أو بالنفاق؟ بالنفاق، معنى أنهم منافقون يعني: تجري عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، ولم يَحكُم بِكُفْرِهِم مع إخباره بأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت أمر باطن في قلوبهم استوجبوا به هـٰذا الذي ذكره الله -جل وعلا- في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾.
ثم بين –جل وعلا– عاقبة من تحاكم إلى غير الله ورسوله حيث قال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾( ). والذي قدمته أيديهم هو: إرادة التحاكم إلى غير الله -عز وجل-، إرادة التحاكم إلى الطاغوت. ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾. جاؤوك مُرْغَمِين أذلاء صَاغِرين، وهـٰذا حال كل منافق: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ﴾ يعني: ما أردنا، (إن) هنا نافية ﴿إِن أَرَدْنَا إِلا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً﴾ يعني: ما أردنا بهـٰذا التحاكم إلى غير الله ورسوله إلا الإحسان والتوفيق، الإحسان إلى من؟ قالوا: الإحسان إلى المتخاصمين، والتوفيق بين المتخاصمين، وقيل: الإحسان أي الإحسان على معناه العام والتوفيق بين ما جاءت به النصوص -بين ما جاء عن الله وعن رسوله- وبين ما ألِفُوه وما اقترحته عقولهم من الأقوال والاعتقادات.
ثم قال الله جل وعلا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾( ). وهـٰذا فيه الإشارة إلى أي شيء؟ إلى كذبهم في دعواهم، وأن ما في قلوبهم مخالفٌ لما أبدته ألسنتهم. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً﴾( ). أمره الله –جل وعلا– في حق هؤلاء بثلاثة أشياء: الإعراض عنهم، والوعظ، والقول البليغ.
أما الإعراض عنهم: فهو عدم السَّمَاع لما يُبْدُونه من الأعذار الباردة، التي إنما هي كذب وزور، من قولهم: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً﴾.
والوعظ هو: تذكيرهم بما يحصل به انزجارهم عن هـٰذا العمل، والوعظ: هو تذكير فيه ترغيب وترهيب، يعني: تذكير مشوب مخلوط بأي شيء؟ بالترغيب والترهيب.
وقوله: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً﴾ هـٰذا أمر من الله –جل وعلا– لرسوله أن يقول فيهم ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ قيل: إنه سرّاً، يعني: قل بينك وبينهم ﴿قَوْلاً بَلِيغاً﴾. وقيل ﴿قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: في شأنهم وفي عملهم وفي ما كان منهم من مخالفة لأمر الله ورسوله وإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله. ﴿قَوْلاً بَلِيغاً﴾ أي: بالغًا ينفذ إلى قلوبهم، ويحصل به الأثر المقصود من الانزجار وترك التحاكم إلى غير الله ورسوله، وترك التحاكم إلى الطاغوت.
هـٰذا هو معنى هـٰذه الآيات.
وفي هـٰذه الآيات بيان لحكم، وهو أن التحاكم لغير الله لا يحصل به الكفر مطلقًا، بل التحاكم إلى الطاغوت، إلى غير الكتاب والسنة من أعمال النفاق، وقد يكون نفاقًا اعتقاديّاً يكفر به صاحبه في الباطن، هـٰذا إذا أبدى من الأعذار ما هو نظير هـٰذه الأعذار المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً﴾.
والحكم بغير ما أنزل الله ليس فيه حكم واحد ينتضم جميع صوره، بل هو مما يَحتمل الكفر الأصغر والكفر الأكبر، لكن الأصل في هـٰذا أنه من أعمال النفاق.
أما من حيث كفر صاحب هـٰذا الفعل فإنه قد يكفر كفرًا أكبر وقد يكفر كفرًا أصغر:
فمن اعتقد وجوب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لكنه خالف لهوى، أو شهوة، أو انتصار لخَصم على آخر، فإن هـٰذا عاصٍ لله ورسوله، لكنه ليس بكافر.
من حكم بغير ما أنزل الله وبغير ما جاء به الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معتقدًا أنه لا يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، أو أن التحاكم إلى غير الشريعة أحسن، أو أنه مساوٍ لحكم الله ورسوله؛ فهـٰذا كافر، ولا خلاف بين العلماء في كفر هـٰذا الصنف.
القسم الثالث من الحكم بغير ما أنزل الله: من حكم بغير ما أنزل الله جاهلاً، فهـٰذا حكمه حكم المخطئين، وحاله حال من أخطأ في قول أو عمل، قد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ بالنظر إلى: هل يُعذر بجهله أو لا يُعذر؟
ثم قال: (وقوله) أي وقول الله تعالى-: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾( ).
هـٰذا فيه بيان لشيء من حُجج المنافقين في إعراضهم عن التحاكم إلى الكتاب والسنة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ﴾ بمخالفة الشريعة ومحادة الله ورسوله، وغير ذلك من أعمال المنافقين ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾. أي: لسنا مفسدين، ولم ينفوا عن أنفسهم الفساد فحسب، بل إنهم أثبتوا أنهم مصلحون حيث قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾. وأتوا في إثبات هـٰذا الوصف لهم بصيغة الحصر، حيث قالوا: ﴿إِنَّمَا﴾ وأتوا بالإثبات بصيغة الجملة الاسمية، التي تفيد الثبوت والاستقرار ﴿نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ وهم كاذبون في هـٰذه الدعوى، ولذلك كذبهم الله جل وعلا حيث قال: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ﴾( ). أي لا يشعرون بإفسادهم، لا يعلمون بإفسادهم؛ لما علا قلوبهم من الفساد الذي انقلبت فيه الأنوار إلى ظلمات، وانقلبت الظلمات إلى أنوار حتى رأوا سيئ فعلهم صلاحًا.
قال الله تعالى -فيما ذكر المؤلف –رحمه الله- قول الله تعالى-: ﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا﴾( ) أيضًا هـٰذه كالتي قبلها في نهي الله عز وجل عن الفساد في الأرض، واعلم أن الفساد في الأرض هو كل ما يَحصل به مخالفة الشريعة، والصلاح هو كل ما أمر الله به ورسوله، فمَدَار الصلاح على الاستمساك بالشريعة، والعمل بما جاء عن الله وعن رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومن ترك ذلك لأي عذر من الأعذار إعراضًا وصدودًا فإنه مفسد ليس مصلحًا، وإنما الإصلاح والصلاح التام الكامل في شريعة رب العالمين؛ لأن بها تحصل مصالح الدنيا ومصالح الآخرة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.)
هـٰذا فيه الإنكار على من اقترح حكمًا غير حكم الله عز وجل، والحكم هنا المراد به الحكم الديني الشرعي ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ لأنه أضاف الحكم إلى الجاهلية، وحكم الجاهلية: هو الحكم المخالف لحكم الله ورسوله. فكل من خالف حكم الله وحكم رسوله فإنه حاكم بالجاهلية، سواء أكان ذلك عن عدم العلم أو عن عدم العمل بالعلم، فَكِلا الأمرين من الجاهلية: من حكم بالجهل فإنه حكم بحكم الجاهلية، ومن حكم بما يخالف علمه، يعني: يعلم أن الصواب في هـٰذه المسألة كذا، لكن يخالف ذلك إلى غيره، ويعرض عن حكم الله وحكم رسوله، فهـٰذا أيضًا حكم بحكم الجاهلية، فحكم الجاهلية هو مخالفة حكم الله عز وجل وحكم رسوله، سواء أكان ذلك عن علم أو عن جهل؛ لأن الجاهلية تقدمت معنا في أكثر من مرة، أنها عدم العلم أو عدم العمل بالعلم، هـٰذا تعريف الجاهلية.
قال: ﴿يَبْغُونَ﴾ أي: يريدون، ويتمنون، ويطلبون، ويَسْعَون، بعد ذلك قال منكرًا عليهم هـٰذا السعـي وهـٰذا الطلب، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾. أي: لا أحد أحسن حكمًا من الله جل وعلا، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، قرَّ في قلوبهم الإيمان، وأثمر في أعمالهم الاستقامة على شرع رب العالمين، هؤلاء لا يجدون أحسن من حكم الله عز وجل؛ لأنه الحكم الموافق لمصالح الدنيا والآخرة.
ثم قال رحمه الله تعالى: (عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)). قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب "الحجة" بإسناد صحيح.)
هـٰذا الحديث فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نفى الإيمان بقوله: ((لا يؤمن أحدكم)). فنفى الإيمان، ونفي الإيمان هنا نفي للإيمان الواجب، ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه)) أي: مَيله ومحبته ورغبته ((تبعًا لما جئت به)) تبعًا لما جاء به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الهدى ودين الحق، من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، فكل من كان هواه مخالفًا، يعني ميله وحبه مخالفًا لما جاء عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه ناقص الإيمان، وعلى هـٰذا: من مال إلى غير الشرع، تحاكم إلى غير الشرع، وتحاكم إلى الطاغوت فإنه ناقص الإيمان، وهو نقص خطير يوقعه في النفاق أو الكفر على التفصيل الذي تقدم، وهـٰذا الحديث كما قال المؤلف -رحمه الله- نقل عن النووي تصحيحه (قال النووي: حديث صحيح). وقد تَعَقَّب ابن رجب -رحمه الله- النووي في جامع العلوم في تصحيحه لهـٰذا الحديث وقال: إن تصحيح هـٰذا الحديث بعيد، لكن الحديث معناه صحيح، وقد قواه ابن حجر في الفتح حيث قال: رجاله ثقات، ونقل تصحيح النووي ولم يتعقبه، فالحديث من حيث المعنى صحيح، ومن حيث السند فيه شيء من الضعف، لكنه ثابت المعنى ومقبول، يصلح للاحتجاج.
قال رحمه الله: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة). خصومة: أي خلاف في أمر إما مال أو غيره، (فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد) أي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عرف أنه لا يأخذ الرشوة) أي: لا يأخذ مالاً لإحقاق باطل، أو إبطال حق. فالرشوة هي المال المبذول لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهـٰذا تعريف الرّشوة، فكل مال بذله الإنسان لإحقاق باطل أو إبطال حق فإنه رشوة. يقول: (عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنًا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به﴾.)
(وقيل) أي: في سبب نزول الآية التي صَدَّر بها المؤلف -رحمه الله- الباب :(نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف) وهو من زعماء اليهود وكبرائهم. (ثم ترافعا إلى عمر) يعني: اتفقا على أن يترافعا إلى عمر (فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أكذلك؟) يعني: الأمر كما قال صاحبك؟ (قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله).
أي إن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ضرب من لم يرض بحكم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالسيف فقتله، وهـٰذا شيء مما ذكره أهل التفسير في سبب نزول هـٰذه الآية، وقد ذكروا آثارًا متعددة لا تخرج عن هـٰذا المعنى، وقد احتج بها جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام -رحمه الله- في الصارم المسلول، ومنهم ابن حجر حيث قال: إن ابن حبان روى ما ذكره عن الشعبي في هـٰذا الباب بإسناد صحيح، فهي إلى الشعبي بسند صحيح، وعلى كل حال الطبري أيضًا ممن مال إلى ثبوت هـٰذه القصة، وهي قصة التخاصم بين الرجلين واختلافهما في التحاكم عند رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعند غيره.
لكن اختلفوا في تعيين من تحاكموا عنده، ومثل هـٰذا يصلح أن يكون سببًا للنزول، وبعضهم قال: إن سبب النزول هو اختلاف الأنصاري مع الزبير بن العوام في سقي الأرض، لما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للزبير ما قال، فقال الأنصاري ولم يرض بحكم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أن كان ابن عمتك؟ أي لأجل أنه كان ابن عمتك حكمت له بهـٰذا الحكم، وهـٰذا ثاني ما قيل في سبب نزول هـٰذه الآية.
وعلى كل حال، سواء أكان هـٰذا سبب النزول أو غيره، الآيات واضحة في المعنى الذي دلت عليه، ومما يؤيد المعنى ما ذُكر من أسباب النزول، وقد أخذ شيخ الإسلام -رحمه الله- من قصة عمر في قتله المنافق جواز قتل المنافق، قال: فيه الدلالة على جواز قتل المنافق؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يُنْكِر على عمر قتله المنافق لما أعرض عن التحاكم إلى شرع الله، إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وطلب التحاكم إلى غيره، وبهـٰذا يكون قد انتهى هـٰذا الباب.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية النساء، وما فيها من الإعانة على فَهْم الطاغوت.
[الشرح]
وقوله: وما فيها من الإعانة على فَهم الطاغوت، فالآية بيَّنت أن كل من أعرض عن حكم الله وعن حكم رسوله فإنه قد تحاكم إلى الطاغوت، فالطاغوت : هو كل ما خالف أمر الله وأمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفي هـٰذه الآية كل من خالف حكم الله وحكم رسوله.
[المتن]
الثانية: تفسير آية البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ﴾.
الثالثة: تفسير آية الأعراف: ﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا﴾.
الرابعة: تفسير: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.
[الشرح]
تقدم هـٰذا.
[المتن]
الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
[الشرح]
أيضًا تقدم هـٰذا.
[المتن]
السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
[الشرح]
في قوله: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)).
[المتن]
السابعة : قصة عمر مع المنافق.
الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الشرح]
نعم، هـٰذا مأخوذ من الحديث أيضًا.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات
وقول الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ﴾( ).
وفي صحيح البخاري قال علي: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله؟).
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصفات، استنكارًا لذلك، فقال: (ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه) انتهى.
ولما سمعت قريش رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يذكر: (الرحمـٰن) أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ﴾.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات)
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن جحد الأسماء والصفات يُخِل بالتوحيد؛ لأنه من أثبت الأسماء والصفات كما جاء بها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمل توحيده؛ لأن بها يحصل تعظيم الله -جل وعلا- وبها تحصل محبته، والتعظيم والمحبة هما قطبا العبادة اللذان لا تستقيم العبادة إلا بهما.
أما مناسبته لما قبله: فلم يظهر لي مناسبة، وإنما هو انتقال إلى ذكر شيء مما يتعلق بالتوحيد وبحوثه، إلا أن يقال: إنه لما تقدم ذكر طاعة غير الله في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، وكذلك التحاكم إلى غير الله، وأن ذلك إخلال باسم الرب، وباسم الحَكَم، يمكن أن يُقال هـٰذا، على كلٍّ لم يظهر لي مناسبة واضحة بين هـٰذا الباب والذي قبله.
يقول رحمه الله في هـٰذا الباب: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات)
ولم يأت المؤلف رحمه الله بالحكم، وذلك أن جحد الأسماء والصفات ليس حكمه واحداً، بل يختلف حكمه باختلاف حال الجاحد، وباختلاف نوع الجَحد.
قوله رحمه الله: (مَنْ جحد) مَنْ: شرطية، وجحد: فعل الشرط، والجحود : هو الإنكار، هكذا عَرَّفه جماعة من العلماء، ولكنه في الحقيقة إنكار وزيادة، فالجحود يتضمن الإنكار وزيادة، حيث إنه يتضمن الاستكبار عن الانقياد والقبول.
وقوله رحمه الله: (شيئًا) نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء، سواء أكان الجَحدُ في قليل الأسماء والصفات أو في كثيرها.
وقوله رحمه الله: (الأسماء) جمع اسم، و(الصفات) جمع صفة، والمراد بالأسماء والصفات: أسماء الله وصفاته، (الأسماء) التي سمى بها نفسه، أو سماه بها رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، و(الصفات) هي التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، هـٰذا هو المراد بالأسماء والصفات.
والمؤلف رحمه الله، ذكر في هـٰذا الباب آيةً وآثارًا ، أما الآية فهي قول الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ﴾. وقبل أن نذكر أو نتكلم على ما ذكره المؤلف رحمه الله، نقول: إن الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته الأصل فيها التوقيف، فإن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يُسمى ولا يُوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه به رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، هـٰذا من القواعد الكلية فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات الوقوف فيها على خبر الله وخبر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأنها خبر عن غيب، والغيب لا مَدْخَل للعقل في إثباته ومعرفة تفاصيله، العقل قد يثبت الكمال المطلق، يثبت معنى الكمال لله جل وعلا، لكن تفاصيل هـٰذا الإثبات لا يمكن إدراكها إلا من طريق السمع، من طريق الوحي، من طريق الله -جل وعلا- وطريق رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وقد جاء في كتاب الله -عز وجل- وفي سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من البيان ما يشفي، وما تحصل به معرفة العبد لربه وتعظيمه له سبحانه وتعالى، ومن تجاوز الكتاب والسنة فقد خرج عن الصراط المستقيم؛ لأنه كل من خالف ما جاء في الكتاب وفي سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الباب -وفي غيره- فقد خرج عن الصراط المستقيم، ولكن في هـٰذا الباب بالذات؛ لأنه بابٌ غيبي موقوف على الخبر فإنه سبب للضلال والزيغ.
وجحد الأسماء والصفات على درجات: منها ما هو جحد للأسماء والصفات جميعًا، وهـٰذا مذهب الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، فلا يثبتون لله اسمًا ولا يثبتون لله صفًة.
ومن الجَحْد الذي يدخل في قوله رحمه الله: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات) ما عليه المعتزلة من جحد الصفات وإثبات الأسماء، حيث أثبتوا الأسماء وألغَوا الصفات. ويدخل أيضًا في هـٰذا الباب ما عليه بعض مثبتة الصفات من جَحْد بعض الصفات، حيث يُنكرون شيئًا من صفات الله عز وجل.
واعلم أن جحد الأسماء والصفات حقيقته جحد للذات، ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن الجهمية ليسوا من فرق الأمة الثلاث والسبعين؛ لأنهم جاحدون للرب، فقولهم في البدعة قولٌ شنيع، ولذلك أخرجهم جماعة من العلماء من أهل السنة والجماعة.
يقول رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ﴾ الآية.)
هـٰذه الآية في سورة الرعد، وتقدم ذكرَ هـٰذه الآية شيءٌ من نِعَم الله -جل وعلا- التي أنعم الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها على عباده، وإنعام الله جل وعلا على عباده يوجب قبول هـٰذه النعم، كما يوجب شكرها، ويوجب أيضًا التعبد له بها، بأن تُصرف فيما يحبه ويرضاه، هـٰذا هو الواجب في النعم: القبول، والشكر على هـٰذه النعم، وصرفها فيما يحب المُنْعِم. وجمع هـٰذه المعاني الثلاثة الشاعر في قوله:
أفادتـكم النعمـاء منِّي ثلاثة
يدي ولساني والضمير المحجبَا
اليد تعمل في هـٰذه النعمة بما يحبه المنعم، واللسان يلهج بالثناء على المنعم، والضمير المحجب هو القلب يشتغل بقبول هـٰذه النعم وحمده عليها والثناء على المنعم بها؛ لأن الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان.
وقوله: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ﴾ أي: إن الله -جل وعلا- قد أنعم عليهم بهـٰذه النعم المتنوعة في الأموال والأنفس بل ونِعَم الدين، وحالهم أنهم يكفرون بالرحمـٰن، وخص ذكر الرحمـٰن لأنهم كانوا ينكرون هـٰذا الاسم كما سيأتي فيما ذكره المؤلف -رحمه الله- في سبب نزول هـٰذه الآية، فبعض كفار قريش كانوا يجحدون اسم الرحمـٰن وينكرونه كما سيأتي في كلام المؤلف في آخر الباب، فذكر المؤلف -رحمه الله- هـٰذه الآية لما فيها من بيان أن جحد الأسماء والصفات هو طريق المشركين الذين عاندوا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فالآية تضمنت بيان ما عليه الكفار من جحد شيء من أسماء الله عز وجل، وجحد الاسم يتضمن جحد الصفة؛ لأن الاسم يتضمن الصفة، فإن كل اسم من أسماء الله -عز وجل- يتضمن معنى يجب إثباته كما يجب إثبات الاسم، فإذا نُفي الاسم انتفى المعنى المتضمن وهو الصفة.
قال رحمه الله: (وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكَذب الله ورسوله؟!).
هـٰذا الأثر عن علي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مليءٌ بالحكمة، وهو نظير ما جاء عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حيث قال: ما أنت محدثٌ قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وهـٰذا الأثر عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يبين لنا أن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- تلقوا عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقه تبليغ الدين تبليغ الرسالة، فإن الرسل يبلغون رسالات الله، لكن هـٰذا التبليغ ليس مجرد إلقاء للعلم والبلاغ دون رَوِية ولا حكمة ولا نظر فيما يُلقى وما يُعلم، قال الله -جل وعلا- في وصف سبيل الرسول: ﴿قُلْ هـٰذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَة﴾ٍ( ). ومن مقتضى البصيرة أن ينظر الإنسان موضع القول الذي يتكلم به: هل هو في محله أو لا؟ هل هو عند أهله أو لا؟ هل قوله مناسب أو لا؟ فعلي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يقول: (حدثوا الناس بما يعرفون) أي بما لا ينكرون، وليس المقصود حدثوهم بما علموه من قبل وكرروا عليهم العلم السابق فقط، بل (بما يعرفون) أي بما لا تنكره عقولهم، كما في حديث ابن مسعود: (ما أنت بِمُحَدِّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم) يعني لا تدركه عقولهم ولا تفهمه ولا تطيقه (إلا كان لبعضهم فتنة). فالمقصود بما يعرفون أي: تطيقه عقولهم، وبما لا ينكرون، وهـٰذا لا شك أنه يختلف باختلاف الناس، فالناس في هـٰذا الأمر ليسوا على درجة واحدة، فإن أفهامهم وعقولهم ومداركهم تختلف اختلافًا كبيرًا هو في الحقيقة أشد من اختلافهم في ألوَانِهم وأَبْشَارهم وألسنتهم وأجناسهم، إذ إنَّ الناس يختلفون في إدراك المعاني وإدراك الأمور اختلافًا بينًا، ثم علل هـٰذا التوجيه، أي ذكر علة هـٰذا التوجيه بقوله: (أتريدون أن يُكذب الله ورسوله؟). وهـٰذا هو الفتنة التي أشار إليها ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فيما رواه مسلم: (ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)، أو (إلا كان فتنة لبعضهم). فالمقصود بالفتنة، هو تكذيب أمر الله، وتكذيب قول الله ، وتكذيب قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإن الإنسان يعادي ما يجهل، وقد يضيق عقله عن إدراك أمرٍ فيرده، قد يضيق عقله عن إدراك أمر من الأمور فيرده، لا لأنه مردود في ذاته، ولكن لأن عقله لم يطقه، والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، فإن من الشرع ما لا تدرك العقول غايته وكنهه وحقيقته بل تحار فيه، وهـٰذا لا يعني أن العقول تحيله؛ لأن المُحال غير المَحار، ما تَحار فيه العقول غير ما تُحيله العقول، فما تَحار فيه العقول الناس فيه متفاوتون، قد يحار فيه شخص ويدركه آخر، أما ما تُحيله العقول فهو الممتنع الذي لا يمكن أن يقبله عقل، فالشريعة تأتي بمحَارَات، لكن لا تأتي بمُحالات، فقوله رحمه الله: (أتريدون أن يُكذب الله ورسوله؟) لا لأن الخبر يتضمن سبب التكذيب، لكن لكون الناظر في الخبر السامع للخبر قصُر فهمه وقصُر إدراكه عن استيعاب هـٰذا الأمر فرده. وقد سئل ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾( ) ما معنى ذلك؟ فقال للسائل: لو أجبتك لكفرت. ومراده بقوله: لكفرت، أي لكذبت فوقعت في الكفر، وهـٰذا فيه النظر إلى حال السامع وأنه يختلف الناس في إدراك معاني كلام الله عز وجل.
وقد فرح بهـٰذا الأثر -أثر علي بن أبي طالب، وأثر ابن مسعود وغيره من الآثار كأثر ابن عباس- بعض أهل البدع المنحرفين، كالصوفية الغلاة، والباطنية الفلاسفة، حيث قالوا: إن في الشريعة ما لا يُدرك معناه، وجعلوا ما هم عليه من باطل من تحريف كلام الله وتحريف كلام رسوله وتعطيل الشرائع مستندًا إلى هـٰذه الأقوال، وهـٰذه الأقوال ترد وتبطل هـٰذه الشُبه وهـٰذه الحُجج التي يحتجون بها؛ لأنهم قالوا في الاحتجاج لما هم عليه من باطل: إنكم لا تدركون ما نحن عليه، ولا نستطيع أن نبين لكم ذلك؛ لأنه إذا بُيِّن لكم ذلك حارت عقولكم وكان لكم فتنة، وكذبتم الله ورسوله، ولذلك لا نخبركم.
هكذا قال الفلاسفة، وهكذا قال غلاة الصوفية، وهكذا قال الباطنية في الاحتجاج على ما معهم من الباطل، ولكن هـٰذا الخبر وخبر ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يبين أن الممتنع من إخباره أو بيانه ليس قولاً خفي على الناس ولم يدركوه، بل هو قول الله وقول رسوله، ولذلك قال: (أتريدون أن يُكذب الله ورسوله؟). فليس الأمر مستورًا خفيّاً لا يُدرَك معناه، بل معناه واضح وهو بيان لقول الله وقول رسوله، لكن العِلة لا في القول ولا في المعنى، إنما العلة في الذهن والعقل الذي يسمع هـٰذا المعنى، فلذلك يُمتنع من بيانه حفظًا له من الفتنة، وقد ردّ عليهم شيخ الإسلام في مواضع عديدة في احتجاجهم بمثل هـٰذه الآثار، وبَيَّن أنها من المجملات التي لا تؤيد أقوالهم، بل فيها ما يبطل مزاعمهم.
كما أن هـٰذا الأثر يُستفاد منه أنه إذا كان في القول فتنة وضرر أعظم من المصلحة المرجوة فإنه ينبغي أن يُعرَض عن القول، ولو كان يفوت به بعض المصالح. وقد لَفَتَ ابن القيم -رحمه الله- إلى معنى جيد استفاده من هـٰذا الأثر ومن أثر ابن مسعود وهو الغيرة على العلم، قال: إن علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أفادا فائدة وهي: وجوب الغيرة على العلم، وهي أن لا يُبذَل العلم لمن لا يستحقه، أو لمن يضعه في غير موضعه، كأن يستفيد منه في التحايل على الشرع، فإن هـٰذا بذل للعلم في غير موضعه، فالعلم لم يُبذل ولم يتكلم به أهل العلم حتى يستفاد منه استباحة ما حرم الله، والتحَيُّل على أحكام الله، إنما بُذل لتصلح به القلوب، وتستقيم به أحوال الناس، فصيانة العلم بعدم بذله لمن يعجز عن فهمه، أو لمن يستعمله فيما لا يُفِيد بل فيما يضر، هـٰذا من الغيرة على العلم، وهو من حقوق العلم على حامله.
ثم قال رحمه الله: (وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصفات، استنكاراً لذلك.)
ابن عباس يُخبر أنه رأى رجلاً انتفض، والانتفاض: هو قريب من الرعشة، وهو الحركة التي تظهر عدم الرضا والاطمئنان للمسموع.
قال: (لما سمع حديثاً عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصفات، استنكاراً لذلك). هل هـٰذا السامع صحابي؟ الظاهر أنه ليس بصحابي؛ لأنه قال: (لما سمع حديثاً عن النبي). فلم يقل: لما سمع من النبي حديثًا، فالظاهر أنه ليس من الصحابة، بل إن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- لم يكن عندهم إشكال فيما يسمعونه من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل إذا أَشكَل عليهم شيء مباشرة سألوا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، كما جرى من عائشة ومن غيرها لما أشكل عليها شيء فيما يتعلق بالخبر عن الله بادروا إلى السؤال، فعائشة رضي الله عنها لما سمعت: ((من نوقش الحساب عُذب)). أشكل عليها هـٰذا فقالت: يا رسول الله كيف وقد قال الله جل وعلا: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً﴾؟ فقال لها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنما ذلك العرض)). يعني: إنما هـٰذا هو العرض، وأما من نُوقش الحساب عُذب، فهـٰذا ليس هو المراد بقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((من نوقش الحساب عُذب)).
وكذلك الشواهد على سؤال الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- فيما يشكل عليهم كثير لمن تتبعه، وقد جاء عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه أخبر بأن الله يضحك، فقال الصحابي وهو من الأعراب: ((أَوَيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: لا عدمنا الخير من رب يضحك)). هكذا كان الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- في تَقَبُّلِهم لما يخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الله عز وجل.
فقول ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثًا عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصفات استنكارًا لذلك، فقال: ما فَرَقَ هؤلاء؟). يعني: ما الذي يجعل هؤلاء يخافون ويضطربون ويبعدون عن القَبُول، ويصيبهم هـٰذا الذي وصف: (يجدون رقة عند محكمه) رقة: أي قبولاً واطمئناناً، (عند محكمه) أي عند محكم خبر الله وخبر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ويهلكون عند متشابهه) أي: يقعون في الهلاك عند المتشابه من قول الله وقول رسوله؟
وهـٰذا يفيدنا أن خبر الله وخبر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينقسم إلى قسمين: خبر محكم وخبر متشابه، والمحكم: هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً كقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾( ). والمتشابه: هو الذي يحتمل أكثر من معنى، يعني: النص الذي يحتمل أكثر من معنى فهو متشابه؛ لأنه يشتبه ما المراد؟ هل المراد هـٰذا أو المراد هـٰذا؟ هل المراد هـٰذا المعنى أو هـٰذا المعنى ؟ والواجب في المتشابه أن يرد إلى المحكم، وهـٰذا في كتاب الله وفي سنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
أما في الكتاب فقد قال الله عز وجل: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾( ). فَقَسَم الله جل وعلا الآيات إلى قسمين: محكمات هن أم الكتاب، أي المَرجِع، فأم الشيء: هو ما يرجع إليه، وأخر متشابهات: يعني فيها اشتباه، فهي محتملة لأكثر من معنى.
وكذلك السنة كما قال ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في هـٰذا الأثر. والواجب في المحكم الإيمان به، والواجب في المتشابه أن يُرد إلى المحكم ويفسر بالمحكم. مثال المحكم: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾( ). مثال المتشابه في هـٰذا الباب: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾( ). فإنّ الله -جل وعلا- أخبر عن نفسه بصيغة الجمع: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾ وهـٰذا خبر عنه بصيغة الجمع، فيحتمل أن يراد التعدد، ويحتمل أن يراد التعظيم، فالنص متشابه لأنه يحتمل احتمالين، فأي الاحتمالين نأخذ؟ هل نأخذ التعدد؟ أو نأخذ ما دل عليه المحكم من أنه واحد وأن الصيغة هنا الجمع للتعظيم لا للتعدد؟ الثاني، وهـٰذا معنى حَمْل المتشابه على المحكم، أي أن نَرُد المعاني المترددة في النص الواحد إلى ما دلت عليه النصوص المحكمة، هـٰذا معنى المحكم والمتشابه، فالواجب في المحكم قبوله والإيمان به، والواجب في المتشابه رده إلى المحكم وعدم ضرب بعضه ببعض، أي ضرب القرآن بعضه ببعض، أو النصوص بعضها ببعض.
ثم قال رحمه الله: (ولما سمعت قريش رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يذكر: (الرحمـٰن) أنكروا ذلك). أي أنكروا على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هـٰذه التسمية، وذلك كما جاء في عدة آثار: في صلح الحديبية أنه لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: لا نعرف هـٰذا، اكتب: باسمك اللهم، فنزل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عند قولهم؛ لأن الأمر في هـٰذا واسع، يعني الأمر فيه واسع من حيث كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، أو كتابة باسمك اللهم، فالبداءة باسم الله حاصلة بهـٰذا أو بهـٰذا، فلما كانت الصيغة التي اقترحوها صيغة صحيحة لا محذور فيها قَبِل، وإن كانوا هم الحامل لهم على تغيير الصيغة كفرهم باسم الرحمـٰن.
قال رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾( ) . أي يكفرون بالله عز وجل، والمقصود يكفرون بهـٰذا الاسم، فلا يثبتونه لله جل وعلا، انتهى الباب.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: عدم الإيمان بجَحد شيء من الأسماء والصفات.
[الشرح]
هـٰذا هو الواجب، الواجب الإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان بالأسماء والصفات ينقسم إلى قسمين:
إيمان مجمل: وهو الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه، وبكل وصفٍ وصف الله به نفسه، هـٰذا الأول.
وأما الثاني: فهو الإيمان المفصل، وهو أن يؤمن بكل اسم بلغه أنَّ الله سمى به نفسه، وبكل وصف بلغه أنَّ الله وصف به نفسه، وكذلك سماه به رسوله أو وصفه به رسوله.
الإيمان الأول واجب على كل أحد، الإيمان الثاني يختلف باختلاف أحوال الناس، نعم.
[المتن]
الثانية: تفسير آية الرعد.
[الشرح]
وهي قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾( ).
وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ بعد ذلك ماذا قال؟ ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾. فإنه بعد أن ذكر كفرهم بالرحمن بيَّن دليل إثبات هـٰذا الوصف لله عز وجل، حيث ذكر الربوبية والإلهية، بعد ذكر وصف الرحمـٰن: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَِ﴾ هـٰذا فيه ذكر الإلهية أو الربوبية؟ الإلهية ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ هـٰذا فيه ذكر الربوبية؛ لأن التوكل من متعلقات الربوبية. وهـٰذا نظير ما في سورة الفاتحة، حيث قال الله جل وعلا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (02) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾( ) فقدم ذكر الإلهية أولاً لأنها الأصل، ثم ثَنَّى بالربوبية لأنها من تمام توحيد الله -عز وجل- وإن كانت متَضَمَّنة في الإلهية.
بعد ذلك ذكر الوصف الذي يتعلق بالأمرين، يتعلق بالإلهية والربوبية وهو قوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. فلما ذكر الله -جل وعلا- إنكار المشركين والكفار في سورة الرعد لهـٰذه الصفة، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾. فإذا كنتم تقرون بأنه لا إله إلا هو، وأنه هو الرب -جل وعلا- فالواجب الإقرار له بهـٰذا الاسم وبما تضمنه من وصف: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي﴾ هـٰذا فيه إثبات الربوبية ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ﴾ هـٰذا فيه ذكر الإلهية ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ هـٰذا أيضًا عَود لذكر الربوبية كما ذكرنا ﴿وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾.
[المتن]
الثالثة: ترك التّحديث بما لا يفهم السامع.
[الشرح]
وذلك مستفاد من قول علي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذب الله ورسوله؟). فمن كان مُحَدِّثًا قومًا فلينظر هل حديثه تدركه عقولهم أو يعجزون عن فهمه؟ فإن كانت تدركه عقولهم فلا بأس، وإن كانوا يعجزون عن فهمه فينبغي له أن يترك الحديث، وليس هـٰذا في كل ما يُعَلَّم، يعني تعليم المبتدئين العلوم الشرعية قد لا تدركه عقولهم فيلقيه عليهم حتى يتمرنوا على فهمه؛ لأنه لا يترتب عليه فتنة، وفيه فائدة وهي: تَرَقِّيهم في التَّعَلُّم، بخلاف ما يترتب عليه فتنة كأن يتكلم معهم في أمر يُخشى عليهم بسببه أن يردوا خبر الله وخبر رسوله، أو يقع في قلوبهم شك أو زيغ، نعم.
[المتن]
الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المُنكر.
[الشرح]
ذكر العلة: أي السبب والحكمة والغاية من هـٰذا النهي أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المُنكر، يعني: ولو لم يتعمد المُنكر التكذيب؛ لأنه ليس قصده رد خبر الله وخبر رسوله، إنما قصده أن هـٰذا مما لا يقبله العقل ولا يدركه الفهم، نعم.
[المتن]
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك، وأنه أهلكه.
[الشرح]
في قوله: (يجدون رقة عند مُحكمه، ويَهلِكون عند متشابهه) والهلاك لا يلزم منه الكفر، إنما الهلاك هو مخالفة أمر الله وأمر رسوله، وهو الخطأ في فهم كلام الله وكلام رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثالث والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾( ).
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هـٰذا مالي، ورثته عن آبائي.
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا.
وقال ابن قتيبة: يقولون: هـٰذا بشفاعة آلهتنا.
وقال أبو العباس – بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: ((وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..)) الحديث، -وقد تقدم-: وهـٰذا كثير في الكتاب والسنة، يَذُم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، ويشرك به.
وقال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة، والملاح حاذقاً، ونحو ذلك مما هو جارٍ على ألسنة كثير.
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أنَّ نِعَم الله -جل وعلا- تُوجب تعظيمه، والإقرار بأنها منه، والشكر له عليها كما تقدم في الباب السابق، فإن موجَب نعم الله -جل وعلا- شكره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، والقيام بحقّه.
وقوله: ﴿نِعْمَتَ اللّهِ﴾ يشمل النِّعَم الدينية والنِّعَم الدنيوية، يعني: النعَم المتعلقة بالدين: الاستقامة والهداية، والنعَم المتعلقة بالأرزاق والأموال والولد، وكل ما هو من شأن الدنيا، فلمّا كان إنكار النعَم نقصًا في التوحيد ذكر المؤلف -رحمه الله- إنكار النعَم في هـٰذا الباب. وإنكار النعَم على درجات كما سيأتي في كلام المؤلف -رحمه الله-، منها: الإنكار الكلي، وهو بأن يضيفها إلى غير الله -عز وجل- خلقًا وإيجادًا، وهـٰذا كفر بالربوبية. ومنها: أن يضيفها إلى غير الله -عز وجل- على وجه السبب، وهـٰذا حكمه سيأتي في ثنايا ما ذكر المؤلف -رحمه الله- في الباب. ومنها: ما يذكر فيه السبب بعد إضافته إلى الله -جل وعلا- وعدم الغفلة عنه، وإنما يعتقد أنه سبب لولا أن الله يسره وقدره لما كان المُسَبَّب، ولما كانت النتيجة، فهـٰذا ليس بكفر، ولا شرك.
إذًا إنكار النعَم على درجات: منها ما هو كلّي، وذلك بإضافتها إلى غير الله خلقًا وإيجادًا، ومنها ما هو جزئي، وذلك بأن يضيفها إلى غير الله سببًا مع الغفلة عن الله -عزّ وجل- أو تسوية غير الله به.
ثم مناسبة هـٰذا الباب للباب الذي قبله: أن النعَم -نِعَم الله جل وعلا على خلقه- هي من مقتضيات الأسماء والصفات، فإن من تأمل أسماء الله -عز وجل- وصفاته وَجَدَ أنها مصدر كلّ خير، فما في الناس من نعمة فإنها منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولعل ذِكر المؤلف -رحمه الله- للنعم بعد ذكر جحد الكفار للرحمـٰن؛ لكون الرحمـٰن هو من أوسع الصفات التي توصل بها النعَم للخلق، فناسب أن يذكر المؤلف -رحمه الله- أن إنكار الأسماء سبب لإنكار النعَم، إنكار أسماء الله –عز وجل- يُفضي إلى إنكار النعَم، ولذلك الكفار لما أنكروا اسم الرحمـٰن أنكروا النعَم إما إنكارًا كليّاً، وإما إنكارًا جزئيّاً على ما سيأتي تفصيله وبيانه، هـٰذه مناسبة هـٰذا الباب لما قبله فيما يظهر والعلم عند الله.
قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾( ).)
هـٰذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل هي سورة النعَم؛ ذكر الله -جل وعلا- نِعَمَه على الخلق وإنعامه عليهم بأنواع متعددة، النعَم الدينية، والنعَم الدنيوية، أولها: نعمة الخلق، ثم نعمة التسخير، وقبل ذلك نعمة الهداية إلى الاستقامة وإلى الدين، وذكر أَجَلَّ النعَم وهي إنزال الوحي، وهـٰذه نعمة على الجميع لا شكّ، إلا أن المنتفع بها هم أهل الإيمان.
﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ أي: إنهم يعرفون هـٰذه النعمة، يعرفون من أَنعَم بها، ومن أين أتتهم، ثم هم بعد هـٰذه المعرفة التي تقتضي الإيمان، وتقتضي الإقرار أنكروها وكذّبوها، وإنكارها يكون بما ذكر المؤلف -رحمه الله- من الآثار.
قال مجاهد ما معناه -يعني: في بيان الآية-: (هو قول الرّجل: هـٰذا مالي ورثته عن آبائي). هـٰذا من إِنكار نعم الله -عز وجل- أن يضيف الإنسان النعمة لنفسه وينُكِر المنعم بها، فإن هؤلاء لما أَنعم الله عليهم بالمال لم يشكروا الله جل وعلا، بل قالوا: هـٰذا مالي، فأضافوه إلى أنفسهم، ثم بَيَّنوا أنه خير ورثوه عمن قبلهم، وهـٰذا فيه الغفلة عن نعمة الله -جل وعلا- وهو المُنعم الأول، المنعم الحقيقي الذي كل شيء منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، كل خير منه، وما عدا ذلك فهم أسباب قدّر الله -جل وعلا- وصول الخير من طريقها.
(هـٰذا مالي ورثته) أي: حَصَّلته ونِلتُه (عن آبائي) يعني: ورِثَه كابرًا عن كابر، وهـٰذا فيه إنكار نعمة الله جلّ وعلا، حيث إنه لم يذكر الله -جل وعلا- في هـٰذه النعمة.
(وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا.) هـٰذا أيضًا من إنكار نعمة الله أن تُضَاف النعمة إلى غيره، فإن إضافة النعمة أن تُضاف نعمة الله -جل وعلا- إلى غيره، فمن أضاف نعمة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إلى غيره استقلالاً، فإنه قد كفر نعمة الله -جل وعلا- وأنكرها، وكان الواجب عليه أن يقول: لولا الله لما كان كذا. هـٰذا أكمل الأحوال، فإن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هو المتفضل المنعم، فإن أراد أن يذكر السبب فليذكر السبب بعد ذكر الله -جل وعلا- مستعملاً في عطفه (ثم)، فيقول: لولا الله ثم فلان لم يكن كذا؛ لأنه يتَبيَّن من هـٰذا أن السبب نازل وأنه دون المُسَبب، أما ذكر السبب على وجه الاستقلال بأن يقول: لولا فلان لما كان كذا وكذا، أو لكان كذا وكذا، فهـٰذا إن كان سببًا حقيقيّاً سيأتي الكلام عليه، وإن كان سببًا غير حقيقي فإنه كذب وكفر بالنعمة. ثم إضافة النعمة لغير الله إذا كان سببًا حقيقيّاً فإما أن يضيفها على أنها من السبب إيجادًا، فهـٰذا كفر بالله عز وجل، وإما أن يضيفها إلى السبب على أنه سبب مع الغفلة عن المسبب فهـٰذا كفرٌ أصغر، شركٌ أصغر، وإما أن يضيفها إليه على وجه الاستقلال مع إقرار قلبه بأن الله هو مقدر الأشياء، وأنه المنعم بها، وأنه لم يذكره إلا على أنه سبب، لا يعتقد فيه أكثر من ذلك، فهـٰذا جائز، ومن العلماء من منعه.
إذًا الأحوال ثلاث:
أن يكون السبب صحيحاً، يعني: السبب صحيح إما في الشرع، وإما في الحِس، فإضافة الأمر أو الشيء إليه استقلالاً يعني: دون ذكر الله -جل وعلا- لها ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن يضيفها إليه على وجه الاستقلال اعتقادًا منه أنه مُوجِد للشّيء، فهـٰذا كفر وشرك أكبر، كما لو قال: لولا فلان لما كان كذا وكذا، فهـٰذا شرك، إذا كان يعتقد أن فلاناً هو الذي أوجد الشيء وخلقه، وأنه سببه الأساسي الأصلي الذي به وجد، فهـٰذا كفر بالله عز وجل.
الحال الثانية: أن يضيفها إليه على أنه سبب مع الغفلة عن المُسَبِّب الذي هو الله جل وعلا، الذي هو أصل كل شيء، فهـٰذا شرك أصغر، ويلتحق بهـٰذا ما لو أضاف إلى سبب غير حسي، يعني: سببًا غير صحيح، لا في الحس، ولا في الشرع، إذا أضاف إلى سبب غير صحيح لا في الحس ولا في الشرع، فإنه أيضًا شرك أصغر إذا اعتقده سببًا.
الحال الثالثة: أن يضيف إلى السبب الحقيقي على وجه الانفراد على أنّه سبب، مع أن قلبه ممتلئ بذكر الله جل وعلا، وأنه هو مسبب الأسباب، ومقدّر الأشياء، وأنه لولا إرادته وتقديره وخلقه لما كان، فهـٰذا حكمه فيه خلاف بين العلماء:
منهم من يرى عدم جواز إفراد السبب بالذكر، ولو كان سببًا صحيحًا.
ومنهم من يرى جواز ذلك.
وظاهر السّنة يدل على جواز ذلك، ومنه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث العباس لما سأله عن أبي طالب، لما سأل العباس رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن أبي طالب: ما نفعه؟ قال: ((إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)).
فقال: لولا أنا، ولم يقل: لولا الله ثم أنا، فهـٰذا فيه ذكر السبب الصحيح على وجه الاستقلال، لكن مع اعتقاد أن الله هو مُسَبِّب الأشياء ومقدّرها، وأنه لا خروج للعبد عن تقدير الله عز وجل، فهـٰذا لا بأس به، وهو جائز.
إذًا: الأقسام ثلاثة، وأما من منع فقد قال: إن نهي السلف في مثل هـٰذا يدل على أنه لا يُذكر السبب الصحيح استقلالاًًًًً، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.
ثم قال: (وقال ابن قتيبة: يقولون: هـٰذا بشفاعة آلهتنا.)
(هـٰذا) أي: ما هم فيه من نِعَم، وما حَصَّلُوه من خير.
(بشفاعة آلهتنا) أي: بتوسط آلهتهم التي يتوجهون إليها بالعبادة، ولا شك أن هـٰذا كفر بالله عز وجل، من أي أنواع الكفر؟ من الكفر الأكبر؛ لأنهم اتخذوا من دون الله آلهة، حيث قالوا: (هـٰذا بشفاعة آلهتنا).
(وقال أبو العباس بعد حديث) أبو العباس من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله:
(بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ((أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)) الحديث، وقد تقدم) أي ذكره في الأبواب السابقة، (وهـٰذا) المشار إليه إضافة النعَم إلى غير الله (كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره). فالإشارة إلى ذم إضافة نعمة الله إلى غيره، كما في حديث زيد بن خالد الجهني، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لأصحابه بعد صلاة الصبح على إثر سماء: ((قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي)) يعني بالله عز وجل ((كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) فمن أضاف النعمة إلى غير الله فهو كافر، وهو إما أن يكون كفرًا أكبر، وإما أن يكون أصغر على التّفصيل السابق، فإن كانت إضافة إيجاد وخلق يكون الكفر أكبر، وإن كانت إضافة سبب على وجه الاستقلال فهو كفر أصغر.
ثم قال: (وهـٰذا كثير في الكتاب والسنة، يذم –سبحانه- من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.)
يعني: إما إضافة استقلال، أو يذكر غيره معه على وجه التشريك.
(يضيف إنعامه إلى غيره) يقول: هـٰذا ببركة فلان، هـٰذا من النجم الفلاني، هـٰذا المطر بسبب الوسم الفلاني، أو الفصل الفلاني، هـٰذا من أي أنواع الشرك؟ هـٰذا من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ احتمال أكبر أو أصغر، لكن من أي أنواع المذموم؟ إضافة إنعام الله إلى غيره على وجه الاستقلال.
الثاني: أن يضيفه إلى غيره على وجه التّشريك، يقول: مطرنا بفضل الله، وبالنوء الفلاني، فهنا ذَكَرَ الله جل وعلا، وذكر معه غيره وهـٰذا شرك؛ لأنه ذكر معه غيره بما يفيد التسوية، وهو "الواو" التي تفيد التسوية، ولو أنه قال: مطرنا بفضل الله، ثم باستسقائنا لكان صحيحًا؛ لأن الاستسقاء سبب لنزول المطر، أما بفضل الله ثم بالنوء الفلاني، فالنوء ليس سببًا للمطر، فلا يصح إضافته لا على وجه الاستقلال، ولا على وجه التَّبَع.
(قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقًا) يعني: في سبب النجاة من مهالك البحار، كانت الريح طيبة والملاح حاذقًا فنجونا، ونحو ذلك مما هو جارٍ على ألسنة الناس.
وخلاصة هـٰذا أن ذكر السّبب ينقسم إلى قسمين:
• أن يذكر مع الله.
• وأن يذكر دونه.
إن ذُكر مع الله: فهنا لا يجوز عطف غير الله عليه إلا بـ "ثم" التي تفيد التراخي والترتيب، فلا يجوز أن تقول: لولا الله وفلان ما حصل كذا، بل لا بد أن تقول: لولا الله ثم فلان؛ لأنك إذا قلت: لولا الله وفلان فإنك سويت مع الله غيره، والله -جل وعلا- لا شريك له.
إذا قال: لولا الله ثم فلان صحيح.
عندنا حال ثالثة في هـٰذا القسم وهي: أن يأتي في العطف بالفاء: لولا الله ففلان: هـٰذه فيها وجهان، تحتمل الجواز وتحتمل التحريم:
تحتمل الجواز لكونها تفيد الترتيب؛ لأن لولا الله ففلان، ليست لولا الله وفلان، واضح أم لا يا إخوان؟
لكنها لا تفيد التراخي كما تفيده (ثم) ، ولذلك قال بعض العلماء: هي في المنع كالواو، والاحتياط أن يقال بالمنع، ولا يستعمل في هـٰذا إلا (ثم)؛ لأنها تفيد الترتيب والتأخُّر بلا منازعة، وتفيد الانفراد في حقّ الله -عز وجل- بالتقدم بلا منازعة. أما إذا ذُكر السّبب منفردًا فهنا له أحوال ثلاث:
الحال الأولى: أن يكون السبب منفردًا مع اعتقاد أنه مُوجِد، فهـٰذا ما حكمه؟ كفر ما درجته؟ أكبر؛ لأنه شرك في الربوبية، حيث اعتقد القائل أن غير الله يخلق كخلق الله، وهـٰذا كفر أكبر.
الحال الثانية: أن يذكره على وجه السبب مع الغفلة عن المسبب، عن الله، مع الغفلة عن الله جل وعلا، هـٰذا حكمه؟ أصغر.
الحال الثالثة: أن يذكره على أنه سبب مع امتلاء قلبه بأن الله هو مقدر الأشياء، وأنه موجدها، وأنه لولا الله لما كان، فهـٰذا فيه قولان:
الجواز، والمنع، والصحيح أنه جائز.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
[الشرح]
إنكارها يكون بإضافتها إلى غير الله -عز وجل- استقلالاً، وبتسوية غير الله معه فيها، هـٰذا كله من إنكار نعمة الله عز وجل.
[المتن]
الثانية: معرفة أن هـٰذا جارٍ على ألسنة كثير.
[الشرح]
وهـٰذا مأخوذ من قوله: (ونحو ذلك مما هو جارٍ على ألسنة كثير). فالواجب الاحتياط، إذا كان هـٰذا يجري على الألسنة كثيراً فالواجب أن يحتاط منه الإنسان؛ حتى لا يقع في لفظه ما يوهم سوء قصده.
[المتن]
الثالثة: تسمية هـٰذا الكلام إنكاراً للنعمة.
[الشرح]
وذلك أنهم أضافوا النعمة إلى غير الله حيث قالوا: (لولا فلان لم يكن كذا وكذا)، و: (هـٰذا مالي ورثته عن آبائي)، وما أشبه ذلك من الكلام الذي فيه إضافة النعمة إلى غير الله.
[المتن]
الرابعة: اجتماع الضّدين في القلب.
[الشرح]
حيث إن هؤلاء اعترفوا بنعمة الله -عز وجل- وعرفوها ثم أنكروها، وهـٰذان ضدان لا يجتمعان، هـٰذان ضدان الواجب ألا يجتمعا؛ لأن مقتضى الاعتراف بالنعَم لله عز وجل، وأنها منه أن يَعقُب ذلك تعظيمه، وعبادته وحده لا شريك له، فلمّا وقع خلاف ذلك دلّ ذلك على اجتماع الضدين في القلب، فهـٰذه الفائدة مستفادة من قوله: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ فهـٰذان ضدان: المعرفة والإنكار.
سؤال: هـٰذا يقول: شيخ لم نفهم التفريع السابق، نرجو حصر المسائل مع التمثيل لكل فرع؟
الجواب: ذكر السبب ينقسم إلى قسمين:
إما أن يذكر مع الله، وإما أن يذكر مستقلاًّ منفردًا.
مع الله تقول: لولا الله ثم كذا، تذكر السبب..واضح ، هنا ذكرت الله -جل وعلا- منفردًا أو معه شيء آخر؟ معه شيء آخر، فمثلاً: الإنسان يقول: لولا الله ثم اجتهادي في الدراسة ما نجحت، لولا الله ثم حرصي على حضور الحِلَق ما تعلمت، لولا الله ثم صبري على تحصيل العلم ما حصلتُه، هـٰذا كله ما هو؟ ذكر لله عز وجل، ومعه غيره، ذكر لله ومعه غيره.
الآن ما حكم هـٰذا القسم؟ حكم هـٰذا القسم أنك إذا ذكرت الله، وذكرت معه غيره فلا يخلو من أن تذكر ذلك بـ (ثم) وهـٰذا ما حكمه؟ جائز، تقول: لولا الله ثم صبري على تحصيل العلم ما حصلته، هـٰذا صحيح أم غير صحيح؟ صحيح.
أن تذكره مستعملاً الواو، تقول: لولا الله وصبري على تحصيل العلم ما حصلته، هـٰذا ما حكمه؟ هـٰذا لا يجوز، شرك؛ لأنه تسوية الله -جل وعلا- مع غيره، والواو تفيد التسوية، ولا يجوز ذكر الله مع غيره؛ لأن الله -جل وعلا- فوق كل شيء ذكرًا ومقامًا.
الثالث: أن تذكر الله -جل وعلا- مع غيره مستعملاً الفاء، تقول: لولا الله فصبري على تحصيل العلم ما حصلتُه، هـٰذا يحتمل وجهين:
الوجه الأول: الجواز؛ لأن الفاء تفيد الترتيب.
والوجه الثاني: المنع؛ لأنه لا يفيد ما تفيده (ثم) من التعقيب والتراخي، والرّاجح المنع.
القسم الثاني: أن يُذكَر السبب على وجه الانفراد، مثاله: لولا صبري على تحصيل العلم ما حصلته، هـٰذا إما أن يذكر السبب مع اعتقاد أنه الموجد الذي عنه صَدَرَ الشيء، وحصل به الشيء استقلالاً، فهـٰذا حكمه كفر أكبر؛ لأنك تعتقد أن غير الله يوجد ويخلق، وغير الله لا يوجد ولا يخلق، هـٰذا القسم الأول.
القسم الثاني: أن تذكر السبب مع الغفلة عن المسبب، فتقول: لولا اجتهادي وحرصي وبذلي في طلب العلم ما حصلته، مع غَفْلَتك عن أن الله -سبحانه وتعالى- هو الميسر للعلم، فلو لم ييسره ما تيسر، هـٰذا ما حكمه؟ شرك أصغر.
القسم الثالث: أن تذكر ذلك على وجه ذكر السبب مع اعتقاد أن الله هو مُقدر الأشياء ومُسببها، وأنه لولا الله لما كان الشيء، لكن هـٰذا هو السبب، فهـٰذا حكمه الجواز على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يذكر السبب مستقلاًّ.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾( )
قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله، وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هـٰذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلاناً هـٰذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
وعن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم.
وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً.
وعن حذيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)). رواه أبو داود بسند صحيح.
وجاء عن إبراهيم النخعي، أنه يكره: أعوذ بالله وبك، ويُجَوِّز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان.
[الشرح]
هـٰذا الباب صِلَة الباب السّابق من حيث ذكر أن كفر النعَم بإضافتها إلى غير الله -جل وعلا- حقيقته أنه يجعل غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ندّاً لله، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. )
مناسبة هـٰذا الباب للباب الذي قبله: أنه في الباب الذي قبله ذكر أن معرفة النعَم لا تكفي في حصول الإيمان بالله -عز وجل-، إنما لا بد -مع معرفتها أنها منه- من الإقرار بها له، وأن إضافتها إلى غيره يُفضي إلى أن يكون ذلك الغير ندّاً لله تعالى، وأمّا مناسبة هـٰذا لكتاب التوحيد فظاهرة.
قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً﴾.)
الله -جل وعلا- نهى النّاس بعد ذكر عظيم خَلقه وصنعه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وتيسيره، وما أنعم به عليهم في السمٰوات وفي الأرض، قال: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً﴾.
﴿أَنْدَاداً﴾ جمع ند، والند هو المثيل والنظير، والكفء والسوي، أليس كذلك؟ هـٰذا هو الند، فنهى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أن نجعل له أندادًا أمثالاً في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فيما يجب له من العبادة، وهـٰذا هو الشاهد في هـٰذه الآية، نهى الله أن نجعل له أمثالاً في العبادة، بأن نجعل غير الله مثل الله عز وجل، والنهي هنا ليس فقط عن الأعمال العِبَادِية، بل حتى عن الأقوال، فلا يجوز تسوية الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بغيره، لا في عَقدٍ ولا في قول، ولذلك ينهى عن تسوية غير الله بالله حتى في اللفظ، فلا يجوز أن تقول: لولا الله وفلان؛ لأنك إذا قلت: لولا الله وفلان فقد جعلت فلانًا ندّاً لله، وتعالى الله -جل وعلا- عن الأنداد.
﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: تعلمون أنه لا ند له، ولا نظير له، فهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الذي ليس مثله شيء كما قال جل وعلا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير﴾( ).
(قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل).
(الأنداد): عَرَّفَه بأنه الشرك، أي: أن يجعل غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- شريكًا له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. قال: (الأنداد هو الشرك أخفى): الشرك الخفي، (من دبيب النمل على صَفَاة سوداء في ظلمة الليل). والخفاء هنا خفاء الأثر، خفاء أثر النملة على الصفاة السوداء، إذ إن النملة لو مشت على رمل لخفي أثرها، فكيف إذا مشت على صفاة، حصى، حجر؟ فإن خفاء أثرها أوضح وأظهر، كما أن الخفاء هنا أيضًا للصوت، لكن الظاهر والعلم عند الله أن الخفاء المراد هو خفاء الأثر؛ لأنه قال: (على صفاة)، والصفاة لا يؤثر فيها سير النمل، ولا تحفظ أثره.
(سوداء) وهـٰذا يزيد في ظلمة الأثر، وذهابه وغيابه.
(في ظلمة الليل) وهـٰذا أيضًا مما يزيد الأمر خفاءً، فهي نملة على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وكل هـٰذه أسباب للخفاء، وما كان كذلك فالاحتراز منه في غاية المشقة، مما يوجب غاية الاحتياط والرقابة، وأن يكون الإنسان مراقبًا لقلبه وعمله وقوله.
ثم قال: (وهو أن تقول) ثم بَيَّن -رحمه الله- شيئًا من جعل غير الله ندّاً له، قال: (وهو أن تقول: والله)، أي: تحلف بالله سبحانه وتعالى، (وحياتك) يعني: وتحلف بغير الله، فالحلف بغير الله تسوية لهـٰذا الغير بالله؛ لأن الحلف لا يكون إلا بالله، فإذا قال الرجل للآخر: وحياتك، أي: حلف بحياة المخاطب، فإنه قد سَوَّى المخاطب بالله -عز وجل- وهـٰذا لا يجوز، وهو مما نهى الله عنه في قوله: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً﴾.
(يا فلان وحياتي) وحلف بحياته، فكذلك الحلف بحياة الشخص جعل نفسه ندّاً لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهكذا الحلف بكل أحد، ليس المقصود حياة معين أو حياة المتكلم، بل المقصود الحلف بغير الله، فلو قال: ورأسك، ورأس أبيك، والشرف، والنبي، وعلي، والحسين، وما أشبه ذلك مما يحلف به، فهـٰذا كله شرك لا يجوز، وهو مما نهى الله عنه بقوله: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. ولو قال القائل: أنا ما قصدت، قلبي نظيف، أنا مُوَحِّد، نقول: إذا نَظُفَ قلبك فنظف لسانك، طهر لسانك من الشرك؛ لأن الحلف بغير الله مهما كان قلبك موحدًا لا بد أن يكون مؤثرًا في قلبك هـٰذا الحلف بغير الله؛ لأنه لا يحلف الإنسان إلا بمعظّم، لا أحد من الناس يحلف بشيء إلا وهو عنده عظيم، ما أحد يحلف بالشيء الحقير، ما أحد يقول: والقلم الذي في يده، أو غير ذلك من المحقرات، لكن لا يحلف إلا بشيء عظيم عنده، وعند المحلوف له، فلذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط، وأن يعظم الله -جل وعلا- بأن يفرده بالحلف، فلا يجوز الحلف بغير الله.
(وتقول: لولا كليبة هـٰذا لأتانا اللصوص). أيضًا هـٰذا من جعل غير الله -عز وجل- ندّاً له، وهـٰذا يفيد عدم جواز ذكر السّبب استقلالاً، والجواب أن يقال: إن كان هـٰذا السبب صحيحًا فلا بأس بذكره استقلالاً، كما تقدم قبل قليل في الباب السابق، إذا كان السبب صحيحًا فيجوز ذكره إذا كان الإنسان قد ملأ قلبه بتعظيم الله عز وجل، وأنّ الله -جل وعلا- هو مُقَدر الأشياء ومسببها، وضربنا لهـٰذا مثالاً في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لولا أنا)). أَكمَل منه أن يذكر الله ثم يذكر معه السبب، فيقول: لولا الله ثم كذا، هـٰذا أكمل منه، لكن إذا ذكره استقلالاً هل نمنعه؟ الجواب: لا، لا نمنعه، ولا نقول: إن هـٰذا من الشرك.
(لولا كُلَيبَة هـٰذا لأتانا اللصوص.) الذين منعوا من ذكر السبب استقلالاً بعد (لولا) احتجوا بمثل هـٰذا، فإن الكلب قد يكون سببًا في منع اللصوص، أليس كذلك؟ إذا أتى اللص نبَحَ الكلب، فتنبه أهل الدار، فامتنع اللص من السرقة.
قال: (ولولا البط في الدار لأتى اللصوص). أيضًا البط إذا دخل غريب أصدر صوتًا، المهم إذا ذكر السبب الحقيقي فلا بأس به على الصحيح، والأكمل منه أن يذكر الله جل وعلا ثم يذكر بعده السبب.
(وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت). هـٰذا من التنديد، من التسوية، من تسوية الله بغيره، من تسوية غير الله به. واعلم أن التنديد آفة اليهود والنصارى، اليهود شبهوا الخالق بالخلق، فقالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾( ) وقالوا: إن الله بخيل: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾( ). فاليهود شبّهوا الله بخلقه، والنصارى شبهوا الخلق بالله، فجعلوا في الخلق من صفات الربوبية والإلهية ما لا يكون إلا لله عز وجل، فقالوا: المسيح ابن الله، وكل هـٰذا مما جاء النهي عنه في قوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. فلا يجوز أن يسوى الله بغيره لفظًا ولا عَقْدًا.
قال: (ما شاء الله وشئت) هـٰذا أيضًا من تسوية غير الله به؛ لأنه قال: ما شاء الله وشئت.
(وقول الرجل: لولا الله وفلان) هـٰذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الواو تفيد التّسوية، وتقتضي مساواة ما بعدها لما قبلها.
يقول: (لا تجعل فيها فلانًا) يعني: لا تجعل في هـٰذه الكلمة فلانًا، (بل قل: لولا الله).
(هـٰذا كله) أي: هـٰذه الألفاظ كلها، (به) أي: بالله عز وجل، (شرك) أي: إنها مما يدخل في قوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فلا يجوز شيء من هـٰذا كما تقدم.
ثم قال: (وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت) فهـٰذا أيضًا من جَعْل الأنداد لله عز وجل، وجه ذلك أنه سَوَّى غير الله -جل وعلا- بالله لفظًا، حيث إنّ الواو تفيد الجمع والتسوية بين المتعاطفات، فإذا قال الرّجل لصاحبه: (ما شاء الله وشئت) ففي هـٰذه الحال سَوَّى صاحبه بالله -عز وجل- في المشيئة، ولا شك أن هـٰذا لا يجوز؛ لأن مشيئة الله غالبة، قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾( ) .
فليست مشيئة الله كمشيئة غيره، بل مشيئة الله غالبة فوق كل مشيئة، فلا يُسَوى الله بغيره في هـٰذا، بل يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان، أو إذا قلت لرجل، قلت لصاحبك: ما شاء الله ثم شئت، وأفضل من ذلك أن تقول: ما شاء الله وحده كما سيأتي.
(وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانًا). لأن هـٰذا من تسوية الله بغيره، ولا يجوز تسوية الله بغيره لا عَقْدًا ولا لفظًا، لا عَقْدًا بالقلب، ولا لفظًا باللسان، فإن (الواو) كما ذكرنا تقتضي التسوية والجمع بين المتعاطفات، وشأن الله ليس كشأن غيره، بل شأن الله أعظم، فالله من وراء كل شيء، فهو محيط بكل شيء -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، لا يخرج شيء عن قدره، ولا عن مشيئته، ولا عن خلقه وإرادته.
(لا تجعل فيها فلانًا). أي: لا تسوِّ مع الله غيره، بل قل: لولا الله فقط، فإن أردت أن تذكر فلانًا فقل: لولا الله ثم فلان، كما في حديث الثلاثة: ((ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك)). فإنه لا بأس أن يذكر الإنسان السبب بعد الله عز وجل، لكن على وجه التأخر في اللفظ والرتبة، و (ثم) هي التي تفيد ذلك بلا لَبْسٍ ولا امتراء، فيأتي الإنسان بـ (ثم) التي تفيد التعقيب والتّرتيب.
قوله: (هـٰذا كله به شرك). أي: هـٰذا كله بالله -عز وجل- شرك، والشرك هنا إما أن يكون من الشرك الأصغر، وإما أن يكون من الشرك الأكبر؛ باعتبار ما يقوم في قلب قائل هـٰذه الكلمات:
فإن كان يريد تسوية غير الله بالله في التعظيم والعبادة فإنه شرك أكبر.
وإن كان يريد التسوية في اللفظ فقط مع اعتقاد تَقَدُّم الله على كل شيء فهـٰذا شرك في اللفظ يجب أن يُعَدِّلَه الإنسان إلى ما ينفي عنه شرك الألفاظ.
فقوله: (هـٰذا كله به شرك). يحتمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
قال رحمه الله: (رواه ابن أبي حاتم)
قال: (قال: وعن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من حلف بغير الله)) ) قرأنا هـٰذا.
قوله: (عن عمر بن الخطاب) الصحيح: أنه عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، فهـٰذا الحديث عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لا عن عمر، وفيه أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). (أو) هنا يحتمل أنها للشك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع، أي: إن ذلك كفر وشرك، والصحيح: أنها شك من الراوي، وقد جاءت في بعض الروايات مُبَيَّنة لا شك فيها: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)). وهـٰذا يُبين أن (أو) هنا للشك، وليست للتنويع.
قوله: ((من حلف بغير الله)). ((من)) شرطية، و((حلف بغير الله)) أي: أقسم بغير الله، فالحلف هو القسم بغير الله، وذلك أن يذكر غير الله في يمينه، في حلفه، في قسمه، بأن يقول: والكعبة، والنبي، وحياتي، وحياتك، وحياة الشيخ الفلاني، وعلي، وعيسى، والشرف، والأمانة، وما أشبه ذلك مما يحلف به الحالفون، فهـٰذا كله شرك، وهو يحتمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، يعني: يحتمل أن يكون شركًا أصغر، وأن يكون شركًا أكبر: فإن كان يعتقد أن المحَلوف به معظم كتعظيم الله -عز وجل- فهـٰذا شرك أكبر، إن كان الحالف يعتقد في المحلوف به أنه يستحق من التعظيم ما يستحقه الله -جل وعلا- فهـٰذا شرك أكبر يَخرج به صاحبه من الإسلام.
وأما إن كان يعتقد أن لا شريك لله في التعظيم، وإنما قاله على وجه الاعتياد، أو جرى به لسانه، أو أنه عظمه لكن ليس التعظيم الذي يختص به الله -عز وجل- فحلف به، فهـٰذا كله من الشرك الأصغر.
ومن العلماء من قال: إن الحلف بغير الله مكروه، وهـٰذا قول ضعيف، فإن الحديث واضح في بيان عظيم شأن الحلف بغير الله، وأنه كفر بالله -عز وجل- وشرك؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وفي الرواية الأخرى: ((فقد أشرك)). وهـٰذا يدل على أنه يعلو ويزيد على مرتبة الكبائر فضلاً عن أن يكون مكروهًا من المكروهات، فمن قال بأنه مكروه فقد أخطأ، والغريب أن هـٰذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لكن العبرة بالدليل لا بالرجال، فالدليل ظاهر في أنّ الحلف بغير الله شرك، وهو الذي عليه جمهور العلماء، فالحلف بغير الله لا شك في تحريمه، قد يكون شركًا أكبر، وقد يكون شركًا أصغر.
ومما يدخل في الحلف بغير الله الحلف بالطلاق والعتاق ، وما أشبه ذلك من الصِّيَغ، لكن هـٰذه الحُلوف والأقسام والأيمان التي يذكر فيها العتَاق والطلاق وما أشبه ذلك ليست حلفًا بغير الله مما يدخل في قوله: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))؛ لأن هـٰذه في معنى القَسَم، وليست قَسَمًا، فمن قال: عليَّ الطلاق، أو قال: عليَّ العتَاق، أي: عتَاق عبيدي أو مالي في سبيل الله، أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي هي في معنى القسم فإنه قد أقسم بالله، وحكم قوله حكم اليمين، أي: إنه إن حنث فإنه يلزمه الكفارة، وبعض العلماء يلزمه ما ذكره في قوله من طلاق أو عتَاق أو خروج من مال، أو غير ذلك، فإذا حنث طَلَقَت زوجته، وعَتق ماله، وهـٰذا مذهب جمهور العلماء، فالقول الذي يقصد فيه قائله الحث أو المنع، التصديق أو التكذيب، فهـٰذا يجري مجرى اليمين، وليس يمينًا إن لم يكن فيه حرف من حروف القسم (الواو) و(الباء) و(التاء). فقوله: عليَّ الطّلاق ليس قسمًا بالطلاق؛ ما قال: والطلاقِ، أو بالطلاقِ، أو تالطلاق، فإن هـٰذه هي القسم، أما هـٰذا فليس قسمًا، إنما هو جارٍ مجرى القسم، يعني: حكمه حكم القسم وليس قسمًا، ما حكمه؟ اختلف العلماء فيه على قولين:
منهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من قال: إنه ليس بمكروه، ولا يدخل في النهي عن الحلف بغير الله. والراجح ترك هـٰذا، وكراهيته، وأن الإنسان إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث ابن عمر: ((من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)). فحصر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القسم بالله عز وجل، وجعل مقابل ذلك الصمت، يعني: ترك القسم، ولكن هل هو من الشرك؟ الجواب: ليس من الشرك، فإذا قال: عليَّ الطلاق، أو العتَاق، أو ما أشبه ذلك لم يقع في الشرك.
هنا سؤال: وهو قول القائل: لعمري، أو لعمرك، هل هـٰذا قسم؟
من العلماء من يقول: هـٰذا قسم، وهو جائز؛ لمجيئه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعن بعض الصحابة، وأما الذي في القرآن ﴿لَعَمْرُكَ﴾( ) فهـٰذا لا يُستدل به؛ لأن الله أقسم بمن شـاء من خلقه، كقوله: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (01) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا﴾( ) ، وقوله: ﴿وَالضُّحَى (01) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾( ) وما إلى ذلك من الإقسامات التي أقسم الله -جل وعلا- فيها بخلقه، لكن جاء عن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، عن ابن عباس وعائشة، وغيرهما هـٰذا القَسَم فقالوا: إنه من الأقسام، وهو مستثنى من الحلف بغير الله.
والصحيح: أنه ليس قَسَمًا، إنما هو كلام جرى على لسان العرب يجري مجرى القسم، وليس قسمًا؛ لأنه خالٍ من أي شيء؟ خالٍ من حروف القسم، فاللام ليست من حروف القسم، إذًا: يجوز أن يقول الرجل لصاحبه: لعَمْرُك، هل هو قسم؟ الجواب: لا، إنما هو في معنى القسم، وليس قسمًا، في معنى القَسَم، يعني: تفيد القَسَم، لعَمْري: قَسَم، كلمة يراد بها تأكيد الكلام إثباتًا أو نفيًا، أو حثّاً أو منعًا.
ثم قال: (وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً). هـٰذا الكلام من ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فيه بيان عظيم الشرك، وأنه أعظم من كبائر الذنوب، فالحلف بغير الله شرك، ولو كان الإنسان صادقًا في يمينه، بارّاً في قسمه، لكن هـٰذا لم يشفع له- يعني: حسنة الصدق، والبر في اليمين-؛ لأنه وقع في الشرك الذي هو أعظم الظلم، لكنه لو حلف بالله على كذب لكان خيرًا له من أي شيء؟ من أن يحلف بغير الله صادقًا؛ لأنه يكون قد وقع في معصية وذنب؛ لأنه من كبائر الذنوب؛ لأنه كذب والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وهي اليمين الغموس أيضًا؛ لأنها حلف على كذب، ومع ذلك مع كونها غموسًا، وكذبًا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولو لم يكن فيها قسم، هي أهون عند ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- من أن يحلف بغير الله صادقًا، وهـٰذا يدل على أن الحلف بغير الله لا ينزل عن درجة المحرمات وكبائر الذنوب، فكيف يقال بأنه مكروه؟
ثم قال رحمه الله: (وعن حذيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)).) هـٰذا فيه التوجيه إلى إقامة القول في المشيئة، إذا أضاف مشيئة غير الله إلى الله أن لا يُسَوِّي بينهما باللفظ؛ بل يجب أن يُفاضل، وأن يُقدِّم مشيئة الله على مشيئة غيره، وأن يُؤخِّر مشيئة الخلق تأخيرًا واضحًا بـ (ثم) التي تفيد التّعقيب والتأخير والتراخي.
(لا تقولوا) هـٰذا نهي من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للأمة (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) وهـٰذا لا بأس به؛ لأن للعبد مشيئة، لكنها مشيئة متأخرة مغلوبة بمشيئة الله الغالبة التي هي فوق كل شيء: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾( ).
وهـٰذا ليس خاصّاً بالمشيئة فقط، بل في كل شيء تذكر فيه الله -عز وجل- مع غيره لا بد أن تأتي بـ (ثم) التي تفيد التعقيب والتأخير، يُشْكِل على هـٰذا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر طاعة الله وطاعة رسوله بالواو، والله -عز وجل- ذكر ذلك أيضًا في الكتاب، ذكر طاعة الله وطاعة رسوله وعطف بينهما بالواو، فهل هـٰذا يُشْكِل على هـٰذه القاعدة؟ فقول الخطيب: أطيعوا الله ورسوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾( ) ما قال: ثم أطيعوا الرسول، فالجواب على هـٰذا: أن طاعة الله هي طاعة رسوله، وطاعة رسوله هي طاعة الله، بخلاف المشيئة، فمشيئة العبد ليست مشيئة الله، لا يلزم أن تكون هي مشيئة الله؛ بل مشيئة الله غالبة، وأوسع من مشيئة العبد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فلذلك أجاز النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذِكر الطاعة بالواو، طاعة الرسول مع طاعة الله بالواو، ومنع ذِكر مشيئته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع مشيئة الله بالواو كما سيأتي في الباب الذي بعده.
يقول رحمه الله: (وجاء عن إبراهيم النّخعي، أنه يكره: أعوذ بالله وبك) الكراهية في كلام السلف تحمل على التحريم، يعني: ليست الكراهية التي لا يعاقب فاعلها؛ بل هي التي يلحق فاعلها الذنب والعقوبة، ليس فقط الذّنب؛ لأن الكراهة في كلام السلف تُحمل على التحريم، فقوله رحمه الله: (عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك) يعني: يمنع ويحرِّم (أعوذ بالله وبك)؛ لأنه تسوية الله -جل وعلا- بغيره، فإن كان ولا بد فليقل: أعوذ بالله ثم بك.
قال: (ويجوز أن يقول: بالله ثم بك)، أو ويُجَوِّز أن يقول: بالله ثم بك.
قال: (ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان). وهـٰذه تقدمت في أول الباب.
ذكر بعد ذلك المؤلف -رحمه الله- مسائل:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد.
[الشرح]
هـٰذه واضحة تقدّم الكلام عليها.
[المتن]
الثانية: أن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعمّ الأصغر.
[الشرح]
وهـٰذه فائدة عزيزة، وهي أن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- يفسرون الآيات الواردة في النهي والذم والتحذير من الشرك الأكبر ينزلونها على الشرك الأصغر، لماذا؟ لأن الشرك الأصغر درجة إلى الشِّرك الأكبر ووسيلة إليه، والوسائل لها أحكام المقاصد.
[المتن]
الثالثة: أنَّ الحلف بغير الله شرك.
[الشرح]
هـٰذه واضحة، الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((من حلف بغير الله فقد أشرك)).
[المتن]
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا، فهو أكبر من اليمين الغموس.
[الشرح]
وهـٰذا يدلّ على أنه من أعظم الكبائر إن لم يكن من الشرك؛ بل هو من الشرك كما دلت النصوص الأخرى، يعني: هـٰذا يدلّ على أنه في الجُرم والذنب أعظم من اليمين الغموس، واليمين الغموس من الكبائر، فهو لا يقْصُر عن درجة الكبائر، ثم جاء الحديث وبيّن أنه من الشرك حيث قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)).
[المتن]
الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
[الشرح]
وهـٰذا الفرق لا بد منه، ولا يظن ظانٌّ أن هـٰذا فرق لفظي لا اعتبار له، لو كان لا اعتبار له لما نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القائل: (ما شاء الله وشئت) عن هـٰذا القول، ولما وجهه إلى قوله: (ما شاء الله ثم شئت).
بعض الناس يقول: أنتم تتشددون في الألفاظ، والمسألة والعُمْدة على ما في القلب.
والجواب على هـٰذا الهراء أن يقال: لسنا أعلم بالله من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَمَى حِمَى التوحيد غاية الحماية، وصانه غاية الصيانة، فنهى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن مثل هـٰذه الألفاظ، ولم ينهَ عنها إلا لأنها سوء أدب مع الله إما في القول، وإما في العَقْد؛ لأنه لا يمكن أن يكون هـٰذا القول مجردًا عن نوع اعتقاد، فالألفاظ تُبِينُ عن المعاني وتدل عليها، وهـٰذه الألفاظ تدل على التشريك والتسوية، فهي تدل على نوع خلل في التوحيد، ولذلك نهى عنها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والواجب على المؤمن أن يتحرى في لفظه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) فإذا كان الإنسان يعجز عن تحرير ألفاظه فليصمت؛ لأنه ليس له خِيَار في أن يتكلم بما شاء، بل يجب عليه أن يحرّر ألفاظه، وأن يَقِيَها الوقوع في الشرك، ولو كان قلبه سليمًا، فإن عجز فعليه بوصية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فليصمت: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)).
¹
[الأسئلة]
سؤال (01): يقول: قولنا: (لعَمْري) هل تقدر؟ فنقول: (والله لعمري) فيدخل في أحكام القسم؟
الجواب: هو جارٍ مجرى القسم، وله حكم القسم، لكن لا حاجة إلى هـٰذا التقدير، لا نحتاج إلى هـٰذا التقدير.
سؤال (02): ما حكم قول: عليَّ الحرام؟
الجواب: قول: عليَّ الحرام مثل (عليَّ الطلاق) هو جارٍ مجرى القسم.
سؤال (03): لقد قلت في هـٰذا الدرس: إن قول: (لعمري) جائز مع أنها تفيد القسم.
السؤال: أليس الترك أولى؟
الجواب: لا، ليس الترك أولى؛ لأنه جاء عن السلف، عن الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، والصحابة أشد منا تعظيمًا لله، وحفظًا للتوحيد.
سؤال (04): لقد أفتيتمونا أنه يجوز أن نقرن بين طاعة الله وطاعة رسوله، فهل يُقَاس على ذلك طاعة الوالدين، وما حكم قول العامة عند التعجب: يا وجه الله الجليل؟
الجواب: أما طاعة الوالدين فليست كطاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا تقاس عليه.
الآن بعض العلماء يقول: إن قوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾( ).
قالوا: إنها منسوخة، منسوخة بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا تقولوا: ما شاء الله وشئت، وإنما قولوا: ما شاء الله ثم شئت)). والصّحيح عدم النسخ؛ لأن الشكر هنا لا يَلتَبِس، فشكر الله عبادة تشمل جميع العبادات، وأما الوالدان فشكرهما لا يلتبس بشكر الله؛ لأن شكرهما مُبَيَّن، وهو الإحسان إليهما، والقيام بحقهما من البر، فلا التِبَاس.
أما سؤاله عن: (يا وجه الله) فالواجب ترك هـٰذا؛ لأن دعاء الصفات لا يجوز، بل هو من الشرك بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لكن في قول القائل: (يا وجه الله) أخف من قول: يا رحمة الله، أو يا سمع الله، وما أشبه ذلك، لماذا؟ لأن الوجه يُعبَر به عن الذات.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء فيمن لم يَقْنَع بالحلف بالله
عن ابن عمر، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله)). رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
[الشرح]
قال رحمه الله: (باب ما جاء فيمن لم يَقْنَع بالحلف بالله.)
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد واضحة؛ لأن من لم يَقْنَع بالحلف بالله فإنه ناقص التوحيد، إما نقص تعظيم إذا لم يرض بالله، وإما نقص شرك إذا طلب من الحالف أن يحلف بغير الله؛ لأن من لم يَقْنَع بالحلف بالله يحتمل معنيين:
المعنى الأول: أن يُحلَف له بالله ولا يرضى، ما يصدّق الحالف مع قيام علامات صدقه، يقول له شخص: والله ما فعلت كذا، ثم هو يقول: ما عليك ما صدقتك، هـٰذا لم يرض، ولو كان قلبه مليئًا بتعظيم الله لقبل يمينه؛ لأنّه من تعظيم الله أن يقبل اليمين به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
الصورة الثانية التي تدخل في عدم القناعة بالحلف بالله: أن يقول له: والله ما فعلت كذا، يقول: يا أخي لا، احلف بالنبي، احلف بالولي الفلاني، احلف بالكعبة، احلف بجبريل، احلف بعلي؛ لأنه عنده أن الحلف بهؤلاء أعظم من الحلف بالله، فهـٰذا لم يَقْنَع بالحلف بالله، وهـٰذا أعظم من الأول، الأول نقص في التّعظيم، وهو معصية، والثاني: شرك بالله العظيم؛ لأنه لم يرض بالحلف بالله.
فقول المؤلف: (باب ما جاء فيمن لم يَقْنَع بالحلف بالله) يشمل الصّورتين، فمناسبته لكتاب التوحيد واضحة.
أما مناسبة هـٰذا لما قبله: فما قبله تضمّن النهي عن التنديد بالله -عز وجل- في قوله: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾( ). ومن ذلك الحلف بغير الله تعالى، فجاء هنا ليبين أن من طلب الحلف بغير الله فإنه ليس من الشرك.
قال رحمه الله: (عن ابن عمر، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تحلفوا بآبائكم)).) وهـٰذا نهي عن الحلف بالآباء، وقد كان جاريًا في كلام العرب الحلف بالآباء؛ لتعظيم العرب لآبائها، فنهاهم الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك، ثم وجههم فقال: ((من حلف بالله فليصدق)). وهـٰذا فيه البيان أن الواجب الحلف بالله؛ لأنه لما نهى عن الحلف بالآباء، وذكر أن من حلف بالله فليصدق بين وجوب الحلف بالله، وأن من كان حالفًا فليحلف بالله كما جاء في الأحاديث: ((من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)).
((من حلف بالله فليصدق)). هـٰذا بيان ما يجب على الحالف، فدلّت هـٰذه الجملة أنّ الحالف يجب عليه أمران:
الأمر الأول: أن يحلف بالله دون غيره إذا أراد الحلف.
الثاني: أن يكون حَلِفُه على صدق، والصّدق هو مطابقة الواقع، فالواجب على من حلف بالله أن يتحرّى الصدق، وأن يحلف على ما هو مطابق للواقع، فإنّ تَرْك مطابقة الواقع في الحلف من امتهان الله عز وجل، ولذلك كانت غَمُوسًا تغمس صاحبها في النار نعوذ بالله؛ لشدة ما تضمّنته من ضعف التّعظيم، وقلّة تقدير الله –جل وعلا- في قلب الحالف، ومن النّاس من الحلف على طرف لسانه في الكذب والصدق، في الدقيق والجليل، وهـٰذا مخالف لما أمر الله -جل وعلا- به من حفظ الأيمان.
ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في توجيه المحلوف له: ((ومن حُلِفَ له بالله فليرض)) أي: فلا يطلب زيادة على الحلف بالله؛ بل يقتصر فلا يقول: احلف بالله الرحمـٰن الرحيم الملك القدوس السلام العزيز، إلى آخره من أسماء الله عز وجل، بل يقتصر على الحلف بالله، فإنه كافٍ في تحقيق وتأكيد المحلوف عليه، كذلك ما يطلب منه الحلف بغير الله، كأن يقول له: احلف بالكعبة، بالنبي، بحياة فلان، بالأمانة، وما أشبه ذلك.
أيضًا: من حُلِفَ له بالله فليرض: يشمل تصديق الحالف في كلامه إن لم تدل القرينة على كذبه، فإن دلت القرينة على كذبه، فإنه لا يلزمه الرضا بيمينه، كما قال الله -جل وعلا- في المنافقين: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾( ) وهـٰذا يدل على عدم وجوب الرضا بأيمانهم، فدل هـٰذا كما هو واضح في الآية على أي شيء؟ على أنه لا يلزم الرضا بيمين من قامت القرينة على كذبه في يمينه، ولكن إن قَبِل الإنسان فيما يتعلق بالحقوق يمين المُقسِم لكان أحسن، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل منهم أيمانهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل.
ثم قال: ((ومن لم يرض)) أي: من لم يرض بالحلف بالله إما لفظًا بأن طلب غيره، أو تصديقًا مع قيام القرينة على صدق الحالف ((فليس من الله)). وهـٰذا فيه أشد التحذير والتنفير من هـٰذا الأمر، ويدل على أنه من الكبائر، وهو أشد من نفي الإيمان، ومن براءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يعني: هـٰذا القول قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فليس من الله)) أشد من قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ليس منا))، ((من غشنا فليس منا))، وأشد من قوله: ((من رغب عن سنتي فليس مني)) وما أشبه ذلك: ((لا يؤمن أحدكم)) هـٰذا أشد ما وَرَد فيما يتعلّق بالكبائر؛ لأن براءة الله من العبد أعظم من براءة غيره، أعظم من نفي الإيمان، وتدل على قُرْبِ الحرمان والخسران من المُتبرأ منه، لكن لا يدل على الكفر.
(رواه ابن ماجه بسند حسن). والحديث كما قال -رحمه الله- حديث حسن، حسنه جماعة من العلماء.
هل هـٰذا الحديث خاص بالدعاوى والخصومات؟
الجواب: حمله بعض أهل العلم على ذلك، والحديث أوسع من هـٰذا، يشمل الدّعاوى والخصومات، ويشمل غيرها من المحلوف عليه، ولو لم تكن دعوى ولو لم تكن خصومة.
ثم قال رحمه الله:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
[الشرح]
هـٰذا واضح.
[المتن]
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
[الشرح]
في قوله: ((ومن حُلِفَ لَهُ بِالله فَليرض)).
[المتن]
الثالثة: وعيد من لم يرضَ.
[الشرح]
واضح في قوله: ((ومن لم يرض فليس من الله)).
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الرابع والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول: ما شاء الله وشئت
عن قتيلة، أن يهوديّاً أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة))، وأن يقولوا: ((ما شاء ثم شئت)). رواه النسائي وصححه.
وله أيضاً عن ابن عباس: أن رجلاً قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما شاء الله وشئت. فقال: ((أجعلتني لله ندّاً؟ ما شاء الله وحده)).
ولابن ماجه عن الطفيـل أخـي عائشة لأمهـا قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوا: وأنتم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبرته. قال: ((هل أخبرت بها أحداً؟)). قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤيا، أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)).
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب قول: ما شاء الله وشئت.)
أي: حكم هـٰذا القول، ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأنّ هـٰذا القول يُخِلّ بالتوحيد، فهو من الشرك إما من الشرك الأصغر، وإما من الشرك الأكبر، فهو من التنديد بالله عزّ وجل، أي: من جعل الأنداد له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وأما مناسبته للباب الذي قبله: فإنه من جنس الباب السّابق في أنه متضمن لما فيه تعظيم غير الله، تسوية الله بغيره، فإن من حَلَفَ بغير الله فقد سواه بالله عز وجل، وكذلك من ذَكَر مع الله غيره على هـٰذا الوجه، وهو وجه التسوية باستعمال حرف الواو، فإنه يكون قد سَوَّى مع الله غيره.
ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب ثلاثة أحاديث كلها تدلّ على معنًى واحد، وهو النهي عن قول: ما شاء الله وشئت، النّهي عن تسوية غير الله بالله في المشيئة، كلّها تدل على هـٰذا المعنى، وإنّما أكثر المؤلف -رحمه الله- من الآثار الدّالة على هـٰذا المعنى، مع أنّ واحدًا من هـٰذه الأحاديث يكفي لإثبات الحكم، هـٰذا لحاجة الناس إلى تقرير هـٰذا المعنى، وأنه مما يجري على ألسنة النّاس كثيرًا أن يسووا غير الله به، فالواجب الاحتراز، والتحفّظ، والعناية.
يقول رحمه الله: (عن قُتَيلَة) قُتَيلَة: امرأة من جهينة، وهي إحدى الصحابيات، قُتَيلَة بنت صفي -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، قالت: (أن يهوديّاً أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). ولم يبين في هـٰذا الحديث من هو اليهودي، وفي بعض الروايات أنه حَبْرٌ من أحبار اليهود، أي: عالم من علمائهم، أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: (إنكم تشركون). وهـٰذه جراءة، وإنما كان منه ذلك لِعِلْمِه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقبل الحق ممن جاء به، ولذلك تجرأ بوصف ما يقع من المسلمين بالشرك، فقال: (إنكم تشركون). وهـٰذا إجمال، ثم بَيَّن فقال: (تقولون: ما شاء الله وشئت). أي: في مخاطبتكم بعضكم بعضاً، أو في مخاطبة أصحابك لك، فيقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، أو أنهم رضي الله عنهم كانوا يقولون هـٰذا للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .(وتقولون: والكعبة). أي: في الحلف واليمين، (فأمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة))، وأن يقولوا: ((ما شاء الله ثم شئت))). وهـٰذا فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقر الحَبر فيما ذكره من أن هـٰذا من الشرك، حيث إنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يَرُد على اليهودي مقَالته، بل أمر المسلمين بأن ينتهوا عمّا فيه شرك، فأمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، أي: يحلفوا برب الكعبة، لا بالكعبة، فإن الكعبة مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا يجوز الحلف به، وإن كانت معظمة، لكنه تعظيم من تعظيم الله -جل وعلا-؛ لأن الله عظم شأنها، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله مهما كان المحلوف به له من المكانة والعظمة عند رب العالمين، فهـٰذا شأن والحلف واليمين شأن آخر، فلا يُجَوِّز تعظيم الله للشيء أن يُحْلَف به؛ لأن الحلف حق لله جل وعلا، كما تقدم في الأحاديث السابقة في الأبواب المتقدمة. والشّرك الذي أخبر به هـٰذا اليهودي، وأقرّه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحتمل أن يكون الشرك الأكبر، ويحتمل أن يكون الشرك الأصغر، لكن الظّاهر أنه شرك أصغر؛ لأنّه لا يمكن أن يكون من الشرك الأكبر ويكون النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد تركه وغفل عنه، إنما هو من الشرك الجاري في الألفاظ دون إرادة التسوية بالرب -جل وعلا- من كل وجه، فإنَّ هـٰذا لم يكن منهم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، (أمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة)).) رب: خالق، ويمكن أن يكون بمعنى صاحب؛ لأن الكعبة بيت الله جل وعلا، فالإضافة هنا إضافة خلق، وإضافة تشريف، وإضافة صُحبة، فالله هو صاحب هـٰذا البيت. (وأن يقولوا: ((ما شاء الله ثم شئت)).) وهـٰذا يدل على أن (ثم) تفيد التعقيب والتراخي، وأنها ليست كالواو في المعنى، وإن كانت تتفق مع الواو في أنها تفيد العطف، لكنه عطف مع التراخي والتعقيب ونزول الرتبة.
قال رحمه الله: (رواه النسائي وصححه). وهو كما قال، فالحديث صححه جماعة من العلماء.
يقول رحمه الله: (وله) أي: للنسائي (أيضًا عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أن رجلاً قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ما شاء الله وشئت). فَسَوَّى بين مشيئة الله وبين مشيئة المُخَاطَب الذي هو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، (فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منكرًا عليه: ((أجعلتني لله ندّاً؟)) ) أي: نظيرًا ومثيلاً، ومساويًا، ومكافئًا؛ حيث سَوَّى مشيئته بمشيئة رب العالمين الذي غلبت مشيئته المشيئات سبحانه وبحمده، قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((بل ما شاء الله وحده)). وهـٰذا أعلى الدّرجات في ذكر المشيئة أن تذكر مشيئة الله وحده سبحانه وبحمده؛ لأن مشيئته غالبة على كل شيء.
المرتبة الثانية: أن يأتي بمشيئة غيره معه على وجه العطف بأن يقول: ما شاء الله ثم شئت، لكن الدرجة الأولى هي ما وَجَّه إليه في هـٰذا الحديث. وهـٰذا الحديث رواه النسائي -رحمه الله- من طريق الأجلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. والأجلح مختلف فيه: ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وجماعة، وصحح حديثه ابن معين وغيره، إلا أن الحديث على كل حال -بغض النظر عن الأجلح بن عبد الله- الحديث ثابت؛ لأن ما تضمنه دلت عليه أحاديث كثيرة، فهو قوي بشواهده.
قال رحمه الله: (ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها). أي: روى ابن ماجه عن الطفيل، و(الطفيل) هو: ابن سخبرة، (أخي عائشة لأمها) أي: إنه أخوها لأمها، وأمها من هي؟ أم رومَان، كانت زوجة لسخبرة والد الطفيل، قدم إلى مكة فمات، فتزوجها أبو بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، تزوج أم رومَان فأتت له بولدين: عائشة وعبد الرحمـٰن.
يقول الطفيل -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود). رأيت: يعني في المنام (كأني أتيت على نفر) يعني: جماعة (من اليهود قُلْتُ: إنكم) أي: القائل الطفيل (إنكم لأنتم القوم) على وجه الثناء والمدح، يعني: أنتم أنتم، (لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله) وقـولهم هـٰذا ذكره الله في القرآن حيث قال: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾( ). فأضافوا بنوة العزير إلى الله جل وعلا. (قالوا) أي: أجابه اليهود، (قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد). يعني: أنتم القوم في توحيدكم وإخلاصكم واستقامة منهجكم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. واليهود قومٌ بُهْت، أصحاب ظلم في اليقظة والمنام، إذ لا سواء بين قول الصحابة: ما شاء الله وشاء محمد، وبين قولهم: عزير ابن الله، أيهما أعظم؟ قولهم عزير ابن الله أعظم ولا مقارنة، قال الله جل وعلا: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً(91) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (92)﴾( ). هـٰذا في قول النصارى في عيسى ابن مريم: إنه ابن الله، ونظيره قولهم، فهـٰذا التعظيم من رب العالمين في قولهم يُبَيِّن أنه قول عظيم، حيث وصفهم الله –جل وعلا- هـٰذا الوصف من الفظاعة والشدة والغلظة، فلا سواء بين قول الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-: ما شاء الله وشاء محمد، وهو نوع من التسوية اللفظية، وبين قول اليهود: عزير ابن الله.
ثم قال: (ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم) أي: في الاستقامة، وصلاح الدين (لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد). فأجابوا بنظير ما أجاب اليهود.
يقول: (فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت). أخبرت بهـٰذه الرؤيا مَنْ أخبرت مِنْ أهلي وأصحابي. (ثم أتيت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبرته) أي: بما رأيت (فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هل أخبرت بها أحدًا؟)) قلت: نعم).
لماذا سأل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ الله أعلم، لكن قد يشعر هـٰذا بأن مثل هـٰذه الرؤيا ينبغي أن لا يستعجل الإنسان في إشاعتها، قد يُشعر هـٰذا ولا نجزم، لكن تأملتُ في سبب سؤال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للطفيل، عن سبب سؤاله إياه هل أخبر أحدًا أو لا، ما سبب هـٰذا القول، وما سبب هـٰذا السؤال؟ فلم يبدُ لي إلا هـٰذا والعلم عند الله، إذا وقف أحدكم على شيء يفيدنا.
المهم: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل: ( ((هل أخبرت بها أحدًا؟)) قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد)) ). (حمد الله وأثنى عليه) هـٰذا شأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مُقَدَّم كلامه العلم فإنه لا يبدأ خطابًا إلا بهـٰذا، و(حمد الله) وهو بالصيغة المتيسرة، والمحفوظ عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه علمهم خطبة الحاجة: ((الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره)). كما في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، ولعله غاير بين الصيغ، لكن هـٰذا هو المشهور المحفوظ.
(حمد الله وأثنى عليه) الثناء هو: تكرار الحمد، فالثناء المراد به: الإطناب، وتكرار حمد الله عز وجل.
(قال: ((أما بعد)) ) هـٰذه كلمة يؤتى بها للفصل بين مُقَدَّم الحديث وبين المقصود منه؛ لأن الحديث يُبْتَدأ عادةً بحمد وثناء، ثم إذا أراد المتكلم أن يَلِجَ فيما يريد الحديث عنه أتى بـ ((أما بعد))، وهي جملة شرطية، ولذلك ما بعدها تتمته، جواب الشرط فيها في قوله: ((فإن)) ولذلك ما بعد ((أما بعد)) الغالب أن يقترن بالفاء، فيخطئ من يقول: ((أما بعد)) إن كذا وكذا، يخطئ لغةً، والصواب أن يقول : أما بعد فإن، أما بعد فكذا، لا بد من الفاء الرابطة للجواب.
تقدير ((أما بعد)): مهما يكن من شيء فإن طفيلاً، هـٰذا معنى ((أما بعد)): مهما يكن من شيء ((فإن طفيلاً رأى رؤيا))، أخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرؤيا، ولعل هـٰذا من الأحاديث القلائل التي يخبر فيها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برؤيا صحابي، ولكن أخبر بالرؤيا لأنها مُمَهِّدة لما يريد أن يصل إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من بيان الحكم.
قال: ((فإن طفيلاً)) وهو أحد الصحابة ((رأى رؤيا)) وحكم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأنها رؤيا، والرؤيا من الله، فدل ذلك على أن ما رآه حق. ((أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها)). أبهم في هـٰذه الرواية سبب امتناع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الإنكار عليهم، وبين ذلك في رواية أحمد والطبراني حيث قال: ((كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها)). والحياء الذي منعه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أن ينهاهم، هل هو الحياء المذموم؟ الجواب: لا، الحياء المحمود، وهو ألا يقول على الله بغير علم، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يُوح إليه في شأن هـٰذه الكلمة بشيء، ولذلك لم ينه الصحابة عن هـٰذه الكلمة، وإلا فإن الله لا يستحيي من الحق، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أثنى على نساء الأنصار أنهن لم يمنعهن الحياء من التّفقه في الدين، فدلّ ذلك على أن الحياء الذي يمنع من التفقه في الدين مذموم، فكيف بالحياء الذي يمنع من تبليغ الدِّين؟ هو مذموم، وأشد ذمّاً؛ لأن التبليغ واجب، لا سيما على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي أمره الله عز وجل في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾( ). فأمره الله جل وعلا بتبليغ الرسالة، فالحياء الذي منعه في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رواية الإمام أحمد: ((كنتم تقولون كذا)) أي كنتم تقولون كلمة ((يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها)). الحياء المحمود الذي معناه: أنه لم يُوح إليه في هـٰذه الكلمة شيء، ولذلك امتنع من أن يحرم على الناس شيئًا، أو يمنعهم من شيء لم يُوح إليه فيه شيء، فلما جاءت هـٰذه الرؤيا، وكأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان لا يطمئن لها، ولا يرتاح إليها، لكنه لم يمنعهم من شيء يكرهه بدون حجة ولا برهان، فلما جاءت هـٰذه الرؤيا عززت ما في نفسه من كراهية هـٰذه الكلمة فمنعهم؛ لأن الرؤيا من الله، وهي من طرق الوحي، ولا فرق في ذلك بين أن يوحى إليه مباشرة، وبين أن يرى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرؤيا، أو أن يراها أحد فيقرّ معناها. أما بعد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهل الرؤيا معتبرة في التشريع؟ الجواب: لا، ليست معتبرة في التشريع؛ لأننا لا نجزم بعصمة الرؤيا من الخطأ، فقد يُلَبَّس على الرائي إما في الرؤيا، وإما في فهمها وتعبيرها، فإذا كان الخطأ في الفهم يتطرق إلى النصوص المؤكّدة من حيث الثبوت كالقرآن والمتواتر من السنة، وما صح منها يخطئ في الفهم هـٰذا أو لا يخطئ؟ يخطئ في فهم الكتاب والسنة، فكيف في فهم الرؤى؟ فالخطأ فيها وارد، ولذلك لا يصدر عن الرؤى في التشريع، قد يستأنس ويميل الإنسان إلى ترجيح واختيار قول، لكنها لا يمكن أن تكون مصدرًا للتشريع؛ لأن الشريعة قد تمت ومصادرها واضحة: ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسنتي)). فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع، لكن قد يستأنس الإنسان بما يراه من الرؤى في ترجيح قول من الأقوال، لكن إنما التشريع من الكتاب والسنة، وهـٰذا أمر مهم؛ لأن من الناس من أقبل على الرؤى حتى في تفسير الواقع وتحليل الأحداث، وما يكون في المستقبل، هـٰذا غلط، الرؤى مَزَلة للأفهام في كثير من الأحيان، وسبب للخطأ في الاعتقاد في كثير من الأحيان، فالواجب على طالب العلم أن يُحَرِّر هـٰذا الأمر، وألا يصدر عن الرؤى ولو تكاثر الراؤون، إذا لم يعضد ذلك ويشهد له النص من الكتاب والسنة، فالعصمة في كتاب الله وسنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا)) جاء النهي ((فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد)) نهاهم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن هـٰذا القول ((ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)). وهـٰذا توجيه إلى أعلى المراتب أن يقولوا: ((ما شاء الله وحده)). المرتبة الثانية: أن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
[الشرح]
واضح؛ لأن اليهودي الحبر قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنكم تشركون)). وفي رواية قال: ((إنكم تنددون)) أي: تجعلون لله ندّاً، وهـٰذا فيه إطلاق الشرك على ما هو أصغر، حيث إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقَرَّه، ولم يقل: انتظر فَصِّل، هـٰذا الشرك ليس بالشرك الأكبر، بل هو شرك أصغر، ففيه أن مسمى الشرك يطلق حتى على الشرك الأصغر، يطلق ولا حاجة إلى التفصيل.
[المتن]
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
[الشرح]
الله أكبر! فهم الإنسان إذا كان له هوى، حيث إن اليهودي فَهِمَ التوحيد، وفَهِمَ أن هـٰذه الأقوال تخالف التوحيد؛ لمـّا كان في ذلك تحقيق لما في نفسه من النَّيْل من أهل الإسلام، إذ إن الظاهر من حاله أنه أراد ذم المسلمين لا النصح لهم فيما يظهر والعلم عند الله، وإلا لو كان يريد التوحيد حقيقة لترك ما هو عليه من الكفر وعدم الإيمان بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتبعه على ما هو عليه. وفيه يا إخواني أن دعوة الرسل واحدة، فإن اليهودي يَفْهَم الشرك ويفهم أن ما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُعَارض للشرك، وأنه ليس فقط في شرك الصور، يعني: الشرك العملي بأن يسجد للصنم، وأن يذبح لغير الله، ويستغيث بغير الله، بل حتى في الألفاظ التي قد يكون مَلْحَظ الشرك فيها خفيّاً، وهـٰذا فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد جَلَّى التوحيد تجليةً عظيمة حتى فهمه خصومه فيما يدعو إليه. المشكلة أن كثيرًا من المسلمين الآن لا يفهمون هـٰذا، إذا قالوا مثل هـٰذه الأقوال ونهاهم أحد عنها، قالوا: ما قَصَدْنا، والأعمال بالنيات، والإيمان في القلب، وما أشبه ذلك من الحُجَج الباردة التي يسوغون بها ما هم عليه من الانحراف.
[المتن]
الثالثة: قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أجعلتني لله ندّاً؟)) فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك . . . .والبيتين بعده.
[الشرح]
أعوذ بالله! كيف بمن قال هـٰذا القول؟ رجل قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (ما شاء الله وشئت) فقدم مشيئة الله على مشيئة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، والمحظور الذي وقع فيه أنه سَوَّى بينهما، استعمل الواو التي تفيد التسوية، فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أجعلتني لله ندّاً؟)) ونهاه عن هـٰذا، وقال: ((بل ما شاء الله وحده، قل: ما شاء الله وحده)). فكيف بمن يقول في قصيدته:
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العَمَمِ
يريد يوم القيامة، وهـٰذا من أبيات البوصيري في بردته، والبوصيري ليس من العلماء ولا من الفقهاء، بل ولا من أهل الدين والصلاح، إنما هو شاعر من الشعراء، جُعلت قصيدته أعظم من بعض سور القرآن تردادًا وتكرارًا واحتفاءً بها، وهي تنضح بالشرك والكفر، وأرى أنه لا ينبغي لأحد أن يستدل بشيء منها حتى فيما فيه المعاني الصحيحة؛ لأنها تضمنت بعض المعاني الصحيحة، منها قوله:
والنفس كالطفل إن تهمله شبَّ على
حب الرضـاع وإن تفطمـه ينفطـم
هـٰذا من المعاني الصحيحة، وهو يترجم في الحق حقيقة ما عليه النفس، من أنها إذا تركت تمادت في الشر، ولكن إذا حجزها الإنسان وحملها على المعاني الطيبة فإنها تنزجر وتكف عن المعاني السيئة، مثل هـٰذا أنا أرى أنه لا يُستشهد به؛ لأن هـٰذا مما ينغمر فيما فيها من السوء والشر، فينبغي التحذير من هـٰذه البردة ومما فيها، فإن فيها الشرك الصُّراح برب العالمين، والغلو الذي تجاوز الحدود في النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[المتن]
الرابعة: أن هـٰذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: (يمنعني كذا وكذا).
[الشرح]
ولو كان من الشرك الأكبر لما أقرهم عليه كما ذكرنا؛ لأن الشرك الأكبر لا يمكن أن يسكت عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويتركهم عليه؛ لأنه أتى بالتوحيد عليه أفضل الصلاة والسلام.
[المتن]
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
[الشرح]
وهـٰذا ثابت في الصحيحين في عدة أحاديث فيها أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من أجزاء النبوة، فلم يبق إلا هو،لم يبق إلا هـٰذا الجزء، وما عداه قد رُفع، لكن هـٰذا الجزء ينبغي أن لا يُستند إليه كما ذكرنا قبل قليل؛ بل ينبغي أن يُعْرَض على الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يستدل بحادثة الطفيل على جواز التشريع من الرؤى؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقرها وبينها واعتمد عليها، أما ما عدا ذلك فإنه يفتقر إلى إقرار النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[المتن]
السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام.
[الشرح]
كما جرى في قصة الطفيل بن سخبرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- .
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: من سب الدهر فقد آذى الله
وقـول الله تعـالى: ﴿وَقَالُوا مَـا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ﴾( ) الآية.
في الصحيح عن أبي هريرة، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسبّ الدّهر، وأنا الدّهر، أقلب الليل والنهار)). وفي رواية: ((لا تسبوا الدّهر، فإن الله هو الدهر)).
[الشرح]
قال رحمه الله تعالى: (باب من سب الدّهر فقد آذى الله.)
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن سبّ الدهر نقص في التوحيد؛ لأن الذي يسب الدهر إما أن يكون معتقدًا أن الدهر هو الخالق الفاعل لما نزل به بسبب السب، فهـٰذا يكون قد كفر كفرًا أكبر في الربوبية. وإما أن يعتقد أن الدهر سبب لما أصابه فلذلك سبه، وهـٰذا كفر أصغر. وإما ألا يعتقد ذلك فيكون السبّ ضعفًا في تعظيم الله عز وجل، فيكون معصية من المعاصي، وجميع المعاصي نقص في التوحيد. فيفيد الباب أيضًا أن كل معصية هي نقص في توحيد العبد، هـٰذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للباب الذي قبله: ففي الأبواب المتقدمة بيان ما يكون من شرك الألفاظ، أو من النقص الحاصل في التوحيد في اللفظ، فإنه -رحمه الله- ذكر في الباب السابق: باب قول: ما شاء الله وشئت، وهـٰذا نقص في التوحيد لفظًا، وكذلك هنا السب هو مما يقع باللسان، وهو نقص في التوحيد يظهر باللسان قد يُنْبِئ عمّا في القلب من كفر أكبر أو أصغر، فناسَب أن يأتي به بعد الأبواب المتقدمة.
قوله رحمه الله: (باب من سب الدهر.)
(السب) هو الشتم، والذم، ويجمعه الكلام القبيح، فالسبّ كلام قبيح يقوله الإنسان في المسبوب. وأما الدّهر: فالدهر هو الزّمان، وقيل: الدهر هو مدّة بقاء الدنيا، وقال الشاعر:
وما الدَّهْرُ إلا ليَلةٌ أو نَهَارُها
وإلا طُلُوعُ الشَمْسِ ثم غِيَارُها
أراد أن الدهر هـٰذا الزمان المتقلب الليل والنهار.
وما الدَّهْرُ إلا ليَلةٌ أو نَهَارُها
وإلا طُلُوعُ الشَمْسِ ثم غِيَارُها
أي : غروبها، وغيبوبتها.
يقول رحمه الله: (فقد آذى الله) هـٰذا جواب الشرط، ولم يبيِّن الحكم، واكتفى ببيان ما يترتب على السب عن بيان الحكم لبيان فَدَاحة الأمر وعِظَمه، فإن من في قلبه تعظيم الله -جل وعلا- يقشعر قلبه لهـٰذا الخبر.
(فقد آذى الله) والأذى: مما أثبته الله سبحانه وتعالى، الأذى المضاف إلى الله عز وجل مُثْبَتٌ له كما في الحديث: ((يؤذيني ابن آدم)) كما سيأتي، لكن الأذى المُثْبَت لا ينافي ما جاء من نفي الضر: ((يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نَفْعي فتنفعوني)) فالأذى قد يحصل به ضرر، وقد لا يحصل به ضرر، ولا تعارض بين هـٰذا وبين ما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربه من نفي الضرر، فالله -جل وعلا- كبير متعالٍ عن أن يصله ضرر عباده أو نفعهم.
قال رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾) القائل هم المشركون، كفار مكة الذين بُعث فيهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ﴾. هـٰذا قولهم، وقد حكم الله على هـٰذا القول في بقية الآية حيث قال: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ﴾ أي: ليس لهم بما يقولون مما تقدم في الآية علم، إنما هو ظن وخَرص، وهو من الظن المذموم، يقول تعالى عن هؤلاء في بيان قولهم: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾. يعني: ليس لنا حياة غير هـٰذه الحياة، فحياتنا هي هـٰذه لا حياة بعدها، وهؤلاء هم الدهرية الذين ينكرون البعث والمعاد، ويقولون: ﴿مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ ليس لنا حياة غير هـٰذه ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ والذي يفعل بنا هـٰذا الدهر ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ﴾ والمراد بالدهر هنا تعاقب الليل والنهار، الزمان، فأضافوا ذلك إلى الزمان، وهـٰذا ما كان عليه أهل الكفر في الجاهلية من إضافة ما يجري من المصائب وأعظمها الموت إلى الدهر، وهـٰذا الشاهد في الآية: أنهم أضافوا الإهلاك إلى الدهر، فإنهم كانوا يضيفون المصائب وما يحل بهم من النوازل والنكبات والكوارث إلى الدهر، فيحملهم هـٰذا على سب الدهر، فكذبهم الله -جل وعلا- في هـٰذه الآية فنفى عنهم العلم، وهـٰذا هو شأن القرآن في بيان حال الكفار، وأنهم لا علم لهم، فيصفهم بأنهم لا علم لهم، وبأنهم جاهلون، وبأنهم لا يعلمون، وبأنهم لا يفقهون، وما أشبه ذلك من الصفات التي تجتمع في أنها إثبات الجهل لهم، ونفي العلم عنهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ أي: بهـٰذه المقالة والدعوى ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ يعني: لا قليل ولا كثير ﴿إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ﴾ إن: هنا نافية، والمعنى: ما هم إلا يظنون، يعني: هـٰذا القول ما صدر منهم إلا عن ظنٍّ وتخمين، وتَوَهُّمٍ وتَخَيلٍ.
ثم قال: (في الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار)).) هـٰذا الحديث حديث إلهي، حديث أخبر فيه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن قول ربه، ويسميه علماء المصطلح الحديث القدسي، يقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم)). ففيه إضافة الأذى إلى الله عز وجل حيث قال تعالى: ((يؤذيني ابن آدم يسب الدهر)). وهـٰذا فيه بيان وكشف الأذى، وأنه سب الدهر، وسب الدهر: هو ذمه وشتمه، والكلام القبيح فيه، كل هـٰذا من سب الدهر، فالذي يسب الدهر باللعن والشتم وما أشبه ذلك يسب الدهر، الذي ينسب الأحداث القبيحة إلى الدهر فقد سبه، الذي يتكلم كلامًا قبيحًا في الدهر فقد سبه، وسب الدهر حكمه تقدمت الإشارة إليه في بيان الترجمة، منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو كفر أصغر، ومنه ما هو معصية من المعاصي.
الكفر الأكبر: السب الذي يصاحبه اعتقاد أن الدهر يخلق؛ لأن هـٰذا تكذيب للقرآن، فإن القرآن أثبت أن الله هو الخالق﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾( ). بل الدهر مخلوق لله تعالى، قال الله جل وعلا: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾( ). فأخبر الله –عز وجل- بخلق الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، فمن قال: إن الدهر يَخلُق ويُوجِد فقد كفر بالله عز وجل، وكذب ما دل عليه القرآن، هـٰذا القسم الأول، الحال الأولى من أحوال حكم السابّ.
الحال الثانية، والقسم الثاني:
أن لا يعتقد الساب أن الدهر خالق، أو أنه مُوجِد، أو أنه سبب لما نَزَل به، إنما يعتقد أن الخالق هو الله، ولكن الدهر سبب لما نزل به وما حل، وهـٰذا حكمه كفر أصغر، شرك أصغر؛ لأنه من شرك الأسباب، وهو أعظم من الكبائر.
القسم الثالث: ألا يعتقد في الدهر الخلق والإيجاد ولا التسبب في الحصول والحدوث، إنما يسبه جريًا على العادة في نسبة الشر للدهر، وذم الدهر عند نزول الحوادث والكوارث، وما ينزعج منه الإنسان، وهـٰذا حكمه أنه معصية من المعاصي، اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكمه:
فمنهم من قال بأنه مكروه، ومنهم من قال بأنه محرم، وعدّه من الكبائر، والصحيح أنه من المحرمات ولا شك؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث أخبر عن الله أنه أذى، والأذى كله محرم؛ لأن المناسب في حق الله التعظيم، لا أن يؤذى جل وعلا، فحقه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أن يُعظَّم، لا أن يؤذى بالسب والشتم، ولو كان الساب والشاتم صحيح الاعتقاد من حيث الخَلق والإيجاد، والتسبب في الحدوث، فالصحيح أن سب الدهر محرم مطلقًا، ومن قال بالكراهة فقد قَصَّر في القول.
((يؤذيني ابن آدم يسب الدهر)) قال الله تعالى: ((وأنا الدهر)) هـٰذا فيه بيان وجه الأذى: أن من سب الدهر فقد سب الله؛ لأن الله –عز وجل- قال: ((وأنا الدهر))، قوله: ((أنا)) مبتدأ، و((الدهر)) خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: وهـٰذه الرواية هي الأشهر والأكثر، رواية رفع الدهر؛ يعني: ((وأنا الدهرُ))، على أن الدهر خبر.
والوجه الثاني: النصب، وهي التي مال إليها داود الظاهري، فيكون: ((وأنا الدهرَ)). وهل بينهما فرق من حيث المعنى؟ الجواب: نعم، بينهما فرق:
من قال: ((وأنا الدهرُ)) أخبر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن نفسه بأنه الدهر، ثم بَيَّن هـٰذا الخبر بقوله: ((أقلب الليل والنهار)).
ومن قال بأن الدهر منصوب على الظرفية فإن الكلام لا يتم إلا بتتمة ما في الحديث، فقوله: ((وأنا الدهر)) ما تم الكلام، ما تتمته؟ ((أقلب الليل والنهار)) يعني: بَيَّن شأنه وهو أنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يقلب الليل والنهار مدة الزمان، والذي جعل داود يقول بهـٰذا القول الفِرار من إثبات الدهر في أسماء الله عز وجل، حيث إنه ذهب جماعة من العلماء منهم نُعيم بن حمَّاد شيخ البخاري، وطائفة إلى أن الدهر من أسماء الله -عز وجل- بناءً على قول: ((وأنا الدهرُ)) رواية الضم، وهي رواية الأشهر، والتي عليها جمهور العلماء، ولكن الجواب على هـٰذا نقول:
إنَّه حتى على قول الجمهور فإنه لا وجه لهـٰذه الرواية، ولا يمكن أن نُحرف الكلام فرارًا من المعنى القبيح، لا سيما وأننا لا ننفك من هـٰذا في الرواية الثانية: ((فإن الله هو الدهر)) لا وجه للانفكاك، هـٰذا مما يضعف ما ذهب إليه داود الظاهري، فإنهم متفقون على أن الدهر في رواية مسلم: ((لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرُ)) على الضم، ولا وجه للنصب، وهـٰذا الذي يُرَجِّح قول الجمهور.
بقي أن نعلم أن تسمية الله بالدهر: جمهور العلماء على أنه ليس من أسماء الله، فليس من أسماء الله الدهر، وذهب جماعة منهم من سمينا منهم نعيم بن حماد وطائفة إلى أن ((الدهر)) من أسماء الله، لكن ما معنى ((الدهر)) على قول نُعَيم ومن قال بأنه من أسماء الله؟ هل هو الليل والنهار؟ لا، إنما أرادوا بذلك الباقي الأزلي، يعني: يتضمن معنى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، هكذا أراد نُعَيم بن حماد ومن معه بإثبات هـٰذا الاسم، وجميع أهل العلم من أهل الإسلام متفقون على أنه لا يجوز تفسير الدهر بأن الله هو الليل والنهار، فإن هـٰذا هو قول الدهرية الذين ذمهم الله -جل وعلا- في قوله: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ﴾ فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في الرد عليهم: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ﴾( ). فكذبهم، وبَيَّن أن قولهم جهل وتخيل ووهم، فهـٰذا جميع أهل العلم متفقون عليه، والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه لا يصح إثبات اسم الدهر في أسماء الله عز وجل؛ لأن أسماء الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كلها حسنى، قال الله جل وعلا: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾( ) . وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾( ). والحسنى مؤنث الأحسن، فهو اسم تفضيل، والمعنى: المنتهية في الحسن، ولا تكون كذلك إلا إذا تضمنت كمال المعنى، والدهر ليس فيه هـٰذا، لا يفيد هـٰذا المعنى، أي: لا يفيد الحسن المنتهي، ولذلك لا يصح إثباته في أسماء الله تعالى.
ما معنى قوله تعالى في الحديث الإلهي: ((وأنا الدهر))؟
نقول: معناه ما جاء بيانه في قول الله عز وجل: ((أقلب الليل والنهار)). يعني: أن من سب الدهر فقد سب المدبر لهـٰذا الدهر، المصرف له، مقلب الليل والنهار سبحانه وبحمده، ولذلك قال: ((وأنا الدهر أقلب الليل والنهار)). فهـٰذا بيان وترجمة لمعنى هـٰذه الإضافة، وأنها ليست إضافة اسم، إنما هو بيان لوجه الأذى في سبّ الدّهر، حيث إن من سب الدهر فقد سب ما جرى فيه من وقائع، وما جرى فيه من وقائع من صنع الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فكل من سب الدهر فقد سب الصانع، إذ إن سب الصنعة سب لصانعها.
ثم قال: ((أقلب الليل والنهار)) أي: أُصرف الليل والنهار وما يَجـري فيهما من أحداث: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾( ) سبحانه وبحمده.
ثم قال: وفي رواية: ((لا تسبوا الدهر)). هـٰذا فيه النهي عن سب الدهر، وهـٰذه الرواية رواية مسلم رحمه الله، فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر، وهـٰذا يفيد ما ذكرناه من التحريم مطلقًا، سواء كان الساب يعتقد في الدهر الخلق، أو يعتقد أنه سبب، أو لا يعتقد هـٰذا وإنما جرى على لسانه سب الدهر، فإن هـٰذا كله محرم.
قال رحمه الله: ((فإن الله هو الدهر)). هـٰذا بيان لوجه النهي عن سب الدهر.
ثم ذكر بعد ذلك المسائل:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن سب الدهر.
[الشرح]
نعم، هـٰذا واضح في الروايتين.
[المتن]
الثانية: تسميته أذًى لله.
[الشرح]
وهـٰذا لا ينافي ما ذكرنا من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الإلهي: ((يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)). فالأذى أمر غير الضرر، لا يلزم منه الضرر، قد تؤذي دون أن تضر.
[المتن]
الثالثة: التأمل في قوله: ((فإن الله هو الدهر)).
[الشرح]
نعم، التأمل في قوله: ((فإن الله هو الدهر)). أي: إنه هو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- المصرف للدهر، كما في الرواية الثانية: ((أقلب الليل والنهار)). وفيها الرد على من جعل الدهر في رواية الصحيحين على النصب: ((وأنا الدهرَ)).
[المتن]
الرابعة: أنه قد يكون سابّاً ولو لم يقصده بقلبه.
[الشرح]
نعم؛ لأن كل من تكلم بالقبيح في شأن الزمان على وجه الذم فإنه يكون بذلك سابّاً لله عز وجل، ولو لم يقصد سب الله، يعني: من قصد ذم الزمان، ولم يقصد سب الله فإنه يدخل في النهي؛ لأن سب الزمان محرم؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هو الذي يقلب الليل والنهار، ووصف الزمان بالذم لا يخلو من أن يكون على الأوجه السابقة التي ذكرناها وتَبَيَّن حكمها: إما أن يكون على وجه نسبة الخلق واعتقاد الخلق،
أو على وجه السببية، أو شيء جرى على اللسان دون أن يعتقد السببية ولا الخلق، والحالة الرابعة:أن يذكر ذم الدهر على وجه الخبر، لا على وجه السب والذم والشتم، وهـٰذا جائز، ومنه قول الله تعالى في سورة فصلت : ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ﴾( ). فالله –جل وعلا- ذكر في هـٰذه الآية في وصف الأيام بأنها نحسات: ﴿فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ﴾. وهـٰذا لا شك أنه ذم أو ليس بذم؟ ذم لكنه ليس ممنوعًا ولا محرمًا، لماذا؟ لأنه على وجه الوصف والخبر، لا على وجه نسبة الذم إلى الدهر، ومنه قول لوط عليه السلام في سورة هود لما جاءه قومه: ﴿وَقَالَ هـٰذا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾( ) فإن هـٰذا وصف للدهر بالقبيح، ومنه أيضًا قول الله تعالى في وصف سنين يوسف: ﴿سَبْعٌ عِجَافٌ﴾( ) و﴿سَبْعٌ شِدَادٌ﴾( ) فهـٰذا كله على وجه الخبر والوصف، لا على وجه الذّم للزمان والسب والشتم، وهـٰذا جائز.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن أخنع اسم عند الله: رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله)).
قال سفيان: مثل (شاهان شاه).
وفي رواية: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)). قوله: ((أخنع)) يعني أوضع.
[الشرح]
هـٰذا الباب ذكره المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد لبيان قادح من قوادح التوحيد، وهو منازعة الله –عز وجل- فيما اختص به من الأسماء والأوصاف، فإن منازعة الله في أسمائه وصفاته بأن يسمي الإنسان نفسه بها، أو يصف غيره بها، فإنها من الشرك وقدح في التوحيد، لذلك قال المؤلف رحمه الله: (باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه) مما لا يصح أن يوصف به إلا الله، فإن هـٰذا من منازعة الله -عز وجل- ما اختص به، وهـٰذا لا يجوز.
أما مناسبة هـٰذا الباب للذي قبله: فإنه في الباب الذي قبله سب الله -عز وجل- بسبّ خلقه، وهـٰذا تنقص للرب جل وعلا، وهنا تنقص لله -عز وجل- بالمشاركة في أوصافه وأسمائه التي اختص بها سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا في الأسماء: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾( )، ﴿فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾( ). وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي: ليس لغيره، بل له وحده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وأما الصفات فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( )، وقال: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( ). وهـٰذا كالأسماء يدل على اختصاص الله –عز وجل- بالصفات العليا؛ لأن المثل معناه الصفة. ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ أي: له الصفة العليا، فمن نازع الله –عز وجل- في هـٰذه الصفات، سواء من حيث اللفظ أو المعنى فإنه يكون قد وقع في ما نهى الله عنه من الشرك.
يقول رحمه الله: (باب التسمي بقاضي القضاة)
(التسمي) سواءٌ سمى الإنسان نفسه بذلك أو سماه به غيره فرضيه، يشمل الأمرين.
(بقاضي القضاة). القاضي: هو الذي يفصل بين الناس، فصل الخصومة بين الناس هـٰذا القضاء، القضاء: فصل الخصومة، وقطع المنازعة بين الناس، والقضاء لا ينحصر فقط في المنازعات المالية أو التي تترتب على الجنايات وشِبهها، بل القضاء يشمل الفصل في كل ما تحصل فيه المنازعة من الأموال والحقوق والجنايات والأقوال والآراء، فقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة)). هـٰذا يشمل كل قضاء، ليس فقط القضاء الذي هو تولي فصل الخصومة بين المتنازعين في الأموال والحقوق، بل كل ما يدخل في القضاء، حتى القضاء بين الصبيان، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حتى في الصبيان إذا تخايروا في الخطوط، يعني: إذا قضيت بين الصبيان أي الخطوط أحسن يدخل في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة)). فالقضاء هو الفصل بين الناس في منازعات الأموال، وفي الحقوق، وفي كل شيء.
يقول رحمه الله: (التسمي بقاضي القضاة) أي: حاكم الحكام، ولا شك أن هـٰذا لا يصح أن يوصف على وجه الإطلاق به غير الله، لا يوصف به غير الله على وجه الإطلاق، بل هو وصف لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-؛ لأنه الذي يحكم ويفصل بين كل أحد، فهـٰذا وصف لا يوصف به غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على وجه الإطلاق.
كذلك قال المؤلف رحمه الله: (ونحوه) أي: من الأوصاف التي لا يصح إطلاقها لغير الله عز وجل كقول: (قاضي الحاجات) فإنّه لا يمكن أن يوصف أحد بهـٰذا الوصف على وجه الإطلاق، هـٰذا الوصف على وجه الإطلاق لا يصح إلا لله عزّ وجل، ونحو ذلك من الأوصاف التي لا يجوز أن يوصف بها أحد غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على وجه الإطلاق.
أما على وجه التقييد: كأن يقال: قاضي القضاة في جزيرة العرب، قاضي القضاة في السعودية، قاضي القضاة في مصر، قاضي القضاة في بلاد الشّام، فهـٰذا لا بأس به لأنه مقيد، المنهي عنه في الأسماء هو الإطلاق، لا التقييد.
قال: (في الصحيح عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن أخنع اسم عند الله: رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله)).)
هـٰذا الحديث فيه بيان قبح هـٰذا الاسم، وأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يمقته ويكرهه، فإن من تسمى بهـٰذا الاسم قد نازع الله – جل وعلا- اسمًا من أسمائه التي اختص بها، ومن هـٰذا نفهم أنه ليس النهي عن التسمي خاصّاً بهـٰذا الاسم، إنما هو في كل ما كان فيه منازعة لله عز وجل في اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
قوله –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: ((إن أخنع اسم عند الله)).
معنى ((أخنع)) أوضع وأحقر، وقيل: أفجر، وقيل: أخنى، كل هـٰذا مما جاء في معنى أخنع، وهو دائر على معنى الذل والصغار والسوء والشر.
((عند الله تعالى)) وهـٰذا فيه بيان أنه اسم ذليل عند الله –جل وعلا- إذا أُطلق على غيره، والذل هنا والصّغار ليس في الاسم ذاته؛ بل في المتسمي به؛ لأن هـٰذا اسم من أسماء الله عزّ وجل، فليس المقصود الاسم نفسه، إنّما المقصود من تسمى بهـٰذا الاسم، فإنه ذليل صاغر حقير عند الله تعالى.
قال: ((رجل تسمّى)). قوله: ((تسمّى)) يشمل ما إذا أطلق على نفسه هـٰذا الاسم، بمعنى: أنه سمى نفسه بهـٰذا الاسم، ويشمل أيضًا: ما إذا أُطلق عليه هـٰذا الاسم ورضيه، فإنه إذا سمي بهـٰذا الاسم ورضيه، فإنه يدخل في الوعيد الذي تضمنه هـٰذا الحديث من الذل والصغار لصاحب هـٰذا الاسم.
قال في تعليل النهي: ((لا مالك إلا الله)) أي: لا يستحق هـٰذا الوصف إلا الله جل وعلا، فإذا كان هـٰذا الوصف لا يناسب إلا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فإنه لا يجوز أن يتسمى به أحد، ولذلك قال: ((لا مالك إلا الله)) أي: إنه إذا سُمي به غير الله فإنه سُمي به من لا يستحقه؛ لخلوِّه من المعنى المتضمن، من تسمى بهـٰذا الاسم من الخلق فإنه خالٍ من المعنى المتضمن للاسم، وهو تمام الملك، فإن مالك الأملاك الله جل وعلا، ولذلك قال: ((لا مالك إلا الله)) وهنا فائدة: أن أسماء الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ليست أعلامًا محضة مجردة كما تقول المعتزلة، بل هي أعلام تتضمن معانيَ، وهـٰذا المعاني معانٍ شريفة كريمة، قال الله جل وعلا : ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ أي: الصفة العليا، فهـٰذه الأسماء متضمنة للصفات العليا لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
قال رحمه الله: (قال سفيان) سفيان: ابن عيينة، أو الثوري؟ سفيان بن عيينة.
(قال سفيان بن عيينة: مثل (شاهان شاه).)
وهـٰذا من غريب الترجمة والتفسير، حيث إنه فسر الكلمة العربية بكلمة عجمية، وهـٰذا على غير ما جرى به العُرف والعادة، فإن العادة أن يُفسَّر ويُترجَم الكلام العربي بكلام عربي، لا بكلام أعجمي، ولكنَّ سفيان بن عيينة رحمه الله فسر ذلك تمثيلاً لما كان منتشرًا في وقته، وسائدًا في عصره من إطلاق هـٰذا الاسم على بعض الملوك، فهو تفسير بالمثال؛ ليدرك السّامع لهـٰذا الحديث أنه ليس خاصّاً بما ورد به اللفظ ((ملك الأملاك))، إنما هو لكل ما وافق ذلك في المعنى، سواءٌ في لغة العرب، أو في غير لغتهم؛ لأن النهي عن معنى لا عن لفظ مجرد، وتبين بهـٰذا سبب تفسير سفيان بن عيينة -رحمه الله- للحديث، أو تمثيله للحديث بكلمة أعجمية.
قال رحمه الله: (وفي رواية: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)) ) الحديث، أي رجل تسمى ملك الأملاك.
((أغيظ)) صيغة أفعل التفضيل من الغيظ، والمقصود أنه أشد الرجال غيظًا عند الله عز وجل من تسمى بهـٰذا الاسم؛ لأنه نازع الله –جل وعلا- صفة من صفاته، واسمًا من أسمائه التي اختص بها، والغيظ يفيد معنى الغضب وزيادة؛ لأنه غضب وإرادة إيقاع العقوبة بالمغضوب عليه، فالمُتَغَيِّظ من الشيء غاضب وزيادة، فقوله: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)) أي: أشد الرجال استحقاقًا لغضب الله ونزول العقوبة به رجل تسمى ملك الأملاك.
وقوله: ((يوم القيامة)) بيان لأن هـٰذا الذي تسمى بالاسم يبدو عقابه ويظهر- وإن أمهله الله في الدنيا، يظهر- يوم القيامة.
قال: ((وأخبثه)) أي: وأخبث الرجال عند الله عز وجل، وهـٰذا يشهد بما ذكرنا قبل قليل في الحديث السابق أن المقت والغضب والحقارة والذل ليست لمجرد اللفظ، الاسم نفسه، إنما لصاحب هـٰذا الاسم الذي تسمى به دون الله عز وجل، فكل من تسمى بهـٰذا الاسم دون الله –عز وجل- فإنه مستحق لهـٰذا الوعيد وهـٰذه العقوبة.
((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)) قال الشارح رحمه الله: (قوله: ((أخنع)) يعني: أوضع). وهـٰذا هو التفسير المشهور، وقد سأل الإمام أحمد -رحمه الله- كما نقل في الصحيح، سأل الإمام أحمد أبا عمرو الشيباني، وهو من أئمة اللغة، سأله عن كلمة ((أخنع)) فقال: أوضع، وهـٰذا فيه تواضع الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فالكلمة مشهورة، لكنه أراد أن يتحقق من أصحاب الشأن فسأل في معنى (أخنع) إمامًا من أئمة اللغة، وهـٰذا الحكم ليس خاصّاً بهـٰذا الاسم كما ذكرنا، يدخل فيه جميع ما اختصّ الله به من الأسماء كـ مالك الملك، ورزاق العباد، وأحكم الحاكمين وما أشبه ذلك من الأسماء الخاصة به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- التي لا تصدق على غيره (رب العالمين)، (مالك يوم الدين)، كل هـٰذه مما اختص الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بها دون الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، يدخل في هـٰذا أيضًا أسماء الله -عز وجل- التي تسمى بها، إذا أطلقت على أحد على وجه يلاحظ فيه الوصف، يقول ابن القيم: إذا أطلق الاسم الذي هو من أسماء الله ويشترك مع المخلوق في الإطلاق-كالسميع والبصير، إذا أطلق- على وجه العموم على شخص فأصبح لا يتميز إلا به فإنه يدخل في النهي، ويدخل في ما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث، فإذا كان الشخص لا يعرف إلا بالبصير، ويلاحظ المعنى فإنه مما ينهى عنه، أما إذا قيلت هـٰذه الأسماء المشتركة على وجه عارض فإنه لا بأس بها، كما قال الله -جل وعلا- في قصة يوسف في غير ما موضع في السورة، من ذلك قول الله تعـالى: ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾( )، ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾( ) وما أشبه ذلك من المواضع التي وصف فيها المخلوق، وأطلق على المخلوق اسم من أسماء الله عز وجل، لكنه كما ذكرنا ليس اسمًا مرتبطًا بالشخص لا يعرف إلا به، كما أنه ليس اسمًا يلاحظ فيه المعنى الذي لا يليق إلا بالله عز وجل، فهـٰذا القسم الثاني مما يدخل فيما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث.
ثم قال رحمه الله:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك.
الثانية: أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان.
[الشرح]
وهـٰذا واضح، تقدم الكلام عليه أن ما في معناه يعني: من الأسماء التي يختص الله بها مثله في النهي، وذكرنا في هـٰذا نوعين:
الأسماء الخاصة المستقلة التي لا يجوز أن يتسمى بها غير الله، فهـٰذه لا يجوز أن يتسمى بها أحد من الخلق، مثلنا لذلك بـ: (رب العالمين)، (مالك يوم الدين)، ذكر بعض العلماء: (الجبار)، (المتكبر) كل هـٰذه من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها أحد من الخلق، واختلف العلماء في أسماء دون هـٰذه كـ: (قاضي القضاة، وحاكم الحكّام، وأقضى القضاة، وأحكم الحاكمين) وما أشبه ذلك، منهم من منع، ومنهم من أجاز، والذين أجازوا إنما أجازوه بتقييد، يعني: أن يكون ذلك على وجه التقييد بعصر أو مصر، وليس على وجه الإطلاق، فإنه لا يجوز أن يكون (قاضي القضاة) على وجه الإطلاق إلا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
الثالثة: التفطن للتغليظ في هـٰذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
[الشرح]
صحيح، التفطّن للتغليظ في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن أخنع اسم)) وفي قوله: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)) مع أن المتسمي بهـٰذا قد لا يلاحظ ما فيه من المعنى، مع أنّ الغالب أن التسمي بهـٰذا لا يكون إلا لملاحظة معناه، لكن الشيخ رحمه الله يقول: لو أن الإنسان سمى شخصًا بهـٰذا الاسم، أو نادى شخصًا بهـٰذا الاسم مع قطع النظر عمّا تضمنه من المعنى فإنه لا يجوز؛ لما ورد من التغليظ في هـٰذا في قوله: (أخنع اسم، وأغيظ رجل، وأخبثه).
[المتن]
الرابعة: التفطن أن هـٰذا لإجلال الله تعالى سبحانه.
[الشرح]
صحيح، منع تسمي الخلق بهـٰذه الأسماء لإجلال الله – عز وجل- وتعظيمه، وعدم منازعته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ما اختص به من الأسماء والأوصاف، فالواجب على المؤمن أن يتحرى ذلك، وإذا عَظُم قدر الله –جل وعلا- في قلب العبد كَلَّ لسانه وحَصُر عن أن يتكلم بمثل هـٰذه الكلمات في حق المخلوق الضعيف الفقير الذي لا غنى به عن الله -عز وجل- مهما بلغ جاهه وماله وقوّته، فهو ضعيف فقير إلى الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾( ). ما يأتي مثل هـٰذا إلا من ضعف تعظيم الله -عز وجل- في القلب، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في ألفاظه، وأن لا يتساهل، وأن لا ينساق مع الناس فيما يستعملونه من الألفاظ؛ لأن الناس يسرق بعضهم من بعض في ما يتكلمون به وما يكتبونه دون أن يلاحظوا الملاحظ الشرعية، والجوانب الإيمانية في بعض الكلمات التي يقولونها، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه وأن ينبه.
%%%%
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك
عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن الله هو الحكم، وإليه الحُكم)) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين؟ فقال: ((ما أحسن هـٰذا! فما لك من الولد؟)) قلت: شريح، ومسلم، وعبد الله. قال: ((فمن أكبرهم؟)) قلت: شريح. قال: ((فأنت أبو شريح)). رواه أبو داود وغيره.
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن التوحيد إجلال الله عز وجل وتعظيمه، قدمه وقطبه الذي يدور عليه التعظيم مع المحبة، ومن تعظيم الله -جل وعلا- تعظيم أسمائه سبحانه وتعالى، فينبغي للمؤمن أن يُعَظِّم الله -جل وعلا- باحترام أسمائه، فضعف احترام أسماء الله عز وجل - ومن صور عدم احترام أسمائه أن يسمي بها الخلق- هـٰذا دال على ضعف التوحيد في قلب العبد.
أما مناسبته لما قبله: فإنه في الباب السابق ذكر حكم التسمي بأسماء الله -عز وجل- التي يختص بها دون غيره مثل: (رب العالمين)، (مالك يوم الدين) مثل: (ملك الأملاك) الذي جاء به النص: ((رجل تسمى ملك الأملاك))، فهـٰذه مما اختص به الله -عز وجل- دون غيره.
في هـٰذا الباب ذكر المؤلف -رحمه الله- أوصافًا ليست خاصّة بالله عز وجل، أي: إن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يختص بها، بل يصح إطلاقها على الخلق، فما حكم إطلاق هـٰذه الأسماء على الخلق مع ملاحظة المعنى الذي فيها؟
يقول رحمه الله، هـٰذا ما يبينه في هـٰذا الباب.
إذًا: الباب السابق بين فيه المؤلف -رحمه الله- حكم التسمي بالأسماء التي يختص الله بها.
في هـٰذا الباب يبين رحمه الله حكم التسمي بالأسماء التي يصح وصف المخلوق بها، يعني: ليست خاصة بالله، ليست مما اختص الله به، بل يوصف بها العبد، يوصف بها المخلوق.
قال رحمه الله: (باب احترام أسماء الله تعالى.)
(أسماء): جمع اسم، وهو كل ما سمى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به نفسه في الكتاب، أو في سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: (وتغيير الاسم لأجل ذلك) أي: تغيير الاسم احترامًا لأسماء الله تعالى، وهـٰذا فيه بيان أن التغيير لا يُشرع إلا إذا كان يتضمن الاحترام لأسماء الله عز وجل، فإن كان التسمي بهـٰذه الأسماء لا يلحق به نقص في أسماء الله -عز وجل- فإنه لا يشرع التغيير.
ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي شريح، قال: (عن أبي شريح). وهو هانئ بن يزيد بن نُهَيك الكندي، من الصحابة، يقول: (أنه كان يُكْنَى أبا الحكم).
(يُكْنَى) أي: يُدعَى بهـٰذه الكنية (أبا الحكم) يكنى أبا الحكم، والكنية: هي ما تقدّمه أبٌ أو أم.
يقول رحمه الله: فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن الله هو الْحَكم وإليه الْحُكم)).
((إن الله هو الحكم)): اسمًا، فمن أسمائه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الْحَكَم، والحكم: هو الذي يفصل بين المتخاصِِِمِين؛ لأنه مأخوذ من الحكم والقضاء، وهو الفصل بين المتنازعين، والله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يحكم بين الناس قدرًا وشرعًا: شرعًا بما شرعه من الشرائع، وقدرًا بما يجريه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من الأحكام، ويظهر تمام الحكم يوم القيامة عند فصل القضاء، لما يأتي الله –جل وعلا- لفصل القضاء بين الناس.
((إن الله هو الحكم وإليه الحكم)) يعني: ويُرجع إليه الحكم، يُرجع إليه قدرًا ويُرجَع إليه شرعًا: قدرًا: فما من حاكم يحكم إلا وقد قَدَّر الله حكمه، وشرعًا: الواجب على كل حَاكِم أن يَحْكُم بما شرع الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، قال الله جل وعلا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾( )، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾( )، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾( ). كل هـٰذا التكرار لتأكيد عظم التحَاكم لغير الله عز وجل، وأنه كفر وظلم وفسق.
فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((وإليه الحكم)) أي: يُرجع إليه الحكم في القدر، ويُرجع إليه الحكم في الشرع، وهـٰذا فيه إنكار النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على هـٰذا الرجل هـٰذا الاسم، هـٰذه الكنية؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مباشرة قال: ((إن الله هو الحكم وإليه الحكم)) يعني: هـٰذا لا يصلح لك، هـٰذه الكنية لا تصلح لك، فقال أبو شريح، في بيان سبب هـٰذه التسمية: (إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين) وهـٰذا لا يكون إلا عن مهارة في الحكم؛ لأن الغالب في القضاء أن يورث الضغائن، ولذلك ندب الفقهاء -رحمهم الله- القاضي إلى الصلح بين المتخاصمين، وقالوا: يجوز للقاضي أن يؤخر، ولا يفصل القضاء، ويصلح، ويترك الأمر للصلح بين المتخاصمين حتى لا تثور الضغائن بينهم؛ لأن فصل القضاء يورث الضغائن، ويثير الأحقاد، ويوجِد في النفوس ما يوجِد، فكونه -رحمه الله ورضي عنه- إذا اختلف قومه جاؤوا إليه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين، لا يكون هـٰذا إلا من حَكَمٍ يُحسِن الحكم، ولا يكون هـٰذا إلا من العدل في الحكم.
قال رحمه الله: (فقال)، من الذي قال؟ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((ما أحسن هـٰذا))! تعجب واستحسان لهـٰذا الصنيع، فإنه صنيع عزيز قليل فاعله في الحكام، أي، في الذين يحكمون بين الناس.
قال: ((فما لك من الولد؟)) رجع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى ما بدأ الكلام عنه أو عليه، وهو الكلام في الكنية، ( ((فما لك من الولد؟)) قلت: شريح، ومسلم، وعبد الله).
وظاهر الحديث أن هانئاً ليس له إلا هؤلاء الثلاثة، ليس له بنات؛ لأنه لم يسم البنات، وقوله: ((فما لك من الولد)) يشمل الذكر والأنثى، فلم يذكر إلا ذكورًا، فلعله لم يكن له إلا هؤلاء.
(قال: ((فمن أكبرهم؟)) قلت: شريح. قال: ((فأنت أبو شريح)) ). فكنَّاه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأكبر أولاده، فأخذ العلماء من هـٰذا أن من السنة أن يكنى الرجال بأكبر بنيه، هكذا قالوا: بأكبر بنيه، مع أن الظاهر أنه بأكبر أولاده ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ( ((فما لك من الولد؟)) فسماهم، ثم قال: ((فمن أكبرهم))؟ قلت: شريح. قال: ((فأنت أبو شريح)).) لم يذكر إناثًا حتى نقول: إنه لا يكنى إلا بالذكور، وعلى كل حال هكذا قال أهل العلم رحمهم الله، ولعله هو الجاري في استعمال العرب، مع أنهم يكْنون بأسماء الإناث حتى ولو لم يكن لهم بنات، كمن؟ أبو حفص، ولو تتبعنا لوجدنا من الأسماء المؤنثة ما حصلت به الكنية مع أن صاحبها ليس له ولد بهـٰذا الاسم، لكن قد تكون لمناسبة كـ (أبي بكرة)، و(أبي هريرة) فإن لها مناسبة، ومنه قالوا: يجوز التكني بالآلات، ويجوز التكني بصغار الحيوان لا بأس بذلك، كـ (أبي هريرة)، و (أبي بكرة).
أبو هريرة: لهريرة كانت معه، وأبو بكرة: للبكرة التي تدلى بها في الحصن.
المهم أن هـٰذا خارج عن بحثنا، والمقصود أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَيَّر كنية هانئ بن يزيد إلى هـٰذه الكنية، كنَّاه ببعض أولاده، بأكبر ولده، وهـٰذا يدل على أن الكنية إذا كانت في مثل هـٰذا فإنها تُغيَّر.
قال بعض العلماء: يشكل على هـٰذا الحديث أن من الصحابة من اسمه الحكم، ولم يغير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسمه، ومنهم من كنيته أبو الحكم ولم يغير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كنيته، فجعل هـٰذا سببًا في القدح في الحديث، ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه قال: كون النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يغير من اسمه الحكم من الصحابة، ولا من كنيته أبو الحكم من الصحابة فإن هـٰذا يدل على أن في المتن شيئًا.
ولكن يُجاب على هـٰذا: بأن الذين تسموا بهـٰذا الاسم، أو تكنوا بهـٰذه الكنية لم تكن التسمية ولا الكنية يلاحظ فيها هـٰذا المعنى، ما يلاحظ فيها معنى الحكم والفصل، بل هي أعلام مجردة عن المعاني، لا يُلتفت فيها إلى ما تضمنت من المعنى كـ (صالح)، و(عبد الله)، و(عبد الرحمـٰن) فإن هـٰذه أسماء في الحقيقة إذا لوحظت معانيها فهي تتضمن التزكية؛ لأن (صالحاً) من الصلاح، و (عبد الله) من العبودية، وإن كانت العبودية القدرية، لكن يمكن أن يراد بها العبودية الاختيارية التي يختص بها المؤمنون، المراد أن الجواب عن هـٰذا الإشكال: بأن التغيير هنا لمعنى، وهو أن التكنية لوحظ فيها المعنى؛ لأنه قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
ومن هـٰذا نستفيد الفائدة التي ذكرناها قبل قليل في الباب السابق: أن الأسماء المشتركة التي لا يختص بها الله -جل وعلا- لا يجوز إطلاقها على المخلوق إذا كان المعنى فيها ملاحظًا، بمعنى: أنه لا يجوز أن يسمي شخصًا الحكم لكونه يحكم بين الناس، ويكون هـٰذا اسماً له لا يعرف إلا به، وكذلك العزيز، وكذلك السميع، والبصير، وغير ذلك من أسماء الله تعالى التي يصح إطلاقها على المخلوق.
ثم قال رحمه الله:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه.
[الشرح]
نعم؛ لأن هـٰذا لم يقصد أن ينازع الله هـٰذا المعنى أو هـٰذه الصفة، إنما ذكر سبب تكنية قومه له بهـٰذه الكنية دون أن يكون قاصدًا منازعة الله -جل وعلا- في هـٰذا الوصف، لكن كونه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- موصوفًا به يمنع أن يتسمى الإنسان بهـٰذا الاسم، أو يتكنى بهـٰذه الكنية إذا لوحظ المعنى.
[المتن]
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.
[الشرح]
والتغيير هنا واجب، بخلاف تغيير الأسماء التي لا منازعة فيها لشيء من أوصاف الله -عز وجل-، كتغيير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أسماء بعض الصحابة، فإن كل تغيير أُمر به في الأسماء يدل على كراهية التسمي لا على تحريمه. وهـٰذه قاعدة مفيدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، بخلاف التغيير هنا، التغيير هنا واجب لماذا؟
لأن فيه منازعة لوصف من أوصاف الله عز وجل، أما ما كان من الأسماء قبيحًا فنهى عنه، أو تضمن تزكية فنهى عنه، فإن الأمر بالتغيير، والنهي عن التسمي محمول على الكراهة؛ لأن من الصحابة من لم يُغَيِّر، ولو كان واجبًا يأثمون بعدم التغيير لما أقرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أسمائهم، ومن ذلك: (حزن) والد المسيب، جَد سعيد بن المسيب رحمه الله، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمره بالتغيير ولم يُغَير، فدل ذلك على أن الأسماء التي تكون للتزكية، أو تكون للقبح إذا أُمر بتغييرها لهذين المعنيين فإن الأمر ليس على الوجوب، وإلا لكان واجبًا على الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- أن يغيروا.
[المتن]
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.
[الشرح]
هكذا ذكر الشيخ -رحمه الله- الفائدة اتفاقًا لما ذكره البغوي في شرح السنة، فإنه قال رحمه الله: يكنى الرجل بأكبر بنيه، هكذا ذكر البغوي في شرح السنة، وجرى عليه العلماء بعده.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الخامس والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
وقول الله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾( ).
عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة -دخل حديث بعضهم في بعض- أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسُناً، ولا أجبن عند اللقاء - يعني رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه القرّاء -. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنَّك منافق، لأخبرن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فذهب عوف إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله! إنَّما كنَّا نخوض ونتحدث حديث الرَّكْب، نقطع به عناء الطريق.
فقال ابن عمر: كأنِّي أنظر إليه متعلقاً بنسـعة ناقة رســول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وإنَّ الحجارة تنكُبُ رجليه – وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب – فيقول له رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65)﴾ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول)
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: كالأبواب التي قبله: أن الهَزْل –وهو ضد الجِد والحزم والصدق- في شيء من ذكر الله -عز وجل- أو القرآن أو الرسول من ضعف التوحيد؛ لأنه ضعف تعظيم لله –جل وعلا-، فلا يكون هـٰذا إلا عن ضعف التعظيم لله، التعظيم لآياته، التعظيم لرسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ومثل هـٰذا يُوجب نقصًا عظيمًا في التوحيد قد يصلُ بصاحبه إلى الكفر، بل هو كفر.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنَّه في البابين السّابقين ذكر سبّ الله واحترام أسماء الله، وفي هـٰذا ذكر ما يجب تعظيمه من حقوق الله، كذكر الله والقرآن والرسول، فإنَّ تعظيمَ هـٰذه الأشياء من تعظيم الله –جلَّ وعلا-، بل الاستهزاء بهـٰذه الأشياء استهزاء بالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فالاستهزاء بآيات الله يستلزم الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالرسول يستلزم الاستهزاء بآيات الله وبالله تعالى، فذَكَر هـٰذا تتميمًا لما أفادته الأبواب السابقة من وجوب تعظيم الله -عز وجل- بالقلب واللسان.
باللسان: بعدم السب، وبالاحترام لأسماء الله -عز وجل-، وأيضًا بتعظيم ذكره وكلامه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول -رحمه الله- في هـٰذا الباب: (باب من هَزَل بشيء فيه ذكر الله)
قوله: (بشيء) نَكِرة في سياق الشّرط، فتعم كلَّ شيء: الدّقيق والجليل، الكثير والقليل، فإنَّه من هَزَل بشيءٍ فيه ذكرُ الله أو القرآن أو الرّسول ولو كان هَزْلاً يسيرًا قليلاً فإنَّه داخل فيما ذكره المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب من آية وحديث.
وقوله رحمه الله: (فيه ذكرُ الله أو القرآن أو الرّسول) المراد: فيه ما يجب تعظيمه لله - عز وجل- مما يكون الاستهزاء به مستلزمًا للاستهزاء بالله -عزّ وجل-، فيشمل ذلك الاستهزاء بالآيات الخلقية، والاستهزاء بالآيات الكونية، فإنَّ الاستهزاء بها والاستخفاف استهزاء بالله تعالى.
ولذلك مرَّ معنا في باب سب الدهر أنَّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قال: ((يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر)). فجعل سبَّ صنعة الله -عز وجل- سبّاً له، فكذلك الاستهزاء بآيات الله -عز وجل- استهزاء به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فليس قوله رحمه الله: (فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) حصراً، بل ذلك على وجه التمثيل لذكر أصول ما يحصل به الاستهزاء، وهنا تركَ المؤلف رحمه الله ذكر الحكم في الترجمة بحكم من استهزأ بشيء (من هَزَل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول).
السبب في هـٰذا أن الحكم يتبيّن مما ذكره من النصوص، فلا حاجة إلى استنباط الحكم في الترجمة؛ لأنه واضح من النصوص، والمؤلف -رحمه الله- قد يُغفل ذكر حكم بعض المسائل التي ذكرها في التراجم: إما لكون الحكم واضحاً يستفاد مما ذكره من النصوص، وإما لكون الحكم مختلفًا فيه، وإما لكون الحكم يختلف بالنظر إلى من قام به الوصف الذي عُلِّق عليه الحكم في المسألة، فقد يكون شركًا أكبر وقد يكون شركًا أصغر وقد يكون معصية، وهنا تركَ المؤلف -رحمه الله- ذكرَ الحكم لكونه واضحًا مما ذكَرَه من النصوص.
قال رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾( ) .)
هـٰذه الآية الكريمة من سورة التوبة ذكر الله -جل وعلا- فيها شيئًا من أحوال المنافقين، فإنَّ الله –سبحانه وتعالى- فَضَح المنافقين في هـٰذه السورة، ومن جملة ما ذكره عنهم وفضحهم بِه ما تضمنته هـٰذه الآية، وهو جوابهم عند مساءلة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، أو عند سؤال الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهم عن سبب استهزائهم واستخفافهم.
قال الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ الخطاب في هـٰذا للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب من أهل الإيمان.
﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾. اللام هنا موطئة أو واقعة في جواب القَسم؟ موطئة؛ لأنها دخلت على شرط، والتقدير: والله لئن سألتهم يا محمد، سألتهم: الضمير يعود على من في قوله: ﴿سَأَلْتَهُمْ﴾؟ على المنافقين.
﴿لَيَقُولُنَّ﴾: هـٰذا فيه بيان بماذا سيجيب هؤلاء، ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾.
﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ لم يُبَيِّن المسؤول عنه، لكنه تَبَيَّن من جوابهم، فهو لم يُبَيِّن لنا ماذا سألهم عنه، لكنّه يتَبَيَّن من جوابهم ﴿لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ قال: ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ ثم جاء بيانُ المسؤول عنه والمُجاب في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ فهـٰذه الآية بَيَّنَت المسؤول عنه، يعني: موضع السؤال والجواب، هو في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وذلك على ما بَيَّنه المؤلف -رحمه الله- من سبب نزول هـٰذه الآية.
فإنَّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أخبر رسولَه عن جوابِ المنافقينَ وحالهم: ﴿لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ يا محمد عن قولهم وعملهم ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ وهـٰذا فيه الحصر في بيان الجواب، فالجواب محصور بهـٰذا الأمر، يعني: لم نقصد ما صدر مِنَّا، إنما غرضنا مما تنقمه علينا الخوض واللّعب، لا حقيقة ما جرى به اللسان وتكلَّمنا به من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أَتَوا بالحصر الدّال على نفي كل غرض غير المذكور في الحصر.
﴿نَخُوضُ﴾ والخوض هو: الشّروع في الشيء على وجه التَّخَوُّض والانهماك، وأصل الخوض هو الولوج في الماء، السير في الماء، ثم أُطلِق على كلِّ ولوجٍ في أمرٍ باطل، هـٰذا معنى الخوض.
وأما قوله: ﴿وَنَلْعَبُ﴾ فهـٰذا فيه بيان أنَّ ما جرى منهم من تَكَلُّمٍ بالباطل ليس مقصودًا لهم، إنما هو لعب، واللعب: الذي لا فائدة فيه، يعني: أننا اشتغلنا بما لا فائدة فيه دون أن نظن أنه يضرنا، أي: لم نعتقد ما تكلّمنا به، ولم نظن أن يبلغ ما قلناه ما ذكرتَه من الكفر.
فنفَوا أمرين: نَفَوا قصد الكلام الذي قالوه، ونَفَوا علمهم بأي شيء؟ بما يترتّب على هـٰذا القول من حكم، ما ندري أن هـٰذا يُوصل إلى الكفر، إنما نخوض ونلعب.
فجاءهم الجواب من رب العالمين مأمورًا فيه بالتبليغ، حيث إنَّ الله أمر رسولَه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبلغهم الجواب على هـٰذا الذي قالوه وأجابوا به سؤال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فقال: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ هـٰذا فيه تعظيم الاستهزاء، يعني: هل هـٰذا محل استهزاء؟ هل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الذي له الأمر كله وهو رب السمٰوات والأرض محل للاستهزاء؟ هل آيات الله المُعرِّفة به الدالة عليه محل للاستهزاء؟ هل الرسول الذي جاءكم بخير الدنيا والآخرة، جاءكم بالهدى الذي تخرجون به من الظلمات إلى النور محل للاستهزاء؟ فالاستفهام هنا استفهام إنكار، وإنكار عظيم، وهو تقديم للحكم، يعني: تقدم هـٰذا الإنكار للحكم لبيان أنه واضح لا يحتاج إلى أن يُعَـلَّم، فإن الفِطَر تأبى مثل هـٰذا وتَرُد مثل هـٰذا: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ إذا كان كذلك ﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ فنهاهم الله -جل وعلا- عن الاعتذار، ونهيه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إياهم عن الاعتذار بيان أنه عُذر غير مقبول. ﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾. فحَكَم الله –جل وعلا- عليهم بالكفر بسبب استهزائهم بالله وآياته ورسوله.
والاستهزاء: هل هو الهَزْل؟ الهَزل من الاستهزاء ولكنه أعم؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف بالشيء والاستهانة به، أما الهَزل فهو أوسع من مفهوم الاستهزاء، فيشمل الاستخفاف ويشمل ما ليس باستخفاف لكنَّه ليس بجِد، إذ إن الهَزْل نقيض الجِد، فالمؤلف رحمه الله ترجم للباب بما هو أوسع ممّا دلَّت عليه الآية، وذلك أنَّ الهَزل يتفق مع الاستخفاف والهزو في الكفر.
ولأنهم اعتذروا بأنهم أرادوا اللعب، واللعب هَزل نقيض الجِد ومع ذلك سماه الله استهزاءً، فالآية دالة على أنَّ من استهزأ أو استخف أو لعب بشيء مما يتعلق بالله، بأسمائه أو صفاته أو أفعاله فإنَّه كافرٌ بالله العظيم.
كذلك من استهزأ بآيات الله الخلقية والشرعية فإنه كافر بالله العظيم، من استهزأ برسول من الرسل فهو كافر بالله العظيم.
وقد نقلَ جماعةٌ من العلماء الإجماع على هـٰذه الأمور كلها، وأنه من هَزَل وأنه من استهزأ بشيء مما يتعلق بالله أو بآياته أو بالرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه كافر، وقد اتفق على هـٰذا علماء الأمة، وهو واضح لا لبس فيه في هـٰذه الآية؛ لأن الله -جل وعلا- أجابهم بهـٰذا الجواب الواضح الصريح فقال: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.
ثم بعد ذلك قال الله –جل وعلا- في بيان انقسامهم بعد هـٰذا الحكم عليهم: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾( ) فدلّت الآية على قَبُول التوبة ممن استهزأ وهزل بشيء مما يتعلق بالله أو بآياته أو برسوله، وهـٰذا من رحمة الله –جل وعلا-؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذكر حالهم بعد هـٰذا في حالين:
الحال الأولى: من يُعفى عنهم.
والحال الثانية: من يمتنع العفو عنهم.
وانظر: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ لماذا يعفو عنهم؟ لتوبتهم وندمهم واستغفارهم، ﴿نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾ ما السبب؟ ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ مصرين مداومين على الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وهـٰذا فيه أنَّ التوبة لا تُقبل من أمثال هؤلاء؛ لأنهم لم يأتوا بمقتضاها وهو النزوع والإقلاع، فإنَّ الله وصفهم بالإجرام الدال على استمرار المعصية.
وقد اختلف العلماء –رحمهم الله- في سبِّ الله وسبِّ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسبِّ القرآن أو شيء من آيات الله -عز وجل- هل تُقبل توبة صاحبه أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه كفر.
فذهب الجمهور إلى قبول التوبة في سبّ الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأنَّ من تاب سقطت عنه المؤاخذة.
والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة: أنَّ سابّ الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا تُقبل له توبة، بمعنى أنَّه لا بد أن يُقتل حتى لو قيل بأنَّه يتوب بينه وبين الله، لكن لا بد من مؤاخذته وقتله على جرمه؛ لأن حق الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يسقط، ولا نعلم هل يُسقِطُه أو لا؟ أما حق الله بالاعتداء على الرسل فإنه يسقط بالتوبة.
وأما بالنسبة لسب الله -عز وجل- فأيضًا المسألة فيها قولان لأهل العلم:
جمهور العلماء على أن سابّ الله إذا تاب يتوب الله عليه ولا يلزمه قتل.
والقول الثاني وهو قول في المذهب –مذهب الحنابلة- أنه يُقتل، وهو مأثور عن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فإنَّ عمر سوَّى بين من سبَّ الله وسبَّ الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ذكر المؤلف -رحمه الله- بعد الآية شواهد، سبب النزول وهو ما نقله -رحمه الله- عن ابن عمر، ومحمد ابن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة. يقول رحمه الله: (دخل حديث بعضهم في بعض)، دخل حديث بعضهم في بعض يعني أنه نصٌّ ملفق من روايات هؤلاء، فجمع ما في رواية هؤلاء في بيان سبب نزول الآية.
واعلم أن هـٰذه الآثار ذكرها ابن جرير الطبري -رحمه الله- عند تفسير الآية، وذكرها ابن أبي حاتم أيضًا، وأسانيدها حسنة، ويدلُّ عليها سياق الآيات.
يقول -رحمه الله- في سياق سبب نزول الآية :(أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء). غزوة تبوك معروفة، وهي من أشد الغزوات التي غزاها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فيها من الشدة والعسر والضيق ما لم يكن في غزوة، خرج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه ولم يلقَوا عدوّاً فرجعوا، يقول رواة هـٰذا السبب في نزول الآية، أنَّه قال رجلٌ: أي من المنافقين (في غزوة تبوك) ولا يُعلم هل هو في الذهاب أو في المجيء: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء) المقصود بالقرَّاء: العلماء، وليس القرَّاء الذين يحسنون القراءة؛ لأن أعلم الناس في ذلك اليوم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل هو أعلم الناس على وجه الإطلاق -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومع ذلك فهو لا يقرأ ولا يكتب.
فالمقصود بالقرَّاء أي أهل العلم لا من يُحسن القراءة فحسب، فإنَّ من الناس من يحسن القراءة ولا يوُصَفُ بالعلم، كما قال الله -جلَّ وعلا- في وصف الذين يقرؤون الكتاب ولا يعملون به ولا يقفون عند نصوصه فهمًا وتدبرًا: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ﴾( ) يعني: إلا قراءة على أحد التفسيرين، أو على التفسير المشهور.
(مثل قُرَّائِنا هؤلاء) يريد رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابَه العلماء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرين بالجنة وغيرهم من أفاضل الصحابة.
(أرغب بطونًا) أي أوسع بطونًا، وهـٰذا دليل على أيِّ شيء؟ على كثرة الأكل، أنهم كثيرو الأكل.
(ولا أكذب ألسُنًا) أي ولا مخالفة في خبرهم للواقع، يعني: لا يخالف قول أحد الواقع كمخالفة خبر هؤلاء للواقع، هـٰذا معنى (ولا أكذب ألسُنًا) أي: إن ألسنتهم تشتغل بالكذب ولا تقول الحق.
(ولا أجبن عند اللقاء) أي لقاء العدو، يعني رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه القُرَّاء أي العلماء.
(فقال له عوف بن مالك) وهو من الصحابة الذين شهدوا هـٰذا القائل: (كذبت) أي لم يطابق قولُك الواقع، وهو صادق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فإنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه القُرَّاء صفاتهم عكس ما ذكر هـٰذا المنافق: فهم أقلُّ الناس ذات يد، فإنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يمر الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيته نار، وليس له من الطعام إلا الماء والتمر، وكذلك حال أبي بكر وحال عمر وحال السّواد الأعظم من الصحابة في وقت النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-. وأما الكَذِب فقد برأهم الله منه، فهم أصدق الناس لسانًا وأصدقهم لهجة، وما بعث الله رسولاً كذَّابًا. وأما الجُبن: فكذاب، فهم أشجع الناس وأثبت الناس أفئدة عند اللقاء، بل إذا فر الناس نادى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أصحابه القُرَّاء العلماء الذين كانوا معه من أوَّل البعثة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع.
فالمنافق كاذب في دعواه، ولذلك بادر عوف بن مالك إلى تكذيبه، قال: (كذبت، ولكنك منافق). يعني: السبب الحامل لك على هـٰذا القول هو نفاقك، لا شبهة أو دليل يؤيّد ما تقول، (لأُخبِرَن رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي بما ذكرت، وبما رميت به النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه العلماء القراء.
(فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليخبِرَه). وإخبار عوف في هـٰذه الحادثة واجب؛ لأن هـٰذا يشيع الإرجاف وقالة السوء على قادة المسلمين في تلك الغزوة التي يحتاج فيها الناس إلى الثقة بأئمتهم وقادتهم، ولذلك بادر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إلى إخبار رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-.
(فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه). أي نزل الخبر من الله –جل وعلا- بما قال هؤلاء، وببيان حكمهم والحامل لهم على القول.
(فجاء ذلك الرجل) القائل هـٰذه الكلمة وهو من المنافقين، بعد أن علم بخبر النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وأنَّ عوف بن مالك سيخبره، جاء إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،كعادة المنافقين إذا أحاط بهم خوف أو نزل بهم ما يخافون منه سوءًا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم جاؤوا إلى رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحلفون ما أردنا إلا الخير، ما أردنا سوءًا ولا شرّاً.
جاء على العادة، يقول: (وقد ارتحل) أي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ارتحل) أي ركب راحلته وحمَّلها متاعه. (وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله) القائل هو هـٰذا المنافق صاحب هـٰذه المقالة: (إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق) يعني: قولنا غير مقصود، إنَّما هو حديث وكلام كما قالوا: يحصل به سعة الصدر وقطع الطريق وإذهاب السآمة والملل من جراء الطريق وعنائه.
(قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنِسعَة ناقة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). النِّسعَة هي الزمام الذي يُوجه به البعير، تعلق بها.
(وإن الحجارة تَنكُبُ رجليه). يعني: تضرب رجليه وهو لا يلتفت إليها؛ لشدة ما وقع في قلبه من الوَجَل والخوف الذي اقترن بإعراض النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنه، وقد هددهم الله –جل وعلا- في عدة مواضع منها قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴾( ). هـٰذا يُبَيِّن لنا أنَّ الله –جل وعلا- هددهم تهديدًا بلغ مبلَغَه في نفوسهم وقلوبهم في مواضع عديدة، منها الآية التي ذكرناها في سورة الأحزاب.
فهـٰذا كان لا يبالي بما يصيب قدمَه من نَكْب الحجارة وإصابتها؛ لعِظَم ما قام في قلبه من الخوف.
(وهو يقول) أي يعتذر ويكرر: (إنما كنا نخوض ونلعب) فيقول له رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (﴿أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.)
(ما يلتفت إليه) في الجواب، (وما يزيده عليه) يعني: لا يزيده على هـٰذه المقالة؛ لأن الله أمره بذلك، وهـٰذا من عظيم امتثال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأمر ربه، ما زاد على هـٰذا؛ لأن الله أمره بذلك فالتزم أمرَ الله، وهـٰذا يبيِّن لنا عظيم عبودية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لربه، حيث اقتصر في جواب هـٰذا المنافق على أي شيء؟ على ما أمره الله بتبليغه: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾( ) .
قال رحمه الله: (ما يلتفت إليه، وما يزيده عليه) وذهب جماعة من العلماء إلى أن هـٰذه الآية ليس لها سبب نزول واحد، لا يتعين أن تكون هـٰذه القصة هي سبب نزول هـٰذه الآية.
فإنَّ المنافقين كانوا يقولون قالة السوء في النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه في مجالسهم وليس في هـٰذا المجلس خاصّةً، قال الله تعالى في بيان حال هؤلاء: ﴿وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمـَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾( )، كما في سورة البقرة، وأيضًا في أول السورة قـال: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾( ) . فمجالسهم الكثيرة يدور فيها من الوقيعة في الله وفي رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفيما جاء به من الحق والهدى شيءٌ كثير.
فقوله تعالى لرسوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ ليس خاصّاً بهـٰذه الحادثة، وعلى كل حال إذا صح السند في سبب نزول هـٰذه الآية وأعان ذلك سياق الآية في الدلالة على المناسبة فإنه لا وجه لإنكار أنه سبب نزول الآية، وإن كان قد تكون الآية تعالج هـٰذه الحادثة وغيرها من الحوادث، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
فالصحيح أنَّ هـٰذا الأثر الذي ذكره من ذكره من الصحابة والتابعين سبب نزول هـٰذه الآية، والآية تدل على صحة ذلك.
هـٰذه استشكلها بعض العلماء فقال:
إنَّ الآية تدل على إيمانهم السابق؛ لأنَّ الله -جل وعلا- قال: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.
وقال آخرون: إنه الإيمان الظاهر الذي هو الإسلام، وليس الإيمان الذي هو مباشرة القلب بحلاوة الإيمان وما جاء به الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الهدى والحق، هـٰذا جواب أن الإيمان هنا المراد به الإسلام، وهم مسلمون في الظاهر.
وقال آخرون: إن هـٰذا ليس في حق هؤلاء جميعًا، بل في حق قوم كانوا معهم وسكتوا على مقالتهم، وسموا في هـٰذا مَخشِي بن حُمير، حيث إنه جاء إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واعتذر إليه، كان معهم وسكت عن مقالتهم ولم يوافقهم في مقالتهم، وقال: (يا رسول الله إنما قعد بي اسمي واسم أبي، وغَيَّر اسمه إلى عبد الرحمـٰن). وكان من توبته -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن جاهد حتى قُتل واستشهد.
فيقال: إن قوله تعالى: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ هو في حق هـٰذا، لكن ما حاجة أن نحمل الآية على حال مَخشِي فقط، بل نقول: هـٰذا في حال المنافقين الذين أظهروا الإيمان والإسلام وكانت قلوبهم خالية من ذلك، فقوله: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ أي بعد إسلامكم، وينتهي الإشكال.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: وهي العظيمة: أنَّ من هزل بهـٰذا فإنه كافر.
[الشرح]
(وهي العظيمة)، يعني وهي أعظم مسائل هـٰذا الباب، (أن من هَزَل بهـٰذا)، المُشار إليه ما تضمنه قوله تعالى: ﴿قُل أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئوُنَ﴾ فهو كافر، وهـٰذا ذكرنا أنه باتفاق العلماء وإجماعهم، لا خلاف بين أهل العلم في أن من استهزأ أو سب الله –جل وعلا- أو استخف بشيء مما يتعلق به من أسمائه أو صفاته أو أفعاله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فهو كافر.
ولا فرق في ذلك بين الاستهزاء القولي والاستهزاء الفعلي:
الاستهزاء القولي بأن ينطق ويستخف بلسانه.
والفعلي بأن يشير إما بوجهه أو بلسانه أو بيده استهزاءً بأسماء الله أو صفاته أو أفعاله أو ما يتعلق به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
إنما الخلاف وقع في أي شيء يا إخواني؟ في التوبة، هل لهم توبة أو لا؟ أما حصول الكفر فلم يقع فيه خلاف بين علماء الأمة.
[المتن]
الثانية: أن هـٰذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان.
[الشرح]
صحيح، لا فرق في ذلك حتى لو كان من الصحابة، هـٰذا معنى قوله: (كائنًا من كان)، فإن من شهد هؤلاء وسكت كان موافقًا لهم في الحكم: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.
[المتن]
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
[الشرح]
هـٰذا في الجواب عن إخبار عوف بن مالك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عمّا جرى من هـٰذا المنافق، هل هو نميمة؟ الجواب: لا، مع أنه نقل لكلام على وجه يحصل به الفساد بالنسبة للمنقول عنه، فإنَّ هـٰذا النقل ترتب عليه ما جرى، مع أننا نقول: إنَّ الله –جل وعلا- قد أخبر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل مجيء عوف بن مالك كما دلَّ عليه الأثر، لكن الفعل وقع.
الجواب: الفرق بين النميمة والنصيحة:
أن المقصود من النميمة الإفساد الذي لا مصلحة فيه، إفساد بين الناقل والمنقول عنه، أما النصيحة: فالمقصود منها الإصلاح؛ لأن المقصود كف شر هؤلاء ومنع فسادهم.
[المتن]
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
[الشرح]
حيث إنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يرأف بهـٰذا مع أنَّ الله وصفه بالوصف الواضح: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾( ) . لكن هـٰذا ليس من المؤمنين؛ لأنه منافق من المنافقين، فلذلك لم يستحق أن يرأف به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، بل كان لا يزيده على ما أمره الله به من قوله: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.
[المتن]
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبَل.
[الشرح]
صحيح، ومن ذلك عذر هؤلاء في أنهم لم يعلموا أنَّ هـٰذا القول يفضي بهم إلى الكفر. وهـٰذه مسألة مهمة، هل من لوازم الحكم بالكفر على فعل من الأفعال العلم بأنَّ الفعل كفر؟ ظاهر الآية يدل على أنه ليس من شروط الحكم بالكفر أن يعلم من وقع منه أنَّه كفر، بل يُحكم بأنَّه كفر وأنه كافر ولو كان يجهل أنَّه كفر إذا كان عالماً بتحريمه وأنه ظلم، فإذا علم أنَّ الاستهزاء ظلم ومحرَّم ولم يظن أنه يصل به إلى حد الكفر وأنه كبيرة من الكبائر فإنَّ هـٰذا لا يشفع له في رفع الحكم، بل هو كافر يجب عليه أن يتوب من فعله.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾( )
قال مجاهد: هـٰذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد: من عندي.
وقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي﴾. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهـٰذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((إنَّ ثلاثةً من بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم مَلَكاً، فأتى الأبرص، فقال: أيُّ شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناسُ به. قال: فمسحه، فذهب عنه قذره، فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً، قال: فأيُّ المال أحب إليك؟ قال: الإبـل أو البقر-شك إسحاق-. فأعطي ناقة عُشَرَاء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعراً حسناً، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، أو الإبل، فأعطي بقرة حاملاً، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه، فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والداً، فأنتج هـٰذان وولَّد هـٰذا، فكان لهـٰذا وادٍ من الإبل، ولهـٰذا وادٍ من البقر، ولهـٰذا وادٍ من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيراً أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيراً، فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هـٰذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهـٰذا، وردّ عليه مثل ما ردّ عليه هـٰذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي ردّ عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فردّ الله إليَّ بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهَدُك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك)). أخرجاه.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾( ).)
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أنَّ قول من أنعم الله عليه: ﴿هـٰذا لِي﴾ لا يخلو من حالين:
إما أن يكون إنكارًا وكفرًا لنعمة الله عز وجل، بأن يضيفها إلى نفسه، على وجه الإيجاد والتسبب المستقل عن تقدير الله جل وعلا، أو المنصَرف فيه النظر عن تقدير الله –جلَّ وعلا- وإرادته، فهـٰذا لا شك أنَّه من الشرك، إما أن يكون شركًا أكبر، وإما أن يكون شركًا أصغر، فلذلك ذكر المؤلف -رحمه الله- هـٰذا الباب في كتاب التوحيد.
الوجه الثاني أو الحالة الثانية في قول القائل: ﴿هـٰذا لِي﴾ أن يكون ذلك مع إثبات التقدير، وأنَّ الله هو الذي تفضل عليه بهـٰذه النعمة، لكنه تفضَّل عليه بذلك لكونه مستحقّاً لهـٰذه النعمة، لا لفضل الله ورحمته وبره وجوده وكرمه، إنما لكون المنعَم عليه أهلاً لهـٰذه النعمة مستحقّاً لها، وهـٰذا فيه تكبر وتعاظم، ولا شك أن التكبر مما ينافي العبودية، بل هو من أعظم ما ينافي العبودية؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع العبودية لله - عز وجل- مع الكبر والعلو، فإنَّ الكبر ينافي العبودية؛ لأن العبودية ذُل وضَعة وانخفاض، فلهذين الوجهين ذكر المؤلف -رحمه الله- هـٰذا الباب وما فيه من الآيات والآثار في كتاب التوحيد.
أما مناسبته للباب السابق: فلم يظهر لي في ذلك شيء.
يقول رحمه الله: (باب ما جاء في قول الله تعالى) أي ما جاء في بيان ومعنى وتفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾. وهـٰذه الآية فيها الخبر عن حال الإنسان من حيث هو، فإنَّ الله –جلّ وعلا- أخبر عن وصف الإنسان في آيات عديدة من كتابه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، والمرادُ بالإنسان في هـٰذه الآيات الذي لم يستنر ويستضئ بنور القرآن وهدي السنة وما جاء به الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ ( )، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (06) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (07) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾( )، وكقوله: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾( ) . وما أشبه ذلك من الآيات التي يخبر فيها الله –جلَّ وعلا- عن حال الإنسان من حيث هو، فإذا استضاء بنور القرآن واهتدى بهدي خير الأنام تهذبت صفاته وتخلت من الظلم والجهل والكفر والكذب والهلع والكنود وما إلى ذلك.
يخبر الله –جل وعلا- في هـٰذه الآية عن حال الإنسان في النعمة والضراء، يقول: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ﴾ أي أذقنا الإنسان ﴿رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾ يعني: هـٰذه النعمة لي، وهـٰذه الإضافة لها وجهان.
يقول -رحمه الله- في بيانها من كلام السلف: (قال مجاهد: هـٰذا بعملي). أي هـٰذه النعمة وهـٰذه الرحمة التي نزلت بي ليست من فضل الله ولا من بره وجوده وإحسانه، إنما هي بعملي، باحترافي وجهدي وكدِّي (وأنا محقوقٌ به) يعني: وأنا أهلٌ لهـٰذه النعمة جديرٌ بها مستحقٌّ لها.
والمعنى الآخر قال: (وقال ابن عباس: يريد: من عندي). أي: من قِبَلي، من جهتي، لا من جهة فضل الله ورحمته وإحسانه وبرّه، ولذلك قال بعد هـٰذا: ﴿لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾( ) أي: الجنة والنّعيم الكامل.
﴿إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ وهـٰذا فيه استمرار غروره وجُحوده لنعمة الله وفضله.
وخاتمة هـٰذه الآية تدلّ على أن المراد بالإنسان هنا هو الكافر؛ لأنّ هـٰذا القول لا يمكن أن يكون صادرًا عمّن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه متضمن لإنكار البعث، وهـٰذا الذي جعل جماعة من المفسِّرين يقولون: إنَّ الضمير في قوله: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ﴾ عائدٌ إلى الكافر.
والقول الثاني: أنه عائد إلى الإنسان من حيث هو.
والصحيح أنه عائد إلى الإنسان من حيث هو، فإذا اهتدى بهدي القرآن سَلِم من هـٰذا القول، ولم يكن منه هـٰذا الاعتقاد.
ثم قال رحمه الله: (وقوله) أي وما جاء في قوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي﴾.
هـٰذه الآية، أو هـٰذا الجزء من الآية ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في موضعين من كتابه: ذكره في سورة القصص من قول قارون، حيث ذكَّره قومه بما يجب عليه في نعمة الله، قالوا له: قال الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا..﴾ ( ) الآية.
ثم ذكر بعـد هـٰذا التذكير قول قارون حيث قال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيـتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾( ). هـٰذا في جوابه لوعظ من وعظه في تذكر نعمة الله –جل وعلا- في المال الذي آتاه الله إياه: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾.
فأجاب الله -جل وعلا- على هـٰذا الزعم وكذَّب هـٰذا القول، فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾( ) فبَيَّن الله –جل وعلا- أنَّه قد أهلك قبل قارون من هو أكثر منه مالاً وقوةً وسعةً في الدنيا، والإهلاك يدل على أي شيء؟ على عدم الرضا، فدلَّ ذلك على أنَّ ما أُوتيه من المال ليس دليلاً على رضا الله جل وعلا عنه ولا دليلاً على اصطفائه واجتبائه.
وقد استدل قارون بإنعام الله -عز وجل- عليه على أنَّه مرضيٌّ عند الرب –جل وعلا-، فكذَّبته هـٰذه الآية.
جاء جزء هـٰذه الآية أيضًا في آية أخرى في سورة الزمر: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾( ). فالله –جلَّ وعلا- ذكر في هـٰذه الآية حال الإنسان على وجه العموم: أنَّه إذا مسه الضر ثم بدل الله هـٰذا الضر بالنعمة لم يكن منه شكر واعتراف بهـٰذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، بل كان منه جحود واستكبار، فكذَّبه الله –جل وعلا- أيضًا في هـٰذا الموضع فقال: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ يعني: بل هـٰذا الذي جرى له من الإنعام فتنة يختبره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها وينظر إيمانه وشكره لهـٰذه النعمة، إيمانه بالله وشكره هـٰذه النعمة التي أنعم بها عليه.
﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيـتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾. قال رحمه الله: (قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب). هـٰذا في بيان معنى قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيـتُهُ﴾ يعني: إنما أُعطيت هـٰذا، وحَصَّلت هـٰذا على علم عندي، ما معنى قوله: ﴿عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾؟
فيه وجهان:
الوجه الأول: على علمٍ مني بوجوه المكاسب، يعني: على معرفة مني بالطرق التي حصل لي بها هـٰذا الكسب وهـٰذا الإنعام، فأضاف حصولَ النعمة وحصولَ الخير إلى نفسه وجهده ومعرفته، فهو مضاف إلى العلم والخبرة والمعرفة.
الوجه الثاني في معنى الآية، قال: وقال آخرون: (على علم من الله أني له أهل). فقوله تعالى: ﴿عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي: على علم من الله بما عندي، فالعلم على الوجه الثاني مضاف إلى الله، يعني: إلى العلم الذي هو صفة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، لا إلى العلم الذي هو وصف للمخلوق، وهـٰذا هو الوجه الذي أشار إليه في قوله رحمه الله: (وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل). وهـٰذا معنى قول مجاهد: (أوتيته على شرف). وهـٰذا المعنى الأخير قريب من قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾( ). فإنَّ الآيةَ تدلَُ على أنَّ الإنعام إنما يكون دليلَ الرضا ودليلَ العلم بحال الإنسان في ظنِّ هؤلاء الذين قالوا هـٰذا القول، وقد كَذَّب الله –جل وعلا- هؤلاء، وبَيَّن أنَّ الإنعام ليس دليل الرضا ولا دليل الاصطفاء والاجتباء، إنما هو أمر يبتلي الله به من يشاء من عباده لينظر شكرهم وإيمانهم.
ومما يدلُّ على ترجيح الوجه الثاني في معنى الآية أنَّ الله –جلَّ وعلا- قال: ﴿قَاَل إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ يعني أُعطيته ولم يقل: حصَّلته وكسبته ونلته، إنما ذكر ذلك بفعل الإيتاء الذي قد لا يكون فيه للإنسان عمل ولا جهد: ﴿قَاَل إِنَّمَا أُوتِيتُهُ على علم عِنْدِي﴾ فكذَّب الله –جل وعلا- قوله في الآيتين.
أما في سورة القصص في قصة قارون فبخبره عن الأمم السابقة وما كانوا عليه من القوة وما جرى لهم من الأخذ.
أما في السورة الثانية –سورة الزمر- فما ذكره الله –جلَّ وعلا- من أنَّ هـٰذا فتنة حيث قال: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾.
ثم قال رحمه الله: (وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ) وذكر الحديث الطويل الذي فيه الخبر عن ثلاثة من بني إسرائيل، قصَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خبرهم ونبأهم في هـٰذا الحديث.
قال: (وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى)). )
((أبرص)) البرص: مرض يصيب الجلد يذهب بلونه.
((أقرع)) مرض يصيب الرأس يذهب بالشعر الذي فيه، وقد يصاحب هـٰذا الذهاب تغير لون جلدة الرأس.
((وأعمى)) العمى معروف، وهو فقد البصر.
هـٰذا نبأ هؤلاء الثلاثة، وذكرهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذه القصة بأوصافهم التي جرى عليهم بها الابتلاء، فذكرُ هـٰذه الأوصاف لا مدحًا لأهلها ولا ذمّاً لمن حصل منه مُوجب الذم، إنما ذكرَ ذلك لبيان الأوصاف التي جرى الاختبار بها.
ولهـٰذا لا يُستدلُّ بهـٰذا الحديث على أنَّ الأعمى أفضل حالاً من الأقرع والأبرص؛ لكون الأبرص والأقرع جرى منهما الكفر، والأعمى استقامت حاله، فإن هـٰذا الاستدلال ضعيف لا وجه له، وهو استدلال طردي بوصف لم يعلق عليه الشارع مدحًا ولا ذمّاً، إنما هي واقعة حال، واقعة عين، ذكر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأوصاف التي جرى فيها الاختبار التي هي موضوع الامتحان، أبرص وأقرع وأعمى.
((فأراد الله أن يبتليهم)) أي يختبرهم، وفي رواية البخاري: ((فبدا لله أن يبتليهم)). وقد تكلم بعض الشراح على رواية بدا، وقالوا: إنها لا تناسب؛ لأن البداء ممنوع في حق الله جل وعلا، فإن كانت هـٰذه اللفظة محفوظة فإنها تحمل على رواية مسلم، ويكون المعنى: أراد الله أن يبتليهم، وليس البداء الذي لم يكن قد سبق به علم الله –جل وعلا- وسبق به تقديره.
((فأراد الله أن يبتليهم)) أي يختبرهم.
(( فبعث إليهم ملكًا)) وهـٰذا المَلَك جاءهم على صورة إنسان فيما يظهر.
((فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحب إليك؟)) ولعله جاءهم بصورته، الله أعلم، لكن فيما يظهر من القصة أنَّه جاءهم على صفة إنسان.
((فقال: أي شيء أحب إليك)) يعني: أي شيء تحب في هـٰذه الدنيا؟
((فقال: لون حسن، وجلد حسن)). وهـٰذا يدلُّ على أنَّ البرص ليس فقط يؤثر على اللون بذهابه، بل يؤثر حتى على الجلد، ولذلك قال: ((لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به)). يعني: بسببه، قذرني: أي كرهني، وهـٰذا ليس وصفًا لكلِّ برص، إنما هو في نوع منه وهو ما يصاحبه سبب للنفرة، وإلا فإنَّ البرص في ذاته ليس سببًا لكراهية الناس وقَذَرِهم للشخص، إلا في بعض أنواعه التي يكون فيها البرص مؤثرًا في الجلد مما يصدر عنه رائحة يكره الناس من أجلها -أي من أجل هـٰذه الرائحة مع اختلاف اللون- صاحب المرض بسببها.
وذكر بعض الشراح أن قوله: ((قد قَذَرَني الناس به)) من حيث التشاؤم؛ لأن الناس يتشاءمون بالأبرص، لكن هـٰذا ليس بصحيح، وليس معروفًا، ولعلَّه عرفٌ خاص لبعض الجهات .
أما المقصود بـ ((قَذَرَني الناس به)) أي كرهوني من أجله.
((قال: فمسحه)) مسح أي شيء؟ مسح هـٰذا المريض الأبرص، مسحه فبرئ، وذلك بقوله: ((فذهب عنه قذره)) أي ذهب عنه المرض الذي اشتكى منه وكرهه.
((فأُعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً)). ولم يقتصر الإنعام والفضل والاختبار على هـٰذا فقط، بل أذهب عنه السوء وأمدَّه بالفضل والرحمة. ((قال: فأي المال أحب إليك؟)) سألَه عن أيِّ أنواع المال أحب إليك؟ ((قال: الإبـل أو البقر)) اختار الإبل أو البقر، ((أو)) هنا للشك من الراوي، قال: ((شك إسحاق)) أحد رواة الحديث. ((فأعطي ناقة عُشَرَاء)) والناقة العشراء: هي الناقة التي تنتج كثيرًا، وقيل: ((عُشراء)) أي التي بلغت الشهر العاشر من الحمل وقَرُب وضعها، وهي ناقة شريفة نفيسة تتعلق بها النفوس؛ لأن خيرها قد قَرُب، حيث إنها قد قَرُب وضعها.
((فأعطي ناقة عُشراء، وقال: بارك الله لك فيها)). فأحسن الله إليه بإذهاب السوء عنه، وأحسن الله إليه بمال نفيس الذي يَقرُب خيره ونماؤه، وزاده فضلاً بأن جعل الملَك يدعو له، فقال: ((بارك الله لك فيها)). وأجاب الله دعاء الملَك، حيث بُورك له فيها فكان منها مالٌ كثير.
((قال: فأتى الأقرع، فقال: أيُّ شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به)). وهـٰذا يدلُّ على أن القرَع الذي كان في هـٰذا الرجل ليس مما يخفيه ستر الرأس؛ لأن ستر الرأس قد يخفي هـٰذا العيب، ويبدو الإنسان سليمًا منه، لكنَّه قَرَعٌ يحصُل به القَذَر، وهو ما قد يكون معه من الرائحة التي يكره الإنسان الجلوس إلى صاحبها، المراد أنه طلب شعرًا حسناً وأن يذهب عنه الذي قَذَره الناس به.
((فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعراً حسناً. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، أو الإبل. فأعطي بقرة حاملاً، قال: بارك الله لك فيها)). وهـٰذا كالأول.
ثم قال: ((فأتى الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه، فردَّ الله إليه بصره)). وهـٰذا فيه عظيمُ إنعام الله -عز وجل- عليه برد البصر.
((قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والداً)) أي قَرُب وضعها.
((فأنتج هـٰذان)) أي: صاحب البقر والإبل ((وولَّد هـٰذا)) أي صاحب الغنم.((فكان لهـٰذا)) أي: للأبرص.
((وادٍ من الإبل، ولهـٰذا)) أي للأقرع ((وادٍ من البقر، ولهـٰذا)) أي: للأعمى ((وادٍ من الغنم. قال: ثم إنَّه أتى الأبرص في صورته وهيئته)). الملَك أتى في هـٰذه المرة على صورة صاحب البلاء، فأتى الأبرص على صورة الأبرص وعلى هيئته في الصورة والحال، فقد وافقه في الشكل والحال.
((فقال: رجلٌ مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري)). والحبال: جمع حبل، وهو ما يحصل به التوصل إلى المقصود، وهو كنايةٌ عن الإعدام والانقطاع.
يقول: ((فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك)). أي: لا وصول لي إلى مرادي ومقصودي إلا بالله ثم بك، بالله لأنه –جل وعلا- منه كل شيء، ثم بك على وجه السبب والتبع، وهـٰذا هو الذي ينبغي عند ذكر السبب مع الله –جل وعلا- أن يُعطَف على لفظ الجلالة، على اسم الله -عز وجل- بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، كما تقدم.
قال: ((أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيراً أتبلغ به في سفري)). أي: أصل به إلى مقصودي وغرضي من هـٰذا السفر.
((فقال)) صاحب المال ((الحقوق كثيرة)) الحقوق: جمع حق، والمراد به أنَّ عليه من الحقوق والواجبات ما يضيق بسببها المال عن الإعطاء، فاعتذر بكثرة الحقوق المانعة من إخراج ما طلب وإعطاء ما طلب، وهو في هـٰذا كاذب، وإلا فلو كان صادقًا لمََا عاقبه الله –جل وعلا- بما سيأتي؛ لأنه إذا كان على الإنسان حقوق كثيرة وعنده مال فإنَّه لا يجوز له على الصحيح أن يتبرع بما يحصل به ضرر أصحابِ الحقوق.
قال رحمه الله: ((فقال له: كأنِّي أعرفك)). هـٰذه للتحقيق أو للشك؟ للتحقيق: كأنِّي أعرفك، أو للشك في أول الأمر فيما يظهر للسامع، حتى يذكره بحاله لعله ينزجر.
يقول: ((كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يَقذرُك الناس، فقيراً، فأعطاك الله -عز وجل- المال؟ فقال: إنما ورثتُ هـٰذا المال كابراً عن كابر)). فجحد نعمة الله عليه، وكَذَب حيث قال: ((إنما ورثت)) أي: حَصَّلتُ ((هـٰذا المال كابرًا عن كابر)). يعني: ليس هـٰذا المال من الإنعام الحاضر، بل هو من الإنعام السابق على آبائي المتقدمين.
ومثل هـٰذا هل يوجب الشكر، أو يُوجب الكفر؟
الجواب: أنَّ مثل هـٰذا في الحقيقة يُوجب الشكر؛ لأن من كان الإنعام سابقًا على آبائه فإنَّه من نعمة الله عليه أن يكون الإنعام ليس مقتصرًا عليه هو، بل عليه وعلى آبائه، فاحتج بحجة باطلة في رد نعمة الله الحاضرة.
((إنما ورثت هـٰذا المال كابرًا عن كابر. فقال: إن كنتَ كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت)).((فصيرك الله)) أي: ردك وجعلك تصير ((إلى ما كنت)) أي إلى حالك التي كنت عليها من سوء المنظر، وقَذَرِ الناس، وقلَّة ذات اليد.
((قال: وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهـٰذا)) أي في السؤال والطلب، ((وردَّ عليه)) أي الأقرع ((مثل ما ردَّ عليه هـٰذا)) أي مثل ما رد عليه الأبرص ((فقال: إن كنت كاذباً)) في دعواك ((فصيّرك الله إلى ما كنت)) يعني: من سوء الحال وقلة ذات اليد.
((وأتى الأعمى في صورته)) أي: في صورة أعمى ((فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي ردّ عليك بصرك شاة أتبلّغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فردّ الله إليَّ بصري)). هـٰذا أقر بنعمة الله -عز وجل- عليه، وإحسانه إليه ((فخذ ما شئت)) فحق تلك النعمة أن يقابل الإنعام بالإنعام ((فخذ ما شئت)) أي من المال ((ودع ما شئت)) أي من المال ((فوالله)) وهـٰذا قَسَم لتأكيد ما سيقول ((لا أجهدك)) أي لا أشق عليك، ولا أردك، وفي بعض النُّسَخ: ((لا أحُدُّك)) أي لا أمنعك، في بعض نُسخ الصحيح.((فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله)) أي: لا أمنعك؛ طلبًا لما عند الله –جل وعلا-، ورغبة فيما عنده، وإخلاصًا له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
((فقال)) الملك الذي جاء في صورة الأعمى: ((أمسك مالك)) وهـٰذا فيه بيان أن هـٰذا الطلب وهـٰذا السؤال ليس إلا للامتحان والاختبار، وليس للأخذ، وهل هـٰذا له نظير في التكاليف الشرعية؟ الجواب: نعم، له نظير في التكاليف الشرعية، منها ما كلَّف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به إبراهيم -عليه السلام- في ذبح ابنه، حيث إنَّه أمره أن يذبح ابنه وابتلاه بهـٰذا البلاء العظيم. ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا﴾( ). أي حصل منك غرضنا ومقصودنا، وهو الاستسلام والامتثال لأمر الله عز وجل.
ومن هـٰذا نستفيد فائدة:
أنَّ من الأحكام الشرعية وكذلك الأحكام القدرية التي يجريها الله -عز وجل- على العبد ما قد يكون المقصود منه الامتثال لا حصول الفعل، وهـٰذا مثال واضح في قصة إبراهيم -عليه السلام-، وكذلك واضح في هـٰذا، حيث إنَّ الله –سبحانه وتعالى- لم ينقص هـٰذا من ماله شيئاً، فإنَّ الملك لم يأخذ من ماله شيئاً، إنما اختبر هـٰذا حتى حصل منه الامتثال وبذل المال، فلما كان ذلك قال له: ((أمسك مالك، فإنما ابتليتم)). يعني: إنما وقع الاختبار والامتحان عليكم بهـٰذا ((فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك)).((رضي الله عنك)) ورضا الله –جل وعلا- صفة من صفاته –سبحانه وتعالى-، وهو غاية ما يسعى إليه الساعون ويطلبه الصادقون. ((رضي الله عنك)) بما جرى منك من شكر الله لنعمته. ((وسخط على صاحبيك)) اللذين كفرا نعمة الله عليهما، وجحدا إنعامَ الله، وبخلا بالمال.
الشاهد من هـٰذا الحديث:
بيان حال من إذا أُنعِم عليه شَكَر، وحال من إذا أُنعِم عليه كَفَر، فحال هـٰذا الرضا، حال من شكر الرضا، وحالُ من كَفَر السخَط، وقد يحُل به عقاب الله –جل وعلا- في الدنيا قبلَ الآخرة، وهـٰذا يُوحب أن يحذَرَ المؤمن من كُفرِ النعمة، ولو كان هـٰذا الكفر بأن ينسب النعمة إلى نفسه، ولذلك ليحذر المؤمن من قوله: هـٰذا لي، أو هـٰذا عندي، فإنَّ هـٰذه الأقوال مما يغفُل بها الإنسان عن نعمة الله وفضله، ويعتد بما عنده من المُكنة والقدرة التي هي من إفضال الله وإنعامه وإحسانه.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآية.
الثانية: ما معنى: ﴿لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾؟
[الشرح]
تفسير الآية تقدم، وهي ليست آية واحدة، أو ليست آية كاملة، إنما هي جزء آية في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾ الآية في سورة فصلت.
الشيخ أراد الآية كلها ولذلك قال: (الآية).
(الثانية: ما معنى: ﴿لَيَقُولَنَّ هـٰذا لِي﴾؟) وذلك بما بَيَّنَه من أثر مجاهد وابن عباس.
[المتن]
الثالثة: ما معنى قوله: ﴿أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي﴾؟
[الشرح]
واضح، وأنَّ في قوله تعالى: ﴿عَلَى عِلْمٍ عِندِي﴾ قولين:
القول الأول: أن العلم مضاف إلى الإنسان.
القول الثاني: أن العلم مضاف إلى الله.
[المتن]
الرابعة: ما في هـٰذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
[الشرح]
صحيح، وهي قصة فيها من العِبَر والعجائب ما يطول المقام بذكره، لكن نحن اقتصرنا على ما يتعلق بالباب، وإلا ففيها فوائد كثيرة.
من الفوائد التي فيها: جواز الاكتفاء بظاهر الحال في إعطاء الزكاة، فإنَّ الأعمى اكتفى بظاهر حال هـٰذا الرجل في إعطاء المال، ولم يطلب منه بيِّنة على فقره وحاجته وانقطاعه، هـٰذا ما لم تدلَّ القرينة على كذب المدعي للفقر، والله تعالى أعلم.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس السادس والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا﴾( ).
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبَّد لغير الله، كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب.
وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشـاها آدم حمـلت فأتاهما إبليس، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتُطيعانِني أو لأجعلن له قرنَيْ أَيِّل، فيخرج من بطنكِ فيشقُّه، ولأفعلنَّ ولأفعلنَّ؛ يخوفهما. سَمِّياه عبدَ الحارث، فأَبَيا أن يطيعاه، فخرج مَيِّتًا، ثم حملت، فأتاهما، فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمَّياه عبد الحارث، فذلك قوله: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا﴾. رواه ابن أبي حاتم.
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته.
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا﴾ قال: أشفقا ألا يكون إنسانًا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
[الشرح]
قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾.)
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن التّعبيد لغير الله -عزّ وجل- من الشرك الذي يجب أن يتنَزَّه عنه المؤمن، وفيه أيضًا: أن حق النعمة أن تُشكر لا تُكفر، ومن حق نِعَم الله على عبده أن يوحده بالعبادة؛ ولذلك ذكر الله -جل وعلا- حال الإنسان في هـٰذه الآية منكِرًا عليه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ إذ حقُّه -جل وعلا- أن يُفرد بالعبادة، وأن يُشكر على إنعامه بتوحيده، لا بالإشراك به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، هـٰذه مناسبته لكتاب التوحيد.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن في الباب السابق ذِكْرَ قصة الثلاثة الذين أنعم الله عليهم بإزالة البلاء، وأحسنَ إليهم بالمال الذي توسّعوا فيه، فمنهم من شكر فَشكَر الله له ورضي عنه، ومنهم من كفر فسَخِط الله عليه وردَّه خاسرًا، فكذلك في هـٰذا الباب بيان حق النعمة، حق إنعام الله -عز وجل- ، وهو أن يُوحَّد -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فشكره أعظم ما يكون بتوحيده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، هـٰذه مناسبة الباب للذي قبله.
قال رحمه الله: (باب قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾.)
لا يَتبيَّن المعنى في هـٰذه الآية إلا بالنظر إلى التي قبلَها، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾( ).
ثم قال تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾. أي: إنهما نَكَثا بالعهد الذي التَزَماهُ، وهو الشكر في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ فجعلا له شركاء، فنقضا العهد الذي تقدَّمَ وقد أقسما عليه؛ لأن قوله تعالى: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا﴾ اللام هنا هي الداخلة في جواب القسم، والتقدير: واللهِ لئن آتيتنا صالحاً لنكوننَّ من الشاكرين، فنقضا العهد ونكثا في اليمين، حيث جعلا له شركاء فيما آتاهما.
وهـٰذه الآية للمفسرين فيها قولان في مرجِع الضمير في قوله تعالى:﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا﴾، مرجِع الضمير اختلَف فيه أهل التفسير على قولين:
القول الأول: أن مرجِع الضمير إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ لأن الله -جل وعلا- قال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾. ثم بعد أن ذكر مبدأ خلق الإنسان وذكر الحَمْل ذكر هـٰذا الخبر، ومعلومٌ أن الذي خُلق من نفس واحدة هو حواء أولاً؛ لأن الله -عز وجل- خلق آدم من سُلالة من طين، ثم خلق منه حواء كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾( ).
فالناس مخلوقون من نفس واحدة، ثم بعد ذلك تناسَل من آدم وحواء بنو آدم، فالكلام في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا﴾ أي: لما آتى الله -جل وعلا- آدمَ وحواء ولدًا سليمًا، هـٰذا معنى قوله: ﴿صَالِحًا﴾ سويّاً ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا﴾، وجاء ما يدل على هـٰذا القول: حديث سمرة في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي، فإن فيهما بيان الشرك الذي أشارت إليه الآية في قوله تعالى: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ﴾، حيث إن حواء طاف بها الشيطان، وكانت قد ولدت عدة أولاد لكنهم يموتون، فطاف بها الشيطان، فقال لها: سَمِّيه عبدَ الحارث، فسمَّتْه عبد الحارث فبقي، فعاش.
وجاء في الأخبار عن بعض السلف -والظاهر أنه من أخبار بني إسرائيل أن الشيطان كان اسمه الحارث-، كان اسمه الحارث لمَّا كان في الملائكة ومعهم، وهـٰذا الحديث كما ذكرناه هو في المسند والترمذي، ولكنه حديثٌ معلولٌ؛ فهو من رواية الحسن عن سَمُرة، ومعلومٌ أن الحسن لا يصحُّ سماعُه عن سمرة فيما عدا حديث العقيقة، كما أن فيه راوياً اختُلِف في توثيقه، كما أن المتن فيه نَكارة، ولذلك ضعَّفه جماعة من العلماء، وهـٰذا القول - على القول بثبوته، وأن الضمير يعود إلى آدم وحواء كما هو قول كثير من المفسرين - لا إشكال فيه من حيث وقوع الشرك، فإن الشرك في ظاهر الرواية لم يكن من آدم -عليه السلام-، ثم إن الشرك لم يكن شركًا عباديّاً، إنما هو شركٌ في التسمية فقط، لا في العبادة وصَرْفِها لغير الله -عز وجل-، وقد ذكر العلماء لهـٰذا الإشكال أجوبة عديدة.
والقول الثاني الذي ذهب إليه جماعة من المحقِّقين من أهل العلم: أن الضمير في الآية يعود إلى جنس بني آدم، إلى الذرية، لا إلى آدم وحواء؛ لأن آدم -عليه السلام- قد قال الله -جل وعلا- فيه: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾( ). ومَن كان هـٰذا شأنه لا يقع منه الشرك، ولذلك ضرب ابن القيم -رحمه الله- صفحًا عن هـٰذا الأثر، وقال: لا يَغُرَّنَّكَ ما جاء وذكر القصة، فإنه لا يمكن أن يقع هـٰذا منهما بصَرْفِ النظر عن ثبوت الحديث من حيث السند، ولا شك أن هـٰذا القول يندفع به إشكالٌ كبير يتكلَّف الإنسان في الجواب عنه، فما الجواب عن التثنية في قوله: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا﴾؟ نقول: الجواب: أن التثنية عائدة إلى الذَّكر والأنثى، ولا غَرابة في أن يكون أول الحديث عن أشخاص، ثم يَستَطْرِد الحديث إلى أنواع، وهـٰذا له نظائر كثيرة في القرآن، يبدأ الحديث عن أشخاص ثم ينتقل من الشخص إلى الجنس، من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾( ). هل الرَّجم للشياطين يقع بالنجوم التي هي زينة ومصابيح؟ الجواب: لا، إنما هو بالشُّهُب، لكنه انتقل من الشخص إلى الجنس، وهو جنس المضيء في السماء. ومن نظائره أيضًا: ما جاء في خلق الإنسان، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾( ). هـٰذا في حق مَنْ؟ آدم، لكن قال الله -عز وجل- هل ذكر ذلك خاصّاً في آدم؟ لا، جاء الخبر عامّاً في آدم وغيره، ولكن يُعلم أنه ليس هـٰذا في غير آدم -عليه السلام-، فإن بقية الخَلق قال الله فيهم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾( ). فالنطفة التي في قرارٍ مكين هي حال الجنس، أما الشخص فحاله أنه سلالة من طين، وهـٰذا نظائره كثيرة في القرآن لمن تأمَّل ونَظَر، فإنّ النصوص قد تستَطْرد من الشخص إلى الجنس، وهـٰذا أحد المواضع والشواهد، فإن الله -عز وجل- ذَكَر أوَّلَ ما ذَكَر في هـٰذه الآية خَلْقَ الإنسان: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾( ). الآن انتقل إلى الجنس لا إلى الشخص؛ لأن التَّغَشِّي لا يكون فقط خاصّاً بآدم وحواء عليهما السلام، بل هو عام للجميع، فيكون انتقل النص من الشخص إلى الجنس.
وهـٰذا القول لا شك أنه قول وجيهٌ قوي يندفع به ما يَرِد على التفسير الذي ذكره الشيخ -رحمه الله- نقلاً عن المفسرين ، يندفع به الشيءُ الكثير، ولذلك ذكر جماعة من العلماء أن هـٰذا الذي ذُكر في الكتب، بل حتى ما ورد عن سَمُرَة الظاهر أنه من أخبار بني إسرائيل، ولذلك سمرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لم يذكر هـٰذا في تفسير الآية مرفوعًا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل فسرها بغير ذلك، ووَرَد أيضًا تفسيرُها بغير هـٰذا عن الحسن الذي روى عن سمرة، فلو كان ثابتًا عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما عَدَلا عنه إلى غيره.
إذاً: نخلُص من قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا﴾ إلى أن مرجِع الضمير في الآية فيه كم قولاً؟ فيه قولان، أن مرجع الضمير فيه قولان:
القول الأول: أنه آدم وحواء، وهو قول كثير من المفسرين.
القول الثاني: أنه إلى الجنس الذَّكر والأنثى.
في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا﴾ ذكرنا أن ﴿صَالِحًا﴾ هنا المراد به السَّوِي في الخِلقة، وذكر الطبري -رحمه الله- أن (الصالح) هنا يشمل الصلاح في الدين، والصلاح في تدبير الأمور، والآية صالحة لهـٰذا، فيمكن أن يقال: (صالح) أي: في الخلقة سويّاً كاملاً، وفي التدبير والتصرف صالحاً كاملاً.
قال: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾، ﴿جَعَلا لَهُ﴾ أي: جـعلا لله -عز وجل-، ﴿جَعَلا﴾ الذكر والأنثى، ﴿لَهُ﴾ أي: لله -عز وجل- ﴿شُرَكَاَء﴾. وهـٰذا يُبيِّن لنا أن الشركة أو الشرك لا يَختص فقط بصَرْف العبادة، بل بكل ما يُنازع الله حقَّه، ولو كان ذلك في التسمية والتعبيد، ولذلك أجمع العلماء على تحريم كل اسم مُعَبَّد لغير الله -عز وجل- ، قال الشيخ رحمه الله: (قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّد لغير الله)؛ لأنه لا يليق أن يكون هـٰذا لغير الله، فإن العبودية على وجه الإطلاق لا تناسب إلا لله الذي هو ربُّ كل شيء، والذي له كل شيء.
قال -رحمه الله- في التمثيل: (كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك). يعني: من الأسماء التي تُعَبد لغير الله. (حاشا) يعني: عدا، خلا، غير (حاشا عبد المطلب) فإنهم لم يتفقوا على تحريم تَعْبِيدِه، وقد ذهب العلماء في هـٰذا مذهبين:
المذهب الأول: تحريم التسمية بعبد المطلب؛ لأنه تعبيد لغير الله، فالمطلب ليس من أسماء الله -عز وجل- ، فهو مما يدخل في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾.
والمذهب الثاني: أنه يجوز التعبيد للمطلب، فيصح أن تقول: عبد المطلب، واستدلوا لهـٰذا بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أنا النبيُّ لا كَذِب، أنا ابن عبد المطلب)). فكونُه يُقِر الانتسابَ إلى هـٰذا الاسم الذي ظاهره الشرك يدل على جوازه، وأنه لا محظور فيه، وذكروا أن من الصحابة مَن اسمه عبد المطلب، وهو عبد المطلب بن ربيعة، ولهـٰذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- صِحةَ وجواز التسمية بهـٰذا الاسم، يصح أن يسمّى عبد المطلب.
والصحيح أنه لا يجوز التسمية بهـٰذا الاسم، أما قولهم واستدلالهم بأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أنا ابن عبد المطلب)). فهـٰذا انتساب وليس إنشاء تسمية، وفَرْقٌ بين الإخبار والانتساب، وبين الإنشاء، فإن الإنشاء له شأن وحال وحُكم، وأما الانتساب فالأمر فيه أوسع، ثم إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عُرف بهـٰذا الاسم بين العرب واشتَهر به، وتميَّز به عن غيره، فلذلك ذَكره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
أما ما ذُكر مِنْ أنَّ مِنَ الصَّحابة مَنِ اسْمه عبد المطلب، فالتحقيق أن اسمه: المُطَّلِب، وليس عبد المطلب، كما ذكر ذلك الزبير بن بَكَّار، وهو مِن أَعْلَم المؤلفين بالصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- وأسمائِهم وأنسابِ قريش، فعلى هـٰذا لا يصح التسمية بعبد المطلب، لكن الخلاف واقع، وما ذكره ابن حزم على وجهه.
ثم قال رحمه الله: (وعن ابن عباس في الآية) يعني: في معناها وتفسيرها، (قال: لما تغشاها) أي: وَطِئها، (لما تغشاهـا آدم حملت، فأتاهمـا إبليس)، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا﴾. وهـٰذا في حال كَوْن الحمل نطفة وعلقة ومضغة في أول الحمل لا تَشعر به المرأة. ﴿حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِه﴾ (مرت) أي: استمرت بهـٰذا الحمل ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾. يقول: (فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتُكما من الجنة). يعني: هـٰذا في الحقيقة يدل على ضَعف هـٰذا الأثر؛ لأنه لا يمكن أن يقدِّم إبليس في عرضه وطلبه بهـٰذا التقديم؛ لأن هـٰذا التقديم يوجِب الانقياد لتوجيهه، أو الانصراف عمَّا يقول والإعراض؟ يوجب الانصراف والإعراض. (لَتُطِيعانِني أو لأجعلن له قرنَيْ أَيِّل) الأَيِّل: ذَكَر الوعْل.(فيخرج من بطنك فيشقُّه، ولأفعلن؛ يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبَيا أن يطيعاه، فخرج ميِّتًا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ذلك، فأدركهما حبُّ الولد) يعني: خَشِيا من موته (فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: ﴿جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا﴾ رواه ابن أبي حاتم).
وما في الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث سَمُرَة أَخْصَر من هـٰذا، وليس فيه هـٰذا التفصيل الذي ذكره في هـٰذه الرواية، التفسير هـٰذا لا يرفعه ابن عباس إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بل هو من قوله، ولعله مأخوذ من بني إسرائيل.
قال رحمه الله: (وله) أي: لابن أبي حاتم (بسند صحيح عن قتادة)، قال: (شركاءَ في طاعته، ولم يكن في عبادته) يعني: في طاعته في التسمية، (لا في عبادته) يعني: لا في صَرْف العبادة إليه.
(وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا﴾ قال: أشفقا ألا يكون إنسانًا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.)
والشاهد من هـٰذا الباب ما ذكره المؤلف -رحمه الله- في المسائل مِن أن من الواجب إفراد الله -عز وجل- بالعبادة والشكر، وأن حق النِّعم أن يُفرد الله -عز وجل- بالتوحيد والعبادة.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تحريم كل اسم مُعَبَّدٍ لغير الله.
الثانية: تفسير الآية.
الثالثة: أن هـٰذا الشرك في مجرد تسميةٍ لم تُقصَد حقيقتُها.
[الشرح]
يعني: أن هـٰذا الشرك في مجرد الاسم، لا أنه في معنى ما تضمنَّه هـٰذا الاسم من أن الولد يكون عبدًا للشيطان، فإن هـٰذا لم يكن قصدهما، ولم يطلبه إبليس منهما، إنما اقتصر فقط على التعبيد اللفظي، لكن لما كان التّعبيد اللفظي قد يتطرّق منه التعبيد القلبي الحقيقي مَنَعَ منه الشارع، وجعله من الشرك.
[المتن]
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنتَ السوية من النِعَم.
[الشرح]
في بعض النسخ: الولد، وهي أَصْوَب، ولا شك أنه من النعم؛ لأن حقها أن تُشكر، قال في الآية: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾. فكون الإنسان يُرزق ويُؤتى بولد سَوِيٍّ كامل صالح هـٰذا من النعم التي توجب الشكر والثناء على الله -عز وجل- بها.
[المتن]
الخامسة: ذِكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
[الشرح]
هـٰذا واضح؛ والمقصود بالطاعة هنا: الطاعة التي لا تَستلزم تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فإنّ الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام، هـٰذا مما يصير به الإنسان مشركًا شركًا أكبر؛ لأنه شركٌ في الإلهية، وشركٌ في الربوبية، لكن لو أطاع غير الله فيما نهى عنه الله فإنه قد يكون من الشرك، لكنه ليس من الشرك الذي يخرج به الإنسان عن الملة؛ لأنّه طاعة في امتثال الأمر ومخالفة الشرع، في مخالفة أمر الله، أو في ارتكاب ما حرمه الله، أو ما أمر بفعله.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾( ) .
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ﴿يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾: يُشركون، وعنه: سموا اللات من الإله، والعُزى من العزيز.
وعن الأعمش: يُدخلون فيها ما ليس منها.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾.)
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أنه لا يمكن أن يتم التوحيد - توحيد العبادة - لمَنْ نَقص في توحيد الأسماء والصفات أبدًا، كل مَنْ قَصُرَ علمه واعتقاده في توحيد الأسماء والصفات قَصُرَ في توحيد العبادة ولا شك؛ لأن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة، فإن مَن أثبت لله -عز وجل- الأسماء وما تضمنته من المعاني أورَثَهُ هـٰذا أمرين:
الأمر الأول: المحبة لله -عز وجل-.
والأمر الثاني: التعظيم له -جل وعلا- وهما قُطْبا التوحيد، لا يتحقق لأحدٍ التوحيد إلا بأن يعظِّم الله -جل وعلا- ويُثْبِت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.
ثم مناسبة هـٰذا الباب للباب الذي قبله: أنه ذكر في الباب السابق أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب التعبيد لأسماء الله -عز وجل-، فذكر الاتفاق في تحريم كل اسم مُعَبَّد لغير الله، والاتفاق في أي شيء؟ في استحباب الأسماء التي التعبيدُ فيها لله -عز وجل- وأسمائه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾.)
لله وحده لا شريك له، ولذلك قدَّم الجار والمجرور، اللام ولفظ الجلالة، الجار والمجرور قَدَّمَهُ لإفادة الحَصْر، وأنها له دون غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾؛ ﴿الحُسْنَى﴾: مؤنث الأَحْسَن، فهي أَفْعَل تفضيل، أي: له الأسماء المنتَهِية في الحُسن، قال الله تعالى: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ أي: فتعبَّدُوا له بها، فالدعاءُ هنا يشمل: دعاء المسألة، ودعاء العبادة، ودعاء الثناء، كل هـٰذا مما يدخل في قوله تعالى: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ أي: بهـٰذه الأسماء . قال: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ اتركوا الذين يميلون في أسمائه عمَّا يجب فيها من الإثبات والتعبد. والإلحاد المشار إليه في الآية فَسَّرَهُ، ذكر الشيخ -رحمه الله- بعض صُوَرِه المتعلقة بكتاب التوحيد. قال رحمه الله: (ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ﴿يُلحدون في أسمائه﴾: يشركون). يشركون في أسمائه، هـٰذا من صور الإلحاد. أولاً: الإلحاد ما هو؟ الإلحاد في اللغة مأخوذ من المَيل، والإلحاد في الأسماء هو المَيْل بها والعدول عمَّا يجب فيها من الإثبات، وعمَّا تضمنته من الحقائق والمعاني، هـٰذا معنى الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-. وله صور، ذكر المؤلف -رحمه الله- بعض صوره:
الصورة الأولى: تسمية غير الله بها، وهو المشار إليه في قوله: (يشركون)، تسميةُ غير الله بها، أي: بالأسماء الحسنى من الشرك، ومن الإلحاد في أسمائه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ومن ذلك أيضًا، الصورة الثانية: الاشتقاق من أسمائه للمعبودات والأصنام، فاشتقاق الأسماء المحدَثة للآلهة من دون الله من أسمائه هـٰذا من الإلحاد في أسمائه. ومثله ما ذكره المؤلف رحمه الله: (وعنه: سموا اللات من الإلـٰه، والعزى من العزيز). فاللات: مشتقٌّ من الإله، والعُزى: اسم صنم معظَّم عند أهل الكفر في الجاهلية مأخوذٌ من العزيز، وكذلك مناة: مأخوذ من المنان.
ثم قال: (وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها). وهـٰذه هي الثالثة من صور الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-: أن يُسمى بما لم يُسَمِّ به نفسه، ومثاله: تسمية الفلاسفة لله -عز وجل- بـ: (العلة)- الله يعطيهم العلة- وتسمية النصارى لله -عز وجل- بـ: (الأب)، وتسمية أهل الكلام لله -عز وجل- بـ: (واجِب الوجود)، كل هـٰذا من الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-.
الرابعة من صور الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-: نَفْيُ ما سمى الله به نفسه، كما فعلت قريش وأهل الجاهلية في إنكار اسم الرحمـٰن: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾( )، فإن نفي ما سمى الله به نفسه من الإلحاد في أسمائه.
الخامسة من صور الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-: نَفْيُ ما تضمنته هـٰذه الأسماء من المعاني أو تحريفُه، فالذين يقولون: يعلم بلا عِلم، ويقدِر بلا قُدرة، ويسمع بلا سَمع، من هؤلاء؟ مَنْ هُم؟ المعتزلة، المعتزلة الذين يقولون: يعلم بلا علم، ويسمع بلا سمع، ويُبصر بلا بصر، هؤلاء ألحدوا في أسماء الله أو لا؟ ألحدوا؛ لأنهم نَفَوْا عن هـٰذه الأسماء معانيها. الذين يقولون: إن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يسمع بسمعٍ متقدِّم حصل به سماع ما يكون من الأصوات، ليس سمعًا متجددًا عند حدوث الأصوات، هؤلاء ألحدوا في أسماء الله -عز وجل-. الذين نَفَوا الصفات وأَوَّلُوها كالرحيم وغير ذلك من الأسماء، فقالوا: الرحيم هو مريد إيصال الخير، ليس أنه متصف بالرحمة، كما تقول الأشاعرة، هؤلاء ألحدوا في أسماء الله. إذًا: آخر الأوجه في الإلحاد في أسماء الله -عز وجل-: هو نفي ما تضمنته من المعاني أو تحريفه.
ثم قال رحمه الله :
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: إثبات الأسماء.
[الشرح]
وهـٰذا واضح من قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾. فأثبت الله الأسماء له جل وعلا، وانفرد بها دون غيره.
[المتن]
الثانية: كونها حسنى.
[الشرح]
لقوله: ﴿الحُسْنَى﴾. وقلنا: الحسنى فعلى تفضيل، والمعنى: المنتهية في الحُسْن، يعني: التي بلغت في الحُسن غايتَه، منتهاه، فكل اسم لا يتَّصِف بهـٰذا فإنه ليس من أسماء الله -عز وجل-، فالمنتَقِم: هل هو اسم لله -عز وجل-؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يتصف بهـٰذا الوصف؛ لأن الانتقام منه ما هو حسن، ومنه ما هو قبيح، والله -جل وعلا- لا يسمي نفسه إلا بما هو منتهٍ في الحسن لا يحتمل وجهًا آخر، كذلك سائر ما يكون من الصفات التي لم يَرِد فيها أسماء فإنه لا يُشتق له منها أسماء؛ لأن أسماءه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- حسنى.
[المتن]
الثالثة: الأمر بدعائه بها.
[الشرح]
لقوله تعالى: ﴿فَادْعُوُه بِهَا﴾. وهـٰذا يشمل دعاء العبادة بأن يتعبد الله -عز وجل- بهـٰذه الأسماء ومعانيها وإثبات ما تضمنته، وأيضًا بالمسألة بها عند السؤال والطلب، وكذلك في الثناء عليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بها عند مقام الثناء والحمد.
[المتن]
الرابعة: ترك مَنْ عارض من الجاهلين الملحدين.
[الشرح]
لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾. وهـٰذا فيه: أنه ينبغي للإنسان أن لا يكترث بكفر الكافرين فيما يتعلق بعلاقته بربه، فإن الإنسان إذا اشغل بهؤلاء انصرف عمّا يجب عليه من تعلق القلب بالله -عز وجل-، وليس يعني هـٰذا ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا ندعو للإسلام ولا نجاهد أهل الكفر، لا، المقصود أننا لا نشتغل بهم اشتغالاً قلبيّاً يصرفنا عن عبادة الله -عز وجل-.
[المتن]
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها.
[الشرح]
وذلك فيما ذكره من الأثر عن ابن عباس، وعن الأعمش، وقد ذكر ثلاثَ صُوَر من صور الإلحاد، وذكرنا صورتين لم يشر إليهما رحمه الله، وقد نبه إلى هـٰذه الصور ابنُ القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين، وفي بدائع الفوائد.
[المتن]
السادسة: وعيد من ألحد.
[الشرح]
لأن قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فيه التهديد لهم.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب لا يقال: السلام على الله.
في الصحيح عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: كنا إذا كنا مع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام)).
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد: أن فيه إثبات الكمال لله -عز وجل- في الصفات.
الباب السابق فيه إثبات الكمال لله -عز وجل- في الأسماء، حيث قال الله تعالى:﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾( ) . وهـٰذا الباب فيه إثبات كمال صفات الله -عز وجل-، وصفات الله -عز وجل- قد بلغت في الكمال أعلاه، قال الله جل وعلا: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( )، وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( ) .
لله المثل الأعلى، أي: لله الصفة العليا التي لا شيء فوقها، لا منتهى للحسن بعدها، بل هي منتهى الحسن والكمال والعلو، ووجه ذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((فإن الله هو السلام)). أي: السالم من كل نقص وعيب في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي جميع شأنه جل وعلا، فهـٰذا الباب مُكَمِّل للباب السابق، فالباب السابق في الصفات وهـٰذا في الأسماء، ومن كان كاملاً في صفاته كان مستحقّاً للعبادة وحده دون غيره؛ لأنه لا يُطلب في العبادة إلا الكامل، وأما من كان فيه نقص فإنه لا يَفِي، لا يفي العابدَ حقه وحاجته وطِلْبَتَه، ولذلك تجد أن المشركين لا يقتصرون على إلـٰه واحد، بل يعبدون آلهة شتى؛ لأنه ما من إلـٰه يَفِي ما يحتاجون إليه، ويعطيهم كل ما يطلبون، ولذلك لما دعاهم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى عبادة الله وحده قالوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هـٰذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾( ) عجيب، كيف يكون الإله واحداً؟
الجواب: أنه واحد كما قال الله -عز وجل-: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (01) اللَّهُ الصَّمَدُ (02) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (03) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (04)﴾( ) . لأنه الغني جل وعلا، الكامل في أسمائه وصفاته، فلا حاجة للعباد في غيره، ولا يقضي حوائجَهم إلا هو، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فإذا كان كذلك فلم يلتفتون إلى غيره؟ ولم ينصرفون إلى غيره؟ وهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الذي له الأسماء الحسنى، وهو السلام، وله المثل الأعلى جل وعلا. هـٰذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وللباب الذي قبله.
قال رحمه الله: بابٌ لا يقال السلام على الله.
لأن الله هو السلام جل وعلا، فالسلام منه يُطلب لا له يسأل، فهو السالم -جل وعلا- من كل نقص وعيب، وهو المُسَلِّم لغيره. فالسلام يتضمن معنيين:
المعنى الأول: أنه الكامل في صفاته، الذي لا نقص فيه جل وعلا.
والمعنى الثاني: أنه المُسَلِّم لعباده، فمن لم يُسلِّمه الله فلا سلامة له، ولذلك سَلَّم الله -عز وجل- على أنبيائه وعلى المرسلين كما قال: ﴿وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾( )، وكما قال: ﴿سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾( )، وكما قال: ﴿سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾( ). وما أشبه ذلك من الآيات التي سَلَّم فيها الله -جل وعلا- على المرسلين والأنبياء، بل وسَلَّم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على المؤمنين كما قال تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾( ). فالاصطفاء يشمل كل مؤمن؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- اختصه دون غيره بهـٰذه المنة العظيمة وهي: الإيمان به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، هـٰذا معنى هـٰذا الاسم العظيم الشريف لله -عز وجل-.
يقول رحمه الله: (في الصحيح عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: كنا إذا كنا مع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده). وهـٰذا في أول الأمر، (السلام على فلان وفلان). يعني: يعينون من يسلمون عليه، (فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تقولوا: السلام على الله)) ) فنهاهم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن هـٰذا القول؛ لما فيه من النقص في حق الله -عز وجل-، وبَيَّن لهم علة هـٰذا النهي فقال: ((فإن الله هو السلام)). يعني: لا حاجة إلى أن يُسأل له ويُطلب له السلام؛ بل السلام يُسأل منه ويُطلب منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. وبهـٰذا يتبين أن هـٰذا القول نقصٌ في التوحيد، فمن قال: السلام على الله، فإنه قد نقص في التوحيد؛ لأن السلام يُطلب من الله، لا يطلب له جل وعلا. واقتصر المؤلف -رحمه الله- على هـٰذا في هـٰذا الموضع لكون الشاهد الذي يُريده هو ما نقله من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام)).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير السلام.
[الشرح]
عرفنا معنى السلام: اسم من أسماء الله -عز وجل-، له معنيان:
المعنى الأول: السالم من كل عيب ونقص.
المعنى الثاني: المُسَلِّم لعباده، فلا سلامة لأحد إلا منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
الثانية: أنه تحية.
[الشرح]
لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تتمة الحديث في بيان ما يسلمون عليه: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين)). فالسلام تحية، ولكنه تحية مُضَمَّنة معنى الدعاء، وقد اختلف العلماء في قول القائل في التحية: ((السلام عليكم)). هل السلام اسم لله -عز وجل-؟ أم أنه دعاء له؟
انقسموا إلى قسمين:
فريق قالوا: إن اللفظ، لفظ السلام في التحية التي يتحايا بها أهل الإسلام هو اسم الله -عز وجل- ، واستدلوا لذلك بأدلة، منها ومن أصرحها وأقواها ما في صحيح مسلم: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ به رجل وهو على غير طهارة فسَلَّم عليه، فلم يَرُدَّ عليه السلام، ثم إنه تيمم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورد عليه السلام ، فقال له الرجل: لم؟ فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة)). فدل هـٰذا على أن السلام ذكر، وهو من أسماء الله -عز وجل-.
ولكن الفريق الآخر احتجوا بحجج وقالوا: إنه لو كان اسمًا لما صح تنكيره، وقد جاء أن من صيغ السلام أن تقول: سلامٌ عليكم، بل قال الله جل وعلا: ﴿سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾.
جمع بين القولين ابنُ القيم -رحمه الله- فقال: كلا المعنيين مراد. فالسلام سؤال مُتَوَسَّلٌ فيه بالاسم المناسب، السلام سؤال تَسأل لمن سلَّمْتَ عليه لمن حَيَّيْتَه تسأل له السلامة، ولكنك سألت السلامة بالاسم المناسب وهو السلام، أنتَ إذا سألت الله الرحمة تقول: اللهم يا جبار ارحمني! أو تقول: يا رحيم ارحمني، أو: اللهم إني أسألك رحمتك وأنت أرحم الراحمين؟ تسأل بالاسم المناسب، وهـٰذا القول يجمع بين هـٰذين القولين، قولي الفريقين، فهو تحية وذكر.
[المتن]
الثالثة: أنها لا تصلح لله.
[الشرح]
لأنّ الله هو السلام.
[المتن]
الرابعة: العلة في ذلك.
[الشرح]
في قوله: ((فإن الله هو السلام)). وهـٰذا فيه الدليل على أن الأحكام الشرعية مُعلَّلة، وأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد يَنُصُّ على العلة، وما لم يَنص فيه على العلة فيمكن التوصل إليها بالنظر والتأمل والتفكر.
[المتن]
الخامسة: تعليمُهم التحيةَ التي تصلح لله.
[الشرح]
وذلك في قوله: (التحيات لله والصلوات والطيبات). هـٰذه التحية التي تصلح لله؛ لأنه نهاهم عن هـٰذا، وعلمهم كيف يحيون ربهم: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي). فالسلام في حق العبد المخلوق الذي لا يَسلم من نقص، وأما الذي في حق الله فهو التحية، وهي: ما معنى التحية في قوله: (التحيات)؟ التحيات: جمع تحية، والمعنى: الملك والبقاء والعظمة لله -عز وجل-، هـٰذا معنى قولنا في الصلاة: (التحيات لله)، وليست تحية واحدة، إنما كل التحيات، أي: كل ما يُحيَّا به المُحَيَّا فهو لله -عز وجل-، فالملك والبقاء والعظمة للرب جل وعلا.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت.
في الصحيح عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتَ، اللهم ارحمني إن شئتَ. ليعزم المسألة، فإن الله لا مُكْرِه له)).
ولمسلم: ((وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه)).
[الشرح]
قال رحمه الله: (باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت.)
أي: حكم هـٰذا القول، ولم يُبيِّن المؤلف -رحمه الله- في الترجمة الحكم؛ لأنه سيتبين من الحديث الذي ساقه في الباب.
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت، فيه إشعار باستكبار العبد أو استغنائه عن رحمة الله ومغفرته ومسألته، ومثلُ هـٰذا قَدْحٌ في التوحيد، مثل هـٰذا ينقص التوحيد ويقدح فيه.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإنه في الباب الذي قبله وفي هـٰذا الباب وفي بضعة أبواب تأتي، المؤلف -رحمه الله- يذكر ما يتعلق بتحقيق التوحيد في اللفظ، تحقيق التّوحيد في الألفاظ، يعني: ما يحصل به كمال توحيد الله -عز وجل- في اللفظ، فإن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت، هـٰذا نقص في التوحيد اللفظي الذي قد يُشعِر ويدل على نقص في التوحيد القلبي، ولذلك كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُنَبِّهًا إلى هـٰذا حيث نهى عن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئتَ.
يقول رحمه الله: (في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت))). الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت)). نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المؤمنَ أن يقول هـٰذا القول: ((اللهم اغفر لي إن شئت)). والمنهي عنه ليس قول المغفرة وسؤالها، إنما هو تعليق المغفرة، تعليق طلب المغفرة بالمشيئة، هـٰذا هو المنهي عنه، ولذلك سيتبين من بقية الحديث أن مقصود النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من النهي النهيُ عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وكذلك: ((اللهم ارحمني إن شئت)) مما ورد النهي عنه، وكذلك في بعض الروايات: ((اللهم ارزقني إن شئت)). كل هـٰذا نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وإنما ذكر هـٰذه الدعوات دون غيرها لا للتخصيص، إنما لكون هـٰذا هو المسؤول غالبًا الذي يتكرر في أدعية الناس ومسائلهم: سؤال المغفرة والرحمة والرزق، وإلا فسائر ما يُسأل الله -جل وعلا- ويُدعى ينبغي أن يكون على هـٰذا، وهو أن يعزم فيه السائل المسألة، ويعزم الداعي الطلب ولا يعلِّق بالمشيئة؛ لأن هـٰذه الصيغة تُشعِر بأمور لا تليق، فهي إما أن تُشعر بأن العبد يشك في قدرة الله -عز وجل- ولا يوقن بإجابته، ولا شك أن هـٰذا ضعف في التوحيد؛ لأن مَن لم يعتقد كمال قدرة الرب وأنه على كل شيء قدير، كان ذلك نقصًا في إيمانه وتوحيده، كما أن فيه ما يُشعر بعلو العبد واستكباره، حيث إنه أظهر الغنى بتعليق السؤال بالمشيئة، ولو كان العبد صادقًا في الإلحاح والطلب لَمَا عَلَّق ذلك بالمشيئة، بل لجزم المسألة.
الثالث: قد يُشعر بالاستكبار والاستغناء عن المسألة.
إذًا: ثلاثة أمور لأجلها نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -فيما يَظهر- عن هـٰذا القول.
قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ليعزم المسألة)) أي: لِيَجزمها، ويجعلها مسألةً مجزومًا بها، لا مسألةً معلقةً مترَدَّدًا فيها.
((ليعزم المسألة فإن الله لا مُكرِه له)). أي: فإن الله -جل وعلا- لا يُكْرَه على شيء، بل هو الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فتعليق السؤال والطلب بالمسألة في مثل هـٰذا لا معنى له؛ لأنه لا مُكره لله، فالله -عز وجل- يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، لا مكره له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على ما يفعل، فلا فائدة من هـٰذا التعليق، كما أن فيه من المعاني المتقدمة التي ذكرناها من سوء الأدب مع الله -عز وجل- : إما باعتقاد نقص القدرة، أو بإظهار الغنى، أو باستكبار العبد وعلوه على ربه.
قال رحمه الله: (ولمسلمٍ: ((وليُعْظِم الرغبة)) أو ((وليُعَظِّم الرغبة)).)
والمقصود بالرغبة هنا: إما صفة السؤال، يعني: يسأل سؤالاً تظهر فيه رغبته في المسؤول وصدقه في الحاجة، وإلحاحه في الطلب، وإما أن يكون المراد بالرغبة هنا: المسؤول، يعني: يكثر ويُعْظِم ما يسأل، فالرغبة إما أن تكون صفة للسؤال، أو صفة للمسؤول. إذا كانت صفة للسؤال فالمعنى: يلح في الدعاء. وإذا كانت صفة للمسؤول، أي: لا يسأل شيئًا يسيرًا، بل يسأل شيئًا كبيرًا، ولا يستكثر على الله -عز وجل- شيئًا، فإن الله -جل وعلا- لا يتعاظمه شيء. ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)). أي: لا يَعْظُم عنده شيء أعطاه، بل كل شيء عنده يسير، فيداه -جل وعلا- مبسوطتان سَحَّاء الليل والنهار، يُنفق -جل وعلا- لا تغِيضُهما نفقة، وعلى هـٰذا فينبغي للمؤمن أن لا يتعاظم ما يسأل ربَّه، بل الله -جل وعلا- بيده الخير كله، وهو -جل وعلا- الكريم الذي يعطي عطاءً واسعًا، فينبغي للمؤمن أن يسأل، وأن يُعْظِم المسألة، والمعنى في قوله: ((ليُعْظِم الرغبة)) يَصْدُق على الوجهين السابقين، فيُلِح الإنسان في الدعاء ويكرر، وإذا سأل يسأل عظيمًا، ولا يستَقِلُّ يكتفي بالقليل، بل يسأل سؤالاً عظيمًا، ولا يقول: هـٰذا لا أتوقع أن يجاب، أو هـٰذا لا يحصُل، أو هـٰذا لا يمكن أن يحققه الله لي، بل إذا صَدَق في الرغبة فالله على كل شيء قدير. ومقصود هـٰذا الباب واضح وهو: تعظيم الله -عز وجل- في اللفظ.
هل من التعليق بالمشيئة قولُ الداعي في دعائه: إن شاء الله؟
مِن العلماء مَن قال: إن قول الداعي: إن شاء الله في دعائه، اللهم وفقنا إن شاء الله، وأسأل الله لكَ التوفيق إن شاء الله، وما أشبه ذلك، أنه من الصورة التي نهى عنها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت))؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: إن شئت، وبين أن يقول: إن شاء الله من حيث التعليق بالمشيئة، فالكل فيه تعليق بالمشيئة.
لكن الصحيح: أن (إن شاء الله) أخف من (إن شئت) من حيث الأدب مع الله -عز وجل-، وعدم استغناء العبد، فإن قوله: (إن شاء الله) لا يظهر منه الاستغناء كما يظهر من قول القائل: ((اللهم اغفر لي إن شئت)). فإن قول: ((اللهم اغفر لي إن شئت)) يظهر فيه واضحًا أن العبد مُستغنٍ عن ربه، وأنه عالٍ على مسألته، أو أنه متعاظِم لمسألته، وأن الله لا يحققها، بخلاف قول: (إن شاء الله) فإنه لا يظهر فيه هـٰذا، لكن إن كان مقصود القائل التعليق بالمشيئة فهو مثل قوله: إن شئتَ، وإن كان أخف، فيُنهى عنه، لكن إن كان مقصود القائل من التعليق بالمشيئة التبركَ فإنه لا بأس به، ومن هـٰذا: ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا عاد مريضًا قال: ((لا بأس، طهور إن شاء الله)). على أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((طهور إن شاء الله)) هل هو دعاء أو خبر؟
فمن العلماء من يقول: إن قوله: ((طهور)) هـٰذا خبر وليس دعاءً، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخبِر بأن ما يَنزل بالإنسان من المرض يطهِّرُه ويكفِّر عنه خطاياه، فإذا كان خبرًا فلا شاهد فيه على جواز قول: (إن شاء الله) في الدعاء للتبرّك.
ما وجه الاستثناء إذا كان خبرًا ((طهور إن شاء الله))؟
قلنا: فيها وجهان:
وجهٌ أنها خبر، يخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن المرض يطهِّر المريض، فمن أين جاء الاستثناء؟
الاستثناء باعتبار حال الإنسان، فقد يَضْجَر الإنسان ولا يصبر فلا يكون تطهيرًا له، بل يكون سببًا لزيادة الإثم، وذلك حال الرجل الأعرابي الذي دخل عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال له: ((طهور إن شاء الله))، قال: كلا! بل حمى تفور، على رجل كبير، تورده القبور. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((نعم إذًا)).
فدل هـٰذا على أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((طهور إن شاء الله)) الاستثناء هنا على القول بأن (طهور) خبر ما وجهه؟ هـٰذا باعتبار أنه طهور من حيث الأصل، لكن قد يتخلف هـٰذا في حق مَنْ؟ المريض، قد لا يحتسب ولا يصبر، فلا يكون تطهيرًا له، هـٰذا وجهٌ.
الوجه الثاني: أن يكون دعاءً، وهـٰذا الذي رجحه شيخنا وجماعة من العلماء: أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((طهور)) دعاء وليس خبرًا، فما وجه التعليق بالمشيئة؟
وجهه أنه للتبرك، لا للتردد، للتبرك بذكر مشيئة الله -عز وجل-، لا للتردد في مشيئته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، لا في التردد في حصول السؤال والمطلوب، وهـٰذا هو الدليل الذي جعل بعض العلماء يقولون: إن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت)). هـٰذا فيما عدا التعليق تبرُّكًا، فإن كان التعليق للتبرك بذكر الله -عز وجل-، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته فإنه لا بأس به وهو جائز. وهـٰذا توجيه حسن جيد.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء.
[الشرح]
وذلك لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت)). فهـٰذا نهيٌ واضح عن الاستثناء في الدعاء.
وأين الاستثناء ؟ ((إن شئتَ)). وهل هـٰذا خاص بسؤال المغفرة والرحمة أو في كل دعاء؟
في كل دعاء.
أَجِبْ على هـٰذا السؤال: في دعاء الاستخارة ماذا تقول؟ ((اللهم إن كنتَ تعلم أن في كذا وكذا خيراً لي فاقدُرْه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنتَ تعلم أن في كذا وكذا شرًّا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصْرِفْه عنِّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رَضِّني به)). هنا ما فيه جزم في الدعاء، فيه جزم أم ما فيه جزم؟
ما فيه جزمٌ؛ فيه ترددٌ، تقول: إن كان كذا، وإن كان كذا.
هـٰذا هل هو من عدم العزم في المسألة؟
الجواب: لا؛ لأن الإنسان في هـٰذه الحال لا يدري أين الخير، فعدمُ العزم والجزم لا لأمر يتعلق بالإجابة، يعني: بالمجيب الذي هو الله جل وعلا، إنما لأمر يتعلق بالداعي وهو أنه لم يتبين له الخير، فسأل الله -عز وجل- الخِيرة، أو الخِيَرة بين الأمرين.
[المتن]
الثانية: بيان العلة في ذلك.
[الشرح]
ما هي العلة في النهي عن الاستثناء؟
تجد العلة في الحديث من قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؛ لأن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فإن الله لا مكره له))، وأيضًا: ((فإن الله لا يتعاظمه شيء)) يعني: أن الله على كل شيء قدير، وهو لا مُكْرِه له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ، فلا وجه مع هذين الوصفين للاستثناء في المسألة والدعاء.
[المتن]
الثالثة: قوله: ((ليعزم المسألة)).
[الشرح]
وما معنى ((ليعزم المسألة))؟
يجزم ويُلح ويؤكد ويحقق السؤال.
[المتن]
الرابعة: إعظام الرغبة.
[الشرح]
وما معنى إعظام الرغبة؟
أنه يسأل ما شاء، أن يسأل ما شاء لا يتعاظَم السؤال ، هـٰذه واحدة.
والثانية: الإلحاح في الدعاء، يعني: الرغبة إما هي صفة السؤال، أو صفة المسؤول.
[المتن]
الخامسة: التعليل لهـٰذا الأمر.
[الشرح]
أن الله لا يتعاظمه شيءٌ، هـٰذا التعليل لإعظام الرغبة.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب لا يقال: عبدي وأَمَتِي
في الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يقل أحدكم: أَطْعِم ربك، وَضِّئْ ربك، وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي، وغلامي)).
[الشرح]
يقول رحمه الله: (باب لا يقال: عبدي وأمتي)، يعني: لا يقول الإنسان هـٰذا القول، ينفي هـٰذا القول عن كلامه.
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد أن في قول: عبدي وأمتي، منازعة لما هو حق لله جل وعلا، من أنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- رب كل شيء، وكل شيء له عبد، وكل أنثى له أمة، فهـٰذه المنازعة اللفظية نهى عنها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإن كان الإنسان قد لا يَرِد في باله ولا في خاطره شيءٌ من المنازعة المعنوية، لكن حفاظًا على المعنى الذي اختصَّ به الرب نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن هـٰذا تكميلاً للتوحيد، فهو كالباب السابق في أنه من باب صيانة اللفظ عن الوقوع فيما ينقص التوحيد، كل هـٰذه الأبواب تدور على هـٰذا المعنى: صيانة الألفاظ عن الوقوع فيما يقدح أو ينقص التوحيد.
يقول رحمه الله: (في الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا يقل أحدكم)).)
هـٰذا نهيٌ، نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أهل الإسلام أن يقولوا هـٰذه الألفاظ: (أطعم ربك، وضئ ربك). أطعم ربك أي: قَدِّم له الطعام، وضئ ربك أي: هَيِّئْ له الوَضوء، فإن هـٰذا مما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، والمقصود بالرب هنا هو المالِك للعبد، أو المالك للأمة، فإنه لا يجوز أن يقول هـٰذا القول: أطعم ربك، وضئ ربك؛ لنهي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
أما إذا كان هـٰذا على وجه التّعظيم فإنه لا يجوز ولا إشكال، لكن إن كان هـٰذا على وجه البيان والإخبار بواقع الحال، وأن الربوبية هنا ليست الربوبية التي تقتضي ما يقتضيه وَصْفُ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من أنه الرب -جل وعلا- ربُّ العالمين، فإن العلماء قالوا: النهي هنا نهيٌ للتنزيه، وليس نهيًا للتحريم.
واعلم أن إضافة الربوبية أو اسم الرب إلى الغير على أوجه:
الإضافة إلى الاسم الظاهر، كقول: رب الغلام، رب زيد، وما أشبه ذلك، فظاهر الحديث جواز هـٰذا النوع؛ لأنه لم يُنْهَ عنه.
الإضافة إلى الضمائر وهي أنواع:
ضمير المتكلم، كقوله: ربي.
ضمير الغائب، كقوله: ربه.
ضمير المخاطَب، كقوله: ربكَ.
الذي ورد النهي عنه: ما كان بصيغة المخاطَب؛ حيث إنه قال: ((لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك)). ولا يخلو هـٰذا القول في ضمير المخاطَب أن يكون صادرًا عن المالك للعبد نفسه، أو أن يكون صادرًا عن غير المالِك: فإن كان صادرًا عن المالك فإنه يُنهى عنه نهيًا مؤكدًا، وإن كان صادرًا عن غير المالك فإنه جائزٌ ما لم يكن فيه إذلالٌ واحتقارٌ للمخاطَب، فإنه يُنهى عنه لأجل الإذلال والاحتقار.
أما إذا كان المخاطِب بذلك هو المالك نفسه فإنه ينهى عنه؛ لما فيه من التعاظم والعلو، فالإنسان لا يقول لعبده: أطعم ربَّكَ؛ لما فيه من العلو والارتفاع، لكن لو قال له آخر: أطعم ربك، فإنه لا بأس بذلك، ودليلُه قول الله تعالى في قصة يوسف: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاسْأَلْهُ﴾( )، وكقوله: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾( ).
أما ضمير الغائب فجائز ما لم يكن فيه احتقار وإذلال، وشاهد هـٰذا في السُّنة قولُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في علامات الساعة وأماراتها: ((حتى تلد الأمة ربّتها))، وفي رواية: ((ربها)). وفي حديث اللُّقَطة قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((حتى يجدها ربُّها)) لَمَّا سُئل عن ضالَّة الإبل، فهـٰذا جائز لوروده في كلام النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
بقي ضمير المتكلم، وهو أن يقول: ربي، فهل هـٰذا جائز؟
الأحسن والأكمل تَرْكُ ذلك، ولكن إن قاله على سبيل الإخبار فإنه يجوز، فإن خُشي منه معنًى رَدِيء فتركه هو المتعيِّن.
أما دليل الجواز: فقول يوسف -عليه السلام- : ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾( ) على القول بأن الرب هنا هو السَّيِّد، ﴿إِنَّهُ رَبِّي﴾ أي: سيدي، وهو مَنْ كان قد اشتراه ﴿أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ أي: أحسن إقامتي وصيانتي ورعايتي، هـٰذا بالنسبة لحكم إضافة الرب إلى الظاهر والمضمر.
قال رحمه الله: ((وليقل: سيدي ومولاي)).
وجَّه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أن يقول: سيدي ومولاي، مَن القائل؟
القائل هو المملوك نفسه، فلا بأس أن يقول: سيدي ومولاي، أما السيد فلأنَّه مُتَرَئِّسٌ عليه متصرِّفٌ فيه، وأما المولى فهي كلمة تُطلق على القريب والناصر والسيد، فالأمر فيها يسير، ولذلك وجَّه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى قول هـٰذين.
ثم قال: ((ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي)).
نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقول المالكُ لعبدِه: عبدي وأمتي، وقد فَرَّقَ العلماء في هـٰذا بين هـٰذا القول في حال خطاب العبد وفي حال الخبر، في حال النداء وفي حال الخبر، فأجازوه في حال الخبر ومنعوه في حال النداء، فإذا نادى الرجلُ مملوكَه فإنه لا يناديه بهـٰذا، لا يقول: يا عبدي يا أمتي، إنما يقول ما وَجَّه إليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ((وليقل: فتاي وفتاتي، وغلامي)).
أما في الخبر- يعني: إذا تكلم الإنسان على غير وجه النداء- فيجوز أن يقول: عبدي وأمتي، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾( ). فأضافهم إلى مالِكيهم، فدل هـٰذا على أن الإضافة لا تمتنع في حال كون ذلك في مساق الخبر.
أما إذا كان نداءً فإنه يتحاشى هـٰذا ويستعمل غيرَه بأن يقول: فتاي وفتاتي وغلامي.
وللعلماء في هـٰذا تفاصيل أخرى يُرجع إليها في كتب شرح الأحاديث، لكن يبقى أن المقصود من هـٰذا الباب هو صيانة اللّفظ عمَّا ينقص التوحيد، هـٰذا المقصود الذي من أجله ساق المؤلف -رحمه الله- هـٰذا الباب في كتاب التوحيد.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي.
[الشرح]
واضح هـٰذا.
[المتن]
الثانية: لا يقول العبد لسيده: ربي، ولا يُقال له: أطعم ربك.
[الشرح]
تكلَّمنا عليه.
[المتن]
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي.
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي.
الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
[الشرح]
وهـٰذا هو المقصود من الباب. والله تعالى أعلم.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس السابع والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: لا يُرَدُّ من سأل بالله.
عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)). رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
[الشرح]
قال المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد: (بابٌ: لا يُرَدُّ مَنْ سأل بالله.)
مناسبة هـٰذا لكتاب التوحيد: أن رَدَّ مَن سأل بالله -عز وجل- يُشعر بضعف التعظيم لله جل وعلا، ولذلك جعل المؤلف -رحمه الله- هـٰذا الباب في كتاب التوحيد.
أما مناسبته لما قبله: فإنه مما يتعلّق بتعظيم الله جل وعلا، فإنّ الأبواب السابقة مما يتعلق بتعظيم الله -عز وجل- لفظًا بصيانة أسمائه وأوصافه عن أن يَشرَكَهُ فيها أحدٌ.
قال رحمه الله: (عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-). نقل في هـٰذا الباب عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع لكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه)).)
خمس جمل في هـٰذا الحديث ذكرها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
الأولى: ((من سأل بالله فأعطوه)). وهـٰذا هو الشاهد في الحديث للباب؛ ((من سأل بالله فأعطوه)) مَنْ شرطية، و((سأل)) فعل الشرط، وجوابه في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فأعطوه)).
والسؤال بالله يكون بأن يسأل السائلُ المسؤولَ بالله ويتوسل إليه بالله جل وعلا، فيقول: أسألكَ بالله، هـٰذا من أعظم ما يكون، وأقرب ما يدخل في الحديث، ويدخل فيه أيضًا ما لو سأله بوصف من أوصاف الله -عز وجل-، أو بفعل من أفعاله، كأن يقول: أسألك بالذي لا إلـٰه غيره، أو: أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. فالأول فيه السؤال بوصف من أوصاف الله -عز وجل-، والثاني: بفعل من أفعاله. ويشهد له ما مر معنا قريبًا في حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى، حيث جاءهم الملك في الصورة التي كانوا عليها فقال: ((أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، والأعمى: بالذي رد عليك بصرك، والأقرع: بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال)). فهـٰذا سؤالٌ بالله -عز وجل-، لكن سؤال بفعل من أفعاله، والسؤال بفعل الله كالسؤال بالله، لكن أعظم ذلك أن يسأله باسم الله الصريح، وهو أن يقول: أسألك بالله، أو ما أشبه ذلك.
قال: ((فأعطوه)). أي: فأجيبوه إلى سؤاله مِن إعطائه مسألتَه، وهـٰذا على وجه الإلزام أو على وجه الندب؟ هـٰذا يختلف باختلاف المسألة: فإن كانت المسألة فيما يحل للإنسان أن يسأل، كأن يكون مستحقّاً للزّكاة فيسأل المال، أو مستحقّاً للإعانة فيسأل المستطيع، فهنا إجابة السّؤال واجبة. وأما إن كان فيما لا يجوز سؤاله، كأن يسأل الإنسان عن خصائص أموره التي لا يحبّ أن يظهرها وليس للسائل مصلحةٌ في إظهارها، فإنه لا يجب إجابتُه في هـٰذه الحال، وإذا سأله عمّا يجب كَتْمُه، فإنه لا يجوز للمسؤول أن يجيب السّائل.
المهم: أن حكم إجابة السائل بالله يختلف باختلاف المسؤول: فقد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبّاً، وقد يكون محرمًا، لكن مِن حيث الأصل يُندب لمن سُئل بالله أن يُجيب سائله، ولذلك قال الفقهاء: يكره أن يَرد مَن سأل بالله.
ومن السؤال بالله -وهو أعظم- أن يسأل بوجه الله كما سيأتي في الباب الذي بعده، فإنه داخل في عموم السؤال بالله، ولكنه في منزلة أعلى من السؤال بالله مجردًا عن ذكر الوجه، وقد جاء فيمن سئل بوجه الله ولم يُجِب وعيدٌ شديد، فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري: ((ملعونٌ من سأل بالله، وملعون من سُئل بالله ثم لم يعطِ ما سئل ما لم يكن هُجْرًا)) أي: قبيحًا. فهـٰذا الحديث يدل على عِظَم ترك إجابة السائل بوجه الله -عز وجل-، وعلى كلٍّ سيأتي الكلام على هـٰذا الحديث في الباب القادم.
المهم: أنه يُكره ردُّ من سأل بالله -عز وجل-، والأصل فيمَنْ سُئل بالله أن يجيب، ما لم يكن من الأحوال التي لا يجوز له الإجابة، أو يُندب له عدم الإجابة، أو ما إلى ذلك، لكن إذا قلنا: الأصل فهـٰذا الأصل الذي يُرجع إليه عند الاشتباه، الأصل الندب إلى إجابة من سأل بالله -عز وجل-؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من سأل بالله فأعطوه)).
وقوله: ((بالله))، الباء في قوله: ((بالله)) هل هي قَسَم أو توسُّل؟
يحتمل القسم ويحتمل التوسل، يحتمل أن يقول: بالله عليك أعطني، هـٰذا من السؤال بالله؛ لأنه من الإقسام بالله عليه. ويحتمل أنه توسلٌ إلى مطلوبه ومقصوده، بأن يقول: أسألك بالله، وهنا لم يُقْسِم بالله، لكنه توسَّل إلى المسؤول بالله وتعظيمه أن يجيبه إلى ما أراد.
في الحال الأولى: إذا لم يُجَب السائل فإنه عليه الكفارة، في الحال الأولى إذا قال: بالله عليك أعطني، فلم يعطه المسؤول، فعلى السائل كفارة؛ لأنه حَنِثَ في يمينه، وإن كان الحِنْثِ من قبل جهة أخرى، لكنه وقع في الحِنث فتجب الكفارة عليه. وإن كان متوسِّلاً فقال: أسألك بالله، فهـٰذا لا كفارة عليه؛ لأنه ليس من القسم، وليس من الحنث في اليمين.
قال رحمه الله: ((ومن استعاذ بالله فأعيذوه)).
من استعاذ بالله: قال: أعوذ بالله من كذا، أو أعوذ بالله من شر كذا، وما أشبه ذلك مما يدخل في الاستعاذة بالله؛ فالواجبُ إعاذته ما لم يكن مستحقّاً للعقوبة، فإن من استحق العقوبة لا ينفعه أن يستعيذ بالله.
لكن فيمن لم تتحتَّم عقوبته، ولم يثبت عليه الحق، وليس في إعاذته محظور، لكن إذا ثبت على الإنسان حدٌّ أو قصاص أو ما أشبه ذلك فاستعاذ بالله، ففي هـٰذه الحال إن كان حدّاً من حدود الله فلا تجب إجابته، بل إجابته محرمة؛ لأن الله هو الذي أمرنا بمعاقبته.
وإن كان في حق الآدمي فُيندب له أن يصفح ويعفو وأن يُعيذ، لكن ليس على وجه الإلزام، فإن كان المستعيذ مستعيذًا من شرٍّ وظلمٍ ليس متحتِّمًا عليه وليس بحقٍّ، ففي هـٰذه الحال يجب على مَن وُجِّهت إليه الاستعاذة بالله أن يعيذ المستعيذ.
قال رحمه الله: ((ومن دعاكم فأجيبوه)).
هـٰذا ثالث ما ذُكر في الحديث: ((من دعاكم)). والدعوة هنا تشمل الدعوة إلى الطعام، والدعوة إلى عموم المجيء ولو لم يكن طعامًا، تشمل الوليمة، وليمة العرس، وغيرها؛ لعموم قوله: ((ومن دعاكم فأجيبوه))، وهـٰذا أيضًا يختلف حكمه باختلاف حال الداعي وحال المدعو.
قال: ((ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه)).
((من صنع إليكم معروفًًا)). المعروف: هو كل نوع ووجه من أوجه الإحسان، صغير أو كبير، فكل من أحسن إليك ولو بالابتسامة حقه المكافأة، ولا فرق بين أن يكون المعروف واجبًا على الفاعل؛ يعني: على مُسدِي المعروف، على مَن صنعه، وبين أن يكون مستحبّاً، ولا وجه للتفريق، بل الشريعة لم تأت بالتفريق، وعموم الحديث يشمل من صنع معروفًا واجبًا عليه، ومن صنع معروفًًا مستحبّاً، فقول الناس: (لا شُكْرَ على واجبٍ) ليس له وجه، بل الشكر يكون على الواجب وعلى المستحب؛ لعموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من صنع إليكم معروفًا فكافئوه)). يشمل هـٰذا ما إذا كان المعروف واجبًا على المحسن كإخراج الزكاة مثلاً، إذا أعطاها مستحقَّها فحقُّ من أخذ أن يَشكر من صنع إليه معروفًا وهو صاحب الزكاة، وإن كانت الزكاة واجبة على مَن؟ على المزكِّي، وعلى هـٰذا فقِسْ من أنواع المعروف الواجبة، المهم: أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((من صنع إليكم معروفًا)) يشمل المعروف الواجب، والمعروف المستحب.
((فكافئوه)). أي: قابلوا هـٰذا المعروف بما تجزونه به على وجه المكافأة.
وقوله: ((كافئوه)) يدل على أن هـٰذه المكافأة من محاسن الأخلاق، ومما ندب إليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويظهر من الحديث أن المكافأة واجبة؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((فإن لم تجدوا ما تكافئونه)) أي: ما تقابلون به إحسانَه من جنسه أو ما هو أعلى منه ((فادعوا له حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه)).
((فادعوا له)) أي: اسألوا اللهَ له الخير.
وإلى متى يكون ذلك؟ ((حتى تروا))، فـ((حتى)) هنا: غَائِيَّة.
((تُرَوا))، أو ((تَرَوا)): تعلموا أو تظنوا.
((تُرَوا أنكم قد كافأتموه)) أي: أنكم قد جازيتموه على إحسانه خيرًا، وفي رواية: ((فأثنوا عليه حتى تُروا أنكم قد كافأتموه)). فيدل هـٰذا على أنه يُدعى له بالخير، ويُثنى عليه بذِكر جميل فعله بين الناس.
والشاهد من هـٰذا الحديث للباب قولُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من سأل بالله فأعطوه)). (رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح)، والحديث كما ذَكر الشيخ -رحمه الله- حديث صحيح.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله.
[الشرح]
لقوله: ((من استعاذ بالله فأعيذوه)).
[المتن]
الثانية: إعطاء من سأل بالله.
[الشرح]
لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من سأل بالله فأعطوه)). وقد فَرَّق بعض العلماء بين أن يكون السؤال خاصّاً، وبين أن يكون عامّاً، فإذا وَقَفَ على حلقة فقال: أسألكم بالله أن تفعلوا كذا، ما يجب إجابته، وإنما الذي ينصَبُّ عليه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((من سأل بالله فأعطوه)) فيما إذا توجه السؤال إلى معيَّن، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو وجيه؛ لأنه إذا لم يوجّهه إلى معيَّن في هـٰذه الحال لا يجب على الجميع إجابته.
[المتن]
الثالثة: إجابة الدعوة.
[الشرح]
لقوله: ((ومن دعاكم فأجيبوه)).
[المتن]
الرابعة: المكافأة على الصنيعة.
[الشرح]
لقوله: ((من صنع إليكم معروفًا فكافئوه)).
[المتن]
الخامسة: أنّ الدّعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.
[الشرح]
وهـٰذا قَيْدٌ مهم؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه)). وفيه أن أدنى ما يكون من المكافأة الدعاء، وإلا فالأصل أن يقابِل الإحسانَ بإحسانٍ من جنسه، أو مما هو أعلى منه، لكن من عَجَز عن هـٰذا وقَصُرَت حيلته في مكافأة من أحسن إليه فلا يعدم سبيلاً يستطيعه كلُّ أحد، وهو أن يدعو لمن صنع إليه معروفًا بالخير، ومن هـٰذا دعوتُه لمن تعلَّم منه واستفاد منه خُلقًا أو علمًا، أو أي أمر مما يحصل به النفع؛ لأن الإنسان قد يستفيد من شخص لا يستطيع أن يلتقي به، كأن يسمع شريطًا فيه خير ولا يستطيع أن يكافئ من أحسن إليه بفائدة علمية أو توجيه، كَفَّ عنه شرّاً أو حثه على خير، فمن حقه أن يدعو له، وإذا عَوَّد الإنسان نفسه هـٰذا طابت نفسه وأصبح مسابِقًا إلى مكافأة الناس، وإلى الإحسان إليهم.
أما إذا كان جَحُودًا، يأخذ من الناس الخير ثم لا يعطيهم شيئًا مقابل هـٰذا، ولو كان دعاءً، كان هـٰذا تعويدًا للنفس على الخمول وعدم مقابلة الإحسان بمثله، ويصبح الإنسان كالذي يأكل ولا يشبع، يأخذ من الناس الخير ولا يقابل ذلك بإحسان مثله.
[المتن]
السادسة: قوله: ((حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه)).
[الشرح]
في بيان الغاية التي ينتهي إليها الدعاء لمن صنع معروفًا إذا لم يقدر إلا على الدعاء.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة
عن جابر قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)). رواه أبو داود.
[الشرح]
هـٰذا الباب تتمة للباب الذي قبله، وهو موافق له في المعنى والغرض.
يقول رحمه الله: (بابٌ: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.)
(لا) هنا: نافية أو ناهية، ففيها النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة، وفيه النفي عن أن يسأل المرءُ بوجه الله غيرَ الجنة.
قال رحمه الله: (عن جابر قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)).) وهـٰذا فيه النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة، يعني: لا يجوز له أن يسأل بوجه الله أمرًا من أمور الدنيا، ولا أمرًا دون الجنة.
وقد أخذ العلماء -رحمهم الله- من هـٰذا كراهية السؤال بوجه الله غير الجنة، وهـٰذا الأخذ فيه نظر، فإن الحديث يدل على تحريم ذلك؛ لقوله: ((لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة)). لكنهم قالوا: إنه قد ورد الاستعاذة بوجه الله فيما هو دون الجنة، كقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما ثبت عنه في السنن في ذِكر دخول المسجد: ((أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم)). وهـٰذا فيه استعاذة بوجه الله في شيء دون الجنة، وكذلك فيما جاء عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا قرأ الآية التي فيها تنويع العذاب، قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أعوذ بوجهك)) عند كل نوع من أنواع العذاب، حتى قال: ((﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً﴾( )، فقال: هـٰذا أهون)). فدل ذلك على أنه يُسأل بوجه الله ما دون الجنة، ولذلك قالوا: يُكرَه؛ لأن هـٰذا الحديث خُصِّصَ بتلك الأحاديث التي فيها استعاذة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بوجه الله في أمر دون الجنة.
والصحيح أن الحديث على وجهه: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة))، ولكن الحديث أشمل من تخصيص الجنة، بمعنى: أنه يتناول سؤال الجنة بوجه الله، فيجوز أن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني الجنة، أو أن تجعلني من أهل الجنة، أو أن تَمُنَّ عليَّ بجنة عدن، أو ما أشبه ذلك، وكذلك كل ما كان سبيلاً وسببًا لدخول الجنة، فإنه من سؤال الجنة من حيث الغاية والمقصد، فله أن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني الاستقامة، أو أن تَقِيَني شرَّ نفسي، أو أن تعيذني من الشيطان الرجيم، أو ما أشبه ذلك، فإن هـٰذا مآله في الحقيقة أنه سؤال للجنة؛ لأنه سؤال لسبب من أسباب دخولها، والذي يُمنع هو: ذِكْرُ وجه الله في المسألة فيما يتعلق بأمر الدنيا؛ لأن شأن الله عظيم، ووجهَه كريم أعظم من أن يُسأل في حقيرٍ من أمر الدّنيا، فإذا سأل الإنسان شيئًا من الدنيا متوسِّلاً بوجه الله -عز وجل-، فإنه يتأكد على المسؤول أن يجيب السّائل، يتأكد على المسؤول أن يجيب مَن سأله، وهو أعظم من أن يقول له: أسألك بالله؛ لأنّ الوعيد وَرَدَ في حق من سأل بوجه الله، فقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي موسى عند الطبراني: ((ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سُئِل بوجه الله ثم لم يعط ما لم يكن هُجرًا)). وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الآخر: ((ألا أخبركم بشر البليَّة؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((من سُئِل بالله أو بوجه الله ثم لم يعطِ سائله)). والحديث عند النسائي وأبي داود وغيرهما.
المراد أن الوعيد ورد في حق من منع مَن سأله بوجه الله، ولذلك قال الهيثمي في الزواجر في كتاب الكبائر: إنَّ مَنْعَ السائل بوجه الله معدودٌ من الكبائر، والسؤال بوجه الله من الكبائر؛ لورود اللعن في حق الاثنين.
وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عن هـٰذا الحديث: ((ملعون من سأل بوجه الله)). وكأنه ما اطمأنَّ إلى هـٰذا الحديث، وقال: هـٰذا الحديث لا يَلْتَئِم؛ لأنه كيف ينهى عن المسألة، ويقول: ((ملعونٌ من سَأل بوجه الله)) ثم يقول: ((وملعون من سُئِل بوجه الله))؟
ولكن قد أجاب عن هـٰذا العلماء فقالوا: إنه قد يُمنَع الإنسان من السؤال، ويجب على السائل أن يُجيب، فلا ترابطَ بين منع السؤال وبين إجابة السائل، وإن كان الحديث من حيث السند فيه وَهَنٌ، لكن شواهده تَعْضُدُه وتقويه.
كما أن الحديث حديث جابر الذي معنا : ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)). فيه ضعفٌ، فهو من رواية سليمان بن معاذ وهو المشهور بابن قَرْبٍ عن ابن المنكدر عن جابر، وسليمان قال عنه العلماء قولاً ضعفوه فيه، فمنهم من قال: إنه لا يعرف، ومنهم من ضعفه.
المراد أنّ الحديث له من الشواهد ما يتقوى به، والمقصود ألا يُجعل وجه الله -عز وجل- في السؤال والطلب في دَنايا الأمور، بل لا يُسأل به إلا عظيمٌ مما يكون كالجنة، أو مما هو سبب لدخولها.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
[الشرح]
وهو: الجنة.
[المتن]
الثانية: إثبات صفة الوجه.
[الشرح]
وهـٰذا واضح؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة)) فأثبت الوجه. والوجهُ صفة ثابتة لله -عز وجل- بالقرآن والسنة، هـٰذا من السنة، وأما القرآن فقول الله -عز وجل-: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ والإِكْرَامِ﴾( ). وهـٰذا أقوى وأصرح دليل لإثبات صفة الوجه؛ لأنه وَصَف الوجه بأنه ذو الجلال، فقال: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ والإِكْرَامِ﴾، فالوصف للوجه لا للرب جل وعلا، وهو صفة للرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على ما يليق به كما مر معنا.
وقد قال بعض العلماء: إنّ الوجه يُعَبَّر به عن الذات، وهـٰذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ورد التفريق بين الذات وبين الوجه، وإن كان قد يصح في الاستعمال أن يُراد بالوجه الذات، لكن في مثل هـٰذا المقصود به الوجه تنصيصًا؛ لأنه قد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من سأل بالله فأعطوه)) وهـٰذا يشمل كل مسألة، وأما هنا فماذا قال؟ قال: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)). فمَنع من السؤال بوجه الله إلا في غاية المطالب، في الجنة فقط، فدلَّ ذلك على التفريق في مثل هـٰذا المساق بين الوجه وبين الذات، وإن كان يصح أن يُطلق الوجه ويراد به الذات، لكن هـٰذا ليس متكَأً لمن يذهبون إلى تأويل صفة الوجه، ويقولون: المراد بالوجه الذات، ولا نُثبت وجهًا حقيقيّاً للرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
¹
[الأسئلة]
سؤال (01): السؤال بوجه الله بالنسبة للمخلوق معلوم، سؤالي: لو أني أسأله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-، فأقول: أسألك بوجهك كذا وكذا أمرًا من أمور الدنيا، هل هـٰذا ممنوع أيضًا، أم أن سؤال المخلوق غير سؤال الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-؟
الجواب: جاء جواب هـٰذا: لا فرق، ظاهر الحديث لا فرق.
سؤال (02): إذا كان هناك إنسان يقول على الدوام: أسألك بوجه الله، فهل تجب إجابته كلما سأل بوجه الله؟
الجواب: تقدم، الإجابة فيها تفصيل، لكن ينبغي له أن ينهاه، وأن يقول له: لا تُشَدِّد؛ لأن بعض العلماء وجه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ملعون من سأل بوجه الله)). حمله على مسألة ما لا يجوز الذي يُلحق به المسؤول حرجًا وضيقًا واضطرارًا، فلا ينبغي له أن يسأل فيما يُلحِق به الضرر بإخوانه.
سؤال (03): هل إذا أهدى إليَّ شخصٌ هدية يجب عليَّ أن أُهْدِي له مثلها أو أفضل منها استدلالاً بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من صنع إليكم معروفًا فكافئوه))؟
الجواب: لا، لا يجب، لكن تجب مكافأتُه بما ترى أنه يحصل به مقابلة إحسانه، فإذا لم تجد ما تكافئه به فادعُ له.
سؤال (04): يقول: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ والإِكْرَامِ﴾( ) هل يجوز أن يبقى وجهه دون ذاته، أم أنه من قصور فهمي؟
الجواب: لا، لا، يبقى وجهه دون ذاته، وهو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إنما ذَكَر الوجه لكونه أشرفَ ما يكون، والله -جل وعلا- يبقى، لا يتناوله فناءٌ، لا ذاته ولا وجهه ولا صفاته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
سؤال (05): قال شيخ الإسلام: من حلف للإكرام فلا كفارة عليه، هل هـٰذا صحيح؟
الجواب: نعم هـٰذا صحيح عن شيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن الحلف إذا كان للإكرام، لإكرام المحلوف عليه فإنه لا كفارة عليه إذا خالف، مثل: لو أردت أن تحضر شيئًا لصاحبك فقال: واللهِ ما تأتي به، فأتيتَ به إكرامًا له، فهـٰذا لا يُعَدُّ حِنْثًا لأنه من باب الإكرام. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، والجمهورُ: على أنه حِنْثٌ، ولو كان للإكرام؛ لأنه مخالفة لليمين.
سؤال (06): هـٰذا حديث إذا دعاكم فأجيبوه عام، وهو أن الأصل فيه الدخول في كل دعوة، فهل هـٰذا على ظاهره، أم أن هناك مخصِّصاً؟
الجواب: حكم إجابة الدعوة فيه تفصيل، لكن هـٰذا هو الأصل، أما التفصيل: فقد تكون إجابة الدعوة محرمة إذا كان فيها محرم، وقد تكون واجبة إذا كان يترتب على عدم إجابتها فساد أو قطيعة رحم، وقد تكون مستحبة إذا كان الإنسان عنده أشغال قد يحصل عليه ضِيق بإجابة الدعوة، فيها تفصيل.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في الـ(لَوْ)
وقول الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾( ).
وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾( ).
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان)).
[الشرح]
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في الـ(لَوْ).)
وجه إدخال هـٰذا الباب في كتاب التوحيد: أن الـ(لَوْ) منها ما يكون منازِعًا للقدر، ومنها ما يكون منازعًا للشرع، فما كان منها منازعًا للقدر وما كان منها منازعًا للشرع، فإنه ينقص توحيد العبد، ولذلك ذكره المؤلف -رحمه الله- في كتاب التوحيد.
وأما مناسبته للباب الذي قبله: فإن من تمام التوحيد الاستسلام لله -عز وجل-، ومن حسن التوحيد وكماله أن يستسلم العبد لله -عز وجل- فيما يجريه عليه من الأقدار والأقضية، وهـٰذا ينشأ عن تعظيم الرب جل وعلا، فله صلة بالتعظيم الذي تقدم الكلام عليه في الأبواب السابقة، وقد نقول: إنه لا صلة للباب بما قبله، ويكون مبدأ بحث جديد فيما يتعلق بمسائل التوحيد.
قال رحمه الله: (باب ما جاء في الـ(لَوْ).)
ولم يجزم المؤلف -رحمه الله- في هـٰذه الترجمة بحكم قول القائل: (لَوْ)، إنما ذكر ذلك على وجه الإطلاق، حيث قال: (باب ما جاء في الـ(لَوْ)) يعني: من النصوص والأحاديث، والسبب في هـٰذا الإطلاق أن قول القائل: (لو) يختلف حكمه باختلاف مَوْرِده، فقد يكون محرمًا وقد يكون جائزًا وقد يكون مندوبًا، على حسب ما يرد فيه هـٰذا الاستعمال وما يُقصَد به.
يقول رحمه الله: (وقول الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾( ).)
هـٰذا في قول المنافقين في الاعتراض على قَدَر الله جل وعلا، و(لو) في مثل هـٰذا السياق محرمة؛ لأنها معارَضة لقَدَر الله -عز وجل-، وتفتح على الإنسان باب الوساوس، وهي أشد من الـ(لَوْ) التي تتعلق بالقدر المحض؛ لأن هـٰذه تتعلق بالقدر والشرع، إذ إن هؤلاء إنما قالوا هـٰذا القول في التنديم على طاعة الله ورسوله حيث قالوا: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ في غزوة أحد، فكأنهم قالوا هـٰذا في معارضة، بل هم قالوا هـٰذا في معارضة طاعة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في خروجه لمقاتلة الكفار، فهـٰذه مُحَرَّمة لمعارضتها للقدر، حيث لم يستسلموا لقضاء الله ولم يرضوا به، ولمعارضتها للشرع، حيث إنها مضمنة التنديم والتَّحْسِير والتأسيف على طاعة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جهاد الكفار والخروج لمقاتلتهم.
وأما الثانية: فهي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾( ) هـٰذه الآية فيها (لو) جاءت في سياق التنديم على طاعة الله ورسوله، فهي متضمِّنة لمعارضة الشرع؛ لأنهم نَدَّمُوهم على طاعة الله ورسوله، وما كانت على هـٰذا السياق فهي محرمة وتقدح في التوحيد.
ثم قال رحمه الله: (في الصحيح عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((احرص على ما ينفعك)).)
وهـٰذه وصية جامعة من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأمة الإسلام: ((احرص على ما ينفعك)). ويشمل قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما ينفع في الدنيا وما ينفع في الآخرة، ولكن ما ينفع في الآخرة مُقَدَّم؛ لأنه الذي يبقى نفعه ويُرجَى ثمرتُه على وجه الدوام، بخلاف ما ينفع في الدنيا فإن نفعه محدود وإن كان داخلاً في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((احرص على ما ينفعك)).
والحرص هو: الجد والاجتهاد في تحصيل ذلك، ومن الحرص أن يأخذ الإنسان بالأسباب المُفْضِية المؤدية إلى ما ينفع في الدنيا والآخرة، فإن الحريص على رضوان الله -عز وجل-، على دخول الجنة لا بُدَّ لتكميل حرصه من أخذ أسباب دخول الجنة، كما أن الحريص على منافع الدنيا لا يُحصلِّها إلا بأخذ أسبابها، فكذلك أمور الآخرة لا يتم وصف الإنسان فيها بالحرص إلا إذا أخذ بالأسباب المؤدِّية إلى ما ينفع.
((احرص على ما ينفعك واستعن بالله)). وهـٰذا فيه أن الإنسان ينبغي له ألا يَركن إلى جُهده وعملِه وكدِّه وحرصه، بل ينبغي بعد أن يأخذ الأسباب ألا يستند إليها، بل يعلِّق قلبه أولاً وآخرًا بالله جل وعلا، وأن يطلب العَوْن منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ، فإنه لا يُحَصِّل الإنسان غرضه ولا يصيب مقصودَه مع تمام الحرص وغاية الجد والاجتهاد إذا لم يكن من الله عونٌ له، فينبغي للعبد أن يستعين الله -عز وجل- في الدقيق والجليل، في الصغير والكبير، في الحقير والعظيم، وإذا كان كذلك فقد جمع سببين من أعظم أسباب إدراك المطلوب، فإنَّ المطالب إنما تُدرك بغاية الحرص مع عظيمِ التوكل والاستعانة بالله -عز وجل- في تحصيلها. فهاتان الجملتان هما وسيلة وسبيل وسبب تحصيل المقاصد والمطالب في الدنيا والآخرة.
((احرص على ما ينفعك واستعن بالله)).
والاستعانة هي: طلب العون، وطلب العون يكون برُكون القلب إلى الله جل وعلا، وميله إليه، وانجذابه إليه، وكِلَةِ الأمر إليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ويكون باللفظ والدعاء والسؤال والطلب والإلحاح في الدعاء أن يُيَسِّر الله -جل وعلا- المقصود، وأن يحصل لك المطلوب.
قال رحمه الله: ((ولا تعجز)). أي: وإياك والعجزَ، والعجزُ هو: القصور في تحصيل المطلوب مع إمكان حصوله، يعني: مع قدرة الإنسان على تحصيله، هـٰذا العجز، فإن العجز يُطلق ويُراد به القصور عن تحصيل المطلوب، ويُطلق ويراد به التقصير في تحصيل المطلوب، فإذا قُوبِل بالكسل كان قُصورًا، وإذا أُطلِق شَمِل القصور والتقصير؛ لأن فواتَ المطالب، وعدم تحصيل المقاصد يرجع إلى سببين:
إما إلى قصورٍ في الشخص عن تحصيل مطلوبه وغرضه، وإما إلى تقصير، يعني: ليس عنده قصور، عنده القدرة والتمكن من تحصيل مطلوبه، لكنه كَسِل وترك الجدَّ في تحصيل مطلوبه، فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تعجز)). المقصود: ولا تعجزن، المقصود به أي: لا تقصر في تكميل ما تقدَّم ليحصل لك مطلوبك، وتنال مرغوبَكَ.
ثم قال: ((وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا)) أو ((لو أني فعلت لكان كذا وكذا)).
أي: إذا كان منك تمام الحرص وكان منك الاستعانة بالله -عز وجل-، وكان منك الجد في الأمرين، ثم مُنعتَ من تحصيل غرضك ففاتك ما تطلب، أو حصل عليك ما ترهب وتفر منه فلا تقل: ((لو أني فعلت لكان كذا وكذا))؛ لأن (لَوْ) في هـٰذا المقام يُشْتَمُّ منها وتُشعر بعدم الرضا بالقدر، وعدم الاستسلام لله -عز وجل-، مع أن الإنسان قد استنفذ جهدَه، واستفرغ طاقته في تحصيل مطلوبه، إما في إدراك محبوب أو في الأمن والفرار من المرهوب، ولذلك ينبغي له في مِثل هـٰذه الحال أن يقول ما وَجَّه إليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل)) أو: ((قَدَّرَ الله وما شاء فعل)) وأيهما أولى وأكمل؟
الأول، أن تقول: قَدَرُ الله وما شاء فعل، ومعنى التركيب: هـٰذا قَدَرُ الله، فقَدَرُ الله يكون خبرًا لمبتدأ محذوف، وإنما رجَّحْنا هـٰذا على ((قَدَّر الله)) لأن الجملة اسمية، والجملة الاسمية فيها من الثبات والاستمرار والدوام ما لا تفيده الجملة الفعلية.
((قَدَرُ الله وما شاء فعل)) أي: هـٰذا وهو فوات المرغوب، أو وقوع المرهوب قَدَرُ الله، وما كان كذلك فالواجب فيه ماذا؟ الواجب فيه التسليم، والرضا بالقضاء، وعدم منازعة الله -جل وعلا- أقداره.
((وما شاء فعل)) أي: والذي شاءَهُ فَعَلَ.
ثم قال في تعليل النهي عن قول: ((لَوْ)) عند فوات المطالب، أو حصول المكاره: ((فإن لو تفتح عمل الشيطان)).
((لَوْ تفتح عمل الشيطان)) أي: هي سببٌ ومِفتاح يدخل منه الشيطان على الإنسان، الشيطان يسعى إلى التحزين، يسعى إلى إلحاق الأذى بالإنسان من كل وجه: الأذى المعنوي والأذى الحسي، الأذى القريب والأذى البعيد، يسلك لذلك كل سبيل، ويطرُق لذلك كل باب، فينبغي للمؤمن أن يكون في غاية الحرص والحذر من هـٰذا العدو المُرصِد الذي أمرنا الله -جل وعلا- باتخاذه عدوّاً.
ومن مفاهيم أو فوائد اتخاذه عدوّاً أن يكون في غاية الحذر منه في كل وقت، وفي كل حال، ومن ذلك إغلاق الأبواب عليه. فإنَّ ((لَوْ)) تفتح عمل الشيطان، هـٰذا الأصل في هـٰذه الكلمة، لكن إذا قال الإنسان: ((لَوْ)) في مساقٍ يبيِّن فيه الأفضل لا على وجه التحسُّر والندم فإنه لا بأس عليه في هـٰذا، وإذا قال: (لو) على وجه الخبر فإنه لا بأس بهـٰذا، ومن ذلك قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في الصحيح لأصحابه في حجة الوداع: ((لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة)). فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لأصحابه هـٰذه المقولة، واستعمل فيها (لَوْ)، لكنها ليست مما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأن (لو) هناك على وجه الخبر لتطمئن نفوس أصحابه.
وهل هي للتمني؟
للعلماء في هـٰذا قولان:
منهم من قال: إن قوله: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت)) للتمني، أي: تمنَّى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يوافِقَ أصحابه؛ حيث تحللوا بالعمرة، ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن تطييبًا لخاطرهم، ولكون هـٰذا أفضل.
وقال آخرون: إن قوله: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت)) ليس من باب التمني، بل هو من باب الخبر الذي يدخل به السرور على أصحابه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإلا فإن الخير فيما اختاره الله -جل وعلا- لرسوله، ولو كان حال الصحابة أفضل لَمَا جعل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- رسوله في الحال المفضولة، فقالوا: إن (لو) هنا ليست من باب التمني إنما هي من باب الخبر.
وكذلك مما يجوز فيه (لو): تمني الخير مع الاجتهاد في تحصيله، وهـٰذا في خبر الرجل الذي قال: ((لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : فهما في الأجر سواء)).
فإن (لو) هنا صادرة من قلب صادقٍ عازمٍ على عمل الخير حِيلَ بينه وبينه، أي: لم يتمكن من العمل بالخير مع صِدْق رغبته فيه، فهـٰذا هل هو مما نهي عنه من اللو أو لا؟
لا، هـٰذه اللو سبب للأجر؛ ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((هما في الأجر سواء)). فدل ذلك على أنها مما يُندب إليه، وهي مشعِرة بتمني الخير.
إذًا: (لو) ليست على وجهٍ واحد في كل موارِدها:
منها ما هو محرم، وضابط المحرم: ما كان معارِضًا للقدر، ما كان معارضًا للشرع، ما كان فيه التحزين والتندُّم والتحسُّر على ما فات.
وما عدا هـٰذا فإنه قد يكون مندوبًا إليه، وقد يكون مباحًا، فما كان على وجه الخبر فإنه مباحٌ في أصله، وما كان في طلب الخير فإنه مندوبٌ إليه.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران.
[الشرح]
تقدم هـٰذا، والفرق بينهما: أن (لو) الأولى فيها معارضة القدر والشرع ضِمنًا، والثانية فيها معارضة الشرع.
[المتن]
الثانية: النهي الصريح عن قول: (لو) إذا أصابك شيء.
[الشرح]
وذلك لِمَا فيه من معارضة القدر، ولما فيه من التندم على ما لا يدركه الإنسان وعدم التسليم للقدر.
[المتن]
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
[الشرح]
وهـٰذا تعليل نبوي، وذلك أنه ينفتِح به على الإنسان شرٌّ كثير من الوساوس والتحسير والتنديم وعدم التسليم لقضاء الله وقدره، وهـٰذا يُفيد أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في إغلاق أبواب الشيطان قولاً وعملاً، حتى هـٰذه الكلمة- مع أنها يسيرة، وقد يستخِفُّ بها كثير من الناس- وَجَّه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى إغلاق الشر بتركِها، ووَجَّه إلى ما ينبغي أن يقوله المؤمن مما يزداد به إيمانًا، ويربِط الله به على قلبه، ويحصل له به الأجر، وهو قوله: ((قَدَرُ الله وما شاء فعل)).
[المتن]
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.
[الشرح]
وذلك في قوله: ((ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل)).
[المتن]
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
[الشرح]
وذلك في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله)).
[المتن]
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
[الشرح]
العجز ما هو؟
التقصير في الحرص، والتقصير في الاستعانة، هـٰذا المراد بالعجز هنا، وأما في قوله: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل)) فهل العجز تقصير أو قصور؟
قصور.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: النهي عن سَبِّ الريح
عن أبي بن كعب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هـٰذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرَتْ به، ونعوذ بك من شر هـٰذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرَتْ به)) صححه الترمذي.
[الشرح]
هـٰذا الباب قال فيه المؤلف رحمه الله: (باب النهي عن سب الريح.)
يعني: ما جاء عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سَبِّ الريح، والنهي يقتضي التحريم في الأصل، وذلك أن الأصل في المناهي أنها محرمة ما لم يدل دليل على أن النهي ليس للتحريم.
ومناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن سبَّ الريح سبٌّ لخلق الله جل وعلا، وسبُّ خلق الله الذي لا يَستحقُّ السب من معارضة أقدار الله -عز وجل-، فالريحُ مأمورة، ليست مما يفعل بنفسه فيستحق الذم أو يستحق الثناء والمدح، بل هي مأمورة، جندٌ من جند الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، يصرِّفها كيف شاء، فسبُّها مضمَّن سبَّ مُصَرِّفها -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وهي في الجملة داخلة فيما نُهي عنه من سب الدهر؛ لأن السب للدهر هو سبٌّ للزمان، وما يجري فيه من أحداث، فإن الناس إنما يسبُّونه لما فيه من الأحداث والأقدار، وقد تقدَّم نهي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن سب الدهر، وقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الإلهي: ((لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر)). وقول الله -عز وجل-: ((يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار)). فمناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد واضحة.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن (لو) فيها من معارضة القدر ما تقدَّم بيانه في الباب السابق، وسبُّ الريح أيضًا فيه معارضة لأقدار الله -عز وجل-، وعدم تسليم لقضائه جل وعلا.
ذكر المؤلف -رحمه الله- في الباب حديث أبي بن كعب، وقد ورد في هـٰذا المعنى أحاديث كثيرة عن عائشة كما في الصحيح، وعن ابن عباس، وعن سلمة بن الأكوع، وعن غيرهم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.
قال المؤلف -رحمه الله- فيما نقل: (عن أبي بن كعب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تسبوا الريح)).) فنهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن سب الريح: ((لا تسبوا الريح)).
والسبُّ هو: الشتم، ويدخل فيه كل كلام قبيح، فاللعن من السب، والذم من السب، والوصف السيئ من السب، ولذلك السب يشمل كلَّ كلام قبيح، فنهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن كل كلام قبيح فيما يتعلق بالريح؛ لأن الريح ليست مما يفعل بنفسه فيستحقُّ مدحًا أو ذمّاً، بل هي مأمورة كما في حديث ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عند الترمذي: ((لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة)). ومن الذي يأمرها؟ الله جل وعلا، الذي يصرِّفُها كيف شاء.
((فإذا رأيتم ما تكرهون)) أي: من الريح ومن أثرها ((فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هـٰذه الريح وخير ما فيها)). وهـٰذا فيه اللجوء إلى الذي بيده الأمر، والذي يُصَرِّف هـٰذه الريح كيف شاء، والذي يمنع شرَّها وإليه تحصيل ما فيها من الخير: ((اللهم إنا نسألك من خير هـٰذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمرت به)) وهـٰذا فيه المبالغة والتفصيل في الطلب والدعاء والسؤال: ((من خير هـٰذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمرت به. ونعوذ بك من شر هـٰذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمرت به))؛ لأن الذي يحصل من قِبَله الخير هو الله، فلا مانع لما أعطى، والذي يدفع عنك الشر هو الله -عز وجل-، فلا معطي لما منع، ولذلك ينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله -عز وجل- في تحصيل الخير، وفي دفع الشر.
وقد صح عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في الصحيح من حديث عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا عَصَفَت الريح أقبل وأدبر، وعُرف ذلك في وجهه، وقال: ((اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به. وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به)). وذلك أن الريح منها ما يكون خيرًا، ومنها ما يكون شرّاً، وفي هـٰذا فائدة؛ وهي أن التفريق بين الرياح والريح، وأن الريح تأتي بالخير، والرياح تأتي بالشر أو العكس؟ الرياح تأتي بالخير، والريح تأتي بالشر لا وجه له؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اللهم إني أسألك من خير هـٰذه الريح)) ولو كانت شرًّا محضًا لَمَا كان فيها خيرٌ يُسأل، إنما منها ما يكون خيرًا، ومنها ما يكون شرّاً.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن سب الريح.
[الشرح]
وذلك في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تسبوا الريح)).
[المتن]
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
[الشرح]
هل هـٰذا الكلام مما يَنْفع في الدنيا، أو مما ينفع في الدنيا والآخرة؟
مما ينفع في الدنيا والآخرة، فبِهِ تُدفع المصائب والبليَّات في الدنيا، ويحصل للإنسان في الدنيا بهـٰذا الكلام المنافع والخيرات، وأما في الآخرة فنفعه ظاهر؛ لأنه ما من داعٍ يدعو إلا وله أجر على دعائه، فـ((الدعاء هو العبادة)) كما في جامع الترمذي بسند صحيح، فالدعاء من أفضل وأجلِّ العبادات التي يُعبد الله بها -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهـٰذا التوجيه إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة.
مثلُه ما تقدَّم قبل قليل في حديث أبي هريرة: ((وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل)). فإن هـٰذا الكلام نافع في الدنيا والآخرة: في الدنيا يحمل على الصبر، ويحمل على عدم الضَّجَر، ويحمل على فتح الأمل للإنسان، فإنه لا ييأس ولا ينقطع في نظره إلى ما جرى عليه من المصائب والبليَّات، بل ينظر إلى أن الله قَدَّر عليه هـٰذا، والفُسحة في المستقبل. وهو نافع في الآخرة لأنه يؤجر على هـٰذا القول، فهو ذكر وقول حسن يثبت به الإيمان ويزداد به اليقين، ويَسْلَم به الإنسان من الشيطان ووساوسه.
[المتن]
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة.
[الشرح]
وذلك في قوله: ((وخير ما أمرت به)). وقد صرح بذلك في رواية ابن عباس في الترمذي حيث قال: ((لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة)).
[المتن]
الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
[الشرح]
وجه ذلك أنه سأل من خيرها، واستعاذ بالله من شرها، ولو كانت لا تأتي إلا بِشَرّ لَمَا كان لسؤال خيرِها وجه، إنما لاكتفى بالاستعاذة بالله من شرها.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾( ).
وقوله: ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾( ).
قال ابن القيم في الآية الأولى: فُسِّر هـٰذا الظن بأنه -سبحانه- لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفُسِّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففُسِّر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأن يُظهره الله على الدين كله، وهـٰذا هو ظن السَّوْء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هـٰذا ظن السَّوْء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾( ). وأكثر الناس يظنون بالله ظن السَّوْء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلَم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
فليعتنِ اللبيب الناصح لنفسه بهـٰذا، وليتبْ إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السَّوْء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتًا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقِل ومستكثِر، وفتش نفسك: هل أنت سالم؟
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة
وإلا فإني لا إخالك ناجيا
[الشرح]
فهـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: وذلك أن الظن السيئ بالله -عز وجل- ، ظن السَّوْء فيه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من أعظم القدح فيه جل وعلا، في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفيما يجب له من الطاعة؛ لأنه أمرنا بحسن الظن به. هـٰذا وجه دخول هـٰذا الباب في كتاب التوحيد.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن الباب الذي قبله فيه التَّعَنُّتُ على القدر وذمه، وذلك بسب ما يُجريه الله -عز وجل- من الوقائع والأحداث، ومن ذلك أي: ويشارك هـٰذا في الإثم ويشابهه ويقاربه: أن يظن الإنسان بربه ظنّاً سيئًا.
ثم قال -رحمه الله- في هـٰذا الباب: (باب قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾( ).) ذكر هـٰذه الآية وهي من سورة آل عمران، والآية الثانيـة التي ذكرهـا: ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾( ) وهي في سورة الفتح.
الجامع بينهما: ذِكْرُ عاقبة الظن السيئ، الأولى فيها بيان شيء من الظن السيئ بالله -عز وجل-، والثانية فيها جزاء الظانين به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ظنّاً سيئًا، فالأولى فيها بيان نوع من أنواع الظن السيئ، قال الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ أي: غير ما يجب اعتقادُه وظنُّه في الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ أي: إنه لا يكون هـٰذا الظن إلا من أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية هم الذين لم يعلموا ما للرب من كمال الصفات، وبديع الأوصاف، وجميل الأفعال، أو أنهم علموا وخالفوا مقتضى علمهم، فإنهم أيضًا موصوفون بأنهم من أهل الجاهلية؛ لأن الجاهلية مأخوذةٌ من الجهل، والجهل يكون بأمرين:
الأمر الأول: عدم العلم.
والثاني: عدم العمل بالعلم.
كل هـٰذا يَصدُق عليه وصف الجهل والجاهلية، فإضافة الظن هنا إضافة الظن إلى سببه، يعني: الظن الصادر عن جهل، أو إلى أهله، وهم المتصفون بهـٰذا الوصف.
﴿يَقُولُونَ﴾: هـٰذا بيان لظنهم.
﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾. الاستفهام هنا استفهام ما نوعه ؟ إنكاري، يعني: ليس لنا من الأمر شيء.
﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾. أجاب الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على ظنهم السيئ، وقولهم الذي يُشعر بما في قلوبهم من ظن الجاهلية :﴿إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ فلا مُعَقِّب لحكمه؛ لأنهم قالوا: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾. فهم اعترضوا على قَدَر الله وقضائه، وما اقتضته حكمته من مجريات الأحداث ووقائعها بأنه يدل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، فأجاب الله على هـٰذا الاستفهام وهـٰذا الإنكار: ﴿إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ وهو واقع، فليس لكم من الأمر شيء.
وقوله: ﴿إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ يشمل الأمر الشرعي، ويشمل الأمر الكوني: فالأمر لله شرعًا، والأمر له -جل وعلا- قدرًا، وإذا كان كذلك فالواجب على العبد -كما أنه منقادٌ لأمر الله القدري لا يخرج عنه أحد مهما كان- أن ينقاد لأمره الشرعي كانقياده لأمره القدري، حتى يَكْمُل في مراتب الإحسان، ويتم له الإيمان.
قال رحمه الله: قال الله تعالى:﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ﴾.
الظن يا إخواني يُطلق في اللغة، ويراد به: ما غَلَبَ فيه أحد الطرفين على الآخر، ولذلك قال الناظم في معنى الظن:
والظن تجويز يكون راجحا
وهو درجة من درجات العلم، فهو تجويز، يعني تجويز ماذا؟ تجويز أحد الطرفين، إما الإثبات وإما النفي، لكنه في أحدهما أو إلى أحدهما أميلُ، وفي أحدهما أقوى، هـٰذا الظن. وهنا في قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ يحتمل أن يكون هـٰذا المعنى الذي هو: غَلَّبوا فيما يتعلق بالله جانب السوء، ويحتمل أن الظن هنا بمعنى اليقين، وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟
الجواب: نعم يأتي الظن بمعنى اليقين، ومنه قول الله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ﴾( ). فالظن هنا بمعنى اليقين والاعتقاد؛ لأنه لا يمكن أن يُحمل على غير هـٰذا، فالآية تحتمل أن يكون الظن الذي هو تجويز غالب، ويحتمل أنه الظن الذي يكون اعتقادًا راسخًا.
وأيهما أشد؟
لا شك أن ما كان يقينًا واعتقادًا راسخًا اعتقاد السوء - أعوذ بالله- اعتقاد السوء برب العالمين أعظم وأشد جُرمًا، وأعظم خطرًا، ومثله تغليب الظن السيئ في الله -عز وجل-.
﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾، من أين نعرف ما الذي يجب أن نظنه في ربنا؟ ما هي مصادر معرفة الظن الحق؟ لأن الله ذمَّهم على أنهم ظنوا فيه غير الحق، فما هي مصادر معرفة الظن الحق فيه جل وعلا؟
العلم بأسمائه، العلم بصفاته، العلم بأفعاله جل وعلا.
من أين نتلقَّى هـٰذه الأمور؟
من الكتاب ومن السنة، فمصدر الظن الحق: الاعتصام بالكتاب السنة، والإقبال عليهما، وما فيهما من الأخبار عن صفات الله وأسمائه وأفعاله جل وعلا، فمنهما -من الكتاب والسنة- يصدُر الظنّ الحق، ولا يمكن لشخص عَرَف الله- كما وصف نفسَه، وكما وصفه به رسولُه، بل كما أخبر الله عن نفسه اسمًا ووصفًًا وفعلاً، وكما أخبر الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ربه اسمًا ووصفًا وفعلاً- أن يتطرَّق إلى قلبه ظنُّ السَّوْء، بل لو ورد عليه واردٌ دفعه، وبادر إلى إزالته؛ لأنه قد لا يسلَم الإنسان من ظن السَّوْء في بعض الأحيان، لكنه ليس ظنّاً مستقرّاً، إنما هو شيء قد يهجم على القلب، فيدفعه بما معه من العلم بالله -عز وجل- والمعرفة به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾.
أي: إن الأمر له -جل وعلا- فلا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه.
وسيأتي بيان الظن السيئ الذي ظنوه بالله -عز وجل- ، هو في هـٰذا الموضع ظنُّهم أن الله لا ينصر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأن ما جاء به الرسول ليس حقّاً، وأن الكفار غالبون ظاهرون على أهل الحق غلبةً دائمةً، كما سيأتي في تفسير الشيخ رحمه الله.
بعد أن بَيَّن الشيخ -رحمه الله- في الآية الأولى صورةً ونوعًا من أنواع الظن السيئ، بَيَّن جزاءه وعقوبة أهله، فقال رحمه الله: وقوله تعالى: ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾( )، هـٰذه عقوبة أهل الظن السيئ بالله -عز وجل-، واعلم أن هـٰذه العقوبة لم يرد نظيرُها في غير الظن السّيئ، ولذلك قالوا: إن أعظم الذّنوب وأشدها عقوبةً ظنُّ السَّوْء بالله -عز وجل- ؛ لأنه لم يرد نظير هـٰذه العقوبة في ذنبٍ من الذنوب، بل قال الله -عز وجل- في هـٰذه الآية: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ هـٰذا ليس في كل من تقدم، إنما هو في ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ لذلك قال: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. كل هـٰذا في الصنف الثالث الذين ذكرهم الله -عز وجل- في هـٰذه الآية، وهـٰذا يُبَيِّن لنا عِظَم عقوبة وجرم أصحاب الظن السيئ بالله -عز وجل-.
ولا فَرْقَ بين أن يكون الظن السيئ، ظن السوء في الله -عز وجل- فيما يتعلق بخاصة الإنسان، يعني: فيما يفعله الله -عز وجل- بالإنسان نفسه، وفيما يتعلق بعموم الأمة، فإن الجميع يشتركون في أي شيء؟ في أنه ظن سَّوْء برب العالمين، لا فَرْقَ في ذلك بين أن يظن الإنسان الظن السيئ فيما يتعلق بخاصة نفسه، وفيما يتعلق بما يفعله الله -عز وجل- بعموم الأمة.
يقول -رحمه الله- في بيان الآية ومعناها: (قال ابن القيم في الآية الأولى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ فُسِّر هـٰذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل). هـٰذا التفسير الأول.
(وفُسِّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله ولا بحكمته).
الثالث: (فُسِّر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يَتم أمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو أن يُتم أمر رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). هـٰذا الرابع.
(وأن يظهره على الدين كله). هـٰذا تابع لتمام أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(وهـٰذا هو ظن السوء). لكن هـٰذا ليس على وجه الحصر، إنما هـٰذا بيان الظن السيئ الذي أنكره الله على هؤلاء في قوله: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ والظن السيئ أوسع من هـٰذا، ظنُّ السَّوْء برب العالمين أوسع من هـٰذا، هـٰذا فيما يتعلق بأمر الرسالة، وأمر الرسول، وأمر الأمة.
من أمثلة الظن السيئ الخاص: ما يقع لكثير من الناس إذا نظروا إلى حال أهل الغنى واليسار من أهل المعصية أو الكفر أو الفجور، حيث يقولون: كيف هؤلاء أُعطوا ما أُعطوا وهم على ما هم عليه من كفر، ونحن على ما نحن عليه من طاعة؟ أو: وأنا على ما أنا عليه من طاعة لم أُمَكََّن، ولم أعطَ، ولم يكن لي مثلُ ما كان لهم؟ هـٰذا لا شك أنه من الظن السيئ برب العالمين؛ لأنه جَهِلَ وخفي عليه أن الله -جل وعلا- يعطي بحكمة، وأن إعطاءه وإمداده لهؤلاء ليس قصرًا عليهم، ولا مكافأةً لهم على كفرهم، بل قد يكون استدراجًا لهم وبلاءً يحاسَبون عليه، ويعاقَبون على ما جرى لهم من الكفر بهـٰذه النعم التي ساقها الله عليهم.
ثم إنه قد يكون من الحكمة أن يُمنَع الإنسان هـٰذا؛ ليكمل إيمانه، وتعظم درجته، وينفك من أسباب الردى والفسوق؛ لأن انفتاح الدنيا قد يكون سببًا في حق بعض الناس للفتنة والضلال. المراد: أن الظن السَّوْء، وظن غير الحق ليس محصورًا فيما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله، بل هو فيه وفي غيره.
ولا شك أيها الإخوة أن الناس إذا أحاط بهم أمرٌ من الأمور من كل جانب، كما هو الحال في واقع أمة الإسلام الآن، لما أحاط بها أعداؤها وفقدت الأمل، قد يتسرب إلى قلوب كثير من الناس ظن السوء بالله -عز وجل- ، لكن على المسلم أن ينفي عن قلبه ذلك، وأن يُصَدِّق بوعد الله -عز وجل- الذي أَخْبَر به كما أنه أخبر أنه لا يُخلِف الميعاد، فالواجب عليه أن يؤمن بهـٰذا وهـٰذا: يُصَدِّق بالوعد، ويُصَدِّق أنه وعدٌ لا يُخلَف، وأنه واقع، وأن تأخره إنما هو لحكمة، فالله -جل وعلا- يُجري الأمور على ما اقتضته حكمته، لا يقدم ما يستحق التأخير، ولا يؤخِّر ما يستحق التقديم، بل كل شيء بقضاء وقدر، وكل شيء قد أحاط به -جل وعلا- وعَلِمَه، فالله بما يجري محيطٌ، وهو عليه شهيد -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، لا تخفى عليه خافية، لكنه مع هـٰذا كله لطيفٌ لما يشاء، فهو -جل وعلا- يُبْرِم لأوليائه وأهل دينه من النصر وصنعة الحق ما لا تدركه أبصارُهم، وقد يخفى عليهم شيءٌ كثير من ذلك، لكن ينبغي على المؤمن أن يُصّدِّق جازمًا بوعد الله -عز وجل-، ولا يتسرب إلى قلبه شيءٌ من الظن السيئ، وأن الله سيُدِيل أهل الكفر على أهل الإسلام، أو أن الله لا ينصر أهل ملة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو ما أشبه ذلك من الظنون التي قد تتسرب إذا ضاقت الأمور على الناس، ورأوا اضمحلال الخير، وزوال أعلامه، وانتشار الباطل وفُشُوَّه وظهوره، فإن الله -عز وجل- تكفل بحفظ هـٰذا الكتاب، وتكفل بحفظ هـٰذه الأمة بحفظ كتابه؛ لأن الكتاب لا يمكن أن يُحفظ إلا بحفظ بحفظ حملته: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾( ). ليس المقصود أن يبقى القرآن والكتاب محفوظًا دون أن يُحفظ حملته، فحِفظ الكتاب بحفظ حملته، حفظًا وفهمًا ودرايةً وعلمًا وعملاً، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)). وهـٰذا من لوازم حفظ الكتاب والذكر الذي حفظه الله جل وعلا.
المراد: ينبغي أن نقاوم هـٰذه الضغوط التي تَرِد على القلوب ليتسرَّب إليها ظنُّ السَّوْء، بل يجب على المؤمن أن يظن بالله -عز وجل- الخير، وإن كان من ظنٍّ سيئ فليظنَّ السوء بنفسه وبني جنسه ممن قصروا في حمل الحق والعمل به، أما وعد الله فوعدُ الله جارٍ لا يمكن أن يتخلف، لكن الله -جل وعلا- قد جعل لكل شيء قَدْرًا ينتهي إليه ويبلغه، فإذا بلغ الكتابُ أجلَه فإنه لا مؤخِّر لحكم الله ولا رادَّ لقضائه، بل لا بد أن يقع: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾( ).
إذًا يا أخي هـٰذه الأمور والصور التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- هي من صور ظن السوء التي ذكرها أهل العلم في قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾.
قال رحمه الله: (الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح).
وهـٰذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، كأن الموضع واحد، يعني: الظن الذي في سورة آل عمران هو الظن المذكور في سورة الفتح.
يقول رحمه الله: (وإنما كان هـٰذا ظن السوء) لماذا؟ (لأنه ظنُّ غيرِ ما يليق به سُبْحَانَهُ).
﴿ظَنَّ السَّوْء﴾: من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني: الظن السَّوْء، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وإنما كان هـٰذا ظنَّ السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. يقول رحمه الله: (وإنما كان هـٰذا ظن السوء) لماذا؟ (لأنه ظنُّ غيرِ ما يليق به سبحانه).
(فمن ظن أنه يديل الباطل) يعني: ينصر الباطل (وأهل الباطل على الحق) يعني: الحق وأهله (إدالةً مستقرة): ثابتة (يضمحل معها الحق) يعني: يزول ويختفي. (أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قَدَّرَه لحكمةٍ بالغةٍ يستحقُّ عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة) أي: لا حكمة فيها (فذلك ظن الذين كفروا، ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾). فالواجب على المؤمن أن يعتقد في كل ما يُجريه الله -عز وجل- أنه بقدرٍ، وأنه بحكمة، وأن الله -جل وعلا- لو شاء لمَنَعَهُ، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾( ). هـٰذا في كل ما يقع مما يكرهه الإنسان، ولذلك كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا لِيمَ أنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في شيء مما لم يصنعه مما كان ينبغي أن يصنعه، قال لأهله: ((دعوه، فلو كان شيء قُدِّر لكان))، أو ((فلو كان شيء قُدِّر لكان)). فلا ينبغي الاشتغال باللوم على ما فات، بل ينبغي أن يُعلم أن ما كان مما يكرهه الإنسان، وما جرى مما لا يحبه الإنسان إنما هو بقضاء الله وقَدَرِه، ولحكمةٍ كان، لحكمةٍ قد تَخفى، قد يُجهِد الإنسان نفسه في التوصل إلى حكمة أمرٍ ما، لكنه لا يتوصَّل، فلا يعني هـٰذا أنه لا حكمة، بل الإيمان المجمَل العام أنه ما من شيء إلا وفيه حكمة يكفي في الجواب عن الحكمة التي خَفِيت عليك في الأمر المعيَّن، فإذا فتح الله عليك، وأدركتَ الحكمة في الأمر المعيَّن الذي تكرهه، أو الذي كرهتَ وقوعه فاعلم أن الله –جل وعلا- قد فتح عليك ما يرسَخ به إيمانك، ويزداد به يقينُك؛ لأن إدراك تفاصيل الحِكَم في الأحكام والوقائع، الأحكام الشرعية، والأحكام القدرية مما يُثَبِّت اليقين، ومما يَسْكُن به القلب ويطمئن، بخلاف ما لو خفيت عليه الحكمة، لكن الحل في مثل هـٰذا، إذا خفيت عليك حكمة تفصيلية في حكم قدري أو في حكم شرعي، فارجع إلى أي شيء؟ إلى أن الله -جل وعلا- حكيمٌ خبيرٌ، إلى أنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يفعل شيئًا من الأشياء ولا يقضي شيئًا من الأقضية إلا لحكمةٍ.
ثم قال رحمه الله: (وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم).
هـٰذا إشارة إلى نوعي الظن السيئ، وأنه يكون فيما يختص بالإنسان، ويكون فيما يتعلق بغيره.
يقول: (ولا يسلم من هـٰذا إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، ومُوجَب حكمته وحمده).
(مُوجَب) يعني: ما يترتب، وما تقتضيه حكمته ورحمته.(ومُوجَب حكمته وحمده، فليعتَنِ اللبيبُ الناصح لنفسه بهـٰذا). أي: بهـٰذا الأمر وهـٰذا الشأن. وهـٰذا أمرٌ يحتاج إلى عناية كما قال ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر كلامًا أطول من هـٰذا، لكن الشيخ اختصر من كلامه زُبَدًا وخلاصةً، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى هـٰذا الكلام في (زاد المعاد) في المجلد الثالث.
قال رحمه الله: (وليتُبْ إلى الله، وليستغفر من ظنه بربه ظنّ السوء). وهـٰذا يدل على أن الإنسان قد لا يتمكن من الانفكاك عن الظن السيئ في بعض الأحيان، لا سيما في الوصف الذي ذكرناه، فعلاجُه أن ينزع عنه، وأن يتوب إلى الله منه، وأن يرجع إلى ما أخبر الله به عن نفسه من جميل الصفات وبديع الأوصاف وجميل الصنائع والأفعال، فإن ذلك مما يدفع عنه هـٰذا الظن السيئ.
قال رحمه الله: (ولو فتشتَ مَن فتشت لرأيتَ عنده تَعنُّتًا على القدر وملامةً له).
وهـٰذا أبسط ما يكون فيما يجريه الله من إعطاء الكافرين، أو فيما يفتحه الله على أهل الفسق والفجور، تجد أن النفس قد تُورد استفهاماتٍ واستنكاراتٍ لمثل هـٰذا، لكنّ جواب ذلك أن يعلم أن الله حكيم خبير.
قال رحمه الله: (وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا). وهـٰذا اقتراح على الله، وتقدُّم بين يديه، فالتقدمُ يكون في الأمر الشرعي ويكون في الأمر القدري، وقد نهانا الله عن التقدُّم بين يدي الله ورسوله في أمر الشرع كما أنه منهي عنه في أمر القدر.
قال رحمه الله: (فمستَقِلٌّ ومستكثِر).
الناس في هـٰذا: (فمستَقِلٌّ)، أي: عنده قليل من هـٰذا الظن السّيئ، (ومستكثِر) أي: يكثر من ظن السوء بربه.
يقول: (وفَتِّشْ نفسك هل أنت سالم؟). يعني لما قال: (ولو فتشت من فتشت) يعني: لا يَشْغَلْك هـٰذا عن أن تنظر إلى قلبك؛ لأن الناس قد يشتغِلُون بما عند غيرهم، ويرى القَذَى في عين أخيه، وينسى الجذع في عينه، ويغفل عمَّا في نفسه من الآفات اشتغالاً بإصلاح غيره، فنَبَّه إلى وجوب النظر إلى النفس (هل أنت سالم؟) هـٰذا سؤال نحتاج أن نجيب عنه، يحتاج أن يجيب كل واحد منا نفسه عليه، هل نحن سالمون من ظن السوء برب العالمين؟
(فإن تَنْجُ منها) أي: من هـٰذه الخَلَّة، وهـٰذه البلية، وهـٰذه المصيبة، وهي ظن السوء برب العالمين.
(فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة) يعني: تنجُ من آفة عظيمة كبيرة.
(وإلا فإني لا إخالك ناجيًا) يعني: وإلا فإني لا أظنك تنجو، وهـٰذا البيت لمن؟
قيل: إنه للفرزدق، ونُسِب إلى الأسود بن سريع -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وهو الأليق أن يكون للأسود بن سريع؛ لما فيه من المعاني العظيمة.
قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾. هـٰذا فيه الجزاء من جنس العمل.
وقوله تعالى: ﴿دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ يعني: هؤلاء قد أحاط بهم السَّوْء من كل مكان، جزاءً لما قام في قلوبهم من الظن السيئ برب العالمين، وهـٰذا معنى الدائرة، الدائرة هي: ما أحاط بك من كل جانب، فقوله: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ يعني: أحاط بهم السَّوْء وأَحْدَقَ من كل جانب، ومن أحاط به السَّوْء والشر من كل جانب هل له مَخْلَص؟ هل يستطيع انفكاكًا وخروجًا؟ الجواب: لا.
﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
وأنتَ تأمَّل في العقوبات والوعيد الوارد، هل ورد نظير هـٰذا في غير الظن؟ لتعلم أن الظن من أعظم الذنوب جرمًا، وأخطرها إثمًا عند رب العالمين.
فيه كلام لابن عقيل ذكره عندي في الحاشية هنا، قال ابن عقيل:
الواحدُ من العوام إذا رأى مراكبَ مُقَلَّدةً بالذهب والفضة، ودارًا مُشَيَّدةً مملوءةً بالخدم والزينة، قال: انظروا ما أعطاهم مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم مُعطِيهم حتى يقولوا: فلانٌ يصلي الجماعات والجُمَع ولا يؤذي الذَّرَّ، ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويُظْهِر الإعجاب كأنه ينطق: لو كانت الشرائع حقّاً لكان الأمر بخلاف ما نرى، وكان الصالح غنيّاً، والفاسق فقيرًا.
يعني: يذكر حال الفاسق، وحال الطائع: فلان كافر فاسق أعطاه الله، وفلان مثل ما قال: لا يؤذي حتى الذر، وصاحب طاعة واستقامة، ولم يعطَ شيئًا، كأنه ينطق: لو كانت الشرائع حقّاً، يعني: هو لم يقل هـٰذا، لكن لسان حاله كأنه يقول: لو كانت الشرائع حقّاً لكان الأمر بخلاف ما نرى، وكان الصالح غنيّاً، والفاسقُ فقيرًا.
لكن هـٰذا من سوء الظن برب العالمين، ومن الجهل بأقضية الله وأحكامه جل وعلا.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية آل عمران.
الثانية: تفسير آية الفتح.
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تُحصر.
[الشرح]
يعني: الإخبار بأن الظن السَّوْء أنواعٌ لا تُحصر.
[المتن]
الرابعة: أنه لا يَسْلَم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
[الشرح]
والله تعالى أعلم .
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثامن والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: ما جاء في مُنْكِري القدر
وقال ابن عمر: والذي نفسُ ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا، ثم أنفقه في سبيل الله ما قَبِلَه الله منه حتى يؤمن بالقدر.
ثم استدل بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره)). رواه مسلم.
وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعتُ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)). يا بني سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((من مات على غير هـٰذا فليس مني)).
وفي روايةٍ لأحمد: ((إن أول ما خلق الله –تعالى- القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة)).
وفي روايةٍ لابن وهب: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار)).
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيتُ أبي بن كعب، فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: ((لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مُتَّ على غير هـٰذا لكنتَ من أهل النار)). قال: فأتيتُ عبد الله بن مسعود، وحذيفةَ بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكلُّهم حدثني بمثل ذلك عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في منكري القدر.)
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن إنكار القدر من أعظم السيئات التي يَنتَقِضُ بها توحيد العبد.
قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن أنكر القدر، أو من كذَّب بالقدر نقض تكذيبُه توحيدَه.
وهـٰذا يدل على أن التوحيد من آكدِ ما يقرره ويدعو إليه الإيمانُ بالقدر، ولذلك قال جماعة من العلماء: إنه ما من آية في كتاب الله في تقرير التوحيد إلا وتدل على إثبات القدر، وعلى خلق الله -جل وعلا- لأفعال العباد. هـٰذه مناسبة إدخال هـٰذا الباب في كتاب التوحيد.
أما مناسبته للأبواب التي قبله: فإن الأبواب التي قبله فيها سوء الظن بالله عز وجل، والتعنت على القدر، والذم لحوادث الزمان، وما يُجريه الله من الرّياح وما أشبه ذلك، وكل هـٰذا من ضعف الإيمان بالقدر، فناسَبَ أن يأتي بأعظم ما يكون مما يتعلّق بالخلل بالقدر، وهو إنكارُه.
وقوله رحمه الله: (باب ما جاء في منكري القدر) يعني: من الوعيد، ومن النصوص الدالة على عِظَم ذلك، وسوء حال صاحبه، وذَكَر في هـٰذا الباب عدةَ أحاديث، وقبل أن نقرأ ما ذكر نريد أن نعرف ما هو القدر؟
القدر في اللغة: مأخوذٌ من التقدير، فيُطلق القدر ويراد به التقدير.
أما في الاصطلاح -يعني في القرآن والسنة- فالمراد بالقدر: حكم الله الكوني. هـٰذا أجمع ما قيل في بيان معنى القدر أنه حكم الله الكوني، وهـٰذا القدر الذي هو حكم الله الكوني له مراتب، بعض العلماء يعرف القدر بمراتبه فيقول: القدر هو علم الله -جل وعلا- بالحوادث والكائنات، وكتابتُه لها، ومشيئتُه إياها، وخلقُه لها، فيعرف القدر بالمراتب التي لا يثبت الإيمان بالقدر إلا بها.
ومن هـٰذا نعلم أن إنكار القدر يكون بإنكار شيء مما تضمنَّهُ تعريفُه:
فمَنْ أنكر خلقَ الله للوقائع والكائنات فإنه لم يؤمن بالقدر.
من قال: إن ما جرى من غير مشيئة الله، لم يؤمن بالقدر.
من قال: إن ما جرى وما يجري وما يقع من الحوادث ليس في علم الله ولا في كتابته، لم يؤمن بالقدر.
أشدُّ ما يكون من إنكار القدر هو: إنكار المراتب الأربع كلها: إنكار علم الله، إنكار كتابته، إنكار مشيئته، إنكار خلقه. وهـٰذا كان في أول الأمر عند ظهور هـٰذه البدعة، ثم إنه لما جرت المناقشة والمباحَثة مع مَن قال بهـٰذا القول تبيّن زيغُه وضلاله، واضمحلّ قوله، وذهب قائل هـٰذا القول، يعني: الذي يُنكر العلم والكتابة، فلم يبقَ من منكري القدر إلا من ينكر المرتبتين الأخيرتين: مرتبة المشيئة والخَلْق، وهو الذي عليه من يُسَمَّوْنَ بالقدرية، فإنهم سُمُّوا بذلك لما جرى منهم من الخلل فيما يتعلق بالخلق والمشيئة، فعندهم أنّ أفعال العباد ليست من خلق الله ولا من مشيئته؛ بل إن الله -جل وعلا- لم يخلق ذلك، هي خلق للناس كما يزعمون، وهـٰذا كَذِبٌ وتكذيبٌ لما دلت عليه نصوص القرآن، ولما دلّ عليه قول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- .
وممّا يدخل في إنكار القدر، وإن كان دخوله ليس كدخول من أنكر المراتب: أن يكون الإنسان معتقدًا أن القدر ليس لحكمة، إنما لمجرّد المشيئة، فإن هـٰذا قدح في الإيمان بالقدر؛ لأنّ من تمام الإيمان بالله أن تؤمن بأنه ما قَدَّر شيئًا، ولا يقدّر شيئًا -جل وعلا- إلا لحكمة، فإن هـٰذا من تمام الإيمان بالقدر.
ذكر المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب قول ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: (وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده)، يقسم بمَنْ؟ يقسم بالله؛ لأن الله -جل وعلا- بيده نفس كل أحد، وهـٰذا قَسَم باسم أو بوصف أو بفعل؟ بوصف، هـٰذا قَسَمٌ بوصف.
وقوله: (بيده). قيل: في ملكه وتصرفه، وهـٰذا يَتَّسِقُ مع قول الذين يقولون بأن معنى اليد الثابتة لله -عز وجل- القدرة، فيكون المعنى: والذي نفسُ ابن عمر في قدرته وملكه.
والصحيح: أن (بيده) وإن كانت تدل على تمام القدرة والمُلْك وتمام التصرف، لكن ليس من لازم هـٰذا تعطيلُ ما دلت عليه النصوص من أن الله -جل وعلا- له يَد كما دَلَّ على ذلك القرآن والسنة، فقوله: (بيده) لا يصلح أن يكون دليلاً لنفي هـٰذا الذي وصف الله به نفسه، بل نقول: (بيده) حقيقةً وهو دالٌّ على تمام القدرة والمُلْك؛ لأن ما كان في يد الإنسان فإنه دالٌّ على كمال قدرته وتصرفه.
ولو أن أحدًا فسر قوله :(والذي نفس ابن عمر بيده) بأنها: في ملكه وتحت قدرته، لم يكن تفسيره غلطًا إذا كان لا ينفي صفة اليد، لكن إن جعل ذلك دليلاً على تعطيل ما وصف الله به نفسه، فإنه قُصور في ما يجب في حق الله -عز وجل- من الصفات.
قال رحمه الله: (والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا).
الضمير في قوله: (لأحدهم) لمنكري القدر؛ لأن هـٰذا القول لم يصدر من ابن عمر ابتداءً، بل صَدَرَ جوابًا لما ذكره له يحيى بن يَعْمُر، وحميد بن عبد الرحمـٰن الطويل، حيث جاءَا إليه وشَكَوَا إليه ما عليه نُفاةُ القدر الذين يقولون: إن الأمر أُنُف، فقال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أخبرهم بأني منهم بريء، وأنهم مني برءاء (والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر). فكان قول ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قولاً في رد هـٰذه البدعة التي بلغته عن قومٍ في البصرة، حيث إن أول ما حدث إنكارُ القدر حصل في آخر زمان الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- بعد انقراض أكثرهم، وانتهاء الخلافة الراشدة، بل حتى انقضاء خلافة معاوية في الفترة التي كانت فيها الفتنة بين بني أمية وابن الزبير، ظهرت هـٰذه النابتة التي قالت بهـٰذا القول، وكان أول من قال بها مَعْبَد الجهني في البصرة.
وملخص ما يقولونه ويزعمونه: أن الأمر أُنُف، أي: مستأنَف، فإن الله لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا يعلم ما يقع، ومن ثَم فإنه لم يخلقه، ولم يشأه، ولم يكتبه.
لكن هـٰذا القول كما ذكرنا انقرض لما أنكره الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، وإنكارُه لم يقتصر على ابن عمر، بل أنكره كثير من الصحابة الذين بقُوا وأدركوا هـٰذه الفتنة، كابن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهما -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، وهـٰذا فيه أن من لم يؤمن بالقدر لا يصحُّ له إيمان، ولا يثبُت له في الإسلام قَدَمٌ؛ لأنه قال: (لو كان لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر). ومعلوم أنه لا يمتنع قبول النفقة والصدقة في سبيل الله لأجل شيء إنكاره لا ينقص الإيمان، ولا يُزيله من أصله، فدل ذلك على أن عدم الإيمان بالقدر من أسباب الكفر، وأنه لا يتم الإيمان ولا يَقَرُّ ولا يثبت لأحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
قال: (ثم استدل بقوله)؛ لأنه لما ذَكَر هـٰذا أخبرهم بحديث جبريل، فقال: حدثني أبي، وذكر ما جرى من قصة مجيء جبريل وسؤاله النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة.
قال: ((الإيمان: أن تؤمن بالله)) من قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره)).
وقوله رحمه الله: ((تؤمن بالقدر خيره وشره)) هـٰذا هو الشاهد، فدل ذلك على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، لا يثبُت الإيمان لأحد إلا بالإقرار به.
وقد دل على ذلك كتاب الله -عز وجل- في قوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾( ). فمن كَذَّب بهـٰذا فقد كَذَّب القرآن، ومن كَذَّب القرآن فهو كافر لا يثبت له وصفُ الإيمان.
قال -رحمه الله- بعد هـٰذا: (وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن تجد معنى الإيمان) وابنه هو: الوليد بن عبادة، وهـٰذا القول من عبادة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في آخر حياته، في حال احتضاره: (يا بُني! إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك).
(إنك لن تجد طعم الإيمان): نفى وجود طعم الإيمان، وهـٰذا فيه إثبات أن للإيمان طعمًا، والإيمان أيها الإخوة حقيقةٌ ترسخ في القلب ويتشربها القلب، من ثمرة الإيمان هـٰذا الطعم الذي ذكره عبادة بن الصامت -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وقد جاء نظيره في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)). فطعم الإيمان في هـٰذا الحديث هو حلاوة الإيمان التي في حديث أنس، وهي الحلاوة التي يجدها الإنسان من جرَّاء إيمانه، هل هي الإيمان نفسه؟
الجواب: لا، هي ثمرة الإيمان وعاقبته، ونتيجته، وجاء التعبير عنها بالذوق، وجاء التعبير عنها بالوَجْد.
أما الذوق: ففي مثل قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاً وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيّاً)). وأما الوجد فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)).
واختلف العلماء أيهما أبلغ: الذوق أو الوجد؟
الصوفية عندهم: الذوق أعلى من الوجد، والظاهر كما استظهر ابن القيم -رحمه الله- أن الذوق أعلى؛ لأن الذوق وجودٌ وزيادة، يعني: تحصيل للشيء وزيادة، وعلى كل حال لا مُشاحة في الأمر، الذوق والوجد كلاهما ثمرةٌ من ثمار الإيمان.
يقول رحمه الله: (لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك).
(ما أصابك) يعني: الذي وقع لك من أقدار الله -عز وجل-.
(لم يكن ليخطئك) أي: لم يكن ليتعَدَّاك إلى غيرك، أي: لم يكن ليزول عنك، وذلك أنه لا مانع لما أعطى، فما قدره الله كائن لا محالة.
ثم قال رحمه الله: (وما أخطأك) أي: ما لم يصبك، أو ما تجاوزك إلى غيرك، (لم يكن ليصيبك): لم يكن لينزل بك، ويقع عليك مهما كان، وهـٰذا يشمل ما يصيب الإنسان من الخير وما يصيبه مما يكره، ويشمل ما يخطئ الإنسان من الخير وما يخطئه مما يحب أن ينصرف عنه، فما أصاب الإنسان لا سبيل لإزالته مهما كان، واعتقاد مثل هـٰذا يقطع عن الإنسان الندم والتَّحسُّر على ما مضى؛ لأنه يعلم أنه لن يزول عنه ما كان قد قدره الله عليه مهما كان.
(أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعتُ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب)) ). هـٰذا فيه الخبر عن أن الله -جل وعلا- أمر القلم بالكتابة ساعةَ خلقه، هـٰذا الصحيح، وليس فيه الإخبار بأن أول المخلوقات القلم، هـٰذه هي الرواية المحفوظة الصحيحة التي عليها المحققون من أهل العلم.
فالحديث ليس مقصوده وغرضه بيان أول المخلوقات، إنما مقصودُه وغرضه أن الله -جل وعلا- أمر القلم بالكتابة ساعةَ خَلْقِه، يعني: مُذْ خَلَقَهُ من أول ساعة خَلْقِه.
((إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب)) أي: أمره بالكتابة.
((فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)). فالقلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، وهـٰذا فيه الدّليل على أي مرتبة من مراتب القدر؟
على مرتبتين:
على العلم، والكتابة؛ لأنه لا يمكن أن يكتب إلا ما عَلَّمه الله أن يكتبه، فهـٰذا دال على أن الأشياء قد قُدِّرَت وفُرغ منها قبل خَلْقِ الخَلْق، فإن الله أمر القلم بالكتابة من أول خَلْقِه، وهو دالٌّ على أن كل ما يكون مكتوب، وأن كل ما يكون من علم الله -عز وجل-.
وقد جاء التصريح بأن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلقها في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وفيه: ((أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السمٰوات والأرض بخمسين ألف سنة)). وهـٰذا يدل على تقدُّم كتابة الله -عز وجل- للخلق، وكذلك يدل عليه حديث عمران بن حصين: ((كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء)) والذِّكْرُ هو: اللوح المحفوظ، والأحاديث في هـٰذا كثيرة، الدالة على كتابة الله للأشياء قبل خلق السمٰوات والأرض.
وفي حديث عمران بعد أن ذكر قال: ((وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السمٰوات والأرض))، وفي رواية: ((وخلق السمٰوات والأرض)).
قال رحمه الله: (يا بُني! سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((من مات على غير هـٰذا فليس مني)) ). ((من مات على غير هـٰذا)) الاعتقاد. قال: ((فليس مني)). وهـٰذا فيه التبرؤ، تبرؤ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِمَّن مات على غير الإيمان بما تضمنه هـٰذا الحديث من أن الله كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، ولا ريب أن مَنْ أنكر الكتابة والعلم فإنه كافر، وهـٰذا عليه إجماع علماء الأمة، لم يختلف فيه أحد، ولذلك قال الشافعي -رحمه الله- في غُلاة القدرية: ناظروهم في العلم، أو ناقشوهم في العلم، فإن جحدوه كفروا؛ لأن دلالة القرآن والسنة على إثبات صفة العلم لا يمكن أن يماري فيها إلا مكابر، فهي من أعظم الصفات، بل هي أوسع الصفات تعلقًا؛ لأنها تتعلق بكل شيء، كما قال الله -عز وجل-: ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾( ). فعلمه قد وَسِعَ كل شيء، تعلق: بالممكنات، وبالواجبات، وبالممتنعات، وبالمستحيلات، وبالماضي، والمستقبل، والحاضر. فعلمه قد انتظم كل شيء -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولذلك هو من أوسع الصفات تعلقًا، فمن مات مُنكِرًا لهـٰذا فليس من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهـٰذا أقلُّ ما يدل عليه هـٰذا القول: ((فليس مني)). أقل ما يدل عليه في مثل هـٰذا السياق أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وإلا فإن النصوص قد دلت على أن من أنكر علم الله المتقدِّم فهو كافرٌ بالله العظيم.
قال رحمه الله: (وفي رواية أحمد: ((إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)).) هـٰذا فيه ما في الحديث السابق من أن الله -جل وعلا- أمر القلم بالكتابة ساعة خلقه، ولذلك قال: ((فجرى في تلك الساعة)). يعني: في تلك الساعة التي خلقه فيها ((بما هو كائن إلى يوم القيامة)). أي: بما قَدَّرَهُ الله من الوقائع إلى أن تقوم الساعة.
(وفي روايةٍ لابن وهب، قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار)).) وهـٰذا كله في بيان عظيم جُرْم مَنْ أنكر القدر.
وهنا يبحث العلماء مسألة لا نُطيل بذكرها، وهي: أَيُّهما أسبق في الخلق: العرش أو القلم؟
لأهل العلم في هـٰذا قولان، والصحيح: أن العرش أسبق المخلوقات؛ لحديث عمران بن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
قال رحمه الله: (وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي). ابن الديلمي: هو من كبار التابعين. (قال: أتيت أبي بن كعب). أبي بن كعب من كبار الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. (فقلت: في نفسي شيء من القدر) لم يبين ما الذي في نفسه وإنما أجمل، فقال: (فحدثني بشيء لعل الله يُذهبه من قلبي). (حدثني بشيء) يعني: مما علمك الله، إما من القرآن، أو مما بلغَك عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (لعل الله يذهبه من قلبي).
وهـٰذا من حكمة ابن الديلمي رحمه الله، حيث طلب علاج قلبه من علماء عصره، فذهب إلى أبيّ بن كعب وطلب منه علاج هـٰذا المرض الذي دَبَّ إلى قلبه، وهو الريب والشك في شيء من القدر.
فقال: ((لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قَبِله الله منك حتى تؤمن بالقدر)) هـٰذا يوافق ماذا؟ يوافق ما ذكره ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وهـٰذا يدل على تطابق فقه الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، فإما أن يكونوا قد تلقَّوْه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإما أن يكون نتيجة علم رسخ في قلوبهم، فاتفقت ألفاظهم في التعبير عنه.
قال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((لو أنفقت مثل أُحُد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هـٰذا لكنت من أهل النار)). وهـٰذا فيه خطورة الشك في أمر القدر، وأن من وقع في قلبه ريب ومات على هـٰذا الريب والشك في القدر، فإنه على خطر أن يكون من أهل النار، فيجب عليه أن يطلب علاج قلبه، وأن يُذهب عن نفسه هـٰذه الوساوس والشكوك التي يُلقيها الشيطان في قلبه فيما يتعلق بالقدر، وليعلم العبد أن القدر كما قال الإمام أحمد: القَدَرُ قُدْرَةُ اللهِ.
هكذا عرف الإمام أحمد القدر، وكما قال ابن عباس: القَدَرُ نِظامُ التوحيدِ، أي: إنه ينتظم التوحيد، فمن آمن بالقدر قَرَّ توحيده واستقام، ومن لم يؤمن به كما قال ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: نقض تكذيبُه توحيده، فينبغي للمؤمن أن يحذر.
قال: (فأتيت عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت). فصاروا كم الذين تكلموا بهـٰذه الكلمة؟ خمسة من صحابة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). فدل ذلك على أنهم تلقَّوْا هـٰذا المعنى من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو أن الإيمان بالقدر أصلٌ لا يثبت الإيمان لأحدٍ إلا به.
قال رحمه الله: (حديثٌ صحيح رواه الحاكم في صحيحه.) وهو كما قال.
السائل لابن عمر هو يحيى بن يَعمُر، هكذا قلنا، وحميد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِي، نعم الذي في صحيح مسلم حميد بن عبد الرحمن الحمْيَرِي، ووصفه بعض الشراح بأنه حُميد الطويل، وليس حُميداً الطويل، أحتاج تحقق الأخ من هـٰذا؛ لأن الذي في صحيح مسلم حميد بن عبد الرحمن الحميري، وأما بعض الشراح فذكروا أنه حميد الطويل.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر.
[الشرح]
صحيح، كل هـٰذه الأحاديث والآثار دالة على ذلك.
[المتن]
الثانية: بيان كيفية الإيمان به.
[الشرح]
وهي أن تؤمن بأن الله عَلِمَ ما يكون إلى قيام الساعة، وأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كتبه، وأن الله شاءه، ثم خلقه، هـٰذه المراتب الأربع التي يتم بها الإيمان بالقدر.
[المتن]
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به.
[الشرح]
لقوله: (لو أنفقت مثل أُحُد ذهبًا ما قَبِلَه الله منك حتى تؤمن بالقدر).
[المتن]
الرابعة: الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.
[الشرح]
حديث عبادة: (إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك).
[المتن]
الخامسة: ذِكْرُ أول ما خلق الله.
[الشرح]
وهـٰذا في حديث عبادة: ((إن أول ما خلق الله القلم)). ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هـٰذا على قولين:
منهم من قال: إنه القلم بناءً على الرواية: ((إن أول ما خلق الله القلم))، أو: ((إن القلم أول ما خلق الله)).
والقول الثاني: أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- خلق أولاً العرش ثم خلق القلم، ويدل لهـٰذا حديث عمران بن حصين في الصحيح، ففيه: ((كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذِّكر كل شيء)). فذَكَرَ الكتابة بعد ذِكْرِ العرش، فدلَّ ذلك على أن العرش متقدِّم.
[المتن]
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
[الشرح]
كما دلت عليه الروايات: ((إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب)).
[المتن]
السابعة: براءته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ممن لم يؤمن به.
[الشرح]
هـٰذا في ((من مات على غير هـٰذا فليس مني)).
[المتن]
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشُّبْهة بسؤال العلماء.
[الشرح]
خُذْها من قصة ابن الديلمي مع أبي بن كعب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
[المتن]
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يُزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقط.
[الشرح]
نعم، وفيه: أن خيرَ ما يجيب به المتكلِّمُ كلامُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي لا يَنطق عن الهوى، لا سيما إذا كان السائل يعقل الكلام ويفهمه كما هو الحال في قصة ابن الديلمي، لكن إن كان السائل لا يفهم هـٰذا، فإذا أجبته بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يفهم، فمن الحكمة أن تُبيِّن له ذلك وأن توضحه له.
ثم إن من فوائد قصة ابن الديلمي: جواز سؤال أكثر من عالم في مسألة واحدة، لكن لا بُدَّ لهـٰذا من تقييد، وهو فيما إذا كان الإنسان محتاجًا إلى السؤال؛ لأن ابن الديلمي لعله أراد أن يَتيقن، وأن يزداد رُسوخه فيما يتعلق بالقدر وإزالة ما في نفسه، فكرر السؤال على الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، على: عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت.
وفيه: أن السلف كانوا متفقِين فيما يتعلق بالأصول، فإنهم لم يختلفوا في ذلك، بل تطابقت أجوبتهم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- بنقل ما سمعوه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ذلك.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: ما جاء في المصورين
عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرةً، أو ليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً)). أخرجاه.
ولهما عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)).
ولهما عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((كل مصوِّر في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم)).
ولهما عنه مرفوعًا: ((مَن صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ)).
ولمسلم عن أبي الهيَّاج قال: قال لي عليٌّ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ ((ألا تدع صورةً إلا طمستها، ولا قبرًا مشرِفًا إلا سويته)).
[الشرح]
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
يقول المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في المصورين).
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد واضحة؛ لأن أول شرك وقع في الناس سببُه التصوير، فإن الذين عبدوا الصالحين في قوم نوحٍ سَوَّل لهم الشيطان أول الأمر أن يصوِّروا لهم صورًا، فقال: انصبوا إلى قبورهم وصَوِّرُوا لهم تصاويرَ، فصوّروها حتى يذكروا عبادتهم، انصبوا لهم أنصابًا، فكانت هـٰذه الأنصاب مبدأ ما جرى من الفتنة التي تطورت وامتدت بأهلها حتى وقعوا في الشرك بالله -عز وجل-.
يقول رحمه الله: (عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرةً، أو ليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً)).)
هـٰذا الحديث فيه عِظَمُ ذنب مَن صَوَّر صورةً يضاهي بها خلق الله جل وعلا، أي: إنه يتشبَّهُ بالله -عز وجل- في صفته التي اختص بها وهي الخلق، كما قال الله -عز وجل-: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾( )، أي: لا خالق إلا الله، فإن ﴿هَلْ﴾ الاستفهامية هنا تفيد النفي، أي: لا خالق إلا الله جل وعلا، فلا خالق غيرُه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فالذي يصوِّر مضاهاةً لخلق الله، أي: تشبهًا بالله -عز وجل- فيما اختص به واتصف فهـٰذا وعيده، أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال فيما يرويه عن الله -عز وجل-: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟)). أي: لا أَظْلَم، فإن ((من)) هنا مُشْرَبة بمعنى النفي، أي: لا أحد أظلمُ ممن ذهب يخلق كخلقي.
ثم ذكر: ((فليخلقوا ذرةً، أو ليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً)).
وهل هـٰذا يدل على تحريم تصوير الذرة والحبة والشعيرة؟
هكذا قال بعض العلماء، منهم مجاهد، وقال عياض: إنه لا يصح عنه، فالحديث يدل على تحريم تصوير الذرة، والحبة، والشعيرة.
لكن هـٰذا المعنى ليس مرادًا عند جمهور العلماء؛ لأن المنهي عنه من التصوير هو ما له رُوح، أما ما لا رُوح فيه، أو ما لا رُوح له، فإنه لم يُنقل إلا عن مجاهد، وفي النقل عنه نَظَرٌ أنه لا يجوز تصوير ما لا روح فيه.
فما معنى الحديث؟
معنى الحديث: أنه مَنْ ضاهى الله في خلقه وتشبَّه به في هـٰذه الصفة، فإنه يَلْحَقُه الإثمُ، سواءٌ صوَّر ما فيه الروح، أو ما لا روح فيه، فالمنهيُّ عنه هو: المضاهاة والمشابهة فيما اختَصَّ الله به، أما مَنْ صوَّر ذرةً أو حبةً أو شعيرةً أو شمسًا أو قمرًا أو شجرًا من غير إرادة المضاهاة، إنما صنعةً أو رغبةً، فإنه لا حرج عليه، ولا يدخل في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الإلهي: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرةً، أو ليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً)).
ويمكن أن يقال: إن الحديث الإلهي ليس فيه النهي عن خلق هـٰذه الأشياء، إنّما فيه التحدي، فالذي يريد أن يُصوِّر ما فيه الروح تحدَّاهُ الله بأن يخلق ما هو أهون وما هو أيسر في الإيجاد، وهو خلق الذرة والشعيرة والحبة؛ لأنها أهون مما له روح؛ لأن خَلْقَ ما له روح يحتاج إلى أمرين: خلق الصورة، وخلق الروح التي تحيا بها الصورة.
أما خلق ما لا روح فيه فليس فيه إلا عمل واحد وهو خلق الصورة فقط.
وقال بعض العلماء: إن قوله: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟)) أي: خلق خلقًا يُعبد معي، وتُصرف له العبادة؛ لأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، فمن صَوَّر ما يُصْرَف له حقُّ الله -جل وعلا- فهو أظلم ما يكون، لكنَّ الحديث ليس فيه دلالة على هـٰذا، بل هو أوسع من هـٰذا، وإن كان الذي يصوِّر الأصنام، ويصور الصور لِتعبد من دون الله من أعظم الناس جُرمًا، لكنه ليس مقصورًا عليه، فإن الحديث فيه بيانُ حكم من ضاهى الله في خلقه وتمثَّل به، أو ماثله في هـٰذه الصفة التي اختص بها -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-؛ لأن الله -جل وعلا- في تقرير التوحيد في مواضع كثيرة قرر التوحيد بنفي قدرة الخلق، أو قدرة المعبودين على الخلق، وأنه لا يخلق إلا هو جل وعلا.
قال رحمه الله: (ولهما عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهِئون بخلق الله)).)
((أشد الناس عذابًا يوم القيامة)). أي: أعظمهم، وأقصاهم عقوبةً يوم القيامة الذين يماثلون ويشابهون بخلق الله، وهـٰذا فيه ما في الحديث السابق.
وقوله: ((بخلق الله)) يشمل ما له روحٌ وما لا روحَ له؛ لأن الجميع خلقُ الله، فما له روحٌ خَلْقُ الله، وما ليس له روحٌ خلقُ الله، وهـٰذا يبيِّن لنا السبب في قوله تعالى في الحديث الإلهي: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟)) وأن الإنكار ليس لمجرد التصوير فقط، إنما هو للتصوير الذي تقع فيه مضاهاة خلق الله -عز وجل-، ومنازعة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ما اختص به من صفة الخلق.
وأخذ بعض العلماء من هـٰذا أن التصوير من أشد الأعمال جُرمًا، سواءٌ كان التصوير لما يُعبد من دون الله، أو التصوير لما لا يُعبد من دون الله؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة)). واستشكل جماعة من العلماء كيف يصفه بأنه أشد الناس عذابًا مع أن المشرك أشد منه عذابًا؟
فأجاب القرطبي وغيره: بأن أشد الناس عذابًا في هـٰذا الجنس من الذنوب، لا في مطلق ما يكون من المعاصي والسيئات، كما مَرَّ معنا في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾( ). وأن الأَظْلَمِيَّة باعتبار اسم الجنس، أي: في المانعين.
قال رحمه الله: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)).
ثم قال: (ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم)).)
وهـٰذا فيه بيانُ عظيمِ إثمِ التصوير، فإن كل مصور في النار، وهـٰذا فيه الخبر بأن المصورين في النار، وأن التصوير من كبائر الذنوب، وأن عقوبته أن يُجعل له بكل صورة صورها نفسٌ يُعذب بها في جهنم، وهـٰذا بيانُ مدة بقائه في جهنم، أو نوع عقوبته في جهنم، فإن (كل مصور في النار) هـٰذا الخبر عن أنه استحق النار، أما ما الذي يجري له في النار؟ فإنه (يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم). وهـٰذا يُبيِّن أن الممنوع من التصوير هو ما كان تصويرًا لذوات الأرواح؛ لأن ما لا روحَ له ليس له نفس، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يُجعل له بكل صورة صورها نفس). فما لا نفس فيه لا يستحقُّ صاحبه العقوبة بالنار؛ لأنه لم يصور ما له نفس، مع أن عموم قوله: (كل مصور) يشمل من صَوَّر ما له نفس وما ليس له نفس، ما له روح وما ليس له روح، لكن تتمةُ الحديث تبيِّن المقصود والمراد.
ثم قال: (ولهما) أي: للبخاري ومسلم (عنه) عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من صور صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الروح، وليس بنافخ)).
((من صور صورة))، وهـٰذا يشمل كل صورة؛ لأن ((صورة)) نكرة في سياق الشرط فتَعُمُّ، لكن تتمة الحديث يأتي من قِبَلها التقييدُ.
((كُلِّف أن يَنْفخ فيها الروح)) أي: يكلفه الله -عز وجل- أن ينفخ فيها الروح تعذيبًا له، وإرغامًا له، وبيانًا لعجزه وعدم قدرته، وأنه وإن وافق خلق الله في الصورة، فإنه عاجز عن تمام الموافقة؛ لأن الروح من أمر الله -عز وجل-، لا تكون إلا بأمره، فليس للناس إليها سبيل، وليس لهم عليها قدرة.
((كُلِّف أن ينفخ فيها الروح)) يعني: التي يحصل لها بها الحياة.
((وليس بنافخ)). أي: هـٰذا التكليف تكليف عقوبة، وليس تكليفاً يُرجى منه الامتثال والطاعة.
وفيه: أن أهل النار يُكلَّفون، وأنهم يكلَّفون ما لا يطيقون جزاءَ جرمهم وما كان منهم من مخالفة في الدنيا.
قال رحمه الله: (ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي). أي: ابن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟). وهـٰذا فيه عَرْضُ عليٍّ على أبي الهياج أن يُرْسله على شيء أرسله به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا شك أن هـٰذا فيه الإغراء بالقبول؛ ليوافق مقصِد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فبَيَّن له: ((ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سويته)).
((ألا تدع صورة)) وهـٰذا يشمل الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل؛ لأن قوله: ((لا تدع صورة))، ((صورة)): نكرة في سياق النهي، أو النفي؟ النهي. ((ألا تدع صورة إلا طمستها)) يعني: إلا أزلت معالمها، والطمس هو: إزالة ما تصير به الصورة صورةً، والصورةُ الرأس كما قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث أبي هريرة عند النسائي: ((إنما الصورة الرأس)). ولذلك أمر بالتمثال أن يُقطع رأسُه فيكون كالشجرة، فجعل ذلك سبيلاً لإزالة الصورة، وأما إذا كانت غير مجسمة، إذا كانت مما لا ظل له من الصور، فإن طمسها بتمزيقها وإزالة الصورة عنها.
قال رحمه الله: ((ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته)).
((ولا قبرًا مشرفًا)) أي: ولا قبرًا مرتفعًا متميزًا، والتميز يكون إما بأن يكون مرتفعًا عن سائر القبور، وهـٰذا إشراف حسي أو معنوي؟ إشراف حسي؛ لأنه ارتفاعٌ ظاهر، ويشمل كذلك ما مُيِّزَ من القبور ولو بغير رفع، كأن يميز بالتَّجْصِيص مثلاً؛ بأن يوضع عليه الجِصُّ، أو بأن يوضع عليه حجارةٌ خاصة تميزُه عن غيره، لا لقصد الإعلام إنما لقصد التمييز، فإن هـٰذا مما يدخل في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته)).
والتسوية هنا إما بأن يُزال الارتفاع فيما إذا كان الإشراف حسيّاً، وإما أن يكون بإزالة التَّمَيُّز الذي حصل به الإشراف إن كان معنويّاً، بأن تزال الحجارة أو يزال الجص أو ما أشبه ذلك مما مُيِّز به القبر.
وهـٰذا الحديث آخر ما ذكره المؤلف -رحمه الله- في هـٰذا الباب الذي ذكر فيه الأحاديث الدالة على تحريم التصوير وما جاء في شأن المصورين.
ومُلَخَّص ما في هـٰذه الأحاديث: أن التصوير من كبائر الذنوب، ومن عظائم الآثام؛ لعدة علل، منها:
أنه مضاهاةٌ لخلق الله -عز وجل-، مشابهة ومماثلة لما يختص الله به من الخلق، وهـٰذا مأخوذ من حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وفيه قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قال الله تعالى: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟)).
((من أظلم)) لا أظلم ((ممن ذهب يخلق كخلقي)).
فوجه الظلم هنا هو: التشبه بالله -عز وجل-، ومماثلته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فيما اختص به من الخلق، يشهد لهـٰذه العلة قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث عائشة: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)). والمضاهاة هي: المشابهة والمضارعة والمشاكلة والمماثلة، فهؤلاء أيضًا مُتَهدَّدون لهـٰذه العلة؛ يعني: هـٰذا الوعيد لأجل هـٰذه العلة وهي مضاهاة خلق الله.
هـٰذا ما ظهر من العلل فيما ذكره المؤلف رحمه الله، ومما دلت عليه النصوص الأخرى من العلل، وقد عَلَّلَ به العلماء تحريمَ التصوير أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه يُفضي إلى تعظيم المصوَّر، ولا شك أن هـٰذا ظاهر فيما إذا كان المصوَّر أهلاً للتعظيم، أي:أهلاً لشيء من التقدير والاحترام، كأن يكون صاحب عبادة أو صاحب علم أو صاحب طاعة، كما جرى من قوم نوح -عليه السلام-، حيث صَوَّرُوا تصاوير الصالحين فيهم، فكان عاقبةُ أمرهم أن عبدوهم من دون الله، وهـٰذه العلة لم يرد لها نصٌّ فيما ذكر المؤلف -رحمه الله- من الأحاديث إلا في حديث أبي الهياج، فإن قرنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين الصور والقبور دالٌّ على العلة، وهي ألا يُغلا فيها وتكون سببًا للوقوع في الشرك، كما أن الغلو في القبور سبب للوقوع في الشرك فكذلك الغلو في الصور، فهـٰذه ثاني علة من العلل التي علل بها العلماء تحريم التصوير.
كذلك: منع دخول الملائكة، وهـٰذا مأخوذٌ من قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة)). والحديث في الصحيح، فإنه يدل على تحريم التصوير؛ لأن اقتناءه سبب لمنع دخول الملائكة، وما كان سببًا لمنع دخول الملائكة فإنه دالٌّ على التحريم.
يُشكِل على هـٰذا أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنبٌ، والجنابة ليست محرمة؟ لكن الجواب على هـٰذا الإشكال أن يقال: إن التحريم في الجنابة لا في حصولها، إنما في استدامتها وإبقائها، فإن استدامة الجنابة لا شك أنها محرمة؛ لأنها سبب لتفويت الواجبات ومقارنة الشياطين، ولذلك شُرِع لمن أَجْنَب ألا ينام إلا على طهارة، واختلف العلماء في حكم الطهارة لمن أراد النوم، هل هي واجبة أو مستحبة؟
الجمهور على أنها مستحبة، وذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة؛ لحديث عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.
المراد أن الحديث يدل على تحريم التصوير؛ لأنه سبب لمنع دخول الملائكة، ولا شك أن امتناع دخول الملائكة لا يكون إلا لمحرَّمٍ، هـٰذا ثالث ما عُلِّل به تحريم التصوير.
يبقى مسألة: ما هو التصوير المحرم؟
ظاهرُ كثيرٍ من هـٰذه الأحاديث الإطلاقُ في تحريم التصوير، ويشمل هـٰذا تصويرَ كل شيء من خلق الله -عز وجل-، سواءٌ كان مما له روح أو مما لا روح له، وسواءٌ كان مما له ظل أو مما لا ظل له، وسواءٌ كان مما يُمْتَهن أو مما لا يُمتَهن؛ لأن الأحاديث مطلقة.
فالحديث الأول، حديث أبي هريرة: ((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟)). فالعلة هي: المضاهاة. ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرةً)) هـٰذا الحديث يدل على أي شيء؟
يدل على أن التصوير محرمٌ مطلقًا؛ لأن العلة في التحريم هي ماذا يا إخواني؟ هي المضاهاة، والمضاهاة واقعة في تصوير ما له روح وما لا روح له، ولذلك قال: ((فليخلقوا ذرةً، أوليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً)). فدلَّ هـٰذا على أي شيء؟ على عموم التحريم في التصوير لما له روح، ولما لا روح له.
كذلك قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)).
كذلك حديث ابن عباس: ((كل مصور في النار)) وهـٰذا يشمل كل صورة، إلا أن هـٰذا الحديث فيه ما يُشير إلى أن الوعيد المذكور في حق من صور صورةً لها نفس، ولذلك قال: ((يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم)) فهـٰذا فيه تقييد لما جاء إطلاقه في الأحاديث السابقة، وهو أن التحذير والوعيد الوارد هو في حق من صوَّر صورة لها نفس؛ لقوله: ((يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم)).
وينضم إلى هـٰذا أيضًا قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من صور صورة في الدنيا كُلِّفَ أن يَنفخ فيها الروح، وليس بنافخ)).
وهـٰذا فيه إخراجٌ لِمَا لا روح له من التصاوير؛ لأن ما لا روح له لا يُكلَّف فيه بنفخ الروح.
وأما حديث: ((ألا تدع صورة إلا طمستها)) فهـٰذا يشمل كل صورة، كالإطلاق الذي في الحديثين الأولين.
فمن مجموع الأحاديث نستخلِص أن: ما لا روح له لا تحريم في تصويره، ومن هـٰذا نفهم أن الإطلاق في الأحاديث فيه تقييدٌ، وليس باقيًا على إطلاقه، بل دلت النصوص على إخراج ما لا روح له من التحريم الذي في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)). والذي قبله في الحديث الإلهي: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟)).
بقي أنَّ ما له روح ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما له ظِلٌّ، الصور التي لها ظل وهي المجسَّمة، وضابِطُها: هي التي تتميّز فيها أجزاء المُصَوَّر، الصور التي تتميز فيها أجزاءُ المُصَوَّر، فيُمْسِك الإنسان ويَجُسُّ بيده أجزاءَ المصوَّر من: الوجه والأنف والعين وسائر الأعضاء.
القسم الثاني من الصور: ما لا ظل له.
القسم الأول: أجمع أهل العلم على أنه محرَّم، وأنه لا يجوز؛ لأنّ الأحاديث منطبِقة على فاعل هـٰذه الصّور، فمُصَوِّرُها ذهب يخلق كخلق الله، ومصوّرها ضاهى خلقَ الله، ولا خلاف بين أهل العلم المعتَبَرين في تحريم هـٰذا النوع من الصور.
والقسم الثاني: وهو ما لا ظل له، اختلف العلماء فيه على قولين:
جمهور الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من علماء الأمة على أنه محرم؛ للعموم في الأحاديث، ولدخولها في قوله: ((يُجعل له بكل صورة صورها نفس يُعذّب بها في جهنم)). ولم يقل: ما كان مجسَّمًا، بل الأحاديث مطلقة، فما لا ظل له من الصور داخلٌ في عموم هـٰذه الأحاديث، وهـٰذا قول الجمهور من أهل العلم.
وذهب جماعة من السلف إلى أن ما لا ظل له من الصور ليس داخلاً في التحريم، واستشهدوا لذلك ببعض الأحاديث، كقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إلا رَقْمًا في ثوب)) لما ذَكَر الصور وتحريمها. فهـٰذا الاستثناء يخرِج ما كان مَرْقُومًا منها على الثياب وما أشبه ذلك مما لا ظل له.
ولكن هـٰذا الذي دَلَّتْ عليه هـٰذه الرواية مَقضِيٌّ عليه بما في الصحيح من حديث عائشة أنها سَتَرَتْ سَهوةً لها بقِرامٍ فيه تصاوير، فجاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأمر بإزالته، وقال لها ما جاء في هـٰذا الباب من قول المؤلف -رحمه الله- : (ولهما عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله))) فهـٰذا الحديث سبب قوله صورة لا ظل لها، فدل ذلك على أن قوله: ((إلا رَقْمًا في ثوب)) ليس هـٰذا مقصود النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يعني: ليس مقصوده استثناء ما كان مُصَوَّرًا مما لا ظل له.
بقي: هل كل صورة محرمة؟ أم الصورة التي تحصل بها المضاهاة؟
أما القسم السابق فكله محرَّم؛ لأنه لا يمكن أن يقع هـٰذا الفعل إلا على وجه المضاهاة. أما الصورة التي لا مضاهاة فيها بخلق الله، وهي ما كان من الصور مأخوذًا من خلق الله لا مضاهِئًا له، يعني: ما كان تصويرًا لخلق الله، لا مضاهاةً لخلقه، لا مماثلة له في الخلق، كالصور التي تكون في المرآة، فالصورة التي في المرآة هل هي مضاهاة لخلق الله أم هي صورة ما خلقه الله؟ هي صورة ما خلقه الله وليست مضاهاة، فلذلك صانع المرآة لا يُعَدُّ مُصَوِّرًا؛ لأن ما معه ليس مضاهاةً لخلق الله، إنما هو إظهار لخلق الله.
ومن هـٰذا نَلِجُ إلى ما يسمى بالصور الفوتوغرافية، هل الصور الفوتوغرافية مما يدخل في هـٰذه الأحاديث؟
العلماء المتأخرون لهم فيها قولان:
منهم من ذهب إلى أن الصور الفوتوغرافية داخلةٌ في النهي.
ومنهم من قال: إنها لا تدخل في أحاديث وعيد التصوير؛ لأنها ليست تصويرًا ولا مضاهاةً لخلق الله، فليس فيها ما ورد من العلل التي من أجلها حَرُمَ التصوير، وهـٰذا اختيار شيخنا محمد رحمه الله.
لكن لا يعني هـٰذا إباحة التصوير، فَرْقٌ بين أن يقول الإنسان: إن التصوير الفوتوغرافي ليس مما يدخل في النصوص، وبين أن يقول: يجوز اقتناءُ الصور وتصويرُ الصور؛ لأن مأخذ شيخنا -رحمه الله- في تحريم التصوير أنه سبب لاقتنائه، واقتناؤُه محرَّم؛ لأنه يمنع من دخول الملائكة، لا أنه مضاهاةٌ لخلق الله، وهـٰذا القول قول شيخنا -رحمه الله- قوي جدّاً لمن تأمله، فإن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه ما جاء في هـٰذه الأحاديث، وإن كان مطابِقًا لعموم الأحاديث في أنه صورة، لكن هـٰذه المطابقة لا تكفي في إلحاق التصوير الفوتوغرافي بما ورد فيه النصُّ؛ لأن المعنى ليس موجودًا، ولأن الصورة التي تُظْهِرُها التصاوير الفوتوغرافية التي لا عَمَلَ فيها للمصور، يعني: لا يعمل فيها رسمًا للعين، ولا رسمًا للفم، ولا رسمًا للأنف، إنما يَضْغط على جهاز وتخرج هـٰذه الصورة، أشبه ما يكون بالمرآة التي تظهر فيها صورة الإنسان كما هي، كما خلقه الله، وتختلف الجودة -جودة إظهار الصورة- باختلاف جودة صَقْلِ المرآة وصناعتها، فالصحيح أن التصوير الفوتوغرافي ليس من هـٰذا.
يبقى: هل يجوز اقتناء التصوير الفوتوغرافي؟
هـٰذا أيضًا فيه خلاف بين العلماء:
منهم من يرى التحريم، وهو رأي شيخنا رحمه الله؛ لأنه يمنع دخول الملائكة، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة يَصْدُق عليه كل صورة.
والقول الثاني: أنه يجوز اقتناءُ التصوير الفوتوغرافي؛ لأن البيت الذي لا تدخله الملائكة من الصور هو ما كان محرَّمًا منها، وليس كل صورة.
ولكن الأحوط والأَوْرَع أن لا يقتني الإنسان هـٰذه الصور؛ لأن مَنْعَ الملائكة من الدخول ليس أمرًا سهلاً، فالملائكة دخولهُم دالٌّ على الخير والرحمة والبركة، ولذلك اختصت ليلة القدر وهي أشرف الليالي بأي شيء؟ بكثرة نزول الملائكة، قال الله -عز وجل-: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾( ). فدل ذلك على أن التَّنَزُّل وكثرتَه دليلٌ على خَيْرِيَّة الوقت وفضيلته، فدخول الملائكة للبيوت من أسباب الرحمة والخير والبركة فيها، فالورعُ ألا يقتنيها الإنسان، لا سيما ما كان مقصوده الاقتناء، أما ما كان الاقتناءُ ليس مقصودًا منه -كالصور التي تكون في الكتب، أو في المجلات، وليست مقصودةً لذاتها، الإنسان لم يشترِ المجلة لأجل ما فيها من الصور، لم يقتنِ الجريدة لأجل ما فيها من الصور، لم يقتنِ الكتاب لأجل ما فيه من الصور- فهـٰذا لا بأس به.
أما إن كانت الصورة مقصودةً فحكمُها حكم الصور الأخرى، سواءٌ كانت في كتاب أو في مجلة أو في غيرها.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.
[الشرح]
وهـٰذا واضح من الأحاديث الكثيرة التي ذُكر فيها الوعيد الشديد في حق من صَوَّر.
[المتن]
الثانية: التنبيه على العلة، وهي تَرْكُ الأدب مع الله؛ لقوله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟)).
[الشرح]
وهـٰذا أيضًا واضح، وهـٰذه العلة إحدى العلل التي ذُكِرت في تحريم التصوير.
[المتن]
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: ((فليخلقوا ذرةً أو شعيرةً)).
[الشرح]
نعم، فإذا عَجَزوا عن ذلك فعجزُهم عن خَلْق ما فيه الروح من باب أولى.
[المتن]
الرابعة: التصريح بأنهم أشدُّ الناس عذابًا.
[الشرح]
لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهِئُون بخلق الله))، وفي رواية: ((المصورون)).
[المتن]
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذِّب بها المصور في جهنم.
[الشرح]
وهـٰذا الحديث فيه دلالة على أن المصوِّر يتكرر تعذيبُه بكل صورة صورها؛ لقوله: ((يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذَّب بها في جهنم)) فهـٰذا يدل على تجدُّدِ العذاب وكثرتِه بكثرة ما يحصل من التصوير.
[المتن]
السادسة: أنه يُكلَّف أن يَنفخ فيها الروح.
[الشرح]
وهـٰذا التكليف تعذيب، وليس غرضُه ومقصوده امتثالَ المكلَّف، إنما غرضه ومقصوده تعذيبه، وفي قوله: ((وليس بنافخ)) دليلٌ على طول تعذيب هـٰذا؛ لأنه يُكلَّف ويحاول أن يكون منه هـٰذا، لكنه لا يصل إلى نتيجة.
[المتن]
السابعة: الأمر بطمسها إذا وُجِدَت.
[الشرح]
والطمسُ يَصْدُق بإزالة معالم الصورة، وعلى هـٰذا: الظل، هل هو صورة؟
الجواب: ليس بصورة، فلو أن الإنسان رسم ظلاً، هل يكون قد رسم صورةً سواءً بيده أو بغير يده؟
الجواب:لا، لا يكون صورةً؛ لأن الصورة ما كان مطابِقًا للمصَوَّر، واضحةً فيه المعالم، أما الصورة التي هي ظل فإنها ليست بصورة، فالطَّمْسُ: إزالة ما تكون الصورة به، فإذا كانت تمثالاً إزالة الرأس، وإذا كانت مما لا ظل له فبتَمْزِيقِها، وإزالة معالم الصورة منها.
أما بالنسبة للأَلْبِسة التي فيها صور: فهي داخلة في عموم النهي، أما إذا كانت مرسومة باليد فهي داخلة في هـٰذه الأحاديث، والمستثنى هو ما كان يُوطأ من التصاوير.
أما ما كان يُلْبَس في العمامة أو في الثوب، أو حتى في اللباس الداخلي فلا يجوز لُبْسُه، يجب إزالة الصورة منه.
وأما لعب الأطفال: فالأطفال يُتساهل في حقهم ما لا يُتساهل في حق الكبار، ولذلك رخَّص العلماء في البنات المجسَّمة للصغار فلا بأس باقتنائها، وإن كان الإمام مالك -رحمه الله- يرى الأحسن ألا يأتي بها الإنسان لابنته، لكنْ كَوْنُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقَرَّ عائشة دليلٌ على أن الأمر فيه سَعة.
ومن القواعد أنه يُرخص في حق الصغار ما لا يُرخص في حق الكبار.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس التاسع والعشرون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في كثرة الحَلِف
وقول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾( ).
عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب)). أخرجاه.
وعن سلمان أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيِّهم ولهم عذاب أليم: أُشَيْمِطٌ زانٍ، وعائِلٌ مستكبِر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه)). رواه الطبراني بسند صحيح.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خير أمتي قَرْني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) قال عِمران: فلا أدري أَذَكَرَ بعد قرنه مرتين أو ثلاثًا؟ ((ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يُؤتمنون، ويَنْذُرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السِّمَن)).
وفيه عن ابن مسعود أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((خير الناس قَرْنِي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قومٌ تَسبق شهادةُ أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادتَه)).
وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
[الشرح]
يقول رحمه الله: (باب ما جاء في كثرة الحَلِف).
مناسبة هـٰذا الباب لكتاب التوحيد: أن كثرة الحلف دليلٌ على ضَعْفِ تعظيم الله -عز وجل- في قلب العبد؛ لأنه لو عَظَّم الله ما جعل الحلف على لسانه عند أدنى قول أو مُوجِب.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فما ظهر لي في ذلك شيء.
قال –رحمه الله–: (وقول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾( )) هـٰذه الآية أمر الله –جل وعلا– فيها بحفظ اليمين، وحفظ اليمين يكون بأمور:
يكون أولاً: بأن لا يبذلها إلا عند الحاجة إلى ذلك، ثم إذا حلف فمن حفظ يمينه أن لا يحلف إلا بالله؛ لأن الحلف بغيره محرم، ثم إذا حلف فالواجب عليه أن يحلف صادقًا بارّاً بيمينه، فلا يحلف في كذب أو ظلم أو جور، ثم إذا خالف يمينه- حنث- فحفظها بأن لا يتركها من غير تكفير، بل يكفر إذا كان قد حنث في يمينه.
هـٰذه بعض الأمور التي يحصل بها حفظ اليمين، والمقصود بحفظ اليمين في هـٰذا الباب، أو الشاهد في هـٰذه الآية لهـٰذا الباب أن من حفظ اليمين عدم الإكثار، ألا يكثر الإنسان الحلف من غير موجب.
قال رحمه الله: (عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((الحلف منفقة للسلعة)).) ((الحلف)) اليمين التي يحلف بها الإنسان.
((منفقة للسلعة)) أي: سبب لنَفَاق السلعة، والنفاق: هو الرواج والذهاب، فمن أسباب ذهاب السلع ورواجها عند الباعة أن يحلفوا عليها، لكن هـٰذا النَّفَاق لا يحصّل به الإنسان خير الدنيا، ولا خير الآخرة، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ممحقة للكسب)) تذهب السلعة، وما ينتج من كسب فإنه ممحوق زائل البركة لا يجني الإنسان منه نفعاً، بل شرّه باقٍ وخيره ذاهب.
شره: إثمه في الآخرة، وإفساده لكسبه في هـٰذه الدنيا، وهـٰذا معنى قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-: ((ممحقة للكسب)).
ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحفظ يمينه، وألا يجعلها سبباً لنفاق السلع بالكذب والتزوير، بل يجب عليه أن يصدق، وألا يحلف إلا إذا اقتضى ذلك مقتضٍ يدعو إليه.
قال رحمه الله: (أخرجاه) أي: البخاري ومسلم.
الشاهد من هـٰذا: حفظ اليمين، بألا يجعلها قريبة عند البيع والشراء، بل لا يبذلها إلا في مظانها.
قال: (عن سلمان أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)).)
ثلاثة، وهـٰذا ليس حصرًا، إنما هو بيان لمن تضمنهم الحديث، وإلا فقد ورد نظير هـٰذا الوعيد لغير من ذُكِر، ومن هـٰذا نفهم أن العدد في مثل هـٰذا السياق لا مفهوم له، يعني: لا يفيد الحصر، حصر الحكم في هؤلاء الثلاثة، ونفيه عن غيرهم، بل قد يزيد في أحاديث أخرى من يستحق ما جاء في هـٰذا الحديث من الوعيد.
((ثلاثة لا يكلمهم الله)) أي: إن الله –جل وعلا– يعذبهم يوم القيامة بنفي تكليمهم ، ونفي تكليم الرب –جل وعلا– دليل على سخطه، وأن الفعل الذي رُتِّب عليه نفي التكذيب من المحرمات؛ لأنه وعيد في الآخرة، وهو من كبائر الذنوب.
((لا يكلمهم الله)) والكلام المنفي هنا هو كلام الرحمة والبر والإحسان، ولا يعني أن لا يكلمهم الله بالكلية، فإنه ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان حتى الكفار، لكنَّ تكليم الله لهم تكليم تقريع وتوبيخ، وبيان نعمته عليهم، وجحودها لهم، فهو كلام تعذيب.
((ولا يزكيهم)) أي: لا يحصل الزكاء.
والزكاء: هو الزيادة في الخير، وذلك في الدنيا والآخرة، فلا يحصل لهم زكاءٌ في الدنيا، وإذا انتفى عنهم الزكاء في الدنيا انتفى عنهم الزكاء في الآخرة.
((ولهم عذاب أليم)) أي: يستحقون عذاباً أليمًا، أليم: فعيل بمعنى مُفْعِل، أي: مؤلم.
ثم قال في بيان هؤلاء: ((أُشَيمِط زان)).
أُشَيمِط: تصغير أشمط، وهو من الشَّمْط، والشمط هو اختلاط الشعر بالشيب، والمقصود: أي صاحب كبرٍ في السن وقع في الزنى، هـٰذا معنى قوله: أُشَيمِط زان، ولذلك في بعض الروايات: ((كبيرٌ شيخٌ زانٍ))؛ لأن داعي الزنى من هـٰذا ضعيف، بخلاف الشاب فإن داعي الزنى في حقه أقوى من غيره، ولذلك رتب هـٰذه العقوبة على زنى الشيخ الكبير؛ لكون الداعي إلى المعصية ضعيفاً، فوقوعه في المحرم دليل على فساده، وتأصل الشر فيه.
قال رحمه الله: ((وعائل مستكبر)).
((عائل)) أي: ذو عيال أو فقير، إما ذو عيال، يعني: صاحب عائلة، أو أنه فقير، ولو لم يكن له عائلة.
((مستكبر)) ولم يقل: متكبِّر؛ لأن العائل ليس من أهل الكبر، فقوله: ((مستكبر)) أي: طالب للكبر، وذلك أن الأصل في الفقير الذي ليس معه ما يسد حاجته وعائلته أن تضعفه المسكنة، ولذلك سُمِّيَ الذي لا يجد حاجته وكفايته مسكينًا؛ لأن الحاجة تسكنه، وتذهب ما في نفسه من العلو والارتفاع، فإذا كان العائل على هـٰذه الصفة دل ذلك على فساده، وأن الكِبر خصلة مُتَكَلَّفة تنافي ما ينبغي على الإنسان أن يكون عليه في كل حال، فكيف إذا كانت الحاجة قد أعوزته، ويده قد قلَّ فيها ما يحصل به الغنى، فالذل في هـٰذا أولى وأحرى.
قال رحمه الله: ((ورجل)) هـٰذا الشاهد من الحديث ((ورجل جعل الله بضاعته)).
((جعل الله بضاعته)) يعني: جعل الله –جل وعلا– محل بيعه وشرائه؛ لأنه اشترى الذي هو أدنى بالذي هو خير، أخذ الذي هو أدنى، وهو الكسب، والثمن القريب الذي يحصله في الدنيا بالذي هو خير وهو الآخرة، وما فيها من النعيم، حيث دلس وكذب، فجعل الله بضاعته، أي: إنه باع الله –تعالى الله عن فعله- باع الله من أجل تحصيل ما يظن أنه كسب وربح في الدنيا، هـٰذا معنى قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ورجل جعل الله بضاعته)). أي يحلف عند البيع والشراء؛ ليؤكد ما معه في بيعه وشرائه وهو كاذب.
قال: ((لا يشتري)) هـٰذا بيانه، قال: ((لا يشتري إلا بِيَمينه ولا يبيع إلا بيمينه)).
أي: لا يشتري إلا حالفًا، ولا يبيع إلا حالفًا، وهـٰذا دليل على ضعف تعظيم الله في قلبه، ولو أنه قدر الله حق قدره لَصَان يمينه، ولم يجعل الله –جل وعلا– بضاعته.
قال رحمه الله: (رواه الطبراني بسند صحيح.) وقد ذكر الهيثمي أن رجاله ثقات.
قال رحمه الله: (في الصحيح عن عمران بن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((خير أمتي قرني)).)
((خير أمتي)) أي: أفضلهم، فـ ((خير)) بمعنى: أخير، يعني: أعظمهم خيرًا، وأكثرهم خيرًا القرن الذي بعث فيه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
هـٰذا معنى قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خير أمتي قرني)) والقرن اختلف العلماء في تحديده على أقوال كثيرة:
أقلها عشر سنوات، وأكثرها مائة سنة، والراجح أن القرن: مئة سنة، هـٰذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
((خير أمتي قرني)) يعني: الذين صحبتهم، والتقوا بي.
((ثم الذين يلونهم)) وهم التابعون، يعني: الذين ولوا الصحابة وهم التابعون.
((ثم الذين يلونهم)) أي: أتباع التابعين، هؤلاء هم خير قرون الأمة، وأفضلها؛ لأنهم أهل الخير والفضل، وأهل السبق والدين والاستقامة، فالخير فيهم أكثر ممن بعدهم.
قال عمران: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثًا). لكن جاءت الروايات في حديث ابن مسعود وغيره بذكر قرون ثلاثة بعد قرنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
((ثم إن بعدكم)) وهـٰذا الشاهد من الحديث. أي: بعد هـٰذه القرون المفضلة.
((قوماً يشهدون ولا يُستَشهَدون)) أي: تكون منهم الشهادة دون طلب.
وقيل في معنى ((يشهدون ولا يُستَشهَدون)) أي: إنهم يشهدون شهادة الزور، هـٰذا المعنى الثاني.
وقيل في معنى ((يشهدون ولا يستشهدون)): إنهم يتحملون الشهادة دون أن يطلب منهم تحملها، وهـٰذا قول ثالث، يكفي هـٰذه الأقوال الثلاثة أبرز ما قيل في معنى ((يشهدون ولا يستشهدون)) والصحيح أنه ينطبق على هـٰذه كلها، لكن في المعنى الأول: وهو أنهم يبذلون الشهادة دون أن تطلب منهم يشكل عليه حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى. قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها)). كما في صحيح مسلم.
فما الجمع بين الحديثين ؟ الجمع بين الحديثين أن المشهود له لا يخلو من إحدى حالين:
الحال الأولى: أن يعلم بشهادتك، يعلم بأنك شهدت الحق الذي له، أو ما يؤيد دعواه، فهنا لا تبذل الشهادة حتى تطلب منك.
الحال الثانية: ألا يعلم أنك قد شهدت له، أنك تشهد على حقه، بمعنى: أنك حضرت المجلس، أو حصل لك ما تقوم به الشهادة، ولكن لا يعلم شهادتك، فهـٰذه الحال ينطبق عليها الحديث الآخر في خير الشهداء.
وقال آخرون: إن قوله: ((الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها)) هو في حق الشهادة، شهادة الحسبة التي تكون في حقوق الله -عز وجل- لا في الحقوق الخاصة. والصحيح الأول.
ثم قال رحمه الله: ((ويخونون ولا يؤتمنون)).
((ويخونون)) الخيانة هي عدم الأمانة، وتشمل عدم النصح، وتشمل الغش والتدليس، فهي معنًى عام يدل على سوء الطوية، وعدم النصح للأمة.
((ولا يؤتمنون)) أي: ولا يَحْصُل للإنسان أمن منهم، بل هم أهل خيانة، فلا يؤتمنون، ولا يؤدون الأمانة التي أمروا بأدائها.
قال رحمه الله: ((وينذرون ولا يوفون)) أي: إنهم يأتون بالنذر، وهو إلزام النفس بما لم يجب، دون أن يوفوا بهـٰذا النذر، ولاشك أن هـٰذا ذم، وسبب للقدح؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أثنى على الذين يوفون بالنذر، وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). فالواجب على صاحب النذر أن يفي بنذره.
ثم قال: ((ويظهر فيهم السِّمَن)).
قوله: ((السِّمَن)) المراد به الاستكثار من أسبابه، أي: من أسباب السمن؛ لأن من الناس من يخلقه الله سمينًا، فليس له فيه كسب، فهـٰذا لا يدخل في الذم؛ لأنه ليس منه فعل.
أما من تعاطى أسباب السمن، فتوسع في المآكل والمشارب، وأسرف على نفسه في ذلك فإنه يدخل في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((ويظهر فيهم السِّمَن)).
وقيل: إن ((السِّمَن)) هنا المقصود به العجب والتفاخر، والإقبال على الدنيا، وليس المقصود عظم الأبدان، فإن عظم الأبدان قد لا يكون بسبب من الإنسان؛ لأن من الناس من يكون مقبلاً على الدنيا صاحب أكل، وتوسع في الأكل، لكن لا يظهر عليه سمن، ومنهم العكس من لا يكون كذلك، ويظهر فيه السمن.
(وفيه: عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)). )
وهـٰذا الحديث فيه: بيان فضيلة القرون المفضلة الثلاثة، القرون الأولى الثلاثة التي أخبر عنها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأنهم خير القرون.
وتقدم الكلام على قوله: ((قرني)) أنهم أصحابه.
((ثم الذين يلونهم)) هم الذين جاؤوا من بعدهم، وهم التابعون.
ثم بعد ذلك ((ثم الذين يلونهم)) وهم تابعو التابعين، هـٰذا واضح.
ثم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته)).
وهـٰذا هو الشاهد من الحديث، حيث فيه التحذير من الاستهانة باليمين.
وقوله: ((تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته)) دليل على الاستخفاف باليمين والشهادة، وأنه لا يبالي أيهما أتى به أولاً الشهادة أو اليمين، وذلك لخفتها في لسانه، وتسرعه فيها، بينما الواجب فيها الحفظ والصيانة، والتأني، والتثبت، فلا يبذلها إلا في موضعها، ولا يأتي بها إلا حيث تدعو الحاجة إليها.
قال رحمه الله: (وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار).
أي: يضربوننا على الاستخفاف بهما، والتسرع فيهما، والتهاون فيهما، كل هـٰذا يدخل في قوله: (يضربوننا على الشهادة) وكذلك على الكذب فيهما، كل هـٰذا مما يشمله قول إبراهيم النخعي رحمه الله: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار).
وبهـٰذا يكون قد انتهى الباب، ومقصوده بيان خطورة الاستخفاف بالحلف، وأن من استخف بالحلف، وأصبح لا يقيم له وزنًا يدل ذلك على ضعف تعظيمه لله -عز وجل- ونقص توحيده.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان.
[الشرح]
وذلك في قول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾.
[المتن]
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
[الشرح]
وذلك في حديث أبي هريرة، من قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)). فقوله رحمه الله: (ممحقة للبركة) لأن الكسب إذا لم يبارك فيه لم ينفع، فإن ما زالت بركته لا نفع فيه، والبركة هي كثرة الخير ونموه، فإذا كان المال مباركًا كان نافعًا لصاحبه، دائم الخير، بخلاف المال الممحوق البركة، فإنه سريع الزوال، قليل النفع.
[المتن]
الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه.
[الشرح]
في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)).
الشاهد في قوله: ((لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)) هل هـٰذا من الكبائر ؟
الجواب: نعم من كبائر الذنوب؛ لأن الكبيرة هي كل ما رتب الله عليه وعيداً في الدنيا، أو في الآخرة، ويدخل في هـٰذا أيضًا من تبرأ منهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو قال: ((ليس منا)) أو ما أشبه ذلك، فإنه من كبائر الذنوب، ويشمل أيضًا نفي الإيمان، فإنه من نفي عنه الإيمان دل ذلك على أن ما يأتي به من الأمور الكبيرة العظيمة؛ لأن انتفاء الإيمان لا يذكر في الأمور اليسيرة.
[المتن]
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
[الشرح]
من أين يؤخذ هـٰذا ؟
من قوله: ((أُشَيمِط زان، وعائل مستكبر)) فإن هذين يبَعُد منهما ما وقعا فيه من إثم، فعظم لما قل الداعي فيهما.
[المتن]
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
[الشرح]
هـٰذا واضح من قوله: ((يشهدون ولا يستشهدون)). ومن قوله أيضًا: ((تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته)).
[المتن]
السادسة: ثناؤه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم.
[الشرح]
وذلك في حديث عمران بن حصين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حيث قال: ((ثم إن بعدكم قوماً)) بعد ذكر القرون المفضلة ((يشهدون ولا يُستَشهَدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون)). وهـٰذا فيه بيان عظيم ما وقعوا فيه من المخالفة لما كان عليه السلف الأول.
[المتن]
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
[الشرح]
من حديثي عمران وابن مسعود.
[المتن]
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
[الشرح]
وهـٰذا يؤخذ من قول إبراهيم، لكن من هم الصغار الذين يضربون؟
هم من كان يصلح للتأديب، وليس كل صغير؛ لأن من الصغار من لا يضرب، وقد حده جماعة من العلماء بالعشر، فمن دون العشر لا يضرب، لكنه يؤدب تأديبًا يسيرًا يحصل به كفه عن الشر دون الضرب؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يأمر بالضرب قبل العشر في أهم الأمور، وهي الصلاة، فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)). فما دون العشر يكتفى فيه بالتوجيه والتأنيب، والحث على الخير، والتعنيف البسيط، والضرب الذي لا يكون لمثلهم هو الضرب الذي يكون جلدًا، وما أشبه ذلك، أما التنبيه، أما الهمز اليسير فإنه لا يكون مما ينهى عنه.
المراد أنه: المقصود بالصغار هم من يصلح للتأديب، وهـٰذا الضابط، يعني: قيد مهم؛ لأنه يصدق على الصغار من دون العشر، ومن كان عمره خمس سنوات، وأربع سنوات، من أحسن الحديث والكلام، مثل هؤلاء لا يضربون، يوجهون بغير الضرب.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾( )الآية.
وعن بريدة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، فقال: ((اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري، أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟)). رواه مسلم.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.)
أي: من الأحاديث والآيات، ومراد المؤلف –رحمه الله– بهـٰذه الترجمة: وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأن حفظ ذمة الله من تعظيم الله -عز وجل-، وحفظ ذمة نبيه من ذلك؛ لأن النبي مبلغ عن الله -عز وجل-.
فهـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد نظير ما في الأبواب السابقة القريبة: من أنه تعظيم لله -عز وجل-، وبيان لما يجب له من الإجلال والتقدير جل وعلا.
وقوله رحمه الله: (باب ما جاء في ذمة الله)
الذمة: مأخوذة في الأصل من الذم وهو اللوم ؛ لأنها إذا أعطيت لشخص فخالفها استحق اللوم والعيب، ولذلك سميت ذمة، فهي مأخوذة في الأصل من الذم، والمراد بها هنا العهد، أي: عهد الله وعهد نبيه، وسمي العهد ذمة لأن مخالف العهد مذموم، هـٰذا وجه المناسبة بين الذمة والعهد.
يقول رحمه الله: وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾( ). هـٰذه الآية أمر الله -جل وعلا-فيها أهل الإيمان بالوفاء بالعهد، والوفاء مأخوذ من التوفية: وهو إعطاء الشيء كاملاً موفورًا محفوظًا، فالوفاء هو إعطاء الشيء على وجه الكمال دون نقص ولا بخس، كما قال الله –جل وعلا– في المطففين: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين (01) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (02) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾( ).
فالوفاء المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ أي: أعطوه كاملاً، ولا تنقصوا منه شيئًا.
وقوله: ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ يشمل كل ما عاهد الله –جل وعلا– الخلق على الوفاء به، وإعطائه، والقيام به. فيشمل أصل الدين، ويشمل الواجبات الشرعية، ويشمل العهود التي بين الناس، والمعاقدات التي بين الناس، ولذلك قال المفسر في الجلالين في تفسير: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾: إنه محمول على الأيمان، والبيع، وما أشبه ذلك من المعاملات. إلا أن هـٰذا التفسير بالمثال، والمأمور به من الوفاء بالعهد هو ما أخذ الله –جل وعلا– العهد فيه على العباد أن يوفوه، وأن يقوموا به، وأصل ذلك الوفاء بالتوحيد، وأصل الدين، وجميع ما أمر الله به ورسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ وذلك أن الإنسان إذا عاهد وجب عليه أن يلتزم بعهد الله -عز وجل-؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعهد، فهو مضاف إليه؛ لأنه أمر به، وإن كان حقّاً لعباده. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾( ). والعقود: عهود، فلكون الله أمر بالوفاء بالعقود، وهي من الحقوق الجارية بين الخلق أضيفت إليه؛ لأنه الآمر، بأي شيء ؟ الآمر بتوفيتها وأدائها على وجه الكمال.
قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾. وهـٰذا يشمل كل يمين، فإذا حلف الإنسان على أمر، أو على عهد، فالواجب عليه أن يفي بعهده وبيمينه، وألا يحنث في ذلك، فإن الحنث في اليمين بعد عقدها دليل على ضعف التعظيم في قلب العبد، ما لم يكن في مخالفة اليمين مصلحة وخير، فإنه يحنث في يمينه، ولحفظ حق الله في التعظيم يكفر عن هـٰذه اليمين التي نكث فيها؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان من هديه أنه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أتى الذي هو خير، وكفَّر عن يمينه، وهـٰذا جارٍ في كل يمين يحلف عليها الإنسان، فإذا كان غيرها خيرًا منها، فالسنة في حقه أن يأتي الذي هو خير، ويُكَّفِر عن يمينه.
وهـٰذه الآية ما مناسبتها للباب؟ بيان وجوب حفظ اليمين؛ لأن الله أمر بالوفاء بها، والوفاء بها حفظ لها.
قال رحمه الله: وعن بريدة قال: (كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية).
(أمر أميرًا) أي: جعل عليهم أميرًا.
(على جيش) وهو: من يُبعث لقتال الكفار، والجيش هو في الغالب العدد الكثير.
قال: (أو سرية) وهم عدد أقل من الجيش كالفرقة في الجيش، وقد ذكر الحربي في تفسير السرية أنها الخيل يبلغ أربعمئة ونحو ذلك.
قال بريدة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أوصاه بتقوى الله تعالى) في بيان هدي النبي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مع أُمرائه الذين يبعثهم على الجيوش أو السرايا. (أوصاه بتقوى الله) وهـٰذه الوصية وصية جامعة تجمع للإنسان خير الدنيا والآخرة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾( ). أمر الله بها عموم الخلق، وأمر بها خُلَّصَ الخلق وأصفياءه، أمر بها خير الخلق خاتم النبيين محمد ابن عبد الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾( ) فأمره بالتقوى. فالتقوى هي أجمع الأوامر التي يجتمع فيها الخير كله، وينتفي بها عن الإنسان الشر كله إذا عمل بها وأخذ، وتقوى الله –جل وعلا– هي أن يجعل بينه وبين الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى، رغبةً ورهبةً، خوفًا وطمعًا.
ثم قال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (ومن معه من المسلمين خيرًا).
يعني: أمره بتقوى الله في ما يتعلق بإمارة الجيش، واختيار الأصلح، والعمل في ما بينه وبين الله جل وعلا. أما في ما يتعلق بالرعية الذين أمَّره عليهم فأمره فيهم بالخير، (ومن معه من المسلمين خيرًا) أوصاه خيرًا بمن معه من المسلمين، والخير يجمع كل طرق الإحسان، وذلك بأن يراعي حال من وليهم، فلا يتكبر عليهم، ولا يحتجب عنهم، ولا يُغْلِظ عليهم، ولا يشق عليهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون، بل يعينهم، ويتحمل معهم المشاق، ويكون مشاركًا لهم في ما يأمرهم به، ويكون متواضعًا لهم.
ثم قال: (فقال) أي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في وصيته لمن أمَّره على جيش أو سرية: ((اغزوا باسم الله)).
هـٰذا أمر بالغزو، والغزو المأمور به: قتال الكفار كما سيأتي في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((قاتلوا من كفر بالله)).
والأمر هنا: أي: اشرعوا بالغزو باسم الله -عز وجل- ، وهـٰذا إما أمر بأن يبتدئ ويفتتح الغزو باسم الله، كقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للغلام: ((يا غلام سم الله وكل بيمينك)). وكقوله لأصحابه: ((توضؤوا باسم الله)) لما قلََّ ماؤهم، وأتاهم بوضوء، ووضع يده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الإناء ففارت ماءً قال: ((توضؤوا باسم الله)) أي: ابدؤوا وضوءكم باسم الله، فهو أمر بأن يبدأ الإنسان، ويفتتح هـٰذا العمل الجليل، وهو الجهاد في سبيل الله باسم الله -عز وجل- ، مستعينًا به متوكلاً عليه مخلصًا العمل له، فإن ذكر اسم الله -عز وجل- في أول الأعمال يتضمن هـٰذه الأمور، وإن كان المتبادِر في ما يتضمنه أنه الاستعانة، لكنَّ الاستعانة لا تكون إلا مع تمام التوكل على الله -عز وجل-، والإخلاص له سبحانه وتعالى.
((قاتلوا من كفر بالله)) أمر بقتال من كفر بالله، والقتال المأمور به هنا هو الجهاد في سبيل الله، وبيَّن في هـٰذا الحديث العلة التي من أجلها شُرع القتال، وهو قتال من كفر بالله، وهـٰذا الإطلاق في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قاتلوا من كفر بالله)) لا بد من تقييده بما جاءت النصوص من القيود: فلا يقاتَل الذمي مع أنه كافر بالله، ولا يقاتَل المُسْتَأْمَن مع أنه كافر بالله، ولا يقاتَل المُعاهَد مع أنه كافر بالله، ولا يقاتَل الصغير من الكفار مع أنه كافر بالله، وكذلك الشيخ الكبير، وكذلك الرهبان، وكذلك النساء... إذا لم يكن لهم شأن في القتال والحرب.
فهـٰذا الإطلاق في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قاتلوا من كفر بالله)) هو بيان للعمل الذي يقومون به من حيث الأصل، وأما من حيث القيود فالنصوص تدل على القيود التي ذكرناها، وقد جاء بعضها في كلام النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الحديث.
قال: ((اغزوا ولا تَغُلُّوا)).
قوله: ((اغزوا)) هـٰذا تكرار لما تقدم الأمر به، وبيان لتفصيل ما تقدّم.
((ولا تغُلُّوا ولا تَغْدِروا ولا تُمَثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا)) نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن أربع خلال:
((لا تغلوا)) نهي عن الغلول، والغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، نهى عنه النّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقد جاء في الغلول أحاديث كثيرة تدل على عظم ذنب من غلَّ، وأن من غل يأتي بما غل يوم القيامة.
((ولا تَغْدِروا)): نهي عن الغدر، والغدر هو أن يفعل الإنسان خلاف ما عاهد عليه، وخلاف ما عاقد عليه غيره على وجه الخِفية، وقد جاء في الغدر أحاديث متعددة في ذمه والنهي عنه، ومنها قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((يُنْصَبُ لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة على قدر غدرته ولا غدر أعظم، أو أشد من غدر إمام عامة)). وهـٰذا فيه التحذير من الغدر، وأن الغدر من الصفات التي نهى عنها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى في قتال الكفار، ولذلك فسَّر جماعة من العلماء قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ولا غدر أشد من غدر إمام عامة)) بهـٰذا الذي نهى عنه أمراء الجيوش والسرايا؛ لأن أئمة المسلمين إذا غدروا لم يوثق بهم، فإنهم إذا غدروا بالأعداء، وخالفوا العهود والمواثيق التي بينهم وبين أعداء المسلمين تربص أعداء المسلمين بأهل الإسلام الدوائر، وأعدُّوا لهم، وكانوا في غاية مقاتلتهم، كما أن فيه التنفير من الإسلام، كما أنه سبب للوقيعة في أئمة المسلمين، ولذلك ينبغي الحذر من الغدر.
قال: ((ولا تمثلوا)) نهى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التمثيل، والتمثيل: هو التشويه بالقتيل، وذلك بجدع أطرافه، وتغيير شكله، وتشويه معالمه، فإن هـٰذا مما نهى عنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
وقد أجمع العلماء على النهي عن الغلول وعن الغدر، وذهب كثير منهم إلى النهي عن التمثيل، والذين رأوا جوازه أجازوه بقيود، ومن ذلك أن يمثلوا بالمسلمين فيجوز التمثيل بهم بنظير ما فعلوا.
قال: ((ولا تقتلوا وليدًا)) الوليد: الصغير، وهو من لم يبلغ، ممن لا يصلح للقتال، فنهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن قتال الصغار؛ لأنهم لا يصلحون للقتال، ولأنه يمكن استصلاحهم، ولأنهم كما قال بعض الفقهاء -وهـٰذا التعليل فيه نظر- مال، حيث إنهم يُسْتَرَقُّون، وينتفع بهم، وقتلهم من باب إضاعة المال، هكذا عللوا وهـٰذا التعليل فيه نظر.
قال: ((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال)).
((إذا لقيت عدوك من المشركين)) ويشمل هـٰذا كل كافر سواءٌ كان من أهل الكتاب، أو من غير أهل الكتاب، سواءٌ كان عربيّاً أو عجميّاً، فإن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إذا لقيت عدوك من المشركين)) يشمل كل من يصدق عليه وصف الشرك، وفي هـٰذا رد على من قال: إنه لا تؤخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، بل المشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا فالقتال، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم)). وهـٰذا يشمل كل مشرك، سواءٌ كان مجوسيّاً أو غير مجوسي، عربيّاً أو غير عربي، فكل من قيَّد ما في هـٰذا من الإطلاق يحتاج إلى دليل.
قال رحمه الله: ((فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال)) شك، والشك هنا غير مؤثّر؛ لأن الخصال هي الخلال. ((ادعهم)) أي: اعرض عليهم ثلاث خلال أو خصال. ((فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)).
((أيتهن)) ما الناصب في ((أيَّ)) ؟ قوله: ((أجابوك)) والنصب على نزع الخافض؛ لأن تقدير الكلام: فأجابوك إلى أيتهن ((فاقبل منهم وكف عنهم)). و((ما)) في قوله: ((ما أجابوك)) زائدة.
((فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)) ثم جاء بيان تفصيل هـٰذه الخلال التي أمر بها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على وجه الترتيب.
قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ثم ادعهم إلى الإسلام))، ((ثم)) العادة أنها تأتي للترتيب والتراخي، وهي هنا لا ترتيب فيها؛ لأنها لم يتقدمها ما تُعطف عليه، بل هي ابتداء كلام؛ لأن قوله: ((ادعهم إلى الإسلام)) هو بيان للخلال التي أمر بها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يعرضها المسلمون على من يقاتلونهم من أهل الشرك، ومن هـٰذا جعل بعض العلماء قوله: ((ثم)) هنا زائدة ليست في محلها، وقالوا: إن جميع الروايات في غير مسلم ليس فيها ((ثم)) فـ ((ثم)) هنا غلط، وقال جماعة آخرون: إن ((ثم)) هنا جاءت للفصل، وما كان كذلك يفيد الاستفتاح وابتداء الكلام، ولا يلزم منه الترتيب، وعلى كلٍّ الأمر في هـٰذا سهل.
المراد أن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ادعهم إلى الإسلام)) هو أولى الخصال والخلال التي أمر بها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تُعرض على المشركين، ((ادعهم إلى الإسلام)) وهـٰذا فيه بيان المقصود من القتال، المقصود من القتال هو دعوة هؤلاء إلي الإسلام بالدرجة الأولى؛ لأن دعوتهم إلى الإسلام هي الغاية التي جاء بها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وعمل عليها، وشُرِعَ من أجلها القتال، والمقصود بالإسلام ما بيَّنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث جبريل، في حديث عمر لما سأل جبريل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الإسلام فقال: ((الإسلام: أن تشهد أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت)). هـٰذا المقصود بالإسلام، وهو الذي بعث به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، فالدعوة إلى هـٰذه الأمور الخمسة.
((فإن أجابوك فاقبل منهم)).
((إن أجابوك)) أي: إن أعطوك ما سألت ((فاقبل منهم)) أي: اقبل منهم استجابتهم لدعوتك، ((وكف عنهم))، فلا تطالبهم بأكثر من ذلك.
يقول: ((ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين)) هـٰذا تابع للأول؛ لأنه بيان لما يترتّب على الإجابة، وليس ذكرًا للخصلة الثانية، إنما هو بيانٌ لما يترتّب على إجابتهم، فإذا أجابوا للإسلام ما المطلوب؟ ((ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين)) وهـٰذا ما كان عليه الأمر في أول الإسلام قبل فتح مكة، فإنَّ الهجرة كانت واجبة، واختلف العلماء في وجوبها، هل هي واجبة على الجميع، أي على جميع من أسلم، سواءٌ كان في مكة أو في غيرها، أو واجبة على أهل مكة فقط؟
والظاهر أنها واجبة على الجميع.
((ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين)) يعني: إلى المدينة ((وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين)) لهم ما للمهاجرين من الغنائم، والفيء، والخمس، وما أشبه ذلك. ((وعليهم ما على المهاجرين)) أي: مما يطلب منهم. ((فإن أبوا أن يتحولوا منها)) أي: من دارهم التي أسلموا فيها ((فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء)) أي: لا يستحقون من الغنيمة والفيء شيئاً؛ لأن الله –جل وعلا – قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾( ). فالولاية منتفية عمّن آمن ولم يهاجر، وذلك قبل نسخ وجوب الهجرة في حديث ابن عباس في الصحيحين: ((لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)). فهـٰذه هي الحال قبل هـٰذا النسخ.
قال: ((إلا أن يجاهدوا مع المسلمين)) فإن جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنيمة والفيء بجهادهم لا بهجرتهم.
يقول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في وصيته: ((فإن هم أبوا فاسألهم الجزية)) هـٰذا بيان للخصلة الثانية، الخلة الثانية من الخلال الثلاث التي أمر بها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ((فإن هم أبوا)) أي: امتنعوا من الإسلام ((فاسألهم الجزية)) أي: فمرهم بأن يُعطوا الجزية، والجزية هي المال الذي يبذله الكفار لأهل الإسلام على أن يُقَرُّوا في ديارهم على دينهم.
((فإن هم أجابوك)) أي: أعطوك الجزية ((فاقبل منهم وكف عنهم)) أي: فلا تقاتلهم ولا تكلفهم أكثر من ذلك؛ لأنهم يكونون في ظل حكم الإسلام، والإسلام عليهم ظاهر؛ لأن الجزية التي يبذلونها هي دليل صغارهم، وذلهم، وانقيادهم لحكم الإسلام.
((فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)) إن امتنعوا من الخصلة الثانية، وهي الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. وانظر إلى قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فاستعن بالله)) فيه التنبيه إلى عدم الاعتداد بقوة النفس، وما مع الإنسان من القدرة والمُكْنَة، بل ينبغي له مهما بلغت قوته- لأنه في الغالب لا يكون مثل هـٰذا العرض إلا ممن كان ظاهر القوة واثقًا من نفسه، مع هـٰذا ينبغي له- أن يستعين بالله، فإن الله إذا لم يُعِن العبد لم يحصل له مقصوده، ولم ينل مطلوبه.
((فاستعن بالله وقاتلهم)) وهـٰذا فيه أيضًا التشجيع على القتال، وأنهم إن أبوا فقد أغلقوا الطرق ولم يبق إلا أن يُقَاتَلوا.
ثم قال: ((وإذا حاصرت أهل حصن)) وهـٰذا هو الشاهد من الحديث قوله: ((وإذا حاصرت أهل حصن)) إلى آخر ما سيأتي.
فيما تقدم من عرض الخلال الثلاث، والخصال الثلاث خلاف بين العلماء، هل هـٰذا عام في كل قتال، أم أنه يجوز تبييت الكفار دون دعوتهم؟
ومنشأ الخلاف أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيّت بني المصطلق، فأتاهم وهم غارُّون، والأنعام على مياههم، وقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم ونساءهم، فأخذ الجماعة من العلماء من هـٰذا جواز تبييت الكفار وهم غارُّون.
والصحيح: التفصيل، وأن القاعدة العامة والأصل: هو ما تضمنه هـٰذا الحديث من أنه لا يقاتل إلا بعد الدعوة، لكن من بلغته الدعوة، وعرفها معرفة واضحة بيِّنة فإن لولي الأمر أن يبيتهم وهم غارُّون، كما جرى من النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع بني المصطلق، فإنهم علموا، وعرفوا ما جاء به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ولم ينقادوا.
أما من لم يسمع، ولم يعرف، فإنه ينبغي أن يعرض عليه الخلال الثلاث.
فإن اشتبه الأمر هل بلغهم أولم يبلغهم، أو هل بلغهم على وجه تقوم به الحجة، أو لم يبلغهم؟ فالأصل: ما تضمنه حديث بريدة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- من عرض الخلال الثلاث؛ لأن المقصود بالقتال الرحمة، لا الإبادة والاستيلاء على الأموال، وهـٰذا هو مذهب الإمام مالك –رحمه الله– وبه تجتمع النصوص.
قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه)) أي: تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه ((فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه)) يعني: لا تقل: أعاهدكم، أو أصالحكم على كذا وكذا، ولكم ذمة الله وذمة رسوله، هـٰذا معنى نهي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قوله: ((فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه)). ((ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك)). ((اجعل لهم ذمتك)) أي: عهدك وعهد أصحابك. ((فإنكم أن تخفروا)) أي: تنقضوا ((ذممكم)) أي: عهودكم. ((وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا)) أي: تنقضوا ((ذمة الله وذمة نبيه)) أي: عهد الله وعهد نبيه. ولاشك أن نقض العهد الذي يكون من الإنسان أهون من أن ينقض عهدًا أعطاه من الله ومن رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إنكم أن تخفروا ذممكم)) ليس فيه الإغراء بإخفار الذمم، إنما فيه بيان ما قد يقع، وإلا فقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أول الأمر: ((اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا)) فنهى عن الغدر، لكن قد يقع من أعراب المسلمين، أو أطرافهم من يقع منه مخالفة ما جرى عليه العهد، فكون ذلك متعلقًا بذمم المقاتلين أولى وأسهل من أن يكون متعلقًا بذمة الله وذمة رسوله، فإن ذمة الله وذمة رسوله مصونة، مستحقة للحفظ والصيانة، وألا تبذل في غير محلها.
قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه)).
ثم قال: ((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله)).
العلة: قال: ((ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟)).
فينزلهم على حكمه، حكمه هل هو يقيني أو اجتهادي؟ حكمه اجتهادي، قد يصيب حكم الله، وقد لا يصيب حكم الله فيهم. وهـٰذا من أدلة المحققين من أهل العلم القائلين: بأن الحكم عند الله في المسائل واحد، وأن عذر المجتهدين فيما يصلون إليه من اجتهاد لا ينافي أن يكون الحكم واحدًا، فالمصيب في مسائل الاعتقاد والعمل واحد؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟)). فدل ذلك على أن أمير الجيش إذا اجتهد وأخطأ حكم الله، فإن اجتهاده ليس حكم الله، بل حكم الله هو الذي قضى به جل وعلا، ولذلك نهى أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله. وهـٰذه مسألة مشهورة في كتب الأصول، وهي: هل كل مجتهد مصيب، أم أن المصيب واحد؟
الصحيح: أن المصيب واحد في مسائل الأصول، وفي مسائل الفروع، يعني: في مسائل العلم، وفي مسائل العمل، في مسائل الاعتقاد، وفي مسائل الفروع، المصيب واحد، وحكم الله واحد، وكون المصيب واحداً لا يعني أن من اجتهد فأخطأ اجتهاده ملوم، وأنه مذموم، وأنه مستحق الإثم؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)). أي: أجر اجتهاده.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه، وذمة المسلمين.
[الشرح]
وذلك فيما بيَّنه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من التفريق، حيث قال: ((اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك)).
[المتن]
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً.
الثالثة: قوله: ((اغزوا باسم الله، في سبيل الله)).
[الشرح]
نعم، هـٰذا فيه بيان الاستعانة بالله، والإخلاص له جل وعلا: ((باسم الله)) هـٰذا الاستعانة، ((في سبيل الله)) هـٰذا الإخلاص.
[المتن]
الرابعة: قوله: ((قاتلوا من كفر بالله)).
[الشرح]
في بيان علة القتال وسببه.
[المتن]
الخامسة: قوله: ((استعن بالله وقاتلهم)).
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
[الشرح]
وأن حكم العلماء قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله؛ لأنهم مجتهدون، قد يصيبون حكم الله وقد لا يصيبونه.
[المتن]
السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
[الشرح]
(في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا)، وإنما يجتهد في التوصل للحق والصواب، فإن توصل إليه فله أجران، وإن لم يصبه فله أجر واحد.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في الإقسام على الله
عن جندب بن عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك)). رواه مسلم.
وفي حديث أبي هريرة أنّ القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
[الشرح]
هـٰذا الباب كسابقه من حيث المناسبة لكتاب التوحيد، فإن المؤلف -رحمه الله- في هـٰذه الأبواب كلها يذكر ما يتعلق بجانب التعظيم، تعظيم الله عز وجل، وحفظ حقه، وقدره -جل وعلا- حق قدره.
يقول رحمه الله: (باب ما جاء في الإقسام على الله).
ولم يبين المؤلف رحمه الله الحكم، وترك ذلك من خلال ما يذكر؛ لأن الإقسام على الله عز وجل لا ينتظمه حكم واحد، بل يختلف حكمه باختلاف قائله: فقد يكون القائل المقسم على الله عز وجل امتلأ قلبه بالثقة بما عند الله، وأنه سبحانه وتعالى يجيبه فيما أقسم عليه، فهـٰذا لا بأس به، وهو المشار إليه في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره))، وهـٰذا يدلّ على أن الإقسام على الله -عز وجل- من مثل هـٰذا أمر حسن. وأما إذا كان الإقسام على الله –عز وجل- صادرًا عن كبرٍ، وإدلالٍ، وعجب بالعمل، ورؤية للنفس فهـٰذا هو الذي جاء فيه نظير ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من الحديث في هـٰذا الباب.
وإنما اقتصر المؤلف -رحمه الله- على هـٰذا الصنف دون الصنف الآخر؛ لأنه هو الذي يحصل به الإخلال بالتوحيد، أما ما كان عن حسن ظن بالله عز وجل، وثقةٍ بوعده، وتصديقٍ له فإن هـٰذا من كمال التوحيد، ولذلك لم يشر إليه المؤلف -رحمه الله-، ولم يذكر حديثه، فالمؤلف ذكر ما هو نقص في التوحيد، لا ما هو كمال فيه ودليل عليه.
يقول رحمه الله: (عن جندب بن عبد الله) فيما نقله في هـٰذا الباب (عن جندب بن عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان)). ((قال رجل)) ) ولم يبين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من القائل؛ لأن المقصود التحذير من الفعل، لا بيان من هو الفاعل، ولذلك أبهمه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يبينه، فالشأن في الفعل، لا في الفاعل. ((قال رجل: والله)) وهـٰذا قسم بالله عز وجل، وحَلِف. ((والله لا يغفر الله لفلان)). هـٰذا إقسام على الله؛ لأنه إلزام لله عز وجل، وحكم عليه بفعل من الأفعال، وليس مجرد قسم يحنث به صاحبه، ولا يطاله فيه إثم، ولا مؤاخذة أكثر من الحنث، بل هو قسم يتضمن الحكم على الله عز وجل، ولذلك كان ما كان في هـٰذا الحديث من العقوبة الشديدة، فدخول هـٰذا الحديث فيما ذكره المؤلف لا بالصيغة؛ لأن صيغة القسم أن يقول: أقسم على الله، أو حق على الله، أو ما أشبه ذلك مما فيه معنى القسم، ومنه هـٰذا فإنه في معنى القسم على الله؛ لأنه أقسم بالله –جل وعلا- على فعلٍ من أفعاله، حيث قال: ((والله لا يغفر الله لفلان)). فهـٰذا قسم على فعل من أفعال الله عز وجل.
فيتبين من هـٰذا أن قوله: الإقسام على الله يشمل: الإقسام بلفظ القسم، أو ما دل عليه مما يتضمن إلزام الله –جل وعلا- فعلاً من الأفعال، والحكم عليه بفعلٍ من الأفعال، فلا يقتصر القسم على صيغةٍ معينة، بل كل ما كان فيه إلزام، وحكم بأمر من الأمور على الله جل وعلا فإنه يدخل في الإقسام على الله عز وجل، ولو لم يذكر فيه لفظ القسم.
((والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟)) الاستفهام هنا استنكار، ليس استفهام استعلام، ففيه إنكار هـٰذا، حيث قال الله جل وعلا: ((من ذا الذي يتألى عليَّ)) أي: من ذا الذي يحلف عليَّ، ويقسم عليَّ، ويحكم عليَّ في فعلي ((أن لا أغفر لفلان؟)).
((إني قد غفرت له)) أي: المحلوف أن يغفر له. ((وأحبطت عملك)) أي: وأحبطت عمل القائل الذي حلف هـٰذا اليمين على الله عز وجل، وأقسم هـٰذا القسم على الله عز وجل.
وفيه عظيم قبح هـٰذا القول، وأنه صادر عن جهل بالله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، وصادر عن نفس ملئت عجبًا، وإدلالاً على الله عز وجل؛ لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن القائل لهـٰذا كان عابدًا، كما ذكر المؤلف رحمه الله : (وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد). وقد جاء ذلك في السنن أن رجلاً عابدًا كان يرى شخصًا على المعاصي فينهاه، حتى إنه مرةً من المرات قال له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله جل وعلا روح العاصي، وروح المُدِل العابد، فقال للعاصي: ((ادخل الجنة)) وقال للمدل بعبادته المستكبر بها: ((اذهبوا به إلى النار)).
فدل ذلك على أن قوله في هـٰذا الحديث: ((والله لا يغفر الله لفلان)) ليس قولاً مجرّدًا عن علو وكبر وعجب ملأ نفسه حتى ظن أنه لا يغفر لفلان، ولذلك هـٰذا النوع من الإقسام الذي يتضمن التحكم على الله عز وجل في رحمته، أو في فعله المتضمن للعجب، والكبر، والرياء، وليس فيه حسن الظن، والتصديق بوعد الله عز وجل، هـٰذا هو الذي جاء في مثله هـٰذا التحذير العظيم: ((إني قد غفرت له وأحبطت عملك)).
((إني قد غفرت له)). وهـٰذا فيما إذا كان دون الشرك ولا شك، وهو يبين لنا أن ما كان عليه هـٰذا الذي حُلِفَ أنه لا يغفر له مما دون الشرك؛ لأن الله –جل وعلا- قضى أنه لا يغفر الشرك، فهـٰذا في حق من لم يشرك.
((وأحبطت عملك)) اختلف العلماء –رحمهم الله- في حبوط العمل هنا، هل هو حبوط كلي يزول به كل ما قدمه من الحسنات، أم أنه حبوط بمعنى أن سيئته أحاطت بما يقابلها من العمل فأحبطته؟
قولان لأهل العلم:
فمنهم من قال: إنَّ الحبوط هنا ليس الحبوط الكامل الذي تذهب به الحسنات، ويكون صاحبه من أهل النار، إنما هو الحبوط الذي يحصل به ذهاب بعض الحسنات مقابل هـٰذا الجرم والذّنب.
وقال آخرون: إنَّ الحبوط يشمل كل عمل، فيكون دالاًّ على أن صاحبه قد خسر عمله، ويدلّ لهـٰذا ما جاء في حديث أبي هريرة: ((تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)) أي: أفسدت وأذهبت عليه دنياه وآخرته.
وجه إذهاب الدّنيا: أنه لم يحصل منها شيئًا، حيث إنه لم يستمتع بما فيها من المتاع الزائل؛ لاشتغاله بالعبادة والطّاعة.
وأما إيبَاقُ الآخرة: فهو ذهاب عمله الذي عمله، فإنه لا يحصّل ما قدمه من الأعمال؛ لأنه قد حبط بما كان معه من العُجب، والإدلال على الله عز وجل بالعمل. وهـٰذا يبين لنا خطورة مثل هـٰذا الكلام، وأنّ الواجب على العبد أن يتوقى نظير هـٰذا الكلام الذي يفسد عليه عمله، ويحبط ما قَدَّم من الصالحات، والإنسان ينبغي أن يحكم لسانه، ففي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفًا)). فالواجب على المؤمن أن يتوقى غوائل اللسان وشره، فإنه مصدر شر كثير، كما أنه سبب خيرٍ كثير، وعلاج هـٰذا توجيه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)). وليتّق الله، فإن الله جل وعلا هو المنُعِم عليه بالعمل الصالح، فينبغي له أن يشكر الله على هـٰذه النعمة، وأن يرحم الخلق على ما فاتهم؛ لأن فوات الصالحات في حق الخلق ليس موجبًا للعلو عليهم والتكبر، إنما يوجب الشفقة عليهم والرحمة، هـٰذا من حيث القدر.
وأما من حيث الشرع: فالواجب أن يأمرهم بما أمره الله –عز وجل- به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من غير جفاءٍ ولا غلظة، بل بما تقتضيه الحال دون تحكم وتيئيس للناس من رحمة الله عز وجل، فإن ممن يدعو إلى الله قوماً ييئِّسون الخلق، ويقنطونهم من رحمة الله، وهـٰذا لا شك خلاف ما جاءت به الرّسل، وخلاف منهج النبوة في الدعوة إلى الله، وفي تحبيب الناس بهـٰذه الرسالة، وتنشيطهم إلى الإقبال عليها، فينبغي الحذر من مثل هـٰذا.
إذًا: مقصود هـٰذا الباب بيان أنّ الإقسام على الله عز وجل في مثل هـٰذا هو من ضعف قدر الله في القلب، حيث يبلغ بالعبد عمله ورؤيته لعمله أن يظن أنه حاكم على الله جل وعلا فيما يفعل، وفيما يجري منه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فالواجب على العبد أن يتوقى هـٰذا وأن يحذره، وأن يعلم أن فضل الله عليه سابق بالعمل الصالح، وفضله عليه لاحق بقبول هـٰذا العمل الصالح، فإذا كان العمل الصالح مسبوقًا بفضل، متبعًا بفضل كان من حق هـٰذه النعمة أن تُشْكَر، ولا تُكْفَر.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: التّحذير من التألي على الله.
[الشرح]
لقول الله عز وجل: ((من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، وأحبطت عملك)).
التألي: الحلف، التألي مأخوذ من الألية، وهي الحلف، ومنه الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾( ) أي: يحلفون. فالتألي: من الألية، وهي اليمين، يقال: تألى، وآلى.
[المتن]
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
[الشرح]
نعم، لم يكن بينه وبين النار إلا هـٰذه الكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته، وهـٰذا يدل على قربها ودنوها، وأن العبد يصل إليها من أقرب طريق، نسأل الله السلامة منها.
[المتن]
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.
[الشرح]
حيث غفر لهـٰذا الرجل، والعلم عند الله، أن المغفرة لهـٰذا الرجل إما فضل من الله- وهي على كل حال فضل من الله- لكن إما فضل بلا سبب منه؛ لأن الله –جل وعلا- يغفر لمن يشاء، وإما أن يكون لما قام في قلبه من الطمع في رحمة الله، فلما قام في قلبه من الطمع برحمة الله -عز وجل- ما قام كان سببًا لحصول ذلك له.
[المتن]
الرابعة: فيه شاهد لقوله: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة)) إلى آخره..
[الشرح]
يشير إلى الحديث الذي أشرنا إليه: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفًا)). فينبغي للمؤمن أن يتوقى لسانه كما ذكرنا، إذا كان هـٰذا شأنه، وهـٰذه حاله وجب عليه أن يتقيه.
[المتن]
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
[الشرح]
نعم ، هـٰذا الرجل سبب المغفرة له ما وقع من تألي الرجل ألا يغفر الله له، وهـٰذا لا شك أنه مكروه، لو قيل لأحد: إن الله لا يغفر لك، أو: والله لا يغفر الله لك، لكان هـٰذا من أشد الأشياء عليه، ومع ذلك كان سببًا للمغفرة والرحمة.
[الأسئلة]
سؤال: قسم أنس بن النضر في أي المواضع يدخل؟
الجواب: يدخل في حسن الظن بالله؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال بعد أن عفا أهل الجناية: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). فهو داخل في هـٰذا، لكن يُنَبه إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتوسع في القسم على الله عز وجل؛ لأن من الناس من يقسم على الله عز وجل عند أدنى موجب، وعند أدنى مناسبة، بل إن بعضهم يقسم على الله في دعائه، وسمعنا هـٰذا من بعض الذين يقنتون في رمضان، يقسمون على الله في القنوت ودعائه أن الله يفعل كذا بالكفار، أو يفعل كذا لأهل الإسلام، وهـٰذا خلاف الأولى؛ لأن القسم لا يكون عند أقرب موجب، بل ينبغي ألا يقوله الإنسان إلا إذا امتلأ قلبه بتعظيم الله عز وجل، وحسن ظنه به، وعظيم الحاجة إليه، وأن يكون بينه وبين ربه لا يظهره؛ لأنه إن أقسم على الله بين الناس، ثم لم يجب الله، إما أن يقول الناس: إن الله لا يجيب الدعاء، وإما أن يظنوا به سوءًا، حيث إنه لم يدخل في زمرة من قال فيهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). فما فيه حاجة، ثم إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مر به ما مر من الكروب، والنوازل، وعظائم الأمور، ولم يذكر أنه أقسم على الله، ولما أخبر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّ البراء بن مالك من الذين إذا أقسموا على الله أبر الله جل وعلا قسمهم، أي: أعطاهم ما حلفوا عليه إكرامًا لهم، ما كان يُقْسِم عند أدنى موجب، بل لما احتاج المسلمون إلى القسم، واشتد بهم الكرب أتوا إليه، فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فأقسم عند الحاجة، وجاءهم الفرج، ثم جاؤوه مرة ثانية في نازلة أخرى، فأقسم وسأل الله عز وجل أن يكون أول شهيد، فأبر الله قسمه، فنصر المسلمين، ومنحهم أكتاف أعدائهم، وظفروا بهم، وكان أول شهيد. فينبغي ألا يسرف الإنسان في القسم على الله.
ومن الناس من الآن يقول: فلان ممن إذا أقسم على الله أبره ، هـٰذا حكم لا يعلم إلا بالوحي، من أين لنا أن فلانًا، أو فلانًا من الناس إذا أقسم على الله أبره؟
هـٰذا تحَكَّم، كما أن التحكم يكون في منع المغفرة، التحكم يكون أيضًا في إثبات فضل لم يرد دليل على إثباته لشخص معين، فينبغي التأني والتريّث في مثل هـٰذه الأمور، وأن يُعمل الإنسان العلم، لا العواطف.
¹
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
- رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
الدرس الثلاثون
www.almosleh.com
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب: لا يُستَشفَع بالله على خلقه
عن جبير بن مطعم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله: نُهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((سبحان الله! سبحان الله!)). فما زال يسبح حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يُستَشفَع بالله على أحد من خلقه)) وذكر الحديث. رواه أبو داود.
[الشرح]
قال المؤلف رحمه الله: (باب لا يُستَشفَع بالله على خلقه).
(لا يُستَشفَع) هـٰذا نفي أو نهي؟ لا يُستَشفَع أي لا تُطلب الشفاعة، والشفاعة: هي التوسط في طلب الخير للغير، فقوله: لا يُستَشفَع بالله أي لا تُطلب الشفاعة بالله عند أحد من خلقه، فلا تُطلب الوساطة من الله عند أحد من الخلق، يعني: لا يجوز للمؤمن أن يقول: يا ربي اشفع لي عند فلان حتى ينهي معاملتي أو يحصل مقصودي، فإن الله –جلّ وعلا– أعظم من أن يُطْلَب منه أن يشفع عند خلقه، ولذلك عَظَّم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قول القائل، وسبّح حتى عُرف ذلك في وجهه، فمعنى قوله: (لا يُستَشفَع بالله على خلقه) أي: لا تطلب الشفاعة من الله عند أحد من الخلق أو لأحد من الخلق، فقوله: (على) له وجهان: إما بمعنى (عند)، وإما بمعنى (إلى)، وكلاهما وارد في لسان العرب، أي له من الشواهد ما يدل عليه، فيصح أن تأتي على بمعنى عند، وتأتي على بمعنى إلى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾( ). ﴿عَلَيَّ﴾: قيل في التفسير أي: عندي، وأما (إلى) فمنه قول الشاعر:
إذا ما أتيت على الرسولِ
أي: إذا ما أتيت إلى الرسول، وذكر أصحاب حروف المعاني شواهد كثيرة متعددة لهذين المعنيين.
المراد أن قوله: (لا يُستَشفَع بالله على خلقه) أي: لا تُطلب شفاعته إلى الخلق، أو لا تطلب شفاعته عند الخلق، فعلى بمعنى (إلى) أو بمعنى (عند).
يقول رحمه الله: (على خلقه) وهـٰذا يشمل جميع الخلق شريفهم ووضيعهم، ويشمل الإنس والجن والملائكة، فكل من سوى الله لا يُستَشفَع بالله عليه: لا يُستَشفَع بالله عنده، لا يُستَشفَع بالله إليه، فإن شأن الله أعظم من ذلك.
قال رحمه الله: (عن جبير بن مطعم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). وهـٰذا كالاعتذار عما جرى، وأنه لم يحصل ما في الحديث من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذين تلقوا عنه تعظيم الله –جل وعلا–، وكان معهم من المعرفة بالله ما يصونهم عن أن يقولوا مثل هـٰذا القول.
(جاء أعرابي إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله نُهِكَت الأنفس) أي: أصابها الإنهاك، وهو الإجهاد والضعف.
مناسبة الباب ما أشرنا إليه، مناسبة الباب لكتاب التوحيد: نظير ما تقدم، أن هـٰذا لا يكون إلا من ضعف التعظيم، وجميع الأبواب المتأخرة -كما تلاحظون- كلها في هـٰذا الشأن وهو بيان ضعف التعظيم، وأن ضعف التعظيم من ضعف التوحيد، ولذلك يا إخوان الاعتناء بمسألة تعظيم الله -عز وجل- مما يحقق به العبد التّوحيد، وله فوائد كثيرة من أهمها تحقيق التّوحيد؛ لأنّ من عظم الله نفى عن قلبه وجلا قلبه عن أن يقع فيه شيء من الشرك، ولذلك عاب الله –جلّ وعلا– المشركين في المواضع التي ذكر فيها شركهم، وبَيَّن سبب ما وقعوا فيه فقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾( ) أي: ما عظّموه حق تعظيمه ولا أجلّوه حق إجلاله، ولو عظموه لما وقعوا في الشِّرك.
وقال -في سياق الآيات التي فيها بيان كفر قوم نوح، والآيات التي أقامها –جل وعلا– دالة عليه: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴾( ) .
﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾ أي: تعظيمًا، ما لكم لا توقرونه توقيرًا يليق به، فالتعظيم من أعظم أسباب تحقيق التوحيد، فإذا نَمَّى العبد في قلبه تعظيم الله -جل وعلا- حصل له هـٰذا.
مما يفيده تعظيم الله -جل وعلا- امتثال أمره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وترك نهيه، مما يفيده تعظيم الله – جل وعلا- تعظيم ما عظمه الله –جل وعلا- من الأماكن والأزمنة والأشخاص والأشياء، ويدلّ لذلك قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾( ). فجعل تعظيم ما عظمه الله- شعائر الله: أي هي الأمور التي عظمها -جل وعلا – جعل ذلك- دليلاً على صلاح القلب وتقواه.
مما يفيده تعظيم الله -جل وعلا- ويثمره أن قلب المُعَظِّم لله -جل وعلا- ينزعج ويغضب إذا انتُهكت حدود الله -جل وعلا–، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومن علامات التعظيم الغضب لله إذا انتهكت محارمه.
فهـٰذه فوائد تبين لك أن تعظيم الله -جل وعلا- هو مصدر خير كثير، هو مصدر التوحيد، هو مصدر الاستقامة على الشريعة، ومصدر تعظيم ما عظمه الله -جل وعلا-، هو مصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سياج الإيمان وعِصَامُه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾( ). فإذا ضَعُف التّعظيم في القلب حصل الاختلال في هـٰذه الأمور كلها، ومن أعظم ما يحصل به الإنسان تعظيم الله -جل وعلا- في قلبه مطالعة ما ذكره الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن هـٰذا من أعظم ما يبعث القلب على تعظيم الرّب، إذا قرأ قول الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾( ) بَعَثَ في قلبه تعظيم هـٰذا الذي له الكبرياء في السمٰوات والأرض، إذا قرأ: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾( ) بعث هـٰذا في قلبه تعظيم الله -جل وعلا-؛ لأنه مُتَسَمٍّ بهـٰذه الأسماء البالغة المنتهى في الحسن، إذا قرأ قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( ) بعث في قلبه تعظيم الله -جل وعلا-؛ لأنه الذي لا أعلى مما وصف به نفسه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾( ) .
المهم أن من أعظم ما يورث القلب التعظيم مطالعة ما أخبر الله به عن نفسه في أسمائه وفي أوصافه وفي أفعاله.
أيضاً مما يبعث في قلب العبد التعظيم التفكر في آلاء الله -عز وجل-، في الآيات التي في السمٰوات وفي الأرض، ويدلك لهـٰذا هدي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : فإنه إذا استيقظ من الليل مسح وجهه ونظر إلى السماء، وكان يقرأ قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السمٰوات وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السمٰوات وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هـٰذا بَاطِلاً﴾( ) إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. فالنظر في الآيات الآفاقية، النظر في الآيات الخلقية الكونية في الأنفس وفي الآفاق مما يُورث تعظيم الرّب المدبِّر لهـٰذه الأمور، الذي ما من حركة ولا سكون إلا بعلمه -جل وعلا-، هـٰذه أمور تُعين الإنسان على تعظيم الله –جل وعلا-، قراءة هدي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومنه ما في هـٰذا الباب الذي ذكره المؤلف –رحمه الله– من حديث جُبير بن مطعم دالٌّ على تعظيم الله، ويشجع على تعظيم الله؛ لأنه يقرأ كيف كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُجِل ربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إذا سمع ما فيه تنقيص لشأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
المهم أن الأسباب التي يحصل بها تعظيم القلب الرب -جل وعلا- كثيرة، فينبغي للمؤمن أن يطلب هـٰذه الأشياء وأن يهتم بها؛ لأنه مثل ما بينا قبل قليل إذا استقام في القلب تعظيم الله -جل وعلا- استقامت أحواله كلها، ونحن نعرف يا إخواني أن التعظيم أحد قطبي العبادة اللذين لا تقوم إلا بهما، قال ابن القيم رحمه الله:
وعبادة الرحمـٰن غاية حبه
مع ذل عابده هما قطبان
الذُّل لمن يكون؟ إنما يكون الذل للعظيم.
نقرأ: يقول رحمه الله: (عن جبير بن مطعم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس) بَيَّنا المعنى (وجاع العيال) أي من يعولهم هـٰذا الأعرابي، والمقصود عيالُ كل ذي عيال، يعني كل من له عيال يعولهم (وهلكت الأموال) والأموال يشمل من جملة ما يشمل بهيمة الأنعام، (فاستسق لنا ربك) أي: اطلب لنا السقيا من الله جل وعلا.
ثم قال: (فإنا نستشفع بالله عليك). أي: نطلب شفاعة الله -جل وعلا- إليك أو عندك كما تقدم، فإن عليك هنا بمعنى إليك أو عندك، وذكرنا الشواهد لهـٰذا.
(وبك على الله). أي: ونستشفع بك على الله، أي: نطلب وساطتك عند الله -عز وجل-. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((سبحان الله، سبحان الله!)). أي: أُنزه الله -جل وعلا- عن هـٰذا القول. ومعلوم أن سبحان الله كلمة دائرة على التنزيه، والمنزه بها هو الله -جل وعلا- في هـٰذا السياق: سبحان الله، وهي لا تكون إلا لله، لا تُقال في حق غيره -جل وعلا- دائرة على التنزيه، والتنزيه إما أن يكون تنزيهاً عن نقص، وإما أن يكون تنزيهاً عن عيب، وإما أن يكون تنزيهاً عن مماثلة ومشابهة، هـٰذا ما تدور عليه كلمة سبحان الله، فينزه العبد بها الله -جل وعلا- عن النقص في صفاته؛ لأن صفاته كاملة وله المثل الأعلى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾( ). يُنزه العبد ربه سبحانه وتعالى عن العيب، وهو ما وصفه به الجاهلون، ومنه هـٰذا الذي جرى من الأعرابي حيث قال: (نستشفع بالله عليك). أي: نطلب وساطة الله عندك، يعني: نطلب من الله أن يتوسط لنا عندك. وهـٰذا لا يليق بالله -جل وعلا-؛ لأن الأمر كله في يد الله -جل وعلا-، فلا يُطلَب من الله أن يشفع عند أحد من الخلق، بل الشفاعة له تُطلب منه -جل وعلا- لا تُطلب منه إلى غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولذلك سبح النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربه حتى عُرف ذلك في وجهه، أي: عُرف التغير في وجهه من شدة ما وقع في نفسه من هـٰذا القول الذي فيه الإخلال بالأدب في حق الله، وفيه الجهل به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وبما يجب له من التعظيم.
قال -رحمه الله- في سياق حديث جبير: (فمازال يسبح حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه). أي: تغيرت وجوه أصحابه لما رأوا من المشقة التي لحقت بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسبب هـٰذا القول.
(ثم قال) القائل هو النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((وَيحك)) وهـٰذه الكلمة الأصل فيها أنّها للترحّم، وهي مقابل ويلك، فكلمة (ويح) مقابل كلمة (ويل) تَرِد للترحّم وَتِرد للتعجّب أيضاً، وتَرِد في بعض الأحيان بمعنى كلمة ويل، وهي هنا على هـٰذا الاستعمال، أي: إنها ليست للترحّم؛ لأنها لا تقال في مثل هـٰذا السّياق، بل هي للتنفير والتحذير، ولذلك قال له: أتدري ما الله؟ سؤال تعجّب من حال هـٰذا القائل، ((أتدري ما الله؟)) أي: أتعلم عمّن تتكلم؟ أتدري ما شأن الله؟ ثم بَيَّن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: ((إنّ شأن الله أعظم من ذلك)). أي: أمره -جل وعلا- وما يجب له أعظم مما تقول، فإنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك. ((إنه لا يُستَشفَع بالله على أحد)) وهـٰذا بيان الإنكار، أو بيان المنْكَر في قول الأعرابي. ((إنه لا يُستَشفَع بالله على أحد)) وقوله: ((أحد)) نكرة في سياق النفي، فتشمل كل أحد: تشمل الملائكة والجن والأنبياء؛ لأنّ شأن الله أعظم من ذلك، فإليه تُطلب الشفاعة -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، لا تطلب الشفاعة منه إلى غيره جل وعلا.
يقول المؤلف: (وذكر الحديث). والحديث فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيّن وصفًا من أوصاف الله -عز وجل- فقال: ((إن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيده كالقبة)). وهـٰذا فيه بيان عظيم ما له، فإذا كان هـٰذا شيئاً مما خلقه الله -عز وجل- ، فإذا كان شأنه كذلك فهو العظيم الذي لا تُطلب الشفاعة منه إلى غيره، بل تُطلب إليه الشفاعة جل وعلا.
وهـٰذا الحديث قد ضعّفه جماعة من العلماء؛ لوهنٍ في بعض رواته، ولاختلاف فيه أيضاً، إلا أن ابن القيم –رحمه الله– نافح عن هـٰذا الحديث منافحة شديدة انتهى بها إلى تصحيح الحديث، وقد حسّن الحديث الإمام الذهبي، فهو حديث لا بأس به.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك.
[الشرح]
وهـٰذا يفيد أنه ينبغي للإنسان أن يُنكِر القول الذي فيه نكارة، فيه تنقص لله -عز وجل- ، ولو كانت نية صاحبه سليمة، بل ينبغي له أن يبين ما يجب لله من التعظيم في القول، وإن كان القلب سليماً من النقص في حق الله -عز وجل-.
[المتن]
الثانية: تَغَيُّره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هـٰذه الكلمة.
[الشرح]
وذلك لعظيم ما في قلب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من تعظيم الرب -جل وعلا–، حيث بدا أثر هـٰذه الكلمة عليه في وجهه وفي قوله: في وجهه عرف الصحابة مشقة هـٰذه الكلمة عليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وأما في قوله فهو تسبيحه ربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ((سبحان الله سبحان الله!)) حتى تأثر الصحابة لما وقع من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وما وقع له من المشقة والعنت بسبب هـٰذه الكلمة.
[المتن]
الثالثة: أنه لم يُنْكِر عليه قوله: نستشفع بك على الله.
[الشرح]
لأن هـٰذا واقع، وكانوا يستسقون بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، كما جاء ذلك في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة، وفي غيرها من الوقائع والشواهد الدالة على أنهم كانوا يطلبون من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يَشفع إلى الله -عز وجل- لطلب السقيا وذلك بالاستسقاء، وقد قال عمر: ((إنا كنا نستسقي بنبيك، وها نحن نستسقي)) أو: ونحن ((نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس استسق)). فهـٰذا يدل على أنهم كانوا يستسقون بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويطلبون شفاعته عند الله في نزول السقيا.
[المتن]
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله.
[الشرح]
وأنها تَرِد بتنزيه الله -عزّ وجل- عن النقص في صفاته أو العيب، فإن من ظن أنه تُطلب شفاعة الله إلى أحد من خلقه لم يَقْدُر الله حق قدره -جلّ وعلا–، فسبحان الله تطلق ويراد بها:
• تنزيهه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن النقص في صفاته.
• تنزيهه عن العيب وما وصفه به الجاهلون.
• والثالث: عن مماثلة أحد من خلقه له في شيء من صفاته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
كما قال الله جل وعلا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾( ).
[المتن]
الخامسة: أنََّ المسلمين يسألونه الاستسقاء.
[الشرح]
أي يسألونه طلب السُّقيا، وهـٰذا أدلته كثيرة كما تقدم.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في حماية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِمَى التوحيد، وسَدِّه طرق الشرك
عن عبد الله بن الشِّخِّير -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلنا: أنت سيدنا. فقال: ((السيد الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)). قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً. فقال: ((قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان)). رواه أبو داود بسند جيد.
وعن أنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن ناساً قالوا: يا رسول الله! يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا. فقال: ((يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينّكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجل)). رواه النسائي بسند جيد.
[الشرح]
هـٰذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: فإن المؤلف –رحمه الله– بعد أن قدّم ما تقدم من الأبواب الكثيرة التي فيها بيان حق الله -جل وعلا- في القول والعَقْدِ والفعل جاء إلى خاتمة الكتاب، وبين لنا –رحمه الله– في هـٰذا الباب ما كان عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من حماية حِمَى التّوحيد –أي: حريم التوحيد- فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان كما سنتكلم في الباب ينافح عن التوحيد أشد المنافحة، وكان يصون حق الله -عز وجل- أعظم صيانة.
أما مناسبته للباب الذي قبله: فإن في الباب الذي قبله نوع حماية من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لحق الله -عزّ وجل- وتوحيده، حيث أنكر على الأعرابي لما قال: ((نستشفع بالله عليك. فقال له: سبحان الله، سبحان الله! أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك)).
وقول المؤلف –رحمه الله–: (وسده طرق الشرك) يبيّن لنا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سد الطرق المُفضية إلى الشرك، فهو منع الشرك، ومنع كل وسيلة تُفْضي إليه، وهـٰذا لا إشكال أنه بَيِّنٌ من عدّة شواهد وفي عدة حوادث من سيرة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، لكن تقدّم لنا في كتاب التوحيد باب يَقْرُب من هـٰذا الباب، وهو قوله –رحمه الله– فيما ترجم: (باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد). فما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين كما قال شيخنا عبد العزيز بن باز –رحمه الله–: أنه في الباب السابق ذكر الحماية الفعلية وفي هـٰذا ذكر الحماية القولية، فاكتمل بهـٰذا تمام صيانة التوحيد وتمام حمايته من أن يُنال وأن يُنقص، حيث إنّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صانه قولاً وفعلاً.
قال –رحمه الله– في ما نقله عن عبد الله بن الشخير -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلنا) أي: هـٰذا الوفد (أنت سيدنا) يخاطبون النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((السيد الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)). هم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- لما قالوا للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أنت سيدنا أخبروا بالواقع، فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سيد ولد آدم كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)). فأخبر ثم بيّن أن هـٰذا الإخبار لا فخر فيه ولا علو ولا ارتفاع، إنما هو تبليغ وبيان للمرتبة التي منحه الله إيّاها وشرّفه بها، والسّيادة ثابتة له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سيادة الشّرف والرِّياسة، فإنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشرف الخلق عند الله يوم القيامة وهو أشرفهم في الدنيا، ويتبيّن هـٰذا في تراجع أئمة البشر وسادتهم في ذلك الموقف العظيم، حيث ردّوا الشفاعة في فصل القضاء إلى نبينا محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكنّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما كان من هديه محبة التواضع، ومن هديه إبعاد كل ما يخشى أن يتطرق به الإنسان إلى ما هو سوء وشر، لا سيما في ما يتعلّق بجناب التّوحيد وحِمَاهُ- قال لهم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((السيد الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)). وجواب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هنا بيان لمن يستحقّ السّيادة على وجه الإطلاق، ولذلك لم يقل: سيدكم الله، إنما قال: السيد- الذي له كمال السّؤدد والسيادة والرياسة والعلو والشّرف على وجه الإطلاق- هو الله تعالى؛ لأنّه مالك الخلق وإليه مرجعهم، وهم عنه -أي عن أمره- صادرون، لا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً، حاجاتهم لا يقضيها إلا هو، أمورهم لا يدبرها إلا هو -جل وعلا-، فهو السيد على وجه الإطلاق.
وبهـٰذا فُسِّر اسم الله الصَّمَد، فإن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال في بيان معنى الصمد: السيد الذي كَمل في سؤدَدِهِ، أي: في علوه وملكه وشرفه وسيادته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
فقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((السيد الله)). هـٰذا فيه الخبر عن أن السيادة له وحده على وجه الإطلاق، وأما غيره: فاختلف العلماء –رحمهم الله– في إطلاق هـٰذا اللفظ على غير الله، والأقوال في هـٰذا أربعة:
القول الأول: أنّ هـٰذا اللفظ لا يجوز إلا لله؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((السيد الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)).
القول الثاني: أنه يجوز إطلاقه على الله وعلى غير الله، لكن الإطلاق على وجه الإطلاق- يعني: التلفّظ بهـٰذا الاسم على وجه الإطلاق- لا يكون إلا لله -عز وجل-، فيكون من الأسماء التي يصح أن يتسمّى بها الخلق وأن يُوصف بها الخلق على المعنى اللائق بهم، لكن لا يجوز أن يكون ذلك على وجه الإطلاق.
القول الثالث: أنّه لا يجوز إطلاقه على الله، وهـٰذا قول الإمام مالك. قالوا في تعليل هـٰذا: لأنّه لم يرد في الكتاب ولا في الأحاديث المشهورة وصف الله ولا تسميته بهـٰذا، وقالوا: لأنّ السيادة مكتسبة من المسُود، يعني: متى يكون السيّد سيِّدًا؟ إذا علا على قومه وشرف فيهم، فهم مشاركون له في استحقاق هـٰذا الوصف، إذ لو كان منفرداً لما كان سيّدًا، فقالوا: لا يليق أن يوصف الله -جل وعلا- بهـٰذا.
القول الرابع: التفريق بين ما كان معرفًا بالألف واللام فلا يجوز إلا لله، وما كان غير معرف بالألف واللام فإنه يجوز إطلاقه على الخلق، ومنه قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأصحابه لما جاء سعد بن معاذ ليقضي في بني قريظة: ((قوموا لسيدكم)) فإنه لم يأت معرفًا، ويُشكل على هـٰذا أنهم هنا لم يقولوا: أنت السيد، إنما قالوا: أنت سيدنا.
الصحيح: أنه لفظ يجوز إطلاقه على الله -جل وعلا- وعلى غيره. أما إطلاقه على الله: فلأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر بذلك فقال: ((السيد الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)). وثبوته بالسّند الصحيح يكفي في إثبات ذلك، ولو لم يرد في القرآن، ولو لم يرد في الكتب المشهورة والأحاديث الصحيحة المشهورة؛ لأن العمدة على الثبوت، فإذا ثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أي وجه كان فإنه يثبت هـٰذا الوصف لله –سبحانه وتعالى–، لكن التلفظ بهـٰذا على وجه الإطلاق الذي يصبح كالعلم الذي لا يعرف إلا به فهـٰذا لا يجوز إلا في حق الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، كغيره من الأسماء: كالسميع، والبصير، والرؤوف، والرحيم، فهـٰذه أوصاف وأسماء يجوز أن يتصف بها الإنسان ويتسمى بها، لكنه لا يُسَمى بها ولا يوصف بها على وجه الإطلاق.
ثم هل السيد من أسماء الله -عز وجل- ؟
بعض العلماء قال: إنه من أسماء الله، وقال آخرون: إنه ليس من أسماء الله، إنما هو وصف. ولعل الذين قالوا: إنه ليس من أسماء الله إنما هو وصف له، بناء على أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يبتدئ الإخبار بذلك، إنما جاء به على وجه الجواب لمن قالوا له: أنت سيدنا، والمسألة تحتاج إلى تحرير، ولكن أكثر العلماء على أنه ليس من الأسماء.
ما وجه إنكار النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟
قلنا: وجه إنكاره: خشيته أن يتطرق إلى ما هو أشد منه كما سيتبين من آخر الحديث، وأيضاً كراهية مواجهة الإنسان بهـٰذا الاسم، حتى ولو كان سيدًا شريفًا فإنه لا يواجه به، فلا يقال: يا سيدي أو: يا سيدنا في مخاطبة الشخص، ومن قيل له ذلك فينبغي له أن ينبه إلى أن الأولى ترك هـٰذا، فليس فيه النهي عن إطلاق هـٰذا اللفظ على وجه العموم، إنما فيه النهي عن إطلاق هـٰذا اللفظ فيما إذا كان مخاطَباً فيه الإنسان نفسه؛ لأنه يخشى أن يتطرق إليه شيء من العلو والارتفاع.
(قلنا: وأفضلنا فضلاً). بَيَّن عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ما قالوه في النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (وأفضلنا فضلاً). أي: أفضلنا خيرًا وتقدمًا. قال: (وأعظمنا طولاً). أي: أعظمنا غنىً وجاهًا. فقال: ((قولوا بقولكم أو بعض قولكم)) أو: هنا للشك وليست للتنويع، وهي شك من الرواة؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إما أن يكون قال لهم: قولوا بقولكم، أو: قولوا ببعض قولكم، ويبعد أن يقول لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وبعض العلماء يقول: إن أو هنا ليست للشك إنما هي للتنويع، والأقرب أنها للشك من بعض الرواة.
((ولا يَستَجرِيَنَّكُم الشيطان)) أي لا يجعلكم جَرِيّاً له -بدون همز-، لا يجعلكم جَرِيّاً له، أي: لا يجعلكم وكلاء له، فالجري: هو الوكيل، وسمي الوكيل (جَرِيّاً) -بدون همز- لأن الوكيل يجري مجرى من وَكَّلَهُ، فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا يستجرينكم الشيطان)) أي: لا يجعلكم وكلاء له في الغلو والوقوع في ما لا يُحمد، وهـٰذا بيان للعلة التي جاء من أجلها النهي عن الإطناب في المدح والثناء، وهي أنهما وسيلة للعلو هـٰذا في الممدوح، ووسيلة للوقوع في الغلو في الصالحين مما قد يكون سببًا لعبادتهم من دون الله، فهي سبب للعلوّ وسبب للغلو، سبب للعلو في الشخص نفسه، وسبب للغلو في ما يتعلق بغيره.
(رواه أبو داود بسند جيد) وهو كما قال الشيخ رحمه الله.
(وعن أنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن ناسًا قالوا: يا رسول الله! يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا).
(يا خيرنا) لا إشكال في أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خير الصحابة، بل هو خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو خير الخلق على الصحيح، ويدل لهـٰذا أن عمر دخل عليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو في بيته متكئ على الحصير قد أثر الحصير في جنبه فقال: ((يا رسول الله أنت رسول الله وصفوته من الخلق)). والصفوة إنما يكون في الخير المصطفى، وأقره النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على هـٰذه الكلمة، فدل ذلك على أنه خير الخلق. وبعض الناس يتوقف في إطلاق مثل هـٰذا على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويقول: ما الدليل على أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خير الخلق؟ نقول: الدليل هـٰذا الحديث وهو إقراره لعمر في ما قال.
وأما قول: (وابن خيرنا) فهو ابن خيرهم من حيث النسب، ولذلك جاء في بعض الروايات: ((يا خير قريش)). فالخيرية هنا في الأب ليست خيرية الدين والتقوى والإيمان، إنما خيرية النسب، فهو خيار من خيار -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(وسيدنا وابن سيدنا) وهـٰذا تقدّم الكلام عليه. فقال: ((يا أيها الناس قولوا بقولكم)) وهنا فيه الجزم وعدم الشك، حيث لم يقل: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، بل قال: ((قولوا بقولكم)) يعني: بالذي تقولون، وذلك لأنه حق كما تبين، ولو كان باطلاً لما أقرَّهم عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ثم قال: ((ولا يستهوينكم الشيطان)) أي: لا يُوقعنكم في الهُوِيِّ والسقوط في ما لا تُحمد عقباه.
((أنا محمد عبد الله ورسوله)): وهـٰذا تكرّر منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مواضع عديدة، يؤكد ويبين أن خير ما يوصف به أنه عبد الله ورسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ((أنا محمد عبد الله)) والعبودية هنا: العبودية الخاصة، بل أعلى درجات العبودية الخاصة، ما الفرق بين العبودية الخاصة والعامة؟ يعني: عبودية القهر والقَدَر، هـٰذا الفرق بينهما، عبودية القهر والقَدَر، العبودية الخاصة هي عبودية الاختيار، وأما العبودية العامة فهي عبودية كل شيء المؤمن والكافر والجماد والحي، هـٰذه هي العبودية العامة، وهي عبودية القهر والقَدَر لا يخرج عنها أحد كما قال الله جل وعلا: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً﴾( ). ((ورسوله)) أي: هو من اصطفاه رسولاً، فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الله وهو رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
((ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي)) وهـٰذا فيه أن الغلو والإطناب في المدح سبب للارتفاع بالرجل فوق منزلته. ((ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله -عز وجل-)) ما هي المنزلة التي أنزلها الله -عز وجل- رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ أنه عبد الله ورسوله، ولذلك قال في حديث عمر في الصحيح: ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله)). اللهم صل وسلم على رسول الله.
(رواه النسائي بسند جيد) وهو كما قال.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تحذير الناس من الغلو.
[الشرح]
هـٰذا واضح في الحديثين.
[المتن]
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا.
[الشرح]
ماذا ينبغي أن يقول؟ (السيد الله). والعجب كل العجب من بعض إخواننا الذين يقدمون للمشايخ والعلماء في محاضراتهم ودروسهم، يطنبون في المدح حتى يقصموا ظهر الرجل، وقد سمعت أحدهم يقدم لآخر يقول: أنت الذي لو عرفت الأشجار قدرك لمدت أغصانها تصافحك. وهـٰذا شريط يوزع ويباع في الناس، وهـٰذا قد لا يستجيز الإنسان أن يقوله في الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، فضلاً عن أمثالنا وأمثال أهل هـٰذا العصر، فينبغي الترشيد في المدح؛ لأن الغلو في المدح يُورِد ويسبب وينتج الغلو في القدح؛ لأنّ كل غلو لا بد أن يقابله غلو من الطرف الآخر، والقصد والاعتدال هو أن يسلك الإنسان السبيل القويم، فيعطي الناس حقهم من الإجلال والتقدير دون زيادة. هـٰذا رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع أنهم وصفوه بوصف مطابق لا يستحقه غيره- قال: ((السيد الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-)). وتجد الواحد منهم إذا مُدح سكت وقد يرضى ولم يعلق بشيء ، ما هو صحيح يا أخي، المفروض أن يفعل كما فعل شيخنا –رحمه الله– لما قال له أحد الناس: أنت غني عن التعريف. أخذ الميكرفون وقال: هـٰذا لا يصلح إلا لله -عز وجل-. ينبغي للإنسان أن يكون حازمًا في مثل هـٰذه الأمور؛ لأن ترك الناس مع أهوائهم -لا سيما أهل الأدب والذين يتوسعون في العبارات- يوقع في مهالك وإشكالات كبيرة، ويظن أن هـٰذا من إجلال الشيخ وتقديره ومن إعطائه حقه، ونحن ندعو للتوحيد ونقول: التوحيد أهم ما يدعى إليه، ثم نخالفه على رؤوس الخلائق وفي منابر المساجد، وهـٰذا غلط، يعني: ينبغي أن نتكاتف ونتعاون في التنبيه عليه سواء من جهة المُقَدِّمِين أو من جهة الممدوحين، الممدوح إذا رأيته قد سكت يا أخي قل له: لا يجوز لك هـٰذا، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -مع أنه أحق من يُثنى عليه ويُمدح- يرد بهـٰذا الرد، ويبين للناس أنه ما ينبغي مثل هـٰذا، لا يتجاوز الإنسان الوصف المطابق المُقَارِب لحال الشخص، أما أن يغلو ويتجاوز فهـٰذا سبب لوقوع شر كبير.
[المتن]
الثالثة: قوله: ((لا يستجرينكم الشيطان))، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
الرابعة: ((ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي)).
[الشرح]
وكل هـٰذا يشهد لما ذكره المؤلف –رحمه الله– من أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَمَى حِمَى التوحيد، وسد الطرق الموصلة إلى الشرك بكل طريق وبكل وسيلة، سواء كان ذلك من الأفعال أو من الأقوال.
¹
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
[المتن]
باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾( ).
عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا محمد! إنَّا نجد أن الله يجعل السمٰوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى بدت نواجذه، تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.
وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السمٰوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: ((يطوي الله السمٰوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)).
وروي عن ابن عباس، قال: ((ما السمٰوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)).
وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ما السمٰوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرس)). قال: وقال أبو ذر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)).
وعن ابن مسعود قال: ((بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماءين خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)). أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق.
وعن العباس بن عبد المطلب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((هل تدرون كم بين السماء والأرض؟)). قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ((بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكِثَف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم)). أخرجه أبو داود وغيره.
[الشرح]
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
قال المؤلف –رحمه الله– في آخر كتاب التوحيد: (باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾( ) ) هـٰذا الباب ختم به المؤلف -رحمه الله- كتاب التوحيد، وقد أحسن غاية الإحسان حيث ختم الأبواب المتعلقة بتحقيق التوحيد بهـٰذا الباب الذي يورث قلب العبد تعظيم الرب -جل وعلا-؛ لأن فيه من أوصاف الله -عز وجل- وعظيم قدرته ما تَجِلُ له القلوب، وما تُعَظِّم به القلوب ربها، ولذلك كان الله –جل وعلا- في ذكره للمشركين في عدة مواضع يُذكرهم ما هم عليه من خطأ، ويبين لهم أن ما وقعوا فيه بسبب ضعف تعظيمهم، ومن ذلك هـٰذه الآية: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. فإنه ذكرها -جل وعلا- في مواضع نسب إليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ما لا يليق به، إما من الشرك أو من أن الكتاب منزل من غيره، فقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾. قولهم وعملهم وعقدهم إنما هو لسبب ضعف تعظيمهم، فقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ أي ما عظموه جل وعلا ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي حق تعظيمه، ولو أنهم عظّموه حق تعظيمه لما وقعوا في ما وقعوا فيه من الشرك ونسبة الباطل إليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
ثم بَيَّن شيئاً من عظيم قدرة الله الدال على عظيم قدره جل وعلا: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعاً﴾ أي كُلُّها، وليست الأرض التي نحن عليها فقط، بل جميع الأرضين السبع ﴿قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي في قبضته -جل وعلا-، وذلك على وجه الحقيقة، لا على وجه كمال الإحاطة والتصرف، كما يدل لذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث التي فيها أنَّ الله يطوي السمٰوات والأرض بيده، فأخبر الله -جل وعلا- في هـٰذه الآية بأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يطوي الأرض في يمينه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كما قال: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السمٰوات مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾. فالسمٰوات تُطوى في يمين الرب -جل وعلا- كما يطوي السجل الكُتُب: أي المكتوب.
قال رحمه الله: (عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).
(حبر) أي: عالم، وسمي الحبر حبرًا قيل: من الحِبر؛ لأنه يستعمل الحِبر في الكتابة، وقيل: إنه من البحر، مقلوب.
قال في حديث ابن مسعود: (قال ابن مسعود: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السمٰوات على إصبع). السمٰوات العظيمة المتعددة كلها على إصبع واحد من أصابع الرحمـٰن -جل وعلا-، وهـٰذا يدل على عظيم قدرة الرب سبحانه وبحمده. ولا يرد في قلبك التكييف، فاصرفه عن قلبك حتى تطمئن وتستفيد من هـٰذا الحديث، فإن السمٰوات العظام الشِّداد على إصبع واحد من أصابع الرحمـٰن -جل وعلا- (والأرضين على إصبع). والمقصود بالأرضين: السبع على إصبع (والشجر على إصبع) وهـٰذا مما في الأرض (والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع). أي: بقية خلق الله -جل وعلا- على إصبع (فيقول: أنا الملك). هـٰذا من كلام من؟ من كلام الحبر. وجاء في بعض الروايات أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حدث أصحابه بهـٰذا قبل مجيء الحبر، فجاء الحبر فقال: يا أبا القاسم ألا أخبرك بما يكون يوم القيامة؟ فأخبره بهـٰذا الخبر، فصَدَّق ما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أصحابه. (فضحك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى بدت نواجذه). أي: أنيابه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ضحك تصديقًا لقول الحبر، (ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾). ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ قراءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هـٰذا الموضع لهـٰذه الآية هو تفسير لها وبيان لمعناها، وأن قوله تعالى: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ هو معنى ما ذكر في هـٰذا الحديث من جعله الأرضين على إصبع.
(وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن) جل وعلا وهو على كل شيء قدير (فيقول: أنا الملك، أنا الله). وإنما يقول: أنا الملك -مع أنّه الملك في الدنيا والآخرة- لظهور ملكه وتفرده به، وهـٰذا هو السر في قول الله -عز وجل- في سورة الفاتحة: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾( ). أي يوم الجزاء والحساب، فإنه لا مالك في ذلك اليوم إلا هو -جلّ وعلا-، وكل صاحب ملك يزول مُلكه، ولا يكون في ذلك اليوم إلا مملوكاً لله جلّ وعلا.
(أنا الله): وهـٰذا فيه الإخبار عن أنه الله الذي لا إله غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
(وفي رواية البخاري: يجعل السمٰوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع). وهـٰذا يفيد أن أصابع الرب -جل وعلا- متعددة، وإياك والتكييف، وإياك والتحريف، فإنهما سوءتان وقع فيهما جماعة ممن ضاقت عقولهم وقلوبهم عن إدراك ما أخبر الله به عن نفسه، وعن تصديق خبر الله ورسوله.
فالواجب في هـٰذه النصوص ما جرى عليه هدي السلف الصالح من الإيمان بها والتصديق، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.
قال: (ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: ((يطوي الله السمٰوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)) ). وهـٰذا طي حقيقي كما قال الله جل وعلا: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾( ). السجل: قيل: الكاتب، يعني: كما يطوي الكاتب كتابه. وقيل: السجل: هو المكتوب فيه، فكما أن السجل الذي هو محل الكتابة يحوي المكتوب ويطويه فكذلك طي الله -جل وعلا- للسمٰوات والأرض: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾.
((يطوي الله -جل وعلا- السمٰوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيمينه)). وهو -جل وعلا- على كل شيء قدير ((ثم يقول: أنا الملك)). وذكرنا السر في أنه ذكر هـٰذا الاسم دون غيره ((أنا الملك)) ما السر في ذكر هـٰذا الاسم دون غيره من الأسماء؟ انفراده -جل وعلا- بالملك، وأنه لا مالك غيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ((أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)) ولماذا خص هذين بالسؤال؟ لأنهم أصحاب العلو، ولأنهم الذين ينازعون الله وصفه الذي اختص به، فالجبار لا يليق إلا به -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهو الجبار، والتكبر لا يليق إلا به جل وعلا: ﴿ولَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾( )، فكل من نازع الله شيئاً من أوصافه كان يوم القيامة حقيراً ذليلاً مسؤولاً عنه بهـٰذا السؤال: ((أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)) وكل من عَبَد غير الله فهو متكبر، وكل من عادى أولياء الله وكذب رسله فهو جبار وكذلك متكبر.
((ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله)) هكذا في رواية مسلم، وفي رواية غيره قال: ((ثم يأخذهن بيده الأخرى)) دون ذكر الشمال، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في وصف يدي الله -عز وجل-: ((وكلتا يديه يمين)). هـٰذا في الخير والبركة.
قال: ثم يقول: ((أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)). يَرُدُّ القول ثانيًا لبيان انفراده وأنه لا مجيب له؛ لأنه في ذلك اليوم لا تسمع همساً، فلا أحد يتكلم: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً﴾( ) فتعنو الوجوه: تذل له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، والذل يقتضي عدم الكلام، فتخشع له الأصوات ولا تسمع يومئذ إلا همساً، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
(وروي عن ابن عباس قال: ((ما السمٰوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمـٰن إلا كخردلة في يد أحدكم)).) وهـٰذا فيه بيان عظيم قدر الله -جل وعلا- وأنه الكبير المتعال سبحانه وبحمده، هـٰذا الخلق العظيم من خلق الله -جل وعلا- هو في يد الله -جل وعلا- في كف الرحمـٰن كالخردلة في يد أحدنا، والخردلة هي من أدق ما يكون، قد لا تدركها العين ولا تراها. وكل هـٰذه الآثار مقصودها والمراد منها بعث التعظيم في القلوب، وأن تعظيم الله -جل وعلا- سبب لأي شيء؟ سبب لتحقيق التوحيد.
(وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ما السمٰوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس). (دراهم سبعة) إشارة إلى عدد السمٰوات وألقيت في تُرس، والترس يستوعب الدراهم ولا تتبين فيه تبيناً واضحًا. والحديث الأول أبلغ في بيان دقة السمٰوات والأرض في كف الرحمـٰن -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وحديث ابن عباس أثبت مما ذكره عن ابن زيد فيما رواه عن أبيه.
قال: (وقال أبو ذر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- : سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ((ما الكرسي في العرش)).) وكل هـٰذا خلق الله، والكرسي أعظم من السمٰوات، فإذا كانت السمٰوات في الكرسي على هـٰذه الحال، والكرسي في العرش على ما يأتي في حديث أبي ذر: ((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)) تَبَيَّن لك عظيم قدر الرب -جل وعلا-، إذا كان هـٰذا شأن خلقه فكيف هو –سبحانه وبحمده–؟ وهـٰذا من قياس الأولى، فإن الله -جل وعلا- وصف نفسه بعظيم الصفات الدالة على عظيم قدره.
فالسمٰوات على عِظَمِها في الكرسي: كالدراهم في الترس، والكرسي في العـرش على عظمه- لقوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السمٰوات وَالأَرْضَ﴾( ) في العرش- كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة -صحراء من الأرض- كيف تتبين وكيف يوقف عليها؟ وشأن الرّب -جل وعلا- أعظم من ذلك، لا إله إلا هو الكبير المتعال.
فإذا أدرك العبد هـٰذه الأمور بعث ذلك في قلبه تعظيم الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وإجلاله سبحانه حق إجلاله.
ما الفرق بين الكرسي والعرش؟
الكرسي: قال ابن عباس: موضع القدمين. وأما العرش: فهو الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا واختصه بالاستواء، وذكر ذلك في مواضع عديدة من كتابه عدها بعض العلماء بسبعة مواضع: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾( ). وقال بعض العلماء في الكرسي: إنه خلق من خلق الله عظيم، ولا نقول: إنه موضع القدمين ولا غير ذلك؛ لأن الأثر الوارد عن ابن عباس في ذلك ضعيف.
قال: (وعن ابن مسعود قال: ((بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماءين خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)).) سبحانه وبحمده.
وهـٰذا بيان لعظيم خلق السمٰوات والأرض، وإذا كان هـٰذا شأن هـٰذا الخلق كما وصف قال: ((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة)) فكيف بالربّ جل وعلا؟ وكيف بهـٰذه الأشياء في الكرسي؟ وكيف بها في العرش؟
قال رحمه الله: (أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زِر عن عبد الله) يعني: عن عبدالله بن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (ورواه بنحوه عن مسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وله طرق) أي: يقوي بعضها بعضاً ويثبت بهـٰذا، فإذا ثبت هـٰذا فإنه مما لا يقال بالرأي، بل لا بد أن يكون مما تلقاه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(وعن العباس بن عبد المطلب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((هل تدرون كم بين السماء والأرض؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ((بينهما مسيرة خمسمائة عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام، وكِثَف- وفي بعض الروايات: ((غلظ)) -كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم)). أخرجه أبو داود وغيره). وهـٰذا من الطرق التي أشار إليها الذهبي – رحمه الله– في قوله: وله طرق. فقد جاء هـٰذا من طرق عديدة، وهو ثابت من حيث الجملة؛ لتعدد الطرق التي ورد بها هـٰذا الخبر.
إلا أنَّه قد ورد اختلاف في إحصاء ما بين السماء والأرض، ففي هـٰذه الآثار التي ذكرها المؤلف في حديث العباس وفي ما ذكره ابن مسعود أن قدر ما بين كل سماء وأخرى كم؟ خمسمائة عام، وفي بعض الروايات أنه واحد وسبعون واثنان وسبعون عاماً، فجمع العلماء بين الاختلاف في التقدير بأنه اختلاف باعتبار السير، فهـٰذا اختلاف باعتبار قَدْر السير، فالسير البطيء الهين الذي جاء الخبر عنه في أثر ابن مسعود وفي أثر ابن عباس، وأما الأثر الذي فيه أنه إحدى وسبعون سنة واثنتان وسبعون سنة فهـٰذا في السير السريع .
وقال بعض العلماء: إن ذكر السبعين إنما هو للتكثير، لكن يُشْكِل على هـٰذا أنه ذكر فوق السبعين عدداً وهو الواحد والاثنان، وهـٰذا لا يكون للتكثير غالبًا.
وعلى كل حال المقصود من هـٰذه الآثار هو بيان عظيم قدر الرب -جل وعلا-، وإذا عَظَّم العبد قدر ربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فإنه لم يجعل في قلبه لأحد تعبدًا ورقّاً سوى لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير قوله: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.
الثانية: أن هـٰذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود في زَمَنِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم ينكروها ولم يتأولوها.
[الشرح]
خلافًا للمعطلة في هـٰذه الأمة، فإنهم تأولوا هـٰذا وأنكروه وقالوا: إن له معنىً مخالفًا لما أخبر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[المتن]
الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك.
[الشرح]
في قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.
[المتن]
الرابعة: وقوع الضَّحِك من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما ذكر الحبر هـٰذا العلم العظيم.
[الشرح]
تعجبًا منه وتصديقًا له.
[المتن]
الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السمٰوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى.
السادسة: التصريح بتسميتها الشِّمال.
السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
[الشرح]
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟
[المتن]
الثامنة: قوله: ((كخردلة في كف أحدكم)).
[الشرح]
الله أكبر!
[المتن]
التاسعة: عِظَم الكرسي بالنسبة إلى السمٰوات.
[الشرح]
أن السمٰوات كسبعة دراهم في ترس بالنسبة للكرسي.
[المتن]
العاشرة: عِظَم العرش بالنسبة إلى الكرسي.
[الشرح]
واضح : (كحلقة حديد ملقاة في فلاة).
[المتن]
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء.
الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء.
الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي.
الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء.
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء.
[الشرح]
كل هـٰذا جاء في الآثار التي ذكرها المؤلف.
[المتن]
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش.
[الشرح]
وهـٰذا مما أجمع عليه علماء الأمة ودل عليه الكتاب والسنة.
[المتن]
السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض.
الثامنة عشرة: كِثَف كل سماء خمسمائة عام.
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السمٰوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة، والله –سبحانه وتعالى– أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[الشرح]
آمين، اللهم صل وسلم على رسول الله.
نسأل الله -عز وجل- أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يُسْمِعنا ما ينفعنا، وأن يجزي الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله– خير الجزاء، وأن يغفر له وأن يرحمه، وأن يعلي درجته في عليين، وأن يبعث في الأمة من أمثاله مجدّدين.
¹
التصانيف العلمية:
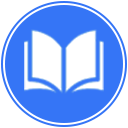 قراءة
قراءة