إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
تأليف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
نبذة مختصرة
إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب: قال المؤلف: أما بعد: فهذه رسالة في «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، والتبرج، والسفور، وخلوة الأجنبي بالمرأة، وسفر المرأة بدون محرم، والاختلاط»، وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي:
المبحث الأول: الحجاب.
المبحث الثاني: التبرج.
المبحث الثالث: السفور.
المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة.
المبحث الخامس: سفر المرأة بدون محرم.
المبحث السادس: شبه دعاة السفور، والرد عليها.
المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والسفور.
المبحث الثامن: الاختلاط.
- 1
إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
PDF 5.4 MB 2019-05-02
- 2
إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
DOC 9.3 MB 2019-05-02
تفاصيل
- إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
- المقدمة
- المبحث الأول: الحجاب
- المطلب الأول: التعريفات: الحجاب، والجلباب، والنقاب، والخمار، والاعتجار، والمقنعة، والبرقع، ودرجات الحجاب
- المطلب الثاني: فضائل الحجاب
- المطلب الثالث: آداب الاستئذان
- المطلب الرابع: غض البصر وفوائده
- المطلب الخامس: الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب
- المطلب السادس: الحكمة من مشروعية الحجاب
- المطلب السابع: شروط الحجاب الإسلامي
- المبحث الثاني: التبرج
- المبحث الثالث: السفور
- المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة
- المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم
- المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها
- المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور
- المبحث الثامن: الاختلاط
- المطلب الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً
- المطلب الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته
- المطلب الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية
- المطلب الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن
- المطلب الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده
- المطلب السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها
- المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب
إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
والتبرج، والسفور، والخلوة بالمرأة الأجنبية، وسفرها بدون محرم، والاختلاط في ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء تأليف الفقير إلى اللَّه تعالى د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
(/)
تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للَّه وبعد: فقد تصفحت رسالة (إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب) والسفور، وما يَتْبَعُ ذلك من مسائل تتعلق في حماية المرأة من دعوات الغربيين والمستغربين، فوجدت هذه الرسالة، والحمد للَّه، مفيدة في موضوعها، وشاملة لكُلّ متطلبات الموضوع، فجزى اللَّه مؤلفها: الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني خير الجزاء، ونفع بما كتب. وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في 6/ 11/ 1432هـ
(1/2)
المقدمة
إن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: فهذه رسالة في «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، والتبرج، والسفور، وخلوة الأجنبي بالمرأة، وسفر المرأة بدون محرم، والاختلاط»، وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: الحجاب. المبحث الثاني: التبرج. المبحث الثالث: السفور. المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة. المبحث الخامس: سفر المرأة بدون محرم. المبحث السادس: شبه دعاة السفور، والرد عليها. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والسفور. المبحث الثامن: الاختلاط
(1/3)
واللَّه أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً نافعًا، خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وينفع به من انتهى إليه، وأن يجعله حجةً لنا، لا حجةً علينا؛ فإنه - عز وجل - خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم، وصلى اللَّه وسلّم، على نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا. المؤلف أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر في عصر الأحد الموافق 9/ 8/1432هـ
(1/4)
المبحث الأول: الحجاب
المطلب الأول: التعريفات: الحجاب، والجلباب، والنقاب، والخمار، والاعتجار، والمقنعة، والبرقع، ودرجات الحجاب
أولاً: تعريف الحجاب لغة وشرعاً: 1 - الحجاب لغة: السِّتْرُ، يقال: حَجَبَ الشيءَ يَحْجُبُه حَجْباً وحِجاباً، وحَجَّبَه: سَترَه، وقد احْتَجَبَ، وتحَجَّبَ إِذا اكْتنَّ من وراءِ حِجابٍ، وامرأَة مَحْجُوبةٌ: قد سُتِرَتْ بِسِترٍ ... والحاجِبُ: البَوَّابُ صِفةٌ غالِبةٌ، وجمعُه: حَجَبةٌ، وحُجَّابٌ ... وحَجَبَه أَي مَنَعَه عن الدخول. والحِجابُ اسمُ ما احْتُجِبَ به، وكلُّ ما حالَ بين شيئين حِجابٌ، والجمع: حُجُبٌ لا غير، وقوله تعالى: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} (1) معناه: ومن بينِنا وبينِك حاجِزٌ في النِّحْلَةِ والدِّين، وهو مثل قوله تعالى: {قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ} (2) إِلاَّ أَنَّ معنى هذا: لا نُوافِقُك في مذهب، [ويقال]: واحْتَجَبَ المَلِكُ عن الناس، ومَلِكٌ مُحَجَّبٌ ... وكُلُّ شيءٍ مَنَع شيئاً فقد حَجَبَه، كما تحْجُبُ الإِخْوةُ الأُمَّ _________ (1) سورة فصلت، الآية: 5. (2) سورة فصلت، الآية: 5.
(1/5)
عن فَريضَتِها؛ فإِن الإِخْوة يحْجُبونَ الأُمَّ عن الثُّلُثِ إِلى السُّدُسِ. والحاجِبانِ: العَظْمانِ اللَّذانِ فوقَ العَيْنَينِ بِلَحْمِهما وشَعَرهِما: صِفةٌ غالِبةٌ، والجمع حَواجِبُ، وقيل: الحاجِبُ: الشعَرُ النابِتُ على العَظْم، سُمِّي بذلك؛ لأَنه يَحْجُب عن العين شُعاعَ الشمس. وقولُه في حديثِ الصلاةِ: «حِين توارَتْ بالحِجابِ» (1): الحِجابُ ههنا: الأُفُقُ، يريد حين غابَتِ الشمسُ في الأُفُق، واسْتَتَرَتْ به، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى توَارَتْ بِالحِجَابِ} (2)، وغير ذلك (3). وقال العلامة الفيومي: «حَجَبَهُ حجباً، من باب قتل: منعه، ومنه قيل للستر: «حِجَابٌ»؛ لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب: حَاجِبٌ؛ لأنه يمنع من الدخول، والأصل في الحِجَابِ: جسم حائل بين جسدين، وقد استعمل في المعاني، فقيل: «العَجْزُ حِجَابٌ» بين الإنسان ومراده، و «المَعْصِيَةُ حِجَابٌ» بين العبد وربه ... » (4). فعلى ما تقدم يكون الحجاب لغة: الستر: وهو كل ما حال بين شيئين، سواء كان هذا الستر جداراً أو غيره، أو عباءة أو غيرها. وهو مصدر يدور معناه لغة: على الستر، والحيلولة، والمنع (5). _________ (1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة «حجب». (2) سورة ص، الآية: 32. (3) انظر: لسان العرب، لابن منظور، فصل الحاء، باب الباء، 1/ 298. (4) المصباح المنير، مادة «حجب»، 1/ 121. (5) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد، ص 27.
(1/6)
2 - الحجاب شرعاً: ورد عدة تعريفات شرعية للحجاب على النحو الآتي: قيل: هو ما تلبسه المرأة من الثياب والعباءة، وما اتخذته من حوائل بينها وبين الرجال الأجانب (1). قال اللَّه تعالى: {فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا} (2) أي ساتراً، ومن ذلك قوله تعالى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (3) أي من وراء ساتر يمنع الرؤية، وقوله - عز وجل -: {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ} (4) أي سور، وقول اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (5) أي من حيث لا يراه، وقال - عز وجل -: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} (6) أي عن ربهم مستورون، فلا يرونه - عز وجل -. وقيل: «الحجاب: لباس شرعي سابغٌ، تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها» (7). وقيل: «الحجاب: هو ساتر يستر الجسم فلا يشف، ولا يصف» (8). _________ (1) انظر: معجم لغة الفقهاء للروَّاس، ص 153. (2) سورة مريم، الآية: 17. (3) سورة الأحزاب، الآية: 53. (4) سورة الأعراف، الآية: 46. (5) سورة الشورى، الآية: 51. (6) سورة المطففين، الآية: 15. (7) حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، للدكتور محمد فؤاد البرازي، ص 30. (8) إعداد المرأة المسلمة، ص 106، وعودة الحجاب، لمحمد القدم، ص 70.
(1/7)
وقيل: «الحجاب: حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها» (1). وقيل: «الحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحلُّ لها أن تظهر زينتها أمامهم» (2). وقيل: «ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب» (3). وقيل: ستر المرأة جميع بدنها بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من بدنها، وزينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس والبيوت (4). وقيل: «ستر المرأة جميع بدنها، ومنه الوجه، والكفان، والقدمان، وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من ذلك ... » (5). والتعريف المختار: الحجاب شرعاً: ما يستر جميع بدن المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب: من لباسٍ واسعٍ سابغٍ يغطي جميع بدنها ووجهها، أو حائل يحول بينها وبينهم، ويمنع رؤية شيء من بدنها. _________ (1) فصل الخطاب، للشيخ أبي بكر الجزائري، ص 26، وعودة الحجاب لمحمد المقدم، ص 70. (2) عودة الخطاب لمحمد المقدم، ص 71. (3) معجم لغة الفقهاء، للروَّاس، ص 153. (4) حراسة الفضيلة، لبكر أبو زيد، ص 27. (5) المرجع السابق، ص 29.
(1/8)
ثانياً: تعريف الجلباب لغةً واصطلاحاً: 1 - الجلباب في اللغة: قال ابن منظور: «الجِلْبابُ: القَمِيصُ. والجِلْبابُ: ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها، وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ، وقيل: هو المِلْحفةُ. قالت: جَنُوبُ أُختُ عَمْرٍو ذي الكَلْب تَرْثِيه: تَمْشِي النُّسورُ إليه وهي لاهِيةٌ ... مَشْيَ العَذارَى عليهنَّ الجَلابِيبُ وقيل: هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ، كالمِلْحَفةِ؛ وقيل: هو الخِمارُ، وفي حديث أُم عطيةَ: «لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها» (1) أَي إِزارها. وقد تجَلْبَب، قال يصِفُ الشَّيْب: حتى اكْتَسَى الرأْسُ قِناعاً أَشْهَبا ... أَكْرَهَ جِلْبابٍ لِمَنْ تجَلْبَبا وفي التنزيل العزيز: {يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ} (2) قال ابن السِّكِّيت: قالت العامرية: الجِلْبابُ: الخِمارُ، وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ: مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، وقد تَجلْبَبَتْ؛ وأَنشد: _________ (1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جلب)، والحديث أخرجه مسلم، برقم 890، ويأتي تخريجه. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/9)
والعَيْشُ داجٍ كَنَفا جِلْبابه وقال آخر: مُجَلْبَبٌ من سَوادِ الليلِ جِلْبابا ابن الأَعرابي: الجِلْبابُ: الإِزارُ. قال أَبو عبيد: قال الأَزهريّ: معنى قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ وكذلك إِزارُ الليلِ وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه وقال ابن الأَثير أَي ليَزْهَدْ في الدنيا وليَصْبِرْ على الفَقْر والقِلَّة والجِلْبابُ أَيضاً الرِّداءُ وقيل هو كالمِقْنَعةِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وظهرها وصَدْرَها والجمع جَلابِيبُ» (1). وقال الحافظ ابن حجر: «الجِلباب - وهُو بِكَسرِ الجِيم، وسُكُون اللاَّم، وبِمُوحَّدَتَينِ بَينهما أَلِفٌ - قِيلَ: هُو المقَنعَة، أَو الخِمار، أَو أَعرَضُ مِنهُ، وقِيلَ: الثَّوب الواسِع يَكُون دُون الرِّداءِ، وقِيلَ: الإِزار، وقِيلَ: المِلحَفَة، وقِيلَ: المُلاءَة، وقِيلَ: القَمِيص» (2). وقال الزبيدي: «والجِلْبَابُ، كَسِرْدَابٍ، و (الجِلِبَّابُ) كَسِنِمَّارٍ مثَّلَ به سيبويهِ ولم يُفَسِّرْه أَحدٌ، قال السيرافيّ: وأَظُنُّه يعْنِي الجِلْبَاب، _________ (1) لسان العرب، مادة: (جلب). (2) فتح الباري، 1/ 424، وانظر: المجموع شرح المهذب، 3/ 172، ومشارق الأنوار عن صحاح الآثار، 1/ 403.
(1/10)
وهو يُذَكَّر ويُؤَنَّثُ: (القَمِيصُ) مُطْلَقاً، وخَصَّه بعضُهم بالمُشْتَمِلِ على البدَنِ كُلِّه، وفَسَّره الجوهريُّ بالمِلْحَفَةِ، قاله شيخُنا». ثم ذكر ما أوردناه عن ابن منظور، ثم قال: «وقال تعالى: {يُدْنِينَ عليْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} (1). وقِيل: هو ما تُغطَّى بهِ المرْأَةٌ، أَو هو ما تُغطِّي به ثِيابَها مِن فَوْقُ كالمِلْحَفةِ، أَو هو الخِمارُ، كذا في المحكم، ونقلَه ابنُ السِّكِّيت عن العامِريَّة، وقيل: هو الإِزارُ، قاله ابنُ الأَعرابيّ، وقد جاءَ ذِكرُه في حدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ (2). وقيل: جِلْبابُها: مُلاءَتُها تَشْتمِلُ بِها، وقال الخَفاجِيُّ في العِناية: قِيل: هو في الأَصْلِ المِلْحَفَةُ، ثم اسْتُعِير لِغَيْرِهَا منَ الثِّيَابِ. ونَقَلَ الحافظُ ابنُ حَجرٍ في المُقَدَّمة عن النَّضْرِ: الجِلْبَابُ: ثَوْبٌ أَقْصرُ مِنَ الخِمَارِ، وأَعْرضُ منه، وهو المِقْنَعَة، قاله شيخُنا، والجمْعُ جَلاَبِيبُ. وقَدْ تَجَلْبَبْتُ، قال يَصِفُ الشَّيْبَ: حتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعاً أَشْهَبَا ... أَكْرَهَ جِلْبَابٍ لِمَنْ تَجَلْبَبا وقال آخَرُ: مُجَلْبَبٌ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ جِلْبَابَا _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) مسلم، برقم 890، ويأتي تخريجه.
(1/11)
والمتأمل في المعاني يجد أنَّ «الإزار»، و «المُلاءة»، و «الرداء» ألفاظ متعددة لمسمَّىً واحدٍ هو: «الجلباب» كما أوضحه «شيخ الإسلام ابن تيمية» بقوله: «الجلباب: هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: «الرداء»، وتسميه العامة: «الإزار»، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها» (1) اهـ. لهذا نجد «ابن الأثير» يقول: «والجلباب: الإزار والرداء، وقيل: الملحفة، وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها، وجمعه جلابيب». ثم قال بعد ثلاثة أسطر: «ومنه حديث أم عطية: لتُلبِسَها صاحبتها من جلبابها، أي إزارها» (2). اهـ. فهذه المعاني المختلفة للجلباب - وإن اختلفت ألفاظها - فإنها تدل جميعها على غطاء جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان. قال برهان الدين البقاعي - رحمه الله -: «والجلباب: القميص، وثوب واسع دون المِلحفة تلبسه المرأة، والملحفة: ما سَتَر اللباس، أو الخمار، وهو كل ما غطَّى الرأس. وقال البغوي: الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به _________ (1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 109 - 111. (2) النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/ 283.
(1/12)
من دثار وشعار وكساء فهو جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون المِلحفة فالمراد ستر الوجه واليدين» (1). ا. هـ. 2 - الجلباب في الاصطلاح: ذكر النووي - رحمه الله - معاني الجلباب المتعددة في اللغة، ثم قال: «وقال آخرون: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، وهذا هو الصحيح، وهو مراد الشافعي - رحمه الله -، والمصنف والأصحاب هنا، وهو مراد المحاملي وغيره بقولهم: هو الإزار، وليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر» (2). ا. هـ. وعَرَّفه ابن حزم بقوله: «والجلباب في لغة العرب التي خاطَبنا بها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، هو ما غَطَّى جميع الجسم لا بعضه» (3) ا. هـ. وإليه ذهب القرطبي حيث قال: «والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن». _________ (1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 15/ 411 - 412. (2) المجموع شرح المهذب، 3/ 172. (3) المحلى، 3/ 212.
(1/13)
ثم أيَّدَ ذلك بقوله: «وفي صحيح مسلم عن أم عطية، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لِتُلْبِسْها أختها من جلبابها» (1). والتعريف المختار: «الجلباب: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، تستر جميع بدنها وملابسها، ووجهها، وتبدي عيناً واحدة، أو العينين فقط». وعلى هذا يكون الجلباب فوق الدرع والخمار؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: «لا بدَّ للمرأة من ثلاثة أثواب تصلِّي فيهنّ: درعٌ، وجلبابٌ، وخمارٌ، وكانت عائشة تحلُّ إزارها فتجلبب به» (2). وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ، فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا: الدِّرْعُ، وَالْخِمَارُ، وَالْمِلْحَفَةُ» (3). ثالثاً: تعريف النقابِ لغةً واصطلاحاً: 1 - النقاب في اللغة: قال ابن منظور: «النِّقابُ: القِناع على مارِنِ الأَنْفِ، والجمع نُقُبٌ، وقد تَنَقَّبَتِ المرأَةُ، وانْتَقَبَتْ، وإِنها لَحَسَنة النِّقْبة، بالكسر. _________ (1) الجامع لأحكام القرآن، 3/ 372، والحديث أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، 2/ 605، برقم 890. (2) أخرجه ابن سعد، 8/ 48 - 49، وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم، في الحجاب، ص 62. (3) ابن أبي شيبة في المصنف، وصحح سنده الألباني في الحجاب، ص 62، وانظر: فتح الباري، 1/ 424.
(1/14)
والنِّقابُ: نِقابُ المرأَة. التهذيب: والنِّقابُ على وُجُوهٍ؛ قال الفراء: إِذا أَدْنَتِ المرأَةُ نِقابَها إِلى عَيْنها، فتلك الوَصْوَصَةُ، فإِن أَنْزَلَتْه دون ذلك إِلى المَحْجِرِ فهو النِّقابُ، فإِن كان على طَرَفِ الأَنْفِ، فهو اللِّفَامُ» (1). وقد ذكر الزَّبيدي نحو هذا، ثم قال: «وفي حديث ابن سِيرِين: النِّقاب مُحْدَثٌ، أَراد: أَنَّ النساءَ ما كُنَّ يَنْتَقِبْنَ، أَي يَخْتَمِرْن. قال أَبو عبيد: ليس هذا وجهَ الحديث، ولكنِ النِّقابُ عند العرب هو الذي يبدو منه مَحْجِرُ العين، ومعناهُ: أَنَّ إِبداءَهُنَّ المَحَاجِرَ مُحْدَثٌ، إِنما كان النِّقابُ لاصِقاً بالعين، وكانت تَبْدُو إِحدى العينين، والأُخْرَى مستورة. والنِّقابُ لا يبدو منه إِلا العينان، وكان اسمه عندهم الوَصْوَصَةَ، والبُرْقُعَ، وكان من لباسِ النساءِ، ثم أَحْدَثْنَ النِّقابَ بعدُ» (2). وجاء في المعجم الوسيط: النِّقابُ: القِناعُ تجعله المرأةُ على مارنِ أنفِها تستر بها وجهها» (3). وسمي النقاب نقاباً لأنّ فيه نَقبين على العينين تنظر المرأة منهما (4). _________ (1) لسان العرب، مادة: (نقب). (2) تاج العروس، مادة: (نقب). وانظر: النهاية لابن الأثير، 5/ 103. (3) المعجم الوسيط، مادة: (نقب). (4) فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود، 1/ 133.
(1/15)
2 - النقاب في الاصطلاح: عَرَّفَ الحافظُ ابن حجر النقاب بقوله: «الخمارُ: الذي يُشدُّ على الأنف، أو تحت المحاجر» (1). وقال السِّندي: «والنقابُ معروف للنساء، لا يبدو منه إلا العينان» (2). وعرَّفه شهاب الدين القسطلاني بقوله: «هو: الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، فإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصواص - بفتح الواو، وسكون الصاد الأولى- فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللِّفام - بكسر اللام، وبالفاء- فإن نزل إلى الفم، ولم يكن على الأرنبة منه شيء فهو اللِّثام - بالمثلثة» (3). وبالرجوع إلى معاني «النقاب» في اللغة، وتعريفاته عند علماء الشرع، يمكن تعريفه بقولنا: «النقاب: هو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف، أو تحت المحاجر، تستر به وجهها، ولا يبدو منه إلا عيناها»، فهو بهذا الاعتبار خاص بالوجه لا غير. _________ (1) فتح الباري، 4/ 53. (2) حاشية السندي على النسائي، 5/ 133. (3) إرشاد الساري، 3/ 312، والزرقاني على الموطأ، 2/ 233. ونقله عنه الكاندهلوي في أوجز المسالك، 6/ 194، والمحشَّى بحاشية كشف المغطَّى عن وجه الموطأ، ص 334، لمحمد إشفاق الرحمن الكاندهلوي، لكن من غير أن يعزوه لأحد.
(1/16)
رابعاً: تعريف الخمارِ لغة واصطلاحاً: 1 - الخمار في اللغة: قال ابن منظور: «الخِمَارُ للمرأَة وهو النَّصِيفُ. وقيل: الخمار ما تغطي به المرأَة رَأْسها، وجمعه أَخْمِرَةٌ، وخُمْرٌ، وخُمُرٌ، والخِمِرُّ - بكسر الخاء والميم، وتشديد الراء- لغة في الخمار. عن ثعلب، وأَنشد: ثم أَمالَتْ جانِبَ الخِمِرِّ والخِمْرَةُ: من الخِمار كاللِّحْفَةِ من اللِّحَافِ، يقال: إِنها لحسنةُ الخِمْرَةِ. وفي المثل: إِنَّ الْعَوَانَ لا تُعَلَّمُ الخِمْرَةَ، أَي إِن المرأَة المجرّبة لا تُعَلَّمُ كيف تفعل، وتَخَمَّرَتْ بالخِمار واخْتَمَرَتْ: لَبِسَتْه. وخَمَّرَتْ به رأْسَها: غَطَّتْه. وفي حديث أُم سلمة: «أَنه - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخُفِّ والخِمار» (1)؛ أَرادت بالخمار العمامة لأَن الرجل يغطي بها رأْسه كما _________ (1) ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 148، مادة (خمر)، وقال: «أراد به العمامه لأن الرجل يُغَطّي بهِا رأسَه كما أن المرأه تغطِّيه بخمارها».
(1/17)
أَن المرأَة تغطيه بخمارها» (1). وذكر الزبيدي نحو ذلك، وفيه: «قِيل: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها، جمعه: أَخْمِرَةٌ، وخُمْرٌ - بضم فسكون- وخُمُرٌ بضَمَّتَين ... وتَخَمَّرَتْ بِه أَي الخِمَار، واخْتَمَرتْ: لَبِسَتْه، وخَمَّرتْ به رَأْسَها: غَطَّتْه، والتَّخْمِيرُ: التَّغْطِيَة. وكُلُّ مُغَطًّى ومُخَمَّرٌ» (2). ويُسمَّى الخمار بالنصيف، فيقال: «وقد نَصَّفَتِ المرأَةُ رأْسها بالخمار، وانتَصَفَت الجارية، وتَنَصَّفت: أَي اختمرت، ونصَّفْتها أَنا تَنْصيفاً، ومنه الحديث في صفة الحور العين: «ولَنَصِيفُ إحداهن على رأْسها خير من الدنيا وما فيها» (3)، وهو الخِمار، وقيل: المِعْجَر .. [والاعتجار في لغة العرب: هو لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه] (4)، وقال أَبو سعيد: النصِيف ثوب تتجلَّل به المرأَة فوق ثيابها كلها، سُمِّيَ نصيفاً لأَنه نصَفٌ بين الناس وبينها، فحَجز أَبصارهم عنها» (5). _________ (1) لسان العرب، مادة (خَمَرَ)، 4/ 257 - 258. (2) تاج العروس، مادة (خَمَرَ). (3) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 1/ 245. وهو في البخاري: بلفظ: «وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، كتاب الجهاد والسير، باب الحور البعين وصفتهن، برقم 2796. (4) ما بين المعقوفين من النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 185. (5) لسان العرب، لابن منظور، مادة: نصف، 9/ 332.
(1/18)
2 - الخمار في الاصطلاح: قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: يَرحَم اللَّه نِساء المُهاجِرات الأول، لما أنزل اللَّه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) شققن مروطهن فاختمرن بها». قوله: «(فاختَمَرنَ) أَي غَطَّينَ وُجُوهَهُنَّ؛ وصِفَةُ ذَلِكَ: أَن تَضَع الخِمار عَلَى رَأسها، وتَرمِيَهُ مِنَ الجانِب الأَيمَن عَلَى العاتِق الأَيسَر، وهُو التَّقَنُّع. قالَ الفَرّاء: كانُوا فِي الجاهِلِيَّة تُسدِل المَرأَة خِمارها مِن ورائِها، وتَكشِف ما قُدّامها، فَأُمِرنَ بِالاستِتارِ» (2). وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في كتاب (الأشربة) عند تعريف الخَمْر: «ومِنهُ خِمار المَرأَة لأَنَّهُ يَستُر وجهها» (3). وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، ووجهها، وعنقها، وجيبها، وسُمّي: الغدفة، ومادة «غدف» أصل صحيح، يدل على سِتْرٍ وتغطية، يقال: أغدفت المرأة قناعها: أي أرسلته على وجهها» (4). _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) فتح الباري، 8/ 490. (3) فتح الباري، 10/ 48. (4) حراسة الفضيلة، ص 30.
(1/19)
وباستقراء معاني «الخمار» في اللغة، وتحديداته في الاصطلاح، يمكننا أن نقول في تعريفه: «هو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، تستتر به عن أعين الرجال الأجانب». خامساً: تعريف الاعتجار لغة واصطلاحاً: 1 - الاعتجار لغة: «المعجر، والعجِارُ: ثوب تَلُفُّه المرأَة على استدارة رأْسها، ثم تَجَلبَبُ فوقه بجلِبابِها، والجمع المَعاجرُ، ومنه أُخِذَ الاعَتِجارُ: وهو لَيُّ الثوب على الرأْس من غير إِدارة تحت الحنَك، وفي بعض العبارات: الاعْتِجارُ: لَفُّ العمامة دون التَّلَحِّي ... والعِجْرة - بالكسر-: نوع من العِمَّة، يقال: فلان حسَنُ العِجْرة. قال ابن منظور: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنه دخل مكة يوم الفتح مُعْتَجِراً بعمامةٍ سَوْداءَ، المعنى أَنه لَفَّها على رأْسه ولم يَتَلَحَّ بها» (1). وقال الإمام ابن الأثير - رحمه الله -: «الاعْتِجارُ بالعَمامة: هو أن يَلُفَّها على رَأسِه ويَرُدّ طَرَفها على وجْهِه ولا يَعْمل منها شيئًا تحت ذَقْنِه ... ». وقال - رحمه الله -: «وفي حديث عُبيد الله بن عَدِيّ بن الخِيار: «جاء _________ (1) لسان العرب، لابن منظور، مادة: (عجر)، 4/ 544، والحديث عند الطبري في تهذيب الآثار، 1/ 65، وأخبار مكة، للفاكهي، 5/ 215.
(1/20)
وهو مُعْتَجِرٌ بِعمَامَتِهِ، ما يَرَى وحْشِيٌّ منه إلاَّ عَيْنَيْه ورِجْلَيْه» (1). 2 - واعتجار المرأة في الاصطلاح: هو لفّ الخمار على رأسها، وردُّها طرفه على وجهها. واللَّه تعالى أعلم (2). سادساً: تعريف القناع والمقنعة: لغة واصطلاحاً: 1 - القناع والمقنعة لغة: قال ابن منظور - رحمه الله -: والمقنع، والمِقْنَعةُ ... ما تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها، وفي الصحاح: ما تُقَنِّعُ به المرأَةُ رأْسَها ... وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: أَنه رأَى جاريةً عليها قِناعٌ فضربها بالدِّرّة، وقال: أَتشَبَّهِين بالحَرائِر؟ وقد كان يومئذ من لُبْسِهِنَّ ... والقِناعُ أَوْسَعُ من المِقْنعةِ، وقد تَقَنَّعَتْ به وقَنَّعَتْ رأْسَها، وقَنَّعْتُها أَلبستها القِناعَ، فتَقنَّعَتْ ... وما تتَقَنَّعُ به المرأَةُ من ثوب تُغَطِّي رأْسَها ومحاسِنَها، وأَلقى عن وجْهه قِناعَ الحياءِ ... قال الأَزهري: ولا فرق عند الثقات من أَهل اللغة بين القِناعِ والمِقْنَعةِ، وهو مثل اللِّحافِ والمِلْحفةِ ... وفي الحديث: «أَتاه رجل مُقَنَّعٌ بالحديد» (3)، وهو المُتَغَطِّي بالسِّلاحِ ... » (4). _________ (1) النهاية في غريب الأثر، باب العين مع الجيم، (3/ 185). (2) انظر: تفسير ابن كثير، 10/ 212، فقد ذكر حديث عائشة: أن نساء الأنصار اعتجرن بمروطهن عندما نزلت: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأصبحن وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان». أخرجه أبو داود، برقم 4102، وسيأتي تخريجه إن شاء الله. (3) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب عمل صالح قبل القتال، برقم 2808، ومسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، برقم 1900، دون ذكر التقنع بالحديد. (4) لسان العرب، مادة (قنع)، 8/ 300 - 301 بتصرف، وانظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، مادة (قنع)، 4/ 114.
(1/21)
2 - القناع في الاصطلاح: قناع المرأة: هو ما تستر به المرأة وجهها (1). ويدل على هذا المعنى رواية أنس: «مرَّت بعُمَرَ - رضي الله عنه - جاريةٌ مُتَنقِبّةً فَعلاهَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: يَا لَكَاعِ، تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ؟ ألقي القناع» (2). ويدل على ذلك المقنع الكندي، سُمّي مقنعاً؛ لأنه كان لا يخرج إلا على وجهه ستر (3)، ومنه ما قال أحمد بن يعقوب في تاريخه: «كانت العرب تحضر سوق عكاظ وعلى وجوهها البراقع، فيقال: إن أول عربي كشف قناعه ظريف بن غنم العنبري» (4). ولعل التعريف المختار اصطلاحاً: القناع ما تستر به المرأة رأسها ووجهها، والعلم عند اللَّه تعالى. سابعاً: تعريف البرقع لغة واصطلاحاً: 1 - البرقع لغة: البرقوع لغة في البرقُع، قال الليث: جمع البُرْقُع البَراقِعُ، قال: وتَلْبَسُها الدوابُّ، وتلبسها نساء الأَعراب، وفيه خَرْقان _________ (1) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص 338، مادة (قنع). (2) انظر: فتح البيان للنواب صديق حسن خان، 7/ 316، وعودة الحجاب، 3/ 215. (3) انظر: الأغاني، ترجمة المقنع، 17/ 60. (4) تاريخ اليعقوبي، ط أوروبة، 2/ 315، نقله المقدم في عودة الحجاب، 3/ 215.
(1/22)
للعينين، قال توْبةُ بن الحُمَيِّر: وكنتُ إِذا ما جِئتُ ليْلى تَبَرْقَعَتْ ... فقدْ رابَني منها الغَداةَ سُفُورُها قال الأَزهري: فتح الباء في بَرْقُوع نادر، لم يجئ فَعْلول إِلا صَعْفُوقٌ، والصواب: بُرقوع - بضم الباء-، وجوع يُرقوع - بالياء- صحيح، وقال شمر: بُرقع مُوَصْوَصٌ: إِذا كان صغير العينين ... ويقالُ: بَرْقَعه فتَبَرْقَع: أَي أَلْبسه البُرْقُعَ فلَبِسَه» (1). 2 - البرقع اصطلاحاً: برقع المرأة ما تستر به وجهها (2). وقيل: البرقع: القناع الذي تغطي به المرأة وجهها (3). والتعريف المختار اصطلاحاً: البرقع هو: قناع فيه خرقان للعينين، تلبسه المرأة تستر به وجهها، واشتهر بذلك نساء الأعراب، والله أعلم. ثامناً: درجات الحجاب: الحجاب الشرعي درجتان، هما: الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر، وأمثالها، بحيث لا يرى الرجال شيئاً من أشخاصهن، ولا لباسهن، ولا _________ (1) لسان العرب، لابن منظور، مادة (برقع)، 8/ 9. (2) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاُ، لسعدي أبو جيب، ص 73. (3) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص 87، مادة (برقع).
(1/23)
زينتهن الظاهرة ولا الباطنة، ولا شيئاً من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن، وقد أمر الله - عز وجل - بهذه الدرجة (1) من الحجاب فقال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (2)، وَقال - سبحانه وتعالى -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (3). ويرشح هذه الدرجة أحاديثُ تحبّب إلى المرأة القرار في البيت، وعدمَ الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن قرارها في بيتها أعظم لها في الأجر عند اللَّه تعالى. الدرجة الثانية: خروجهن من البيوت مستورات بالجلباب، الذي يغطي جميع البدن مع الوجه والكفين، ومن أدلتها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الآية (4). _________ (1) انظر: «جواهر القرآن» لمفتي عموم باكستان العلامة محمد شفيع، و «أحكام الحجاب في القرآن» للشيخ المفسر الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53. (3) سورة الأحزاب، الاية: 33. (4) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/24)
المطلب الثاني: فضائل الحجاب
أولًا: الحجاب طاعة لله - عز وجل - وطاعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقد أوجب اللَّه تعالى طاعته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (1). وقال - عز وجل -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2). وقد أمر اللَّه - سبحانه وتعالى - النساء بالحجاب فقال - عز وجل -: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (3). وقال سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (4)، وقال تبارك وتعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (5). _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 36. (2) سورة النساء، الآية: 65. (3) سورة النور، الآية: 31. (4) سورة الأحزاب، الآية: 33. (5) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/25)
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (1). وعن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» (2) يعني أنه يجب سترها. وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أختٍ له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: «مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام» (3). قال الخطابي - رحمه الله -: «أما أمره إياها بالاختمار؛ فلأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب حدثنا محمد بن بشار، 3/ 476، برقم 1173، وابن خزيمة، 1/ 93، 1685، مسند البزار، 5/ 427، برقم 427، والطبراني في المعجم الكبير، 9/ 295، برقم 9481، والمعجم الأوسط، 3/ 189، برقم 2890، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 384، برقم 7698، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 1/ 303. (3) رواه الإمام أحمد في المسند، 28/ 540، برقم 17306، سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، 3/ 231، رقم 3295، سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً، 1/ 689، برقم 2134، سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب حدثنا محمود بن غيلان، 4/ 116، برقم 1544، وحسنه، سنن النسائي، كتاب الأيمان والنذور، إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة، 7/ 20، برقم 3815، وفي الكبرى له، 3/ 163، برقم 4783، والدارمي، 1/ 166، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 8/ 218، برقم 2592، وقال محققو المسند: «صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام».
(1/26)
والاستتار» (1). ثانيَا: الحجاب إيمان واللَّه - سبحانه وتعالى - لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، فقد قال سبحانه: {وَقُل لِلِمُؤمِنَاتِ} (2)، وقال - عز وجل -: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} (3). ودخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، عليهن ثياب رقاق، فقالت عائشة: «إن كنتن مؤمنات، فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به» (4)، وأُدْخِلت امرأة عروس على عائشة - رضي الله عنها - وعليها خمار قبطي معصفر، فلما رأتها قالت: «لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا» (5). ثالثا: الحجاب طهارة: بَيَّن اللَّه سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب، وأجملها قي قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (6)، فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات. وبيان ذلك أنه إذا لم تر العين لم يشته القلب، أما إذا رأت العين _________ (1) معالم السنن، 4/ 55. (2) سورة النور، الآية: 31. (3) سورة الأحزاب، الآية: 59. (4) تفسير القرطبي، 14/ 244. (5) المرجع السابق. (6) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/27)
فقد يشتهي القلب، وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر؛ لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة، فكان الحجاب أطهر للقلب، وأنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية والعصمة. رابعاً: الحجاب عِفَّةٌ رغَب الإسلام في التعفف (1)، وعظَّم شأنه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر به، وَيَحُثُّ عليه، ففي الحديث أن هرقل سأل أبا سفيان: ماذا يأمركم؟ - يعني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: قلت: يقول «اعبدوا اللَّه وحده، ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، والصلة» (2). وكان من دعا النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسألك الهدى والتقى والعفة» (3)،، وفي لفظ آخر: «إني أسألك الهدى والتقى والعفاف» (4) الحديث. _________ (1) العفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والمتعفف: المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر، انظر: "المفردات " للراغب (ص 507). (2) جزء من حديث طويل رواه البخاري، في كتاب بدء الوحي وغيره، 1/ 9، برقم 7، ومسلم في كتاب الجهاد، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، 3/ 1393، برقم 1773، والإمام أحمد،4/ 198، برقم 2370. (3) رواه الإمام أحمد، 6/ 216، برقم 3692، وبالأرقام: 4073، و4195، و4420. (4) رواه مسلم في كتاب الذكر، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم 2721، والترمذي في الدعوات، باب حدثنا محمود بن غيلان، برقم 3489، وابن ماجه في أبواب الدعاء، باب دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، 2/ 1260، برقم 2832، والإمام أحمد، 7/ 63، برقم 3950، و4162.
(1/28)
والعفة صفة من صفات الحور العين التي أشار إليها قوله تعالى: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} (1)، وقوله - عز وجل -: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ} (2)، وقوله جل وعلا: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ} (3). فقوله جل وعلا: {قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ} يعني: أنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن، (عِينٌ) أي: حسان الأعين، جميلات المظهر، عفيفات تقيات نقيات. فقد جعل سبحانه عفّتهن قرينة حجابهن وقرارهن في خيامهن، وامتدحهن بالعفة مع الجمال، فأعظم ما تكون العفة إذا ما اقترنت بالجمال، وقد وصف بهما يوسف - عليه السلام - في قول امرأة العزيز: {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ} (4). خامساً: الحجاب سِتْرٌ: عن يعلى بن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إن اللَّه تعالى حَيِيٌّ ستير، يحب الحياء والستر» (5) الحديث. _________ (1) سورة الرحمن، الآية: 72. (2) سورة ص، الآية: 52. (3) سورة الصافات، الآية: 48. (4) سورة يوسف، الآية: 32. (5) رواه أبو داود، في الحمام: باب النهي عن التعري، 4/ 70، برقم 4014، و4015 والنسائي في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال، 1/ 200، برقم 406، ورواه الإمام أحمد، 29/ 483، برقم 17968، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 2335.
(1/29)
وقد امتن اللَّه - سبحانه وتعالى - على الأبوين بنعمة الستر، فقال - عز وجل -: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} (1)، وقال سبحانه ممتنًا على عباده: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} (2) الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «يتقي اللَّه فيواري عورته، فذاك لباس التقوى» (3). ولذلك تجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون اللَّه، ولا يستحيون منه كعامة الغربيين مثلًا، لا يتجاوز غرض الزينة والرياش، وأما المؤمنون المتقون، فإنهم يحرصون على اللباس أولاً لستر العورات التي يستحيا من إظهارها، ثم بعد ذلك لهم سعة في إباحة الزينة والتجمل. إن الذنوب معايب يُبْتعدُ عنها، ويُستتر منها، والعورات كذلك معايب يجب أن تستر، ويبتعد عما يحرم منها، وكأن المكثرين من الخطايا هم الذين لا يبالون بما يبدو من عوراتهم، ومن هنا ترى المؤمنين المبتعدين عن الذنوب بعيدين عن إظهار العورات. والعورات يجب سترها، قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (4). _________ (1) سورة طه، الآية: 118. (2) سورة الأعراف، الآية: 26. (3) أخرجه ابن أبي حاتم، 6/ 1، الطبري في التفسير، 12/ 368، (4) سورة الأعراف، الآية: 31.
(1/30)
وقال جل وعلا: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1)، ويدخل في حفظ الفروج حفظها عن التكشف، وعن أن يُنظر إليها. وعن جبار بن صخر - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إنا نُهينا أن تُرى عوراتنا» (2). وحب الستر من أخلاق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. * فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إن موسى كان رجلًا حَييًّا سِتِّيرًا، لايرى من جلده شيء، استحياءً منه» (3) الحديث. وكان من دعاء رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهم استر عوراتي، وآمن روعاتي» (4) الحديث، وفي لفظ: «اللَّهم استر عورتي». _________ (1) سورة النور، الآيتان: 30 - 31. (2) رواه الحاكم 3/ 223، وابن أبي حاتم في العلل، 2/ 276، برقم 2327، والديلمي في الفردوس، 2/ 527، وصححه العلامة الألباني لشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 4/ 281. (3) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثني إسحاق بن نصر، 4/ 156، برقم 3404، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن تفسير سورة الأحزاب، 5/ 359، برقم 3221، والإمام أحمد، 16/ 396، برقم 10678. (4) جزء من حديث رواه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه الإمام أحمد، 8/ 403، برقم 4785، وأبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، 4/ 479، برقم 5076، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح، 2/ 1273، برقم 3871، والبخاري في الأدب المفرد، ص 411، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 73، برقم 40، والحاكم، 1/ 517، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه، 3/ 241، برقم 961، وصححه النووي في الأذكار، ص 66، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية، 1/ 108، وصححه العلامة الألباني في كثير من كتبه، انظر: صحيح الأدب المفرد، ص 488.
(1/31)
سادساً: الحجاب حياء: والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياً - بالقصر-؛ لأن به حياة الارض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا، شقي في الآخرة، وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر، ويطلبه حثيثاً (1). * والحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل، وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف الأخلاق، وحمأة الذنوب، كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل، وارتياد معالي الأمور: عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ حَسَّان بن حريث، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - يقول: قَالَ النَّبِيُّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ»، وفي روايةٍ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ»، أو قال: «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ» شك الراوي (2). _________ (1) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص 72، ومدارج السالكين، 2/ 259. (2) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، 8/ 29، برقم 6117، ومسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، 1/ 64، برقم 37، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في الحياء، 4/ 399، برقم 4798.
(1/32)
* ولعظيم أثره جعله الإسلام في طليعة خصائصه الأخلاقية: فَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ» (1). * وَبَيِّن - صلى الله عليه وسلم - أن الحياء لم يزل مستحسناً في شرائع الأنبياء الأولين، وأنه لم يُرفع، ولم ينسخ في جملة ما نسخ اللَّه من شرائعهم، فعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» (2). * والحياء نوعان: أولهما: نفسي، وهو الذي خلقه اللَّه تعالى في جميع النفوس، كحياء كل شخص من كشف عورته، والوقاع بين الناس. _________ (1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحياء، 2/ 1399، برقم 4181، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، 4/ 32، وأبو نعيم في الحلية، 3/ 220، وأبو يعلى، 6/ 269، برقم 3573، والبيهقي في شعب الإيمان، 10/ 156، وهو عند الطبراني في معجميه: الصغير، 2/ 31، والأوسط، 2/ 210، وهو في الموطأ برواية محمد بن الحسن عن يزيد بن طلحة، 3/ 452، وقد حسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 2/ 616، برقم 940. (2) أخرجه البخاري، في الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، 8/ 29، برقم 6120، وأبو داود في الأدب: باب ما جاء في الحياء، 4/ 399، برقم 4799، وابن ماجة، في الزهد: باب الحياء، 2/ 1400، برقم 4183.
(1/33)
والآخر: إيماني، وهو خصلة تمنع المؤمن من ارتكاب المعاَصي خوفًا من اللَّه تعالى، وهذا القسم من الحياء فضيلة يكتسبها المؤمن، ويتحلّى بها، وهي أمُّ كل الفضائل الأخرى. فلذلك وجب على المسلمين أن يُعوِّدُوا بناتهم على الحياء، والتخلّق بهذا الخلق الذي اختاره اللَّه تعالى لدينه القويم؛ لأن عدم الحياء علامة لزوال الإيمان، ولا يخفى ما يتولد عن ذلك من العواقب الوخيمة (1). وقد أحسن القائل حين قال: إِذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِي ... وَلَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ ... وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ (2) : سابعاً: الحجاب يناسب الغيرة: إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الإنسان السويُّ، والغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر عن القيود غريزة تستمد قوتها من الشهوة، فهذه تغري بالسفور، وتلك تبعث على الاحتجاب. إن المدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى، وقررت أن لا تحرم المنتسبين إليها التمتع بسفور النساء، واختلاط الجنسين، _________ (1) حجاب المرأة العفة والأمانة والحياء، للسيد عبد الله جمال الدين أفندي، ص 15. (2) لم ينسب هذا الشعر في كثير من الكتب التي أوردتهما، وهما في ديوان أبي تمام، 1/ 756، وفي ديوان بشار بن برد، 1/ 23، وفي روضة العقلاء لابن حبان، ص 57 نسبا إلى رجل من خزاعة، ومثله في الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا، 1/ 306.
(1/34)
وضحَّتْ بالطبيعة الثانية في سبيل ذلك، فالرجل الغربي يخالط نساء الناس، ويجالسهن متهتكات، مقابل التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وبنته، فيخالطهن غيره، ويجالسهن. إن القضاء على الغيرة بلغ عند مدنية الغرب إلى أن اعتبرتها من النقائص، بالرغم من أن الإنسان يشعر بفطرته أنها فضيلة، وتواضع كتابها وشعراؤها على تغيير هذه الفطرة. ومن الدليل على كون السفوريين يتكلفون إسكات صوت الغيرة في قلوبهم، وإماتتها مقابل ما يتمتعون به من الاختلاط بنساء غير نسائهم، أن مقلدتهم من المسلمين لا يسمحون بالدخول على نسائهم إلا لمن يسمح لهم بالدخول على نسائه، فلو قصدوا بالسفور الذي يدعون له إلى تحرير المرأة من أسر الاحتجاب كما يدعونه، لما حافظوا على شرط المعاوضة في سفور نسائهم عند أي رجل من معارفهم (1). والإسلام يعدُّ الغيرة من صميم أخلاق الإيمان، فمن لا غيرة له لا إيمان له، ولهذا كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أغير الخلق على الأمة: * فعن الْمُغِيرَةِ بن شُعبةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: «لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ (2) فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ _________ (1) عودة الحجاب، 3/ 113. (2) ضربه بالسيف غير مصفح: إذا ضربه بحدِّه، وضربه صَفْحًا: إذا ضربه بعرضه.
(1/35)
- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ! وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ» (1). * وعن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ» (2). وإن من ضروب الغيرة المحمودة: أنفةَ المحبِّ وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره، ومن هنا كانت الغيرة نوعاً من أنواع الأثرة، لابد منه لحياطة الشرف، وصيانة العرض، وكانت أيضاً مثار الحمية والحفيظة فيمن لا حمية له، ولا حفيظة. وضد الغيور الدَّيُّوث، وهو الذي يقر الخبث في أهله، أو يشتغل بالقيادة، وقال العلماء أيضًا: الديوث «هو الذي لا يَغَارُ على أهله» (3)، وفي المحكم: «والدَّيُّوثُ: الّذِي يُدْخِلُ الرِّجالَ على حُرْمَتِه بَحَيْثُ يَراهُم» (4)، وقد ورد الوعيد الشديد في حقه: _________ (1) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا شخص أغير من الله»، 9/ 123، برقم 7416، ومختصراً في الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله، 8/ 173، برقم 6846، ورواه معلقاً في النكاح، باب الغيرة، 7/ 35، قبل الرقم 5220، ومسلم، كتاب اللعان،2/ 1136، برقم 1499. (2) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، 7/ 35، برقم 5223، ومسلم، في التوبة، باب غيرة الله تعالى، وتحريم الفواحش، 4/ 2114، برقم 2761، واللفظ له، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الغيرة، 3/ 471، برقم 1168. (3) النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 147، مادة (ديث). (4) المحكم والمحيط الأعظم، 9/ 392.
(1/36)
* فعن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ» (1) الحديث. إن الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة، وقوام أخلاقها في الجاهلية والإسلام؛ لأنها طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية؛ ولأنها طبيعة النفس الحرة الأبية. ثامناً: فضائل الحجاب الجامعة: وإذا أردت أن تعرف فضل الحجاب وستر النساء وجوههن عن الأجانب، فانظر إلى حال المتحجبات: ماذا يحيط بهن من الحياء، والبعد عن مزاحمة الرجال في الأسواق، والتصوُّن التامّ عن الوقوع في الرذائل، أو أن تمتد إليهن نظرات فاجر؟ وإلى حال أوليائهن: ماذا لديهم من شرف النفس، والحراسة لهذه الفضائل في المحارم؟ وقارن هذا بحال المتبرجة السافرة عن وجهها التي تُقَلِّب وجهها في وجوه الرجال، وقد تساقطت منها هذه الفضائل بقدر ما لديها من سفور وتهتك، وقد ترى السافرة الفاجرة تحادث أجنبيَّاً فاجراً، تظن من حالهما _________ (1) أخرجه النسائي، 5/ 80، برقم 2562، واللفظ له، وفي الكبرى له أيضاً، 2/ 42، برقم 2354، والإمام أحمد، (2/ 134)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص 549، برقم 755، والحاكم، 1/ 72، والبيهقي في الكبرى، 10/ 226، وفي شعب الإيمان له أيضاً، 13/ 261، والضياء في المختار، 1/ 308، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 230، برقم 2070.
(1/37)
أنهما زوجان بعقد، أُشْهِد عليه أبو هريرة - رضي الله عنه -، ولو رآها «الديوث» زوجها وهي على هذه الحال، لما تحركت منه شعرة؛ لموات غيرته، نعوذ باللَّه من موت الغيرة، ومن سوء المنقلب. وأين هؤلاء الأزواج من أعرابي رأي من ينظر إلى زوجته، فطلّقها غيرة على المحارم، فلما عُوتب في ذلك، قال قصيدته الهائية المشهورة، ومنها: وأترك حبَّها من غير بغضٍ ... وذاك لكثرة الشركاءِ فيه إذا وقع الذبابُ على طعامٍ ... رفعتُ يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسودُ ورودَ ماءٍ ... إذا رأتِ الكلابَ وَلَغنَ فيه (1) وأين هؤلاء الأزواج من عربية سقط نصيفها -خمارها- عن وجهها، فالتقطته بيدها، وغطَّت وجهها بيدها الأخرى، وفي ذلك قيل: سَقَطَ النَّصِيفُ ولم ترد إسقاطه ... فتناولته واتَّقَتْنا باليد وأعْلَى من ذلك وأجلُّ: ما ذكره اللَّه سبحانه في قصة ابنتي شيخ مدين: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} (2)، فقد جاء عن عمر _________ (1) أورده الدميري في حياة الحيوان الكبرى، 1/ 11، ولم ينسبه لشاعر معين، بينما ذكر الأبيات صاحب المستطرف، 1/ 104، باختلاف في البيت الأول، وأورد الأبيات في قصة طويلة طريفة، ونسبها لامرأة رجل اسمه فيروز، غلام أحد الملوك، وكذلك أوردها في غذاء الألباب، 2/ 42، ولم ينسبها لأحد. (2) سورة القصص، الآية: 25.
(1/38)
- رضي الله عنه - بسند صحيح أنه قال: «جاءت تمشي على استحياء قَائِلَةً بثوبها على وجهها، لَيْسَت بِسَلْفَعٍ مِن النساء ولاّجةً خرَّاجة». والسَّلْفع من النساء: الجريئة السليطة، كما في تفسير ابن كثير - رحمه الله - (1). وفي الآية أيضاً من الأدب والعفة والحياء، ما بلغ ابنة الشيخ مبلغاً عجيباً في التحفُظ والتحرُز، إذ قالت: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} (2)، فجعلت الدعوة على لسان الأب، ابتعاداً عن الرَّيب والرِّيبة (3). _________ (1) تفسير ابن كثير، 3/ 384. (2) سورة القصص، الآية: 25. (3) حراسة الفضيلة، للعلامة بكر أبو زيد، ص 115 - 116.
(1/39)
المطلب الثالث: آداب الاستئذان
قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُون} (1). قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «هذه آداب شرعية، أدَّب اللَّه بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان، أمر اللَّه المؤمنين ألا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده ... » (2). والاستئذان له أحكام في مسائل متعددة، منها المسائل الآتية: أولاً: معنى «حتى تستأنسوا»: المعنى حتى تستأذنوا، قال الإمام الطبري - رحمه الله -: « ... والصواب من القول في ذلك عندي: أن يقال: إن الاستئناس: الاستفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم، مخبراً بذلك مَنْ فيه، وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنهم له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. _________ (1) سورة النور، الآيات: 27 - 29. (2) تفسير القرآن العظيم، 10/ 204.
(1/40)
وقد حُكي عن العرب سماعاً: اذهب فاستأنس، هل ترى أحداً في الدار؟ بمعنى: انظر هل ترى فيها أحداً؟ فتأويل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم: السلام عليكم، [أ] أدخل؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخير، إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا، كما ذكرنا من الرواية، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» (1). وهذا هو الصواب إن شاء اللَّه تعالى في معنى الاستئناس (2). _________ (1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 19/ 149. (2) قال العلامة الإمام الشنقيطي - رحمه الله - تعالى: «اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ أَشْكَلَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ التَّعْبِيرِ عَنِ الِاسْتِئْذَانِ بِالِاسْتِئْنَاسِ، مَعَ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الْمَادَّةِ وَالْمَعْنَى. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ: وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ: أَنَّ الِاسْتِئْنَاسَ فِي لُغَةِ الْيَمَنِ: الِاسْتِئْذَانُ. وَفِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِمَا يُنَاسِبُ لَفْظَهَا وَجْهَانِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاهِدٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ مِنَ الِاسْتِئْنَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الِاسْتِيحَاشِ; لِأَنَّ الَّذِي يَقْرَعُ بَابَ غَيْرِهِ لَا يَدْرِي أَيُؤْذَنُ لَهُ أَمْ لَا، فَهُوَ كَالْمُسْتَوْحِشِ مِنْ خَفَاءِ الْحَالِ عَلَيْهِ، فَإِذَا أُذِنَ لَهُ اسْتَأْنَسَ وَزَالَ عَنْهُ الِاسْتِيحَاشُ، وَلَمَّا كَانَ الِاسْتِئْنَاسُ لَازِمًا لِلْإِذْنِ أُطْلِقَ اللَّازِمُ، وَأُرِيدَ مَلْزُومُهُ الَّذِي هُوَ الْإِذْنُ، وَإِطْلَاقُ اللَّازِمِ، وَإِرَادَةُ الْمَلْزُومِ أُسْلُوبٌ عَرَبِيٌّ مَعْرُوفٌ، وَالْقَائِلُونَ بِالْمَجَازِ يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ، وَعَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُطْلِقَ فِيهَا اللَّازِمُ الَّذِي هُوَ الِاسْتِئْنَاسُ وَأُرِيدَ مَلْزُومُهُ الَّذِي هُوَ الْإِذْنُ يَصِيرُ الْمَعْنَى: حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا، وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [النور: 53]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدَهُ: {فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} [النور: 28]، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي هَذَا الْوَجْهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ: وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ الْكِنَايَةِ، وَالْإِرْدَافِ; لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الِاسْتِئْنَاسِ يَرْدِفُ الْإِذْنَ فَوُضِعَ مَوْضِعَ الْإِذْنِ. الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْآيَةِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِئْنَاسُ بِمَعْنَى الِاسْتِعْلَامِ، وَالِاسْتِكْشَافِ، فَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مَنْ آنَسَ الشَّيْءَ إِذَا أَبْصَرَهُ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا أَوْ عَلِمَهُ. وَالْمَعْنَى: حَتَّى تَسْتَعْمِلُوا وَتَسْتَكْشِفُوا الْحَالَ، هَلْ يُؤْذَنُ لَكُمْ أَوْ لَا؟ وَتَقُولُ الْعَرَبُ: اسْتَأْنِسْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، وَاسْتَأْنَسْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، أَيْ: تَعَرَّفْتُ وَاسْتَعْلَمْتُ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، أَيْ: عَلِمْتُمْ رُشْدَهُمْ وَظَهَرَ لَكُمْ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى: {إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ} [طه: 10]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا} الْآيَةَ [القصص: 29]، فَمَعْنَى آنَسَ نَارًا: رَآهَا مَكْشُوفَةً، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ نَابِغَةِ ذُبْيَانَ: كَأَنَّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا ... بِذِي الْجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحِد مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مَوْشِيٍّ أَكَارِعُهُ ... طَاوِي الْمُصَيْرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الْفَرَد فَقَوْلُهُ: عَلَى مُسْتَأْنِسٍ، يَعْنِي: حِمَارَ وَحْشٍ شَبَّهَ بِهِ نَاقَتَهُ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُسْتَأْنِسًا أَنَّهُ يَسْتَكْشِفُ، وَيَسْتَعْمِلُ الْقَانِصِينَ بِشَمِّهِ رِيحَهُمْ وَحِدَّةِ بَصَرِهِ فِي نَظَرِهِ إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُ الْحَارِثِ بْنِ حِلِّزَةَ الْيَشْكُرِيِّ يَصِفُ نَعَامَةً شَبَّهَ بِهَا نَاقَتَهُ: آنَسَتْ نَبْأَةً وَأَفْزَعَهَا الْقَنَّا ... صُ عَصْرًا وَقَدْ دَنَا الْإِمْسَاءُ فَقَوْلُهُ: آنَسَتْ نَبْأَةً، أَيْ: أَحَسَّتْ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ، وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي هُوَ أَنَّ مَعْنَى تَسْتَأْنِسُوا تَسْتَكْشِفُوا وَتَسْتَعْلموا، هَلْ يُؤْذَنُ لَكُمْ، وَذَلِكَ الِاسْتِعْلَامُ وَالِاسْتِكْشَافُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالِاسْتِئْذَانِ أَظْهَرَ عِنْدِي، وَإِنِ اسْتَظْهَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، وَهُنَاكَ وَجْهٌ ثَالِثٌ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ تَرَكْنَاهُ لِعَدَمِ اتِّجَاهِهِ عِنْدَنَا. وَبِمَا ذَكَرْنَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ أَصْلَ الْآيَةِ: حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَأَنَّ الْكَاتِبِينَ غَلِطُوا فِي كِتَابَتِهِمْ، فَكَتَبُوا تَسْتَأْنِسُوا غَلَطًا بَدَلَ تَسْتَأْذِنُوا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ صَحَّحَ سَنَدَهُ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَوْ فَرَضْنَا صِحَّتَهُ فَهُوَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي نُسِخَتْ وَتُرِكَتْ، وَلَعَلَّ الْقَارِئَ بِهَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ; لِأَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - أَجْمَعُوا عَلَى كِتَابَةِ تَسْتَأْنِسُوا فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، وَعَلَى تِلَاوَتِهَا بِلَفْظِ: تَسْتَأْنِسُوا، وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فِي مَصَاحِفِهِمْ وَتِلَاوَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَهُ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وَقَالَ فِيهِ: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42]، وَقَالَ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} الْآيَتان [القيامة: 16 - 17] [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 6/ 167 - 168].
(1/41)
ثانياً: دُخُولُ الإِنْسَانِ بَيْتَ غَيْرِهِ بِدُونِ الاسْتِئْذَانِ وَالسَّلامِ لا يَجُوزُ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} الْآيَةَ، نَهْيٌ صَرِيحٌ، وَالنَّهْيُ الْمُتَجَرِّدُ عَنِ الْقَرَائِنِ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ عَلَى الْأَصَحِّ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ. ثَالثاً: الاسْتِئْذَانُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ، يَقُولُ الْمُسْتَأْذِنُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ عِنْدَ الثَّالِثَةِ، فَلْيَرْجِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ، وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُبُوتًا لَا مَطْعَنَ فِيهِ؛ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ (1). _________ (1) متفق عليه: البخاري، واللفظ له، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، برقم 6245، ومسلم، كتاب الآداب، باب الاستئذان، برقم 2153.
(1/43)
ولفظ مسلم عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنَّنِي أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»، فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ. وفي لفظ عند مسلم: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ، وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: فَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ هَذَا. وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهَا، وَإِلَّا فَلْأَجْعَلَنَّكَ عِظَةً، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ»، قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، قَالَ فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ، تَضْحَكُونَ انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ فَأَتَاهُ، فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ.
(1/44)
وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا إِلَى قَوْلِهِ: قَالَ لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ فِي الْأَسْوَاقِ (1). وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْعَشِيُّ وَجَدُوهُ، قَالَ يَا أَبَا مُوسَى: مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَدْلٌ، يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ: إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأُبَيٍّ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، آنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَوْلُ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَا بَعْدَهُ. فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي مُوسَى، وَأُبَيِّ بْنِ _________ (1) البخاري، برقم 6245، ومسلم، 3153.
(1/45)
كَعْبٍ - رضي الله عنهم - تَدُلُّ دَلَالَةً صَحِيحَةً صَرِيحَةً عَلَى أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ ثَلَاثٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: «وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ بَيْنَنَا مَعْرُوفٌ لِكِبَارِنَا، وَصِغَارِنَا، حَتَّى إِنَّ أَصْغَرَنَا يَحْفَظُهُ، وَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» (1). وَالظَّاهِرُ مِنْهُ كَمَا قَالَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ تُبَيِّنُ أَنَّ هَذَا الِاسْتِئْذَانَ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ فِي الْآيَةِ بِالِاسْتِئْنَاسِ، وَالسَّلَامَ الْمَذْكُورَ فِيهَا لَا يُزَادُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَأَنَّ الِاسْتِئْنَاسَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ، هُوَ الِاسْتِئْذَانُ الْمُكَرَّرُ ثَلَاثًا; لِأَنَّ خَيْرَ مَا يُفَسَّرُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الثَّابِتَةُ عَنْهُ» (2). قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي (3): مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِئْنَاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا}: الِاسْتِئْذَانُ بِتَنَحْنُحٍ، وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافَ التَّحْقِيقِ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ لِذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ تَفْسِيرُ الْآيَةِ بِمَا ذُكِرَ إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَدِلَّةِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْحَقَّ هُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ مِنَ الِاسْتِئْذَانِ وَالتَّسْلِيمِ ثَلَاثًا كَمَا رَأَيْتَ. وَأَنَّ الصَّوَابَ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ (4) عَنِ الطَّبَرِيِّ مِنْ _________ (1) شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 131. (2) أضواء البيان، 5/ 492. (3) فتح الباري، 11/ 8. (4) فتح الباري، 11/ 8.
(1/46)
طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ: الِاسْتِئْنَاسُ هُوَ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا إِلَى آخِرِهِ، وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ» (1) يُؤَيِّدُهَا أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (2): وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (3)، زِيَادَةٌ مُفِيدَةٌ، وَهِيَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، أَوْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ لِعُمَرَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، حَتَّى أَتَاهُ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّالِثَةَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: «قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا»، ثُمَّ رَجَعَ فَأَذِنَ لَهُ سَعْدٌ، الْحَدِيثَ، فَثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمِنْ فِعْلِهِ، وَقِصَّةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ هَذِهِ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ (4) مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مُطَوَّلَةً بِمَعْنَاهُ، وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ كَذَا فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَنَسٍ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ، اهـ مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: فَثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمِنْ فِعْلِهِ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ اسْتِئْذَانِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (5): حَدَّثَنَا _________ (1) مسلم، كتاب الآداب، باب الاستئذان، برقم 2153. (2) فتح الباري، 11/ 28. (3) الأدب المفرد، ص 369. (4) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، 4/ 515، برقم 5187. (5) مسند أحمد، 19/ 397، برقم 12406.
(1/47)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْمَعِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا وَهِيَ بِأُذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ زَبِيبًا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ»، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ (1)، وَالنَّسَائِيُّ (2) مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ - هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ - قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، فَقَلْتُ: أَلَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دَعْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ سَلَامَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ، فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -»، وَذَكَرَ ابْنُ _________ (1) برقم 5185. (2) في الكبرى، برقم 10158، ورقم 10159 ..
(1/48)
كَثِيرٍ الْقِصَّةَ إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى، فَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (1). ثم قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَبِمَا ذَكَرْنَا تَعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِئْنَاسَ فِي الْآيَةِ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّنَحْنُحَ وَنَحْوُهُ، كَمَا عَزَاهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي لِلْجُمْهُورِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يُقَدَّمُ السَّلَامُ أَوِ الِاسْتِئْذَانُ؟ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: «أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ مَشْرُوعٌ، وَتَظَاهَرَتْ بِهِ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُسَلِّمَ وَيَسْتَأْذِنَ ثَلَاثًا، فَيَجْمَعُ بَيْنَ السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ السَّلَامِ، ثُمَّ الِاسْتِئْذَانُ، أَوْ تَقْدِيمُ الِاسْتِئْذَانِ ثُمَّ السَّلَامُ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَقَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّهُ يُقَدِّمُ السَّلَامَ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ وَالثَّانِي يُقَدِّمُ الِاسْتِئْذَانَ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمَاوَرْدِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنْ وَقَعَتْ عَيْنُ الْمُسْتَأْذِنِ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ قَبْلَ دُخُولِهِ قَدَّمَ السَّلَامَ، وَإِلَّا قَدَّمَ الِاسْتِئْذَانَ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَانِ فِي تَقْدِيمِ السَّلَامِ» (2)، انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ بِلَفْظِهِ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ، فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْ تَقْدِيمِ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ، وَتَقْدِيمِ الِاسْتِئْنَاسِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى السَّلَامِ فِي قَوْلِهِ: {حَتَّى _________ (1) تفسير القرآن العظيم، 10/ 250. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 131.
(1/49)
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا} لَا يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الِاسْتِئْذَانِ; لِأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي مُطْلَقَ التَّشْرِيكِ، فَيَجُوزُ عَطْفُ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ بِالْوَاوِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} (1)، وَالرُّكُوعُ قَبْلَ السُّجُودِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} (2)، وَنُوحٌ قَبْلَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَاوَ رُبَّمَا عُطِفَ بِهَا مُرَادًا بِهَا التَّرْتِيبُ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (3)، وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» بِصِيغَةِ الْأَمْرِ، وَكَقَوْلِ حَسَّانٍ - رضي الله عنه -: هَجَوْتَ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ ... وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ عَلَى رِوَايَةِ الْوَاوِ فِي هَذَا الْبَيْتِ. وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاوَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَدِلَّةِ الْخَارِجِيَّةِ لَا تَقْتَضِي إِلَّا مُطْلَقَ التَّشْرِيكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ، وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى إِرَادَةِ التَّرْتِيبِ فِي الْعَطْفِ، كَالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَدْءِ بِالصَّفَا، أَوْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ كَالْبَيْتِ الْمَذْكُورِ; لِأَنَّ جَوَابَ الْهِجَاءِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَهُ، أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ أَوِ الْقَرِينَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْآيَةُ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ رَاجِحٌ، وَلَا قَرِينَةٌ _________ (1) سورة آل عمران، الآية: 43. (2) سورة الأحزاب، الآية: 7. (3) سورة البقرة، الآية: 158.
(1/50)
عَلَى إِرَادَةِ التَّرْتِيبِ فِيهَا بِالْوَاوِ» (1). اهـ. وَقد علَّم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الاستئذان لمن لا يعلمه، فعن كَلَدَةَ بْنِ ْحَنْبَل، ذكر أَنَّه دَخَلَ على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» (2). وعَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ: «اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ». فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ (3). وذُكِرَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جَابِرٍ - رضي الله عنه -: «السَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ» (4). قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَالْمُخْتَارُ أنَّ صِيغَةَ الِاسْتِئْذَانِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهَا أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْذِنُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ انْصَرَفَ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي _________ (1) أضواء البيان، 6/ 174. (2) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كيف الاستئذان، 4/ 509، برقم 5176، والنسائي في السنن الكبرى، 4/ 169، برقم 6702، والبخاري في الأدب المفرد، ص 371، برقم 1081، والإمام أحمد في المسند، 24/ 152، برقم 15425، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/ 270. (3) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كيف الاستئذان، 4/ 510، برقم 5179، وابن أبي شيبة، 8/ 418، برقم 26185، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 340، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 270. (4) سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في السلام قبل الكلام، 5/ 59، برقم 2699، وأبو يعلى، 4/ 48، ومسند الشهاب، 1/ 56، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 816.
(1/51)
الصَّحِيحِ فِي سِيَاقِهَا تَغَايُرٌ; لِأَنَّ فِي بَعْضِهَا: أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي مُوسَى بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَرَدَّهُ مِنْ حِينِهِ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَجَمَعَ بَيْنَهَا ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ قَالَ (1): «وَظَاهِرُ هَذَيْنِ السِّيَاقَيْنِ التَّغَايُرُ؛ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى عُمَرَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَفِي الثَّانِي أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا: بِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الشُّغْلِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تَذَكَّرَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ بِرُجُوعِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَجَاءَ هُوَ إِلَى عُمَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي. اهـ. مِنْهُ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى» (2). رابعاً: اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ إِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ سَمِعُوهُ لَزِمَهُ الِانْصِرَافُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ; لِأَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوهُ، وَلَمْ يَأْذَنُوا لَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ، وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ عَدَمَ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ مُطْلَقًا، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَدْرِ هَلْ سَمِعُوهُ أَوْ لَا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الِانْصِرَافُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، كَمَا أَوْضَحْنَا أَدِلَّتَهُ وَلَمْ يُقَيَّدْ شَيْءٌ مِنْهَا بِعِلْمِهِ بِأَنَّهُمْ سَمِعُوهُ (3). خامساً: إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا لا يزيد على الثلاث: قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لَنَا رُجْحَانُهُ _________ (1) فتح الباري، 11/ 28. (2) أضواء البيان، 6/ 175. (3) أضواء البيان، 6/ 175.
(1/52)
مِنَ الْأَدِلَّةِ، أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ، لَمْ يَسْمَعُوا اسْتِئْذَانَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ، بَلْ يَنْصَرِفُ بَعْدَهَا لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَعَدَمِ تَقْيِيدِ شَيْءٍ مِنْهَا بِكَوْنِهِمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَهُ الزِّيَادَةَ، وَمَنْ فَصَّلَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (1): أَمَّا إِذَا اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَشْهَرُهَا أَنَّهُ يَنْصَرِفُ، وَلَا يُعِيدُ الِاسْتِئْذَانَ. وَالثَّانِي: يَزِيدُ فِيهِ. وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الِاسْتِئْذَانِ الْمُتَقَدِّمِ لَمْ يُعِدْهُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ أَعَادَهُ، فَمَنْ قَالَ بِالْأَظْهَرِ فَحُجَّتُهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهُ، فَلَمْ يَأْذَنْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ; لِأَنَّهُ ظَاهِرُ النُّصُوصِ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ ظَاهِرِ النَّصِّ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ» (2). سادساً: الْمُسْتَأْذِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَلاَّ يَقِفَ تِلْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ، وَلَكِنَّهُ يَقِفُ جَاعِلًا الْبَابَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، وَيَسْتَأْذِنُ وَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رحمه الله -: «ثُمَّ لِيُعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْتَأْذِنِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ أَلَّا يَقِفَ تِلْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ، وَلَكِنْ لِيَكُنِ الْبَابُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَسَارِهِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (3): حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ فِي آخَرِينَ، _________ (1) شرح صحيح مسلم، 14/ 131. (2) أضواء البيان، 6/ 176. (3) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، 4/ 512، برقم 5186، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 4318.
(1/53)
قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ، انْفَرَدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ (1). وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، ح، وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ: سَعْدُ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، قَالَ عُثْمَانُ: مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ»، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (2)، مِنْ حَدِيثِهِ انْتَهَى». وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ لَا يَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ خَوْفًا أَنْ يُفْتَحَ لَهُ الْبَابُ، فَيَرَى مِنْ أَهْلِ الْمَنْزِلِ مَا لَا يُحِبُّونَ أَنْ يَرَاهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْبَابُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، فَإِنَّهُ _________ (1) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كم في الاستئذان، 4/ 509، برقم 5174. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 4318. (2) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كم في الاستئذان، 4/ 509، برقم 5175، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم 7016، وفي التعليق الرغيب، 3/ 273.
(1/54)
وَقْتَ فَتْحِ الْبَابِ لَا يَرَى مَا فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى (1). سابعاً: الْمُسْتَأْذِنُ إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَنْزِلِ: مَنْ أَنْتَ؟، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَنَا بَلْ يُفْصِحُ بِاسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِهِ; لِأَنَّ لَفْظَةَ أَنَا يُعَبِّرُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَا تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَةُ الْمُسْتَأْذِنِ، وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَى هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُبُوتًا لَا مَطْعَنَ فِيهِ. فعن جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا أَنَا، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا» (2)، وَتَكْرِيرُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَفْظَةَ (أَنَا) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْضَهَا مِنْ جَابِرٍ; لِأَنَّهَا لَا يُعْرَفُ بِهَا الْمُسْتَأْذِنُ فَهِيَ جَوَابٌ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا لَا يُطَابِقُ سُؤَالَهُ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ جَوَابَ الْمُسْتَأْذِنِ بِأَنَا، لَا يَجُوزُ لِكَرَاهَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِذَلِكَ، وَعَدَمِ رِضَاهُ بِهِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَلفظ مُسْلِم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا أَنَا». ثامناً: استئذان الرجل على أمه أو ابنته أو أخته البالغين: قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «اعْلَمْ أَنَّ الْأَظْهَرَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَى أُمِّهِ وَأُخْتِهِ، وَبَنِيهِ وَبَنَاتِهِ _________ (1) انظر: أضواء البيان، 6/ 177. (2) البخاري، كتاب الاستئذان، باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا، 8/ 55، برقم 6250، ومسلم، كتاب الآداب، باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا، 3/ 1697، برقم 2155.
(1/55)
الْبَالِغِينَ; لِأَنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، فَقَدْ تَقَعُ عَيْنُهُ عَلَى عَوْرَاتِ مَنْ ذُكِرَ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي (1) فِي شَرْحِهِ لِحَدِيثِ: «إِنَّمَا جُعِلُ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (2) مَا نَصُّهُ: «وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْرَعُ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى الْمَحَارِمِ; لِئَلَّا تَكُونَ مُنْكَشِفَةَ الْعَوْرَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ (3)، وَمِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُرِيدُ أَنْ تَرَاهَا (4). وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ بِالنُّونِ مُصَغَّرًا: سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ (5)، وَمِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي فَدَخَلَ، وَاتَّبَعْتُهُ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: تَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ؟ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، _________ (1) فتح الباري، 11/ 25. (2) البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، برقم 6241، ومسلم، كاب الآداب، باب حريم النظر في بيت غيره، برقم 2156. (3) الأدب المفرد للبخاري، ص 364، برقم 1058، وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم 433. (4) الأدب المفرد للبخاري، ص 364، برقم 1059، وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم 434. (5) الأدب المفرد للبخاري، ص 364، برقم 1060. وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم 434.
(1/56)
قُلْتُ إِنَّهَا فِي حِجْرِي؟ قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ (1) وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْآثَارِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ» (2). وَهَذِهِ الْآثَارُ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ تُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا، وَيُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (3)، فَوُقُوعُ الْبَصَرِ عَلَى عَوْرَاتِ مَنْ ذُكِرَ لَا يَحِلُّ، كَمَا تَرَى، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رحمه الله - فِي تَفْسِيرِهِ لِلْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا (4). «وَقَالَ هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ. وَقَالَ أَشْعَثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي أَكُونُ فِي مَنْزِلِي عَلَى الْحَالِ الَّتِي لَا أُحِبُّ أَنْ يَرَانِي أَحَدٌ عَلَيْهَا، لَا وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْخُلُ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا} الْآيَةَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: ثَلَاثُ آيَاتٍ جَحَدَهُنَّ النَّاسُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، قَالَ وَيَقُولُونَ: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُكُمْ بَيْتًا، إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْإذنُ كُلُّهُ قَدْ جَحَدَهُ النَّاسُ، قَالَ: قُلْتُ: _________ (1) الأدب المفرد للبخاري، ص 364، برقم 1061. (2) فتح الباري، 11/ 25. (3) البخاري، برقم 2641، وسبق تخريجه. (4) تفسير الطبري، 18/ 78، وابن كثير، 10/ 209.
(1/57)
أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَخَوَاتِي أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مَعِي فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ لِيُرَخِّصَ لِي فَأَبَى، فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ، قَالَ: فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ أَكْرَهُ إِلَيَّ أَنْ أَرَى عَوْرَتَهَا مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ، قَالَ: وَكَانَ يُشَدِّدُ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيَّ الْأَعْمَى أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَلَيْكُمُ الْإِذْنَ عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ» (1). اهـ مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى (2). تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الرجل على امرأته: قال العلامة الشنقيطي: «اعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا امْرَأَتُهُ، أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ}؛ وَلِأَنَّهُ لَا حِشْمَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ، وَيَجُوزُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْمُلَابَسَاتِ مَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا، وَلَوْ كَانَ أَبًّا أَوْ أُمًّا أَوِ ابْنًا، كَمَا لَا يَخْفَى، وَيَدُلُّ لَهُ الْأَثَرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ أَبِيهِ طَلْحَةَ عَلَى أُمِّهِ، فَزَجَرَهُ طَلْحَةُ عَنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى أُمِّهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، مَعَ أَنَّ _________ (1) تفسير القرآن العظيم، 10/ 209. (2) أضواء البيان، 6/ 180.
(1/58)
طَلْحَةَ زَوْجَهَا دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ» (1). وَقَالَ الإمام ابْنُ كَثِيرٍ: «وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَإِلَّا فَالْأَوْلَى أَنْ يُعْلِمَهَا بِدُخُولِهِ، وَلَا يُفَاجِئَهَا بِهِ; لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ لَا تُحِبُّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهَا» ثُمَّ نَقَلَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ (2) بِسَنَدِهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ، فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ، كَرَاهَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، قَالَ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» (3). ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين «عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ» (4)، وفي الحديث الآخر «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» (5). _________ (1) أضواء البيان، 6/ 180. (2) تفسير الطبري، 18/ 88. (3) تفسير القرآن العظيم، 10/ 210، وأضواء البيان، 6/ 180. (4) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة، 7/ 39، برقم 5243، و5244، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر، 3/ 1528، برقم 715، واللفظ له. (5) البخاري، كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، 7/ 39، برقم 5247، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر، 3/ 1527، برقم 715، واللفظ له.
(1/59)
عاشراً: إِذَا قَالَ أَهْلُ الْمَنْزِلِ لِلْمُسْتَأْذِنِ: ارْجِعْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}، وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَمَنَّى إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: ارْجِعْ، لِيَرْجِعَ، فَيَحْصُلَ لَهُ فَضْلُ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ; لِأَنَّ مَا قَالَ اللَّهُ إِنَّهُ أَزْكَى لَنَا لَا شَكَّ أَنَّ لَنَا فِيهِ خَيْرًا وَأَجْرًا، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هَدْرٌ: قال العلامة الشنقيطي: «اعْلَمْ أَنَّ أَقْوَى الْأَقْوَالِ دَلِيلًا وَأَرْجَحَهَا فِيمَنْ نَظَرَ مِنْ كُوَّةٍ إِلَى دَاخِلِ مَنْزِلِ قَوْمٍ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ الَّتِي نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِهَا؛ لِيَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، وَلَا غُرْمِ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَلَا قِصَاصٍ، وَهَذَا لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لِثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُبُوتًا لَا مَطْعَنَ فِيهِ، وَلِذَا لَمْ نَذْكُرْ هُنَا أَقْوَالَ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِسُقُوطِهَا عِنْدَنَا؛ لِمُعَارَضَتِهَا النَّصَّ الثَّابِتَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِي صَحِيحِهِ: بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَحَادِيثِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» (1)، وَالْجُنَاحُ الْحَرَجُ، _________ (1) البخاري، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، 9/ 11، برقم 6902، ومسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره،3/ 1699، برقم 2158.
(1/60)
وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ»، لَفْظُ جُنَاحٍ فِيهِ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَهِيَ تَعُمُّ رَفْعَ كُلِّ حَرَجٍ مِنْ إِثْمٍ وَدِيَةٍ وَقِصَاصٍ، كَمَا تَرَى» (1). ولفظ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ» (2). وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِيهِ التَّصْرِيحُ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ، وَكَوْنُ ذَلِكَ حَلَالًا لَهُمْ مُسْتَلْزِمٌ أَنَّهُمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ إِثْمٍ، وَلَا دِيَةٍ، وَلَا قِصَاصٍ; لِأَنَّ كُلَّ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا مُؤَاخَذَةَ عَلَى فِعْلِهِ الْبَتَّةَ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُؤَاخَذَةِ، كَمَا لَا يَخْفَى. وَفي لفظ الحديث عند مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ - رحمه الله - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ أَنَّ رجلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ» (3). وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ دَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي عَيْنِ الْمَذْكُورِ، وَثُبُوتُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا رَأَيْتَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّى وَانْتَهَكَ الْحُرْمَةَ، وَنَظَرَ إِلَى بَيْتِ غَيْرِهِ دُونَ اسْتِئْذَانٍ، أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَخْذِ عَيْنِهِ الْخَائِنَةِ، وَأَنَّهَا هَدْرٌ لَا عَقْلَ فِيهَا، وَلَا قَوَدَ، وَلَا إِثْمَ، وَيَزِيدُ مَا _________ (1) أضواء البيان، 6/ 181. (2) مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، 3/ 1699، برقم 2158. (3) مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، 3/ 1699، برقم 2158.
(1/61)
ذَكَرْنَا تَوْكِيدًا وَإِيضَاحًا مَا جَاءَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ أَنَّهُ هَمَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. وقد ذكر الإمام الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - تَحْتَ التَّرْجَمَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا، وَهِيَ قَوْلُهُ: بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ: حَديث أَنَسٍ - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ، وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ» (1). وعَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ» (2)، اهـ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ هُنَا فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ. وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ: بَابُ الِاسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (3). وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ _________ (1) مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، 3/ 1699، برقم 2158. (2) البخاري، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له،9/ 10،برقم 6901. (3) البخاري، برقم 2641، وسبق تخريجه.
(1/62)
الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ» (1). وَهَذِهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ تُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، فَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ خَالَفَهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَنْ أَوَّلَهَا; لِأَنَّ النَّصَّ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ، إِلَّا لِدَلِيلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ (2). والْمِشْقَصُ - بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ، وَفَتْحِ ثَالِثِهِ - هُوَ نَصْلُ السَّهْمِ إِذَا كَانَ طَوِيلًا غَيْرَ عَرِيضٍ، وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الْجُحْرُ الْأَوَّلُ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ-: وَهُوَ كُلُّ ثُقْبٍ مُسْتَدِيرٍ فِي أَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ، وَالثَّانِي - بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ - جَمْعُ حُجْرَةٍ: وَهِيَ نَاحِيَةُ الْبَيْتِ (3). الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه: «اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ إِذَا أَرْسَلَ رَسُولًا إِلَى شَخْصٍ لِيَحْضُرَ عِنْدَهُ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا: هَلْ يَكُونُ الْإِرْسَالُ إِلَيْهِ إِذْنًا; لِأَنَّهُ طَلَبَ حُضُورَهُ بِإِرْسَالِهِ إِلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذَا جَاءَ منْزِلَ مَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلَهُ الدُّخُولُ بِلَا إِذْنٍ جَدِيدٍ اكْتِفَاءً بِالْإِرْسَالِ إِلَيْهِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا أَتَى الْمَنْزِلَ اسْتِئْذَانًا جَدِيدًا، وَلَا يَكْتَفِي بِالْإِرْسَالِ؟ وَكُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ _________ (1) مسلم، برقم 2158، وسبق تخريجه. (2) أضواء البيان، 6/ 183 ببعض التصرف. (3) أضواء البيان، 6/ 183.
(1/63)
الْإِرْسَالَ إِلَيْهِ إِذْنٌ يَكْفِي عَنِ الِاسْتِئْذَانِ عِنْدَ إِتْيَانِ الْمَنْزِلِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ» (1)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ»، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ شَيْئًا، اهـ مِنْ أَبِي دَاوُدَ (2). قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي سَيَأْتِي فِي الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُ (3). اهـ. وَيَدُلُّ لِصِحَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا: بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «هُوَ إِذْنُهُ» (4) اهـ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا _________ (1) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، 4/ 513، برقم 5189، والبخاري في الأدب المفرد، ص369، برقم 1076، والبيهقي، 8/ 340، برقم 17449،، وابن حبان، 13/ 128، برقم 5811، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 426، برقم 822. (2) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، 4/ 513، برقم 5192. والبخاري في الأدب المفرد 1/ 369، برقم 1075، وأحمد، 16/ 520، برقم 10894، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 340، برقم17450، وفي شعب الإيمان له، 6/ 445، برقم 8831. وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، 1/ 426، برقم 823. (3) 11/ 31. (4) رواه البخاري معلقاً، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاسئذان ثلاثاً، بعد رقم 6245، وأبو داود موصولاً في كتاب الأدب، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، برقم 5190، وأكّد الحافظ ابن حجر وصله في تغليق التعليق، 5/ 123.
(1/64)
يُعَلِّقُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، إِلَّا مَا هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِرَارًا. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (1): «فِي حَدِيثِ: كَوْنِ رَسُولِ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ، وَلَهُ مُتَابِعٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِلَفْظِ: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ» (2)، وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ إِذْنُهُ» (3)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَرْفُوعًا، انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ. فَهَذِهِ جُمْلَةُ أَدِلَّةِ مَنْ قَالُوا: بِأَنَّ مَنْ دُعِيَ لَا يَسْتَأْذِنُ إِذَا قَدِمَ. وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: يَسْتَأْذِنُ إِذَا قَدِمَ إِلَى مَنْزِلِ الْمُرْسِلِ، وَلَا يَكْتَفِي بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ، فَقَدِ احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: «أَبَا هِرٍّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ»، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا» (4)، اهـ مِنْهُ، قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ أَبَا هِرٍّ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلَمْ يَكْتَفُوا بِالْإِرْسَالِ عَنِ الِاسْتِئْذَانِ، وَلَوْ كَانَ يَكْفِي عَنْهُ لَبَيَّنَهُ - صلى الله عليه وسلم - ; لِأَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ. _________ (1) فتح الباري، 11/ 31. (2) الأدب المفرد، برقم 1176، سبق تخريجه. (3) سبق تخريجه. (4) البخاري، كتاب الاستئذان، باب إذا دُعي الرجل فجاء هل يستأذن، برقم 6246.
(1/65)
وَمِنْ أَدِلَّةِ أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ ظَاهِرُ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} (1) الْآيَةَ ; لِأَنَّ ظَاهِرَهَا يَشْمَلُ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ وَغَيْرَهُ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ أَدِلَّةِ الْقَوْلَيْنِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي (2): «وَجَمَعَ الْمُهَلَّبُ وَغَيْرُهُ بِتَنْزِيلِ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ إِنْ طَالَ الْعَهْدُ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالْمَجِيءِ احْتَاجَ إِلَى اسْتِئْنَافِ الِاسْتِئْذَانِ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَطُلْ لَكِنْ كَانَ الْمُسْتَدْعِي فِي مَكَانٍ يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْإِذْنِ فِي الْعَادَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى اسْتِئْنَافِ إِذْنٍ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: لَعَلَّ الْأَوَّلَ فِيمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَسْتَأْذِنُ لِأَجْلِهِ، وَالثَّانِي بِخِلَافِهِ. قَالَ: وَالِاسْتِئْذَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَحْوَطُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنْ حَضَرَ صُحْبَةَ الرَّسُولِ أَغْنَاهُ اسْتِئْذَانُ الرَّسُولِ، وَيَكْفِيهِ سَلَامُ الْمُلَاقَاةِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنِ الرَّسُولِ احْتَاجَ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ، وَبِهَذَا جَمَعَ الطَّحَاوِيُّ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: «فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ، وَإِلَّا لَقَالَ: فَأَقْبَلْنَا، كَذَا قَالَ»، اهـ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ. وَأَقْرَبُهَا عِنْدِي الْجَمْعُ الْأَخِيرُ، وَيَدُلُّ لَهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِيهِ، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الْمُتَقَدِّمِ: فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى» (3). _________ (1) سورة النور، الآية: 27. (2) فتح الباري، 11/ 32. (3) أضواء البيان، 6/ 186.
(1/66)
الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك في ثلاثة أوقات: قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1). قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدَّم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر اللَّه تعالى المؤمنين أن يستأذنَهم خَدَمُهم مما ملكَت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} أي: في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، {وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ}؛ لأنه وقت النوم، فيُؤمَرُ الخدمُ والأطفال _________ (1) سورة النور، الآيات: 58 - 60.
(1/67)
ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله، أو نحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: {ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} أي: إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم؛ ولأنهم طَوَّافُونَ عليكم، أي: في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوَّافين ما لا يغتفر في غيرهم؛ ولهذا رَوَى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال في الهِرَّة: «إنها ليست بنجَس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (1). ولما كانت هذه الآية محكمة، ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلاً جدًا، أنكر عبد اللَّه بن عباس ذلك على الناس، كما قال ابن أبي حاتم: حَدَّثنا أبو زُرْعَة، حَدَّثنا يحيى بن عبد اللَّه بن بُكَيْر، حَدَّثني عبد اللَّه بن لَهِيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جُبَيْر قال: قال _________ (1) الموطأ برواية محمد بن الحسن، 1/ 160، ومسند الشافعي، ص 3، ومسند الإمام أحمد، 37/ 211، برقم 22528، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، 1/ 28، برقم 75، وسنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، 1/ 153، برقم 92، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، 1/ 55، برقم 68، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، 1/ 131، برقم 367، والدارقطني، 1/ 70، برقم 22، ومصنف عبد الرزاق، 1/ 100، برقم 352، والبيهقي، 1/ 245، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 131، برقم 68.
(1/68)
ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} (1) إلى آخر الآية، والآية التي في سورة النساء: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (2)، والآية التي في الحجرات: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (3). وروي أيضًا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات، فلم يعملوا بهن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلى آخر الآية. وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة - وهذا حديثه - أخبرنا سفيان، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس - آية الإذن - وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء، عن ابن عباس يأمر به (4). وقال الثوري، عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، قال: لم تنسخ. قلت: فإن _________ (1) سورة النور، الآية: 58. (2) سورة النساء، الآية: 8. (3) سورة الحجرات، الآية: 13. (4) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث، 4/ 514، برقم 5191، والبيهقي، 7/ 97، وصححه الألباني موقوفاً على ابن عباس في صحيح أبي داود.
(1/69)
الناس لا يعملون بها. فقال: اللَّه المستعان. وقال ابن أبي حاتم (1): حَدَّثنا الربيع بن سليمان، حَدَّثنا ابن وهب، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عَمرو، عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر اللَّه بها في القرآن، فقال ابن عباس: إن اللَّه ستِّير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم، ولا حِجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجلَ خادمُه أو ولده أو يتيمه في حجره، وهو على أهله، فأمرهم اللَّه أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمَّى اللَّه. ثم جاء اللَّه بعد بالستور، فبسط اللَّه عليهم في الرزق، فاتخذوا الستور، واتخذوا الحِجَال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه أبو داود، عن القَعْنَبِيّ، عن الدَّرَاوَرْدِيّ، عن عمرو بن أبي عَمْرو به. وقال السُّدِّي: كان أناس من الصحابة - رضي الله عنهم -، يحبون أن يُوَاقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم اللَّه أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وقال مقاتل بن حَيَّان: بلغنا - واللَّه أعلم - أن رجلاً من الأنصار _________ (1) تفسير ابن أبي حاتم، 8/ 2632، وأخرجه البيهقي أيضاً، 7/ 97.
(1/70)
وامرأته أسماء بنت مُرْثد صنعا للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول اللَّه، ما أقبح هذا! إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد، غلامهما بغير إذن! فأنزل اللَّه في ذلك: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}، ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ، قوله: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، ثم قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} يعني: إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم، وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث ... كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه (1). _________ (1) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ببعض التصرف، 10/ 269 - 272.
(1/71)
المطلب الرابع: غض البصر وفوائده
قال اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} الآية (1). وغض البصر له أحكام وآداب كثيرة، منها الأمور الآتية: أولاً: وجوب غض البصر عما حرم الله النظر إليه؛ لأن اللَّه - عز وجل - أمر بالغض منه المؤمنين والمؤمنات، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير الآية آنفة الذكر: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ باللَّه وبك يا محمد {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} يقول: يكفُّوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم اللَّه عن النظر إليه، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم ... وقال - رحمه الله - في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَقُلْ} يا محمد {للْمُؤْمِنَاتِ} من أمتك {يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} عما يكره اللَّه النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه _________ (1) سورة النور، الآيتان: 30 - 31.
(1/72)
{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} يقول: ويحفظن فروجهنَّ عن أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم» (1). وقال ابن كثير - رحمه الله -: «هذا أمر من اللَّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا» (2). ثانياً: بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد من الأمر بغض البصر في أحاديث كثيرة، منها ما يأتي: 1 - «عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» (3). 2 - عن عبد اللَّه بن بُرَيْدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لعليّ: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرةَ؛ فإن لك الأولى وليس لك الآخرة» (4). 3 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والجلوس _________ (1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 19/ 154 - 155. (2) تفسير القرآن العظيم، 10/ 212. (3) مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة، 3/ 1699، برقم 2159. (4) أخرجه أحمد، 38/ 95، برقم 22991، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، 2/ 212، برقم 2149، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في نظر المفاجأة، 5/ 101، برقم 2777، وقال: «حسن غريب»، والحاكم، 2/ 194، برقم 2788، وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي، 7/ 90، برقم 13293، وابن أبي شيبة، 4/ 324، رقم 17503، وقال الألباني في صحيح أبي داود، 6/ 364، برقم 1865: «حديث حسن».
(1/73)
على الطرقات». قالوا: يا رسول اللَّه؛ لا بد لنا من مجالسنا، نتحدث فيها، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إن أبيتم، فأعطوا الطريق حقَّه»، قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: «غَضُّ البصر، وكَفُّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» (1). 4 - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ» (2). قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهَون أن يُحِدَّ الرجل نظَره إلى الأمرد، وقد شَدَّد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحَرَّمه طائفة من أهل العلم؛ لما فيه من الافتتان، وشَدّد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا» (3). وقال الإمام ابن كثير أيضاً: _________ (1) صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها، 3/ 132، برقم 2465، وصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، 3/ 1675، برقم 2121، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (2) البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، 8/ 54، برقم 6243، ومسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، 4/ 2046، برقم 2657، واللفظ له. (3) تفسير القرآن العظيم، 10/ 215.
(1/74)
«ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف: «النظر سهام سمّ إلى القلب»؛ ولذلك أمر اللَّه بحفظ الفروج، كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}، وحفظُ الفَرج تارةً يكون بمنعه من الزنى، كما قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه. 5 - كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» (1). {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} أي: أطهر لقلوبهم، وأنقى لدينهم، كما قيل: «مَنْ حفظ بصره، أورثه اللَّه نورًا في بصيرته». ويروى: في قلبه» (2). ثالثاً: فوائد غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة، منها الفوائد الآتية: _________ (1) مسند أحمد، 33/ 235، برقم 20034، وأبو داود، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري، 4/ 72، برقم 4019، والترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في حفظ العورة، 5/ 97، برقم 2759، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، 1/ 618، برقم 1920، والحاكم، 4/ 199، برقم 7358، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 137: «إسناده ثابت»، وحسنه في صحيح ابن ماجه، برقم 1559. (2) تفسير القرآن العظيم، 10/ 214.
(1/75)
1 - امتثال الأمر من الله، الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده: 2 - تخليص القلب من الحسرة؛ فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأَضَرُّ شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما لا سبيل إلى وصوله، ولا صبر له عنه، وذلك غاية الألم. قال الفرزدق: تَزَوَّدَ منها نظرةً لم تَدعْ لهُ ... فؤادًا ولم يشعر بما قد تزودا فلم أر مقتولًا ولم أر قاتلًا ... بغير سلاح مثلها حين أقصدا 3 - غض الطرف يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين، وفي الوجه، وفي الجوارح؛ كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكآبة. قال ابن القيم في كتابه: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لما ذكر هذه الفائدة: «ولهذا - واللَّه أعلم - ذكر سبحانه آية النور في قوله: {اللَّه نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} عقب قوله: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ... 4 - يورث صحة الفراسة؛ فإنها من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة؛ فإنه يصير بمنزلة المرآة المجْلُوَّة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصُّعَداء في مرآة قلبه فطمست نورها، كما قيل في ذلك: مرآة قلبك لا تريك صلاحه ... والنفس فيها دائماً تتنفس
(1/76)
وقال شجاع الكرماني - رحمه الله -: من عمر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال، لم تخطئ فراسته، وكان شجاع لا تخطئ له فراسة؛ فإن اللَّه سبحانه يجزي العبد من جنس عمله، فمن غض بصره عن المحارم عوضه اللَّه سبحانه إطلاق نور بصيرته، فلما حبس بصره له تعالى، أطلق له بصيرته جَزاءً وفاقاً. 5 - تُفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه؛ وذلك سبب نور القلب؛ فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات، وانكشف له بسرعة، ونفذ من بعضها إلى بعض، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه، وأظلم، وانسدّ عليه باب العلم وأحجم. 6 - يورث قوة القلب وثباته وشجاعته؛ فيجعل اللَّه له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، وفي أَثَرٍ: أن الذي يخالف هواه يَفْرَقُ الشيطان من ظله، ولذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه، ومهانة النفس وحقارتها ما جعله اللَّه لمؤثر هواه على رضاه، بخلاف من آثر رضا مولاه على هواه، فإنه في عز الطاعة، وحصن التقوى، بخلاف أهل المعاصي والأهواء. قال الحسن: «إنهم وإن هملجت بهم البغال، وطقطقت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى اللَّه إلَّا أن يذل من
(1/77)
عصاه» (1). وبعض الناس يطلبون العزّ في أبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة اللَّه، فمن أطاع اللَّه فقد والاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه عاداه فيما عصاه فيه (2). وفي دعاء القنوت: «إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت» (3). 7 - يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر، وذلك لقهره عدوه، وقمع شهوته، ونصرته على نفسه، فإنه لما كف لذته، وحبس شهوته للَّه تعالى، وفيهما مَضَرَّةُ نفسِهِ الأمَّارةِ بالسوء، أعاضه اللَّه سبحانه مسرة، ولذة أكمل منهما. كما قال بعضهم: واللَّه لَلَذَّةُ العفة أعظم من لذة الذنب، ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحاً وسروراً ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وهنا يمتاز العقل من الهوى. 8 - يُخلِّص القلب من أسر الشهوة، فلا أسر أشد من أسر الشهوة والهوى، قد سلب الحول والقوة، وعزَّ عليه الدواء. _________ (1) ذكره في غذاء الألباب، 1/ 68، ولم يعزه لأحد رواه، وهو أخذه على ما يبدو من ابن القيم في روضة المحبين. (2) انظر: الحاشية السابقة. (3) أخرجه أبو داود، 1/ 536، برقم 1425، والطبراني في الكبير، 3/ 73، برقم 2702، والبيهقي في الكبرى، 2/ 209، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، 5/ 168، برقم 1281.
(1/78)
فهو كما قيل: كعصفورة في كف طفل يسومها ... حياضَ الردى والطفل يلهو ويلعب (1) 9 - يسدّ عنه باباً من أبواب جهنم، فإنّ النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة الفعل، وتحريمُ الرب تعالى وشرعُهُ حجابٌ مانع من الوصول، فمتى هَتَك الحجاب تجرأ على المحظور، ولم تقف نفسه منه عند غاية؛ لأن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها، وذلك أن لذته في الشيء الجديد. فصاحب الطارف لا يقنعه التليد (2)، وإن كان أحسن منه منظراً أو أطيب مخبراً، فَغَضُّ البصر يسدّ عنه هذا الباب، الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه ... 10 - يقوّي عقله، ويثبته، ويزيده، فإرسال البصر لا يحصُلُ إلا من قلة في العقل، وطيش في اللب، وخور في القلب، وعدم ملاحظة للعواقب، فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب، ومُرسِلُ الطرفِ لو علمَ ما تجني عواقبُ طَرْفِهِ عليه لما أطلق بصره. ولذا قال بعضهم: وأعقل الناس من لم يرتكب سبباً ... حتى يفكر ما تجني عواقبه (3) _________ (1) ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى، ولم ينسبه لأحد. (2) الطارف: المال المستحدث، والتليد: المال القديم الأصلي. (3) لم أجد من ذكره.
(1/79)
11 - يخلِّص القلب من سكرة الشهوة، ورقدة الغفلة؛ فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن اللَّه والدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى في عشاق الصور: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (1)» (2). قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رحمه الله -: «وَالنَّظَرُ أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الإِنْسَانَ؛ فَإِنَّ النَّظْرَةَ تُولِدُ الخَطْرَةَ، ثُمَّ تُولِدُ الْخَطْرَةُ فِكْرَةً، ثُمَّ تُولِدُ الْفِكْرَةُ شَهْوَةً، ثُمَّ تُولِدُ الشَّهْوَةُ إرَادَةً، ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ عَزِيمَةً جَازِمَةً، فَيَقَعُ الْفِعْلُ، وَلا بُدَّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ. وَفِي هَذَا قِيلَ: «الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ البَصَرِ أَيْسَرُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ بَعْدَهُ، وَلهذَا قَالَ الشَّاعِرُ: كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَؤهَا مِنَ النَّظَرِ ... وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَر كَمْ نَظْرَةً فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا ... فَتْكَ السِّهَامِ بِلا قَوْسٍ وَلا وَتَر وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا ... فِي أَعْيُنِ الْغِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى الخَطَر يَسُرُّ مُقْلَتَهُ مَا ضَرَّ خَاطِرَهُ ... لا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ» (3) _________ (1) سورة الحجر، الآية: 72. (2) انظر: غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، 1/ 80 - 95، وحجاب المرأة المسلمة للدكتور محمد فؤاد البرازي، ص 388 - 391. (3) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، طبعة الرياض، نشر مكتبة الرياض الحديثة، 1392هـ،، ص 134.
(1/80)
12 - يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي قد يكون. 13 - يورث القلب أُنساً باللَّه. 14 - يسدّ على الشيطان مداخله من القلب. 15 - يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. 16 - يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلب، فإذا فسد النظر فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد النظر (1). رابعاً: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله - عز وجل -: قال اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (2). فقد أمر اللَّه - عز وجل - المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، ولم يذكر اللَّه تعالى ما يُغَض البصر عنه، ويحفظ الفرج، غير أن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم دون المحلل (3). وتقدم أن الأمر بغضّ البصر عن جميع ما حرم اللَّه على العبد النظر إليه، وأن حفظ الفرج بحفظه من النظر إليه، ويكون تارة بحفظه من الزنا. _________ (1) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص 158 - 159. (2) سورة النور، الآية: 30. (3) انظر: الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، 6/ 225.
(1/81)
قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «ويَدْخُلُ فِيهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا حِفْظُهُ مِنَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ تَقْدِيمُهُ الْأَمْرَ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَلَى الْأَمْرِ بِحِفْظِ الْفَرْجِ; لِأَنَّ النَّظَرَ بَرِيدُ الزِّنَا ... » (1). والعفيف الذي يراقب اللَّه تعالى ويخشاه يغض بصره عما حرّم اللَّه النظر إليه، امتثالاً لأمر اللَّه تعالى: وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي ... حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا (2)» (3) قَالَ تَعَالَى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (4)، وَهَذَا فِيهِ التَهْدِيدُ لِمَنْ لَمْ يَغُضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْحَرَامِ (5). وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صَدْرَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ، قَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ، يَقُولُ اللَّهُ - عز وجل -: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (6)، قَالَ قَتَادَةُ: عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ} (7) خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ النَّظَرُ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ (8). _________ (1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 6/ 188. (2) البيت لعنترة بن شداد، وهو في ديوانه، ص 93. (3) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 6/ 255، وأضواء البيان للشنقيطي، 6/ 189. (4) سورة غافر، الآية: 19. (5) انظر: أضواء البيان للشنقيطي، 6/ 189. (6) سورة النور، الآية: 30. (7) سورة النور، الآية: 31. (8) البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً}، قبل الحديث رقم 6238.
(1/82)
قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} فِيهِ الْوَعِيدُ لِمَنْ يَخُونُ بِعَيْنِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ، وَهَذَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَتَانِ مِنَ الزَّجْرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ، جَاءَ مُوَضَّحًا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ. مِنْهَا: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ»، فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» (1). وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «أَرْدَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ، فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا»، الْحَدِيثَ (2). _________ (1) البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً}، برقم 6229، مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه، برقم 2121. (2) البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً}، برقم 6228.
(1/83)
وَمَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنْهُ: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - صَرَفَ وَجْهَ الْفَضْلِ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ نَظَرَهُ إِلَيْهَا لَا يَجُوزُ، وَاسْتِدْلَالُ مَنْ يَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْكَشْفَ عَنْ وَجْهِهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ بِكَشْفِ الْخَثْعَمِيَّةِ وَجْهَهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْجَوَابُ عَنْهُ في الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْحِجَابِ فِي سُورَةِ «الْأَحْزَابِ». وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: مِنْ أَنَّ نَظَرَ الْعَيْنِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهَا تَكُونُ بِهِ زَانِيَةً، فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَى الْعَيْنِ: النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ: الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ» (1). وَمَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنْهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «فَزِنَى الْعَيْنِ النَّظَرُ»، فَإِطْلَاقُ اسْمِ الزِّنَى عَلَى نَظَرِ الْعَيْنِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ، وَالْأَحَادِيثُ بِمِثْلِ هَذَا كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّظَرَ سَبَبُ الزِّنَى، فَإِنَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى جَمَالِ امْرَأَةٍ مَثَلًا، قَدْ يَتَمَكَّنُ بِسَبَبِهِ حُبُّهَا مِنْ قَلْبِهِ تَمَكُّنًا يَكُونُ سَبَبَ هَلَاكِهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَالنَّظَرُ بَرِيدُ الزِّنَى، وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْأَنْصَارِيُّ: كَسَبَتْ لِقَلْبِي نَظْرَةً لِتَسُرَّهُ ... عَيْنِي فَكَانَتْ شِقْوَةً وَوَبَالًا _________ (1) البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، برقم 6243، مسلم، كتاب القدر، باب قدر على بن آدم حظه من الزنا وغيره، برقم 2657.
(1/84)
مَا مَرَّ بِي شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْهَوَى ... سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْهَوَى وَتَعَالَى (1) وَقَالَ آخَرُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْقَلْبِ رَائِدٌ ... فَمَا تَأْلَفُ الْعَيْنَانِ فَالْقَلْبُ آلِفُ (2) وَقَالَ آخَرُ: وَأَنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا ... لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ الْمُنَاظِرُ رأيت الذي لا كلّه أنت قادر ... عليه ولا عن بعضه أنت صابر (3) وقال أبو الطيب المتنبي: وَأَنَا الَّذِي اجْتَلَبَ الْمَنِيَّةَ طَرْفُهُ ... فَمَنِ الْمُطَالِبُ وَالْقَتِيلُ الْقَاتِلُ (4) وذكر ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه ذم الهوى فصولاً جيدة نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر، وحذر فيها منه، وذكر كثيراً من أشعر الشعراء، والحكم النثرية في ذلك، وكله معلوم، والعلم عند اللَّه تعالى> (5). _________ (1) ديوان مسلم بن الوليد، ص 201. (2) نسبه في خزانة الأدب، 5/ 22: للشاعر مضرس بن قرطة أحد بني صبح. (3) ذكره في محاضرات الأدباء، 2/ 123 وعزاه إلى جارية. (4) ديوان المتنبي، ص 177. (5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 6/ 189 - 192 بتصرف.
(1/85)
المطلب الخامس: الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1). وتفصيل ذلك في هذه الآية على النحو الآتي: 1 - {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}. قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «وقوله: {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} قال سعيد بن جُبَيْر: عن الفواحش، وقال قتادة وسفيان: عمَّا لا يحلُّ لهن، وقال مقاتل: عن الزنى، وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج، فهو من الزنا، إلا هذه الآية: _________ (1) سورة النور، الآية: 31.
(1/86)
{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} ألا يراها أحد» (1). وقال الزمخشري: «وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلا هذه الآية؛ فإنه أراد به الاستتار» (2). قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِحِفْظِ الْفَرْجِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الِاسْتِتَارُ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا حِفْظُهُ مِنَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ تَقْدِيمُهُ الْأَمْرَ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَلَى الْأَمْرِ بِحِفْظِ الْفَرْجِ; لِأَنَّ النَّظَرَ بَرِيدُ الزِّنَا» (3). ووجه دلالة قوله تعالى: {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب: أن اللَّه تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بحفظه، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائل حفظ الفرج تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها، وتأمل محاسنها، والتلذذ بذلك، ثم الوصول إلى الاتصال، وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر» إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» (4)، فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (5). _________ (1) تفسير القرآن العظيم، 10/ 217. (2) تفسير الزمخشري، 3/ 229. ونقله عنه الشنقيطي في أضواء البيان، 6/ 188. (3) أضواء البيان، 6/ 188. (4) البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2046، وتقدم تخريجه. (5) انظر: رسالة الحجاب، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ص 7، وهي في مجموع فتاوى ابن عثيمين.
(1/87)
2 - قوله - عز وجل -: «{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: أي: لا يُظهرْنَ شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود [- رضي الله عنه -]: كالرداء والثياب، يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم ... » (1). وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، واختاره المحققون (2). _________ (1) تفسير القرآن العظيم، 10/ 217. (2) والقول الآخر في معنى {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: « ... وقال الأعمش، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم نحوُ ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السَّبيعي، عن أبي الأحْوَص، عن عبد اللَّه قال في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: الزينة القُرْط والدُّمْلُج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار، [وزينة يراها الأجانب، وهي] الظاهر من الثياب. وقال الزهري: [لا يبدين] لهؤلاء الذين سَمَّى اللَّه ممن لا تحلّ له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك، عن الزهري: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه [برقم 4104]: حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤَمَّل بن الفضل الحَرَّاني قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة، - رضي الله عنها -؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه، لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة، واللَّه أعلم. [تفسير القرآن العظيم، 10/ 217 - 218]. ولكن حقق العلماء رحمهم اللَّه تعالى الآثار المنسوبة إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسيره: «إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا: بالوجه والكفين»، وقوله الآخر: بأن ذلك الكحل والخاتم، فبيَّنوا بأنها جاءت بأسانيد ضعيفة لا يعتمد عليها، ويسقط الاستدلال بها، كما بيَّنوا صحة الآثار المسندة إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - في تفسيره: «إلا ما ظهر منها» بأن ذلك ظاهر الثياب، والرداء. قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب اللَّه السندي المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف أثناء نقده لأثر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه». [وليس هناك حديث صحيح مرفوع في هذا المعنى إلا ما جاء عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - في أثر أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره [18/ 119]، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 182 - 183، 7/ 86]، قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} قال: الكحل والخاتم. قلت: إسناده ضعيف جدًّا، بل هو منكر، قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد اللَّه الضبي الكوفي الملائي الأعور عن أنس وإبراهيم النخعي، وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي [تهذيب الكمال، 7/ 663] في ترجمة مسلم بن كيسان الملائي: روى عن سعيد بن جبير- وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد بن جبير. ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح، قال الفلاس: متروك الحديث، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال يحيى أيضَاً: زعموا أنه اختلط، وقال يحيى القطان: حدثني حفص بن غياث قال: قلت لمسلم الملائي: عمن سمعت هذا؟ قال- عن إبراهيم عن علقمة، قلنا: علقمة عمن؟ قال: عن عبد اللَّه، قلنا: عبد اللَّه عمن؟ قال: عن عائشة-، وقال النسائي: متروك الحديث» [ميزان الاعتدال، 4/ 106] اهـ، "وقلت: هذا الإسناد ساقط لا يصلح للمتابعات والشواهد، كما لا يخفى على أهل هذا الفن الشريف. وقال الإمام الحافظ البيهقي في السنن الكبرى: «أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا حفص بن غياث عن عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: ما في الكف والوجه. [السنن الكبرى، 2/ 225، 7/ 852، وقال الشيخ منصور بن إدريس البهوتي - رحمه الله -: «ولا يبدين زينتها إلا ما ظهر منها» قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها، رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخلفهما ابن مسعود» اهـ، من كشاف القناع، 1/ 243]. قلت: إسناده مظلم ضعيف؛ لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال الإمام الذهبي: أحمد بن عبد الجبار العطاردي روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته، ضعفه غير واحد، قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولا أرى له حديثاً منكراً، إنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم، وقال مطين: كان يكذب، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه، وقال ابن عدي: كان ابن عقدة لا يحدث عنه، وذكر أن عنده قِمَطْرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحد، مات سنة 272 هـ[ميزان الاعتدال، 1/ 112 - 113]. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب، 1/ 19]. وكذا يوجد في هذا الإِسناد- عند الإمام البيهقي- عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز المكي عن مجاهد وغيره، قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين،. وقال: وكان يرفع أشياء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: كان ضعيفاً (مرتين) عندنا، وقال أيضا: ضعيف، وكذا ضعفه النسائي [ميزان الاعتدال، 2/ 503]، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب، 1/ 450]. قلت: هذان الإسنادان ساء حالهما إلى حد بعيد، لا يحتج بهما ولا يكتبان، وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة، وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما -، ولو صح الإِسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء أهل الحديث، فكيف في هذه الحال؟ وقد صحت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وإلى غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - عكس هذا المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في سننه، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره، وزد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي مفصلاً من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب والستر. وإليكم أولاً ما جاء عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، ومنهم عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره إذ قال - رحمه الله -: حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الثياب [تفسير الطبري، 18/ 119، وقد رواه ابن أبي شيبة، والحاكم، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي في التلخيص. قلت: إسناده في غاية الصحة، وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره [2/ 283]. ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسناداً آخر بقوله: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه مثله - قلت: إسناده في غاية الصحة. وقال الإمام السيوطي: أخرج ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وكحل العينين، ثم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن» الآية. ثم قال - رضي الله عنه -: «والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، وأما خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها» [الدر المنثور، 5/ 42]، قلت: رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه قد اطلعت على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره، ورجالها كلهم ثقات، إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة المتوفى سنة 143 هـ، يروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - - ولم يلقه والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي - وهو إمام كبير ثقة ثبت، كما لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية - أعني رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - - البخاري في الجامع الصحيح [انظر مثلاً: فتح الباري، 8/ 207، 228، 265]؛ إذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة، وإن كانت ليست على شرطه في الجامع الصحيح - قال ذلك الحافظ في التهذيب [تهذيب التهذيب، 7/ 340]. وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال مشيراً إلى رواية التفسير هذه «في ترجمة علي بن أبي طلحة: هو مرسل عن ابن عباس، وبينهما مجاهد» [تهذيب الكمال، 5/ 480]، واعتمد على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل، 4/ 4909]، والإمام القرطبي في تفسيره [الجامع لأحكام القرآن، 4/ 243]، وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة، فكانت قوية ومُحتجّاً بها عند علماء التفسير وغيرهم، وإن ظاهر القرآن والسنة وأثار الصحابة والتابعين تؤيدها، فليعتمد عليها ويستأنس بها». اهـ[الحجاب في الكتاب والسنة للسندي، ص 21 - 26].
(1/88)
قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: « ... والْمُرَادَ بِالزِّينَةِ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ خَارِجًا عَنْ أَصْلٍ خِلْقَتِهَا، وَلَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا; كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ: إِنَّهَا ظَاهِرُ الثِّيَابِ; لِأَنَّ الثِّيَابَ زِينَةٌ لَهَا خَارِجَةٌ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ بِحُكْمِ الِاضْطِرَارِ، كَمَا تَرَى، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ عِنْدَنَا، وَأَحْوَطُهَا، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الرِّيبَةِ وَأَسْبَابِ الْفِتْنَةِ ... » (1). (2). _________ (1) أضواء البيان، 6/ 197. (2) وقد نقل الشنقيطي - رحمه الله - أقوال العلماء في تفسير قول اللَّه تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، ثم بعد أن ذكر هذه الأقوال والآثار عنهم قال: وَقَدْ رَأَيْتَ فِي هَذِهِ النُّقُولِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ السَّلَفِ أَقْوَالَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَالزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ، وَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ رَاجِعٌ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ; كَمَا ذَكَرْنَا: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ خَارِجًا عَنْ أَصْلٍ خِلْقَتِهَا، وَلَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا ; كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ: إِنَّهَا ظَاهِرُ الثِّيَابِ ; لِأَنَّ الثِّيَابَ زِينَةٌ لَهَا خَارِجَةٌ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ بِحُكْمِ الِاضْطِرَارِ، كَمَا تَرَى. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ عِنْدَنَا وَأَحْوَطُهَا، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الرِّيبَةِ وَأَسْبَابِ الْفِتْنَةِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ: مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ، وَلَيْسَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا أَيْضًا، لَكِنَّ النَّظَرَ إِلَى تِلْكَ الزِّينَةِ يَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ، وَذَلِكَ كَالْخِضَابِ وَالْكُحْلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ الْمَوْضِعِ الْمُلَابِسِ لَهُ مِنَ الْبَدَنِ، كَمَا لَا يَخْفَى. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ بَعْضُ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا ; كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِمَا ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، وَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، فَاعْلَمْ أَنَّنَا قَدَّمْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا أَنْ يَقُولَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْآيَةِ قَوْلًا، وَتَكُونُ فِي نَفْسِ الْآيَةِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ الْقَوْلِ، وَقَدَّمْنَا أَيْضًا فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ فِي الْقُرْآنِ إِرَادَةَ مَعْنًى مُعَيَّنٍ فِي اللَّفْظِ، مَعَ تَكَرُّرِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي الْقُرْآنِ، فَكَوْنُ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ مِنَ اللَّفْظِ فِي الْغَالِبِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ ; لِدَلَالَةِ غَلَبَةِ إِرَادَتِهِ فِي الْقُرْآنِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، وَذَكَرْنَا لَهُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ فِي التَّرْجَمَةِ. وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنَ النَّوْعَيْنِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ لِلَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، وَمَثَّلْنَا لَهُمَا بِأَمْثِلَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ كِلَاهُمَا مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا. أَمَّا الْأَوَّلُ مِنْهُمَا، فَبَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ فِي مَعْنَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ مَثَلًا، تُوجَدُ فِي الْآيَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، وَهِيَ أَنَّ الزِّينَةَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، هِيَ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا: كَالْحُلِيِّ، وَالْحُلَلِ. فَتَفْسِيرُ الزِّينَةِ بِبَعْضِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ خِلَافُ ظَاهِرِ مَعْنَى لَفْظِ الْآيَةِ، وَذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، فَلَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ. وَأَمَّا نَوْعُ الْبَيَانِ الثَّانِي الْمَذْكُورِ، فَإِيضَاحُهُ: أَنَّ لَفْظَ الزِّينَةِ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مُرَادًا بِهِ الزِّينَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ أَصْلِ الْمُزَيَّنِ بِهَا، وَلَا يُرَادُ بِهَا بَعْضُ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُزَيَّنِ بِهَا ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف، الآية: 31]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف، الآية: 32]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا} [الكهف، الآية: 7]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا} [القصص، الآية: 60]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} [الصافات، الآية: 6]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل، الْآيَةَ: 8]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص، الْآيَةَ: 79]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف، الآية: 46]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} [الحديد، الْآيَةَ: 20]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ} [طه، الآية: 59]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ مُوسَى: {وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ} [طه، الآية: 87]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور، الآية: 31]، فَلَفْظُ الزِّينَةِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ كُلِّهَا يُرَادُ بِهِ مَا يُزَيَّنُ بِهِ الشَّيْءُ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ، كَمَا تَرَى، وَكَوْنُ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْغَالِبُ فِي لَفْظِ الزِّينَةِ فِي الْقُرْآنِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الزِّينَةِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ يُرَادُ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى، الَّذِي غَلَبَتْ إِرَادَتُهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ; كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: يَأْخُذْنَ زِينَتَهُنَّ أَحْسَنَ مَا تَرَى ... وَإِذَا عَطَلْنَ فَهُنَّ خَيْرُ عَوَاطِل وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ تَفْسِيرَ الزِّينَةِ فِي الْآيَةِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فِيهِ نَظَرٌ. وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ فِي الْقُرْآنِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَأَنَّ مَنْ فَسَّرُوهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ زِينَةٌ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ كَظَاهِرِ الثِّيَابِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ زِينَةٌ يَسْتَلْزِمُ النظر إِلَيْهَا رُؤْيَةَ مَوْضِعِهَا مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ ; كَالْكُحْلِ وَالْخِضَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ مُقَيِّدُهُ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ -: أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ الزِّينَةَ الظَّاهِرَةَ هِيَ مَا لَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا رُؤْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ هُوَ أَحْوَطُ الْأَقْوَالِ، وَأَبْعَدُهَا عَنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ، وَأَطْهَرُهَا لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ هُوَ أَصْلُ جَمَالِهَا وَرُؤْيَتَهُ مِنْ أَعْظَمَ أَسْبَابِ الِافْتِتَانِ بِهَا ; كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكَرِيمِ، هُوَ تَمَامُ الْمُحَافَظَةِ، وَالِابْتِعَادُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي» [أضواء البيان، 6/ 197 - 200 بتصرف].
(1/92)
وقال الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -: «قال سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: مَا (ظَهَرَ مِنْهَا) يعني بذلك: ما ظهر من اللباس؛ فإن ذلك معفوٌّ عنه، ومراده بذلك - رضي الله عنه -: الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. وأما ما يُروَى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسَّر {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب اللَّه عليهن ستر الجميع، كما سبق في
(1/94)
الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها. ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: «أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة»، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق (1)، وهو الحق الذي لا ريب فيه. _________ (1) سبق أن ما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تفسيره: «ما ظهر منها» بأنه ضعيف، ولكن على افتراض صحة نسبته إليه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى: «والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: وحقيقة الأمر أن اللَّه جعل الزينة زينتين، زينةً ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل اللَّه - عز وجل - آية الحجاب بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش - رضي الله عنها - فأرخى النبي - صلى الله عليه وسلم - الستر ومنع أنسَا أن ينظر. ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها. فلما أمر اللَّه أن لا يُسئلن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن؛ والجلباب هو المُلاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة: الإزار، هو الإزار الكبير الذي، يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عَبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب «فكن النساء ينتقبن»، وفي الصحيح «إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» [البخاري، برقم 1838]، فإذا كنَّ مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهر للأجانب، فما بقي يَحِلُّ للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة: فابن مسعود ذكر آخر الأمرين؛ وابن عباس ذكر أول الأمرين» [حجاب المرأة ولباسها في الصلاة" ص: 13 - 17، مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 110)]، ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ في مراحل تشريع الحجاب قال - رحمه الله -: «وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب» اهـ، وقال أيضَاً - رحمه الله -: «وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تُنه عن أَبدائه للنساء ولا لذوي المحارم» اهـ. [من مجموع الفتاوى، (22/ 117 - 118)] .. وقال العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «وأما ما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر «إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب اللَّه عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ولم يستثن شيئاً وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن من نساء المؤمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك» [رسالة الحجاب والسفور، ص 19]. وهذا الجمع أولى لما ورد عن ابن عباس أيضًا من قوله: تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به. قال روح في حديثه: قلت: وما (لا تضرب به)؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: «تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها». رواه أبو داود في كتاب المسائل، [ص 110، وصححه الألباني في الرد المفحم، ص 50].
(1/95)
وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة - رحمه الله -: أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسناد، لا يصحُّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة .. ولأن في إسناده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لا يحتج بروايته .. وفيه علة أخرى ثالثة وهي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك، وهو مدلس. ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة وقد تقدم قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، ولم يستثن شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن من نساء المؤمنين» (1). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «إن اللَّه تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها، وهي التي لا بد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال: (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، لم يقل: إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، _________ (1) حكم الحجاب والسفور، ص 8 - 10.
(1/97)
فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد، ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي لا يجوز إبدؤها إلاّ لأناس مخصوصين، سواء كانت من صنع اللَّه تعالى، كالوجه، أم من صنع الآدميين، كثياب الجمال الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى، والاستثناء في الثانية فائدة معلومة» (1). 3 - قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن، وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها، فهي مأمورة ضمنًا بستر ما بين الرأس والصدر، وهما الوجه والرقبة، وإنما لم يُذكر هاهنا واللَّه أعلم؛ للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لا بد أن يغطيهما. والاختمار لغة على تغطية الوجه، قال بعضهم في وصف امرأة بالجمال وهي مخمرة وجهها: قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التّقَى المذهب نور الخمار ونور خدِّك تحته ... عجباً لوجهك كيف لم يتلهَّبَ (2) _________ (1) رسالة الحجاب، ص 8. (2) ذكره في يتيمة الدهر، ونسبه لأبي علي التنوخي، 2/ 406، برواية: (المترهب) بدلاً من (المذهب) في البيت الأول، وذكره وبمثله رواه في وفيات الأعيان، 4/ 160.
(1/98)
قال الألباني - رحمه الله -: «فقد وصفها - يعني المليحة - بأن خمارها كان على وجهها أيضاً» اهـ (1). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الخُمُر التي تغطّي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان» (2). قَالَ الإمام الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِي صَحِيحِهِ، «بَابُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رحمه الله - قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (3). حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: «أَنَّ عَائِشَةَ - رحمه الله - كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، أَخَذْنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (4). وَقَالَ الحافظ ابْنُ حَجَرٍ - رحمه الله -، فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: _________ (1) حجاب المرأة المسلمة، هامش ص 33. (2) حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص 33، ومجموع فتاويه، 22/ 76. (3) البخاري، كتاب التفسير، باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، برقم 4758. (4) البخاري، كتاب التفسير، باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، برقم 4759.
(1/99)
«قَوْلُهُ: «فَاخْتَمَرْنَ»: أَيْ غَطَّيْنَ وُجُوهَهُنَّ، وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ تَضَعَ الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا، وَتَرْمِيهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْعَاتِقِ الْأَيْسَرِ، وَهُوَ التَّقَنُّعُ. قَالَ الْفَرَّاءُ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُسْدِلُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا مِنْ وَرَائِهَا، وَتَكْشِفُ مَا قُدَّامَهَا، فَأُمِرْنَ بِالِاسْتِتَارِ» (1). قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ النِّسَاءَ الصَّحَابِيَّاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهِ فَهِمْنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، يَقْتَضِي سِتْرَ وُجُوهِهِنَّ، وَأَنَّهُنَّ شَقَقْنَ أُزُرَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ، أَيْ: سَتَرْنَ وُجُوهَهُنَّ بِهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} الْمُقْتَضِي سِتْرَ وُجُوهِهِنَّ، وَبِهَذَا يَتَحَقَّقُ الْمُنْصِفُ: أَنَّ احْتِجَابَ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ وَسِتْرَهَا وَجْهَهَا عَنْهُمْ ثَابِتٌ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُفَسِّرَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ أَثْنَتْ عَائِشَةُ - رحمه الله - عَلَى تِلْكَ النِّسَاءِ بِمُسَارَعَتِهِنَّ لِامْتِثَالِ أَوَامِرِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُنَّ مَا فَهِمْنَ سَتْرَ الْوُجُوهِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، إِلَّا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ وَهُنَّ يَسْأَلْنَهُ عَنْ كُلِّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِنَّ فِي دِينِهِنَّ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (2)، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُفَسِّرْنَهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِنَّ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي: «وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ _________ (1) البخاري، كتاب التفسير، باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، برقم 4759. (2) سورة النحل، الآية: 44.
(1/100)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ مَا يُوَضِّحُ ذَلِكَ، وَلَفْظُهُ: «ذَكَرْنَا عِنْدَ عَائِشَةَ نِسَاءَ قُرَيْشٍ وَفَضْلَهُنَّ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِنِسَاءِ قُرَيْشٍ لَفَضْلًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ، وَلَقَدْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أُنْزِلَ فِيهَا، مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا فَأَصْبَحْنَ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ» (1). قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَمَعْنَى مُعْتَجَرَاتٍ: مُخْتَمِرَاتٍ، كَمَا جَاءَ مُوَضَّحًا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا، [الاعتجار: هو لفّ الخمار على الرأس، وردُّ طرفه على الوجه، ولا يعمل منه شيئ تحت الذقن] (2)، فَتَرَى عَائِشَةُ - رحمه الله - مَعَ عِلْمِهَا، وَفَهْمِهَا، وَتُقَاهَا أَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ هَذَا الثَّنَاءَ الْعَظِيمَ، وَصَرَّحَتْ بِأَنَّهَا مَا رَأَتْ أَشَدَّ مِنْهُنَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ، وَهُوَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ فَهْمَهُنَّ لُزُومَ سَتْرِ الْوُجُوهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} مِنْ تَصْدِيقِهِنَّ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَإِيمَانِهِنَّ بِتَنْزِيلِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ احْتِجَابَ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ، وَسِتْرَهُنَّ وُجُوهَهُنَّ تَصْدِيقٌ _________ (1) فتح الباري، لابن حجر، 8/ 490، وتفسير ابن أبي حاتم، 8/ 2575، برقم 14405، وانظر: سنن أبي داود، برقم 4100، و4101. وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 80 «في سنده الزنجي بن خالد، واسمه مسلم، وفيه ضعف، لكنه قد توبع عند ابن مردويه». (2) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، 3/ 158.
(1/101)
بِكِتَابِ اللَّهِ، وَإِيمَانٌ بِتَنْزِيلِهِ، كَمَا تَرَى، فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ، مِمَّنْ يَدَّعِي مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ لِلْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى سَتْرِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا عَنِ الْأَجَانِبِ، مَعَ أَنَّ الصَّحَابِيَّاتِ فَعَلْنَ ذَلِكَ مُمْتَثِلَاتٍ أَمْرَ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ إِيمَانًا بِتَنْزِيلِهِ، وَمَعْنَى هَذَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ وَأَصْرَحِهَا فِي لُزُومِ الْحِجَابِ لِجَمِيعِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا تَرَى» (1). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}؛ فإن الخمار ما تُخمِّر به المرأة رأسها وتُغطِّيه به كالغدفة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس؛ فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر، كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة؛ فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلًا لم ينظروا إلى ما سواه؛ نظراً ذا أهمية؛ ولذلك إذا قالوا: فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فتبيّن أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك، فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر، ثم ترخص في كشف الوجه» (2). 4 - قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} _________ (1) أضواء البيان، 6/ 594 - 595. (2) رسالة الحجاب، ص 7 - 8.
(1/102)
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «إن اللَّه تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولى الإربة من الرجال، وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة، ولم يطّلع على عورات النساء؛ فدل هذا على أمرين: أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن، وموضع الفتنة، فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال» (1). 5 - قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق، وفي رجلها خلخال صامت -لا يسمع صوته -ضربت برجلها الأرض، فيعلم الرجال طنينه، فنهى اللَّه المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي، دخل في هذا النهي؛ لقوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}: ومن ذلك أيضاً أنها تنهى عن التعطر والتطيب» (2). _________ (1) رسالة الحجاب، ص 8 - 9. (2) تفسير القرآن العظيم، 10/ 224.
(1/103)
وقال شمس الدين ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في «منع ما يؤدي إلى الحرام»: «قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} فمنعهن من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزاً في نفسه؛ لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن» (1). وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: «قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}: إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة؛ وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها، وسماع حديثها، فإذا حرّم اللَّه تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حُليِّها، فيفتن به سامعه، كان تحريم النظر إلى وجهها- وهو محط محاسنها- أولى وأشد حرمة» (2). اهـ. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} يعني: لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف الوجه. _________ (1) إعلام الموقعين، 3/ 137. (2) فصل الخطاب، ص 41.
(1/104)
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدري ما هي، وما جمالها؟ لا يدري أشابة هي أم عجوز؟ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟ أيما أعظم فتنة: هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابَاً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة، ويدعو إلى النظر إليها؟ إنَّ كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم، وأحق بالستر والإِخفاء؟؟» (1). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فَرَخَّصَ لِلْعَجُوزِ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي النِّكَاحِ أَنْ تَضَعَ ثِيَابَهَا، فَلَا تُلْقِي عَلَيْهَا جِلْبَابَهَا، وَلَا تَحْتَجِبُ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْحَرَائِرِ؛ لِزَوَالِ الْمَفْسَدَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِهَا، كَمَا اسْتَثْنَى التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ فِي إظْهَارِ الزِّينَةِ لَهُمْ؛ لِعَدَمِ الشَّهْوَةِ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْفِتْنَةُ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إذَا كَانَ يُخَافُ بِهَا الْفِتْنَةُ، كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُرْخِيَ مِنْ جِلْبَابِهَا، وَتَحْتَجِبَ، وَوَجَبَ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا وَمِنْهَا» (2). اهـ. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله -: «قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}، وهذا يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاً، وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة، وهي الخلاخيل، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك؛ لأنه _________ (1) رسالة الحجاب، ص 9 - 10. (2) دقائق التفسير، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 4/ 429.
(1/105)
مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة؛ ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتُعْلِم الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهن اللَّه عن ذلك» (1). اهـ. ونقل عن ابن حزم - رحمه الله - قوله بأن هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى، ولا يحل إبداؤه. ولا ريب أن الفتنة المتوقعة من كشف الوجه أعظم بكثير وأشد خطراً وضرراً من فتنة كشف القدمين، أو الضرب بالأرجل، واللَّه أعلم (2). قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - في تفسير قوله - عز وجل -: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (3). _________ (1) حجاب المرأة المسلمة، ص 36. (2) انظر: عودة الحجاب، 3/ 290 - 292. (3) سورة النور، الآية: 31.
(1/106)
لما أمر المؤمنين بغض الأبصار، وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك، فقال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة، ونحو ذلك من النظر الممنوع. {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} من التمكين من جماعها، أو مسّها، أو النظر المحرم إليها. {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} كالثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها، قال: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا، ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، ليستثني منه قوله: {إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} أي: أزواجهن {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} يشمل الأب بنفسه، والجد وإن علا {أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن} ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا. {أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} أشقاء، أو لأب، أو لأم. {أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقاً، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكم، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية.
(1/107)
{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر. {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} أي: أو الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعِنِّين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره. {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} أي: الأطفال الذين دون التمييز؛ فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء. {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن، لِيُصوِّت ما عليهن من حُليٍّ، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة، ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر اللَّه
(1/108)
تعالى بالتوبة، فقال: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة، ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه اللَّه، ظاهراً وباطناً، إلى: ما يحبه ظاهراً وباطناً، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن اللَّه خاطب المؤمنين جميعاً، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ} أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة» (1). الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (2). قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله -: «يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء، فلا يحضن، ولا يلدن، واحدتهنّ قاعد {الَّلاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} يقول: اللاتي قد يئسن من البعولة، فلا يطمعن في الأزواج {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} يقول: فليس عليهنّ حرج، ولا إثم أن يضعن ثيابهنّ، يعني جلابيبهنّ، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب، لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم _________ (1) تيسير الكريم الرحمن، ص 662 - 663. (2) سورة النور، الآية: 60.
(1/109)
من الرجال، وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة» (1). وقال - رحمه الله - في قوله سبحانه: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}: «يقول: ليس عليهنّ جناح في وضع أرديتهنّ، إذا لم يردن بوضع ذلك عنهنَّ أن يبدين ما عليهنَّ من الزينة للرجال. والتبرّج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} يقول: وإن تعففن عن وضع جلابيبهنّ وأرديتهنّ، فيلبسنها، خير لهنّ من أن يضعنها» (2). وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «وقوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}، قال سعيد بن جُبَيْر، ومُقَاتل بن حَيَّان، وقتادة، والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض، ويئسن من الولد، {اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًاً}، أي: لم يبق لهن تَشوُّف إلى التزويج، {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} أي: ليس عليهن من الحرج في التستر، كما على غيرهن من النساء. قال أبو داود: حَدَّثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (3)، فنسخ، واستثنى _________ (1) جامع البيان، 19/ 216. (2) جامع البيان، 19/ 218. (3) سورة النور، الآية: 31.
(1/110)
من ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية (1). قال ابن مسعود في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال: الجلباب، أوالرداء، وكذلك رُوي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جُبَيْر وغيره، في قراءة عبد اللَّه بن مسعود: (أن يضعن من ثيابهن)، وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند قريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صَفيق. وقال سعيد بن جبير: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، ليرى ما عليهن من الزينة ... وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} أي: وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائزًا -خير وأفضل لهن، واللَّه سميع عليم» (2). وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -: _________ (1) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} 2/ 461، برقم 4111، والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 93، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، 12/ 300. وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2443. (2) تفسير القرآن العظيم، 10/ 272 - 273 بتصرف.
(1/111)
«{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة {اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} أي: لا يطمعن في النكاح، ولا يُطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزاً لا تُشتهى، أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تُشتهى {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ} أي: حرج وإثم {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} أي: الثياب الظاهرة، كالخمار ونحوه، الذي قال اللَّه فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فهؤلاء يجوز لهنّ أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها، ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب، ربما تُوهِّم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} أي: غير مظهرات للناس زينة، من تجمل بثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض برجلها، ليُعلم ما تخفي من زينتها، لأنّ مجرد الزينة على الأنثى، ولو مع تسترها، ولو كانت لا تُشتهى، يُفتن فيها، ويُوقع الناظر إليها في الحرج» (1) اهـ. وقال العلامة الشنقيطي: «ومن الأدلّة القرآنيّة الدالَّة على الحجاب، قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}؛ لأن اللَّه جلَّ وعلا بيَّن في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحًا، _________ (1) تيسير الكريم الرحمن، ص 672.
(1/112)
أي: لا يطمعن في النكاح لكبر السن، وعدم حاجة الرجال إليهنّ، يُرخّص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهنّ، بشرط كونهن غير متبّرجات بزينة، ثمّ إنه جلَّ وعلا مع هذا كله قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}، أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن، أي: واستعفافهن عن وضع ثيابهن، مع كبر سنهنّ وانقطاع طمعهن في التزويج، وكونهن غير متبرّجات بزينة، خير لهن. وأظهر الأقوال في قوله: {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}، أنه وضع ما يكون فوق الخمار، والقميص من الجلابيب، التي تكون فوق الخمار والثياب. فقوله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}، دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال، ولها طمع في النكاح، لا يُرخّص لها في وضع شىء من ثيابها، ولا الإخلال بشىء من التستّر بحضرة الأجانب (1). وقال الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -: «يخبر سبحانه أن القواعد من النساء - وهن: العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً - لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن، إذا كنّ غير متبرجات بزينة؛ فَعُلِمَ بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها، وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحاً في _________ (1) أضواء البيان، 6/ 591 - 592.
(1/113)
ذلك، ولو كانت عجوزاً؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة (1)؛ ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة، ولو كانت عجوزاً، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟! ولا شك أن إثمها أعظم، والجناح عليها أشدّ، والفتنة بها أكبر، وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح؛ وما ذاك - واللَّه أعلم- إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعاً في الأزواج، فنُهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها ولغيرها من الفتنة. ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن، إن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب - ولو من العجائز- وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة» (2). (3). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ _________ (1) وقالوا في هذا المعنى: لكل ساقطة في الحي لاقطة ... وكل كاسدة يوماً لها سوق وهو بيت مشهور في كتب أهل العلم، ولم أجد من نسبه لشاعر معين، انظر: الاخيار للحصني الحنفي، 3/ 301، وإعانة الطالبين للدمياطي، 3/ 259، واللباب في قواعد الإعراب، ص 8، وغيرها. (2) رسالة في الحجاب والسفور، ص 6 - 8. (3) وانظر: عودة الحجاب، 3/ 299 - 300.
(1/114)
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن اللَّه تعالى نفى الجناح، وهو الإثم، عن القواعد، وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً؛ لعدم رغبة الرجال بهن؛ لكبر سنّهنّ، نفى اللَّه الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة، ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً: كالوجه والكفين، فالثياب المذكورة المرخَّص لهذه العجائز في وضعها هي: الثياب السابغة التي تستر جميع البدن، وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشوابّ اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب، ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة، ومن قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَة} دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة، وإظهار جمالها، وتطلع الرجال لها، ومدحهم إياها، ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة، والنادر لا حكم له» (1). الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ _________ (1) رسالة الحجاب، ص 10 - 11.
(1/115)
النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (1). قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «هذه آداب أمر اللَّه تعالى بها نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال مخاطباً لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهن إذا اتقين اللَّه كما أمرهن، فإنهن لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ}. قال السُّدِّي وغيره: يعني بذلك: ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي: دَغَل، {وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا}: قال ابن زيد: قولاً حسنًا جميلاً معروفًا في الخير. ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أي: الْزَمْنَ بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرجن وهن تَفِلات» (2)، وفي رواية: «وبيوتهن خير _________ (1) سورة الأحزاب، الآيتان: 32 - 33. (2) تفسير القرآن العظيم، 11/ 150.
(1/116)
لهن» (1)» (2). وعن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحَة ربها وهي في قَعْر بيتها» (3). وعَنْ عَبْدِ اللَّه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا» (4). وقوله تعالى: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} قال مجاهد: _________ (1) أخرجه أحمد، 15/ 405، برقم 9645، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، 1/ 210، برقم 565، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 134، برقم 5160، وابن خزيمة، 3/ 90، برقم 1679. والشافعي في مسنده، ص 171، ومعرفة السنن والآثار، 4/ 237، وعبد الرزاق، 3/ 151، برقم 5121، والدارمي، 1/ 98، برقم 1314، وابن الجارود (1/ 91، رقم 332).، وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أحمد، 36/ 7، برقم 21674، وابن حبان، 5/ 589، برقم 2211، والبزار، 9/ 231، والطبراني، 5/ 248، برقم 5239، والجملة الأولى في الصحيحين: البخاري: كتاب الجمعة، باب حدثنا عبد اللَّه بن محمد، برقم 900، ومسلم، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم 442. وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 7/ 212، والإرواء، برقم 515, وصحيح أبي داود، برقم 574. وأما الرواية الثانية: «وبيوتهن ... »، فقد أخرجها أحمد، 9/ 340، برقم 5471، وابن خزيمة، 3/ 93، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، 1/ 210، برقم 567، والمستدرك، 1/ 209، برقم 755، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 131، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 103، برقم 576. (2) تفسير القرآن العظيم، 11/ 150. (3) الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، 1685، وصححه الألباني في إرواء الغليل،، سبق تخريجه بنص: «المرأة عورة». (4) أخرجه البزار، 5/ 426، برقم 2060، وابن خزيمة، 3/ 95، برقم 1690، وقال ابن كثير في تفسيره، 11/ 151: «وهذا إسناد جيد»، وقد صحح العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 579، لفظ: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».
(1/117)
كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} يقول: إذا خرجتن من بيوتكن -وكانت لهن مشية وتكسر وتغنُّج -فنهى اللَّه عن ذلك. وقال مقاتل بن حيان: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها، ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج (1). وقال الإمام القرطبي - رحمه الله -: «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن؟ والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع، فأمر اللَّه تعالى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفاً لهن، ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى، فقال: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} ... وحقيقته [التبرج]: إظهار ما سَتْرُهُ أحْسَنُ ... إلى أن قال: «وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من الِمشْيَةِ على تغنيج وتكسير، وإظهار المحاسن للرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً، وذلك _________ (1) انظر: تفسير القرآن العظيم، 11/ 152.
(1/118)
يشمل الأقوال كلها ويعمُّها، فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذّل وتستّر تام، واللَّه الموفق» (1). وقال ابن العربي: «من التبرج أن تلبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصفها، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «رُبَّ نساءٍ كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» (2)، وإنما جعلهنَّ كاسياتٍ؛ لأن الثيابَ عليهن، وإنما وصفهنَّ بعاريات لأن الثوب إذا رقَّ يكشفهنَّ، وذلك حرام» (3). وقال العلامة السعدي - رحمه الله -: «يقول تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ} خطاب لهن كلهن {لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} الله، فإنكن بذلك، تَفُقْن النساء، ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها؛ فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المُحرَّم، فقال: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} أي: في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون فَتَلِنَّ في ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويُطمِع {الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي: مرض شهوة الزنا؛ فإنه مستعد، ينظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح [فإن القلب الصحيح] _________ (1) الجامع لأحكام القرآن، 14/ 175 - 176. (2) نص الحديث في صحيح مسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»، مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، برقم 2128. (3) أحكام القرآن، 3/ 1401.
(1/119)
ليس فيه شهوة لما حرم الله؛ فإن ذلك لا تكاد تُمِيلُه، ولا تحركه الأسباب، لصحة قلبه، وسلامته من المرض. بخلاف مريض القلب، الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد، يدعوه إلى الحرام، يجيب دعوته، ولا يتعاصى عليه، فهذا دليل على أن الوسائل، لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول، واللين فيه، في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم، منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال، أن لا تلِينَ لهم القول. ولما نهاهن عن الخضوع في القول، فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: {وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا} أي: غير غليظ، ولا جافٍ كما أنه ليس بِلَيِّنٍ خاضع. وتأمل كيف قال: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} ولم يقل: «فلا تَلِنَّ بالقول»، وذلك لأن المنهي عنه، القول اللين، الذي فيه خضوع المرأة للرجل، وانكسارها عنده، والخاضع، هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلامًا لينًا، ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم؛ فإن هذا، لا يطمع فيه خصمه؛ ولهذا مدح الله رسوله باللين، فقال: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} (1)، وقال لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا _________ (1) سورة آل عمران، الآية: 159.
(1/120)
لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (1). ودلّ قوله: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} مع أمره بحفظ الفرج، وثنائه على الحافظين لفروجهم، والحافظات، ونهيه عن قربان الزنا، أنه ينبغي للعبد، إذا رأى من نفسه هذه الحالة، وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه، ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فَلْيَعْرِفْ أن ذلك مرض؛ فَلْيَجْتَهِدْ في إضعاف هذا المرض، وحسم الخواطر الردية، ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أي: اقررن فيها؛ لأنه أسلم وأحفظ لَكُنَّ، {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عمومًا، وبجزئيات من التقوى، نص عليها [لحاجة] النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة، خصوصًا الصلاة والزكاة، اللتان يحتاجهما، ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات، وأجل الطاعات، وفي الصلاة، الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة، الإحسان إلى العبيد. _________ (1) سورة طه، الآيتان: 33 - 34.
(1/121)
ثم أمرهن بالطاعة عمومًا، فقال: {وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} يدخل في طاعة الله ورسوله، كل أمر، أمرَا به أمر إيجاب أو استحباب. {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ} بأمركن بما أَمَرَكُنَّ به، ونهيكن بما نهاكُنَّ عنه، {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ} أي: الأذى، والشر، والخبث، يا {أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} حتى تكونوا طاهرين مطهرين. أي: فاحمدوا ربكم، واشكروه على هذه الأوامر والنواهي، التي أخبركم بمصلحتها، وأنها محض مصلحتكم، لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجًا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم، ولتتطهر أخلاقكم، وتحسن أعمالكم، ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل، الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم، وبين لهن طريقه، فقال: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} والمراد بآيات الله، القرآن والحكمة، أسراره، وسنة رسوله، وأمرهن بذكره، يشمل ذكر لفظه، بتلاوته، وذكر معناه، بتدبره والتفكر فيه، واستخراج أحكامه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله {إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} يدرك أسرار الأمور، وخفايا الصدور، وخبايا السموات والأرض، والأعمال التي تبين وتسر. فلطفه وخبرته، يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال، ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني «اللطيف» الذي يسوق عبده إلى الخير، ويعصمه من الشر، بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق، ما لا
(1/122)
يدريه، ويريه من الأسباب، التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا [له] إلى أعلى الدرجات، وأرفع المنازل» (1). وقال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «نهى سبحانه في هذه الآيات نساء النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين، وهن من خيرِ النساء، وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تليين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا، ويظن أنهن يوافقنه على ذلك، وأمر بلزومهن البيوت، ونهاهن عن تبرج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن: كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق، ونحو ذلك من الزينة؛ لما في ذلك من الفساد العظيم، والفتنة الكبيرة، وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. وإذا كان الله سبحانه يحذّر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن، وإيمانهن، وطهارتهن، فغيرهن أولى وأولى بالتحذير، والإنكار، والخوف عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن، ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}؛ فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن» (2). وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: «في هذه الآية _________ (1) تيسير الكريم الرحمن، ص 779 - 780. (2) الحجاب والسفور، ص 3 - 4، ومجموع فتاوى ابن باز،.
(1/123)
الكريمة دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجاب، وتقرره، وهي على النحو الآتي: 1 - منع المؤمنة من ترقيق قولها وتلينه إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس محرمًا لها. 2 - تقدير وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين، وهو علة نهي المرأة عن ترقيق قولها إذا قالت. 3 - وجود تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة، بحيث لا تزيد المرأة إذا تكلمت مع أجنبي في كلامها ما ليس بضروري للإفهام، فلا يجوز منها إطناب ولا استطراد، بَل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها. 4 - لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي، فلا تخرج إلا لحاجة ماسه إذ البيت هو محل تربية أولادها، وخدمة زوجها، وعبادة ربها بالصلاة، والزكاة، وذكر الله وما والاه. 5 - تحريم التبرج، وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة من وجهها، مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حيية. إن هذه الدلالات الخمس من هذه الآية في خطاب أمهات المؤمنين رضي عنهن اللَّه كل واحدة منها دالة بفحواها على فرضية الحجاب، وتَحتُّمِه على المرأة المسلمة، غير أن المبطلين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها: «إنها نزلت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -
(1/124)
وهي خاصة بهن، ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم»، وهو قول مضحك عجيب. . . وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بأنه لو أشرك لحبط عمله، وكان من الخاسرين في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معصوم لا يتأتى منه الشرك، ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام من باب «إياك أعني، واسمعي يا جارة»، وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله، وخسر فغيره من باب أولى، كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. ويبدو أنه لما كان الحجاب مخالفاً لما كان عليه العرب في جاهليتهم، ولم يشرع تدريجاً، وشيئًا فشيئاً حتى بالقوة، إذ لا يمكن فيه التدريج، فلما شرع دفعة واحدة كان أمراً عظيماً، فبدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يقال- وما أكثر من يقول يومئذ، والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين-: انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب، وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن بالحياة. . . إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المرضى في كل زمان ومكان، فلما فرضه على نساء رسوله - صلى الله عليه وسلم - لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَرْغَبَ بنفسها عن نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فترى السفور لها، ولا تراه لأزواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبناته، وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي، ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
(1/125)
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}» (1). الدليل الرابع: آية الحجاب، وهي قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2). قال الإمام ابن جرير - رحمه الله -: «وإذا سألتم أزواج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ} يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل» (3). قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «قَدْ قَدَّمْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا أَنْ يَقُولَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْآيَةِ قَوْلًا، وَتَكُونُ فِي نَفْسِ الْآيَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ الْقَوْلِ، وَذَكَرْنَا لَهُ أَمْثِلَةً فِي التَّرْجَمَةِ، وَأَمْثِلَةً كَثِيرَةً فِي الْكِتَابِ لَمْ تُذْكَرْ فِي التَّرْجَمَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي التَّرْجَمَةِ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ، فَقَدْ قُلْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُ _________ (1) فصل الخطاب في المرأة والحجاب، ص 35 - 36. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53. (3) جامع البيان، 20/ 313.
(1/126)
كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ إِنَّ آيَةَ «الْحِجَابِ» أَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} خَاصَّةٌ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ تَعَالَى لِهَذَا الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ إِيجَابُ الْحِجَابِ بِكَوْنِهِ أَطْهَرَ لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الرِّيبَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى إِرَادَةِ تَعْمِيمِ الْحُكْمِ، إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ غَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا حَاجَةَ إِلَى أَطْهَرِيَّةِ قُلُوبِهِنَّ وَقُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الرِّيبَةِ مِنْهُنَّ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ تُعَمِّمُ مَعْلُولَهَا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي مَرَاقِي السُّعُودِ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ تُخَصِّصُ وَقَدْ تُعَمِّمُ ... لِأَصْلِهَا لَكِنَّهَا لَا تَخْرِمُ وَبِمَا ذَكَرْنَا تَعْلَمُ أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الدَّلِيلَ الْوَاضِحَ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الْحِجَابِ حُكْمٌ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النِّسَاءِ، لَا خَاصٌّ بِأَزْوَاجِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ اللَّفْظِ خَاصًّا بِهِنَّ; لِأَنَّ عُمُومَ عِلَّتِهِ دَلِيلٌ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ فِيهِ، وَمَسْلَكُ الْعِلَّةِ الَّذِي دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، هُوَ عِلَّةُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، هُوَ الْمَسْلَكُ الْمَعْرُوفُ فِي الْأُصُولِ بِمَسْلَكِ الْإِيمَاءِ وَالتَّنْبِيهِ، وَضَابِطُ هَذَا الْمَسْلَكِ الْمُنْطَبِقِ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ، هُوَ أَنْ يَقْتَرِنَ وَصْفٌ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى وَجْهٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَلِكَ الْوَصْفُ عِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ لَكَانَ الْكَلَامُ مَعِيبًا عِنْدَ الْعَارِفِينَ، وَعَرَّفَ صَاحِبُ َمرَاقِي السُّعُودِ دَلَالَةَ الْإِيمَاءِ وَالتَّنْبِيهِ فِي مَبْحَثِ دَلَالَةِ
(1/127)
الِاقْتِضَاءِ وَالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ وَالتَّنْبِيهِ بِقَوْلِهِ: دَلَالَةُ الْإِيمَاءِ وَالتَّنْبِيهِ ... فِي الْفَنِّ تَقْصِدُ لَدَى ذَوِيه أَنْ يُقْرَنَ الْوَصْفُ بِحُكْمٍ إِنْ يَكُنْ ... لِغَيْرِ عِلَّةٍ يُعِبْهُ مَنْ فَطِنْ وَعَرَّفَ أَيْضًا الْإِيمَاءَ وَالتَّنْبِيهَ فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ بِقَوْلِهِ: وَالثَّالِثُ الْإِيمَا اقْتِرَانُ الْوَصْفِ ... بِالْحُكْمِ مَلْفُوظَيْنِ دُونَ خِلْف وَذَلِكَ الْوَصْفُ أَوِ النَّظِيرُ ... قِرَانُهُ لِغَيْرِهَا يَضِيرُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، لَكَانَ الْكَلَامُ مَعِيبًا غَيْرَ مُنْتَظِمٍ عِنْدَ الْفَطِنِ الْعَارِفِ. وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، هُوَ عِلَّةُ قَوْلِهِ: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، وَعَلِمْتَ أَنَّ حُكْمَ الْعِلَّةِ عَامٌ. فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ تُعَمِّمُ مَعْلُولَهَا، وَقَدْ تُخَصِّصُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي بَيْتِ مَرَاقِي السُّعُودِ، وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ آيَةِ الْحِجَابِ عَامٌ لِعُمُومِ عِلَّتِهِ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُ هَذِهِ الْآيَةِ عَامًّا بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْقُرْآنِيَّةِ. فاعلم أن الحجاب واجب، بدلالة القرآن على جميع النساء (1) (2). _________ (1) أضواء البيان، 6/ 584 - 585. (2) وقال العلامة الشنقيطي - رحمه الله - أيضاً: «وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ آيَةِ الْحِجَابِ عَامٌّ هُوَ مَا تُقَرَّرُ فِي الْأُصُولِ، مِنْ أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ يَعُمُّ حُكْمُهُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِذَلِكَ الْوَاحِدَ الْمُخَاطَبَ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي سُورَةِ «الْحَجِّ»، فِي مَبْحَثِ النَّهْيِ عَنْ لَبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَقَدْ قُلْنَا فِي ذَلِكَ; لِأَنَّ خِطَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَاحِدٍ مِنْ أُمَّتِهِ يَعُمُّ حُكْمُهُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، لِاسْتِوَائِهِمْ فِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَخِلَافُ أَهْلِ الْأُصُولِ فِي خِطَابِ الْوَاحِدِ، هَلْ هُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ الدَّالَّةِ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ؟ خِلَافٌ فِي حَالٍ لَا خِلَافٌ حَقِيقِيٌّ، فَخِطَابُ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ صِيغَةُ عُمُومٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ لَا يَعُمُّ; لِأَنَّ اللَّفْظِ لِلْوَاحِدِ لَا يَشْمَلُ بِالْوَضْعِ غَيْرَهُ، وَإِذَا كَانَ لَا يَشْمَلُهُ وَضْعًا، فَلَا يَكُونُ صِيغَةَ عُمُومٍ. وَلَكِنَّ أَهْلَ هَذَا الْقَوْلِ مُوَافِقُونَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ خِطَابِ الْوَاحِدِ عَامٌّ لِغَيْرِهِ، وَلَكِنْ بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ خِطَابِ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ الدَّلِيلُ بِالنَّصِّ وَالْقِيَاسِ. أَمَّا الْقِيَاسُ فَظَاهِرٌ، لِأَنَّ قِيَاسَ غَيْرِ ذَلِكَ الْمُخَاطَبِ عَلَيْهِ بِجَامِعِ اسْتِوَاءِ الْمُخَاطَبِينَ فِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ مِنَ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ. وَالنَّصُّ كَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُبَايَعَةِ النِّسَاءِ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ» [أخرجه مالك في الموطأ، 5/ 1431، وأحمد، برقم 27006، ويأتي تخريجه. قَالُوا: وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ حَدِيثُ: «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ». قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ: اعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ»، لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصِلٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلَكِنْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حَبَّانَ، قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُبَايَعَةِ النِّسَاءِ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَالَ صَاحِبُ كَشْفُ الْخَفَاءِ وَمُزِيلِ الْإِلْبَاسِ عَمَّا اشْتُهِرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ: «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ»، وَفِي لَفْظٍ: «كَحُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ»، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِهَذَا اللَّفْظِ; كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثَ الْبَيْضَاوِيِّ. وَقَالَ فِي الدُّرَرِ كَالْزَرْكَشِيِّ: لَا يُعْرَفُ. وَسُئِلَ عَنْهُ الْمُزِّيُّ وَالذَّهَبِيُّ فَأَنْكَرَاهُ، نَعَمْ يَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، فَلَفْظُ النَّسَائِيُّ: «مَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ»، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: «إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»، وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَلْزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ الشَّيْخَيْنِ بِإِخْرَاجِهَا لِثُبُوتِهَا عَلَى شَرْطِهِمَا، وَقَالَ ابْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ فِي شَرْحِ الْوَرَقَاتِ الْكَبِيرِ: «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ» لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصِلٌ إِلَى آخِرِهِ، قَرِيبًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ، انْتَهَى. قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ: الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ بِقَافَيْنِ مُصَغَّرًا، وَهِيَ صَحَابِيَّةٌ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، وَرَقِيقَةٌ أُمُّهَا، وَهِيَ أُخْتُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَقِيلَ: عَمَّتُهَا، وَاسْمُ أَبِيهَا بِجَادٌ - بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ جِيمٍ - ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ، تَيْمُ بْنُ مُرَّةَ. وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي مَرَاقِي السُّعُودِ بِقَوْلِهِ: خِطَابٌ وَاحِدٌ لِغَيْرِ الْحَنْبَلِ ... مِنْ غَيْرِ رَعْيِ النَّصِّ وَالْقَيْسِ الْجَلِي انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ. وَبِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا تَعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ آيَةِ الْحِجَابِ عَامٌّ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُهَا خَاصًّا بِأَزْوَاجِهِ - صلى الله عليه وسلم - ; لِأَنَّ قَوْلَهُ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ كَقَوْلِهِ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَمَا رَأَيْتَ إِيضَاحَهُ قَرِيبًا» [أضواء البيان، 6/ 589 - 591].
(1/128)
وقال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَإِذَا عَلِمْتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ حُكْمَ آيَةِ الْحِجَابِ عَامٌّ، وَأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مَعَهَا مِنَ الْآيَاتِ فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى احْتِجَابِ جَمِيعِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، عَلِمْتَ أَنَّ الْقُرْآنَ دَلَّ عَلَى الْحِجَابِ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ آيَةَ الْحِجَابِ خَاصَّةٌ بِأَزْوَاجِهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَا شَكَّ أَنَّهُنَّ خَيْرُ أُسْوَةٍ لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْآدَابِ الْكَرِيمَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلطَّهَارَةِ التَّامَّةِ، وَعَدَمِ التَّدَنُّسِ بِأَنْجَاسِ الرِّيبَةِ، فَمَنْ يُحَاوِلُ مَنْعَ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ كَالدُّعَاةِ لِلسُّفُورِ وَالتَّبَرُّجِ وَالِاخْتِلَاطِ الْيَوْمَ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِهِنَّ فِي هَذَا الْأَدَبِ السَّمَاوِيِّ الْكَرِيمِ الْمُتَضَمِّنِ سَلَامَةَ الْعَرْضِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ دَنَسِ الرِّيبَةِ غَاشٌّ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مَرِيضُ الْقَلْبِ كَمَا تَرَى» (1). وقال الإمام ابن باز - رحمه الله -: «فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال، وتسترهن منهم، وقد أوضح اللَّه سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء، _________ (1) أضواء البيان، 6/ 592.
(1/130)
وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة، وأن التحجب طهارة وسلامة» (1). وقال الشيخ أبو بكر الجزائري- حفظه اللَّه -: «فهذه الآية الكريمة تعرف بآية الحجاب، إذ هي أول آية نزلت في شأنه، وعلى أثرها حَجَبَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نساءه، وحجب المؤمنون نساءهم، وهي نص في فرض الحجاب، إذ قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} قطعي الدلالة في ذلك، ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إذ لو كان الأمر كما قيل لما حجب أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نساءهم، ولما كان لإذن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبداً. وفوق ذلك أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلهن اللَّه تعالى أمهات المؤمنين، إذ قال اللَّه تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}، فنكاحهن محرم على التأبيد كنكاح الأمهات، فأي معنى إذا لحجبهن وحجابهن إذا كان الحكم مقصورًا عليهن، ومن هنا كان الحكم عاما يشمل كل مؤمنة إلى يوم القيامة، وكان من باب قياس الأولى، فتحريم اللَّه تعالى التأفيف للوالدين يدل على تحريم ضربهما من باب أولى، وهذا الذي دلت عليه نصوص الشريعة، وعمل به المسلمون» (2). _________ (1) حكم السفور والحجاب، ص 4. (2) فصل الخطاب في المرأة والحجاب، ص 34 - 35.
(1/131)
الدليل الخامس: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1). قال الإمام الطبري - رحمه الله -: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ}: لا تتشبهن بالإماء في لباسهن، إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن اللَّه به. فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن، فلا يبدين منهن إلاَّ عينًا واحدة» (2). وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «يقول اللَّه تعالى آمرًا رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن؛ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب: هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) جامع البيان، 20/ 324.
(1/132)
قال الجوهري: الجلباب: الملحفة، قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلًا لها: تمشي النسور إليه وَهْيَ لاهية ... مَشْيَ العَذَارى عليهن الجلابيبُ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدةً. وقال محمد بن سيرين: سألت عَبيدةَ السّلماني عن قول اللَّه تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: تغطي ثُغْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وعن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: «لما نزلت هذه الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها» (1). وقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} أي: إذا فعلن ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر، لسن بإماء ولا عواهر. قال السدي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ _________ (1) تفسير ابن أبي حاتم، 10/ 3154، برقم 17784، وتفسير عبد الرزاق، 3/ 123، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: {يدنين من جلابيبهن}، برقم 4101، وصحح إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 83.
(1/133)
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}، قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة، يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضَيِّقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة، كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب، قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها. وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. ثم قال تعالى متوعدًا للمنافقين، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر: {وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا {وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ} يعني: الذين يقولون: «جاء الأعداء» و «جاءت الحروب»، وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق {لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي: لنسلطنَّك عليهم» (1). وقال العلامة السعدي - رحمه الله -: «{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ _________ (1) تفسير القرآن العظيم، 11/ 242 - 243.
(1/134)
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1). هذه الآية التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه، أن يأمر النساء عمومًا، ويبدأ بزوجاته وبناته؛ لأنهن آكد من غيرهن؛ ولأن الآمر [لغيره] ينبغي أن يبدأ بأهله، قبل غيرهم كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (2) أن {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أي: يغطين بها، وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} دلّ على وجود أذية، إن لم يحتجبن، وذلك، لأنهن إذا لم يحتجبن، ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض، فيؤذيهن، وربما استهين بهن، وظن أنهن إماء، فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} حيث غفر لكم ما سلف، ورحمكم، بأن بين لكم الأحكام، وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} أي: مرض شك أو شهوة _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) سورة التحريم، الآية: 6.
(1/135)
{وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ} أي: المخوفون المرهبون الأعداء، المحدثون بكثرتهم وقوتهم، وضعف المسلمين. ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه، ليعم ذلك، كل ما توحي به أنفسهم إليهم، وتوسوس به، وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين، وتوهين قواهم، والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة، وغير ذلك من المعاصي الصادرة، من أمثال هؤلاء. {لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم، ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك، لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوة ولا امتناع؛ ولهذا قال: {ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً} أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً بأن تقتلهم أو تنفيهم» (1). وقال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ عَلَى احْتِجَابِ الْمَرْأَةِ وَسِتْرِهَا جَمِيعَ بَدَنِهَا حَتَّى وَجْهَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، فَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ مَعْنَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}: أَنَّهُنَّ يَسْتُرْنَ بِهَا جَمِيعَ وُجُوهِهِنَّ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ إِلَّا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ تُبْصِرُ بِهَا، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ. _________ (1) تيسير الكريم الرحمن، ص 788.
(1/136)
فَإِنْ قِيلَ: لَفْظُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، لَا يَسْتَلْزِمُ مَعْنَاهُ سَتْرَ الْوَجْهِ لُغَةً، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ عَلَى اسْتِلْزَامِهِ ذَلِكَ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ، مَعَارَضٌ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ: إِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهُ، وَبِهَذَا يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْوَجْهِ. فَالْجَوَابُ: أَنَّ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قَرِينَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِيهَا: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} يَدْخُلُ فِي مَعْنَاهُ سَتْرُ وُجُوهِهِنَّ بِإِدْنَاءِ جَلَابِيبِهِنَّ عَلَيْهَا، وَالْقَرِينَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ}، وَوُجُوبُ احْتِجَابِ أَزْوَاجِهِ وَسِتْرِهِنَّ وُجُوهَهُنَّ، لَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرَ الْأَزْوَاجَ مَعَ الْبَنَاتِ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْوُجُوهِ بِإِدْنَاءِ الْجَلَابِيبِ، كَمَا تَرَى. وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا: هُوَ مَا قَدَّمْنَا فِي سُورَةِ النُّورِ، فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، مِنْ أَنَّ اسْتِقْرَاءَ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الْمُلَاءَةُ فَوْقَ الثِّيَابِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَفْسِيرُ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ إِيضَاحُهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ قَامَتْ قَرِينَةٌ قُرْآنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، لَا يَدْخُلُ فِيهِ سَتْرُ الْوَجْهِ، وَأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ}، قَالَ: وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ: أَنْ يُعْرَفْنَ عَلَى أَنَّهُنَّ سَافِرَاتٌ كَاشِفَاتٌ عَنْ وُجُوهِهِنَّ;
(1/137)
لِأَنَّ الَّتِي تَسْتُرُ وَجْهَهَا لَا تُعْرَفُ، بَاطِلٌ، وَبُطْلَانُهُ وَاضِحٌ، وَسِيَاقُ الْآيَةِ يَمْنَعُهُ مَنْعًا بَاتًّا; لِأَنَّ قَوْلَهُ: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} صَرِيحٌ فِي مَنْعِ ذَلِكَ. وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} رَاجِعَةٌ إِلَى إِدْنَائِهِنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، وَإِدْنَاؤُهُنُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، لَا يُمْكِنُ بِحَالٍ أَنْ يَكُونَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ بِسُفُورِهِنَّ وَكَشْفِهِنَّ عَنْ وُجُوهِهِنَّ كَمَا تَرَى، فَإِدْنَاءُ الْجَلَابِيبِ مُنَافٍ لِكَوْنِ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةً شَخْصِيَّةً بِالْكَشْفِ عَنِ الْوُجُوهِ، كَمَا لَا يَخْفَى. وَقَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: لِأَزْوَاجِكَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ لَيْسَتْ بِكَشْفِ الْوُجُوهِ; لِأَنَّ احْتِجَابَهُنَّ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ: الْأَوَّلُ: سِيَاقُ الْآيَةِ، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ آنِفًا. الثَّانِي: قَوْلُهُ: لِأَزْوَاجِكَ، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ أَيْضًا. الثَّالِثُ: أَنَّ عَامَّةَ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فَسَّرُوا الْآيَةَ مَعَ بَيَانِهِمْ سَبَبَ نُزُولِهَا، بِأَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كُنْ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِنَّ خَارِجَ الْبُيُوتِ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْضُ الْفُسَّاقِ يَتَعَرَّضُونَ لِلْإِمَاءِ، وَلَا يَتَعَرَّضُونَ لِلْحَرَائِرِ، وَكَانَ بَعْضُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجْنَ فِي زِيٍّ لَيْسَ مُتَمَيَّزًا عَنْ زِيِّ الْإِمَاءِ، فَيَتَعَرَّضُ لَهُنَّ أُولَئِكَ
(1/138)
الْفُسَّاقُ بِالْأَذَى ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُنَّ إِمَاءٌ، فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْمُرَ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتِهِ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَمَيَّزْنَ فِي زِيِّهِنَّ عَنْ زِيِّ الْإِمَاءِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ وَرَآهُنَّ الْفُسَّاقُ، عَلِمُوا أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ لَا إِمَاءَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ}، فَهِيَ مَعْرِفَةٌ بِالصِّفَةِ لَا بِالشَّخْصِ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مُنْسَجِمٌ مَعَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، كَمَا تَرَى. فَقَوْلُهُ: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، لِأَنَّ إِدْنَائِهِنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يُشْعِرُ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرَ، فَهُوَ أَدْنَى وَأَقْرَبُ لِأَنْ يُعْرَفْنَ، أَيْ: يُعْلَمُ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، فَلَا يُؤْذَيْنَ مِنْ قِبَلِ الْفُسَّاقِ الَّذِينَ يَتَعَرَّضُونَ لِلْإِمَاءِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَسَّرَ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةَ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ تَعَرُّضَ الْفُسَّاقِ لِلْإِمَاءِ جَائِزٌ، بل هُوَ حَرَامٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُتَعَرِّضِينَ لَهُنَّ مِنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وَأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}، إِلَى قَوْلِهِ: {وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا}. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَرِّضَ لِمَا لَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} الآيَةَ، وَذَلِكَ مَعْنًى مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: حَافِظٌ لِلْفَرْجِ رَاضٍ بِالتُّقَى ... لَيْسَ مِمَّنْ قَلْبُهُ فِيهِ مَرَضْ وَفِي الْجُمْلَةِ: فَلَا إِشْكَالَ فِي أَمْرِ الْحَرَائِرِ بِمُخَالَفَةِ زِيِّ الْإِمَاءِ
(1/139)
لِيَهَابَهُنَّ الْفُسَّاقُ، وَدَفْعُ ضَرَرِ الْفُسَّاقِ عَنِ الْإِمَاءِ لَازِمٌ، وَلَهُ أَسْبَابٌ أُخَرَ لَيْسَ مِنْهَا إِدْنَاءُ الْجَلَابِيبِ» (1). وقال العلامة الإمام ابن باز - رحمه الله -: «أمر اللَّه سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة (2). وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول اللَّه - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. ثم أخبر اللَّه سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه» (3). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (4). _________ (1) أضواء البيان، 6/ 586 - 588. (2) أخرجه ابن أبي حاتم، 10/ 3154، والطبري، 20/ 324، وقال الشيخ الألباني: «وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم، والحمد للَّه»، جلباب المرأة المسلمة، ص59،، وسيأتي تمام تخريجه. (3) حكم الحجاب والسفور، ص 4 - 5. (4) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/140)
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة، وتفسير الصحابي حجة؛ بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوله - رضي الله عنه -: «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة - رحمه الله - لما نزلت هذه الآية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها» (1)، وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق» (2). الدليل السادس: قال اللَّه تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (3). فنفى الجناح عنهن في ترك الحجاب في هؤلاء المذكورين من الأقارب. قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «لما أمر تبارك وتعالى النساء _________ (1) ابن أبي حاتم، برقم 17784، وأبو داود، برقم 4101، وصححه الألباني، وتقدم تخريجه. (2) رسالة الحجاب، ص 13 - 14. (3) سورة الأحزاب، الآية: 55.
(1/141)
بالحجاب من الأجانب, بَيَّن أنّ هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم, كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}» (1). وجه الدليل هو: أنه لما نفى الجناح عن هؤلاء المذكورين في عدم الاحتجاب عنهم؛ وذلك لأنهم غير أجانب منهن بقي الجناح في حق غيرهم إذا لم يحتجبن عنهم، وهم الأجانب. قال العلامة السعدي - رحمه الله -: {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}؛ لما ذكر أنهن لا يسألن متاعًا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عامًا [لكل أحد] احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون، من المحارم، وأنه {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ} في عدم الاحتجاب عنهم. ولم يذكر فيها الأعمام، والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته، من أبناء الإخوة والأخوات، مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن، من باب أولى؛ ولأن _________ (1) تفسير القرآن العظيم، 11/ 209.
(1/142)
منطوق الآية الأخرى، المصرحة بذكر العم والخال، مقدمة، على ما يفهم من هذه الآية. وقوله: {وَلا نِسَائِهِنَّ} أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن، أي: اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجًا لنساء الكفار، ويحتمل أن المراد جنس النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة. {وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء، شرط فيه وفي غيره، لزوم تقوى الله، وأن لا يكون في محذور شرعي فقال: {وَاتَّقِينَ اللَّهَ} أي: استعملن تقواه في جميع الأحوال {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} يشهد أعمال العباد، ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك، أتم الجزاء وأوفاه» (1). _________ (1) تيسير الكريم الرحمن، ص 787.
(1/143)
ثانياً: أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة: الدليل الأول: أحاديث أسباب نزول الحجاب: قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في سبب نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النّبِيّ إِلاّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىَ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِيّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوَاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيماً * إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنّ اللهَ كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً} (1): «هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية, وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - , كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي - عز وجل - في ثلاث, قلت: يا رسول اللَّه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى, فأنزل اللَّه تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}، وقلت: يا رسول اللَّه إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن؟ فأنزل اللَّه آية الحجاب, وقلت لأزاوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا تمالأن عليه في الغيرة: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ} فنزلت كذلك, وفي رواية لمسلم ذكر أسارى _________ (1) سورة الأحزاب، الآيتان: 53 - 54.
(1/144)
بدر وهي قضية رابعة» (1). وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول اللَّه، يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب, فأنزل اللَّه آية الحجاب» (2). قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش الأسدية التي تولى اللَّه تعالى تزويجها بنفسه, وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة، والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث, فاللَّه أعلم» (3). وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما تزوّج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش, دعا القوم فطعموا, ثم جلسوا يتحدثون, فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا, فلما رأى ذلك قام, فلما قام, قام من قام، وقعد ثلاثة نفر, فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليدخل, فإذا القوم جلوس, ثم إنهم قاموا فانطلقوا, فجئت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى _________ (1) البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ... ، برقم 402، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -، باب من فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، برقم 2399، وهي رواية مسلم المشار إليها فلفظها: «قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ». (2) مسلم، كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -، باب من فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، برقم 2399. (3) تفسير القرآن العظيم، 11/ 202.
(1/145)
دخل, فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} الآية (1). وفي لفظ البخاري عن أنس بن مالك قال: بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينت بنت جحش بخبز ولحم, فَأُرْسِلْتُ على الطعام داعياً, فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون, ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون, فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه, فقلت: يارسول اللَّه ما أجد أحداً أدعوه, قال: «ارفعوا طعامكم»، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - , فانطلق إلى حجرة عائشة - رضي الله عنها - فقال: «السلام عليكم - أهل البيت - ورحمة اللَّه وبركاته»، قالت: وعليك السلام ورحمة الله, كيف وجدت أهلك يا رسول اللَّه؟ بارك اللَّه لك؟ فَتَقَرَى (2) حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة, ويقلن له كما قالت عائشة, ثم رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثلاثة رهط [في البيت] يتحدثون, وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - شديد الحياء, فخرج منطلقاً نحو حُجْرة عائشة, فما أدري أخبرتُه أم أُخْبِرَ أن القوم خَرَجوا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في أُسْكُفَّةِ (3) الباب داخله والأخرى خارجة, أرخى الستر بيني وبينه, وأنزلت آية الحجاب» (4). _________ (1) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}، برقم 4791، وبرقم 4792، وبرقم 6239، و6271، ومسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، رقم 11792. (2) أي: تتبعها. (3) أسكفة الباب: عتبته. (4) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}، برقم 4793، و4794، والنسائي في السنن الكبرى، برقم 10101.
(1/146)
وعن أنس بن مالك قال: أعرس رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ببعض نسائه, فصنعت أم سُليم حيساً (1)، ثم جعلته في تَوْر (2)، فقالت: اذهب بهذا إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وأقرئه مني السلام، وأخبره أن هذا منا له قليل, قال أنس: والناس يومئذ في جهد, فجئت به فقلت: يارسول اللَّه، بعثت بهذا أم سُليم إليك, وهي تقرئك السلام، وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل, فنظر إليه ثم قال: «ضعه»، فوضعته في ناحية البيت، ثم قال: «اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً»، فسمى رجالاً كثيراً وقال: «ومن لقيت من المسلمين»، [فدعوت من قال لي، ومن لقيت من المسلمين] , فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس, فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة، قال أنس: فقال لي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «جِئْ بِهِ»، فجئتُ به إليه، فوضع يده عليه ودعا، وقال: «ما شاء اللَّه»، ثم قال: «ليَتَحَلَّق عَشَرة عَشَرَة, وليسمُّوا, وليأكل كل إنسان مما يليه»، فجعلوا يسمّون ويأكلون، حتى أكلوا كلهم, فقال لي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «ارفعه» قال: فجئتُ فأخذت التور, فنظرت فيه فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال: وتخلّف رجال يتحدثون في بيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وزوج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - التي دخل بها معهم مُولية وجهها إلى الحائط, فأطالوا الحديث, _________ (1) الحيس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوَّى كالثريد. (2) التور: إناء يشرب فيه.
(1/147)
فشقوا على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، [وكان أشدَّ الناس حياء, - ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاً]- فقام رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - , فخرج فسلَّم على حُجره وعلى نسائه, فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه, ابتدروا الباب فخرجوا, وجاء رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حتى أرخى الستر، ودخل البيت وأنا في الحجرة, فمكث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في بيته يسيراً، وأنزل اللَّه عليه القرآن, فخرج وهو يقرأ هذه الآية: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النّبِيّ إِلاّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىَ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ} إلى قوله: {بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً} الآيات, قال أنس: فقرأهن عليَّ قبل الناس, فأنا أحدث الناس بهن عهداً» (1). قال ابن كثير - رحمه الله -: «وقد رواه مسلم، والترمذي، والنسائي جميعاً عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به» (2) , وعلقه البخاري في كتاب النكاح, فقال: وقال إبراهيم بن طهمان، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس فذكر نحوه (3). ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر عن الجعد به (4) , (5). _________ (1) تفسير ابن أبي حاتم، 10/ 3149، برقم 17759. وهذا لفظه. (2) مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، برقم 94 - (1428)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، برقم 3218، والنسائي، كتاب النكاح، باب الهدية لمن عرس، برقم 3387. (3) البخاري، كتاب النكاح، باب الهدية للعروس، برقم 5163، (4) مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، برقم 95 - (1428)، وانظر: صحيح البخاري، برقم 5170. (5) تفسير القرآن العظيم، 11/ 204.
(1/148)
وعن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لزيد: «اذهب فاذكرها عليَّ»، قال: فانطلق زيد حتى أتاها، قال وهي تُخمر عجينها, فلما رأيتُها عظُمَتْ في صدري ... , وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً}، وزاد في آخره بعد قوله: وَوَعَظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىَ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِيّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقّ} الآية» (1). وعن عائشة - رحمه الله - قالت: إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح -، وكان عمر يقول لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: احجب نساءك, فلم يكن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ليفعل, فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - , وكانت امرأة طويلة, فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة، حِرْصاً على أن _________ (1) مسلم في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، برقم 89 - (1428) عن محمد بن حاتم، عن بهز، وعن محمد بن رافع، عن أبي النضر بن القاسم، والنسائي، كتاب النكاح، باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها، برقم 3251، وفي التفسير في الكبرى، قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطراً}، برقم 11346، عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان به.
(1/149)
ينزل الحجاب, قالت: فأنزل اللَّه الحجاب» (1). ولكن قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «هكذا وقع في هذه الرواية, والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب، كما رواه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رحمه الله - قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها, وكانت امرأة جسيمة, لا تخفى على من يعرفها, فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما واللَّه ما تَخْفَيْنَ علينا, فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة، ورسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وإنه ليتعشّى وفي يده عَرْقٌ (2) , فدخلت فقالت: يارسول اللَّه إني خرجت لبعض حاجتي, فقال لي عمر: كذا وكذا, قالت: فأوحى اللَّه إليه, ثم رُفعَ عنه، وإن العرق في يده ما وضعه, فقال: «إنه قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن» (3). لفظ البخاري» (4). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «والحاصِل أَنَّ عُمَر - رضي الله عنه - وقَعَ فِي قَلبه نُفرَة مِن اطِّلاع الأَجانِب عَلَى الحَرِيم النَّبَوِيّ، حَتَّى صَرَّحَ بقَولهِ لَهُ عَلَيهِ الصَّلاة والسَّلام: اُحجُب نِساءَك، وأَكَّدَ ذَلِكَ إِلَى أَن نَزَلَت _________ (1) أخرجه ابن جرير بسنده في جامع البيان، 22/ 28. (2) العرق: العظم أخذ عنه معظم اللحم، وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. (3) المسند، 40/ 333، برقم 24290، والبخاري في كتاب الوضوء، باب خروج النساء إلى البراز، برقم 146، ورقم 147، و4795، و5237، و6240، ومسلم، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، برقم 2170. (4) تفسير القرآن العظيم، 11/ 206.
(1/150)
آيَة الحِجاب، ثُمَّ قَصَدَ بَعدَ ذَلِكَ أَن لا يُبدِينَ أَشخاصهنَّ أَصلاً، ولَو كُنَّ مُستَتِرات، فَبالَغَ فِي ذَلِكَ، فَمَنَعَ مِنهُ، وأَذِنَ لَهُنَّ فِي الخُرُوج لِحاجَتِهِنَّ دَفعًا لِلمَشَقَّةِ، ورَفعًا لِلحَرَجِ» (1). وقال القسطلاني - رحمه الله -: «وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء لا حجب أشخاصهن في البيوت» (2). وقال ابن كثير - رحمه الله -: «فقوله تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} حَظَر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام, حتى غار اللَّه لهذه الأمة، فأمرهم بذلك, وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والدخول على النساء» (3). ثم استثنى من ذلك فقال تعالى: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}. قال مجاهد، وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه, أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول, فإن هذا مما يكرهه اللَّه ويذمّه, وهذا دليل على _________ (1) فتح الباري، 8/ 531. (2) إرشاد الساري، 7/ 303. (3) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، برقم 5232، ومسلم، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، برقم 2172.
(1/151)
تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفن, وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً في ذم الطفيليين, وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم قال تعالى: {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا}، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا دَعَا أَحَدُكُم أخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرساً كان أو غيره» (1). وفي الصحيح أيضاً عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لو دُعيتُ إلى ذِراعٍ لأجبتُ، ولو أُهدِي إليَّ ذِراعٌ أوْ كُرَاعٌ لقبِلْتُ» (2)؛ ولهذا قال تعالى: {وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث, ونسُوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - , كما قال تعالى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ}. وقيل: المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به, ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزل اللَّه عليه النهي عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: {وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا _________ (1) مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم 100 - (1429)، وأصله في الصحيحين. (2) البخاري، كتاب الهبة، باب القليل من الهبة، برقم 2568، ورقم 5178.
(1/152)
إليهن بالكلية, ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن, فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا ابن أبي عمر, حدثنا سفيان، عن مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن مجاهد، عن عائشة - رحمه الله - قالت: كنت آكل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حيساً في قَعْبٍ (1) , فمر عمر فدعاه فأكل, فأصابت إصبعه إصبعي, فقال حسّ (2) - أو أوه- لو أُطاع فيكن ما رأتكن عين, فنزل الحجاب» (3). وقد جمع الحافظ - رحمه الله - بين هذه الروايا فقال: « ... وطَرِيق الجَمع بَينها أَنَّ أَسباب نُزُول الحِجاب تَعَدَّدَت، وكانَت قِصَّة زَينَب آخِرها لِلنَّصِّ عَلَى قِصَّتها فِي الآيَة» (4). وقال الحافظ بعد ذكر حديث عائشة - رحمه الله - آنف الذكر الذي أصابت أصبعه أصبعها فيه: «ويُمكِن الجَمع بِأَنَّ ذَلِكَ وقَعَ قَبلَ قِصَّة زَينَب، فَلِقُربِهِ مِنها أَطلَقت نُزُول الحِجاب بِهَذا السَّبَب، ولا مانِع مِن تَعَدُّد الأَسباب» (5). _________ (1) القعب: القدح الضخم. (2) حس: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضّه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما. انظر: النهاية في غريب الحديث، 1/ 385. (3) تفسير القرآن العظيم، 11/ 207. (4) فتح الباري، لابن حجر، 1/ 249. (5) فتح الباري، لابن حجر، 8/ 531.
(1/153)
«{ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} أي هذا الذي أمرتكم به، وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب» (1). الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» (2). قال الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - في شرحه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» (3): «وهذا الحديث دالٌّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائها، وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال: «ظُفر المرأةِ عورةٌ، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِنْ منها شيئَاً، ولا خُفَّها؛ فإن الخُفَّ يصفُ القدم، وأَحَبُّ إليَّ أن تجعل لكُمِّها زِرّاً عند يدها حتى لا يبين منها شيء». اهـ. وقد تقدّم ذكر ما نقله شيخ الإِسلام ابن تيميه عن الإمام أحمد أنه قال: «كل شيء منها عورة حتى ظفرها»، قال شيخ الإسلام: «وهو قول مالك» (4) اهـ. وفي لفظٍ عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون _________ (1) تفسير القرآن العظيم، 11/ 207. (2) الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، 1685، وصححه الألباني في إرواء الغليل،، سبق تخريجه بنص: «المرأة عورة». (3) البزار في البحر الزخار، برقم 2061، وابن خزيمة في صحيحه، برقم 1685، وتقدم تخريجه. (4) الصارم المشهور، ص 96، والرد القوي، ص 245.
(1/154)
بروحة ربها وهي في قعر بيتها» (1) (2). وقال المباركفوري - رحمه الله -: «(فإذا خرجت استشرفها الشيطان): أي زيّنها في نظر الرجال، وقيل: أي نظر إليها ليغويها، ويغوي بها، والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء، وبسط الكف فوق الحاجب، والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها؛ فإذا خرجت أمعن النظر إليها، ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها بها؛ ليوقعهما، أو أحدهما في الفتنة، أو يريد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق، سمّاه به على التشبيه» (3). الدليل الثالث: حديث عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» (4). _________ (1) البزار في البحر الزخار، برقم 2061، وابن خزيمة في صحيحه، برقم 1685، وتقدم تخريجه. (2) قال الشنقيطي - رحمه الله -: «وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون، وهذا الحديث يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة، وما جاء فيه من كون المرأة عورة: يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة، ومما يؤيد ذلك: الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج عن بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: «إنك لا تمرّين بأحد إلا أعجبتِهِ، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها»، ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات». اهـ. منه ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه». [أضواء البيان، 6/ 596]. (3) تحفة الأحوذي، 4/ 337، برقم 183. (4) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1838، ورواه مالك موقوفاً على ابن عمر، الموطأ، 3، 473، برقم 1175.
(1/155)
ووجه الدليل منه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: «وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمْنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن» (1). وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: «قوله في حديث ابن عمر: «لا تنتقب المرأة»؛ وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها» (2). وقال صفي الرحمن المباركفوري: «هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغير والتطوير فى ألبسة النساء بعد نزول الحجاب، والأمر بإدناء الجلباب، وأن النقاب كان قد صار ديدن النساء بحيث لم يكنَّ يخرجنَ إلا به، وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها، وإنما المراد أنها تتخذ النقاب لباساً مستقلاً، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهَ عن تغطية وجوه المحرمات، وإنما النهي عن النقاب ونحوه، وعن القفازين فقط» (3). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وَكُنَّ النِّسَاءُ يُدْنِينَ عَلَى _________ (1) انظر: حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام، ص 14. (2) عارضة الأحوذي، 4/ 56. (3) انظر: إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب، الحلقة الخامسة، مجلة الجامعة السلفية، ص 50.
(1/156)
وُجُوهِهِنَّ مَا يَسْتُرُهَا مِنَ الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ مَا يُجَافِيهَا كبدن الرجل، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ، فَلَهَا أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا لَكِنْ بِغَيْرِ اللِّبَاسِ الْمَصْنُوعِ بِقَدْرِ الْعُضْوِ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَيَلْبَسُ الْإِزَارَ» (1). وقال الشيخ محمد أديب كلكل تعليقاً على هذا الحديث: «وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب، ولبس القفازين عامَّة، فنُهين عنه في الإحرام» (2). قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: «والمسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: «ولا تَنَتقِب الَمرأةُ»؛ وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها» (3). وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ووجه المرأة في الإِحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى، وقيل: إنه كبدنه، فلا يغطى بالنقاب والبُرْقُع ونحو ذلك مما صنع على قدره؛ وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهَ إلاَّ عن القفازين والنقاب، وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال _________ (1) انظر: حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 14، ومجموع الفتاوى له، 15/ 370 - 371. (2) انظر: اللباب في فرضية النقاب، ص 115. (3) عارضة الأحوذي، 4/ 56.
(1/157)
من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فَعُلِمَ أن وجهها كبدن الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة، فلها أن تغطي وجهها ويديها (1)؛ لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإِزار» (2). * وقال الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في تهذيب السَنن: «وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمِقْنَعة والجِلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصَّل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد، في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء، وهذا واضح بحمد اللَّه» (3). وقال أيضًا في إعلام الموقعين في الحديث نفسه: «ونساؤه - صلى الله عليه وسلم - _________ (1) يعني في حال الإحرام. (2) مجموع الفتاوى، 20/ 120. (3) تهذيب سنن أبي داود، 5/ 282 - 283 بهامش عون المعبود.
(1/158)
أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن، ورَوى وكيع، عن شعبة، عن يزيدَ الرِّشْك، عن معاذة العدوية قالت: سألتُ عائشة - رحمه الله - ما تلبسُ المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب ولا تتلثم، وتسدل الثوبَ على وجهها» (1). ثم ذكر ابن القيم - رحمه الله - قول الذين يمنعون المحرمة من تغطية وجهها وردَّ عليهم إلى أن قال: «فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر اللَّه لها أن تدني عليها جلبابها، لئلا تُعْرَفَ ويفْتَتَن بصورتها؟» (2). وذكر الإمام ابن القيم أيضاً في بدائع الفوائد سؤالاً في كشف المرأة وجهها في حال الإِحرام، وجواباً لابن عقيل في ذلك، ثم تعقبه بالرد فقال: «سبب هذا السؤال والجواب خفاءُ بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإِحرام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النصُّ بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء، لم يُرِد _________ (1) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه زعفران أو ورس، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها» رواه البيهقي، 5/ 47، وغيره. انظر: مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص 108 - 110. (2) إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1/ 266.
(1/159)
أنها تكون مكشوفة لا تُسْتَرُ البتة؛ بل قد أجمع الناسُ على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودِرْعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإِزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يُزاد على موجَب النص، ويُفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارًا؟ فأي نص اقتضى هذا، أو مفهومِ أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل، يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبُرقع، بل وكَيَدِها يحرم سترُها بالمفصَّل على قدر اليدين كالقُفَّاز، وأما سترها بالكم، وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم يُنْه عنه البتة، ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم، فليس معه بذلك نص ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس المحرِم، لما جعل اللَّه بينهما من الفرق. وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها، إنما أراد به هذا المعنى، أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يَلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها كبدن الرجل. ولو قُدِّر أنه أراد وجوبَ كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك، وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة - رحمه الله -: «كُنَّا إذا مَرَّ
(1/160)
بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها» (1)، ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب (2)، كما قاله بعض الفقهاء، ولا يُعْرَفْ هذا عن امرأة من نساء الصحابة، ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملاً ولا فتوىً، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإِحرام، ولا يكونَ ظاهرًا مشهورًا بينهن يعرفه الخاص والعام. ومن آثر الإِنصاف، وسلك سبيل العلم والعدل، تبين له راجح المذاهب من مرجوحها، وفاسدها من صحيحها، واللَّه الموفق والهادي» (3). ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخِيطَ كلَّه والخِفافَ، وأنَّ لها أن تغطي رأسها، وتستُر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوبَ سدلًا خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب، ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - تعني جدتها» (4). قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدْلاً، كما جاء عن عائشة _________ (1) أخرجه أحمد، برقم 24021، وأبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، 1/ 107: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. (2) انظر: نيل الأوطار، 5/ 71. (3) بدائع الفوائد، 3/ 174 - 175. (4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، 1/ 328، برقم 16 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وابن خزيمة، 4/ 203، برقم 2690، والحاكم، 1/ 45، وصححه، ووافقه الذهبي.
(1/161)
- رحمه الله - قالت: «كنّا مع رسول اللَّه - رضي الله عنه - إذا مرَّ بنا رَكْبٌ سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزونا رفعناه» (1). قال العلامة الصنعاني في حاشيته على شرح العمدة بعد ما ذكر الحديث: «لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين». قال: «قوله: بوجهها وكفيها، أقول: فلا يُلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا لأن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهم، فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين» (2). الدليل الرابع: حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ» (3). قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «ففي قولها: فإذا حاذونا تعني الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى عند الركبان، وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر _________ (1) فتح الباري، لابن حجر، 3/ 406. (2) العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاني، 3/ 476. (3) أخرجه أحمد، 40/ 522، برقم 24021، وأبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، 1/ 107: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه.
(1/162)
من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب، وتغطية الوجه عند الأجانب، ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن» (1). وهذا الحديث صريح في شمول الحجاب للوجوه، بل يفيد أن تغطية الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب، والحديث حكمه عام لجميع نساء المؤمنين؛ فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب كما يزعمه الزاعمون، والدليل على ذلك أن عائشة - رحمه الله - التي روت هذا الحديث، وهي التي كانت تفتي: بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وروى مالك في الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإِحرام كان عامًّا في النساء، لا في زمن الصحابة فقط، بل فيما بعدهم أيضَاً، فقد روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نُخَمِّرُ وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا» (2). وهذا العموم هو الذي فهمه العلماء في حديث عائشة. _________ (1) رسالة الحجاب، ص 18 - 19. (2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، برقم 16، وابن خزيمة، برقم 2690، والحاكم، 1/ 45، وصححه، ووافقه الذهبي، وتقدم تخريجه.
(1/163)
قال في عون المعبود في قولها: «يمرون بنا»: أي علينا معشر النساء» (1). وقال الشوكاني: «واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقَاً كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبينه - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها لا وجهها، فتسدل الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال» (2). والمقصود من نقل كلام الشوكاني، وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه الضمائر راجعة إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة» (3). الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «كنا نغطّي وجوهَنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإِحرام» (4). _________ (1) عون المعبود، 5/ 102، 104، 105. (2) نيل الأوطار، 5/ 7. (3) مجلة الجامعة السلفية، عدد أكتوبر، 1978م. (4) أخرجه الحاكم، 1/ 454، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وهو صحيح على شرط مسلم وحده.
(1/164)
الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت: «كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -» (1). وفي تعبير أسماء - رضي الله عنها - بصيغة الجمع في قولها: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» دليلٌ على أن عمل النساء في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب، واللَّه أعلم، أما حديث فاطمة بنت المنذر، فيفيد أن تغطية الوجه في الإِحرام كان عامًّا في النساء، لا في زمن الصحابة فقط؛ بل فيما بعدهم أيضًا. قال صفي الرحمن المباركفوري - رحمه الله -: «وهذا الحديث أيضاً صريح في شمول الحجاب للوجوه، بل ويفيد أن تغطية الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب، وحكم هذا الحديث عام لجميع نساء المؤمنين؛ فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب كما يزعمه الزاعمون، والدليل على ذلك أن عائشة - رضي الله عنها - هي التي روت هذا الحديث، وهي التي كانت تفتي بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجهها، وروى مالك في الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإِحرام كانت عامًّة في النساء، لا في زمن الصحابة فقط، بل فيما بعدهم أيضَاً، فقد روى عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا» (2). الدليل السابع: حديث ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ _________ (1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، 1/ 328، وابن خزيمة، برقم 2690، والحاكم، 1/ 45، وصححه، ووافقه الذهبي، وتقدم تخريجه. (2) إبراز الحق، للمباركفوري، ص 49.
(1/165)
جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (1). قال الترمذي: «وفي الحديث رخصة للنساء في جَرِّ الإزار؛ لأنه يكون أستَرَ لهن». وقال البيهقي: «في هذا دليل على وجوب ستر قدميها». وفي رواية لأحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للنساء أن يُرْخين شبرًا، فقلن: يا رسول الله إذًا تنكشف أقدامُنا، فقال: «ذِرَاعاً ولا يَزِدْنَ عليه» (2). وفي رواية له أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنها - أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - سألنه عن الذيل، فقال: «اجعلنَه شِبرَا»، فقلن: شبراً لا يَسْتُرُ من عَورَةِ، فقال: «اجعلْنَه ذرَاعَا»، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعاً _________ (1) أخرجه أحمد، 9/ 158، برقم 5173، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، برقم 4117، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في ذيول النساء، برقم 1730، وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب الزينة، باب ذيول النساء، برقم 5336، وفي الكبرى له، كتاب الزينة، ذيول النساء، برقم 9651، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون، برقم 3580، قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص80: «حسن صحيح»، وقال محققو المسند في التعليق على الحديث رقم 4489، 8/ 73: «إسناده صحيح على شرط الشيخين، دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولاً بهذه الزيادة بإسناد صحيح». (2) انظر: سنن النسائي، 8/ 209، برقم 5336، وابن ماجه، برقم 3580، وأحمد، برقم 5173.
(1/166)
أرخت ذراعَاً، فجعلته ذيلاً (1). قال العلامة التويجري - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث والحديثين بعده دليل على أن المرأة كلها عورة في حق الرجال الأجانب؛ ولهذا لما رخّص النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء في إِرخاء ذيولهن شبرًا، قلن له: إنَّ شبراً لا يستر من عورة، والعورة ها هنا القدم، كما هو واضح من باقي الروايات عن ابن عمر، وأم سلمة - رضي الله عنهم -. وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء على جعل القدمين من العورة، وإذا كان الأمر هكذا في القدمين، فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن؟ ولا سيما الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة؟ وأعظم ما يَفْتَتِنُ به الرجال، ويتنافسون في تحصيله إن كان حسناً. ومن المعلوم أن العشق الذي أضنى كثيراً من الناس، وقتل كثيراً منهم، إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة، لا إلى الأقدام وأطراف الأيدي، ولا إلى الحلي والثياب، وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترها، فوجهُها أولى أن يُسْتَر، واللَّه أعلم» (2). وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -: «هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة - رضي الله عنهم -، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه _________ (1) مسند أحمد، 5/ 455، برقم 5636، وصححه محققو المسند لغيره، 5/ 455. (2) الصارم المشهور، ص 97 - 98.
(1/167)
بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة؛ فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة اللَّه وشرعه» (1). الدليل الثامن: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (2). قال الشنقيطي - رحمه الله -: «فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن، وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب؛ لأن من سألها متاعَاً لا من وراء حجاب فقد دخل عليها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حذَّره من الدخول عليها، ولما سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرمَاً لزوجته: كأخيه، وابن أخيه، وعمه، وابن عمه، ونحو ذلك، قال له - صلى الله عليه وسلم -: «الحَمو الموتُ»، فسمَّى - صلى الله عليه وسلم - دخول قريب الرجل على امرأته، وهو غير محرم لها باسم الموت، ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا، كما قال الشاعر: والموتُ أعظمُ حادثٍ ... مِمَّا يمرُّ على الجِبِلَّةْ _________ (1) الحجاب، ص 10. (2) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم 5232، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2172.
(1/168)
والجبلة: الخُلُق، ومنه قوله تعالى: {وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ} (1). فتحذيره - صلى الله عليه وسلم - هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء، وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت، دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} عام في جميع النساء كما ترى، إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه - صلى الله عليه وسلم -، لما حذَّر الرجال هذا التحذير البالغ العامِّ من الدخول على النساء. وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن، ولو لم تحصل الخلوة بينهما، وهو كذلك، فالدخول عليهن، والخلوة بهن كلاهما محرم تحريمًا شديداً بانفراده، كما قدمنا أن مسلماً - رحمه الله - أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، فدلَّ على أن كليهما حرام» (2). وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: «إِيّاكُم والدُّخُول»، بِالنَّصبِ عَلَى التَّحذِير، وهُو تَنبِيه المُخاطَب عَلَى مَحذُور لِيَحتَرِز عَنهُ كَما قِيلَ: إِيّاكَ والأَسَد، وقَوله: «إِيّاكُم» مَفعُول بِفِعلِ مُضمَر تَقدِيره اتَّقُوا. وتَقدِير الكَلام اتَّقُوا أَنفُسكُم أَن تَدخُلُوا عَلَى النِّساء، والنِّساء أَن يَدخُلنَ عَلَيكُم. ووقَعَ فِي رِوايَة ابن وهب بِلَفظِ: لا تَدخُلُوا عَلَى _________ (1) سورة الشعراء، الآية: 184. (2) أضواء البيان، 6/ 592 - 593.
(1/169)
النِّساء، وتَضَمَّنَ مَنعَ الدُّخُول مَنع الخَلوة بِها بِطَرِيقِ الأَولَى» (1). وقال الشيخ عبد القادر السندي: «الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز دخول الأجنبي على الأجنبية، وكذا قريب الزوج من أخ وعم ونحو ذلك، وفي رواية لمسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: «الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه»، وفي الحديث تغليظ شديد، وتنبيه خطير من الدخول على النساء (2). وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: «لا يَخْلُوَنّ رجل بأجنبية، وإن قيل حَمُوها، ألاَ حَمُوها الموتُ، أحدُ الأحْماء أقارِب الزَّوج، والمعنى فيه: أنه إذا كان رَأيُه هذا في أخي الزَّوج وما شابهه، وهو قريب، فكيف بالغَريب؟ أي: فلْتَمُتْ، ولا تَفْعَلَنّ ذلك، وهذه الكلمة تقولُها العرب كما تقول: الأسَدُ الموتُ، والسُّلطانُ النارُ، أي لقاؤهما مِثْل الموت والنار، يعني أنّ خَلْوة ابن عم الزوج معها أشدّ من خلوة غيره من الغُرَباء؛ لأنه ربما حَسَّن لها أشياء، وحَمَلها على أمور تَثْقُل على الزَّوج من الْتِماس ما ليس في وُسْعه، أو سُوء عِشْرة أو غير ذلك» (3). الدليل التاسع: عن عائشة - رضي الله عنها -: «أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ _________ (1) فتح الباري، 9/ 331. (2) انظر: عودة الحجاب، 3/ 309. (3) النهاية، 1/ 448، وهو منقول بتصرف، من مادة (حما).
(1/170)
لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ» (1). وفي رواية أنه قال لها: «أتحتجبين مني، وأنا عمك؟». وفي ثالثة: «فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس». ورواية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة». وقال عروة: «فبذلك كانت عائشة تقول: حَرموا من الرضاع ما يحرم من النسب»، وفي رواية مسلم: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحتَجِبِي منه، فإنه يحَرُمُ من الرضَاعِ ما يحَرُمُ من النسَبِ» (2). قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه» (3). والشاهد فيه واضح، وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر النساء. وقال العيني - رحمه الله -: «قوله بعد أن نزل الحجاب، فيه أنه لا يجوز _________ (1) وفي رواية: «قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ». وفي رواية: «صدق أفلح، ائذني له». والحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل، برقم 5103، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم 1445. (2) مسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم 1445. (3) فتح الباري، 9/ 152.
(1/171)
للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه إجماعاً، وما ورد من بروز النساء، فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب كما صرح به هنا» (1). الدليل العاشر: عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كانَ لإحداكنَّ مَكُاتَبٌ، وكانَ عندَه ما يؤدّي، فلتَحتَجِبْ منه» (2). قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «وجه الدلالة من هذا الحديث - يعني على وجوب الحجاب - أنه يقتضي أنَّ كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها، فإذا خرج منه، وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً، فدل على وجوب احتجاب _________ (1) عمدة القاري، 20/ 98. (2) أخرجه أحمد، 44/ 73، برقم 26473، وأبو داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب، برقم 3928، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، برقم 1261، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي» اهـ. وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم 2520، والحاكم، 2/ 219، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وابن حبان، (1412)، والطبراني في المعجم الكبير،17/ 215، برقم 19391، والبيهقي، 10/ 327، وأشار إلى جهالة نبهان، ثم قال: قال الشافعي: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وقال محققو المسند، 44/ 73: «إسناده ضعيف ... ، فقد روى البيهقي في سننه، 10/ 324 من طريق أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قال: ادْخُلْ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وهذا إسناد صحيح».
(1/172)
المرأة عن الرجل الأجنبي» (1). وروى الطحاوي بإسناده عن ابن شهاب أَنَّ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ، قَالَ: فَكُنْتُ أَتَمَسَّكُ بِهَا كَيْمَا أَدْخُلَ عَلَيْهَا وَأَرَاهَا، فَقَالَتْ وَهِيَ تَسِيرُ: مَاذَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ يَا نَبْهَانُ؟ قُلْتُ: أَلْفَا دِرْهَمٍ، قَالَتْ: فَهُمَا عِنْدَكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَتِ: ادْفَعْ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ؛ فَإِنِّي قَدْ أَعَنْتُهُ بِهِمَا فِي نِكَاحِهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ, ثُمَّ أَلْقَتْ دُونِيَ الْحِجَابَ، فَبَكَيْتُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أُعْطِيهَا إيَّاهَا أَبَدًا، قَالَتْ: إنَّكَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَنْ تَرَانِي أَبَدًا, إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهِدَ إلَيْنَا أَنَّا إذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ؛ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ». ثم قال الطحاوي - رحمه الله -: «وَمِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ مِمَّا يَدْخُلُ فِيهِ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّاسِ ... » (2). وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ سُلَيْمَانُ، قَالَتْ: كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ، قَالَتِ: ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ» (3). _________ (1) رسالة الحجاب، ص 19. (2) مشكل الآثار، 1/ 121. (3) رواه البيهقي، 7/ 95، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 6/ 183، وقال البيهقي عقبه: «وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ، فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَإِذَا قَضَى أَرْخَتْهُ دُونَهُ».
(1/173)
الدليل الحادي عشر: عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «يرحم اللَّه نساء المهاجرات الأول، لما أنزل اللَّه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها» (1). وفي لفظ للبخاري: «أنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَانَتْ تَقُولُ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (2). «وروى ابن أبي حاتم هذا الحديث من طريق صفية بنت شيبة، قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: «إن لنساء قريش لفضلَاً، وإني واللَّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا لكتاب اللَّه، ولا إيماناً بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} انقلب رجالهن إليهن، يتلون عليهن ما أنزل اللَّه عليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته، وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل، فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل اللَّه من كتابه، فأصبحن وراء رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان» (3). وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «رحم اللَّه نساء الأنصار، لما _________ (1) البخاري، كتاب التفسير، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، برقم 4758. (2) البخاري، كتاب التفسير، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، برقم 4759. (3) أخرجه ابن أبي حاتم، 8/ 2575، وعزاه السيوطي في الدر المنثور، 11/ 27 لأبي داود وابن أبي حاتم وابن مردويه، وقد رواه البخاري مختصراً معلقاً في كتاب التفسير، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، برقم 4758،.
(1/174)
نزلت {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} الآية. شققن مروطهن فاعتجرن بها، وصلين خلف رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كأنما على رؤوسهن الغربان» (1). «ولا يتأتّى تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن» (2). قال الحافظ - رحمه الله -: «قَوله: (مُرُوطهنَّ) جَمع مِرط وهُو الإِزار، وفِي الرِّوايَة الثّانِيَة: (أُزُرهنَّ)، وزادَ (شَقَقنَها مِن قِبَلِ الحَواشِي). قَوله: (فاختَمَرنَ) أَي غَطَّينَ وُجُوهَهُنَّ؛ وصِفَة ذَلِكَ: أَن تَضَع الخِمار عَلَى رَأسها، وتَرمِيه مِنَ الجانِب الأَيمَن عَلَى العاتِق الأَيسَر وهُو التَّقَنُّع، قالَ الفَرّاء: كانُوا فِي الجاهِلِيَّة تُسدِل المَرأَة خِمارها مِن ورائِها، وتَكشِف ما قُدّامها، فَأُمِرنَ بِالاستِتارِ، والخِمار لِلمَرأَةِ كالعِمامَةِ لِلرَّجُلِ ... وأَخرَجَهُ النَّسائِيُّ مِن رِوايَة ابن المُبارَك عَن إِبراهِيم بن نافِع بِلَفظِ (أَخَذَ النِّساء). وأَخرَجَهُ الحاكِم مِن طَرِيق زَيد بن الحُبابِ، عَن إِبراهِيم بن نافِع بِلَفظِ: (أَخَذَ نِساء الأَنصار)، ولابنِ أَبِي حاتِم مِن طَرِيق عَبد اللَّه بن عُثمان بن خُثَيمٍ عَن صَفِيَّة ما يُوضِّح ذَلِكَ، ولَفظه: «ذَكَرنا عِندَ عائِشَة نِساء قُرَيش وفَضلَهُنَّ، فَقالَت: إِنَّ نِساء قُرَيش لَفُضَلاء، ولَكِنِّي واللَّه ما رَأَيت أَفضَل مِن نِساء الأَنصار أَشَدّ تَصدِيقًا بِكِتابِ اللَّه، ولا _________ (1) ذكره في الدر المنثور، 12/ 143. (2) إلى كل فتاة تؤمن باللَّه، ص 41.
(1/175)
إِيمانًا بِالتَّنزِيلِ، لَقَد أُنزِلَت سُورَة النُّور {وَلْيَضْرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فانقَلَبَ رِجالهنَّ إِلَيهِنَّ يَتلُونَ عَلَيهِنَّ ما أُنزِلَ فِيها، ما مِنهُنَّ امرَأَة إِلاَّ قامَت إِلَى مِرطها فَأَصبَحنَ يُصَلِّينَ الصُّبح مُعتَجِرات كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الغِربان» ويُمكِن الجَمع بَينَ الرِّوايَتَينِ بِأَنَّ نِساء الأَنصار بادَرنَ إِلَى ذَلِكَ» (1). الدليل الثاني عشر: حديث عائشة - رحمه الله - في حديث الإفك، قال: «فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ (2) حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي» الحديث (3). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله: (فخمرت): أي غطيت وجهي بجلبابي، أي: الثوب الذي كان عليها، وفِي رِوايَة أَبِي أُويس فاستَرجَعَ وأَعظَمَ مَكانِي، أَي حِينَ رَآنِي وحدِي، وقَد كانَ يَعرِفُنِي قَبلَ أَن يُضرَب عَلَينا الحِجاب، فَسَأَلَنِي عَن أَمرِي، فَسَتَرت وجهِي عَنهُ بِجِلبابِي، وأَخبَرته بِأَمرِي» (4). _________ (1) فتح الباري، 8/ 490. (2) باسترجاعه: تعني قوله: «إنا للَّه وإنا إليه راجعون». (3) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، برقم 4141، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، برقم 2770. (4) فتح الباري، 6/ 6.
(1/176)
وقال صفي الرحمن المباركفوري - رحمه الله -: «ومعنى هذا أنه لو لم يكن رآها قبل الحجاب لم يكن ليعرفها برؤيتها، فهذا الحديث نص في شمول الحجاب للوجه، ويفيد أن الحجاب يمنع الرائي من معرفة المرأة بوجهها؛ لكون الوجه مستوراً تمام الستر» (1). وهذا يدل على أن تغطية الوجه عامة لجميع النساء؛ لأنه لم يرد أن ذلك خاص بها ولا غيرها. الدليل الثالث عشر: حديث أُمِّ عَطِيَّةَ - رحمه الله - قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» (2) هذا أحد ألفاظ مسلم. وفي لفظ له: «أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ». ولفظ البخاري: «قالت امرأة: يا رسول اللَّه، إحدانا ليس لها _________ (1) إبراز الحق، ص 49. (2) البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، برقم 351، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم 890.
(1/177)
جلبابٌ؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها» (1). قال العلامة ابن عثيمين- رحمه الله -: «فهذا الحديث يدل على أنّ المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج امرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج؛ ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن حل هذا الإشكال، بأن تلبسها أختها من جلبابها، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به، فكيف يرخّص لهن في ترك الجلباب لخروجٍ غير مأمور به، ولا محتاج إليه، بل هو للتجول في الأسواق، والاختلاط بالرجال، والتفرج الذي لا فائدة منه، وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر، واللَّه أعلم» (2). قال الإمام ابن رجب - رحمه الله -: و (الجلباب): قال ابن مسعود ومجاهد وغير هما: هو الرداء، ومعنى ذلك: أنه للمرأة كالرداء للرجل، يستر أعلاها، إلا أنه يقنعها فوق رأسها، كما يضع الرجل رداءه على منكبيه. _________ (1) البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، برقم 351، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم 890. (2) رسالة الحجاب، ص 15.
(1/178)
وقد فسر عَبيدَةُ السلماني قول اللَّه - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ} بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، وهذا كان بعد نزول الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرأة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله - عز وجل -: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. ثم أمرت بستر وجهها وكفيها ... إلى أن قال: فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب؛ فلهذا سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرأة منا ليس لها جلباب؟ فقال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» يعني تعيرها جلباباً تخرج فيه ... إلى أن قال: فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس؛ لا للصلاة، ويدل عليه: أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيَّض وغيرهن، وقد تكون فاقدة الجلباب حائضاً، فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال ... وليس من باب أخذ الزينة للصلاة؛ فإن الحرة تصلي في بيتها بغير جلباب بلا خلاف» (1). الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ _________ (1) فتح الباري، لابن رجب، 2/ 351، برقم 351.
(1/179)
رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» (1). قال الإمام النووي - رحمه الله -: «هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. قيل: معناه: كاسيات من نعمة اللَّه، عاريات من شكرها. وقيل: معناه: تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهاراً [لجمالها] ونحوه، وقيل: معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. وأما مائلات فقيل: معناه: عن طاعة اللَّه، وما يلزمهن حفظه، مميلات: أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: مائلات: يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا، مميلات، يمشطن غيرهن تلك المشطة، ومعنى: «رؤوسهن كأسنمة البخت» أن يكبرنها، ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها» (2). وقال القاضي عياض - رحمه الله -: «كاسيات عاريات، ... إلخ: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: كاسيات من نعم اللَّه تعالى، عاريات من الشكر. الثاني: كاسيات: يكشفن بعض جسدهنّ، ويسبلن الخُمر من ورائهن، فتنكشف صدورهن، فهن كاسيات بمنزلة العاريات، إذا _________ (1) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، برقم 2128. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 110، وفيض القدير للمناوي، 4/ 209، برقم 5045.
(1/180)
كان لا يستر لباسُهُنَّ جميعَ أجسادهنَّ. الثالث: يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها، فهن كاسيات في ظاهر الأمر، عاريات في الحقيقة. وقوله: «مائلات مميلات»: أي زائغات عن استعمال طاعة اللَّه تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج» (1). الدليل الخامس عشر: عَنْ عَائِشَةَ - رحمه الله - قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ» (2). الدليل السادس عشر: حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه - في قصة زواج رسول اللَّه من ِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ - رحمه الله -: «فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ» (3). وفي رواية أخرى عن أنس - رضي الله عنه - أيضاً قال: «فلما قُرِّب البعير لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ليخرج، وضع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رجله لصفية لتضع قدمها _________ (1) إكمال المعلم بفوائد مسلم، 8/ 386، برقم 2128. (2) البخاري، أبواب المسجد، باب أصحاب الحراب في المسجد، برقم 5236، مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد، برقم 892. (3) البخاري، كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، برقم 5085، ومسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، برقم 1365.
(1/181)
على فخذه، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه، وسترها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها، ثم شده من تحت رجلها، وتحمَّل بها، وجعلها بمنزلة نسائه» (1). وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضاً؛ لأنه من فعله - صلى الله عليه وسلم - بيده الكريمة، فهو عمل كامل، حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - ستر جسمها كله، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه، فهو القدوة الحسنة، ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها، وجميع بدنها، ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح، لكفى به موجبًا وموجهاً إلى أكمل الصفات» (2). وقصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات المؤمنين، بل على عكس من ذلك تدل عل عمومه لهن ولنساء المسلمين؛ لأن السياق يصرح تمام التصريح بأن الصحابة كانوا مترددين في أمر صفية أنها مملوكة سُرِّيَّةٌ أو حرَّة متزوجة؟ وأنهم كانوا على جزم صارم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو حجبها فهي أمارة على أنه أعتقها وتزوجها، ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم كانوا يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر، وأنه أكبر ميزة، وأعظم فارق في معرفة الحرة من المملوكة، فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة، والحرة لا تصلح أن تكون سُرِّيَّة، فهي إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين. _________ (1) الطبقات الكبرى لابن سعد، 8/ 121، وبنحوه: مسند أحمد، 19/ 268، برقم 12239، وأبو عوانة، 3/ 203، وقال محققو المسند، 19/ 268: «إسناده صحيح على شرط مسلم». (2) نظرات في حجاب المرأة المسلمة، ص 97.
(1/182)
فالصحابة - رضي الله عنهم - إنما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزويج؛ لأن صفية كانت سبيًا مملوكة، نعم لو كانت من الحرائر المؤمنات من قبل، ثم جعلوا الحجاب أمارة على كونها من أمهات المؤمنين لكان في ذلك دليل على اختصاص الحجاب بهن، وأما إذ ليس فليس، ثم ليعلم أن التزوج والعتق ليسا من خصائصهن، فالحجاب الذي جعلوه أمارة على العتق والتزوج كيف يكون مختصا بهن؟ ثم إن القصة لا تدل على أكثر من أن أمهات المؤمنين كن محتجبات، ولا يلزم من كونهن محتجبات اختصاصهن بالحجاب» (1). الدليل السابع عشر: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» (2). وفي لفظ مسلم: عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» (3). قال الشيخ حمود التويجري- رحمه الله -: «وفي نهيه - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، وأنه لم يبق للرجال سبيل إلى معرفة _________ (1) مجلة الجامعة السلفية، قاله أبو هشام الأنصاري. (2) البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، برقم 524. . (3) مسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، برقم 338.
(1/183)
الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال، ونحوِ ذلك؛ ولهذا قال: «كأنه ينظُرُ إليها»، فدلَّ على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات ممتنع في الغالب من أجل احتجابهن عنهم، ولو كان السفور جائزًا لما كان الرجال يحتاجون أن تُنْعَتَ لهم الأجنبيات من النساء، بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن، كما هو معروف في البلدان التي قد فشا فيها التبرج والسفور» (1). قال الإمام النووي- رحمه الله -: «باب تحريم النظر إلى العورات»، ثم ساق الحديث، ثم قال: «وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة وهذا ... حرام بالإجماع، ونبّه - صلى الله عليه وسلم - بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها ... إلى أن قال: «وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه؛ سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها، وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء» (2). وقال القسطلاني - رحمه الله -: «في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تباشر المرأة المرأة _________ (1) الصارم المشهور، ص 203، وطبعة أخرى، ص 95. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 30.
(1/184)
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» قال الطيبي - رحمه الله -: المعنى به في الحديث النظر مع المس، فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين، وتجس باطنها باللمس» (1). الدليل الثامن عشر: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» (2). قال العلامة التويجري - رحمه الله -: «ويستفاد من هذا الحديث أن نساء المؤمنين في زمن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كن يستترن عن الرجال الأجانب، ويغطين وجوههن عنهم، وإنما كان يقع النظر عليهن فجأة في بعض الأحيان، وأيضَاً لو كُنَّ يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب لكان في صرف البصر عنهن مشقة عظيمة، ولاسيما إذا كثرت النساءُ حول الرجل؛ لأنه إذا صرف بصره عن واحدة فلا بد أن ينظر إلى أخرى أو أكثر، وأمَّا إذا كن يغطين وجوههن كما يفيده ظاهر الحديث؛ فإنه لا يبقى على الناظر مشقة في صرف النظر؛ لأن ذلك إنما يكون بغتة في بعض الأحيان، واللَّه أعلم» (3). وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري في معرض الرد على من استدل بهذا الحديث على إباحة السفور: «هذا لا يتمّ به الاستدلال؛ فإن غاية ما فيه إمكان وقوع النظر على الأجنبيات، وهذا لا يستلزم جواز كشف _________ (1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 9/ 237. (2) مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة، برقم 2159؟ (3) الصارم المشهور، ص 92.
(1/185)
الوجوه والأيدي أمام الأجانب، وإيضاح ذلك أن المرأة كثيرَاً ما تكشف وجهها وكفيها ظنًّا منها أنها بمأمن من نظر الأجنبي، بينما تكون هي بمرأى منه، مثلاً تمر في طريق خالية من الرجال، فتكشف وجهها، ويكون رجل عند باب غرفته أو شباكها أو في شرفة أو على سقف أو في ناحية أخرى يراها، وهي لا تشعر به، كذلك ربما تضطر المرأة إلى كشف بعض جسدها لأمر ما، كما أنها ربما ينكشف بعض أعضائها من غير خيار منها، أو من غير أن تشعر بانكشافه - وقد أسلفنا بعض هذا - وربما تكون المرأة غير مسلمة أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر اللَّه، وكشفت بعض أعضائها تعمدَاً - وقد عمت به البلوى في هذا الزمان - فالسبيل في هذه الصور وأمثالها أن يؤمر الرجل بغض البصر، وليس من مقتضيات هذا أن يجوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة» (1). الدليل التاسع عشر: حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها -:أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ»، وفي رواية أخرى: ثلاث تطليقات»، وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي (2)، اعْتَدِّي عِنْدَ _________ (1) مجلة الجامعة السلفية، عدد نوفمبر وديسمبر، 1978م. (2) قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي - رحمه الله - في "عارضة الأحوذي: «(قوله لها: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» قيل في ذلك وجهان: أحدهما: أن ذلك قبل نزول الحجاب، وهو ضعيف؛ لأن مغيب عليّ إلى اليمن حين سافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب بمدة. الثاني: وهو الصحيح: أن أم شريك كانت مبجلة رجلة، فكان المهاجرون والأنصار يداخلونها بجلالتها ورجولتها، فلم يكن ذلك موضع تحصين لكثرة الداخل فيه والخارج، وعسر التحفظ فيه، فنقلها منه إلى دار امرأةٍ لها زوج أعمى، فتكون في حصانة من الرجال، وفي ستر من ضراوة الرجل المختص بذلك المنزل». [5/ 146].
(1/186)
ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عنده»، وفي رواية: «انتَقِلي إلى أم شريكٍ، وأم شريك امرأة غنية من الأنصارِ، عظيمةُ النفقَةِ في سبيلِ اللَّهِ، ينزلُ عليها الضيفَانِ، فإني أكره أن يَسقُطَ خمارُك، أو ينكشفَ الثوبُ عن سَاقَيكِ، فيرى القومُ منك بعضَ ما تكرهين، ولكن انتقِلي إلى ابنِ عمك عبدِ اللَّه ابن أم مكتومِ الأعمى - وهو من البطن التي هي منه - فإنك إذا وَضَعتِ خمارَك لم يَرَك»، فانتقلتُ إليه، فلما انقضت عدتي سمعتُ نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال: «إنّي واللَّه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميمَاً الداري كان رجلاً نصرانيّاً، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. . .» الحديث (1). وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك»، وفي رواية: _________ (1) مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم 1480، واللفظ له، وأحمد، 45/ 309، برقم 27327، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، برقم 2284، والنسائي، كتاب النكاح، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، برقم 3245، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 3/ 65، والبيهقي في الكبرى، 7/ 135. وانظر: العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاني، 4/ 240 - 241.
(1/187)
«فإني أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلاً عن غيره - عند البصير من الرجال الأجانب؛ وذلك لأن الخمار عام لمسمَّى الرأس والوجه لغة وشرعَاً (1)، ويشهد لهذا ما تقدم من قول الحافظ ابن حجر في تعريف الخَمْر: «ومنه الخِمار؛ لأنه يغطي وجه المرأة». وقول القاضي أبي علي التنوخي فيما ينسب إليه: قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقى المذهب نور الخمار، ونور خدك تحته ... عجبا لوجهك كيف لم يتلهب وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عَورَةُ». وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن، فبعيد أن تأتي الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس، وإباحة كشف الوجوه، وقوله: «لم يرك» ظاهر في إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة، وليس في الحديث ما يدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه (2). الدليل العشرون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً، فَلَمَّا رَجَعْنَا، وَحَاذَيْنَا بَابَهُ إِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ _________ (1) انظر: نظرات في حجاب المرأة المسلمة، ص 72 - 73، والصارم المشهور، ص 77 - 78. (2) انظر: عودة الحجاب، للمقدم، 3/ 328.
(1/188)
مُقْبِلَةٍ لاَ نَظُنُّهُ عَرَفَهَا، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟». قَالَتْ: جِئْتُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، رَحِمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ، وَعَزَّيْتُهُمْ» (1). فقد ظن الصحابة - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده، لأنها كانت مستترة، ولكنه عرفها، وقال لها: «يا فاطمة» (2). الدليل الحادي والعشرون: حديث جَابِرٍ بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا» (3). وقد بيّن العلامة صفي الرحمن المباركفوري - رحمه الله -: أن هذا الحديث يدل على تحريم السفور، وعلى فرضية احتجاب النساء _________ (1) أحمد، 11/ 137، برقم 6745، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في التعزية، برقم 3125، والبيهقي في السنن الكبرى، 4/ 60، وفي دلائل النبوة له، 1/ 192، والحاكم، 1/ 373، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. (2) انظر: عودة الحجاب للمقدم، 3/ 329. (3) أخرجه الإمام أحمد، 22/ 440، برقم 14586، وأبو داود، كتاب النكاح، باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا، برقم (2082) في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة، وهو يريد تزويجها، والحاكم، 2/ 165، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، والبيهقي، 7/ 87، وقال الحافظ في بلوغ المرام: «رجاله ثقات»، وقال في الفتح: «وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة». فتح الباري، 9/ 87، وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 6/ 201: «فالسند حسن، وقد حسنه الحافظ». وانظر تمام تخريجه في: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص 107.
(1/189)
عن الرجال الأجانب من وجوه: «الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا جناح أن يغترها، فينظر إليها»، فهو يفيد أن النظر إلى المرأة لم يمكن وهي منتبهة بوجود الرجل، وأن النظر إليها مع غرتها لا يجوز، بل فيه جناح إلا إذا كان لمثل هذه الأغراض المشروعة. الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن استطاع أن ينظر» أو «فقدر أن يرى» إلخ يدل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهلاً في ذلك الزمان، بل كان يحتاج إلى حيل وتصرفات، ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه لم يكن لاشتراط الاستطاعة والقدرة معنى. الثالث: ما فعله جابر من الاختباء تحت أصول النخل دليل على أن النساء لم يَكُنَّ يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في مأمن من نظر الرجال» (1). الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ - عز وجل - فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا» (2). _________ (1) إبراز الحق، ص 51. (2) رواه الإمام أحمد، 29/ 492، برقم 17976، وسعيد بن منصور في سننه، 1/ 146، برقم 519، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، برقم 1886، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 3/ 13، والبيهقي 7/ 85، والطيالسي، 2/ 507، برقم 1282، والحاكم، 4/ 492، وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب، وقال الذهبي في "التخليص": ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ، والطبراني في المعجم الكبير، 19/ 224، برقم 500، وابن حبان، 9/ 349، برقم 4042، وعبد الرزاق، 6/ 156، برقم 10335، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 98، وانظر تخريجه مطولاً في: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، للشيخ فريح بن صالح البهلال، ص 103 - 107.
(1/190)
الدليل الثالث والعشرون: حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا عْظَّمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا» (1). قال العلامة التويجري - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب النساء من الرجال الأجانب؛ ولهذا أنكروا _________ (1) رواه الإمام أحمد، 30/ 66، برقم 18137، وسعيد بن منصور في سننه، 1/ 145، برقم 514، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، برقم 1087،)، وحسَّنه، والنسائي، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، برقم 3253، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر والولود، برقم 1865، والدارمي 1/ 155، والطحاوي 3/ 14، وابن الجارود في المنتقى، ص 170، والمقدسي في المختار، 2/ 333، وصحح إسناده، 96. وقال البوصيري في الزوائد، 1/ 118: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات»، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 96.
(1/191)
على محمد بن مسلمة لما أخبرهم أنه تخبأ لمخطوبته حتى نظر إليها وهي لا تشعر، فأخبرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رخَّص في ذلك للخاطب. وكذلك المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - لما طلب النظر إلى المخطوبة كَرِه ذلك والداها، وأعظمت ذلك المرأةُ، وشددت على المغيرة، ثم مكنته من النظر إليها طاعة لأمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -. وفي هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه نساء الصحابة - رضي الله عنهم - من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب؛ ولهذا لم يتمكن جابر ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما - من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق الاختباء والاغتفال، وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها له في النظر إليها» (1). وكذلك يشهد لهذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر - رضي الله عنه - المتقدم: «فإن استطَاعَ أن يَنظرَ إلى ما يَدعُوه إلى نِكَاحِهَا فَليَفعَل». وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري معلقاً على حديث المغيرة - رضي الله عنه -: «وهذا الحادث يدل أيضَاً على أن النساء كن قائمات بالتستر بحيث لم يكن الرجل يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفات، أو إلا أن يسمحن له بالرؤية، ولو كن يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الخدين، مكتحلات العينين، مخضوبات الكفين لم يكن الرجال يحتاجون إلى تجشم هذه المشقات في رؤيتهن». _________ (1) الصارم المشهور، ص 94 - 95.
(1/192)
وقال معلقًا على قول جابر - رضي الله عنه - في آخر حديثه: «فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إِليها» (1). وفي هذا الحديث دليل من وجهين: الأول: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن استطاع أن ينظر. . . إلخ» يدل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهلَا، بل كان لابد لها من حيل وتصرفات، ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه في ذلك الزمان لم يكن لاشتراط الاستطاعة في النظر إليهن معنى. والثاني: ما فعله جابر من الاختباء تحت الكرب دليل على أن النساء لم يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في أمن من نظر الرجال. «وقال في حديث محمد بن مسلمة - رضي الله عنه -: «وهذا الحديث مثل حديث جابر في الدلالة على المطلوب، مع مزيد الدلالة على أن النظر إلى المرأة الأجنبية كان من أسباب التعجب والنكران عند أوائل هذه الأمة» (2). الدليل الرابع والعشرون: حديث أَبِي حُمَيْدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ _________ (1) المحلى لابن حزم، 11/ 220. (2) مجلة الجامعة السلفية، عدد نوفمبر وديسمبر، 1978م، وإبراز الحق، ص 52.
(1/193)
إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» (1). قال الشيخ أبو هشام الأنصاري - رحمه الله -: «إن رفع الجناح عن إظهار التزين في هذه الحالة المخصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة دليل على أن في إظهار التزين في عامة الأحوال جناحًا وإثماً. والدليل على تغاير حكم الخطبة عن حكم عامة الأحوال أن الخاطب أبيح له النظر إلى المخطوبة، بل هو مأمور بذلك أمر حض وإرشاد، أو أمر استحباب وندب، بينما هو مأمور بغض البصر عن الأجنبيات، وحرم عليه النظر إليهن إلا النظرة الأولى، أو نظرة الفجأة التي تصدر منه من غير عمد وقصد، والذين لهم إلمام بقواعد الشريعة يعرفون جيدًا أن تقييد إِباحة الشيء أو جوازه أو رخصته بحالة خاصة دليل على تحريمه في الأصل، كما أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة (2)، فجواز أو إباحة إظهار التزين - الذي يعده البعض كشف الوجه - للمخطوبة دليل على تحريم إظهار تلك الزينة في عامة الأحوال. وصنيع الفقهاء والمحدثين يرشد إلى ما قلنا؛ فإن عامتهم بوبوا _________ (1) أخرجه الإمام أحمد 39/ 15، برقم 23602، والطحاوي، 3/ 14، والطبراني في الأوسط، 6/ 99، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «ورجال أحمد رجال الصحيح»، وسكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير، 3/ 147، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 97، وصححه محققو المسند، 39/ 15،. (2) انظر: زاد المعاد، 2/ 213.
(1/194)
على أحاديث الخطبة بباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله، فتقييدهم النظر إلى المخطوبة بالجواز يشعر بأن النظر إلى غير المخطوبة غير جائز عندهم» (1). وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ... ، ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالنظر وأطلق ... ولا يجوز له الخلوة بها؛ لأنها محرمة، ولم يَرد الشرعُ بغير النظر، فبقيت الخلوة على التحريم؛ ولأنه لا يُؤمَن مع الخلوة مواقعة المحظور ... ، ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة، ولا لريبة، قال أحمد في رواية صالح: ينظر إلى الوجه، ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها، ويتأمل محاسنها؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك» (2). وقيَّد الحجاوي والفُتُوحي وغيرهما جواز النظر بما إذا غلب على ظنه إجابته، قال الجراعيُّ: «متى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجز، كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك». وكما أن الأحاديث التي ذُكرت آنفًا قد دلت بمنطوقها على جواز _________ (1) مجلة الجامعة السلفية، نوفمبر، ديسمبر، 1978م. (2) المغني، 6/ 552 - 553 مختصراً، وفي المسألة تفصيل يراجع في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم 95 - 99.
(1/195)
نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، فكذلك هي دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظرُ إلى غيرها من سائر الأجنبيات ويوضح ذلك قوله في حديث أبي حُميد - رضي الله عنه -: «إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة»، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير خاطب. وأيضاً فوضع البأس والجُناح على الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه لا يجوز النظر لغير خاطب، وأن عليه في نظره إلى الأجنبية بأساً وجناحَاً، واللَّه أعلم (1). وقد أخرج البخاري - رحمه الله - في الجامع نحو حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - فقد عقد بابًا إذ قال: «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»، وقال الحافظ في الفتح: «قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها» (2). وقال السندي: «وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث؛ فإنه لا يجوز لغير الخاطب أن ينظر إليها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة، وأما في حالة كشف الوجه والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهوم، فهذا أيضَاً دليل على عدم جواز كشف الوجه والكفين» (3). وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ألقَى اللَّه - عز وجل - _________ (1) انظر: عودة الحجاب، 3/ 324. (2) راجع الخلاف في هذا في فتح الباري، لابن حجر، 9/ 182. (3) رسالة الحجاب، ص 42 - 43.
(1/196)
في قلب امرئ خِطبَةَ امرأة فلا بأس أن ينظُرَ إليها»؛ فهذا الإذن بهذا السياق يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب (1). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبةوإن كانت لا تعلم»: وجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الجناح، وهو الإثم، عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة، مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك؛ فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر، فالجواب: إن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه، وما سواه تبع لا يقصد غالباً، فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه؛ لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب ... » (2). الدليل الخامس والعشرون: حديث أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا» (3). _________ (1) انظر: عودة الحجاب، 3/ 325. (2) رسالة الحجاب، ص 14. (3) أخرجه أحمد، 13/ 235، برقم 7841، والحميدي، 1172، وسعيد بن منصور، برقم 523، والنسائي في كتاب النكاح، إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم، برقم 32246، وفي الكبرى له أيضاً: كتاب النكاح، إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم، برقم 5330، وابن حبان 9/ 349، برقم 4041، و4044، وبنحوه: مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم 1424، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 3/ 14، والبيهقي، 7/ 84، وقال محققو المسند 13/ 235: «إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجالِ مسلم»، وصححه الألباني في التعليقات الحسان، برقم 4030.
(1/197)
وقال العلامة حمود التويجري - رحمه الله -: «في هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه نساء الصحابة - رضي الله عنهم - من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب؛ ولهذا لم يتمكن جابر، ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما - من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق الاختباء والاغتفال، وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها له في النظر إليها» (1). فليتأمل ذلك المفتون بسفور النساء، وتكشفهن بين الرجال الأجانب، وليتقوا اللَّه في أمورهم عامة، وفي نسائهم خاصة، وليعلموا أنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، وليحذروا أن يكونوا ممن قال اللَّه تعالى فيهم: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (2). الدليل السادس والعشرون: حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ» (3). _________ (1) الصارم المشهور، ص 202. (2) سورة النساء، الآية: 115. (3) البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، برقم 867، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها، برقم 645.
(1/198)
وحديث عَائِشَةَ - رحمه الله - قَالَتْ: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ» (1). قال العلامة محمد بن العثيمين - رحمه الله -: «والدلالة في هذا الحديث من وجهين: أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على اللَّه - عز وجل -، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين - رضي الله عنهم -، وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّبِقُونَ الاْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (2)، فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة، فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال اللَّه تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً} (3). الثاني: أن عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -، _________ (1) البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، برقم 869، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً، برقم 445. (2) سورة التوبة، الآية: 100. (3) سورة النساء، الآية: 115.
(1/199)
وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين اللَّه، ونصحاً لعباد اللَّه أخبرا بأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد، فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً، وقد اتسع الأمر، وقل الحياء، وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟! وعائشة وابن مسعود - رضي الله عنهما - فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور (1). ثالثاً: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب: نقل الإجماع العملي المستمر على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب جمع من أهل العلم، منهم من يأتي: 1 - قالَ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُنذِر النيسابوري المتوفى سنة 318هـ: «وأَجمَعُوا عَلَى أَنَّ المَرأَة تَلبَس المَخِيط كُلّه والخِفاف، وأَنَّ لَها أَن تُغَطِّيَ رَأسَها، وتَستُرَ شَعرَها إِلاَّ وجهَها، فَتَسدُل عَلَيهِ الثَّوب سَدلاً خَفِيفًا، تُستَر بِهِ عَن نَظَرِ الرِّجال، ولا تُخَمِّرهُ إِلاَّ ما رُوِيَ عَن فاطِمَة بِنت المُنذِر، قالَت: كُنّا نُخَمِّر وُجُوهنا ونَحنُ مُحرِمات مَعَ أَسماء بِنت أَبِي بَكر؛ تَعنِي جَدَّتها» (2). _________ (1) رسالة الحجاب، ص 17. (2) عزاه إليه الحافظ في الفتح، 3/ 406، وهو في بداية المجتهد، ص 272.
(1/200)
2 - وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 463هـ: «وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً، تستتر به عن نظر الرجال إليها» (1)، وقال في موضع آخر: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا، وَتَسْتُرَ شَعْرَهَا وهي محرمة، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا سَدْلًا خَفِيفًا، تَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلَيْهَا» (2). 3 - وقال الإمام ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595 هـ: «وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً، تستر به من نظر الرجال إليها، كَنَحْوِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رحمه الله - أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا رَكِبٌ سَدَلْنَا عَلَى وُجُوهِنَا الثَّوْبَ مِنْ قِبَلِ رُؤوسِنَا، وَإِذَا جَاوَزَ الرَّكْبُ رَفَعْنَاهُ، وَلَمْ يَأْتِ تَغْطِيَةُ وُجُوهِهِنَّ إِلَّا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ» (3). _________ (1) التمهيد لابن عبد البر، 15/ 108. (2) الاستذكار لابن عبد البر، 11/ 28، برقم 15257. (3) بداية المجتهد، 1/ 336، وتقدم تخريجه.
(1/201)
4 - وقال شيخ الحنابلة الموفق ابن قدامة المتوفى سنة 620هـ في قول الخرقي: «الْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَإِنْ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا»، قال: فَأَمَّا إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا; وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رحمه الله - قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا حَاذَوْنَا، سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ؛ وَلِأَنَّ بِالْمَرْأَةِ حَاجَةً إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا سَتْرُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، كَالْعَوْرَةِ» (1). 5 - وقال أبو الحسن بن القطان المتوفى سنة 628هـ: «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً، تستتر به عن نظر الرجال إليها» (2). 6 - وَقال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ: «أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ، فَلِذَلِكَ جَازَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ الَّتِي تَسْتَتِرُ بِهَا، وَتَسْتَظِلُّ بِالْمَحْمَلِ، لَكِنْ نَهَاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَقِبَ أَوْ تَلْبَسَ _________ (1) المغني لابن قدامة، 5/ 154. (2) الإقناع، 1/ 262، برقم 1458.
(1/202)
الْقُفَّازَيْنِ، وَالْقُفَّازَانِ: غِلَافٌ يُصْنَعُ لِلْيَدِ، كَمَا يَفْعَلُهُ حَمَلَةُ الْبُزَاةِ، وَلَوْ غَطَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا بِشَيْءِ لَا يَمَسُّ الْوَجْهَ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ يَمَسُّهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا، وَلَا تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجَافِيَ سُتْرَتَهَا عَنْ الْوَجْهِ لَا بِعُودِ، وَلَا بِيَدِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ» (1). 7 - وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 752هـ: «قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء، وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يزاد على موجب النص، ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؟ فأي نص اقتضى هذا؟! أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة، بل وجه المرأة كبدن الرجل، يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع، وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفازين، وأما سترها بالكم، وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب، فلم ينه عنه البتة» (2). 8 - وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن مفلح المتوفى سنة 763هـ: «وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا في وَجْهِهَا، فيحرم عليها تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أو نِقَابٍ أو غَيْرِهِ وفاقاً للثلاثة. قال ابن الْمُنْذِرِ: كَرَاهِيَةُ الْبُرْقُعِ ثَابِتَةٌ عن سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ _________ (1) مجموع الفتاوى، 26/ 112. (2) بدائع الفوائد، 3/ 141.
(1/203)
عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فيه ... إلى أن قال: «وَيَجُوزُ لها أَنْ تُسْدِلَ على الْوَجْهِ لِحَاجَةٍ؛ ولقول عَائِشَةَ: «كان الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ... الحديث، وعن فاطمة بنت المنذر، قالت: «كُنَّا نُخَمِّرُ وجوهَنا، ونحنُ محرمات ... الحديث، إلى أن قال: «وحُكْمُ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ في جَمِيعِ ما سَبَقَ إلَّا في لُبْسِ الْمَخِيطِ، وَتَظْلِيلِ الْمَحْمَلِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِمَا سَبَقَ من حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِحَاجَةِ السَّتْرِ» (1). وقال - رحمه الله - أيضاً: «وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ، وَمَنْ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ إجماعاً، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَنَصُّهُ: (وَخَوْفُهَا) وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا» (2). 9 - وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ: «اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق» (3). 10 - وقال العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله -: «واتفق المسلمون على عدم خروج نساء المؤمنين أمام الرجال إلا متحجبات، غير سافرات الوجه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة» (4). 11 - وحكى النووي: عن إمام الحرمين الجويني أبي المعالي أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه، وبأن _________ (1) كتاب الفروع، لابن مفلح، 3/ 450 بتصرف. (2) كتاب الفروع، 5/ 155. (3) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار، 6/ 130. (4) حراسة الفضيلة، ص 37.
(1/204)
النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» (1). 12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله -: «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم» (2). 13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله -: «وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء» (3). 14 - ونقل الإمام النووي - رحمه الله - أن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها» (4). 15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن حبيب العامري - رحمه الله -: «إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ... وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض ... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة _________ (1) روضة الطالبين، للإمام النووي، 7/ 21. (2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 5/ 231. (3) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، 1/ 202. (4) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 30.
(1/205)
المسلمين، لا يباح بدعوى زهد وصلاح ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة ... فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها» (1). وقال - رحمه الله -: «ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفَعَلَهُ، وأقر عليه ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة، فضلاً عن أن تظن به زهادة أو عبادة، بل يرتكب محظوراً محرماً، فاسق به مجرم بارتكابه معاصي لا تحصى» (2). 16 - ذكر الإمام الصنعاني - رحمه الله - إجماع المسلمين على تحريم التبرج» (3). رابعاً: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب: قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به الشريعة الكاملة. وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. _________ (1) أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات، والرد على من استباح ذلك وادعى العصمة من الفتن، ص 260. (2) المرجع السابق، ص 287. (3) منحة الغفار على ضوء النهار، 4/ 2011، 2012.
(1/206)
وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحته فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة، وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. مفاسد السفور وكشف المرأة وجهها كثيرة، منها: 1 - الفتنة؛ فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يُجَمِّل وجهها، ويبهيه، ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 2 - زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان، ومن مقتضيات فطرتها، فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها. 3 - افتتان الرجال بها لا سيما إذا كانت جميلة، وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات، وقد قيل: «نظرة، فسلام، فموعد، فلقاء». والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل، فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل اللَّه السلامة. 4 - اختلاط الرجال بالنساء، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه، والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا
(1/207)
خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة وفساد عريض، وقد «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم من المسجد، وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «استأخرن؛ فإنه ليس لكنَّ أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها» (1)، ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}» (2). وقد جاء في فتنة النساء أحاديث كثيرة، منها: 1 - حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (3). 2 - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (4). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي الحديث: أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد لهذا قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ _________ (1) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، برقم 5272، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 856. (2) رسالة الحجاب، ص 20 - 22. (3) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (4) مسلم، كتاب العلم، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، برقم 2742.
(1/208)
الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ} فجعلهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ... وقد قال بعض الحكماء: «النساء شر كلهن، وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن، ومع أنهن ناقصات عقل ودين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين» (1). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «ففتنة النظر أصل كل فتنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (2). وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء» (3). وفي مسند محمد بن إسحاق السرّاج من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر» (4). وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لم يكفر ممن كفر ممن مضى إلا من قبل النساء، وكفر من بقي من قبل النساء» (5) ... _________ (1) فتح الباري، لابن حجر، 9/ 138. (2) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (3) مسلم، برقم 2742، وتقدم تخريجه. (4) علل الحديث لابن أبي حاتم، برقم 1311، ومسند السراج، ص 26، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم 6052. (5) مصنف ابن أبي شيبة، 3/ 46، برقم 17643، وقال الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة، 1/ 338: «إسناده حسن».
(1/209)
إلى أن قال: «والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل: كل الحوادث مبدؤها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ... فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها ... في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته ... لا مرحباً بسرور عاد بالضرر» (1) _________ (1) روضة المحبين، ص 113.
(1/210)
المطلب السادس: الحكمة من مشروعية الحجاب
من أبرز حِكَم مشروعية الحجاب الحِكم الآتية: أولاً: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية، والهواجس النفسانية؛ لأن قلوب البشر مهما تطهرت بالتقوى، ونفوسهم مهما تزكَّت بالمجاهدة، فلن تصل بأصحابها إلى العصمة من الخواطر، أو الوقوع في المآثم عند وجود أسبابها، إلّا أن يتولى اللَّه تعالى الصالح من عباده بعنايته، فيحفظه من هذه المعاصي. إن شيوع السفور، وانتشار التبرج، وإظهار المحاسن، وإبراز المفاتن، يُلهب العواطف، ويثير الغرائز، وقد يبعث أوهامًا هابطة، وظنونًا ساقطة، تكون سببًا في إرجاف المرجفين، وتَقَوُّلِ الخراصين؛ لهذا أراد الشارع الحكيم أن يطهر تلك القلوب بقطع أسباب هذه الخواطر والهواجس، فشرع الحجاب، طهارة لتلك القلوب من إلقاء الشيطان .. إن المرأة التي تخطِرُ في مِشْيتها، وتبدي أمام الرجال الأجانب زينتها، تكون عرضة لعبث أصحاب الأهواء، خاصة إذا رأت نظرات المستحسنين، واستروحت لعبارات المعجبين؛ فترق الحواجز بين الفريقين، ويقع ما لا يُحمد عقباه من الجانبين. فكم من نظرة تمكنت بسببها خطرة، وكم من خطرة استدعت
(1/211)
عبرة، ثم أورثت حسرة، وكم من متضمخة بالأفعاء (1) ساقت مرضى النفوس إلى لقاء، وكم من لقاء أدَّى إلى إفضاء، وللَّه در القائل: نظرة فابتسامةٌ فسلامٌ ... فكلامٌ فموعدٌ فلقاءٌ (2) قال ابن القيم - رحمه الله -: «دافِع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلًا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها» (3). لهذا كانت طهارة قلوب الفريقين حكمة من حكم الشارع العظيمة التي أشار إليها في قوله الكريم: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (4). ومن عرف أن هذه الآية نزلت في أمهات المؤمنين اللاتي حفظهن اللَّه تعالى، أدرك أن حُكمها يعم كافة النساء؛ لأنهن أحوج إلى طهارة القلوب من نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - اللاتي طهَّرهن اللَّه، وجعل لهن أمومة شرعيةً تنأى بالمؤمنين عن تصورهن بغير هذا المعنى الكريم. وقلوب رجال المؤمنين بحاجة أيضًا إلى هذه الطهارة التي _________ (1) الأفعاء: الروائح الطيبة، كما في القاموس المحيط. (2) القائل هو الشاعر أحمد شوقي، انظر: الشوقيات، 2/ 112. (3) الفوائد، ص 31. (4) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/212)
تسمو بأصحابها في درجات التقوى والكمال؛ لذا كانت علة سؤالهن من وراء حجاب مُفْصِحَةً عن حقيقة هذه الحكمة التي يُراد منها الطهارةُ والعفافُ ونَقَاءُ السريرة. وقد بيَّنَ القرآن الكريم وسائل إذهابِ الرجس، ووسائلَ التطهير، فوجَّه الخطاب إلى نسوة من أطهر نساء الأرض، وأرفعهن شأنًا، اللاتي عِشْنَ في بيت النبوة، ونَهَلْنَ من آدابه الرفيعة؛ لتكون تلك الأوامر أوقعَ أثرًا في قلوب سواهن، فقال لهن: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (1). تلك هي وسائل التطهير التي يُذهب اللَّه تعالى بها الرجس عن عباده، والتي منها عدم التبرج. ثانياً: الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين: وقد نص القرآن الكريم على ذلك، فقال اللَّه - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} (2). _________ (1) سورة الأحزاب، الآيتان: 32 - 33. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/213)
ويحكي المفسرون عند هذه الآية أن ناسًا من فساق أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيتعرضون للنساء. فإن رأَوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة فكُفُّوا عنها، وإلاَّ تعرضوا لها .. ومن هنا ندرك هيبة الحجاب الذي يصدُّ الفاسقين عن المتحجبات، والوقار الذي يخلعه ذلك الشعار الإسلامي على المؤمنات، فيحفظهنَّ من الأذى، ويقيهن من عوادي السوء، ويصونهن من كيد الأشرار، والمتدبر للآية الكريمة السابقة وما جاء بعدها يدرك أن أولئك الماجنين دخلوا في عموم قول اللَّه تعالى الوارد بعد آية إدناء الجلابيب: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} (1). لقد قرنَ اللَّه تعالى هؤلاء بأولئك، لأن الفاسقين الذين يعيثون في الأرض فسادًا يحطمون أخلاق الأمة، والمنافقين والمرجفين يدمرون نظامها، ويَفُلُّون قوتها. لهذا حسم الإسلام مادة الشر، ففرض على النساء الحجاب، _________ (1) سورة الأحزاب، الآيتان: 60 - 61.
(1/214)
وحرَّم عليهن السفور والاختلاط، وحافظ على كرامتهن بما شرعه من زواجر تردع الماجنين، وتكفّ الفاسقين، وتجعلهم تحت مظلة الأدب والوقار والطهر أجمعين. ثالثاً: الحجاب إصلاح الظاهر بما يتناسب وما قصد إليه الشارع من صلاح الباطن، ليتم الانسجام التام بين حشمة المظهر وعفة المخبر .. ذلك أن المرأة المتبرجة التي تبرز محاسنها، وتبدي مفاتنها، امرأة متمردة على ما فطرها اللَّه عليه من الحشمة والوقار المركوزين في النفس بمقتضى الإيمان الذي فطر اللَّه تعالى المخلوقات عليه، والذي يدعو إلى التمسك بالفضائل، ونبذ جميع الرذائل. وهي مع ذلك تعطي إيماءة واضحة على فساد باطنها، إذ ماذا يمكنك أن تتصور تلك النفس التي تستمرئ إظهار مفاتن الجسد، وتستروح غشيان الشواطئ بعريٍ فاضح؟!! إِنَّ ذلك يومئ إلى حيوانية في التصور، ويكشف عن هبوط في السلوك، يغري أصحاب النفوس المريضة بهؤلاء الفاسقات، ويدفعهم إلى الجريِ وراء أولئك المتهتكات. وهي مع ذلك تشير بتبرجها إلى تبعيتها لبيوت الأزياء الغربية، وخضوعها لمؤثرات الاستعمار الفكري بحيث باتت واحدة من ضحاياه .. وما أشد إفلاس الأمة حين تصبح مربيات الأجيال، وصانعات
(1/215)
الرجال دُمًى تحركها العقلية الاستعمارية عن طريق بيوت الأزياء، وما يسمى «جمعيات تحرير المرأة» فَيتقمصْنَ شخصياتها، ويُقَلّدنها في أفعالها، وما أشد مُصَاب الأمة حين تُنكب بناشئة تربو على أيدي أمهات من ذلك القبيل، فينشؤون نشأة لا يعرفون قيمة لفضيلة، ولا يدركون مدى هبوط الرذيلة. عقلهم غربي، وسلوكهم أجنبي، ولسانهم عربي .. وصدق فيهم ما رواه أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ» (1)؟ رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب: فالمرأة التي تعلو وجهها حُمْرة الحياء حين يقع عليها نظر رجل، وتتحرج عندما تتكلم مع غير محارمها لحاجة أو ضرورة تدعوانها إلى ذلك، امرأةٌ نقية المعدن، طيبة القلب، نبيلة الشعور، وحجابها يزيد ضميرها حياةً، وعنصرها زكاةً، وباطنها نقاءً، فتمتنع عما لا يجوز، وتنأى بنفسها عما لا ينبغي، وتتأبَّى من غشيان مجالس السوء، ولا عجب أن يصونها الحجاب؛ لأنه يدعو إلى _________ (1) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، برقم 7320، واللفظ له، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، برقم 2669.
(1/216)
الحياء، ويبعدها عن مواطن الريبة، ويُقَرِّبُها من فِعَال الخير، وصدق رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول: «الحياء خير كله» (1). ولما كان الحياء خيرًا كله؛ فإن عاقبته إلى خير، حيث يحجز صاحبه عن الرذائل، ويسوقه إلى الفضائل، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» (2). إن المرأة التي يدفعها حياؤها إلى ستر مفاتنها، وعدم إبداء زينتها، والاعتزاز بحجابها، والبعد عما يسخط ربها، هي امرأة ربا الإيمان في قلبها، وعظم اليقين في نفسها، وتسربلت الخير في عملها، وحياء يدفع لهذا كله لا شك أنه من الإيمان المركوز في فطرة الإنسان، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ» (3)، وفي رواية أخرى: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ» (4). قال الحافظ ابن حجر: «فإن قيل: الحياء من الغرائز، فكيف جُعل شعبة من الإيمان؟ أُجِيب بأنه قد يكون غريزة، وقد يكون تخلقًا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم _________ (1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، برقم 37. (2) البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، برقم 6117، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، برقم 37. (3) البخاري، كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، برقم 24، ومسلم واللفظ له، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، برقم 36. (4) البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، برقم 9، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، برقم 35.
(1/217)
ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا على فعل الطاعة، وحاجزًا عن المعصية. فإن قيل: لِمَ أفرده - أي البخاري - بالذكر هنا، أي في باب أمور الإيمان؟ أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الَحِييُّ يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر وينزجر» (1). والمرأة التي لا تتورع عن الابتذال في ملبسها، ولا تترفع عن إظهار مفاتنها، ثم لا تستشعر تأنيب الضمير حين تفتن الرجال بنفسها، بل تزهو بسيئ العمل، ولا يصطبغ وجهها - من ذلك بحمرة الخجل، فهذه امرأة فقدت حياءها، ومن ثمَّ فقدت ثمرة إيمانها، وإن استحلت ذلك مع علمها بحرمته فقدت الإيمان نفسه - والعياذ باللَّه تعالى -، وصدق رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول: «الْحَيَاءُ وَالإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ» (2). إن الإنسان حين يفقد حياءه، لا يشعر بغضاضة من اقتراف المعصية، وإنِ اقترفها من غير رادع، أو ألمَّ بها من دون وازع، سَهُل _________ (1) فتح الباري، 1/ 52. (2) أخرجه الحاكم، 1/ 22، وقال: «صحيح على شرطهما»، والبخاري في الأدب المفرد، برقم 1313، وأبو نعيم في الحلية، 4/ 297، والبيهقي في شعب الإيمان، 6/ 140، وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة، 5/ 213، رقم 25350 موقوفًا على ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، 2/ 36، برقم 991.
(1/218)
عليه غيرها، بحيث ينتقل من معصية إلى أخرى، وينحدر من مأثم إلى آخر حتى تهوي به الموبقات في مكان سحيق. لقد عالج الإسلام مرضى النفوس، فطهرههم من دَنَسِ الرذيلة، ثم حفزهم إلى التحلي بكل فضيلة، كما حارب الفاحشة بالعفاف، والتبرجَ بالحجاب، وأقام من الإيمان والحياء حارسًا أمينًا على الإنسان حتى يقيَهُ مصارع السوء؛ فإذا فَقَدَ أحدهما فقد الآخر، وتمرَّغ في أوحال الرذيلة، ووقع في دَنَسِ الخطيئة. وما حجاب المرأة إلا درع يقيها من نظرات المتطفلين، ويصونها من عبث العابثين، ويرد عنها أذى المستهترين، وما هو إلا أثر من آثار الإيمان والحياء، فما أحوج المرأة المسلمة إليهما في هذا الزمان الذي ظهر فيه الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خامساً: الحجاب يتناسب مع طبيعة المرأة التي فطرها اللَّه تعالى على الإيمان والحياء؛ لأن حالها مبني على الستر، وطبيعة الحجاب تضمن لها ذلك لكونه من مقتضيات الخَفَر، فهو مادة من قانون حياتها الذي لا يجوز لها الخروج عليه، أو الانعتاق منه. وحين تعيش المرأة في نطاق هذا النظام، وتحيا ضمن تلك الطبيعة، تشعر براحة النفس، وهدوء البال، فلا نظرات تلاحقها، ولا متسكعًا يتبعها، ولا قلقًا يؤرقها، ولا فراغًا يضجرها؛ لأنها في كَنفِ القانون الإلهي الذي قَرنَ الحياء بالإيمان. فالإيمان زوَّدها بحصانة تحفظها، والحياء أسبغ عليها حجابًا
(1/219)
يسترها، ومنحها من الوقار والهيبة ما يصرف الفاسقين عنها .. إن خروجَ المرأة عن تلك الطبيعة يُعتبرُ عدوانًا صارخًا على الفطرة، وتمردَها على الشرع ضربٌ من العبث بسنن اللَّه التي بثها في الكون، ولهذه الحكمة حرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة، كما حرم على المرأة أن تتشبه بالرجل؛ لما في ذلك من الخروج عن الفطرة، والعبث بسنن اللَّه في الكون فللرجل لباسه، وللمرأة لباسها .. تلك هي سنة اللَّه تعالى في خلقه، وتلك هي القِسمة العادلة التي تناسب طبيعة كلٍّ منهما. والإسلام يحرص على بقاء الرجل ضمن معاني الرجولة، ليؤدي دوره المطلوب منه في الحياة؛ كما يحرص على بقاء المرأة في إطار الأنوثة، ليتم التكامل، وتطَّرد سنة اللَّه الكونية في خلق النوع الإنساني الذي أخبرنا عنه بقوله الكريم: {وَمِن كُلِّ شَيء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (1). وخروج الرجل أو المرأة عن إطارهما يعني التحلل من المواصفات الخاصة بكل منهما، وبالتالي التحلل من أساسيات الفطرة، وأصول النوع، وذلك ضرب من خُواء النفس، وفقر الروح، وخلل التفكير. لقد جاء الإسلام ليعيد التوازن إلى ذلك الإنسان الشارد، ويرده _________ (1) سورة الذاريات، الآية: 49.
(1/220)
إلى جادة الهدى بإعادته إلى فطرته، وتذكيره بمهمته في هذه الحياة، كما حرص على النهوض به من إسفاف التفكير إلى سلامة التدبير، ومن ضعف المعالجة إلى نضج التحليل، ومن سطحية النظرة إلى أعماق الفكرة، فإذا استجاب لهذا النداء فَقَمِنٌ به أن يثري المجتمع بفكره، ويشد أزره بصالح عمله. إن فرضَ الحجاب على المرأة تكريم لها، لإبقائها على أنوثتها، ومنعَها من التبرج صيانة لها من الخروج عن طبيعتها، وحين تتحلل هذه الطبيعة، وتختل تلك الفطرة - نظرًا لتشبه كل فريق بالآخر - تضطرب القيم، وتختل الموازين، وتفسد المفاهيم. لهذا قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (1). لقد أوصد الإسلام كل باب يعتبر ذريعة لتحلل المرأة، واختلال فطرتها وحظر كل ما يؤدي إلى فسادها وإغراء الرجال بها، ففرض عليها من الأحكام ما يدفع عنها غوائل السوء، وكان من جملة تلك الأحكام الإلهية إلزامها بالحجاب {ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} (2). تلك هي بعض الحِكَم من شرعية الحجاب، أردنا أن نوضحها، _________ (1) البخاري، كتاب اللباس، باب: المتشبهين بالنساء، والمتشبهات بالرجال، برقم 5885. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/221)
لندلل على عمق نظرة التشريع الإسلامي، وسموّ مقاصده، ونبل أهدافه؛ ولنؤكد أن الحجاب ما هو إلا فضيلة تهدف إلى وقاية المرأة، والمحافظة على المجتمع، والحرص على أخلاق الأمة، لئلا تذوب في غيرها من الأمم، أو تصبح تبعًا لها في ملبسها، وأسلوبِ حياتها، فتفقد خصائصها الإسلامية، وتغدو أمة على هامش الأحداث، لا تحظى باحترام، ولا تُقابَل بتقدير» (1). _________ (1) حجاب المسلمة، للدكتور محمد فؤاد البرازي، ص 121 - 134 بتصرف.
(1/222)
المطلب السابع: شروط الحجاب الإسلامي
أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً: 1 - الشرط لغة: العلامة. 2 - الشرط اصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (1). ثانياً: شروط الحجاب الشرعي إجمالاً: الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساترًا لجميع بدنها كاملاً. الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة. الشرط الثالث: أن يكون ثخينًا لا يشف عما تحته. الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا واسعاً غير ضيق. الشرط الخامس: أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب. الشرط السادس: أن لا يُشبه لباس الرجال. الشرط السابع: أن لا يُشبه لباس الكافرات. الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة. الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب. الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير. _________ (1) عدة الباحث في أحكام التوارث، للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، ص 4.
(1/223)
ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلاً: الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها كاملاً: لما كانت المرأة مصدر التعلق والفتنة والإغراء، فقد أمرها اللَّه تعالى بالحجاب السابغ الساتر لجميع بدنها، صيانة لها من الأوغاد، وحفاظًا على المجتمع من الفساد؛ لأدلة كثيرة، منها: 1 - قال اللَّه تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1). فقد أمر اللَّه تعالى في هذه الآية النساء أن يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن للناظرين إلا أمام من استثناه منهم في تتمتها حذرًا من الافتتان. واستثنى الرداء والثياب وما ظهر منهن بغير قصد، كالذي يبدو _________ (1) سورة النور، الآية: 31.
(1/224)
عند حركتها، أو إصلاح شأن من شؤونها، أو ما تكشفه الريح منها، فهذا هو المعفو عنه إذا سارَعْن إلى ستره. 2 - وقال اللَّه - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} (1). فقد أمر اللَّه تعالى زوجات النبي الطاهرات، وبناته الفضليات، وكافة النساء المؤمنات أن يرتدين الجلباب الشرعي السابغ الذي يغطي أجسامهن ووجوههن؛ لئلا يتعرض لهن أحد بسوء، فتعرف المرأة من حجابها السابغ لجميع البدن بأنها حرَّة وليست بأمة، عفيفة غير متطلعة لفاحشة، فتنقطع أطماع أصحاب القلوب المريضة عنهن (2). الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة (3)؛ للأدلة الآتية: 1 - عموم قوله - عز وجل -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (4)، فإن هذا العموم _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) انظر: حجاب المرأة المسلمة، للبرازي، ص 142. (3) ترجم الترمذي، 3/ 461 لذلك بقوله: «باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة»، والدارمي، 2/ 279 لذلك بقوله: «باب في كراهية إظهار الزينة»، وابن الجوزي في أحكام النساء، ص 288 بقوله: «تحريم التبرج، وإظهار الزينة، وإبراز المحاسن، وكل ما يستدعي شهوة الرجل»، والهيتمي في الزواجر، 2/ 71، طبع دار الكتب العلمية، وقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج». (4) سورة النور، الآية: 31.
(1/225)
يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة بأي نوع من أنواع الزينة التي تلفت أنظار الرجال إليها. 2 - قال اللَّه - عز وجل -: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} (1)، إن من الزينة المنهي عن إبدائها: ضربُ المرأة برجلها ليُعلم خلخالها، أو تحريك يديها ليُسمع وسوسة حليها، فقد كان ذلك من عادات المرأة في الجاهلية التي نهى اللَّه عنها. قال ابن كثير - رحمه الله -: «كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خَلخال صامت لا يُعلم صوته، ضربت برجلها الأرض، فيسمع الرجال طنينه، فنهى اللَّه المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خَفيّ دخل في هذا النهي، لقوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} إلى آخره» (2). 3 - قال اللَّه - سبحانه وتعالى -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (3). أمر اللَّه تعالى في هذه الآية نساء المسلمين بالقرار في البيوت، وعدم التبرج؛ فلو كان الحجاب مزينًا فإن الخروج به من التبرج المنهي عنه، ولمّا كان المقصود من الأمر بالجلباب هو ستر الزينة، فلا يجوز أن يكون هو نفسُهُ مزينًا يستدعي أنظار الرجال. _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) تفسير القرآن العظيم، 10/ 224. (3) سورة الأحزاب، الآية: 33.
(1/226)
قال الشوكاني - رحمه الله -: «التبرج: أن تبديَ المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره، مما تستدعي به شهوة الرجل» (1). وقال القرطبي - رحمه الله - عند قول اللَّه تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (2): أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرج: التكشف والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مشيدة، وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها. وقيل لعائشة - رحمه الله -: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب، والصباغ، والتمائم، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، ورِقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قِصَّتُكُنَّ قصة امرأة واحدة، أحلَّ اللَّه لكُنَّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحلُّ لكُنَّ أن يَرَوا منكنَّ مُحرَّمًا» (3). وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه مسلم وغيره: «إذا شهدتْ إحداكنَّ المسجدَ فلا تمسَّ طيبًا»، قال: «ويلحقُ بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحُسْنِ الملبس، والحليّ الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال» (4). _________ (1) فتح القدير للشوكاني، 4/ 278. (2) سورة النور، الآية: 60. (3) تفسير القرطبي، 12/ 309 - 310. (4) فتح الباري، 2/ 350، وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، 1/ 168، وفيض القدير، 1/ 387 - 388، وأوجز المسالك، 4/ 104.
(1/227)
ومما قاله الحافظ ابن حجر وقبله المفسر القرطبي رحمهما الله تعالى يتبين بجلاء أن إظهار الحلي على مواضعها منهي عنه. وبعض النساء المحجبات يتساهلن في ذلك فيظهرن للأجانب: الأساور، والقلائد، والأطواق، والأقرطة من فوق الحجاب، فهذا مما لا يحل إبداؤه، ولا يجوز إظهاره. 4 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» (1). وقال الذهبي أيضًا: «فمن الأفعال التي تُلعن عليها المرأة: إظهار الزينة، والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيُّبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولُبسُها الصباغات، والأُزُر من الحرير، والأقبيةَ القصار، مع تطويل الثوب، وتوسعة الأكمام، وتطويلها، إلى غير ذلك إذا خرجت، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت اللَّه عليه فاعِلَه في الدنيا والآخرة. ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء، قال عنهنَّ النبي _________ (1) أحمد، 2/ 169، برقم وابن جرير، 28/ 52، ومسند الشاميين، للطبراني، 2/ 304، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 6/ 41 وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»، وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 121ـ
(1/228)
- صلى الله عليه وسلم -: «وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» (1). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرَّ على الرجال من النساء» (2)، فنسألُ اللَّه أن يقينا فِتَنَهُنَّ، وأن يُصلحهُنَّ وإيانا بمنِّه وكرمه» (3). 5 - عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ... » (4). الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآتية (5): _________ (1) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم 3241، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم 2737. (2) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (3) الكبائر للذهبي، ص 135، والحديث الذي أورده الذهبي بلفظ: «اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء»، وهو في السنن الكبرى للنسائي، 5/ 398، 9215، وشرح مشكل الآثار للطحاوي، 13/ 216، وصحيح ابن حبان، 16/ 493. (4) أخرجه أحمد، 39/ 368، برقم 23943، والبخاري في الأدب المفرد، ص 207، برقم 590، والحاكم، 1/ 119، وصححه، وابن حبان، 10/ 422، والبزار، 9/ 204، والطبراني في الكبير، 18/ 306، والبيهقي في شعب الإيمان، 10/ 220، وصححه محققو المسند، 39/ 368، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 234. (5) ترجم الهيثمي في موارد الظمآن، ص 351 لذلك بقوله: «باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره»، وصاحب المنتقى، 2/ 116 لذلك بقوله: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها»، وابن مفلح في الآداب الشرعية، 3/ 523بقوله: «فصل في كراهة لبس الشفوف، والمنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 94، وقال: «الترهيب في لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة»، وصديق حسن خان في حسن الأسوة، ص / 568 بقوله: «باب ما ورد في ترهيب النساء من لبس الرقيق من الثياب الذي يشف عن البشرة».
(1/229)
1 - عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ، مَائِلاَتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَ» (1). قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: «وأما معنى قوله: كاسيات عاريات، فإنه أراد اللواتي يَلبَسْنَ من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة، مائلات عن الحق، مميلات لأزواجهن عنه» (2). 2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ _________ (1) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، برقم 2128. (2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 13/ 204، ونقله السيوطي في تنوير الحوالك، 3/ 103.
(1/230)
نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ» (1). قال الإمام أبو بكر بن العربي: «من التبرج أن تلبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصفها، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «رُبَّ نساءٍ كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» (2). وإنما جعلهنَّ كاسياتٍ لأن الثيابَ عليهن، وإنما وصفهنَّ بعاريات لأن الثوب إذا رقَّ يكشفهنَّ، وذلك حرام» (3). وقد ذكر القرطبي نحوه، ونقل عن ابن العربي عبارته الأخيرة على نحو أتم فقال: «وإنما جعلهن كاسيات؛ لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رقَّ يصفهنَّ ويبدي محاسنهن، وذلك حرام» (4). ولعله لهذا المعنى الذي يحمله هذا الحديث الشريف، قال جرير بن _________ (1) أحمد، 11/ 654، برقم 7083، وابن حبان، برقم 5753، والحاكم، 4/ 436، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وأخرجه الطبراني مختصرًا في المعجم الصغير، 2/ 258، الروض الداني بإسناد صحيح بلفظ: «سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 240: «رواه أحمد، والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الطبراني قال: «سيكون في أمتي رجال يركب نساؤهم على سروج، كأشباه الرجال»، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 2683. (2) انظر: صحيح مسلم، برقم 2128، وتقدم تخريجه. (3) أحكام القرآن، 3/ 1401. (4) الجامع لأحكام القرآن، 12/ 310.
(1/231)
عبد اللَّه - رضي الله عنه -: «إن الرجل لَيَلبس وهو عارٍ، يعني: الثياب الرقاق» (1). 3 - وعن هشام بن عروة: «أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر من ثياب مَرْويَّة وقوهيَّة (2) رقاق عتاق بعدما كُفَّ بصرها، قال: فَلَمَستها بيدها، ثم قالت: أُفّ، رُدوا عليه كسوته، قال: فشقَّ ذلك عليه، وقال: يا أُمَّهْ، إنه لا يشفّ، قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف» (3). 4 - وروي عن علقمة بن أبي علقمة، عن أُمِّه - رضي الله عنها -: قالت: «دَخَلتْ حفصةُ بنتُ عبد الرحمن على عائشةَ، وعليها خمار رقيق [يشف عن جيبها]، فشقَّتْهُ عائشةُ [وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور] وكَسَتها خِماراً كثيفاً» (4). _________ (1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، 8/ 277، والطبراني في الكبير، 2/ 292، برقم 2215، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 136: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». (2) مَرْويَّة: ثياب منسوجة في (مَرْو). وهي كما في لسان العرب: مدينة بفارس، النسب إليها: مَرْويّ، ومَرَويّ، ومَرْوَزيّ. (الأخيران من معدول النسب)، وقال الجوهري: النسبة إليها: مَرْوَزيّ على غير قياس، والثوب: مَرْوِيّ على القياس. وقوهيَّة: ثياب بيض، نسبة إلى (قُوهُستان)، بين نيسابور وهَراة، وكل ثوب أشبهه يقال له قوهيّ، وإن لم يكن من قوهستان. انظر: القاموس المحيط، وحكى ابن منظور عن الأزهري: أن الثياب القوهية معروفة، منسوبة إلى قوهستان. (3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 8/ 252، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 127. (4) أخرجه مالك في الموطأ، 2/ 913، برقم 1625، وطبقات ابن سعد، 8/ 72، وما بين المعقوفين من الطبقات، وأورد القرطبي في تفسيره، 14/ 215: «ودخلت نسوة من بني تميم على عائشة - رضي الله عنها - عليهن ثياب رقاق فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، وأدخلت امرأة عروس على عائشة - رضي الله عنها - وعليها خمار قبطي معصفر، فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا». وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 126.
(1/232)
الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآتية: 1 - قول أُسَامَةَ بن زيد - رضي الله عنه -: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُبْطِيَّةً (1) كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً (2)، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا» (3). قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا - رحمه الله -: «المعنى: إن ثوب المرأة إما أن يكون كثيفًا، أي غليظًا ضيقًا يصف تقاسيم جسم المرأة، وإما أن يكون رقيقًا يصف لون بشرتها، وكلاهما غير جائز. _________ (1) القِبط - بالكسر -: نصارى مصر، الواحد: قِبطيّ على القياس، والقُبطيّ: ثوب من كتَّان رقيق يُعمل بمصر، نسبة إلى القِبط على غير قياس، فرقًا بينه وبين الإنسان، وثياب قُبطية أيضًا، وجبة قبطية، والجمع قَباطي. المصباح المنير، 2/ 488، مادة (قبط). (2) الغِلالة هي: شِعار يلبَس تحت الثوب؛ لأَنه يُتَغَلَّل فيها أَي يُدْخَل، وفي التهذيب: الغِلالة الثوب الذي يلبس تحت الثياب. لسان العرب، 5/ 3287، مادة (غلّ). (3) أخرجه أحمد، 36/ 120، برقم 21786، وابن سعد، 4/ 64، والطبراني في الكبير، 12/ 387، برقم 13433، والبيهقي 2/ 234، برقم 3388، والضياء، 2/ 171، برقم 1368، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 136: «رواه أحمد، والطبراني، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات»، وحسنه الألباني في الثمر المستطاب، ص 318.
(1/233)
والمطلوب: أن يكون ثوبُ المرأة الظاهرُ أمام الناس واسعًا كثيفًا لا يصف جسمًا ولا بشرة» (1). قَالَ الإمام مَالِكٌ - رحمه الله -: «بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَلْبَسْنَ الْقَبَاطِيَّ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لَا تَشِفُّ فَإِنَّهَا تَصِفُ، قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى تَصِفُ أَيْ تَلْصَقُ بِالْجِلْدِ. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الْوَصَائِفِ يَلْبَسْنَ الْأَقْبِيَةَ، فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، وَإِذَا شَدَّتْهَا عَلَيْهَا ظَهَرَ عَجُزُهَا، وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُ لِضِيقِهِ يَصِفُ أَعْضَاءَهَا: عَجُزَهَا وَغَيْرَهَا مِمَّا شُرِعَ سِتْرُهُ» (2). قال ابن رشد: «القباطيّ: ثياب ضيقة تلصق بالجسم لضيقها، فتبدو ثخانة جسم لابسها من نحافته، وتصف محاسنه، وتبدي ما يُسْتَحْسَنُ منه مما لا يُستحسَن، فنهى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يلبسها النساء امتثالاً لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}» (3). 2 - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» (4). _________ (1) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 301. (2) المنتقى شرح الموطأ، للباجي، 7/ 224. (3) المدخل، لابن الحاج، 1/ 242. (4) مسلم، برقم 2128، وتقدم تخريجه.
(1/234)
قال الشوكاني - رحمه الله -: «والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها، وهو أحد التفاسير كما تقدم. والإخبارُ بأن من فعل ذلك من أهل النار، وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام، وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين» (1). 3 - وعَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَلاَ أُرِيكِ شَيْئًا رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ فَدَعَتْ بِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَنَتْهَا، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ - رحمه الله -: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ يُعْرَفُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه -، وَلاَ تُدْخِلِي عَلَيَّ أَحَدًا، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ - رحمه الله - جَاءَتْ عَائِشَةُ - رحمه الله - تَدْخُلُ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: لاَ تَدْخُلِي، فَشَكَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذِهِ الْخَثْعَمِيَّةَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ جَعَلَتْ لَهَا مِثْلَ هَوْدَجِ الْعَرُوسِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَوَقَفَ عَلَى الْبَابِ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ مَا حَمَلَكِ أَنْ مَنَعْتِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلْنَ عَلَى ابْنَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَجَعَلْتِ لَهَا مِثْلَ هَوْدَجِ الْعَرُوسِ؟ فَقَالَتْ: أَمَرَتْنِي أَنْ لاَ تُدْخِلِي عَلَيَّ أَحَدًا، وَأُرِيتَهَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: _________ (1) نيل الأوطار، 2/ 131.
(1/235)
فَاصْنَعِي مَا أَمَرَتْكِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَغَسَلَهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ - رضي الله عنهما -» (1). قال العلامة الألباني - رحمه الله -: «ومما يحسن إيراده هنا استئناساً ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا». ثم ساق الحديث. ثم قال العلامة الألباني - رحمه الله -: «فانظر إلى فاطمة بضعة النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح، فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة ... ثم ليستغفرن اللَّه تعالى، وليتبن إليه، وليذكرن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحياء والإيمان قُرِنا جميعًا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» (2). _________ (1) أخرجه البيهقي، 4/ 34، واللفظ له، ومختصراً في 3/ 396، وأبو نعيم في حلية الأولياء، 2/ 43مختصرًا، قال العلامة علاء الدين المارديني الشهير بابن التركماني في الجوهر النقي، 3/ 396: «قلت: في سنده من يُحتاج إلى كشف حاله»، وأخرجه الجوزقاني في كتابه: الأباطيل والمناكير، والصحاح والمشاهير، 2/ 62 بإسناده إلى أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن أسماء بنت عُميس، أن فاطمة بنت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قالت: .. وذكره .. ثم قال: هذا حديث مشهور حسن، رواه عن أم جعفر عمارةُ بنُ المهاجر. كما ذكره الذهبي في تلخيص الأباطيل، ص 33، وقال: «وهذا حسن»، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 134. (2) حجاب المرأة المسلمة للألباني، ص 63.
(1/236)
وكما لا يجوز للمرأة لُبْسُ الثياب الضيقة التي تصف أعضاءها، فكذا لا يجوز نظرُ المحارم والنساء إلى المجسَّم من عورتها، ولا نظَرُ الأجانب إلى ما يصف أيَّ عضوٍ من أعضائها، حتى ولو كان ما تلبسه ثخينًا لا يشف عن شيء منها. قال العلامة الشيخ علاء الدين عابدين: «ولا يجوز رؤية الثوب بحيث يصف حجم عضوها ولو كثيفًا لا تُرى البشرة منه، ولو بلا شهوة. ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزقٍ بها يصف حجمها، كما أفاده سيدي الوالد مما استفاده مما في التبيين» (1) (2). الشرط الخامس: أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآتية (3): 1 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ _________ (1) الهدية العلائية، ص 243. (2) انظر: حجاب المسلمة، للبرازي، ص 270. (3) ترجم الدارمي، 2/ 279 لذلك بقوله: «باب في النهي عن الطيب إذا خرجت»، وابن خزيمة، 3/ 91 بقوله: «باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها، وتسمية فاعلها زانية»، والمنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 84 بقوله: «ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة»، وابن الجوزي في أحكام النساء، ص 216، بقوله: «نهي المرأة إذا تطيبت أن تخرج»، والبنا الساعاتي في الفتح الرباني، 17/ 303 بقوله: «باب ما جاء في خروج النساء من منازلهن لغير حاجة، ووعيد من تعطرت للخروج»، والهيتمي في الزواجر، 2/ 45 بقوله: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج.
(1/237)
زَانِيَةٌ» (1). قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي - رحمه الله - بعد هذا الحديث: «فيه تشديد وتشنيع على من تستعمل الطيب من النساء للخروج، وتشبيه لها بالزانية؛ لأنها تهيج بالتعطُّر شهوات الرجال، وتفتح باب عيونهم للنظر إليها، وذلك من مقدمات الزنا، وقد نشأ ذلك في نساء زماننا، نعوذ باللَّه من فتنهنّ» (2). وقال المناوي - رحمه الله -: «فهي زانية» أي كالزانية في حصول الإثم وإنْ تفاوت؛ لأن فاعل السبب كفاعلِ المسبَّب. قال الطيبي: شبَّه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا بالزنا، مبالغة وتهديدًا وتشنيعًا عليها، «وكل عين زانية»، أي كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من الزنا، إذ هو حظها منه. _________ (1) أخرجه أحمد، 32/ 483، برقم 19711، وأبو داود بنحوه، كتاب الترجيل، باب في طيب المرأة للخروج، برقم 4173، والنسائي، كتاب الزينة، ما يكره للنساء من الطيب، برقم 5126، وفي السنن الكبرى له أيضاً، كتاب الزينة، ما يكره للنساء من الطيب، برقم 9361، والترمذي، كتاب الأدب عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، برقم 2786 بنحوه، وقال: «حسن صحيح»، وابن حبان، 10/ 270، برقم 4424، وابن خزيمة، 3/ 91، برقم 1681، واللفظ له، والبيهقي، 3/ 246، برقم 6188، والحاكم، 2/ 397، والدارمي، 1/ 198، وقال محققو المسند،32/ 483: «إسناده جيد»، وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 136. (2) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 303.
(1/238)
وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية؛ لأن اللَّه إذا حرَّم شيئًا زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة، وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان ابن عمر - رضي الله عنهما - ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت حتى يبرد» (1). وقال المباركفوري: «زانية: لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها، وحَمَلتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنى العين، فهي آثمة» (2). 2 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ» (3). قال ابن دقيق العيد: «وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال، وأُلحِقَ به حسن الملبس والحلي الظاهر» (4). وقد ترجم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم على أحاديث الخروج إلى المساجد بقوله: «باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مُطيَّبة»، ثم قال عند حديث: «لا تمنعوا _________ (1) فيض القدير، 3/ 147. (2) تحفة الأحوذي، 8/ 71. (3) مسلم، كتاب الصلاة، باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً، برقم 444. (4) ذكره المناوي في فيض القدير، 3/ 137.
(1/239)
إماء اللَّه مساجد اللَّه» (1): «هَذَا وَشَبَهه مِنْ أَحَادِيث الْبَاب ظَاهِر فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَع الْمَسْجِد، لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاء مَأْخُوذَة مِنْ الْأَحَادِيث، وَهُوَ: أَلَّا تَكُون مُتَطَيِّبَةً، وَلَا مُتَزَيِّنَةً، وَلَا ذَاتَ خَلَاخِل يُسْمَع صَوْتهَا، وَلَا ثِيَاب فَاخِرَة، وَلَا مُخْتَلِطَة بِالرِّجَالِ، وَلَا شَابَّة وَنَحْوهَا مِمَّنْ يُفْتَتَن بِهَا، وَأَنْ لَا يَكُون فِي الطَّرِيق مَا يَخَاف بِهِ مَفْسَدَة وَنَحْوهَا، وَهَذَا النَّهْي عَنْ مَنْعهنَّ مِنْ الْخُرُوج مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَة ذَات زَوْج أَوْ سَيِّد، وَوُجِدَتْ الشُّرُوط الْمَذْكُورَة (2)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج وَلَا سَيِّد، حَرُمَ الْمَنْع إِذَا وُجِدَتْ الشُّرُوط» (3). وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي في باب: «آداب تتعلق بخروجهن وصلاتهن في المسجد»: «في أحاديث الباب النهي عن خروج المرأة من بيتها متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة، فإن طرأ عليها ما يستدعي الخروج لضرورة وهي متطيبة، فلتبادر إلى إزالته، ولتخرج متلففة بما يستر جميع بدنها ويمنع صفته، بحيث لا يُرى منه شيء إلا ما تدعو الضرورة لكشفه، كبعض وجهها لترى الطريق» (4). _________ (1) أخرجه مسلم، برقم 442، أحمد، برقم 9645، وأبو داود، برقم 565، تقدم تخريجه. (2) ومعنى العبارة: يكره كراهة تنزيه منع الزوج زوجته، والسيد أَمَتَهُ من الخروج إلى المسجد إذا لم تكن مطيبة، ولا متزينة .. إلخ. (3) شرح صحيح مسلم، للنووي، 4/ 161 - 162. (4) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 5/ 205.
(1/240)
3 - وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ - وفي رواية: المسجد - فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» (1). قال المناوي: «إذا شهدت إحداكن العشاء» أي أرادت حضور صلاتها مع الجماعة بنحو مسجد، وفي رواية مسلم بدل «العشاء»: «المسجد». «فلا تَمسَّ طيبًا» من طيب النساء قبل الذهاب إلى شهودها أو معه؛ لأنه سبب للافتتان بها، بخلافه بعده في بيتها، وتخصيص العشاء ليس لإخراج غيرها، بل لأن تطيُّب النساء إنما يكون غالبًا في أول الليل. قال ابن دقيق العيد: «ويُلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحُسْنِ الملبس، والحلي الذي يظهر، والهيئة الفاخرة. فإن قلت: فلمَ اقتصر في الحديث على الطيب؟ قلت: لأن الصورة أن الخروج ليلًا، والحليَّ، وثياب الزينة مستورة بظلمته، وليس لها ريح يظهر، فإن فُرضَ ظهوره كان كذلك. فإن قلتَ: فلمَ نكَّر الطيب؟ قلت: ليشمل كل نوع من الأطياب _________ (1) مسلم، كتاب الصلاة، باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً، برقم 443.
(1/241)
التي يظهر ريحها؛ فإن ظهر لونه وخفي ريحه فهو كثوب الزينة؛ فإن فُرض أنه لا يُرى لكونها متلففة، وهي في ظلمة الليل احتمل أن لا تدخل في النهي» (1). فإذا كان التبخر والتعطر محرمًا على من تريد المسجد؛ فإنه يكون مُحرَّمًا بالأولى على من تخرج من بيتها متعطرة متبخِّرة لغيره، سيَّما تلك التي تطوف الأسواق بقَدِّها، وتختال في الطرقات بمشيتها، وتغشى الحدائق ودور الخيالة (السينما) بنفسها. لهذا عدَّ ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي خروجها متعطرة من الكبائر فقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة، حتى ولو أذِنَ لها زوجها بذلك، ثم قال بعد أن أورد عدة أحاديث: «عُدَّ هذا - أي كون التعطر كبيرة من الكبائر - هو صريح هذه الأحاديث، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا يعني قواعد الشافعية - على ما إذا تحققت الفتنة، أما مع مجرّد خشيتها فهو مكروه، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر» (2). وقال ابن حزم: «ولا يحلُّ لهنَّ أن يخرجن متطيبات، ولا في ثياب حسان، فإن فعلنَ فليمنعها» (3)، أي فليمنعها الزوج من ذلك. _________ (1) فيض القدير، 1/ 387 - 388 باختصار. وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، 1/ 168، وفتح الباري، 2/ 350، وأوجز المسالك، 4/ 104. (2) الزواجر عن اقتراف الكبائر، 2/ 45. (3) المحلى، 4/ 129.
(1/242)
قال المناوي - رحمه الله -: «أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب، قال بعض الكبراء: تَزيُّنُ المرأة، وتطيُّبها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما، وعدم الكراهة والنُّفرة؛ لأن العين رائد القلب، فإذا استحسنت منظرًا أَوْصَلَتهُ إلى القلب فحصلت المحبة، وإذا نظرت منظرًا بشعًا، أو لا يُعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة؛ ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن: إيَّاكِ أن تقع عين زوجك على شيء لا يستملحه، أو يشم منك ما يستقبحه» (1). فإذا عزمت المرأة على الخروج من بيتها، وجب عليها غسل الطيب عن بدنها، وإزالته عن جلبابها وثيابها، أو الخروج بثيابٍ غيرها، لئلا تبوء بغضب ربها. 4 - فعن مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ، فَقَالَ لَهَا: إِلَى أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ: تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يُقْبَلُ اللَّهُ مِنَ امْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ» (2). _________ (1) فيض القدير، 3/ 147. (2) أخرجه أحمد، 12/ 311، برقم 7356، وابن خزيمة، 3/ 91 - 92، واللفظ له، وأبو داود، أول كتاب الترجل، باب في طيب المرأة للخروج، برقم 4174، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، برقم 4002، وعبد الرزاق، 4/ 371، برقم 8109، والحميدي، 2/ 429، والطيالسي، 1/ 358 (منحة المعبود)، والبيهقي، 3/ 133، و246، بثلاثة أسانيد أحدها صحيح، وأبو يعلى، 11/ 271، برقم 6385. وقال محققو المسند، 12/ 313: «إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات»، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 216، برقم 2020.
(1/243)
قال ابن الأثير: «يا أَمَة الجبار»: إنما أضاف الأَمَةَ هنا إلى الجبَّار دون باقي أسماء اللَّه تعالى؛ لأن الحال التي كانت عليها المرأة من الفخر والكبرياء بالطيب الذي تطيبت به، وجرِّ أذيالها، والعُجبِ بنفسها، اقتضى أن يضيف اسمها إلى اسم الجبار، تصغيرًا لشأنها، وتحقيرًا لها عند نفسها، وهذا من أحسن التعريض، وأشبهه بمواقع الخطاب» (1). وقال الشيخ محمد عبد الرحمن البنا الساعاتي: «إنما طلبَ منها الغسل كغُسلِ الجنابة، يعني في وجوبه، وتعميم بدنها بالماء مبالغة في إزالة ريح الطيب، والمعنى: أن اللَّه تعالى لا يقبل من امرأة تطيَّبت لأجل المسجد صلاةً مادامت رائحة ذلك الطيب عالقة بها، فإذا كان هذا عقاب من تطيبت لأجل المسجد والصلاة، فما بالك بعقاب من تطيبت للخروج في الأسواق والمتنزهات، ولم تركع للَّه ركعة من الصلوات المفروضات. نسأل اللَّه السلامة» (2). 5 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ» (3). _________ (1) جامع الأصول في أحاديث الرسول، 4/ 772. (2) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 5/ 200. (3) أخرجه النسائي، كتاب الزينة، اغتسال المرأة من الطيب، برقم 5127، وفي السنن الكبرى له أيضاً، كتاب الزينة، اغتسال المرأة من الطيب، برقم 9362، وبنحوه البيهقي، 3/ 133، وابن أبي شيبة 9/ 26، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1031.
(1/244)
قال السندي - رحمه الله -: «قوله: فلتغتسل من الطيب ظاهرهُ أنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد وهي قد استعملت الطيب في البدن، فلتغتسل منه، وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة، حتى يزول عنها الطيب بالكلية، ثم لْتخرج. ومثله قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه} (1)، لا أنها إذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغُسل لذلك، لكن رواية أبي داود ظاهرة في الثاني؛ فقيل: أمَرَها بذلك تشديدًا عليها، وتشنيعًا لفعلها، وتشبيهًا له بالزنا؛ وذلك لأنها هيَّجت بالتعطر شهوات الرجال، وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا، فحكم عليها بما يُحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة، «واللَّه تعالى أعلم» (2). والوجه الأول القاضي بوجوب الغُسل عليها إذا أرادت الخروج متطيبة إلى المسجد، هو الذي ذهب إليه الحافظ ابن خزيمة في صحيحه حيث قال: «باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلَّت قبل أن تغتسل» (3). وقد كان السلف الصالح رحمهم اللَّه تعالى يتشددون في هذا _________ (1) سورة النحل، الآية: 98. (2) حاشية السندي بهامش سنن النسائي، 8/ 154. (3) صحيح ابن خزيمة، 3/ 91.
(1/245)
الباب، فيزجرون المرأة إذا شمُّوا طيبها، ولا يأذنون لها - حينذاك - ـ بالخروج من بيتها. * فعن إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ، فَوَجَدَ رِيحَ رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبَةُ هَذِهِ الرِّيحِ؟ أَمَا لَوْ عَرَفْتُهَا لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، إِنَّمَا تَطَّيَّبُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَبِسَتْ أُطَيْمِيرَهَا أَوْ أُطَيْمِيرَ خَادِمِهَا، قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّهَا قَامَتْ عَنْ حَدَثٍ» (1) يعني من شدة الخوف. * وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ وَجَدَ مِنَ امْرَأَتِهِ رِيحَ مِجْمَرٍ، وَهِيَ بِمَكَّةَ، فَأَقْسَمَ عَلَيْهَا أَلاَ تَخْرُجَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» (2). * وعَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَتَهُ اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَوَجَدَ بِهَا رِيحُ دُخْنة فحبسها، وَقَالَ: إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَإِنَّمَا طِيبُهَا شَنَارٌ فِيهِ نَارٌ» (3). وأما ما جاء عن عائشة - رحمه الله -، أنها قالت: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ يَنْهَاهَا» (4). _________ (1) مصنف بن أبي شيبة، 9/ 25 - 26. (2) مصنف بن أبي شيبة، 9/ 27. (3) مصنف بن أبي شيبة، 9/ 27، وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي، 4/ 429، والفائق للزمخشري. (4) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، برقم 1832، والبيهقي، 5/ 48، ولفظه: «فلا ينهانا»، وله في معرفة السنن، 7/ 143، وبنحوه أحمد، 41/ 50، برقم 24502، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 5/ 10: «سكت عنه أبو داود والمنذري، وإسناده رواته ثقات، إلا الحسن بن الجنيد شيخ أبي داود، وقد قال النسائي لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي»، وقال النووي في المجموع، 7/ 219: «هذا حديث حسن»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 6/ 92، برقم 1606.
(1/246)
فهو خاص بحالة مريد الإحرام لا بغيرها، ويقابل تلك الحالة من المنهيات قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (1)، وما ذلك إلا لكونها في عبادة خاصة؛ لهذا أذنَ لها بالطيب قبل شروعها في الإحرام رغم أنه مُحَرَّمٌ عليها عند خروجها من منزلها في غير الحالة المذكورة، وحَرَّمَ عليها النقاب والقفازين أثناء إحرامها مع كونهما من حجاب المسلمات الذي دَرَجْنَ عليه في غير حالة الإحرام. وقد ذكر الإمام الشافعي - رحمه الله - في باب «الطيب للإحرام» من كتابه: «اختلاف الحديث» بعضَ الأحاديث الواردة في ذلك، ثم قال: «وبهذا كله نأخذ، فنرى جائزًا للرجل والمرأة أن يتطيبا بالغَالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد الإحرام، إذا كان تطيبَ به قبل الإحرام» (2). وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «يُستحبّ أن يتطيّب في بدنه عند إرادة الإحرام، سواء الطِّيب الذي يبقى له جُرم بعد الإحرام، والذي _________ (1) أخرجه البخاري، برقم 1838، تقدم تخريجه. (2) اختلاف الحديث، ص 175.
(1/247)
لا يبقى، وسواء الرجل والمرأة، هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب في جميع الطرق». وبعد أن أورد أقوالًا أخرى قال: «والصواب استحبابه مطلقاً ... وسواء في استحبابه المرأة الشابة والعجوز، وقالوا: والفرق بينه وبين الجمعة؛ فإنه يكره للنساء الخروج إليها مُتطيبات؛ لأن مكان الجمعة يضيق، وكذلك وقتها، فلا يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك» (1). وقال الخطيب الشربيني: «وَيُسَنُّ أَنْ يُطَيِّبَ مُرِيدُ الْإِحْرَامِ بَدَنَهُ لِلْإِحْرَامِ رَجُلًا كَانَ أَوْ خُنْثَى، أَوْ امْرَأَةً شَابَّةً، أَوْ عَجُوزًا: خَلِيَّةً أَوْ مُتَزَوِّجَةً، اقْتِدَاءً بِهِ - صلى الله عليه وسلم -.رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَقِيلَ: لَا يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ، كَذَهَابِهَا إلَى الْجُمُعَةِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ زَمَانَ الْجُمُعَةِ وَمَكَانَهَا ضَيِّقٌ، وَلَا يُمْكِنُهَا تَجَنُّبُ الرِّجَالِ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ» (2). وبناءً على ذلك فإن هذا الحديث خاص بحالة الإحرام؛ ولعل الحكمة في الترخيص لهن بالطيب أثناء ذلك هي دفعُ الروائح الكريهة الناجمة عن كثرة التعرق من شدة الحرارة، وكثرة الزحام، ويبعد عنهن في الغالب كل البعد استمالة الرجال إلى المعصية أثناء ذلك؛ لكونهن يؤدين عبادة اللَّه تعالى في أقدس البقاع. _________ (1) المجموع شرح المهذب، 7/ 218. (2) مغني المحتاج، 1/ 479.
(1/248)
أما ماعدا تلك الحالة، فيحرم على المرأة أن تتطيب عند خروجها من بيتها؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة التي تنهى عن ذلك أشد النهي. وحديث عائشة - رحمه الله - قالت: «طَيَّبتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِه، وطيَّبتُهُ بِمِنًى قبلَ أن يُفيضَ» (1). وليس في هذا الحديث أي دلالة على جواز خروج المرأة متطيبة. بل يؤخذ منه عين الترجمة التي وضعها له الإمام البخاري، حيث قال: «باب تطييب المرأة زوجها بيديها». قال الحافظ ابن حجر: «كَأَنَّ فِقه هَذِهِ التَّرجَمَة مِن جِهَة الإِشارَة إِلَى الحَدِيث الوارِد فِي الفَرق بَين طِيب الرَّجُل والمَرأَة، «وأَنَّ طِيب الرَّجُل ما ظَهَرَ رِيحه، وخَفِيَ لَونه، والمَرأَة بِالعَكسِ» (2)، فَلَو كانَ ذَلِكَ ثابِتًا لامتَنَعَت المَرأَة مِن تَطَيُّب زَوجها؛ لِما يُعَلَّق بِيَدَيها وبَدَنها مِنهُ حالَة تَطيِيبها لَهُ، وكانَ يَكفِيه أَن يُطَيِّب نَفسه، فاستَدَلَّ المُصَنِّف بِحَدِيثِ عائِشَة المُطابِق لِلتَّرجَمَةِ، وقَد تَقَدَّمَ مَشرُوحًا فِي الحَجّ، وهُو _________ (1) البخاري، كتاب اللباس، تطييب المرأة زوجها بيديها برقم 5922، بلفظه، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، برقم 1189. (2) الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في طيب الرجال والنساء، برقم 2788، بلفظ: «طيب الرجال ما ظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه»، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الزينة، الفصل بين طيب الرجال والنساء، برقم 9348، ومعجم الشيوخ لابن عساكر، 2/ 191، وصححه الألباني في مختصر الشمائل، برقم 188.
(1/249)
ظاهِر فِيما تُرجِمَ لَهُ، والحَدِيث الَّذِي أَشارَ إِلَيهِ: أَخرَجَهُ التِّرمِذِيّ، وصَحَّحَهُ الحاكِم مِن حَدِيث عِمران بن حُصَينٍ، ولَهُ شاهِد عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيّ عِند الطَّبَرانِيِّ فِي الأَوسَط (1). ووجه التَّفرِقَة أَنَّ المَرأَة مَأمُورَة بِالاستِتارِ حالَة بُرُوزها مِن مَنزِلها، والطِّيب الَّذِي لَهُ رائِحَة لَو شُرِعَ لَها كانَت فِيهِ زِيادَة فِي الفِتنَة بِها، وإِذا كانَ الخَبَر ثابِتًا، فالجَمع بَينه وبَين حَدِيث الباب أَنَّ لَها مَندُوحَة أَن تَغسِل أَثَره إِذا أَرادَت الخُرُوج؛ لأَنَّ مَنعها خاصّ بِحالَةِ الخُرُوج. واللَّه أَعلَم» (2). الشرط السادس: أن لا يُشبهَ لباس الرجال للأدلة الآتية (3): 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ _________ (1) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه [لبس الحرير]، برقم 4050، والمسند، 33/ 185، برقم 19975، والبيهقي، 3/ 246، والطبراني في الكبير، 18/ 147، برقم 314، ومسند البزار، 9/ 33، برقم 3549، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 7168. (2) فتح الباري، 10/ 366. (3) ترجم البزار، 2/ 446 (كشف الأستار) لذلك بقوله: «باب النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال»، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 103، وصديق حسن خان في حسن الأسوة، ص 569 لذلك بقوله: «الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس، أو كلام، أو حركة، أو نحو ذلك»، والحافظ الذهبي في الكبائر، ص 134 بقوله: «الكبيرة الثالثة والثلاثون: تشبُّهُ النساء بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء»، وصاحب المنتقى، 2/ 116 مع نيل الأوطار، والبنا الساعاتي في الفتح الرباني، 17/ 300 بقولهما: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أو تَشبَّهَ بالرجال». وانظر: [حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: 226]
(1/250)
لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ» (1). 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (2). قال الحافظ ابن حجر: «قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس. قلت: [القائل هو ابن حجر] وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس، فمختلف باختلاف عادة كل بلد .. لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي، فمختص بمن تعمَّد ذلك. وأما من كان ذلك من أصل خلقته، فإنما يؤمر بتكلف تركه، والإدمان على ذلك بالتدريج؛ فإن لم يفعل وتمادى دَخَلَهُ الذم، ولا سِيَّما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأَخذُ هذا واضح من لفظ _________ (1) أخرجه أحمد، 14/ 61، برقم 8309، وأبو داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء، برقم 4100، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، برقم 9209، والحاكم، 4/ 194، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، وأقره الذهبي، وابن حبان، 13/ 62، والبيهقي في شعب الإيمان، 6/ 187، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 131، والشيخ الساعاتي في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 303: «ورجاله رجال الصحيح»، وقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب، 4/ 469، وصَحَّحَ إسناده، وصحح إسناده محققو المسند،14/ 61، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2069، وفي جلباب المرأة المسلمة، ص 141. (2) البخاري، كتاب اللباس، بَاب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِ، برقم 5885.
(1/251)
المتشبهين. وأما إطلاق من أطلق، كالنووي، وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني، والتكسر في المشي، والكلام، بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنًا، ولو بالتدرج، فتركَهُ بغير عذر لحقهُ اللوم. واستدل لذلك الطبري بكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع المخنث من الدخول على النساء، حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة، فمنَعَهُ حينئذٍ، فدلَّ على أنْ لا ذمَّ على ما كان من أصل الخلقة» (1). 3 - وعن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا» (2). وفي رواية الدارمي: «فاخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً، وأخرج عمر فلاناً، أو فلانة، قال عبد اللَّه فأشك» (3). زاد أحمد في رواية له: «فَقُلْتُ: مَا الْمُتَرَجِّلاتُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: «الْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (4). قال ابن التين: «المراد باللعن في هذا الحديث مَن تشبَّه من _________ (1) فتح الباري، 10/ 332 - 333 باختصار. (2) أخرجه البخاري كتاب اللباس، بَاب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِ، برقم 5886. (3) سنن الدارمي، 2/ 364، برقم 2649، وقال محقق السنن: «إسناده صحيح». (4) أحمد، 4/ 144، برقم 2292، وابن أبي شيبة، 9/ 63، وقال محققو المسند، 4/ 144: «حسن لغيره».
(1/252)
الرجال بالنساء في الزِّي، ومن تشبَّه من النساء بالرجال كذلك. قال: وإنما أَمَرَ بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت؛ لئلا يفضي الأمر بالمتشبه إلى تعاطي الأمر المنكر. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة - نفع اللَّه به - ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات، ونحوها، لا التشبه في أمور الخير. وقال أيضاً: اللعن الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضربين: - أحدهما: يُراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه، وهو مخوف؛ فإن اللعنَ من علامات الكبائر. - والآخر: يقع في حال الحرج، وذلك غير مخوف، بل هو رحمة في حق من لعنه، بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقًا لذلك، كما ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم. قال: والحكمة في لعن مَن تشبَّهَ، إخراجُه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء .. » (1). 4 - وعن سالم، عن أبيه - ابن عمر - رضي الله عنهما - - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، _________ (1) فتح الباري، 10/ 333 باختصار.
(1/253)
وَالدَّيُّوثُ، وَالرَّجِلَةُ» (1). قال الحافظ المنذري: «الدَّيُّوث» - بفتح الدال، وتشديد الياء المثناة تحت-: هو الذي يعلم الفاحشة في أهله، ويقرهم عليها (2). وقال في موضع آخر: هو الذي يقر أهله على الزنا. «والرَّجِلة»:- بفتح الراء، وكسر الجيم-:هي المترجلة المتشبهة بالرجال (3). قال المناوي - رحمه الله -: «الدَّيُّوث، والرَّجلة من النساء»: بمعنى المترجلة. «ومدمن الخمر» أي: المداوم على شربها. قال ابن القيم: وذِكر الدَّيُّوث في هذا وما قبله، يدل على أنَّ أصل الدين الغَيرة، ومَن لا غَيرة له لا دِين له، فالغَيرة تحمي القلب، فتحمي له الجوارح، فترفع السوء والفواحش، وعدمها يميت القلب، فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة، والغَيرة في القلب _________ (1) أخرجه أحمد 10/ 322، برقم 6180، والنسائي في البيوع، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، برقم 4459، وفي الكبرى له أيضاً، كتاب الزكاة، المنان بما أعطى، برقم 2355، والبزار (كشف الأستار)، 2/ 372 - 373، واللفظ له بإسنادين جيدين على ما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب،3/ 327، والحاكم، 4/ 174، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وأقره الذهبي في التلخيص، والبيهقي في شعب الإيمان، 10/ 278، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 8/ 148: «رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات»، وحسّن إسناده محققو المسند، 10/ 322، وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 333: «حسن صحيح». (2) الترغيب والترهيب، 3/ 106. (3) الترغيب والترهيب، 3/ 327.
(1/254)
كالقوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة كان الهلاك» (1). والضابط في تشبه النساء بالرجال في الملبوس، وهل هو بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، أو كل زمانٍ بحسبه؟ وقد أجاب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب مفصَّل، فقال: «وَقَدْ اسْتَفَاضَتْ السُّنَنُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا بِلَعْنِ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ والمترجلات مِنَ النِّسَاءِ»، وَأَمَرَ بِنَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى نَفْيِهِمْ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَد، وَغَيْرُهُمَا، وَقَالُوا: جَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا، وَنَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا عِبَادَ اللَّهِ» (2). وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ «مَرَّ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ - رحمه الله - وَهِيَ تَعْتَصِبُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَيَّةٌ لَا لَيَّتَيْنِ» (3). _________ (1) فيض القدير، 3/ 327. (2) مسلم، برقم 1189، تقدم تخريجه. (3) أحمد، 44/ 142، برقم 26525، وأبو داود، كتاب اللباس، باب كيف الاختمار، برقم 4115، والحاكم، 4216، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وعبد الرزاق، 133، برقم 5050، والطبراني، 23/ 312، برقم 705، والبيهقي في شعب الإيمان، 5/ 150.
(1/255)
وَقَدْ فُسِّرَ قَوْلُهُ: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» بِأَنْ تَكْتَسِيَ مَا لَا يَسْتُرُهَا، فَهِيَ كَاسِيَةٌ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ عَارِيَةٌ، مِثْلُ مَنْ تَكْتَسِي الثَّوْبَ الرَّقِيقَ الَّذِي يَصِفُ بَشَرَتَهَا؛ أَوْ الثَّوْبَ الضَّيِّقَ الَّذِي يُبْدِي تَقَاطِيعَ خَلْقِهَا، مِثْلَ: عَجِيزَتِهَا، وَسَاعِدِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا كُسْوَةُ الْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا، فَلَا يُبْدِي جِسْمَهَا، وَلَا حَجْمَ أَعْضَائِهَا؛ لِكَوْنِهِ كَثِيفًا وَاسِعًا. وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ الضَّابِطُ فِي نَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَعَنْ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ رَاجِعًا إلَى مُجَرَّدِ مَا يَخْتَارُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَيَشْتَهُونَهُ، وَيَعْتَادُونَهُ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ إذَا اصْطَلَحَ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يَلْبَسَ الرِّجَالُ الْخُمُرَ الَّتِي تُغَطِّي الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ وَالْعُنُقَ وَالْجَلَابِيبَ الَّتِي تُسْدَلُ مِنْ فَوْقِ الرُّؤُوسِ، حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْ لَابِسِهَا إلَّا الْعَيْنَانِ، وَأَنْ تَلْبَسَ النِّسَاءُ الْعَمَائِمَ وَالْأَقْبِيَةَ الْمُخْتَصَرَةَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا سَائِغًا، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلنِّسَاءِ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الْآيَةَ (1). وَقَالَ: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} الْآيَةَ (2). _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/256)
وَقَالَ: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1). فَلَوْ كَانَ اللِّبَاسُ الْفَارِقُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مُسْتَنَدُهُ مُجَرَّدَ مَا يَعْتَادُهُ النِّسَاءُ أَوْ الرِّجَالُ بِاخْتِيَارِهِمْ وَشَهْوَتِهِمْ، لَمْ يَجِبْ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبَ، وَلَا أَنْ يَضْرِبْنَ بِالْخُمُرِ عَلَى الْجُيُوبِ، وَلَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِنَّ التَّبَرُّجَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَادَةً لِأُولَئِكَ، وَلَيْسَ الضَّابِطُ فِي ذَلِكَ لِبَاسًا مُعَيَّنًا مِنْ جِهَةِ نَصِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ مِنْ جِهَةِ عَادَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى عَهْدِهِ، بِحَيْثُ يُقَالُ: إنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ وَغَيْرُهُ يَحْرُمُ. فَإِنَّ النِّسَاءَ عَلَى عَهْدِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ ثِيَابًا طَوِيلَاتِ الذَّيْلِ، بِحَيْثُ يَنْجَرُّ خَلْفَ الْمَرْأَةِ إذَا خَرَجَتْ، وَالرَّجُلُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُشَمِّرَ ذَيْلَهُ حَتَّى لَا يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ؛ وَلِهَذَا لَمَّا «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرِّجَالَ عَنْ إسْبَالِ الْإِزَارِ، وَقِيلَ لَهُ: فَالنِّسَاءُ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا» قِيلَ لَهُ: إذَنْ تَنْكَشِفَ سُوقُهُنَّ! قَالَ: «ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (2). حَتَّى إنَّهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ رُوِيَ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ إذَا جَرَّتْ ذَيْلَهَا عَلَى مَكَانٍ قَذِرٍ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ عَلَى مَكَانٍ طَيِّبٍ، أَنَّهُ يَطْهُرُ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، جَعَلَ الْمَجْرُورَ _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 33. (2) الترمذي، كتاب اللباس، جر ذيول النساء، برقم 1731، وأحمد، 8/ 391، برقم 4773، والنسائي، كتاب الزينة، ذيول النساء، برقم 5337، وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 80: «حسن صحيح».
(1/257)
بِمَنْزِلَةِ النَّعْلِ الَّذِي يَكْثُرُ مُلَاقَاتُهُ النَّجَاسَةَ، فَيَطْهُرُ بِالْجَامِدِ، كَمَا يَطْهُرُ السَّبِيلَانِ بِالْجَامِدِ لِمَا تَكَرَّرَ مُلَاقَاتُهُمَا النَّجَاسَةَ. ثُمَّ إنَّ هَذَا لَيْسَ مُعِينًا لِلسَّتْرِ، فَلَوْ لَبِسَتْ الْمَرْأَةُ سَرَاوِيلَ، أَوْ خُفًّا وَاسِعًا صُلْبًا، كَالْمُوقِ، وَتَدَلَّى فَوْقَهُ الْجِلْبَابُ، بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ حَجْمُ الْقَدَمِ؛ لَكَانَ هَذَا مُحَصِّلًا لِلْمَقْصُودِ، بِخِلَافِ الْخُفِّ اللَّيِّنِ الَّذِي يُبْدِي حَجْمَ الْقَدَمِ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ لِبَاسِ الرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَوْ لَبِسَتْ جُبَّةً وَفَرْوَةً لِحَاجَتِهَا إلَى ذَلِكَ إلَى دَفْعِ الْبَرْدِ، لَمْ تَنْهَ عَنْ ذَلِكَ. فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَمْ يَكُنْ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْفِرَاءَ؟! قُلْنَا: فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْحَاجَةِ؛ فَالْبِلَادُ الْبَارِدَةُ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى غِلَظِ الْكُسْوَةِ، وَكَوْنِهَا مُدَفِّئَةً، وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَى ذَلِكَ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، فَالْفَارِقُ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَعُودُ إلَى مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ، وَهُوَ مَا يُنَاسِبُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرِّجَالُ، وَمَا تُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ. فَالنِّسَاءُ مَأْمُورَاتٌ بِالِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ، دُونَ التَّبَرُّجِ وَالظُّهُورِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَشْرَعْ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْأَذَانِ، وَلَا التَّلْبِيَةِ، وَلَا الصُّعُودُ إلَى الصَّفَا والمروة، وَلَا التَّجَرُّدُ فِي الْإِحْرَامِ كما يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ ... فَلَوْ أَرَادَ الرِّجَالُ أَنْ يَنْتَقِبُوا، وَيَتَبَرْقَعُوا، وَيَدَعُوا النِّسَاءَ بَادِيَاتِ الْوُجُوهِ لَمُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ. وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ ... [النِّسَاءُ] مَأْمُورَاتٌ فِي هَذَا بِمَا يَسْتُرُهُنَّ وَيَحْجُبُهُنَّ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَ لِبَاسُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَمَّا كَانَ أَقْرَبَ إلَى
(1/258)
مَقْصُودِ الِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ: كَانَ لِلنِّسَاءِ، وَكَانَ ضِدُّهُ لِلرِّجَالِ. وَأَصْلُ هَذَا: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الشَّارِعَ لَهُ مَقْصُودَانِ: أَحَدُهُمَا: الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. والثَّانِي احْتِجَابُ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدَ الْفَرْقِ لَحَصَلَ ذَلِكَ بِأَيِّ وَجْهٍ حَصَلَ بِهِ الِاخْتِلَافُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فَسَادُ ذَلِكَ، بَلْ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِاللِّبَاسِ إظْهَارُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، لِيَتَرَتَّبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ مَا يُنَاسِبُهُ ... وَكَذَلِكَ أَيْضًا: لَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ حَجْبِ النِّسَاءِ وَسَتْرِهِنَّ دُونَ الْفَرْقِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ؛ بَلْ الْفَرْقُ أَيْضًا مَقْصُودٌ، حَتَّى لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الصِّنْفَيْنِ اشْتَرَكُوا فِيمَا يَسْتُرُ وَيَحْجُبُ، بِحَيْثُ يُشْتَبَهُ لِبَاسُ الصِّنْفَيْنِ لَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ هَذَا الْمَقْصُودَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (1)، فَجَعَلَ كَوْنَهُنَّ يُعْرَفْنَ بِاللِّبَاسِ الْفَارِقِ أَمْرًا مَقْصُودًا. وَلِهَذَا جَاءَتْ صِيغَةُ النَّهْيِ بِلَفْظِ التَّشَبُّهِ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» (2)، _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) أحمد، / 330، برقم 3060، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في لباس النساء، برقم 4097)، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء، برقم 2784، وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه، كاب النكاح، باب في المخنثين، برقم 1904، والطبراني، 11/ 204، برقم 11502، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2068.
(1/259)
وَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ والمترجلات مِنْ النِّسَاءِ» (1)، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِاسْمِ التَّشَبُّهِ، وَيَكُونُ كُلُّ صِنْفٍ يَتَّصِفُ بِصِفَةِ الْآخَرِ ... الْمُشَابَهَةَ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تُورِثُ تَنَاسُبًا وَتَشَابُهًا فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ ... وَالرَّجُلُ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ يَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِنَّ بِحَسَبِ تَشَبُّهِهِ، حَتَّى يُفْضِيَ الْأَمْرُ بِهِ إلَى التَّخَنُّثِ الْمَحْضِ، وَالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ ... وَالْمَرْأَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ تَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ، حَتَّى يَصِيرَ فِيهَا مِنْ التَّبَرُّجِ وَالْبُرُوزِ وَمُشَارَكَةِ الرِّجَالِ: مَا قَدْ يُفْضِي بِبَعْضِهِنَّ إلَى أَنْ تُظْهِرَ بَدَنَهَا كَمَا يُظْهِرُهُ الرَّجُلُ، وَتَطْلُبُ أَنْ تَعْلُوَ عَلَى الرِّجَالِ كَمَا تَعْلُو الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، وَتَفْعَلَ مِنْ الْأَفْعَالِ مَا يُنَافِي الْحَيَاءَ وَالْخَفْرَ (2) الْمَشْرُوعَ لِلنِّسَاءِ، وَهَذَا الْقَدْرُ قَدْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ. وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرْقٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَنْ يَكُونَ لِبَاسُ النِّسَاءِ فِيهِ مِنَ الِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ مَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَ ذَلِكَ: ظَهَرَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ، وَتَبَيَّنَ _________ (1) البخاري، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، برقم 5886. (2) الخَفَر - بالفتح-: الحياء ... أي الحياء من كل ما يُكْره لهنّ [النساء] أن ينظرْنَ إليه. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، (خفر)].
(1/260)
أَنَّ اللِّبَاسَ إذَا كَانَ غَالِبُهُ لُبْسَ الرِّجَالِ نُهِيَتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ، وَإِنْ كَانَ سَاتِرًا، كالفراجي الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ الْبِلَادِ أَنْ يَلْبَسَهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، وَالنَّهْيُ عَنْ مَثَلِ هَذَا بِتَغَيُّرِ الْعَادَاتِ. وَأَمَّا مَا كَانَ الْفَرْقُ عَائِدًا إلَى نَفْسِ السِّتْرِ، فَهَذَا يُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ بِمَا كَانَ أَسْتَرُ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي اللِّبَاسِ قِلَّةُ السَّتْرِ وَالْمُشَابَهَةُ، نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» (1). الشرط السابع: أن لا يُشبهَ لباس الكافرات للأدلة الآتية (2): 1 - قال اللَّه - عز وجل -: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّه شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّه وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} (3). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جعل اللَّه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - على شريعة من الأمر شرعها له، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته. و «أهواؤهم»: هي ما يَهْوَوْنه، وما عليه المشركون من هديه _________ (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 22/ 145 - 155 بتصرف واختصار. (2) ترجم الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 131لذلك بقوله: «باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره»، وعَنْوَنَ محقق كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ص/ 12 لأحد فصوله بقوله: «فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار، والنهي عن التَشبه بهم». (3) سورة الجاثية، الآيتان: 18 - 19.
(1/261)
الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل، وتوابع ذلك، فهم يَهْوَوْنه، وموافقتهم فيه: اتباع لما يَهْوَوْنه؛ ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، ويُسَرُّون به، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيمًا ليحصل ذلك، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أَحْسَمُ لمادة متابعتهم في أهوائهم، وأعون على حصول مرضاة اللَّه في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره؛ فإن «من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه»، وأيُّ الأمرين كان، حصل المقصود في الجملة، وإن كان الأول أظهر» (1). 2 - وقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (2). 3 - وقال تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (3). قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله -: فقوله: {وَلاَ يَكُونُوا} نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم _________ (1) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ص 14. (2) سورة الحشر، الآية: 19. (3) سورة الحديد، الآية: 16.
(1/262)
في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي» (1). وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: «ولهذا نهى اللَّه المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية» (2)، وغير ذلك من الآيات. 4 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (3). قال المناوي: «أي من تزيَّا في ظاهره بِزِيِّهم، وفي تخلقه بخلقهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم، أي: وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهرُ الباطنَ «فَإِنَّهُ مِنْهُمْ»، وقيل: المعنى، من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يُكرَم كما يُكرمون، ومن تشبه بالفساق يُهانُ ويُخذل كَـ (هُمْ) .. وبأبلغ من ذلك صرَّح القرطبي فقال: لو خُصَّ أهل الفسوق والمجون بلباس مُنع لُبسُهُ _________ (1) اقتضاء الصراط المستقيم، ص 43. (2) تفسير القرآن العظيم، 8/ 20. (3) أخرجه الإمام أحمد، 9/ 127، برقم 5115، وابن أبي شيبة، 4/ 212، برقم 19401، والبيهقي في شعب الإيمان، 2/ 417، والطبراني في مسند الشاميين، 1/ 135، برقم 216، وعبد بن حميد، برقم 848، وسنن سعيد بن منصور، 2/ 143، برقم 2370، والديلمي في مسند الفردوس، برقم 2099، وحسن إسناده الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص205.
(1/263)
لغيرهم، فقد يَظُنُّ به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء، فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه، وقال بعضهم: قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات، وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون عادات، في نحو: طعام، ولباس، ومسكن، ونكاح، واجتماع، وافتراق، وسفر، وإقامة، وركوب، وغيرها، وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة. وقد بعث اللَّه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بالحكمة التي هي سنته، وهي الشِّرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأَمر بمخالفتهم في الهَدْيِ الظاهر في هذا الحديث، وإن لم يظهر فيه مفسدة، لأمور: - منها: أن المشاركة في الهدي في الظاهر تؤثر تناسبًا وتشاكلًا بين المتشابهين تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس؛ فإن لابس ثياب العلماء - مثلًا - يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، ولابس ثياب الجند المقاتلة - مثلًا - يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع. - ومنها: أن المخالفة في الهَدْي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب، وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان. - ومنها: أن مشاركتهم في الهَدْيِ الظاهر توجب الاختلاط
(1/264)
الظاهر، حتى يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهديين المرضيين، وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه» (1). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «هذا الحديث أقل أحواله: أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم، كما في قوله: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (2)، وهو نظير ما سنذكره عن عبد اللَّه بن عمرو، أنه قال: «من بنى بأرض المشركين، وصنع نَيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة» (3). فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه؛ فإن كان كفرًا أو معصية، أو شعارًا للكفر أو المعصية: كان حكمه كذلك، وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونها تشبهًا. والتشبُّهُ: يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذًا _________ (1) فيض القدير، 6/ 104. وقد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ص 11 - 12 باختصار. (2) سورة المائدة، الآية: 51. (3) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 9/ 234, وصحَّح إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، 1/ 457 - 458.
(1/265)
عن ذلك الغير (1). فأما من فعل الشيء، واتفق أن الغير فعله أيضًا، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبهًا نظر، لكنْ قد يُنهى عن هذا، لئلا يكون ذريعة إلى التشبُّهِ، ولِمَا فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها، وإحفاء الشوارب، مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود» دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية» (2). وقال أيضاً بتفصيل أوضح: «مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان: أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم، فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم: - إما أن يُفعل لمجرد موافقتهم، وهو قليل. - وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل. - وإما لشبهة فيه تُخَيِّلُ أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة. وكل هذا لاشك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفراً بحسب الأدلة الشرعية. _________ (1) وهذا ينطبق على النساء اللواتي يتتبعنَ أحدث الأزياء الغربية، ويلبسْنَها ليقال عنهن: «متحضرات»، ويتابعن بيوت الأزياء الشهيرة في جميع فصول السنة ليوصفن بـ «المتحررات»، ولكنْ من كل التزام شرعي، وخلق إسلامي، «المتقدمات» ولكن إلى فساد الجيل، ثم إلى جهنم وبئس المصير. [حجاب المسلمة، ص: 247]. (2) اقتضاء الصراط المستقيم، ص 83.
(1/266)
- وإما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم، فهو نوعان: أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذًا عنهم، إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان، أو المكان، أو الفعل، ونحو ذلك، فهو غالبُ ما يُبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير، والميلاد، ونحوهما؛ فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك، وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك. فهذا يُعرَّفُ صاحبُه حُكمه، فإن لم ينتهِ وإلا صار من القسم الأول. النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذًا عنهم، لكنهم يفعلونه أيضًا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة، فتوقُّفُ كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم إذ ليس كوننا تشبَّهْنا بهم بأولى من كونهم تشبَّهوا بنا، فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر: فظاهر، لما تقدم من المخالفة. وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وتوجب عليهم مخالفتنا، كما في الزيّ ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب، كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين، والسجود، وقد تبلغ إلى الكراهة، كما في تأخير المغرب، والفطور، بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذًا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم لما قدمناه» (1). _________ (1) اقتضاء الصراط المستقيم، ص / 222 - 223. [حجاب المسلمة، ص: 249].
(1/267)
5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (1)، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا» (2). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلل النهي عن لُبسها بأنها «من ثياب الكفار»، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: «إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة» (3)؛ ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير، وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي، قال: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ: «إِلاَّ هَكَذَا»، وَرَفَعَ لَنَا _________ (1) المعصفر: نسبة إلى العُصْفُر: نبات سُلافَتُه الجِرْيالُ، وهي معربة والعُصْفُر هذا الذي يصبغ به الثياب. انظر: لسان العرب، (عصفر). (2) مسلم، كتاب اللباس، بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، برقم 2077. (3) علق الشيخ الألباني - رحمه الله - على هذا الحديث في جلباب المرأة المسلمة، ص 185: «لهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار، ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر - رضي الله عنه - ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة! إنه ليس من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير، وقال: «إلا هكذا»، ورفع لنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما».
(1/268)
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا» (1). 6 - وعن علي - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم ولَبوسَ الرهبان، فإنه من تزيَّا بهم أو تَشَبَّهَ فليس مني» (2). 7 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -، قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ، بِيضٌ لِحَاهُمْ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ»، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلْا يَأْتَزِرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ»، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ»، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ (3)، وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ (4)، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قُصُّوا سِبَالَكُمْ، وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ» (5). _________ (1) البخاري، كتاب اللباس، بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ، برقم 5829، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ، برقم 2069 واللفظ له. (2) رواه الطبراني في الأوسط، 4/ 178، برقم 3909، وضعفه الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 183، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 131، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 10/ 272: «أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به». (3) العثانين: جمع عُثنون، وهي اللحية. (4) السبال: جمع سَبَلة-بالتحريك-: الشارب. [بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 237]. (5) أخرجه أحمد، 36/ 613، والطبراني في الكبير، 8/ 216، برقم 7924، وأبو حاتم في العلل، برقم 1455، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 131: «رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا القاسم، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر»، وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح، 9/ 291، وصحح إسناده محققو المسند، 36/ 613، وحسّن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 186.
(1/269)
قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا: «والمعنى: أن اليهود كانوا يقصون لحاهم، ويتركون شواربهم، كما يفعله السواد الأعظم من الناس الآن في زمننا هذا، حتى بعض العلماء؛ فلا حول ولا قوة إلا باللَّه» (1). الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شُهرة للأدلة الآتية (2): 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا» (3). _________ (1) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 237. (2) ترجم الإمام أبو داود، 4/ 43 لذلك بقوله: «باب في لبس الشهرة»، وابن ماجه، 2/ 1192بقوله: «باب من لبس شهرة من الثياب»، وصاحب المنتقى، 2/ 110 مع نيل الأوطار بقوله: «باب الرخصة في اللباس الجميل، واستحباب التواضع فيه، وكراهة الشهرة والإسبال»، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 107 بقوله: «الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعًا واقتداءً بأشرف الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة»، والهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 135 بقوله: «باب في ثوب الشهرة»، والبنا الساعاتي في منحة المعبود، 1/ 352، وفي الفتح الرباني، 17/ 289 بقوله: «النهي عن الشهرة والإسبال، ووعيد من فعل ذلك». وانظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية، 2/ 179، و182. (3) أخرجه أحمد، 9/ 476، برقم 664، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم 4029، والنسائي في الكبرى، كتاب الزينة، ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره، برقم 9487، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، برقم 3608، واللفظ له، وعبد الرزاق، 11/ 80، برقم 19979، والبيهقي في الشعب، 5/ 168، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 125: «رجال إسناده ثقات»، وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 289: «وسنده صحيح»، وحسنه محققو المسند، 9/ 476، كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2089.
(1/270)
قال صاحب عون المعبود: «قال ابن الأثير: الشُهْرة: ظُهور الشَّيء [في شُنْعة حتى يَشْهَره الناس] (1)؛ والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس؛ لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعُجب والتكبر» (2). قال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم لُبسِ ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصًا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الناس من الفقراء، ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، قاله ابن رسلان. وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد، وإن لم يطابق الواقع» (3). وقال أيضًا في الدراري المضيَّة: «ويُلحق بالثوب غيرُه من الملبوس، ونحوه مما يُشْهَرُ به اللابس له، لوجود العلة» (4). _________ (1) النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (شهر). (2) انظر: نيل الأوطار، 2/ 113، وعون المعبود، 11/ 73. (3) نيل الأوطار (2/ 113). وقد نقل قول ابن رسلان أيضًا: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه: «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» (11/ 73 - 74). (3) 2) الدراري المضيَّة (2/ 182). [حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: 220] (4) 2/ 182، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 125: «رجال إسناده ثقات»، وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 289: «وسنده صحيح».
(1/271)
2 - وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ» (1). وعن كنانةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشهرتين: أن يلبسَ الثيابَ الحسنة التي يُنظر إليه فيها، أو الدنيَّة أو الرَّثَّة التي يُنظر إليه فيها» (2). قال علاء الدين بن عابدين: «وينبغي للرجل أن يكون موافقًا لأقرانه، فلا يلبس لباسًا مرتفعًا جدًّا، ولا رديئًا دونًا، فإنه لو فعل ذلك ارتكب النهي، وأوقع الناس في الغيبة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشهرتين في اللباس: المرتفعة جدًّا، والمحتقرة جدًّا، بأن لا يُزدرَى عند السفهاء، ولا يُعاب عند الفقهاء» (3). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ مِنَ الثِّيَابِ، وَهُوَ الْمُتَرَفِّعُ الْخَارِجُ عَنِ الْعَادَةِ، وَالْمُتَخَفِّضُ الْخَارِجُ عَنِ الْعَادَةِ؛ فَإِنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الشهرتين: الْمُتَرَفِّعَ، وَالْمُتَخَفِّضَ، وَفِي الْحَدِيثِ _________ (1) أخرجه ابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، برقم 3608، وأبو نعيم في الحلية، 4/ 190 - 191، والبيهقي في الشعب، 5/ 169، وعزاه ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح،8/ 255 أيضًا إلى الضياء، وحسن إسناده الكناني في مصباح الزجاجة، 4/ 90، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 217: «ومنه نعلم أن قول البوصيري في الزوائد "إسناده حسن". غير حسن، إلا إن كان يريد أنه حسن لغيره، فسائغ، ولعله لذلك أورده المقدسي في الأحاديث المختارة. واللَّه أعلم. (2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 273، وإسناده صحيح مرسلاً كما في جلباب المرأة المسلمة، ص 218. (3) الهدية العلائية، ص 295.
(1/272)
«مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ» (1)، وَخِيَارُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا، وَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ فِي الظَّاهِرِ يُثَابُ الْإِنْسَانُ عَلَى فِعْلِهِ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ، وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ مَعَ النِّيَّةِ الْفَاسِدَةِ، فَمَنْ حَجَّ مَاشِيًا لِقُوَّتِهِ عَلَى الْمَشْيِ، وَآثَرَ بِالنَّفَقَةِ، كَانَ مَأْجُورًا أَجْرَيْنِ: أَجْرَ الْمَشْيِ، وَأَجْرَ الْإِيثَارِ، وَمَنْ حَجَّ مَاشِيًا بُخْلًا بِالْمَالِ، إضْرَارًا بِنَفْسِهِ، كَانَ آثِمًا إثْمَيْنِ: إثْمَ الْبُخْلِ، وَإِثْمَ الْإِضْرَارِ، وَمَنْ حَجَّ رَاكِبًا؛ لِضَعْفِهِ عَنِ الْمَشْيِ؛ وَلِلِاسْتِعَانَةِ بِذَلِكَ عَلَى رَاحَتِهِ لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ عَلَى الْعِبَادَةِ، كَانَ مَأْجُورًا أَجْرَيْنِ، وَمَنْ حَجَّ رَاكِبًا يَظْلِمُ الْجَمَّالَ وَالْحَمَّالَ، كَانَ آثِمًا إثْمَيْنِ. وَكَذَلِكَ اللِّبَاسُ: فَمَنْ تَرَكَ جَمِيلَ الثِّيَابِ، بُخْلًا بِالْمَالِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهُ مُتَعَبِّدًا بِتَحْرِيمِ الْمُبَاحَاتِ، كَانَ آثِمًا، وَمَنْ لَبِسَ جَمِيلَ الثِّيَابِ إظْهَارًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ، وَاسْتِعَانَةً عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، كَانَ مَأْجُورًا، وَمَنْ لَبِسَهُ فَخْرًا وَخُيَلَاءَ، كَانَ آثِمًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» (2). 3 - عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ _________ (1) أخرجه أحمد، 9/ 476، برقم 5664، والنسائي فى الكبرى، 5/ 460، برقم 9560، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس ثوب شهرة من الثياب، برقم 3606، واللفظ له، والبيهقي في شعب الإيمان، 5/ 168، وأبو يعلى، 10/ 62، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم 2906، وقال محققو المسند، 9/ 476: «حديث حسن» .. (2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 22/ 138 - 139.
(1/273)
الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» (1). 4 - وعن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟»، قَالَ: قَدْ أَتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: «فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ» (2). قال ملا علي القاري: «والمعنى: البَسْ ثوبًا جيدًا ليعرفَ الناس أنك غنيّ، وأن اللَّه أنعم عليك بأنواع النعم». وفي شرح السنة هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة، ومظاهرة الملبس على اللبس، على ما هو عادة العجم. قلت: اليوم زاد العرب على العجم، وقد قيل: مَن رقَّ ثوبه رقَّ دينه. قال البغوي: ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه» (3). _________ (1) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، برقم 91. (2) أخرجه أحمد، 28/ 467، برقم 17231، وأبو داود، كتاب اللباس، باب فِي الْمَصْبُوغِ بِالصُّفْرَةِ، برقم 4065، واللفظ له، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، برقم 2006، والنسائي، كتاب الزينة، الجلاجل، برقم 5223، والحاكم، 4/ 181، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وأقره الذهبي في التلخيص، وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ص 63، برقم 75، وقال محققو المسند، 28/ 467: «إسناده صحيح على شرط مسلم» .. (3) مرقاة المفاتيح، 8/ 257، وحديث النهي عن كثرة الإرفاه أخرجه أحمد، 39/ 389، برقم 23969، وأبو داود، برقم 4162، والنسائي، برقم 5058، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 502، وقال محققو المسند، 39/ 389: «إسناده صحيح»، وقال الإمام الخطابي في معالم السنن، 3/ 57: «معنى الإرفاه: الاستكثار من الزينة، وأن لا يزال يهيئ نفسه، وأصله من الرفه».
(1/274)
والنهي عن ثياب الشهرة يشمل الرجال والنساء على حدٍّ سواء لعموم النصوص الواردة في ذلك، ويدخل في هذا: الخروج عن عادة بلده وعشيرته في اللباس، إلا إذا كانت أزياؤهم مخالفة للشريعة الإسلامية، كأن تكون ضيقة تصف العورة، أو مختصة بالكفار، بحيث يعرفون بها، ويشتهرون فيها، فيجب حينئذٍ مخالفتهم فيها. قال الشيخ محمد السَّفَّاريني الحنبلي - رحمه الله -: «وفي الغُنية: من اللباس المُنَزَّهِ عنه: كلُّ لبسة يكون بها مشتهرًا بين الناس، كالخروج عن عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئلا يُشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك سببًا لحملهم على غِيبته، فيشركهم في إثم الغيبة له. انتهى ... » (1). الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية (2): 1 - عن عِمْرَانَ بنِ حِطَّان «أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ» (3). _________ (1) غذاء الألباب، 2/ 158 - 159، وهناك نصوص كثيرة نحو هذا ... (2) ترجم أبو داود، 4/ 72 لذلك بقوله: «باب في الصليب في الثوب»، وابن أبي شيبة، 8/ 196 بقوله: «في لبس الثوب فيه الصليب»، والبنا الساعاتي في بلوغ الأماني، 17/ 282 بقوله: «باب ما جاء في الصور والتصاليب تكون في البيت، وفي الستور والثياب والبسط، ونحو ذلك». (3) البخاري، كتاب اللباس، باب نقض الصور، برقم 5807.
(1/275)
قال الحافظ ابن حجر: «قَوله: (إِلاَّ نَقَضَهُ)، كَذا لِلأَكثَرِ، ووقَعَ فِي رِوايَة أَبان إِلاَّ قَضَبَهُ، بِتَقدِيمِ القاف ثُمَّ المُعجَمَة ثُمَّ المُوحَّدَة، وكَذا وقَعَ فِي رِوايَة عِند ابن أَبِي شَيبَة، عَن يَزِيد بن هارُون، عَن هِشام، ورَجَّحَها بَعض شُرّاح المَصابِيح، وعَكَسَهُ الطِّيبِيُّ فَقالَ: رِوايَة البُخارِيّ أَضبَط، والاعتِماد عَلَيهِم أَولَى. قُلت: ويَتَرَجَّح مِن حَيثُ المَعنَى أَنَّ النَّقض يُزِيل الصُّورَة مَعَ بَقاء الثَّوب عَلَى حاله، و (القَضْب): وهُو القَطع يُزِيل صُورَة الثَّوب» (1). وقال القسطلاني: «(نَقَضَه): أي كسرَهُ وغيَّرَ صورته» (2). 2 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ» (3). قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرحه لهذا الحديث: « ... أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يترك في بيته شيئًا» يشمل الملبوس، والستور، والبُسُط، والآلات. «فيه تصليب» أي صورة الصليب التي _________ (1) فتح الباري، 10/ 385. (2) إرشاد الساري، 8/ 481. (3) أخرجه أحمد، 43/ 136، برقم 25996، وأبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في الصليب في الثوب، برقم 4153، وسنن النسائي الكبرى، كتاب الزينة، التصاوير، برقم 9706، وطبقات ابن سعد، 1/ 386، ومسند أبي يعلى، 8/ 104، والبيهقي في شعب الإيمان، 8/ 329. وصححه الألباني في صحيح غاية المرام، ص 142، وقال محققو المسند، 43/ 136: «إسناده صحيح».
(1/276)
للنصارى من نقش في ثوب، أو غيره. «إلا قَضَبه»، ولفظ البخاري: «إلا نَقَضَه» أي قطعه وكسره، وغيَّرَ صورة الصليب. والصليب وإن لم يكن على صورة ذي حياة، لكنْ يُمحَى لما يعبده النصارى» (1). 3 - وعن دِقْرَةِ (2) أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: «اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ» (3). 4 - وعَنْ دِقْرَةَ (4) أُمِّ عَبْدِ اللَّه (5) بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ فَأَتَاهَا بَعْضُ أَهْلِهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ قَدْ عَرَقْتِ فَغَيِّرِي ثِيَابَكِ، فَوَضَعَتْ ثَوْبًا كَانَ عَلَيْهَا، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِا بُرْدًا عَلَيَّ مُصَلَّبًا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَآهُ فِي ثَوْبٍ قَضَبَهُ، قَالَتْ: فَلَمْ تَلْبَسْهُ» (6). _________ (1) بذل المجهود، 17/ 32. (2) دِقْرة - بكسر الدال المهملة، وسكون القاف - كما في الإكمال لابن ماكولا. (3) أخرجه أحمد، 42/ 16، برقم 25091، وسنن النسائي الكبرى، كتاب الزينة، التصاوير، برقم 9707، وجود إسناده الشيخ البنا في بلوغ الأماني، 17/ 285، وحسّن إسناده محققو المسند، 42/ 16. (4) يقول محققو المسند إنها في إحدى نسخ المخطوط (أم زفرة)، وهو خطأ. (5) الصحيح أنها أم عبد الرحمن، كما في الحديث السابق، وقد أشار محققو المسند إلى هذا الخطأ من النساخ، المسند، 43/ 13. (6) أخرجه أحمد، 43/ 13، برقم 25810. وبنحوه في شعب الإيمان للبيهقي، 5/ 142. وحسن إسناده محققو المسند، 43/ 13.
(1/277)
5 - وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -،قَالَتْ: «إِنَّا لاَ نَلْبَسُ الثِّيَابَ الَّتِي فِيهَا الصَّلِيبُ» (1). 6 - وعَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ تَابُوتٍ لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ؟ فَقَالَ: «حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ يُحَرِّقُ ثَوْبًا فِيهِ صَلِيبٌ، يَنْزِعُ الصَّلِيبَ مِنْهُ» (2). ففي هذا الأثر دليل على عدم جواز لبس ثوب فيه صليب، وإلّا ما أقْدمَ عمر - رضي الله عنه - على إحراقه. 7 - وعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سِتْرًا فِيهِ صَلِيبٌ، فَأَمَرَ بِهِ فقضب (3)» (4). ففي الأحاديث والآثار المتقدمة دلالة واضحة على النهي عن لبس ثوب فيه صورة صليب، لما فيه من مضاهاة النصارى الذين اتخذوه شعارًا لعقيدتهم الباطلة، وشريعتهم المحرفة، وأشركوا بعبادتهم له مع اللَّه إلهًا آخر. قال ابن قدامة: «ويكره الصليب في ثوب؛ لأن عمران بن حِطَّان روى عن عائشة: «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضَبَه». رواه أبو داود» (5). وقال ابن مفلح المقدسي: «يُكره الصليب في الثوب، ونحوه، _________ (1) مصنف ابن أبي شيبة، 8/ 196. (2) مصنف ابن أبي شيبة، 8/ 196. (3) في طبعة مكتبة الرشد: (فقصت)، وفي طبعة عوامة كما أثبت، وهو الأصح على ما يبدو. (4) مصنف ابن أبي شيبة، 8/ 197. (5) المغني، 1/ 590، والحديث في سنن أبي داود، برقم 4153، وتقدم تخريجه.
(1/278)
قال ابن حمدان: ويحتمل التحريم .. قال إبراهيم: أصاب أصحابُنا خمائص (1) فيها صُلُب، فجعلوا يضربونها بالسُّلوك (2)، يمحونها بذلك» (3). والمعنى: أنهم كانوا إذا أصابوا أكسية نُقش عليها الصلبان، خاطوا عليها بالخيوط ليطمسوها، لئلا تبقى على حالتها، وهذا دليل على أنهم كانوا يرونها غير جائزة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والكراهية في كلام السلف كثيرًا، وغالبًا يُراد بها التحريم» (4). الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية (5): 1 - عن أَبي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ _________ (1) خمائص: جمع خميصة، وهي: كساء أسود معلم الطرفين، ويكون من خز، أو صوف. انظر: المصباح المنير، مادة (خمص). (2) سلوك: واحدها: سِلكة - بالكسر-: الخيط يُخاط به، جمع: سِلك، وجمع الجمع: أسلاك، وسلوك. انظر: القاموس المحيط، مادة (سلك). (3) الآداب الشرعية والمنح المرعية، 3/ 512. (4) مجموع فتاوى ابن تيمية، 32/ 241. (5) ترجم الإمام البخاري، 10/ 385، لذلك بقوله: باب نقض الصور، 4/ 158، والدارمي، 2/ 284 بقوله: «باب في النهي عن التصاوير»، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، 4/ 41 بقوله: «الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها»، والذهبي في الكبائر، ص 181، وقال: «الكبيرة الثامنة والأربعون: التصوير في الثياب، والحيطان، والحجر، والدراهم، وسائر الأشياء، والأمر بإتلافها»، والبنا الساعاتي في منحة المعبود، 1/ 358 بقوله: «باب النهي عن التصوير، واتخاذ الصور، والتشديد في ذلك».
(1/279)
بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» (1). 2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ» (2). قال الخطابي: «والصورة التي لا تدخل الملائكةُ البيتَ الذي هي فيه: ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي يكون فيها الروح مما لم يقطع رأسه، أو لم يمتهن» (3). 3 - وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رحمه الله - قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي، عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ _________ (1) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، برقم 3322، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ... ، برقم 2106. (2) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إِذَا قال آمين، برقم 3325، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ... ، برقم 2106 بلفظ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل»، وفي لفظ آخر: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» [مسلم، كتاب اللباس والزينة، بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ... ، برقم 2112. (3) فتح الباري، 10/ 382.
(1/280)
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَتَكَهُ، وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»، قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ» (1). 4 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً (2) فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»، وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا _________ (1) البخاري، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، برقم 5954، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ... ، برقم 2107. قال الحافظ ابن حجر: «القرام - بكسر القاف، وتخفيف الراء -: هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون، يُفرش في الهودج أو يُغطى به. على سهوة - بفتح المهملة، وسكون الهاء -. وقد نقل ابن حجر في معناها أقوالًا عديدة، ثم اختار المعنى المناسب لها في هذا الحديث فقال: فتعين أن السهوة بيت صغير عُلقت الستر على بابه». فتح الباري، 10/ 387. (2) نمرقة - أي بضم النون والراء، ضبطه ابن السِّكّيت هكذا، وضبطها أيضًا: بكسر النون والراء، وبغير هاء-، وجمعها: نمارق، وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراء، وقال عياض وغيره: هي وسادة، وقيل: مِرفقة، وقيل: هي المجالس، ولعله يعني الطنافس. وفي المُحْكم: النمرق والنمرقة، قد قيل: هي التي يلبسها الرجل، وفي الجامع: النمرق تجعل تحت الرحل، وفي الصحاح: النمرقة: وسادة صغيرة، وربما سَمَّوا الطنفسة التي تحت الرحل: نمرقة». عمدة القاري، 11/ 224.
(1/281)
تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ» (1). وقد ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث في كتاب البيوع فقال: «باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء»، وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: «والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء، فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية» (2). قال النووي - رحمه الله -: «أما اتخاذ المصوَّر فيه صورةَ حيوان، فإن كان معلقًا على حائط، أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامة، ونحو ذلك، مما لا يُعَدُّ ممتهنًا فهو حرام، وإن كان في بساط يُداس، ومخدّة، ووسادة، ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل، وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء: من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته _________ (1) البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، برقم 2105، واللفظ له، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ... ، برقم 2107. (2) فتح الباري، 4/ 325.
(1/282)
ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقمًا في ثوب، أو غير رقم، وسواء كانت في حائط، أو ثوب، أو بساط ممتهن، أو غير ممتهن، عملًا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النُّمْرُقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواء امتُهن أم لا، وسواء عُلِّقَ أم لا، وكرهوا ما كان له ظل، أو كان مُصَوَّرًا في الحيطان وشبهها، سواء كان رقمًا أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: «إلا ما كان رقمًا في ثوب»، وهذا مذهب القاسم بن محمد. وأجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما ورد في اللَّعِبِ بالبنات (1)، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادَّعى بعضهم أن إباحة اللَّعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، والله أعلم» (2). وقد تعقَّبَ الحافظُ ابن حجر الإمامَ النووي في بعض ما ساقه، قال: «وفيما نقله مؤاخذات: - منها: أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها _________ (1) أي: الدمى، مفردها: دمية، ويقصد بها هنا ما يُتخذ على صورة البنات. (2) شرح صحيح مسلم للنووي، 14/ 81 - 82.
(1/283)
ظل حَرُمَ بالإجماع، سواء كانت مما يمتهن أم لا، وهذا الإجماع محله في غير لُعَبِ البنات، وصحَّحَ ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حَرُمَت، سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها أوفرقت هيئتها جاز، وهذا المذهب منقول عن الزهري، وقوَّاه النووي، وقد يشهد له حديث النُّمْرُقة. - ومنها: أن إمام الحرمين نقل وجهًا أن الذي يُرَخَّصُ فيه مما لا ظل له، ما كان على ستر، أو وسادة؛ وأما ما على الجدار والسقف فيُمنع. - ومنها: أن مذهب الحنابلة جوازُ الصورة في الثوب، ولو كان معلقًا على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن سُترَ به الجدار منع عندهم. - ومنها: قول النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقًا، وهو مذهب باطل ... قلت: المذهب المذكور نَقَله ابن أبي شيبة، عن القاسم بن محمد بسند صحيح، ففي إطلاق كونه مذهبًا باطلًا نظر، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله: «إلا رقمًا في ثوب»؛ فإنه أعمُّ من أن يكون معلقًا، أو مفروشًا، وكأنه جعل إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورًا، ومن كونه ساترًا للجدار ...
(1/284)
ثم قال الحافظ: لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رُخِّصَ فيه من ذلك ما يُمتهن، لا ما كان منصوبًا، وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن عكرمة، قال: «كانوا يقولون في التصاوير في البسُط والوسائد التي توطأ ذُلٌ لها»، ومن طريق عاصم، عن عكرمة، قال: «كانوا يكرهون ما نُصِبَ من التماثيل نصبًا، ولا يَرون بأسًا بما وطئته الأقدام» (1). قال ابن قدامة: «فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات، فقال ابن عقيل: يكره لبسها وليس بمحرَّم، وقال أبو الخطاب: هو محرم، لأن أبا طلحة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة»، متفق عليه (2). وحجة من لم يَرَهُ مُحرَّمًا: أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال في آخره: «إلا رقمًا في ثوب» متفق عليه» (3). وقال ابن مفلح الحنبلي: «ولا يجوز لُبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين» اختاره أبو الخطاب، وجزم به السامري، وصاحب التلخيص، لما روى أبو طلحة، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، أو صورة» متفق عليه. _________ (1) فتح الباري، 10/ 388 باختصار. (2) البخاري، برقم 3322، ومسلم، برقم 2106، وتقدم تخريجه. (3) المغني، 1/ 590، والحديث أخرجه البخاري، برقم 3322، ومسلم، برقم 2106، وتقدم تخريجه.
(1/285)
والمراد به كلب منهي عن اقتنائه، وقال أحمد في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسها، وكتعليقِهِ وستر الجدار به وِفَاقًا، وظاهره عام في الكل. والثاني: يُكره ولا يحرم، قاله: ابن عقيل، وقدَّمه ابن تميم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الخبر: «إلا رقمًا في ثوب»، وكافتراشه، وجعله مِخَدًا، لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتكأ على مخدة فيها صورة. رواه أحمد (1). وعُلم مما سبق أنه يحرم تصوير الحيوان، وحكاه بعضهم وفاقًا، لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» رواه البخاري (2). فلو أُزيل منها ما لا تبقى الحياة معه لم يكره في المنصوص، ومثله شجر ونحوه» (3). وقال البهوتي - فقيه الحنابلة في وقته -: «يحرم على ذكر وأنثى لُبس ما فيه صورة حيوان» لحديث أبي طلحة قال: سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، أو كلب» متفق عليه. _________ (1) لم أجد هذا اللفظ، وفي مسند أحمد، 10/ 404، برقم 6326: «حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْشٍ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُكْرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ»، وضعفه محققو المسند. (2) البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}، برقم 7558. (3) المبدع في شرح المقنع، 1/ 377 - 378.
(1/286)
«وتعليقُه»: أي ما فيه صورة، «وسترُ الجدار به» لما تقدم. «وتصويرُه كبيرة» للوعيد عليه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». «حتى في ستر، وسقف، وحائط، وسرير، ونحوها» لعموم ما سبق. «لا افتراشه وجعله» أي المصوَّر، «مِخَدًا» فيجوز «بلا كراهة». قال في الفروع: «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتكأ على مِخَدَّةٍ فيها صور». رواه أحمد، وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة» (1). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا الحرير، ولا المكان المغصوب، هذا إذا كانت الصلاة فرضًا، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وإن كانت نفلًا، فقال الآمدي: لاتصح، روايةً واحدة. وينبغي أن يكون الذي يجرُّ ثوبه خيلاءً في الصلاة على هذا الخلاف؛ لأن المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير» (2). وقال الشوكاني في شرحه للحديث السابق: «فيه الإذن بتصوير الشجر، وكل ما ليس له نفس، وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات. _________ (1) كشاف القناع، 1/ 325، ونحو مختصراً في الإقناع. (2) الاختيارات الفقهية، ص 41 باختصار.
(1/287)
قال في البحر: ولا يكره تصوير الشجر، ونحوها من الجماد إجماعًا» (1). وإذا جاز تصوير ما لا روح له، جاز لُبسُ الثوب الذي رُقمت عليه تلك الصورة التي لا روح فيها بالأَوْلى، لكن محل ذلك الثياب التي تبدو بها المرأة أمام زوجها، ومحارمها، والنساء، لا الجلباب الذي تستتر به فوق ثيابها، وتخرج به من منزلها، فهذا لا يحل لها، لأنه من الزينة المنهي عن إبدائها. وأما حديث أبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ»، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ، عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟! فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» (2). وحديث عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا، فَنَزَعَ نَمَطًا (3) مِنْ تَحْتِهِ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ _________ (1) نيل الأوطار، 2/ 105. (2) البخاري، كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، برقم 5958، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ... ، برقم 2106. (3) النَّمَط: - بفتحتين -، قال النووي في شرح صحيح مسلم، 14/ 86: «المراد بالنمط هنا: بساط لطيف له خَمَل».
(1/288)
تَنْزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ سَهْلٌ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي» (1). فقد تمسَّكَ المجيزون بهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا رقمًا في ثوب» فاحتجوا به على جواز ما له روح وما لا روح له. ولا حجة لهم في هذين الحديثين وغيرهما على ما ذهبوا إليه، لأن الرَّقْمَ المذكور محمول على ما كان لغير ذي روح جمعًا بين الأدلة. قال النووي - رحمه الله -: «إلا رقمًا في ثوب»: هذا يحتج به مَن يقول بإباحة ما كان رَقْمًا مطلقًا، وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رَقْمٍ على صورةِ الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قَدَّمْنا أنَّ هذا جائز عندنا» (2). ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي مفاد هذا الكلام، ثم أضاف فائدة أخرى فقال: «ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن» (3). _________ (1) أخرجه مالك، 5/ 1406، واللفظ له، وأحمد، 25/ 353، برقم 15979، والنسائي، كتاب الزينة، والتصاوير، برقم 5349، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الصورة، برقم 1750، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن حبان، 13/ 162، والبيهقي، 7/ 271، والطبراني في الكبير، 5/ 104، برقم 4731، وصححه لغيره محققو المسند، 25/ 353، وصححه الألباني في غاية المرام، ص 134. (2) شرح صحيح مسلم للنووي، 14/ 85 - 86. (3) فتح الباري، 10/ 391.
(1/289)
وعن مجاهد قال: حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «أتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ (1) سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ». فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ» (2). قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول المكان: التي تكون فيه باقيةً على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة، لكنها غُيِّرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها، أو بقطع رأسها فلا امتناع (3). _________ (1) قال الفَتَّنيّ: «قِرامُ ستر: هو ستر رقيق، وقيل: صفيق من صوف ذي ألوان، وإضافته: كثوبِ قميص، وقيل: القرام: ستر رقيق وراء الستر الغليظ، ولذا أضافه». اهـ مجمع بحار الأنوار، 4/ 257. (2) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في الصور، برقم 4160، واللفظ له، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، برقم 2806، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن حبان، 13/ 165، برقم 5854، والبيهقي، 7/ 270، وقال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان، 13/ 165: «إسناده صحيح على شرط مسلم»، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 3105. قال أبو داود: والنَّضَدُ: شيء توضع عليه الثياب، شبه السرير. (3) فتح الباري، 10/ 392.
(1/290)
5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «ادْخُلْ». فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُوسُهَا، أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ» (1). قال الخطابي: «وفيه دليل على أنَّ الصورة إذا غُيِّرَت بأن يُقطعَ رأسها، أو تُحَلَّ أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت، لم يكن بها بعد ذلك بأس» (2). لهذا كله اعتبر الحافظ الذهبي أن عموم أحاديث النهي عن الصور يشمل كذلك ما كانت منقوشة في سقف، أو جدار، أو منسوجة في ثوب أو مكان، قال - رحمه الله -: «وأما الصور: فهي كل مصوَّر من ذوات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص منتصبة، أو كانت منقوشة في سقف أو جدار، أو موضوعة في نَمَط، أو منسوجة في ثوب أو مكان، فإن قضية العموم تأتي عليه فليُجتَنب، وباللَّه التوفيق» (3). وقال ابن العربي: «حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت _________ (1) النسائي، كتاب الزينة، ذكر أشد الناس عذاباً، برقم 5365، وفي السنن الكبرى له أيضاً، كتاب الزينة، التصاوير، برقم 9708، وشرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 287، وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف، 108 - 109، وفي غاية المرام، ص 111. (2) معالم السنن، 6/ 82. (3) الكبائر، ص 182، طبعة دار الكتاب العربي، عام 1400هـ- 1980م.
(1/291)
ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله: «إلا رقمًا في ثوب». الثاني: المنع مطلقًا حتى الرَّقْم (1). الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل، حَرُم، وإن قطعت الرأس، أو تفرقت الأجزاء، جاز، قال: وهذا هو الأصح (2). الرابع (3): إن كان مما يُمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز» (4). وبهذا الاستعراض السابق لأقوال أهل العلم، نخلُصُ إلى حرمة اتخاذ ما فيه صورة ذي روح، سواء كان ثوبًا، أو سترًا، أو نحوه، فإن كانت الصورة مقطوعة الرأس، أو مفرقة الأجزاء، أو ممتهنة، بأن كانت في بساط يُوطأ، أو مخدة يُجلس عليها، ونحوها مما يمتهن، _________ (1) لإطلاق الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ ما فيه صورة. (2) لكثرة أدلته الصحيحة، ولجمْعِهِ بينها، ولكونه مذهب الجمهور. ومما يدل عليه: - ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قدم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هتكه، وقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللَّه، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين»، وقد تقدم تخريجه. وفي رواية أخرى للبخاري، برقم 2479: «فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا». - وجاء أيضًا في سنن النسائي: « .. فإما أن تُقطع رؤوسها، أو تجعل بساطًا يوطأ .. »، وتقدم آنفًا مع تخريجه. (3) ويمكن إدراجه تحت القول الثالث؛ لدلالة حديث النسائي السابق عليهما. (4) فتح الباري، 10/ 391.
(1/292)
فليس ذلك بحرام. قال النووي: «هذا تلخيص مذهبنا - يعني الشافعية - في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم» (1). وهو مذهب الحنابلة - أيضًا - في الصحيح عندهم، كما سبق بيانه. أما إذا كانت الصورة لغير ذي روح، كالأشجار، والأنهار، والأبنية، والبحار، ونحوها، فإن تصويرها، واتخاذ ما صُوِّرت فيه من ثوب، وغيره جائز بالاتفاق. لكنَّ محل جواز صورة ما لا روح له في ثوب المرأة مقيَّدٌ بما إذا لم يكن جلبابها الذي تخرج به، فإن كانت الصورة فيه لم يجز لها الخروج به؛ لكونه من الزينة المنهي عن إبدائها لغير زوج، أو محرم، أو امرأة. وهنا ينتهي القول في الشروط الواجب توافرها في الحجاب، ليكون حجابًا إسلاميًا يرضى اللَّه - عز وجل - عنه، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم (2). _________ (1) شرح صحيح مسلم للنووي، 14/ 81 - 82. (2) انظر: حجاب المسلمة للبرازي، ص 141 - 372، وعودة الحجاب للمقدم، 3/ 145 - 160 بتصرف.
(1/293)
المبحث الثاني: التبرج
المطلب الأول: تعريف التبرج لغة وشرعاً
أولاً: التبرج لغة: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، يقال: تبرجت المرأة: إذا أظهرت وجهها، ومحاسن جيدها ووجهها، وقال أبو إسحاق في قوله - عز وجل -: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينةٍ} (1): التبرج: إظهار الزينة، وما يستدعى به شهوة الرجل، وقيل: إنهن كن يتكسرن في مشيهن، ويتبخترن، والتبرج: إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا (2). وقال العلامة الفيومي - رحمه الله -: «تبرَّجت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب» (3). وقال الإمام ابن الأثير - رحمه الله -: «التبرج إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا ... » (4). ثانياً: التبرج اصطلاحاً: قيل: تعمّد المرأة إظهار زينتها للرجال، ومنه قول اللَّه - عز وجل -: {غير متبرجات بزينة}» (5). _________ (1) سورة النور، الآية: 60. (2) لسان العرب لاين منظور، مادة (برج)، 2/ 212. (3) المصباح المنير، مادة (برج)، 1/ 42. (4) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الباء مع الراء، 1/ 113. (5) عودة الحجاب للمقدم، 3/ 125.
(1/294)
وقيل: التبرج: هو كل زينة أو تجمّل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الرجال الأجانب (1). وقيل: التبرج هو إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها (2). وقيل: التبرج هو التبختر والتكسر في المشية (3). وقيل: التبرج أن تبدي المرأة محاسنها، وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل» (4). والتعريف الجامع أن يقال: التبرج هو: تعمُّد إظهار المرأة زينتها، ومحاسنها، وتبخترها، وتكسرها للرجال الأجانب، واللَّه تعالى أعلم. _________ (1) انظر: عودة الحجاب للمقدم، 3/ 125. (2) انظر: عودة الحجاب، 3/ 125، وتفسير الطبري، 22/ 4. (3) انظر: المرجع السابق، 3/ 125، وتفسير الطبري، 22/ 4. (4) انظر: معجم لغة الفقهاء للرواس، ص 99، وفتح القدير للشوكاني، 4/ 278، وانظر: حجاب المسلمة، ص 275.
(1/295)
المطلب الثاني: المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته
لا شك أن المطالب المنحرفة الداعية إلى التبرج، والسفور، والفساد تنحصر في أمرين: الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين: الحرية والمساواة، وآثارهما التدميرية في العالم الإسلامي. ليُعلم أن النداء بتحرير المرأة تحت هاتين النظريتين: حرية المرأة، ومساواة المرأة بالرجل، إنما ولدتا على أرض أوربة النصرانية في فرنسا، التي كانت ترى أن المرأة مصدر المعاصي، ومكمن السيئات والفجور، فهي جنس نجس يجتنب، ويحبط الأعمال، حتى ولو كانت أُمَّاً أو أختاً. هكذا نشر رهبان النصارى في أوربا هذا الموقف المعادي المتوتر من المرأة، بينما كانوا - أي أولاء الرهبان- مكمن القذارة في الجسد والروح، ومجمع الجرائم الأخلاقية، ورجال الاختطاف للأطفال، لتربيتهم في الكنائس، وإخراجهم رهباناً حاقدين، حتى تكاثر عدد الرهبان، وكوَّنوا جمعاً مهولاً أمام الحكومات والرعايا. ومن هذه المواقف الكهنوتية الغالية الجافية، صار الناس في توتر وكبت شديدين، حتى تولدت من ردود الفعل لديهم، هاتان النظريتان: المناداة بتحرير المرأة باسم: حرية المرأة، وباسم: المساواة بين المرأة والرجل، وشعارهما: رفض كل شيءٍ له صلة
(1/296)
بالكنيسة، وبرجال الدين الكنسي، وتضاعفت ردود الفعل، ونادوا بأن الدين والعلم لا يتفقان، وأن العقل والدين نقيضان، وبالغوا في النداءات للحرية المتطرفة الرامية إلى الإباحية والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو ديني يَمس الحرية، حتى طغت هذه المناداة بحرية المرأة، إلى المناداة بمساواتها بالرجل بإلغاء جميع الفوارق بينهما وتحطيمها، دينية كانت أم اجتماعية، فكل رجل، وكل امرأة، حرٌّ يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، لا سلطان عليه لدين، ولا أدب، ولا خلق، ولا سلطة، حتى وصلت أوربة ومن ورائها الأمريكتان وغيرهما من بلاد الكفر إلى هذه الإباحية، والتهتك، والإخلال بناموس الحياة، وصاروا مصدر الوباء الأخلاقي للعالم. إن المطالبات المنحرفة لتحرير المرأة بهذا المفهوم الإلحادي تحت هاتين النظريتين المولدتين في الغرب الكافر، هي العدوى التي نقلها المستغربون إلى العالم الإسلامي، فماذا عن تاريخ هذه البداية المشؤومة، التي قلَبَت جُلَّ العالم الإسلامي من جماعة مسلمة يُحجِّبون نساءهم، ويحمونهن، ويقومون على شؤونهن، ويقمن هنَّ بما افترضه للَّه عليهن، إلى هذه الحال البائسة من التبرج والانحلال والإباحية؟! تقدّم غير مرة أن نساء المؤمنين كن محجبات، غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات الأبدان، ولا كاشفات عن زينة، منذ عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري.
(1/297)
وأنه على مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، وتوزعها إلى دول، دبَّ الاستعمار الغربي الكافر لبلاد المسلمين، وأخذوا يرمون في وجوههم بالشبه، والعمل على تحويل الرعايا من صبغة الإسلام إلى صبغة الكفر والانحلال. وكانت أول شرارة قُدحت لضرب الأمة الإسلامية هي في سفور نسائهم عن وجوههن، وذلك على أرض الكنانة، في مصر، حين بعث والي مصر محمد علي باشا (1) البعوث إلى فرنسا للتعلم، وكان فيهم واعظ البعوث: رفاعة رافع الطهطاوي، المتوفى سنة 1290 هـ، وبعد عودته إلى مصر، بذر البذرة الأولى للدعوة إلى تحرير المرأة، ثم تتابع على هذا العمل عدد من المفتونين المستغربين، ومن الكفرة النصارى، منهم: الصليبي النصراني مرقس فهمي الهالك سنة 1374هـ في كتابه: (المرأة في الشرق) الذي هدف فيه إلى نزع الحجاب، وإباحة الاختلاط. وأحمد لطفي السيد، الهالك سنة 1382هـ، وهو أول من أدخل الفتيات المصريات في الجامعات مختلطات بالطلاب، سافرات الوجوه، لأول مرة في تاريخ مصر، يناصره في هذا عميد الفجور _________ (1) هل تعلم أن لقب (الباشا) بمعنى: نعل السلطان. انظر: مجلة الدارة لعام 1420، وهذا غير مستغرب على الأعاجم؛ لغلوهم وإسرافهم في الألقاب.
(1/298)
العربي: طه حسين، الهالك سنة 1393هـ. وقد تولى كِبْرَ هذه الفتنة داعية السفور: قاسم أمين، الهالك سنة 1362 الذي ألّف كتابه: «تحرير المرأة»، وقد صدرت ضده معارضات العلماء، وحكم بعضهم بردته، بمصر، والشام، والعراق، ثم حصلت له أحوال ألَّف على إثرها كتاب: «المرأة الجديدة»، أي: تحويل المسلمة إلى أوربية. وساعد على هذا التوجه من البلاط الأميرة نازلي مصطفى فاضل، وهذه قد تنصرت وارتدت عن الإسلام، كما في كتاب «الملكة نازلي»: (ص 8، 226 - 227) للمحلاوي. ثم مُنَفِّذ فكرة قاسم أمين داعية السفور: سعد زغلول، الهالك سنة 1346هـ، وشقيقه أحمد فتحي زغلول الهالك سنة 1332هـ. ثم ظهرت الحركة النسائية بالقاهرة لتحرير المرأة عام 1919م برئاسة هدى شعراوي، الهالكة سنة 1367هـ، وكان أول اجتماع لهن في الكنيسة المرقصية بمصر سنة 1920م، وكانت هدى شعراوي أول مصرية مسلمة رفعت الحجاب -نعوذ باللَّه من الشقاء- في قصة تمتلئ النفوس منها حسرة وأسى، ذلك أن سعد زغلول لما عاد من بريطانيا مُصَنَّعاً بجميع مقومات الإفساد في الإسلام، صُنِع لاستقباله سرادقان: سرادق للرجال، وسرادق للنساء، فلما نزل من الطائرة عَمَدَ إلى سرادق النساء المتحجبات، واستقبلته هدى شعراوي بحجابها لينزعه، فَمدَّ يده -يا ويلهما-، فنزع الحجاب عن وجهها،
(1/299)
فصفق الجميع ونزعن الحجاب. واليوم الحزين الثاني: أن صفية بنت مصطفى فهمي زوجة سعد زغلول، التي سمّاها بعد زواجه بها: صفية هانم سعد زغلول، على طريقة الأوربيين في نسبة زوجاتهم إليهم، كانت في وسط مظاهرة نسائية في القاهرة أمام قصر النيل، فخلعت الحجاب مع من خلعنه، ودُسْنَه تحت الأقدام، ثم أشعلن به النار؛ ولذا سُمي هذا الميدان باسم: «ميدان التحرير». وهكذا تتابع أشقياء الكنانة: إحسان عبد القدوس، ومصطفى أمين، ونجيب محفوظ، وطه حسين، ومن النصارى: شبلي شُمَيِّل، وفرح أنطون -نعوذ باللَّه من الشقاء وأهله-، يؤازرهم في هذه المكيدة للإسلام والمسلمين الصحافة، إذ كانت هي أُولَى وسائل نشر هذه الفتنة، حتى أُصْدِرَت مجلة باسم: «مجلة السفور» نحو سنة 1318هـ، وهرول الكُتَّاب الماجنون بمقالاتهم القائمة على المطالبة بما يُسند السفور والفساد، ويهجم على الفضائل والأخلاق من خلال وسائل الإفساد الآتية: نشر صور النساء الفاضحة، والدمج بين المرأة والرجل في الحوار والمناقشة، والتركيز على المقولة المحدَثَة الوافدة: «المرأة شريكة الرجل» أي: الدعوة إلى المساواة بينهما، وتسفيه قيام الرجل على المرأة، وإغراؤها بنشر الجديد في الأزياء الخليعة ومحلات الكوافير، وبرك السباحة النسائية والمختلطة، والأندية الترفيهية،
(1/300)
والمقاهي، ونشر الحوادث المخلة بالعرض، وتمجيد الممثلات والمغنيات ورائدات الفن والفنون الجميلة .. . يساند هذا الهجوم المنظم أمران: الأمر الأول: إسنادهم من الداخل، وضعف مقاومة المصلحين لهم بالقلم واللسان، والسكوت عن فحشهم، ونشر الفاحشة، وإسكات الطرف الآخر، وعدم نشر مقالاتهم، أو تعويقها، وإلصاق تُهم التطرف والرجعية بهم، وإسناد الولايات إلى غير أهلها من المسلمين الأمناء الأقوياء. هكذا صارت البداية المشؤومة للسفور في هذه الأمة بنزع الحجاب عن الوجه، وهي مبسوطة في كتاب: المؤامرة على المرأة المسلمة للأستاذ أحمد فرج، وفي كتاب: «عودة الحجاب ج/1» للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل، ثم أخذت تدب في العالم الإسلامي في ظرف سنوات قلائل، كالنار الموقدة في الهشيم، حتى صدرت القوانين الملزمة بالسفور، ففي تركيا أصدر الملحد أتاتورك -الهالك سنة 1356هـ-قانوناً بنزع الحجاب سنة 1920م، وفي سنة 1348هـ صدر قانون مدني على غرار قانون (نوشاتيل) المدني السويسري، فحرم تعدد الزوجات وغير ذلك، وفي مدة قصيرة جعل من المرأة التركية شقيقة المرأة السويسرية، فأصبحت المرأة التركية ترتدي أثواب السهرة العارية الكتفين والظهر، كما أنها لا تحجم عن ارتداء المايوه ... عياذاً باللَّه تعالى، وفي إيران أصدر الرافضي رضا
(1/301)
بهلوي قانوناً بنزع الحجاب سنة 1926م، وفي أفغانستان أصدر محمد أمان قراراً بإلغاء الحجاب، وفي ألبانيا أصدر أحمد زوغو قانوناً بإلغاء الحجاب، وفي تونس أصدر أبو رقيبة الهالك سنة 1421هـ قانوناً بمنع الحجاب، وتجريم تعدد الزوجات، ومن فعل فيعاقب بالسجن سنة، وغرامة مالية!! كما أصدرت قرارات عدوانية على الشريعة، منها: إطلاق الحرية للمرأة إذا تخطت العشرين من عمرها أن تتزوج بدون موافقة والديها، ومعاقبة من يتزوج ثانية بالحلال، وتبرئ من يخادن عَشْراً بالحرام!! وفي مجلة العربي نشر استطلاع عن تونس وفيه صورة للوحات الدعاية المنصوبة في الشوارع، ففي كل ميدان لوحتان: إحداهما تمثل أسرة ترتدي الزي المحتشم مشطوبة بإشارة (×)، والأخرى تمثل أسرة متفرنجة، ومكتوب تحتها: «كوني مثل هؤلاء». ولذا قال العلامة الشاعر العراقي محمد بهجت الأثري - رحمه الله - المتوفى سنة 1416هـ: أبو رقيبة لا امتدتْ لَه رَقَبَة ... لم يتقِ اللَّه يوماً لا ولا رَقَبَه وكان متولي كِبْرَها هو وآخرون، منهم المدعو: الطاهر الحداد المولود سنة 1317هـ الهالك سنة 1353هـ حين ألَّف كتابه: «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» بين عام 1338 - 1348هـ يدعو فيه إلى تحرير المرأة، وقيل: بل هو من تأليف النصراني: الأب سلام، تحمله الطاهر
(1/302)
الحداد، وفي آخره أثار اثني عشر سؤالاً أجاب عليها عدد من المفتين، وقد حكم عليه مفتيا المالكية بالمروق من الدين، وبسببه حُرِمَ من الامتحان في كلية الحقوق حتى مات سنة 1353هـ غير مُشيَّع إلا من أهله، وعدد من أصدقائه، وكان مُولعاً بالغناء، والتردد على المقاهي، والانتماء إلى المذهب الاشتراكي، ثم ركزت الصحافة على نشر ما في الكتاب من الطوام، وما زالوا كذلك حتى تحولت تونس إلى «جسم مريض» بالسفور والحسور، وتجد تفاصيل هذه المعركة الإلحادية على: «الحجاب»، و» العفة» في كتاب لا يُفرح به في نحو أربعمائة صفحة، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون (1). وفي العراق تولى كِبْرَ هذه القضية -المناداة بنزع الحجاب- الزهاوي، والرُّصافي، نعوذ باللَّه من حالهما، كما هو مفصَّل في كتاب: «حكايات سياسية في تاريخ العراق الحديث» (ص 91 - 143). وانظر خبر اليوم الحزين في نزع الحجاب في الجزائر كما في كتاب: «التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد» [ص 33 - 139] في 13 ماي عام 1958م قصة نزع الحجاب، قصة تتقطع منها النفسُ حَسَراتٍ، ذلك أنه سُخِّر خطيب جمعة بالنداء في خطبته إلى نزع الحجاب، ففعل المبتلى، وبعدها قامت فتاة جزائرية فنادت بمكبر الصوت بخلع الحجاب، فخلعت حجابها ورمت به، وتبعها _________ (1) من سقطات «الأعلام» للزركلي وصفه للطاهر الحداد المذكور بأنه من زعماء الإصلاح، فليُتنبَّهْ!
(1/303)
فتيات -منظمات لهذا الغرض- نزعن الحجاب، فصفق المسَخَّرون، ومثله حصل في مدينة وهران، ومثله حصل في عاصمة الجزائر: والصحافة من وراء هذا إشاعة، وتأييداً. وفي المغرب الأقصى، وفي الشام بأقسامه الأربعة: لبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين، انتشر السفور والتبرج والتهتك والإباحية على أيدي دعاة البعث تارة، والقومية تارة أخرى، إلا أن المصادر التي تم الوقوف عليها لم تسعف في كيفية حصول ذلك، ولا في تسمية أشقيائها، فلا أدري لماذا أعرض الكُتَّاب ومُسَجِّلو الأحداث آنذاك عن تسجيل البداية المشؤومة في القطر الشامي خاصة، مع أن الانفجار الجنسي والعري، والتهتك والإباحية على حال لا تخفى (1). وأول كتاب يتحدث عن تحرير المرأة في الشام سنة 1347هـ أي بعد وفاة فاسم أمين بعشرين سنة - هو الكتاب الذي ألفته - أو ألِّف باسم - نظيرة زين الدين، بعنوان: «السفور والحجاب»، ومما يثير الانتباه أن الذي قرظه هو علي عبد الرازق صاحب كتاب: «الإسلام وأصول الحكم» الكتاب الذي فَجَّر العلمانية في مصر، وردّ عليه علماء مصر. أما في الهند وباكستان، فكانت حال نساء المؤمنين على خير حال من الحجاب -دِرْعُ الحشمة والحياء- وفي التاريخ نفسه -حدود عام _________ (1) ثم وجدت ذلك في كتاب الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - «ذكريات» (5/ 101 - 112)، (223 - 274)، (6/ 10 - 25) [الواجد بكر أبو زيد - رحمه الله -].
(1/304)
1370هـ- بدأت حركة تحرير المرأة والمناداة بجناحيها: الحرية والمساواة، وترجم لذلك كتاب قاسم أمين: «تحرير المرأة»، ثم من وراء ذلك الصحافة في الدعاية للتعليم المختلط، ونزع الخمار، حتى بلغت هذه القارة من الحال ما لا يشكى إلا إلى اللَّه تعالى منه، وهو مبسوط في كتاب: «أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية» لخادم حسين ص 182 - 195. وهكذا تحت وطأة سعاة الفتنة بالنداء بتحرير المرأة باسم الحرية والمساواة، آلت نهاية المرأة الغربية بداية للمرأة المسلمة في هذه الأقطار. فباسم الحرية والمساواة: - أخرجت المرأة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياته. - وخُلع منها الحجاب وما يتبعه من فضائل العفة والحياء والطهر والنقاء. - وغمسوها بأسفل دركات الخلاعة والمجون، لإشباع رغباتهم الجنسية. - ورفعوا عنها يد قيام الرجال عليها؛ لتسويغ التجارة بعرضها دون رقيب عليها. - ورفعوا حواجز منع الاختلاط والخلوة؛ لتحطيم فضائلها على صخرة التحرر، والحرية والمساواة. - وتَمَّ القضاء على رسالتها الحياتية، أُمَّاً وزوجة، ومربية أجيال، وسكناً لراحة الأزواج، إلى جعلها سلعة رخيصة مهينة مبتذلة في كَفِّ كُلِّ لاقِطٍ من خائن وفاجر.
(1/305)
إلى آخر ما هنالك من البلاء المتناسل، مما تراه محرراً في عدد من كتابات الغيورين، ومنها: كتاب: «حقوق المرأة في الإسلام» لمؤلفه محمد بن عبد اللَّه عرفة. هذه هي المطالب المنحرفة في سبيل المؤمنين، وهذه هي آثارها المدمرة في العالم الإسلامي. الأمر الثاني: إعادة المطالب المنحرفة؛ لضرب الفضيلة في آخر معقل للإسلام، وجعلها مِهاداً للجهر بفساد الأخلاق: إن البداية مدخل النهاية، وإن أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية: الحجاب لنساء المؤمنين، فإذا أسفرن عن وجوههن حَسَرْن عن أبدانهن وزينتهن التي أمر اللَّه بحجبها وسترها عن الرجال الأجانب عنهن، وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من الفضائل إلى الرذائل؛ من الانحلال والتهتك والإباحية، كما هي سائدة في جُلِّ العالم الإسلامي، نسأل اللَّه صلاح أحوال المسلمين. واليوم يمشي المستغربون الأُجَرَاء على الخُطَا نفسها، فيبذلون جهودهم مهرولين، لضرب فضيلة الحجاب في آخر معقل للإسلام، حتى تصل الحال - سواء أرادوا أم لم يريدوا- إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار الإسلام الأولى والأخيرة، وعاصمة المسلمين، وحبيبة المؤمنين: «جزيرة العرب» التي حمى اللَّه قلبها وقبلتها منذ أسلمت ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين إلى يومنا هذا من
(1/306)
أن ينفذ إليها الاستعمار، والإسلام فيها -بحمد اللَّه- ظاهر، والشريعة نافذة، والمجتمع فيها مسلم، لا يشوبه تَجَنُّسُ كافر، وهؤلاء المفتونون السَّخَّابون على أعمدة الصحف اتَّبَعُوا سَنَن من كان مثلهم من الضالين من قبل، فنقلوا خطتهم التي واجهوا بها الحجاب إلى بلادنا وصحافتنا، وبدؤوا من حيث بدأ أولئك بمطالبهم هذه يُجَرِّمون الوضع القائم، وهو وضع إسلامي في الحجاب، وفيه الطهر والعفاف، وكل من الجنسين في موقعه حسب الشرع المطهر، فماذا ينقمون؟ وإنَّ ما تقدم بيانه من أصول الفضيلة، يردّ على هذه المطالب المنحرفة الباطلة، الدائرة في أجواء الرذيلة: من السفور عن الوجه، والتبرج، والاختلاط، وسلب قيام الرِّجال على النساء، ومنازعة المرأة في اختصاص الرجل، وهكذا من الغايات المدمرة. وإن حقيقة هذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين: إعلانٌ بالمطالبة بالمنكر، وهجر للمعروف، وخروج على الفطرة، وخروج على الشريعة، وخروج على الفضائل والقيم بجميع مقوماتها، وخروج على القيادة الإسلامية التي تحكم الشرع المطهر، وجعل البلاد مِهاداً للتبرج والسفور والاختلاط والحسور. وهذا نوع من المحاربة باللسان -والقلم أحد اللسانين- وقد يكون أنكى من المحاربة باليد، وهو من الإفساد في الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وما يفسده اللسان من
(1/307)
الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد» (1). هذا وليعم أن الدعوة إلى السفور والتبرج، وترجيل المرأة ليست قاصرة على الصحافة فحسب، بل هناك أدوات أخرى تعمل بجهد جهيد إلى ذلك من إذاعات وتلفزة، وقنوات، وشبكات، وكتب، وقصص، وغيرها كلها تشترك في مسارعة الخطا إلى نشر التغريب بين المسلمين، وتَحْمِلُهم على الخروج على أحكام دينهم، وعفَّتهم وفَضيلتهم، فَنُحَذِّرُ الجميع من عقاب اللَّه وسخطه، ونذكِّرهم بأيام اللَّه، واللَّه موعدهم. [العلاج لهذا السيل الجارف]: لهذا فإن المتعين إجراؤه أمام التوجه المنحرف هو ما يأتي: 1 - على مَن بسط اللَّه يده إصْدار الأوامر الحاسمة للمحافظة على الفضيلة من عاديات التبرج والسفور والاختلاط، وكفُّ أقلام الرعاع السُّفوريّين عن الكتابة في هذه المطالب؛ حماية للأمة من شرورهم، وإحالة مَن يَسْخر من الحجاب إلى القَضاء الشرعي؛ ليطبق عليهم ما يقضي به الشرع من عقاب. وإلحاق العقاب بالمتبرجات؛ لأنهن شراك للافتتان، وهن أولى بالعقاب من الشاب الذي يتعرض لهن؛ إذ هي التي أغرته فَجَرَّته إلى نفسها. _________ (1) الصارم المسلول، 2/ 735.
(1/308)
2 - على العلماء وطلاب العلم بذل النصح، والتحذير من قالة السوء، وتثبيت نساء المؤمنين على ما هن عليه من الفضيلة، وحراستها من المعتدين عليها، والرحمة بهن بالتحذير من دعاة السوء، عبيد الهوى. 3 - على كل مَن وَلاَّه اللَّه أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج وغيرهم، أن يتقوا اللَّه فيما وُلُّوا من أمر النساء، وأن يعملوا الأسباب لحفظهن من السفور والتبرج والاختلاط، والأسباب الداعية إليها، ومن دعاة السوء. وليعلموا أن فساد النساء سببه الأول: تساهل الرجال. 4 - على نساء المؤمنين أن يتقين اللَّه في أنفسهن، وفي مَن تحت أيديهن من الذراري، بلزوم الفضيلة، والتزام اللباس الشرعي والحجاب بلبس العباءة والخمار، وأن لا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذيلة. 5 - ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح، وأن لا يكونوا باب سوء على أهليهم، وأمتهم، وليتقوا سخط اللَّه ومقته وأليم عقابه. 6 - على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها، وليعلم أن محبتها -كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (1) لا تكون بالقول والفعل فقط، بل تكون بذلك، وبالتحدث بها، وبالقلب، _________ (1) فتاوى ابن تيمية، 15/ 332، 344.
(1/309)
وبالركون إليها، وبالسكوت عنها، فإن هذه المحبة تُمَكِّن من انتشارها، وتُمَكن من الدفع في وجه من ينكرها من المؤمنين، فليتق اللَّه امرؤ مسلم من محبة إشاعة الفاحشة، قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1). هذا ما أردت بيانه- وما على أهل العلم والإيمان إلا البلاغ والبيان- للتخفف من عهدته، ورجاء انتفاع من شاء اللَّه من عباده، وللنصح به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول اللَّه؟ قال: «للَّه، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» (2). وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في «الحِكَم الجديرة بالإذاعة» (3): «رُوي عن الإمام أحمد أنه قيل له: إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذا، فقال: لا نزال بخير ما دام فينا من يُنكر»، ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له: اتق اللَّه يا أمير المؤمنين، فقال: «لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم» (4). _________ (1) سورة النور، الآية: 19. (2) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم 55. (3) الحكم الجديرة بالإذاعة، ص 43. (4) تاريخ المدينة لابن شبة، 2/ 773، وهو ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمر، وفيه مبارك بن فضالة مدلس، وقد عنعن كما في التقريب، رقم: 6464، وأورده ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب، ص 155. انظر: محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب، لعبد العزيز بن محمد بن محسن، 2/ 601.
(1/310)
وما يتذكر إلا أولو الألباب، واللَّه يتولى الجزاء والحساب (1). وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر، ثم تركيا، ثم الشام، ثم العراق، وانتشر في المغرب الإسلامي، وفي بلاد العجم، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون. وإن له في جزيرة العرب بدايات، نسأل اللَّه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يكف البأس عنهم (2). وكان بدء انفلات النساء في البلاد الإسلامية تقليداً للبلاد الغربية حصل بترك الحجاب، وكشف النساء وجوههن، وتبع ذلك شيئاً فشيئاً كشف: رؤوسهن، وصدورهن، وسواعدهن، وأعضادهن، وسوقهن، وبعض أفخاذهن، وتبع ذلك أيضاً مخالطتهن الرجال ومشاركتهن لهم في سائر الأعمال والتسوية بينهم وبينهن، يوضح ذلك ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - عن بدء السفور في بلاد الشام، حيث قال (3): «وكانت النصرانيات واليهوديات من أهل الشام يلبسن قبل الحرب الأولى الملاءات الساترات كالمسلمات، وكل ما عندهن أنهن يكشفن الوجوه، ويمشين سافرات، أذكر ذلك وأنا صغير، وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات المدرسة سافرة فأغلقت دمشق كلها حوانيتها، وخرج أهلوها محتجين متظاهرين حتى روّعوا _________ (1) حراسة الفضيلة، للعلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيد، ص 137 - 152. (2) حراسة الفضيلة، ص 34. (3) ذكريات لعلي الطنطاوي، 5/ 226.
(1/311)
الحكومة فأمرتها بالحجاب، وأوقعت عليها العقاب، مع أنها لم تكشف إلا وجهها، ومع أن أباها كان وزيراً عالماً جليلاً، وكان أستاذاً لنا. ومرّت الأيام، وجئت هذه المدرسة ألقي فيها دروساً إضافية، وأنا قاضي دمشق سن 1949م، وكان يدرِّس فيها شيخنا محمد بهجت البيطار، فسمعت مرّة صوتاً من ساحة المدرسة، فتلفتّ أنظر من النافذة، فرأيت مشهداً ما كنت أتصور أن يكون في ملهى فضلاً عن مدرسة، وهو أن طالبات أحد الفصول - وكلهن كبيرات بالغات- قد استلقين على ظهورهن في درس الرياضة، ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها!». إلى أن قال (1): «كان أن دمشق التي عرفناها تستر بالملاءة البنت من سنتها العاشرة، شهدت يوم الجلاء بنات السادسة عشرة وما فوقها يمشين في العرض بادية أفخاذهن، تهتز نهودهن في صدورهن تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة، وشهدتُ بنتاً جميلة زُيِّنتْ بأبهى الحُلَل، وأُلبست لباس عروس، وركبت السيارة المكشوفة وسط الشباب ... قالوا: إنها رمز الوحدة العربية! ولم يَدْرِ الذين رمزوا هذا الرمز أن العروبة إنما هي في تقديس الأعراض، لا في امتهانها». إلى أن قال (2): «ألا مَن كان له قلب فليتفطّر اليوم أسفاً على الحياء، _________ (1) ص 238. (2) ص 239.
(1/312)
مَن كانت له عين فلتَبْكِ اليوم دماً على الأخلاق، مَن كان له عقل فليفكر بعقله، فما بالفجور يكون عز الوطن، وضمان الاستقلال، ولكن بالأخلاق تحفظ الأمجاد، وتسمو الأوطان، فإذا كنتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق، والعورات من أسر الحجاب والستر، إذا ظننتم ذلك من دواعي التقدم ولوازم الحضارة، وتركتم كل إنسان وشهوته وهواه، فإنكم لا تحمدون مغبة ما تفعلون ... » (1). هذه قصة بدء السفور، وكشف النساء وجوههن في بلاد الشام، حكاها الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - عن مشاهدة ومعاينة، وكانت وفاته سنة 1420هـ، والسعيد مَن وُعظ بغيره، ومثل هذا الذي حصل في بلاد الشام حصل في مصر، وتركيا، وإيران وغيرها، وكانت بداية السفور، وكشف الوجوه في القرن الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي (2) (3). _________ (1) ذكريات علي الطنطاوي، 5/ 226 - 239 .. (2) انظر: حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد اللَّه أبو زيد، ص 139 - 143. (3) انظر: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية، للعلامة عبد المحسن العباد، ص 6 - 9.
(1/313)
المطلب الثالث: أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده
أولا: التبرج معصية للَّه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -: ومن يعص اللَّه ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا نفسه، ولن يضر اللَّه شيئَاً، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» (1). واعلم- رحمك اللَّه - أن كل آية أو حديث اشتملت، أو اشتمل على الزجر عن معصية اللَّه - عز وجل -، ومعصية رسوله - صلى الله عليه وسلم - يصلح أن يستدل به هنا، غير أننا- اختصارًا- نورد فيما يلي ما جاء في النهي عن معصية التبرج بخصوصها، فمن ذلك: ما رواه أَبو حَرِيزٍ، مَوْلَى أمير المؤمنين مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: «خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ، بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبْلِغُكُمْ ذَلِكَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالشِّعْرُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالتَّبَرُّجُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ» (2). وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ -، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، _________ (1) البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، برقم 7280. (2) مسند الإمام أحمد، 28/ 131، برقم 16935، والطبراني في الكبير، 14/ 296، برقم 16240، وصححه لغيره محققو المسند، 28/ 131.
(1/314)
وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ» (1). قال السيوطي - رحمه الله -: «والتبرج بالزينة: أي إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله: «لغير محلها» (2). ثانيا: التبرج كبيرة موبقة: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللًّهِ - صلى الله عليه وسلم - تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» (3). فتأمل كيف قرن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة. _________ (1) أخرجه النسائي في السنن (المجتبى)، كتاب الزينة، الخضاب بالصفرة، برقم 5088، وفي السنن الكبرى له أيضاً، كتاب الزينة، الخضاب بالصفرة، برقم 9310، وبنحوه: مصنف ابن أبي شيبة، برقم 185، والحاكم في المستدرك، برقم 7418، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في شعب الإيمان، 4/ 168، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، 10/ 195: «صححه ابن حبان، والحاكم. وعبد الرحمن بن حرملة، قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال الطبري: لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه»، وقال الألباني في ضعيف أبي داود، برقم 905: «منكر». (2) وكذا ذكره السندي في حاشيته، انظر: سنن النسائي، 8/ 141 - 142. (3) أخرجه الإمام أحمد، 11/ 437، برقم 6850، والطبراني في مسند الشاميين، 2/ 304، برقم 1390، وقال محققو المسند، 11/ 437: «صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن»، وحسن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 121.
(1/315)
ثالثًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللَّه: فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ» (1). وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ» (2). رابعًا: التبرج من صفات أهل النار: فعن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ _________ (1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، 2/ 258، وفي المعجم الكبير للطبراني [القسم الذي كان مفقوداً]، برقم 1408، ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله: «أراد - صلى الله عليه وسلم - النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف، ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة». [تنوير الحوالك، 3/ 103]، وانظر: نيل الأوطار، 2/ 131، وحسن إسناده الألباني في الثمر المستطاب، ص 317. (2) أحمد، برقم 7083، وابن حبان، برقم 5753، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 2683، وتقدم تخريجه. وقوله: «كأسنمة البخت» هو جمع «سنام»، وهو أعلى ظهر البعير، و «البخت» - بضم الباء، وسكون الخاء -: جمال طوال الأعناق، والعِجاف: جمع عجفاء.
(1/316)
كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» (1). وعَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الشِّعْبِ [فإذا نحن بامرأة عليها حبائر (2) لها وخواتيم وقد بسطت يدها إلى الهودج] إِذْ قَالَ: «انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ شَيْئًا؟» فَقُلْنَا: نَرَى غِرْبَانًا فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ (3) أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ _________ (1) رواه مسلم، برقم (2128)، وتقدم تخريجه. قال النووي - رحمه الله -: «قيل: معنى كاسيات أي من نعمة اللَّه عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه، وقيل: تلبس ثوبًا رقيقاً يصف لون بدنها، وهو المختار، ومعنى مائلات: عن طاعة اللَّه، وما يلزمهن حفظه، مميلات أي: يعَلِّمْنَ غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، ومميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة، ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي: يكبرنها، ويعظمنها بلف عمامة أو- نحوها، واللَّه أعلم» [المجموع شرح المهذب، 4/ 307]. (2) حبائر ثياب جديدة، وثوب حبير أي جديد. انظر: الصحاح للجوهري، 2/ 620. (3) الأعصم: هو الأبيض الجناحين، وقيل الأبيض الرجلين، وقيل: هو أحمر المنقار والرجلين، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 249. وفي الحديث كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء، لأن هذا الوصف في الغربان قليل، ونظير ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الكسوف: «رأيت النار، ورأيت أكثر أهلها النساء» متفق عليه، وفي الصحيحين أيضاً من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: «وقمت على باب النار، فإذا عامة من دخلها النساء»، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء»، وانظر: التذكرة للقرطبي، 1/ 369، والجنة والنار، للأشقر، ص 83 - 84.
(1/317)
إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغِرْبَانِ» (1). خامسًا: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة: قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: «حدثنا علي بن خَشْرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن ميمونة بنت سعد- وكانت خادمًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ نُورَ لَهَا» (2). _________ (1) رواه الإمام أحمد، 29/ 305، برقم 17770، والحاكم، 4/ 602، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، سنن النسائي الكبرى، كتاب عشرة النساء، ذكر الاختلاف على أبي رجاء في هذا الحديث، برقم 9223، ومسند أبي يعلى، 13/ 271، وعبد بن حميد، ص 121، وما بين المعقوفين من أبي يعلى، وزاد الألباني في تخريجه: أبا يعلى، وابن عساكر، وابن قتيبة في " إصلاح الغلط؟ وقال: (وهذا سند صحيح، وقول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» خطأ، وافقه الذهبي عليه، فإن أبا جعفر اسمه عمير بن يزيد لم يخرج مسلم له شيئاً» ـ. سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1850، وقال التويجري - رحمه الله -: «والظاهر أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - إنما حَدَّث به قصد الإنكار على المرأة المبدية لزينتها بين الرجال الأجانب» [الصارم المشهور، ص 14]، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 4/ 466. (2) رواه الترمذي في سننه، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة، برقم 1167 وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عُبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهو صدوق، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة، ولم يرفعه»، والطبراني في الكبير، 20/ 38، برقم 70، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، 5/ 583، ومعرفة الصحابة، لأبي نعيم، برقم 7196، وأمثال الحديث له أيضاً، برقم 234، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، برقم 8132، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم 1800.
(1/318)
قوله: الرافلة: قال في النهاية: «الرافلة ... : هي التي تَرْفُلُ فِي ثوبها، أي تتبختر، والرفل: الذيل، ورفل إزاره: إذا أسبله، وتبختر فيه» (1). وقوله: «في الزينة»: أي في ثياب الزينة، قوله: «في غير أهلها» أي بين من يحرم نظره إليها، قوله: «كمثل ظلمة يوم القيامة» أي تكون يوم القيامة كأنها ظلمة، قوله: «لا نور لها» الضمير للمرأة، قال الديلمي: يريد المتبرجة بالزينة لغير زوجها» (2). وقال في الفردوس: «والرَّفْلُ التمايل في المشي مع جَر ذيل، يريد أنها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة» (3). قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: «ذكره الترمذي، وضعفه، ولكن المعنى صحيح؛ فإن اللذة في المعصية عذاب، والراحة نصب، والشبَعَ جوع، والبركة مَحَق، والنور ظلمة، والطيب نتن، وعكسه الطاعات، فخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك، ودم الشهيد اللون لون دم، والعَرْفُ عرف مِسْك» (4). سادسَاً: التبرج نفاق: فعَنْ أَبِي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الْمَوَاتِيَةُ، الْمُوَاسِيَةُ؛ إِذَا اتَّقَيْنَ اللَّهَ، _________ (1) النهاية في غريب الحديث، 2/ 247، مادة (رفل). (2) تحفة الأحوذي، 4/ 329. (3) نقله المناوي في فيض القدير، 5/ 507. (4) عارضة الأحوذي، 5/ 113 - 114.
(1/319)
وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ، وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ» (1). سابعًا: التبرج فاحشة: فإن المرأة عورة، وكشف العورة فاحشة ومقت، قال تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (2). والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} (3). والمتبرجة جرثومة خبيثة ضارة تنشر الفاحشة في المجتمع الإسلامي، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (4). عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ» (5). _________ (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 7/ 82، ورواه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أبو نعيم في الحلية، 8/ 376، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1849، رقم 632. (2) سورة الأعراف، الآية: 28. (3) سورة البقرة، الآية: 268. (4) سورة النور، الآية: 19. (5) أخرجه أحمد، برقم 19711، وأبو داود، برقم 4173، والنسائي، برقم 5126، وابن حبان، برقم 4424، وابن خزيمة، برقم 1681، وتقدم تخريجه.
(1/320)
ثامنًا: التبرج تهتك وفضيحة: عن عائشة - رحمه الله - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ - عز وجل -» (1). ومثل ذلك ما ثبت عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ» (2). تاسعَاً: التبرج سنة إبليسية: المعركة مع الشيطان معركة جدية، وأصيلة، ومستمرة، وضارية، لأنه عدوٌّ عنيد يصر على ملاحقة الإنسان في كل حال، وعلى إتيانه من كل صوب وجهة، كما وصفه _________ (1) رواه الإمام أحمد، 42/ 422، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب دخول الحمام، رقم (3750).والحاكم في المستدرك، 4/ 288، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وعبد الرزاق، 1/ 294، برقم 1132، وأبو يعلى، 8/ 138، والطبراني في الأوسط، 7/ 100، برقم 6973، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 3021. قال المناوي - رحمه الله -، 3/ 176: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وضعت ثيابها في غير بيت زوجها» كناية عن تكشفها للأجانب، وعدم تسترها منهم «فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللَّه - عز وجل -» لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سواءتهن، وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين اللَّه، وكشفن سواءتهن، هتكن الستر بينهن وبين اللَّه تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها، وخانت زوجها يهتك اللَّه سترها، والجزاء من جنس العمل، وأهتك خرق الستر عما وراءه، والهتيكة الفضيحة». (2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم 590، والإمام أحمد، 39/ 368، برقم 23948، والطبراني في الكبير، 18/ 306، برقم 788، ومسند البزار، 9/ 204، برقم 3749، والحاكم، 1/ 119، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن أبي عاصم، في السنة، برقم 89، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 186، برقم 1887.
(1/321)
اللَّه تعالى في قوله: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} (1)، ولا عاصم لبني آدم من الشيطان إلا التقوى والإيمان والذكر، والاستعلاء على الشهوات، وإخضاع الهوى لهدى اللَّه تبارك وتعالى. ومن استعراض ما حدث لآدم - عليه السلام - مع عدوّه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السوأة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته، إذ يقول اللَّه سبحانه: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا} (2)، وقال - عز وجل -: {فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} (3). وقال عز من قائل: {فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} (4). لقد نسي آدم، وأخطأ، وتاب، واستغفر، فقبل اللَّه توبته، وغفر له، وانتهى أمر تلك الخطيئة الأولى، ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين ابن آدم في صراعه الطويل المدى مع الشيطان الذي يأتيه من مواطن الضعف فيه، فيغويه، ويمنيه، ويوسوس له حتى _________ (1) سورة الأعراف، الآيتان: 16 - 17. (2) سورة الأعراف، الآية: 20. (3) سورة الأعراف، الآية: 22. (4) سورة الأعراف، الآية: 121.
(1/322)
يستجيب فيقع في المحظور. إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف السوءات، وهتك الأستار، وإشاعة الفاحشة، وأن هذا هدف مقصود له. ومن ثم حذرنا اللَّه - عز وجل - عن هذه الفتنة خاصة، فقال. جل وعلا: {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} (1). ومن هنا فإن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات، وهو مؤسس الدعوة إلى التبرج بدرجاته المتفاوتة، بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس والجن الداعين إلى (تحرير) المرأة عن قيد الستر والصيانة والعفاف. ومن ثم قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (2). عاشرًا: التبرج من سنن اليهود والنصارى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (3). _________ (1) سورة الأعراف، الآية: 64. (2) سورة الأعراف، الآية: 27. (3) سورة فاطر، الآية: 6.
(1/323)
لقد اتفق مخططو الدولة الصِّهْيُونية العالمية التي تريد أن تسيطر على العالم في «بروتوكولات حكماء صهيون» على أن من السبل التي يجب اتباعها لإخضاع من يسمونهم «الجوييم»، أو «الأمميين» حربَ الأخلاق، وتقويض نظام الأسرة بشتى الوسائل الممكنة، ووجدوا أن الأسباب المدمرة للأسرة تتركز في كل ألوان الإغراء بالفواحش، وإثارة الشهوات، وهكذا غَدَوْا يصنعون: عن طريق الأفلام الماجنة التي توزعها في العالم «دور صهيونية»، وعن طريق الأزياء الخليعة التي تنشرها دور الأزياء الصهيونية، وكذا المجلات والقصص ونحوها. ولليهود باع كبير في هذا المجال، عرفوا به في كل عصر ومصر. وها هو ذا ناصحنا الأمين رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يحذِّرنا أولاً من فتنة النساء، كما في حديث أسامة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (1). ثم ها هو يخص فتنة النساء بالتحذير، ويبين لنا أنها كانت أول ما فتن به بنو إسرائيل. وذلك في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (2). _________ (1) البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة برقم 5096، ومسلم، كتاب العلم، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، برقم 2740. (2) مسلم، كتاب العلم، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، برقم 2742.
(1/324)
وقد شرع اللَّه لهن الستر، وأمَرَهُنَّ بالصيانة، فقلن: «سمعنا وعصينا»، كما كانت عادة الأمة المغضوب عليها. ويشرح لنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - جانبًا من فتنة نساء بني إسرائيل، وإلحاحهن على التحيل لبث هذه الفتنة، فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ (1)، وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا» (2) وقد كان نساء العجم من اليهود أو النصارى الذين يعيشون مع المسلمين يحرصن على هذا التبرج، قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري أخيه: «إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (3) الآية» (4). الحادي عشر: التبرج جاهلية منتنة: قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي _________ (1) وذلك لتبدو طويلة، تماماً كما يفعل بعض النساء اليوم من لباس ما يسمى بـ (الكعب العالي)، وللغرض نفسه. (2) مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي، برقم 2252. (3) سورة النور، الآية: 30. (4) فتح الباري، 11/ 7.
(1/325)
بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1). وقد وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوى الجاهلية بأنها منتنة (2) أي خبيثة، وأمرنا بنبذها، وقد جاء في صفته - صلى الله عليه وسلم - أنه {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (3). وقد تبرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل من يدعو بدعوى الجاهلية، فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (4). وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ» (5). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «سُنَّة الجاهِلِيَّة اسم جِنس يَعُمّ جَمِيع ما كانَ أَهل الجاهِلِيَّة يَعتَمِدُونَهُ» (6). ودعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية، كلاهما منتن خبيث، _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 33. (2) انظر: صحيح البخاري، برقم 4905، ومسلم، برقم 2584. (3) سورة الأعراف، الآية: 157. (4) رواه من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم1297، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، برقم 103. (5) البخاري، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغير حق، برقم 6882. (6) فتح الباري، 12/ 211.
(1/326)
أبغضه اللَّه تعالى، وحرَمه علينا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الأولى: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» (1)، فوجب أن نقول في الأخرى: «دعوها فإنها منتنة»، بل ضعوها حيث وضعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا قال: «أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ» (2). فلا يجوز لأي مسلمة بحال أن ترفع ما وضعه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، أو تعَظِّمَ ما حَقره من أمر الجاهلية، سواء في ذلك: ربا الجاهلية، أو تبرج الجاهلية، أو دعوى الجاهلية، أو حكم الجاهلية، أو ظن الجاهلية، أو حمية الجاهلية، أو سنة الجاهلية. الثانِي عشر: التبرج: انتكاس، وتخلف، وانحطاط: من استعراض ما حدث لآدم - عليه السلام - مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السَّوأة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته، إذ يقول الله سبحانه: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا} (3). _________ (1) قطعة من حديث رواه البخاري عن جابر - رضي الله عنه -، بَاب قَوْلُهُ: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}، برقم 4905، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، برقم 2584. (2) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1218. (3) سورة الأعراف، الآية: 20.
(1/327)
ويقول - عز وجل -: {فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} (1). ويقول سبحانه: {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا} (2). وكل هذه الآيات توحي بأهمية هذه المسألة، وعمقها في الفطرة البشرية، فاللباس، وستر العورة: زينة للإنسان، وستر لعوراته الجسدية، كما أن التقوى لباس، وستر لعوراته النفسية. والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوءاتهما الجسدية والنفسية، وتحرص على سترها ومواراتها، والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس، وتعرية النفس من التقوى ومن الحياء من اللَّه، ثم من الناس. والذين يطلقون ألسنتهم، وأقلامهم، وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور والأساليب الخبيثة - هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته، وخصائص إنسانيته، التي بها صار إنسانًا متميزَا عن الحيوان (3). قال تبارك وتعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (4). _________ (1) سورة الأعراف، الآية: 22. (2) سورة الأعراف، الآية: 27. (3) اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية، ص 16 - 17. (4) سورة الأسراء، الآية: 70.
(1/328)
إن العري فطرة حيوانية، ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت، لم يتغير حالها يومًا، بعكس الإنسان الذي يصح أن نَصِفَهُ بأنه «حيوان مستور»، وهذه الفطرة الحيوانية لا يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان. إن رؤية العُرْي والتكشف جمالًا هو انتكاس في الذوق البشري قطعَاً، ومؤشر واضح يبين انتشار التخلف في المجتمع البشري. وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم، يقولون: إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريَاً من كل ستر إلا شعره، ثم رأى أن يستر جسمه بأوراق الشجر، ثم بجلود الحيوانات، ثم جعل يترقى في مدارج الحضارة حتى اكتشف الإبرة، وابتدع وسيلة الحياكة، فاستكمل ستر جسمه. وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني، فكل زيادة في هذا التقدم كانت مؤدية إلى زيادة في توكيد الحشمة، وكل خلل في كمال الستر عنوان التخلف والرجعية. وآية ذلك أن المتخلفين في أواسط أفريقيا عراة، حين تشرق حضارة الإسلام في هذه المناطق، يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة، وانتشالهم من وهدة التخلف، والتسامي بهم إلى مستوى (الحضارة) بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها.
(1/329)
قال الشيخ مصطفى صبري - رحمه الله -: «لا خلاف في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي يَزَعُهُ عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية، ويسد ذرائعها، ويكون حاجزًا بين الذكور والإناث ... ثم إن الاحتجاب كما يكون تقييدًا للفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية، ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية، فهو يتناسب مع الغيرة التي جُبل عليها الإنسان، ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرى، إلا أن الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة تستمد قوتها من الشهوة الجسمانية، فهذه تغري بالسفور، وتلك تبعث على الاحتجاب، وبين هاتين الغريزتين تجافِ، وتحارب يجريان في داخل الإنسان» (1). الثالث عشر: التبرج باب شر مستطير: وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع، وعِبَر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، لا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. فمن هذه العواقب الوخيمة: تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها. ومنها: الإعراض عن الزواج، وشيوع الفواحش، وسيطرة الشهوات. _________ (1) قولي في المرأة، للشيخ مصطفى صبري - رحمه الله -، ص 24 - 25.
(1/330)
ومنها: انعدام الغيرة، واضمحلال الحياء. ومنها: كثرة الجرائم. ومنها: فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب، خاصة المراهقين، ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها. ومنها: تحطيم الروابط الأسرية، وانعدام الثقة بين أفرادها، وتفشي الطلاق. ومنها: المتاجرة بالمرأة، كوسيلة دعاية، أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها. ومنها: الإساءة إلى المرأة نفسها، والإعلان عن سوء نيتها، وخبث طويتها، مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء. منها: انتشار الأمراض: قال - صلى الله عليه وسلم -: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوْا» (1). ومنها: تسهيل معصية الزنا بالعين، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العينان زناهما النظر» (2)، وتعسير طاعة غض البصر التي أُمِرنا بها إرضاء للَّه سبحانه. _________ (1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، رقم 4019، وأبو نعيم، في حلية الأولياء، 8/ 333، والحاكم، 4/ 583، برقم 8623، وقال: «صحيح الإسناد»، والبيهقي في شعب الإيمان، 3/ 197، برقم 3315، والطبراني في الأوسط، 5/ 61، برقم 4671، وابن عساكر، 35/ 260، والديلمي في الفردوس، 5/ 288، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 4009. (2) البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2657، وتقدم تخريجه.
(1/331)
ومنها: استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعًا أخطر عاقبة من القنابل الذرية، والهزات الأرضية، قال تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} (1)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ» (2)» (3). _________ (1) سورة الإسراء، الآية: 16. (2) أحمد، 1/ 178، برقم 1، وأبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، برقم 4340، والترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، برقم 2168، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم 4005، والبيهقي، 10/ 91، وابن حبان، 1/ 540، برقم 305، ومسند البزار، 1/ 135، برقم وأبو يعلى، 1/ 118، برقم 128، وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح، برقم 5142، وتخريج المختارة، 54 - 58، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1564، وصحيح ابن ماجه، 3236. (3) انظر: عودة الحجاب، 3/ 125 - 142 بتصرف.
(1/332)
المبحث الثالث: السفور
المطلب الأول: تعريف السفور لغة وشرعاً
أولاً: السفور لغة: كشف الوجه، يقال: «سفرت المرأة وجهها: إذا كشفت النقاب عن وجهها، ويقال: سفرت المرأة عن نقابها تسفره سفوراً، فهي سافرة: جلّته، وسمي السَّفَرُ سَفَراً؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافياً منها» (1). ويقال: سفرت المرأة سفوراً: كشفت وجهها، فهي سافر، بغير هاء (2). ثانياً: السفور اصطلاحاً: هو كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب عنها. وقيل: خروج المرأة أمام الرجال الأجانب بغير حجاب (3). والتعريف المختار: السفور: هو كشف المرأة وجهها، وإظهاره أمام الرجال الأجانب، واللَّه تعالى أعلم. _________ (1) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة (سفر)، 4/ 368 - 370. (2) المصباح المنير للفيومي، 1/ 279. (3) معجم لغة الفقهاء للروَّاس، مادة (سفور)، ص 219.
(1/333)
المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة: 1 - قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1). فقد فسَّرَ بعض السلف: كابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وأبي الجوزاء، وإحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي، وغيرهم، قولَه تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2) بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب (أي أطراف الأعضاء)، وما قد يبدو معها كالخاتم ونحوه (3)، فإن في إخفاء ذلك من الحرج ما لا يخفى، فبقي الوجه والكفان داخلين في عموم ما يُحظَرُ كشفه، وعليه فلا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة، كالمعالجة، وتحمُّل الشهادة (4). فقد أخرج ابن جرير بإسناد صحيح إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: هي الثياب» (5). _________ (1) سورة النور، الاية: 31. (2) سورة النور، الآية: 31. (3) انظر: تفسير ابن جرير، 18/ 92 - - 93، وتفسير ابن كثير، 3/ 283. (4) انظر: تفسير البيضاوي، 2/ 62، والمغني لابن قدامة الحنبلي، 7/ 460، ومغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين، 3/ 128. (5) انظر: تفسير ابن جرير، 18/ 92، وأخرج نحوه - - أيضًا - - عبد الرزاق، 3/ 204، وابن أبي شيبة، 4/ 283 بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير، 9/ 228، والحاكم، 2/ 397 من طريقه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(1/334)
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي لا يُظهرنَ شيئًا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من الِمقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه، ونظيره في زِيِّ النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه، وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم» (1). وبعد أن أورد ابن عطية اختلافَ أهل العلم في قَدرِ ما يظهر من الزينة، قال: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في كل ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابدَّ منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه، ويقوي ما قلناه: الاحتياط، ومراعاة فساد الناس، فلا يُظَنُّ أن يُباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه» (2). أي: ما يظهر عند حركتها، أو إصلاح شأن من شؤونها، ونحو ذلك. 2 - قال اللَّه - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ _________ (1) تفسير ابن كثير، 3/ 283. (2) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)، 10/ 488 - 489.
(1/335)
وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} (1) فسر بعض الصحابة والتابعين إدناء الجلباب بستر الوجه، وهذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وعَبِيدة السلماني، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وغيرهم. 3 - فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «أمَرَ اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجْنَ من بيوتهنَّ في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهنَّ بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة» (2). - وقال محمد بن سيرين: «سألتُ عَبيدة السَّلماني عن قول اللَّه - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} (3)، فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى» (4). 4 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «لمَّا نزلت: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) أخرجه ابن أبي حاتم، 10/ 3154، والطبري، 20/ 324، وانظر: تفسير ابن كثير، 3/ 283، وقال الشيخ الألباني: « ... الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صحَّ هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد اللَّه بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذا، ولكنه ضعيف الإسناد أيضًا، لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم، جلباب المرأة المسلمة، ص59، والحمد للَّه». (3) سورة الأحزاب، الآية: 59. (4) أخرجه الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، 20/ 325، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم، 10/ 3155، كما في الدر المنثور، 12/ 143، وهو في تفسير ابن كثير، 3/ 283.
(1/336)
جَلَابِيبِهِنَّ} (1) خرج نساء الأنصار كأنَّ على رؤوسهنَّ الِغربان من الأكسية» (2). لهذا قال الجصَّاص: «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار العفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيَبِ فيهن» (3). وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، في تفسيرها أيضًا: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، لا تتشبهْنَ بالإماء في لباسهن إذا هنَّ خَرجْنَ من بيوتهنَّ لحاجتهنّ، فكشفْنَ شعورهنّ ووجوههنّ، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرِضَ لهنَّ فاسق - إذا عَلِمَ أنهنَّ حرائر - بأذًى من قول» (4). 5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في قول اللَّه تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} برقم 4101، وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره، 10/ 3154، الصنعاني في تفسيره، 2/ 123، والجصاص في أحكام القرآن، 3/ 372، وأورده السيوطي في الدر المنثور، 5/ 221 من رواية عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، من حديث أم سلمة بلفظ: « ... من أكسية سود يلبسنها، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 3456، جلباب المرأة المسلمة، ص 84. (3) أحكام القرآن، 3/ 458. (4) جامع البيان، 22/ 33.
(1/337)
لَمَّا أَنْزَلَ اللَّه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (2). قال الحافظ ابن حجر: «قَوله: فاختَمَرنَ: أَي غَطَّينَ وُجُوهَهُنَّ؛ وصِفَة ذَلِكَ أَن تَضَع الخِمار عَلَى رَأسها، وتَرمِيه مِنَ الجانِب الأَيمَن عَلَى العاتِق الأَيسَر، وهُو التَّقَنُّع، قالَ الفَرّاء: كانُوا فِي الجاهِلِيَّة تُسدِل المَرأَة خِمارها مِن ورائِها، وتَكشِف ما قُدّامها، فَأُمِرنَ بِالاستِتارِ» (3). وقال أيضًا في كتاب الأشربة: «ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها» (4). 6 - وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ, قَالَتْ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَذَكَرَتْ نِسَاءَ قُرَيْشٍ وَفَضْلَهُنَّ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ لِنِسَاءِ قُرَيْشٍ لَفَضْلاً, وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ, وَلا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ، لَقَدْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} انْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِنَّ فِيهَا, وَيَتْلُو الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ, وَعَلَى كُلِّ ذِي قَرَابَتِهِ, مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا الْمُرَحَّلِ، فَاعْتَجَرَتْ بِهِ تَصْدِيقًا وَإِيمَانًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ, فَأَصْبَحْنَ يُصَلِّينَ وَرَاءَ رَسُولِ _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، برقم 4758. (3) فتح الباري (8/ 490). (4) فتح الباري (10/ 48).
(1/338)
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ مُعْتِجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ» (1). والاعتجار في لغة العرب: هو لفُّ الخمار على الرأس مع تغطية الوجه. قال ابن الأثير: «وفي حديث عبيد الله بن عديّ بن الِخيار: «جاء وهو معتجر بعمامته، ما يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه»: الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه، ويردَّ طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه» (2). 7 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت في حديث قصة الإفك: « ... فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ، مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ [فأدلج] (3)، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي» (4). _________ (1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، 8/ 2575، وبنحوه أبو داود، كتاب اللباس، باب في قول اللَّه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، برقم 4102، وانظر: فتح الباري، 8/ 490، وعزاه السيوطي في الدر المنثور، 5/ 42 إلى أبي داود، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. اهـ. وقال الشيخ الألباني: «وفي سنده الزنجي بن خالد، واسمه مسلم، وفيه ضعف، لكنه قد توبع عند ابن مردويه في تفسيره، كما في تخريج الكشاف، للزيلعي، ص435 - مخطوط»، [جلباب المرأة المسلمة ص: 80]. (2) النهاية لابن الأثير، 3/ 185، مادة (عجر)، ومجمع بحار الأنوار، 3/ 523. (3) من الدلجة - بلاضم-: وهو السير في أول الليل. (4) البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، برقم 4141، واللفظ له، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، برقم 2770.
(1/339)
8 - وعن أسماء بنت أبي بكر - رحمه الله - قالت: «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَامِ» (1). 9 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» (2). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا مما يدلُّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن» (3). وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي: «وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعوَّدْنَ الانتقاب ولبسَ القفازين عامة، فنُهينَ عنه في الإحرام» (4). 10 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ _________ (1) أخرجه ابن خزيمة، 4/ 203، برقم 2690، والحاكم، 1/ 454، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، والحقُّ أنه على شرط مسلم وحده؛ لأن في إسناده زكريا بن عديّ، وقد روى له البخاري في غير صحيحه، كما في تهذيب التهذيب، 3/ 331، وصححه محقق صحيح ابن خزيمة، 4/ 202، والألباني في إرواء الغليل، 4/ 212. (2) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1838. (3) مجموع الفتاوى، 15/ 371 - - 372، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص/ 17، طبع دار المعارف، وتفسير سورة النور، ص/ 56. (4) الحجاب (ص / 369).
(1/340)
رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» (1). 11 - ومما يشهد لذلك ما رواه البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: «خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ جَارِيَةٌ لِفُلاَنٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِيهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ - رحمه الله - فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الأَمَةَ، وَتُجَلْبِبِيهَا وَتُشَبِّهِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ، حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقَعَ بِهَا، لاَ أَحْسَبُهَا إِلاَّ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ، لاَ تُشَبِّهُوا الإِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ» (2). قال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي: «وفيه دليل على أَنَّ المرأة تستر وجهها في غير حالة الإحرام» (3). _________ (1) أخرجه أحمد، 40/ 21، برقم 24021، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، برقم 1835، واللفظ له، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، برقم 2935، والبيهقي، 5/ 48، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وتكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به، وقال الحافظ في التلخيص الحبير، 2/ 272: «وأخرجه ابن خزيمة، وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - - وهي جدتها - - نحوه، وصححه الحاكم». وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، وتقدم تخريجه مطولاً في أدلة الحجاب. (2) أخرجه البيهقي، 2/ 226، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 111، وسكت عليه بما يفيد أنه مقبول عنده على عادته - رحمه الله -، وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 6/ 204: «قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات، غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد اللَّه الحربي، وهو صدوق كما قال الخطيب، 10/ 303، وقال البيهقي عقبه: «والآثار عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك صحيحة». (3) إعلاء السنن، 10/ 223.
(1/341)
12 - وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ابن عون، عن محمد، عن عبيدة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} (1)، فَلَبسَها عندنا ابن عون، قال: وَلبسها عندنا محمد، قال محمد: ولَبِسها عندي عَبيدة، قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطّى أنفه وعينه اليسرى، وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبًا من حاجبه، أو على الحاجب» (2). وإسناده في غاية الصحة (3). _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) تفسير ابن جرير، 20/ 325. (3) والقائلون بجواز كشف الوجه قالوا: تظهر وجهها وكفيها. وحَدُّ الوجه: من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولًا، وما بين شحمتي الأذنين عرضًا. وأظهر ما استدل به هذا الفريق على ما ذهب إليه، الأدلة الآتية: 1 - قول اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31]. فقد ذهب من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر. ومن التابعين: سعيد ابن جبير، وعطاء، وعكرمة، والضحاك، وأبو الشعثاء، وإبراهيم النخعي وغيرهم، إلى أن ما ظهر منها هو: الوجه والكفان. وعلى هذا التأويل يكون معنى الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره، وهو الوجه والكفان [تفسير ابن جرير، 18/ 93 - 94، وتفسير ابن كثير، 3/ 283، وقد أخرج أثر ابن عباس مرفوعًا بسند جيد: ابن أبي حاتم، والبيهقي، وإسماعيل القاضي، كما في عون المعبود شرح سنن أبي داود، 11/ 162]. =
(1/342)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري بعد استقصائه لما قيل في الآية: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك - إذا كان كذلك -: الكحل والخاتم والسوار والخضاب» [تفسير ابن جرير، 18/ 94]. كما استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بالأحاديث الآتية: 2 - فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ» [صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 885]. فقد ذهب هذا الفريق إلى أنه لو لم تكن هذه المرأة كاشفة عن وجهها، لما استطاع الراوي أن يصفها بأنها سفعاء الخدين. 3 - وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ... [البخاري، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، برقم 5126، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... ، برقم 1425]. فقد ذهب هذا الفريق إلى أنه لو لم تكن هذه المرأة كاشفة عن وجهها لما صعَّد الرسول - صلى الله عليه وسلم - النظر إليها وصوَّبه، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة [فتح الباري، 9/ 210]. 4 - وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» [البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم 1513، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما، أو للموت، برقم 1334]. =
(1/343)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = فقد استدل هذا الفريق بهذا الحديث على أن سترَ وجهِ المرأة ليس فرضًا عليها؛ حيث لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الخثعمية بستره، بل اكتفى بتحويل وجه الفضل عنها. قال ابن بطال: «في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أُمنتِ الفتنة لم يمتنع .. ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُحوّلْ وجه الفضل حتى أَدْمَنَ النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه .. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لَأمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية بالاستتار ولما صَرَف وجه الفضل .. وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء» [فتح الباري، 11/ 10]. 5 - وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». [سنن أبي داود، كتاب كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، برقم 4106، والبيهقي، 8/ 163، وفي معرفة السنن له أيضاً: 3/ 144، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2045، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية، 1/ 123: وأخرجه ابن عديّ، وقال: رواه خالد مرة أخرى، فقال: عن أم سلمة، وعن قتادة مرفوعًا: «إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»، وهذا معضل، أخرجه أبو داود في المراسيل، وعزاه ابن كثير في تفسيره، 3/ 283، نحو هذا إلى أبي حاتم الرازي]. فهذا نص واضح - لو صحَّ الحديث - على جواز إظهار المرأة وجهها وكفيها، لكن لا يغفل عن قول القائلين بذلك يشترطون أن لا يكون عليها شيء من الزينة، ولا يحصل بذلك فتنة [انظر: حجاب المسلمة، للبرازي، ص 147]. ورد القائلون بتحريم سفور وجه المرأة، ووجوب تغطيته بما يأتي: 1 - إن قول هذا الفريق بجواز كشف الوجه مشروط بأمن الفتنة، وحيث يغلب على الظن وجودها، فضلًا عن تحققها، فيحرم - حينئذ - كشفه. [انظر: أحكام القرآن للجصاص، 3/ 289، والدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين، 5/ 244، ومجمع الأنهر، 1/ 81، وأحكام القرآن لابن العربي، 3/ 1357، ومواهب الجليل، 1/ 499، وجواهر الإكليل، =
(1/344)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = 1/ 186، والروض المربع، 1/ 140، وكشاف القناع، 1/ 309]. وقال الشيخ محمد علي السايس: «وينبغي أن يكون القول بهذا خاصًا بالحالات التي تؤمنُ فيها الفتنة، وفي الأوقات التي يكثر فيها الفساق في الأسواق والطرقات، فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة عن وجهها، ولا أن تبدي شيئًا من زينتها» [تفسير آيات الأحكام، 3/ 162]. ويستأنس في هذا بما رواه ابن هشام، عن ابن إسحاق في سبب إجلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهود بني قينقاع عن المدينة، مِن أنَّ امرأة من العرب قَدِمت بِجَلَبٍ [وهو ما يجلب إلى السوق ليباع من إبل وغنم، وغير ذلك] لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبَت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سَوْءَتُها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديًا. إلخ القصة. [السيرة النبوية لابن هشام، 3/ 51، وعنه ابن كثير في السيرة، 3/ 6، وفي إسناد هذه القصة بعض اللين، لكن يشهد لها أحاديث صحيحة في ستر النساء وجوههن، لا مجال للطعن فيها]. 2 - أما أثر ابن عباس الذي احتجوا به، فقد رواه الطبري، 18/ 119، والبيهقي، 2/ 182، و7/ 86، وإسناده ضعيف جدًا، بل منكر، ولا يُحتج بمثله. قال الشيخ عبد القادر بن عبد اللَّه السندي: «قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31]، قال: الكحل والخاتم [أي موضعهما]. وإسناده ضعيف جدًا، بل هو منكر. قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد اللَّه الضبي الكوفي الملائي الأعور، عن أنس وإبراهيم النخعي. وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج اِلمزّي في ترجمة مسلم بن كيسان الملائي: «روى عن سعيد بن جبير، وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد ابن جبير [تهذيب الكمال، 7/ 663]». ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح، قال الفلاس: متروك الحديث، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال البخاري: =
(1/345)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = يتكلمون فيه، وقال يحيى أيضًا: زعموا أنه اختلط، وقال يحيى القطان: حدثني حفص بن غياث، قال: قلت لمسلم الملائي: عمن سمعتَ هذا؟ قال: عن إبراهيم، عن علقمة، قلنا: علقمة عمَّن؟ قال: عن عبد اللَّه، قلنا: عبد اللَّه عمن؟ قال: عن عائشة، وقال النسائي: متروك الحديث» [ميزان الاعتدال، 4/ 106]. وقال الإمام الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، 2/ 225، و7/ 852: «أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: ما في الكفِّ والوجه». وقال الشيخ منصور بن إدريس البهوتي - رحمه الله -: «{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها، رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود» [كشاف القناع، 1/ 243]. وإسناده مظلم ضعيف، لضعف راويين هما: أـ أحمد بن عبد الجبار العطاردي: قال الإمام الذهبي: «أحمد بن عبد الجبار العطاردي: رَوى عن أبي بكر بن عياش وطبقته، ضعَّفهُ غير واحد. قال ابن عديّ: رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولا أرى له حديثًا منكرًا، إنما ضعَّفوه لأنه لم يَلْقَ الذين يحدث عنهم. وقال مطين: كان يكذب. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابنه عبد الرحمن: كتبتُ عنه وأمسكتُ عن التحديث عنه لِمَا تكلم الناس فيه. وقال ابن عديّ: كان ابن عُقدة لا يحدث عنه، وذكر أن عنده قِمَطرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحد، مات سنة 72» [ميزان الاعتدال، 1/ 112]. وقال الحافظ في التقريب: «ضعيف» [تقريب التهذيب، 1/ 19. ب - وكذا يوجد في هذا الإسناد عند الإمام البيهقي: عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز المكي، عن مجاهد وغيره، قال الحافظ الذهبي: ضعَّفهُ ابن معين، وقال: وكان يرفع أشياء. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن المديني: كان ضعيفًا (مرتين) عندنا. وقال أيضًا: ضعيف. وكذا ضعَّفهُ النسائي [ميزان الاعتدال، 2/ 503]. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب، 1/ 450]. قلت [القائل البرازي]: هذان إسنادان ساء حالهما إلى حَدٍّ بعيد لا يُحتجُّ بهما، ولا يُكتبان، =
(1/346)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة، وبذلك يمكن أن يُقال: إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما -، ولو صحَّ الإسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء الحديث، فكيف في هذه الحال؟ وقد صحَّت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإلى غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - بعكس هذا المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في سننه، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره. زد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كما سوف يأتي مفصلًا من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب والستر. وإليكم أولًا ما جاء عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، ومنهم: عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، 18/ 119إذ قال - رحمه الله -: «حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: «{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31] قال: الثياب» [وقد رواه ابن أبي شيبة، والحاكم من طريقه، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في: التلخيص]. قلت: إسناده في غاية الصحة. وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره، 2/ 283. * ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسنادًا آخر بقوله: «حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه مثله. قلت: إسناده في غاية الصحة. * وقال الإمام السيوطي - رحمه الله - في الدر المنثور، 5/ 42: «أخرج ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وكحل العينين، ثم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم { .. لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31]، ثم قال: «والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، وأما خلخالها ومعضدها، ونحرها، وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها». =
(1/347)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = ورواية ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه قد اطلعتُ على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره، ورجالها كلهم ثقات، إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة المتوفى سنة 143 هـ، يَروِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عنهما ولم يلقَه، والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي - وهو إمام كبير، ثقة، ثَبْتٌ، كما لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية - أعني: رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - - إذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة وإن كانت ليست على شرطه في الجامع الصحيح [البخاري في الجامع الصحيح [فتح الباري، 8/ 207، و228، و265]، قال ذلك: الحافظُ في التهذيب [تهذيب التهذيب، 7/ 340]. وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال، 5/ 480 مشيرًا إلى رواية التفسير هذه في ترجمة علي بن أبي طلحة: «هو مرسل عن ابن عباس، وبينهما مجاهد»، واعتمد على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل، 4/ 4909ي، والإمام القرطبي في تفسيره [14/ 243]، وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة، فكانت قوية ومحتجًا بها عند علماء التفسير وغيرهم، وإن ظاهر القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين تؤيدها، فليعتمد عليها، ويستأنس بها» [عودة الحجاب، 3/ 266] نقلاً عن رسالة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 21 - 26. فقد ظهر من هذا التحقيق ضعف ونكارة ما ينسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - من تفسيره {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31] بالكحل، والخاتم، أي موضعهما، وهو الوجه والكفان، سواء بسند الإمام ابن جرير الطبري، أو بسند الإمام البيهقي، هذا بالإضافة إلى الأسانيد الأخرى التي هي في درجتها من الضعف والنكارة. كما ثبت في المقابل صحة أثر ابن مسعود الذي فسر {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالثياب، لا الوجه والكفين؛ وكذا الرواية التي وردت برجال ثقات عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس نفسه التي تخالف روايته الضعيفة الأولى بل المنكرة التي لم يعد هناك مستند صحيح للاعتماد عليها بعد بيان ضعفها ونكارتها، فلزم المصير إلى روايته الأخرى التي لا تخرج عن رواية ابن مسعود ومن وافقه، - رضي الله عنهم - أجمعين. 3 - وأما ما رواه جابر: «فقامت امرأة من سِطَةِ النساء، سفعاء الخدين» ... فقد أجاب بعضهم بأن الحادثة وقعت قبل أن يفرض الحجاب، وبالتالي لا حجة فيها على جواز كشف الوجه، والدليل على ذلك: أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من =
(1/348)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = الهجرة، وآية الحجاب من سورة الأحزاب نزلت - كما ذكر الحافظ ابن حجر - عن أبي عَبِيدة وطائفة في ذي القعدة سنة ثلاث، وعند آخرين: فيها سنة أربع، وصححه الدمياطي، وقيل: بل كان فيها سنة خمس [انظر: فتح الباري، 8/ 462]. ولو صحَّ أنها وقعت بعد أن فُرِض الحجاب، فلا ضير عليها في ذلك؛ لأنها في مجلس علم مع المعصوم - صلى الله عليه وسلم -، يضاف إلى ذلك أن الحافظ ابن حجر وآخرين قد ذكَروا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَحرُمُ عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل العصمة، بخلاف غيره [انظر: فتح الباري، 9/ 210، وسبل السلام، 3/ 112، وفتح العلام، 2/ 90]. وقال أيضًا: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أَنَّ من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - الخلوة بالأجنبية، والنظر إليها [انظر: فتح الباري، 9/ 203، ونقله الشوكاني في نيل الأوطار، 6/ 189، طبع دار التراث، لكنه قال: والذي صحَّ لنا .. وانظر إن شئت الخصائص الكبرى، 2/ 247 248 للسيوطي، باب اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن .. ويُحتمل أن تكون عجوزًا لا تُخشى الفتنة من كشف وجهها؛ لكونها ممن لا يرجون نكاحًا؛ ولو فرضنا أنها كانت شابة، ففيها من سَفع خديها ما يرجح عدم رغبة الرجال فيها، مما يجعلها في حكم القواعد من النساء. ويُحتمل - أيضًا - أن يكون جلبابها انحسر عن وجهها من غير قصد منها، فَروَى جابر ما رآه منها في تلك الحالة، يدل على ذلك أن سبعة من أجلاء الصحابة رَوَوا ذلك الحديث، ولم يَصِفْها واحد منهم بما وصفها به جابر - رضي الله عنه -، وهذا يؤكد أنه انفرد عن بقية الرواة بوصف وجهها، مما يقوي احتمال انحسار غطائه من غير قصد منها، ورؤيته إياه أثناء ذلك. كما لم يذكر أيُّ راوٍ منهم كشفًا لوجهِ أيِّ امرأة ممن حضر تلك الخُطبة رغم كثرتهن؛ لهذا قال الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحه لرواية عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما -: «لا يَدري حينئذٍ من هي»، معناه: لكثرة النساء، واشتمالهن ثيابهن لا يَدري من هي» [شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 172]. 4 - ويجاب عن حديث الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - بما يلي: أـ ليس في هذا الحديث حجة للقائلين بجواز كشف الوجه؛ لأنه لا يلزم من قول الراوي: «صعَّد النظر إليها» أنها كانت كاشفة الوجه. قال الحافظ ابن حجر: «فصعَّد النظر إليها وصوَّبه» وهو بتشديد العين من: «صعَّد»، والواو من «صوَّب». =
(1/349)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = والمراد: أنه نظر أعلاها وأسفلها. والتشديد: إما للمبالغة في التأمل، وإما للتكرير، وبالثاني جزم القرطبي في المفهم، قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا. ووقع في رواية الفضيل بن سليمان: «فخفَّض فيها البصر ورفَّعه»، وهما بالتشديد أيضًا» [فتح الباري، 9/ 206]. فلما كان التصويب: النظر إلى أسفلها، لزم منه أن يكون قطعًا إلى مستور؛ لأن سُوقَ النساء الحرائر عورة بإجماع المسلمين، فكذلك «التصعيد» مثله، لابدَّ وأن يكون إلى مستور أيضًا استصحابًا للحال، خاصة وأن ستر الوجه كان عمل الأمة منذ نزول آيات الحجاب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: « ... استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات، لئلا يراهن الرجال». ونَقلَ أيضًا عن الغزالي أنه قال: «لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات» [فتح الباري، 9/ 337، ومثله في إرشاد الساري، 8/ 117 - - 118، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 8/ 62 - - 63، وانظر هذا النص في مصدره الأصلي: إحياء علوم الدين، 2/ 47]. فمن ادَّعى كشف وجه المرأة الواهبة نفسها أَعْوزَه هذا الادِّعاء إلى الدليل الناطق بذلك، ودونه خرط القتاد؛ أو يلزمه - حينئذ - القول بأن أسفلها كان مكشوفًا كأعلاها، ولا قائل به. ولمَّا كان الأمر على هذا، فكيف أجاز أولئك التفريقَ بين متلازمَين - أعني بهما: التصويب والتصعيد - مع أنهما في حديث واحد؟!! ولمَّا كان مجيزو كشف الوجه يقولون بستر أسفلها، فإنه يلزمهم - أيضًا - القول بستر أعلاها - أي وجهها -، وبالتالي: لم يبقَ لهم في هذا الحديث حجة؛ لأن اللغة تشهد أن منطوقه ومفهومه خارجان عن دائرة النزاع. ب - وعلى فرض أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها، فقد جاءت تعرض نفسها على النبي - صلى الله عليه وسلم - للزواج منها، ولها - في هذه الحالة - أن تكشف وجهها ليتأمله، فيُفصحَ عن رغبته فيها، أو عزوفه عنها. ج - ومن جهة أخرى، فإن ذلك خصوصية للرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات =
(1/350)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = الأجنبيات، لمكان العصمة، بخلاف غيره [فتح الباري، 9/ 210، وسبل السلام، 3/ 112، وفتح العلام، 2/ 90. د - على أن ابن العربي سلك مسلكًا آخر في الجواب - وإن استبعده الحافظ في الفتح - فقال: «يحتمل أنَّ ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها متلفِّعة» [فتح الباري، 9/ 210]. وكون ذلك بعد الحجاب وهي متلفعة أولى؛ لأنَّ تصويب النظر قد كان قطعًا على مستور، فكذلك التصعيد مثله، فلا يقتضي أنها مكشوفة الوجه. بهذه الإجابات المتعددة يظهر أنه لا حجة لمجيزي كشف الوجه بهذا الحديث، ويبقى انتقاب النساء هو الأصل الذي استمرَّ عليه عمل المسلمات المؤمنات منذ القرون الأولى التي شهد لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخير. 5 - كما أجاب القائلون بلزوم ستر الوجه عن عدم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الخثعمية بستر وجهها، واكتفائه بتحويل وجه الفضل إلى الشق الآخر بأنها كانت محرمة، والمحرمة تكشف وجهها إلا عند خوف الفتنة. وحين استدل ابن بطّال بهذا الحديث على «أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء» تعقَّبَهُ الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادَّعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة» [فتح الباري، 11/ 10]. غير أن الشيخ ناصرًا الألباني ردَّ على ابن حجر قوله هذا بما لا يغني فقال: «قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكأنَّ الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه - رحمه الله -. ثم هب أنها كانت مُحْرِمَة؛ فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه ... » [حجاب المرأة المسلمة، ص 29]. ويجاب على هذا الكلام الذي أورده الألباني من نواحٍ عدة: أـ أما قوله: «لا دليل على أنها كانت محرمة؛ بل الظاهر خلافه» فإنه لا يصح، لمصادمته عدة أحاديث تثبت أن المرأة كانت محرمة، منها: =
(1/351)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = - ما رواه مسلم في صحيحه، عن جابر - رضي الله عنه - « ... فلما دفع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، مَرَّت به ظُعُنٌ تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن ... » الحديثَ [مسلم، برقم 1218]. - وما رواه النسائي في سننه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن امرأة من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - غداةَ جمع ... » الحديثَ [النسائي، برقم 2635]. وتؤيد روايةَ النسائي هذه: «غداةَ جمع» روايتا ابنِ ماجه، برقم 3024، والحميدي، 1/ 235] ولفظهما: « ... غداةَ النحر .. » الحديثَ. - ومما يؤكد أن سؤالها وقع وهي مُحْرِمة، إخبار الفضل نفسه أن نظره إلى المرأة الخثعمية كان أثناء المسير من جَمْعٍ - أي المزدلفة - إلى مِنى. فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عن أخيه الفضل، قال: «كنت رديف رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من جَمْع إلى مِنى؛ فبينما هو يسير إذ عَرَض له أعرابي مُردفًا ابنةً له جميلة، فكان يسايره، قال: فكنتُ أنظر إليها ... » الحديث، برقم 1791. وفي لفظ آخر لأحمد، برقم 1805، عن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من المزدلفة، وأعرابي يسايره، وَرِدْفُهُ ابنةٌ له حسناء، قال الفضل: فجعلتُ أنظر إليها، فتناول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بوجهي يصرفني عنها، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة». فإذا ضممنا روايات الحديث المتقدمة بعضها إلى بعض في هذه الواقعة الواحدة، أفادت: - أَنَّ سؤال الخثعمية كان غَداةَ جمع، كما في حديث ابن عباس المتقدم عند النسائي. - وأن الفضل بن العباس كان ينظر إليها عندما كانت تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث ابن عباس الآخر عند النسائي. - وأن نظر الفضل إلى تلك المرأة كان بيقين عند الدفع من جَمْع - أي المزدلفة - كما في حديث جابر عند مسلم. - وأن ذلك النظر كان - بالتحديد - أثناء المسير من المزدلفة إلى مِنى، كما في حديث ابن عباس عن أخيه الفضل من رواية الإمام أحمد. فقد دلَّت هذه الروايات على أنَّ سؤال الخثعمية، ونظر الفضل إليها كانا بيقين عند المسير من المزدلفة إلى مِنى، مما يدل دَلالة قاطعة على أنهما كانا قبل الرمي، أي قبل التحلل من الإحرام. =
(1/352)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = فلما ثبت من هذه الدلائل أنها كانت مُحْرِمَة بيقين، ظهر منها أن كشف وجهها، وعدم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها بستره، إنما كان بسبب إحرامها. ب - وأما قوله: « ... فقد قدَّمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل .. » فهي من محاولات الألباني لإثبات أنها لم تكن مُحْرمة، والذي يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر يجد أنه لم يجزم بذلك، بل حكاه على سبيل الاحتمال في الجزء الرابع في كتاب جزاء الصيد من فتح الباري حيث قال: «ويُحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» [فتح الباري، 4/ 67]. لكنه عَدَلَ عن هذا الاحتمال بما جَزَم به في الجزء الحادي عشر في: «كتاب الاستئذان» من فتح الباري، 11/ 10: أنها كانت مُحْرِمَة كما تقدم. ج - وأما قوله: « .. ثم هَبْ أنها كانت مُحْرِمَة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة، ذلك لأن المُحْرِمَة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسَّدل عليه ... » فإنه غير مُسلَّم به، لثبوت الأدلة المتعددة على وجوب الستر لغير المحرمة، كما تقدم ذكرها. وبهذا الإيضاح تتداعى كافة الشبهات التي يتعلق بها مجيزو كشف الوجه استنادًا على هذا الحديث الذي لا ينهض حجة لدعواهم. أما الذين يُصِرُّون على أن سؤال الخثعمية إنما وقع بعد رمي جمرة العقبة أي بعد التحلل، ولا تقنعهم كافة الحجج بأن إحرامها كان سببًا في كشف وجهها، فنقول لهم: لو سلَّمنا لكم - جدلًا - بما تقولون، فلا ضير عليها في ذلك؛ لأن أباها كان يعرضها على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها. ومما يدل على ذلك، ما رواه الفضل بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: «كنتُ رِدْفَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رجاءَ أن يتزوجها، وجعلتُ ألتفتُ إليها، ويأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - عنقه فيَلْويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» [رواه أبو يعلى، برقم 6731، بإسناد قوي، كما في: فتح الباري، 4/ 68، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 4/ 277: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». وبهذا البيان يتضح لكل منصف أنه لا حجة بهذا الحديث للقائلين بكشف الوجه، سواء كانت المرأة الخثعمية الكاشفة عن وجهها مُحْرِمَة أم لا؛ لأنها إذا كانت مُحْرِمَة فكشفها عن وجهها بسبب إحرامها، وإن كانت حلالًا فكشفُ وجهها لعرضِ أبيها إياها على =
(1/353)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رجاءَ أن يتزوجها. 6 - كما أجاب هذا الفريق عن حديث أسماء الذي رَوَتهُ عائشة: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يَصلُحْ أَنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه»، بأنه ضعيف لا يُحتج به، للأمور الآتية: (أ) الإرسال: فقد قال أبو داود، رقم الحديث 4106، بعد روايته للحديث: «هذا مرسل، خالد بن دُرَيْك لم يُدرِكْ عائشة». ونقل الحافظ الزيلعي، نصب الراية، 1/ 299، عن أبي داود مثله، ثم قال: «قال ابن القطان: «ومع هذا فخالد مجهول الحال». (ب) وفي سند الحديث سعيد بن بشير، وهو ضعيف عند نقاد الحديث، فقد قال يعقوب بن سفيان: سألتُ أبا مسهر عنه فقال: «لم يكنْ في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث» .. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان حاطبَ ليل، وقال الميموني: «رأيت أبا عبد اللَّه يُضَعِّفُ أمره»، وقال الدوريُّ وغيره عن ابن معين: «ليس بشيء»، وقال عثمان الدارميُّ وغيره عن ابن معين: «ضعيف». وقال عليُّ بن المديني: «كان ضعيفًا»، وقال محمد بن عبد اللَّه بن نمير: «منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقويِّ الحديث، يروي عن قتادة المنكرات»، وقال البخاري: «يتكلمون في حفظه وهو محتمل»، وقال النسائي: «ضعيف». وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقويِّ عندهم»، وقال ابن عديّ: «له عند أهل دمشق تصانيف، ولا أرى بما يرويه بأسًا، ولعله يَهَمُ في الشيء بعض الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق»، وقال السَّاجي: «حَدَّثَ عن قتادة بمناكير»، وقال الآجُرِّيُّ عن أبي داود: «ضعيف»، وقال ابن حبان: «كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يَروي عن قتادة ما لا يُتابعَ عليه، وعن عمرو بن دينار ما لا يُعرفُ من حديثه» [انظر: تهذيب التهذيب، 4/ 10]. فأنت ترى أن أئمة النُّقاد وجمهورهم اتَّفقوا على ضعفه وجرحه ومنهم: ابن معين، وابن المديني، وغيرهما، وحسبك بهما حجة في هذا المجال. وابن مَعين: هو إمام الجرح والتعديل، روَى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد بن =
(1/354)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = حنبل، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وخلائق آخرون، وقد قال الإمام أحمد: «كان يحيى بن معين أَعلمَنا بالرجال»، وقال عبد الخالق بن منصور: «قلتُ لابن الرومي: سمعت بعض أصحاب الحديث يُحدِّث بأحاديث يحيى بن معين، ويقول: حدَّثني مَن لم تطلع الشمس على أكبر منه، فقال: وما يُعَجِّب؟ سمعت ابن المديني يقول: «ما رأيت في الناس مثله»، وقال العِجلي: «ما خلق اللَّه تعالى أحدًا كان أعرف بالحديث من يحيى بن معين». [انظر: تهذيب التهذيب، 11/ 280 - - 288]. - - وأما ابن المديني: فهو شيخ البخاري، وقد أقرّ له بالعلم والتمكن البالغ، وقال فيه: «ما استصغرتُ نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وكان أعلم أهل عصره، وقال النسائي: كأنَّ اللَّه - عز وجل - خلق عَلِيَّ بنَ المديني لهذا الشأن». [انظر: تهذيب التهذيب، 7/ 351، و352]. أما توثيقُ ابنِ عَدِيٍّ لسعيد بن بشير بعض التوثيق، فلا يُلتَفتُ إليه في مقابل جرح جمهور جهابذة النقد له، فالحديث - عدا عن إرساله - ضعيف لا يسوغ الاستدلال به في هذا المقام. والذين ضعَّفوا سعيد بن بشير - وهم جمهور النَّقَدة - قد بيَّنوا سبب الجرح، فصار قولُهم المقدَّمَ فضلًا عن أنهم الجمهور، وقد قال السيوطي في شرح التقريب: «إذا اجتمع فيه - أي الراوي - جرحٌ مفسَّر، وتعديل، فالجرح مقدَّمٌ ولو زاد عدد المُعَدِّل، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء؛ لأنَّ مع الجارح زيادةَ علم لم يطَّلعْ عليها المعدِّل، ولأنه مصدِّقٌ للمعدِّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمرٍ باطن خفي عنه» [تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 1/ 309]. (ج) وفي حديث عائشة السابق عنعنة بعض المدلسين، مثل: الوليد بن مسلم، وقَتادة بن دِعامة السَّدوسي، وليس في روايتهما تصريح بالسماع. والصحيح في المدلِّس - كما قال ابن الصلاح - التفصيل: فإن صَرَّحَ بالسماع قُبل، وإن لم يُصرّح بالسماع فحُكمُهُ حكمُ المرسل. قال الزين: وإلى هذا ذهب الأكثرون» [انظر: تنقيح الأنظار المطبوع مع توضيح الأفكار، 1/ 352 - - 353. * أما الوليد بن مُسْلم، فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: «ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية» [تقريب التهذيب، 2/ 236. أما «تدليس التسوية»: فهو أن يسقط الراوي من =
(1/355)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = سنده غير شيخه لكونه ضعيفًا، أو صغيرًا، ويأتي بلفظ محتمل أنه عن الثقة الثاني تحسينًا للحديث، وهو شرّ أقسامه». وقال الذهبي - أيضًا - في ترجمته: «الإمام الحافظ، عالم أهل دمشق، ولد سنة تسع عشرة ومائة؛ صنَّف التصانيف والتواريخ، وعُنيَ بهذا الشأن أتمَّ عناية، قال أحمد بن حنبل: ما رأيتُ في الشاميين أعقلَ منه، وقال ابن جوصاء: لم نزل نسمع أنه مَن كتبَ مصنفات الوليد صَلَحَ أن يلي القضاء، وهي سبعون كتابًا. وقال أبو مُسْهِر وغيره: كان الوليد مُدَلِّسًا، وربما دلَّس عن الكذابين. وبعد أن نقل الذهبي أقوالًا أخرى في توثيقه والثناء عليه، قال: «لا نزاعَ في حفظه وعلمه، وإنما الرجل مُدَلس، فلا يُحتجُّ به إلا إذا صَرَّح بالسماع» [انظر: تذكرة الحفاظ، 1/ 302 - - 304، وانظر - - إن شئت - - أيضًا ميزان الاعتدال، 4/ 347 - - 348، وتهذيب التهذيب، 11/ 151 - - 155. وقال أيضًا: «إذا قال الوليد: عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد؛ لأنه يُدَلِّسُ عن كذابين، فإذا قال: حَدَّثنا، فهو حجة» [ميزان الاعتدال، 4/ 348، وانظر: توضيح الأفكار، 1/ 354]. * وأما قتَادة بن دِعامة السَّدوسي: فقد قال ابن حِبَّان في ترجمته: « ... كان من علماء الناس بالقرآن والفقه، وكان من حفاظ أهل زمانه، جالَسَ سعيد بن المسيّب أيامًا، فقال له سعيد: قم يا أعمى، فقد نَزَفْتَني ... مات بواسط على قَدَرٍ فيه سنة سبع عشرة ومائة، وهو ابن ست وخمسين سنة، وكان مُدَلِّسًا». [انظر: الثقات لابن حبان، 5/ 321]. وترجم له الحافظ صلاح الدين العلائي في: جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص 312، ووصفه بأنه: «أحد المشهورين بالتدليس». وقال الحافظ الذهبي في ترجمته: «حافظ ثقة ثبت، لكنه مدلس، ورُميَ بالقَدَر، قاله: يحيى بن معين؛ ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لاسيَّما إذا قال: حَدَّثنا» [ميزان الاعتدال، 3/ 385]. وترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، 8/ 355 ترجمة طويلة، ثم قال: «وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، حجة في الحديث، وكان يقول بشيء من القَدَر، وقال هَمَّام: «لم يكن قتادة يلحن» ثم ذكر قولَ ابنِ حِبَّان السابق ذكره. =
(1/356)
ثانياً: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور: __________ = وإذا قال قائل: كيف تغمز حديث أسماء بنت أبي بكر، المروي في سنن أبي داود، بعنعنة الوليد بن مسلم، وقتادة بن دِعامة السدوسي مع أنهما من رُواةِ الصحيحين؟ قلت: إنَّ عنعنة المدلِّسين مقبولة في الصحيحين وشبههما، لما سيأتي بيانه، أما في غيرهما فيحكم عليها بالتفصيل الذي تقدم ذكره عن ابن الصلاح، وهو أنَّ المدلِّس إذا صرَّح بالسماع قُبِل، وإن لم يُصَرِّح بالسماع فحكمه حكم المرسل، قال الزين: وإلى هذا ذهب المتأخرون. ففي تقريب النووي، وشرحه للسيوطي: « ... فما رواه بلفظ محتمِل لم يبين فيه السماع فمرسل لا يُقبل، وما بُيّن: كسمعتُ، وحدثنا، وأخبرنا، وشبهها، فمقبول يحتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة، والسفيانين، وغيرهم: كعبد الرزاق، والوليد بن مسلم؛ لأن التدليس ليس كذبًا، وإنما هو ضرب من الإيهام؛ وهذا الحكم جارٍ - كما نص عليه الشافعي - فيمن دلَّسَ مرة واحدة. وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى، وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع؛ لكونها على شرطه دون تلك، وفصَّل بعضهم تفصيلًا آخر فقال: إن كان الحامل له على التدليس تغطيةَ الضعيف فَجرح؛ لأنَّ ذلك حرام وغش، وإلا فلا» [تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 1/ 229 - - 230، وانظر: - - أيضًا - - تنقيح الأنظار، 1/ 353 - - 356]. وبناء على ما تقدم: فحديث أسماء الذي رواه أبو داود: ضعيف؛ لعنعنة الوليد بن مسلم، وقَتادة بن دِعامة السدوسي، وهما وإن كانا ثقتين، إلا أنهما مُدَلِّسان، ولم يُصَرِّحا بالسماع. ومن كان على هذه الحالة لا يُقبل حديثه ما لم يُصرِّحْ بالسماع، أو يَرْوِهِ صاحبا الصحيحين وشبههما، كما تقدم تفصيله. د) كما صحَّ عن عائشة - رضي الله عنها - العمل بخلاف ذلك، وقولها بوجوب ستر الوجه والكفين لغير أمهات المؤمنين [انظر: كتاب حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، للدكتور فؤاد البرازي، ص 143 - 176 بتصرف، وانظر: ص 179 - 198 من كتابه هذا].
(1/357)
نقل الإجماع العملي في منع خروج النساء سافرات الوجوه جمع غفير من علماء الإسلام (1) الذين أمدَّهم اللَّه - عز وجل - بالعلم النافع _________ (1) من مميزات هذا القرن، من جهة المسائل الفقهية: ظهور الجدل والتأليف في مسألة كشف وجه المرأة، وهذا بعكس القرون السابقة، حيث انحصر البحث في بطون الكتب: الفقهية، والحديثية، والتفاسير، لم تكن جدلاً في المنتديات، ولا دعوة على المنابر، ولم تؤلف فيها مؤلفات مستقلة، كلا، بل كان العالم يعرض رأيه فيها، ثم يمضي لغيرها، دون إغراق في مناقشة المخالف، أو تعمق وفحص، وكان العلماء فيها على قولين: - الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بما فيهن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضوان اللَّه عليهن. - الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضوان اللَّه عليهن، فعليهن التغطية. وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمن أمرين مهمين هما: - الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف، فحكم الاستحباب فوق حكم المباح. في المباح: يستوي الفعل والترك، لكن في الاستحباب: يفضل فعل المستحب. - الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطاً، هو: أمن الفتنة، والفتنة هي: حسن المرأة، وصغر سنها (أن تكون شابة)، وكثرة الفساق، فمتى وجدت إحداها فالواجب التغطية. وبهذا يعلم أن تجويزهم الكشف مقيد غير مطلق، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بأفضلية التغطية، وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء .. !!. وقد التزم المستحبون ذلك الشرط، وذلك التفضيل، فانعكس على مواقفهم: - فأما الشرط، فالتزامهم به، أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوال، فأوجبوا التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة، فالموجبون أوجبوها في كل حال، والمستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على هذا الحكم في هذا الحال .. هذا بالأصل، وذاك بالشرط. - وأما التفضيل، فالتزامهم به منعهم من السعي في: نشر مذهبهم، والدعوة إليه، وحمل النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف، فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!! .. ترتب على ذلك أثر مهم هو: إجماع عملي، تمثل في منع خروج النساء سافرات، فلم يكن لاختلافهم العلمي النظري أثر في واقع الحال .. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء .. !!. فمخلص أقوالهم: - ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق الأزواج .. وإجماع على التغطية حال الفتنة .. وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات. - وإيجاب على الجميع، بما فيهن الأزواج، في كل حال. - واستحباب على الجميع دون الأزواج، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية. هذه المذاهب في هذه المسألة .. وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري، يمحوه اتفاق عملي، فانعكس على أحوال المسلمات، فلم تكن النساء يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرناً، عمر الخلافة الإسلامية، حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء [انظر: الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة للدكتور لطف الله، ص 5 - 7.
(1/358)
والرسوخ في العلم على النحو الآتي: 1 - أبو حامد الغزالي، وقد عاش في القرن الخامس (توفي 505هـ)، في الشام والعراق، الذي قال في كتابه: «ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات» (1). 2 - الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع حيث نقل في كتابه: [روضة الطالبين] الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر إلى المرأة: «والثاني: يحرم، قاله الإصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من _________ (1) انظر: عودة الحجاب، 3/ 407. و [إحياء علوم الدين، في الباب الثالث في آداب المعاشرة، وما يجري في دوام النكاح، كتاب آداب النكاح، 1/ 729].
(1/359)
الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية» (1). 3 - ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره: (البحر المحيط): «وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة» (2). 4 - ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال: «استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال» (3). وقال ابن حجر: أيضاً: «ولَم تَزَل عادَة النِّساء قَدِيمًا وحَدِيثًا يَستُرنَ وُجُوههنَّ عَن الأَجانِب» (4). 5 - ابن رسلان، الذي حكى: «اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق» (5) (6). _________ (1) انظر: عودة الحجاب، 3/ 407. [5/ 366 - 367]، وذكر هذا أيضاً: الشربيني في مغني المحتاج» [3/ 407]. (2) البحر المحيط، 7/ 250. وانظر: عودة الحجاب، 3/ 407. (3) فتح الباري، 9/ 337. وانظر: عودة الحجاب، 3/ 407. (4) فح الباري، 9/ 324. (5) عون المعبود، في اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها، 12/ 162. (6) انظر: الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة، للدكتور لطف اللَّه خوجه، ص 5 - 7 بتصرف.
(1/360)
6 - وقال الشيخ تقي الدين الحصني: «النظر قد لا تدعو إليه الحاجة، وقد تدعو إليه الحاجة. الضرب الأول: أن لا تمسَّ إليه الحاجة، فحينئذٍ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقًا، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففيه خلاف، والصحيح التحريم، قاله الإصطخري، وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني. ووجَّههُ الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات ... » (1). 7 - وقال الخطيب الشربيني في شرحه على متن المنهاج: « ... وَوَجَّهَهُ الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه» (2). 8 - وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي عند شرحه لحديث أسماء: «والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه. أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن _________ (1) كفاية الأخيار، 2/ 75. (2) مغني المحتاج، 3/ 128 - 129، ونحوه في فتح العلام بشرح مرشد الأنام، 1/ 41 - 42.
(1/361)
يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. قاله ابن رسلان» (1). 9 - وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود: «إن المرأة إذا بلغت لا يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى إظهاره، للحاجة إلى معاملة، أو شهادة، إلا الوجه والكفين، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف من الفتنة فلا. ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره» (2). 10 - وقال الخطيب: «وَكَذَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا عِنْدَ الْأَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ - كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ-، وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ، وَبِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ» (3). 11 - وقال الشوكاني عند حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»: فيه دليل لمن قال إنه يجوز نظر الأجنبية - يعني وجهها وكفيها -. ثم قال: قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه. _________ (1) عون المعبود، 11/ 162. (2) بذل المجهود، 16/ 431. (3) حاشية البجيرمي على الخطيب، 10/ 63.
(1/362)
أما عند خوف الفتنة، فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفُساق .. » (1). 12 - وقال الشيخ يوسف الدجوي: « ... أما إذا خشيت الفتنة، ولم يؤمن الفساد، فلا يجوز كشف وجهها، ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء» (2). 13 - وقال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا، تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء» (3). 14 - ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح، والكاندهلوي في أوجز المسالك، والزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك، عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، قالت: «كنا نُخَمِّرُ وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر - تعني جدتها -، _________ (1) نيل الأوطار، 6/ 130. (2) مقالات وفتاوى الدجوي، 2/ 543. (3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 15/ 108، وسيأتي ما ورد عن أسماء فيما يلي أثناء كلام ابن حجر.
(1/363)
قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا كما جاء عن عائشة قالت: «كنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا مرَّ بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعناه» (1) (2). ثالثاً: المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب ذهب كثير من المفسرين إلى وجوب ستر الوجه، نشير هنا إلى أسماء بعضهم، مع الإشارة إلى المواضع التي صرحوا فيها بذلك، ليرجع إليها من شاء. فمن هؤلاء المفسرين: الرازي (3)، والبيضاوي (4)، والجلال المحلي (5)، والنسفي (6)، والزمخشري (7)، والقرطبي (8)، والقاسمي (9)، والبقاعي (10)، _________ (1) فتح الباري، 3/ 406، وأوجز المسالك، 6/ 196 - 197، وشرح الزرقاني على الموطأ، 2/ 234، والحديث تقدم تخريجه. (2) حجاب المسلمة، للدكتور فؤاد البرازي، ص 231 - 234 بتصرف. (3) تفسير الرازي، 25/ 230. (4) تفسير البيضاوي، 2/ 135. (5) تفسير الجلالين، 3/ 455 بهامش حاشية الجمل. (6) تفسير النسفي، 4/ 182. (7) تفسير الكشاف، 3/ 274. (8) تفسير القرطبي، 14/ 243. (9) محاسن التأويل، 13/ 4908. (10) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 15/ 411 - 412.
(1/364)
والآلوسي (1)، والإيجي (2)، والجصاص (3)، والصاوي (4)، والجمل (5)، وأبو بكر بن العربي (6)، والنيسابوري (7)، وابن جزي (8)، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي (9)، ومحمد الأمين الشنقيطي (10)، وحسنين محمد مخلوف (11)، وأبو الأعلى المودودي (12)، وغيرهم (13). رابعاً: المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب كثيرون لا يحصر عددهم، ولكن منهم يأتي: 1 - أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} الآية .. إلى قوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (14). _________ (1) روح المعاني، 22/ 89. (2) جامع البيان في تفسير القرآن، 2/ 273. (3) أحكام القرآن، 3/ 372. (4) حاشية الصاوي على الجلالين، 3/ 288. (5) الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل، 3/ 455. (6) أحكام القرآن، 3/ 1586. (7) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 22/ 32. (8) التسهيل لعلوم التنزيل، 3/ 144. (9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 6/ 247. (10) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 6/ 586 - 587. (11) صفوة البيان لمعاني القرآن، ص 537. (12) الحجاب، ص 302 - 303، وتفسير سورة الأحزاب، ص 161 - 163، وص 165 - 167. (13) انظر: حجاب المسلمة، للبرازي، ص 235. (14) سورة النور، الآيتان: 30 - 31.
(1/365)
أمر اللَّهُ سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر، وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعًا بالتوبة، وأمر النساء خصوصًا بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه اللَّه تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة: هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد، وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يُعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول. وقد ذكر عَبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح: «أن المرأة المحرمة تُنهى عن الانتقاب والقفازين»، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمْن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقد نهى اللَّه تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره، فقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} (1)، وقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2)، فلما نزل ذلك عمد _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) سورة النور، الآية: 31.
(1/366)
نساء المؤمنين إلى خمرهن فشُققن، وأرخينها على أعناقهن. و «الجيب» هو شق في طول القميص، فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها. وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها، والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت، فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل بصفية قال أصحابه: «إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه، فضرب عليها الحجاب .. وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن» (1). وقال أيضًا بعد كلام طويل نافع: «لو كان في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجال فتنة للرجال، لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهًا، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه ... ثم قال: « ... وكذلك المرأة مع المرأة، وكذلك محارم المرأة: مثل ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها، ومملوكها عند مَن يجعله مَحْرَمًا: متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب، بل وجب. _________ (1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 15/ 371 - 372، حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة، ص 15 - 18 طبع مكتبة المعارف بالرياض.
(1/367)
وهذه المواضع التي أمر اللَّه بالاحتجاب فيها مَظنَّةُ الفتنة؛ ولهذا قال تعالى: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} (1)، فقد تحصُلُ الزكاة والطهارة بدون ذلك، لكن هذا أزكى. وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة، لما يوجد في ذلك من شهوة القلب، واللذة بالنظر، كان تركُ النظر، والاحتجابُ أَوْلى بالوجوب» (2). ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: «الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب» (3). ج- وقال أيضًا: «وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كان في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذٍ فتصلي في بيتها وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا» (4). _________ (1) سورة النور، الآية: 30. (2) مجموع فتاوى ابن تيمية، 15/ 374 - 378 باختصار. (3) مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 114، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص 6 (طبع مكتبة المعارف). (4) مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 115، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص 7 (طبع مكتبة المعارف بالرياض).
(1/368)
د - ثم قال: «ولهذا أُمرت المرأة أن تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نُهيت عن إبداء ذلك للأجانب، ولم تُنْهَ عن إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم. فعُلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، التي يُنهى عنها لأجل الفحش، وقبحِ كشف العورة، بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهي عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشة، كما قال في الآية: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} (1)، وقال في آية الحجاب: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2)، فنُهي عن هذا سدًّا للذريعة، لا أنه عورة مطلقًا لا في الصلاة ولا غيرها ... ». إلى أن قال: «وكنَّ نساء المسلمين يصلينَ في بيوتهن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وبيوتهنَّ خير لهن» (3)، ولم يؤمَرْنَ مع القُمُص إلا بالخُمُر، لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه، ولم تؤمر بما يغطي رجليها: لا خُف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها: لا بقفازين ولا غير ذلك، فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب» (4). _________ (1) سورة النور، الآية: 30. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53. (3) أخرجه مسلم، برقم 442، أحمد، برقم 9645، وأبو داود، برقم 565، وتقدم تخريجه. (4) مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 117 - 119، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص 11 - 13 طبع مكتبة المعارف، باختصار.
(1/369)
هـ - وقال أيضًا في موضع آخر: «وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى وليّ الأمر: الأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن هذا المنكر وغيره؛ ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره». ووأما عن تغطية وجهها وهي محرمة، فقد قال: «ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل: إنه كرأس الرجل فلا يُغطى. وقيل: إنه كَيدَيْهِ، فلا يُغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ إلا عن القفازين والنقاب. وكُنَّ النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعُلمَ أن وجهها كيدي الرجل، ويديها: وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها ويديها، لكنْ بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار» (1). 2 - الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: نصَّ الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في مواضع عدة من كتبه على وجوب ستر المرأة وجهها، نجتزئ منها ما يلي: _________ (1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 117 - 120، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص 14 - 15.
(1/370)
أ- قال في إعلام الموقعين: «وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة، وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، فأين حَرَّم اللَّه هذا وأباح هذا؟!! واللَّه سبحانه إنما قال: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (1)، ولم يطلق اللَّه ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال. وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب، وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك؛ لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن، فأين أباح اللَّه ورسوله لهن أن يكشفن وجوهن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس، وأذِنَ للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة. وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالباً كالبطن والظهر والساق، فظن أن ما يظهر غالباً حكمه حكم وجه الرجل. وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر، فإن العورة عورتان: عورة في النظر، وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس» (2). _________ (1) سورة النور، الآية: 30. (2) إعلام الموقعين عن رب العالمين، 2/ 80.
(1/371)
ب- وقال أيضًا أثناء كلامه عن أثر كشف المرأة وجهها في وقوع الافتتان بها: « ... ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال، فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن، فيقع الافتتان» (1). جـ- وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة، فقد ذكر في كتابه: بدائع الفوائد سؤالًا عن كشف وجه المرأة في حال إحرامها، وجواب ابن عقيل عليه، ثم تعقبه بقوله: «سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لها كشف الوجه في الاحرام، ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل. ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُردْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء، وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يزاد على موجب النص، ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؟ فأي نص اقتضى هذا، أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل، يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع، بل وكَيَدِهَا يحرم سترها _________ (1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص 67 ..
(1/372)
بالمفصَّل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكُمّ، وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم يُنْهَ عنه البتة. ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم، فليس معه بذلك نص ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس المحرم لِمَا جعل اللَّه بينهما من الفرق. وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى، أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها كبدن الرجل، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه، فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك، وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة - رحمه الله -: «كنّا إذا مَرَّ بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها»، ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب، كما قاله بعض الفقهاء، ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملاً ولا فتوى، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهن يعرفه الخاص والعام. ومن آثر الإنصاف، وسلك سبيل العلم والعدل، تبين له راجح المذاهب من مرجوحها، وفاسدها من صحيحها، واللَّه الموفق والهادي» (1). _________ (1) بدائع الفوائد، 3/ 142 - 143.
(1/373)
د- وقال أيضاً: «ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» يعني في الإحرام، فسوّى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه البتة. ونساؤه - صلى الله عليه وسلم - أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كُنَّ يُسْدِلْن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفْنَ وجوههن. وروى وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرِّشْك، عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة - رحمه الله -: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها ... ثم ذكر ابن قيم الجوزية قول طائفة منعت المحرمة من تغطية وجهها، وردَّ عليهم، ثم قال: «فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة، مع أمرِ اللَّه لها أن تدني عليها من جلبابها، لئلا تعرف ويُفتتن بصورتها» (1). هـ- وقال أيضًا: «وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه، كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوَّى بين وجهها _________ (1) إعلام الموقعين، 1/ 222 - 223.
(1/374)
ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب. ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفَصَّل على قدرهما، وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء، وهذا واضح بحمد اللَّه. وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه» (1). 3 - الإمام الصنعاني - رحمه الله -: نص الأمير الصنعاني - رحمه الله - على وجوب ستر المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب؛ فقد قال عند حديث: «لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار»: «لابُدَّ في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها، كما أفاده حديث الخمار، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها، كما أفاده حديث أم سلمة (2). _________ (1) تهذيب السنن، 2/ 350، والحديث أخرجه أحمد، برقم 24021، وأخرجه أبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني: «حسن في الشواهد» وتقدم تخريجه. (2) والحديث المشار إليه هو ما أخرجه أبو داود بسنده عن أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - " «أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها»، [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم 640]، وقد صحح الأئمة وقف هذا الحديث، بينما ضعفه الألباني مرفوعاً وموقوفاً كما في ضعيف سنن أبي داود، برقم 99.
(1/375)
ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها، فكلها عورة» (1). * وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة، فقد قال: «واعلم أن المصنف - يعني به الحافظ ابن حجر - لم يأتِ بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة، والذي يَحرمُ عليها في الأحاديث: الانتقاب، أي لبس النقاب، كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين، فيحرم عليها النقاب، ومثله: البرقع، وهو الذي فُصِّلَ على قدر ستر الوجه؛ لأنه الذي ورد به النص، كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقًا، فكذلك المرأة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب. ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المُحْرِم لا يُغطَّى بشيء، فلا دليل معه ... » (2). 4 - الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله - فقد قال عند كلامه عن شروط الصلاة: «ويباح كشف وجهها حيث لم يأتِ دليل بتغطيته، والمراد _________ (1) سبل السلام، 1/ 131. (2) سبل السلام، 2/ 191.
(1/376)
كشفه عند صلاتها بحيث لا يراه أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة» (1). ونستنتج من كلام الصنعاني، وصديق حسن خان، أنه: - يباح للمرأة كشف وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي، حيث لم يأت دليل بتغطيته. - أما خارج الصلاة فكلها عورة، لا يجوز ظهور شيء منها، ولا نظر الأجنبي إليها. ـ يحرم على المرأة المُحْرِمة ستر وجهها بالنقاب والبرقع، وتغطي وجهها بغير ما ذُكر كالخمار والثوب عند مرورها بالرجال، أو مرور الرجال بها. 5 - الشيخ محمد بن علي الشوكاني: ذهب الشوكاني - رحمه الله - إلى أن للمرأة ستر وجهها وهي محرمة عند مرور الرجال قريبًا منها. فقد قال عند حديث: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه»، قال: «تمسك به أحمد، فقال: إنما لها أن تُسدل على وجهها من فوق رأسها، واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها؛ فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، _________ (1) فتح العلام، 1/ 97.
(1/377)
لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكنْ إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم. وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم -» (1). (2). خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة: منهم من قال بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب، ومنهم من قال باستحباب ستر وجهها عن الرجال الأجانب عند أمن الفتنة، أما عند خشية الفنة فيجب عند جميع العلماء، والتفصيل على النحو الآتي: 1 - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها. وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم، استنادًا إلى الحديث الصحيح: «المرأة عورة» (3). ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة، لكنهم قالوا بوجوب _________ (1) انظر: نيل الأوطار، 5/ 6. (2) انظر: حجاب المرأة المسلمة، ص 218 - 230. (3) الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، 1685، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.
(1/378)
سترهما لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن. فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما، وحرمة كشفهما؛ لذا نقل الإمام النووي، والتقي الحصني، والخطيب الشربيني، وغيرهم عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه (1). 2 - دَلَّت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض، وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور الرجال الأجانب بها عند البعض الآخر، وما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم رغم كونها محرمة. لهذا قال الحافظ ابن عبد البر: «أجمعوا أنَّ لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها - أي وهي محرمة بنحو خمار - إلا ما ذكرنا عن أسماء» (2). (3). _________ (1) انظر: روضة الطالبين، 7/ 21، وكفاية الأخيار، 2/ 75، ومغني المحتاج، 3/ 128 - 129، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى. (2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 15/ 108. (3) انظر: حجاب المسلمة، للدكتور محمد فؤاد البرازي، ص 215 - 216. وانظر: عودة الحجاب للمقدم، ص 417 - 434، والاستيعاب فيما قيل في الحجاب، 156 - 233.
(1/379)
المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة
المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً
أولاً: الخلوة بالمرأة بدون محرم لغة: يقال: خلا المكان، والشيء يخلو خلوَّاً، وخلاءً، وأخْلى إذا لم يكن به أحد، ولا شيء فيه، وهو خالٍ ... ويقال: خلا الرجل وأخلى: وقع في موضعٍ خالٍ لا يُزاحم فيه، ويقال: وخلت الدار خلاءً: إذا لم يبقَ فيها أحدٌ، ويقال: ووجدت فلانة مُخليةً: أي خالية (1). ويقال: خلا المنزل من أهله، يخلو خلوَّاً، وخلاءً، فهو خالٍ، وأخلى بالألف لغةٌ، فهو مُخْلٍ، وأخليته: جعلته خالياً، ووجدته كذلك، وخلا الرجل بنفسه، وأخلى بالألف لغةٌ، وخلا بزيد خلوةً: انفرد به، وكذلك خلا بزوجته خلوةً، ولا تسمى خلوة إلا بالاستمتاع ... فإن حصل معها وطء فهو الدخول ... (2). ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً: أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه في غيبةٍ عن أعين الناس (3). _________ (1) لسان العرب لابن منظور، مادة «خلا»، 14/ 237 - 238. (2) المصباح المنير للفيومي، مادة «خلا»، 1/ 180. (3) عودة الحجاب، للمقدم، 3/ 45.
(1/380)
المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم
ثبتت الأحاديث الصحيحة في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بغير محرم، ومنها الأحاديث الآتية: 1 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (1). 2 - وحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» الحديث (2)، وهذا يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو مسنين، وجميع النساء ولو كن صالحات أو عجائز. 3 - حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (3). _________ (1) رواه البخاري، كتاب الحج، باب حج النساء، برقم 1862، وكتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له، برقم 3006، وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، برقم 5233، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341. (2) أخرجه أحمد، 1/ 268، برقم 114، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم 1171، وقال: «حسن صحيح غريب». والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، 2/ 635،برقم 607،والحاكم، 1/ 114،وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، والضياء المقدسي في المختار، 1/ 295، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 215. (3) مسند أحمد، 23/ 19، برقم 14651، والمعجم الكبير للطبراني، 11/ 191، برقم 11462، قال محققو المسند، 23/ 19: «حسن لغيره، وبعضه صحيح»، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، 6/ 215: «وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وعنعنة أبي الزبير، لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد تقويه».
(1/381)
4 - عن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ» (1). 5 - وعنه - رضي الله عنه - قال: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ» (2). 6 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ» (3). 7 - وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ» (4). _________ (1) مسند أحمد، 29/ 357، برقم 17824، وابن حبان، 12/ 397، برقم 5548، وأبو يعلى، 13/ 275، برقم 7348، وبنحوه في مصنف بن أبي شيبة، 4/ 409، برقم 17955، وقال محققو المسند، 9/ 357: «حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الشيخين»، وصححه لغيره الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 8/ 146، برقم 5557. (2) رواه أحمد في المسند، 29/ 341، برقم 17805، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج، برقم 2780، واللفظ له، وقال: «حسن صحيح»، والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 90، ومسند أبي يعلى، 13/ 270، 7341، ومصنف ابن أبي شيبة، 4/ 409، 17955، وقال محققو المسند، 29/ 341: «حديث صحيح بطرقه وشواهده»، وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف، 176 - 177. (3) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2173. (4) مسند أحمد، 22/ 226، برقم 14324، والمعجم الأوسط، 9/ 14، برقم 8984، وسنن الدارمي 2/ 411، برقم 2783، وقال محققو المسند، 22/ 227: «وقد جمع مجالد في هذا المتن ثلاثة أحاديث، وهي صحيحة، الأول: «لا تلجوا على المغيبات»، والثاني: «إن الشيطان يجري من أحدكم مَجْرى الدم»، والثالث: «لكن اللَّه أعانني عليه فأَسلم»، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، برقم 935.
(1/382)
وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبيلًا إلى سهولة الدخول عليها، أو الخلوة بها، كابن العم وابن الخال مثلاً؛ ولذلك حذرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك لأنه من مداخل الشيطان، ومسارب الفساد. 8 - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (1)، والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة، فبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن. وقد حكى الإجماعَ على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء منهم النووي، وابن حجر العسقلاني. قال النووي - رحمه الله -: «كَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاث وَنَحْو ذَلِكَ، فَإِنَّ وُجُوده كَالْعَدَمِ، وَكَذَا لَوْ اِجْتَمَعَ رِجَال بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّة فَهُوَ حَرَام» (2). قال النووي - رحمه الله -: «وَوَافَقَ مَالِكٌ عَلَى ذَلِكَ كُلّه إِلَّا اِبْن زَوْجهَا، _________ (1) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، برقم 5232، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليها، برقم 2172. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 109.
(1/383)
فَكَرِهَ سَفَرهَا مَعَهُ لِفَسَادِ النَّاس بَعْد الْعَصْر الْأَوَّل؛ وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاس لَا يَنْفِرُونَ مِنْ زَوْجَة الْأَب نَفْرَتهمْ مِنْ مَحَارِم النَّسَب، قَالَ: وَالْمَرْأَة فِتْنَة إِلَّا فِيمَا جَبَلَ اللَّه تَعَالَى النُّفُوس عَلَيْهِ مِنْ النَّفْرَة عَنْ مَحَارِم النَّسَب، وَعُمُوم هَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَى مَالِك» (1). لَا يَأْمَنَنَّ عَلَى النِّسَاءِ أَخٌ أَخَا ... مَا فِي الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ أَمِينُ إنَّ الْأَمِينَ وَإِنْ تَحَفَّظَ جَهْدَهُ ... لَا بُدَّ أَنْ بِنَظْرَةٍ سَيَخُونُ (2) _________ (1) شرح النووي على صحيح مسلم، 1/ 486. (2) ذكر البيت الأول في كتاب التمثيل والمحاضرة، للثعالبي، ص 49، دون نسبة لأحد، وذكر البيتان في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، 2/ 402، دون نسبة لأحد.
(1/384)
المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية
أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (1). 1 - قال الإمام النووي - رحمه الله -: «في هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، وهذان الأمران مجمع عليهما» (2). 2 - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» (3). 3 - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي - رحمه الله -: «وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق» (4). 4 - وقال الشوكاني - رحمه الله -: «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية» (5) (6). _________ (1) رواه البخاري، برقم 1862، ومسلم، برقم 1341، وتقدم. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 96. (3) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 17. (4) المفهم شرح صحيح مسلم، 5/ 500. (5) نيل الأوطار، 6/ 127. (6) وانظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، للشيخ فريح بن صالح البهلال، ص 135.
(1/385)
المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم
المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحاً
أولاً: السَّفْرُ لغة: جمع سافر، والمسافرون: جمع مسافِرٍ، وسُمِّيَ المسافرُ مسافراً؛ لكشفه قناع الكنِّ عن وجهه، وبروزه إلى الأرض الفضاء، وسمِّي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافياً منها، ويقال: سَفَرتُ أسفرُ سُفوراً: خرجت إلى السفر، فأنا سافر، وقوم سفَرٌ مثل: صاحبٍ، وصحْبٍ، وسُفَّارٍ، مثل: راكب وركّاب، ويجمع السفر على أسفار (1). ثانياً: السفر اصطلاحاً: قطع المسافة، والخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصداً مكاناً بعيداً مسافةً يصح فيها قصر الصلاة الرباعية (2)، واللَّه تعالى أعلم. _________ (1) لسان العرب، لابن منظور، مادة «سفر»، 4/ 368. (2) انظر: معجم لغة الفقهاءـ للدكتور محمد روَّاس، ص 219.
(1/386)
المطلب الثاني: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم
يحرم سفر المرأة بدون محرم لأدلة صحيحة صريحة، منها الأدلة الآتية: 1 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (1). فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم (2)، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها (3). 2 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمةٌ» (4)، وفي لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها»، وفي لفظ له: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم _________ (1) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر هل يؤذن له، برقم 3006، ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1341. (2) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 172. (3) المرجع السابق، 1/ 182. (4) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟، برقم 1088، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1339.
(1/387)
الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 3 - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»، وفي لفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم»، وفي لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» (1). 4 - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها» (2). 5 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (3). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «فإن حُمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل: أي يوم بليلته، أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل المسافة يومًا وليلة» (4). _________ (1) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟، برقم 1086، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1338. (2) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341. (3) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، برقم 5233، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1341. (4) فتح الباري، 2/ 566.
(1/388)
وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله: «لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان (1)، والطائف، وجدة، فإذا قدمت على أهلٍ أو ماشية فأتمَّ» (2). وهذه الأحاديث نصوص من النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصِّص سفراً من سفر، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله، ويهمله، ويستثنيه بالنيّة من غير لفظ، بل قد فهم الصحابة - رضي الله عنهم - دخول سفر الحج في ذلك، لمّا سأله ذلك الرجل عن سفر الحج، وأقرّه على ذلك، وأمره أن يسافر مع امرأته، ويترك الجهاد الذي قد تعيّن عليه بالاستنفار فيه، ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام، وهو أغلب أسفار النساء؛ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد، ولا في التجارة غالباً، وإنما تسافر في الحج، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يُؤمَن فيه البلاء، ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظاً لها، وصايناً، كنسوةٍ ثقات، ورجال مأمونين، ومنعها أن تسافر بدون ذلك، فاشتراط ما اشترطه اللَّه ورسوله أحق، وأوثق، وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحمٌ على وضم (3) _________ (1) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان، 4/ 121. (2) البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 137،وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، 2/ 445، قال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 14: «وإسناده صحيح». (3) الوضم: كل شيء يجعل عليه اللحم يقيه من الأرض.
(1/389)
إلا ما ذبَّ عنه، والمرأة في السفر معرضة للصعود، والنزول، والبروز، محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها، وتحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيِّمٍ يقوم عليهنّ، وغير المَحرَم لا يؤمَن، ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلب، والشيطان بالمرصاد (1). وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « ... ألا لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإيَّاكم والفُرقَة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنتُهُ وساءته سيئتُهُ فذلكم المؤمن» (2)، ولفظ أحمد: « ... ولا يخلونَّ رجل بامرأةٍ فإن ثالثهما الشيطان» (3). ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب منه شر من الذي تخافه على نفسها، وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم ... (4). _________ (1) شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 174 - 179. (2) الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، برقم 2165، وصححه الألباني، في صحيح سنن الترمذي، 2/ 457. (3) مسند الإمام أحمد، 1/ 311، برقم 177، وعبد الرزاق، 11/ 341، برقم 20710، ومسند الشافعي، ص 310، والنسائي في الكبرى، 5/ 387، برقم 3169، والطبراني في الأوسط، 7/ 193، برقم 7249، وقال محققو المسند: «صحيح الإسناد»، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430. (4) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 174 - 179 بتصرف يسير جداً.
(1/390)
وقال الإمام النووي - رحمه الله - بعد أن ساق روايات الأحاديث التي تنهى عن سفر المرأة بغير محرم: « .. وفي رواية أبي داود: «ولا تسافر بريداً» (1)، والبريد مسيرة نصف يوم، قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة، أو البريد، قال البيهقي: كأنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لا، وسُئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا، وسئل عن سفرها يوماً؟ فقال: لا، وكذلك البريد، فأدَّى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن فروى تارةً هذا، وتارةً هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كلِّه تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - تحديد أقل ما يسمَّى سفراً. فالحاصل أن كل ما يُسمَّى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك؛ لرواية بن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، وهذا يتناول جميع ما يسمَّى سفراً، واللَّه أعلم» (2). ومحرم المرأة: هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد: بنسب، _________ (1) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم، برقم 1725، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 7179. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 103 - 104.
(1/391)
أو سبب مباح، وهم على النحو الآتي: أ- من تحرم عليه من النسب: كآبائها وإن علوا، وأبنائها وإن نزلوا، وإخوانها: الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبني إخوتها، وبني أخواتها، وأعمامها وإن علوا، وأخوالها فكلهم محارم لها. ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع: أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها. وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (1). _________ (1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، 1/ 180 - 181.
(1/392)
المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها
تدور شُبه دعاة السفور حول أقوالٍ لا حظ لها من المعنى الذي يمكن أن يتقبَّله العقل السليم؛ لأنها من نوع ما يسميه علماء المنطق بالسفسطة التي لها شكل الحجة، وليست لها حقيقتها. وهي أقوال يُراد بها إخضاع النفس، أكثر مما يراد بها إقناع العقل. هذا فيما يتعلق بالمغرضين من أعداء الدين الذين يتخذون السفور ذريعة لمقاصدهم السيئة، أما الفريق الآخر الذي يبيح السفور بناءً على اجتهاد فقهي مخلص في طلب الحق. أولاً: أغلب ما تعلق به دعاة التبرج والسفور الأمور الآتية: 1 - أحاديث ضعيفة، لا تثبت عند أهل العلم بالحديث. 2 - وقائع أحوال لا عموم لها. 3 - نصوص يفهم منها إباحة السفور، لكنها كانت قبل نزول الحجاب. 4 - نصوص يُفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص فيه، مثل: الخِطبة، والشهادة، والتطبيب، وغيرها، وهذه في الحقيقة تؤيد أن الأصل منع السفور، وإلا لما كان لهذه الاستثناءات معنى (1). _________ (1) انظر: المغني لابن قدامة، 6/ 559.
(1/393)
5 - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال، فيسقط بها الاستدلال (1). ثانياً: الشبه والرد عليها على النحو الآتي: الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يَصلُح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه (2). قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب. والجواب أن في الحديث عللاً قادحة: العلة الأولى: انقطاع سنده، كما صَرَّح بذلك الإمام أبو داود - رحمه الله - نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث: «هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة» (3). وكذا قال أبو حاتم الرازي (4)، وعبد الحق في أحكامه (5). _________ (1) انظر: عودة الحجاب للمقدم، 3/ 335. (2) رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، برقم 4104، والبيهقي في السنن الكبرى، 2/ 226، وفي شعب الإيمان له أيضاً، 10/ 219، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، 3/ 373. (3) سنن أبي داود، 4/ 106. (4) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، 3/ 294. (5) كما في تهذيب التهذيب، 3/ 87.
(1/394)
«وقال ابن معين: مشهور، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي. ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، في أتباع التابعين» (1). وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة يرسل (2). العلة الثانية: أن في سنده سعيدَ بن بشير أبو عبد الرحمن البصري، قال الحافظ: «ضعيف» (3). العلة الثالثة: أن فيه قتادة، وهو مدلس، وقد عنعنه، كما أن فيه الوليدَ بنَ مسلم، قال الحافظ: «ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية» (4)، وقد عنعنه. وعلى فرض صحة الحديث، أو تقويته بشواهده، فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة: الجواب الأول: فمنهم من حمله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وَالسَّلَفُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ: هِيَ الثِّيَابُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ: هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، مِثْلُ الْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ»، ثم بيّن - رحمه الله - أن تشريع الحجاب مرَّ بمرحلتين: _________ (1) المصدر السابق، 3/ 86 - 87. (2) تقريب التهذيب، 1/ 212. (3) المصدر السابق، 1/ 292. (4) المصدر السابق، 2/ 336.
(1/395)
أولاهما: تغطية البدن ما عدا الوجه والكفين. والأخرى: حجاب جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان. ثم قال - رحمه الله - ما نصه: «فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ، وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ، أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ: كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّا تُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ، فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُ إلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ، فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ» (1). إلى أن قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وَعَكْسُ ذَلِكَ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالْقَدَمَانِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تُبْدِيَ ذَلِكَ لِلْأَجَانِبِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ، بَلْ لَا تُبْدِي إلَّا الثِّيَابَ» (2). وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في معرض الرد على من أباح النظر إلى الوجه والكفين محتجاً بحديث أسماء - رحمه الله -: «وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ -إنْ صَحَّ- فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ، فَنَحْمِلُهُ عَلَيْهِ» (3). وقال القاري في شرح هذا الحديث: «قولها: «وعليها ثياب رِقَاق» - بكسر الراء - جمع رقيق، ولعل هذا كان قبل الحجاب» (4). _________ (1) مجموع الفتاوى، 22/ 110 - 112 بتصرف. (2) المصدر السابق، 22/ 117 - 118. (3) المغني، 6/ 559. (4) مرقاة المفاتيح، 4/ 438.
(1/396)
وقد ضعف الشنقيطي - رحمه الله - الحديث، ثم قال: «مَعَ أَنَّهُ مَرْدُودٌ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى عُمُومِ الْحِجَابِ، وَمَعَ أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ ثُبُوتُهُ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْحِجَابِ» (1). وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله -: «لو قُدِّر أن حديث عائشة صحيح، فهو محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب، وبناءً على هذا يكون منسوخاً، لا يجوز العمل به» (2). وقال الشيخ محمد علي الصابوني في روائع البيان: «ويحتمل أنه كان قبل آيات الحجاب، ثم نسخ بها» (3). وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «ثم على تقدير الصحة -أي صحة حديث عائشة - رحمه الله - -يحمل على ما قبل الحجاب؛ لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه» (4) (5). _________ (1) أضواء البيان، 6/ 597. (2) يا فتاة الإسلام، ص 257. (3) روائع البيان، 2/ 157. (4) رسالة الحجاب، ص 30. (5) واعلم أنَّ هناك جملة من الأحاديث والآثار يفهم منها كشف الوجه واليدين أو اليدين فقط، وعادة العلماء الموجبين للحجاب أن يجيبوا عنها بقولهم: «هذا كان قبل الأمر بالحجاب»، ومن أمثلة ذلك: 1 - حديث عائشة هذا الذي نحن بصدده. 2 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -،زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: «دَخَلَتْ عَلَيَّ خُوَيْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةُ، وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا، فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ، مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خُوَيْلَةَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ لهاَ زَوْجَ لَهَا يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَهِيَ كَمَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا، فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا، وَأَضَاعَتْهَا» الحديث أخرجه أحمد، 43/ 335، برقم 26309، وحسنه محققو المسند، كما جوّد إسناده الألباني في إرواء الغليل، 7/ 78، وانظر: الفتح الرباني، 17/ 304. 3 - عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «آخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ... » الحديث، رواه البخاري، كتاب الصوم، بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ، برقم 1968، والمؤاخاة كانت في أوائل الهجرة، وانتهت بعد آية التوريث، وآية التوريث نزلت قبل الحجاب. 4 - ما رواه البيهقي في قصة توبة أبي لبابة، وقال: «حديث صحيح»، وفيه قول أم سلمة - رضي الله عنها -: «أفلا أبشره يا رسول اللَّه بذلك؟ قال: «بلى إن شئتِ»، قالت: فقمتُ على باب حجرتي، فقلت - وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب - يا أبا لبابة أبشر فقد تاب اللَّه عليك». 5 - وعن أَنَسٍ، - رضي الله عنه -، قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ وَيُشْرِفُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لاَ تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تُنْقُزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ»، رواه البخاري في المغازي، باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا واللَّه وليهما، برقم 4064، وفي الجهاد، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، وفي فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب أبي طلحة، ومسلم، في الجهاد، باب غزوة النساء مع الرجال، برقم 1811. مجوب عليه بحَجَفَةْ: أي ساتر له، قاطع بينه وبين الناس، مترس عليه بترس، تنقزان: أي تثبان، والمقصود تحملان القرب، وتقفزان بها وثباً.
(1/397)
الجواب الثاني: ومن العلماء من ذهب إلى وجوب تأويل حديث عائشة - رحمه الله - إن صَحَّ: إذا ثبت لدينا دليل واحد يفيد تحريم كشف الوجه والكفين؛ ثم
(1/398)
فرضنا جدلًا ثبوت حديث عائشة - رحمه الله - الذي يبيح كشفهما؛ وافترضنا أيضا تكافؤ الدليلين من حيث الثبوت؛ وعلمنا أن الأصل في الدليل الشرعي الإعمال لا الإهمال؛ وأن الواجبَ - عند التعارض - أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما؛ لأن إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهما؛ إذن يتعين محاولة الجمع بينهما، وهذا ما فعله فريق من العلماء: قال ابن رسلان في حديث عائشة - رحمه الله -: «والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوها (1)، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق» (2). وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي: «لو ثبت أن حديث عائشة صحيح - مع العلم بأنه لم يثبت - فحينئذٍ كشف المرأة وجهها لرجل أجنبي مقيد ذلك بالحاجة، والضرورة، لا مطلقا» (3). ومقصودهم - واللَّه أعلم - أن المرأة إذا بلغت لم يحلَّ أن يظهر من بدنها شيء؛ لأنها كلها عورة، إلا أن تحتاج، أو تضطر لكشف _________ (1) ومثلها: النظر للمداواة، وللشهادة لها أو عليها، والنظر للمعاملة من بيع أو رهن أو إجارة، أو تعليم، ويشترط لجواز ذلك فقْدُ جنس، ومحرم صالح، وتعذره من وراء حجاب، ووجود مانع خلوة، ويشترط في النظر للتزويج أن يكون بعد العزم على التزوج، ورجاء الإجابة. (2) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار، 6/ 13. (3) يا فتاة الإسلام، ص 258 بهذا السياق.
(1/399)
وجهها وكفيها، فيحلُّ لها ذلك حينئذ بقدره»، أو: «أن المرأة إذا بلغت حلَّ لها أن تُظهر وجهها وكفيها ما لم تُخَفْ الفتنةُ بهما، فإن خيفت الفتنة فعليها ستر ذلك». فإذا قيل: بل يتعين الترجيح؛ لأن التكلف في الجمع بينهما غير خافٍ على من تأمله. فيقال: نحن أسعد بهذا المسلك منكم؛ «إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مُقَدَّم كما هو معروف عند الأصوليين؛ وذلك؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه؛ فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل، وتغييره إياه؛ ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادةَ علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبِت مقدم على النافي، وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتَاً ودلالة» (1). وقد تقدم أن سند الحديث ضعيف، أما من حيث متنه وألفاظهُ فهو معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب، سواء في ذلك عموم آيات الحجاب، أو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله وتقريره، فهل يسوغ أن يؤخذ بظاهرِ حديثٍ هذا حاله، فيكون مخصصًا لكل ما ورد من عموم ألفاظ القرآن، وما صح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفية، وتقريره _________ (1) رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص 28.
(1/400)
لفعل سودة - رضي الله عنهما -؟ أضف إلى ذلك مخالفة لفظه: «لا يصلح أن يُرى منها» لحديث جرير بن عبد اللَّه - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفُجاءة فأمرني أن أصرف بصري» (1). وقد كان إسلام جرير - رضي الله عنه - في رمضان سنة عشر من الهجرة (2). كما أنه مخالف لحال أمهات المؤمنين ونسائهم، وقد قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ عَمِلَ عملا ليسَ عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (3). وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «وأيضًا فإن أسماء - رحمه الله - كان لها حين هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع وعشرون سنة، فهي كبيرة السن، فيبعد أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين، فلابد على تقدير الصحة من أن يحمل على ما قبل الحجاب؛ لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه» (4). _________ (1) مسلم، كتاب الآداب، باب الاستئذان، برقم 2159. (2) أي قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر. (3) مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم 1718، بلفظه، وقد اتفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»، انظر: البخاري، برقم 2697. (4) رسالة الحجاب، ص 30. وإذا كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يهتم بستر المرأة المسلمة منذ أوائل مراحل الدعوة بمكة، وأمر ابنته زينب بتخمير نحرها، فهل يخفى ذلك على المسلمات، بما فيهن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -، وهي التي كان يتردد - صلى الله عليه وسلم -، على بيت أبيها صباح مساء. روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لم أعقل أبوي إلا وهما يَدينان الدين، ولم يمرَّ عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - طرفي النهار بكرة وعشياً ... الحديث. انظر: البخاري، برقم 2297. وعن الحارث بن الحارث الغامدي، قال: «قلت لأبي ونحن بمنى: «ما هذه الجماعة؟»، قال: «هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم»، قال: فنزلنا - وفي رواية: فتشرفنا - فإذا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى توحيد اللَّه والإيمان به، وهم يردون عليه قوله، ويؤذونه، حتى انتصف النهار، وتصدّع عنه الناس، وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي، تحمل قدحًا فيه ماء، ومنديلاً، فتناوله منها، وشرب، وتوضأ، ثم رفع رأسه»، فقال: «يا بنية! خمّري عليك نحركِ، ولا تخافي على أبيك غلبةً ولا ذلاًّ»، قلت: «من هذه؟» قالوا: «هذه زينب ابنته». قال الألباني: «أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن عساكر في تاريخ دمشق». من حجاب المرأة المسلمة ص 35 - 36.
(1/401)
وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله -: « ... وعن محمد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة - رحمه الله -: «ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيَّب ظهور قدميها» (1). وفي رواية لأبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس لها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» (2). _________ (1) رواه مالك في الموطأ، كتاب صلاة الجمعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، 1/ 142، موقوفاً على أم سلمة. وهو عند أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم 639. (2) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم 640، والدارقطني، 2/ 414، والحاكم، 1/ 250، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي، 2/ 233، ضعفه الألباني مرفوعاً وموقوفاً كما في ضعيف سنن أبي داود، برقم 99، وتقدم تخريجه.
(1/402)
فإذا عدَّ القدمين عورة، وأذن لها في الإسبال كي لا تنكشف القدمان، وأمر بعدم الضرب بالأرجل حتى لا يسمع صوت الخلاخل، أو تظهر الزينة الخفية، فإن أمره بتغطية الوجه الذي هو مجمع الحُسْن والفتنة أولى. فهذا من باب «التنبيه بالأدنى على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم»، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص كشف ما هو أعظم منه فتنة؛ فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة اللَّه وشرعه. وأخيرًا: «فإن هذا الحديث لو سلَّمنا صلاحيته للاحتجاج فهو حجة على أهل السفور؛ وذلك لأن هذا نص يقضي بأن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز لها أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحدٍ كائنًا من كان، أباً أو أخاً أو ابناً، أو عماً، أو غيرهم، ومعلوم أن اللَّه قد أذن للمرأة في إبداء الزينة أمام المحارم، ومنع عنه أمام الأجانب، فما هي الزينة التي تبديها أمام المحارم، ولا تبديها أمام الأجانب؟ وبتعبير آخر: لما جاز لها كشف وجهها وكفيها أمام الأجانب، ولم يجز لها كشف شيء من أعضائها سوى الوجه والكفين أمام المحارم، فأي فرق يبقى بين المحارم والأجانب؟ مع أن القرآن ينص على الفرق بينهما في صراحة باتة، فتفكَّر!، ولو قيل: إن هذا نص يجري فيه التخصيص من نصوص أخرى، قلنا: فما لناحيةِ الحجابِ والسفور لا يجري فيها التخصيص
(1/403)
بالنصوص؟!» (1). الشبهة الثانية: ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخلت عَلَيَّ ابنةُ أخي لأمي عبد اللَّه بن الطفيل مزينة، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول اللَّه إنها ابنة أخي وجارية، فقال: «إذا عركت (2) المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا»، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفِّ مثل قبضة أخرى» (3). والحديث في سنده الحسين، وهو سُنَيْد بن داود المِصيصي المحتسب، قال الحافظ في التقريب: «ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يُلَقِّن حجاج بن محمد شيخَه» (4)، وقال الذهبي في الميزان: «حافظ له تفسير، وله ما يُنكَر»، وقال: «صدقه أبو حاتم»، وقال أبو داود: «لم يكن بذلك»، وقال النسائي: «الحسين بن داود ليس بثقة» (5). _________ (1) مسألة السفور والحجاب، لأبي هشام الأنصاري، مجلة الجامعة السلفية، عدد نوفمبر- ديسمبر 1978م، ص 77. (2) عركت: حاضت. (3) أخرجه الطبري، 19/ 157، وقال في الدر المنثور، 11/ 25: «وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن جريج: ... ». (4) تقريب التهذيب، 1/ 335. (5) ميزان الاعتدال، 2/ 236. وانظر ترجمته أيضَاً في تهذيب التهذيب، 4/ 244، والجرح والتعديل، 4/ 326، وتاريخ بغداد، 8/ 42 - 44، وطبقات المفسرين، 1/ 209، وسير أعلام النبلاء، 10/ 627.
(1/404)
كما أن هذا الحديث معضل؛ لأن بين ابن جريج وعائشة - رضي الله عنها - مفاوز، فقد توفي ابن جريج بعد المائة والخمسين، ولم يدرك عائشة - رضي الله عنها -. ونقل الذهبي في الميزان عن عبد اللَه بن أحمد بن حنبل قوله: «قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها»، يعني قوله: أخبِرت، وحُدثت عن فلان» (1). وقال الحافظ في التهذيب: «وقال الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت، جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني، وسمعت فحسبك به،. . . وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقًا، فإذا قال: حدثني، فهو سماع، وإذا قال: أخبرني، فهو قراءة، وإذا قال: «قال» فهو شبه الريح» (2). وقال الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهما» (3). وقال الإمام صلاح الدين العلائي: «يكثر من التدليس» (4). واعلم؛ أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهداً لحديث _________ (1) ميزان الاعتدال، 2/ 659، برقم 5227. (2) تهذيب التهذيب، 6/ 404. (3) المرجع السابق، 6/ 405. (4) جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص 108، برقم 33.
(1/405)
عائشة السابق، وذلك لتخالف متن الحديثين، ولإعضال هذا الحديث كما رأيت (1). الشبهة الثالثة: ما جاء عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ بنت أبي بكر - رضي الله عنها -، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الأَكْمَامِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: تَنَحَّيْ، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرًا كَرِهَهُ، فَتَنَحَّتْ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لِمَ قَامَ؟ قَالَ: «أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا؟ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلاَّ هَكَذَا»، وَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَغَطَّى بِهِمَا ظَهْرَ كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفِّهِ إِلاَّ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلاَّ وَجْهُهُ» (2). _________ (1) وقد تعقب العلامة الألباني الشيخ أبا الأعلى المودودي: في تقويته هذا الحديث بمرسل قتادة، ثم احتجاجه بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس حتى على الأب والأخ وسائر المحارم! غير أن مدار المساجلة كان حول لفظ لم أعثر عليه في مظانه من تفسير ابن جرير، وكلا الشيخين لم يعزه إلى موضعه فيه، واللفظ المشار إليه: عن ابن جريج قال: «خرجت لابن أخي عبد اللَّه بن الطفيل مزينة، فكرهه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنه ابن أخي يا رسول اللَّه، فقال: «إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها إلا ما دون هذا»، وقبض على ذراع نفسه»، وبين الألباني: مخالفة لفظ الحديث لنص القرآن {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية، وفيها: {أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} ثم قال: «فهي - أي الآية - صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها لابن أخيها، فكان الحديث منكرَاً من هذه الجهة أيضًا» حجاب المرأة المسلمة، هامش ص 18. (2) السنن الكبرى، 7/ 86، والطبراني في الأوسط، 8/ 199.
(1/406)
قال البيهقي: «إسناده ضعيف» (1). وعلة هذا الحديث ابن لَهِيعة، واسمه عبد اللَّه الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، وهو ثقة فاضل، لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت، فحدث من حفظه فخلط (2). قال ابن حبان: «سبرت أخباره، فرأيته يدلس على أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم» (3). وقال الألباني: «ضعيف من قبل حفظه» (4)، وقال أيضًا: «وبعض المتأخرين يحسن حديثه، وبعضهم يصححه» (5). ومن حسَّن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي رواه عنها خالد بن دريك، إنما حسنه - رغم انقطاعه - باعتبار حديث أسماء بنت عميس - هذا رغم ضعفه - شاهداً موصولًا له. ولو سلَّمنا بتحسين الحديثين، لكان الجواب عن حديث أسماء هذا كالجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها -، تماما كما تقدم في الشبهة الأولى، والعلم عند اللَّه تعالى (6). _________ (1) السنن الكبرى، 7/ 86. (2) فمن حدث عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة وغيرهم فحديثه قوي، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف، إلا أن يجبره وجه آخر. (3) الضعفاء الصغير، ص 66، والضعفاء والمتروكون، ص 95. (4) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، برقم 319، ورقم 461. (5) حجاب المرأة المسلمة، ص 25. (6) انظر: عودة الحجاب، ص 355.
(1/407)
الشبهة الرابعة: ما جاء في حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ (1)، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ (2)، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»، قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ» (3). فقال من يحتج بالسفور في قول جابر - رضي الله عنه -: «سفعاء الخدين» يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، إذ لو كانت متحجبة لما رأى خديها، ولما علم بأنها سفعاء الخدين. والجواب: أولاً: أن الحديث ليس فيه حجة لأهل السفور، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «وأجيب عن حديث جابر هذا بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآها كاشفة عن وجهها، وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابراً رأى وجهها، _________ (1) سطة النساء: أي جالسة وسطهن. (2) أي: فيهما تغير وسواد. (3) أخرجه البخاري، في مواضع من صحيحه، منها: كتاب العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، برقم 977، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم 4 - (885)، واللفظ له.
(1/408)
وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًا، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال، كما قال نابغة ذبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ... فتناولته واتقتنا باليدِ (1) فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - رآها سافرة، وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك» (2). وقال الشيخ حمود بن عبد اللَّه التويجري - رحمه الله -: «وأما حديث جابر - رضي الله عنه - فليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى تلك المرأة سافرة بوجهها، وأقرها على ذلك، حتى يكون فيه حجة لأهل السفور، وغاية ما فيه أن جابرًا رأى وجه تلك المرأة، فلعل جلبابها انحسر عن وجهها بغير قصد منها، فرآه جابر، وأخبر عن صفته، ومن ادعى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رآها كما رآها جابر، وأقرها فعليه الدليل» (3). ثانياً: أنه قد روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر، ولم يذكروا كشف المرأة عن وجهها، قال الشيخ حمود التويجري أيضاً - رحمه الله -: «ومما يدل على أن جابرًا - رضي الله عنه - قد انفرد برؤية وجه المرأة التي خاطبت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري - رضي الله عنهم - رَوَوْا خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وموعظته للنساء، _________ (1) ديوان النابغة، ص 40. (2) أضواء البيان، 6/ 597. (3) الصارم المشهور، ص 117 - 118.
(1/409)
ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر - رضي الله عنه - من سفور تلك المرأة وصفة خديها. فأما حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - فرواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: بِمَ نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (1)» (2). فوصف ابن مسعود - رضي الله عنه - المرأة التي خاطبت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها ليست من عِلية النساء، أي ليست من أشرافهن، ولم يذكر عنها سفورًا، ولا صفة الخدين. وأما حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار»، فقالت امرأة منهن جَزْلَة: وما لنا يا رسول اللَّه؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن _________ (1) أي: الزوج، أي يجحدن إحسان أزواجهن. (2) رواه أحمد، 7/ 119، برقم 4019، والحاكم، 2/ 191، وأبو يعلى، 9/ 48، والترمذي مختصراً، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، برقم 635، ومصنف ابن أبي شيبة، 2/ 351، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم 3075.
(1/410)
العشير» الحديث (1)، فوصف المرأة بأنها كانت جزلة، ولم يذكر ما رواه جابر من سَفْع خَدَّيها. وامرأة جزلة أي تامّةُ الخَلْق، ويجوز أن تكون ذات كلام جزل أي: قوي شديد. وقال النووي: جزلة بفتح الجيم وإسكان الزاي، أي ذات عقل ورأي، قال ابن درَيد: الجزالة العقلُ والوقار (2). وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، فرواه الإمام أحمد، والشيخان، وأهل السنن إلا الترمذي، وفيه: «فقالت امرأة واحدة لم يُجِبْهُ غيرها منهن: نعم يا نبي اللَّه، لا يُدرى حينئذٍ من هي، قال: فتصدقن ... » الحديث (3). وقال النووي - رحمه الله - في قوله: «لا يدري حينئد من هي»: معناه لكثرة النساء، واشتمالهن بثيابهن لا يُدرى من هي؟». فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يذكر عن تلك المرأة سفورًا، ولا عن غيرها من النسوة اللاتي شهدن صلاة العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان شهودُ ابن عباس - رضي الله عنهما - لصلاة العيد في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فرواه الترمذي، وقال: «حديث _________ (1) مسلم، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... برقم 79. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 66. (3) أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، برقم 979، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم 884.
(1/411)
غريب صحيح»، وفيه: «فقالت امرأة منهن: ولم ذلك يا رسول اللَّه؟ ... » الحديث (1). وأما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، فأخرجاه في الصحيحين وفيه: «فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ ... » الحديث (2). فهؤلاء خمسة من الصحابة - رضي الله عنهم -، ذكروا نحو ما ذكره جابر - رضي الله عنه -، من موعظة النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء، وسؤالهن له عن السبب في كونهن أكثر أهل النار، ولم يذكر واحد منهم سفورًا، لا عن تلك المرأة التي خاطبت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيرها، وهذا يقوي القول بأن جابراً - رضي الله عنه - قد انفرد برؤية وجه تلك المرأة، ورؤيته لوجهها لا حجة فيه لأهل التبرج والسفور؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رآها سافرة بوجهها، وأقرها على ذلك» (3). ثالثًا: قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح حديث جابر هذا عند مسلم: «قَوْله: (فَقَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ سِطَة النِّسَاء) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ: سِطَة بِكَسْرِ السِّين، وَفَتْح الطَّاء الْمُخَفَّفَة، وَفِي بَعْض النُّسَخ (وَاسِطَة النِّسَاء) قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مِنْ خِيَارهنَّ، وَالْوَسَط الْعَدْل وَالْخِيَار، _________ (1) الترمذي، كتاب الإيمان، باب في استكمال الإيمان، برقم 2613، والطبراني في الأوسط، 2/ 36، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 205. (2) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم 304، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... ، برقم 79 دون ذكر اللفظة مورد الشاهد. (3) الصارم المشهور، ص 118 - 122 بتصرف.
(1/412)
قَالَ: وَزَعَمَ حُذَّاق شُيُوخنَا أَنَّ هَذَا الْحَرْف مُغَيَّر فِي كِتَاب مُسْلِم، وَأَنَّ صَوَابه (مِنْ سَفَلَة النِّسَاء)، وَكَذَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي مُسْنَده، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنه، وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أَبِي شَيْبَة: اِمْرَأَة لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَة النِّسَاء، وَهَذَا ضِدُّ التَّفْسِير الْأَوَّل، وَيُعَضِّدهُ قَوْله: بَعْده: «سَفْعَاء الْخَدَّيْنِ»، هَذَا كَلَام الْقَاضِي، وَهَذَا الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ تَغْيِير الْكَلِمَة غَيْر مَقْبُول بَلْ هِيَ صَحِيحَة، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَا مِنْ خِيَار النِّسَاء كَمَا فَسَّرَهُ هُوَ، بَلْ الْمُرَاد امْرَأَة مِنْ وَسَط النِّسَاء جَالِسَة فِي وَسَطهنَّ، قَالَ الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة: يُقَال وَسَطْت الْقَوْم أَسِطهُمْ وَسْطًا وَسِطَة أَيْ تَوَسَّطْتهمْ» (1). وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «وَهَذَا التَّفْسِيرُ الْأَخِيرُ هُوَ الصَّحِيحُ، فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ثَنَاءٌ الْبَتَّةَ عَلَى سَفْعَاءِ الْخَدَّيْنِ الْمَذْكُورَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ جَابِرًا ذَكَرَ سَفْعَةَ خَدَّيْهَا لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ شَأْنُهَا الِافْتِتَانُ بِهَا; لِأَنَّ سَفْعَةَ الْخَدَّيْنِ قُبْحٌ فِي النِّسَاءِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، أَيْ: فِيهَا تَغَيُّرٌ وَسَوَادٌ»، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ: «وَالسَّفْعَةُ فِي الْوَجْهِ: سَوَادٌ فِي خَدَّيِ الْمَرْأَةِ الشَّاحِبَةِ، وَيُقَالُ لِلْحَمَامَةِ سَفْعَاءُ لِمَا فِي عُنُقِهَا مِنَ السَّفْعَةِ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ: مِنَ الْوُرْقِ سَفْعَاءُ الْعِلَاطَيْنِ بَاكَرَتْ ... فُرُوعَ أَشَاءٍ مَطْلَعَ الشَّمْسِ أَسْحَمَا (2) _________ (1) شرح النوي على صحيح مسلم، 6/ 175. (2) البيت في ديوان حميد بن ثور الهلالي، ص 24 بلفظ: من الورق حماء العلاطين باكرت .... وهكذا لا يكون البيت شاهداً لما في الحديث.
(1/413)
قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ: السَّفْعَةُ فِي الْخَدَّيْنِ مِنَ الْمَعَانِي الْمَشْهُورَةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: أَنَّهَا سَوَادٌ وَتَغَيُّرٌ فِي الْوَجْهِ، مِنْ مَرَضٍ أَوْ مُصِيبَةٍ أَوْ سَفَرٍ شَدِيدٍ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مُتَمِّمِ بْنِ نُوَيْرَةَ التَّمِيمِيِّ يَبْكِي أَخَاهُ مَالِكًا: تَقُولُ ابْنَةُ الْعُمَرِيِّ مَا لَكَ بَعْدَمَا ... أَرَاكَ خَضِيبًا نَاعِمَ الْبَالِ أَرْوَعَا فَقُلْتُ لَهَا طُولُ الْأَسَى إِذْ سَأَلْتِنِي ... وَلَوْعَةُ وَجْدٍ تَتْرُكُ الْخَدَّ أَسْفَعَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنَ السَّفْعَةِ مَا هُوَ طَبِيعِيٌّ كَمَا فِي الصُّقُورِ، فَقَدْ يَكُونُ فِي خَدَّيِ الصَّقْرِ سَوَادٌ طَبِيعِيٌّ، وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى: أَهْوَى لَهَا أَسْفَعُ الْخَدَّيْنِ مُطَّرِقُ ... رِيشَ الْقَوَادِمِ لَمْ تُنْصَبْ لَهُ الشَّبَكُ وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ السَّفْعَةَ فِي الْخَدَّيْنِ إِشَارَةٌ إِلَى قُبْحِ الْوَجْهِ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ قَبِيحَةَ الْوَجْهِ الَّتِي لَا يَرْغَبُ فِيهَا الرِّجَالُ لِقُبْحِهَا، لَهَا حُكْمُ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا» (1). رابعاً: أن هذه المرأة ربما تكون من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، فلا تثريب عليها في كشف وجهها على النحو المذكور، ولا يمنع ذلك من وجوب الحجاب على غيرها، قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ _________ (1) أضواء البيان، 6/ 597 - 599، ومما يؤيده أن الإمام ابن قدامة: أشار إلى استثناء القواعد، من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا من قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية، فحكى: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: «فنسخ، واستثنى من ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية، ثم قال ابن قدامة: «وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى». المغني، 6/ 560.
(1/414)
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1). يؤيد ذلك أن الراوي وصفها بأنها سفعاء الخدين، أي فيهما تغير وسواد، فهي من الجنس المعذور في السفور، حيث لم يكن بها داع من دواعي الفتنة، ويؤيده أيضَاً ما تعارف عليه النساء غالباً من أن المرأة التي تجرؤ على سؤال الرجال هي أكبرهن سناً، والعلم عند اللَّه تعالى (2). خامساً: أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه القصة كانت قبل الحجاب أو بعده، فيحتمل أنها كانت قبل أمر اللَّه تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة» (3). _________ (1) سورة النور، الآية: 60. (2) انظر: الصارم المشهور، ص 122، نظرات، ص 68، رسالة الحجاب، ص 32، فصل الخطاب، ص 96، الحجاب للسندي، ص 44 - 45. (3) رسالة الحجاب، ص 32، ولا يمتنع أن تشرع في السنة الثانية، وتخرج النساء إليها قبل أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك لو قلنا إنه كان في السنة السادسة.
(1/415)
وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله -: «من المعروف والمتقرر أن أحاديث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لا تتعارض، ولا تتضارب، ولا يرد بعضها بعضاً؛ لأنها من عند اللَّه، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أَلا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ ومِثلَهُ مَعَهُ» (1)، ولكن إذا حصل تعارض بين أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فحينئذ لابد من سلوك طريق الجمع، فنقول: إذا ثبت أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى المرأة سفعاء الخدين وأقرها، وأنها لم تكن من القواعد (2)، فالجمع هو أن حديث جابر كان قبل الأمر بالحجاب، فيكون منسوخًا بالأدلة التي ذكرناها، وهي أكثر من أربعين دليلًا، ومن ترك الدليل، ضل السبيل، وليس على قوله تعويل» (3). الشبهة الخامسة: ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قيل له: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: «نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، [فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين _________ (1) مسند الإمام أحمد، 28/ 410، برقم 17174، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم 163، ورقم 4274، وانظر: صفة الصلاة له، ص 171. (2) وأنها لم تكن أمَة، وقد جاء في المسند: «أنها كانت من سفلة النساء»، وأخرجه مسلم، برقم 4 - (885)، وأبو داود، والدارمي، وتقدم تخريجه. (3) يا فتاة الإسلام، ص 262 - 263.
(1/416)
فرغ منها]: «أأنتن على ذلك؟»، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي اللَّه، ثم قال: «هلمّ لكنَّ فداكن أبي وأمي»، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، وفي رواية: [فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال]، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ» (1). قال ابن حزم: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى أيديهن فصحَّ أن اليَدَ من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره» (2). والجواب: أنه ليس في الحديث ذكر الوجه بحال، فأين فيه ما يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة؟ وفي الحديث ذكر الأيدي ولكن ليس فيه تمرير بأنها كانت مكشوفة حتى يتم الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة. غاية ما فيه أن ابن عباس - رضي الله عنهما - رآهنّ يهوين بأيديهن (3)، ولم يذكر حسرهنّ عن أيديهنّ، وإذا كان الحديث محتملًا لكل من الأمرين لم يصحَّ الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة، فإن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، واللَّه تعالى أعلم. _________ (1) رواه البخاري برقم 979، ومسلم، برقم 884، وسبق تخريجه، والزيادات في هذه الرواية من مسند الإمام أحمد، 5/ 189، برقم 3063، ومصنف عبد الرزاق، 3/ 279، برقم 5632، وانظر: سنن أبي داود، برقم 1141، وسنن النسائي، برقم 1588. (2) المحلى، 3/ 217. (3) ولعل صغر سنه المنوه في صدر الحديث يقضي بأن يغتفر له حضور موعظة النساء.
(1/417)
الشبهة السادسة: ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أومت - وفي لفظ: أومأت - امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقبض رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يده، فقال: «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟» قالت: بل امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -، قال: «لو كُنْتِ امرأةً غَيَّرْتِ أظفارَك بالحِناء» (1). والجواب عنه من وجهين: أولاً: أن في إسناده مطيعَ بن ميمون العنبري، قال في التقريب: «لين الحديث» (2)، وقال في التهذيب: «روى عن صفية بنت عصمة ... قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعاً غير محفوظ» (3). وفيه أيضاً: صفية بنت عصمة، قال الحافظ في التقريب: «لا تعرف» (4)، وقال المناوي: «رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه، فقد قال في العلل: حديث منكر، وفي الميزان: وعن ابن عدي أنه _________ (1) أخرجه أحمد، 43/ 300، برقم 26258، وأبو داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم 4166، والنسائي، كتاب الزينة، الخضاب للنساء، برقم 5089، والبيهقي 7/ 86، وحسنه الألباني في حجاب المرأة المسلمة، ص 32. (2) تقريب التهذيب، 2/ 255. (3) تهذيب التهذيب، 10/ 183. (4) تقريب التهذيب، 2/ 603.
(1/418)
غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة» (1)، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (2). ثانياً: وعلى فرض! صحته، ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو مختص بذكر اليد. الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أيضاً أن هند ابنة عتبة قالت: «يا نبي اللَّه بايعني»، قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سَبُع» (3). والجواب عنه كسابقه، مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين، وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية، وعمتها، وجدتها، ثلاثتهن مجهولات. أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في لسان الميزان (4) في فصل في النساء المجهولات، وقال في التقريب: «مقبولة» (5)، يعني إذا توبعت، وإلا فلَيّنة. وأما عمتها أم الحسن: فقال في التقريب: «لا يعرف حالها» (6)، _________ (1) فيض القدير، 5/ 330. (2) ضعيف الجامع الصغير، 5/ 49، برقم 4846. (3) سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم 4165، والبيهقي، 7/ 86، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم 894. (4) لسان الميزان، 7/ 528. (5) تقريب التهذيب، 2/ 608. (6) المرجع السابق، 2/ 620.
(1/419)
وأما جدتها: فقال الذهبي في الميزان: «أم الحسن عن جدتها عن عائشة، لا يُدرى مَن هاتان» (1). الشبهة الثامنة: ما جاء في حديث سهل بن سعد (2) - رضي الله عنه - «أنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ... » (3). الحديث. والجواب من وجوه: أحدها: ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه، ونظر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على سفورها، لأن تصويب النظر لا يفيد رؤية الوجه، فيمكن أن يكون نظرة إليها لمعرفة نبلها وشرفها وكرامتها، فإن هيئة الإنسان قد تدل على ذلك. الثاني: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي من أنه «يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده لكنها كانت متلفعة» (4)، وسياق الحديث يبعد ما قال سيما الأخير، بل إنه يشير إلى وقوع ذلك في أوائل الهجرة؛ لأن الفقر كان قد تخفف كثيرًا بعد بني قينقاع والنضير _________ (1) ميزان الاعتدال، 4/ 612. (2) كان عمره حينئذ خمسة عشر عاماً. (3) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، برقم 5030، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... ، برقم 1425. (4) فتح الباري، 9/ 210.
(1/420)
وقريظة، ومعلوم أن نزول الحجاب كان عقب قريظة، وفي الحديث إشارة إلى شدة فقر الرجل الذي تزوجها حتى أنه لم يكن يملك خاتماً من حديد. الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم، ولا يقاس عليه غيره من البشر (1). الرابع: أنه ثبت في صحيح السنة أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة لقصد الخطبة، ويباح لها النظر إليه وكشف وجهها له، وعليه فلا حجة في الحديث على إباحة كشف الوجه لأجنبي غير خاطِب، ومن استدل به على ذلك فقد حمل الحديث على غير مَحْمله، واللَّه أعلم. الشبهة التاسعة: حديث سبيعة بنت الحارث - رضي الله عنها - «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ (2) مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدْ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ لَهَا: ارْبَعِي (3) عَلَى نَفْسِكِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ _________ (1) قال الحافظ ابن حجر: «والذي تحرر عندنا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره». فتح الباري، 9/ 210. وانظر: مجلة الجامعة السلفية، عدد نوفمبر، وديسمبر 1978م، ص 74، 76. (2) أي خرجت من نفاسها، وسلمت. (3) أي: ارفقي.
(1/421)
- صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (1). والجواب: أولاً: ليس في الحديث دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين رآها أبو السنابل بل غاية ما فيه أنه رأى خضاب يديها، وكحل عينيها، ورؤية ذلك لا يستلزم رؤية الوجه، قال الشيخ عبد العزيز بن خلف: «والمستمسك من الحديث هو أنه عرف منها أنها كانت مكتحلة ومخضبة، وله أن يعرف أنها كانت مكتحلة حين تكون قد لوت الجلباب على وجهها، وأخرجت عيناً كما وصف ابن عباس - رضي الله عنهما - فعل المؤمنات بعد نزول آية إدناء الجلابيب» (2). ثانيًا: قال الحافظ ابن حجر في الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة: وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهري التي في المغازي: فقال: «ما لي أراك تجملت للخُطَّاب؟»، وفي رواية ابن إسْحاق: «فتهيأت للنكاح، واختَضبت»، وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: «فلقيها أبو السنابل وقد _________ (1) أخرجه أحمد، 45/ 422، برقم 27435، والنسائي، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، برقم 3518، وفي الكبرى له، كتاب الطلاق، واستثني من عدة المطلقات، برقم 5681، وابن حبان، 10/ 130، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 70. وخبر سبيعة الأسلمية في البخاري، برقم 4909، ومسلم، برقم 1485. (2) نظرات في حجاب المرأة المسلمة، ص 75.
(1/422)
اكتحلت»، وفي رواية الأسود: «فتطيبت وتعطرت» (1). ويتضح من هذا أن إظهار زينتها إنما كان للخُطَّاب، وعليه ينبغي حمل هذه الروايات، وقد سبق ذكر جملة من النصوص في الترخيص في نظر الخاطب إلى المخطوبة بإذنها، أو بغير إذنها، فَعَلِمَ أبو السنابل بخضابها واكتحالها، وقال لها: «ما لي أراك تجملت للخطاب»، وكان قد نظر إليها مريداً خطبتها لكنها أبت أن تنكحه، جاء في رواية البخاري أنه كان ممن خطبها، فأبت أن تنكحه، فقال لها ما قال، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «كذب (2) أبو السنابل» رواه أحمد، وفي رواية الموطأ: فخطبها رجلان أحدهما شاب، وكهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: «لم تحلي»، وكان أهلها غَيَبًا فرجا أن يؤثروه بها» (3). _________ (1) فتح الباري، 9/ 475. (2) وقد يراد بالكذب الخطأ في الفتوى، وهو في كلام أهل الحجاز كثير، أو يراد به ظاهره من جهة أنه كان عالمَاً بالقصة وأفتى بخلافه، وهذا بعيد، قال الحافظ: «وفيه أن المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه لئلا يحمله الميلُ إليه على ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبي السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته، ورجا إذا قبلت ذلك منه وانتظرت مُضي المدة حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره». فتح الباري، 9/ 475. (3) أحمد، 7/ 305، برقم 4273، ومسند الشافعي، ص 244، والبيهقي، 7/ 429، وسعيد بن منصور، 1/ 350، وأما رواية الموطأ، 4/ 849، في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، والنسائي في الكبرى، برقم 5672، وأحمد، 44/ 306، برقم 26715. ومعنى: (حطّت إلى الشاب): مالت إليه، ونزلت بقلبها نحوه. و (غَيَبًا) بفتح الياء جمع غائب» جامع الأصول، 8/ 108.
(1/423)
فأين في الحديث جواز كشف الوجه والكفين لغير الخاطب؟ وقولها: «جمعت علي ثيابي» يوحي بأنها خرجت عن حال التزين المذكورة، وإذا ضممنا إليها قولها: «حين أمسيت» فهمنا عن سلوكها - رضي الله عنها - حرصها الشديد على الاستتار عن الأجانب ليس فقط بالحجاب بل أيضاً بظلام الليل. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفيه مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها، ولو كان مما يستحي النساء من مثله، لكنْ خروجُها من منزلها ليلاً؛ ليكون أستر لها كما فعلت سبيعة» (1). الشبهة العاشرة: احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في الأمر بغض البصر على أن هذا يلزم منه أن تكون وجوه النساء مكشوفة، وإلا فعن ماذا يُغَض البصر إذا كانت النساء مستورات الوجوه؟ وذلك مثل قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (2). وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا علي لا تُتْبع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة» (3). وفي حديث جرير بن عبد اللَّه - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن _________ (1) فتح الباري، 9/ 475. (2) سورة النور، الآية: 30. (3) أخرجه أحمد، برقم 22991، وأبو داود، برقم 2149، برقم 2777،وتقدم تخريجه.
(1/424)
نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري» (1). فاستنبطوا من الآية القرآنية الآمرة بغض البصر أن في المرأة شيئاً مكشوفًا، ثم أثبتوا- باجتهادهم- أن هذا الشيء المكشوف هو الوجه والكفان، ثم استشهدوا لذلك بالأحاديث التي فيها أيضًا أمر بغض البصر. والجواب: أن هذا الأمر بغض البصر أمر من اللَّه - سبحانه وتعالى -، وأمر من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقضي بوجوب التزامه طاعة للَّه - عز وجل - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، أما كونه يقضي بأن هناك شيئًا مكشوفاً للأجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان، فهذا قول غير صحيح يرده النقل والعقل، ويأباه الواقع، وبيان ذلك من وجوه: الوجه الأول: أن المدينة النبوية في زمن التنزيل كان فيها نساء اليهود والسبايا والإماء، ونحوهن، وربما بقي النساء غير المسلمات في المجتمع الإسلامي سافراتٍ كاشفات الوجوه، فأُمِروا بغض البصر عنهن. وغاية ما في الأمر بغض البصر إمكان وقوع النظر على الأجنبيات، وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدي أمام الأجانب. قال البخاري - رحمه الله -: «قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: «اصرف بصرك _________ (1) مسلم، برقم 2159، وتقدم تخريجه.
(1/425)
عنهن، يقول اللَّه - عز وجل -: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} قال قتادة: عما لا يحل لهم» (1). والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير المؤمنات، لأنهن مظنة الاستجابة لأمر اللَّه - عز وجل -، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (2)، الآية. وقال جلّ وعلا: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (3). وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (4) الآية، ولم يقل: (ونساء أهل المدينة). وقال تبارك وتعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (5) الآية، وقال سبحانه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (6) _________ (1) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً ... }، قبل الحديث رقم 6228. (2) سورة الأحزاب، الآية: 36. (3) سورة النور، الآية: 51. (4) سورة الأحزاب، الآية: 59. (5) سورة النور، الآية: 30. (6) سورة النور، الآية: 31.
(1/426)
الآية، ولم يقل: (وقل لنساء المدينة)؛ لكن الأمر توجه لمن شرفهن اللَّه تعالى بالإيمان مطلقاً. والقرآن اليوم يخاطبنا كما خاطب رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - من قبل، فنحن اليوم أيضاً لا نخاطب الكوافر والفواسق بستر الوجه، وإنما نخاطب المؤمنين والمؤمنات، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا كانت المرأة غير مسلمة، أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر اللَّه، وتعمدت كشف زينتها - وهذا ما عمت به البلوى في زماننا - فالواجب هنا - على الأقل - أن يؤمر الرجل بغض البصر، مع العلم بأن هذا لا يقتضي أن ما فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره تجيزه الشريعة بغير عذر أو مصلحة. الوجه الثاني: أن اللَّه تبارك وتعالى أمر بغض البصر؛ لأن المرأة - وإن تحفظت غاية التحفظ، وبالغت في الاستتار عن الناس - فلابد أن يبدو بعض أطرافها في بعض الأحيان كما هو معلوم بالمشاهدة من اللاتي يبالغن في التحجب والتستر؛ فلهذا أمر الرجال بغض البصر عما يبدو منهن في بعض الأحوال. وهذا الأمر بالغض لا يستلزم أنها تكشف ذلك عمداً وقصداً، فكم من امرأة تحرك الريح ثيابها، أو تقع فيسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها فيراها بعض الناس على تلك الحال، كما قال النابغة الذبياني:
(1/427)
سَقَط النصِيف ولم تُرِدْ إِسقاطه ... فَتَنَاوَلَتْهُ، وأتَّقَتْنا بالْيَدِ (1) أي تناولته بيدٍ، واتقتنا فسترت وجهها باليد الأخرى. ومن هنا قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، ولم يقل: (إلا ما أظهرنه)؛ لأن (أظهر) في معنى التعمد، بخلاف (ظهر) أي من غير قصد منها فهذا مَعفُوٌّ عنه، لا ما تظهره هي بقصد، فعليها حرج في تعمد ذلك، وكثيراً ما يصادف الرجل المرأة وهي غافلة، فيرى وجهها أو غيره من أطرافها، فأمره الشارع حينئدٍ بصرف بصره عنها كما في حديث جرير بن عبد اللَّه - رضي الله عنه -، قال: «سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري» (2)، فهذا هو موقع نظر الفجأة، وفي سؤال جرير عن نظر الفجأة دليل على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب، وتغطية وجوههن عنهم، وإلا لكان سؤاله عن نظر الفجأة لغوًا لا معنى له، ولا فائدة من ذكره. الوجه الثالث: «عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، قال: فكان عثمان ينادي: ألا لا يدنُ إليهن أحد، ولا ينظر إليهن أحد، وهن في الهوادجِ على الإبل، فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشِّعب، _________ (1) ديوان النابغة، ص 40. (2) مسلم، برقم 2159، وتقدم تخريجه.
(1/428)
وكان عثمان وعبد الرحمن بذنَب الشعب، فلم يصعد إليهن أحد» (1). ومن المقطوع به أن أمهات المؤمنين كن يحتجبن حجابًا شاملاً جميع البدن بغير استثناء، ومع هذا قال عثمان - رضي الله عنه -: «ولا ينظر إليهن أحد» يعني إلى شخوصهن، لا إلى وجوههن لأنها مستورة بالإجماع، ومع ذلك نهى عن النظر إلى شخوصهن تعظيمًا لحرمتهن، وإكبارًا وإجلالًا لهن، وذلك لشدة احترام الصحابة رضوان اللَّه عليهم أمهات المؤمنين رضي اللَّه عنهن، ويستفاد من هذا أن مِنْ حِفظ حرمة المؤمنة المحجبة غضَّ البصر عنها - وإن تنقبت، خاصة وأن جمالها قد يعرف، وينظر إليها -لجمالها وهي مختمرة؛ وذلك لمعرفة قوامها أو نحوه، وقد يعرف وضاءتها وحسنها من مجرد رؤية بنانها كما هو معلوم، ولذلك فسَّر ابن مسعود - رضي الله عنه - قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بأن الزينة هي الملاءة فوق الثياب، ومما يوضح أن الحسن قد يعرف مع الاحتجاب الكامل قول الشاعر: طافَتْ أُمامَةُ بالركبانِ آونَةً ... يا حُسْنَها مِن قوام ما وَمنْتَقِبا فقد بالغ في وصف حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشفاً، وهو يصفها بهذا الحسن أيضاً مع كونها منتقبة، ومن ثم قال العلماء: إنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة _________ (1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 8/ 210، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 111: «وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات».
(1/429)
نظر شهوة ولو كانت مستورة؛ لأن ذلك مدعاة إلى الافتتان بها كما لا يخفى، ووقوعه فيما سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «زنا العين»، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والعينان تزنيان، وزناهما النظر» (1). ولا مخرج من ذلك إلا غض البصر عنها ولو كانت محجبة، لأنه إذا نظر إليها نظر شهوة - ولو كانت محجبة - لكان حرامًا عليه كما تقدم. الوجه الرابع: أنه قد تعرض للمرأة المحجبة ضرورات بل حاجات تدعوها إلى كشف وجهها، ويرخص لها في ذلك مثل نظر القاضي إلى المرأة عند الشهادة، والنظر إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرائم، ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة بشروطه، والنظر إلى المراد خطبتها، وهذا كله يكون بقدر الحاجة فقط لا يجوز له أن يتعداها، فإن دعته نفسه إلى الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور بغض البصر عنها، واللَّه أعلم. الوجه الخامس: أن اعتبار أمر اللَّه تعالى المؤمنين بغض الأبصار دليلاً على أن وجوه المسلمات كانت مكشوفة للأجانب مجرد وهم وظن، بدليل ترتيب آيات الحجاب حسب نزولها؛ وذلك لأن الأمر بالحجاب الكامل الذي جاء في قوله - عز وجل -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (2) الآية. _________ (1) البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2046، وتقدم تخريجه. (2) سورة الأحزاب، الآية: 33.
(1/430)
وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1). وقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (2)، كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وشاع الحجاب بعدها في المجتمع المسلم بعد نزولها، وقبل الأمر بغض البصر، الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة (3). ومما يدل على ذلك أيضاً قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك: «بينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني، فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمَّرت - وفي رواية: فسترت - وجهي بجلبابي» (4). فهذا الحديث يؤكد أن الأمر بغض البصر الوارد في سورة النور متأخر عن الأمر بالحجاب الذي ورد في سورة الأحزاب التي نزلت _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59. (3) انظر: عمدة القاري للعيني، 20/ 223. (4) صحيح البخاري، برقم 4141، ومسلم، برقم 2770، وتقدم تخريجه.
(1/431)
في السنة الخامسة، ثم جاء الأمر بغض البصر في السنة السادسة بعد عام من شيوع الحجاب وامتثال المجتمع الإسلامي للأمر بالحجاب حتى صار هو القاعدة. ومن هنا يتضح أن استنباط البعض من الأمر بغض البصر أن وجوه النساء كانت سافرة غير صحيح، بدليل أن الأمر بالحجاب نزل أولاً، وامتثله نساء المؤمنين، ثم نزل في السنة التي تليها الأمر بغض البصر، ولعّل الحكمة في ذلك أن الأمر بغض البصر مع بقاء الوجوه سافرة قد يشق على بعض النفوس، ولكنه مع الحجاب أيسر، ومن ثم فإن الأمر بغض البصر نزل تأكيدًا للحجاب القائم فعلًا، أي أنه - أي إطلاق البصر - لا يجوز للمرأة الأجنبية، وإن كانت محجبة سدّا للذرائع، ودرءًا للفتنة، فتناولت الشريعة الحكيمة إخماد الفتنة وسد ذريعتها من الجانبين: من جانب المرأة حيث كلفتها بالحجاب، ثم من جانب الرجل حيث كلفته بغض البصر. ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر في سورة النور أصلاً من أصول النظام الاجتماعي في الدولة المسلمة، واستمر عليه المسلمون قروناً مديدة، ولم يستطع أحد أن يشكك في وجوب التزامه، ولم يطالب أحد ببتر جزء من هذا الحجاب خوفًا من تفريغ آية غض البصر من مضمونها، أو تعطيلها عن مجال عملها، تاللَّه إنها لشبهة أوْهَى من بيت العنكبوت يغني فسادها عن إفسادها. الوجه السادس: أن الأمر بغض البصر مطلق، فيشمل كل ما
(1/432)
ينبغي أن يُغَضَّ البصر عنه، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (1)، ولم يبين الشيء الذي يُغَض عنه البصر، فدل على أن هذا الأمر مطلق فيشمل كل ما ينبغي غض البصر عنه، سواء أكان ذلك عن المسلمة المحجبة حتى في حالة احتجابها لشدة حرمتها، ودرءًا للفتنة، أو حينما يظهر شيء من بدنها عفواً من غير قصد، أو يقصد عند الضرورة أو الحاجة الشرعية، وسواء كان غض البصر عن الإماء المسلمات السافرات، أو عن نساء أهل الكتاب والسبايا اللائي لا يتحجبن، درءًا للفتنة بهن كذلك. ومما ينبغي أن نلتفت إليه أن من مقاصد الأمر بغض البصر: أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك ألا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» (2). وبيّن - صلى الله عليه وسلم - عورة الرجل التي ينبغي غض البصر عنها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الفخذ عورة» (3). _________ (1) سورة النور، الآية: 30. (2) مسلم، برقم 338، وتقدم تخريجه. (3) رواه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الترمذي، في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، برقم 2796، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل، 1/ 298.
(1/433)
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لجرهد الأسلمي - رضي الله عنه -: «غطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة» (1). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة والركبة عورة» (2). فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين لك فساد قول السفوريين، وجواب تساؤلهم: ما معنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة؟ والعلم عند اللَّه - سبحانه وتعالى -. الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ (3) بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ _________ (1) أبو داود، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، برقم 4014، وبنحوه: أحمد، 25/ 274، برقم 15926، والبخاري معلقاً، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، قبل الرقم 371، وقال البخاري: «حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط، حتى نخرج من اختلافهم»، وانظر: إرواء الغليل، 1/ 198. (2) أخرجه الطبراني في الأوسط، 7/ 372، برقم 7761، والصغير، 2/ 205، والحاكم، 3/ 657، برقم 6418، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 9/ 170: «فيه أصرم بن حوشب، وهو متروك»، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، برقم 271. (3) أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة من خلف الفضل.
(1/434)
إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (1). وفي رواية لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: « ... قَدْ لَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا» (2). قال الشيخ عبد القادر بن حبيب اللَّه السندي: «قلت: لا حجة في الحديث للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر على الفضل بن عباس إنكارًا باتاً بأن لوى عنقه، وصرفه إلى جهة أخرى، وكان في هذا الصنيع من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إنكار واضح؛ لأنه أنكر باليد (3). وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مشيرًا إلى هذا الحديث: «ويُقرِّب ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها، _________ (1) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول اللَّه تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً ... }، برقم 6228، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1218. (2) رواه أحمد، 2/ 6، برقم 562، والترمذي في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، برقم 885، وقال: «حسن صحيح»، وبنحوه أبو داود في المناسك: باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1735. (3) رسالة الحجاب، ص 35.
(1/435)
وجعلتُ ألتفت إليها، ويأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (1). ثم قال الحافظ: «فعلى قول الشابة: إن أبي، لعلها أرادت جدها لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسمع كلامها، ويراها رجاء أن يتزوجها» (2). ثم قال الحافظ: «وفي الحديث: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، وقال عياض: «وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن فعله - صلى الله عليه وسلم - غطى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظراً ينكر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب» (3). ثم قال الحافظ: روى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للفضل حين غطى وجهه: «هذا يوم مَن ملك فيه سمعه وبصره، ولسانه غفر له» (4) (5). وقال الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده على الدكتور يوسف القرضاوي: «وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي _________ (1) أبو يعلى، 12/ 97، برقم 6731، قال محققه حسين أسد: «إسناده صحيح». (2) فتح الباري، 4/ 88. (3) فتح الباري، 4/ 70. (4) أخرجه أحمد، 5/ 164، برقم 3041، وابن خزيمة، 4/ 262، برقم 2832، وابن سعد في الطبقات، 4/ 54، وقال عنه محققو المسند، 5/ 165: «إسناده ضعيف». (5) فتح الباري، 4/ 70.
(1/436)
إلى وجه المرأة بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل عنها، فهذا من غرائب الاستدلال لأن الحديث يدل على خلاف ما يقول لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقر الفضل على ذلك، بل صرف وجهه، وكيف يمنعه من شيء مباح! (1). قال النووي - رحمه الله - عند ذكره لفوائد هذا الحديث: «منها تحريم النظر إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه» (2). وقال العلامة ابن القيم: «وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزًا لأقره عليه» (3). وقال الدكتور البوطي معلقًا على الحديث نفسه: «قالوا: فلولا أن وجهها عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه لما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالفضل، أما المرأة ذاتها فقد كان عذرها في كشفه أنها كانت محرمة بالحج» (4). وقال الشنقيطي - رحمه الله - بعد أن ذكر الحديث: «قالوا: فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها، وأجيب عن ذلك أيضَا من وجهين: الوجه الأول: الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث _________ (1) الإعلام، ص 69. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 98. (3) روضة المحبين، ص 102. (4) إلى كل فتاة تؤمن باللَّه، ص 40.
(1/437)
التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآها كاشفة عنه، وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات الحديث: أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها». إلى أن قال - رحمه الله -: «ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها، ومما يوضح هذا أن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - الذي روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة، ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَدَّمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله (1)، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له: إنها كانت كاشفة عن وجهها، واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصداً لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها. فإن قيل: قوله إنها وضيئة، وترتيِبه على ذلك بالفاء قوله: «فطفق الفضل ينظر إليها»، وقوله: «وأعجبه حسنها» فيه الدلالة الظاهرة _________ (1) انظر مثلاً: صحيح البخاري، برقم 1678، ومسلم، برقم 1293، وغيرهما.
(1/438)
على أنه كان يرى وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه. فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها كانت كاشفة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآها وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال، مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدِّها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم، ولذلك فسر ابن مسعود: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: طافت أمامة بالركبان آونة ... يا حسنها من قوام ما ومنتقبا فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشفَاً. الوجه الثاني: أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها (1)، وعليها ستره عن الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن، ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل ابن عباس - رضي الله عنهما - (2)، والفضل منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من _________ (1) انظر: عارضة الأحوذي، 4/ 56، المسألتان الرابعة عشرة، والخامسة عشرة. (2) الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءتها، ولم يذكروا أنها كانت كاشفة عن وجهها - كما في حديث علي بن أبي طالب، وفيه قول العباس: «يا رسول اللَّه لمَ لويت عنق ابن عمك؟»، وكذا حديث جابر في صحيح مسلم في الحج وفيه: «فلما دفع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مرت به ظُعُن يَجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر».
(1/439)
النظر إليها، وبذلك يُعْلم أنها محرمة لم ينظر إليها فكشفها عن وجهها إذًا لإحرامها لا لجواز السفور (1). فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن يرى الرجال وجهها إن كانت سافرة لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج، لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من الرجال، فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الورع وعدم النظر إلى النساء، فلا مانع عقلًا ولا شرعًا ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم، ولو نظر إليها لحُكي كما حُكيَ نظر الفضل إليها، ويفهم من صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة كما ترى، وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم. وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداعٍ إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي، ألم تسمع _________ (1) وقد استدل ابن بطال بحديث الخثعمية على أن ستر وجه المرأة ليس بفرض، ثم قال: «لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء»، غير أن الحافظ تعقبه بقوله: «وفي استدلاله بقصة الخثعمية لِما ادعاه نظر، لأنها كانت محرمة» فتح الباري، 11/ 12.
(1/440)
بعضهم يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ... ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك؟ ولقد صدق من قال: وما عجب أن النساء ترجلت ... ولكن تأنيث الرجال عجاب (1) قال الشيخ حمود التويجري - رحمه الله -: «وأما قول ابن حزم: لو كان وجهها مغطى ما عرف ابنُ عباس أحسناءُ هي أم شوهاء، فجوابه أن يقال: إن عبد اللَّه بن عباس لم يشهد قصة الخثعمية (2)، ولم يَرَ وجهها، وإنما حدثه بحديثها أخوه الفضل بن عباس - رضي الله عنهما -، ثم قال: وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته له لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه، ولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رآها سافرة بوجهها وأقرها على ذلك، وكثيرًا ما ينكشف وجه المتحجبة بغير قصد منها، إما بسبب اشتغال بشيء أو بسبب ريح شديدة أو لغير ذلك من الأسباب فيرى وجهها من كان حاضرَاً عندها، وهذا أولى ما حُملت عليه قصة الخثعمية، واللَّه أعلم (3). _________ (1) أضواء البيان، 6/ 599 - 602. (2) وقد أشار الحافظ في فتح الباري، 4/ 80 إلى احتمال شهود ابن عباس القصة، فقال: «ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة، فحضره ابن عباس، فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده». (3) الصارم المشهور، ص 139 - 140.
(1/441)
وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري - رحمه الله -: «هذا هو النص الذي كثيرًا ما يتوكأ عليه من يتصدى لشق ستور النساء من علماء هذا الزمان، يتوكأ عليه لإقامة الحجة على جواز السفور، مع أن هذا الاستدلال لا يتمشى على طريقة الفقهاء المحدثين، فهي واقعة حال لا عموم لها، يتطرق إليها من الاحتمالات ما لا يتركها كمصدر للدليل، فمعلوم أن كشفها عن وجهها كان لأجل الإحرام (1) لا لجواز السفور، ثم يحتمل أن تلك المرأة كانت راكبة فكانت تحتاج إلى كشف وجهها للتثبت على راحلتها والتمكن عن ظهرها وزمامها، أو التجأت إلى ذلك لازدحام الحجيج وإيابهم وذهابهم فكان ما انكشف منها من قبيل {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2)، أو تعمدت من كشف وجهها أن يراها النبي - صلى الله عليه وسلم - شابة وضيئة حسناء فلعله يميل إلى التزوج بها، أو كشفت وجهها لأنها علمت أنها بمأمن من نظر الرجال، ويستأنس لذلك أن الراوي ذكر نظر الفضل إليها، ولم يذكر نظر أحد غيره إليها، فلو نظر إليها أحد غيره، لحكى ذلك كما حكى نظر الفضل إليها، ولما صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل عنها لم يبق أحد ينظر إليها حتى تحتاج إلى ستر الوجه وتؤمر به، ويفهم من صرف نظر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة، وأن وجه المرأة هو مصدر الفتن ومزلة الأقدام، فمن شاء فليفتح بابها، ومن شاء فليغلق. _________ (1) انظر: فتح الباري، 4/ 67. (2) سورة النور، الآية: 31.
(1/442)
والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من الكتاب والسنة هي أصول وقوانين كلية، وهذه واقعة عين، وقد علمت ما فيها من الاحتمالات، فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوص، ولا يترك الدليل الكلي في مقابلة واقعة عين مثل هذه» (1). الشبهة الثانية عشرة: ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ». وفي رواية: «ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يُعْرَفن من تغليس رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة، وفي رواية للبخاري: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا» (2). قال الأصمعي: التلفع: أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك، وقال الجوهري [في الصحاح]: تلفعت المرأة بمرطها: أي تلفحت به (3)، وكذا قال ابن الأثير، وزاد: وتغطت، قال: واللفاعُ: ثوبٌ يُجلل به الجسد كله (4)، قال الجوهري: وتلفع الرجل بالثوب _________ (1) مجلة الجامعة السلفية، وتقدم ذكر العدد وتأريخه. (2) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم 578، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، برقم 645، والرواية الثانية: البخاري، كتاب الأذان، باب سرعة انصراف النساء من الصبح، برقم 872. (3) الصحاح، مادة (لفع). (4) النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (لفع).
(1/443)
والشجرُ بالورق إذا اشتمل به (1). قال العلامة التويجري - رحمه الله -: «وهذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة كن يغطين وجوههن، ويستترن عن نظر الرجال الأجانب، حتى إنهن من شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يَعْرِفُ بعضهُن بعضَاً، ولو كُنَ يكشفن وجوههن لعرف بعضهُن بعضاً كما كان الرجال يعرفُ بَعضهم بعضَاً، قال أبو بَرْزَة - رضي الله عنه -: «وكان - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفتل من صلاة الغداة حين يعرفُ الرجل جليسه» (2). قال الداودي في قوله: «ما يعرفن من الغَلَس» معناه: لا يعرفْن أنساء أم رجال؟ أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصَّة. قيل: لا يُعْرَفُ أعيانهن، فلا يُفَرَّقُ بين خديجة وزينب - قال النووي: «وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في النهار لا يُعْرف عينُها فلا يبقى في الكلام فائدة» (3). وقول النووي هذا مع ما تقدم عن أئمة اللغة في تفسير التلفع يؤيد ما ذكرتُه من مبالغة نساء الصحابة - رضي الله عنهم - في التستر وتغطية وجوههن عن الرجال الأجانب، ويؤيد هذا ما تقدم (4) عن عائشة _________ (1) الصحاح، مادة (لفع). (2) رواه البخاري، في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، وباب القراءة في الفجر، برقم 578 ومسلم، في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، برقم 647. (3) شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 438. (4) قال العيني: بعد حكاية كلام النووي: «ورُدَّ بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم، وقال بعضهم: «وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى» انتهى، قلت: هذا غير موجه؛ لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات، والرجل لا يعرف هيئة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج، وقال الباجي: «وهذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن منقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس»، قوله: «من الغلس» كلمة: «من» ابتدائية، ويجوز أن تكون تعليلية، والغَلس بفتحتين: آخر الليل، ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة الذي مضى من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه؛ لأنه إخبار عن رؤية جليسه، وهذا إخبار عن رؤية النساء من البعد». عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 6/ 74 - 75.
(1/444)
- رضي الله عنها - أنها ذكرت نساء الأنصار وفضلهن، وأنهن لما أنزلت سورة النور {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) قامت كل امرأة منهن إلى مِرْطها فاعتجرت به، فأصبحن وراء رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - معتجراتِ كأن على رؤوسهن الغربان، رواه ابن أبي حاتم - وقد تقدم تفسير الاعتجار وأنه لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه» (2). قال بدر الدين العيني - رحمه الله -: «ثم عدم معرفتهن يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل، أو لتغطيتهن بالمروط غاية التغطي، وقيل: معنى «ما يعرفهن أحد» يعني ما يعرف أعيانهن، وهذا بعيد، والأوجه فيه أن يقال: «ما يعرفهن أحد» أي: نساء هم أم رجال، وإنما يظهر للرائي الأشباح خاصة» (3). وقال في موضع آخر: «قوله: «متلفعات» حال، أي متلحفات _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) الصارم المشهور، ص 85 - 87. (3) عمدة القاري، 4/ 90.
(1/445)
من التلفع، وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه، ويتلحف به» (1). الشبهة الثالثة عشرة: قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة السفور مصلحة تقتضيها مشقة التزام الحجاب في عصرنا. والجواب أن تقرير التيسير ورفع الحرج في الدين عن المسلمين ثبت بأدلة القرآن والسنة: قال اللَّه تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2). وقال سبحانه: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (3). وقال - عز وجل -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (4). وقال جل وعلا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (5). وقال تبارك وتعالى في وصف رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (6) حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ _________ (1) المرجع السابق، 6/ 74. (2) سورة الحج، الآية: 78. (3) سورة النساء، الآيتان: 27 - 28. (4) سورة البقرة، الآية: 185. (5) سورة البقرة، الآية: 286. (6) أي يشق عليه، ويعنته، ويحرجه كل أمر يشق على أمته، ويعنتها، أو يحرجها، وهو حريص على أمته، حريص على جلب المصالح لها، ودفع المفاسد والمساوئ عنها، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم.
(1/446)
رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (1)، وقال في صفته في التوراة والإنجيل: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (2). فهذه الآيات صريحة في التزام مبدأ التخفيف والتيسير على الناس في أحكام الشرع، قال الشاطبي - رحمه الله -: «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع» (3). أما السنة القولية: فمنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» (4). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ» (5). وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «ادْعُوَا النَّاسَ، وَبَشِّرَا، وَلاَ تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا، وَلاَ تُعَسِّرَا [وتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا]» (6). _________ (1) سورة التوبة، الآية: 128. (2) سورة الأعراف، الآية: 157. (3) الموافقات، 1/ 340. (4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 36/ 624، برقم 22291، من حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما -، ومن حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، والطبراني في الكبير، 8/ 222، برقم 7883، وابن عساكر، 54/ 413، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 6/ 1022. (5) رواه البخاري، في الإيمان: باب الدين يسر، برقم 39. (6) رواه البخاري، في الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه، برقم 3038، ومسلم، في الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير، وفي الأشربة، برقم 1733، وما بين المعقوفين من رواية البخاري.
(1/447)
وقال للصحابة في حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد: «فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرْينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (1). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «بشروا، ولا تنفروا، ويسروا، ولا تعسروا» (2). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» (3). وأما سنته الفعلية - صلى الله عليه وسلم -: فـ «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بينَ أَمْرَيْنِ إلاَّ أَخَذَ أيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إثْماً، فَإِنْ كَانَ إثْماً، كَانَ أبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» (4) الحديث. أضف إلى ذلك ما ثبت من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ثم إجماع علماء الأمة على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف الشرعية. والحاصل: أن الشارع لا يقصد أبدًا إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا تطيقه أنفسهم، فكل ما ثبت أنه تكليف من اللَّه للعباد فهو داخل في مقدورهم وطاقتهم (5). _________ (1) البخاري، في الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم 220. (2) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم 1732. (3) رواه الإمام أحمد، 25/ 384، برقم 15936، والبخاري في الأدب المفرد، ص 134، والطبراني في الكبير عن محجن ابن الأدرع، 20/ 296، والطبراني في الكبير أيضاً عن عمران بن حصين، 18/ 230، والضياء عن أنس، 7/ 132، قال الزين العراقي: «سنده جيد»، ورمز له السيوطي بالصحة. انظر: فيض القدير، 3/ 486، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 55. (4) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 3560، ومسلم، في الفضائل، باب مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام، برقم 2327. (5) انظر: عودة الحجاب للمقدم، 3/ 335 - 393.
(1/448)
الشبهة الرابعة عشرة: حديث قيس بن أبي حازم، قال: دخلت مع أبي على أبي بكر _ وكان رجلاً خفيف اللحم أبيض، فرأيت يدي أسماء موشومة» (1). قال دعاة السفور: هذا الأثر يدل على أن أسماء كانت كاشفة لوجهها حال دخول قيس بن أبي حازم مع أبيه عليها؛ إذ لو كانت ساترة لوجهها ما عرف بياضها. وأجيب بأنه لا يدل على أنها كانت كاشفة لوجهها في تلك الحادثة من وجوه: الوجه الأول: أن الحديث ليس فيه ذكر أنهما رأيا وجه أسماء البتة، ولا يجوز أن يحمل ما لا يتحمله. فقد يعرف البياض من رؤية _________ (1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 8/ 283، والطبراني في الكبير، 24/ 131، برقم359 وابن أبي خيثمة في تاريخه، 3/ 51، برقم3785، 3789، وبنحوه ابن أبي شيبة، 6/ 91، برقم 20709. واللفظ في المتن لفظ ابن سعد، ولفظ ابن أبي خيثمة: «فرأيت أسماء بيضاء موشومة الذراعين، ورأيت أبا بكر أبيض نحيفاً». ولفظ الطبراني: «عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلنا على أبي بكر - رضي الله عنه - في مرضه، فرأينا امرأة بيضاء، موشومة اليدين، تذب عنه، وهي أسماء بنت عميس». قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 170: «رجاله رجال الصحيح»، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 10/ 376: «أخرج الطبراني بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم، قال: «دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فرأيت يد أسماء موشومة». قال أهل اللغة: «الوَشْم بفتح، فسكون: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر»، قاله الحافظ في الفتح، 10/ 372.
(1/449)
اليدين أو نحو ذلك مما يظهر ضرورة. الوجه الثاني: أن إسلام أسماء قديم، وقد هاجرت إلى الحبشة والمدينة فهي من المهاجرات الأول. وقد قالت عَائِشَةُ - رحمه الله -: «يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل -: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (1). قال الحافظ ابن حجر: «أي غطين وجوههن» (2). وقال العيني: «أي غطين وجوههن بالمروط التي شققنها» (3) (4). _________ (1) البخاري، برقم 4758، وتقدم تخريجه. (2) فتح الباري، 8/ 490. (3) عمدة القاري للعيني، 15/ 348. (4) انظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص 332 - 333.
(1/450)
المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور
أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً - رحمه الله - 1 - (2640 - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب، وعن معنى آيات في الحجاب، وعن جواز اختلاط النساء بالرجال). من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلّمه اللَّه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 4619 وتاريخ 9 - 8 - 78هـ وبرفقة الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأتي: الأول: ما معنى قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهُنَّ} (1)؟ الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، على أقوال: الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم بأسانيدهم، عن ابن مسعود أنه قال: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الزينة _________ (1) سورة النور، الآية: 31.
(1/451)
السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الثياب والجلباب. الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، أنه قال: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: هو خضاب الكف، والخاتم. الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه قال في قوله: {إلا ما ظهر منها} الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: {إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير، وعطاء. وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه» (1). وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن _________ (1) ضعف هذا الحديث كثير من العلماء؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع. وقال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة، ثانياً لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. وعلة ثالثة وهي عنعنه قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، ورابعة أنه شاذ من هذا الوجه، فليس له شاهد من حديث غيره.
(1/452)
الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» (1). إذا علمت ما سبق من الأقوال، فالراجح منها هو قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب. أما أدلة الكتاب فهي ما يلي: الأول: قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (2). وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها، فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: رحم اللَّه نساء المهاجرين الأول لما نزل {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أزرهن فاختمرن بها. _________ (1) مراسيل أبي داود، ص 310، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 47: «رواه أبو داود في كتابه المراسيل، رقم 437، ورواه في سننه عن قتادة، عن خالد بن دريك عن عائشة ... بلفظ: «إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه». فهذا بلا شك حديث واحد، مداره على راوٍ واحد، وهو قتادة، إلا أن بعضهم رواه عنهم مرسلًا بلفظ، وبعضهم رواه عنه مسندًا بلفظ آخر، والمعنى واحد، وما علمت أحدًا من أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه راوٍ واحد، تارة مرسلًا، وتارة مسندًا، يجعلهما حديثين بمتنين مختلفين!» وضعفه. (2) سورة النور، الآية: 31.
(1/453)
و «الخمار» ما تغطي به المرأة رأسها. و «الجيب» موضوع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج، ومن تشبه بهن من نساء المسلمين. الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1). قال الراغب في مفرداته، وابن فارس في معجمه: القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج. وقال البغوي في تفسيره: قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي. وأما «التبرج» فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما. وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن اللَّه تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترن كالشابات فهو أفضل لهن، قال البغوي: {وإن يستعففن} فلا يلقين الحجاب والرداء {خير لهن}، وقال أبو حيان _________ (1) سورة النور، الآية: 60.
(1/454)
{وإن يستعففن} عن وضع الثياب ويستترن كالشابات فهو أفضل لهن. انتهى كلام أبي حيان. ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث: قال تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1). وجه الدلالة أن اللَّه تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عن التبرج، وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب المواجهة يعم، ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج المنهي عنه إظهار الوجه واليدين. الرابع: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (2) المتاع عام في جميع ما يمكن أن يصلب من مواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. وجه الدلالة من الآية أن اللَّه تعالى أذن في مسألة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 33. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/455)
عورة: بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها وسؤال عما يعرض وتعين عندها، وهذا يدل على مشروعية الحجاب؛ ولهذا قال: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1) يريد الخواطر التي تعرض للنساء في أمر الرجال. وبالعكس: أي ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له. الخامس: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (2). وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعبيدة السماني - رضي الله عنه -، أنهما قالا: أمر اللَّه نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. انتهى كلامهما. وقوله: (عَلَيْهِنَّ) أي من على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه. والجلابيب جمع جلباب. قال ابن منظور في «لسان العرب» نقلاً عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/456)
الجلباب الخمار. وقال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار، لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزاراً يشتمل به فيجلل جميع البدن، وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح مسلم عن أم عطية - رضي الله عنها -: «قالت: يا رسول اللَّه، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها» (1)، وقال أبو حيان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والمحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإمام بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. وإذ قد أتينا على الأدلة من الكتاب فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه الآيات. قال - رحمه الله -: «والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة؟ على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: وحقيقة الأمر أن اللَّه جعل الزينة زينتهن: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم. _________ (1) مسلم، برقم 890، تقدم تخريجه.
(1/457)
وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم. وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل اللَّه - عز وجل - آية الحجاب بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش، فأرخى النبي - صلى الله عليه وسلم - الستر ومنع أنساً من أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك على خيبر قالوا إن حجبها فهي من نساء المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، «والجلباب» هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره (الرداء)، وتسمية العامة (الإزار الكبير) الذي يغطي رأسها ويستر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، وجنسه «النقاب»، فكان النساء ينتقبن، وفي الصحيح «أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» (1)، وإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن _________ (1) أخرجه البخاري، برقم 1838، وتقدم تخريجه.
(1/458)
عباس أول الأمرين» (1). انتهى كلام شيخ الإسلام. وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي: الدليل الأول: عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أنها كانت عند رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مع ميمونة، قالت: «بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه، فقلت: يا رسول اللَّه، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!». رواه الترمذي وغيره (2). وقال بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح»، وقال ابن حجر: إسناده قوي» (3). [الدليل] الثاني: عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل اللَّه آية الحجاب» (4). [الدليل] الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه» رواه الإمام _________ (1) مجموع الفتاوى، 22/ 109. (2) أخرجه الإمام أحمد، 44/ 159، برقم 26537، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهُنَّ} برقم 4112، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء، برقم 2778، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، 7/ 512، بينما ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، 1/ 332. (3) فتح الباري، 9/ 337. (4) البخاري، برقم 402، ومسلم، برقم 2399، وتقدم تخريجه.
(1/459)
أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم (1). [الدليل] الرابع: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال: «ردوها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي بعد إخراجه: «هذا حديث حسن» (2). أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر، وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. [الدليل] الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المرأة عورة»، رواه الترمذي، والبراز، وابن أبي الدنيا، والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب» (3)، وقال المنذري: «رجاله رجال الصحيح». والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث _________ (1) أخرجه أحمد، برقم 24021، وأبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، 1/ 107: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. (2) رواه الإمام أحمد في المسند، برقم 17306، وسنن أبي داود، رقم 3295، وسنن ابن ماجه، برقم 2134، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 8/ 218، برقم 2592، وقال محققو المسند: «صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام»، وتقدم تخريجه. (3) الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، 1685، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.
(1/460)
أم سلمة وحديث أنس السابقين (1). [السؤال] (الثاني): من المقصود بقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (2)؟ والجواب: أما المراد بقوله: (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على قولين: [القول] الأول: أن المراد بالنساء المسلمات، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فلذلك قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله (3). وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه (4) عن مجاهد، قال، لا تضع المرأة خمارها أي لا _________ (1) انظر: ص 474. (2) سورة النور، الآية: 31. (3) انظر: الرد المنثور، 11/ 30. (4) السنن الكبرى، 7/ 95.
(1/461)
تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن اللَّه تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. وروى سعيد بن منصور، والبيهقي (1) في سننهما، وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه كتب إلى عبده: أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها (2). [القول] الثاني: أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول ابن العربي المالكي، وبناه على اللفظ عام، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط. والقول الأول أرجح، لما سبق من الأدلة على ذلك. وأما قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياً، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس - رضي الله عنه - «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى من ذلك قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك» (3). _________ (1) السنن الكبرى، 7/ 95. (2) انظر: الرد المنثور، 11/ 31، وقوّاها الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 116، باتفاق المفسرين المحققين. (3) انظر: ص 474.
(1/462)
وبهذا القول قال ابن عباس، ومجاهد، وجماعة من أهل العلم وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -. وأما قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} فاختلف المفسرون في ذلك على سبعة أقوال، وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء كالعنِّين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك. والسؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (1). الجواب: ما روى ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، وتكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى اللَّه عن ذلك؛ لأنه من عمل الشيطان. وجاء هذا التفسير أيضاً عن ابن مسعود، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير وغيرهم (2). 2 - (2651 - خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة) قوله: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. _________ (1) أبو داود، كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، برقم 4106، والمقدسي في المختارة، 2/ 298، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 206. (2) مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 25 - 34.
(1/463)
لكن كثير من الرضعاء يخشى منهم، إذا كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر، فينبغي أن لا يخلو بها، ولا يكون محرماً في الحج كما نبه عليه في المناسك؛ فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك، واستفظاعه، مثل ما عند صاحب القرابة. المقصود التنبيه أن الرضعاء يختلفون، والأصل الإباحة، لكن يصار إلى ملاحظتهم، الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغي أن يكون محرماً في سفر أو نحوه. 3 - (2652 - الخلوة بجمع من النسوة) س: جمع نسوة؟ ج: ما يصلح، الشيطان غير مأمون؛ فإنه قد يتسرب إلى واحدة وهي قد تتسرب إليه، أو يخص على من يعلم أنها تجيبه ونحو ذلك، لا تبيت المرأة إلا مع ذي محرم ولو كانت الدار ذات صفف وكل في صفة إذا كان يحويها باب واحد بأن يكون في دار. (تقرير) 4 - (2653 - ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق، ولا تسجن إلا مع نساء، وكذلك الأحداث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على برقيتكم رقم 7261 وتاريخ 24 - 11 -
(1/464)
1388هـ بخصوص نقل السجينات من جهة لأخرى، أو ترحيلهن وفيهن السعوديات والأجنبيات، وفيهن من لا محرم لها، وتطلبون الحل الشرعي لهذه الحالة وأمثالها؟ والجواب: الحمد للَّه. المعروف في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أن المرأة لا تسجن مثل هذا السجن الطويل، ومع هذا فإذا دعت الحاجة إلى سجن المرأة فيتعين أن تسجن عند نساء ثقات قويات لا تسلط للرجال عليهن، وإذا سجنت المرأة فلا تخرج من سجنها إلا إذا دعا أمر ضروري لذلك، على أن يرفقها محرمها المأمون في خروجها حتى ترجع إلى محلها، ولا يدع أحداً من الرجال يقربها ولا يخلو بها، حتى ولو كان للتحقيق، فلا يخلو بها الرجل مطلقاً، حتى ولو فرضنا أن التحقيق سري فلا بد من وجود محرمها، فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة قوية ولا تمكن أحداً يقربها ولا يخلو بها، وإن كانت امرأتان فهما أحوط. هذا إذا لم يكن معها محرم، وإلا فحضور محرمها الذي يغار عليها هو المتعين. وبهذه المناسبة ينبغي تفقد القائمين على سجون النساء والصبيان ومن يتصلون بهم، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المحافظة على النساء السجينات والأحداث، غيرة على محارم اللَّه أن تنتهك. وحيطة على محارم المسلمين، ولا يكفي إحسان الظن في مثل
(1/465)
هذا بل المقام مقام خطر عظيم يستدعي الحذر والحزم وأخذ بالأحواط. واللَّه يتولى الصالحين والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 2026 - 1 في 27 - 3 - 1389هـ) 5 - (2654 - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... وفقه اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ... وبعد فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم. ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب الجواب اللازم. والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، سواء كانت المرأة خفرة (1) أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (2)، وركوبها معه في _________ (1) الخَفَر - بالفتح-: الحياء ... أي الحياء من كل ما يُكْره لهنّ [النساء] أن ينظرْنَ إليه. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، (خفر)]. (2) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه.
(1/466)
السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمكَّن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد، طوعاً منها أو كرهاً. ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة. ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها، ففي الحديث: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (1)، وفي الحديث الآخر: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» (2). لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين. كما يتعين على المسئولين القيام بهذا الأمر بحد وصرامة، ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه، ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر، فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية، فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره أسواطاً معلومة، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا، ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك. ولكن لا بد من إعلان ذلك في الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً. وعلى _________ (1) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (2) مسلم، برقم 2742، وتقدم تخريجه.
(1/467)
مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة النجدة مراقبة ما ذكر، وتطبيق الجزاء، وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر، وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم وأفراد رجالهم. كما ينبغي نصيحة هؤلاء النساء وولاة أمورهن، وتذكيرهم بما ورد، وتخويفهم مغبة طاعة النساء، فقد روي في الحديث: «هلك الرجال حين أطاعوا النساء» (1)، وفي الحديث الآخر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن» (2)، ولما أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب جعل - صلى الله عليه وسلم - يرددها ويقول: «هن شر غالب لمن غلب» (3). واللَّه الموفق، والسلام عليكم (4). مفتي الديار السعودية (ص- ف 2663 - 1 في 18 - 9 - 1385) _________ (1) «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» أخرجه أحمد، 34/ 106، برقم 20455، والطبراني في الأوسط، 1/ 135، برقم 425، وفي الكبير له أيضاً، 20/ 279، برقم 1812، والحاكم، 4/ 291، وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البزار، 9/ 137، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم 436، وضعفه أيضاً محققو المسند، 34/ 106. (2) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم 304. (3) أخرجه أحمد،11، 478،برقم 6885،والبيهقي في الكبرى،10/ 240،وابن سعد، 7/ 53، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد،4/ 332: «رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله ثقات»،بينما ضعفه محققو المسند،11/ 478،بينما ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم 5172. (4) وانظر: فتوى في المحرم في السفر في الحج، برقم 283/ في 7/ 3/ 79.
(1/468)
6 - (2655 - الخلوة بالأخت مع الشبهة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه اللَّه تعالى السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته وبعد فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم 12824 - 1 وتاريخ 29 - 4 - 80هـ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته. ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة، ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة بيننا وبين قاضي بقيق الحالي انتهت بكتابنا له برقم 56 وتاريخ 24 - 1 - 1380هـ باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة. وسبق أن كتبنا له في 19 - 9 - 1379هـ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على ذلك وعدم ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيها، ولكن حيث ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم 1744 وتاريخ 17 - 4 - 80هـ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يأتي بوالدته معها في البيت، وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار على نفسها من أخيها، فإن الذي ينبغي أن تكون في بيت فيه نساء موثوقات لا رجال فيه، أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه،
(1/469)
ويسلم لهم مصرفها، لأن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع هؤلاء النسوة اللاتي قد اشتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به لما يلحقها ويلحق أخاها من العار بسبب ذلك، لا سيما وهي امرأة لم يعرف لها سابق تهمة، وأيضاً فإن سجنها مع النساء ذوات السوء مما ينفر الخطاب ويسبب عدم رغبة الأكفاء في الزواج بها، وإذا خطبها الكفؤ ورضيت به فإن زوجها أخوها فذاك، وإلا زوجها القاضي. واللَّه يتولاكم. والسلام (1). رئيس القضاة (ص-ق 408 في 18 - 5 - 1380هـ) _________ (1) مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 50 - 55.
(1/470)
ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1 - أحكام النظر والخلوة والاختلاط السؤال الثاني من الفتوى رقم (4671) س2: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟ ج2: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2424) س2: هل النظر في صور النساء الموجودة في الجرائد والمجلات يأخذ حكم النظر إليها في الشارع أو البيت؟ ج2: النظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها، وهذا قد يكون
(1/471)
وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (14496) س4: ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟ ج 4: يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد اللَّه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز 2 - مصافحة المرأة السؤال الثالث من الفتوى رقم (18999) س3: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟ ج3: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه
(1/472)
ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (1) قال المنذري: «رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي، ورجاله ثقات، رجال الصحيح». وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم (443) س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟ ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ما مست يده يد امرأة قط» (2) كما ثبت في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن الترمذي والنسائي، وفي بعضها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أصافح النساء» (3) هذا هديه - صلى الله عليه وسلم -، _________ (1) رواه الروياني في مسنده، 3/ 466، برقم 1270، والطبراني في الكبير، 20/ 221، برقم 486، وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة، برقم 226. (2) البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، برقم 2713، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم 1866. (3) طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، 44/ 556، برقم 27006، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، برقم 1597، وقال: «حسن صحيح»، والنسائى، كتاب البيعة، بيعة النساء، برقم 4181، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، برقم 2874، والطبراني في الكبير، 24/ 181، برقم 459، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 148، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323.
(1/473)
ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} الآية (1)، فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر اللَّه بذلك، فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2)، ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلاً صارفاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد اللَّه بن سليمان بن منيع ... عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (1742) س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟ ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) - رحمه الله - عن _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 21. (2) سورة الحشر، الآية: 7.
(1/474)
عروة عن عائشة - رضي الله عنها -، في روايتها لقصة مبايعة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - للنساء، قالت: «لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتكن على ذلك» (1)، وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول اللَّه: ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة» (2)، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (3)، وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد اللَّه بن قعود ... عبد اللَّه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز 3 - الخلوة بالمرأة الأجنبية السؤال السادس من الفتوى رقم (4246) س6: ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو _________ (1) البخاري، برقم 2713، ومسلم، برقم 1866، وتقدم تخريجه. (2) طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، برقم 27006، والترمذي، برقم 1597، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323، تقدم تخريجه. (3) سورة الأحزاب، الآية: 21.
(1/475)
المحرم»؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرا في البيت الواحد أم لا؟ ج6: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة، وأن يقع منهما ما يغضب اللَّه تعالى من الفاحشة أو وسائلها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد اللَّه بن قعود ... عبد اللَّه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (7584) س5: هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما، بعيداً عن أعين الناس، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟ ج5: ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيداً عن أعين الناس فقط، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك؛ لأن الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ
(1/476)
بعد فهو في حكم الخلوة الحسيَّة بعيداً عن أعين الناس. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد اللَّه بن قعود ... عبد اللَّه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز الفتوى رقم (10388) س: إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم، لذا أحضرت سائقاً أجنبياً، فهل يصح أن يذهب بعائلتي، وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدوني جزاكم اللَّه خيراً. ج: لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (20914) س3: والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع، وهي تذهب مع سائق سعودي، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظراً لقسوة الظروف وشدة الحاجة؛ ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها، فهل يجوز للوالدة أن
(1/477)
تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؛ نظراً لأن لديها أولاداً ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه، فهم يكونون في المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جداً. أفتونا جزاكم اللَّه خيراً. ج3: إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها، ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (1)، ووجودها مع السائق في السيارة بدون محرم خلوة. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 4 - لباس المرأة وما يتعلق به السؤال السادس من الفتوى رقم (1843) س6: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟ ج6: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباساً ضيقاً يحدد جسمها، ويصفه لمن يراها؛ _________ (1) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه.
(1/478)
لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية، ويثير الفتنة، ويكون سبب شر خطير، ولا يجوز لها أن تلبس لباساً أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم؛ لما في ذلك من تشبهها بالرجال، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهات من النساء بالرجال. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4680) س: إنه لا يخفى عليك في هذا العصر ما أحدث من تقاليد، منها: إحداث فتحة الجيب من الخلف، والبعض منها على وسطه حزام، وأعلى الثوب ضيق والأسفل واسع، ومع ذلك إن بعض الثياب ضيقة حتى كل أعضائها تشاهد، كأن لم يكن عليها ثوب، والبعض من النساء تحتج بأن المشايخ أفتوا بأن المرأة تلبس ما شاءت من الزينة، وفي بعض الأحيان تجيئهم الفتوى من برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة بأنها تلبس ما شاءت من الزينة لزوجها بدون تفصيل، فالآن -جزاكم اللَّه خير الجزاء- بينوا لنا الطريقة التي كان عليها السلف الصالح، وبما شرعه لنا الصادق المصدوق، والبعض من الثياب والمخدات وغيرها فيها صور، هل يجوز استعمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. ج: أولاً: الملابس من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا
(1/479)
يعدل عنه إلا بدليل شرعي يوجب ذلك، ولا نعلم دليلاً شرعياً على جعل فتحة الجيب في مكان أو جهة معينة من الثوب، ولا على منع وضع ما يسمى السحاب في هذه الفتحة في أي جهة من الثياب، إنما الممنوع أن يكون الثوب ضيقاً يحدد مكان العورة من الجسم، أو يكون رقيقاً يشف عما تحته، أو قصيراً تظهر منه العورة أو بعضها، أو فيه تشبه بالملابس المختصة بالكفار، أو تشبه النساء بالرجال، أو الرجال بالنساء. ثانياً: لا يجوز اتخاذ الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح؛ لعموم نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح، واتخاذها في البيوت، ولما في اتخاذ المرأة ملابس فيها صور من الفتنة، وخاصة إذا خرجت من بيتها أو كان معها أجانب في دارها، أما اتخاذها وسائد أو بسطاً فلا حرج فيه، لما فيه امتهانها، وقد ثبت من حديث عائشة، وأبي هريرة ما يدل على ذلك. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4962) س1: أ- ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
(1/480)
ب- ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟ ج- هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أمام محارمها؟ د- هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟ هـ- هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من النساء المسلمات؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز؟ ج1: أ- يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها، أو زوجها، أو أحد محارمها، فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضاً. ب- كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه، وقد كتب في ذلك الأخ الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة فيرجع إليها. ج- يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها، ويجوز أن تظهر به أمام محارمها. د- لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال. هـ- لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال، ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا، ويجوز لها أن تلبس القفازين. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/481)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19771) س3: ما حكم وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة، سواء خلفية أو أمامية مما يظهر جزءاً من الساق؟ ج3: لا يجوز للمرأة أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها تبدو منها سيقانها أو بعضها؛ لأن المرأة كلها عورة، وقد قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية (1)، نهى -سبحانه- المرأة أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والرابع والثامن من الفتوى رقم (19771) س2: ما حكم لبس الملابس الشفافة للنساء؟ ج2: لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءها، ومن فعلت ذلك فهي من الكاسيات العاريات اللاتي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. س4:ما حكم عدم لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل؟ ج 4: المطلوب ستر رجلي المرأة عند الخروج، سواء _________ (1) سورة النور، الآية: 31.
(1/482)
بالجوارب أو غيرها من الثياب، فلا يتعين لبس الجوارب. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. س8: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتف؟ ج8: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين عند الخروج؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. واللَّه الهادي إلى سواء السبيل. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9090) س1: ما حكم لبس النساء حمالات الثدي؟ ج1: لبس حمالات الثدي يحدده، ويجعل النساء كواعب، فتكون بذلك مثار فتنة، فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/483)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (5089) س1: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟ ج1: لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساتراً لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقاً يحدد أعضاءها، ولا شفافاً يشف عما وراءه، ولا مثيراً للفتنة. س3: في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادراً، فرجل تزوج امرأة مسلمة ولم ترض أن تلبس الحجاب، فهل يطلقها أو ماذا يفعل؟ وآخر مسلم تزوج بامرأة كتابية، ولم ترض أيضاً أن تلبس الحجاب فما الحكم؟ ج3: المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر عاصية لزوجها، ومخالفة لشرع الله، وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب الشرعي، وإذا لم تستجب له طلقها، سواء كانت مسلمة أو كتابية؛ بعداً عن المنكر، وصيانة للأسرة من مثار الشر. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5363) س3: هل لا بد من لبس السواد في الخروج أم مختلف الألوان ما دام ليست فيها ألوان صارخة؟
(1/484)
ج3: لبس السواد للنساء ليس بمتعين، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء، لا تلفت النظر، ولا تثير فتنة. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (7523) س5: ما حكم لبس السواد للنساء، وما معنى قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في الخبر: « .. وكأن على رؤوسهن الغربان»؟ ج5: يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة - رضي الله عنها -: « .. كأن على رؤوسهن الغربان» فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/485)
الفتوى رقم (3831) (1) س1: هل يجوز استخدام طالبات مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة، وبلباس سراويل ضيقة تبرز كل عضلات الجسم ومفاتنه، وبثوب طوله شبران؟ ج1: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من كشف عوراتهن، وإبراز مفاتنهن بلبس الملابس القصيرة والضيقة؛ ولما فيه من لهو الرقص والإيقاع، وهما شر مستطير، يثير شهوة من حضر الاستعراض، ويحرك فيهم دواعي الفحش والفساد، وانحراف الأخلاق؛ ولهذا الاستعراض سوابق ولواحق كريهة، له مقدمات هي: تدريب هؤلاء الطالبات على الرقص والإيقاع بتلك الملابس الفتانة، حتى يحكمن هذا الفن الممقوت؛ تمهيداً للاستعراض، وضماناً للنجاح في مجال الشر، بإعجاب الحاضرين، وله توابع مرذولة، قد ينتهي بهن أو بكثير منهن إليها، هي: اتخاذ ما دربن عليه وبرزن فيه مهنة لهن، يكسبن من حمأتها ما يعشن به في دنيا اللهو والمجون. س2: هل يأثم ولي أمر الطالبة بالسماح لها في المشاركة، وهل ينطبق حكم الدياثة عليه إذا سمح بذلك؟ ج2: كل من استرعاه اللَّه رعية فهو مسؤول عنها، فولي أمر الطالبة من أب أو من ينوب عنه مسؤول عنها، فإن أدبها بآداب الإسلام، فأحسن تأديبها، وصانها من مزالق الشر والفساد كتب اللَّه _________ (1) السائل من خارج المملكة.
(1/486)
له الأجر والثواب، وحفظ له كرامته، وصانه في عرضه. وإن أساء تربيتها، أو أهمل في ذلك، أو دفع بها إلى مواطن الفتن ومهاوي اللهو- أثم بجنايته على من استرعاه اللَّه، وساءت عاقبته، فجنى ثمن سوء تصرفه: خيبة في دنياه، وعذاباً في أخراه إن لم يتغمده اللَّه برحمته. س3: هل يحق للجهات الحكومية أن تجبر الطالبات على ذلك بدعوى الاحتفالات الوطنية؟ ج3: لا سعادة للأمم، ولا نهوض لها، ولا انتظام لشؤونها، ولا حفظا لكيانها، إلا بولاة يسوسونها، ويحسنون قيادتها، على منهاج كتاب اللَّه تعالى، وهدي رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ عقيدة، وقولاً، وعملاً، وفصلاً فيما شجر بينهم بتوفيق من اللَّه سبحانه. ولا قيام للحكام وولاة الأمم، ولا اعتبار لهم ولا وجاهة، إلا بأمم لها شأنها في جميع جوانب الحياة: ديناً واستقامة، وعلماً وثقافة، وصناعة وزراعة، وقوة وسعة في كل ما تنهض به الأمم، ويدعم أركانها، حتى تكون مثلاً أعلى يرفع العقلاء إليها أبصارهم إعجاباً بها، ويهابها من يعلم حالها. فبقدر ما يبذل ولاة الأمور من خير وحسن سياسة لأممهم وما يحققون لهم من إصلاح يجنون ثمرته: قوة وعزاً، ووجاهة ورفعة شأن، وبقدر ما تستجيب الأمم لرعاتها المصلحين فيما يدعونها إليه من المعروف، ويتعاونون معها على تحقيقه تجد سعادة ورخاء، وراحة واطمئنان ... إلخ. فعلى حكام
(1/487)
المسلمين وولاة أمورهم أن يسوسوا أممهم سياسة إسلامية، يحتذون فيها حذو رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ويهتدون بهديه، ويقتفون فيها أثر خلفائه الراشدين؛ ليسعدوا وتسعد أممهم، ويحمدوا العاقبة في الأولى والآخرة، وليحذروا أن يخالفوا شريعة الإسلام ونهجها القويم، فيلقوا بأيديهم إلى التهلكة، اتباعاً لهواهم، وتقليداً لدول الكفر في الحكم في رعيتهم، وفي عاداتهم وانحرافهم في أخلاقهم، وفي ثقافتهم، بإدخالهم اللهو والمجون في دور التعليم، وخلطهم الإناث بالذكور فيها، إلى غير ذلك من ألوان الشر والفساد، فإنهم إن فعلوا ذلك انحلت عروتهم، وضعفت شوكتهم، وهانوا على اللَّه فأهانهم، وحقت عليهم كلمة العذاب، وذلك جزاء المفسدين. وأخيرا لا يوجد في قول البشر أجمل ولا أكمل ولا أحكم ولا أشمل من وصية ونصيحة من أوتي جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم -، إذ يقول: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (1). ويقول: «ما من عبد استرعاه اللَّه رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم _________ (1) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم 893، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر ... ، برقم 1829، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(1/488)
يجد رائحة الجنة» (1)، وفي رواية: «ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم اللَّه عليه الجنة». فليتق اللَّه كل وال فيمن استرعاه اللَّه، ولينصح لهم، وليحكم فيهم بالحق، فإنه مسؤول عنهم. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (19479) س 11: هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي البنطال (البنطلون) وهي محجبة خارجة إلى السوق، وماذا إذا كان البنطال فضفاضا؟ ج 11: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه _________ (1) رواه بهذا اللفظ أو بألفاظ قريبة منه: أحمد، 5/ 25، 27، والبخاري، 8/ 107، واللفظ له، ومسلم، 1/ 125، 126، 3/ 1460 برقم 142، والدارمي، 2/ 324، وابن أبي شيبة، 12/ 220، 15/ 234، وابن حبان 10/ 347، برقم 4495، وأبو عوانة، 1/ 32، والطبراني، 20/ 200، 201، 202، 205، 206، 207، 208، 209، 218، 221 - 223، 225، 228، برقم 449، 455 - 459، 469، 472 - 474، 476، 478، 506، 513 - 519، 524، 533، 534، والبيهقي، 8/ 160 - 161، 161، 9/ 41، والبغوي، 10/ 70، برقم 2478.
(1/489)
أيضا يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1678) س3: يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الحيض. ج3: لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل عموم قول اللَّه: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1)، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2)، كما إنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس، وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة، بقول اللَّه - سبحانه وتعالى -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} (3). _________ (1) سورة البقرة، الآية: 195. (2) سورة النساء، الآية: 29. (3) سورة النور، الآية: 31.
(1/490)
وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعاً منه كحال الطهر. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (2036) س6: هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون؟ ج6: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية» (1) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى _________ (1) أحمد،4/ 394، 400، 414، 418، وأبو داود، 4/ 400 - 401، برقم 4173، والترمذي، 5/ 106، برقم 2786، والنسائي في الكبرى، 5/ 435، برقم 9422، وفي المجتبى، 8/ 153، برقم 5126، وابن خزيمة، 3/ 91، برقم 1681، وابن حبان، 10/ 270، برقم 4424، والحاكم، 2/ 396، والطحاوي في المشكل، 7/ 141، 11/ 478، برقم 2716، 4553، والبيهقي، 3/ 246.
(1/491)
تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب، وليست المرأة -أيضا- مطالبة بالذهاب إلى المسجد، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 5 - عورة المرأة أمام المرأة السؤال الأول من الفتوى رقم (3250) س1: هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة؟ ج1: فيه قولان لأهل العلم، والأرجح عدم الوجوب؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/492)
الفتوى رقم (16774) س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لا، وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة والعياذ باللَّه؟ ج: لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة؛ لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} إلى قوله سبحانه: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} الآية (1)، فأمرها اللَّه سبحانه بضرب الخمار على وجهها وجيبها عن الرجال، ما عدا المحارم المذكورين في الآية، أو من بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الأدلة الأخرى، والمراد بالنساء في الآية جميع النساء، المسلمات وغير المسلمات، واللَّه أعلم. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (20518) س1: كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه، كل ذلك تشبها بالكافرات، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. _________ (1) سورة النور، الآية 31.
(1/493)
ج1: على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء، حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة، كالخروج لهن في ثياب البذلة، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك، وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن الريبة، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير والضيق والشفاف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من تشبه بقوم فهو منهم» (1)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (2) أخرجه مسلم في (صحيحه). وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز _________ (1) أخرجه أحمد، 9/ 123، برقم 5114)، وعبد بن حميد، ص 267، وابن أبى شيبة 5/ 313، برقم 19747، وعبد الرزاق، 11/ 453، برقم 20986، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، 1/ 189، والبيهقي في شعب الإيمان، 2/ 75، والطبراني في الكبير، 12/ 317، وضعفه محققو المسند، 9/ 123، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 5/ 109. (2) مسلم، 3/ 1680، برقم 2128.
(1/494)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20513) س1: ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم، فما حكم لبسها أمام النساء، وعند الأقارب من الرجال؟ ج1: لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6729) س1: زوجتي معلمة، وفي المدرسة تخلع العباءة وغطاء الرأس، هل يلحقها إثم؟ مع العلم أن المدرسة لا يوجد فيها رجال. ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا حرج إن شاء اللَّه. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/495)
6 - بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (21302) الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان باللَّه ورسوله، واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة- وللَّه الحمد- قرناً بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، ليس هذا موضع بسطها. ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة، وما يلزمها من اللباس؛ فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء، الذي جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان وشعبة من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً: تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة كما قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
(1/496)
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} الآية (1)، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف: الرأس، واليدين، والعنق، والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة- هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (2) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (3) وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) أخرجه أحمد، برقم 5114، وعبد بن حميد، ص 267، وابن أبي شيبة، برقم 19747، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 5/ 109، وتقدم تخريجه. (3) مسلم، برقم 2077، وتقدم تخريجه.
(1/497)
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (1)، ومعنى: «كاسيات عاريات» هو: أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشفّ بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين على نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي اللَّه عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه اللَّه ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة للَّه ورسوله، ورجاء لثواب اللَّه، وخوفاً من عقابه. كما يجب على كل مسلم أن يتقي اللَّه فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه اللَّه ورسوله من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. نسأل اللَّه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد _________ (1) مسلم، برقم 2128، وتقدم تخريجه.
(1/498)
وعلى آله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 7 - المحرم وسفر المرأة بلا محرم السؤال الثالث من الفتوى رقم (18173) س3: لي ابن أخ عمره خمس سنوات، وابن أخت أربع سنوات، فهل يعدان محرمين لي، وهل صحيح أن المحرم يجب أن يكون حقيقة محرماً عندما يصبح يفرق بين الأشياء والألوان والحلوى وغيرها، أم حتى البلوغ؟ ج3: يشترط في المحرم الذي يكون مع المرأة أن يكون بالغا عاقلاً؛ لأن الصغير وغير العاقل لا يحصل بهما المقصود في المحرمية من حماية المرأة والقيام بشأنها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم (17455) س2: أنا أسكن في كفر الزيات والكلية التابعة لها في طنطا والمسافة بينهما 13 كم، فما حكم السفر إلى الكلية بدون محرم، مع العلم بأني
(1/499)
أتلقى العلم الشرعي على يد أخت؟ ج2: المسافة المذكورة ليست مسافة سفر يحتاج إلى محرم، ولكن لا يجوز لك أن تركبي وحدك مع رجل ليس من محارمك؛ لأن هذه خلوة محرمة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما» (1). وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11750) س: يتقدم أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بالدمام التي تبعد عن مدينة الخفجي بحوالي 300 كيلو متر، وذلك لعمل توكيل للسفر بهن إلى الجامعة بالدمام والعودة بهن إلى الخفجي بصفة جماعية، وذلك لشخص مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه، وينص على ذلك في الوكالة، مثلا: «وكلت فلاناً وابنته فلانة .. إلخ للسفر بابنتي إلى الدمام والعودة بها مع زميلاتها .. » فما رأي سماحتكم إذا كان السفر بالمرأة أو الطالبات بهذه الصفة الجماعية ووجود أحد محارم قائد السيارة معه، كذلك التوكيل على _________ (1) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه.
(1/500)
استلام خادمة من المطار والسفر بها إلى مكفولها؟ أفيدونا جزاكم اللَّه خيراً. ج: السفر المذكور لا يجوز؛ لأنه بدون محرم، كما أن التوكيل لا يصح ولا يفيد شيئا في ذلك ولا يحل سفر المرأة بدون محرم. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 8 - السفر بالطائرة بدون محرم السؤال الثالث من الفتوى رقم (9950) س3: هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم؟ ج3: لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج، سواء طالت المسافة أو قصرت. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9355) س1: هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم؟ مع
(1/501)
العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة، والغرض الرئيسي من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة؟ ج1: في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها أو أحد محارمها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (17702) س: أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة من أخي، ومعهم أخي وأبناؤنا الصغار، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك، وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم -مدة السفر ساعتان-. ج: لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» (1) متفق على صحته وزوج أختها لا يعتبر محرماً لها، وكذلك أختها ليست محرماً لها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز _________ (1) متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341، وتقدم تخريجه.
(1/502)
الفتوى رقم (2642) الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق الدكتور محيي الدين خليل، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إلى اللجنة برقم (2554\ 2 \ د) وتاريخ 7\ 8 \ 99 هـ، ونصه: إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية، ويشكو البعض من هذا الإجراء، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة، مستندين إلى: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها» (1)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة _________ (1) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1340.
(1/503)
إلا ومعها محرم» (1)، وعن أبي هريرة أيضاً أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» (2). لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعاً السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم. وأجابت بما يلي: إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم ممن ذكرهم اللَّه تعالى في سوره النور: كالأمر بغض البصر، وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع: من زوجها، أو أحد محارمها، فكان حراماً؛ لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» (3) رواه _________ (1) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1340. (2) البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، برقم 1088، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1339. (3) أحمد، 2/ 13، 19، 142 - 143، والبخاري، 2/ 35، ومسلم، 2/ 975، برقم 1338، وأبو داود، 2/ 348، برقم 1727، وابن أبي شيبة، 4/ 5، وابن خزيمة، 4/ 133، برقم 2521، والطحاوي في شرح المعاني، 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441، برقم 2720، 2729، 2730، والبيهقي، 3/ 138، 5/ 227، كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -.
(1/504)
أحمد، والبخاري، ومسلم؛ ولما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها» (1) رواه أبو داود، والحاكم؛ ولما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (2) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميالٍ، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وما في معناه، فلا يعتبر، وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلاً أم _________ (1) أبو داود، 2/ 347، برقم 1724، والحاكم، 1/ 442، وابن حبان، 6/ 439، برقم 2727، وابن خزيمة، 4/ 136، برقم 2526، البيهقي3/ 139. (2) متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341، وتقدم تخريجه.
(1/505)
كثيراً، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر براً أم بحراً أم جواً، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده، بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى. وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفراً فيصدق عليه عموم النهي في الحديث. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (1). اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز _________ (1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 17/ 17 - 313، باختيار.
(1/506)
9 - في صفة العباءة الشرعية للمرأة فتوى رقم (21352) وتاريخ 9/ 3/ 1421هـ الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (934)، وتاريخ 12/ 2/ 1421هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: «فقد فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي «الجلباب»: هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية: أولاً: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعاً: ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن
(1/507)
تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامساً: ألاّ تكون مُشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً. وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)، واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة للَّه تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان. وباللَّه التوفيق. وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (2) _________ (1) سورة المائدة، الآية: 2. (2) حراسة الفضيلة، ص 157 - 159.
(1/508)
ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 1 - مشروعية الحجاب الحمد للَّه رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: أحمد بهاء الدين في بعض الصحف وما يدعيه من تحليل لما حرمه اللَّه, وخاصة ما نشره في زاوية (يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد (36992)، و (36993)، و (36994)، و (36996) من تحامله على الحجاب والنقاب, والدعوة إلى السفور, واعتبار الحجاب بدعة من البدع, واعتباره أنه من الزي, والزي مسألة تتعلق بالحرية الشخصية, وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث, وأن الإسلام لم يأمر به ولم يشر إليه, وأن النساء كن يجالسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافرات, ويعملن في التجارة والرعي والحرب سافرات, وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد الخلفاء الراشدين, والدولة الأموية والعباسية, وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام دخلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل: البرقع، واليشمك, وفرضوها على العرب المسلمين فرضاً. إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولها الحقيقي.
(1/509)
ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعاً وعقلاً ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له. والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته، ويقلل من سيئاته، سراً وجهراً في كل أقواله وأفعاله، وأن يبتعد عن وسائل الفتنة، ومزاولة أسبابها وغاياتها. والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته, سواء في ذلك العبادات، والمعاملات، والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية. ودعاة السفور المروِّجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم معرفة لعواقبه الوخيمة, وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبأون بالأخلاق الفاضلة ولا يقيمون لها وزناً, وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأجراء من الخونة والأعداء فهم يعملون لهذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة: ليلاً ونهاراً, سراً وجهاراً, جماعة وأفراداً, إنهم يدعون إلى تحرير المرأة من: الفضيلة، والشرف، والحياء، والعفة إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء. والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عملاً وقولاً باللسان والجنان. وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى
(1/510)
والرشاد ويقربهم من مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف التهم؛ ليكون بذلك عالماً ربانياً، فقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال لكميل بن زياد في وصيته له: «يا كميل: الناس ثلاثة: عالم رباني, ومتعلم على سبيل النجاة, وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مرسلة لا يهتدون بنور العلم ولا يلجأون إلى ركن وثيق» (1). والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين ذكورهم وإناثهم بخير في دينهم ولا دنياهم, بل تعود عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه اللَّه ويأباه، فالحكمة والخير للمسلمين جميعاً في الحجاب لا السفور في حال من الأحوال، وبما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ونهيه عن ضده في كتاب اللَّه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما سنبينه فيما بعد إن شاء اللَّه، فهو أيضاً وقاية لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر اللَّه - سبحانه وتعالى - بغضه ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض, ويبعد المرأة عن مخالطة الرجال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات. والتبرج ليس تحرراً من الحجاب فقط، بل هو والعياذ باللَّه تحرر _________ (1) أخرجه ابن عساكر، 50/ 252 بهذا اللفظ، وأخرج أبو نعيم، 1/ 212 عن أبي الدرداء لفظ: «الناس ثلاثة: عالم، ومتعلم، والثالث همج لاخير فيه».
(1/511)
من الالتزام بشرع اللَّه وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة, والحكمة الأساسية في حجاب المرأة هي درءُ الفتنة, فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. فمن أدلة الحجاب وتحريم السفور من الكتاب قوله - سبحانه وتعالى -: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1). فجاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على وجوب الحجاب وتحريم السفور في موضعين منها: الأول: قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، وهذا يدل على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثنى _________ (1) سورة النور، الآية: 31.
(1/512)
وهو ملابسها الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه - سبحانه وتعالى - بتكريره النهي عن إبداء الزينة في نفس الآية. والثاني: قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فهو صريح في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلاً وشرعاً وعرفاً، ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب, كما لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف, كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح. ولما كان اللَّه - سبحانه وتعالى - يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سبباً للفتنة فيطمع بها الذي في قلبه مرض. والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل شيء تحدثه في بدنها تجملاً وتزيناً.
(1/513)
وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع الزينة كاليدين، والرجلين، والنحر، وما إلى ذلك، وإذا كان الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة, بل هو المورد والمصدر لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائه آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدنها. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة: فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة، ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به كالثياب والحلي والكحل والخضاب. اهـ. وقال البيضاوي في تفسيره: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} كالحلي والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. اهـ. فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقل، فإن اللَّه جلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها، وهذا عموم لا مخصص له من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان، فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض؛ لأن عموم القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر, ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية, أو الاجتهادات الفردية, فلا يخصص عموم القرآن إلا
(1/514)
بالقرآن الكريم، أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة, ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية. والمراد بقوله جل وعلا: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} كما قال بذلك ابن مسعود - رضي الله عنه - , وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم- «ما لا يمكن إخفاءه» كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها, وما يبدو من أسافل الثياب، وما قد يظهر من غير قصد كما تقدمت الإشارة لذلك, فالمرأة منهية من أن تبدي شيئاً من زينتها ومأمورة بأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة. وحينما نهى - سبحانه وتعالى - المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها- علمها - سبحانه وتعالى - كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على رأسها فقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} يعني من الرأس وأعالي الوجه {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبة وما حولها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. وفي قوله تعالى أيضاً في آخر هذه الآية: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما يدعو إلى الفتنة حتى بالحركة والصوت، وهذا غاية في توجيه المرأة المسلمة, وحث من اللَّه لها على حفظ كرامتها ودفع
(1/515)
الشر عنها. ويشهد أيضاً لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بزوجته صفية, وفعل أمهات المؤمنين, وفعل النساء المؤمنات في عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بالخمر والجلابيب, وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى نزلت آيات الحجاب، وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء كان قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم اللَّه لأن الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان. ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور, ومنها قوله تعالى في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1). قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابث ومكتسب. وقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} يدل على تخصيص الوجه; لأن الوجه عنوان المعرفة , فهو نص على وجوب ستر الوجه, _________ (1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 17/ 17 - 313.
(1/516)
وقوله تعالى: {فَلَا يُؤْذَيْنَ} هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر, فلذلك حرم اللَّه تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت, ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه - سبحانه وتعالى - لكان كافياً في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة, ومن جملتها وجهها, وهو أعظمها; لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة. قالت أم سلمة: «لما نزلت هذه الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»، قال ابن عباس: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة، وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول اللَّه - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ومن آيات الحجاب أيضاً قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1)، فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم, وقد أوضح اللَّه سبحانه في هذه الآية الحكمة في ذلك، وهي _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/517)
أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها. وهذه الآية عامة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن من المؤمنات، قال القرطبي - رحمه الله -: «ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى, وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجاب» , وقول القرطبي - رحمه الله -: إن صوت المرأة عورة; يعني إذا كان ذلك مع الخضوع, أما صوتها العادي فليس بعورة؛ لقول اللَّه سبحانه: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (1)، فنهاهن سبحانه عن الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة بالشهوة, وأذن لهن سبحانه في القول المعروف, وكان النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن, وهكذا كان النساء في عهد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن, وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه. وأما الأدلة من السنة فمنها: ما ثبت في الصحيحين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بخروج النساء إلى _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 32.
(1/518)
مصلى العيد قلن: يا رسول اللَّه، إحدانا لا يكون لها جلباب! فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه (1) , فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب, وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب، وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» (2). وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغني: «والمرأة إحرامها في وجهها, فإن احتاجت سدلت على وجهها» , وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه, إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة, وقد روى البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» (3). فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها؛ فإنها تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها, لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا _________ (1) مسلم، برقم 890، تقدم تخريجه. (2) البخاري، برقم 867، ومسلم، برقم 645، وتقدم تخريجه. (3) أخرجه البخاري، برقم 1838، وتقدم تخريجه.
(1/519)
جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا» (1). وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع لستر الوجه خاصة ولم تمنع من الحجاب مطلقاً, قال أحمد: «إنما لها أن تسدل على وجهها فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل». اهـ. وقال ابن رشد في البداية: «وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي, رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليها ... ». إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام, وأجمعوا على أنه يجب عليها ستره بحضور الرجال, فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجباً فستره في غيره أوجب. وكانت أسماء - رضي الله عنها - تستر وجهها مطلقاً, وانتقاب المرأة في الإحرام, لا يجوز لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة على أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية، ومعنى «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين, لا أن _________ (1) أخرجه أحمد، برقم 24021، وأبو داود، برقم 1835، واللفظ له، وتقدم تخريجه.
(1/520)
المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض؛ فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء، ومنهم العلامة الصنعاني - رحمه الله -، وبهذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقاً إلا ما ظهر من ذلك كله في حالة الاضطرار، أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك, وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع اللَّه - سبحانه وتعالى -؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء , وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. واللَّه المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه (1). 2 - أهمية الغطاء في وجه المرأة من عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ... وفقه اللَّه لكل خير، آمين. _________ (1) مجموع فتاوى ابن باز، 5/ 224 - 233.
(1/521)
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته , وبعد: فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم اللَّه بهداه وهذا نصه: «أرجو من فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واجب أوجبه الدين الإسلامي, وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك, إنني أسمع الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة, كما قرأت أنه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال كما تساعده في الحروب, فهل هذه الأشياء حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له إنني أنتظر الإجابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه؟ انتهى. الجواب: الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال, ثم شرع اللَّه سبحانه الحجاب للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها وحسماً لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1) الآية , والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - , فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة _________ (1) سورة الأحزاب، الآية 53.
(1/522)
المذكورة والمعنى في ذلك. وقال - سبحانه وتعالى - في السورة نفسها: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (1)، الآية؛ فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع, ومثل قوله - عز وجل - في سورة الأحزاب أيضاً {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (2) الآية. وأنزل اللَّه في ذلك أيضاً آيتين أخريين في سورة النور، وهما قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (3) الآية، والبعولة هم: الأزواج, والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوجه أعظمها، وقوله سبحانه: {إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} المراد به: الملابس في أصح قولي العلماء, كما قاله الصحابي الجليل عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ _________ (1) سورة الأحزاب، الآية 33. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59. (3) سورة النور، الآيتان: 30 - 31.
(1/523)
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1)، ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم - أن اللَّه سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة, فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه، وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة, ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة , وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء - رضي الله عنهما - ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب. وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرضه اللَّه سبحانه, وليس من عمل الأتراك, أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد, ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة, كما قالت أم سليم - رضي الله عنها -: «كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي _________ (1) سورة النور، الآية: 60 ..
(1/524)
المرضى» (1)، هكذا كان عملهن، لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن متبرجات مبتذلات، فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة, وتفكك الأسر , وفساد المجتمع. ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم, ونسأل اللَّه أن يهدي الجميع صراطه المستقيم, وأن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به, إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته (2). 3 - لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز سلمه اللَّه. السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد: أنا امرأة متزوجة أقوم أحياناً في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر إذا جلست ما فوق الركبة، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل ولتخفيف شدة الحر وكذلك لأتزين أمام زوجي، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 9 سنوات وخشية ألا تزول المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا، لكنني لم أقبل نصيحته على أساس أن _________ (1) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب رد النساء الجرحى والقتلى، برقم 2883. (2) مجموع فتاوى ابن باز، 3/ 354 - 356.
(1/525)
أطفالنا ما زالوا صغاراً وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة. وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك والتوجيه بما ترون. والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته (1). ج: وعليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد: لا يجوز لك لبس الثياب الرقيقة التي تصف العورة، ولو لم يكن عندك أحد، وهكذا اللباس القصير الذي فوق الركبة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك وقال: «اللَّه أحق أن يستحيا منه من الناس» (2). وفق اللَّه الجميع, والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية (3) _________ (1) سؤال شخصي مقدم من السائلة ص. ن. س. وقد أجاب عنه سماحته: في 3/ 8/1418هـ. (2) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، برقم (2693)، وأبو داود في (كتاب الحمام)، باب ما جاء في العري، برقم (3501)، وابن ماجه في (كتاب النكاح)، باب التستر عند الجماع، برقم (1910). (3) مجموع فتاوى ابن باز، 21/ 184 - 185.
(1/526)
المبحث الثامن: الاختلاط
المطلب الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً
أولاً: الاختلاط لغة: يقال: خَلَطَ الشيء بالشيء يَخْلِطُه خَلْطاً، وخَلَّطَه فاخْتَلَطَ: مَزَجَه، واخْتَلَطا وخالطَ الشيءَ مُخالَطة وخِلاطاً: مازَجَه. والخِلاط: اخْتِلاطُ الإِبِل، والناسِ، والمَواشي، ويقال: ... أَخْلاطٌ من الناس، وخَلِيطٌ، وخُلَيْطى، وخُلَّيْطى: أَي أَوْباشٌ مُجْتَمِعُون مُخْتَلِطُون. وخلَط القومَ خَلْطاً، وخالَطَهم: داخَلَهم. والخَلِطُ: المختلط بالناس المُتَحَبِّبُ، يكون للذي يَتَمَلَّقُهم، ويتحَبَّبُ إِليهم، ويكون للذي يُلْقي نساءَه ومتاعَه بين الناس (1). وقال العلامة الفيُّومي - رحمه الله -: «خلطت الشيء بغيره خَلْطًا من باب ضرب: ضممته إليه فَاخْتَلَطَ هو، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في خلط الحيوانات، وقد لا يمكن كَخَلْطِ المائعات فيكون مزجاً ... وقد توسع فيه حتى قيل: رجل خَلِيطٌ إذا اخْتَلَطَ بالناس كثيراً، والجمع: الخُلَطَاءُ» (2). _________ (1) لسان العرب، لابن منظور، مادة (خلط)، 7/ 291 - 295 بتصرف. (2) المصباح المنير، 1/ 177.
(1/527)
وقال ابن فارس - رحمه الله -: «(خلط): الخاء، واللام، والطاء أصل واحد ... تقول: خلطت الشيء بغيره فاختلط» (1). ويقال: خلط الشيء بالشيء: ضمه إليه، قال اللَّه تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2). والخليط: المجاور، والشريك، ومنه قول اللَّه تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (3) (4). فالاختلاط في اللغة: يطلق على الامتزاج، والاجتماع، والمداخلة بالأبدان، والانضمام والضم، والمجاورة، والاشتراك من الشريك، واللَّه تعالى أعلم. ثانياً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح: 1 - هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعاً يؤدي إلى ريبة (5). _________ (1) معجم مقاييس اللغة، ص 327، وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 2/ 62. (2) سورة التوبة، الآية: 102. (3) سورة ص، الآية: 24. (4) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص 119. (5) عودة الحجاب، لمحمد بن إسماعيل المقدم، 3/ 52، وانظر: التبرج لعكاشة الطيبي، ص 68، وتحريم الاختلاط للبداح، ص 9.
(1/528)
2 - وقيل: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم: بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن من غير حائل، أو مانع يدفع الريبة والفساد (1). 3 - وقيل: الاختلاط هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد، بحكم العمل، أو البيع، أو الشراء، أو النزهة، أو السفر، أو نحو ذلك (2). 4 - وقيل: «هو اختلاط جنسي الذكور والإناث اختلاطاً منظماً، ومقنّناً في مجال العلم، أو العمل، أو نحوهما، بمختلف الوجوه، كالاختلاط في الدراسة الجامعية، أو في ميدان العمل بالدوائر الرسمية، والمحلات التجارية، والشركات، والمعامل وغير ذلك» (3). 5 - وقيل: هو: «اجتماع الرجال بالنساء في التعليم، والعمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة، والخاصة، وغيرها» (4). _________ (1) المرجع السابق، 3/ 52، والتبرج لعكاشة الطيبي، ص 68، وتحريم الاختلاط للبداح، ص 9. (2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، 1/ 420، وعنوان هذا المبحث: «خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله». (3) العلاقات الجنسية غير الشرعية، عبد الملك السعدي، ص 312، وانظر: تحريم الاختلاط والرد على من أباحه، للدكتور عبد العزيز البداح، ص 10. (4) حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد، ص 81، وانظر: تحريم الاختلاط والرد على من أباحه، لعبد العزيز البداح، ص 9.
(1/529)
6 - وقيل: «هو اختلاط جنسي الذكور والإناث بمختلف الوجوه، كالاختلاط في الدراسة الجامعية، أو في ميدان العمل بالدوائر الرسمية، والمحلات التجارية، والشركات، والمعامل، وغير ذلك» (1). 7 - وقيل: الاختلاط: هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم اجتماعاً يؤدي إلى ريبة، والأمر بالقرار في البيت وتحريم الخلوة يعتبران نهياً عنه» (2). 8 - وقيل: الاختلاط المحرم: هو اجتماع النساء بالرجال الأجانب اجتماعاً خاصاً أو عاماً يحدث بسببه الافتتان» (3). 9 - والتعريف الاصطلاحي المختار للاختلاط المحرم هو: انضمام واجتماع ومداخلة الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم: بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن، من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. واللَّه تعالى أعلم. ويؤخذ من هذا التعريف الاصطلاحي للاختلاط المحرم: أنه كل اجتماع بين الرجال الأجانب والنساء غير المحارم، يحصل به انضمام، أو اجتماع، أو مداخلة بالنظر، أو الإشارة، أو الابتسامة _________ (1) التبرج والاختلاط، عثمان بن ناعورة، ص 42، وتحريم الاختلاط، للبداح، ص9. (2) المرأة والشريعة الإسلامية، لمحمد الأباصيري، ص 47، وانظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر، لأبي محمد بن عبد اللَّه الإمام، ص29. (3) انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر، لأبي محمد بن عبد اللَّه الإمام، ص29.
(1/530)
والضحك، أو الكلام المحرم، أو ملامسة الأبدان بالاحتكاك أو المصافحة، أو غير ذلك، مثل ما يحصل: في الدراسة الجماعية في الجامعات المختلطة، أو المدارس المختلطة بين الجنسين، وكذا ما يحصل في ميدان العمل بالدوائر الرسمية، أو البيع أو الشراء، أو النزهة أو السفر، أو العمل بالشركات أو المحلات التجارية، أو المستشفيات: والاختلاط بين الأطباء والطبيبات، وبالممرضين والممرضات، ومن ذلك كل طبيب عنده ممرضة، أو طبيبة عندها ممرض، يخلو بها في بعض الأوقات، أو السكرتيرة للطبيب، والسكرتير للطبيبة، أو الاختلاط في المؤتمرات، أو الندوات، أو المحاضرات، أو الاجتماعات، أو الأكل الجماعي في المطاعم، سواء كانت عامة أو خاصة، أو خدمة النساء للرجال الأجانب، وتقديم الأطعمة أو المشروبات مباشرة بدون حجاب، ولا حائل، كما يحصل في الطائرات وغيرها. فهذا هو الاختلاط المحرم الذي لا شك في تحريمه، نسأل اللَّه السلامة والعافية.
(1/531)
المطلب الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته
أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي: 1 - اختلاط الأولاد: الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة- في المضاجع بعد التمييز، فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينهم في المضاجع، فعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» (1). 2 - اتخاذ الخدم الرجال، واختلاطهم بالنساء، وحصول الخلوة بهن، رُوِي في بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوَلَت أحَدَ ابنَيْها بلالًا أو أنسًا قال: «رأيت كفًا» يعني أنه لم يَرَ وجهًا (2)، وقد كان أنس - رضي الله عنه - خادمًا خاصّاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعيش عنده كأحد أهله. 3 - اتخاذ الخادمات اللائي يبقين بدون محارم، وقد تحصل بهن الخلوة. 4 - السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم _________ (1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم 495، وأحمد، 11/ 369، برقم 6757، والمستدرك، 1/ 197، والدارقطني، 1/ 230، ومصنف ابن أبي شيبة، 1/ 304، برقم 3482، والسنن الكبرى للبيهقي، 2/ 228، ومسند البزار، 17/ 189، وحسنه النووي في رياض الصالحين، ص 378، وحسن إسناده الألباني، في صحيح أبي داود، 2/ 401، برقم 509. (2) تكملة فتح القدير، 8/ 98.
(1/532)
إلى ما لا تحمد عقباه، فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضًا. 5 - استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب، وأصدقاءه- في حال غيابه ومجالستهم. 6 - الاختلاط في دور التعليم كالمدارس، والجامعات، والمعاهد، والدروس الخصوصية. 7 - الاختلاط في الوظائف، والأندية، والمواصلات، والأسواق، والمستشفيات، والزيارات بين الجيران، والأعراس، والحفلات. 8 - الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعد، والمكاتب، والعيادات، وغيرها (1). ثانياً: أقسام الاختلاط: المباح، والمحرم: له ثلاث حالات: قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. _________ (1) انظر: عودة الحجاب، لمحمد أحمد المقدم، 3/ 56 - 57.
(1/533)
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت، والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر؛ ولكشف حقيقة هذا القسم فإنَّا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل: أما المجمل: فهو أن اللَّه تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصَّل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سدَّ الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فستة: ... ». ثم ذكرها - رحمه الله - (1)، ثم قال: «وأما _________ (1) الأدلة التي ذكرها: قوله تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ... } [سورة يوسف، الآية: 23]، والثاني قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْضَارِهِمْ ... } [سورة النور، الآيتان: 30 - 31]، قال: والثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ... ، والرابع: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ... } [سورة النور، الآية: 31]، والخامس: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [سورة غافر، الآية: 19]، والدليل السادس: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ... } [سورة الأحزاب، الاية: 33].
(1/534)
الأدلة من السنة، فإننا نكتفي بعشرة أدلة»، ثم ساقها - رحمه الله - (1) (2). ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين: لم يكن اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل والتعليم معروفاً في مجتمعات المسلمين، ولم يعرف قبل تمكن الاحتلال الفرنسي والإنجليزي من أرض الإسلام، وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ التعليم في العراق 1921 م- 1932 أن أعيان البصرة كتبوا لرئيس مجلس الوزراء في العراق كتاباً يتضمن استنكاراً لما قام به مدير المعارف في وقته من زيارة مدرسة للبنات، واعتبروا ذلك تغريباً وسبيلاً للسفور (3). وقد دخل الاختلاط في أماكن التعليم بلاد الإسلام في أول الأمر عن طريق المدارس الأجنبية التي أنشأها المحتل الأجنبي (4)، حيث إن أول مدرسة للبنات فتحها المنصرون في الدولة العثمانية في بيروت عام 1830 م، تبع ذلك افتتاح مدارس كثيرة للبنات في مصر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والهند والأفغان، التي بدأت في أول أمرها للبنات، ثم تحولت مختلطة بين الجنسين (5). _________ (1) وسأذكرها إن شاء اللَّه في الأدلة على تحريم الاختلاط المحرّم. (2) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية في زمنه، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية، 10/ 35. (3) تاريخ التعليم في العراق، ص 121. (4) المدارس الأجنبية، بكر أبو زيد، ص 34، والمدارس الأجنبية في الخليج، عبد العزيز البداح، ص 341. (5) المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام، محمد الصواف، ص 220.
(1/535)
وظهر التيار التغريبي في مصر - أنموذجاً- وجرى على يديه الاختلاط في أماكن العمل والتعليم عن طريق ثلاثة مسارات: المسار الأول: عن طريق المستغربين [كأحمد لطفي السيد الهالك سنة 1382هـ]، وهو أول من أدخل الفتيات المصريات في الجامعات مختلطات بالطلاب سافرات الوجوه، لأوَّل مرة في تاريخ مصر، يناصره في ذلك طه حسين الهالك سنة 1393هـ] (1)، الذين أمسكوا بأزمة الجامعة المصرية، فأدخلوا البنات فيها بشكل تدريجي حتى صارت مختلطة بين الطالبات والطلاب، ولما ثار عليهم علماء الأزهر، قال طه حسين قولته الماكرة: «لاأعلم نصاً في كتاب اللَّه أو سنة نبيه يمنع اختلاط الشبان بالشابات لطلب العلم»!!! (2). ولما وقعت بعض جرائم الزنا إبان افتتاح الجامعة المصرية قال بكل صراحة: «لا بد من ضحايا» لكنه لم يذكر هذه الضحايا في سبيل ماذا؟!! (3). المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم الذين دعوا إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، فكانوا سنداً للمستغربين، وعوناً لهم، كرفاعة الطهطاوي في كتابه «تلخيص الإبريز في تاريخ باريز»، وخير _________ (1) انظر: حراسة الفضيلة، للعلامة بكر أبو زيد، ص 139. (2) انظر: طه حسين في ميزان الإسلام، أنور الجندي، ص 61 - 62. (3) المرأة المسلمة، وهبي غاوجي، ص 242.
(1/536)
الدين التونسي في كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» (1)، ومحمد عبده الذي كتب بعض فصول كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين (2)، وعبد العزيز جاويش الذي أنشأ مجلة «الهداية»، وهي تستهدف تقريب الدين من الثقافة الغربية الحديثة، وقد نشرت مقالاً لعبد القادر المغربي عن حجاب المرأة دعا فيه إلى السفور والاختلاط، واستشهد فيه - على زعمه - بأحاديث وآثار شرعية!! (3). المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة المتعلقة بعمل المرأة وتعليمها واختلاطها بالرجال، مستهدفة ذلك الحاجز القوي الذي أقامه الإسلام على أساس المحافظة على العِرض والشرف والخلق، حين دعا إلى حماية كرامة المرأة بالفصل بينها وبين الرجل في المجتمعات ودوائر الأعمال، وفي لقاء البيوت والأسر (4). وهكذا انتشر وباء الاختلاط في مجتمعات المسلمين بعد تآزر قوى الظلام (المستغربون، أدعياء العلم، أقلام الصحافة المسمومة) وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل (5). _________ (1) الإسلام والحضارة الغربية، محمد حسين، ص 18. (2) مؤامرات على الحجاب، البرازي، ص 57. (3) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، محمد حسين، ص 357 - 360. (4) الصحافة والأقلام المسمومة، أنور الجندي، ص 32 - 33. (5) تحريم الاختلاط والرد على من أنكره، لعبد العزيز البداح، ص 52 - 54.
(1/537)
المطلب الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية
أولاً: الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب محرّم تحريماً مؤكداً؛ لأن العِفَّة حجاب يُمَزِّقه الاختلاط، ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم، وللنساء مجتمعاتهن، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية. كل هذا لحفظ الأعراض، والأنساب، وحراسة الفضائل، والبعد عن الرِّيب والرذائل، وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في بيتها؛ ولذا حُرِّم الاختلاط، سواء في التعليم، أم العمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة، والخاصة، وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب، وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحياء، وتقلص العفة والحشمة، وانعدام الغيرة. ولهذا فإن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال: «المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية»، التي فتحت أول ما فتحت في بلاد الإسلام في: (لبنان) كما بينه العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله - في كتابه: «المدارس الاستعمارية
(1/538)
-الأجنبية العالمية- تاريخها ومخاطرها على الأمة الإسلامية» (1). وقد عُلِم تاريخيّاً أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا وإخضاعها؛ بتضييع مقومات كرامتها، وتجريدها من الفضائل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي الحكيم. كما عُلِمَ تاريخياً أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات، وزوال الدول، كما كان ذلك لحضارة (2) اليونان والرومان، وهكذا عواقب الأهواء والمذاهب المضلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجَعْدِ المعطِّل وغيره من الأسباب» (3). وقال ابن القيم - رحمه الله - ما مختصره: «فصل: ومن ذلك أن وليّ الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرَج، ومجامع الرجال ... فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (4)، ... وفي حديث آخر أنه قال للنساء: «علَيْكُنَّ حافات الطريق» (5). _________ (1) انظر: حراسة الفضيلة، لبكر أبو زيد، ص 82. (2) المرجع السابق، ص 81 - 82. (3) مجموع الفتاوى، 13/ 182. (4) البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، برقم 5096، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب، برقم 2740. (5) أخرجه البيهقي في الشعب، 10/ 240، وفي الآداب له، برقم 668.
(1/539)
ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة، والرقاق، ومنعهنّ من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وإن رأى وليّ الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخّص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية. وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، واللَّه سائلٌ وليّ الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق. فعلى وليِّ الأمر أن يقتدي به في ذلك. وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صِحْ به، وقد أخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «أن المرأة إذا تطيَّبت وخرجت من بيتها فهي زانية» (1). _________ (1) لم أجد هذا اللفظ، وإنما ما ورد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ على القوم لِيَجِدُوا رِيحَهَا فهي زَانِيَةٌ». أخرجه أبو داود، برقم 4173، والترمذي، برقم 2786، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، برقم 5126، والحاكم، 2/ 397، وأخرجه أيضًا: أحمد، برقم 19711، وقال محققو المسند: «إسناده جيد»، وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 216، برقم 2019، وفي غيره من كتبه.
(1/540)
ويمنع المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهدَ عشاء الآخرة في المسجد، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» (1). ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل كل بلية وشرّ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة (2). ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسل اللَّه عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفاً، والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين - لكانوا أشد شيء منعاً لذلك» انتهى كلامه - رحمه الله - (3). _________ (1) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب حدثنا محمد بن بشار، 3/ 476، برقم 1173، وابن خزيمة، 1/ 93، 1685، مسند البزار، 5/ 427، برقم 427، والطبراني في المعجم الكبير، 9/ 295، برقم 9481، والمعجم الأوسط، 3/ 189، برقم 2890، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 384، برقم 7698، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 1/ 303. (2) مثل: الإيدز وغيره. (3) الطرق الحكمية، لابن القيم، ص 324 - 326، بتصرف، وانظر: حراسة الفضيلة، لبكر أبو زيد، ص 81 - 84.
(1/541)
ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط بين النساء والرجال غير المحارم؛ ولهذا قال العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله - بعد أن ساق كلام ابن القيم - رحمه الله - آنف الذكر: «ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط، وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء ... » (1)، ثم ذكر - رحمه الله - الأسباب التي توصل إلى الاختلاط على النحو الآتي: 1 - تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها، للأحاديث المستفيضة كثرة وصحة، ومنها: خلوة السائق، والخادم، والطبيب وغيرهم بالمرأة، وقد تنتقل من خلوة إلى أخرى، فيخلو بها الخادم في البيت، والسائق في السيارة، والطبيب في العيادة، وهكذا!!. 2 - تحريم سفر المرأة بلا محرم، والأحاديث فيه متواترة معلومة. 3 - تحريم النظر العمد من أيٍّ منهما إلى الآخر، بنص القرآن والسنة. 4 - تحريم دخول الرجال على النساء، حتى الأحماء -وهم أقارب الزوج- فكيف بالجلسات العائلية المختلطة، مع ما هن عليه من الزينة، وإبراز المفاتن، والخضوع بالقول، والضحك .. ؟. 5 - تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية، حتى المصافحة للسلام. 6 - تحريم تشبه أحدهما بالآخر (2). _________ (1) حراسة الفضيلة، ص 84. (2) المرجع السابق، ص 85.
(1/542)
ثم قال - رحمه الله -: «وشرع لها صلاتها في بيتها، فهي من شعائر البيوت الإسلامية، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كما ثبت الحديث بذلك. ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذِنَ لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية: الأول: أن تؤمن الفتنة بها وعليها. الثاني: أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي. الثالث: أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع. الرابع: أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة. الخامس: أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. السادس: إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره. السابع: تكون صفوف النساء خلف الرجال. الثامن: خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. التاسع: إذا نابَ الإمامَ شيء في صلاته سَبَّح رجل، وصفقت امرأة. العاشرة: تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن، كما في حديث أم سلمة
(1/543)
- رضي الله عنها -، في صحيح البخاري وغيره. إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال، واللَّه أعلم». (1) ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، قال العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله -: «ولا بد من التنبيه إلى أن دعاة الإباحية، لهم بدايات تبدو خفيفة، وهي تَحْمِلُ مكايد عظيمة، منها في وضع لبنة الاختلاط، يبدؤون بها من رياض الأطفال، وفي برامج الإعلام، وركن التعارف الصحفي بين الأطفال، وتقديم طاقات -وليس باقات- الزهور من الجنسين في الاحتفالات». ثم قال - رحمه الله -: «إذا كان الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال مرفوضاً؛ لأنه ليس من عمل المسلمين على مدى تاريخهم الطويل في تعليم أولادهم في الكتاتيب وغيرها؛ ولأنه ذريعة إلى الاختلاط فيما فوقها من مراحل التعليم، فالدعوة إلى الاختلاط في الصفوف الأولى من الدراسة الابتدائية مرفوضة من باب أولى، فاحذروا أن تخدعوا أيها المسلمون!!. وهكذا .. من دواعي كسر حاجز النفرة من الاختلاط، بمثل هذه البدايات، التي يستسهلها كثير من الناس. _________ (1) حراسة الفضيلة، ص 85 - 86، ببعض التصرف.
(1/544)
فليتق اللَّه أهلُ الإسلام في مواليهم، وليحسبوا خطوات السير في حياتهم، وليحفظوا ما استرعاهم اللَّه عليه من رعاياهم، والحذر الحذر من التفريط والاستجابة لفتنة: الاستدراج إلى مدارج الضلالة، وكل امرئٍ حسيب نفسه» (1). _________ (1) حراسة الفضيلة، ص 86 - 87.
(1/545)
المطلب الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن
لما حرَّم الله الزنا حرَّم الأسباب الموصلة إليه؛ ولهذا قال العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله -: «قاعدة الشرع المطهّر: أن اللَّه سبحانه إذا حرّم شيئاً حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه، تحقيقاً لتحريمه، ومنعاً من الوصول إليه، أو القرب من حماه ... وفاحشة الزنا من أعظم الفواحش، وأقبحها وأشدها خطراً وضرراً، وعاقبةً على ضروريات الدين؛ ولهذا صار تحريم الزنا معلوماً من الدين بالضرورة. قال اللَّه تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} (1). ولهذا حرِّمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله، والتبرج ووسائله، والاختلاط ووسائله، وتشبه المرأة بالرجل، وتشبهها بالكافرات .. وهذا من أسباب الرِّيبة، والفتنة، والفساد» (2). أولاً: الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (3). _________ (1) سورة الإسراء، الآية: 32. (2) حراسة الفضيلة، 49. (3) سورة النور، الآيتان: 30 - 31.
(1/546)
يأمر اللَّه تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات وجوب غض البصر، وحفظ الفرج عن الزنا، ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، واختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل والتعليم من أعظم وسائل وقوع الفاحشة (1). وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: « ... فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن؛ لما يؤدي إليه من المفسدة، وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر، والسعي إلى ما هو أسوأ منه» (2). الدليل الثاني: قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (3). «يقول اللَّه تعالى آمرًا رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية (4). فلا يتعرض لهن من في قلبه مرض، فإذا كانت الشريعة تأمر المرأة بالحجاب عند خروجها لئلا يتعرض لها _________ (1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، 1/ 421. (2) مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم، 10/ 37. (3) سورة الأحزاب، الآية: 59. (4) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 11/ 242.
(1/547)
من في قلبه مرض، أفيتصور أن تجيز هذه الشريعة اجتماع الرجال بالنساء السافرات في أماكن العمل والتعليم مع ما يفرضه ذلك على المرأة من التبذل، ومن ثمَّ جرأة الفساق عليها؟!. الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (1). ومعنى هذه الآية الكريمة الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يعم جميع النساء بالمعنى «فإذا كانت أمهات المؤمنين الطاهرات قد أُمرن بذلك فغَيْرهن من باب أولى؛ ولأنهن القدوة لنساء الأمة» (2)، كيف والشريعة جاءت بلزوم النساء بيوتهن، والانطفاف عن الخروج منها إلا لضرورة (3)، وإذا كانت الشريعة قد جاءت بمنع المرأة من الخروج من بيتها لغير حاجة درءاً للفتنة، وصيانة للمرأة، فهل يصحّ أن يكون خروجها للعمل والدراسة مع الرجال التي هي مواضع فتنة جائزاً شرعاً؟ ويؤخذ من قوله تعالى: {وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ} الأمر بالقرار في البيوت سداً لباب الاختلاط؛ لأنه خروج لغير ضرورة معتبرة فاتح لباب الاختلاط، ويؤخذ من قوله تعالى: {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 33. (2) انظر: تحريم الاختلاط للبداح، ص 12، نقله عن صالح الفوزان. (3) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 14/ 227.
(1/548)
الجَاهِلِيَّةِ} أن تبرج المرأة يدعو إلى القرب منها، واللقاء بها، والمحادثة معها، فترك التبرج يحميها من الاختلاط (1). الدليل الرابع: قول اللَّه تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (2). قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته: «وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف - عليه السلام - ظهر منها ما كان كامناً، فطلبت منه أن يوافقها، ولكن أدركه اللَّه برحمته، فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (3)، وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء، اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه» (4). الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (5). _________ (1) انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر، ص 114،وانظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، 10/ 38 .. (2) سورة يوسف، الآية: 23. (3) سورة يوسف، الآية: 34. (4) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم، 10/ 36. (5) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/549)
أمر اللَّه تعالى المؤمنين إذا سألوا نساء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حاجة - ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى - أن يسألوهم من وراء حجاب (1)، والأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط (2). الدليل السادس: قول اللَّه تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} (3). ففي هذه الآية بيّن جلّ وعلا أن ابنتي شيخ مدين لا تسقيان الماء حتى يصدر الرعاء لئلا يختلطا بالرجال (4)، وهذا فيه مدح وثناء على هذا الخُلُق والسلوك كما هو بيِّنٌ من السياق. الدليل السابع: قول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (5). قال السعدي - رحمه الله -: «والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» خصوصاً هذا الأمر الذي في _________ (1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 14/ 178. (2) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم، 10/ 244. (3) سورة القصص، الآية: 23. (4) التفسير الكبير للرازي، 23/ 204. (5) سورة الإسراء، الآية: 32.
(1/550)
كثير من النفوس أقوى داع إليه» (1). وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «ولا يصح لعاقل أن يشك في أن اختلاط الجنسين في غاية الشباب ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق إلى انتشار الفاحشة وفشو الرَّذيلة بين الجنسين» (2). وقال أيضاً: «ومعلوم أن اختلاط الجنسين في الجامعات على الحالات المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه لذريعة الزنا كما هو مشاهد مشاهدة لا يمكن معها الجدال إلا من مكابر» (3). الدليل الثامن: قول اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (4)، قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته: «وجه الدلالة أن اللَّه تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط» (5). ثانياً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال: الدليل الأول: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا _________ (1) تفسير السعدي، ص 457. (2) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 78. (3) المصدر السابق، ص 80. (4) سورة غافر، الآية: 19. (5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 38.
(1/551)
وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (1). فدلّ هذا الحديث العظيم على: أن تفضيل الصفوف الأخيرة مع فوات أجر التقدم (2) يدلّ على مشروعية بعد المرأة عن الرجال، وأنها كلما كانت أبعد عنهم كانت أقرب إلى الخير، وكلما قربت منهم كانت أقرب إلى الشر، فدلّ على أن الاختلاط شر، والبعد عنه خير. قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال؛ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال، وَرُؤْيَتهمْ، وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ، وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم» (3). وقال الشوكاني - رحمه الله -: «قوله: «خير صفوف النساء آخرها» إنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال» (4). وقال السندي - رحمه الله - في حاشيته على سنن النسائي: «أي أقلها أجراً، وفي النساء بالعكس؛ وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة، ثم _________ (1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الصف الأول فالأول ... ، برقم 440. (2) فإن الأصل أن المتقدم أعظم أجراً، وله أجر من خلفه؛ لأنهم يقتدون به؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخراً، فقال لهم: «تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللَّه». (3) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 159. (4) نيل الأوطار، 3/ 226.
(1/552)
هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه، وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل، ويمكن حمله على إطلاقه؛ لمراعاة الستر. فتأمل واللَّه تعالى أعلم» (1). وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد هذا الحديث: «فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة، مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى» (2). وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «ولا ينبغي أن يغرَّنا ما يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلِّدين للكفار من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ باللَّه، هو الذي يُزيّن ذلك في قلوبهم، وإلاّ فلا شكَّ أنّ الأمم التي كانت تُقدّم النساء وتجعلهن مع الرجال مختلطات، لا شكَّ أنّها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر، يتمنون الخلاص منه، فلا يستطيعون» (3). الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود - رضي الله عنه -: عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي _________ (1) حاشية السندي على سنن النسائي، 2/ 94. (2) مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 30. (3) شرح رياض الصالحين، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، 3/ 152 - 153.
(1/553)
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» (1). قال في عون المعبود: «(صلاة المرأة في بيتها) أي الداخلاني لكمال سترها (أفضل من صلاتها في حجرتها) أي صحن الدار، قال ابن الملك: أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها، وهي أدنى حالاً من البيت، (وصلاتها في مخدعها) - بضم الميم، وتفتح وتكسر، مع فتح الدال في الكل- وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، يحفظ فيه الأمتعة النفيسة من الخدع، وهو إخفاء الشيء، أي في خزانتها أفضل من صلاتها في بيتها؛ لأن مبنى أمرها على التستر» (2). فإذا فُضِّلَ في حقّ المرأة الصلاة في بيتها بُعداً عن الفتنة، ومخالطة الرجال، فمنعها من الاختلاط بالرجال في أماكن العمل والتعليم من باب أولى. وقال المباركفوري - رحمه الله -: «فائدة: اعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ومع هذا لو استأذنت للصلاة إلى المسجد لا تُمنع، بل تؤذن لكن لا مطلقاً، بل بشروط قد وردت في الأحاديث. _________ (1) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديدفي خروج النساء إلى المساجد، برقم 570، وابن خزيمة، 3/ 95، برقم 1690، والحاكم، 1/ 209، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي، 3/ 131، والبزار، 5/ 426، برقم 2060، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 108، برقم 579. (2) عون المعبود، 2/ 195.
(1/554)
قال النووي - رحمه الله -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه»، هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذةً من الأحاديث، وهي أن لا تكون مطيبةً ولا متزينةً، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابةً ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. انتهى كلام النووي (1). وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قالَ ابن دَقِيق العِيد: هَذا الحَدِيث عامّ فِي النِّساء، إِلاَّ أَنَّ الفُقَهاء خَصُّوهُ بِشُرُوطٍ، مِنها: أَن لا تَتَطَيَّب، وهُو فِي بَعض الرِّوايات: «وليَخرُجنَ تَفِلات» (2) أي غَير مُتَطَيِّبات ... _________ (1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 161. (2) أخرجه أحمد، 15/ 405، برقم 9645، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، 1/ 210، برقم 565، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 134، برقم 5160، وابن خزيمة، 3/ 90، برقم 1679. والشافعي في مسنده، ص 171، ومعرفة السنن والآثار، 4/ 237، وعبد الرزاق، 3/ 151، برقم 5121، والدارمي، 1/ 98، برقم 1314، وابن الجارود (1/ 91، رقم 332).، وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أحمد، 36/ 7، برقم 21674، وابن حبان، 5/ 589، برقم 2211، والبزار، 9/ 231، والطبراني، 5/ 248، برقم 5239، والجملة الأولى في الصحيحين: البخاري: كتاب الجمعة، باب حدثنا عبد اللَّه بن محمد، برقم 900، ومسلم، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم 442. وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 7/ 212، والإرواء، برقم 515, وصحيح أبي داود، برقم 574.
(1/555)
ولِمُسلِمٍ مِن حَدِيث زَينَب امرَأَة ابن مَسعُود: «إِذا شَهِدَت إِحداكُنَّ المَسجِد فَلا تَمَسَّنَّ طِيبًا» (1). قالَ: ويَلحَق بِالطِّيبِ ما فِي مَعناهُ؛ لأَنَّ سَبَب المَنع مِنهُ ما فِيهِ مِن تَحرِيك داعِيَة الشَّهوة كَحُسنِ المَلبَس والحُلِيّ الَّذِي يَظهَر، والزِّينَة الفاخِرَة، وكَذا الاختِلاط بِالرِّجالِ» (2). وقال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُتَطَيِّبَةَ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى الْمَسْجِدِ; لِأَنَّهَا تُحَرِّكُ شَهْوَةَ الرِّجَالِ بِرِيحِ طِيبِهَا، فَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَلْحَقُوا بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ: كَالزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ، وَصَوْتِ الْخَلْخَالِ، وَالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، وَالِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِجَامِعِ أَنَّ الْجَمِيعَ سَبَبُ الْفِتْنَةِ بِتَحْرِيكِ شَهْوَةِ الرِّجَالِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ كَمَا تَرَى» (3). الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (4). _________ (1) أخرجه مالك في الموطأ، 2/ 276، ومسلم، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم 443، ولفظه: «فلا تمس طيباً». (2) تحفة الأحوذي، 3/ 130، ونص الحافظ في فتح الباري، 2/ 350. (3) أضواء البيان، 5/ 546. (4) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلونّ رجل بامرأة، برقم 5232، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2172.
(1/556)
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وتَضَمَّنَ مَنعَ الدُّخُول مَنع الخَلوة بِها بِطَرِيقِ الأَولَى» (1). وقال الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ التَّحْذِيرُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ، وَلَوْ لَمْ تَحْصُلِ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَالدُّخُولُ عَلَيْهِنَّ، وَالْخَلْوَةُ بِهِنَّ، كِلَاهُمَا مُحَرَّمٌ تَحْرِيمًا شَدِيدًا بِانْفِرَادِهِ، كَمَا قَدَّمْنَا أَنَّ مُسْلِمًا - رحمه الله - أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كِلَيْهِمَا حَرَامٌ» (2). وقال أيضاً: «فتأمّلوا قوله - صلى الله عليه وسلم - في دخول قريب الزوج على زوجته: «الحمو الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه هو الموت» (3). وفيه التنصيص على عدم استثناء أقارب الزوج من هذا العموم. وقال القاضي عياض - رحمه الله -: «يريد لما فيه من الغرر المؤدي إلى الموت، فكذلك الخلو بالأحماء مؤدٍّ إلى الفتنة والهلاك في الدين؛ فجعله كهلاك الموت، فأورد هذا الكلام مورد التغليظ والتشديد، والأشبه أنه في غير أبي الزوج، ومن عدا المحارم منهم، واللَّه أعلم» (4). وقال القرطبي - رحمه الله -: «وقوله: «إياكم والدخول على المغيبات»؛ هذا _________ (1) فتح الباري، 9/ 331. (2) أضواء البيان، 6/ 546. (3) محاضرات الشيخ الأمين، ص 162. (4) إكمال المعلم، 7/ 61.
(1/557)
تحذير شديد، ونهيٌ وكيد ... وقال: وقوله: «الحمو الموت»؛ أي: دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة؛ أي: فهو مُحرَّم معلوم التحريم، وإنَّما بالغ في الزجر عن ذلك، وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة، لإلْفِهِم لذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة، وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدِّين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو برجمها إن زنت معه» (1). وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا: أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا، وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد: الْأَخ، وَابْن الْأَخ، وَالْعَمّ، وَابْنه، وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ، وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ، وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَوْت، وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ الْأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ» (2). وقال ابن الأثير: «يعني أنّ خَلْوة الحَمِ معها أشدّ من خلوة غيره من الغُرَباء؛ لأنه ربما حَسَّن لها أشياء، وحَمَلها على أمور تَثْقُل على الزَّوج من الْتِماس ما ليس في وُسْعه» (3). _________ (1) المفهم، 5/ 500 - 502 .. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 129 .. (3) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (حمو)، ص 236.
(1/558)
وقد ذكر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «جواباً عما يقوله أخو الزوج: لماذا لا تثق بي؟! ولماذا لا تتركني أدخل بيتك؟! فهذا مما يوجب التقاطع بين الأقارب، فقال: (إنه إذا حصل التقاطع بطاعة اللَّه فليكن، ما دمت أنا فعلت ذلك طاعة للَّه ورسوله فليكن، أليس اللَّه - عز وجل - يقول: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} (1)، يعني: لو بذلا غاية الجهد، وبلغا منك المشقة في التزين لا تطعهما، فأنا إذا أطعت اللَّه لا يهمني، إذا كان يريد أن يقطع الصلة بيني وبينه فليقطعهما، أما أن أخضع لأمر نهى عنه الشرع من أجل مراعاة هذا الرجل، وأنا أخشى على أهلي وعلى فراشي، فهذا لا يجوز أبداً» (2). الدليل الرابع: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنّه سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ أَضْحًى، أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، ولَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا، وَلاَ إِقَامَةً، ثمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ» (3). قال ابن حجر - رحمه الله -: «قَولُهُ: (ثُمَّ أَتَى النِّساءَ) يُشعِرُ بِأَنَّ النِّساءَ كُنَّ _________ (1) سورة لقمان، الآية: 15. (2) شرح صحيح البخاري، لابن عثيمين، 4/ 612. (3) البخاري، كتاب النكاح، باب {وَالَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ}، برقم 5249.
(1/559)
عَلَى حِدَةٍ مِنَ الرِّجالِ غَيرَ مُختَلِطاتٍ بِهِم» (1). فإذا كانت الشريعة قد شرعت فصل الرجال عن النساء في أفضل الأماكن وأطهر البقاع، وهي المساجد، فالفصل في أماكن العمل والتعليم من باب أولى وأحرى. الدليل الخامس: حديث أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ» (2). وإذا مُنِعَ الاختلاط في الطريق مع كونه عابرًا عارضًا فمنعه في المجالس، وأماكن العمل والتعليم أولى، وهذا قياسٌ أولويٌ، وقال ابن حجر معلّقًا على حديث أم سلمة في انصراف النساء قبل الرجال: «وَفِيهِ اِجْتِنَاب مَوَاضِع التُّهَم، وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلًا عَنْ الْبُيُوت» (3). وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «وجه الدلالة: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا منعهنّ من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى _________ (1) فتح الباري، 2/ 466. (2) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، برقم 5272، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 856. (3) فتح الباري، 2/ 336.
(1/560)
الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!» (1). الدليل السادس: حديث أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» (2). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزهري - رحمه الله -: «نَرَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ» (3). يؤخذ من هذا الحديث: أنّ النساء كنّ يقمن عقب الصلاة مباشرة، بإقرار من النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلمه، مما يدلُّ على مشروعية ذلك، ومع ثبوت الفضل في بقاء المصلي في مصلاه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْه» (4)، إلا أنهنّ كنّ يبادرن بالانصراف تجنبًا للاختلاط بالرجال، وهذا يدل على أنّ درء مفسدة الاختلاط مقدّمة على نافلة البقاء في المصلّى لتحصيل الفضل المذكور. وقد بوّب البيهقي الشافعي - رحمه الله - في السنن الكبرى على هذا الحديث بقوله: «باب مكث الإمام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل الرجال» (5). _________ (1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، 10/ 42. (2) البخاري، كتاب الصلاة، باب التسليم، برقم: 837. (3) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، بعد الحديث 870. (4) البخاري، كتاب المساجد، باب الحدث في المسجد، برقم 445. (5) سنن البيهقي، 2/ 182.
(1/561)
وقال بدر الدين العيني الحنفي في شرحه هذا الحديث: «فيه خروج النساء إلى المساجد، وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة الفساد» (1). وقال ابن بطال المالكي في شرحه: «وفي حديث أم سلمة من الفقه: أن خروج النساء ينبغي أن يكون قبل خروج الرجال» (2). وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في شرح الحديث: «وَفِي الْحَدِيث مُرَاعَاة الْإِمَام أَحْوَالَ الْمَأْمُومِينَ، وَالِاحْتِيَاط فِي اِجْتِنَاب مَا قَدْ يُفْضِي إِلَى الْمَحْذُور، وَفِيهِ اِجْتِنَاب مَوَاضِع التُّهَم، وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلًا عَنْ الْبُيُوت» (3). واستدلالاً بهذا الحديث قال البهوتي الحنبلي -كما في الإقناع مع شرحه-: «(فَإِنْ كَانَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ) مَأْمُومِينَ بِهِ (اسْتُحِبَّ لَهُنَّ) أَيْ لِلنِّسَاءِ (أَنْ يَقُمْنَ عَقِبَ سَلَامِهِ) وَيَنْصَرِفْنَ؛ لِأَنَّهُنَّ عَوْرَةٌ فَلَا يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ، (وَ) اسْتُحِبَّ (أَنْ يَثْبُتَ الرِّجَالُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُونَ مَنْ انْصَرَفَ مِنْهُنَّ)» (4). الدليل السابع: حديث أمِّ سلَمةَ - رضي الله عنها -: «إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ, وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ _________ (1) عمدة القاري، 6/ 122. (2) شرح ابن بطال لصحيح البخاري، 2/ 463. (3) فتح الباري، 2/ 336. (4) كشاف القناع، 1/ 487.
(1/562)
صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ, فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ» (1). قال ابن قدامة - رحمه الله -: «إذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ, فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَثْبُتَ هُوَ وَالرِّجَالُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُنَّ قَدْ انْصَرَفْنَ, وَيَقُمْنَ هُنَّ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ؛ لأن الإخلالَ بذلك من أحد الفريقين يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء» (2). وقال الكشميري: «قوله: (كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنْ المَكْتوبةِ قُمْنَ، وَثَبت رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِن الرِّجَالِ)، وذلك لئلا يلزمَ الاختلاطُ في الطريق» (3). الدليل الثامن: حديث عائشة - رضي الله عنها - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا» (4). قال ابن بطال: «هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء في الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يَتَبَيَّنَّ لمن لقيهنّ من الرجال؛ فهذا يدل أنهن لا يُقِمْنَ في المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود اللَّه، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة _________ (1) البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، برقم 866. (2) المغني، 2/ 336. (3) فيض الباري، للكشميري، 2/ 593. (4) البخاري، برقم 872، وتقدم تخريجه.
(1/563)
الإثم في الاختلاط بهن» (1). وقال ابن رجب: «وهذا يدل على سرعة خروجهن من المسجد عقيب انقضاء الصلاة مبادرة لما بقي من ظلام الغلس، حتى ينصرفن فيه، فيكون أستر لهن» (2). الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (3). وهذا الحديث يدل على أن المرأة فتنة ضارّة على الرجال، واتقاء الفتنة الضارة أو المضلة، واجب شرعي لأدلة كثيرة، وقد بوّب البخاري - رحمه الله - في كتاب الإيمان بقوله: «بابٌ من الدين الفرار من الفتن» (4)، وذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ» (5)، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» (6)، فإذا ثبت أن النساء فتنة للرجال، وأنّ اتقاء الفتنة واجبٌ، ثبت أن مخالطة الرجال للنساء محرمة لتضمنها ترك الواجب. _________ (1) شرح البخاري، لابن بطال، 2/ 473. (2) فتح الباري، لابن رجب، 5/ 316. (3) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (4) البخاري، كتاب الإيمان، قبل الحديث رقم 19. (5) البخاري، كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، برقم 19. (6) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم 2867.
(1/564)
وأفاد الحديث: أنّ فتنة النساء أضرّ الفتن على الرجال، والقاعدة في الشريعة: «تحريم كل ما فيه ضرر»؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» (1). وما قيل في حق الرجال مع النساء يقال في حق النساء مع الرجال؛ لأن ما ثبت للرجل يثبت نظيره للمرأة إلا ما دلّ الدليل على اختصاصه بالرجال؛ ولأنّ اختلاطها بالرجل إيقاع للضرر عليه، وإيقاع الضرر بالغير محرم للحديث السابق. وأفاد الحديث أن هذا الحكم عام في جميع الرجال، وجميع النساء، وذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «على الرجال من النساء»، غير أنّه يستثنى من هذا الحكم الزوج، والمحارم للأدلة المشهورة على جواز مخالطتهم. قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» ... وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون» (2). ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من _________ (1) أحمد، 5/ 55، برقم 2865، ومالك في الموطأ، 4/ 1078، برقم 2758، ومسند الشافعي، ص224، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم 2340، والحاكم، 2/ 58، والطبراني في الكبير، 2/ 86، والبيهقي، 6/ 70، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 250. (2) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 41 ..
(1/565)
النساء»، هذا حديث عظيم، يدل على أنه من مشكاة النبوة، وله صلة كبيرة بموضوعنا؛ لأن اختلاط النساء بالرجال هو من أعظم الفتن التي تدخل في خشية رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على أمته بعد وفاته من فتن النساء. وقد شرح العلماء هذا الحديث شرحاً واضحاً قال ابن بطال - رحمه الله -، وفي حديث أسامة أن فتنة النساء أعظم الفتن؛ مخافة على العباد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عمّم جميع الفتن بقوله: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، ... فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن» (1). وقال القرطبي - رحمه الله -: «ففتنة النساء أشدّ من جميع الأشياء، ويقال: في النساء فتنتان، وفي الأولاد فتنة واحدة، فأما اللتان في النساء، فإحداهما: أن تودي إلى قطع الرحم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات. والثانية: يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام» (2). وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» (3). وقال المناوي - رحمه الله -: «لأن المرأة لا تأمر زوجها إلا بشر، ولا تحثه إلا على شر، وأقل فسادها أن ترغبه في الدنيا؟ ليتهالك فيها، _________ (1) شرح ابن بطال لصحيح البخاري، 7/ 188. (2) تفسير القرطبي، 5/ 44. (3) فتح الباري، 9/ 173.
(1/566)
وأي فساد أضر من هذا، مع ما هنالك من مَظِنَّةِ الميل بالعشق، وغير ذلك من فتن وبلايا ومحن، يضيق عنها نطاق الحصر» (1). وقال المباركفوري: «لأن الطباع كثيراً تميل إليهن، وتقع في الحرام لأجلهن، وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا، وأي فساد أضر من هذا» (2). وقال العلامة ابن عثيمين: «يجب علينا أن نبصر هؤلاء القوم الذين يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجال، وأن نبين لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل؛ لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس لها إلا شهوة الفرج وملء البطن، أصبحت لا قيمة لها، وأصبحت ذليلة إما للدنيا واما لجبابرة الخلق» (3). وهذا الحديث فيه ثلاثة عمومات: العموم الأول: قوله: (فتنة) فهذه اللفظة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم عند علماء الأصول، فهي تعم جميع الفتن، فالافتتان بالنساء أعظم من الافتتان بغيرهن!!. العموم الثاني: قوله: (على الرجال) فهو لفظ يعم جميع الرجال المعنيين به، ويدل على هذا العموم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ _________ (1) فيض القدير، 5/ 436. (2) تحفة الأحوذي، 8/ 53. (3) شرح صحيح البخاري، لابن عثيمين، 4/ 447.
(1/567)
إِحْدَاكُن» (1)، والحازم هنا هو القوي في الإيمان التقي للرحمن، فإذا فتن بالنساء التقي، فمن باب أولى أن يفتن بهن الشقي!!. العموم الثالث: قوله: (من النساء) فالنساء عموماً يفتنّ الرجال، وكما يقال: لكل ساقطة لاقطة، فالنساء وإن تفاوتن في كيدهن وجمالهن ودينهن، إلا أنهن مما تحصل الفتنة بهن. وقد يشكل على القارئ القول بأن الافتتان بالنساء أعظم من كل فتنة؛ لأنه يدخل في ذلك أن الافتتان بهن أعظم من الشرك والكفر والإلحاد. والجواب عن هذا الإشكال هو موجود في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (2)، ومعناه: أن بني إسرائيل كانوا على خير وصلاح، فانحدروا إلى المعاصي، ثم إلى الشرك والكفر بسبب فساد من فسد من نسائهم، وهذا يظهر جلياً بمعرفة أمرين اثنين: الأول: أن النساء أسرع إلى المعاصي من الرجال؛ لكثرة الجهل فيهن، ولضعف عقولهن، إلا من رحم اللَّه، فهن يقبلن على اللهو والترف والغفلة والتأخر عن الطاعات أكثر من الرجال، بل يدفعن الرجال إلى ذلك، ويكلفنهم جمع المال من حلال أو حرام؛ من _________ (1) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم 304. (2) مسلم، برقم 2742، وتقدم تخريجه.
(1/568)
أجل أن يتحقق لهنّ ذلك، وهنّ أسرع تصديقاً لأهل الدجل والسحر والتنجيم وغيرهم من الرجال، بل ويدفعن الرجال إلى ذلك، وهذا أمر معلوم؛ فهذا منشأ كل فساد. الثاني: سرعة استجابة كثير منهنّ لمطالب الرجال الشهوانية المنحرفة، فإذا أرادوا الرقص طلبوا النساء فتقدمن إلى ذلك، واذا شربوا الخمور أرادوا النساء فاستجبن لذلك، واذا تاجروا بهنّ استسلمن لذلك، فترى الرجال المنحرفين يصطحبون النساء معهم، ويتوسعون في الفجور والميوعة، حتى يحصل الهلاك، والتاريخ مليء بهذا، فلو أن النساء لم يستجبن للرجال، لبقيت الحياة هينة» (1). الدليل العاشر: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (2). فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باتقاء النساء، والأمر يفيد وجوب المأمور به، فيجب على الرجال اتقاء النساء، ولا يتحقق هذا إلا بترك الاختلاط بهنّ، ومن وجه آخر فإنّ الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فيكون نهيًا عن مخالطة النساء؛ لأن المخالطة مضادة للاتقاء، والنهي يقتضي التحريم. ثم إنّ الأمر بالاتقاء معلل بكون النساء فتنة، فيدلّ على المنع _________ (1) انظر: الاختلاط أصل الشر، ص 126 - 127. (2) مسلم، برقم 2742، تقدم تخريجه.
(1/569)
من كل ما فيه فتنة؛ لأن (العلة تعمم معلولها). وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» مشروعية أخذ العبرة من المجتمعات التي وقعت فيها الفتن والضياع الأخلاقي بسبب مخالفة هذا الأمر (وَاتَّقُوا النِّسَاءَ). قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟!» (1). الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرجن وهن تَفِلات» (2). قال الخطابي في معالم السنن: «التفل: سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تتطيّب ونساء تفلات» (3). قال القاضي عياض: «خروج النساء للمساجد مباح لهنّ، ولكن على شروط كما جاء الحديث. وقاله العلماء: ألا يخرجن متطيبات ولا متزينات ولا مزاحمات للرجال» (4). وقال النووي - رحمه الله -: «هَذَا وَشَبَهه مِنْ أَحَادِيث الْبَاب ظَاهِر فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَع الْمَسْجِد لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاء مَأْخُوذَة مِنْ الْأَحَادِيث، _________ (1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 1/ 241. (2) أخرجه مسلم، برقم 442، أحمد، برقم 9645، وأبو داود، برقم 565، تقدم تخريجه. (3) معالم السنن، 1/ 162. (4) إكمال المعلم، 2/ 353.
(1/570)
وَهُوَ أَلَّا تَكُون مُتَطَيِّبَة، وَلَا مُتَزَيِّنَة، وَلَا ذَات خَلَاخِل يُسْمَع صَوْتهَا، وَلَا ثِيَاب فَاخِرَة، وَلَا مُخْتَلِطَة بِالرِّجَالِ ... » (1). وهذا يدل على تحريم التطيب على مريدة الخروج إلى المساجد؛ لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال (2). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قالَ ابن دقيق العيد: ويَلحَق بِالطِّيبِ ما فِي مَعناهُ لأَنَّ سَبَب المَنع مِنهُ ما فِيهِ مِن تَحرِيك داعِيَة الشَّهوة كَحُسنِ المَلبَس والحُلِيّ الَّذِي يَظهَر والزِّينَة الفاخِرَة وكَذا الاختِلاط بِالرِّجالِ» (3). وقال ابن الملقن - رحمه الله -: «وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط: أن يكون ذلك لضرورة، وأن تلبس أدنى ثيابها، وأن لا يظهر عليها الطيب، وما في معناه من البخور، وأن يكون خروجها في طرفي النهار، وأن تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال» (4). الدليل الثاني عشر: حديث زَينَب الثقفية امرَأَة ابن مَسعُود: «إِذا شَهِدَت إِحداكُنَّ المَسجِد فَلا تَمَسَّ طِيبًا» (5). _________ (1) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 161. (2) انظر: فيض القدير، 3/ 177، ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ونسبه إلى ابن دقيق العيد، 10/ 40. (3) فتح الباري، 3/ 114. (4) الإعلام، ابن الملقن، 2/ 240. (5) أخرجه مالك في الموطأ، 2/ 276، ومسلم، برقم 443، تقدم تخريجه.
(1/571)
قال الزرقاني: «لا تمس طيباً وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق به ما في معناه: كحلي يظهر أثره، وحسن ملبس، وزينة فاخرة، والاختلاط بالرجال، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة، ونحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة» (1). الدليل الثالث عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ» (2). قال ابن القيم: «نهى [الشرع] المرأة اذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً؛ وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها؛ فإن رائحتها وزينتها وصورتها، وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تَفِلَةً، وأن لا تتطيّب وأن تقف خلف الرجال، وأن لا تُسَبِّحَ في الصلاة إذا نابها شيء؛ بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، كل ذلك سداً للذريعة، وحماية عن المفسدة» (3). فدل هذا الحديث والحديثان قبله على أن المرأة ممنوعة من الخروج إلى المسجد إذا كانت متطيبة، فمنعها من الخروج إلى أماكن العمل والتعليم المختلطة من باب أولى. الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: _________ (1) شرح الزرقاني على موطأ مالك، 2/ 57. (2) مسلم، برقم 444، وتقدم تخريجه. (3) إعلام الموقعين، 3/ 161.
(1/572)
«لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ» (1). قال ابن حبان: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس للنساء وسط الطريق) لفظة إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة النساء الرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه، والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن» (2). الدليل الخامس عشر: حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحَة ربها وهي في قَعْر بيتها» (3). والمعنى ما دامت المرأة في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس بها، فإذا خرجت طمع وأطمع (4)، فكيف إذا كان خروجها للجلوس مع الرجال؟. قالت نبيلة بنت زيد بن سعد: «ومعنى الحديث: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فأمعن النظر إليها ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها بها، ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة» (5). _________ (1) صحيح ابن حبان، 12/ 415، برقم5601، والبيهقي في شعب الإيمان، 10/ 241، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 856. (2) صحيح ابن حبان، 12/ 417. (3) أخرجه الترمذي، برقم (1173)، وابن خزيمة، برقم (1685)، ومسند البزار، برقم 427، وتقدم تخريجه. (4) شرح الطيبي، 6/ 237. (5) كتاب التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي، ص 40 - 41.
(1/573)
وإذا كان خروج المرأة مصيدة الشيطان لها، فاصطياده لها عند اختلاطها بالرجال الأجانب أعظم وأولى. الدليل السادس عشر: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (1). قال العلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيد - رحمه الله -: «فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيوت، إذا بلغ الأولاد عشر سنين، فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم، وعدم اختلاطهم، لغرس العفة والاحتشام في نفوسهم، وخوفاً من غوائل الشهوة التي تؤدّي إليها هذه البداية في الاختلاط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال إبراهيم الحربي - رحمه الله -: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. كما في [ذم الهوى لابن الجوزي] (2)» (3). (4). _________ (1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم 495، وأحمد، 11/ 369، برقم 6757، والمستدرك، 1/ 197، والدارقطني، 1/ 230، ومصنف ابن أبي شيبة، 1/ 304، برقم 3482، والسنن الكبرى للبيهقي، 2/ 228، ومسند البزار، 17/ 189، وحسنه النووي في رياض الصالحين، ص 378، وحسن إسناده الألباني، في صحيح أبي داود، 2/ 401، برقم 509. (2) انظر: ذم الهوى، ص 116. (3) حراسة الفضيلة، 78. (4) انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر، ص 116.
(1/574)
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالتفريق بين الأولاد، وعدم اختلاطهم ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً أو ذكوراً مع أنهم أبناء عشر سنين، فكيف بمن هم أكبر منهم، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى (1)، «وفي هذا ردّ على من يرى اختلاط الذكور بالإناث في الصفوف الأولى من الدراسة» (2). الدليل السابع عشر: حديث عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضي الله عنها -، قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ» (3). قال ابن بطال: «هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً} وهذا إجماع من العلماء، وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «جهادكن الحج» دليل أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد؛ لأنهن لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار، وترك المباشرة للرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتار عنهم؛ فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد» (4). ففي هذا الحديث بيان أنه ليس على النساء قتال؛ لأن في ذلك _________ (1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، 10/ 40 .. (2) إضافة الشيخ صالح الفوزان، كما قال البداح في تحريم الاختلاط، ص 26 .. (3) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء، برقم 2875. (4) شرح البخاري، لابن بطال، 5/ 75.
(1/575)
تعريضاً لهن لمخالطة الرجال، أفتمنع الشريعة المرأة من القتال، وهو عبادة؛ لأنه مظنة الاختلاط بالرجال، وتجيز لها الاختلاط بالرجال في أماكن العمل والتعليم؟! حاشا للَّه. الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُنَّ؟» قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ، قَالَ: «هَلْ تَغْسِلْنَ؟»، قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «هَلْ تَحْمِلْنَ؟» قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟» قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» (1). قال العيني: «قوله: «خرج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ... »؛ لأن الرجال أقوى لذلك، والنساء ضعيفات، ومظنة للانكشاف غالباً، خصوصاً إذا باشرن الحمل؛ ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد» (2). الدليل التاسع عشر: حديث أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} (3)» (4). _________ (1) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع الجنائز، برقم 1578، مصنف ابن أبي شيبة، 5/ 252، برقم 25789، والبيهقي 4/ 77، والبزار، 2/ 249، وبنحوه عبد الرزاق، 3/ 456، برقم 6298، ولأبي يعلى، 7/ 109، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، برقم 344. (2) عمدة القاري، للعيني، 8/ 111. (3) سورة الطور، الآيتان: 1 - 2. (4) البخاري، كتاب الحج، باب طواف النساء بالحج مع الرجال، برقم 1514.
(1/576)
فقد أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون طوافها من وراء الناس غير مخالطة للرجال، والأمر يفيد الوجوب، وإذا ثبت ذلك في الطواف ثبت في غيره لعدم الفارق، ويبينه تبويب البخاري؛ حيث بوب عليه بقوله: «باب طواف النساء مع الرجال». قال الحافظ ابن حجر الشافعي - رحمه الله - في شرحه: «قَوله: «باب طَواف النِّساء مَعَ الرِّجال» أَي هَل يَختَلِطنَ بِهِم أَو يَطُفنَ مَعَهُم عَلَى حِدَة بِغَيرِ اختِلاط أَو يَنفَرِدنَ؟» (1). وقال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: «إِنَّمَا أَمَرَهَا - صلى الله عليه وسلم - بِالطَّوَافِ مِنْ وَرَاء النَّاس لِشَيْئَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ سُنَّة النِّسَاء التَّبَاعُد عَنِ الرِّجَال فِي الطَّوَاف. وَالثَّانِي: أَنَّ قُرْبهَا يُخَاف مِنْهُ تَأَذِّي النَّاس بِدَابَّتِهَا» (2). وقال البدر العيني الحنفي في شرحه لهذا الحديث: «وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها» (3). وقال ابن بطال المالكي في شرحه: «كذلك ينبغي أن تخرج النساء إلى حواشي الطرق، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف _________ (1) صحيح البخاري، 1/ 177. (2) شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 20. (3) عمدة القاري، 9/ 262.
(1/577)
النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح، قال غيره: طواف النساء من وراء الرجال هي السنة؛ لأن الطواف صلاة، ومن سنة النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال، فكذلك الطواف» (1). وقال السندي في حاشية النسائي: «ففيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن، حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة، لا في حال طواف الرجال، واللَّه تعالى أعلم» (2). وقال الباجي المالكي في شرح الموطأ: «(مسألة): وأما طواف النساء من وراء الرجال فهو للحديث الذي ذكرناه «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»، ولم يكن لأجل البعير، فقد طاف رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على بعيره يستلم الركن بمحجنه، وذلك يدل على اتصاله بالبيت» (3). وعلل الزرقاني المالكي في شرح الموطأ أمرها بالطواف من وراء الناس بقوله: «لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف» (4). وقال القاضي عياض المالكي: «وكونها من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النساء مع الرجال؛ لئلا يختلطن بهم» (5). _________ (1) شرح ابن بطال لصحيح البخاري، 2/ 112. (2) 5/ 223. (3) المنتقى، 2/ 372. (4) 2/ 415. (5) إكمال المعلم، 4/ 182.
(1/578)
وأمرها بالطواف من وراء الناس ووقتَ صلاتهم مع أنّ الأصل أن الاقتراب من الكعبة حال الطواف أفضل من الابتعاد (1) يدلُّ على أنّ مصلحة البُعدُ عن الاختلاط بالرجال قدرَ الإمكان أهم وأولى، والقاعدة الشرعية تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما. ويوضح هذا الحديث ويقويه ماجاء في صحيح البخاري: عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ. قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَالِ!. قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟. قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ!. قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ. يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ» (2). قال ابن حجر في شرحه: «قَوْله: (وَقَدْ طَافَ نِسَاء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَال) أَيْ غَيْر مُخْتَلِطَات بِهِنَّ» (3)، وقال: «قَوْله: (حَجْرَة) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم بَعْدهَا رَاءٍ أَيْ نَاحِيَة، قَالَ الْقَزَّاز: هُوَ مَأْخُوذ _________ (1) نص على أفضلية القرب من الكعبة جماعة من الفقهاء، بل قال النووي في المجموع، 8/ 39: «يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف». (2) البخاري، كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، برقم 1539. (3) فتح الباري، 3/ 480.
(1/579)
مِنْ قَوْلهمْ: نَزَلَ فُلَان حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلًا» (1). وهذا الحديث يدل على أمور، منها: الأول: أنّ استعمال لفظة «الاختلاط» على هذا المعنى معروفٌ من فجر الإسلام، فهو لفظ أصيل واستعمالٌ سلفيٌّ معروف، وليس مصطلحًا دخيلاً كما ادّعى البعض!. الثاني: أنّ ترك الاختلاط بالرجال، حتى في الطواف هو هدي الصالحات الطاهرات أمهات المؤمنين، مع أنهنّ أبعد النساء عن الافتتان ونحوه. الثالث: أن الاختلاط بالرجال مستنكرٌ في ذلك الزمن المفضّل؛ ولذلك قال ابن جريج متعجبًا مستنكرًا: «كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ!». الرابع: أنّ الفرق بين الاختلاط الممنوع، وبين وجود النساء مع الرجال في مكان واحد مع التباعد التام بينهم والتميُّز - كمؤخرة المسجد ونهاية المطاف وحافة الطريق- كان مستقرًّا عندهم (2). الدليل العشرون: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» (3). ففي هذا الحديث النهي عن الدخول على المرأة إلا أن يكون معها _________ (1) المرجع السابق. (2) انظر: الاختلاط بين الجنسين، ص 42. (3) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم 1862، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341.
(1/580)
ذو محرم، فدل ذلك على منع الاختلاط في أماكن العمل والتعليم. الدليل الحادي والعشرون: حديث ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ».قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ» (1). قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو تركنا ... » فيه حثٌّ على تخصيص ذلك الباب للنساء دون الرجال؛ فإنّ من معاني «لو» العرض، والتحضيض، قال في شرح الكوكب المنير: «وتأتي لو أيضاً للعرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيراً، وتأتي [لو] أيضاً للتحضيض نحو لو فعلت كذا، أي: افعل كذا، والفرق بينهما: أن العرض: طلب بلين ورفق، والتحضيض: طلب بِحَثٍّ» (2)، وعلى كلا المعنين تدلُّ على الطلب، والقاعدة في الأصول: «أنّ الطلب الجازم يدلُّ على الوجوب، والطلبُ غير الجازم يدلُ على الاستحباب» (3)، وبالنظر في علة ذلك نجد أن العلة المناسبة هي: الفصل بين الرجال والنساء، وعدم الاختلاط بينهما، والقاعدة في الأصول: «أنّ من مسالك إثبات العلّة: المناسبة» (4)، ولذلك بوّب عليه أبو داود في سننه بقوله: «بَاب _________ (1) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، برقم: 462، والطبراني في الأوسط، 1/ 303، برقم 1018، وابن عساكر، 31/ 120، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 136. (2) شرح الكوكب المنير، 1/ 281. (3) انظر: الأحكام للآمدي، 1/ 89. (4) المناسبة أو المناسب مبحث طويل في علم أصول الفقه، ليس هذا محل بسطه، فينظر: شرح الكوكب المنير، 4/ 152، وفي حواشي المحقق إحالة إلى عدد من الكتب لمن أراد التوسع.
(1/581)
فِي اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ» (1)، وإذا ثبتَ هذا في محل الدخول والخروج مع عدم مكثهنّ فيه، ثبتَ في أمكنة الدراسة والعمل والمجالس التي يطول البقاء فيها، وهذا ما يعرف في علم أصول الفقه بـ «قياس الأولى» (2)، والنتيجة: أنّ الفصل بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط مطلوبٌ شرعًا. قال شمس الحق العظيم آبادي: «قوله: «لو تركنا هذا الباب» أي باب المسجد الذي أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - «للنساء» لكان خيراً وأحسن لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد، والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال، بل يعتزلن في جانب المسجد، ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام» (3). وقد رُويَ الحديث عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَنَى الْمَسْجِدَ جَعَلَ بَابًا لِلنِّسَاءِ، وَقَالَ: «لاَ يَلِجَنَّ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَحَدٌ» قَالَ نَافِعٌ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَاخِلاً مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَلاَ خَارِجًا مِنْهُ» (4). فإذا كان النساء بحاجة الى باب خاص بهن؛ ليصلن إلى _________ (1) سنن أبي داود، 1/ 179. (2) وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل. القاموس البين في اصطلاحات الأصوليين، ص 244. (3) عون المعبود، للعظيم آبادي، 2/ 92. (4) أخرجه الطيالسي، 3/ 368، وأبو نعيم في الحلية، 1/ 313.
(1/582)
مسجدهن، وهن في حال الإتيان إلى العبادة، فمن باب أولى أن يكون لهن أبواب خاصة بهن في المدارس والجامعات والمعاهد، وتكون لهن أماكن خاصة بهن للتدريس (1). الدليل الثاني والعشرون: حديث أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قال: «قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا» (2). قال العيني: «قوله: (غلبنا عليك الرجال) معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام، ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع العلم، ونتعلم أمور الدين» (3). فهذا الحديث واضح الدلالة في منع اختلاط النساء بالرجال في أماكن التعليم؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للنساء يوماً على حدة، ولم بجعلهن مع الرجال. الدليل الثالث والعشرون: حديث أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه -: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا»، فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ _________ (1) انظر: الاختلاط أصل الشر، ص 119. (2) البخاري، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، برقم 101. (3) عمدة القاري، للعيني، 2/ 134.
(1/583)
- صلى الله عليه وسلم - فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ» (1)، وبوب له البخاري بقوله: (باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال الحافظ: «قوله: (على حدة) أي ناحية وحدهن (2). فأين الذين استجازوا لأنفسهم تعليم النساء مع الرجال من هذا الحديث وأمثاله، أم أن الديمقراطية قد طغت على عقولهم فلا يفقهون حديثاً؟! وإلا فالحديث يبيّن أن الأمر كان واضحاً جدّاً عند النساء والرجال في عهد النبوة من أنه لا قبول لاختلاط النساء بالرجال في التعليم، وأما في عصرنا فالديمقراطية قد أباحت لأهلها أن يختلط النساء بالرجال حتى في المحاضرات الدينية، فنقول لعمرو خالد حامل لواء اختلاط النساء بالرجال وأمثاله: تبّاً لك، ثم تباً!! افعلوا ما شئتم؟ إن اللَّه بما تعملون بصير، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيكم وفي أمثالكم: «إذا لم تستحْي فاصنع ما شئت» (3). الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم؛ ليجدوا ريحها، فهي زانية، وكل عين رأتها زانية» (4). _________ (1) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من الرجال والنساء مما علمه اللَّه ليس برأي ولا تمثيل، برقم 7310، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم 2633. (2) انظر: فتح الباري، 1/ 258. (3) رواه البخاري، كتاب أحاديث النبوة، باب حدثنا أبو اليمان، برقم، 3484، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. (4) أخرجه أحمد،32/ 483،برقم 19711، وأبو داود، برقم 4173، والنسائي، برقم 5126، وتقدم تخريجه.
(1/584)
قال أحمد شاكر: «انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل بعض نساء عصرنا، وهن ينتسبن إلى الإسلام، يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على اللَّه وعلى رسوله، وعلى بديهيات الإسلام، يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها عارية باغية، وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور، ويجترئون جميعاً، فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط» (1). الدليل الخامس والعشرون: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أمُّ سليم خلفنا (2)، وقد بوب له بقوله: باب المرأة وحدها تكون صفّاً. قال الحافظ - رحمه الله -: «فيه أن المرأة لا تصفّ مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور» (3). وقال ابن رشد - رحمه الله -: «(الأقرب أن البخاري قصد أن يبيَّن أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني: أنه مختص بالرجال» (4). فقد أفاد الحديث أن فتنة النساء لا تؤمن، حتى في محل الأمان! ألا ترى أن أم سليم - رضي الله عنها - صلت وحدها، والذي أمامها هو ابنها، وغلام دون البلوغ؟!! _________ (1) قاله في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، 15/ 108. (2) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفاً، برقم 727. (3) فتح الباري، 2/ 275 (4) نقلاً من فتح الباري، 2/ 276.
(1/585)
الدليل السادس والعشرون: حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (1). ومعنى الحديث واضح، وهو يتضمّن تحريم اختلاط الرجال بالنساء؛ لأن منع المرأة من الولايات العامة هو من أجل أمور، ومنها: احتياجها إلى مخالطة الرجال، وهذا قاله الجمهور.: «عند جمهور الفقهاء والعلماء القدامى أن النساء أمرن بالقرار في البيوت؛ لأن مبنى حالهن على الستر، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز، فالإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال، والمشاورة معهم في الأمور، والمرأة ممنوعة من ذلك» (2). الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي - رضي الله عنها - أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه، إني أحب الصلاة معك؟! قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت اللَّه - عز وجل -» (3). _________ (1) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، برقم 4425. (2) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، ص 129 - 130. (3) أخرجه أحمد، 45/ 37، برقم 27090، وابن حبان، 5/ 595، برقم 2217، وابن خزيمة، 3/ 95، برقم 1689، والطبراني (25/ 356)، وقال الحافظ في الفتح، 2/ 451: «وإسناد أحمد حسن»، وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 82، برقم 340.
(1/586)
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل: تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» (1). وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى» (2). الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته! فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تَعْتَدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فاذا حللت فآذنيني» (3). الدليل التاسع والعشرون: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قصة الفضل بن عباس والمرأة الخثعمية أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا» (4). _________ (1) فتح الباري، 2/ 451 - 452. (2) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 29. (3) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً، برقم 1480. (4) رواه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، برقم 885، وأحمد، 2/ 6، برقم 562، والبيهقي، 7/ 89، والبزار، 2/ 165، وأبو يعلى، 1/ 413، والضياء في المختارة، 1/ 335، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 62.
(1/587)
وجه الدلالة في هذا الحديث: أن اختلاط المرأة بالرجال غير المحارم داعٍ إلى الإفساد لهما عن طريق الشيطان، فمن يأمن على نفسه من هذا العدو وهو الذي تسبب في إخراج الأبوين من الجنة، فلا نجاة من إفساد هذا العدو إلا بترك الاختلاط. الدليل الثلاثون: حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه -: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ» (1). وهذا الحديث فيه تحريم مصافحة الأجنبية، وهو متضمّن لتحريم الاختلاط بهن؛ لأن المصافحة لا تقع منهما إلا بعد حصول الاختلاط بينهما. الدليل الحادي والثلاثون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا -يعني تصفها- كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» (2). فالزوجة منهية عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها كأنه ينظر إليها، لأنه ينفتن بها قلبه، ويزهِّده في زوجته من حيث لا تَشعر، ويتشوَّف للموصوفة، ويتمنى رؤيتها، فكيف يستقيم مثل هذا النهي للمرأة أن تصف، ويؤذن لزوجها أن يجالس المرأة الموصوفة ويخالطها في العمل _________ (1) رواه الروياني في مسنده، 3/ 466، برقم 1270، والطبراني في الكبير، 20/ 221، برقم 486، وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة، برقم 226. (2) البخاري، برقم 524، وتقدم تخريجه.
(1/588)
أو الدراسة مخالطة مستديمة (1). فخلاصة هذه الأحاديث وأمثالها: أنها تدل عل تحريم اختلاط النساء بالرجال لغير ضرورة. ودلالتها إما ظاهرة وإما متضمنة. وهذا التضمن يجري في الحكم على الظاهر؛ لاتفاق ما تضمنته مع الأدلة الظاهرة، ومع الأدلة المتنوعة الآتية؛ ولموافقتها للضوابط الشرعية والقواعد المرعية المتعلقة بصيانة المرأة المسلمة والمحافظة عليها. فالذين أجازوا اختلاط النساء بالرجال محجوجون بهذه الأحاديث وبغيرها من الأدلة القويمة، فأين يذهبون إن لم يقبلوها ويذعنوا لها، ويثبتوا على العمل بها؟! فلا شك ولا ريب أن من كان متحريّاً للحق باحثاً عنه راغباً فيه، أنه سيفرح بهذه الأحاديث وبأقوال أهل العلم المعتبرين فيه، وأما من كان متبعاً لهواه؛ فإنه سيعاند هذه الأحاديث وأمثالها بكل ما أوتي ويقيم الدنيا ولا يقعدها! وهذا الصنف نخوفه باللَّه الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، يقلبها كيف شاء، فنخاف عليه من زيغ القلب؛ فليتق اللَّه وليخش أن يصيبه قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (2)، ونعلمه أن الحق باق ومنصور بنصر اللَّه، وأن الباطل مضمحل وزائل بإذن اللَّه، فلأن يكون المسلم ذَنَباً في الحق، خير له من أن يكون رأساً في الباطل، يدعو إلى تبرج _________ (1) انظر: الاختلاط للطريفي، ص 28. (2) سورة الأنفال، الآية: 24.
(1/589)
المسلمات واختلاطهن بالرجال (1). ثالثاً: الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن: الأثر الأول: عن ابن جُرَيْجٍ «قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ» (2). قال ابن حجر: «قَوله: «وقَد طافَ نِساء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجال»؛ أَي: غَير مُختَلِطات بِهِنَّ ... قَوله: «حَجرَة» - بِفَتحِ المُهمَلَة، وسُكُون الجِيم بَعدها راءٍ- أَي: ناحِيَة» (3). وقال المهلب: «قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساء، يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم» (4). فهذا الأثر صريح الدلالة في أن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يتجنبن مخالطة الرجال حال الطواف، والنساء تطوف من وراء الرجال. _________ (1) انظر: الاختلاط أصل الشر، ص 121 - 125. (2) كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، برقم 1619. (3) فتح الباري، 4/ 549. (4) شرح البخاري، لابن بطال، 4/ 298.
(1/590)
الأثر الثاني: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: نَهَى عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَطُوفَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَرَأَى رَجُلًا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ» (1). ففي هذا الأثر بيان أن من هدي الصحابة - رضي الله عنهم - منع اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، فمنعه في أماكن العمل والتعليم من باب أولى. الأثر الثالث: عَنْ مَنْبُوذِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلاَةٌ لَهَا، فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لاَ آجَرَكِ اللَّهُ، لاَ آجَرَكِ اللَّهُ، تُدَافِعِينَ الرِّجَالَ! أَلاَ كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ؟ ّ» (2). ففي هذا الأثر أنكرت عائشة - رضي الله عنها - على المرأة التي تزاحم الرجال لاستلام الركن، فكيف يجوز للمرأة مخالطة الرجال في أماكن العمل والتعليم. الأثر الرابع: عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قَالَ: «أَمَا تَغَارُونَ أَنْ تَخْرُجَ نِسَاؤُكُمْ؟ .. أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَوْ تَغَارُونَ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَكُمْ _________ (1) أخبار مكة للفاكهي، 1/ 252: «وفي إسناده مغيرة بن مقسم الضبي، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، وهو معضل من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي، ثقة من الخامسة، روايته عن عمر معضلة، فالأثر ضعيف». انظر: دراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب، 2/ 929. (2) مسند الشافعي، 1/ 127، السنن الكبرى للبيهقي، 5/ 81، أخبار مكة للفاكهي، 1/ 122.
(1/591)
يَخْرُجْنَ فِي الْأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ» (1). ففي هذا الأثر ينكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خروج النساء إلى الأسواق ومزاحمتهن للرجال، وإنكار ما يحصل في أماكن العمل والتعليم من باب أولى. الأثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي قال: «رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى حياضاً عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً، فضربهم بالدّرّة، ثم قال لصاحب الحوض: اجعل للرجال حياضاً، وللنساء حياضاً» (2). ففي هذا الأثر أنكر عمر - رضي الله عنه - اختلاط الرجال بالنساء عند حياض الماء، وإنكار اختلاطهن في أماكن العمل والتعليم من باب أولى. الأثر السادس: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود - رضي الله عنه -، قَالَ: «لأَنْ يُزَاحِمَنِي بَعِيرٌ مَطْلِيٌّ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُزَاحِمَنِي امْرَأَةٌ عَطِرَةٌ» (3). _________ (1) مسند أحمد، 2/ 343، برقم 1118، وقال محققو المسند، 2/ 343: «إسناده ضعيف، شريك- وهو ابن عبد اللَّه القاضي- سيئ الحفظ». (2) مصنف عبد الرزاق، 1/ 75، برقم 246، وابن سعد في الطبقات، 6/ 155. إسناده عند عبد الرزاق رجاله ما بين ثقة وصدوق، وأبو سلامة الخبيبي الراوي عن عمر - رضي الله عنه -، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذا ابن حجر في الإصابة، وقال في التقريب: صحابي له حديث واحد، ورواية ابن سعد من غير إسناد. انظر: دراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب، 2/ 928. (3) رواه الطبراني في المعجم الكبير، 9/ 352، برقم 9751، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 8/ 115: «رواه الطبراني وفيه أبو الزعراء، وثقه العجلي وابن حبان وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح».
(1/592)
ففي هذا الأثر تفضيل ابن مسعود - رضي الله عنه - مزاحمة البعير المطلي بالقطران من مزاحمة امرأة في الطريق، وهذا في الطريق، فكيف يقول عن أماكن التعليم والعمل؟! (1). وغير ذلك من الآثار الكثير. رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب: لا أعلم أحداً من علماء الإسلام الأعلام عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا هذا قال بجواز الاختلاط الذي يدعو إلى الريبة والفساد. قال أبو بكر العامري (ت 530 هـ): «اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد حِلَّ هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله، وأقر عليه، ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول، ولا تقبل له شهادة» (2). وممن أشار إلى هذا الاتفاق الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر في وقته (ت 1378هـ) حيث قال: «وتحريم الدين لاختلاط الجنسين على النحو الذي يقع في الجامعة معروف لدى عامة المسلمين، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنة، وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا على بصيرة من حكمته السامية» (3). وممن نص على اتفاق العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان _________ (1) انظر: تحريم الاختلاط للبداح، ص 29 - 31. (2) أحكام النظر إلى المحرمات، العامري، ص 83. (3) محاضرات إسلامية، لمحمد الخضر حسين، ص 191.
(1/593)
حيث قال: «الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يثير الفتنة أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» (1). وقال الشيخ محمد الخطيب وهو من علماء لبنان: «إن الاختلاط لا يختلف في حرمته اثنان من المسلمين، ولا ينكر مساوئه ومفاسده من له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد» (2). وقال الشيخ عبد اللَّه بن جار اللَّه - رحمه الله -: «وجهت جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت سؤالاً إلى أربعة عشر عالماً وفقيهاً من علماء المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية عن حكم الإسلام في اختلاط الطلبة والطالبات، وبيان الأضرار الناجمة عن الاختلاط في التعليم، فأفتى كل منهم بتحريم ذلك، وأيدوا فتاواهم بالآيات القرآنية من سورة النور والأحزاب الدالة على تحريم الاختلاط والسفور والتبرج، ووجوب الحجاب والقرار في البيوت» (3). وقال الشيخ فريح البهلال: «ويؤيد الاتفاق والإجماع المذكورين توارد أهل العلم على إفراد هذه المسألة بالتأليف، الذين بلغت _________ (1) من مقال بعنوان: على رسلكم أيها الصحفيون، [نقله عنه الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح، في كتابه: تحريم الاختلاط، ص 33]. (2) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح في الكويت، ص 34. (3) مسؤولية المرأة المسلمة، ص 62.
(1/594)
مؤلفاتهم فيما وقفت عليه منها: ما يزيد على ثلاثمائة مؤلف، والتي اتفقت على وجوب ستر وجوه المؤمنات عن الأجانب، وخطر السفور والتبرج والاختلاط». وقال أيضاً: «اعلم - أخي الكريم- يا من ترجو اللَّه والدار الأخرة أن الأدلة ثبتت على فرضية احتجاب نساء المؤمنين عن الرجال الأجانب، وتحريم خروجهن سافرات الوجوه، وتبرجهن بالزينة، واختلاطهن بالرجال من كتاب ربك سبحانه، وسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع علماء المسلمين، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد، ومن تجربة من ذاق مرارة التبرج والسفور، واختلاط النساء بالرجال». ومما يقوي هذا الإجماع سير علماء الإسلام من عهد السلف إلى عصرنا هذا على منع الاختلاط، ولا يعلم أن أحداً منهم تزعم مسألة الاختلاط، ودعا إليها أو نافح عنها، وأيضاً لم يعرف الاختلاط منذ انحرفت الأمة عن دينها إلا من قِبَل دعاة النفاق والشقاق: كالرافضة، والصوفية، وأمثالهما، أو من قبل البدو والجهال، حتى جاءت الديمقراطية الوثنية في هذا العصر، فأباحت اختلاط النساء بالرجال بجميع أشكاله» (1). خامساً: الأئمة الأربعة، وجَمْعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب على وجه الريبة _________ (1) الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص 485، وص 44.
(1/595)
وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 1 - روى مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيم النخعي [ت 96 هـ] , قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَهَذَا إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ هَذَا, وَإِذَا قَالَ: (كَانُوا) فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ, فَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا, ثُمَّ يَفْعَلُونَهُ لِلْعُذْرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ إِذَا قَرُبْنَ مِنَ الْجِنَازَةِ» (1). 2 - قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر [21 - 104هـ]، ببدعة اجتماع الرجال بالنساء، كما رواه ابن سعد في الطبقات (2). قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} (3):كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. 3 - قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري [22 - 110هـ]: إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. رواه الخلال (4). 4 - ومنع أبو حنيفة [ت 150 هـ]: المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس في زمن الصلاح والتقى (5). _________ (1) شرح معاني الآثار، 1/ 458. (2) 8/ 157. (3) سورة الأحزاب، الآية: 33. (4) اسشهد به السيوطي في تحذير الخواص، ص 227، والكناني في الأسرار المرفوعة، ص71، منسوباً للحسن. (5) انظر: مجمع الأنهر، 2/ 412، وفيه الكلام عن عدم كشف الوجه للمرأة الشابة، والكلام عن زمان الفتنة.
(1/596)
5 - قال الإمام مالك بن أنس: [ت 179هـ]: «أرى للإمام أن يتقدم إلى الصُّنَّاع في قعود النساء إليهم، وأرى ألا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصُّنَّاع، فأمَّا المرأة المُتَجالَّةُ (1)، والخادم الدون التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده فإني لا أرى بذلك بأساً» (2). 6 - والإمام الشافعي [ت 204هـ] يقول في النساء الجماعات في الطرقات وأمام الناس، وليس الواحدة مع الواحد: إن خرجوا متميزين - يعني في الطرقات لقضاء الحوائج وشهود الصلوات - لم أمنعهم، وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز (3). وقال أيضاً كما في مختصر المزني (4): ولا يثبت - يعني الإمام - ساعة يسلِّم إلا أن يكون معه نساء، فيثبت لينصرفن قبل الرجال. 7 - وقال أَشْهَبُ المالكي [مصري، ت 204هـ]: «أَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِالنِّسَاءِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بِالرِّجَالِ، فَذَلِكَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ صَحِيحٌ إمَّا لِكَثْرَةِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، أَوْ لِكَثْرَتِهِنَّ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَا يُقَدِّمُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مُخْتَلِطِينَ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا مَعْلُومًا أَوْ _________ (1) تجاللن: أي طعنَّ في السن وكَبِرْن، يقال: تجالّت المرأة فهي متجالّة، وجلت فهي جليلة: إذا كبرت، وعجزت. غريب الحديث للخطابي، 2/ 121. (2) البيان والتحصيل، 9/ 335. (3) مختصر المزني، ص 33. (4) مختصر المزني، ص 15.
(1/597)
يَوْمَيْنِ فَعَلَ» (1). 8 - قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكي [ت 242هـ] في آداب المحتسب: «ويمنع اختلاط النساء مع الرجال عند الصلاة، وفي الأعياد، وفي المحافل، ويفرق بينهم» (2). 9 - وقال محمد بن سحنون المالكي [ت 256هـ]: «وأكره للمعلم أن يعلم الجواري، ولا يختلطن مع الغلمان؛ لأن في ذلك فساداً لهن» (3). 10 - وقال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ المالكي [مصري، ت 268هـ]: «أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفْرِدَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا» (4). 11 - وقال الخلال [ت 311هـ] في جامعه: سئل أحمد عن رجل يجد امرأة مع رجل، قال: صِحْ به» (5). 12 - إمام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي: [229 - 321 هـ] , منع من الاختلاط (6). 13 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 386هـ]: «وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت _________ (1) منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، 8/ 306. (2) آداب الحسبة والمحتسب، ص 38. (3) الجامع في كتب آداب المعلمين، ص 136. (4) منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، 8/ 306. (5) ذكره ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية، ص 407 (6) شرح معاني الآثار، 1/ 458، ونقله ابن التركماني في الجوهر النقي، 4/ 25عن الطحاوي.
(1/598)
إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ» (1). 14 - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [ت 403هـ] في المنهاج المصنف في شعب الإيمان: «فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَحْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَبِنْتَهُ مُخَالَطَةَ الرِّجَالِ وَمُحَادَثَتَهِمْ وَالْخُلْوَةَ بِهِمْ» (2). وقال أيضاً عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً} (3): «فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم» (4). 15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [ت 403 هـ] بكراهة تعليم المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان (5). 16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [ت450هـ] في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني (6): «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ الإمام فى الصلاه ثَبَتَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، فَإِنِ انْصَرَفْنَ وَثَبَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الرِّجَالُ _________ (1) الرسالة مع شرح النفراوي، 2/ 322. (2) ص 38، وهو في شعب الإيمان، 13/ 260. (3) سورة التحريم، الآية: 6. (4) المنهاج في شعب الإيمان، 3/ 397. (5) الجامع في كتب آداب المعلمين، ص 324. (6) الحاوي الكبير، 2/ 343.
(1/599)
بِالنِّسَاءِ». وقال أيضاً: «والمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها، وكذلك بمنعهم من المسير عند اشتداد الريح، وإذا حُمل فيها الرجال والنساء حجز بينهم بحائل» (1). وقال أيضاً: «وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ مَأْمُورَةٌ بِلُزُومِ الْمَنْزِلِ» (2). وقال في أدب الدين والدنيا عند تعريفه للديوث: «الدَّيُّوثُ: هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَدُثُّ بَيْنَهُمْ» (3). 17 - وقال ابن عبد البر المالكي [ت 463 هـ]: «يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر، وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلى الرجال» (4). 18 - وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي [من مدينة شيراز بإيران، _________ (1) الأحكام السلطانية، ص 412. (2) الحاوي، 2/ 51. (3) أدب الدنيا والدين، ص 268. (4) التمهيد، 9/ 124.
(1/600)
ت 476هـ]: «ولا تجب الجمعة على المرأة؛ لما روى جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض» (1)، ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز» (2). 19 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [من مدينة سرخس بفارس إيران اليوم ت 483هـ]: «وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ; لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ, وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى, وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ. فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ» (3). 20 - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [ت 498 هـ] بأن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم (4). 21 - وقال أبو حامد الغزالي [ت 505 هـ] عن منع الاختلاط في مجالس الذكر: «ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر؛ فإن ذلك مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه _________ (1) أخرجه ابن أبى شيبة، 1/ 446، برقم 5149، سنن الدارقطني، 2/ 3، سنن البيهقي، 2/ 184، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم 1380. (2) المهذب مع المجموع، 4/ 350. (3) المبسوط، 16/ 8. (4) الأحكام السلطانية، ص 306.
(1/601)
المنكرات» (1). 22 - وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الأندلسي، أبو بكو الطرطوشي [ت 520هـ] كما في المدخل لابن الحاج عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: «يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء» (2). 23 - وقال أبو بكر بن العربي [ت 547] في الرد على من قال بجواز تولية المرأة القضاء: «فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده» (3). وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال، والخلطية فيما بينهم (4). 24 - وقال الكاساني الحنفي [ت 587هـ] في تعليل عدم وجوب الجمعة على المرأة: «وأما المرأة فلأنها مشغولة بحامة الزوج، ممنوعة عن _________ (1) إحياء علوم الدين، للغزالي، 3/ 43 - 44. (2) المدخل لابن الحاج، 2/ 297. (3) الجامع لأحكام القرآن، لابن العربي، 3/ 1446. (4) أحكام القرآن، 3/ 136.
(1/602)
الخروج إلى محافل الرجال؛ لكون الخروج سبباً للفتنة» (1). 25 - قال ابن الجوزي [بغدادي، ت 597هـ]: «فأمّا ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال؛ فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال، ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى غير ذلك» (2). 26 - وقال ابن قدامة الحنبلي: [شامي، ت 620هـ]: «إذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَثْبُتَ هُوَ وَالرِّجَالُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُنَّ قَدْ انْصَرَفْنَ، وَيَقُمْنَ هُنَّ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، لِكَيْ يَبْعُدَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» (3). وقال أيضاً: «المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال؛ لذلك لا تجب عليها جماعة» (4). _________ (1) بدائع الصنائع، 1/ 582. (2) كشف المشكل من حديث الصحيحين، 1/ 776. (3) المغني، 1/ 328. (4) المغني، 3/ 216.
(1/603)
وقال أيضاً في ذكر منكرات المساجد: «أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، فينبغي إنكار ذلك عليهم» (1). 27 - قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي [ت 634هـ] فقيه الحنابلة في زمانه، كما في ذيل طبقات الحنابلة (2) أن اجتماع الرجال بالنساء في مجلس في غير معروف محرم» (3). 28 - قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه العامري [في القرن السادس (4)] في كتابه أحكام النظر: «اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب؛ فقد كفر، واستحق القتل بردته، وإذ اعتقد تحريمه وفعله، وأقر عليه ورضي به؛ فقد فسق، لا يسمع له قول، ولا تقبل له شهادة» (5). 29 - وقال الإمام النووي [من مدينة نوى بالشام، [631 - 679هـ عُمدة الشافعية]: «من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك، ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعاً من القبائح: إضاعة المال في _________ (1) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة، ص 140. (2) 4/ 195. (3) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، 4/ 195. (4) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، 54/ 56، ولم يذكر تاريخ وفاته. (5) أحكام النظر إلى المحرمات، لللعامري، ص 83، و287.
(1/604)
غير وجهه: إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار: اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم، ووجوههم بارزة» (1). وقال أيضاً في المنهاج شرح صحيح مسلم: «وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال؛ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال، وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ، وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ» (2). 30 - الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي [ت 702هـ] كما في فتح الباري بمنع الاختلاط في المحافل والأعياد (3). 31 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [ت728]: «وقد كان من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه التمييز بين الرجال والنساء، والمتأهلين والعزاب، فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد، والنساء في مؤخره. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (4). وقال: «يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى _________ (1) المجموع، 8/ 140. (2) شرح صحيح مسلم، 2/ 183. (3) فتح الباري، 2/ 620. (4) صحيح مسلم، برقم 440، وتقدم تخريجه.
(1/605)
يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأُزر» (1)، وكان إذا سلَّم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولاً، لئلا يختلط الرجال والنساء ... وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون داراً معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب، وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه؛ فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي، وعدم المانع» (2). وقال أيضاً: «وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلاً عن بني آدم» (3). وقال أيضاً: «وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع، فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب، مثل: رفع الأصوات في المسجد، أو اختلاط الرجال والنساء، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل؛ فإن قبح _________ (1) البخاري، كاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً، مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، برقم 441، واللفظ له. (2) الاستقامة، 1/ 359 - 361. (3) جامع المسائل، 5/ 229.
(1/606)
هذا ظاهر لكل مسلم» (1). 32 - وقال محمد بن محمد القرشي الشافعي [ت 729]: «ولا يجوز لأحد التطلع على الجيران من السطوحات والنوافذ، ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة، فمن فعل شيئاً من ذلك عزره المحتسب» (2). 33 - وقال ابن الحاج المالكي [ت 737هـ]: «فإن أرادت إحداهن الخروج تنطقت وتزينت ونظرت إلى أحسن ما عندها من الثياب والحلي فلبسته، وتخرج إلى الطريق كأنها عروس، وتمشي في وسط الطريق تزاحم الرجال، ولهن صنعة في مشيهن حتى إن الرجال ليرجعون مع الحيطان حتى يوسعوا لهن الطريق أعني المتقين منهم، وغيرهم يخالطونهن ويزاحموهن، ويمازحوهن قصداً، كل هذا سببه عدم النظر إلى السنة وقواعدها، وما مضى عليه سلف الأمة - رضي الله عنهم -» (3). 34 - وقال ابن قيم الجوزية [دمشقي ت 751هـ]: «ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج، ومجامع الرجال قال مالك: ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم، وأرى ألا يترك _________ (1) اقتضاء الصراط المستقيم، ص145. (2) معالم القربة، ص79. (3) المدخل، 1/ 176.
(1/607)
المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ، فأما المرأة المتجالَّة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأساً. انتهى. فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (1)، وفي حديث آخر: «باعدوا بين الرجال والنساء» (2)، وفي حديث آخر أنه قال للنساء: «لكن حافات الطريق» (3)، ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت -ثيابها بحبر ونحوه- فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء، وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، واللَّه سائل ولي الأمر عن _________ (1) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (2) ذكره الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة، 24/ 643 بلفظ: «باعِدوا بين أنفاس الرجالِ والنساء»، وقال: «لا أصل له، وقد علقه ابن حزم في طوق الحمامة، ص 128 جازماً بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -! وكذلك فعل جمع من بعده؛ منهم ابن الحاج في المدخل، 1/ 245، وكذلك ذكره ابن جماعة في منسكه، في طواف النساء من غيرسند». ا. هـ. (3) أخرجه البيهقي في الشعب، 10/ 240، وفي الآداب له، برقم 668، وتقدم تخريجه.
(1/608)
ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك، وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به، وقد أخبرني النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية» (1)، ويمنع المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» (2)، ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسل اللَّه عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفاً، والقصة مشهورة في كتب التفاسير، فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد _________ (1) أخرجه أبو داود، برقم 4173، والترمذي، برقم 2786، وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 216، برقم 2019، تقدم تخريجه .. (2) الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، 1685، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.
(1/609)
الدنيا والرعية قبل الدين، لكانوا أشد شيء منعاً لذلك، قال عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا ظهر الزنا في قرية أذن اللَّه بهلاكها» (1)، وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «ما طفّف قوم كيلاً، ولا بخسوا ميزاناً، إلا منعهم اللَّه - عز وجل - القطر، ولا ظهر في قوم الزنا، إلا ظهر فيهم الموت، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط، إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا لم ترفع أعمالهم، ولم يسمع دعاؤهم» (2). 35 - وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة [ت767 هـ] في هداية السالك: «ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل، _________ (1) أخرجه الطبري بهذا اللفظ، 17/ 475، وهكذا ذكره الذهبي في كتاب الكبائر، ص 61، وورد بلفظ: «إذا ظهر الزنا والربا فى قريةٍ فقد أحلوا بأنفسهم كتابَ اللهِ»، أخرجه الطبراني 1/ 178، برقم 460، والحاكم، 2/ 43، وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، والبيهقى في شعب الإيمان، 4/ 363، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 4/ 118: «وفيه هاشم بن مرزوق، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات»، وحسَّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 1859 .. (2) الطرق الحكمية، 2/ 721 - 724، و237، والحديث عزاه ابن القيم إلى ابن أبي الدنيا في هذا الكتاب، وعزاه إلى معجم الطبراني في الجواب الكافي، ص 31، وذكره بإسناده ابن الجوزي في ذم الهوى، ص 192، ولم يذكر من خرجه.
(1/610)
وبأيديهم الشموع متقدة» (1). وقال أيضاً: «ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال، بل تكون في حاشية الطواف بحيث لا تزاحم الرجال، قياساً على الصلاة؛ فإنهن مأمورات بالتأخير عن صفوف الرجال، ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال، وكذلك لايستحب لها الصلاة خلف المقام، أو في غيره من المساجد مزاحمة للرجال، ويستحب لها ذلك إذا لم تفض إلى مخالطة الرجال، وهذا مما لا يكاد يختلف فيه؛ لما يتوقع بسببه من الضرر ... ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم، سافرات عن وجوههن، وربما كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع تقد» (2). 36 - وقال ابن رجب الحنبلي [بغدادي، سكن دمشق، ت 795هـ]: «وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد» (3). 37 - [وقال] ابْنُ عَرَفَةَ المالكي [تونسي، ت 803هـ]، وسَحْنُونٌ [مغربي، ت 240هـ]: «يَعْزِلُ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ» (4). _________ (1) 2/ 864. (2) هداية السالك، 2/ 864 - 868. (3) فتح الباري، لابن رجب، 2/ 134. (4) منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، 8/ 306.
(1/611)
38 - وقال ابن النحاس الشافعي [ت 814 هـ]: «في ذكر مما يقع في النكاح وبعده من المنكرات ... ومنها: اجتماع النساء على السطح أو في الغرف للنظر إلى الرجال مهما كان، وربما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة منه» (1). 39 - قال ابن حجر العسقلاني [أصله من عسقلان بفلسطين، وعاش بالقاهرة، ت 852هـ]: «وقَد ورَدَ ما هُو أَصرَح مِن هَذا فِي مَنعهنَّ، ولَكِنَّهُ عَلَى غَير شَرط المُصَنِّف، ولَعَلَّهُ أَشارَ إِلَيهِ، وهُو ما أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى مِن حَدِيث أَنَس، قالَ: «خَرَجنا مَعَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنازَة، فَرَأَى نِسوة فَقالَ: «أَتَحمِلنَهُ»؟ قُلنَ: لا. قالَ: «أَتَدفِنَّهُ»؟ قُلنَ: لا. قالَ: «فارجِعنَ مَأزُورات غَير مَأجُورات» (2). ونَقَلَ النَّووِيّ فِي شَرح المُهَذَّب أَنَّهُ لا خِلاف فِي هَذِهِ المَسأَلَة بَين العُلَماء، والسَّبَب فِيهِ ما تَقَدَّمَ؛ ولأَنَّ الجِنازَة لا بُدّ أَن يُشَيِّعها الرِّجال، فَلَو حَمَلَها النِّساء لَكانَ ذَلِكَ ذَرِيعَة إِلَى اختِلاطهنَّ بِالرِّجالِ، فَيُفضِي إِلَى الفِتنَة» (3). وقال ابن حجر أيضاً في فتح الباري: «فيه اجتناب مواضع التهم، _________ (1) تنبيه الغافلين، ص 472 (2) ابن ماجه، برقم 1578، مصنف ابن أبي شيبة، برقم 25789، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، برقم 344، وتقدم تخريجه. (3) فتح الباري، 3/ 182.
(1/612)
وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات، فضلاً عن البيوت» (1). 40 - وقال بدر الدين العيني الحنفي: [أصله من حلب، وسكن القاهرة، ت: 855هـ] في شرحه على البخاري: في التعليق على قول البخاري «باب حمل الرجال الجنازة دون النساء»: «أي هذا باب في بيان حمل الرجال الجنازة دون حمل النساء إياها لأنه ورد في حديث أخرجه أبو يعلى عن أنس - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأى نسوة، فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أتدفنَّه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات» (2)؛ لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالباً خصوصاً إذا باشرن الحمل؛ ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال وهو محل الفتنة ومظنة الفساد» (3). وقال أيضاً عند حديث عائشة ل: «لو أدرك رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل»: «لو شاهدت عائشة لما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكاراً، ولا سيما نساء مصر؛ فإن فيهن بدعاً لا _________ (1) فتح الباري، 2/ 336. (2) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع الجنائز، برقم 1578، مصنف ابن أبي شيبة، 5/ 252، برقم 25789، والبيهقي 4/ 77، والبزار، 2/ 249، وبنحوه عبد الرزاق، 3/ 456، برقم 6298، ولأبي يعلى، 7/ 109، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، برقم 344. (3) عمدة القاري، 8/ 111.
(1/613)
توصف، ومنكرات لا تمنع، منها: مشيهن في الأسواق في ثياب فاخرة وهن متبخرات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع الرجال، مكشوفات الوجوه في غالب الأوقات، ومنها ركوبهن مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال ... » (1). 41 - وقال أحمد المغراوي المالكي [ت 898هـ] بكراهة تعليم المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان (2). 42 - الإمام الحطاب الرعيني المالكي [ت954هـ] في مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3) حيث قرر إنكار الاختلاط بين الرجال والنساء والاجتماع فيما بينهم عند ختم القرآن. 43 - وقال عبد اللَّه باقشير الحضرمي الشافعي [ت 958 هـ]: «ومن الكبائر: إظهار شعائر الفسق، كاجتماع الرجال والنساء متكشفات للعب ونحوه» (4). 44 - وقال الحجاوي الحنبلي [شامي، ت 968هـ] في الإقناع: «(ويُمْنَعُ فِيهِ (5) اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) قال البهوتي في شرحه: (لِمَا _________ (1) عمدة القاري، 6/ 158. (2) المصدر السابق، ص 552. (3) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، 4/ 154. (4) الموجز المبين، ص 71. (5) أي في المسجد.
(1/614)
يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ)» (1). 45 - وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي (ت 972 هـ): «وأما كون الجمعة لا تجب على المرأة؛ فلأن تكليفها بالخروج ومخالطة الرجال فيه مشقة عليها، وربما أدى إلى مفسدة» (2). 46 - ونقل ابن حجر الهيتمي الشافعي [مصري، ت 974هـ]: «أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك، ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء» (3). 47 - قال الخطيب الشربيني الشافعي [من أهل القاهرة، ت 977هـ]: «التَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ، وَهُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ لِلسَّلَفِ فِيهِ خِلَافٌ، فَفِي الْبُخَارِيِّ «أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ»، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالضَّرَاعَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَةَ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ فَعَلَهُ الْحَسَنُ وَجَمَاعَاتٌ، وَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَالِكٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَنْ جَعَلَهُ بِدْعَةً لَمْ يُلْحِقْ بِفَاحِشِ الْبِدَعِ، بَلْ يُخَفِّفُ أَمْرَهُ: أَيْ إذَا خَلَا عَنْ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ أَفْحَشِهَا» (4). _________ (1) الإقناع، 2/ 367. (2) معونة أولي النهى، 2/ 470. (3) الزواجر، ص 345. (4) مغني المحتاج، 2/ 261.
(1/615)
48 - وأبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت982هـ) في تفسيره أشار إلى مزاحمة جهلة العوام النساء في الطواف (1). 49 - قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي [ت 1004هـ] في نهاية المحتاج شرح منهاج النووي: في ذكر سياق ألفاظ القذف: «(قَوْلُهُ: وَيَا قَحْبَةُ) لِامْرَأَةٍ (قَوْلُهُ صَرِيحٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ) أَيْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ، وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ، هَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْقَبُولُ لِوُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرًا» (2). 50 - وقال علي بن سلطان القاري الحنفي [ت 1014هـ] تعليقاً على قول ابن الهمام: «(وتخرج العجائز للعيد لا الشواب)، وهو قول عدل؛ لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ... » (3). 51 - وقال البهوتي الحنبلي [مصري، ت 1051هـ] في الكشاف: «(وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ قِيَامُهُنَّ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَثُبُوتُ الرِّجَالِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكْهُنَّ الرِّجَالُ، _________ (1) تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، 5/ 40. (2) نهاية المحتاج، 8/ 172. (3) مرقاة المفاتيح، 2/ 248.
(1/616)
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ل (1)؛ وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» (2). 52 - وفي حاشية الشبراملسي الشافعي [مصري، ت 1087هـ] على نهاية المحتاج في باب القذف: «قَوْلُهُ: (وَيَا قَحْبَةُ) لِامْرَأَةٍ «قَوْلُهُ صَرِيحٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ» أَيْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ، وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ هَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْقَبُولُ لِوُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرًا، وَعَلَيْهِ فَهُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلَ الصَّرْفَ» (3). 53 - وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ الشافعي [مصري، 1090هـ] بِحُرْمَتِهِ [أي الاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة] لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ» (4). 54 - وقال الحموي مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد أبو العباس الحسيني الحموي [ت1098 هـ]: [أصله من حماة بسوريا، وسكن القاهرة]: «وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ , كَمَا فِي الْفَتْحِ. قُلْت: وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ _________ (1) البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، برقم 870. (2) كشاف القناع، 1/ 494. (3) نهاية المحتاج مع حاشيته، 7/ 105. (4) البجيرمي على الخطيب، 2/ 226.
(1/617)
بِالرِّجَالِ» (1)، فعلّل تحريم الزفاف في زمانه بعلة اختلاط النساء بالرجال، ولا يتمُّ ذلك إلا إذا كان الاختلاط (حرامٌ) عنده. وقال أيضاً كما في كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم في حكم العرس المختلط: «وهو حرام في زماننا، فضلاً عن الكراهة؛ لأمور لا تخفى عليك، منها اختلاط النساء بالرجال» (2). 55 - قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي [1044 - 1126 هـ] في كتابه الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها، إلا عند المنكر، قال: «بِقَوْلِهِ: (وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ، كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، أَوِ الْجُلُوسِ عَلَى الْفُرُشِ الْكَائِنَةِ مِنَ الْحَرِيرِ، أَوِ الِاتِّكَاءِ عَلَى وَسَائِدَ مَصْنُوعَةٍ مِنْه» (3). وقال أيضاً: «ومن مستحبات الطواف الدنو من البيت للرجال دون النساء ... ومن مكروهاته: الطواف مع مخالطة النساء ... » (4). 56 - وقرر سليمان بن عمر الجمل [ت 1204هـ] في حاشيته على شرح _________ (1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لابن نجيم، 2/ 114. (2) غمز عيون البصائر، لابن نجيم، 2/ 114. (3) الفواكه الدواني، 2/ 322. (4) الفواكه الدواني، 1/ 417.
(1/618)
منهج الطلاب (1) أن الاختلاط بالنساء مظنة الفساد. 57 - وقال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي [مصري، 1150 - 1221هـ]: «اجْتِمَاعُ النَّاسِ [نساء ورجالاً] بَعْدَ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ عَرَفَةَ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ وَكَرِهَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ، ... وقال الشيخ الطوخي بحرمته: لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ» (2). وقال البجيرمي أيضاً في حاشيته على الشربيني: «الاختلاط بهن [أي النساء] مظنة الفساد» (3). 58 - وذكر الصاوي المالكي [مصري، ت 1241هـ] من مبطلات الوصية: «أَنْ يُوصِيَ بِإِقَامَةِ مَوْلِدٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالنَّظَرِ لِلْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرِ» (4). 59 - قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني: (يمني ت1250هـ) في شرح حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ». «الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي اجْتِنَابِ مَا قَدْ يَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ، وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ، وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي _________ (1) حاشية الجمل على المنهج، 2/ 458. (2) حاشية البجيرمي على الخطيب، 2/ 435. (3) البجيرمي على الخطيب، 2/ 461. (4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 4/ 585، ومثله في حاشية الدسوقي، 4/ 427.
(1/619)
الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عَنِ الْبُيُوتِ» (1). وقال أيضاً: «قَوْله: (وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخِرُهَا) إنَّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنَ الْبُعْد عَنْ مُخَالَطَة الرِّجَال» (2). وقال أيضاً في تفسيره فتح القدير: «لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف، شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان؛ لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء، فربما يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين» (3). 60 - وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي:: إمام الحنفية في عصره [1198 - 1252هـ] في حاشيته: «وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْخُرُوجُ لِفُرْجَةِ قُدُومِ أَمِيرٍ أَيْ لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ وَمِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (4). 61 - والآلوسي [ت 1270هـ] في كلامه عن الزجر عن الاختلاط في تفسيره (5). 62 - وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي [من طرابلس المغرب، وسكن القاهرة، ت1299هـ]: «(وَيَنْبَغِي) لِلْقَاضِي (أَنْ _________ (1) نيل الأوطار، 2/ 364. (2) نيل الأوطار، 3/ 219. (3) فتح القدير، 5/ 203. (4) حاشية ابن عابدين، 6/ 355. (5) 9/ 328.
(1/620)
يُفْرِدَ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ (يَوْمًا) مُعَيَّنًا مِنَ الْأُسْبُوعِ، (أَوْ وَقْتًا) مُعَيَّنًا مِنَ الْيَوْمِ (لِـ) قَضَاءٍ بَيْنَ (النِّسَاءِ) سَتْرًا لَهُنَّ، وَحِفْظًا مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ فِي مَجْلِسِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُنَّ خَاصَّةً، أَوْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ، وَهَذَا فِي نِسَاءٍ يَخْرُجْنَ، وَلَا يُخْشَى مِنْ سَمَاعِ صَوْتِهِنَّ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ، وَأَمَّا الْمُخَدَّرَاتُ وَاَللَّاتِي يُخْشَى مِنْ سَمَاعِ صَوْتِهِنَّ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ، فَيُوَكِّلْنَ مِنْ يُخَاصِمُ عَنْهُنَّ، أَوْ يَبْعَثُ لَهُنَّ فِي مَنَازِلِهِنَّ ثِقَةً مَأْمُونًا» (1). 63 - وفي حواشي عبد الحميد الشرواني الشافعي [داغستاني من أهل مكة المكرمة، 1230 - 1301هـ]: «قوله: (إن الثاني) أي: يا قحبة، صريح أي لامرأة ولو ادَّعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه، ونحو الاختلاط بالرجال فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيراً عليه فهو صريح يقبل الصرف» (2). 64 - مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي الشافعي [1250 - 1320هـ] في كتابه بغية المسترشدين: «ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهن» (3). _________ (1) منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، 8/ 306. (2) 8/ 205. (3) بغية المسترشدين، ص 537.
(1/621)
65 - ومحمد جمال الدين القاسمي [ت1332 هـ] في تفسيره محاسن التأويل بعد التعليق على حادثة الإفك: «ولما فضّل تعالى الزواجر عن الزنى، وعن رمي العفائف عنه، بيّن من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهما، وذلك في مخالطة الرجال بالنساء، ودخولهم عليهن، وفي أوقات الخلوات، وفي تعليم الآداب الجميلة». 66 - وقال محمد رشيد بن علي رضا [ت1354هـ] في تفسيره المنار: «لَعَارٌ عَلَى بِلَادِ الْإِنْكِلِيزِ أَنْ تَجْعَلَ بَنَاتِهَا مَثَلًا لِلرَّذَائِلِ بِكَثْرَةِ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ» (1). 67 - وقال عبد الرحمن الجزيري [مصري ت1360هـ]: «وأُمرنا بصون أجساد النساء من التبذل، والظهور أمام الأجانب، وحثِّ المرأة على حفظ جسدها بالإحتشام والتستر، والبعد عن مواطن الريبة، وبؤر الفساد، وعن الاختلاط بالرجل الأجنبي حتى لا تقع في محرم، ولا يجرها الاختلاط والتبذل إلى الوقوع في الذنب، وتستوجب إقامة الحد عليها» (2). 68 - قال حسن البنا - من دعاة مصر-[ت 1368 هـ]: «هذا الاختلاط الفاشي بيننا في المدارس والمعاهد والمجامع والمحافل العامة، وهذا الخروج إلى الملاهي والمطاعم والحدائق، وهذا _________ (1) تفسير المنار، 4/ 269. (2) الفقه على المذاهب الأربعة، 5/ 25.
(1/622)
التبذل والتبرج الذي وصل إلى حد التهتك والخلاعة، كل هذه بضاعة اجنبية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة ... » (1). 69 - وقال مصطفى صبري التوقادي الملقب بـ (شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية) [ت1373 هـ]: «وهناك بعد آية الحجاب، أحاديث نبوية كثيرة تأمر بستر النساء عن الرجال الأجانب، وتنهى عن الاختلاط بهم ... إني لا أمنع المرأة عن التعلم، ولا من التبحر في العلوم لمن يستشعر منها النبوغ، لكن بشرط أن يكون كل من التعلم والتبحر في مدارس خاصة بالنساء، لا يخالطهن الطلاب الذ كور، ومدرساتهن منهن ... » (2). وقال أيضاً في رسالته: قولي في المرأة: «وهناك أحاديث كثيرة تأمر بستر النساء عن الرجال الأجانب وتنهى عن الاختلاط بهم ... » (3). 70 - وقال محمد فريد وجدي [من كتاب مصر- (ت1373 هـ)]: «إن من أقبح مظاهر أسر المرأة في الأفراد والأمم ترك حبلها على غاربها، وقذفها بذلك الجسم اللين، والعواطف الرقيقة، والفؤاد المملوء رحمة، والمهجة المتشبعة بالشفقة، أن تزاحم الرجال في معترك الحياة كتفاً لكتف لسد رمقها» (4). _________ (1) المرأة المسلمة، حسن البنا، ص 21. (2) قولي في المرأة، مصطفى صبري، ص 59 - 60. (3) قولي في المرأة، ص 59. (4) المرأة المسلمة، لمحمد فريد وجدي، ص 54.
(1/623)
71 - وقال عبد المجيد سليم [مصري، ت 1374هـ] من علماء الأزهر: «هذا وقد ذكر العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية فصلاً بيّن فيه أنه يجب على أُولي الأمر أن يمنعوا اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال. وذكر فيه أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر» (1). 72 - وقال الشيخ أحمد شاكر [من علماء مصر -: (ت 1377 هـ)] تعليقاً على حديث: «إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم؛ ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين رأتها زانية» (2): «انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعرات، وهن ينتسبن إلى الإسلام زوراً وكذباً، يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على اللَّه وعلى رسوله، وعلى بديهيات الإسلام، يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها عارية باغية، وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور، ويجترئون جميعاً، فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط» (3). 73 - وقال الشيخ محمد الخضر حسين [ت 1377 هـ]: «وإذا كان اختلاط الجنسين من قبيل التطوّر الاجتماعي فهو من نوع ما _________ (1) فتاوى الأزهر، نسخة ألكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية. (2) أبو داود، برقم 4173، والترمذي، برقم 2786، وتقدم تخريجه. (3) المسند، 15/ 108.
(1/624)
ينشأ عن تغلب الأهواء، وتقليد الغربيين في غير مصلحة، فيتعيّن على دعاة الإصلاح أن يجهروا بإنكارهِ، ويعملوا على تنقية المجتمع من أقذائه ومتى قَوِيت عزائمهم، وجاهدوه من طُرُقه الحكيمة أماطوا أذاه وغلبوه على أمره» (1). 74 - وقال محمد بن الحسن الحجوي [من علماء المغرب - (ت 1379هـ)]: «ويكون تعليم البنات على يد نسوة معلمات فاضلات ماهرات في التعليم حسنة السلوك مؤتمنات، وفي محلات مخصوصة بالبنات لا مختلطات بالأولاد» (2). 75 - وقال مصطفى السباعي [من علماء سورية - (ت 1384هـ)]: «يتشدد الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال، وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت كل الحضارات؛ في إنسانيتها ونبلها وسموها على الفصل بين الجنسين، ولم يؤثِّر هذا الفصل على تقدم الأمة المسلمة، وقيامها بدورها الحضاري الخالد في التاريخ» (3). 76 - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [مفتي البلاد السعودية في زمانه- (ت1389هـ)]: «وأما اختلاط النساء بالرجال فهذا من أكبرالمنكرات التي يتعيّن إنكارها على الجميع» (4). _________ (1) محاضرات إسلامية، ص 197. (2) تعليم الفتيات لا سفور المرأة، الحجوي، ص 124. (3) المرأة بين الفقه والقانون، لمصطفى السباعي، ص 186. (4) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، 10/ 49.
(1/625)
77 - وقال محمد بن سالم البيحاني [من علماء اليمن (ت1391 هـ)]: «حرام على النساء الاختلاط بالرجال في الأسواق والمصانع والمساجد والمعاهد ودواوين الحكومة، وإن قال أدعياء العلم وكذبة المصلحين بخلاف ذلك، فإنما هي الخيانة في أمانة العلم، والكذب في التجديد والتضليل بالمرأة المسكينة ... » (1). 78 - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [ت1393 هـ]: «إن من الغريب أن يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم - يمنع من ذلك منعاً باتاً» (2). 79 - وقال أبو الأعلى المودودي [من علماء باكستان - ت 1399هـ]: «إثارة النغمة للتعليم المختلط، وفتح المعاهد المختلطة يمرح فيها المراهقون والمراهقات جنباً إلى جنب من قبل بعض الأفراد لا تفسر إلا بكونهم مصابين بداء التقليد الأعمى للغرب» (3). 80 - وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد اللَّه بن حميد (1329 - 1402) في فتاويه رقم (230، 239، 240، 245، 247، 250) بتحريم كشف وجوه النساء بحضرة الرجال _________ (1) اللمع على كتاب إصلاح المجتمع، ص 246. (2) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 32. (3) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 32.
(1/626)
الأجانب والاختلاط بهم، وحلف على ذلك!!. 81 - وقال محمد محمد حسين [من أدباء مصر - (ت 1403هـ]: «كثر كلام الناس في هذه الأيام - في الصحف وفي دور العلم، وأقسام الفلسفة ومعاهد تخريج المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين منها خاصة - عن الكبت الجنسي ومضاره - وشاع بين كثير ممن ينتحلون الدراسات النفسية - والفرويدية منها خاصة - أن السبيل إلى تلافي الأضرار المتولاة عن هذا الكبت هي اختلاط الذكور بالإناث، وتخفف النساء من الحجاب ومن الثياب، وهو تخفف لا يعرف الداعون إليه مدىً ينتهي عنده، ولعله ينتهي إلى ما انتهى إليه الأمر في مدن العراة التي نُكِست فيها المدنية فارتدت إلى الهمجية الأولى! ذلك هو المجتمع المختلط الذي يدعون إلى تعميمه في المدارس وفي الإدارات الحكومية، وفي المصانع وفي الشركات وفي الأندية والمجتمعات، وقد أخذت هذه الدعوة سبيلها إلى التنفيذ في بعض هذه الميادين، والواقع أن هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه أكبر وأعم، يراد به فرنجة المرأة، وحملها على أساليب الغرب في شتى شؤونها: في الزواج وفي الطلاق، وفي المشاركة في العمل والإنتاج في شتى الميادين، وفي الزي وفي المحافل والمراقص، إلى آخر ما هنالك، وهذا الاتجاه هو بدوره جزء من اتجاه أكبر يراد به سلخنا من أدب
(1/627)
إسلامنا وتشريعه، وإلحاقنا بالغرب في التشريع والأدب» (1). 82 - وقال عبد اللَّه ناصح علوان [من علماء سوريا - (ت 1407هـ)]: «يا نساءنا المسلمات: إياكن أن تسمعن إلى دعاة الإباحية الذين يدَّعون أن السفور والاختلاط تصعيد للغريزة، وتصريف لكوامن الشهوة، بل يجعل اجتماع النساء بالرجال، والشباب بالشابات أمراً مألوفاً وعادياً» (2). 83 - وقال تقي الدين الهلالي [من علماء المغرب - (ت1407 هـ)]: «يجب أن تكون مدارس الإناث مفصولة عن مدارس الذ كور من روضة الأطفال إلى شهادة الدكتوراه» (3). 84 - وقال صالح البليهي [من علماء السعودية - (ت 1410هـ)]: «امنعوا الاختلاط، فهو خير لكم وخير لنسائكم، وخير للمجتمع كله، فمن أسباب الشر والفساد الاختلاط، سواء كان ذلك في حقول التعليم أو الدوائر الحكومية، ولا شك أن الذي يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال مجرم ومن المفسدين للأرض، وعدو للَّه ورسوله، وعدو للإسلام والمسلمين» (4). 85 - وقال الشيخ حمود التويجري [من علماء السعودية - (ت1413 _________ (1) حصوننا مهددة من داخلها، محمد محمد حسين، ص 61. (2) إلى كل أب غيور يؤمن باللَّه، عبد اللَّه علوان، ص 30. (3) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 65. (4) يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي، البليهي، ص 47.
(1/628)
هـ)]:» أقبح من ذلك ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام من خلط النساء بالرجال الأجانب في المدارس، وصنوف الأعمال بحيث يجعل لكل رجل وامرأة أجنبية منه مجلس واحد لتتم العلاقة بينهما من قريب، وتحصل الفتنة والفاحشة بينهما بأدنى وسيلة، وهذا مما دَبَّ إليهم من قبائح الإفرنج، ورذائلهم، فالله المستعان» (1). 86 - وقال الشيخ عبد اللَّه آل محمود - مفتي دولة قطر في زمانه - (ت 1417 هـ): «إن الاختلاط من مساوئ الأخلاق، وليس من خلق أهل الإسلام في شيء، بل ولا من خلق العرب في جاهليتهم ... » (2). 87 - وقال محمد بن سليمان الجراح [من علماء الكويت - (ت 1417هـ)]: «اعلم أن فكرة الاختلاط فكرة كافرة خاطئة خاسئة المخالفة للحس والعقل والوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ ... » (3). 88 - وقال محمد متولي الشعراوي [مصري ت 1419هـ]: «مسألة الاختلاط بين الفتاة والشاب لا منطقية ولا طبيعية .. نحن لا نمنع المرأة من العمل، لكن تخرج إلى العمل في محيط أسرتها، وإن استدعى أن _________ (1) الصارم المشهور، ص 91. (2) الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق، المحمود، ص 9. (3) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 8.
(1/629)
تخرج إلى المجتمع لكن في حشمتها وفي وقارها وفي اتزانها، ولا نجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط ... » (1). 89 - وقال أبو الحسن الندوي [من علماء الهند - (ت 1420هـ)]: «فأي بلد إسلامي سار على هذا الدرب، وطرح الحشمة، وسمح بالاختلاط بجميع أنواعه، وشجع التعليم المختلط، كانت نتيجته ذلك التفسخ الخلقي والجنسي، والثورة على سائر الحدود الخلقية والدينية ... » (2). 90 - وقال الشيخ سيد سابق [مصري، ت1420هـ] في فقه السنة: «إعلان الزواج: يستحسن شرعاً إعلان الزواج؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهاراً للفرح بما أحل اللَّه من الطيبات، وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج، والإعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه: كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك» (3). _________ (1) الفتاوى، الشعراوي، 5/ 12 - 13. (2) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، ص 8. (3) فقه السنة، 2/ 231.
(1/630)
91 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز [مفتي المملكة العربية السعودية (1330 - 1420هـ)]: «فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط؛ سواء كان ذلك من جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جداً له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية ... » (1). وقال أيضاً: «اختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع الشرور» (2). 92 - وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز [1420هـ]:، ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي [1415هـ] ما نصه: «اختلاط الطلاب بالطالبات، والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة، ووقوع الفاحشة ... » (3). 93 - وقال الشيخ علي الطنطاوي [سوري، ت1420هـ]: «هذا هو باب الشهوات، وهو أخطر الأبواب، عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه، وأول هذا الطريق هو الاختلاط ... » (4). 94 - وقال الشيخ محمد بن عثيمين [ت 1421هـ]: «ولهذا كان أعداؤنا _________ (1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 1/ 418. (2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 5/ 234. (3) فتاوى اللجنة، 17/ 53. (4) ذكريات علي الطنطاوي، 5/ 268.
(1/631)
- أعداء الإسلام - بل أعداء اللَّه ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم، كل هؤلاء - يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء، يدعون إلى التبرج، يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل، يدعون إلى التفسخ في الأخلاق، يدعون إلى ذلك بألسنتهم، وأقلامهم، وأعمالهم ... » (1). وقال العلامة ابن عثيمين أيضاً: «يجب علينا أن نبصِّر هؤلاء القوم الذين يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجال، وأن نبين لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل؛ لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس لها إلا شهوة الفرج، وملء البطن، أصبحت لا قيمة لها، وأصبحت ذليلة إما للدنيا، وإما لجبابرة الخلق» (2). 95 - وقال بكر أبو زيد [ت 1429هـ]: «حُرِّم الاختلاط سواء في التعليم، أم العمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها ... » (3). 96 - قال الشيخ محمد جميل زينو [شامي، يسكن بمكة معاصر]: «من المنكرات العامة: الاستماع إلى الموسيقى، أو الأغاني _________ (1) شرح رياض الصالحين، 1/ 95. (2) شرح صحيح البخاري، لابن عثيمين، 4/ 447. (3) حراسة الفضيلة، ص 97.
(1/632)
الخليعة، واختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم، ولو من الأقارب كابن العم والخالة وأخ الزوج وغيره» (1). 97 - وقال الدكتور سعد الدين السيد صالح المصري: «ينظر الإسلام إلى المجتمع على أنه مجتمع انفرادي، للرجال مكانهم، وللنساء مكانهن، ولا التقاء بينهما ولا اختلاط إلا بالزواج ... بل الإسلام يحرم الاختلاط حتى في المسجد» (2). 98 - وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: «الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يثير الفتنة أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» (3). 99 - وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال: «اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم وخلوتهم بهن من المفاسد المدمرة للأخلاق والحياء، وضياع الأولاد، المنذر بالخطر المحدق بالفرد والمجتمع» (4). وقال أيضاً: «وذلك أن المرأة المشاركة للرجال ضاعت وأضاعت رعاية أولادها وزوجهأ وبيتها، وفسدت وأفسدت الرجال، وركبت ما هب ودب من المنكرات والفواحش، وأصبحت متعة وسلعة لكل ساقط ولاقط، وحينئذٍ ضاع _________ (1) توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، نسخة ألكترونية من موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية. (2) احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، ص 231. (3) من مقال له بعنوان: على رسلكم أيها الصحفيون. (4) الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص 249.
(1/633)
حياؤها، وأنوثتها، وكرامتها، ودينها، وكان عاقبة أمرها خسراً». وإذا كان ابن القيم وأمثاله من السابقين يرون أن الاختلاط أصل كل شر في عصرهم، فكيف لو رأوا اختلاط النساء بالرجال في عصرنا، وقد اقترن بالمجون الفاحش، والصور العارية، والأدب المكشوف، والقصص الغرامية، وحفلات الرقص المثيرة، والموسيقى المثيرة، والطرب الخليع، ومناظر الجمال الجذابة، وصور الإغراء بالفاحشة، فتسيطر عليهم هذه الاستثارة الشهوانية التي تطفئ فيهم القوى الفكرية والعقلية، ولا يكادون يبلغون الحلم حتى تغتالهم الشهوات البهيمية، وتستحوذ عليهم؟!! فماذا ينتظر من وراء هذا الاختلاط؟!! (1). 100 - وقال صاحب كتاب الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق: «فتقليد المسلمين لغير المسلمين في مثل هذا الاختلاط هو مدعاة إلى الفتنة في الأرض وفساد كبير، ولن يخفى ضرره على من له مسْحة من عقل أو دين، ولكن الهوى يعمي ويصم!» (2). 101 - وقال عبد اللَّه القلقيلي [مفتي المملكة الأردنية]: «اختلاط الطلاب والطالبات في الدراسة مما لا يبيحه الشرع الإسلامي، بل يحظره ويكرهه وينكره» (3). _________ (1) انظر: المرجع السابق، ص266. (2) انظر: ضرورة الفصل بين الجنسين، ص 80. (3) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 44.
(1/634)
102 - وقال عبد المحسن العباد البدر: «حصول الجمع بين البنين والبنات بعد سن التمييز في الصفوف الأولية غير سائغ لما فيه من محاذير يدركها كل عاقل» (1). 103 - وقال عبد القادر الخطيب [رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق]: «إن اختلاط الرجال بالنساء من خصائص الأجانب، فالإثم كل الإثم على كل من يساعد على إباحة الاختلاط؛ سواء كان في الجامعات وسائر المدارس والكليات، أو في المتاجر والدوائر والمجتمعات ... » (2). 104 - وقال عبد اللَّه النوري [رئيس لجنة الفتوى في الكويت]: «أما حكم الاختلاط في الإسلام مع وضعنا الحاضر، فلا أظن أن أحداً يجهله إلا من ران على قلوبهم ما كانوا يريدون، الإسلام لم يبح اختلاط الإناث بالذ كور إلا اختلاط المحارم بالمحارم ... » (3). 105 - وقال محمد أحمد المقدم المصري: «ومن صور الاختلاط المحرم: الاختلاط في دور التعليم كالمدارس، والمعاهد، والجامعات، والاختلاط في الوظائف والأندية ... » (4). _________ (1) من مقال له بعنوان: لا يجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية في الابتدائية. (2) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 51. (3) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 8. (4) عودة الحجاب، المقدم، 3/ 56.
(1/635)
106 - وقال محمد الخطيب [من علماء لبنان]: «إن الاختلاط لا يختلف في حرمته اثنان من المسلمين، ولا ينكر مساوئه ومفاسده من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» (1). 107 - وقال محمد علي الصابوني الشامي: «حذر اللَّه جل ثناؤه من مقارفة الفواحش، وارتكاب الموبقات، فنهى عن الزنا، ودواعيه القريبة والبعيدة، من النظر إلى النساء، والاختلاط بهن، وكشف العورات، وإبداء الزينة ... » (2). 108 - وقال محمد لطفي الصباغ الشامي: «هناك نوعان من الاختلاط يتهاون فيهما كثير من الصالحين، ولابد من أن نشير ههنا إلى أنهما معولان يهدمان في كيان مجتمعنا الإسلامي: أما أولهما: فهو الاختلاط في التعليم. وأما ثانيهما: فهو الاختلاط في العمل، ومثل الذين يتهاونون في الخلوة والاختلاط الآثم بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لنداء الفضيلة، ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادّعوا أن الانفجار لا يكون؛ لأن على البارود تحذيراً من الاشتعال والاحتراق!! إن هذا خيال بعيد عن الواقع، ومغالطة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثه» (3). _________ (1) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 34. (2) تفسير آيات الأحكام، الصابوني، 2/ 181. (3) تحريم الخلوة والاختلاط المستهتر، محمد الصباغ، ص 25.
(1/636)
109 - وقال منير الغضبان السوري: «ماذا تريدون يا دعاة الاختلاط؟ أما الاختلاط في الجامعات فماذا نقول عنه؟! ضرورة اجتماعية؟! ضرورة خلقية؟! ضرورة قومية؟! ضرورة تربوية؟! هكذا يقولون!! ويقولون: إن المرأة والرجل قد بلغا من الرشد والمسؤولية بحيث يترفعان عن العلاقة الجنسية بينهما، إنما زمالة درس وصداقة مرحلة! إنهم لكاذبون!! أما لو صح قولهم بالحديث عن الرشد لأمكن أن حاجة المرأة إلى أن تتزوج انتهت مع دخول الجامعة، وهذا يكذبه الواقع لكل ذي لب، والفضائح التي تقع في الجامعات، ويندى لها الجبين أكثر من أن تحصى ... » (1). ويتضح من هذه النصوص وغيرها أن علماء الإسلام: في الهند، والباكستان، وتركيا، والشام، والعراق، ومصر، والمغرب، وقطر، واليمن، والسعودية، قد صرحوا بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل والتعليم، ولم يعرف لهم مخالف يعتد بقوله، فأين هذا من المفتونين الذين يدعون أن مصطلح الاختلاط مصطلح حادث، فهم بهذا إما جهلة وإما مغرضون، والجاهل يتعلم ولا يتكلم، والمغرض حسيبه ربه، {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئَاً} (2). ولما رأت الحكومة السعودية -حفظها اللَّه- فتح مدارس _________ (1) إليك أيتها الفتاة المسلمة، منير الغضبان، ص 22. (2) سورة المائدة، الآية: 41.
(1/637)
لتعليم البنات، وكلت تنظيمها إلى العلماء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم:، فجعلوا لها تعليماً مستقلاً عن مدارس البنين، وجعلوا لها رئاسة خاصة تسمى: رئاسة تعليم البنات، ومنفصلة عن وزارة المعارف، واستمر العمل على ذلك، فكان لذلك أحسن النتائج التعليمية -وللَّه الحمد-» (1). 110 - وقال نجم الدين الواعظ [مفتي الديار العراقية]: «اختلاط الذكور بالإناث لا يجيزه دين من الأديان، ولا سيما دين الإسلام» (2). 111 - وقال وهبي غاوجي الألباني: «إن الإسلام يأذن باجتماع النساء والرجال في بيوت اللَّه تعالى للعبادة، وسماع العلم، مع الفصل بينهم، ولكنه لا يأذن بالاختلاط، كما لا يأذن بالخلوة» (3). _________ (1) إضافة الشيخ صالح الفوزان [نقله عنه الدكتور البداح في تحريم الاختلاط]، ص 51. (2) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص 42. (3) المرأة المسلمة، وهبي غاوجي، ص 237.
(1/638)
المطلب الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده
أولاً: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان، والانحراف عن الدين هذه المفسدة مأخوذة من الواقع المشاهد المخالف لتاريخ المسلمين، فإن تاريخ المسلمين وقد مضى عليه ثلاثة عشر قرناً والمرأة المسلمة محفوظة مصانة من قبل نفسها، ومن قبل المسلمين، لا تقبل الاختلاط بالرجال، ولا يقبل الرجال الاختلاط بها، إلا ما ندر وبطريقة عفوية، فلما جاءت الدعوات الهدامة من قبل أعداء الإسلام: كالإسماعيلة الباطنية، والرافضة، والصوفية، وحزب التحرير، والشيوعية الاشتراكية، والبعثية الاشتراكية والعلمانية الليبرالية، كانت دعوة تحرير المرأة من جملة ما دعوا إليه، ووجد بعد ذلك إنشاء أحزاب ديمقراطية تنهج النهج الديقراطي الغربي، ومن ذلك الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل. ففي خضم هذه الأحزاب، حصلت انحرافات عظيمة في كثير من المسلمين: في عقائدهم، وعبادتهم، وسياستهم، وفي آدابهم وأخلاقهم، ومن آثار هذه الانحرافات قبول كثير منهم اختلاط النساء بالرجال في الوظائف والأعمال وغيرها، وقامت الدعوة إلى اختلاط النساء بالرجال وانتشرت، فمصاحبة ظهور اختلاط النساء بالرجال للدعوات الإلحادية والشركية والكفرية دليل عل أن
(1/639)
الاختلاط المذكور ما توصل إليه دعاة الإفساد، إلا في هذه الأحوال المتردية من غفلة كثير من المسلمين وجهلهم بالإسلام وآدابه، وتحول بعضهم إلى أعداء ومحاربين له. ومعلوم أنه عند الفتن العظام يحصل من الشر ما لا يكون في الحسبان، فانتشار الاختلاط في هذا الزمان يُعدّ من النوازل على المسلمين، ومن مستجدات الأحداث الكبار. و «قد حاط الإسلام المسلمة بضوابط حكيمة رسخت في أعماق القلوب، لا يستطيع المسلمون هدمها إلا إذا غيروا دينهم، وبدلوه كله» (1). فعلى هذا لم يكن انحراف المسلمين في قبول الاختلاط مقصوراً عليه؛ بل يُعدّ الاختلاط فرعاً من فروع الانحرافات. ثانياً: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا: «اختلاط النساء بالرجال الذي هو أمر جسيم الخطب عظيم الضرر، وفيه فساد الدين والدنيا والعرض والمال والأخلاق والعقل والنسب» (2). «وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة» بل صارخة- بخطر الاختلاط على الدنيا والدين» (3). _________ (1) المرأة المسلمة، ص 104. (2) مرآة النساء فيما حسن منهن وساء، ص 144 .. (3) عودة الحجاب، 3/ 64.
(1/640)
وخطره على ذلك من جهة قبوله فما قبل إلا بسبب ضعف الإيمان، وفساد اليقين، وقلة الخشية والمراقبة للَّه، وذهاب الحياء والعفاف وخمود الغيرة، وأساس هذا كله حب الدنيا وحب المنكرات. والجهة الثانية: ما يحدثه الاختلاط من فساد وأمراض، فالمقتربون منه يحصل فيهم الفساد، كما حصل في الدعاة إلى الاختلاط. وأما خطره على الدنيا فليعلم أن صلاح الدنيا بإقامة الدين وذهابها بذهابه، فمتى حصل الاختلاط لغير ضرورة شرعية، فقد عرض المختلطون دنياهم من مال وجاه وملك وأمن واستقرار وعافية أبدان، ومأكل ومشرب وملبس ومنكح وغيره للنقص بنزع البركة وتسليط الآفات والأمراض والعلل والتلف، فلا يأمن مكر اللَّه إلا القوم الخاسرون، فإذا كانت معصية أبينا آدم، وهي: أكل لقمة من شجرة حرمها اللَّه عليه، أدت إلى خروجه من الجنة، فما بالك بانتهاك حرمات اللَّه انتهاكاً يقوم على: البغي، والظلم، والاعتداء، والمكر، والغدر، والاحتيال، وغير ذلك؟! أفلا يغير اللَّه الأحوال؟! إنه غيور شديد العقاب، عزيز ذو انتقام!! ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة، وبلاء؛ لأن الإسلام لا يحرم شيئاً إلا لضرر فيه محض، أو لأغلبية ضرره على منفعته، فإطلاق اختلاط النساء بالرجال ضرر محض من وجه، وضرر أغلب من وجه آخر.
(1/641)
أما ضرره المحض فمتى كان لغير حاجة معتبرة فهذا الاختلاط ليس فيه منفعة أصلاً، فهو ضرر محض، وأما ضرره الأغلبي فمتى كان لحاجة، كالتعليم، وطلب الرزق، وغير ذلك، فالضرر هنا أعظم من المنفعة؛ لأن تعلم المرأة وعملها تقدر عليه المرأة دون اختلاط، فلم تصل الحاجة هنا إلى حد الضرورة. وعلى هذا التفصيل يظهر للمنصف أن الاختلاط الحاصل في عصرنا لا يخرج عن هذين الأمرين، وأما كونه أصل كل شر فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» (1). قال الإمام القرطبي - رحمه الله - عند حديث «فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» (2): «فإنهن أول فتنة بني إسرائيل، وفتنتهن على الرجال أشد من كل فتنة، والمحنة بهن أعظم من كل محنة؛ لأن النفوس مجبولة على الميل إليهن، وعلى اتباع أهوائهن، مع نقص عقولهن، وفساد آرائهن» (3). رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء؛ لأن المرأة المختلطة بالرجال تتسبب في ذهاب حيائها، ولا خير في امرأة ذهب حياؤها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحياء من الإيمان» (4)، بل قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: _________ (1) رواه البخاري، برقم5096، ومسلم، برقم2740 من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -، وتقدم تخريجه. (2) مسلم، برقم 2742، وتقدم تخريجه. (3) المفهم، 7/ 313. (4) رواه البخاري، برقم 24، و6118، ومسلم، برقم 36، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.وتقدم تخريجه
(1/642)
«الحياء والإيمان قرنا جميعاً، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر» (1) .. واللَّه لا يعبأ بمن نزع منه الحياء، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» (2). خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة؛ لأنه يُسهل النظر على المرأة والخلوة بها، وقد أشارت الإحصاءات الأمريكية الرسمية إلى ما نسبته (87.8 %) من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالاً جنسياً في حياتهم، نسبة (22 %) منهم قبل سن الثالثة عشرة (3). سادساً: يزيد الاختلاط في أماكن العمل والتعليم من معدلات الاغتصاب، وحالات الاعتداء الجنسي على النساء، فقد جاء في تقرير صدر عن منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: «إن العنف وحالات الاغتصاب تتزايد ضد الطالبات من جانب مدرسيهن والطلاب، كما أن أخبار وحوادث الاغتصاب التي تتم من قبل الذكور في دروات المياه في المدارس والجامعات جعلت الذعر يدب بين طالبات وفتيات الجامعة ... » (4). _________ (1) رواه الحاكم، 1/ 22 عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، والبخاري في الأدب المفرد، ص 445ومصنف ابن أبي شيبة، 5/ 213، برقم 25350، وأبو نعيم في الحلية، 4/ 297، ورواه البيهقي في الشعب، 10/ 166، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وصححه الوادعي في الصحيح المسند، برقم 752، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم 991. (2) رواه البخاري، برقم 3484،وتقدم تخريجه. (3) الاختلاط في التعليم، إبراهيم الأزرق، ص 156. (4) العدوان على المرأة، فؤاد آل عبد الكريم، ص 239.
(1/643)
سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم يؤدي إلى التحرش بها، ففي دول الاتحاد الأوربي يتعرض (35 %) من النساء إلى شكل من أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل، وتشير إحصائية المفوضية الأوربية إلى أنه خلال عام واحد تعرض نحو (50 %) من النساء العاملات إلى تحرشات جنسية (1). ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل والتعليم إلى غرق الشباب في الميوعة والانحلال، قال الرئيس الأمريكي السابق (كنيدي): «إن الشباب الأمريكي مائع ومترف وغارق في الشهوات، وإن من بين كل سبعة شباب يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غير صالحين؛ وذلك لأننا سعينا لإباحة الاختلاط بين الجنسين في الجامعة بصورة مستهترة مما يؤدي إلى إنهماكهم في الشهوات» (2). تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي، وقد أشارت إحدى الباحثات بعد عودتها من أمريكا أنه وجدت مائة وأربعاً وخمسين كلية للبنات، وقالت: «إن الأمريكيين يرون أن الاختلاط يشغل الفتيات عن الجد والنشاط العلمي بالملابس والزينة وما إلى ذلك، مما لا يفكرن فيه عندما يفتقدن الفتيان» (3). _________ (1) مجلة هدى، العدد (7)، (37) .. (2) من مقال بعنوان: "الاختلاط آثار وأخطار"، مها الجمعة. (3) مكانك تحمدي، أحمد جمال، ص 87.
(1/644)
عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، والعزوف عن الزواج، فقد بلغت نسبة الطلاق في أمريكا في العام 1970م (55 %)، أما نسبة الطلاق بعد ذلك العام، فقد تكون توقفت أو قلَّت؛ لأن نسبة الزواج قد تضاءلت كثيراً، وأصبحت الأنثى بدل أن تكون زوجة، فهي عشيقة، وحبيبة، وخليلة في ساعات الحاجة فقط (1). الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية، قال ابن القيم: «لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة» (2). الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف؛ فإن من غوائل اختلاط النساء بالرجال: تمزيق عفاف كثير منهن، قال العلامة بكر أبوزيد - رحمه الله -: «إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط؛ ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي؛ فللرجال مجتمعاتهم، وللنساء مجتمعاتهن» (3). _________ (1) التبرج والاختلاط، عثمان ناعورة، ص 117، وانظر: مجلة البحوث الصادرة عن رئاسة الإفتاء بالمملكة عدد (77) بحثاً بعنوان: "عمل المرأة والاختلاط، وأثره في انتشار الطلاق"، للدكتور عثمان جمعة ضميرية، ص 345. (2) الطرق الحكمية، 2/ 722. (3) حراسة الفضيلة، ص 58.
(1/645)
الثالث عشر: أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه» (1). قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء، لا بأصواتهن، ولا بالرؤية إليهن، ولا بمسهن، ولا بالسعي إليهن، ولا بهواية القلب لهن، كل ذلك من أنواع الزنا، والعياذ باللَّه!! فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق بالنساء» (2). فالمختلطون بالنساء لا يكاد أحد منهم يسلم من الوقوع في هذه الأنواع، أو في بعضها، وهذه الأنواع تعد من السيئات التي يكتسبها المسلم، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت حداً، فأقمه عليَّ، فقال له رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «وماذا صنعت؟»، قال: قبّلت امرأة، فأقيمت الصلاة، فصلّى الرجل مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل اللَّه على رسوله قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (3)» (4). _________ (1) رواه البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2657، وتقدم تخريجه. (2) شرح رياض الصالحين، 6/ 759. (3) سورة هود، الآية: 114. (4) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر، برقم 6823، ومسلم، كتاب الآداب، باب {إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيِّئَاتِ} برقم 1696.
(1/646)
فاستمرارية المختلطين على أنواع من الزنا الأصغر ساعة بعد ساعة، فتمضي الأيام بسيئاتها، والأسابيع والشهور والسنين، فما أكثر حصول الزنا الأصغر عند صنف الاختلاط، أضف إلى هذا: أن الإصرار على هذا الزنا يصيره ذنباً كبيراً بل ذنوباً كبيرة. الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة: لقد قال العلماء: «التبرج والسفور داعية الفجور»،. وقالوا: «ما اجتمع تبرج النساء واختلاطهن بالرجال إلا كان ثالثهما الزنا». وقال بعض الحكماء: «إذا رأيت اختلاط النساء بالرجال، فتذكر كم أولاد الزنا»، وقد أجاب الكاتب أحمد رفيق باشا العثماني بإجابة عبّر بها عن لسان العرب قبل تحوّل كثير منهم إلى الانحطاط. قال المقدم: «إن سائلاً سأل أحمد رفيق باشا بما نصه: لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن، من غير أن يخالطن الرجال، ويغشين مجامعهم؟ فأجابه في الحال قائلاً: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن، وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل، فسكت على مضض، كأنه أُلقم الحجر!» (1). وقال العلامة ابن باز - رحمه الله -: «الدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم _________ (1) عودة الحجاب، 3/ 64 - 65.
(1/647)
آثاره: الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا، الذي يفتك بالمجتمع، ويهدم قيمه وأخلاقه» (1). «فالاختلاط من أكبر انتشار الرذيلة والفاحشة في المجتمع، سواء بالاختلاط بهن في الأماكن العامة، أو بالخلوة بهن» (2). الخامس عشر: اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالآداب الكريمة بين المسلمين وهي كثيرة، ومنها: الاحترام وغض البصر، وصيانة اللسان عما لا يعنيه، وغير ذلك، فإذا وجد الاختلاط بين الرجال والنساء، فكثيراً ما تحصل الجرأة على إطلاق النظر من كلا الصنفين أو أحدهما إلى الآخر، وهذا محذر منه شرعاً، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (3)، وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (4)، فذهاب أدب غض البصر سبب كبير للانطلاق في الفتنة. قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «ففتنة النظر أصل كل فتنة ... » (5)، _________ (1) نقلاً من المرأة الغربية، ص 76 - 77، وهو في مجموع فتاوى ابن باز، 1/ 419. (2) دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر، 2/ 928. (3) سورة النور، الآية: 30. (4) سورة النور، الآية: 31. (5) روضة المحبين، ص 96.
(1/648)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فجعل سبحانه غض البصر، وحفظ الفرج، هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش ... » (1). السادس عشر: اختلاط النساء بالرجال سبب تأخيرالزواج أوتركه؛ لأن المحتاجين إلى النساء يجدون بغيتهم في بعض المختلطات لا يبقى عندهم الرغبة في النكاح الشرعي، والمصابرة والمجاهدة من أجل الوصول إليه، بل ينثني عنه كثير، خصوصاً إذا كان الزواج يكلفهم مبالغ كبيرة، وهم فقراء، والمرأة التي تجد بغيتها في الرجال يزين لها الشيطان أنها لا تتعجل بالزواج؛ لأنها إن عجلت به تحملت مسؤولية الزوجية وبعدها الأمومة، وحيل بينها وبين عشاقها والأصدقاء والزملاء؛ ولهذا صار شعار بعض المختلطات المراهقات الزواج بعد انتهاء الدراسة، أو بعد الثامنة عشرة، أو بعد إحراز الوظيفة. السابع عشر: الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء؛ لأن اختلاط النساء بالرجال ينزع الثقة من المرأة المختلطة من قبل زوجها؛ بسبب الأخبار السيئة عن المختلطات والحوادث والجنايات، وبسبب قربها من الرجال، خصوصاً إذا كانت اللقاءات بهم ميسرة، والمعاصي عليهم ظاهرة؛ فلا يبقى هنا اطمئنان ولا أمان. _________ (1) العبودية، ص 25.
(1/649)
ويدب الشك في أولياء المرأة المختلطة وفي أقاربها؛ لوجود شيء من القرائن، ويرتاب الخاطب في المختلطة، أما لو علم أنها تعشق، أو تصادق شخصاً فيعزف عنها أكثر، وأيضاً المرأة التي يختلط زوجها بالنساء في الوظائف والأعمال تشك فيه، خصوصاً إذا رأت عليه بعض التغيرات!! الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق؛ فإن من نتائج اختلاط النساء بالرجال كثرة الطلاق، وهذه الكثرة ليست محصورة على بلاد الكفار، بل قد صارت من نصيب كثير من المسلمات المتورطات في معصية الاختلاط. ولا شك أن اختلاط المرأة بالرجال في الوظائف والأعمال يفتح باباً خطيراً، ألا وهو تشكك الأزواج في زوجاتهم المختلطات، فالرجل في قلق منذ خروج زوجته إلى العمل، فإذا تأخرت عن موعد مجيئها أخذته الريبة، والمرأة المختلطة إن كانت نزيهة فهي في خوف على نفسها، وسمعتها من الرجال القريبين منها في العمل، وبعض الأزواج يجعلون مراقبين على زوجاتهم، يبلغونهم أولاً بأول، فلا أمان للزوج ولا للزوجة بسبب الاختلاط، فهلا استراحت الزوجات، وهلا استراح الأزواج. التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال؛ ولهذا قال محمد رشيد العويد: «إن المر أة فقدت كل قيمتها اليوم في أوروبا، وبلغت من الذل والشقاء حداً لم تبلغه المرأة في أي مكان،
(1/650)
فقد أصبحت ألعوبة تتدحرج من يد إلى يد، ويستبدل بها غيرها، إنها تشاهد في كل مكان خادماً في المطاعم والفنادق، وحمالة في الأسواق والطرقات، وسائقة عربات وعجلات، إنها توجد في جميع المناسبات متاعاً رخيصاً متوفراً في كل مكان، وقد نزلت عن مكانتها العالية التي منحها اللَّه تعالى حتى تهلهل لباسها، وصدئ قلبها، وأصبح شعارها السآمة والكآبة والقلق والحيرة دون أن تفكر في غاية حياتها، وعلو مكانتها، ومصيرها الذي شرع اللَّه!» (1). العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة؛ لأن أعداء الإسلام دعوا المرأة في بلادهم إلى الاختلاط والسفور ليسهل عليهم التمتع بها كما يشاؤون، ومتى شاؤوا، تمتعاً بالنظر إليها، والكلام معها، واللمس لها، والخلوة بها، والعشق لها، وبعد ذلك ممارسة الفاحشة معها، وهذه الممارسة هي التمتع الكامل بها، ومن أجله جندوا الوسائل، وجيَّشوا الدعايات إلى قبول الاختلاط، وكل نوع من أنواع التمتع المذكور له لذَّته عند أرباب دعاة الاختلاط، وعشاق القرب من النساء ينبئك عن ذلك ما قاله من هو مبتلى بهذا المرض: قلت: اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ... ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم ولم يقفوا عند هذا حتى جعلوها سلعة يتاجرون بها في المزاد _________ (1) رسالة إلى حواء، ص 83.
(1/651)
العلني: في الصحف، والجرائد، والمجلات، والقنوات الفضائية، والفنادق، والمطاعم، والأسواق، وغير ذلك. الحادي والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية؛ لأن المرأة حين تخرج من بيتها إلى المجتمع المختلط تحاول أن تستأثر بنفسها دون زميلاتها بإعجاب الرجال بها، ولفت أنظارهم إليها، وخصوصاً إذا كانت ذات رشاقة وجمال، وغنى في المال، فتراها تسعى لأن تلبس أجود القماش، وأحدث الأزياء، وأن تستعمل جميع وسائل الزينة من مساحيق وأصباغ، وتجميلات في الوجه واليدين والخصر والساقين إلى غير ذلك. وأنها إن وجدت مع نساء لم يحزن ما حازت حقرتهن، وتعالت، وتكبرت عليهن، وحسبت نفسها أنها الوحيدة في عالم الحسن والجمال، والفريدة بالإعجاب والدلال، وإذا وجدت مع نساء سبقنها، وتفوقن عليها في ذلك، حسدتهن، وحقدت عليهن، وضاقت بهن ذرعاً، وامتلأت منهن غيظاً، وأصابها هم وغم، وحسرة وحزن، وهكذا تجدها إما متكبرة متعالية، وإما حاقدة حاسدة،! وهذه أمراض خطيرة في النفس، وآفات مضعفة للعقل (1). الثاني والعشرون: اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم وإلحاق البطالة بهم؛ لأن تمكين النساء من وظائف الرجال، مما جعلهم يتساقطون في الشوارع بدون وظائف، وهذا حاصل عالمياً في بلاد الكفار _________ (1) انظر: التبرج أخطر معاول الهدم، ص 82.
(1/652)
أولاً، ثم في بلاد المسلمين ثانياً! وهذا الاعتداء من النساء والمنتصرين لهن سبب ثورة الرجال عليهن، والسعي في إيقافهن، والانتقام منهن. الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها؛ لأن أكبر مسؤولية على المرأة المسلمة: بيتها وزوجها وأولادها؛ فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته ... والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها» (1).، ونساء العرب، وخاصة نساء قريش خير النساء؛ لقول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» (2). ولم تزل المرأة العربية، وخصوصاً القرشية على هذا الحنان والرعاية، حتى طرأ عليها ما طرأ من الفساد الغربي، من اختلاطها بالرجال غير المحارم. وللَّه درُّ من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من ... همّ الحياة وخلّفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له ... أمّاً تخلت أو أباً مشغولا (3) _________ (1) رواه البخاري، برقم 893، ومسلم 1829، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (2) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: {إِذْ قَالَتْ المَلاَئكَةُ يَا مَرْيمُ إنَّ اللَّه يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ}، برقم 3434، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل نساء قريش، برقم 2527. (3) الشعر لأحمد شوقي، انظر: الشوقيات، 1/ 183.
(1/653)
الرابع والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال؛ لأن الإسلام أوجب على النساء أن يقمن بوظيفتهن الزوجية والبيتية، فهذه أكبر وظيفة خصت بها النساء، وقيامهن بهذه الوظيفة يسبب لهن هدوء البال والأمن والاستقرار، وعدم الصراع مع الرجال في معترك الحياة، فمتى خرجت المرأة من دار مملكتها إلى أماكن الريب والإفساد من اختلاط بالرجال وغير ذلك، فأصل خروجها ناتج عن افتتانها باالمال والجاه، والاغترار بما عليه الكفار! وهذا فيه من الأخطار على المرأة المفتونة ما فيه! فممكن يذهب دينها، وتتحول عبوديتها إلى المال والجاه، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ!» (1). وصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين قال: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ» (2)، وقد عرف على مر التاريخ أن الافتتان بالمال بلية الرجال فقط، وأما في عصرنا فقد فتنت النساء بالمال فتنة أدت إلى أضرار جسيمة، وأحوال ذميمة، بل لقد كانت فتنتهن بأموال الكفار، ومد أيديهن إليهم أصل هذه الفتنة، ومنبع شرها؛ فقد جرهن أعداء _________ (1) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل اللَّه، برقم 2887 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (2) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب إن فتنة هذه الأمة في المال، برقم 2336، وأحمد، 29/ 15، برقم 17471، وابن حبان، 8/ 17، برقم 3223، عن كعب بن عياض - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 2/ 141.
(1/654)
الإسلام تارة على وجوههن، وتارة على أرجلهن؛ فصارت الداعيات إلى تحرير النساء في مهب العواصف، وفي طريق المتالف؛ بسبب هذا الاندفاع والجري وراء المال؛ فهان عليهن أن يخالفن أحكاماً شرعية كثيرة، ويتعدين حدود اللَّه، فما مثلهن إلا كما قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ... فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع (1) وأين رجالهن من قول حماة الأعراض وأسود الفضيلة: أصون عرضني بمالي لا أدنسه ... لا بارك اللَّه بعد العِرْض بالمال واختلاط المرأة بالرجال يدفعها إلى طلب المزيد من اكتساب المال، إما عن طريق الترقية لها على حساب بذل عرضها، واما عن طريق التواطؤ على المنكرات، وغير ذلك. الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه؛ فإن الاختلاط كان في بعض المدارس والجامعات وغيرها من الأماكن، ثم ظهر في أماكن يتحقق فيها الفساد أكثر وأكثر، ويجر إلى الويلات. ومما جر إليه الاختلاط ما يحصل في الرياضة النسوية من كشف العورات الغليظة، ففي كتاب الاستيعاب ما نصه: «وقد شاهد الشيخ _________ (1) البيت نسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار، 1/ 259 لإبراهيم بن أدهم، ومثله البيهقي في الزهد الكبير، ص 170، وهو في مسند إبراهيم بن أدهم، ص 24، وغيرها من كتب التاريخ والحديث، ولكن صاحب تاج العروس، ص 5272 نسبه لعبد اللَّه بن المبارك، وصاحب محاضرات الأدباء، ص 609، نسبه لأبي العتاهية، ولم أجده في ديوانه، والأغرب من هذا نسبة الجاحظ لهذا البيت في كتابه الحيوان، 6/ 506 لبعض المُجَّان.
(1/655)
علي الطنطاوي - رحمه الله - مثل ذلك في دمشق الشام عام1949 م، فقال ما ملخصه: «إنه حضر إحدى المدارس ليلقي فيها درساً إضافياً، فسمع صوتاً من ساحة المدرسة، فتلفت ينظر من النافذة، فرأى مشهداً قال: ما كنت أتصور أن يكون في ملهى فضلاً عن مدرسة، وهو أن طالبات أحد الفصول، وكلهن كبيرات بالغات، قد استلقين على ظهورهن في درس الرياضة، ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها» (1). وفي المصدر نفسه ما نصه: «لقد بدأت مؤامرة السفور بالدعوة إلى كشف الوجه، وامتدت إلى الجلسات المختلطة المحتشمة، ثم إلى السفر من غير محرم: بدعوى الدراسة في الجامعة، ثم زينت الوجوه المكشوفة بأدوات الزينة، وبدأ الثوب ينحسر شيئاً فيشئاً، حتى وقعت الكارثة، فخرجت المرأة سافرة عن مفاتنها، كاشفة عن المواضع التي أمر اللَّه بسترها، حتى أضحت عارية» (2). اللهم سلم سلم! اللهم احفظ عوراتنا، وآمن روعاتنا، وصن أعراضنا!. السادس والعشرون: النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛ لتشبههن بهم؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (3)، وفيه أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، _________ (1) الاستيعاب، ص 670 - 671. (2) المصدر السابق، ص672. (3) البخاري، برقم 5885، وتقدم تخريجه.
(1/656)
وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ»، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا» (1). وعند أبي داود، والحميدي، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ!» (2). وروى عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ» (3). وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَالرَّجِلَةُ» (4)، فأين يذهب المختلطون من رجال ونساء من هذا اللعن، وقد بلغ بهم الاختلاط إلى حد المكابرة والمعاندة والإصرار عليه؟!! السابع والعشرون: سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن؛ لما جاءعن جُبَيْر بْنِ نُفَير قال: «لما فتحت قبرص فُرِّق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء جالساً _________ (1) البخاري، برقم 5886، وتقدم تخريجه. (2) أبو داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء، برقم 4099، والبيهقي في شعب الإيمان، 10، 225، والبزار، 17/ 40، والحميدي، برقم 274، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 145. (3) أحمد، 11/ 462، برقم 6874، والطبراني في الكبير، 13/ 467، برقم 14332، وأبو نعيم في الحلية، 3/ 321، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، 3/ 259. (4) أخرجه أحمد، برقم 6180، والنسائي، برقم 4459، وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 333: «حسن صحيح»، وتقدم تخريجه.
(1/657)
وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز اللَّه فيه الإسلام وأهله؟! قال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على اللَّه إذاهم تركوا أمره!! بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر اللَّه، فصاروا إلى ما ترى» (1). وعن حسان بن عطية قال: «ما أُتِيَت أُمّة قط إلا من قبل نسائهم» (2). فالناظر في حضارات الدول وسقوطها يرى أن من أعظم أسباب ذلك: انتشار الفساد بين رجال هذه الدول، عن طريق تقريب النساء من الرجال، ففي دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي سرد تاريخي عن دولة الرومان، ويقرر فيها أن انحطاط تلك الدولة كان بسبب الترف المصحوب باختلاط النساء بالرجال، بل يكاد أن يكون هذا السبب هو أصل رَزَايَا الدول والشعوب! قال المقدم: «لا ننسى أن انحراف المرأة أو الانحراف بالمرأة كان السبب الأول في أن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزق، ونزل بأهلها العقاب الإلهي، والأوجاع والأمراض الفتاكة، كما وقع قديماً: لليونان، والرومان، والفرس، والهنود، وبابل، وغيرها من الممالك!» (3). الثامن والعشرون: من شؤم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات وراقصات وممثلات؛ لأن كثيراً من الناس لا تطيب عندهم _________ (1) الزهد للإمام أحمد، برقم 767، وحلية الأولياء لأبي نعيم، 1/ 216. (2) حلية الأولياء لأبي نعيم، 6/ 76. (3) عودة الحجاب، 2/ 16.
(1/658)
المهرجانات والاحتفالات إلا بوجود فرقة نسائية ما بين مغنيات وراقصات، ولا تسأل عما تحدثه حركة الرقص والأغاني النسائية في المشاهدين؟ فإنها تسبي العقول، وتهيج النفوس إلى الفجور، وتحرك الهوى إلى الرذائل، وكثيراً ما يصاحب الرقص والغناء شرب الخمور، فإذا اجتمعت هذه فلينتظر هؤلاء الدمار!! عن عمران بن حصين - رضي الله عنها - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ» (1). . وعن هِشام بْنِ الغَاز، عن أبيه، عن جده ربيعة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يكون في آخر أمتي الخسف والقذف والمسخ»، قالوا: بم يا رسول اللَّه؟! قال: «باتخاذهم القينات، وشربهم الخمور» (2). التاسع والعشرون: الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية؛ لا شك أن من الحقائق التي يدفع بها في نحور مجيزي اختلاط النساء _________ (1) رواه الترمذي، في كتاب الفتن، علامة حلول الخسف والمسخ، برقم 2212، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، برقم 3، وابن أبي شيبة، برقم 38541، والطبراني في الصغير، 2/ 172، برقم 973، وعبد بن حميد، ص 189، وحسّنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 302. (2) أخرجه الدولابي في الكنى، 1/ 482، برقم 272، وابن عساكر (48/ 50، وحسنه الألباني في تحريم آلات الطرب، ص 47.
(1/659)
بالرجال: ما هو معلوم لدى أهل الإسلام، وحرره الباحثون في الغرب من أن الدراسة الاختلاطية تسبب اختلال القوى العقلية، وهذا بسبب تحول القاعات الدراسية الى مراسلات ومفاكهات ونظرات وقهقهات، ويتبع ذلك عشق وغرام وحب وهيام، فتلتهب الأحشاء، وتتحرك غريزة الشهوة، فتسبي العقول، وتطمس الفكرة، وتبلد الذاكرة. وعلى كل حال: فالتعليم المختلط: فساد عام في الطلاب، والطالبات، والمدرسين، والمدرسات، والمدراء، والمديرات، إلا من رحم اللَّه. الثلاثون: سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين؛ لأنه قرَّر المجربون لاختلاط النساء بالرجال في بلاد الغرب، وفي بلاد المسلمين استحالة سلامة المختلطين من الفتن، يقول محمد أحمد جمال في كتابه: «إن الذين يدَّعون أن اختلاط الجنسين في تلمذة أو عمل، أو أي نشاط اجتماعي، أو سياسي، أو حتى عسكري، يبطل ما تفيض به طبيعة كل منهما من عواطف وهواتف نحو الآخر، يكابرون في حقيقة ملموسة، وينكرون واقعاً منظوراً!! نشرت جريدة عربية أن قيادة جيش التحرير أصدرت قراراً بوقف التدريب العسكري النسوي، وهو قرار سار لأنه أوقف مهزلة كانت بطلاتها بعض المتطوعات اللاتي قلبن الجد إلى هزل، ولم يقدرن المسؤولية كمواطنات مجندات في هذه الظروف العصيبة لا إنهن في رأيي مظلومات لم يقلبن الجد هزلاً، ولم يفتهن تقدير
(1/660)
المسؤولية الوطنية كمجندات يتدربن على الحرب، ولكن من يقول للجائع ظل في المطبخ العامر بالأطايب، دون أن تأكل، ومن يقول للظمآن: أقم على شاطئ المنهل، دون أن تشرب، ومن يقول للعاري: انظر إلى معارض الألبسة والأغطية، دون أن تكتسي، ومن يستطيع أن يكتم فم المتثائب، ويختم على أنف العاطس، تلك بلا ريب مستحيلات فوق طاقة البشر» (1). (2). الحادي والثلاثون: الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا: لَمَّا حرَّم اللَّه الزنى حَرَّم الأسباب المفضية إليه؛ لأن قاعدة الشرع المطهّر: أن اللَّه سبحانه إذا حرّم شيئاً حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه؛ تحقيقاً لتحريمه، ومنعاً من الوصول إليه، أو القرب من حماه، ووقاية من اكتساب الإثم، والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة. ولو حرَّم اللَّه أمراً، وأبيحت الوسائل الموصلة إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. وفاحشة الزنا من أعظم الفواحش، وأقبحها وأشدها خطراً وضرراً وعاقبةً على ضروريات الدين، ولهذا صار تحريم الزنا معلوماً من الدين بالضرورة. _________ (1) نقلاً من كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص 261 - 262. (2) انظر: الاختلاط أصل الشر، ص 76 - 101.
(1/661)
قال اللَّه تعالى: {وَلاَ تَقَرْبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} (1). ولهذا حرِّمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله، والتبرج ووسائله، والاختلاط ووسائله، وتشبه المرأة بالرجل، وتشبهها بالكافرات .. وهكذا من أسباب الرِّيبة، والفتنة، والفساد» (2). قال ابن القيم: «لمّا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها ... فإذا حرم الرب تعالى شيئاً، وله طرق ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى، وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ... وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أن اللَّه تعالى ورسوله سدّ الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها» (3). _________ (1) سورة الإسراء، الآية: 32. (2) حراسة الفضيلة، لبكر أبو زيد، ص 94. (3) إعلام الموقعين، 3/ 121.
(1/662)
المطلب السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها
الذين يتعلقون بالآيات والأحاديث المتشابهات، هم ممن قال اللَّه فيهم: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} (1). وهم الذين قال اللَّه فيهم: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} (2). وهم الدعاة على أبواب جهنم؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن وقوع الفتن في آخر الزمان (3)، وأخبر - صلى الله عليه وسلم -: أنه يدعو الناس إلى هذه الفتن «دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» (4). وعلى هذا سأذكر في هذ المطلب شبه دعاة الاختلاط، والرد _________ (1) سورة آل عمران، الاية: 7. (2) سورة النساء، الآيتان: 26 - 27. (3) البخاري، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، برقم 7061، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، برقم 157، وكتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، برقم 2671. (4) البخاري، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة، برقم 7084.
(1/663)
عليها على النحو الآتي: أولاً: يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل، ومنه الاختلاط، وقد عاش الصحابة زمناً قبل فرضه في المدينة ومكة نحواً من سبعة عشر عاماً، وأما بعد فرضه فخمسة أعوام نبوية فقط، ولهم في ذلك مرويات وقصص في كتب السنة والسير، وكان فرضه سنة خمس من الهجرة، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: نزل الحجاب مبتنى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش - رضي الله عنها - (1). وذلك قريب سنة خمس من الهجرة، قال صالح بن كيسان قال: نزل حجاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. رواه ابن سعد (2). بل جزم ابن العربي في «أحكام القرآن» (3) أنه سنة ست، وعلى هذا فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - عاش بعد فرضه أربع سنين وشيئاً. ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها: الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ _________ (1) البخاري، كتاب النكاح، باب الوليمة حق، برقم 5166. (2) الطبقات الكبرى لابن سعد، 8/ 75. (3) 6/ 332.
(1/664)
اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ، فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ» (1)، ثم عَقب بقوله: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم. فهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب؛ فإن الحجاب ولوازمه فرض في قريب السنة الخامسة، وهذا العرس كان قبل ذلك، فزوجة أبي أسيد هي سلامة بنت وهب وأولادها ثلاثة: أسيد وهو الأكبر، والمنذر وحمزة، كما نص عليه خليفة بن خياط في «طبقاته» (2)، وَعُمْرُ أبي أسيد الساعدي حينما فرض الحجاب كان سبعاً وستين سنة، وابنه الأكبر الذي أمه سلامة المتزوجة كما في هذا الحديث ذكره عبدان المروزي في الصحابة، وكذلك ابن الأثير وغيرهم، ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - توفي سنة إحدى عشرة للهجرة، والحجاب فرض سنة خمس للهجرة، يعني قبل وفاته بخمس سنين، فمتى تزوج أسيد وسلامة - رضي الله عنهما -؟ ومتى ولد لهما؟ ومتى أمكن أن يكون ابنهما أسيد، وأن يعد صحابياً في خمس سنين. وقال النووي - رحمه الله - عن هذا العرس: «هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب» (3). وقال العيني - رحمه الله -: «وكان ذلك قبل نزول الحجاب» (4). _________ (1) البخاري، كتاب النكاح، باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، برقم 5182، ومسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً، برقم 2006. (2) طبقات خليفة، ص 254 ط العمري. (3) شرح النووي على صحيح مسلم، 13/ 177. (4) عمدة القاري، 6/ 332.
(1/665)
وبهذا قال القرطبي في «تفسيره» (1). وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أسيد أيضاً، كابن بطال بقوله: «وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر في العرس، وأن ذلك من الأمر المعروف القديم» (2). الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - في «الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلاً (3)، وقال بعضهم معلقاً: «وفيه الإذن لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى». والجواب: أن الخروج للحاجات لا ينكره أحد، ثم إن هذا جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً، ففي البخاري (4) كان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: احجب نساءك، فلم يكن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل اللَّه آية الحجاب. الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ: _________ (1) الجامع لأحكام القرآن، 9/ 98. (2) شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 7/ 294. (3) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}، برقم 4795، ومسلم، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، برقم 2170. (4) البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، 6240.
(1/666)
فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ ... قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ» (1). فهذا النص صريح أن هذا كان لما «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة»، يعني قبل فرض الفرائض حتى الصلوات والحج والصيام، وقبل فرض الحجاب بخمس سنين، وبين ذلك ابن بطال - رحمه الله - قال: «وكان ذلك قبل نزول الحجاب» (2). والقلب حينما يبحث عن شبهة يُعمى عما بين عينيه من الحق، ومن أغمض عينيه عن نص أمامه في ذات الخبر، فهل سيبحث عن جمع أدلة الباب، وتحري الحق فيها ليسلم له دينه؟! الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ ... » (3) الحديث. فقد قال الحافظ البيهقي بعد إخراج الحديث: «وكان ذلك قبل نزول الحجاب» (4). وقال الحافظ ابن رجب: «هذا كان قبل نزول الحجاب» (5). _________ (1) البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب حدثنا مسدد، برقم 3926. (2) شرح صحيح البخاري لابن بطال، 4/ 560. (3) البخاري، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، برقم 929. (4) الآداب للبيهقي، 207. (5) فتح الباري، لابن رجب، 6/ 73.
(1/667)
وقال القاضي عياض مبيناً أنها قبل فرض الحجاب كما في «المعلم» مثل هذه القصة لعائشة، وهي حينئذ - واللَّه أعلم - بقرب ابتنائه بها، وفي سن من لم يُكلَّف» (1)، وقد تزوجت وعمرها تسع سنين، يعني قبل فرض الحجاب ببضع سنين. ثم إن العرب تُغلِّب إطلاق لفظ «الجارية» على الأمة غير الحرة، أو على الحرة غير البالغة، فإذا بلغت تسمى امرأة، ولهذا قالت عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (2). ويبين أنهما إماء، ويوضحه قوله في رواية أخرى: «وعندي جاريتان من جواري الأنصار» (3) يعني من إمائهم، وكان الضرب والغناء من خصائص الموالي، قال الخطابي: «والعرب تثبت مآثرها بالشعر، فترويها أولادها وعبيدها فيكثر إنشادهم لها» (4). وهي من دون البلوغ كما هو معروف، قال القرطبي في «المفهم»: «الجارية في النساء كالغلام في الرجال، وهما يقالان على من دون البلوغ منهما» (5). _________ (1) المعلم شرح صحيح مسلم، 3/ 168. (2) الترمذي، كتاب النكاح، باب إكراه اليتيمة على التزويج، برقم 1109، البيهقي، 1/ 319، والديلمي في الفردوس، 1/ 317، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 1834. (3) مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في العيدين، 892. (4) غريب الحديث، 1/ 655. (5) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، للقرطبي، 8/ 10.
(1/668)
الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - أنها قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بني عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين» (1). فهذا قبل الحجاب فالربيع خطبها زوجها إياس بن بكير قبل غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، ثم خرج هو وأخواه، وبعد بدر تزوجت الربيع من إياس، ودخل عليها زوجها، وأنجب محمداً منها، وقد أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله ابن منده، والحجاب فرض بعد ذلك سنة خمس أو ست كما تقدم، فكيف يُستدل بذلك على حُكم نزل بعد؟. والربيع بنت معوذ بن عفراء كانت عجوزاً معمَّرة، كما قاله الذهبي في «تاريخ الإسلام» (2)، وتوفيت سنة سبع وثلاثين للهجرة، وزواجها كان قبل فرض الحجاب. وهذه أدلّة يوردونها وهي قبل فرض الحجاب، وأدلة شرب الخمر قبل النسخ أكثر منها وأصرح، وسيأتي يومٌ داعيها كما في الخبر: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» (3). _________ (1) البخاري، كتاب المغازي، باب حدثني خليفة، برقم 4001. (2) 5/ 402. (3) البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، برقم 5581.
(1/669)
ومع هذا فكثير من الوقائع زمنها قبل فرض الحجاب، يقطع به العلماء، ويجزمون به، قال الحافظ ابن حجر: «وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاً» (1). فهذه الشبه الخمس السابقة كلها أحاديثها قبل نزول الحجاب، ولا شك أن كثيراً من دعاة الاختلاط يذكرون أدلة في سياقات مختلفة، لا معنى لذكرها، ولا حجة لهم فيها، ومنها: الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين في خروج سودة لحاجتها ليلاً، وقد تقدم أن الواقعة قبل فرض الحجاب، ثم أنه لا أحد من أهل الإسلام يمنع المرأة أن تخرج لحاجة، ثم ألا يعتبر الكاتب بقصدها الخروج ليلاً، وترك النهار، وهذا من حشمة نساء الصدر الأول وحيائهن؛ ولهذا أنشد النميري عند الحجاج قوله: يخمرن أطراف البنان من التقى ... ويخرجن جنح الليل معتجرات قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة (2). الشبهة السابعة: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ _________ (1) فتح الباري، 7/ 256. (2) انظر: الأغاني، 6/ 206.
(1/670)
قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ» (1). فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول: أن هؤلاء صبيان لم يبلغوا، فسهل ابن سعد الذي يحكي عن نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي صغير كان عمره دون البلوغ قطعاً، قال الزهري: كان له يوم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سنة، كما رواه أبو زرعة في «تاريخه»، وكيف لأحد أن يثبت أن من معه ليسوا حُدثاء مثله، ورفيق الصبي صبيّ! الوجه الثاني: هذه المرأة جاء في نفس الخبر أنها امرأة عجوز من القواعد، ولكن من يستدل به لا يورد ذكر أنها عجوز، روى البخاري قال سهل بن سعد: «فكنا نفرح بيوم الجمعة، من أجل ذلك .. إلخ» (2). والقواعد من النساء لسن مخاطبات بالحجاب بنص القرآن كما تقدم. وهذا الخبر سيق في مساق انتشار الصحابة بعد الجمعة، وأنهم لا ينتظرون، وليس في هذا الخبر إلا أن المرأة تطبخ الطعام في مزرعتها، ثم تدفع الطعام لهم ليأكلوا، كحال الآخذ والمُعطي، _________ (1) البخاري، كتاب الجمعة، باب قول اللَّه تعالى: {فَإذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا في الأَرْضِ} برقم 938. (2) البخاري، كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس، 2349.
(1/671)
والفهم أبعد من ذلك ظنون. الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي!، فَقَالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ- أَوْ عَجِبَ- مِنْ فَعَالِكُمَا»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (1)» (2). فقد قال الحافظ ابن شكوال: إن الرجل الأنصاري هو عبد اللَّه بن رواحة، وعبد اللَّه بن رواحة قتل بمؤتة سنة ثمان، واللَّه أعلم، ثم إن هذا لا يثبت زمنه، والاستدلال بهذا بعيد، فتلك ضرورة شديدة، فقد جاء في إحدى الروايات - كما عد إسماعيل القاضي - أنه لم يطعم ثلاثة أيام، وإنقاذ رجل من الهلاك، لا يلتفت معه إلى وجود امرأة في مكان بليل دامس. _________ (1) سورة الحشر، الآية: 9. (2) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}، برقم 3798.
(1/672)
الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ». وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، فَقَالَ: «لاَ تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ... » الحديث (1). فهذه المرأة التي تُسمى أم شريك، وكانت من القواعد كبيرة صالحة، واسمها على الصحيح غزيلة بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة، والقواعد لا يخاطبن بالحجاب والاحتراز من الرجال بنص القرآن قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} (2). قال المفسرون من السلف كعطاء وسعيد بن جبير والحسن: هي المرأة الكبيرة التي لا تلد. قال ابن عبد البر معلقاً على قصة أم شريك: «ففيه دليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال، ويتحدثون عندها، ومعنى الغثسيان الإلمام والورود» (3). _________ (1) مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، برقم 2942. (2) سورة النور، الآية: 60. (3) التمهيد، لابن عبد البر، 19/ 153.
(1/673)
قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة: يُغشون حتى ما تهرُّ كلابهم ... لا يسألون عن السواد المقبل (1) وتجالت المرأة فهي متجالة، وجلت فهي جليلة إذا كبرت وعجزت، وهذا حُكم اللَّه فيهن، بنص القرآن فلا يدخل معهن غيرهن، إلا عند من لا يفرق بين أعمار الناس في الأحكام. وليس لعالم يُدرك مواضع النصوص، أن تمر عليه مثل هذه القصة، فيدع المحكم البيّن، إلى طريق التوى به التواءً يذهب بكل ما عمد إليه، ويورد قصة امرأة لا يدري هل هي من القواعد أم لا، وهل غشيان أصحاب النبي لها يلزم معه الدخول عليها، أو تخدمهم في باحة بيتها، فإن بيوتهم كانت حُجَراً مسقوفة، يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة، يجلى فيها الزوار، وهكذا كانت حُجرات أمهات المؤمنين، ومن ظن أذ حُجراتهم غُرف بلا باحات فقد غلِطَ وجهل. الاستدلال بأحاديث الإماء الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج أبي النعمان قال: «سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، تَقُولُ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» (2). _________ (1) انظر: ديوان حسان بن ثابت، ص 73. (2) أخرجه أحمد، 44/ 624، برقم 27067، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة، برقم 78، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، برقم 62، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، برقم 382، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 71.
(1/674)
فأم صبية محكومة بحكم الإماء، فهي جارية من جواري عائشة، كما رواه البيهقي (1) من طريق محمد بن إسماعيل عن عبد اللَّه بن سلمة عن أبيه عن أم صبية الجهنية، وكانت جارية لعائشة - رضي الله عنها -. وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها، وبه ينتقض الاحتجاج به، فالإماء كما هو معلوم في الشريعة غير مخاطبات بالحجاب مثل الحرائر بل كان عمر بن الخطاب يضربهن على تشبههن بالحرائر. وجاء عند الواقدي في «السير» قال: حدثني عمر بن صالح بن نافع حدثتني سودة بنت أبي ضبيس الجهني أن أم صبية الجهنية قالت: كنا نكون على عهد النبي، وعهد أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تجاللن، وربما غزلنا فيه، فقال عمر: لأردنكن حرائر فأخرجنا منه. وفي هذا الحديث فائدتان: الأولى: أنها متجالة يعني كبيرة. والثانية: أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا زمن عمر - رضي الله عنه -، وجزم مُغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (2) في كونها من الموالي، والأمة ليست مأمورة بالحجاب في الإسلام، ومع هذا فقد قال الطحاوي بعد روايته للحديث: «في هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه» (3). _________ (1) الدعوات، للبيهقي، 1/ 135. (2) شرح سنن ابن ماجه، لمغلطاي، 1/ 217. (3) 1/ 25.
(1/675)
الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا» (1). فلا أدري كيف يفهم منه الاختلاط، فكيف يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها ... » الحديث. وهو قد جمعهم قبل الصلاة يتوضؤون جميعاً، ثم يفوتهم وقت الصلاة، ولا ريب أن من فهم هذا الفَهم أساء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فهماً وتشريعاً، والمقصود به غير هذا المعنى. ويُفسر هذا الأثر ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»، وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار»: عن ابن جريج، قال: «سألت عطاء عن الوضوء الذي بباب المسجد، فقال له إنسان: إن أناساً يتوضؤون منه، قال: لا بأس به، قلت له: أكنت متوضئاً منه؟ قال: نعم، فراددته في ذلك، فقال: لا بأس، قد كان على عهد ابن عباس، وهو جعله، وقد علم أنه يتوضأ منه النساء والرجال، والأسود، والأحمر، فكان لا يرى به بأساً» (2). يعني يتناوبون على أواني واحدة يتوضأ منها الجميع لا تتنجس المياه بكثرتهم، ولا باختلاف أجناسهم، كما يتناوب المتأخرون على الحمامات والصنابير، وليس في ذلك دلالة على اجتماعهم في ساعة واحدة، وإنما يتناوبون، والعلماء عند الاستدلال ينظرون إلى _________ (1) البخاري، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، برقم 193. (2) عبد الرزاق، 1/ 73، برقم 236، وتهذيب الآثار للطبري، 2/ 713.
(1/676)
القصد من سياق الخبر وروايته؛ لأن الراوي إذا قصد بيان حكم في حديث لم يحترز إلا له، ولهذا لم أجد أحداً من الأئمة ممن أورد هذا الحديث إلا ويورده في أبواب عدم تنجس الماء من بقايا المرأة وفضلها، لا يخرجونه عن ذلك؛ لأن ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عد سماع الخبر. وما جاء في لفظ: «كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا» (1) يعني لا نغترف اغترافاً بأواني بل الماء تغمس الأيدي فيه يشير إلى أنه لا يتنجس بورود المرأة فيه قبلنا، وهكذا يقررها الفقهاء في جميع المذاهب الأربعة. قال إمام المدينة الزهري مبيناً ذلك: تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك (2). وعلى هذا فسر أئمة الإسلام في القرون المفضلة. الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ» (3). فالمقطوع به أن أزواجهم معهم، يبتن حيث يبيتون ويرتحلن _________ (1) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة، برقم 80، والبيهقي، 1/ 190، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 140، برقم 73. (2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر، 3/ 135. (3) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب رد النساء الجرحى والقتلى، برقم 2883.
(1/677)
حيث يرتحلون، وأي ضررٍ في ذلك؟ ولا يُتخيل أن أزواجهم في المدينة والنساء يخرجن للجهاد، وإذا كان كذلك والمرأة حال السفر مع زوجها ترحل وتنزل، وعند التحام الصفين تكون النساء في الخلف، والمرأة منهن تعين الجريح المثخن لا المعافى الصحيح، وما الضرر في ذلك، ولا يعدو هذا كونه سفراً من الأسفا، ر فالنساء يذهبن للحج والعمرة قوافل والنساء مع رجالهم. ثم كيف يقاس هذا على اختلاط المرأة بالرجال في ميادين العمل والدراسة؟! كيف وقد أمر اللَّه أهل العلم بالعدل والإنصاف: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا} (1). الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد، ففقدها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلاَّ آذنتموني» فأتى قبرها، فصلى عليها» (2). فقد أورده بعضهم مستدلاً به على دخول المرأة أماكن الرجال، فاليوم أربع وعشرون ساعة، والصلوات الخمس لا تخلص بمجموعها إلى أربع ساعات متفرقات، ومحاولة إيراد عمل المرأة في المسجد وحشرها في الأربع ساعات، وترك العشرين ساعة لا _________ (1) سورة الأنعام، الآية: 152. (2) البخاري، كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان، برقم 458، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم 956.
(1/678)
يليق بحامل قلم، ثم هي لا تعمل كل يوم قطعاً، فمساجدهم كانت تراباً لا فراشاً، ولا يظهر فيها ما دقَّ كمساجدنا، أما أنها تُنَظِّف والرجال يصلون، والنساء خلفهم، وهي منصرفة تترك الصلاة وحدها تكنس فهذا محال، وأما في حال خلو المسجد وهو أكثر الوقت فلا حرج ثَمَّ، فمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أبواب تغلق فيه، كما ثبت عن ابن عمر في البخاري: قال: «كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرُشُّونَ شَيْئًا» (1). الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك قالت: فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي» (2). فقد استدل فيه بعضهم على جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها». وهذا من الجهل العريض، وعدم معرفة بحال الحُجرات النبوية، ولا بلسان العرب، فالحجرات غرف معها باحات صغيرة مكشوفة للضيفان، والداخل إلى الباحة موصوف بالدخول، وتُسمى حجرة تبعاً، وهذا بإجماع العارفين بالسنة والتاريخ والسير، ففي الصحيح عن عائشة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: _________ (1) البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، برقم 174. (2) البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، برقم 2661، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، برقم 2770.
(1/679)
«كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ» (1). وأخرج الإسماعيلي في «صحيحه»، والبيهقي عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي (2). تعني الحجرة والباحة مفتوحة السقف، وليست الحجرة المسقوفة التي تكون فيها المرأة عند وجود الرجال؛ لأن المسقوفة لا تصلها الشمس. قال ابن حجر في معنى الدخول: «لا يَلزَم مِنَ الدُّخُول رَفع الحِجاب فَقَد دَخَلَ مِنَ الباب وتُخاطِبهُ مِن وراء الحِجاب» (3). ومثل هذا احتجاجه بلفظ «الدخول» في الحديث: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ» (4). الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة جماعة في المسجد، وهذا يرد عليه من وجوهٍ: الوجه الأول: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن بالعبادة لهن، واحترز بقوله: «خير _________ (1) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، برقم 522، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم 611. (2) البيهقي، 1/ 442، ومسند إسحاق بن راهويه، 2/ 145، ومسند السراج، ص 338، وبنحوه في البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، برقم 550. (3) فتح الباري، 9/ 286. (4) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2173.
(1/680)
صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (1) حضاً على المباعدة للجميع، وعدم القرب، فلما تحصَّلَ تحقيق العبادة مع دفع المفسدة بشيء من السبل والاحترازات فعل ذلك، وما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من سد الذريعة أن جعل للنساء موضعاً متأخراً عن الرجال. الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل مع وجود النساء خلف الرجال ضبطاً لأفعالهن وأقوالهن أن يظهرن شيئاً من ذلك بلا حاجة، فقال - صلى الله عليه وسلم - مبيناً ما يفعلن عند سهو الإمام: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (2) - يعني في الصلاة-. يعني إذا انتاب أحد النساء شيء في الصلاة أن تصفق ولا تسبح، ومعلوم أن تصفيق النساء والرجال يشتبه من جهة السماع، ولكن خص اللَّه - عز وجل - النساء في ذلك حتى لا يظهر من صوتهن شيء يتميزن به بلا حاجة، ومع هذا فالمرأة إذا تكلمت من غير خضوع بالقول فجائز، مع ذلك خصه النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء في مثل هذا، ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالتسبيح كحال الرجال. الوجه الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خَصّص للنساء باباً يدخلن للمسجد ويخرجن منه. _________ (1) صحيح مسلم، برقم 440، وتقدم تخريجه. (2) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، برقم 1203.
(1/681)
الوجه الرابع: أنه كان يتأخر بعد سلامه من الصلاة، فيثبت مكانه ويأمر الرجال بذلك، حتى لا ينصرف الرجال فيختلطوا بالنساء عند خروجهن كما تقدم في حديث أبي أسيد - رضي الله عنه -. وقد أخرج البخاري من حديث أم سلمة قالت: «كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم» (1). قال ابن شهاب الزهري: «نُرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال» (2). وعن أم سلمة - رضي الله عنها - كما في «صحيح البخاري» (3) قالت: كان يسلم، فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -. الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط النبي بالنساء، وفلي بعض النساء لرأسه، وإردافه لأسماء، فهذا من خصوصياته، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أبو المؤمنين، يزوج النساء بلا وليهم لو شاء، قال تعالى عن لوط وهو يعرض نساء قومه: {هَؤُلاَءِ بَنَاتِي} (4)، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد، قال: لم تكن بناته، _________ (1) البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، برقم 870. (2) البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، بعد الحديث رقم 870. (3) البخاري، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم850. (4) سورة الحجر، الآية: 71.
(1/682)
ولكن كنّ من أمته، وكل نبي أبو أمته (1). وبنحوه قال سعيد بن جبير. وقال عن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (2)، قال أُبيّ بن كعب: وهو أبوهم» (3). وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس. والاختلاط حُرِّم درءاً للمفسدة، وهي منتفية منه - صلى الله عليه وسلم -. ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، قال اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (4)، فليتأسّ بزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعاً، وينفي الخصوصية، فالآية أباحت الأربع، ولم تمنع من الزيادة، وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وتُبين فذاك واجب في الحالين، في مسألة الاختلاط: «إياكم والدخول على النساء» (5)، وفي مسّ المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه» (6). _________ (1) انظر: تفسير الثوري، 131، وتفسير ابن أبي حاتم، 6/ 2035، وتفسير الطبري، 15/ 414. (2) سورة الأحزاب، الآية: 6. (3) مصنف عبد الرزاق، 10/ 181، برقم 18748. (4) سورة الأحزاب، الآية: 21. (5) البخاري، برقم 5232، ومسلم، برقم 2172، تقدم تخريجه. (6) البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2046، وتقدم تخريجه.
(1/683)
الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قدمت على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت)؟ قلت: نعم، قال: (بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة». ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلّت رأسي، ثم أهللت بالحج. . . الحديث» (1). فلا يمكن أن يكون ذلك إلا من محرم، قال النووي في هذه القصة في «المجموع» (2): «هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له». ولو ساغ أن أستدل بكل فعل مجمل على ظاهره، دون الرجوع للمحكم، لأحللت الحرام القطعي بالظنون، ففي نصوص كثيرة يقال: «جاء فلان ومعه امرأة»، واستدل بذلك على جواز الخلوة، واتخاذ الأخدان والعلاقات المحرمة؛ لأنه لم يرد في النص ذكر الرحم بينهما، والأصل في الشرع أن الرجل إذا وُجد مع امرأة تحمل على أنها من محارمه إلا لِظِنَّة وشُبهة، وهذا الأصل في المسلمين، وكيف بالصحابة الصالحين - رضي الله عنهم -. الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين عن أم _________ (1) البخاري، كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، برقم 1725، مسلم، كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، برقم 1221. (2) 8/ 199.
(1/684)
الفضل بنت الحارث - رضي الله عنهما -: «أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ» (1). وذكر شراح الحديث بأن هذا أصل في المناظرة في العلم بين الرجال والنساء» (2). ولا شك أن المناظرة في العلم والتعليم، لا ينكر وجودها أحد، وهذا تعميم أورد فهماً خاطئاً، ولو تحقق له صفته علم أنه أتي من تلقينٍ، وإدامة نظر في مقالات صحفية، لا تُري القارئ إلا ما ترى، تُسوِّدها أقلام ذاهلة، أحبوا شيئاً فطوَّعوا له النصوص، المناظرة في العلم بين الرجال والنساء التي يستنبطها العلماء الحذاق من النصوص، هي على حالٍ وصفها مسروق بن الأجدع، كما في «الصحيحين» قال: سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب (3). وكما ذكره البخاري في «تاريخه» قال عبد اللَّه الباهلي: «رأيت سِتر عائشة - رضي الله عنها - في المسجد الجامع، تُكَلِّم الناس من وراء الستر، وتُسأل من ورائه» (4). _________ (1) البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، برقم 1988، ومسلم، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، برقم 1123. (2) انظر: فتح الباري لابن حجر، 4/ 238، وعمدة القاري للعيني، 17/ 116. (3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، برقم 370 - (1321). (4) 5/ 121.
(1/685)
وكما جاء في «المسند» عن عبد اللَّه أبي عبد الرحمن قال: «سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي الْأَشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالُوا: حَدَّثَنَا، قَالَ: سَلُوا، فَقَالُوا: مَا مَعَنَا شَيْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ، فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: سَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ» (1). الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت في ذكر الأسواق، والبيع والشراء، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنها طرقات لا مواضع جلوس وقرار فضلاً عن الخلوة، ومع هذا فهذه الاستثناءات لم يرتضها الصحابة تمام الرضا، وإنما خففوا فيها بلا مبالغة للحاجة إليها، فقد روى أحمد عن علي - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق، أما تغارون! ألا إنه لا خير فيمن لا يغار» (2). الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاط، وقولهم: إن الاختلاط لم يضبطه الفقهاء مثل الخلوة: فهذه دعوى من جهة الإطلاق لا تستقيم على قدم التحقيق، لما سبق، ثم إن الخلوة تعلقها بمسائل الفقه ظاهر بخلاف تعلق الاختلاط، فالاختلاط لا تتعلق به مسائل فقهية تتصل بأبواب العقود والفسوخ مثل الخلوة، فالفقهاء يوردون الخلوة في مسألة إثبات _________ (1) مسند أحمد، 33/ 401، برقم 20276، وحسن إسناده محققو المسند. (2) مسند أحمد، برقم 1118، وقال محققو المسند، 2/ 343: «إسناده ضعيف»، وتقدم تخريجه.
(1/686)
المهر، لمن عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، وأنه إذا لم يختلِ بها فليس لها المهر كاملاً، وإذا اختلى بها فلها المهر، ولو قُدر أنها حملت بعد العقد، وقد خلا بها، وأسدل الستار بينهما، فلحاق النسب لمن عقد عليها بالإجماع، ولو قال إنه لم يمسها إلا إذا لاعن، وأما إذا عقد عليها، ولم يخلُ بها، وطلقها، فلها نصف المهر، وله نفي الولد بلا لعان على الصحيح. وبعض المسائل المتعلقة بالأخلاق لا يكثر منها الفقهاء ذكراً، مع تقرر تحريمها كتخبيب المرأة على زوجها، كأن يقول رجل لامرأة: «تطلقي من زوجك وأتزوجك بعده»، فهذا محرم، بل قال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها» (1)، ولا يكاد يذكر الفقهاء التخبيب في كتب الفقه إلا نادراً، لأن أثره في العقود والفسوخ ضعيف، وذكر الاختلاط في دواوين الفقه أوفر منه بكثير. وتعلق الخلوة بمسائل كبيرة رتبها الشرع لازم لإكثار العلماء من ضبط وصفه والإكثار منه إيراداً في كتب الفقه، وأما الاختلاط فصلته بأبواب الأخلاق والقيم أكبر مع عناية الفقهاء به ذكراً وتحذيراً، وهم مجمعون على التحذير منه كما سلف، في مواضع _________ (1) سنن أبي داود، أول كتاب الطلاق، باب فيمن خبب امرأة على زوجها، برقم 2177، وعبد الرزاق، 11/ 456، برقم 20994، والحاكم، 2/ 197، والطبراني في معاجمه الثلاثة، الكبير، 13/ 228، برقم 13959، والأوسط، 2/ 223، برقم 1803، والصغير، 2/ 17، برقم 698، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 1890.
(1/687)
متنوعة من أبواب الفقه وفصوله كأحكام الأعراس، ومسائل اعتكاف النساء، والجهاد، والشهادة، والخصومة عند القاضي واتباع الجنائز. وجميع فقهاء المذاهب الأربعة يطبقون على التحذير منه، ومنعه في مصنفاتهم (1). الشبهة الحادية والعشرون: قول دعاة الاختلاط: «إن الحجاب من خصائص أمهات المؤمنين: وعلى هذا، فالاختلاط محرم عليهن خاصة؛ لأن اللَّه ذكرهن وحدهن في الآية: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2). فهذه جهالة عصرية، لا تقوم على نظر، ولا على برهان، ولا على قول لأحد من مفسري القرآن من السلف، وكأن القرآن لم يفهمه أحد إلا أهل الحضارة المعاصرة، وخير القرون ومن بعدهم نقلوا الأحكام على غير وجهها، وبيان ذلك على هذا التفصيل في الوجوه الآتية: الوجه الأول: أن القرآن عام للناس بجميعه كما قال تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (3) أي من يبلغه ما فيه فهو حجة عليه، والعبرة بعموم حُكمه، وإن تم تخصيص الخطاب لأعلى البشر، وهم الأنبياء، فضلاً عن آحاد الصحابة، _________ (1) انظر: الاختلاط للطريفي، ص 71. (2) سورة الأحزاب، رقم الآية: 53. (3) سورة الأنعام، الآية: 19.
(1/688)
وأزواج الأنبياء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم: «إن اللَّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» (1)، فإذا كان خطاب الأنبياء الوارد في القرآن المخصوصين به عاماً لأهل الإيمان، فكيف بخطاب توجه لمن هو دونهم، فإذا دخل المؤمنون في خطاب الأنبياء فدخول النساء في خطاب أمهات المؤمنين أولى. الوجه الثاني: أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد اهتمام به، وأنه أولى بالاتباع من غيره، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل زائد عن مجرد الخطاب، كما هي عادة القرآن في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (2)، وقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (3). الوجه الثالث: أن آية الحجاب جاء معها بنفس الخطاب أوامر أخرى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (4)، فهل هذا الخطاب خاص، فلا يُشرع ذكر ما يُتلى في بيوتهن من القرآن والسنة إلا أزواجه! مع أن هذه الآية أظهر في الخصوصية؛ حيث قال: {فِي بُيُوتِكُنَّ}، وأما في الحجاب قال: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (5)، فما _________ (1) مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم 1015. (2) سورة الأحزاب، الآية: 50. (3) سورة الأحزاب، الآية: 52. (4) سورة الأحزاب، الآية: 34. (5) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/689)
قال: (حجابكن) كما هنا {في بيوتكن}، وهل يفهم من هذا التخصيص الزائد: أن لا يدخل فيه تلاوة الآيات والحكمة في بيوت غيركن، ولا غيركن في بيوتهن وبيوت غيرهن، وهذا لا يقول به مسلم، ولا يلتزمه من يقول بخصوصية الحجاب، مع أنه في نفس الآيات ونفس السياق. الوجه الرابع: ما أجمع عليه العلماء أن الأحكام تدور مع العلل والمقاصد من التشريع، فاللَّه تعالى قال في آية الحجاب مخاطباً الصحابة: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1)، فما هو الشيء الذي يريد اللَّه إبعاده من قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين، ولا يوجد عند بقية النساء وبقية الرجال إذا التقوا في المجالس والبيوت والتعليم، وما هو الشيء الذي يجده الصحابة تُجاه أمهاتهم أمهات المؤمنين، ولا يجدونه في بقية النساء، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم، فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة. وإذا كان الاختلاط منع منه من وُصفن بالأُمهات وزوجهن أولى بالمؤمنين من أنفسهم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (2) خوفاً على قلوب هؤلاء الأمهات، وقلوب أبنائهن، وهم خير الأجيال، فكيف بقلوب غيرهم رجالاً ونساءً. الوجه الخامس: أن اللَّه قال: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ} (3)، فجعل _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53. (2) سورة الأحزاب، الآية: 6. (3) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/690)
طهارة قلوب الصحابة مطلباً بذاتها، وهذا يحصل في جميع النساء، بل هو في غير أمهات المؤمنين أكثر؛ لأن نظر الصحابة لأمهات المؤمنين نظر إجلال وتعظيم وتوقير. الوجه السادس: أن الصحابيات اعتدن على تتبع أمهات المؤمنين فما فعلنه يرينه تشريعاً لهن من باب أولى، كما جاء في البخاري ومسلم عن عمر أن زوجته هجرته، فقالت له محتجة بأمهات المؤمنين: «ما تنكر فو اللَّه إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» (1). الوجه السابع: أن اللَّه يُخصص في بعض السياقات الأنبياء والصحابة تنبيهاً إلى دخول غيرهم من باب أولى في الحكم، وهذا أسلوبٌ شرعي كثير في الأحكام تنبيهاً إلى أنه لما دخل الأعظم والأجل فغيره أولى؛ لهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في بيان الحدود: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (2)، وقال في تحريم الربا: «أول ربا أضع ربا عمي العباس» (3)، وقال في تحريم دماء الجاهلية: «أول دم أضع دم ابن ربيعة بن عبد الحارث بن عبد المطلب» (4)، وربيعة ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -. _________ (1) البخاري، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، برقم 5191، ومسلم، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ... برقم 1479. (2) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، برقم 3475، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم 1688. (3) مسلم، كتاب الاعتكاف، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1218. (4) مسلم، كتاب الاعتكاف، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1218.
(1/691)
الوجه الثامن: لو قلنا بالخصوصية، فخصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - من باب أولى في المواضع التي يتوجه الخطاب إليه، لمزية له ليست في أحد من الأتباع، فالآيات التي يُخاطب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - عامة له ولغيره، مع كون الخطاب خاصاً به ليس بمشتركٍ بالمقابلة مع المؤمنين كما هنا: {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1). فهل الدخول في البيوت بلا استئذان جائز لخصوصية النص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - هنا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} (2). وهل السراح والطلاق يُمنع لخصوصية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - به في القرآن: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (3). وهل من تريد اللَّه ورسوله من النساء لا تدخل في استحقاق الأجر العظيم؟ كما جاء في سياق نفس آيات الحجاب الموجهة لأمهات المؤمنين: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (4). الوجه التاسع: دفع فهم الخصوصية في آيات الحجاب غير _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53. (3) سورة الأحزاب، الآية: 28. (4) سورة الأحزاب، الآية: 29.
(1/692)
واحد من مفسري السلف كما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة قال: «لما ذكر اللَّه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل نساء المسلمات عليهن فقلن: ذُكرتن ولم نذكر، ولو كان فينا خير ذكرنا، فأنزل اللَّه: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (1) (2). الوجه العاشر: أن المفسرين يطبقون على هذا الأمر على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، قال الجصاص الحنفي: «وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره» (3). وقال القرطبي المالكي (4): «في هذه الآية دليل على أن اللَّه تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى». وإلى هذا نص ابن جرير، وابن كثير، وأئمة التفسير. الوجه الحادي عشر: سبب تخصيص أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لمزيد تشديد عليهن؛ لأن أمرهن يمس النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمعلوم أن حفظ العرض يُقّدم في بعض الأحوال على حفظ الدين اهتماماً به، فيسوغ أن تكون زوجة نبي من أنبياء اللَّه كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح، لكن لا _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 35. (2) طبقات ابن سعد، 8/ 200، وعبد الرزاق، 3/ 574، وتفسير الطبري، 20/ 269، وعند الترمذي، برقم 3022، وغيره عن مجاهد، عن أم سلمة، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم 2565. (3) أحكام القرآن، للجصاص، 5/ 242. (4) تفسير القرطبي، 14/ 227.
(1/693)
يُمكن أن تقع في الزنا، واللَّه يعصمهن من ذلك؛ لأن الزنا أذيته مُتعدية للزوج وعرضه، فمن يبقى مع زانية وهو عالم ديُّوث في الشرع، بخلاف من يبقى مع كافرة؛ لهذا أجاز اللَّه زواج اليهودية والنصرانية بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (1)، وحرم نكاح الزانية ولو مؤمنه: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (2)، وقال: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ} (3)، وأًمهات المؤمنين قدوة والتشديد عليهن أولى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} (4) مع أن تحريم الفاحشة على جميع النساء، ولكن لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مزيد تشديد، وهو في: الحجاب، وفي الاختلاط، والفاحشه سواء، ولتمام عدل اللَّه ورحمته بهن فهن في باب الثواب أعظم من الصحابيات فضلاً عن نساء الأمة في الإثابة على العمل: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} (5). وحينما ذكر المضاعفة في العقاب والثواب دل على أن بقية النساء على إثم وثواب ولكن بلا مضاعفة. _________ (1) سورة المائدة، الآية: 5. (2) سورة النور، الآية: 3. (3) سورة النور، الآية: 26. (4) سورة الأحزاب، الآية: 30. (5) سورة الأحزاب، الآية: 31.
(1/694)
الوجه الثاني عشر: لو كانت الخصوصية في منع الاختلاط بأمهات المؤمنين، فمَن المَعني بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للنساء وسط الطريق» (1)، وبقوله: «خير صفوف النساء آخرها» (2) يعني البعيدة عن الرجال، ولماذا جعل النبي للنساء يوماً خاصاً يعلمهن العلم بعيداً عن مجالس الرجال كما تقدم (3). الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم: لم نجد تحريم الاختلاط في القرآن. هذه الشبهة تذكرنا بقصة امرأة في عصر السلف جرت بينها وبين عبد اللَّه بن مسعود، قال عبد اللَّه: «لعن اللَّه الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق اللَّه» (4)، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: «إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت؟! فقال: وما لي [لا] ألعن من لعن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ومن هو في كتاب اللَّه، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول!. قال: لئن كنت قرأتيه لقد _________ (1) صحيح ابن حبان، برقم5601، والبيهقي في شعب الإيمان، 10/ 241، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 856، وتقدم تخريجه. (2) صحيح مسلم، برقم 440، وتقدم تخريجه. (3) الاختلاط لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي، ص 43 - 79 بتصرف. (4) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، برقم 4886، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة .... ، برقم 2125.
(1/695)
وجدتيه، أما قرأت: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1)؟! قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم ترَ من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها» (2). فالسنة النبوية وحي من عند اللَّه؛ لأن اللَّه أنزل على رسوله القرآن والسنة، وهذا مذكور في القرآن بكثرة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (3). وقوله تعالى: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (4). وقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (5). فالحكمة في هذه الآيات هي السنة، فالمُفَرِّقُ بين القرآن والسنة داخل في قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} (6)، فحذار من سلوك هذا الطريق؛ فإنه طريق الزائغين عن _________ (1) سورة الحشر، الآية: 7. (2) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، برقم (4886)، واللفظ له، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ... برقم (2125). (3) سورة النساء، الآية: 113. (4) سورة البقرة، الآية: 129. (5) سورة الأحزاب، الآية: 34. (6) سورة البقرة، الآية: 85.
(1/696)
الحق، المتبعين أهواءهم!!. فإن الاختلاط محرم في السنة النبوية كما تقدم ذكر الأدلة على ذلك، فيكون مما أمر به القرآن. الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومداواتهن الجرحى: مثل حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم» (1). وعنه أيضاً قال: «كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى» (2) .. وعن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: غزوت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى» (3). وعن يزيد بن هرمز «أن نجدة [بن عامر، من زعماء الخوارج] كتب _________ (1) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، برقم 2880، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء مع الرجال، برقم 1811. (2) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء مع الرجال، برقم 1810. (3) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء مع الرجال، برقم 1812.
(1/697)
إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد: فأخبرني هل كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟! وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة ... » (1). والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول: العلماء مجمعون على أن المرأة ليس عليها جهاد، قال ابن حزم: «واتفقوا أن لا جهاد فرضاً على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد» (2). وقال محمد بن عيسى بن أصبغ: «واتفقوا كذلك أن المرأة ومن لم يبلغ، والمريض الذي لا يستطيع القتال لا جهاد فرضاً عليه» (3). وقال أبومحمد المقدسي: «ولا يسهم لامرأة، ولاصبي، ولا مملوك؛ لأنهم من غير أهل القتال، ويرضخ لهم دون السهم» (4). قلت: والأدلة على عدم فرضية الجهاد على المرأة كثيرة، وأصلها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: «لكن أفضل الجهاد حج _________ (1) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء مع الرجال، برقم 1812. (2) مراتب الإجماع، ص 201. (3) نقلاً من كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 707. (4) الكافي، 5/ 524.
(1/698)
مبرور» (1). قال العلامة بكر بن عبد اللَّه أبوزيد - رحمه الله -: «لم يعقد راية لامرأة قط في الجهاد، وكذلك الخلفاء بعده، ولا انتدبت امرأة لقتال، ولا لمهمة حربية، بل إن الاستنصار بالنساء، والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة، واختلال تصوراتها. وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول اللَّه، تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث؟! فأنزل اللَّه: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (2)» (3). قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديت: «وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين - في عصرنا- الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، فيخرجون المرأة عن خدرها، وعن صونها وسترها الذي أمر اللَّه به، فيدخلونها في نظام الجند، عارية الأذرع والأفخاذ، بارزة المقدمة والمؤخرة، متهتكة فاجرة، يرمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية، تشبهاً بفجور اليهود والإفرنج، عليهم لعائن اللَّه المتتابعة إلى يوم _________ (1) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، برقم 2784. (2) سورة النساء، الآية: 32. (3) رواه أحمد، 44/ 320، برقم 26736، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، برقم 3022، وأبو يعلى، 12/ 393، والحاكم، وغيرهم بسند صحيح حيث صححه الحاكم، 2/ 306، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وانظر: حراسة الفضيلة، ص 55 - 56.
(1/699)
القيامة» (1). فإذا عُلِمَ أن المرأة لم يفرض عليها الجهاد في سبيل اللَّه، وإن كانت ذات شجاعة، عُلِمَ أن خروج النساء في الغزو ليس فيه اختلاط بالرجال؛ لأنهن لا يقاتلن معهم. فكل الأحاديث الواردة في خروج النساء في الغزو وفي الجهاد في سبيل اللَّه لا يراد بها القتال مع الرجال. الوجه الثاني: دلت الأحاديث على جواز خروج النساء في الغزو، ولكن هذا الخروج له ضوابط، قال ابن عبد البر: «وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيراً يؤمن عليه الغلبة» (2). فقوله: «مباح» دليل على أنه ليس سنة، وقوله: «إذا كان العسكر كبيراً يؤمن عليه الغلبة» مفيد على أن خروجهن حسب المصلحة، وخروج المحرم لا بد منه، فإن لم يوجد لها محرم، فلا خروج. ومن الضوابط أيضاً: أن كثيراً من العلماء نصُّوا على أن الخارجات من كبيرات السن، وكرهوا خروج الشابات. وهذا واضح؛ لأن الخارجات في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الغالب كُنَّ كبيرات في السن، كأمِّ سليم وأم عطية وغيرهما. وأما عمل الخارجات في الغزو: فسقي القوم، ومداواة المرضى _________ (1) عمدة التفسير، لأحمد شاكر، 3/ 157. حراسة الفضيلة، ص 55 - 56. (2) التمهيد، 19/ 266.
(1/700)
ورد الجرحى والقتلى، كما دلت الأحاديث السابقة على هذا. وهذا لا يلزم فيه الاختلاط بغير محارمهن، قال النووي: «وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِخْتِلَاط النِّسَاء فِي الْغَزْو بِرِجَالِهِنَّ فِي حَال الْقِتَال؛ لِسَقْيِ الْمَاء وَنَحْوه» (1). وإن حصل شيء من الاختلاط فلضرورة. قال القرطبي في: «ويسقين الماء؛ أي: تحملنه على ظهورهن، فيضعنه بقرب الرجال، فيتناوله الرجال بأيديهم فيشربوه» (2). وإن حصل شيء من الاختلاط فلضرورة ذلك الحال، قال ابن حجر: «وفِيهِ جَوازُ مُعالَجَة المَرأَة الأَجنَبِيَّة الرَّجُل الأَجنَبِيّ لِلضَّرُورَةِ. قالَ ابن بَطّال: ويَختَصُّ ذَلِكَ بِذَوات المَحارِمِ ثُمَّ بِالمُتَجالاَّتِ مِنهُنَّ ... فَإِن دَعَت الضَّرُورَة لِغَيرِ المُتَجالاَّتِ، فَليَكُن بِغَيرِ مُباشَرَةٍ ولا مَسٍّ» (3). فاتضح مما سبق أن خروج النساء في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة للغزو في سبيل اللَّه ليس فيه اختلاطهن بالرجال، إلا ما قد يضطر إلى ذلك. ولا حجة لمبيحي الاختلاط في الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، فكيف يحتج بهذه الأحاديث لتبرير المؤامرة الدولية على المرأة المسلمة لإقحامها في فتن الاختلاط والتبرج وغير ذلك؟! وكيف يحتج بها _________ (1) شرح مسلم للنووي، 12/ 190. (2) المفهم شرح صحيح مسلم، 3/ 684. (3) فتح الباري، 6/ 94.
(1/701)
دعاة الاختلاط للمتاجرة بالمرأة؟! وكيف يحتج بها مفسدو العالم على الاختلاط بالشابات المتبرجات؟! وكيف يحتج مروجو الفتن على الخلوة بالمرأة وسفرها بدون محرم وغير ذلك؟! فليربؤوا بأنفسهم عن سلوك هذا الطريق في الاستدلال. الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ في غزوة حنين مرادهم أنها مختلطة بالمسلمين تقاتل الكفار، والجواب عن هذه الشبهة يتضح بإيراد الحديث. عن أنس - رضي الله عنه - أن أم سليم اصطحبت معها خنجراً؛ لتدافع عن نفسها إذا اعتدى عليها مشرك (1). فليس فيه أنها مختلطة بالصحابة في قتال ولا في غيره؛ ولهذا شراح الحديث لم يذكروا أمر الاختلاط استنباطاً من هذا الحديث، وإنما استنبطوا منه أن المرأة المسلمة تقاتل دفاعاً عن نفسها. الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في أم عمارة: «ما التفتّ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني». هذه القصة رواها ابن سعد (2)، وفي سندها محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وإذا سقط الأصل وهو الصحة، سقط الفرع _________ (1) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى للقاتل، برقم 2718، وأحمد، 21/ 395، برقم 13/ 975، وابن حبان، 12/ 152، برقم 7158، وابن سعد، 8/ 425، والبزار، 2/ 286، برقم 6349، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 2361. (2) الطبقات الكبرى، 8/ 305.
(1/702)
وهو الاستدلال. الشبهة السادسة والعشرون: استدلالهم أن أسماء بنت يزيد شهدت اليرموك وقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها، وهذه القصة رواها سعيد بن منصور، وابن أبي عاصم، والطبراني (1). وفي سندها مهاجر مولى أسماء، وهو مقبول كما في «التقريب»، أي: عند المتابعة، ولا نعلم له متابعاً. ولو صحت لم يصح الاستدلال بها؛ لأنه لا يفهم من القصة أنها قاتلت مع الرجال وبحضرتهم، بل ظاهرها أنها قتلت السبعة المذكورين لما جاؤوا إلى خيمتها، أو اقتربوا منها. الشبهة السابعة والعشرون: استدلالهم بأن سمراء بنت نهيك وكانت تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف، فعن يحيى بن أبي سليم قال: «رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بنتَ نَهِيكٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -:عَلَيْهَا دِرْعٌ غَلِيظٌ، وَخِمَارٌ غَلِيظٌ، بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» (2). هذه القصة رواها الطبراني في الكبير، وهي ضعيفة؛ لأن يحيى بن _________ (1) سنن سعيد بن منصور، 6/ 372، برقم 2603، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، 6/ 128، برقم 3349، والطبراني في المعجم الكبير، 24/ 157، برقم 403، وهو عند أحمد، 45/ 541، برقم 27560، والقصة عند ابن عساكر، 2/ 101 منسوبة لأم حكيم بنت الحارث، 39/ 61 القصة عن أسماء بنت يزيد. (2) المعجم الكبير، للطبراني، 24/ 311، برقم 7805، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، 6/ 3369، وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 101: «سنده جيد».
(1/703)
أبي سُلَيم لا يعلم له سماع من سمراء بنت نهيك، بل لم يعاصرها، وإنما سمع منها أبو بلج الصغير واسمه جارية بن بلج، وهو مجهول، وقد حسن بعضهم هذه القصة بسبب حصول اشتباه بين أبي بلج يحيى بن سُليم، ويقال ابن أبي سليم، وبين أبي بلج جارية بن بلج، فظنوا أن الأول هو الثاني، وليس كذلك كما سبق. فالقصة ضعيفة من جهة سندها. وأيضاً يرد عليهم بما قاله فضل إلهي: «لم يرد فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - ولاها على حسبة السوق غاية ما في الأمر أنها كانت تقوم بالاحتساب في السوق، وقيام أحد بذلك في السوق، لا يدل على تعيينه والياً على حسبة السوق» (1). وأيضاً على فرض صحتها فالمرأة المذكورة كبيرة السن، ودعاة الاختلاط يبحثون عن الشابات، ويبحثون عمن تقبل الاختلاط، لا عمن تأتي لتحارب منكرات الاختلاط وغيرها، فلو كانت هذه المرأة حية لأدبت بسوطها أصحاب الاختلاط؛ لأنهم يتاجرون بالنساء، ويتخذونهن متعة رخيصة. الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر - رضي الله عنه - استعمل الشفاء على السوق، فقد روى ابن أبي عاصم (2) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر - رضي الله عنه -،استعمل الشفاء على السوق، ولا يعلم امرأة استعملها غير هذه. _________ (1) في كتابه مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 136. (2) في الآحاد والمثاني، 6/ 4، برقم 3179.
(1/704)
هذه القصة فيها علل: الأولى: ضعف ابن لهيعة. الثانية: الإرسال؛ لأن يزيد بن أبي حبيب لم يدرك عمر. وقد ضعفها العلماء، قال أبوبكر بن العربي المالكي: «وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَدَّمَ امْرَأَةً عَلَى حِسْبَةِ السُّوقِ، وَلَمْ يَصِحَّ; فَلَا تَلْتَفِتُوا إلَيْهِ; فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ دَسَائِسِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ» (1). والقصة أخرجها مالك، وعبد الرزاق، والبيهقي في الشعب بلفظ: «إن عمر مر على الشفاء، وكان بيتها بين المسجد والسوق» (2). وليس فيها أنه استعملها على السوق، وهي بهذا اللفظ صحيحة. وأخرجها عبد الرزاق مرة أخرى مرسلة، وفيها: «أن الشفاء بنت عبد اللَّه جاءت إلى عمر»، وليس فيها أن عمر استعملها. فالذي يتحرر مما سبق أن ذكر استعمال عمر لها، لا أساس له من الصحة؛ للعلل الواردة في القصة، ولطعن أهل العلم فيها؛ ولأن الرواية الصحيحة بدونها. وأيضاً نسبة القصة إلى عمر تخالف الحال الذي كان عليه عمر من غيرته على أعراض النساء؛ فهو الذي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يحجب نساءه، فوافق اللَّه عمر؛ فأنزل آية الحجاب. وأيضاً منع عمر النساء أن يختلطن بالرجال في موارد المياه، وفي الطواف، وغير ذلك، كما سبق ذكره (3). _________ (1) أحكام القرآن، 6/ 212. (2) الموطأ، برقم 317، وعبد الرزاق، 1/ 526، والبيهقي في الشعب، برقم 2617. (3) انظر: الاختلاط أصل الشر، ص 176 - 183 بتصرف.
(1/705)
الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم: إن مصطلح «الاختلاط» مصطلح حادث، لم يعرف في المعجم الإسلامي، ولم يرد في النصوص الشرعية. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنه جاء في السنة الإشارة إلى مصطلح (الاختلاط)، ومن ذلك حديث أبي أسيد الأنصاري - رضي الله عنه - «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ: فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلنِّسَاءِ «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ» (1). ففي هذا الحديث جاء ذكر «اختلاط النساء بالرجال»، وقد أنكره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عنه. وأثر ابن جريج قال: «أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ، أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ» (2). ففي هذا الأثر جاء ذكر «اختلاط الرجال بالنساء»، وأن عائشة _________ (1) سنن أبي داود، برقم 5272، وتقدم تخريجه. (2) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، برقم 1618.
(1/706)
- رضي الله عنها - تطوف دون الرجال. الوجه الثاني: أنه جاء في الآثار الإشارة إلى ما يرادف الاختلاط كـ (المزاحمة)، و (المدافعة)، ومن ذلك: ما روى منبوذ بن أبي سليمان، عن أمه «أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلاَةٌ لَهَا، فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لاَ آجَرَكِ اللَّهُ، لاَ آجَرَكِ اللَّهُ، تُدَافِعِينَ الرِّجَالَ، أَلاَ كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ» (1). وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أَمَا تَغَارُونَ أَنْ تَخْرُجَ نِسَاؤُكُمْ؟ .. أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَوْ تَغَارُونَ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ فِي الْأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ» (2). الوجه الثالث: أن مصطلح (الاختلاط) مشهور متداول عند عامة المفسرين والمحدثين والفقهاء، فقد تثبت أن هذا المصطلح معروف عند العلماء كافة، ومن قال إن مصطلح «الاختلاط» مصطلح حادث فهو إما جاهل، أو مغرض. ولا بد من القول هنا إنه لا يلزم من تحريم الأشياء ورود ذكرها لفظاً في الكتاب والسنة، بل قد تكون داخلة تحت الأصول والقواعد العامة للشريعة. _________ (1) مسند الشافعي، ص 127، والسنن الكبرى للبيهقي، 5/ 81، وأخبار مكة للفاكهي، 1/ 122. (2) مسند أحمد، 2/ 343، برقم 1118، وقال محققو المسند، 2/ 343: «إسناده ضعيف».
(1/707)
الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء حاصل في الطواف، فيدل ذلك على جوازه في أماكن العمل والتعليم. والجواب عن هذا من ستة أوجه: الوجه الأول: أن السنة دلت على أن طواف النساء من وراء الرجال، عن أم سلمة قالت: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} (1)» (2). قال ابن بطال: «وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح، قال غيره: طواف النساء من وراء الرجال هي السنة؛ لأن الطواف صلاة، ومن سنة النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال، فكذلك الطواف» (3). قال الزرقاني - رحمه الله -: «قوله: «فقال: طوفي من وراء الناس»؛ لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف» (4). الوجه الثاني: أن هذا من خصوصيات مكة بإجماع المُفسرين، _________ (1) سورة الطور، الآيتان: 1 - 2. (2) البخاري، برقم 1514، تقدم تخريجه. (3) شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 2/ 112 .. (4) شرح الزرقاني على الموطأ، 2/ 311.
(1/708)
قال تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} (1). فقد أخرج ابن أبي شيبة، والبيهقي، عن مجاهد قال: «إنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لأَنَّ النَّاسَ يَبُكَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِنَّهُ يَحِلَّ فِيهَا مَا لاَ يَحِلُّ فِي غَيْرِهَا» (2). وأخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، «عن عتبة بن قيس قال: إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالأنثى، قيل: عمن تروي هذا؟ قال: عن ابن عمر» (3). وعند البيهقي «عن قَتَادَةُ: مَنْ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لِيُشْرِكَ فِيهِ عَذَّبَهُ اللهُ، وَفِي قَوْلِهِ: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} (4)، قَالَ: «إِنَّ اللهَ بَكَّ بِهِ النَّاسَ جَمِيعًا فَتُصَلِّي النِّسَاءُ أَمَامَ الرِّجَالِ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ بِبَلَدٍ غَيْرِهِ» (5). وبنحوه قال سعيد بن جبير، وغيره (6). _________ (1) سورة آل عمران، الآية: 96. (2) مصنف بن أبي شيبة، 3/ 273، والبيهقي في شعب الإيمان، 3/ 445، وأخبار مكة للأزرقي، 1/ 396. (3) هكذا في الدر المنثور، 3/ 673، وفي مصنف بن أبي شيبة، 3/ 272، برقم 14127، دون قوله: قيل: عمن تروي .... (4) سورة آل عمران، الآية: 96. (5) تفسير ابن أبي حاتم، 3/ 709، شعب الإيمان، 5/ 466، وفي الدر المنثور، 3/ 673، عزاه لابن جرير، وعبد بن حميد، والبيهقي. (6) تفسير ابن أبي حاتم، 3/ 709.
(1/709)
بل يُعفى عن السُّترة في مكة، ولا يُعفى عن غيرها، فروى ابن جرير، «عن عطاء، عن أبي جعفر قال: مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت، فدفعها. قال أبو جعفر: إنها بَكَّةٌ، يبكّ بعضُها بعضًا» (1). وبقي الأمر على هذا قروناً طويلة، قال ابن جبير في رحلته (2) (578هـ): «وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنه الرخام حسناً، منها سود، وسمر، وبيض قد ألصق بعضها ببعض، واتسعت عن البيت بمقدار تسع خطاً إلا في الجهة التي تقابل المقام، فإنها امتدت إليه حتى أحاطت به، وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض، وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة». الوجه الثالث: أن عمل نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطواف من وراء الرجال، فعن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ. قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَالِ!. قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟. قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ!. قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ» (3). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قَوله: (وقَد طافَ نِساء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ _________ (1) تفسير ابن جرير، 6/ 24. (2) رحلة ابن جبير، ص 22. (3) البخاري، برقم 1539، تقدم تخريجه.
(1/710)
الرِّجال)؛ أَي: غَير مُختَلِطات بِهِنَّ ... قَوله: (حَجرَة) ... أَي: ناحِيَة» (1). وقال المهلب: «قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساء، يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم» (2). فهذا الأثر صريح الدلالة في أن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يطفن من وراء الرجال. الوجه الرابع: جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - ما يدل على إنكار الاختلاط بين الرجال والنساء في الطواف، فعَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: «نَهَى عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَطُوفَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَرَأَى رَجُلًا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ» (3). وعَنْ مَنْبُوذِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلاَةٌ لَهَا، فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لاَ آجَرَكِ اللَّهُ، لاَ آجَرَكِ اللَّهُ، تُدَافِعِينَ الرِّجَالَ! أَلاَ كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ؟ ّ» (4). الوجه الخامس: صرح جماعة من أهل العلم بإنكار اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، واعتبروا ذلك من المخالفات، قال ابن _________ (1) فتح الباري، 4/ 549. (2) شرح البخاري، لابن بطال، 4/ 298. (3) أخبار مكة، للفاكهي، 1/ 252. (4) مسند الشافعي، 1/ 127، السنن الكبرى للبيهقي، 5/ 81، أخبار مكة للفاكهي، 1/ 122.
(1/711)
جماعة الشافعي (ت 767هـ): «ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال، بل تكون في حاشية الطواف بحيث لا تزاحم الرجال، قياساً على الصلاة، فإنهن مأمورات بالتأخير عن صفوف الرجال، ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال، وكذلك لا يستحب لها الصلاة خلف المقام، أو غيره من المساجد مزاحمةً للرجال، ويستحب لها ذلك إذا لم تفض إلى مخالطة الرجال، وهذا مما لا يكاد يختلف فيه؛ لما يتوقع بسببه من الضرر ... ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم، سافرات عن وجوههن، وربما كان ذلك في الليل، وبأيديهم الشموع تقد» (1). الوجه السادس: ذكر الفاسي تبعاً للفاكهي أن من أعمال خالد القسري - أمير مكة في زمن التابعين - التي حمده الناس عليها قيامه بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف حيث أجلس عند كل ركن حرساً يفرقون بين الرجال والنساء (2). فمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في الطواف معروف في زمن السلف الصالح، وأثنى أهل العلم والفضل على من قام به من الأمراء. الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل والتعليم من التطور الاجتماعي والرقي العلمي، الذي لا غالب به. _________ (1) هداية السالك، 2/ 864 - 868. (2) العقد الثمين، الفاسي، 4/ 15 - 16.
(1/712)
والجواب عن هذه الشبهة أن يُقال: «ليس هناك تطور يعرض للاجتماع نفسه، وإنما تطور الاجتماع أثر أفكار وأذواق وميول نفسية، ورقي هذا التطور أو انحطاطه يرجع إلى حال تلك الأفكار والأذواق والميول، فإن غلب على الناس جودة الفكر وسلامة الذوق وطهارة ميولهم النفسية، كان التطور الاجتماعي راقياً، وهذا هو الذي لا تنبغي معارضته، ويصحّ أن يقال فيه: إنه تطور لا غالب له، أما إذا غلب على الناس انحراف الأفكار في تصور الشؤون الاجتماعية، أو تغلبت أهواؤهم على عقولهم، كان التطور الاجتماعي في انحطاط، وهذا هو الذي تجب معارضته، وأقل دعوة تقوم لإصلاحه يمكنها أن تقوّم عوجه، وترد جماحه، وإذا كان اختلاط الجنسين من قبيل التطور الاجتماعي، فهو من نوع ما ينشأ عن تغلب الأهواء، وتقليد الغربيين في غير مصلحة، فيتعين على دعاة الإصلاح أن يجهروا بإنكاره، ويعملوا على تنقية المجتمع من أقذائه، ومتى قويت عزائمهم، وجاهدوه من طرقه الحكيمة أماطوا أذاه، وغلبوا على أمره» (1). الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص الشرعية على جواز اختلاط الرجال بالنساء، كخروج النساء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - للجهاد. والجواب عن هذا أن يقال: «أنه قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط _________ (1) محاضرات إسلامية، الشيخ محمد الخضر حسين، ص 197.
(1/713)
ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نوَّر اللَّه قلبه، وتفقه في دين اللَّه، وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض, ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بعض الغزوات, والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد؛ لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن، وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته، بخلاف حال الكثير من نساء العصر, ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الغزو، فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق، وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا, وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم, وأقرب إلى التطبيق العملي بكتاب اللَّه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؟ فما هو الذي نُقِلَ عنهم على مدار الزمن؟ هل وسَّعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط، فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها، وتختلط معهم، ويختلطون معها، أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟» (1). _________ (1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 1/ 423.
(1/714)
المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب
أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً - رحمه الله -: السؤال الرابع: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟ [من الفتوى رقم 2640] الجواب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت (1)، والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك؛ فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم؛ فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل. أما المجمل: فهو أن اللَّه تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين؛ فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول _________ (1) الحوانيت: جمع حانوت، وهو الدكان. المصباح المنير، مادة (دكة).
(1/715)
الغرض السيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه؛ فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سدَّ الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فستة: الدليل الأول: قال تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (1). وجه الدلالة: أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف - عليه السلام - ظهر منها ما كان كامناً، فطلبت منه أن يوافقها، ولكن أدركه اللَّه برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (2)، وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. _________ (1) سورة يوسف، الآية: 23 .. (2) سورة يوسف، الآية: 34.
(1/716)
الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية (1). وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بيَّن تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفُ الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ» (2)، قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر اللَّه بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه _________ (1) سورة النور، الآيتان: 30 - 31. قلت: وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسف، بخلاف سورة النور فلا يقرؤونها، وقد قال بعض السلف: ما حصلناه في سورة يوسف أنفقناه في سورة النور. والعجب الثاني قراءة صدر سورة مريم دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسى، ونفي الولد، والأمر بعبادة اللَّه، واختلاف الأحزاب في عيسى ... إلخ. وبعض يخص السور أو الآيات ببعض المساجد، وبعض يقرأ آيات الرحمة دون غيرها، وهكذا بعض لا يقرأ الآيات التي تذم بعض الأشخاص إذا كان من بلده ... (2) أخرجه أحمد، 38/ 95، برقم 22991، وبرقم 2149، والترمذي، برقم 2777، والحاكم، 2/ 194، برقم 2788، وحسنه الألباني، وتقدم تخريجه.
(1/717)
زناً، فروى أبو هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا» (1) متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، ومؤدٍّ إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها، فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة، وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر، والسعي إلى ما هو أسوأ منه. الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها؛ لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط. الدليل الرابع: قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (2). وجه الدلالة: أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزاً في نفسه، لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط _________ (1) البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2657، وتقدم تخريجه. (2) سورة النور، الآية: 31.
(1/718)
يمنع لما يؤدي إليه من الفساد. الدليل الخامس: قوله تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (1)، فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها فزنى بها. وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط. الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (2). وجه الدلالة: أن اللَّه أمر أزواج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين؛ لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق، على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء، وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج _________ (1) سورة النور، غافر: 19. (2) سورة الأحزاب، الآية: 33.
(1/719)
والسفور عند الرجال الأجانب، والتعرّي عندهم، وقلَّ الوازع عن من أُنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم. وأما الأدلة من السنة؛ فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة: الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي - رضي الله عنهما - أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه، إني أحب الصلاة معك؟! قال: «قد علمتُ أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت واللَّه تصلي فيه حتى ماتت» (1). وروى ابن خزيمة في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ صَلاَةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً» (2). وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة _________ (1) أخرجه أحمد، برقم 27090، وابن حبان، برقم 2217، وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 82، برقم 340، وتقدم تخريجه. (2) صحيح ابن خزيمة، 3/ 95، برقم 1691، والبيهقي في الكبرى، 3/ 131، وحسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 77، برقم 948.
(1/720)
في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها، وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى. الثاني: ما رواه مسلم، والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (1)، قال الترمذي بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح». وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدةٍ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر، والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخِّرات عن الرجال عن مخالطتهم، ورؤيتهم، وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم، وسماع كلامهم، وذمَّ أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم، والقرب من الإمام، وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال، وربما أُفسدت به العبادة، وشوشن النية والخشوع؛ فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة، مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع _________ (1) صحيح مسلم، برقم 440، تقدم تخريجه.
(1/721)
الاختلاط من باب أولى. الثالث: روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنها - قال: قال لنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيباً» (1). وروى أبو داود في سننه، والإمام أحمد، والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرجن وهن تَفِلات» (2). قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه، كحسن الملبس، والحلي الذي يظهر أثره، والهيئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات. الرابع: روى أُسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (3) رواه البخاري، ومسلم. _________ (1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم 443. (2) أخرجه مسلم، برقم 442، أحمد، برقم 9645، وأبو داود، برقم 565، تقدم تخريجه. (3) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، تقدم تخريجه.
(1/722)
وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. الخامس: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (1) رواه مسلم. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز. السادس: روى أبو داود في السنن، والبخاري في الكنى بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء: «اسْتَأْخِرْنَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ» (2). هذا لفظ أبي داود. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «يحققن الطريق: أن يركبن حقها وهو وسطها» (3). _________ (1) مسلم، برقم 2742، تقدم تخريجه. (2) سنن أبي داود، برقم 5272، تقدم تخريجه. (3) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، 1/ 68، مادة (حقّ).
(1/723)
وجه الدلالة: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟! السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال: «لاَ يَلِجُ مِنْ هَذا البَابِ مِنَ الرِّجَال أحَدٌ» (1)، وروى البخاري في التاريخ الكبير له، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَدْخُلُوا المسجِدَ مِنْ بَابِ النِّسَاء» (2). وجه الدلالة: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولاً، وخروجاً، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سداً لذريعة الاختلاط، فإذا مُنِعَ الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى. الثامن: روى البخاري في صحيحه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا» (3)، وفي رواية ثانية: «كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ _________ (1) أخرجه الطيالسي، 3/ 368، وأبو نعيم في الحلية، 1/ 313. (2) ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، 12/ 964، وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير. (3) البخاري، برقم: 837، وتقدم تخريجه.
(1/724)
فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» (1)، وفي رواية ثالثة: «كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ» (2). وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع. الدليل العاشر: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ» (3)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح»، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رجاله ثقات». وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ، أَوْ حَمْأَةٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ» (4). وجه الدلالة من الحديثين: أنه - صلى الله عليه وسلم - منع مماسة الرجل للمرأة _________ (1) البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام، برقم: 866. (2) البخاري، برقم 866. (3) رواه الروياني في مسنده، برقم 1270، والطبراني في الكبير، برقم 486، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 226، وتقدم تخريجه. (4) المعجم الكبير للطبراني، 8/ 205، برقم 7830، وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، 2/ 2: «ضعيف جداً».
(1/725)
بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها؛ لما في ذلك من الأثر السيئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة، إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة؛ ولهذا منعه الشارع؛ حسماً لمادة الفساد. ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة، وتشتد الحاجة إليه، ويكون في مواضع العبادة، كما يقع في الحرم المكي، والحرم المدني. نسأل اللَّه تعالى أن يهدي ضالَّ المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هُدىً، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات، وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب. وصلى اللَّه على محمد، وآله، وصحبه. مفتي الديار السعودية (ص- ف 1118 في 14 - 5 - 1388هـ) (2641 - منع اختلاط النساء السافرات بالرجال) جلالة الملك المعظم ... أيده اللَّه حفظ اللَّه جلالتكم: بلغني أن بعض المهندسين الأجانب الذين يُجْلَبون إلى نجد تبعاً لبعض المصالح يطالبون بمجيء نسائهم معهم. ولا يخفى على جلالتكم أن وجود نساء النصارى في المملكة مفسدة كبرى. أولاً: لفسادهن وخبثهن. ثانياً: لا وجه لإجبارهن
(1/726)
على الغطا لكونهن غير مسلمات، ولو كن من مدعيات الإسلام وجب إجبارهن على التغطي التزاماً لما يدَّعينه من الإسلام. ونشوء المسلمين من ذكر وأنثى محتاجون إلى إبعاد جميع أسباب الشر عنهم، وتأثير الخلطة أمر معلوم، أعزكم اللَّه وأعز بكم دينه. (ص-م 348 في 9 - 3 - 75هـ) محمد بن إبراهيم (1) (2642 - منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ... وبعد نرفع لسموكم برفقه المكاتبة الواردة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الظهران برقم (بدون) في 2 - 1 - 1380هـ المعطوفة على ما رفعه له رئيس محكمة الخبر برقم 2249، وتاريخ 4 - 1 - 1380هـ حول ما لاحظه في مدينة الخبر من خروج النساء الأجنبيات في شوارعها سافرات متبرجات كاشفات الوجوه والرؤوس، باديات السيقان والأذرع. ولا يخفى سموكم ما في ذلك من الفساد والفتنة للرجال، مع أن ذلك وسيلة كبرى لاقتداء _________ (1) وتقدم في فتوى برقم 1278/ 1 في 13/ 5/85هـ في (توحيد الإلهية) حكم اختلاط النساء بالرجال، وحضور المرأة مجالس الرجال، برقم 3559/ 1، في 26/ 11/86هـ، في كتاب الجهاد، وفتوى في صلاة الجماعة، برقم 204/ 3/1، في 12/ 8/87هـ.
(1/727)
المسلمين بهن، والتزين بزينتهن كما هو الواقع، وكما أشار إلى ذلك قاضي الظهران بحيث تعذر التمييز بينهن. والذي يتعين في مثل هذا غيرة للَّه ولدينه، وقياماً لواجب الرعية التي ولاّكم اللَّه عليها هو العمل على حسم أسباب الفساد، وتدهور الأخلاق بمنع أولئك النساء من الخروج سافرات متبرجات، لا سيما والمعروف أن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أخذ التعهد عليه بالخضوع لتعاليم البلاد المعمول بها فيها، وأملنا وطيد في أن تولوا هذا الأمر الخطير ما يستحقه من العناية والاهتمام التام، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «كُلَّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (1). حفظكم الله ونصر بكم الحق وأهله أينما كان والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ف 147 في 24 - 2 - 1380هـ) (2643 - خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ... وبعد فإنه اتصل بعلمي بأنه يحصل للنساء مزاحمة من بعض الرجال في «حديقة الحيوانات» في اليوم المخصص للنساء، وأن بعض _________ (1) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم 893.
(1/728)
الناس يخرج إلى هناك لهذا الغرض، وللنظر إلى النساء المتفرجات. وتعلمون سموكم خطر هذا الأمر على فساد الأخلاق، وقد يحدث ما بين حين وآخر من جرائها ما لا تحمد عقباه؛ لذا نرجو أن يتخذ سموكم الإجراءات الإيجابية الحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والتي يظهر أثرها لدى المتحمسين للخير المنكرين لهذه الشرور وأمثالها. وفقكم اللَّه والسلام عليكم. (ص-م 1240 في 17 - 3 - 1384هـ) (2644 - اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... بمنطقة نجد وتوابعها المحترم السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد: فقد اتصل بعلمنا أنه يحصل في أسواق الأقمشة اختلاط سفلة الرجال بالنساء، ومتابعتهم لهن، ومحاولة معاكستهن، أو للحصول منهن على وعد أو موافقة. وحيث إن هذا الأمر مبدأ خطير، وله ما بعده إذا حصل التساهل، لذا نأمل أن تهتموا بهذا الأمر، وتوصوا مركز الهيئة في السوق بملاحظة ذلك بدقة، واستمرار الملاحظة، وفقنا اللَّه وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة اللَّه. (ص-م 1241 - دوسية 76 - 14)
(1/729)
(2645 - حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس مدارس البنات المحترم السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ... وبعد كتب لنا بعض المطلعين من مكة يقول: إنه لاحظ وضع مكتب في فناء مدرسة البنات يجلس عليه ثلاثة رجال من موظفي المحاسبة، وتأتي المدرسات فيجتمعن حولهم على هذا المكتب ليوقعن على مسيرات الرواتب، ويستملن استحقاقهن. وذكر أن بعض أولياء أمور المدرسات طلب تسليم راتبها إليه بعد توقيعها على المسيرات، وبموجب وكالة منها، فلم يحصل، بل أصروا على حضورها بنفسها، واستلامها الراتب. وقصده بذلك يستفتي عن حكم اختلاط هؤلاء الثلاثة الرجال بالمدرسات على الصفة التي ذكرها. وقد لفت نظرنا هذا، ورأينا تنبيهكم عليه لتقوموا حوله بما يلزم، وتخبرونا بالحقيقة. والسلام عليكم. (ص-م 3130 في 14 - 11 - 1385هـ) (1646 - جواب عن شبهات دعاة السفور) أحاديث نظر الفجأة مع أحاديث إباحة النظر إلى المخطوبة تفيد المنع من السفور، فإنه قد اغتر به من اغتر، ومفسدته أكبر المفاسد، وحاصله أن زوجها يستمتع بمقدار، وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه، فلا بقي إلا الفرج.
(1/730)
الرجل الذي يرضى أن يتفكه بزوجته ديوث. وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم، وإلاَّ فهي من أوضح شيء، ولكن الهوى يعمي ويصم، وقصة صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل استدلوا بها، ولا دليل فيها، إذ لا يفيد أنها كاشفة وجهها، فإنه قد يدرك شيء مع تغطية الوجه، خصوصاً الأعراب، فإنهم قد لا يكملون التستر. وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة، وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى الفاحشة. وأيضاً من يقول: إن الرجل يصرف وجهه عنها؟ ما يَحصلْ، بل وجهه في وجهها، ونظره في نظرها. من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم، والمرأة لها السفور؟! ولا يمكن صرف وجوههم، فالنظر واقع، والمفسدة لا محالة، فيكون فيه المنع من السفور. (تقرير) (2647 - س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور؟) ج: يريد أن يطلب زكاماً فيحدث جذاماً. ... (تقرير) (2648 - القبلة) أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز.
(1/731)
والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب الشهوة؟ فأجاب بالجواز. ولكنها كذب، وقد فندها تلميذه في «روضة المحبين» (1). (2649 - مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... ... الموقر السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد: حفظك اللَّه - اتصل بعلمي أنه يوجد في السوق «بالمقيبرة» نساء يبعن البيض مقدار خمس نساء، وهن نساء فاتنات للرجال؛ لجمالهن، وتبرجهن بالملابس والحلي، ويصافحن الرجال بأيديهن، وأنه يشاهد بعض سفلة الرجال يجلسون إليهن، ويتكلمون معهن، وحيث إن ذلك منكر ظاهر، فإنا نأمل منعهن من هذه المهنة، ولا يسمح أن يتولى ذلك إلا رجال، أو نساء عجائز ليس فيهن شبهة ما دمن بهذه الحالة، قوّاكم اللَّه في الحق، وأخذ بيدكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة اللَّه. _________ (1) ص129 - 231. قال ابن القيم: «وأما الفتوى التي حكيتموها فكذب عليه، لا تناسب كلامه بوجه، ولولا الإطاله لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لاتصدر عمن هو دونه فضلاً عنه، وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماً، وهي بخط رجل متهم بالكذب. ا. هـ.
(1/732)
(ص-م 1244 في 17 - 3 - 84هـ) (2650 - الواجب في مسألة الاختلاط) وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التي ذكرتها (1)، فهذا من أكبر المنكرات التي يتعين إنكارها على الجميع، كما يجب على كل فرد أن يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة، وفي الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (2)، وهذه المسائل تحتاج إلى موالات النصائح، وبذل الجد في تحذير الناس من مغبتها. وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلك، والاستعانة بذوي السلطة وأصحاب النفوذ لعل اللَّه أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم (3). (ص-ف 1278 - 1 في 13 - 5 - 1385) _________ (1) في السؤال - وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج، وعند القدوم من السفر، وعند حفل الولادة، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال). (2) البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتلقى من شؤم المرأة برقم 5096، ومسلم، كتاب العلم، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، برقم 2740. (3) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 35 - 50.
(1/733)
ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء قرار رقم (172) وتاريخ 20/ 8/1412 الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وآله وصحبه، وبعد: فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة والثلاثين المنعقدة في الرياض في المدة من 12/ 8/1412هـ إلى 20/ 8/1412هـ، اطَّلَع على كتاب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (498/ 1س) وتاريخ 27/ 11/1411هـ، حول ما لُوحظ من نشاطِ الصحف في الكلام حولَ توظيف النساء بأساليب مختلفة. كما اطَّلَعَ المجلسُ على الكتاب الصادر من المقام السامي برقم (2966/م) وتاريخ 19/ 9/1404هـ، الموجَّه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، والْمُعطَى نسخة منه لكلِّ وزارة ومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، وفيه الإشارة إلى الأمر التعميمي رقم (11651) وتاريخ 16/ 5/1403هـ، الْمُتضَمِّن أنَّ السماحَ للمرأة بالعمل الذي يُؤدِّي إلى اختلاطها بالرِّجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمرٌ غيرُ مُمكن، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأنَّ ذلك
(1/734)
مُحرَّمٌ شرعاً، ويتنافى معَ عادات وتقاليد هذه البلاد, وفيه: (نرغب إليكم إبلاغ المسؤولين لديكم بالتقيُّد بما قضى به الأمر التعميمي الْمُشار إليه وإبلاغه للجهات المختصَّة، والشركات المتعاقدة معكم للتقيُّد بموجبه وملاحظة ذلك بكلِّ دقَّة، وقد زُوِّدَت جميع الجهات الحكومية بنسخة منه للاعتماد، وإبلاغ الجهات المختصة بها والشركات والمؤسسات المتعاقدة بالتقيُّد به واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل المرأة خلافاً لِما تضمَّنه الأمر الْمُشار إليه، وتصحيح ما هو موجود من ذلك بما يتَّفق معه، فأكملوا ما يلزم بموجبه).ا. هـ. وبناءً على ذلك، وعلى كثرة الشكاوى من المواطنين حول مُخالطة النساء للرِّجال في العمل، وما يترتَّب على توظيف النساء في المجالات التي يُمكن أن يقوم بها الرِّجال من العزوف عن الزواج وتعطيل البيوت، وإهمال الأولاد، والاضطرار إلى استقدام الخادمات من المفاسد العظيمة - قرَّر المجلس ما يلي: 1) وجوب منع توظيف النساء فيما يقتضي اختلاطهنَّ مع الرِّجال. 2) اقتصار توظيفهنَّ على ما يختصُّ بهنَّ كالعمل في مدارس ومعاهد وكليات النساء، والطب والتمريض والصيدلة النسائية. 3) العناية بمناهج تعليم النساء، وإبعاد المواد التي تستدعي دراستها العمل في ميدان الرِّجال.
(1/735)
4) منع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من نشر ما يدعو إلى توظيفهنَّ في غير مجال العمل النسوي، أو التشجيع على هذا بأي وسيلة كانت لمخالفة ذلك لِما تقتضيه الشريعة المطهرة. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه. هيئة كبار العلماء (1) _________ (1) انظر: حكم قيادة المرأة للسيارة، للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري، ص 117 - 119.
(1/736)
ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 1 - الاختلاط في الدراسة: السؤال الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون من الفتوى رقم (12087) س 38: هل تجوز الدراسة المختلطة؟ ج 38: اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة، وإثارة الشهوة، ووقوع الفاحشة، ويتضاعف الإثم ويعظم الجرم إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئا من عوراتهن، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن، أو داعبن الطلاب أو المدرسين ومازحن معهم، أو غير ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض. س 39: هل يجوز حضور النساء إلى المسجد سافرات الوجوه بلا ستر (فاصل)؟ ج 39: يحرم عليهن الحضور إلى المساجد متبرجات؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، أما المرأة المتحجبة التي لا تتعاطى أسباب الفتنة فلا مانع من حضورها المسجد، وبيتها خير لها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/737)
السؤال الأول من الفتوى رقم (7484) [2 - اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتنة] س1: يوجد بعض المجتمعات، خصوصاً في جهات الجنوب، يحصل بينهم اختلاط الرجال بالنساء، وبغير غطاء شرعي، ويحصل أحياناً الخلوة بين الرجل وامرأة ليست له محرم، وإذا نصحوا من هذا لا ينتصحون، بل يقولون: قلوبنا طاهرة، وإذا قيل لهم: إن هذا الأمر أُمر به الصحابة، وقلوبهم أطهر من قلوبكم، لا يتعظوا بهذا، ويحاولون التملص من الحجة بأعذار واهية. فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر، ومن تقع عليه المسؤولية تجاه هذا الأمر، وهل يجب على المرأة أنها تطبق الحجاب، وتمتنع عن الاختلاط، حتى ولو لم يأمرها وليها، أو زوجها بذلك، وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمر، وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم، ويمتنع عن الخلوة بالنساء غير المحارم، حتى ولو كان قلبه نظيفاً كما يزعم؟ ج1: كشف العورة حرام، سواء كان من رجل أم امرأة، واختلاط الرجال بالنساء اختلاطاً يثير الفتنة، ويكون ذريعة للفساد حرام، وخلوة المرأة بغير محرمها، وزوجها حرام، وعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يصون عرضه، ويلتزم بشريعة ربه، وعلى ولي الأمر الخاص والعام أن يأخذ على أيدي السفهاء، ويعزر من يتجاوز شرع اللَّه وحدوده وآدابه. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/738)
السؤال الأول من الفتوى رقم (10937) س1: نعيش على أرض جزيرة، وهي منطقة سياحية، وإذا دخلها الناس الأجانب خلعوا ثيابهم، إلا ما يواري سوآتهم، ويدخلون المتاجر على هذه الهيئة. فهل يجوز للمرأة المسلمة العمل بالمتجر منفردة أو مع زوجها؟ أجبت على هذا السؤال بعدم الجواز صيانة للمرأة عن هذا المجتمع الفاجر والظالم، وأن تبقى في خدرها خير لها واللَّه أعلم. قالوا: إنما رأوا شيخاً وسألوه، فقال لهم: بل يجب أن تنزل المرأة وتعمل بجانب زوجها في متجره؟ حتى لا يميل الزوج إلى الفساد. فما هو الفصل بين الفريقين؟ أفيدونا أفادكم اللَّه. ج1: لا يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال الأجانب، ومزاولتها البيع لهم، مع ما هم عليه من تجرّدهم من الملابس إلا ما يواري السوأتين؛ وذلك صيانةً للمرأة، وحفظاً لها من الفتنة وأسبابها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 3 - الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم الفتوى رقم (7794) س: تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي،
(1/739)
(أخت أبي) مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختاً شقيقة لي، وتوفيت رحمها اللَّه، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتاً تزوجها ابن عمتي (أخت أبي) المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها، وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان، وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي الزوجة الثالثة أخذ معه أختاً لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها، وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان، ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها، وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى. وإنني واللَّه يعلم أرى أنه ليس محرماً على جميع أخواتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال: نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت. إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه اللَّه لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله: هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما دمت حياً. وفي المقابل؛ فإن والدنا جزاه اللَّه
(1/740)
خيراً وعفا عنه، لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلاً في أمر ما لا نحب أحداً يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث: «لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم» (1). لذا آمل أن تبصرني في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضياً بهذا الوضع؟ وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان، ومقابلة أخواتي؟ وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا، أو السفر بها دون محرم آخر؟ وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ؟ وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل؟ وفقكم اللَّه لما يحبه ويرضاه. ج: أولاً: رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فهو ابن لها، وأخ لأولادها، ولا علاقة لأخوات الابن بهذه الرضاعة، ولا يصرن بها محارم لابن عمتهن المذكور. ثانياً: يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها، وابن العمة المذكور يعتبر من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك. ثالثاً: يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء: كعم الزوج وخاله وأخيه وابن العم والعمة والجار؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إياكم _________ (1) انظر: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341، وهو بلفظ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم».
(1/741)
والدخول على النساء». فقيل: أرأيت الحمو؟ فقال: «الحمو: الموت» (1). رابعاً: يحرم سفر المرأة بدون محرم، أو مع من هو غير محرم لها: كابن عمها وعمتها ونحوهما. خامساً: عليك دعوة والدك بالتي هي أحسن، وتبين الحكم له باللين والرفق؛ لعل اللَّه أن يهديه، وتعرض عليه هذه الفتوى، ولن يخالفها إن شاء اللَّه تعالى. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 4 - عمل المرأة السؤال الرابع من الفتوى رقم (19504) س4: امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها، وتضطر للعمل في أماكن مختلطة وبدون حجاب، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل. فما الحكم؟ ج4: لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي، والبعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم اللَّه، ومن ترك شيئا للَّه عوضه اللَّه خيراً منه، واللَّه جل شأنه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ _________ (1) البخاري، برقم 5232، مسلم، برقم 2172.
(1/742)
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (1). وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (2768) س6: فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة، تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل، مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات فاسخات ورجال، ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين؟ ج6: لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها؛ لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد، وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها، ومن يتق اللَّه يجعل له من أمره يسراً، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها: أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو في المكاتب بالدول غير الإسلامية- فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه، وهو الكفر باللَّه جل وعلا، فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، واجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة، والرجال على حدة؛ لما في الاختلاط من المفاسد _________ (1) سورة الطلاق، الآيتان: 2 - 3.
(1/743)
الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3626) س5: حكم الإسلام في عمل زوجتي الملتزمة بالزي الإسلامي بالإدارة، مع أن هذا العمل لضرورة، أي: مرتبي قليل ومكتري لمنزل. ج5: يجوز لها أن تعمل مدرسة أو في عمل إداري أو نحوهما ما دامت ملتزمة بأحكام الإسلام وآدابه من لبسها ما يستر عورتها، ومن عدم خلوتها أو اختلاطها برجال غير محارم لها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4873) س: زوجتي تعمل بالجامعة قسم الطالبات، ولا تتعرض بالاحتكاك بالرجال، وتلبس الزي الذي يخفي جسدها بما فيه الوجه، وهي تخدم طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية في قسم المكتبات، هل يجوز أن تعمل؟
(1/744)
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على زوجتك في الاستمرار في العمل المذكور. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (8259) س5: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في الخطوط الجوية كمضيفة أو في الفنادق وما إلى ذلك؟ ج5: أولاً: عملها في الخطوط الجوية كمضيفة يستلزم سفرها بلا زوج ولا محرم، كما يشهد له الواقع، ومع ذلك يعرضها للاحتكاك بالرجال، ورؤيتهم منها ما لا يحل لهم، وكل ذلك محرم. ثانياً: عملها في الفنادق مثار فتنة، ومدعاة لاختلاط بها مريب، ومظنة لخلوة الأجانب بها، وفي ذلك ما فيه من الشر المستطير وفساد المجتمع. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1/745)
5 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة السؤال الثالث من الفتوى رقم (2923) س3: هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط فيها السائقون والسائقات؟ ج3: لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن، ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالباً، وذلك من عورتها؛ ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن، ومثار الفساد. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1) عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز _________ (1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 17/ 239، وفي هذا المجلد فتاوى أخرى، 17/ 239 - 244.
(1/746)
6 - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة التاريخ 25\ 1 \ 1420 هـ. الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فمِّما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام، وفي هذه البلاد خصُوصاً، من كرامة وحشمة وَعَمَل لائقٍ بها، ونيلٍ لحقوقها الشرعية التي أوجبها اللَّه لها، خلافاً لما كانت تعيشه في الجاهلية، وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام، من تسيُّبٍ وضياعٍ وظلمٍ. وهذه نعمة نشكر اللَّه عليها، ويجب علينا المحافظة عليها، إلاَّ أنّ هناك فئاتٍ من الناس، ممن تلوثّت ثقافتهم بأفكار الغرب، لا يُرضيهم هذا الوضع المشرّف، الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياءٍ، وسترٍ، وصيانةٍ، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة، والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف، ويُطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في: 1 - هتك الحجاب الذي أمرها اللَّه به في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (1)، وبقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/747)
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1)، وبقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2)، وقول عائشة ل في قصة تخلّفها عن الركب، ومرور صفوان بن المعطل - رضي الله عنه - عليها، وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت: «وكان يراني قبل الحجاب» (3)، وقولها: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (4)، إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها، وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع، وكل من في قلبه مرض. 2 - ويطالبون بأن تُمَكَّن المرأةُ من قيادة السّيّارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد، وما يعرّضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. 3 - ويُطالبون بتصوير وجه المرأة، ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي، ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولا _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53. (3) صحيح البخاري، برقم 4141، ومسلم، برقم 2770، وتقدم تخريجه. (4) أخرجه أحمد، برقم 24021، وأخرجه أبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني: «حسن في الشواهد» وتقدم تخريجه.
(1/748)
شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب. 4 - يُطالبون باختلاط المرأة والرجال، وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلاً لها، ولا شك أنّ ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملاً لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلافُ ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحلّ له، ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تُحمد عقباها. ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» (1)، كلُّ ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة. فالواجبُ على المسلمين أن يُحافظوا على كرامة نسائهم، وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضلِلة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات، وانخدعت _________ (1) أخرجه أحمد، برقم 9645، وأبو داود، برقم 565، والشافعي في مسنده، ص 171، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 7/ 212، والإرواء، برقم 515، وتقدم تخريجه.
(1/749)
بها، من عواقب وخيمة، فالسعيد من وُعِظَ بغيره. كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة؛ حمايةً للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (1)، وقال عليه الصلاة والسلام: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً» (2)، ومن الخير لهنَّ المحافظةُ على كرامتهنَّ وعفتهنَّ، وإبعادهنَّ عن أسباب الفتنة. وفق اللَّه الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3) عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبوزيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز _________ (1) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (2) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،، باب خلق آدم وذريته، برقم 331، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم 1468. (3) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 17/ 244 - 248، وهذا البيان من اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز: في 25/ 1/ 1420هـ، وعليه ختمة حصل قبل وفاته بيومين حيث توفي 27/ 1/ 1420هـ، فهو يعتبر نصيحة مودِّعٍ من هذا الإمام الناصح للَّه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وجماعة المسلمين في كل مكان.
(1/750)
رابعاً: فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز:: 1 - الاختلاط في الدراسة الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وبعد: فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جريدة الجزيرة بعددها رقم 3754، وتاريخ 15/ 4/ 1403 هـ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية، ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير، وفساد كبير، لا يجوز فعله، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (1)، وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها، وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات, ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك، كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل، وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع الشرور، وقد جاءت الشريعة _________ (1) مسند الإمام أحمد، 11/ 369، برقم 6756، وبنحوه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم 495، الدارقطني، 1/ 231، في سنن البيهقي، 2/ 229، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 7.
(1/751)
الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث, ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيراً منها، وقد ذكر العلامة ابن القيم: في كتابه «إعلام الموقعين» منها تسعة وتسعين دليلاً، ونصيحتي للكاتب وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. نسأل اللَّه للجميع الهداية والتوفيق. ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير بسبب الاختلاط، وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما يشفي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ» (1)، فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك؛ فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها، ثم إخباره بخلقها وخُلُقها، وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية، وما ضرهم ذلك، بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي, والنادر خلاف ذلك لا حكم له. واللَّه المسؤول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم _________ (1) مسند الإمام أحمد، 22/ 440، برقم 14586، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، برقم 2084، وابن أبي شيبة، 4/ 21، برقم 17389، والحاكم، 2/ 166، في سنن البيهقي، 2/ 229، وصححه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 99.
(1/752)
وسعادتهم في العاجل والآجل، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يغلق عنهم أبواب الشر، ويكفيهم مكائد الأعداء، إنه جواد كريم، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. (1) 2 - الاختلاط بين الرجال والنساء من عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين، وفقني اللَّه وإياهم لفعل الطاعات، وجنبني وإياهم البدع والمنكرات. السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. أما بعد: فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه، بل يجب الحذر منه، والابتعاد عنه، وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم، لا يرون بذلك بأساً، بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم، وأن نياتهم طيبة، فتجد المرأة مثلاً تجلس مع أخي زوجها، أو زوج أختها، أو مع أبناء عمها، ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة. ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب، وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح , قال اللَّه - سبحانه وتعالى -: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ _________ (1) مجموع فتاوى ابن باز، 5/ 234 - 235 ..
(1/753)
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1)، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} الآية (2) , وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3)، والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة ل: «لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها» (4). وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وأن كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول اللَّه إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لتلبسها أختها من جلبابها» (5)، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53. (3) سورة الأحزاب، الآية: 59. (4) تفسير ابن أبي حاتم، برقم 17784، تفسير عبد الرزاق، 3/ 123، وأبو داود، برقم 4101، وصحح إسناده الألباني، وتقدم تخريجه. (5) البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، برقم 351، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم 890.
(1/754)
المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، فلم يأذن لهن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بالخروج بغير جلباب. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ل، قالت: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ» (1)، وقالت: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (2)، فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على اللَّه - عز وجل -، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً, فهم القدوة الصالحة لغيرهم. وعن عائشة ل قالت: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» (3)، رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، ففي قولها: «فإذا حاذونا» تعني «الركبان» سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه; لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً. _________ (1) البخاري، برقم 867، ومسلم، برقم 645، وتقدم تخريجه. (2) البخاري، برقم 869، ومسلم، برقم 445، تقدم تخريجه. (3) أخرجه أحمد، برقم 24021،وأبو داود، برقم 1835،وابن ماجه، برقم 2935، وتقدم تخريجه.
(1/755)
وإذا تأملنا السفور، وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة، منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها، وهي من أكبر دواعي الشر والفساد، ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بها، فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب، ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها، ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب, وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال, وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر؛ فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه، والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال, وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم. وقد «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم من المسجد، وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ» (1). ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (2)، فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها؛ بل يجب عليها ستره كما يحرم عليها الخلوة بهم، أو الاختلاط _________ (1) سنن أبي داود، برقم 5272، وتقدم تخريجه. (2) سورة النور، الآية: 31.
(1/756)
بهم، أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها، وقد بين - سبحانه وتعالى - من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1) أما أخ الزوج، أو زوج الأخت، أو أبناء العم، وأبناء الخال، والخالة ونحوهم، فليسوا من المحارم، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم؛ لما في ذلك من افتتانهم بها، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (2).متفق عليه. والمراد بالحمو أخ الزوج وعمه ونحوهما; وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها، وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها، ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم; لأن اللَّه حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في الآية السابقة، وليس _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) البخاري، برقم 5232، مسلم، برقم 2172، تقدم تخريجه.
(1/757)
أخ الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (1)، والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب، أو مصاهرة، أو رضاع كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم». وإنما نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية، ويمشي بينهم بالفساد، ويوسوس لهم، ويزين لهم المعصية، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ فإن الشيطان ثالثهما» (2)، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك، بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها، محافظة على الأعراض، وتعاوناً على البر والتقوى، وتنفيذاً لأمر اللَّه - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - , وأن يتوبوا إلى اللَّه - سبحانه وتعالى - مما سلف منها، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق، وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس؛ فإن الواجب على المسلم اتباع _________ (1) رواه البخاري، برقم 1862، ومسلم، برقم 1341، وتقدم تخريجه. (2) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه.
(1/758)
شرع اللَّه برضا وطواعية، ورغبة فيما عند اللَّه، وخوف من عقابه, ولو خالفه في ذلك أقرب الناس، وأحب الناس إليه، ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها اللَّه - سبحانه وتعالى - ; لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء, وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والنهي عما يخالفها. واللَّه المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته (1). _________ (1) مجموع فتاوى ابن باز، 5/ 236 - 240 ..
(1/759)
3 - [بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة الحمد للَّه, والصلاة والسلام على رسول اللَّه, أما بعد: فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة, ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها, منها: الخلوة المحرمة بالمرأة, ومنها: السفور, ومنها: الاختلاط بالرجال بدون حذر, ومنها: ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور, والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم، واعتبرها محرمة, وقد أمر اللَّه جل وعلا نساء - صلى الله عليه وسلم - النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت, والحجاب, وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع، قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (1) الآية. وقال تعالى «{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} (2). وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 33. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/760)
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (2). فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة. وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك, وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية، وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب من محبة الإباحية، والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم، وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه.
(1/761)
وقال اللَّه تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (1). وقال سبحانه: {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (2). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (3)، وعن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ»، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ _________ (1) سورة الأعراف، الآية: 33. (2) سورة البقرة، الآية: 168 - 169. (3) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، تقدم تخريجه.
(1/762)
تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» متفق عليه (1). وإنني أدعو كل مسلم أن يتق اللَّه في قوله وفي عمله, وأن يحذر الفتن والداعين إليها, وأن يبتعد عن كل ما يسخط اللَّه جل وعلا، أو يفضي إلى ذلك, وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الشريف، وقانا اللَّه شر الفتن وأهلها, وحفظ لهذه الأمة دينها، وكفاها شر دعاة السوء, ووفق كُتَّاب صحفنا، وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وصلاح أمر المسلمين، ونجاتهم في الدنيا والآخرة, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللَّه على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم (2). 4 - [بيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله (3) الحمد للَّه رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: _________ (1) البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم 3606، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، برقم1847. (2) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله -، 3/ 351 - 353. (3) نشر هذا الموضوع مركز الدعوة الإسلامية بلاهور. باكستان الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 1399 هـ الموافق مارس 1979 م.
(1/763)
فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط؛ سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة، أمر خطير جداً له تبعاته الخطيرة, وثمراته المرة, وعواقبه الوخيمة, رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى، فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختياراً أو اضطراراً بإنصاف من نفسه، وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي, والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر, ويجد ذلك واضحاً على لسان الكثير من الكُتَّاب، بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه. والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها, وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم اللَّه أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط; لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها اللَّه عليها.
(1/764)
فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخصّ الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي, ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع، ويهدم قيمه وأخلاقه. ومعلوم أن اللَّه تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيباً خاصاً يختلف تماماً عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها، والأعمال التي بين بنات جنسها. ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجاً لها عن تركيبها وطبيعتها, وفي هذا جناية كبيرة على المرأة، وقضاء على معنوياتها، وتحطيم لشخصيتها, ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث; لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف, فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم قد فصلت منه، وعزلت تماماً عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره؛ ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه. فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب, والمرأة تقوم بتربية الأولاد
(1/765)
والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار، وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن، ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعاً للبيت بمن فيه, ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياً، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً وصورة، لا حقيقة ومعنى. قال اللَّه جل وعلا: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1)، فسنة اللَّه في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك, وأمر اللَّه سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط، وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك; لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه, وفي ذلك مخالفة لأمر اللَّه، وتضييع لحقوقه المطلوب شرعاً من المسلمة أن تقوم بها. والكتاب والسنة دلاَّ على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال اللَّه جل وعلا: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ _________ (1) سورة النساء، الآية: 24.
(1/766)
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (1)، فأمر اللَّه أمهات المؤمنين- وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد; لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى, ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة، وإيتائهن الزكاة، وطاعتهن لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - , ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم، وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب، ويطهرها من الأرجاس والأنجاس، ويرشد إلى الحق والصواب. وقال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (2)، فأمر اللَّه نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب، وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلاً لئلا تحصل لهن _________ (1) سورة الأحزاب، الآيتان: 33 - 34. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59.
(1/767)
الأذية من مرضى القلوب، فإذا كان الأمر بهذه المثابة، فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم, وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة, والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها، ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. قال اللَّه جل وعلا: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1). يأمر اللَّه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض النظر، وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم، ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، ولا شك أن إطلاق البصر، واختلاط النساء بالرجال، والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة, وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه، وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له، فاقتحامها هذا الميدان معه، واقتحامه الميدان معها، لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر، _________ (1) سورة النور، الآيتان: 30 - 31.
(1/768)
وإحصان الفرج، والحصول على زكاة النفس وطهارتها. وهكذا أمر اللَّه المؤمنات بغض البصر، وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها, وأمرهن اللَّه بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها; لأن الجيب محل الرأس والوجه, فكيف يحصل غض البصر، وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال، واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير, كيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها، وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال، أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ والإسلام حرّم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة, وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن، كما في قوله - عز وجل -: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} (1)، يعني مرض الشهوة، فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم، وأن يكلموها, ولا بد أن ترقق لهم الكلام، وأن يرققوا لها الكلام, _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 32.
(1/769)
والشيطان من وراء ذلك يُزَيِّن ويُحَسِّن، ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له, واللَّه حكيم عليم؛ حيث أمر المرأة بالحجاب, وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب يمنع- بإذن الله- من الفتنة، ويحجز دواعيها, وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء, والبعد عن مظان التهمة، قال اللَّه - عز وجل -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1) الآية. وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها. وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب; لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر، أو غير مباشر, وأمرها بالقرار في البيت، وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي, وقد سمى اللَّه مكث المرأة في بيتها قراراً, وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها، وراحة لقلبها، وانشراح لصدرها، فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها، وقلق قلبها، وضيق صدرها، وتعريضها لما لا تحمد عقباه, ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم، وعن السفر إلا مع ذي محرم, سداً لذريعة الفساد، وإغلاقاً لباب الإثم، وحسماً لأسباب الشر, وحماية للنوعين من مكايد الشيطان, ولهذا صح عن _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/770)
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (1)، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (2). وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نوّر اللَّه قلبه، وتفقّه في الدين، وضمّ الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحده لا يتجزأ بعضها عن بعض, ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بعض الغزوات, والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد, لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن، وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصر, ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الغزو، فقياس هذه على تلك يعتبر قياساً مع الفارق، وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا, وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم, وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب اللَّه، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسَّعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط، فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان _________ (1) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (2) مسلم، برقم 2742، تقدم تخريجه.
(1/771)
من ميادين الحياة مع الرجال، تزاحمهم ويزاحمونها، وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ، لم نجد هذه الظاهرة, أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل, كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود; لأن طبيعة الرجال إذا التقت مع طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام, وبعض الشيء يجر إلى بعض, وإغلاق الفتنة أحكم وأحزم، وأبعد من الندامة في المستقبل. فالإسلام حريص جداً على جلب المصالح، ودرء المفاسد، وغلق الأبواب المؤدية إليها, ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة، وفساد مجتمعها كما سبق; لأن المعروف تاريخيّاً عن الحضارات القديمة: الرومانية، واليونانية، ونحوهما، أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال، ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال, وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي .. وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل، وخسران الأمة, وعدم انسجام الأسرة، وانهيار
(1/772)
صرحها, وفساد أخلاق الأولاد, ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر اللَّه به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها، فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء، وجميع ما فيه مسؤوليات عامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة» (1)، رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال، يعتبر مخالفاً لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها، فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل, وقد ثبت من التجارب المختلفة- وخاصة في المجتمع المختلط- أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطريّاً ولا طبيعيّاً, فضلاً عما ورد في الكتاب والسنة واضحاً جليّاً في اختلاف الطبيعتين والواجبين. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - المنشأ في الحلية، وهو في الخصام غير مبين- بالرجال, يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما. لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية، والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاختلاط، واشتراك المرأة في أعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق, ولكن نظراً إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام اللَّه، _________ (1) رواه البخاري، برقم 4425، وتقدم تخريجه.
(1/773)
وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وكلام علماء المسلمين, رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك, ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء، وحمايتهن من وسائل الإضرار بهن، والانتهاك لأعراضهن. قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: «إن الاختلاط يألفه الرجال, ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها, وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهاهنا البلاء العظيم على المرأة ... إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد». وقال شوبنهور الألماني: «قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده، وباذخ رفعته, وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة، حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانها، ودنيء آرائها». وقال اللورد بيرون: «لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء اليونان، لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة، ولرأيت معي وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه، وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير» اهـ. وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: «إن النظام الذي يقضي
(1/774)
بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد، فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية, لأنه هاجم هيكل المنزل, وقوّض أركان الأسرة, ومزق الروابط الاجتماعية؛ فإنه يسلب الزوجة من زوجها، والأولاد من أقاربهم، فصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة, إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية، مثل ترتيب مسكنها، وتربية أولادها، والاقتصاد في وسائل معيشتها، مع القيام بالاحتياجات البيتية, ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل خالية، وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية, وتلقى في زوايا الإهمال، وطفئت المحبة الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة، والقرينة المحبة للرجل, وصارت زميلته في العمل والمشاق, وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة». وقالت الدكتورة إيدايلين: «إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا، وسر كثرة الجرائم في المجتمع، هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل، وانخفض مستوى الأخلاق، ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه». وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: «إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقاً إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة».
(1/775)
وقال عضو آخر: «إن اللَّه عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد، لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج؛ بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال». وقال شوبنهور الألماني أيضاً: «اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب، ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة، ولا تنسوا أنكم سترثون معي للفضيلة والعفة والأدب، وإذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة» (1). ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط التي هي نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال، لطال المقال، ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة. والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها، والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها، هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها, وفيه صلاحها وصلاح المجتمع، وصلاح الناشئة، فإن كان عندها فضل، ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية، كالتعليم للنساء، والتطبيب والتمريض، لهن ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء، كما سبقت الإشارة إلى ذلك, وفيها شغل لهن شاغل، وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع، وأسباب رُقِيِّهِ, كُلٌّ في جهة اختصاصه, ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي اللَّه _________ (1) ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي - رحمه الله - في كتابه: المرأة بين الفقه والقانون.
(1/776)
عنهن، ومن سار في سبيلهن, وما قمن به من تعليم للأمة، وتوجيه وإرشاد, وتبليغ عن اللَّه سبحانه، وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فجزاهن اللَّه عن ذلك خيراً, وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة، والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم. واللَّه المسؤول أن يبصر الجميع بواجبهم, وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه, وأن يقي الجميع وسائل الفتنة، وعوامل الفساد، ومكايد الشيطان, إنه جواد كريم، وصلى اللَّه على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (1). 5 - حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية الحمد للَّه رب العالمين، والسلام على عبده ورسوله محمد صلى اللَّه عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم، واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد: فقد اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية في الأول من شهر رمضان عام 1400 هـ من اعتزام فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية على توظيف النساء في الدوائر الحكومية للقيام بأعمال النسخ والترجمة والأعمال الكتابية الأخرى، ثم قرأت ما _________ (1) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله -، 1/ 418 - 427، وانظر: مجموع فتاويه، 4/ 254 - 258، و4/ 308 - 310.
(1/777)
كتبه الأخ الناصح محمد أحمد حساني في صحيفة الندوة في عددها الصادر في 8/ 9/ 1400 هـ تعقيباً على ذلك الخبر، وكان صادقاً وناصحاً للأمة في تعقيبه، فشكر اللَّه له وأثابه، ذلك أن من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط، وذلك أمر خطير جداً، له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه، مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال، والأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم اللَّه - أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. منها قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (1)، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2). _________ (1) سورة الأحزاب، الآيتان: 33 - 34. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/778)
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1). وقال اللَّه جل وعلا: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}، إلى أن قال سبحانه: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)، وقال: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، - يعني الأجنبيات- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (3)، ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم، سداً لذريعة الفساد، وإغلاقاً لباب الإثم، وحسماً لأسباب الشر، وحماية للنوعين من مكائد الشيطان، ولهذا صحّ عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 59. (2) سورة النور، الآيتان: 30 - 31. (3) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم 5232، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2172، وتقدم تخريجه.
(1/779)
أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (1). وصحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «وَلا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (3)، وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب القرار في البيت، والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد، وتقويض الأسر، وخراب المجتمعات، فما الذي يلجئنا إلى مخالفتها، والوقوع فيما يغضب اللَّه، ويحل بالأمة بأسه وعقابه؟، ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير، وصارت تتحسر على ما فعلت، وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها الآن!! لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها، وجعلها تعمل في غير وظيفتها؟!، لقد نادى العقلاء هناك، وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها اللَّه له، وركبَّها عليه جسميّاً ونفسيّاً وعقليّاً، ولكن بعد ما فات الأوان. ألا فليتق اللَّه المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لتعليم البنات، وليراقبوه سبحانه فلا يفتحوا على الأمة باباً عظيماً من _________ (1) البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. (2) مسلم، برقم 2742، وتقدم تخريجه. (3) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه.
(1/780)
أبواب الشر، إذا فتح كان من الصعب إغلاقه، وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعباً هو العمل على ما يبقيه مجتمعاً متماسكاً قوياً، سائراً على نهج الكتاب والسنة، وسد أبواب الضعف والوهن، ومنافذ الشرور والفتن، ولا سيما ونحن في عصر تكالب الأعداء فيه على المسلمين، وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون اللَّه، ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم، فلا يجوز لنا أن نفتح أبواباً من الشر مغلقة. ولعل في كلمتي هذه ما يُذكِّر المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لتعليم البنات بما يجب عليهم من مراعاة أمر اللَّه ورسوله، والنظر فيما تمليه المصلحة العامة لهذه الأمة، والاستفادة مما قاله الأخ محمد أحمد حساني من أن عملية نقص الموظفين لا تعالج بالدعوة إلى إشراك النساء في وظائف الرجال؛ سداً للذريعة، وقفلاً لباب المحاذير، بل إن العلاج الصحيح يكون بإيجاد الحوافز لآلاف الشبان الذين لا يجدون في العمل الحكومي ما يشجع للالتحاق به، فيتجهون إلى العمل الحر، أو إلى المؤسسات والشركات، ومن هنا منطلق العلاج الصحيح، وهو تبسيط إجراءات تعيين الموظفين، وعدم التعقيد في الطلبات، وإعطاء الموظف ما يستحق مقابل جهده، وعندها سوف يكون لدى كل إدارة فائض من الموظفين، هذا وإنني مطمئن إن شاء اللَّه إلى أن المسؤولين بعد قراءتهم لهذه الكلمة سيرجعون عما فكروا فيه من تشغيل المرأة بأعمال الرجال، إذا علموا أن ذلك محرم بالكتاب
(1/781)
والسنة، ومصادم للفطرة السليمة، ومن أقوى الأسباب في تخلخل المجتمع، وتداعي بنيانه، وهو مع ذلك أمنية غالية لأعداء المسلمين، يعملون لها منذ عشرات السنين، وينفقون لتحقيقها الأموال الطائلة، ويبذلون لذلك الجهود المضنية، ونرجو أن لا يكون أبناؤنا وإخواننا معينين لهم أو محققين لأغراضهم. أسأل اللَّه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكايد الأعداء ومخططاتهم المدمرة، وأن يوفق المسؤولين فيها إلى حمل الناس على ما يصلح شؤونهم في الدنيا والآخرة، تنفيذاً لأمر ربهم وخالقهم، والعالم بمصالحهم، وأن يوفق المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لتعليم البنات لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن، وأسباب النقم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان (1). الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز. _________ (1) مجموع فتاوى ابن باز - رحمه الله -، 6/ 355 - 358.
(1/782)
6 - حكم مصافحة النساء من وراء حائل (1) س: الأخ الذي رمز لاسمه: ر. ع. ق. أ - من المعهد العلمي بحوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية يسأل عن: حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزاً، وكذلك يسأل عن: الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه؟ ج: لاتجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً؛ سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً؛ لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صحّ عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إني لا أصافح النساء» (2). وقالت عائشة ل: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ» (3)، ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. واللَّه ولي التوفيق (4). _________ (1) نشرت في (المجلة العربية)، في باب {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}. (2) طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، برقم 27006، والترمذي، برقم 1597، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323، تقدم تخريجه. (3) البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، برقم 5288، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم 1866. (4) مجموع فتاوى ابن باز، 6/ 359.
(1/783)
7 - أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات (1) القسم الأول س1: هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال, خاصة مع وجود ممرضين من الرجال؟. ج1: الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء, هذا واجب, كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال، والطبيبات للنساء, إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل، فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة, وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة، فلا حرج في علاجها له, وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء, هذا هو الواجب, وهكذا الممرضات والممرضون, الممرض للرجال، والممرضة للنساء, حسماً لوسائل الفتنة, وحذراً من الخلوة المحرمة. س2: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال, وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء وغيرهم, فما حكم الشرع في ذلك, وهل علينا إثم في السكوت؟ ج2: الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات, وألا ترتفع أصواتهم عندهم, بل يكون ذلك في _________ (1) هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته بمستشفى النور بمكة المكرمة عام 1401هـ في شهر رجب.
(1/784)
محلات أخرى, أما المصافحة، فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه, أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني لا أصافح النساء» (1). وقالت عائشة ل: «واللَّه ما مسَّت يد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام» (2). فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها, فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض، ولا غيرهم ممن ليس محرماً لها, بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه, لكن بدون مصافحة، وبدون تكشف، فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب; لأن المرأة عورة وفتنة، واللَّه جل وعلا يقول: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (3). ويقول سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} (4) الآية، والرأس والوجه من أعظم الزينة, وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي والخضاب، فكله فتنة للآيتين المذكورتين, والمقصود أنها كلها عورة, فالواجب عليها التستر، والبعد عن _________ (1) طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، برقم 27006، والترمذي، برقم 1597، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323، تقدم تخريجه. (2) البخاري، برقم 5288، ومسلم، برقم 1866، تقدم تخريجه. (3) سورة الأحزاب، الآية: 53. (4) سورة النور، الآية: 31.
(1/785)
أسباب الفتنة; ومن أسباب الفتنة: المصافحة. س3: بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة، يلبسن لباساً ضيقاً، ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن, ما حكم الشرع في ذلك؟ ج3: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين اللَّه تعالى، وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن, بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً, ساتراً لهن ستراً شرعياً، مانعاً من أسباب الفتنة, للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق, ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» (1). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» (2)، رواه مسلم في صحيحه, وهذا وعيد عظيم, أما الرجال الذين بأيديهم سياط، فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم. فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق, أما النساء الكاسيات _________ (1) أخرجه الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، برقم 1685، ومصنف ابن أبي شيبة، برقم 7698، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 1/ 303، وتقدم تخريجه. (2) مسلم، برقم 2128، تقدم تخريجه.
(1/786)
العاريات، فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن: إما لقصرها، وإما لرقتها, فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة, مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن, وكل هذا نوع من العري, فالواجب تقوى اللَّه في ذلك، والحذر من هذا العمل السيئ, وأن تكون المرأة مستورة، بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال, وشرع لها ذلك بين النساء، فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء, والواجب تقوى اللَّه على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض والممرضة, لا بد من تقوى اللَّه في حق الجميع, كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى اللَّه في ذلك، وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة, واللَّه الهادي إلى سواء السبيل. س4: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين, وما حكم العلاج بالموسيقى؟ ج4: الحفلات لا تكون بالاختلاط, بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم، وحفلات النساء للنساء وحدهن, أما الاختلاط فهو منكر، ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ باللَّه من ذلك. أما العلاج بالموسيقى، فلا أصل له، بل هو من عمل السفهاء, فالموسيقى ليست بعلاج، ولكنها داء, وهي من آلات الملاهي, فكلها مرض للقلوب، وسبب لانحراف الأخلاق, وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة
(1/787)
والأحاديث النافعة, أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل، ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم, ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة, ولا حول ولا قوة إلا باللَّه. س5: أنا ممرض، وأعمل في تمريض الرجال، ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي، ويستمر ذلك حتى الفجر, وربما حصل بيننا خلوة كاملة, ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة، ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع، فهل نترك الوظيفة مخافة للَّه، وليس لنا وظيفة أخرى للرزق, نرجو توجيهنا بما ترون؟ ج5: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة, بل هذا غلط ومنكر عظيم, وهذا معناه الدعوة للفاحشة؛ فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد؛ فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها, ولهذا صح عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» (1)، فلا يجوز هذا العمل, والواجب عليك تركه; لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم اللَّه - عز وجل - , وسوف يعوضك اللَّه خيراً منه إذا تركته للَّه سبحانه؛ لقول اللَّه - عز وجل -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2). _________ (1) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه. (2) سورة الطلاق، الآيتان: 2 - 3.
(1/788)
وقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (1)، وهكذا الممرضة، عليها أن تحذر ذلك، وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها; لأن كل واحد منكما مسؤول عما أوجب اللَّه عليه، وما حرم عليه. س6: أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة, وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى, فما هو رأي الشرع في هذا؟ ج6: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها؛ فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة, ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة, لا في غرفة الكشف, ولا في غيرها؛ للحديث السابق؛ ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم اللَّه, ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم, وعلى النساء للنساء وحدهن. س7: بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل, وقد يكون ذلك جهلاً منهن بهذا أثناء العمل؟ ج7: إذا كنّ يراهنّ الرجال؛ فلا يجوز لهنّ ذلك, أما بين النساء فلا بأس, ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه; لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2). وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ _________ (1) سورة الطلاق، الآية: 4. (2) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(1/789)
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} (1) الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس واليد والقدم والصدر , فكل هذا من الزينة. القسم الثاني (2) س1: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان, هل يجوز, علماً بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال، ونفس البلد؟ ج1: لقد سعينا كثيراً وعملنا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء, وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها, وهذا هو الحق; لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم اللَّه, فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل، فهذا لا بأس به, واللَّه يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (3)، وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء; وأن يكون قسم الأطباء على حدة، وقسم الطبيبات على حدة; أو يكون مستشفى خاصاً للرجال، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار, هذا _________ (1) سورة النور، الآية: 31. (2) هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بمستشفى النور في مكة يوم الإثنين 27\ 7\1412هـ. (3) سورة الأنعام، الآية: 119.
(1/790)
هو الواجب على الجميع. س2: أنا طبيب حصلت على بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي, ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر، وكيف تحافظ على الحجاب, وهل كشف الوجه محرم، خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد؟ ج2: الواجب التستر والحجاب على المؤمنة; لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة, قال تعالى في كتابه العظيم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1)، فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب, وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع. ويقول اللَّه جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} الآية، والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية, قال سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} (2) الآية, فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي, وهو من ليس محرماً لها؛ لعموم الآيات المذكورات; ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها, لكن لا مانع من اتخاذ النقاب، وهو الذي فيه نقب للعين أو _________ (1) سورة الأحزاب، الآية: 53. (2) سورة النور، الآية: 31.
(1/791)
للعينين فقط, فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن، فعن الكافر من باب أولى, ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام (1). _________ (1) مجموع فتاوى ابن باز، 9/ 425 - 435.
(1/792)
خامساً: فتوى الشيخ العلاّمة محمد بن صالح بن عثيمين: في قيادة المرأة: السؤال: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول: إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ «الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين: القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. والقاعدة الثانية: أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم مقدم على جلب المصالح. فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1)، فنهى الله تعالى عن سبِّ آلهة المشركين مع أنه مصلحة لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (2)، وقد حرَّم اللَّه تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما. وبناءً على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة؛ فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة. _________ (1) سورة الأنعام، الآية: 108. (2) سورة البقرة، الآية: 219.
(1/793)
فمن مفاسد هذا: نزع الحجاب؛ لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة، ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل: جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلاَّ إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلابد من التقييد، فيقال: جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين. وبهذا عُرف أن الوجه مدار قصد. وربما يقول قائل: إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب بأن تتلثم المرأة، وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم طويلاً، بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان كما صحّ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة، وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة؛ ولهذا كانت مضرب المثل فيه، ويقال: أحيا من العذراء في خدرها، وإذا نُزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها. ومن مفاسدها: أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت، والبيت
(1/794)
خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة؛ ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. ومن مفاسدها: أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت، وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده؛ لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل، وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب، فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يميناً وشمالاً في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضاً. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب، وهم أقوى تحملاً من المرأة. ومن مفاسدها: أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة، مثال ذلك: الوقوف عند إشارات الطريق، وفي الوقوف عند محطات البنزين، وفي الوقوف عند نقط التفتيش، وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة أو حادث، وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء (البنشر)، وفي الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف رجلاً سافلاً يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها،
(1/795)
لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة ازدحام السيارات في الشوارع، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات، وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة الحوادث؛ لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزماً وأقصر نظراً وأعجز قدرة، فإذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف. ومن مفاسدها: أنها سبب للإرهاق في النفقة؛ فإن المرأة بطبيعتها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زيّ رمت بما عندها، وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها؟ ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك - بل لعله أولى منه - السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما. واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه
(1/796)
وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها، وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدوّ متربّص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام، يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي، فأُعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرّروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته: هربوا من الرّق الذي خلقوا له ... وبلوا برق النفس والشيطان وظنَّ هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدّم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر، وما ذلك إلاَّ لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية، وما تنطوي عليه من حِكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد، فنسأل اللَّه لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة» (1). _________ (1) من كتاب (الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام. إعداد خالد الجريسي: ص 556).
(1/797)
سادساً: فتوى الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة: (س: هل يجوز قيادة المرأة للسيارة عند حاجتها، وعدم وجود محرم لها لتلبية طلباتها الضرورية بدلاً من الركوب مع السائق الأجنبي؟ جزاكم اللَّه خيراً. ج: قيادة المرأة للسيَّارة لا تجوز؛ لأنها تحتاج معها إلى كشف الوجه، أو كشف بعضه؛ ولأنها تحتاج في قيادة السيارة إلى مُخالطة الرجال فيما لو تعطَّلت سيارتها أثناء السير، أو حصل عليها حادث، أو مخالفة مرورية؛ ولأنَّ قيادتها للسيّارة تُمكِّنها من الذهاب إلى مكان بعيد عن بيتها، وعن الرّقيب عليها من محارمها، والمرأةُ ضعيفةٌ تتحكَّم فيها العواطف والرَّغبات غير الحميدة، وفي تمكينها من القيادة إفلاتٌ لها من المسؤولية والرَّقابة والقوامة عليها من رجالها؛ ولأنّ قيادتها للسيّارة تُحوجها إلى طلب رُخصة قيادة، وهذا يُحوجها إلى التصوير، وتصويرُ النساء حتى في هذه الحالة يَحرمُ لِما فيه من الفتنة والمحاذير العظيمة» (1). _________ (1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان، 3/ 466.
(1/798)
سابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيد في التحذير من الدُّعاة لقيادة المرأة للسيَّارة والآلات الأخرى حيثُ ذكر: أنَّ الدعوة إلى قيادة المرأة للسيَّارة والآلات الأخرى واحدة من خُطَط المُسغربين وأتباعهم من سَذّجَةِ الفُسَّاقِ المُنْدَسِّين في ساحةِ بلاد المسلمين، يُفوِّقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين، وإنزاله بهنَّ (1). _________ (1) ينظر: حراسة الفضيلة، ص 122 - 123 - 125.
(1/799)
ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر: س: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟ والجواب على هذا السؤال إجمالاً من وجوه، منها: الأول: أن الدولة السعودية قامت على أساس تحكيم شرع اللَّه، ومن أجل ذلك مكَّن اللَّه لها في الأرض ومن تحكيمها لشرع اللَّه بقاؤها محافظة على احتجاب النساء عن الرجال، وعدم الاختلاط بهم وقيادتهن السيارات. الثاني: أن من الإدارات الحكومية في هذه الدولة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا غرو أن تبقى محافظة على الحجاب وترك اختلاط النساء بالرجال، وترك كل ما يؤدي إليه من كل ما هو منكر. الثالث: محافظتها على ابتعاد النساء عن مخالطة الرجال، وذلك بفصل الدراسة بين النوعين، فدراسة البنين على حدة، ودراسة البنات على حدة. الرابع: أن قيادة المرأة السيارة يقودها إلى ترك الحجاب والاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة والسفر بدون محرم وغير ذلك من المحاذير، والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع التي تؤدي إلى الحرام، ومن أدلة ذلك قول اللَّه - عز وجل -: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
(1/800)
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1)، فسبُّ آلهة الكفار حق، ولكنه نُهي عنه لما يترتب عليه من الباطل، وهو كون الكفار يسبون اللَّه، ومن أمثلة ذلك بيع السلاح لاستعماله في الفتنة، وبيع العنب على من يصنع منه الخمر؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. الخامس: أن من قواعد الشريعة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، ومن المعلوم أن المفاسد المترتبة على قيادة المرأة السيارة كثيرة وخطيرة، فيكون المنع مندرجاً تحت هذه القاعدة. السادس: أن المنع من قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد مبني على فتاوى أهل العلم كما سيأتي ذلك موضحاً. السابع: أنه ليس بغريب ولا عجيب أن تنفرد هذه البلاد عن غيرها بالمحافظة على الحجاب وترك الاختلاط ومنع المرأة من قيادة السيارة؛ لأن هذه البلاد معقل الإسلام، وفيها قبلة المسلمين والحَرَمان الشريفان، وفيها تُؤدّى مناسك الحج والعمرة، وفيها وُوري الجسد الشريف لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ومنها شع النور وانطلق الهداة المصلحون من الصحابة ومَن بعدهم في أنحاء الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الثامن: أن انفراد هذه البلاد عن غيرها بترك الاختلاط بين _________ (1) سورة الأنعام، الآية: 108.
(1/801)
الرجال والنساء وعدم قيادة المرأة السيارة تمسُّك بما هو حق، والحق لا يُزهَد فيه لقلة السالكين، كما أنه لا يُغتر بالباطل لكثرة الواقعين فيه، فكل عاقل ناصح لنفسه يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، وقد قال اللَّه - عز وجل -: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (1). التاسع: أن قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من الديمقراطية الزائفة التي استوردها المسلمون من أعدائهم، وقد قال الله - عز وجل -: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (2)، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} (3)، وقال: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} (4)، وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ _________ (1) سورة الأنعام، الآية: 116. (2) سورة المائدة، الآية: 49. (3) سورة آل عمران، الآية: 149. (4) سورة البقرة، الآية: 120.
(1/802)
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} (1). العاشر: أن ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد حق مَنَّ اللَّه على هذه الدولة بالمحافظة عليه، ولم يكن ما يقابل ذلك من الاختلاط والقيادة، حقاً حُجب عن هذه الدولة في الماضي ولكنه شر وقاها اللَّه منه، ونسأل اللَّه - عز وجل - أن يقيها منه في المستقبل (2). _________ (1) سورة الجاثية، الآيتان: 18 - 19. (2) كتاب: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية، للعلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، ص 9 - 13.
(1/803)
تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز: عن الاختلاط بالنساء قال: في بيان طويل لرعيته، منه قوله: « ... أقبح ما هنالك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن، وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها، حتى نبذن وظائفهن الأساسية: من تدبير المنزل، وتربية الأطفال، وتوجيه الناشئة - الذين هم فلذات أكبادهن وأمل المستقبل - إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق، ونسين واجباتهن الخُلُقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة، ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن، فلا - واللَّه! - ليس هذا (التمدن) في شرعنا وعرفنا وعادتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام ومروءة أن يرى زوجته، أو أحداً من عائلته أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى هوَّة الدمار، ولا يقبل السير عليها إلاَّ رجل خارج عن دينه، خارج من عقله، خارج من تربيته. فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها. إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقاً يتمتعن بها، لا توجد حتى
(1/804)
الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة، وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب، فلا نجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي إذا وجَّهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية، وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين، من أرباب الحصانة والإنصاف. ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب، واجتمع بهم كثير ممن نثق بهم من المسلمين، وسمعناهم يشكون مرَّ الشكوى من تفكك الأخلاق، وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد، وهم يقدِّرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدنا، وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود البشرية إلى طريق الهدى وساحل السلامة، ويودّون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم هذه التي يتشاءمون منها، وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة. وهؤلاء نوابغ كتَّابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوة السحيقة التي أمامهم، والمنقادين إليها بحكم الحالة الراهنة، وهم لا يفتؤون في تنبيه شعوبهم بالكتب والنشرات والجرائد على عدم الاندفاع في هذه الطريق، التي يعتقدونها سبب الدمار والخراب. إنَّني لأعجب أكبر العجب ممن يدَّعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده، من الشبيبة التي ترى بأعينها، وتلمس بأيديها ما نوَّهنا عنه من الخطر الخلقي الحائق بغيرنا من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك، وتتبارى في طغيانها، وتستمر في عمل كلِّ أمر يخالف تقاليدنا
(1/805)
وعاداتنا الإسلامية والعربية، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاءنا به نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة وهدى لنا ولسائر البشر. فالواجب على كل مسلم وعربي فخور بدينه، مُعتزٍّ بعربيته، ألاّ يخالف مبادئه الدينية، وما أمر به اللَّه تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش، والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه، فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة، والعلم الصحيح، والسير على الأخلاق الكريمة، والانصراف عن الرذيلة، وكل ما من شأنه أن يمس الدينَ والسمتَ العربي والمروءةَ، والتقليدِ الأعمى، وأن يتبع طرائق آبائه وأجداده، الذين أتوا بأعاظم الأمور باتباعهم أوامر الشريعة، التي تحث على عبادة اللَّه وحده، وإخلاص النية في العمل، وأن يعرف حق المعرفة معنى ربه، ومعنى الإسلام وعظمته، وما جاء به نبينا: ذلك البطل الكريم والعظيم - صلى الله عليه وسلم -، من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين، وتُعَلِّمُه أن العزّة للَّه وللمؤمنين، وأن يقوم بأود عائلته، ويصلح من شأنها، ويتذوق ثمرة عمله الشريف، فإذا عمل فقد قام بواجبه وخدم وطنه وبلاده ... » (1). _________ (1) من كتاب المصحف والسيف: مجموعة من خطابات وكلمات ومذكرات وأحاديث جلالة الملك عبد العزيز آل سعود:، جمع وإعداد: محيي الدين القابسي، ص 322. وفيه أن هذا البيان أعلنه: عام 1356 هـ. وهذا البيان كذلك في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، 16/ 55 - 76، مجموع رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا، جمع العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 1312هـ- 1392هـ، الطبعة الثانية، 2004م.
(1/806)
عاشراً: خطاب الملك فهد: التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال جاء في خطاب الملك فهد: التعميمي رقم: 2966/م وتاريخ 19/ 9/ 1404 هـ ما نصّه: «نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/ 5/ 1403 هـ المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال؛ سواء في الإدارات الحكومية، أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن، سواء كانت سعودية أو غير سعودية؛ لأن ذلك محرم شرعاً، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها، أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال، فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه» (1). _________ (1) من مجلة البحوث الإسلامية، العدد 15، ص 274.
(1/807)
الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادة النساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين أنه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 20/ 4/1411 هـ من كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز: الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن غديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن لحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر والمحافظة على الحرم ومنع بوادر الشر؛ لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن. ونظراً إلى أن قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه، فإن وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعاً باتاً، ومن يخالف هذا
(1/808)
المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل. (من صحيفة الجزيرة في عددها 6621، الصادر يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني 1411 هـ) (1). _________ (1) انظر: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية، للعلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، ص 21 - 28.
(1/809)
الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال لأهمية شان المرأة والاهتمام به، فقد تقرر الأمر من ديوان مجلس الوزراء، بمنع النساء من العمل، الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، كما ذكر ذلك في التعميم الآتي: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صاحب السمو الملكي، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني، بعد التحية: بناءً على ما لاحظنا: من قيام بعض الجهات الحكومية، بالرفع عن طلب السماح لها، بالتعاقد، أو تعيين عدد من السيدات السعوديات، للعمل بها، أو الترخيص لهن بممارسة بعض الأعمال، أو المهن، التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال. ولأنه سبق أن صدر الأمر رقم 1960/ 8، وتأريخ 22/ 12/1399هـ بمنع النساء من العمل في الوظائف، التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، كما صدر الأمر رقم 11575، وتأريخ 19/ 5/1401هـ بالتأكيد على ذلك، وعدم الترخيص للمرأة بممارسة المهن التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال. نخبركم: بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها
(1/810)
بالرجال، سواء في الإدارات الحكومية، أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة، أو الشركات، أو المهن، ونحوها، أمر غير ممكن، سواء كانت سعودية، أو غير سعودية. لأن ذلك محرم شرعاً، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد؛ وإذا كان يوجد دائرة، تقوم بتشغيل المرأة، في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها، أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال، فهذا خطأ يجب تلافيه. وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك، والرفع عنه; وقد زودت الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا، للاعتماد والإحاطة، فأكملوا ما يلزم بموجبه. توقيع رئيس مجلس الوزراء (1) وصلى اللَّه وسلَّم وبارك على عبده، وخليله، وأمينه على وحيه، حبيبنا، ونبينا؛ محمد بن عبد اللَّه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. _________ (1) كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، 16/ 98 - 99.
(1/811)
المصادر:
1 جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
2 موقع الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني
التصانيف العلمية:
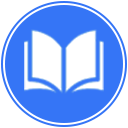 قراءة
قراءة